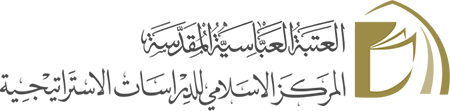
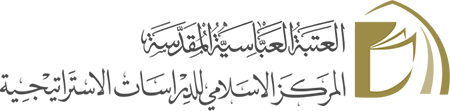
الحق والتكليف
في الإسلام
(1)بسم الله الرحمن الرحيم
(2)دراسات دينية معاصرة 2
الحقّ والتكليف
في الإسلام
المرجع الديني
سماحة الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
تعريب : السيد هاشم الميلاني
العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
(3)جوادي آملي ، عبد الله ، 1350هجري - مؤلف .
الحق والتكليف في الإسلام / المرجع الديني سماحة الشيخ عبد الله الجوادي الآملي ؛ تعريب السيد هاشم الميلاني .-الطبعة الاولى .- النجف ، العراق .- العتبة العباسية المقدسة ، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ، 1444 هـ .= 2022 .
294 صفحة ؛ 24سم . - (دراسات دينية معاصرة : 2)
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية : صفحة 285 - 294
ردمك : 9789922680088
النص باللغة العربية مترجم من اللغة الفارسية .
1. الايمان (اسلام). 2. الحقيقة (فلسفة). 3. الدين والانسان. أ. الميلاني ، هاشم ، مترجم. ب . العنوان .
LCC:BP166.78 .J39 2022
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
فهرسة اثناء النشر
(4)مقدّمة المركز13
المقدّمة15
الفصل الأوّل: المفاهيم والكلّيّات19
مفهوم الحقّ19
المعنى الفلسفيّ للحقّ20
مفهوم الحقّ في الفقه20
مفهوم الحقّ في اصطلاح المحامين22
الاتّجاه الجديد في الحقّ23
مفهوم الحقّ في قاموس الدين24
تعريف التكليف26
تعريف الحكم28
النسبة بين الحكم والتكليف29
العلاقة بين الحقّ والتكليف30
1. الإنسان والحقّ31
ماهيّة الإنسان وحقيقته32
المحاور الثلاثة لمبحث معرفة الإنسان33
الدين وحقّ الإنسان36
2. النسبة بين الحقّ والقانون40
3. الحقّ والأخلاق43
4. النسبة بين الحرّيّة والحقّ والتكليف45
5. العلاقة بين الإيمان والحقوق51
الفصل الثاني: مباني الحقّ والتكليف عند المسلمين والغربيّين53
1. العلقة بين المسائل الحقوقيّة والأبستمولوجيا54
2. علاقة الأنطولوجيا بالحقّ والتكليف57
الأنطولوجيا في الفكر الغربيّ 58
الأنطولوجيا في الفكر الإسلاميّ61
3. الأنثروبولوجيا ومسألة الحقّ والتكليف والحكم65
الإنسان عند مفكّري الغرب65
الإنسان في مرحلة ما قبل الحداثة66
الإنسان في المرحلة الجديدة 66
الإنسان في مرحلة ما بعد الحداثة70
الإنسان عند مفكّري الإسلام70
معنى الإنسان71
هويّة الإنسان عند المفكّرين المسلمين 72
الإنسان وخالقيّة الحقّ تعالى74
الإنسان وربوبيّة الله76
أبعاد الإنسان الوجوديّة79
1. البعد الحيوانيّ79
2. البعد الإنسانيّ80
3. البعد الإلهيّ 80
نطاق علم الإنسان82
الحقيقة والاعتبار في مالكيّة الإنسان84
نطاق حياة الإنسان87
ارتباط الإنسان مع الموجود 88
موقع الإنسان في نظام الوجود91
نسبة الحقوق وموقعيّة الأشخاص 92
النسبة بين الحقوق واقتضاء خلافة الإنسان98
النسبة بين معرفة الدين وحقوق الإنسان 100
أدلّة محوريّة التكليف في الدين101
نسبة الوجوب والحرمة الدينيّة مع محوريّة الحقّ 102
توافق العبوديّة أو تضادّها مع حقوق الإنسان105
4. العلاقة بين العقوبات الدينيّة والتكليف110
العقوبة الحقيقيّة والمجازيّة 111
أقسام العقوبات والانتقام 112
قصور برامج الدين بخصوص حقوق الإنسان116
حصيلة البحث118
الفصل الثالث: منشأ الحقّ والتكليف123
المصدر الأنطولوجيّ للحقّ والتكليف125
علاقة فلسفة الحقوق بالفلسفة الإلهيّة126
المصدر الإبستمولوجيّ للحقّ والتكليف 127
منشأ الحقوق عند مفكّري الغرب 128
منشأ الحقوق عند مفكّري الوحي والنبوّة 129
مصدر الحقّ عند المثاليّين131
منشأ الحقّ عند الواقعيّين133
منشأ الحقّ والتكليف عند أنصار الفردانيّة133
منشأ الحقوق والتكاليف في الإسلام135
الدين سبيل لتأمين الحقوق140
التكليف ضمان الحقّ 141
رؤية صدر المتألّهين142
حكمة التكليف الوجوديّة143
هذه الشبهة تنقسم إلى قسمين144
الدين منشأ الحقّ والتكليف148
الهادي بالذات والهادي بالعرض150
المبدأ الفاعليّ للحقّ151
المستحقّ والمحقّق للحقّ 152
حكمة طاعة الله عند ابن سينا153
هل قبول الدين ورفضه حقّ أم تكليف؟ 155
مصدر فعل الإنسان 156
حقّ الإنسان التكوينيّ والتشريعيّ 158
مباني الحقّ والتكليف162
الضامن للحقوق الفرديّة والاجتماعيّة 164
الفصل الرابع: أهداف الحقّ والتكليف وآثارهما 167
المقدّمة 167
هدف الخلقة عند كلتا الرؤيتين 169
1. تحصيل المعرفة 170
2. الاطمئنان الباطنيّ والهدوء الروحيّ 174
سرّ الحصول على الهدوء في ظلّ التكليف 176
3. الأمن الفرديّ والاجتماعيّ177
أصناف الناس أربعة في المجتمع الإسلاميّ 180
4. تعديل قوى الإنسان182
5. إقامة القسط والعدل الاجتماعيّ 186
6. الخلاص من هوى النفس189
7. الابتعاد عن الرذائل الخُلقيّة والمفاسد الاجتماعيّة193
أهمّ تكاليف أنبياء الله 194
8. إصلاح الدنيا والآخرة وإعمارهما195
9. حرّيّة الإنسان198
10. الكمالات المعنويّة200
نقد نظريّة (الدين الأقلّيّ) و(الانحصار النقليّ)201
أقسام الأهداف ومراتبها203
الفصل الخامس: رجوع التكاليف إلى الحقوق207
تبيين كلمة الدين، التكليف، الحقّ 207
التقسيمات المختلفة للحقوق209
التحدّيات النظريّة بين الدين والحقّ والتكليف 212
الدين من دون تكليف213
القرآن والدين من دون تكليف 216
1. الدعايات الخارجيّة 216
2. الدعايات الداخليّة218
الدين التكليفيّ من دون حقّ 219
المعاني المختلفة للدين التكليفيّ220
الإجابة عن هذه المعاني221
تلازم الحقّ والتكليف224
تلازم الحقوق والتكاليف الفرديّة225
تلازم الحقوق والتكاليف الاجتماعيّة227
رجوع التكليف إلى الحقّ 227
إرجاع التكاليف إلى الحقوق في القرآن229
1. الأمر بالعبادة في القرآن229
2. التكليف بمودّة أهل البيت عليهالسلام 231
3. الحكم بالعمل الصالح 231
4. نسبة العمل مع العامل 232
5. علاقة الظلم بالظالم 232
6. وجوب حفظ النفس 233
إرجاع التكاليف إلى الحقوق في الروايات 235
1. الأمر بالصلاة235
2. التكليف بالصيام 237
3. وجوب الجهاد238
4. الأمر بالإحسان240
5. تكليف إطاعة الولي242
كلمة أخيرة245
الفصل السادس: الحقّ في التعاليم الدينيّة247
موقعيّة حقوق الإنسان 249
1. محوريّة الإنسان في الرسالة الإلهيّة249
2. سجود الملائكة249
3. فضيلة الإنسان250
4. الإنسان خليفة الله251
5. كرامة الإنسان العقليّة 251
أبعاد حقوق الإنسان في الإسلام 253
1. الحقوق الأساسيّة 254
الف. حقّ الحياة254
ب .حقّ الحرّيّة255
ج. حقّ التديّن 258
جدليّة حقّ التديّن، وحقّ الارتداد 261
الحقّ الإلهيّ264
1. حقوق الأعضاء والجوارح 266
الف. حقّ اللسان267
ب .حقّ العين والأذن 268
2. حقوق الأسرة269
حقّ النفقة 269
3. تساوي حقوق الرجل والمرأة 270
شبهة تعارض ضرب المرأة مع حقوقها 272
4. حقّ تعالي المرأة في ظلّ الأحكام 287
5. حقّ التعليم والتريبة 280
6. حقوق الأولاد 281
7. حقوق الوالدين282
المآخذ 285
باتت مباحث الدين محور النقاش المحتدم طيلة القرون الماضية، سواء في الغرب أو الشرق، وقد اشتدّت هذه المباحث في فترة النهضة الاوروبية، والانقلاب على القراءة الدينية الرسمية، وظهور تيار الإصلاح الديني، وما تبعه من ظهور تيارات ومدارس فكرية: سياسية واجتماعية وثقافية حيث كان الدين دوماً طرفا في النقاش هذا.
والعالم الإسلامي لم يكن بمعزل عن هذا الجدل المستمر، وإن بنحو آخر، وما نزاع الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء وأهل الحديث، إلا من نتائج هذا الجدل، غير ان العالم الإسلامي بعد احتكاكه بالغرب الحديث، واجه نوعاً آخر من التحديات الدينية، ربما لم تكن من ذي قبل، بل ولدت جراء النهضة العلمية والعقلية الحديثة، وتغيير وجهة الإنسان من السماء إلى الأرض والسعي نحو تحقيق أكبر قدر من السعادة الدنيوية المحضة، وتغيرّت ميتافيزيقا الغيب الى فيزيقا الطبيعة، فانولدت جراءه لاهوت الطبيعة والدين الطبيعي والإنسان الطبيعي محور الكون.
التحديات هذه، تفرض على الخطاب الإسلامي، الخوض في هذا المضمار، لتقديم قراءات تأسيسية حول مباحث الدين وما يتعلّق به سعة وضيقا، مع لحظ المباحث الجديدة والإجابة على التحديات الحديثة، بغية الوصول الى الحقيقة.
هذا الكتاب الذي نضع ترجمته بين يدي القارئ الكريم من مؤلفات
(13)المرجع الديني سماحة الشيخ عبد الله جوادي آملي دام عزه، يقدّم بين دفتيه موضوع الحق والتكليف من وجهة نظر إسلامية ويبحث عن العلقة الترابط التلازم القائم بين موضوع الحق وموضوع التكاليف، وانّ التكليف كلها ترجع الى الحقوق، ونحن إذ نقدّم هذا الكتاب الى القرّاء الكرام تأمل أن ينال رضاهم ويروي ظمأهم المعرفي وأن يكون خطوة الى الأمام نحو التأصيل المعرفي الذي تحتاج إليه الساحة المعرفية في الوسط الإسلامي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الميامين.
(14)بات موضوع الحقّ والتكليف مورد عناية علماء الإسلام وموافقتهم منذ القدم سيّما الفقهاء؛ لورودهما في المتون الدينيّة: الكتاب والسنّة. ويمكن القول - من دون تردّد - بأنّ استعمال كلمة: الحقّ، الحكم والتكليف في الآيات والروايات، كانت هي الداعي الأساس لعلماء الدين في الخوض والبحث فيها. وبعد فحص إجماليّ في ميراث علماء الإسلام المكتوب، يتّضح أنّهم تناولوا هذه المسألة بحسب اقتضاءات المواضيع المختلفة، وقدّموا في ذلك مباحث معمّقة، فقد تطرّق العلّامة في القواعد في مبحث النكاح إلى الحقّ ومصاديقه، وكذلك المحقّق القمّيّ في جامع الشتات كتاب الطلاق باب جواز الصلح على الطلاق، وصاحب الجواهر في كتاب النكاح باب نفقة الأقارب، والشيخ الأنصاري في كتاب البيع في المكاسب المحرّمة.
وقد تابع الموضوع بعض تلامذة الشيخ الأنصاري وبعض شرّاح المكاسب أيضًا وتناولوه بالشرح والتفصيل.
وقد اكتفى كثير من فقهاء الشيعة بالتعليقة والشرح على ما ذكره الشيخ، ولكن خصّص بعضهم رسائل منفردة لها، وأوّل من كتب بشكل مستقلّ في ذلك - على ما ذكره الشيخ آقابزرك الطهرانيّ - هو الشيخ هادي
الطهرانيّ (1253 - 1321) تحت عنوان: رسالة الحقّ والحكم، ثمّ تلاها رسالة أخرى، تحت عنوان: الفرق بين الحقّ والحكم للسيّد محمّد آل بحر العلوم (1261 - 1326)، والكتاب الآخر في الموضوع نفسه للسيّد آقامير محمّد تقي المدرّس الأصفهانيّ (1276 - 1333) بعنوان: الضابط بين الحقّ والحكم، وقد تأثّر المؤلّف فيه بأفكار الشيخ هادي الطهرانيّ. ثمّ كتب بعده بعض فقهاء الشيعة وهو الميرزا عبد الرحيم بن نصر الله الكبيري القره داغي التبريزيّ (ت 1334هــ) كتابًا وسمّاه: رسالة الحقّ والحكم.
وهناك كتاب ثمين آخر للفقيه الشيعيّ الحاج محمّد الغروي الأصفهانيّ المعروف بالكمبانيّ (ت 1361هــ) باسم رسالة الحقّ. وهذا العالم الجليل في ضمن تعليقته على المكاسب وفي بداية بحث البيع، ألّف هذه الرسالة في بيان اختلاف الحقّ والحكم، والحقّ والملك، وكانت مباحثه ناظرة أيضًا إلى ما كتبه الشيخ هادي الطهرانيّ.
وبعد التوسّع في المباحث الحقوقيّة سيّما الحقوق الكلاسيكيّة في إيران، ظهرت كتب قيّمة في هذا المضمار وقد أخذت الصبغة الحقوقيّة نوعًا ما في الأغلب.
بخصوص هذا الموضوع قد طُرحت مباحث كثيرة بين العلماء - كما قلنا- ودوّنت آثار مستقلّة وقيّمة بهذا الخصوص، ولكن في العقود الأخيرة سيّما بعد الثورة وحاكميّة الإسلام ودخول فقه أهل البيت عليهمالسلام في المعترك العلميّ، طُرحت شبهات وأسئلة كثيرة من قبل العلماء في المجامع العلميّة ومحافلها، وبما أنّ الإجابة استدعت التأمّل والدقّة، زادت في ثراء هذه المباحث.
كان يدور محور البحث سابقًا مدار المسائل الفقهيّة والحقوقيّة ولا تتعدّاهما، وما يتعلّق بالشبهات غير الفقهيّة فهو إمّا لم يطرح أو طرح بشكل قليل جدًّا، ولكن اليوم فقد طرحت شبهات ومناقشات فقهيّة وكلاميّة جديدة حول مفهوم الحقّ والتكليف، الحقّ والحكم والاختلاف فيما بينها، بحيث إنّ الإجابة عليها تستدعي التأمّل والدقّة المتناهية.
شبهات من قبيل: هل لغة الدين تكليفيّة؟ ابتناء الحكومة الدينيّة على أصل التكليف وابتناء الحكومة الديمقراطيّة على الحقّ، دوران العصر الحاضر على الحقّ ودوران الإنسان الكلاسيكيّ على التكليف، تحوّل مفهوم الحقّ في العصر القديم والجديد، وجود أو عدم وجود ملازمة بين أحكام الدين وتعاليمه مع الاختيار والحرّيّة وحقوق الإنسان، هل إدلاء الصوت للحاكم الدينيّ (البيعة للمعصوم عليهالسلام) من حقّ الناس أو من تكاليفهم، إقامة الحكومة وانتخاب القائد هل يعدّ حقًّا للناس أو تكليفًا، من الذي يحقّ له سلب الحقّ أو إيجابه، وما هو منشأ الحق؟ وعشرات الأسئلة الفقهيّة والكلاميّة الأخرى التي أدّت إلى تحدّيات حقيقيّة تطلّبت أجوبة مستدلّة.
وكما أنّ العلماء الماضين قد نقّحوا المباحث والمسائل المطروحة في زمنهم بشكل جيّد، كذلك يجب اليوم تنقيح المناقشات الجديدة والإجابة عليها طبقًا لتعاليم الدين، وكما أنّ السلاح القديم لا ينفع أمام الأدوات الحديثة، فعليه يلزم تحديث المباحث الدينيّة لردّ الشبهات الجديدة والمواجهة مع الأسئلة والإجابة عنها. وأن لا نخاف من الشبهات الجديدة، كما لا نزعم بأنّ القدامى قد تطرّقوا إلى جميع المشاكل وأجابوا عن كلّ الشبهات.
من هذا المنظار، وبناء على هذه الضرورات، بات من الواضح والبديهيّ لزوم الخوض في هذه المباحث بشكل مستقلّ، لذا نتابع البحث في هذا الموضوع هنا، عسى أن ينفع النفوس المستعدّة.
(17)كلمة (الحقّ) كسائر المفردات والكلمات، لها معنيان: لغويّ واصطلاحيّ. فالحقّ (ح ق ق) في قاموس اللغة يأتي بمعنى الثبوت، والموجود الثابت، وما يقابل الباطل، الوجود الثابت الذي لا يمكن إنكاره، كما يأتي بمعنى الوجود المطلق وغير المقيّد بأيّ قيد، أي ذات الباري المقدّسة وعندما تستخدم هذه الكلمة كمصدر، تأتي بمعنى الثبوت، وإذا استعملت وصفًا تكون بمعنى الثابت.
وفي الاصطلاح العامّ تطلق على الحكم المطابق للواقع في الأقوال والعقائد والمذاهب والأديان.
ولا نتردّد في أنّ للحقّ ماهيّة اعتباريّة عقلائيّة في بعض الأحيان، وفي بعضها الآخر شرعيّة، ولا شكّ في أنّ للحقّ في جميع الموارد معنى وماهيّة واحدة، وهو مشترك معنويّ لمصاديقه، كما أنّه من المفاهيم الاعتباريّة،
ولا يمكن تعريفه الحقيقيّ بالحدّ والرسم المنطقيّ.
يُطلق علماء المنطق كلمة (الحقّ) على القضيّة المطابقة للواقع والمتوافقة مع نفس الأمر، ويقولون في الفرق بينها وبين الصدق أنّ الحقّ هو الحكم المطابق للواقع ويشمل الأقوال والعقائد ويقابل الباطل، بينما الصدق يختصّ بالأقوال ويقابل الكذب. وقد يقال إنّ الفرق بين الحقّ والصدق يكون في أنّ المطابقة في الحقّ تكون من جانب الواقع، بينما في الصدق تكون من جانب الحكم. وقد يقصد الفلاسفة من كلمة (الحقّ) الوجود العينيّ والخارجيّ، وقد يقصدون الموجود الواجب القائم بالذات.
وردت معانٍ مختلفة لكلمة الحقّ في الكتب الأصوليّة والفقهيّة، فقد عدّها البعض المرتبة الضعيفة للملكيّة، وعدّها البعض الآخر نوعًا من السلطة. وذهب فريق إلى أنّها اعتباريّة وعرّفها آخرون بأنّها الاختيار في إتيان الفعل. وعلى أيّ حال، فإنّه لا يوجد أيّ إجماع في تعريفها الماهويّ بين الفقهاء، ولكن أجمع تعريف من بين سائر التعاريف هو أنّ الحقّ من سنخ السلطة لا الملكيّة. فعندما يرد ذكر الحقّ في الفقه فإنّه يستبطن نوعًا من السلطة: فالحقّ سلطة فعليّة لا يُعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بل لا بدّ من قيامها بين طرفين: الطرف الذي له الحقّ ويكون لنفعه، والطرف الذي
يكون الحقّ في ذمّته ويتكفّل أداءه «لا يجري لأحد إلّا جرى عليه، ولا يجري عليه إلّا جرى له».
وعليه، فالزعم بأنّ المعنى الفقهيّ للحقّ نوع أو مرتبة من مراتب الملكيّة غير صحيح وذلك أوّلًا إنّ صاحب الحقّ مضافًا إلى استطاعته فعل الحقّ وتركه، يمكنه أيضًا إسقاطه، ولذا يقال: «لكلّ ذي حقّ أن يُسقط حقّه». وثانيًا إنّ متعلّق الحقّ فعل من الأفعال دائمًا، والحال إنّ متعلّق الملك مضافًا إلى كونه فعلًا يمكن أن يكون شيئًا. وثالثًا إنّ الملك سلطة قويّة، والحقّ سلطة ضعيفة؛ بمعنى أنّ المالك باستطاعته فعل أيّ تصرّف مشروع في ملكه، ولكن صاحب الحقّ لا يمكنه فعل سوى بعض التصرّفات المسموحة له.
وقد قسّم علماء الأصول الحقّ إلى قسمين: حقّ الله، وحقّ العباد. حقّ الله هو الذي لا يسقط حتّى لو أسقطه العبد، كالصلاة والصوم والحجّ والجهاد، وحقّ العباد هو الحقّ الذي يسقط بإسقاطهم كالقصاص.
وقد ذهب بعض الأصوليّين والفقهاء بعد نقد هذا التعريف، إلى معنى آخر، وقالوا بأنّ المراد من حقّ الله مجموعة من الحقوق التي يراعى فيها النفع العامّ ولا تخصّ الأشخاص كحرمة الزنا، فهذه الحزمة من الحقوق تنسب إلى الله لأهمّيّتها ورتبتها، والغرض من حقّ العباد ما يشتمل على مصلحة أو نفع شخصيّ وخاصّ، كحرمة مال الغير. والفرق بينهما أنّ حقّ العبد يكون مباحًا بعد إباحة المالك، ولكن حقّ الله لا يصير مباحًا بإباحة العبد، كحرمة الزنا الذي لا يباح بإباحة الزوج.
وقد أشكل على هذا التعريف بأنّه لم يكن تامًّا وكاملًا؛ لأنّ أمثال
الصلاة والصوم والحجّ تعدّ من الحقوق الإلهيّة، ولم تكن فيها منافع عامّة، وعليه تخرج حينئذٍ كثير من حقوق الله من دائرة التعريف، وقد قيل في مقام الإجابة: بأنّ هذه الحقوق إنّما شُرّعت لتحصيل الثواب والكمال ورفع الكفران والعقاب، وهي نوع منفعة عامّة بحدّ ذاتها على خلاف حرمة مال الغير.
ذهب المحامون في مفهوم الحقّ إلى أنّه ممزوج مع عنصر القوّة والمنفعة ويلازمهما، وبلحاظ هذا التصوّر قالوا في تعريفه: الحقّ قوّة تستند إلى القانون يتمكّن صاحبه الاستعانة بالقانون من تملّكه أو منع الآخرين من تملّكه. أو: الحقّ قوّة يمنحها القانون لشخص، أو منفعة تصان من قبل القانون .
وقد تكون نظرتهم في هذا التعريف نظرة غائيّة؛ لأنّه ناظر إلى الثمرة العمليّة في الأغلب، وقد قسّموا الحقّ إلى أقسام مختلفة: عامّ، خاصّ، سياسيّ، أصليّ، تبعيّ، عينيّ، دينيّ، منقول، غير منقول، طبيعيّ، اختصاصيّ، وقد لوحظ في جميعها عنصر الاختيار والقوّة.
إنّ منشأ الحقّ ومنطلقه عندهم يرجع إلى إرادة الإنسان أو إنسانيّته، كما أنّ الحقوق عندهم إمّا أن تكون خاصًّا أو طبيعيًّا، فلو كان الحقّ خاصًّا كان منشؤه إرادة الإنسان، وإن كان طبيعيًّا فإنّه حاصل له لمجرّد كونه إنسانًا. ثمّ إنّ ما يُبحث عنه في علم الحقوق حول موضوع الحقّ، قد تمّ بيانه بالتفصيل في كتب الفقهاء والكتب الفقهيّة ولا بدّ من لحاظه والتأمّل فيه، ولكنّ شرحه وبسطه يتطلّب حديثًا مستقلًّا.
العلماء في العلوم المختلفة، وإن جعلوا الحقّ من سنخ السلطة والاختصاص والملك، غير أنّهم لم يقدّموا تعريفًا جامعًا ومنسجمًا له، وعدم الانسجام هذا والاختلاف في معنى الحقّ سبّب حصول تحديّات للبعض، من هذه التحدّيات السؤال عن إمكانيّة تقسيم الحقّ إلى معنيين: قديم (تراثيّ) وجديد (حداثيّ) مع إعطاء رؤية جديدة له تمتاز عن معناه التراثيّ [الكلاسيكيّ]؟
وقد حاول البعض تبرير هذا التقسيم الثنائيّ للحقّ وإصباغه صبغة منطقيّة كي يتمّ قبوله بنحو أفضل. فهذا الفريق من علماء الإسلام يقولون - تبعًا لمفكّري الغرب في قبول الرؤية الجديدة لمفهوم الحقّ - إنّ كلمة الحقّ كان لها بُعدٌ أخلاقيٌّ في الماضي وتستخدم في القضايا السلوكيّة والأخلاقيّة، وعلى سبيل المثال: لو فعل شخص عملًا كان يتمّ الكلام في الحكم على عمله هل هو حقّ أو خلاف الحقّ. ولكن اليوم إذا تحدّثنا عن حقّ شخصٍ لم نرد التكلّم عن حكم أخلاقيّ فقط، بل نكون في مقام إثبات مدّعاه أو إبطاله، وهذا هو مفاد حقوق الإنسان اليوم.
وعليه، فإنّ المائز الأساس بين مفهوم الحقّ الكلاسيكيّ ومفهومه الجديد يتلخّص في أنّ الحقّ قديمًا كان بمعنى (الكون على الحقّ) وحديثًا صار بمعنى (امتلاك الحقّ) وهذا المعنى من الحقّ لم يكن ليتوصّل إليه الإنسان القديم، وقد التفت الإنسان المعاصر بأنّ له حقوقًا لا بدّ أن يمتلكها في حياته المادّيّة، وهذا هو التحوّل الحقيقيّ والاتّجاه الجديد لمعنى الحقّ ولا يمكن إنكاره.
يوجد في هذا الكلام أمران: الأوّل تفكيك الحقّ إلى معنيين، والثاني الاتّجاه القديم والحديث في الحقّ. لا يوجد كلام في إمكان تعريف الحقّ إلى معنيين، غير أنّه لا يوجد أيّ مبرّر في تخصيص أحدهما للاتّجاه الحديث؛ لأنّ كلا المعنيين وردا في كتب علماء الدين والمتون الإسلاميّة، واستعمل المعنى الثاني فيها أكثر من الأوّل، فقد ورد الكلام في الكتب الفقهيّة والحقوقيّة حول انتقال الحقّ وإسقاطه في الأغلب، وهذا يكون بمعنى (امتلاك الحقّ) لا (الكون على الحقّ) والتفاوت بين هذين المفهومين يكون في مقام الثبوت والإثبات، لا الاتّجاه القديم والجديد؛ أي يرد الكلام تارة عند العلماء وفي المباحث العلميّة حول ثبوت الحقّ ويراد منه مفهوم (الكون على الحقّ) وتارة أخرى عن إثبات الحقّ ويراد منه حينئذٍ معنى (امتلاك الحقّ).
فمن الخطأ البيّن والواضح ربط معنيي الثبوت والإثبات بالاتّجاه القديم والجديد، فهذا الخلط والخبط يكون مصداقًا بارزًا للخلط بين ما بالعرض وما بالذات.
يُعدّ معنى الحقّ في القرآن من المواضيع المبحوثة التي تعتبر من المبادئ التصوّريّة، وقد استعمل الحقّ في القرآن الكريم بمعناه العامّ، ونشير إلى بعض المعاني فيما يلي:
أ - الحقّ في قبال الباطل، كقوله: ﴿جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ﴾ و﴿قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ .
ب -الحقّ في قبال الضلال والتيه: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ﴾ .
ت -الحقّ في قبال السحر الداخل ضمن الباطل، كالسحر في قصّة موسى عليهالسلام حيث قال بأنّ ما جئت به حقّ وليس سحرًا، وما جئتم به سحر وباطل: ﴿قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ﴾ .
ث - الحقّ في قبال الهوى، فقد يستعمل القرآن الكريم الحقّ في قبال الهوى، كقوله: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ وقد يطلق في بعض الآيات على ذات الباري المقدّسة.
فما بيّنه القرآن الكريم من معنى الحقّ، مفهوم عامّ قد يجمع كلّ المفاهيم المستعملة في مختلف العلوم، وهذا من مميّزات القرآن الكريم حيث لم يكن مجرّد كتاب علميّ بل هو نور: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ومن خصائص النور والكتاب المبين أنّه لم يدع أيّ إيهام في البين.
يمتاز الحقّ في الثقافة الدينيّة وعند المعصومين عليهمالسلام، بميزة خاصّة ربّما لم تكن متداولة في اصطلاحات العلوم، أي إنّ الحقّ في قاموس الدين يبتني على أساسٍ يخالف المعنى المتعارف.
قال الإمام الصادق عليهالسلام في بيان معنى الحقّ والباطل:
«اتّقِ الله حيث شئت ومن أيّ قوم شئت، فإنّه لا خلاف لأحد في التقوى والمتّقي محبوب عند كلّ فريق وفيه إجماع كلّ خير ورشد، وهو ميزان كلّ علم وحكمة، وأساس كلّ طاعة مقبولة، والتقوى ما ينفجر من
عين المعرفة بالله يحتاج إليه كلّ فنّ من العلم وهو لا يحتاج إلّا على تصحيح المعرفة بالخمود تحت هيبة الله وسلطانه، ومزيد التقوى يكون من أصل اطّلاع الله - عزّ وجلّ - على سرّ العبد بلطفه، فهذا أصل كلّ حقّ، وأمّا الباطل فهو ما يقطعك عن الله متّفق عليه أيضًا عند كلّ فريق، فاجتنب عنه وأفرد سرّك لله تعالى بلا علاقة».
إنّ أساس جميع حقوق الإنسان في مدرسة الإمام الصادق عليهالسلام ، هو الارتباط بذات الحقّ تعالى المستترة في التقوى ومعرفة الإنسان، كما أنّ الباطل هو قطع علقة الإنسان بالله تعالى. إنّ جميع الخيرات والبركات والأنوار في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة للإنسان، تنشأ من إحقاق الحقوق، وأساسها المعرفة والحبّ الإلهيّ وكمال الارتباط بالذات الربوبيّ: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك». فهو تعالى الحقّ المحض والبحت والبسيط، وعلامة حقّانيّة كلّ شخص تكون بالاتّصال معه: ﴿ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ .
يتجذّر التكليف عند أهل اللغة من جذر (كلّف) بمعنى الأمر بشيء يصعب الإتيان به. أمّا في الاصطلاح وفي الثقافة الدينيّة يطلق على الأمر الإلهيّ.
يقول اللاهيجي في گوهر مراد:
«يُطلق التكليف على الخطاب الإلهيّ المتعلّق بأفعال العباد من جهة
الاتّصاف بالحسن والقبح على سبيل الاقتضاء أو التخيير، والمراد من الاقتضاء الطلب، والطلب إمّا أن يتعلّق بالفعل أو الترك، والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك.
وبناء على هذا، تمّ تقسيم الأوامر الإلهيّة بخصوص أفعال الإنسان إلى أقسام:
الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة والإباحة. وهذه الأحكام من حيث عدّها من أقسام الحسن والقبح، قد تكون حسنًا وقبحًا عقليًّا تتصف بالعقليّة، ومن حيث ورود النقل عليها تتصف بالمنقول الشرعيّ، فأيّ تكليف من تكاليف العباد عقليّ ونقليّ، وكلاهما من مصادر الشريعة».
لقد قسّم الكثير من متفكّري المسيحيّة والإسلام التكليف إلى أخلاقيّ وحقوقيّ، محبّذ ومذموم، عقليّ ونقليّ، وإن التفت متفكّرو الغرب إلى التقسيم الأوّل (الأخلاقيّ والحقوقيّ) أكثر من غيره، فقد سعوا دمج التكليف بالأخلاق، وذهب البعض منهم كإيمانويل كانط وكثير من أتباعه إلى عدم وجود أيّ تكليف غير أخلاقيّ. ولعلّ منشأ البحث حول اختلاف الحقّ والتكليف طُرح في الغرب بالابتناء على هذا المبنى العقديّ، وعلى هذا المبنى يكون البحث بحثًا مهمًّا. ولكن لو لم نذعن بأنّ جميع التكاليف أخلاقيّة فلا يبقى مجال لهذا البحث، ويكون الموضوع خارجًا تخصّصًا عن مدار البحث لا تخصيصًا. وهذا الموضوع وإن كان جديرًا بالبحث والفحص، ولكن سنتطرّق إليه في مكان مناسب آخر.
يأتي الحكم في اللغة بمعنى الأمر، وقد قال بعض أهل اللغة في معناه: القضاء وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم، يقال: الحكمة لأنّها تمنع صاحبها من أخلاق الرذائل.
فالحكم في اللغة بمعنى القضاء والمنع، والتحكيم يعني منع مخالفة الدستور، وفي اصطلاح العرف يعني إسناد أمر إلى أمر آخر بالإيجاب أو السلب، وعند المناطقة يُطلق على نفس الإسناد حيث يكون إدراكه بالتصديق سواء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا.
والحكم في اصطلاح الفقه والأصول، خطاب ذات الباري المقدّسة إلى المكلّفين وينقسم إلى وضعيّ وتكليفيّ. الحكم التكليفيّ هو الحكم المتعلّق بالأفعال والاقتضاء والتخيير، فالاقتضاء يشمل الوجوب والندب والحرمة والكراهة، والمراد من التخيير هو الإباحة. وكلّما كان الاقتضاء فعلًا يكون (الوجوب) مع منع نقيضه الذي هو الترك ويكون ندبًا مع منع نقيضه. ولو كان الاقتضاء تركًا يكون (الحرمة والحظر) مع المنع من نقيضه الذي هو الفعل، وإذا كان بدون المنع من النقيض يكون مكروهًا.
والحكم الوضعيّ هو الحكم باختصاص شيء لشيء، وهو على ثلاثة أقسام:
1 - السببيّ؛ كالخطاب المتعلّق بأنّ دلوك الشمس سبب الصلاة.
2 - الشرطيّ؛ كالقول بأنّ الطهارة شرط للصلاة.
3 - المنع؛ كالقول بأنّ النجاسة الفلانيّة تمنع من الصلاة.
ولا يخفى أنّ بعض الفقهاء لم يعد الوضعيّ حكمًا، وعليه تحال الأحكام الوضعيّة إلى الاقتضاء.
من الممكن أن يتبيّن من خلال ما مضى النسبة بين الحكم والتكليف، حيث إنّ الحكم يُطلق على نفس الأمر، ولكن التكليف هو العمل بذلك الأمر، ولا توجد في الحكم أيّ مشقّة وعناء؛ لأنّه يجري من الأعلى إلى الأدنى، ولكن يوجد عناء ومشقّة جسديّة في التكليف كما قلنا، وإن يسهل إتيانه بعد مضيّ فترة وبعد تكرار العمل، فتذهب بتبعه المشقّة والعناء. ولكن مع هذا فقد تمّ التطرّق إلى الحكم والتكليف في المباحث الفقهيّة في قسم واحد، فالتكليف يقع في قسم الحكم، ويقع الحقّ في قبال الحكم، والإنسان ليس مالكًا للحكم ولا مَلِكًا عليه، بل الحكم لله فقط: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ والإنسان مكلّف برعايته.
والقول بأنّ هكذا قراءة للدين: أي بأن يكون الله هو الحاكم المطلق، ويكون الإنسان متلقّي الحكم فقط، وهذا يتنافى مع حرّيّة الإنسان واختياره، وأنّ الأحكام الفقهيّة تمنح الحرّيّة الطبيعيّة، فهذا القول أمر جدير بالاهتمام ويقتضي فهمه الصحيح إلى تأمّلات كلاميّة. كما أنّ مقولة تضادّ الإلزامات الدينيّة أو تناقضها مع أصل حرّيّة الإنسان؛ أوّل الكلام وهي بحاجة إلى استدلال؛ من حىث أنّ منشأ الحكم والحاكميّة هل هي للمولى أم للعبد؟ وهل صدور الحكم يبتني على الربوبيّة أم العبوديّة؟
يظهر أنّ بيان مقولة كون الإنسان مصدرًا لا موردًا له، وأنّ صدور الحكم يبتني على العبوديّة لا الربوبيّة، هذه المقولة بحاجة إلى الدليل والبرهان، ولا يمكن قبولها من دون إقامة برهان بأيّ وجه، ولكن من وجهة نظرنا حيث يكون الإنسان موردًا للحكم ومكلّفًا بالإلزامات والأحكام
(29)الفقهيّة، فمضافًا إلى دلالة بعض الآيات عليه، من قبيل: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ، فمضافًا إلى هذا أنّه أمر مقبول من وجهة نظر كلاميّة وعقديّة، فعندنا أنّ الإنسان لا يمكنه أن يكون منشأ الحكم؛ لأنّه عبد الله، وصدور الحكم يليق بالربّ لا العبد، إلّا في موارد إذن الشارع؛ أي يكون العبد مصدرًا للحكم في النطاق الذي أجازه الله تعالى فقط.
بعد بيان مفهوم الحقّ والتكليف، نتطرّق إلى بيان مسألة تعدُّ من أهمّ مسائل مجتمعنا، وهي العلاقة بين الحقّ والتكليف.
والسؤال المطروح هو أنّ الإنسان هل يمتلك الحقّ أو التكليف؟ إنّه مكلّف أو صاحب حقّ؟ وعلى سبيل المثال: فإقامة الحكومة هل هي حقّ الناس أو تكليفهم؟ وكذلك هل قبول قيادة الحاكم حقّ أو تكليف؟ هل الترشيح حقّ أو تكليف؟ فلو كان حقًّا للناس فلماذا الإفتاء بوجوب المشاركة في الانتخابات، أو أنّ الترشيح واجب كفائيّ؟ وإذا كان تكليفًا، فماذا عن حقّ الإنسان؟ هل الإسلام يعتقد بالحقّ للإنسان أو يراه مكلّفًا فقط؟ هل الإنسان في الإسلام مكلّف أو صاحب حقّ؟.
كلّ واحد من هذه الأسئلة والشبهات بحاجة إلى جواب منطقيّ، ويلزم تقييمها بالبرهان كي يتّضح بطلانها أو صوابها.
وليعلم أنّ أغلب هذه الشبهات لا تندرج ضمن المباحث الفقهيّة، بل إنّها مواضيع خارج نطاق الفقه، لذا وللإجابة لا بدّ من الخروج من نطاق الفقه واصطباغ البحث بصبغة كلاميّة وفلسفيّة.
وبناء على هذا ولبيان الموضوع، نقدّم المباحث ضمن محورين كلّيّين، أحدهما: ما هو حقّ الإنسان. والآخر: ما هو رأي الإسلام بهذا
(30)الخصوص؟ وعليه يتمّ التطرّق إلى موضوع الحقّ والتكليف تحت عنوانين؛ الأوّل: الإنسان والحقّ، والثاني: الدين وحقّ الإنسان.
لأجل البحث في الموضوع وتحصيل النتيجة المطلوبة، لا بدّ في البدء من بيان معنى الحقّ ومفهومه للإنسان، وقد ذكرنا سابقًا بأنّ للحقّ معانٍ عامّة ومشتركة بين جميع المعاني؛ أي يكون بمعنى (الثابت) وله معنى خاصّ تتبلور تلك المعاني الخاصّة في اصطلاح العلوم المختلفة. وفي مورد بحثنا، هل يراد منه المعنى الفقهيّ أو المعنى الفلسفيّ؟ هل يراد منه المعنى الحقوقيّ أو المفهوم القرآنيّ؟
والجواب: إنّ أيًّا من المعاني المذكورة لم تكن محطّ نظرنا في هذا البحث، بل المراد من الحقّ هنا، الحقّ المقابل للتكليف، وبهذا المعنى يكون الحقّ ما ينفع الفرد ويقع على عاتق الآخرين، أمّا التكليف فيقع على عاتق الفرد لنفع الآخرين. وبعبارة أخرى: يكون الحقّ للمحقّ والمستحقّ، ويكون التكليف للمكلّف، والتكليف يتقبّل الفتوى بخلاف الحقّ. وبعد بيان هذه النقطة، يُطرح سؤال وهو أنّ الإنسان هل يلزم عليه تحمّل أعباء الوظائف والتكاليف التي عيّنها المرجع الفقهيّ بالفتوى، أم إنّه موجود محقّ ومستحقّ يمكنه استيفاء حقّه، وعلى الآخرين أداء حقوقه؟
وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ أن لا نغفل عن نقطة في غاية الدقّة والكلّيّة، وهي أنّ حقّ كلّ موجود يتناسب مع هويّته، فلو فرضنا الحقّ للجمادات والطبيعة الفاقدة للروح، فالمراد منه حقّ يتناسب مع سنخ ماهيّتــها، ولو افترضنا حقوقًا للحيوانات، فالمقصود منها الأمور التي تتناسب مع الهويّة الحيوانيّة، وعندما نتكلّم عن حقّ الإنسان، فالمقصود منه الحقوق المتناسبة مع هويّته، وإذا تكلّمنا عن الحقّ الإلهيّ، فهو يتناسب مع
(31)هويّته القدسيّة، ولا يوجد شكّ وتردّد في تفاوت حقّ الجماد مع حقّ الحيوان، وحقّ الحيوان والجماد مع حقّ الإنسان، وجميع هذه الحقوق تمتاز عن حقوق الله تعالى؛ وذلك لاختلاف ذات هذه الموجودات وهويّتها بعضها عن البعض الآخر.
وبناء على هذا عند تبيين وتحليل معنى الحقّ ومفهومه، لا بدّ من الالتفات إلى أمرين: الأوّل أنّ الحقّ شيء يقابل التكليف، والنقطة الأدقّ والأهمّ أنّ الحقّ هو الذي يتناسق مع حقيقة الشيء ومع واقعيّات أطرافه، كما أنّ المطلب الأصيل [والأساس] حول التكليف كذلك أيضًا. فعندما يتكلّم عن حقّ الإنسان، لا بدّ من تبيين مفهوم (الحقّ) و(الإنسان). وقد تبيّن - لحدّ الآن - مفهوم الحقّ تقريبًا وما هو المقصود منه، ولا بدّ من بيان مفهوم الإنسان والمراد منه.
إذا لم يتمّ تقديم مفهوم صحيح عن الإنسان، لا تتضح نتائج البحث وإن كان لنا تلقّ واضح وصحيح لمعنى الحقّ، وعليه لتكميل البحث وجامعيّته، لا بدّ من بيان مفهوم الإنسان وموقعيّته بين سائر الظواهر كالحيوان والنبات والجماد. هل يقع الإنسان في عرض سائر الظواهر والموجودات أم في طولها؟ هل يُقتصر وجوده على البعد الظاهريّ والجسمانيّ هذا، أم له بعد آخر مضافًا إلى ذلك البعد؟ إذا كان موجودًا ذا بعدين (روحانيّ وجسمانيّ) فما هي غاية خلقته في العالم المادّيّ؟ هل هدف خلقة الإنسان تناظر هدف خلقة باقي الموجودات، أو تمّ خلقه للدنيا والآخرة معًا؟
وفي مقام الإجابة عن هذه الأسئلة، لا بدّ من التعرّف على الإنسان كما هو. هذه المعرفة للإنسان، والوقوف على موقعيّته بين سائر المخلوقات، تخرج عن حدود العلوم التجريبيّة، ولا بدّ من أخذ الجواب
(32)الصحيح من العلوم الإنسانيّة؛ لأنّها تدور في محور الإنسان وشؤونه مطلقًا، وإذا لم يتعرّف شخص على الإنسان، فمعرفته بالعلوم الإنسانيّة تكون ناقصة ومعيوبة قطعًا، وهنا مكمن تمايز العلوم التجريبيّة والرياضيّة عن العلوم الإنسانيّة، حيث إنّ مسائل العلوم التجريبيّة والرياضيّة لا تحتاج إلى معرفة الإنسان، وإن كانت مستعملة من قبل الإنسان، إلا أنّ العنصر المحوريّ في العلوم الإنسانيّة هو البحث عن معرفة الإنسان، وما دام لم يتمّ التعرّف على الإنسان كما هو، يكون الرأي في العلوم الإنسانيّة غير مستقيم أيضًا.
لو أراد الشخص التعرّف على الإنسان كما يشاء هو لا كما يكون واقع الإنسان، أي لم يمتلك رؤية واقعيّة عن موقعيّة الإنسان، بل أراد إلقاء رأيه الخاصّ، فطرح مسألة (الحقّ والتكليف) حينئذٍ تكون غير صحيحة من دون تردّد؛ لأنّه يتكلّم عن حقٍّ وتكليفٍ ظاهريّين لم يُقدّم لهما تعريف جامع وكامل.
والنقطة الأخرى: إنّ الحق والتكليف وإن كانا ضمن الحكمة العمليّة ويقعان في حدود ينبغي ولا ينبغي، غير أنّهما لم يُعدّا ضمن الاعتبارات المحضة؛ لأنّ كلّ واحد منهما مسبوق بملاكات تكوينيّة وحقيقيّة، تكون منبعًا وسندًا عينيًّا للقوانين الحقوقيّة والقواعد الفقهيّة والتكليفيّة، كما أنّهما يناط إليهما الثواب والعقاب التكوينيّ والحقيقيّ المنكشف يوم القيامة، ولم يكونا أبدًا عقدًا محضًا واعتبارًا اجتماعيًّا صرفًا ينطلق من الآداب والرسوم وثقافة الناس العاديّة. فيلزم - للتعرّف على حقوق الإنسان - التعرّف أوّلًا على ماهيّة الإنسان، حيث إنّ معرفة الإنسان مبحث أنطولوجيّ.
إنّ الأنثروبولوجيا، ورؤية الأديان وسائر المدارس حول الإنسان، ورؤية الحكماء والمتكلّمين والمسلمين والمسيحيّين حول منزلة الإنسان
(33)وموقعيّته الحقيقيّة في المنظومة الكونيّة، وعلاقته مع مسألة الحقّ والتكليف، كلّ هذه أمور سوف نتطرّق إليها في مبحث مستقلّ، ولكن هنا ومن باب مناسبة الموضوع، نشير إجمالًا إلى النطاق الكلّيّ لمعرفة الإنسان بعنوان المباحث التصوّريّة للبحث.
إنّ لمبحث معرفة الإنسان ثلاثة محاور كلّيّة لا بدّ من الالتفات إليها، وإلّا سوف تكون معرفة الإنسان ناقصة ولو أقيمت بأيّ وجه، وهذه المحاور الثلاثة هي:
أ - معرفة الهويّة؛ أي ما هي حقيقة الإنسان وهويّته؟
ب - معرفة الموقعيّة؛ أي معرفة هذا الأصل والسؤال عن موقعيّة الإنسان في نظام الخلقة.
ت - معرفة تعامل الإنسان مع الوجود؛ بمعنى السؤال عن كيفيّة التعامل بين الإنسان ونظام الخلقة.
إنّ دليل هذه العناصر المحوريّة الثلاثة واضح جدًّا، من حيث إنّ الإنسان في نظام الوجود لم يكن بمنأى عن سائر المنظومة الكونيّة، بمعنى أن يكون الله تعالى قد خلقه منفصلًا ويلبّي حوائجه بشكل مستقلّ أيضًا، بل إنّه ضلع من أضلاع مثلّثٍ يكون الإنسان ضلعًا فيها، والكون ضلعًا آخر، والضلع الثالث هو الترابط بين الكون والإنسان.
وعليه، لا يُتصوّر أنّ الإنسان يعمل من خارج حدود الكون أو منقطعًا عن العالم، بل إنّ جميع ذرّات وجوده تؤثّر في العالم: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ كما أنّ العالم يؤثّر فيه أيضًا. وعليه، فإنّ معرفة الكون (الأنطولوجيا) من لوازم معرفة الإنسان؛
لأنّه ضلع من أضلاع هذا المثلّث، كما أنّ من لوازمه أيضًا معرفة الترابط بين العالم والإنسان، ومعرفة إنسانيّة الإنسان. وهذا النوع من المعرفة توصل الإنسان إلى طريق مطمئن للتعرّف على حقوق الإنسان، وحقّ الإنسان هو المتناغم مع هذا المثلث، أي بأن يتناغم مع هويّة الإنسان وشاكلته الداخليّة، ومع شاكلته الخارجيّة والظاهريّة، ومع نظام الكون وترابط الإنسان والكون.
فلو كان الإنسان داخل هذا المثلّث، بأن يعيش في هذه المنظومة، تكون حقوقه معلومة في جميع أبعادها، ولا بدّ من تنظيم حقوقه مع لحاظ ذلك المثلّث، أي لا بدّ من الالتفات أوّلًا إلى أنّ أيّ شيء في نظام الوجود يُعدّ حقًّا كي تتطابق حقوق الإنسان الطبيعيّة معه، وثانيًا ما هو الحقّ في بنية الإنسان، وثالثًا ما هو الحقّ في الترابط بين العالم والإنسان كي تتناغم معه حقوق الإنسان. وهذا أصل كلّيّ في التعرّف على حقوق الإنسان.
والأمر الآخر إنّ معرفة الإنسان على ضوء هذا المثلث المنسجم، يمكنه أن يكون له طرائق عدّة، الطريق الأفضل منها هو العناية التامّة بالإرشادات التي تصنع الإنسان. فلو كان وجود الإنسان صدفة ينشأ هكذا كنشوء الأعشاب غير النافعة، لأمكنه أن يتحدّث عن معرفة نفسه، أو إذا كان موجودًا ذا علّة وكان هو علّته الفاعليّة، فحينئذٍ كان بإمكان المجتمع الإنسانيّ والعقل الجمعيّ ونحوهما التعرّف التامّ عليه، وعندما يتعرّف على نفسه من خلال العقل الفرديّ أو الجمعيّ، أمكنه التعرّف على حقوقه وتكاليفه، ولكن إذا أثبت البرهان العقليّ والنقليّ أنّ الإنسان لم يكن صُدفة ولا معتمدًا على نفسه، بل متعلّق حدوثًا وبقاءًا بالله الغنيّ بالذات، فحينئذٍ وللتعرّف على نفسه لا بدّ وأن يستعين بتعاليمه.
وهذا أصل آخر يدعو إلى الالتزام بتعاليم الله تعالى للتعرّف على
(35)المخلوقات، وإلّا سوف تنحرف عمليّة الإنسان وتؤول إلى الضلال، وبتبعه تتعرقل عمليّة معرفة حقوق الإنسان.
مع لحاظ ما ذُكر؛ ولأجل تبيين مباحث حقوق الإنسان وتكاليفه، من الضروري البحث عن معرفة الإنسان ضمن المحاور الثلاثة وسيأتي الكلام عنها في محلّه. ومن المسلّم به أنّ الإنسان إذا لم يعرف كما هو، ولم تثبّت أضلاع وجوده، تقع حقوقه الواقعيّة في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، في هالة من الإبهام، فلا تمتاز بتعريف جامع ولا تقع في المسير الصحيح. وعليه لأجل التبيين الصحيح للحقّ وإرجاعه إلى الطريق الصواب، لا بدّ من الاستمداد بالتعاليم الإلهيّة والدينيّة، أي الكلام والرسالة التي تصنع الإنسان.
لا يوجد أدنى تردّد في وجود حقوق للإنسان، ولكن يقع الكلام في نظرة الدين إلى هذه الحقوق، هل يعترف الدين بحقوق الإنسان؟ كيف يمكن الجمع بين عقوبات الإنسان الدنيويّة والاخرويّة مع حقوقه، كيف يمكن عقد الصلة بين تكليف الإنسان في الدين وبين كونه ذا حقوق؟ و....
الدين مجموعة من القوانين، خالق الدين هو ذاته خالق الإنسان والكون، وخالق الإنسان عارف بحقيقته وموقعيّته ومصالحه ومنافعه، لذا دوّن برامج لتأمين حقوقه ومنافعه ومصالحه، وعرضها في مجموعة اسمها (الدين) ليصل الإنسان إلى حقوقه.
إنّ قسمًا كبيرًا من الدين المشتمل على ما ينبغي وما لا ينبغي، جاء لتأمين حقوق الإنسان وحفظها، فــ (ما ينبغي) يعدّ طرقًا لتأمين الحقوق، و(ما لا ينبغي) يكون دليلًا لموانع تأمين الحقوق وآفاتها، ولأجل تأمين حقوق الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة، يجب الالتزام بالواجبات الدينيّة،
(36)ولأجل الابتعاد من الآفات والخطرات التي تواجه حقوق الإنسان يكون التحرّز من الأعمال القبيحة أمرًا لازمًا وضروريًّا.
جاء شخص إلى الإمام الباقر عليهالسلام فسأله عن سبب تحريم الخمر والميتة والدم في لحم الخنزير، فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّ الحلال والحرام لم يكن لرغبة الله في الحلال أو نفوره عن الحرام، بل إنّ الله تعالى خلق الإنسان ويعلم بما هو قوامه ومصلحته فأحلّها، ويعلم ما يضرّه فحرّمها. فالتكاليف الدينيّة لم تكن ثقلًا إضافيًّا على عاتق الإنسان كي يصل شخص ثالث مثلًا إلى المنافع بل إنّها لأجل وصول الإنسان نفسه إلى الحقّ، ولأجل رفع الموانع العالقة في طريق الحقّ.
وما يقال تارة بأنّ الدين يسوق الإنسان إلى التكليف ويُنشئ الإنسان قبل أن يلتفت إلى حقوقه، والإنسان المتديّن يكون مكلّفًا قبل أن يكون محقًّا، فهذا القول يرجع إلى نوعيّة رؤية القائل، فقد تتمّ المراجعة السطحيّة لألفاظ وكلمات: الحقّ والتكليف في قاموس القرآن والسنّة، وقد تُراجع بنظرة فاحصة وعلميّة ويتمّ التأمّل فيها. ففي الرؤية الأولى تكون النتيجة كما قالوها، ولكن في الرؤية الثانية نصل إلى نتيجة أخرى تباينها.
إذ الرؤية إلى الدين والتكاليف الدينيّة لا بدّ وأن تكون رؤية هادفة وغائيّة، كما أنّ الإنسان من وجهة نظر دينيّة ذو غاية. فلو نُظر إلى الدين برؤية هادفة لم يُر منه إلّا الحقّ المحض، وبهذه الرؤية يمكن إرجاع جميع التكاليف إلى الحقوق. ولو لم نشهد على مدى التاريخ الإسلاميّ وعند العلماء سيّما المتكلّمين هكذا مباحث؛ فسببه الأساس يرجع إلى أنّ النظرة إلى الدين وتعاليمه وأحكامه كانت تدور مدار الحقّ والحكمة والغائيّة، ولم يُتصوّر حينذاك وجود تمايز بين التكاليف الدينيّة (ما ينبغي وما لا ينبغي) وبين الحقوق. وهذه كانت موجودة لدى كبار متكلّمي الشيعة وحتّى بعض متكلّمي الأشاعرة.
(37)فقد ذهب ابن النوبخت في الياقوت، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل، والخواجه نصير الدين الطوسيّ في تجريد الإعتقاد، والعلّامة الحلّيّ في شرح التجريد، والمرحوم اللاهيجي في گوهرمراد، والسيّد الشريف الجرجانيّ في شرح المواقف إلى أنّ تكاليف الدين لا تخلو من الغرض والغاية، وإلّا لزم أن تكون الأفعال الإلهيّة عبثًا ومن دون فائدة، والحال إنّ الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب إيصال الإنسان إلى المنافع العظيمة؛ لأنّ الثواب الابتدائيّ لا يتناسق مع الكمال، حتّى إنّ تكليف من علم الله تعالى بثبوت كفرهم حسنُ ليعرّضهم للثواب والنفع.
وبناء على هذا، فإنّ الانشغال بالتكاليف الدينيّة والتعهّد بالأوامر الدينيّة، تكون منطلق الإنسان نحو التكامل والتعالي، ومقدّمة لفتح آفاق متعالية للشخص المكلّف والإنسان المتديّن.
قال السيّد الشريف الجرجانيّ في جوابه لمنكري التكاليف الدينيّة:
«إنّ التكليف لغرض يعود إلى العبد وهو المنافع الدنيويّة والآخرويّة».
فما أجملنا فيه القول آنفًا، إنّما هو رؤية أغلب علماء الإسلام حول الصلة بين الدين ورعاية حقوق الإنسان. ولكن نظر بعض العظماء إليها برؤية عرفانيّة، وجعل تكليف الإنسان في زمن التكليف، نوع حضور وتشرّف إلى ملكوت الذات الربوبيّة، فقد رأى رضي الدين علي بن طاوس الحلّيّ مع لحظ حكمة التكليف، إلى أنّه ناشئ من حاجة الإنسان الطبيعيّة وتكريم لحقّ الإنسان من قبل ذات الباري تعالى.
وبهذه النظرة لم تكن أيّ واحدة من تعاليم الدين وأحكامه تكليفًا
بمعنى المشقّة، بل إنّها وصول إلى الحقّ، ولم تكن الغاية مجرّد نيل الثواب، بل إنّها نموذج لتعالي الإنسان.
فالسيّد ابن طاوس بما أنّه ينظر إلى الدين من هذا المنظار، عقد احتفالًا عندما بلغ سنّ التكليف، وأسّس هذه السُّنة الحسنة الداعية إلى الاحتفال عند بلوغ سنّ التكليف. وقد أحيى هذه السُّنة لولده محمّد أيضًا، وكتب له كتابه القيّم (التشريف بتعريف وقت التكليف).
إنّه يرى أنّ الإنسان عندما نظر إلى مراتب وجوده ومراحله منذ البدء وحتّى الوصول إلى الرشد العقلانيّ، وعندما ينظر إلى كثرة النعم والبركات وعلى رأسها وجوده.. فبعد الاطّلاع على هذه النقطة تحصل له حالة الشكر، ويكتشف أنّ التكليف الدينيّ إنّما هو تكريم من الله في حقّه. وفي الواقع فإنّ التكليف هو ذاته التشرّف أي الدخول في مقام الخلافة الالهية والاستعداد لتلقي رسالة الله المؤثرة في إزالة ظلمات الجسم، والأصول إلى طهارة الروح.
فالدين لم يكن لمجرّد بلوغ الإنسان كماله الطبيعيّ، بل شرّع لحقيقة وجود الإنسان، وتمّ بناء أساسه على كماله الروحيّ والجسديّ. يقول العلّامة الطباطبائيّ رحمهالله في بيان هدف إرسال الرسل إنّهم جاؤوا لتعليم الناس العقائد والأعمال كي يصلوا على ضوئها إلى سعادتهم الواقعيّة. يجب أن يبني الإنسان حياته على أساس العقائد الدينيّة، وأن يعمل بوظائفه أمام الله وأمام المجتمع البشريّ، كي يصل إلى كماله.
والحاصل، فإنّ الدين لم يكتف بالاعتراف بحقوق الإنسان فحسب، بل إنّ غاية تشريع الدين إحياء حقوق الإنسان، وإنّ وجود التكاليف الشرعيّة ولحاظ العقوبات الدنيويّة والأخرويّة، لأجل تحديد وجهة الإنسان
نحو حقوقه الطبيعيّة. ومع التعرّف على هذه النقطة والوصول إلى هذا المقام، لم تكن أوامر الدين ذا مشقّة وعناء له فحسب، بل تكون مبشّرة وذات بهجة.
وفي الواقع، فإنّ إحساس المشقّة والعناء من التكاليف، وزعم مباينتها مع حقوق الإنسان، إنّما ينشأ من الكسل وهوى النفس والجهل والكبر، وإلّا لزم النقص في فلسفة الخلق، حيث إنّ خالق الإنسان مع كونه خلق الإنسان كأشرف الكائنات، أراد أن يهمل حقوقه جرّاء التعاليم التي أرسلها. وتوجد هنا مباحث كثيرة سنذكرها في الفصل الخامس تحت عنوان: (عودة التكاليف إلى الحقوق).
إنّ للإنسان في حياته حقوقًا ومميّزات لا بدّ منها لحياته الاجتماعيّة، ولم تكن بعض هذه الحقوق بتلك المرتبة من الأهميّة، ولو لم يلتفت إليها الشخص لم تكن لها تبعات سلبيّة عليه أو على غيره، ولكن لبعض الحقوق أهميّة كبيرة حيث إنّ إهمالها يوجب تضييع حقوق الآخرين. ولأجل أن يصل الإنسان إلى ما له من مميّزات في المجتمع، أو لأجل أن لا يتعدّى على حقوق الآخرين، لا بدّ من رسم بنية وضوابط يصل الجميع على ضوئها إلى خصائصهم وحقوقهم على سواء من دون التعدّي على حقوق الآخرين، وتسمّى مجموعة العقود الاجتماعيّة التي تدوّن لأجل تنظيم الأمور العامّة، قانونًا.
هذا القانون يُعدّ في المجتمعات الدينيّة تلك التعاليم والأحكام الوحيانيّة التي تمّ تبليغها تحت عنوان الشرع المقدّس إلى الأنبياء. كما أنّ حاجة الإنسان إلى القانون في المجتمع إنّما هو لأجل إحقاق الحقّ الفرديّ والاجتماعيّ وإحيائه، وسدّ باب الطغيان وتعدّي الآخرين وظلم الظالمين.
(40)وقد عُدّ هذا المعنى هدف تشريع الدين في القرآن: (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ﴾ وذيل هذه الآية يدلّ على أنّنا لو كنّا من أهل القسط والعدل وعدم ظلم الآخرين، لكنّا أقرب إلى الله وإلى دينه.
إنّ الله تعالى أرسل قانونه ليصل الناس إلى حقوقهم في المجتمع: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾ .
هل الناس في المجتمع ومن أجل نيل حقوقهم، بحاجة إلى نظام قانونيّ وآليّة منضبطة أم لا؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال: بأنّ أكثر الناس لا يمتلكون حسّ الحياء غير أنّهم يُطأطئون رؤوسهم أمام الخوف، ويرتدعون عن ارتكاب القبائح ليس لقبحها بل لما يتبعها من عقاب.
ولو كانت الثقافة الدينيّة لدى الناس من التعالي بحيث يرون الله تعالى ناظرًا وشاهدًا لجميع أعمالهم، وأنّهم في محضره، وتمكّنوا من تغليب الهدى على الهوى، فحينئذٍ إمّا أن يستغنوا عن القانون الاجتماعيّ المعدّ كوسيلة لحفظ حريم حقوق أفراد المجتمع، أو تصل الحاجة إليه إلى أدنى المستويات، ولكن لم يكن الأمر هكذا لدى أغلب الأفراد، بل إنّ فرعون الهوى يغلب موسى العقل كما قال علي عليهالسلام : «كم من عقل أسير تحت هوى أمير».
فالقانون يكون في الواقع بمثابة الجدار أو الحصن الذي كان يبنيه القدامى أطراف المدن والديار للأمن من هجوم الأعداء، يقول العلّامة
الطباطبائيّ في بحثة التاريخيّ والفلسفيّ لقصّة نوح عليهالسلام : كان الناس بعد آدم عليهالسلام يعيشون أمّة واحدة على بساطة وسذاجة، وهم على الفطرة الإنسانيّة حتّى فشى فيهم روح الاستكبار، وآل إلى استعلاء البعض على البعض تدريجيًّا، واتّخاذ بعضهم بعضًا أربابًا، وهذه هي النواة الأصليّة التي لو نشأت واخضرّت وأينعت لم تثمر إلّا دين الوثنيّة والاختلاف الشديد بين الطبقات الاجتماعيّة باستخدام القوي للضعيف، واسترقاق العزيز واستدراره للذيل، وحدوث المنازعات والمشاجرات بين الناس. فشاع في زمن نوح الفساد في الأرض، وأعرض الناس عن دين التوحيد وعن سنّة العدل الاجتماعيّ، وأقبلوا على عبادة الأصنام، وتباعدت الطبقات فصار الأقوياء بالأموال والأولاد يضيّعون حقوق الضعفاء، والجبابرة يستضعفون من دونهم ويحكمون عليهم بما تهواه أنفسهم (الأعراف، هود، نوح) فبعث الله نوحًا عليهالسلام إليهم بالكتاب والشريعة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وخلع الأنداد والمساواة فيما بينهم بالتبشير والإنذار .
فالقوانين الاجتماعيّة، سيّما القانون الإلهيّ، لم يكن لتحجيم حقوق الإنسان، بل جاءت لإحياء الحقّ الفرديّ والاجتماعيّ الملازم لتعالي الإنسان، فالقانون لصيانة الحقّ وسلامة النفس، ولم يكن لتبرير الظلم والجور، والحقّ هو ما بيّن القانون الإلهيّ حدوده وثغوره.
وقد استعمل بعض مفكّري الغرب في تعريف الحقّ والقانون عبائر لا تخلو من إشكال، يقول هوبز في تعريف الحقّ والقانون أنّه عبارة عن حرّيّة الإنسان في تفعيل أهوائه، والحقّ في الواقع هو الحرّيّة والاختيار، ولم تكن الحرّيّة سوى فقدان الموانع الخارجيّة أمام الإنسان، والقانون حكم يمنع رغبات الإنسان.
فتعريف هوبز للحقّ والقانون كلّيّ وناقص، لذا أشكل عليه بعض مفكّري الغرب ولم يقبلوا تعريفه، ويظهر أنّ مشكلة هذا التعريف تكمن في كلّيّته، ولأجل أن يكون التعريف جامعًا كان يلزم عليه أن يقدّم تعريفًا أدقّ للحقّ والقانون؛ لأنّ التعريف المذكور لا يوجد في القواميس اللغويّة ولم يكن مقبولًا لدى العلماء. ولم يكن من المقبول أبدًا تعريف مفهوم (الحقّ في الحرّيّة) بمعنى التحرّر التامّ ومن دون قيود وشروط؛ لأنّ رغبات الإنسان ليس لها حدود معيّنة، وربّما تسوق هذه الأهواء النفسانيّة الإنسان إلى أرذل مراتب الحيوانيّة، فكيف يمكن جعل انحطاط الإنسان ورذالته إلى هذا الحدّ، تعريفًا لمعنى الحقّ؟ إذ إنّ حقّ الإنسان هو الخلافة الإلهيّة، لا التوغّل في وحل أهواء النفس.
يمكن الحصول على النسبة بين الأخلاق والحقّ من خلال التعريف المقدّم للحقّ إلى حدٍّ ما، فللحقّ علقة وطيدة مع الأخلاق؛ فالفرد والمجتمع بمقدار اهتمامهما بالقيم الأخلاقيّة، يظهرون الالتزام بالحقوق. فالحقوق في المجتمع الذي لم يتخلّق بالأخلاق تكون في غاية التزلزل. ويظهر أنّ للأخلاق دورًا أكثر أهميّة من القانون في إحياء حقوق الأفراد في كثير من الموارد؛ لأنّ الوازع الداخليّ يكون أكثر ثباتًا واستقرارًا من العوامل الخارجيّة.
ويمكن القول بوجود رابطة التقابل بين الحقّ والأخلاق؛ لأنّ الفرد أو المجتمع لو لم يذعنان بالخُلق الإنسانيّة، يكون الحق نسبيا وغير مطلق. لأنّ كلّ شخص يميل الى أن يفسّر الحقّ طبقًا لميوله وأهوائه، ويتسلّط على حقوق الآخرين لنفعه الشخصي، وعندما يكون للغير على عاتقه حقوق، لم يرتض التنازل عنها بسهولة، فالإنسان يقنع بحقّه ويراعي حقوق الآخرين من
(43)دون ضغط القانون والعوامل الخارجيّة، حينما يمتلك سلامة النفس ويبتعد عن الاستكبار والاستعلاء في نفسه.
يقول الإمام السجّاد عليهالسلام في رسالة الحقوق المعطّرة بعطر السجايا الأخلاقيّة في جميع مفاصلها:
«وحقّ أهل ملّتك إضمار السلامة والرحمة لهم، والرفق بمسيئهم، وتألّفهم واستصلاحهم، وشكر محسنهم وكفّ الأذى عنهم، وتحبّ لهم ما تحبّ لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك».
وقد لخّص عليهالسلام حقوق المسلم على المسلم في سبعة بنود، لم يقدر عليها أحد إلّا بعد التخلّق بالصفات الأخلاقيّة.
إنّ سلامة النفس وإصلاحها، وحبّ الآخرين بمقدار حبّي لنفسي، واحترام الكبار بمثابة الآباء، وتكريم الشباب بمثابة الإخوان، والتوجّه نحو الشباب والأطفال بمثابة الأولاد، وتوقير العجائز بمثابة الأمّهات، والسعي نحو سعادة الآخرين، ومساعدة المظلومين، وإشباع الجوعان، وإكساء العريان، وعيادة المرضى، وتلبية حاجة المحتاجين، كل واحدة من هذه الخصال الأخلاقيّة الهامّة، توجب الاستقرار واستمرار الحقّ ووصول البشر إلى حقوقهم الحّقة، وإن لم نتمكّن بالوقت نفسه من إهمال المقرّرات المدوّنة تحت عنوان القانون.
فالحقّ والأخلاق توأمان، ويوجب فقدان أحدهما تزلزل الآخر كما أنّ إحياء الحقّ يستلزم وجود فضاء أخلاقيّ عند الفرد والمجتمع، وأنّ محوريّة الحقّ وطلب الحقّ يوجب انبعاث الصفات الأخلاقيّة الجيّدة كما يوجب تهذيب النفس وطهارتها.
لا شكّ أنّ الحريّة من أفضل النعم الإلهيّة، ومن حقوق الإنسان المتسالم عليها، غير أنّ معنى الحرّيّة، وحدودها واختلافها مع الحقّ والتكليف والنسبة بينهما، لم يكن بتلك الدرجة من الوضوح.
فتارة يقال: إنّ الحرّيّة تُحدّ بالعدالة وتكون حقًّا ما لم تضرّ بالعدالة، وهذا البيان ربّما يكون صحيحًا إلى حدّ ما، ولكن ما معنى العدالة ومن الذي يبيّنه؟ نحن نعتقد أنّ معنى العدالة الذي قيل إنّه وضع الشيء في موضعه، لا بدّ وأن يبيّنه الدين. وذهب البعض إلى عدم الحاجة إلى الدين، وبالإمكان إعطاء تعريف للحقّ والحرّيّة من دون الرجوع إلى الشريعة، فتفسير الحرّيّة وحدودها ونسبتها مع الحقّ والعدالة، أمور يمكننا الوقوف عليها، وهذا الرأي أنانيّ [يتمحور حول الذات]؛ لأنّه يُوكل ويُرجع إلى المجهول.
إذا قيل: إنّ الحرّيّة هي التي لا تتجاوز العدالة، وإذا تجاوزت العدالة لم تكن مشروعة، فهذا الكلام حقّ، ولكن لم يتم تبيين معنى العدالة وحدودها في هذا التعريف، وكذا تعيين مرجعيّةٍ لتعريف الإنسان العادل.
والأمر الآخر أنّ الدين يحتوي على الحقوق والأخلاق والأحكام، وهذه المباحث لم تندرج في حدود الفقه، بل لا بدّ من طرح الموضوع في نطاق أوسع من الفقه كي تكون الإجابة أكثر استدلالًا. فالمخالفون يذعنون بجميع هذه المفاهيم، ويذعنون بالحقوق والأخلاق والحرّيّة، ولكن عندما نصل إلى نطاق ومنشأ هذه المفاهيم، نرى أنّ ما يقصدونه من الحرّيّة والأخلاق والحقّ، لم يكن في الواقع أخلاقًا ولا حرّيّةً ولا حقًّا. وبهذا المعيار يمكن دفع الشبهات، فنحن نريد أن نتطرّق إلى منشأ الحرّيّة والحقّ بسلاح العقل والتفكّر.
(45)فالسؤال الذي يطرح نفسه أنّ مفهوم الحرّيّة والأخلاق والحقّ، هل يؤخذ من الثقافة والعادات والآداب وسنن الناس أم من الوحي؟
فما تمّ التسالم عليه في الأمم المتّحدة إنّما هو تفاهم وسطيّ وليس نهائيًّا، لوجود الخلاف دائمًا في معنى هذه الكلمات بين الآراء المختلفة، فمن يمتلك رؤية كونيّة توحيديّة، يفسّر العدالة والحرّيّة والحقّ بما يخالف من يمتلك رؤية كونيّة مادّيّة، ومنشأ هذا الخلاف هو الخلاف الإبستمولوجي.
إذ من المباحث المهمّة في الإبستمولوجيا مسألة أدوات المعرفة، فالبعض يعتمد على أداة واحدة والبعض الآخر على عدّة أدوات، فصاحب الرؤية المادّيّة يكتفي بالحسّ والتجربة في المعرفة، [نعم] بهذه الأداة المعرفيّة يمكن معرفة كثير من الأمور الطبيعيّة والمادّيّة، ولكن لا تكفي التجربة والحسّ للوقوف على روابط الموجودات، بل نحتاج إلى أداة أخرى هي العقل الذي أوسع نطاقًا من الحسّ والتجربة. فيمكننا توسيع نطاق العلوم بالعقل، والوقوف على روابط الظواهر بشكل أوسع، ولكن لا يعطي العقل معرفة كاملة للإنسان أيضًا، وهناك أداة أرفع من العقل هي الشهود العرفانيّ، والشهود هذا لا يعطي أيضًا معرفة كاملة للإنسان، فيكون الوحي والنبوّة أعلى منه، وهو في الواقع سلطان العلوم والمعارف.
فمن يقتصر في معرفة الإنسان على الحسّ والتجربة، يحدّد حياة الإنسان بالولادة والقبر ويكتفي بهذا المقدار، ويحصر هويّة الإنسان في هذه المرتبة الجسمانيّة، ويجعله رديفًا للنباتات والحيوانات ولكنه شجر وحيوان ناطق. فهم يجعلون دنياه محدودة بالعالم المادّيّ هذا فحسب، ويقولون لا توجد نشأة أخرى بعد الموت. فهذه الرؤية تؤثّر في تحديد المفاهيم كالحقوق والحرّيّة والأخلاق، فلا معنى للتكاليف والأحكام عندهم، وهذه هي النتيجة الطبيعيّة لواحديّة الأداة (الحسّ والتجربة)؛ لأنّ الحسّ لا يولي معرفة للإنسان أكثر من هذا.
(46)ثمّ إنّ العقل والمنطق والرياضيّات، يوقفنا على نطاق أوسع، فطريق الفلسفة والحكمة لا بأس به، غير أنّه لا يوصلنا إلى نهاية الطريق. يقول العقل لنا بأنّنا جئنا من ديار بعيدة، غير أنّه لم يقل لنا أين هذه الديار. إنّه يوصلنا إلى منتصف الطريق ولا يوصلنا إلى الهدف. فالعقل هذا يقرّر ويعترف بعجزه عن إدراك بعض الأمور. وعليه، لا بدّ من التمسّك بأداة أخرى أرفع من العقل وهي الوحي والنبوّة.
فلا بدّ من تحليل الموضوع على ضوء هذا البيان الذي ذكرناه، كمدخل، فبهذه الرؤية تتّضح كثيرًا من المبهمات والاختلافات، وترتفع بعد التحليل والفحص المنطقيّ. فإذا اختلف مفهوم الحرّيّة والحقّ عند القوانين الدوليّة مع ما يقوله الفلاسفة وحكماء الإسلام، إنّما هو بسبب اختلاف المباني الأنطولوجيّة من جهة والإبستمولوجيّة من جهة أُخرى. فالخلاف بين شريحتين كبيرتين من أهل العلم والنظر لم يكن ظاهريًّا وصوريًّا بل مبنائيّ. إنّهم تطرّقوا إلى هذه المفاهيم من خلال أداة الحسّ والتجربة، بينما تطرّق إليها حكماء الإسلام بأداة الحسّ والعقل والوحي، وقاموا بتحليل الموضوع.
قالوا في تعريف الحرّيّة إنّها عبارة عن الاختيار في اتّخاذ القرار والعمل، وكلّ إنسان بحاجة إلى الاختيار في تحسين وضعه المادّيّ، ولكن من دون تحديد حدود الاختيار هذا. فالإنسان حرّ ومختار وله الحقّ في اتّخاذ أيّ قرار والعمل به، فلو كلّفناه بالأحكام والتكاليف، سلبنا عنه في الواقع حرّيّته، وعليه فالإنسان المكلّف لم يكن حرًّا، ولكن الإنسان الحقّ يكون صاحب الاختيار والحرّيّة، فالحرّيّة تتناسب مع كون الإنسان محقًّا ولا تتناسب مع كونه مكلّفًا.
وفي مقام الإجابة عن هذه الشبهة وتحليل البحث بشكل صحيح، لا بدّ في البداية من إعطاء معنى واضحٍ للحرّيّة، هل الحرّيّة في قاموس الدين
(47)والثقافة الإسلاميّة تكون بالمعنى نفسه الذي ذهب إليه بعض المتنوّرين، أم لها معنى آخر؟
فما قاله علماء الدين في معنى الحرّيّة قديمًا وحديثًا، يختلف تمامًا عن تعريفها لدى العلمانيّين، إذ إنّهم بعدما زعموا أنّ كمال الإنسان في التمتّع بالملاذ الجسديّة، وأنّ شأنه الوجوديّ وشخصيّته لم تكن غير هذا، ذهبوا في معنى الحرّيّة إلى هذا التعريف الغائيّ، وقالوا: الحرّيّة هي تحرّر الإنسان من أيّ قيد وتعهّد في مقام اتّخاذ القرار والعمل .
ولكن لا بدّ من الالتفات إلى أنّ كمال الإنسان هل هو ما قالوه، وإنّ شحصيّته هل تنحصر في البعد المادّيّ والجسديّ، وليس له هويّة أخرى؟ فلو كان هذا المبنى أساسًا لفكر الشخص فكلامه صحيح، غير أنّ هذا المبنى بعيد عن المباني المأخوذة من الوحي والنبوّة.
يقول ابن مسكويه في كتابه القيّم طهارة الأعراق عند الإجابة عن هذه النظريّة بأنّ الشريعة أفضل حامٍ للعدالة والحرّيّة؛ لأنّ الإنسان مدنيّ بالطبع، والدين يرسم له قواعد الحياة، ومن يُعبّر عن الحرّيّة بعنوان إرضاء هوى النفس والشهوات الحيوانيّة، يجعل روح الإنسان عبدًا مملوكًا أو عاملًا في خدمة الجسد، بحيث يهيّئ له المأكل والمشرب بحسب ما يشتهيه، وهذا ظنّ أغلب الناس .
وقد أشار المرحوم صدر المتألّهين في الحكمة المتعالية عند شرح الحرّيّة إلى هذا الأمر، وقال:
«إنّ النفس إمّا أن لا تكون مطيعة بغريزتها إلى الأمور البدنيّة ومستلذّات القوى الحيوانيّة، وإمّا أن تكون مطيعة لها، فالتي لا
تكون كذلك هي الحرّة، وإنّما سمّيت بها لأنّ الحرّيّة في اللغة تطلق على ما يقابل العبوديّة... فظهر من هذا أنّ الحرّيّة الحقيقيّة، تكون غريزيّة للنفس».
فلو اقترنت الحرّيّة بالحكمة، يتمكّن الإنسان من التحرّر من أسر المادّيّات والشهوات، وهذا هو كمال الإنسان وفضيلته وسعادته وعزّته.
وقد أراد سائر الحكماء وعلماء الدين من الحرّيّة هذا المعنى أيضًا، أي ما جاء في المتون الدينيّة (الكتاب والسنّة)، فحدّ الحرّيّة في الثقافة الدينيّة يمتدّ نحو تحصيل العزّة الإنسانيّة والكمالات المعنويّة في الدنيا والآخرة، والحرّيّة تعني إقرار المتطلّبات العقلانيّة، لا اختيار وإعمال الإرادة نحو الأهواء النفسانيّة، فالدين وإن حدّد الحرّيّة في مقام التعريف نوعًا ما، بحيث أخرج أهواء النفس من حدود الحرّيّة، غير أنّه وسّع حدودها كثيرًا بمعنى عدم وجود أيّ قيود لابتناء الحرّيّة على التعقّل والفكر في الثقافة الإسلاميّة الملكوتيّة.
وقد تجلّت أجمل معاني الحرّيّة وأفضلها في القرآن في قصّة يوسف؟ز حيث قال؟ز لصاحبه: ﴿يَاصَاحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ 39 ........ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .
إنّ معنى الحرّيّة في نظر الوحي والنبوّة يعني التسليم أمام قدرة الواحد القهار، ومكافحة الأرباب المتفرّقين، لذا نهت بعض آيات القرآن بشدّة الركون إلى الظالمين وأصحاب القدرة والسلطة، وجعلت نتيجة هذا الركون
العبوديّة والأسر ومصاحبة النار: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ﴾ .
وقد صرّحت بعض الآيات أنّ حدود الحرّيّة إنّما هي كمال الإنسان وسعادته وعزّته وتحرّره من أسر هوى النفس، وجعل القرآن من يزعم أنّ العزّة في متابعة فرعون النفس، وأنّ حرّيّة الإنسان تعني الحرّيّة في اتّخاذ القرار والعمل بالشهوات، مخدوعين قد ضلّوا سبيل الحياة الواقعيّة، وبما أنّهم لم يستسلموا لحكم الله وقعوا في عبوديّة فرعون والفراعنة: (وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ) ﴿وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ أي أنّ من طلب العزّة والكرامة زعم أنّها عند الآلهة المصنوعة، والحال أنّ تلك الحياة التي تنشأ تحت قدرة غير الله إنّما هي أذلّ أنواع الحياة.
يقول أمير البيان عليهالسلام في كلامه الثمين: «فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين» وقد جعل شرط الوصول إلى الحرّيّة والكمال الواقعيّ، تطهير النفس من درن الشهوات، وقال: «طهّروا أنفسكم من دنس الشهوات تدركوا رفيع الدرجات».
فالأثر الكبير ونتيجة المعرفة التوحيديّة، هي الحرّيّة في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، ولا يزعمنّ أحد أنّ الحرّيّة أمر مستقلّ منقطعة الصلة مع العقائد والأفكار ولا يكون لها مبنى أبستمولوجي.
فعندما ينمو التوحيد في القلب ويزدهر، تنتج الحياة الخالدة والثقافة المقرونة بالحرّيّة في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، والإنسان الموحّد هو الذي
يذوق طعم الحرّيّة حصرًا، وبإمكانه تنفيذها في حياته الفرديّة والاجتماعيّة لنفسه ولغيره.
لقد عبّر المعجم الدينيّ عن الذين لم يستندوا على الله، وجعلوا هواهم آلهتهم، بالصمّ والبكم الذين أسرتهم الشهوات وقلبت لهم الحقائق، أنّهم عندما يُسلبون من الحرّيّة الحقيقيّة يجدون أنفسهم في أسر الخرافات والموهومات، فيزعمون الأسر حرّيّة والحرّيّة عبوديّة، فهؤلاء وإن تغنّوا بشعار الحرّيّة غير أنّهم أُسروا خلف زنزانة أهواء النفس، ومن كان مقيّدًا وأسيرًا كيف يمكنه أن يحرّر الآخرين، إذ الأسير لا يتمكّن من تحرير نفسه فكيف يتمكّن من هبة وسام الحرّيّة لغيره، يقول الله في وصف هذه الفئة: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزْقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ75 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ .
مع لحاظ ما مرّ من الكلام لحدّ الآن، يمكننا الوقوف على علقة الإيمان وحقوق الإنسان إلى شكل كبير، والوقوف أيضًا على هذا الأصل الكلّيّ بأنّ العقيدة والإيمان بتعاليم الله، تعدّ أساس حقوق الإنسان؛ لأنّ من آمن بالله واعتقد بالدين الإلهيّ، عرف أنّ الله هو منشأ الحقوق فقط، وعليه فإنّ معرفة الدين الإلهيّ يستلزم العلم بمنشأ حقوق الإنسان، وهي مقدّمة لتحصيل ذلك [أي الحقوق].
محور البحث في هذا الفصل يدور حول مباني الحقّ والتكليف عند علماء الإسلام والغرب، ولأجل تبيين المسألة لا بدّ من الالتفات إلى أنّ اختلاف المباني يرجع في الغالب إلى اختلاف المصادر، وهذا الاختلاف يغيّر مسير التفكّر لدى الإنسان، ولذا يندر أن يحصل الوفاق في المباني النظريّة والمعرفيّة عند اختلاف المنابع والمصادر، وهذا أصل أساسي ومعيار مهمّ في جميع المباحث النظريّة والعمليّة.
وبناء على هذا، فإنّ المباني العقديّة الناشئة من العقل والوحي والنصوص الدينيّة، لا تتساوى مع العقيدة الناشئة من التجربة والعقل الأداتيّ، فالاختلاف بين العلماء في طريقة التفكّر والانطباعات حول الحقّ والحكم والتكليف وسائر المباحث الحقوقيّة، إذا كان مبنائيًّا - لا منهجيًّا - يعود إلى اختلاف المصادر في الأغلب.
ويظهر أنّ مسائل الحقّ والتكليف وجميع المسائل الحقوقيّة والفقهيّة إذا لم تبحث بشكل جذريّ، سوف لا تثمر نتائج مرضيّة، وفي الواقع فإنّ هذا البحث يتفرّع من موضوع الإبستمولوجيا والأنثروبولوجيا والأنطولوجيا (معرفة الله والدين) كما أنّ الحقوق والأحكام والتكاليف، مفاهيم تفسّر
(53)على ضوء الإنسان والحياة الفرديّة والاجتماعيّة وعلقته مع القوّة الأعلى، لذا لا بدّ قبل كلّ شيء من إيضاح هذه الأمور المحوريّة ونوع علاقتها مع مسألة الحقّ والتكليف. ولأجل التنسيق والترتيب المنطقيّ للمباحث، نتطرّق إلى هذه المواضيع تحت عنوان علاقة الأبستمولوجيا مع المسائل الحقوقيّة، ونسبة الأنطولوجيا مع مسألة الحقّ والتكليف، وعلاقة الأنثروبولوجيا مع معرفة الدين.
لا يوجد شكّ في الترابط الوثيق والنسبة العميقة بين المسائل الحقوقيّة والمباني المعرفيّة؛ لأنّ العنصر المحوريّ لهذه المسائل يوجد في مباحث نظريّة المعرفة.
توجد آراء ونظريّات كثيرة في مباحث نظريّة المعرفة، غير أنّه يمكن بيانها تحت رؤيتين كلّيّتين؛ الرؤية التي تحصر معيار المعرفة والفهم البشريّ في الحسّ والتجربة، ولا تقبل أيّ أداة أُخرى للمعرفة. وقد ذهب كثير من المفكّرين إلى ظهور هذه الرؤية منذ عصر التنوير في الغرب، وعلى يد أغوست كنت مؤسّس مدرسة الوضعيّة، ولكنّ تاريخها يعود إلى أبعد من ذلك، كما أنّ القرآن الكريم ينسب نشأتها إلى مشركي زمن موسى عليهالسلام، ويقول: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾.
هذه رؤية من يجعل الحسّ والتجربة أساس المعرفة، ويحصر جميع الكون في وجوده المادّيّ ولم يعتقد بما وراء الطبيعة.
وهناك رؤية أُخرى ترى أنّ المعارف البدائيّة تحصل بواسطة الحسّ والتجربة ولا يمكن إنكار هذا النوع من العلوم والمعارف الحسّيّة، كما يصرّح القرآن الكريم بذلك: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ .
ولكن توجد معارف أعلى من الحسّ والتجربة، يستفاد منها في كثير من العلوم، معارف تعدّ أساس علم الرياضيّات، فهكذا معاني ومفاهيم رياضيّة وإن لم تكن بمعزل عن المادّة، غير أنّها لا تملك صورًا مادّيّة وخارجيّة ولا يمكن تقسيمها أيضًا. وهذه الحزمة من المعارف يقال لها المعارف الرياضيّة.
وهناك معارف أرقى من المعرفة الرياضيّة، وهي التي تدير الكلام والحكمة، ويدرك الإنسان كثيرًا من الأمور بواسطتها، كالمجردات العقليّة، والملائكة، والوحي، والنبوّة، والرسالة، والخلافة والإمامة، وأسماء الله حيث لم تندرج في نطاق الحسّ والتجربة الطبيعيّة أو الإدراك الممزوج بالرياضيّات، بل إنّها مفاهيم مجرّدة محضة تقع في نطاق الحكمة والكلام.
والأرقى من الحكمة والكلام، هو العرفان النظريّ الباحث عن الهويّة المطلقة ولا بشرط المقسميّ للوجود، وموضوعه أرقى بمراتب من موضوع الحكمة والكلام. وقد ورد التأكيد الكثير في الآيات والروايات على هذا القسم من المعرفة التي لا تكون في الواقع سوى العلوم والمعارف الشهوديّة، حيث يقصد الشارع في هذه البيانات الالتفات إلى تلك المعارف وعدم الاكتفاء بالمعرفة الحسّيّة والعقليّة، فقد جاء في الكلام الإلهيّ: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ وفي آٰية أخرىٰ: ﴿أَفَمَنْ
شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ وفي موضع آخر ﴿وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ﴾ .
وقد ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«إنّ الله خلق خلقه في ظلمة ثمّ ألقى عليه شيئًا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى، ومن أخطأ ضلّ».
وقد سُئل عارف ما حقيقة المعرفة؟ قال: نور أسكنه الله قلوب خواصّه. هذه كلّها مراتب المعرفة ومراحلها، وسلطان هذه العلوم إنّما هو معارف وعلوم الأنبياء والأولياء، ويقال لها الكشف ووحي خليفة الله المعصوم. فلنظريّة المعرفة أداة متعدّدة ومراتب مختلفة، أدناها الحسّ والتجربة وأرقاها الكشف والشهود العرفانيّ لدى العرفاء أي تختم بالوحي وكشف الأنبياء والأئمّة المعصومين.
ولو أراد شخص أن يتكلّم عن الحقّ والتكليف وسائر المسائل الحقوقيّة والفقهيّة بالابتناء على هذه المعارف، لا بدّ أن يلحظ من الأعلى إلى جميع المراتب والمراحل، وأن يحفظ حقوق جميع الأدوات المعرفيّة وشؤونها بحيث لا تختلف مع أيّ حلقة من حلقات المعارف.
وبهذا البيان الإجماليّ تتضح علاقة الحقّ والحكم والتكليف مع الإبستمولوجيا، كما أنّ حدود هذه المسائل تتعيّن مع لحاظ معيار المعرفة، بمعنى أنّ من يحصر أداة المعرفة في الحسّ والتجربة فقط، يقوم بإثبات
الحقّ والتكليف وجميع المسائل الحقوقيّة والأخلاقيّة على ضوئها ولا يتمكّن من إثبات ما وراءها. فالحقوق لهؤلاء تفسّر في نطاق الأمور المادّيّة فقط، ولا يوجد مصداق لحقوق الإنسان المعنويّة، وتكون التكاليف مجرّد عوامل لتنظيم السلوك الأخلاقيّ وتكون ضروريّة لأجل احترام القانون. وقد بيّن كثير من متفكّري الغرب الحقّ والتكليف بهذا المستوى.
إنّ البحث الأنطولوجي متأخّر عن الإبستمولوجيا في مقام الإثبات، غير أنّه متقدّم عليه في مقام الثبوت، وقد ظهرت مدراس مختلفة بهذا الخصوص، يمكن إرجاع جميعها إلى رأيين كلّيّين مفتاحيّين؛ المدرسة الإلهيّة، والمدرسة التي يحصر أتباعها جميع الكون في المادّة، وإنّ كل موجود لا بدّ وأن يكون مادّيًّا ومحسوسًا، وعلى عكس النقيض كلّ ما لم يكن مادّيًّا ومحسوسًا ليس بموجود، يرى هؤلاء أنّ أيّ نوع من الأمور الميتافيزيقيّة كالعقول والمجرّدات والوحي والنبوّة وغيرها، كلّها خرافة وأساطير وافيون، يقول القرآن في وصف هذه الفئة: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ وأيضاً ﴿يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ .
هذا الفكر الإلحاديّ زمن صدر الإسلام وقبله، يضرب بجذوره من حيث الإثبات في الإبستمولوجيا الحسّيّة، وقد تمّ إحياؤه في بعض المقاطع التاريخيّة سيّما عصر النهضة الأوروبيّة، وسرت أفكاره ودعاياته إلى بعض المسلمين أيضًا.
نهض في الغرب علماء كبار ومفكّرون عظام، قدّموا في موضوع معرفة الله ومعرفة الكون دراسات مؤثّرة، ولكن أدّت بعض العوامل من داخل الدين وعلل من خارجه، الى أن يذهب جمع كثير من مفكّري الغرب في العصر الحديث إلى بيان بعض الامور الانطولوجية، لم تكن واقعيّة في كثير من الأحيان، وقد أدّى اعتماد هؤلاء على الحسّ والتجربة، ورفض المعارف العقليّة والفطريّة والقلبيّة والوحيانيّة وكلّ المعارف غير الحسّيّة وغير التجريبيّة، إلى إحيائهم الأفكار الإلحاديّة وتجديد شرك المشركين أمام توحيد الأنبياء الإبراهيميّين (موسى وعيسى ومحمد عليهمالسلام ).
إنّ اعتراف مؤرّخي الغرب المنصف والمعقول، يدلّ على أنّ ما يتمّ تداوله وتبيينه وتبليغه اليوم في الغرب بواسطة كثير من المفكّرين، والذي أصبح الفكر الغالب على عقول أولئك الناس، بحيث ساق كثيرًا من الأتباع نحوه، انما هو تلك الأفكار التي جرت على لسان مخالفي الأنبياء الإبراهيميّين أمام الأنبياء ورسل الله تعالى. ونشير فيما يلي إلى قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وما جرى على لسانهم بهذا الخصوص.
لقد طلب البعض من نبيّ الله موسى عليهالسلام بأن يجعل لهم إلهًا كما لعبدة الأصنام فخاطبهم موسى ونسبهم إلى الجهل: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلـٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وعندما ذهب موسى إلى الجبل، وعبدوا العجل بإغواء السامري، قالوا في جواب هارون خليفة موسى عليهالسلام: ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾ .
وفي زمن عيسى عليهالسلام عندما قال لهم: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ﴾ .
لقد أنكر مخالفو الأنبياء أكبر المعاجز؛ لأنّهم لم يريدوا التفكّر في ما وراء الطبيعة، بل كانوا يحبّون أن تتلخّص جميع الأمور وحتّى الله في المادّة.
وقد تجلّت بالتحقيق أفكار المعاندين ومخالفي الأنبياء في القرون الماضية عند الغرب في عصرنا الراهن، حيث تسعى هذه الأفكار ربط جذور الأنطولوجيا ومبدأ العالم بالأمور المادّيّة. ان أغلب كلام مفكّري الغرب وكذلك الأفكار الغربيّة المطروحة،انما تذكر وتبين نفس ما يرجع أصله وأساسه إلى الفكر الإلحاديّ عند مخالفي الأنبياء، ولا يرجع إلى كلام أنبياء الله.
ولقد بيّن الأنبياء ورسل الله عقائدهم وأفكارهم بشكل جليّ، بحيث كان كلامهم مفهومًا لعامّة الناس، إذ يعدّ الابتعاد عن الإبهام في الكلام من أبرز خصائص جميع الأنبياء؛ لأنّ مسيرهم وهدفهم واضح، ولا توجد ضرورة للكلام المغلق، إنّ الإبهام في الكلام لغير الخواصّ لم يكن هاديًا فحسب، بل كان مغويًا في كثير من الموارد.
إنّ الفكر الإلحادي يُبيّن بشكل مبهم ومغلق في الأغلب كي لا يفهم المخاطب شيئًا أو يعجز عن الفهم الدقيق، وهذه الخاصّيّة توجد في أغلب آثار مفكّري الغرب الذين يتطرّقون إلى مباحث الأنطولوجيا، وقد طرحت هنا مباحث غير برهانيّة وغير معقولة، نشير إلى بعضها:
ذهب البعض منهم، مثل: غابريل، مارسل وياسبرس إلى إبطال دلائل إثبات وجود الله مطلقًا، والبعض الآخر مثل جان سارتر أنكروا أصل وجود الله وقالوا إنّ الإنسان يعيش في عالم فارغ من الله. وقبل البعض مثل بارت وكيركغارد وجود الله في حدود التجربة الدينيّة وأنكروا إثباته العقلانيّ. وقسم آخر، مثل: تيليش وأتباعه، فكّكوا بين المعبود والخالق وفرّقوا بين الألوهيّة والربوبيّة، وهناك آخرون، مثل: كانط ولوك، أنزلوا براهين إثبات الحقّ والله إلى مرتبة البراهين الأخلاقيّة. أمّا أتباع هيغل الملحدون، مثل: فيورباخ وماركس وأنجلس، جعلوا الاعتقاد بالله نوعًا من الاغتراب وتحميل الانضباط، وأخيرًا هناك فرقة، أمثال: أسبينوزا ولايب نيتز، فسّروا الله كوجود مطلق وكلّيّ. وكانت نتيجة هذه الرحلة الفكريّة أن أقاموا أدلّة على عدم وجود الله، وخصّصوا فصولًا حوله في كتبهم .
هذه الأمواج الفكريّة العظيمة، تسمى في القرآن الطائف الشيطانيّ الذي ظهر في مغرب العالم، وتمّ الترويج له من خلال مراكز الدعاية العالميّة، بحيث غرق الإنسان الغربيّ في بحره المواج والمتلاطم من الحيرة والضياع، ونظروا إلى جميع حقائق الكون حتّى الخالق برؤية الشكّ والظنّ، وعلى حدّ تعبير أحد مفكّري الغرب المشهورين أنّ البشر اليوم في الغرب محكوم بالعيش في السحر والأساطير العلميّة والاجتماعيّة والسياسيّة.
وهذا السحر أدّى إلى زعم بعض الأشخاص بأنّ الإنسان لم يمتلك مفهومًا ثابتًا عن الله في الثقافات والحضارات المختلفة، وأنّ إله إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم مختلف.
كان أصحاب الفكر والنظر المسلمين، منذ ظهور الإسلام وإلى يومنا الحاضر، وبناء على تأكيد أئمّة الدين وقادتهم ووصاياهم، يدأبون دومًا في المباحث الأنطولوجيّة ومعرفة كنه العالم، وبما أنّهم ينهلون من منبع الوحي، لم يتردّدوا أبدًا في عالم ما وراء الطبيعة، وقد جعلت آيات وروايات كثيرة، الاستفادة من التفكّر والتعقّل ثقافة عامة المسلمين، وجعلت أساس التديّن الاعتقاد الصحيح بمبدأ الوجود.
فتكرار كلمات التفكّر والتعقّل ومشتاقاتهما أكثر من ثلاثمائة مرة من جهة، وتقديم أدلّة كثيرة في قالب الأشكال المنطقيّة والاستدلالات العقليّة العميقة من دون الاستفادة من كلمة التفكّر والتعقّل من جهة ثانية، تدلّ على اهتمام الإسلام بمبادئ اليقين ومباني العلم القطعيّ.
ولعلّ من مميّزات القرآن على سائر الكتب السماويّة، هي هذه النقطة، كما يقول العلامة الطباطبائيّ رحمهالله بأنّ أيّ كتاب سماويّ لم يقدّم العلم والمعرفة البرهانيّة كالقرآن وقد علّم القرآن معرفة الله للناس من طرق مختلفة وألجأ أفكارهم إلى التفكّر في الخلقة أكثر من أيّ شيء آخر، ونبّههم على أنّ هذا العالم الفسيح المشحون جميع أجزائه بنظم واستحكام خاصّ، يحكي عن وجود خالق لا يمكن إنكاره يقول القرآن بكلّ صراحة: ﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أو يقول: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾ .
وقد ورد التأكيد في تعاليم أهل البيت عليهمالسلام أيضًا على هذا الأمر،
يقول أمير البيان علي عليهالسلام : «أوّل الدين معرفته» . وعلى غرار منهج القرآن وطريقة أهل البيت عليهمالسلام سعى علماء الدين سيّما علماء الشيعة وبطرق مختلفة، إلى إثبات مبدأ الوجود للناس، وبما أنّهم استعملوا في هذا الأمر جميع الأدوات المعرفيّة كالحسّ والتجربة، والبرهان العقليّ، والشهود القلبيّ، والتجربة الباطنيّة، والفطرة والوحي، نالوا نجاحًا كبيرًا.
وقد تكلّم بشكل واضح المتكلّمون وحكماء الإسلام الكبار بهذا الخصوص، كالشيخ المفيد، والسيّد المرتضى، والخواجه نصير الدين الطوسيّ، وأبي علي سينا، وشيخ الإشراق، والشيخ البهائيّ، ومير داماد، ومير فندرسكي، والإمام الخمينيّ، والعلّامة الطباطبائيّ، وكثير من كبار علماء الإسلام الآخرين.
وهذا هو سرّ المدرسة الإلهيّة أمام المدرسة الإلحاديّة، كما أنّ آراء أتباع هذه المدرسة لا تحصر نظام الخلقة بالمادّة والمادّيّة، بل ذهبوا إلى أنّ الوجود على قسمين: مادّيّ ومجرّد، خلافًا للمفكّرين المادّيّين الذين حصروا الكون في نطاق المادّة.
وأساس الفكرة الإلهيّة تدور حول أنّ مجموع الظواهر في المنظومة الكونيّة تنقسم حول عنصر محوريّ واحد وضمن أربعة أقسام:
أ - الظواهر المادّيّة: فهناك من الموجودات تدخل ضمن الظواهر الطبيعيّة ولها حجم ووزن، وهي جميع الموجودات المادّيّة.
ب - الموجود المستكفي: وهي موجودات وإن لم يكن لها مادّة، غير أنّها تحتوي على لوازم المادّة كالشكل والصورة، من قبيل ما يراه الإنسان في الرؤيا، فالموجودات غير المادّيّة التي تحتوي على صورة وكيفيّة
تتواجد في العالم ويطلق عليها في الاصطلاح الموجود المثاليّ الذي له مقدار دون مادّة، كما أنّه غير قابل للتقسيم والتوزين والتجزئة.
ت - الموجود التامّ: ويطلق على طائفة من الموجودات تكون مجرّدة عقليًّا، كالملائكة وحملة العرش واللوح والقلم والكرسيّ، وهي أفضل من القسم الثاني.
ث - الموجود الذي أرقى من التامّ: وهو الوجود الذي أرقى وأعلى من جميعها وهو خالقها وبارؤها، ويطلق عليه اصطلاحًا (الموجود الأرقى من التامّ)؛ لأنّ هذا القسم الخاصّ من الموجود، لم يحتوي على جميع الكمالات بشكل غير محدود فحسب، بل يكون سببًا لتأمين حاجة جميع الموجودات وإكمالها.
وبناء على هذين المدرستين الإلهيّة والإلحاديّة يكون الموجود في المباحث الأنطولوجيّة ومعرفة المبدأ إمّا منحصرًا في عالم المادّة أم لا، فإذا لم ينحصر في عالم المادّة ينقسم إلى التقسيمات الأربعة المذكورة، وتكون نسبة هذا البحث مع مسألة الحقّ والحكم والتكليف وسائر المسائل الحقوقيّة والإنسانيّة، إنّنا لو قلنا بموجود أرقى من الموجود التامّ، لا بدّ أن نذعن بأنّ ذلك الوجود غير المتناهي هو الذي يعيّن الحقوق والتكاليف والأحكام حصرًا؛ لأنّه منشأ الوجود، ويقع جميع نظام التكوين والتشريع تحت تدبيره وربوبيّته، ويكون الإنسان مسؤولًا أمام أوامره وتعاليمه دون غيره، فتشريع الحقّ والحكم والتكليف وتقنينها بعهدة الوجود الأرقى من التّام دون غيره، ولكن إذا حصرنا الوجود في المادّة والأمور المادّيّة، لا بدّ أن ترتبط جميع أعمالنا بالأمور الطبيعيّة والمادّيّة دون أن يخرج شيئًا من نطاق الطبيعة.
وبناء على تعاليم القرآن، فإنّ عدم قبول المبدأ الإلهيّ، والبعد عن
(63)مدرسته، وترك الحقوق الدينيّة، يلازم قبول المبدأ المادّيّ، والعمل بأوامر الأهواء النفسيّة، كما يقول القرآن بهذا الخصوص: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ .
ويقول القرآن بخصوص تفكّر بعض علماء النصارى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ .
ثمّ إنّه وإن لم يمكن حصر أصل الفكر والنظر البشريّ بزمان أو مكان خاصّ، غير أنّ ظهور بعض الأفكار ربّما تترك أثرها لمدّة مديدة على أفكار الآخرين، فرؤية الغرب في التمسّك بالطبيعة كمبدأ الوجود، إن كانت ناشئة من الغفلة، لم يكن وسمها بالإلحاد، وإن كانت مع علم والتفات كالفكر العلمانيّ، فإنّها في الواقع رؤية وعقيدة إلحاديّة، بمعنى أنّ الفكر العلمانيّ قد تعدّى حلقات فكر المشركين القائلين بوجود الله كواجب وخالق المنظومة الكونيّة وربّ الأرباب، غير أنّهم اختلفوا في الأرباب الصغار، وذهبوا إلى أنّ الملائكة ارباب ومدراء البحار والصحراء والإنسان والصلح والحرب والملائكة وأنّ تدبير المخلوقات بيدهم، فعدم التوجّه نحو الله في بعض الأمور الطبيعيّة أو الشؤون الإنسانيّة إنّما هو الشرك في الربوبيّة، الراجع إلى زمن الجاهليّة قبل الإسلام، ونشاهد رشحات منه في جاهليّة القرن العشرين.
والحاصل أنّه يوجد في الفكر الدينيّ بين الله الخالق، وبين المجتمع الإنسانيّ المخلوق حقوق، يرى العباد بأنّهم ملزمين بأدائها، وعند أداء
حقوق، قد ألزم الله على نفسه أداء حقوق عباده، يقول الإمام السجّاد عليهالسلام بهذا الخصوص:
«فأمّا حقّ الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئًا، فإذا فعلت بالإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة».
إنّ الأنثروبولوجيا [معرفة الإنسان] تعدّ من مباني مسألة الحقّ والتكليف، فإذا تأزّمت مسألة الحقوق والتكاليف والأحكام حول الإنسان عند البعض، لا بدّ من البحث عن عللها وعواملها ومنشأها. ومن العوامل التي توجب ظهور هذا النزاع، إنّما هو عدم إعطاء تعريف دقيق وصحيح لحقيقة الإنسان. إذ إنّ كثيرًا من الشبهات هنا، تنشأ من التعاريف المختلفة في ماهيّة الإنسان والتصوّر المختلف حول حقيقته.
فهل معنى الإنسان من منظار المجتمع الإسلاميّ هو ذاته عند غير المسلمين؟ وعندما نتكلّم عن حقّ الإنسان وتكليفه، فهل المراد من الإنسان هو هذا الجسم الظاهريّ والشكل الصوريّ، أو أنّ لشاكلته الوجوديّة بعدًا آخر ما فوق الطبيعة عدا بعده الطبيعي؟ فالجواب الصحيح لهكذا أسئلة يؤثّر في فهم المطلب ورفع المنازعات بشكل كبير، لذا سنبحث هنا إجمالًا عن مفهوم الإنسان وماهيّته من مختلف المناظر.
من المواضيع التي كثر البحث حولها عند مفكّري الغرب، وكانت تقريبًا محور المباحث الفلسفيّة، موضوع معرفة الإنسان [الأنثروبولوجيا]،
ولا يبعد ظهور بعض المدارس الغربيّة جرّاء هذا البحث، ولأجل تحليل موضوع معرفة الإنسان وفحصه في الغرب، يلزم لحظ ثلاث مراحل، فترة ما قبل الحداثة (التراث) فترة الحداثة (التجدّد) وفترة ما بعد الحداثة. ومدّعى بعض مفكّري الغرب الجدد أنّ الإنسان لم يمتلك أيّ شأن ومنزلة في فترة ما قبل الحداثة، وحاز في مرحلة الحداثة على هذه الميزة، وستكتمل هذه الميزة في مرحلة ما بعد الحداثة.
لقد عرّف مفكّرو الغرب القدامى (قبل المرحلة الجديدة) الإنسان بلحاظ طبيعته، وذهبوا أنّ للإنسان طبيعة غير قابلة للتغيير، الأرض مركز الكون، والإنسان يقع لشرافته ومنزلته في مركز الأرض، ولعالم الطبيعة نظم خاص، والهدف من خلقة الإنسان تناغمه مع نظام الطبيعة، ونظام الكون مستحكم بحيث لا تتمكّن إرادة الإنسان من مخالفته، ولا بدّ أن تسير وفقه.
ولم يكن الإنسان في الرؤية التراثيّة [الكلاسيكيّة] بمعزل عن نظام الكون، بل إنّ نظام الوجود منحه منزلة وجعله في موقعيّة رفيعة، والإنسان عند هؤلاء كنصّ مغلق على الفلسفة فكّ شفراته.
لقد وردت عدّة تعاريف لماهيّة الإنسان في العصر الحديث، نشير إلى أربعة منها:
1 - عند علم الأحياء: يُعدّ الإنسان نوعًا من الحيوان، لا يكون من النباتات ولا الآلهة؛ لأنّ النبات أخسّ من الإنسان، والآلهة أرفع من الإنسان.
2 - عند علم النفس: يكون الإنسان فاعلًا منفردًا وعالمًا.
3 - عند علم الاجتماع: يكون الإنسان عضوًّا واحدًا من نظام اجتماعيّ واسع.
4 - عند الدين: يمكن أن يكون الإنسان جميع هذه الموارد.
ومع لحاظ الشواهد التي ستأتي، وما ورد صراحة في بعض العبائر، فإنّ مرادهم من الإنسان - من بين التعاريف الأربعة - هو ما ورد في علم الأحياء .
ولقد أكثر مفكّرو العصر الجديد في تعريف الإنسان وماهيّته، والإشارة إليها تحتاج إلى مجال واسع، وسنشير إلى ما يتناغم مع أهداف هذا الكتاب فيما يلي:
الإنسان هو الحيوان الأسطوريّ الماشي على الرجلين ولا يملك أجنحة، ذهب روسو إلى أنّ الإنسان صانع العقد الاجتماعيّ، وعند مدرسة مانشستر يكون موجودًا اقتصاديًّا، وعند كارلوس لينه -عالم النباتات السويديّ صاحب الدراسات في تصنيف النباتات والحيوانات وتمّ اعتماد دراسته اليوم في التصنيف العلمي - يكون الإنسان موجودًا مفكّرًا أو من الثديّات المستوية قامتها، إنّه فكر محض وموجود له دم ولحم .
ويقول أيضًا:
يرى الفلاسفة أنّ الإنسان حيوان عاقل، ولا أدري لما لا يطلقون عليه الحيوان العاطفيّ؛ لأنّ العاطفة والإحساس هي الفارق بين
الإنسان والحيوان دون العقل، وربّما رأيت قطّة تستعمل العقل، ولكن لم أرها تضحك أو تبكي.
ويرى أتويسبرسن أنّ الإنسان حيوان يمكنه تصنيف الأمور ضمن طبقات .
الإنسان موجود فريد، وهو الحيّ الوحيد الذي يمتلك ثقافة. ويمتاز الإنسان مع حيوانيّته بعوامل عدّة تؤهّله ليمتلك الثقافة. ولا بدّ من الإشارة إلى هذه العوامل والمؤشّرات من بين سائر العوامل، وهي: امتلاكه لقامة معتدلة تعينه على الحركة، يمتلك أصبع السبابة الذي يعينه مع سائر الأصابع للأخذ والقبض، قدرة رؤية الأبعاد والألوان، امتلاكه الحالة الاجتماعيّة وغيرها، وأهمّ خاصيّته قدرته على صنع الرمز والمثال .
ويقول في مكان آخر:
إنّ ميزة الإنسان على سائر الحيوانات، بأنّه الوحيد من بينها القادر على معرفة قيمة الأصنام... ولكن يرى دارون أن لا يوجد فرق بين الإنسان وسائر الثديّات من حيث القدرات الذهنيّة .
إنّ فلاسفة العصر الحديث في الغرب الذين كانت لهم دواعي صناعة الأديان أسّسوا مدرسة تحت عنوان مدرسة محوريّة الإنسان، وأحكموا مبانيها على أصول مستحكمة خاصّة، إنّ الإنسانويّين الليبراليّين الذين أمضوا على
منشور هذه المدرسة، ذكروا في الأصل الأوّل والثاني منه: 1 - إنّ الإنسانويّين المذهبيّين يرون أنّ الكون موجود قائم بنفسه وغير مخلوق لخالق غيبيّ. 2 - يذهب الإنسانويّون إلى أنّ الإنسان جزء من عالم الطبيعة، ظهر إلى الوجود على أساس عمليّة تكامليّة مستدامة (نظريّة دارون التكامليّة)، ومضافًا إلى الإنسان، فإنّ الفلسفة والدين أيضًا محكومة بهذا القانون.
وأجمع تعريف للإنسان الحديث، التعريف الوصفيّ الذي أورده ويل دورانت في تاريخه، حيث يقول:
«كان حادّ الذهن، يقظًا متعدّد الكفاءات مستعدًا لقبول كلّ مؤثّر وكلّ فكرة، مرهف بالحسّ والجمال، حريصًا على نيل الشهرة، وكانت له روح ذات نزعة فرديّة جريئة عديمة المبالاة، تعمل على تنمية جميع المواهب الكامنة فيه، روح مزهوّة فخورة تسخر من الذلّة المسيحيّة، وتحتقر الضعف والجبن وتتحدّى العرف والتقاليد والأخلاق والمحرمات والبابوات، بل تتحدّى الله نفسه في بعض الأحيان، وكان في وسع هذا الرجل أن يقود حزبًا ثائرًا في المدينة أو جيشًا في الدولة، فإذا كان من رجال الكنيسة فقد كان يسعه أن يجمع مائة منصب تحت مسوحه، وأن يستخدم ثروته في الوصول إلى السلطان، وفي الفنّ لم يعد هذا الرجل صانعًا يعمل مغمورًا مع غيره في مشروع جماعيّ كما كان يعمل نظيره في العصور الوسطى، لقد كان شخصًا منفردًا منفصلًا عن غيره... فقد كان في حركة دائمة ساخطًا متأفّفًا من القيود... ليس غريبًا على النساء في القصور، ولا عن الجند في المعسكرات».
لقد بذل المتجدّدون غاية مساعيهم في وصف الإنسان، كي يحوز مقامًا رفيعًا في الطبيعة، وإن لم يوفّقوا لتقديم تعريف أنطولوجي جيّد له نوعًا ما. ولكن سعوا ليجعلوه أعلى ممّا هو عليه. ومنذ منتصف القرن الأخير أي حدود عام 1960م سعى مفكّرو الغرب تكميل آراء العلماء القدامى، وعليه فإنّ ماهيّة الإنسان في هذه المرحلة المرسومة بما بعد الحداثة تتّصف بالفردانيّة، وتتشخّص عن طريق التواصل مع الطبيعة والعالم المادّيّ وسائر بني نوعه. وتتّصف من وجهة نظر أخلاقيّة بالحرص والطمع، ويتمّ التعامل مع الآخرين من هذا المنطلق.
فالإنسان في تعامله مع الآخرين موجود حريص، أنانيّ، لا يتحمّل المسؤوليّة، حيوان سياسيّ وصانع الحكومات، يبحث عن منافعه، لجوج ينفي المقدّسات ولا يوجد له أيّ حريم. إنّهم سعوا بعد ذكر هذه الأوصاف في تعريف الإنسان إعلاء شأنه، ولكن بناء على اعتراف بعض أصحاب النظر في الغرب، فإنّ محوريّة الإنسان الحديث قد أدّت إلى موت الإنسان في ما بعد الحداثة جرّاء هذه الأوصاف.
إنّ مسألة معرفة الإنسان وحقيقته معرفة عميقة وعريقة، تعدّ من أهمّ المباحث في الفلسفة الإسلاميّة من القديم وإلى يومنا الحاضر، وتدور أغلب المباحث حول محورين: حقيقة الإنسان وأوصافه، الغاية من خلقته وسيره التكامليّ.
إنّ أفضل جواب حول ماهيّة الإنسان وحقيقته، لا بدّ أن يأتي من خالق الإنسان لا الإنسان نفسه. ولا يوجد شكّ في أنّ أجمع بيان بهذا الخصوص إنّما هو ما ورد عن القرآن والعترة، وأيّ بيان في وصف حقيقة
(70)الإنسان وتبيينه عدا بيان الوحي لم يكن بيانًا صادقًا وصائبًا، لذا نقوم ببيان معناه وحقيقته بالاستعانة بالكتاب والسنّة.
إنّ لكلمة الإنسان كسائر الألفاظ معنى لغويًّا ومعنى اصطلاحيًّا، ففي المعنى اللغويّ جعله البعض مأخوذًا من جذر (أنس)، وذهب البعض الآخر إلى أنّه مأخوذ من النسيان، فإذا كان مأخوذًا من جذر الأنس، يصحّ معنى أنّه الكون الجامع وخليفة الله؛ لأنّه مظهر الأسماء ومجمعها، ومن هذه الوجهة تتيسّر إيناس الحقائق وإبصارها: ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ أي أبصرت ورأيت النار، وشاهدتها وعاينتها، ولكن إذا كان من النسيان، فبحكم اتّصافه بصفة «كلّ يوم هو في شأن» لا يمكن أن يتوقّف في شأن واحد.
وما يحصل من القرآن الكريم في معناه الاصطلاحيّ، هو أنّ الإنسان حيّ متألّه، وقد تمّ بيان هذا المعنى في محلّه.
لقد سعى المفكّرون المسلمون سيّما الحكماء والعرفاء إلى تحصيل المعنى الحقيقيّ للإنسان مع الاستعانة بالنصوص الدينيّة، ويظهر أنّهم وُفّقوا في هذا الأمر إلى حدّ كبير.
والإنسان وإن تمّ تعريفه في الفكر الدارج بالحيوان الناطق، ولكن هذا التعريف ناظر إلى ماهيّة الإنسان المتعارف والعادي، وللإنسان باعتبار رتبته الوجوديّة لا الماهويّة معنى آخر لا يتّسم بالجنس والفصل الماهويّ، كما أنّ الملاك والمعيار في مقام الوجود يقتضي الالتفات إلى هويّة الموجود لا
الماهيّة بمعنى الجنس (الحيوان) والفصل (الناطق).
وبهذه الرؤية يُعبّر الإنسان في الفلسفة والعرفان بالكون الجامع، أي أنّ الإنسان جامع لجميع العوالم، وتكون جميع العوالم في ظلّه. وهو المقصود الأصليّ والأوّليّ من جميع العوالم، كما أنّ الأسرار الإلهيّة والمعارف الحقيقيّة تظهر بواسطة الإنسان، وحينما يُعدّ الإنسان عين الحقّ - بمعنى العين الباصرة - فإنّه أشارة إلى نتيجة قرب الفرائض، حيث يكون الإنسان بهذا القرب سمع الحقّ وبصره، ويكون واسطة الحقّ والخلق.
الإنسان مركّب في ماهيّته الخارجيّة من الروح والجسم (النفس والجسم) ونفسه انما هي تجلّي الحقّ، وقد جعله الله وكيله من بين سائر مخلوقاته، واختاره لخلافته في الأرض، كما فسّر كثير من المفسّرين قوله: (خلق الله آدم على صورته) بهذا المعنى؛ لأنّ الأرض - خلافًا للعالم العلويّ - عالم التغيير والاستحالة، ولأجل هذا التغيير والتحوّل تظهر منه حكم جميع أسماء الله في الأرض، ولذا علّم الله الإنسان أسماءه، وأمر الملائكة بالسجود له.
وذهب عرفاء الشيعة إلى أنّ الإنسان هو المظهر التامّ لله تعالى، وحقيقته تجلّي الاسم الأعظم، وتحليلهم لذلك أنّ للحقّ تعالى ظهورًا خاصًّا في كلّ موجود، ولكن الإنسان هو الظهور التامّ والجامع لكلّ الظهورات ولذا صار خليفة الله.
وقد ورد في تعاليم أهل البيت عليهمالسلام أنّ صورة الإنسان تعدّ أكبر دليل
لله على الخلق، وهي الكتاب المدوّن بيد الله، ومجموع صور العالمين، والشاهد على كلّ غائب، ودليل كلّ منكر، والصراط المستقيم نحو الخير، ومصحف الوجود الكامل، وكلّ الأشياء له ولا يكون شيء خارجًا عنه، أي لم تكن لغيره.
فالكلّ مفتقر ما الكلّ مســتغن هذا هو الحقّ قد قلناه لا نكني
فالكلّ بالكلّ مربوط وليس له عنه انفصال خذوا ما قلته عنّي
وبناء على هذه التعابير، ذهب الفلاسفة إلى أنّ نفس الإنسان حقيقة تحوز جميع العوالم ونشات الوجود الثلاثة بالقوّة، مع الحفاظ على وحدته الشخصيّة بنفس الوقت أو أنّ الإنسان وجود جُمعت فيه جميع المراتب العينيّة والمثاليّة والحسّيّة، وانطوت فيه عوالم الغيب والشهادة وما فيها، فهو مع عالم الملك ملك، ومع الملكوت ملكوت ومع الجبروت جبروت.
فحقيقة الإنسان لم تكن على صورته وشاكلته الظاهريّة، بل سيرته ونفسه الباطنيّة، ولم يكن معنى الإنسان من دون لحاظ جانبه الباطنيّ والنفسانيّ حدًّا تامًّا. فينبغي عند تعريف أيّة ظاهرة وتحصيل معناها أن ننظر إليها برؤية واقعيّة لا سطحيّة وظاهريّة. والنتيجة للرؤية العميقة والعقلانيّة لمعنى الإنسان وحقيقته، هو هذا المعنى الذي ذكره الحكماء والعرفاء المسلمين.
بعد ما بيّنا معنى الإنسان، نشير إجمالًا إلى هويّته الحقيقيّة، وللبحث عن هويّة الإنسان مطالب متعدّدة نشير إلى بعضها:
من النقاط التي صرّحت بها النصوص الدينيّة، وباتت مورد بحث علماء الدين، مسألة معرفة المبدأ، هل الإنسان موجود خلق صدفة، ومن دون علّة فاعليّة أو لا؟ فإذا لم تكن الصدفة منشأ الإنسان ولا بدّ له من علّة فاعليّة، فهل هو مبدأه الفاعليّ وخالق نفسه أو موجود آخر؟ فإذا لم تكن الصدفة، ولم يكن هو المبدأ الفاعليّ وخالق نفسه، فمن أين تكوّن هل من قبل الله أو من قبل غيره؟
هذه هي الأسئلة الثلاثة حول منشأ الإنسان، ولكلّ واحدة منها اقتضاءاتها الخاصّة، ولقد بيّن القرآن الكريم هذه الآراء الثلاثة المذكورة في ايتين: إحداها في سورة الطور الآية 35: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ﴾ والأخرى في سورة الواقعة الآية 58 و59: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ58 أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ﴾ فالرؤيتان: (الصدفة وخالقيّة الإنسان لنفسه) المنتهيتان إلى استقلال الإنسان غير صحيحتين وهما اللتان تشكلان مباني النزعة الإنسانيّة، ولكن الرؤية الثالثة الدالّة على أنّ الإنسان موجود متّصل بالله، تعتقد بوجود مراحل في تكوّن الإنسان إلى اكتمال وجوده. فالمرحلة الوجوديّة الأولى للإنسان مرحلة العلم الإلهيّ، حيث يحوز الإنسان في هذه المرحلة الوجود العلميّ فقط ولم يكن له وجود في مقام العين: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ ثمّ تنزّل من هذه المرحلة ووصل إلى الشيئيّة وإن لم يكن شيئًا مذكورًا: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ .
وفي هذه المرحلة يتبدّل الغذاء إلى نطفة، يقول القرآن الحكيم هنا
للأبوين: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ 58 أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ﴾ وورد ما يشبه هذا المطلب في القرآن عن لسان الله سبحانه بخصوص الزراعة: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ﴾ .
والمرحلة الثالثة هي المرحلة العينيّة، يتحقّق الإنسان في العالم الخارجيّ والواقع، ويقول القرآن في هذه المرحلة: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ﴾ .
ما مرّ ذكره كان رؤية القرآن لمراحل تكوين الإنسان، حيث تتكوّن هويّته الحقيقيّة في ثلاث مراحل: العلميّة، الشيئيّة والعينيّة. وكلّ ما يذكره حكماء الإسلام إنّما هو لزوم مطابقة حقوق الإنسان الواقعيّة مع هذا الأصل الحقيقيّ لخلقة الإنسان.
ولا شكّ أنّ الرؤية التي ترى الإنسان مستقلًّا، لا يمكن أن تتساوى مع الرؤية التي ترى الإنسان موجودًا معتمدًا على الله في الحقوق والتكاليف والأحكام المتعلّقة به. فلو كان الإنسان مستقلًّا، ولم يعتمد على أيّ مبدأ إيجاديّ، يكون نظامه الحقوقيّ على صورة، وإذا كان معتمدًا على سبب إيجاديّ هو الله تعالى يكون على صورة أُخرى.
ولكلّ واحد من العامل وصاحب العمل حقوق مستقلّة، فمن لم يعتقد بوجود خالق لنفسه، يدور نظامه الحقوقيّ وتكاليفه مدار محوريّة الإنسان، ومن اعتقد بخالق لنفسه وعرفه، يكون نظامه الحقوقيّ وتكاليفه متناسقة مع مخلوقيّته ومع خالقيّة الله تعالى.
وبما أنّ الإنسان المتديّن يرى مبدأ وجوده الخالق القادر المتعالي، لا
يمكنه أن ينسى مبدأ وجوده ولو للحظة، ولا يوجد أيّ فرض علميّ وعقليّ يدعم الذي يعتمد في أصل هويّته على الله تعالى، ولكن يعمل مستقلًّا عن مبدأه الفاعليّ في المباحث الحقوقيّة.
الموضوع الآخر الذي يُبحث في موضوع الإنسان، ما يتعلّق بمعرفة ربوبيّة الله. والسؤال المطروح هو أنّ تدبير الإنسان بعد خلقته بيد من يكون؟ فهل تربية الإنسان تقع على عاتقه أو له إله آخر في التدبير؟، وهذا السؤال العلميّ العميق يصدق على من لا يقبل وجود الله، وكذلك على من يقبل بخالقيّة الله تعالى.
فمن لم يعتقد بوجود خالق للإنسان، لا يقبل ربوبيّة شخص آخر وتدبيره أيضًا، ولكن ربّما يوجد فيمن أذعن لخالقيّة الله في مقام العلم، من لا يذعن بربوبيته في مقام العمل على الأقلّ، وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ فهؤلاء وإن لم ينكروا خالقيّة الله، غير أنّهم يعتقدون بأنّ تدبير أمورهم وربوبيّتها موكولة إليهم، وأنّ الإنسان يملك اختيار نفسه، ولا يحتاج في حياته المادّيّة والمعنويّة إلى غيره، وهذا هو إنكار التوحيد الربوبيّ وإنكار ربوبيّة الله، وتفويض أمور الإنسان إلى الإنسان ولا يقلّ خطورة عن الجبر، بل أكثر منه بكثير.
هاتان الرؤيتان تذهب إحداهما إلى أنّ هويّة الإنسان حدوثًا وبقاءًا متعلّقة بالغير (الخالق)، والرؤية الأخرى تقبل بتعلّق الإنسان بغيره في مرحلة الحدوث واستقلاله في مرحلة البقاء، وتكون نتيجة هاتين الرؤيتين مختلفتين بخصوص مبحث الحقّ والتكليف؛ لأنّ من أذعن بخالقيّة الله وربوبيّته
للإنسان، جعل الله واضع الحقوق والتكاليف، ولكن من أذعن بالخالقيّة فقط دون الربوبيّة، يجعل هوى النفس واضع الحقوق والتكاليف: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلـٰهَهُ هَوَاهُ﴾ . وهذه هي الرؤية الهيومانية التي تجعل الميول وهوى الأنفس والطبع بدل حجة الله البالغة أي القرآن والعترة، وتحدد الحقوق وتنظمها على أساس هذه الميول والأهواء النفسية، وهي في غفلة من أن ميول الإنسان ربما لا تتطابق مع مصالحه ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ﴾ .
ومن البديهيّ جدًّا أنّ النظام الحقوقيّ المبتني على هذا الفكر وهذه الثقافة، لا ينتج سوى الظلم على النفس، والحقّ أنّ نظام التشريع لا بدّ أن يتوافق مع نظام التكوين، فربّما أمر يطابق ميول الإنسان، ولكن لا يتطابق مع مصلحته وبالعكس.
ولإرادة الإنسان دور محوري في بنية شخصيّة الإنسان، لذا لا بدّ من تعديل إرادة الإنسان؛ لأنّه يتمكّن بعزم قويّ من تقديم مصالحه على ميوله، لذا يقال للإنسان (متحرّك بالإرادة) لا (متحرّك بالاميال) لأنّ وجه تمايزه عن الحيوان والنبات والجماد إنّما هو في منشأ تحركه؛ بمعنى أنّ كلّ الموجودات تمتاز بجاذبة ودافعة، وعلى سبيل المثال: فإنّ في الجمادات لا يمكن انجذاب كل تراب الى الاحجار ليصبح درًّا أو عقيقًا يمنيًّا.
وفي مرتبة أرقى، يكون النبات هكذا في ازدهاره ايضا، وفي مرحلة الحيوان التي هي أرقى منه، تكون حركته بحسب الاميال، ولكنّ الإنسان موجود يقع في مرتبة أعلى من حيث الجذب والدفع، وتتمّ حركته بحسب الإرادة، فلو حدّدنا هويّة الإنسان وشخصيّته في مرتبة الجماد والنبات، يتمّ
تنظيم نظامه الحقوقيّ على هذه الصورة، ولو عرّفت أيّ مدرسة الإنسان بانه حيوان، سيكون نظامه الحقوقيّ بشكل آخر، ولو جعلت مدرسة ما مرتبته أرفع من الجماد والنبات والحيوان، لتمّ نظامه الحقوقيّ بشكل آخر.
وفي القسمين الأوّلين، يوجد عدم تناسق بين الحقوق الوضعيّة وتكوينه البنيويّ، إذ لا يوجد تناسق بين النظام التشريعيّ المبتني على الميول والأهواء، مع النظام التكوينيّ الذي جبله عليه خالقه كإنسان، لذا يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ وفي آية أخرى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلً﴾ أي تحدّد فئة من أمثال البشر بحدود الجماد، وفئة أخرى في حدود الحيوان أو أضلّ.
أمّا في القسم الثالث، فيوجد تناسق بين الحقوق التشريعيّة والبنية التكوينيّة إذ الإنسان المسلم المعتقد بالتوحيد الربوبيّ، ينظّم حقوقه على أساس ربوبيّة الله والمصالح الحقيقيّة لا الميول والأهواء، والمسلم الحقيقيّ يعتقد بخالقيّة الله كما يلتزم بربوبيّته، إذ يبتني اعتقاد المسلم على أنّ كمال الإنسان مرهون بالعمل بمقررات الله تعالى وتعاليمه.
فمن يدّعي الإسلام ولكن يشكّك ويناقش في أصول التعاليم وفروع الأحكام والمقرّرات، فهذا الاختلاف بين الذهن واللسان مصداق للتحدّث إسلاميًّا والتفكّر إنسانويًّا [هيومانيًّا] فأيّ إنكار أو تردّد بخصوص نظام الإسلام الحقوقيّ الناشئ من حاقّ الدين، فإنّه انصراف وحياد من أحكام الله والاتّجاه نحو القوانين الوضعيّة البشريّة، فلو قُرّرت حقوق الإنسان ونُظّمت في الجوامع البشريّة بحيث يتنزّل أفراد الإنسان في مقام العمل بها إلى مرتبة الجماد والنبات، أو تؤول إلى تسليم الإنسان أمام أهوائه النفسانيّة
ليكون أضلّ من الحيوان، فهذا مصداق حقيقيّ للظلم على الإنسان. فهل يمكن جعل هكذا قانون يوجب الظلم للنظام الاجتماعيّ وللإنسان حقًّا؟ وهل يمكن العثور على شخصيّة الإنسان الواقعيّة في ظلّ هكذا نظام حقوقيّ؟
فتدوين الحقوق على أساس الأهواء المقطعيّة والظاهريّة من دون لحاظ الحكمة المستمرّة والمصلحة الإنسانيّة الثابتة، يكون مصداقًا واقعيًّا لظلم النفس، وقد أشير إليه في بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ .
وفي آية أُخرى تجعل عاقبة من لا يلتفت إلى تعاليم رسل الله، مع التعلّق بظواهر الأمور الدنيويّة ونسيان الآخرة، تجعل عاقبته سيّئة وتقول: ﴿فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ .
إنّ لهويّة الإنسان الحقيقيّة أبعادا ثلاثة، والبحث عنه من دون لحاظ جميع هذه الأبعاد، يعدّ نقصًا في شخصيّة الإنسان، أي إنّ معرفة الإنسان بمعناه الواقعيّ، والحديث عن حقوقه، إنّما تتحصّل فيما لو عرفناه بأبعاده الثلاثة هذه، وهذه الأبعاد هي:
يُعبّر القرآن عن البعد الحيوانيّ في الإنسان، الذي يتلخّص في الشهوات والغضب وبعض الآمال النفسانيّة هكذا: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ
كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ﴾ وفي آية أخرى تخاطب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ .
البعد الآخر الذي يُعدّ أرقى من الأنا الحيوانيّة، هو الأنا الإنسانيّة، والإنسان في هذه المرحلة يحوز مقام الفكر والتعقّل والعزم والإرادة مضافًا إلى البعد الحيوانيّ، وتشير آيات القرآن إلى هذا الجانب والبعد الوجوديّ للإنسان، كقوله تعالى في النحل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ .
والحاصل: إنّ جعل (الفؤاد) للإنسان في الآيات، وإنّه خلق مع قلب وروح مستوية الخلقة، تحتوي على التوحيد الفطريّ وعصارة إلهام الفجور والتقوى، يدلّ كلّ هذا على البعد الإنسانيّ الأرقى من البعد الحيوانيّ في الإنسان.
البعد الثالث الذي هو أرقى مرتبة في أنا الإنسان، وهو أنا الأنا وهو في الحقيقة لا يتعلّق بالإنسان، بل بصاحبه الأصليّ وخالقه، ويكون الإنسان المتعارف أمينًا بالنسبة لهذه الوديعة الإلهيّة، وقد أُشير إلى هذا البعد في
الوجود الإنسانيّ في آية سورة الإسراء الشريفة: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ ولا يوجد مخلوق من بين سائر المخلوقات اكتسى بهذه الطبقات [السمع والبصر والفؤاد] كالإنسان الذي تزيّن بها.
وبناء على هذا، فلو أنّ الإنسان سُئل بهذه الأجزاء المكوّنة له؛ أي: البصر والسمع والفؤاد، فإنّه ينبئ عن وجود أنا في باطن الباطن، ووراء هذه الأجزاء الظاهريّة والباطنيّة؛ لأنّ هويّة الإنسان المتعارف تتشكّل من الفؤاد والقلب، فلو سئل الإنسان عن قلبه فيما أهمله؟ ولماذا لم يصحّح تصديقه وتكذيبه، وإيمانه وكفره إخفاقه؟ فإنّه يظهر من هذا وجود موجود شريف آخر في باطن باطنه وقلب قلبه، وإنّ إمامة فؤاده وزعامة قلبه يقع تحت اختيار تلك الوديعة الإلهيّة المستورة، وهي تلك الأنا الإلهيّة، والبعد الخالد والمجهول في الإنسان.
فلو صحّ هذا يجدر حقوق الإنسان أن يراعي مضافًا إلى حقوق أبعاده السابقة، حقّ الأنا الثالث للإنسان، فعندما يقول القرآن أنّ الإنسان ظالم لنفسه، يقصد منه هذه الأنا الثالثة، حيث إنّ التعدّي على هذا البعد الوجوديّ يُعدّ ظلمًا مضاعفًا. فلو دُوّنت حقوق الإنسان بمعزل عن هذ البعد الثالث، فهل يمكن عدّه حقًّا واقعيًّا للإنسان؟
فهل من الصواب أن يقال إنّ الحق الواقعي للإنسان، هو الذي ينظّمه الإنسان كيفما شاء؟ أو إنّ القول الصائب هو القول القائل بأنّ الحقّ الواقعيّ للإنسان ما يتمّ تنظيمه مع رعاية جميع جوانبه الوجوديّة، وإن لم يشارك هو في تنظيمه وتدوينه ويمكن الوقوف على صوابيّة أيّ واحد من هذين القولين بأدنى تأمّل.
وبناء على هذا، فللإنسان ثلاثة أبعاد طبيعيّة ومثاليّة وعقليّة، والحقوق الواقعيّة لا بدّ أن تحتوي على هذه الجوانب الثلاثة الوجوديّة، ولأرسطو كلام قال صدر المتألهين في شرحه وتوضيحه أنّ في كلّ إنسان ثلاثة أناس متفاوتة، الإنسان الطبيعيّ الذي يمتلك الأعضاء والجسم، الإنسان المثاليّ الذي يمتلك كمال الإنسان الطبيعيّ بشكل جيّد، والإنسان العقليّ الجامع للكمالات السابقة .
من المباحث المهمّة في معرفة الإنسان والمرتبطة بحقوقه، البحث عن نطاق علمه ومعرفته، إذ إنّ أوّل عنصر محوريّ في تدوين القانون والنظام الحقوقيّ وجود العلم الكافي بجميع أبعاد موضوع ما. ومن البديهيّ أنّ من لم يمتلك الإحاطة التامّة بموضوع، لا يمكنه تدوين قانون جامع وكامل حوله. ومن المسلّم أنّ نقص القانون يكون ظلمًا بحقّ من دُوّن القانون لرعاية مصالحه ومنافعه، والإنسان وإن بلغ القمّة في العلم فإنّ حظّه منه قليل، كما يدلّ عليه التجربة اليوميّة، واعتراف العلماء الدائم، ونصّ عليه الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وفي آية أخرى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا29 ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ) ولا شكّ في محدوديّة علم الإنسان وإن وصل إلى أعلى المراتب، وإنّ الإطلاق مختص بذات الإله الأقدس. وإذا حاز الأنبياء والأولياء أعلى مراتب العلوم بين بني البشر، فهو لاتّصالهم بالمخزن الإلهيّ.
فالإنسان مع لحاظ علمه القليل وعلومه المحدودة، وبعد التأمّل في
نظام الكون والقوانين الناشئة من الذات التي علمها غير متناهي، تحصل له أسئلة يصعب عليه جوابها. والسؤال الذي يُطرح أمامه من بين مئات الأسئلة الأخرى، هو أنّ الإسلام في نظامه الحقوقيّ، قد وسّع دائرة حقوق الرجال بالنسبة إلى النساء، وأغفل جانب حقوق النساء، وعلى سبيل المثال: ففي تقسيم الإرث بين الأخ والأخت والبنت والابن، يقول بالتفاوت.
والقرآن قد جعل الجهل منشأ ظهور هذه الشبهات، ويقول في مقام الإجابة على هذه الشبهة: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً﴾ .
إنّ لمسألة إرث الرجل والمرأة بحثًا مفصّلًا، يتّضح من مجموعه أوّلًا تساوي إرث المرأة والرجل في بعض الحالات، ثانيًا عندما يكون سهم الرجل أكثر من المرأة، تمّ تقرير حقوق كثيرة أخرى للمرأة تتعادل معها الحقوق بينهما. وعليه، فإنّ علم البشر محدود جدًّا ولو أراد سنّ القوانين للفرد والمجتمع بهذا المقدار من العلم الناقص، سنعلم ماذا تكون عاقبة هكذا مجتمع. فالإنسان لقلّة معلوماته لا يمكنه وضع قانون جامع وكامل، وتدوين هكذا قانون، خارج عن عهدة الإنسان العادي والمتعارف الحائز لعلوم بشريّة وكسبيّة، ولا بدّ أن يحوز واضع القانون مضافًا إلى العلوم العاديّة، العناية الإلهيّة في إفاضة العلم اللدنيّ عليه.
وفي الواقع، فإنّ المقنّن الحقيقيّ للقانون هو الله سبحانه، والإنسان الملكوتيّ الحائز لمقام النبوّة والرسالة يتلقّاه من جانب الله ويلقيه إلى
المجتمع الإنسانيّ. لأنّ هكذا مقنّن عليم وقادر محيط على جميع الكون، والإنسان الملهم يمكنه الوقوف على زوايا الإنسان الوجوديّة والعلاقة بينه وبين نظام الكون. والعلوم السماويّة لهكذا شخص، تكون أوفر من علومه الأرضيّة ويكون علمه أكثر بمراتب من علم الشخص العاديّ.
والغرض إنّ الشخص الملهم بإلهام الله، هو الشخص الوحيد الذي يمكنه وضع القوانين الجامعة لمصالح ومنافع الفرد والمجتمع، وهذه الخاصّيّة توجد في الأئمّة عليهمالسلام خلفاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الحقيقيّين قال علي عليهالسلام : «أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم منّي بطرق الأرض» وبيان علي عليهالسلام هذا لم يكن وصفًا لحالته الخاصّة، بل إنّ لجميع أهل بيت العصمة والطهارة هذا المقام الرفيع، كما يقول عليهالسلام في خطبة أخرى: «بنا اهتديتم في الظلماء، وتسنّمتم العلياء، وبنا انفجرتم عن السرار».
نعم، كما قلنا سابقًا، فإنّ خالق الكون أفضل من جميع المخلوقات، وقوام هذه الموجودات مرهونة بلطفه، هو العالم من الأزل إلى الأبد، ويعلم أنّ هويّة الإنسان الواقعيّة لا تنحصر في حياته الجماديّة والنباتيّة والحيوانيّة.
وسؤالنا هو: إنّ الحقوق التي يسنّها الله العالم للإنسان أفضل وأقرب للواقع، أم الحقوق التي وصل إليها البشر بعلومه المحدودة؟
المسألة الأخرى في معرفة حقوق الإنسان، موضوع مالكيّته، ولا شكّ
أنّ للإنسان عقلاً وإرادة وعزماً، وانه قادر على أداء الأعمال، ولكن هل يملك مستقبله أيضًا ليرسمه كيفما شاء؟ هل يملك أمواله بشكل تامّ وله أن يصرفها كيفما شاء؟ هل له مالكيّة مستقلّة لحياته ومختار لينهي حياته متى شاء وكيفما شاء؟ هل عزّته وشرفه وشخصيّته الحقوقيّة ملك طلق له يمكنه بيعها متى ما شاء؟ هل يملك عرضه وأولاده وله الولاية المطلقة عليهم له أن يبيعها أو يهبها أو يرهنها ويؤجّرها إلى الغير؟ وأخيرًا هل الإنسان مالك لهذه الأشياء أو أمين عليها؟
يُعدّ هذا الأمر من المسائل العقديّة المهمّة، له علقة وطيدة مع الحقوق والتكاليف والأحكام. فلو قام المبنى العقديّ على أنّ الإنسان أمين على هذه الأشياء لاندرجت حقوقه وتكاليفه في منظومة خاصّة، ولو دلّ المبنى على أنّ الإنسان مالك مطلق لها، لاندرجت حقوقه وتكاليفه وأحكامه في منظومة أخرى، بمعنى أنّنا مع مبنيين عقديّين ورؤيتين في موضوع مالكيّة الإنسان، نصل إلى نوعين من حقوق الإنسان، لذا فإنّ المسائل الفقهيّة والحقوقيّة في الإسلام المقنّنة على العقائد الدينيّة، تختلف عن سائر المدارس، وعليه فإنّ الديمقراطيّة الدينيّة والديمقراطيّة المطلقة والحرّة، وجمهوريّة الخلق مع جمهوريّة الإسلام، تختلف اختلافًا كبيرًا.
إنّ عقيدتنا الدينيّة تذهب إلى أنّ وجود الإنسان وهويّته وشخصيّته، أمانة إلهيّة والإنسان أمين من قبل الله ولا يمكنه التدخّل في مستقبله ورسمه كيفما شاء. إنّ شخصيّة الإنسان وهويّته جزء من حقوق الله، والإنسان مكلّف بحفظ هذه الحقوق، واستعمالها في مسير صاحبها ومداره، ومضافًا إلى الضعف العلميّ وقلّة المعرفة في تدوين الحقوق، يوجد محذور آخر يسلب الإنسان حقّ التقنين الحرّ والعشوائيّ، وهو أنّ الإنسان أمين على جميع أركانه الوجوديّة وليس مالكًا، وكلّ أمين مكلّف بالعمل طبقًا لإرشاد صاحب الأمانة وأوامره.
(85)ولكن من كان مبناه العقديّ المالكيّة دون الأمانة، فإنّه متحلّ بالفكر القارونيّ والثقافة الفرعونيّة. إنّ الله يقول في قصّة قارون: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 77 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ .
نعم، إنّ منطق الحسّ والشهوات والغضب، يجعل جميع المنافع والمصالح للأنا الحيوانيّة، ويدين أداء الحقوق الماليّة الواجبة. ولقد وصف القرآن الكريم تقابل منطق المالكيّة والأمانة بشكل جميل جدًّا بخصوص قوم شعيب:﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلـٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ 84 وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ85 َقِيَّةُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 86 قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأََنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ﴾ .
كان منطق النبيّ شعيب عليهالسلام أنّ أمانة الله مودعة عندكم، وكان منطق قومه بما أنّنا حزنا هذه الأموال فلنا أن نتصرّف فيها كما نشاء، وهذه هي ثقافة كلّ من يرى نفسه مالكا للأموال الحقيقيّة والاعتباريّة لا أمينا.
وهكذا الأمر بخصوص أصل الحياة، بمعنى أنّ من رأى نفسه مالكًا لحياته، ربّما يسمح لنفسه أن ينتحر، أو إذا تصوّر ملكيّته لجسمه، يزعم بأنّ من حقّه أن يبيعه أو يرهنه إلى الغير ويرنو نحو الفساد.
والحاصل: فإنّ على مبنى الأمانة، تتكوّن حقوق الإنسان وتكاليفه بحيث تسوق الإنسان إلى أن يكون أمينًا على ماله وهويّته ومستقبله، وهكذا إنسان أمين لا يمكنه أن يرسم مستقبله كالمالك وكما يحلو له، أو يرى لنفسه الحقّ في أن يستسلم أمام القوانين الوضعيّة فيما يخصّ استمرار حياته ومستقبله، بل إنّه يرى أنّ أيّ عدول عن الحقوق الإلهيّة بخصوص ماله وحياته وعرضه، ذنب لا يغفر، ولا يرى نفسه بتاتًا مالكًا لعزّته وشرفه كي يتعامل معها كالمالك، وبهذه النظرة والمبنى العقديّ فإنّ الإنسان لا يخسر شيئًا من حقوقه، بل يضمن سعادته وكماله في الدنيا والآخرة، خلافًا للرؤية المالكة حيث مع زعمها الباطل وتوهّمها الخاطئ لا تحصل على أيّ شيء للنفس بل تحصل على الذلّة والدناءة.
نطاق حياة الإنسان:
الأمر المحوريّ الآخر الذي له دور في معرفة الإنسان، موضوع نطاق حياة الإنسان وحدوده، هل تتحدّد حياة الإنسان بعيشه الدنيويّ بحيث لا يوجد بعدها أيّ حياة، أو أنّ الحياة المادّيّة تعدّ المرحلة الأولى لسير الإنسان، وأنّ الموت انتقال من النشأة الظاهريّة الملكيّة إلى النشأة الباطنيّة الملكوتيّة؟ وببيان آخر: هل يوجد للإنسان معاد أو أنّ سجلّه يختم بالموت؟ فلو اعتقدنا للإنسان حياة جديدة ومعادًا، لا بدّ من لحاظ حقوق خاصّة، وإذا لم نعتقد بذلك لا بدّ من لحاظ حقوق أُخرى.
ولا يضع أيّ عاقل قانونًا واحدًا وحقوقًا متساوية للموجود الأبديّ والموجود المؤقّت. يقول القرآن الكريم: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ أي إنّك أيّها الإنسان، موجود أبديّ لا تفنى، فعندما يكون الإنسان أبديًّا ولم تتحدّد حياته بعالم المادّة، بل اعتقد بأنّ المعاد حقّ
والحساب والمؤاخذة بعد الموت حتم، فلا بدّ أن ينظّم أعماله على أساس هذه العقيدة ويتّجه تدوين نظامه الحقوقيّ نحو هذا المنحى.
وبعبارة أُخرى: لو كان المعاد والحياة الأبديّة جزءًا واقعيًّا من حياة الإنسان، فمن الضروريّ أن يُشرّع نظامه الحقوقيّ بما يتناسب معه، ولكن من لم يعتقد بهذه العقيدة، وزعم أنّ حياته مؤقّتة ومحدودة بهذه الدنيا وتتلخّص حياته من الولادة إلى الموت، فإنّ نظامه الحقوقيّ سيكون مختلفًا.
إنّ شعار أتباع المادّة يكون بحسب عقيدتهم هكذا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾ وفي هكذا تفكّر تكون هويّة الإنسان المادّيّة والمحدودة أصلًا، وما يتوافق مع ميوله وأهوائه حقًّا وإن كان باطلًا في الواقع، وفي قباله فإنّ ما لا يروقه يكون باطلًا وإن كان حقًّا في الواقع، ومن البديهيّ مدى تأثير قبول أو عدم قبول هذا الأمر، ومدخليّته في الزيادة أو النقيصة، او السلب والاثبات عند تحديد حقوق الانسان.
تُعدّ البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكيفيّة ارتباطه بها، من المؤشّرات الأساسيّة والمحوريّة الأخرى في تحديد حقوق الإنسان والمجتمع، إذ الإنسان لا يعيش في الخلأ، بل يعيش في منظومة لها أجزاء تحيط أطرافه وله ارتباط معها، لذا فإنّ إحدى شؤون الإنسان التعامل مع نظام التكوين، وهذا التعامل يمكن أن يكون بنّاءً أو منطقيًّا أو مخرّبًا، وإنّ كيفيّة تعامل الإنسان له تأثير مباشر على نظام الوجود. إذ إنّ لظواهر نظام الوجود وجميع أجزائها الصغيرة والكبيرة، ارتباطًا وثيقًا بعضها ببعض، وتؤثّر جميع حركات الإنسان على نظام الوجود.
وبناء على هذا، فإنّ الحقوق التي تدوّن للإنسان، لا بدّ أن لا تؤثّر على نظام الوجود سلبًا، ولا تحطّ من مقام الإنسان، ولا تظلم وتتعدّى على العالم وأطرافه، أي إنّ حقوق الإنسان لا بدّ أن تدوّن مع لحاظ نظام التكوين وضوابط العالم الذي يعيش فيه. وقد ورد التصريح بهذا في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ففي آية: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ لو تم تدوين النظام الحقوقي والقانون البشري على أساس الميول والأهواء، سوف تفسد السماء والأرض ومن فيهن، وتكون النتيجة ما ورد في قوله تعالى ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ﴾ .
فلو كان الفكر الإلحاديّ والإنسانويّ مبنى القوانين المدونة في المجتمع، فسوف يسوق تعامل الإنسان في المجتمع لتأمين ميوله وأهوائه وإن كانت بطرق غير شرعيّة، وهذا القانون يعطي للإنسان الحقّ في التصرّف في نظام الوجود كيفما يشاء، ويسمح لأصحاب القدرة تجويز أيّ عمل ينفعهم، ونتيجة هكذا قانون يكون ما قاله الله: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ .
هذا، والحال أنّ الإنسان خُلق لإعمار نظام التكوين، هذا واجبه في الأرض: ﴿وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ فلو كان تعامل الإنسان مع نظام الوجود غير عقلائيّ وطبقًا للأهواء، ولم يكن إلهيًّا ومنطقيًّا، كما انه إذا ابتنى هذا التعامل مع نظام حقوقيّ خاصّ، فانه لن يؤدّي هكذا عمل إلى إحقاق الحقّ قطعًا، بل يكون أكبر ظلم للإنسان أيضًا، وإلى هذا المورد أشارت الآيتان السابقتان في فساد السماوات والأرض واضمحلال نظام الوجود، أي إنّ
المصائب والبلايا الطبيعيّة في الأرض تكون انعكاسًا لأعمال الإنسان.
وقد بيّن العلّامة الطباطبائيّ (قدّس سرّه) نقطة دقيقة بهذا الخصوص، تتطابق مع العقل والنقل، حيث قال:
«المراد بالفساد الظاهر المصائب والبلايا الظاهرة فيهما الشاملة لمنطقة من مناطق الأرض من الزلزال، وقطع الأمطار، والسنين، والأمراض السارية، والحروب والغارات... إنّ بين أعمال النّاس والحوادث الكونيّة رابطة مستقيمة، يتأثّر إحداهما من صلاح الأخرى وفسادها».
فلو دوّنت حقوق الإنسان على مبنى العقل والوحي، لعمرت الأرض وصلحت العباد: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فلو اتّجه قوم إلى الله، وكانت لهم أعمال صالحة ومرضية، لأنزل الله عليهم - وفاء لسنّته - البركات والنعم، وأصبح نظام الوجود لهم أمنًا وهادئًا، ولكن إذا استمرّوا على الانحراف والطريق الخاطئ، واعتادوا على القبائح، جعل الله حياتهم مضطربة، وأفناهم بالقهر وغلبة الطبيعة، هذه سنّة الله التي رتّبها الله على العالم والإنسان، والبشر في يومنا وإن تمكّن بفضل التقنيّة والصناعة الغلبة على كثير من البلايا الطبيعيّة، غير أنّه لم يتمكّن من الغلبة على سنّة الله القطعيّة.
إنّ خطأ النزعة الإنسانيّة يكمن في زعمها بأنّ العثور على بعض علل الحوادث يمكّنها من التغلّب على نواميس الطبيعة، وسوق عناصر الطبيعة المحوريّة لمنافعهم وكيفما يشاؤون ليكون نظام الخلقة مطيعًا لهم. وقد
وصلوا بالخيالات والتوهّمات الباطلة بأنّ كشف بعض علل الحوادث تغنيهم عن مبدأ الكون والتدبير الربوبيّ.
والخطأ الآخر زعمهم بأنّ المسلمين في مبانيهم العقديّة لا يعبأون بعلل الحوادث الطبيعيّة، ويسندون جميعها إلى الله من دون واسطة، والحال أنّ المعارف الدينيّة والمؤلّفات الكلاميّة ومباني الإسلام العقديّة لا تؤدّي إلى هذا الزعم، بل عقيدتنا تعلّمنا بأنّ وجود الإنسان كسائر الموجودات مرتبط بسائر أجزاء العالم، وتترابط جميع حركاته وسكناته مع سائر أجزاء الوجود ترابطًا وثيقًا، بحيث إنّ أعماله وحركاته إن كانت صالحة وطبقًا لسائر أجزاء العالم وسائر الموجودات، لساعده نظام الوجود وسائر الظواهر للوصول نحو الكمال والسعادة، ولو كانت أعماله طالحة لأسرعت كلّ هذه الأمور إلى إفساده.
إذن، لا بدّ أن يتبع النظام الحقوقيّ الفطرة الإنسانيّة والسنن الإلهيّة، وإلّا إذا ابتنت على الأهواء لفسدت الأرض والسماء، وبتبعها يفسد الإنسان الذي يعدّ جزءًا منها، وحينئذٍ لم يتمّ تأمين حقوق الإنسان فحسب بل يكون أعلى مراتب الظلم في حقّ الإنسان.
لا يوجد شكّ في أنّ حقّ أيّ شيء لا بدّ أن يكون متناسقًا ومتطابقًا مع استحقاق شأنه الوجوديّ، وأيّ تدوين للحقوق من دون لحاظ موقعيّة ذي الحقّ في نظام الوجود، يستلزم الظلم بل إنّه عين الظلم له. وعليه، فمن الضروريّ في تعريف حقوق الإنسان وتنظيمها الالتفات إلى موقعيّة الإنسان ومنزلته بين سائر الموجودات، نعم ربّما توجد حقوق مشتركة لا تتعلّق بموقعيّة الأشخاص الخاصّة، بل تتعلّق بأصل وجودهم، ولكن عندما نبحث عن الموقعيّة، فعدا الحقوق المشتركة، لا بدّ من لحظ الحقوق الخاصّة لكلّ ذي حقّ؛ بمعنى أنّ الرتبة المتساوية والموقعيّة المتساوية تستدعي حقوقًا
(91)متساوية، أمّا الشأن الأرقى فله حقوق أكثر، والرتبة الأدنى لها حقوق أقلّ.
وعلى سبيل المثال: ففي دائرة واحدة، فلكلّ الأشخاص من حيث اشتراكهم في الإنسانيّة حقوق مشتركة، ومن حيث رتبهم الإدراية حقوق مختلفة أخرى، ولا يتساوى بتاتًا حقّ المدير مع حقّ الموظّف العاديّ كما لا تتساوى اختياراتهم، وعندما يبحث عن الاختيارات في المدوّنات الحقوقيّة، فإنّ اختيارات القائد ورؤساء القوى والوزراء والوكلاء وسائر الأشخاص في المراتب النازلة؛ لا تتساوى حقوقهم من حيث اختلاف رتبهم، نعم إنّ المزايا الجاهليّة والطاغوتيّة والوهميّة، وزعم التفاخر والتكاثر المادّيّ المحض، فإنّ جميعها آفلة وزائلة، ولا سهم لها في تدوين الحقوق العادلة وتنظيم المزايا المنصفة.
من هذا المنظار، يمكن تقسيم الحقوق في الإسلام إلى ثلاثة أقسام:
أ - الحقوق المشتركة بين جميع البشر من حيث الإنسانيّة، ويطلق عليها الحقوق الإنسانيّة.
ب - الحقوق المشتركة بين الموحّدين، وتشمل أتباع جميع الأديان، فهذه الحقوق تفصل الموحّدين عن الكفّار والمشركين، كما يوجد تفاوت بين الموحّد والملحد والمؤمن والفاسق: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ 18 أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 19 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ﴾ .
إنّ عدم لحاظ فضيلة التوحيد والإيمان، ورذيلة الشرك والفسق والقول بتساوي حقوقهم، يُعدّ نوعًا من عدم العدالة وعدم المساواة في الحقوق،
علمًا بأنّ الحديث عندما يكون عن حقّ الموحّدين والمؤمنين، لا يعني إهمال الحقوق الانسانية للملحدين والفسقة. وهذا القسم من الحقوق المختصّة بالموحّدين، يطلق عليها الحقوق العقديّة أو الدينيّة.
ج - وهناك من الحقوق ما تختصّ بالمسلمين، وفي هذا القسم مضافًا إلى الفاصل بين التوحيد والشرك، يوجد امتياز الإسلام على سائر الأديان. بيان ذلك:
إنّ المسلم من حيث كونه إنسانًا، له حقوق مشتركة مع غيره، ومن حيث كونه موحدًا له حقوق متساوية مع أتباع سائر الأديان التوحيديّة، ومن حيث كونه مسلمًا استسلم للدين الخاتم فله حقوق خاصّة، ويطلق على هذا القسم من الحقوق: الحقوق الإسلاميّة.
وبناء على هذا، فلا بدّ من تنظيم حقوق أيّ شخص على أساس موقعيّته وشأنه ورتبته، وهذا أصل مبنائيّ، وطبقًا للأصول العقديّة لا بدّ من الالتزام به في المباحث الحقوقيّة، ولا يتيسّر تدوين حقوق الإنسان من دون لحاظ موقعيّة الإنسان في المراتب الثلاثة المذكورة. ولا بدّ من الالتفات إلى التقابل بين الحقّ والتكليف أيضًا، أي كلّما وُجد الحقّ حضر التكليف، وكلّما تجلّى حقّ جديد، ظهر تكليف جديد، كي لا يتحقّق الحقّ من دون تكليف، ولا يؤدّي إلى الطغيان.
والسؤال الرئيس في تنظيم حقوق الإنسان، هو السؤال عن ماهيّة الإنسان وقد مضى بحثه، والسؤال الآخر هو السؤال عن موقعيّة الإنسان في نظام الوجود؛ أي ما هي موقعيّة الإنسان من بين الموجودات المتعدّدة والمتنوّعة في هندسة الخلقة، وما هي رتبته في سلّم الخلقة، كي يتمّ تنظيم حقوقه وتعريفها على غرار موقعيّته، كما أنّ الحقوق الواقعيّة هي التي تتطابق مع واقعيّة وجود الإنسان وموقعيّته في نظام التكوين. والمبنى العقديّ
(93)عند الشيعة المستوحى من الكتاب والسنّة، لم يهمل العقل البرهانيّ أيضًا، الإنسان مرتبة أعلى من الجماد والنبات والحيوان والملائكة، وأدنى من المرتبة الإلهيّة.
إنّ حقيقة الإنسان هي التي قال الله عنها: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ إنّ له موقعيّة تكون السماء والأرض في رتبة أقلّ منه، كما ورد في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام :
وتحسب أنّك جرم صــــغير وفيك انطوى العالم الأكبر
وأنت الكتاب المبين الذي بأحــرفه يــظهر المــضــمر
وقد رفع الله تعالى موقعيّته بحيث جعل جميع المخلوقات تحت قدرته وسلطته: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ أي إنّ كمال جميع الموجودات في السماء والأرض، ورودها في نفق الإنسانيّة، وجعله منصّة للتحلّق نحو التقرّب إلى الله سبحانه، إنّ الله قد عرض أمانته على جميع الأشياء، لكنّها أبت تحمّل هذا الحمل الثقيل، والإنسان هو الذي استحقّ هذا الثقل، وإن زلّ بعضهم وتخلّف بجهله العلميّ وجهالته العمليّة عن حمل هذه الأمانة الإلهيّة المهمّة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ .
فالإنسان يحمل أمانة أبت السماوات والأرض والجبال عن حملها،
وإنّ إباءهم عن حملها هذا إباء إشفاقيّ لا استكباريّ، الذي ابتلي به إبليس، وقال الله في حقّه: ﴿أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ﴾ .
إنّ الإنسان لاجل الوصول إلى مقام الخلافة الإلهيّة، بحاجة إلى تمهيدات إحداها الامانة الإلهيّة والأخرى المعرفة بأسماء الله، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ﴾ ثم بعدما أمكن الله الإنسان لهذا المقام وخاطبه وقال: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ أي إن نهاية مسيرك لقاء الله لا الفناء، ولأجل هذه الموقعية أمر الله الملائكة بالسجود له: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ فهذا يدل على حقيقة الإنسان المتعالية ومنزلته الواقعية، ويثبت تفاضله على سائر مخلوقات الأرض والسماء، ولا يتمكن أي موجود في نظام الخلقة من تسخير موقعيته لأنه ولد بنفحة إلهية وأعطي وسام الخلافة الإلهية: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ .
فإذا صار الإنسان خليفة الله، فحينئذٍ يطلب حقوقه الواقعيّة، حقوق لا تكون أعلى من شأنه ولا أدنى؛ لأنّها في كلا الحالتين لا تكون حقوقًا واقعيّة. وإذا كان مبنانا العقديّ أنّ الإنسان تجلّي الحقّ في الأرض ومرآة قامة لقدرة الله وخليفته - لا بمعنى أن يكون إلهًا أو يكون الله في ظلّه كما زعم البعض - فوضع حقوق الجماد والنبات والحيوان لهكذا موجود ظلم
تفريطيّ، وتشريع حقوق إلهيّة له ظلم إفراطيّ، والإنسان لا يكون ضمن الفئة الأولى ولا له الموقعيّة الإلهيّة.
فالإفراط والتفريط قد عُدّا علامة الجاهل في كلام أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا ترى الجاهل إلّا مُفْرِطًا أَوْ مُفَرِّطًا» وقد تُستخدمان في وصف الإنسان، بحيث يرفع البعض موقعيّته ليحلّ محلّ الله، ليستنتجوا بكلامهم هذا وعقيدتهم هذه، أنّ جميع ميوله تعدّ حقًّا، بل لم يكتفوا بهذا وزعموا أنّ الحقّ هو ما يطلبه الإنسان. وهذا الإفراط الجاهليّ مصداق لكلام الله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ وباطن هذا الكلام تنزّل مقام الإنسان إلى الحيوان، كما يعتقد أصحاب اللذّة في الغرب بأنّ الإنسان يسعى لتحصيل اللذّة فقط، فاللذّة مطلوبة ذاتًا والأوجاع والآلام غير مطلوبة ذاتًا. وهذه العقيدة تمّ قبولها من قبل بعض فلاسفة الغرب، أمثال: لوك وهوبز وبنتام ومِل وسيجويك.
إنّ النظرة الإلحاديّة والهيومانيّة تعتقد بألوهيّة الإنسان، إله لا يعرف حدودًا لرغباته وميوله وأهوائه، فمحوريّة الإنسان هي محوريّة الحيوانيّة ذاتها ، وخلاصة تدوين حقوق الإنسان وعصارته تبتني على العقيدة الهيومانيّة، وهي ليست أكثر من الحقوق الحيوانيّة. فتدوين الحقوق في حدود الأكل والشرب واللبس والشهوات وتكثير النسل والسكن وتقدّم التقنيّة لازدهار الحياة النباتيّة والحيوانيّة، والتوجّه الحقوقيّ المحض إلى الجوانب المادّيّة والمُلكيّة، من دون لحاظ الجوانب المعنويّة والملكوتيّة، ومن دون الالتزام بالتكاليف المتقابلة، إنّما هي في الواقع ادّعاء للألوهيّة، واتّخاذ حياة
نباتيّة وحيوانيّة، وبعبارة أخرى: رفع الشعار الفرعونيّ والشعور الحيوانيّ. ينقل القرآن ان فرعون جمع أتباعه وادّعى الربوبيّة: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى﴾ .
وزعم البعض أنّ الإنسان لموقعيّته هذه ولسيطرته على مستقبله، له أن يقرّر لنفسه ما يشاء ويعمل به، وقد قلنا قبل هذا إنّ تأييد هذه العقيدة يبتني على جعل خلقة الإنسان بالصدفة (من دون علّة فاعليّة) أو جعله مستقلًّا، ولكن لو اعتقدنا بوجود خالق للانسان عليم حكيم كامل وجامع لكلّ الجهات، لا بدّ أن نلتفت إليه عند تدوين حقوق الإنسان والتحدّث عنها، لا الالتفات الى كلام الإنسان المحدود في نطاق علومه.
نعم، الإنسان حرّ وله حقوق كثيرة؛ لأنّه صاحب كرامة، ولكن من الضروريّ الالتفات والتفطّن إلى أنّ جميع الكرامات والقيم الإنسانيّة تكون مستندة إلى مقام الخلافة الإلهيّة، ولا بدّ من تفسير كرامته وتحليلها في جنب تحليل خلافته وتفسيرها، والكرامة تكون ذات معنى عندما تتصل بالخلافة، وفي حالة الانقطاع فلا توجد كرامة بل يوجد سقوط: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ﴾ أو يعاقب بعقوبة ﴿شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ﴾ الأليمة.
وقد أُشير في المناجاة الشعبانيّة إلى عروج الإنسان الواقعيّ:
«إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة».
والوصول إلى هذا المقام يمّر عبر الجمع بين الحقوق والتكاليف المتقابلة.
إذا احتفظت موقعيّة الإنسان مفهومها الواقعيّ من خلال الاتّصال بمقام الخلافة، لا بدّ من السؤال عن مقتضى خلافة الانسان الإلهيّة؟ ذهب البعض إلى أنّ مقتضى ذلك إعطاء الحرّيّة، وتكريم مقام الإنسان، واستحداث أرضيّة للفكر والثقافة، وإعطاء فرصة له وتشجيعه للعزم واتّخاذ القرارات في شؤون الحياة، وبعبارة أخرى: تشخّص الهويّة الإنسانيّة، وهذا الكلام مقبول، ولا يكون بالمآل حكم العقل البرهانيّ غير هذا أيضًا، والكلام وإن كان صحيحًا لكنّه غير تامّ.
يدّعي أتباع هذه الرؤية ويقولون: بما أنّ الإنسان صاحب كرامة، لا بدّ أن تدور جميع الأمور مداره، وهو معيار الحقّ والباطل. إنّ محوريّة التكليف وأداء الوظائف لأيّ شخص، يتناقض مع كرامته وحرمته وموقعيّته، ولا يليق بمقامه قبول عبوديّة أيّ شخص، وإنّ خلافة الإنسان تقتضي كسر جميع الحدود.
يدّعي أتباع هذه الرؤية أنّ قيمة الإنسان ومنزلته عندهم أرفع ممّا جاء في تعاليم الإسلام بمراتب؛ لأنّ الفكر الإسلاميّ يحدّد الإنسان ضمن نطاق ويستعبده ولكن من وجهة نظرنا فإنّ تحمّل المسؤولية والتكليف، غير قابل للجمع مع محوريّة الإنسان.
وقد أذعن أتباع هذه الرؤية بعدم وجود أيّ سلطة على الإنسان، بل إنّ مقتضى كرامته سلطته غير المحدودة على جميع الأمور. وعند أتباع هذه الرؤية، لا يوجد أيّ إلزام وقطعيّة لأيّ من التعاليم الميتافيزيقيّة على فرض وجودها. إذ إنّ خلافة الإنسان تتجلّى وتظهر حينما يستحكم الإنسان ارتباطه وعُلقته بالعالم المادّيّ والطبيعة.
وشعار حماة هذه الرؤية: «الحقّ يدور مدار الإنسان حيثما دار»
(98)وخلاصة هذه الرؤية ألوهيّة الإنسان لا الاعتقاد بخلافته الإلهيّة؛ لأنّ الخليفة يُطلق على من يذعن بقوانين وأوامر المستخلف عنه. والخليفة لا بدّ أن يحصل على شرائط الاستخلاف من قبل المنوب عنه. فلو أصبح شخص نائبًا عن الرئيس، لا يمكنه بتاتًا ادّعاء الرئاسة، ومن لم يعمل بمتقضى الخلافة الإلهيّة، تفقد إنسانيّته مصداقها الحقيقيّ، وحينئذٍ لا يمكن افتراض أيّ كرامة وشرفٍ له، لما قلنا بأنّ جميع كرامات الإنسان إنّما هي لأجل خلافته، وعندما لم يراع قانون الخلافة تنتفي أصل الخلافة، وبانتفائها ترحل جميع الشؤون المتعلّقة بها.
وهكذا إنسان لم يحصل على الرقي فحسب، بل يتنزّل عن مقام الإنسانيّة، ويكون رديفًا للبهائم والشياطين، ويكون مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ﴾ فالاحتفاظ بمقام الإنسانيّة لا يجتمع مع عدم قبول التعاليم الدينيّة والخلافة الإلهيّة؛ لأنّ خلافة الله لا تكون كالوكالة أو الوزارة الدنيويّة التي تعدّ من الأمور الاعتباريّة وتنفصل عن هويّة الإنسان الحقيقيّة والأصيلة، فمن كان وزيرًا أو وكيلًا أو مسؤولًا فله شأنان في الواقع، شأن حقيقيّ والآخر اعتباريّ، أحدهما الإنسانيّة وهي الحقيقيّة والأخرى الوكالة والوزارة وهي اعتباريّة. فلو تقاعد هكذا شخص فانه حينئذ تسلب منه المسؤولية الاعتباريّة فقط ولم تؤخذ منه حقيقته الإنسانيّة التي تعدّ من الشؤون الحقيقيّة.
إنّ الخلافة الإلهيّة لم تكن من الشؤون الاعتباريّة، بل إنّها بمنزلة الفصل الأخير والمقوّم النهائيّ؛ بمعنى أنّ الإنسان إمّا أن يكون خليفة الله،
وإمّا «كالأنعام بل هم أضلّ» فلا يمكن الاحتفاظ بالإنسانيّة إذا لم يصبح خليفة الله أو لم يكن لائقًا لها. فإذا خسر مقام الخلافة أصبح في عداد شياطين الجنّ والإنس، وحينئذٍ يكون أخس من التراب والجبال ويُخاطب بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا﴾ أو يقال له ولمن على شاكلته ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ .
إذا أصبح الإنسان خليفة الله من خلال صون مقام الروح المجرّدة الرفيع، لكان أرقى وأعلى رتبة من الجبال والأرض والسماوات، وكان أشرف المخلوقات، ولكن إذا لم يحتفظ بهذا المقام الرفيع وانحصر في هيكله المادّيّ هذا، لكان أضلّ من سائر الموجودات بل يصبح شيطانًا.
والحاصل: إنّ حقوق الإنسان لا بدّ أن تدوّن على أساس حقيقة (الخلافة الإلهيّة) لا على أساس «أنا ربّكم الأعلى» إنّ قيمة الإنسان وبعبارة أخرى إنسانيّة الإنسان تكون بخلافته الإلهيّة، وخلافته الإلهيّة تستدعي الإذعان بربوبيّة الله. فلو بُحثت حقوق الإنسان ضمن هذه الرؤية وهذا الفضاء، لكان الطريق صحيحًا يُحفظ فيه كرامة الإنسان وهويّته، اما لو اصبحت الوهية الانسان محور القوانين، فحينئذ لا تبقى له كرامة ولا هويّة؛ لأنّ هذا الزعم الخاطئ لا ينطبق على بنية وجود الإنسان، كما لا ينطبق مع نظام الوجود، ولا يتناسق مع ماضي المجتمع وحاله ومستقبله.
لقد قلنا في بداية هذا الفصل إنّ موضوع حقوق الإنسان وتكاليفه، يبتني على مقدّمات لو لم تتمّ لم يمكن تبيين مسألة الحقّ والتكليف، ومن
تلك المباحث النسبة بين التديّن ومعرفة الدين مع الحقّ والتكليف، وسنتطرق إليه في نهاية هذا القسم إجمالًا.
والسؤال المطروح: ما هي النسبة بين الدين وحقوق الإنسان؟ هل الدين يدور حول الحقّ أو التكليف؟ هل الدين يدعو إلى حقوق الإنسان أو تكاليفه؟ هل يخدم الإنسان أو يسخّره؟
ذهب البعض إلى أنّ الأديان السماويّة تدور حول التكليف لا الحقّ، والدين يحتوي على مجرّد التكاليف، ومن أذعن للدين يتحوّل إلى موجود عليه أن يعمل بالتكاليف الملقاة على عاتقه، ويدور الكلام حول (التوقّع من الإنسان) لا (التوقّع من الدين)، إذا الدين لا يلتفت إلى توقّعات الإنسان، ولكن ما يُطرح خارج دائرة الدين إنّما هو حقّ الإنسان وميوله وتوقّعاته.
إنّ كلّ ما هو بشريّ يدور مدار الحقّ، وما هو إلهيّ يدور مدار التكليف، فكلّ ما يأتي من الأعلى وله بعد سماويّ وميتافيزيقيّ تكليف، ولكن إذا نشأ من الأدنى وكان له بُعد أرضي فهو حقّ، والشاهد على هذا المدّعى عدّة أمور:
1 - إنّ لغة الدين؛ أي الأوامر والنواهي، تختصّ بالأنظمة التكليفيّة لا الحقّيّة، والأوامر والنواهي تتناسق مع الإجبار والإكراه بشكل أكبر، والحال أنّ ملاك الحقّ الحرّيّة والاختيار. لذا، فإنّ المدرسة التي تكتنف بالأوامر والنواهي لا يمكن أن تبتني على الحقّ، بل تدور مدار التكيلف.
2 - إنّ علاقة الدين وصاحب الشريعة مع الإنسان، علاقة المولى مع العبد، وقد تمّ تنظيم التعاليم الدينيّة بحيث يكون المولى في جانب منها والعبد في الجانب الآخر، فالمنظومة الدينيّة منظومة تدور حول
العبوديّة والتكليف، والناس في هكذا منظومة كالعبيد ليس لهم إلّا طاعة أوامر المولى، والسعي لتأمين متطلّباته، الناس يخدمون الدين، والحال أنّ الدين لو دُوّن على مبنى الحقّ لكان الإنسان مخدومًا لا خادمًا.
3 - الدين يشتمل على عقوبات دنيويّة وأخرويّة، ومفهوم العقاب يستعمل عند التخلّف عن الأوامر الدينيّة وهذا يكون في نطاق التكليف، وعليه فالعقاب يقع ضمن نظاق التكليف لا الحقّ، إذ لا يُعاقب أحد لعدم استيفاء الحقّ.
4 - الدين لا يتكفّل بيان جميع مسائل البشر ومشاكلهم، نعم ربّما يطلب الإنسان بعض حقوقه من الدين، والدين أيضًا بدوره يمنحه تلك الحقوق، ولكن لا يمكن بتاتًا استيفاء جميع حقوق الإنسان من الدين؛ لأنّ الدين كالدواء يفيد لبعض الأمراض لا لجميعها، فالدين دواء ناجع لكن لبعض الأمراض الخاصّة.
ونستمرّ هنا بالبحث من خلال بيان أربع نقاط كي تتبيّن النسبة بين الدين وحقوق الإنسان. هل يجعل الدين الإنسان مكلّفًا أم صاحب حقّ؟ وهل يخدمه أو يطلب منه الخدمة؟ وهل يلبّي توقّعاته أو يتوقّع منه؟
توجد في تعاليم الدين وجوب وحرمة ولها خاصّيّة تكليفيّة، والسؤال المطروح: هل تكاليف الدين تكون للإنسان أو على الإنسان؟ إذ هناك فرق بين أن يكون شيء على الإنسان أو له. فلو كان على الإنسان أمكن حينئذٍ أن يكون منافيًا لحقّه، وإذا كان للإنسان لا يمكن القول بمنافاته مع الحقّ. والرؤية التي ترى التكليف منافيًا لحقّ الإنسان، ترى التكليف حملًا زائدًا أثقل كاهل الإنسان. نعم، ربّما تكون التكاليف من جنس الثقل وليس
(102)دائمًا، وتكاليف الدين لم تكن من سنخ سائر التكاليف.
لو دقّقنا النظر بصورة جيّدة في مفهوم الحقّ والتكليف، وفحصنا العلاقة بينهما، لعلم أنّ العلاقة بينهما يمكن تصوّرها على نحوين:
1 - ربّما يكون الحقّ لشخص والتكليف على الآخرين، وربّما يكون الحقّ للآخرين والتكليف على هذا الشخص، فهنا يكون الحقّ لطرف والتكليف لطرف آخر، فحقّ هذا الشخص إنّما يقابله التكليف، وحاصله نفع هذا الشخص والتبعيّة للآخرين، والحقّ للطرف الآخر يكون تكليفًا لهذا الشخص وحاصله النفع للآخر والتبعيّة لهذا الشخص.
2 - وهناك قسم آخر من علاقة الحقّ والتكليف، وذلك اجتماعهما في طرف واحد. فهذا الشخص له الحقّ وله التكليف. ولا شكّ برجوع التكاليف إلى الحقوق في هذا القسم، وهي في الواقع طريق لتحقّق الحقّ وإحيائه. والإلزامات في بعض الأمور إنّما تأتي لأنّها الطريق الوحيد لتحقّق الحقّ، وانّ استيفاء الحقوق من دونها مستحيل. وهذا النوع من ارتباط الحقّ والتكليف، يحصل في بعض الأمور كتعليم الشباب وتربيتهم.
فهناك في نظام التعليم، تكاليف للطلّاب ليكتبوا مثلًا هذا المقدار من الواجب أو يقرأون فصلين من الكتاب، ولهذا الدرس حصّتان و...، وعند تحليل هذه التكاليف فإنّها ترجع بأجمعها لحقوق الطلاب، ولم يكن أيّ منها حملًا زائدًا عليه، أي إنّ الطالب هنا لا يحمل على عاتقه حمل المدرسة والفضاء التعليميّ، بل إنّه يحمل ثقل نفسه.
فهنا لم يكلّفه أحد حملًا زائدًا، وإذا أُمر بأداء تكاليف المدرسة، فهو لأجل إنّ كسب العلم والتعلّم يعدان من حقوقه المتسالم عليها، ولكن بما أنّه
لا يعرف حقّه أو غفل عنه واشتغل باللعب، فهنا يتمّ تبيين استحقاقه هذا لطلب العلم بصيغة التكليف، كما أنّ جميع منافع هذه التكاليف الظاهريّة تعود إليه، وبما أنّ كسب العلم قد فرض حقًّا مسلّمًا له، ترتّبت عليه هذه التكاليف الظاهريّة. وبهذه الرؤية وهذا المبنى الفكريّ، وإن كانت جميع المنظومة التعليميّة تكاليف من منظار نظام التعليم، ولكنّها حقّ من منظار التأهيل.
وبعد لحاظ هذا المثال نبدأ بالحديث عن الممثّل، فحقوق الدين وتكاليفه تكون هكذا تمامًا؛ بمعنى أنّ الله إذا كلّف الإنسان في الدين والتعاليم الدينيّة وألزمه بالصلاة والصوم والحجّ والزكاة وسائر الموارد، فإنّ جميع هذه الأمور تعود إلى حقوق الإنسان، كما أنّ للإنسان الحقّ في التكامل والعلم، والنموّ ومجاورة الملائكة، والبعد عن الصفات الحيوانيّة، والرقيّ على الجماد والنبات. فهذه كلّها من حقوقه المسلّمة، والطريق الوحيد لتحصيلها إنّما هو أداء التكاليف وأحكام الدين.
فعندما يأمر الدين أن تكون الأعمال (قربة إلى الله)، فلأنّه يرى أنّ القرب من الله، والوصول إلى الله، وخلافة الله في الأرض، من حقوق الإنسان.
فتعاليم الدين كالصلاة والصوم والحجّ والجهاد و...، توجب التقرّب إلى الله، وإذا وجبت الصلاة فلأجل رفعها الموانع أمام استيفاء حقوق الإنسان: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ﴾ أو تمنحه حقّ الأمان والسكون ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ .
وقد وجب الصوم؛ لأنّه جنّة أمام النار، وينجي الصائم من نار الشهوة والغضب المانعين من استيفاء حقّ الكمال للإنسان. وهذه الخاصّيّة تكون لجميع تكاليف الدين، وعند التحليل والتدقيق ترجع إلى الحقوق، كالتكاليف والواجبات في المدرسة ونظام التعليم، فتعاليم الدين من وجهة نظر تعليميّة تعدّ تكاليفًا، ومن وجهة نظر تأهيليّة تعود جميعًا إلى حقوق الإنسان.
إنّ ثمرة بيان الأحكام وتعاليم الدين من وجهة نظر فقهيّة ان هناك تكاليف وضعت على عاتق المكلّفين، ولا توجد عبارة في الفقه أفضل من كلمة التكليف لهذه التعاليم، ولكن من وجهة علم الكلام المتكفّل لبيان ملاكات الأحكام والمسؤول عن تشريح آثارها، تعدّ هذه الأمور ضمن حقوق الإنسان. وقد ورد في القرآن الكريم عدّة موراد إرجاع التكاليف إلى الحقوق، وسنتطرّق إليها في فصل خاصّ بهذا العنوان. فإذن، لم تكن أيّ من تكاليف الدين حملًا زائدًا على عاتق الإنسان بل إنّ جميع التكاليف تكون للإنسان وليست ضدّه.
هل هناك تضادّ بين نظام العبوديّة وعبادة الله مع حقوق الإنسان؟ وهل الدين لا يريد أن يخدمه الإنسان كالعبيد؟ فبالنظر إلى تعاليم الدين نرى أنّ الدين يريد أشخاصًا خدمًا يخدمونه دائمًا ويستسلموا له، وأن تُعدم فيهم روحيّة طلب الكمال ومطالبة الحقّ.
إنّ منشأ هذا السؤال يعود إلى القرآن والسنّة وأدعية المعصومين عليهمالسلام ، كما ورد في نصوص الدين من الكلام حول العبد والمولى: ﴿وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ﴾ وورد في مناجاة أمير المؤمنين عليهالسلام : «مولاي يا مولاي
أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلّا المولى». وقد جعل أهل الطريقة العبوديّة شرطًا أساسيًّا للوصول إلى الحقيقة.
فهذه الأدبيّات أدّت إلى زعم البعض أنّ الإنسان من منظار الدين والتعاليم الدينيّة، لا بدّ أن يكون في خدمة مولاه كالعبد ويسعى لأجله ويستمع لأوامره ويحقّق متطلّباته. ومنشأ هذا الزعم الواهي والمعتقد الخاطئ تطبيق البعض لجميع لوازم العبوديّة الأرضيّة وشرائطها على رابطة العبد ومولاه السماويّ، والخلط بين ثقافة السماء وخدع الأرض، والحال أنّ هذه مغالطة واضحة؛ لأنّ النصوص الإسلاميّة كالقرآن والحديث، عندما تريد بيان العلاقة بين الإنسان وربّه، تبيّن ذلك بلسان المحاورة وتستفيد من التشبيه والتمثيل، واستخدمت هكذا أدبيّات خاصّة لتكون قابلة للفهم لجميع الأفراد حتّى البسطاء.
وهذا الاستعمال لم يكن بمعنى اتّحاد المعنيين، بل يظهر اختلافهما الكبير بأدنى تأمّل؛ لأنّ المراد من إحداهما العبوديّة الظاهريّة، والمقصود من الأخرى العبوديّة الملكوتيّة والمعنويّة، ولا يمكن قياس النظام التشريعيّ الإلهيّ مع العبوديّة المادّيّة.
ففي نظام الرقّ يكون الشخص تحت سلطة نظيره الآخر أوّلًا، ويكون في خدمة مولاه في جميع الأمور لتلبية حوائجه وتوقّعاته ثانيًا. ولكن في نظام العبوديّة لم يقع الإنسان تحت سلطة شخص من نظرائه ومن بني نوعه أوّلًا، لان مولاه هو الذي منحه الوجود واخرجه من كتم العدم الى حيز الوجود وهيّأ له جميع حوائجه وشؤونه، وثانيًا ففي النظام الإلهيّ والدينيّ لم يكن الإنسان خادمًا لله كي يعمل لمنافعه، بل إنّه خادم لنفسه وتعود نتائج أعماله إلى نفسه. إذ الله تعالى لا يريد خَدَمًا كي يؤدّي الإنسان خدماته له، وإذا ورد في بعض العبائر طلب الله الخدمة من العبد، فالمقصود هو خدمة الإنسان لنفسه لا خدمة الله تعالى.
(106)والله تعالى لا يريد من الإنسان تقديم الخدمات له أو لما يتعلّق به، بل الهدف أن يخدم الإنسان نفسه. وعليه، فإنّ في النظام الإلهيّ والدينيّ لم تكن العلاقة بين الله وعبده علاقة يطلب فيها خالق الكون تلبية منافعه؛ لأنّ الله هو منشأ المنافع ومخزن الأرباح ومنبع العطاء والجود.
وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ونقرأ في أدعية ليلة الجمعة: «يا باسط اليدين بالعطيّة» أي يعطي الله المنافع للعباد فحسب، بل إذا أراد إعطاء شيء لعبده يهبه بكلتا يديه مع تنزّهه عن اليدين.
لذا، لا يتردّد جميع الأنبياء والأوصياء في تقديم أيّ نوع من الإيثار له، وهنا يقول أمير المؤمنين عليهالسلام :
«كفى بي عزًّا أن أكون لك عبدًا، وكفى بي فخرًا أن تكون لي ربًّا، أنت كما أُحبّ فاجعلني كما تحبّ» .
وأيضًا، عندما قال المشركون في إحدى الحروب: (نحن لنا العزّى ولا عزّى لكم) أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المسلمين أن يقولوا: (الله مولانا ولا مولى لكم) فمولويّة الله توجب العزّ والشرف، وإذا ورد الكلام في الأوامر والتعاليم الدينيّة عن العبد والمولى، لا بدّ من التأمّل أوّلًا من هو المولى؟ هل هو شخص مثل الإنسان، أو من ليس له أيّ مثيل وتكون جميع الكائنات مرتبطة به حدوثًا وبقاء، فهناك فرق كبير بين أن يكون الإنسان عبدًا لله أو عبدًا لشخص مثله، ففي نظام الرقّ يكون المولى شخصًا عاديًّا، وفي نظام العبوديّة الدينيّة يكون المولى هو الربّ الكريم.
وثانيًا لا بدّ من الالتفات إلى الاختلاف الماهويّ بين هذين النظامين
في العبوديّة، ففي إحداهما يكون العبد خادمًا والمولى مخدومًا، وفي الآخر يكون العبد خادمًا ومخدومًا، ويكون المولى منبع الجود والفيض والكرم، فنظام العبوديّة الدينيّة والملكوتيّة لا يتنافى ولا يتناقض مع حقوق الإنسان فحسب، بل يتوافق معه، ويمرّ الطريق الوحيد لتحقّق حقوق الإنسان عبر العبوديّة له تعالى والنظام الدينيّ الذي شرّعه. فالعبوديّة لله الطريق الوحيد لإحقاق الحقّ وكلّ مسير غيرها ضلالة صرفة وانحراف عن المسير.
ولتكميل ما مرّ من الكلام، يمكن القول:
1 - نزل القرآن الحكيم لتعليم الانسان الكتاب والحكمة، ولتزكية روحه وتضحية نفسه.
2 - التعليم والتزكية تعدّان ضمن العلوم والأمور الإنسانيّة، ولا يتيسّران من دون معرفة الإنسان ومعرفة ماهيّته وهويّته.
3 - إنّ عنوان (خلافة الله) تضيء كواسطة العقد لمعرفة الإنسان في كتاب الله التكوينيّ؛ أي القرآن.
4 - لهذه الإضاءة منافع كثيرة؛ لأنّها تبيّن سماويّة الإنسان مضافًا إلى نسبته إلى الأرض، كما تبيّن طرد بعض الأشخاص الذين رمتهم بسوط ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ وعصى ﴿شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ﴾ من حريم الإنسانية الآمن، وتبين أيضا نيل الصلحاء في مقام الإنسانية لمنزلة علم أسماء الله الرفيعة، والوصول إلى مقام (خلافة الله) المنيعة، والصعود نحو مقام الصناعة الخاصة الإلهية: «فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا» والوصول أيضا إلى درجة تعليم وإنباء الملائكة:
﴿يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ وفي النهاية مقام سجود الملائكة: ﴿قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ .
5 - تمّ توكيل مهمّة إعمار الأرض في أبعادها العلميّة والعمليّة المختلفة من قبل الله الى خليفته؛ أي الإنسان الصالح والمتّقي: ﴿وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ .
6 - بعد بيان موقعيّة الإنسان الكامل والمتكامل تضمحلّ شبهة منكري الوحي والنبوّة بأنّ البشر لا يمكنه أن يكون رسولًا من قبل الله سبحانه؛ لأنّ مدّعى الكفار كان: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ فابتلى الله تعالى هؤلاء المنكرين والكافرين بعذاب أليم: ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إنّ هؤلاء قالوا لموسى عليهالسلام وأخيه هارون: ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ وقالوا لنوح عليهالسلام : ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ لأنّه يظهر بعد تحليل الإنسان بــ (ما هو) المشترك ظاهرًا بين جميع الأشخاص، و(من هو) المائز الأساس لافتراق البعض عن البعض الآخر كما في ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ رفع توهّم التماثل العامّ بين جميع الأشخاص، ويظهر إمكان وصول البعض إلى مقام النبوّة والرسالة المنيع، ويظهر أيضًا الشرط الأهمّ؛ وهو العبوديّة المحضة لله، المبيّن في (أشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله) والتفاوت بين الحرّيّة الحيوانيّة المذمومة، والحرّيّة الإنسانيّة المحمودة.
الشبهة الأخرى المذكورة: إنّ معرفة كلّ شيء مرهونة بآثاره ولوازمه، فللحقّ آثار وللتكليف لوازم، ويمكن الوقوف على أيّ واحد منهما من خلال الآثار واللوازم، وعلى سبيل المثال: فإنّ العقاب من آثار التكليف ولم يكن من لوازم الحقّ، واختيار الفعل والترك من آثار الحقّ لا التكليف، والدين يشتمل على عقوبات دنيويّة وأُخرويّة تندرج تحت عنوان التكليف لا الحقّ. كما أنّ التكليف مقرون بالإكراه والإجبار، ولكنّ الحقّ مقرون بالاختيار والحرّيّة.
فصاحب الحقّ ومن يرى نفسه محقًّا لا مكلّفًا، يكون ثبوت الحقّ وسقوطه باختياره، وله الحقّ في استيفائه أو تركه، وعند عدم استيفاء حقّه لا يمكن لأحد إصدار حكم عليه أو عقوبته، بمعنى أنّ عدم طلب الحقّ لم يكن كترك التكليف المستدعي للعقاب والعذاب. وعلى سبيل المثال: فللإنسان الحقّ في الاستفادة من المحيط السليم والغذاء السليم والتنزّه في الحدائق، فمن لم يرد الاستفادة من هذه الحقوق الحقّة، لا يمكن لأحد عقوبته بسبب ترك هذا الحقّ.
فإذا قبلنا أنّ التكاليف الدينيّة ترجع إلى الحقوق، لا بدّ من الإذعان بأنّ الإنسان حرّ في استيفاء تلك التكاليف، وإلّا يكون نوعًا من الإجبار وخروج عن نطاق الحقّ. فعدم التساوي بين الترك والفعل، وترتّب العقوبة الدنيويّة والأخرويّة، والتهديد بالعقاب ونتيجة سوء العمل، تدلّ على تكليفيّة أفعال الإنسان وعدم الأحقّيّة. والحاصل: أنّ العمل بأوامر الدين وأداء التكاليف الدينيّة، إذا كانت حقًّا للإنسان، لا بدّ أن لا يعاقب الإنسان بتركها والحال أنّ الأمر ليس كذلك.
وفي مقام الإجابة عن هذه الشبهة لا بدّ من تحليل معنى العذاب وتقييمه وذكر أقسامه [فنقول]:
(110)هل العقوبات الإلهيّة اعتباريّة أم حقيقيّة؟ وهل توجد عقوبة خاصّة لكلّ عمل متروك، أم أنّ العقوبة هي النتيجة الطبيعيّة لترك العمل؟
بيان ذلك: إنّ حقوق الإنسان على قسمين: الحقوق الأوّليّة والأساسيّة التي تعود إلى موجوديّة الإنسان وحياته، الحقوق الثانويّة التي لا علاقة لها بحياة الإنسان وإن كانت لا تخلو من تأثير في تكامل حياة الإنسان، فحقّ السلامة والغذاء والهواء السليم ونحوها يمكن عدّها من الحقوق الأوّليّة، أمّا الأمور الأخرى كالسفر والنزهة واللعب تعدّ من الحقوق الثانويّة، ومن ترك هذه الحقوق لا يكون مطلوبًا من قبل السلطات الحاكمة، ولا تعدّه السلطات القضائيّة مجرمًا ولا تُصدر له عقوبة؛ لأنّه مختار في فعل هذه الأمور أو تركها، والسؤال المطروح هنا عن عدم استيفاء هذه الحقوق، فهل يترتّب عليها آثار سلبيّة في نظام التكوين أم لا؟
وذلك أنّ ماهيّة الحقوق تبتني على وجود فائدة للمستحقّ، وتأثيرها في تكامله، ومع عدمها يحصل الخلل في تعالي صاحب الحق، كما يمكن أن تكون فوائد جميع الحقوق متساوية من حيث الفوائد والآثار الإيجابيّة، ولكن لا شكّ في أنّ وجودها نافع في رُقيّ صاحب الحقّ وتقدّمه، علمًا بأنّ الشيء الذي يكون وجوده وعدمه متساويًا للشخص، لا مزيّة له ولا يمكن عدّه حقًّا لذلك الشخص. فالسلامة نوع من الحقوق، ولكن عدم استيفائها يسبّب الخطر التدريجيّ لحياة الشخص، وكذلك يكون تعلّم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس حقًّا متسالمًا عليه لروح الإنسان الملكوتيّة، والتسامح والتساهل فيها يوجب مرض القلب، وعلاج مرض القلب حقّ متسالم عليه لروح الإنسان الإلهيّة، والغفلة عنه يوجب اشتداد مرض
(111)القلب: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾ .
والحاصل: يجب السعي لتأمين سلامة الجسم والروح، والاستفادة من الهواء الطلق والنزهة الإيجابيّة، والغذاء السليم والتعليم والتربية وسائر العوامل الداعية للسلامة. فهذه الأمور تعدّ من الحقوق، ولكن ترك استيفائها يسبّب تهديد النشاط والسلامة الروحيّة والجسديّة وبالمآل تؤثّر في حضارة الفرد والمجتمع المرتكزة في تديّن الشخص. ويجب الاهتمام بحفظ السلامة الروحيّة كالاحتفاظ بالسلامة الجسديّة، والاستفادة من الأمور الترفيهيّة السليمة إلى جنب التعاليم العلميّة والأخلاقيّة. وهنا، لا يوجد أثر من العقوبات الحكوميّة، بل إنّها من العوارض السلبيّة لعدم استيفاء الحقوق.
وعلى أيّ حال، فمن البديهيّ أنّ ترك استيفاء الحقوق والتكاليف المترتّبة عليها، له آثار ولوازم سلبيّة، وليس من المعقول القول بأنّ هذه الحقوق إذا كانت حقّ الإنسان، فلماذا يترتّب على عدم استيفائها هذه النتائج الثقيلة؟
فالحقوق والتكاليف الدينيّة من هذا القبيل، إذ إنّ عقوبات ترك التكاليف الدينيّة ليست اعتباريّة، بل إنّها النتيجة الطبيعيّة لترك العمل، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ .
في جواب السؤال عن معنى الانتقام الإلهيّ والعقوبات، يقال: إنّ الانتقام والعقوبة على أقسام، نشير إلى أربعة أقسام معروفة منها:
1 - الانتقام على شاكلة التشفّي الذي يأخذه المظلوم من الظالم ليشفي
غليله ويرتاح قلبه، والانتقام الإلهيّ لم يكن من هذا النوع قطعًا.
2 - الانتقام القضائيّ الذي تلتزم به السلطة القضائيّة أمام المجرم لإقرار السلام والأمان في المجتمع ولعبرة الآخرين، وهذا الانتقام وإن كان صحيحًا ولكن لم يدخل الانتقام الإلهيّ في هذا القسم؛ لعدم وجود تهديد يوم القيامة من قبل الآخرين كي يستتبّ الأمن بهذا الانتقام، والقيامة لم تكن دار العمل ليعتبر الآخرون بهذا الانتقام.
3 - الانتقام الطبّيّ وهو الذي يأخذه الطبيب من المريض الذي لا يلتزم بالعلاج، فالمريض الذي لا يعتني بوصفة الطبيب الحاذق يشتدّ مرضه، فاشتداد المرض وتهديد زوال السلامة انتقام طبّيّ، فالطبيب لا يضرب من خالف أوامره بالسوط، ولكن يُنبّهه على أنّك لم تلتزم بالأمور الطبّيّة فابتليت بالمرض الفلانيّ. فانتقام الطبيب تشديد المرض وتهديد زوال سلامة المريض، والانتقام الإلهيّ للناس العاديّين يمكن تبريره بهذا النحو.
4 - القسم الرابع من الانتقام وهو الأدقّ من قبله، انتقام الوالدين من الابن المشاكس، فمربّي الطفل يطلب منه عدم الاقتراب من النار، ولكن الطفل المشاكس لا يعتني ويمسك النار بيده فتحترق يده، ويمكن عدّ الانتقام الإلهيّ من هذا القبيل. فرجوع التكاليف إلى الحقوق وإن كان صحيحًا، ولكن ترك التكاليف الموصلة إلى الحقوق لا تُنتج سوى ما يُسمّى بالعقوبة، فالعذاب وإن يُدرك في الآخرة، لكنّ المجرم ينال العذاب في نفس لحظة ارتكاب الذنب: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ فأصل النار موجودة الآن بالفعل، ولكن بما أنّ المذنب
سكران بالدنيا لا يحسّ ألم الاحتراق. فباطن الذنب هو العذاب الأخرويّ في هذه الدنيا، وما يحصل في الآخرة إنّما هو تجسّمه.
لم يكن معنى العذاب الإلهيّ أن يقول الله تعالى بما أنّكم لم تستوفوا حقوقكم المبيّنة على شاكلة التكاليف، سنكتب لكم عقوبة إضافيّة، فالعذاب الحاصل للإنسان جرّاء ترك التكليف، إنّما هو أثر طبيعيّ لعدم استيفاء الحقوق. فعقوبة الله في الدنيا من هذا القبيل، فإذا عاقب المعلّم أو المربّي التلميذ المشاكس، فإنّما هو لأجل تنبّهه ونجاته من خطر الجهل العلميّ والجهالة العمليّة ولعبرة الآخرين. فالشابّ الغافل المبتلى بالمخدّرات مثلًا، ألا يقول لأولياء البيت أو المدرسة بعد تعافيه وبلوغه الرشد، لماذا لم تمنعوني؟
فعقوبات الذنب الدنيويّة من هذا القبيل، إنّ الحدود والدِيَات وضعت لأجل حفظ الأمن في المجتمع ولتذكّر الجناة وغيرهم وتنبّههم، وإذا لم يكن كذلك سوف يعترض المجتمع الواعي على المسؤولين لعدم اتّخاذ اللازم، يقول الله في حكمة إرسال الرسل لئلّا يقول أحد يوم القيامة: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِــعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾ أي إنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب الإلهيّة حقّ المجتمع المسلّم، حيث ينبّه الله تعالى الناس بواسطة رسله، وينذرهم من مغبّة الذنوب والضلال، بحيث يمكن القول بأنّ إرسال المنذرين جزء من مطالبات الناس، ووجود الهداة المنذرين من حقّ الإنسان. فالإنسان الحائز للفهم والعلم والمعطى أدواة المعرفة، من حقّه أن يعرف حقائق حياته وواقعيّاتها، فإذا يوجد معادٌ وحسابٌ وكتابٌ وعقابٌ - وهو كذلك - فمن حقّ الإنسان الاطّلاع عليها، وقد أرسل الله الرسل لتأمين هذا الحقّ للبشريّة، وكي يتمّ حجّته عليهم:
﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ .
ولا غنى عن العقل والأدلّة العقليّة لكنّها غير كافية، ومن الضروريّ وجود الوحي لازدهار العقل الفرديّ والجمعيّ وإثارته، وتصحيح العيوب وتكميل النواقص: «ويثيروا لهم دفائن العقول» وعليه، فالإنذار الإلهيّ والعقوبات الدنيويّة تعدّ نوعًا من حقّ الإنسان كي تنجيه من الوقوع في العذاب الأبديّ، ويعود هذا الأمر إلى نفع الإنسان.
وقد اتّضح لحدّ الآن إنّ العقوبات لم تكن تضييعًا لحقّ الإنسان أوّلًا، بل إنّها الأثر التكوينيّ لعمل الإنسان وسلوكه، وثانيًا إنّ استلام رسالة الله بواسطة سفراء الله من الحقوق المتسالم عليها ومن متطلّبات الإنسان الحتميّة، وفي صدر الإسلام عندما قطعت يد السارق بأمر علي عليهالسلام، مدح السارق أمير المؤمنين عليهالسلام وقال قد أنجاني عليّ فالعقوبة في الواقع نجاة للمجرم، والنجاة من حقوق الإنسان.
والحاصل: إنّ الحقّ قرين الحرّيّة والاختيار وقد يكون ملازمًا لهما، والدين أيضًا قد رسم عقوبات دنيويّة وأخرويّة للمذنبين، ولكنّ هذا النوع من الأوامر والتعاليم الدينيّة لم تكن بمعنى التكليفيّة وكفاح الدين للحقّ؛ لأنّ أيّ عقاب في الدين إنّما هو من النتائج السيئة وأثر لعدم استيفاء حقوق الإنسان، لا عقوبة من قبل شخص ثالث، وهناك فرق كبير بين الصدمات التي ينالها الإنسان المستحقّ جرّاء عدم استيفائه الحقوق، وبين العقوبة التي ينالها من شخص ثالث ويترتّب على عدم استيفاء الحقوق آثار سلبيّة إحداها العقوبات المذكورة في الدين، وفي الواقع إنّ هذا القسم من الدين، يبيّن
قسمًا من الواقعيّات، ولا يبين العقوبات الاعتباريّة لمن لم يستوف حقه، ولذا يمكن القول: إنّ هذا النوع من الأوامر والنواهي الإنشائيّة، إنّما هي إخبار عن الحقائق العينيّة والواقعيّة التكوينيّة.
الإشكال الآخر: إنّ توقّع الإنسان من الدين ان يقضي جميع حوائجه وحقوقه توقّع غير صائب؛ لأنّ الدين كالدواء يعالج به بعض الأمراض الخاصّة لا جميع الأمراض والأوجاع، ونقول ان هكذا تفسير وتشبيه للدين ناشئ من التلقّي الخاطئ عن الدين. وعدم صحّة هذا التشبيه يكمن أوّلًا في أنّ للدواء الخاصّ عناصر مخصوصة ومحدودة ولها أثر خاصّ، والحال أنّ أصل الدين مجموعة منتظمة تكون جميع معارفه وحيانيّة، وبما أنّ العلم الإلهيّ محيط بجميع الأشياء، نظّم قوانين ثابتة في أصولها وكلّيّاتها، ومتغيّرة في فروعها وجزئيّاتها، وتلك الأصول والفروع تقضي جميع الحوائج والحقوق: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ وإذا أردنا التشبيه لا بدّ من تشبيه أصل الدين بأصل الدواء، وأحكامه الخاصّة بمثابة الدواء الخاصّ، أي بما أنّ أصل الدواء الكلّيّ والجامع لعنوان الدواء يصلح لجميع الأمراض وإنّ كلّ دواء خاصّ يعالج مرضًا خاصًّا، فأصل الدين والجامع الكلّيّ لعنوانه يقضي جميع الحوائج الفرديّة والاجتماعيّة، وكلّ واحد من أحكامه يلبّي حاجة مخصوصة، لذا قال الله في القرآن: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وعليه، فإنّ التشبيه المذكور يحتوي على مغالطة العامّ والخاصّ، والكلّيّ والجزئيّ والجامع والفرد.
وثانيًا، إنّ من يحمل هكذا تصوّر عن الدين مضافا إلى خلفيّته الفكريّة
عن الدين وانه منحصر في المتن المنقول أيّ الكتاب والسنّة، فإنّ هؤلاء يزعمون افتراق البرهان العقليّ عن أدلّة الدين، فجعلوا العقل أمام الدين، والحال أنّ هذا الزعم عن الدين غير صائب؛ لأنّ العقل يقابل النقل لا الدين، فالعقل والنقل جناحان للدين، والدين الإلهيّ يكتمل بهذين الجناحين.
وبعبارة أخرى: لا يصحّ بتاتًا جعل العقل أمام الشرع بل العقل يقابل السمع، وكلاهما ككفّتي الميزان في خدمة الشرع.
وإذا أردنا أن نسطّر الكلمات ونتكلّم كلامًا علميًّا لا بدّ أن نسأل هل الأمر الفلانيّ عقليّ أو نقليّ؟ عقليّ أو سمعيّ؟ إذ العقل والنقل يكتشفان الدين بشكل سواء، فحكم العقل حكم الشرع كما أنّ حكم السمع والنقل عند الإنسان هو حكم الشرع، نعم لا نقصد العقل الوهميّ والخياليّ بل العقل البرهانيّ، وعلى سبيل المثال: إذا شخّص الطبيب أو مجموعة الأطباء أنّ المريض الفلانيّ لا بدّ أن يستعمل العلاج الفلانيّ أو يلزم أن يخضع لعمليّة جراحيّة، فحينئذٍ يلزم على الطبيب شرعًا العمل بعلمه هذا، وبعد هذا التشخيص الشخصي او بعد حكم مجموعة اطباء عمل بوظيفته قربة الى الله فإنّه حينئذ ينال الأجر والثواب يوم القيامة، وإذا خالف الطبيب علمه عامدًا عالمًا فإنّه يعذّب يوم القيامة، ولا يمكنه أن يحتجّ يوم القيامة بأنّك يا إلهي لم تخبرني في القرآن أو الرواية بوجوب معالجتي المريض الفلانيّ بالعلاج الفلانيّ. فهذا العذر لا يقبل من الطبيب أبدًا؛ لأنّ البرهان العقليّ في فنّ الطبابة حجّة شرعيّة كالدليل المعتبر النقليّ.
فالعقل بمعيّة النقل شاخصان ومؤشّران أساسيّان للشريعة الإلهيّة، والعقل كالنقل صاحب الفتوى، وإن لزم تبيين مبادئه وأصوله، كما أنّه ليس من السهل القيام بتفسير القرآن والحديث وفقه الحديث وفقه القرآن، فكذلك فقه العقل. وإذا كان العقل كالنقل لا يمكن القول إنّ الدين كالدواء المفيد
(117)لبعض الأمراض، بل لا بدّ من جعل الدين الحاصل من مجموع العقل والنقل، دواءا لجميع الأمراض ونافعًا لجميع الأعصار والأمصار. فهذا التشبيه والتمثيل الخاطئ - تماثل أصل الدين بالدواء الخاصّ لا أصل الدواء - ناشئ من ذلك التلقّي الخاطئ.
وقد تسربل البعض بلباس أهل الخير وطرح شبهة، وقال: إنّ كمال الدين وقوّته عدم تدخّله في حقوق الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة؛ لأنّ تصرّفه في الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة توجب سلب الحرّيّة؛ لأنّ ماهيّة الدين الاهتمام بالآخرة وهدفه السعادة الآخرويّة لا الراحة الدنيويّة .
وهذه الرؤية وإن كانت في ظاهرها لصلاح الدين، لكنّها ظلم كبير للشريعة وتناظر قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ وجواب هذه الشبهة ما ذكرناه سابقًا ولا حاجة إلى الإعادة.
يمكن تلخيص النتائج الحاصلة من هذا الفصل ضمن النقاط الآتية:
1 - يظهر أنّ مباحث الحقّ، الحكم والتكليف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمباني الإبستمولوجيّة والأنطولوجيّة والأنثروبولوجيّة، بحيث إذا لم يتمّ تبيين تلك المباني الفكريّة والعقديّة، لا يترتّب على هذا البحث أيّ نتائج مثمرة. وعليه، يلزم الخوض في هذه المباني قبل الولوج في بيان المباحث الحقوقيّة، كما أنّ البحث من دون تعيين المباني العقديّة، سيبقى في هالة من الإبهام، وتقتصر جميع المباحث على المجادلات اللفظيّة.
2 - لا يوجد أدنى شكّ في أنّ الخوض في معرفة الواقعيّات من دون حصول منبع مطمئن ومصون من الخطأ في نطاق المعرفة، يسبّب الضعف والتزلزل وقد يؤول إلى مشاكل مستعصية لا يمكن حلّها. فالمباني الفكريّة كلّما ارتبطت بهكذا مصادر، تكون أقرب إلى الصواب قطعًا، وفي المقابل كلّما تمّ الاعتماد على الأدوات الحسّيّة والتجريبيّة أو العقل الأداتيّ، كثرت الأخطاء المعرفيّة بتلك النسبة. والفارق بين رؤية المسلمين مع الغربيّين، إنّ الغربيّين يعتمدون في مبانيهم على المصادر البشريّة، ولكنّ المسلمين ضمن اعتمادهم على العقل البرهانيّ، يستندون إلى المصدر الوحيانيّ أيضًا. وبهذا يمكن وضع الأفكار والرؤى على المحكّ والحكم بالصحّة أو الخطأ.
إنّ ما يصوغ رؤية المسلمين مصدر ﴿لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ والغربيّون لو عثروا على كتابهم المقدّس الواقعيّ لوصلوا إلى نتائج واحدة ومشتركة مع المسلمين، بحيث ترتفع معها كثير من الخلافات الدينيّة والمذهبيّة، ولكن ظهر الخلاف لاختلاف مصادر استنباط المباني والحال أنّ المصادر الوحيانيّة تؤيّد بعضها البعض وإن تعدّدت: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ .
3 - لقد ابتنت التكليفيّة والأحقّيّة في الإسلام على مبنى وعقيدة لا يوجد فيها تعارض بينهما فحسب، بل تسبّب الوفاق الكامل والمعيّة التامّة بينهما، ولكنّ الأحقّيّة ابتنت عند المتجدّدين على مباني أفرغت الحقّ من معانيه الحقيقيّة، فالمباني الإبستمولوجيّة والأنطولوجيّة والأنثروبولوجيّة المطروحة عندهم، تختلف كثيرًا عن مفهومها لدى المجتمع الإسلاميّ، أي إنّ نوعيّة إدراكهم لتلك المفاهيم لا تتناسق
مع رؤية الأمّة الإسلاميّة في كثير من الموارد .
وعليه، لا ينبغي لنا الإصرار أو محاولة تقريب وجهة نظرنا مع عقيدتهم في الأحقّيّة، أو محاولة الابتعاد عن التكليفيّة أو العدول عنها لنصل إلى قبول محوريّة الحقّ عندهم، وطبقًا لفهمهم ورؤيتهم عن هذين المفهومين، فإنّه لا يتحصّل منه معنى صحيحًا للحقّ ولا مفهومًا دقيقًا للتكليف. نعم، إنّ متابعة الهوى لا ينتج أفضل من هذا.
4 - إنّ متجدّدي الغرب تكلّموا عن الحقّ في زمن شاع فيه دعاية عدم وجود نظم للعالم، وعندما لاقى هذا الفكر رواجًا وإقبالًا جيّدًا من قبل مفكّريهم، وكانت رسالة هذه الرؤية عدم وجود أيّ نظم في نطاق الوجود، وإنّ الظواهر سيّما الإنسان موجود مطلق في منظومة الطبيعة، كما أنّ دراسات علماء الغرب في علوم الأحياء والطبيعة تسير بناء على هذا المبنى سيرًا عرضيًّا لا طوليًّا إلى اليوم، أي لا يبحثون في الظواهر مع لحاظ علّتها الغائيّة مع ما لها من علقة فيما بينها، فبهذه الرؤية وبهذه المباحث حول الإنسان، ذهبوا إلى عدم وجود أيّ معيار وملاك خاصّ لأعمال الإنسان وسلوكه، فالحقّ ما يرومه الإنسان، وكلّ ما كان فوق الإنسان والطبيعة نوع من التكليف والعناء للإنسان ولا يمكن قبوله. وقد صرّح بعضهم أنّ من قبل شيئًا أرفع من عقله فإنّه يكون عبدًا له وإن جاء من قبل الله والدين، وعليه فإنّ الحقّ والتكليف يختلف معناهما بلحاظ نظريّة المعرفة والوجود المعتمدة، ولا بدّ من الالتفات إلى هذا في المباحث المعرفيّة والحقوقيّة.
5 - يظهر من المباحث التي مرّت حول معرفة الإنسان، أنّ هويّة الإنسان وماهيّته لا يمكن بيانها وتفسيرها عند مفكّري الإسلام من دون
ارتباطها بالله، بل الإنسان يقبل التعريف مع لحاظ حقيقته المطلقة وبها يحوز مقامه المناسب، ولكن فسّر كثير من مفكّري الغرب الإنسان من دون لحاظ وجود الله تعالى. وهاتان الرؤيتان المختلفتان سبّبتا شرخًا عميقًا في سائر مباحث معرفة الإنسان، فعندما توجد رؤيتان مختلفتان حول ماهيّة الإنسان سوف يختلف مبنى الحقّ والتكليف بتبعها.
6 - إنّ البحث عن الحقّ والتكليف والتعارض بينهما، يضرب بجذوره في ثقافة الغرب وعقيدة علماء المسيحيّة؛ إذ أنّهم تاريخيًّا ومعرفيًّا قسّموا العلماء إلى قسمين: تقليديّين ومتجدّدين، يقول إيان بار بور المفكّر المسيحيّ:
«ذهب الكلاسيكيّون إلى أنّ الإنجيل مصون من أيّ نقص وخطأ ولا يقبل أيّ تأويل والرأي المخالف له خاطئ قطعًا، ولكن ذهب المتجدّدون في قبالهم الى أنّ الإنجيل صنيعة البشر» .
وبناء على هذا، يقال إنّ الفكر التقليديّ يدور مدار التكليف، والفكر المتجدّد يبتني على الحقّ. الإنسان التقليديّ ينظر إلى الأمور من منظار التكليف، والإنسان المتجدّد يرى إلى القضايا من مجاري الحقّ، إنّهم يريدون برؤيتهم الخاصّة هذه، ارتقاء شأن الإنسان وموقعيّته من رؤية الإنسان التقليديّ وأن يصبغوا رؤاهم بصبغة قيميّة.
وربّما يكون هذا المبنى وهذه العقيدة صحيحة بناء على دين المسيحيّة المحرّف، والاعتقاد الحاكم على الناس آنذاك، ولكنّ الحقّ أنّ هذا التقسيم وهذه النتائج تتعلّق بذلك الدين المحرّف والعقيدة بالتثليث، ولا ينطبق ولا يقاس بتاتًا مع دين الإسلام ومباني المسلمين العقديّة، وذلك أوّلًا أنّ النصّ الواقعيّ للإسلام متاح للمسلمين جميعًا خلافًا للمسيحيّة، وثانيًا إنّ عقيدة
المسلمين عقيدة توحيديّة لا تثليثيّة، وعليه فمجرّد الاشتراك اللفظيّ وإطلاق الدين على الإسلام والمسيحيّة، لا يستوجب توافق مباحث الدينين معًا. نعم، إنّ بين المسيحيّة الأصيلة والإنجيل غير المحرّف تقاربًا عميقًا مع الإسلام الأصيل والقرآن الحكيم.
7 - زعم البعض وجود نتيجة قيميّة لمباحث الحقّ والتكليف فقط، فأصحاب محوريّة الحقّ يبحثون عن إحقاق حقوق الإنسان، وجلّ سعيهم في إيصال الإنسان إلى موقعيّته الحقيقيّة، ولكنّ أصحاب التكليف يريدون للإنسان أن يعيش مكلّفًا وعبدًا يقبل قيوميّة الآخرين دائمًا، إنّهم يصدّون الإنسان من الرقيّ الفكريّ والعمليّ، ويريدون أن تكون لهم حكومة مطلقة على الإنسان. ولكنّ هذا الزعم باطل ووهم وخيال؛ لأنّ البحث هنا نظريّ فقط وإذا تمّ تبيينه بشكل صحيح تتغيّر الرؤية القيميّة أيضًا وتنتج عكس ما قيل.
إنّ محوريّة التكليف في ثقافة الإسلام السماويّة، تعني عبوديّة الله سبحانه والخلاص من دسائس الشيطان، وهذا وحده مقام رفيع للإنسان. إنّ تكليف الإنسان وعبوديّته لله تعالى، هو الطريق الوحيد للوصول إلى موقعيّة الإنسان المنيعة والرفيعة.
وبناء على هذا، فإنّ التكاليف الإلهيّة بمثابة الدواء لعلاج القلوب المريضة، والأنبياء أطبّاء للبشريّة في الواقع، يعالجون نفوسهم ويطهّرونها، ويوجد معنى خاصّ في قاموس الدين لمفهوم العبوديّة والحرّيّة والتكليف والحقّ.
(122)لا يصحّ التطرّق إلى مصادر الحقّ والتكليف ومبانيهما بشكل كلّيّ ومن دون لحاظ النظرة الكونيّة لسائر الآراء والمدارس المختلفة، كما أنّ الأديان والمذاهب بيّنوا آراء متفاوتة بهذا الخصوص وبحسب مبانيهم، فقد ذهبت الأديان الإلهيّة إلى أنّ منشأ الحقّ ومصدره أمر واحد، ولكن طرحت المدارس الأخرى غير الإلهيّة آراء مختلفة، فمنهم من زعم أنّ منشأ الحقوق حاجة الإنسان، وبعضهم الآخر جعل الإرادة والقدرة، وقسم ثالث القانون.
وكلّ واحد من هذه الآراء بحاجة إلى بحث وتحليل، وسوف نتطرّق في هذا الفصل إلى تحليل الآراء المذكورة بهذا الخصوص وبحثها، وكذلك رؤية مدرسة الإسلام السماويّة، وقبل الخوض في البحث لا بدّ من الالتفات إلى عدّة نقاط ضروريّة:
1 - إنّ المراد من منشأ الحقّ إنّما هو مبدأ الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة، أو الجهة المقنّنة للحقّ؛ أي من هو واضع الحقوق والتكاليف؟ ومن الذي يحقّ له وضع القوانين الحقوقيّة أعمّ من الفرديّة والاجتماعيّة؟ ويُبحث عن هذا الموضوع - كموضوع مبنى الحقّ - في مباحث فلسفة الحقوق، ونتطرّق إليه هنا بقدر الحاجة، ومن الضروريّ بيانه كمدخل للبحث.
(123)2 - يدخل موضوع حقوق الإنسان والتعرّف على منشأها ومحتواها وآثارها، في العلوم الإنسانيّة، ومن الجدير تحديد البحث في نطاق هذا العلم دون سواه من العلوم. وعليه، فإنّ مفهوم الحقّ هنا لم يكن اعتباريًّا محضًا، ولا يتحقّق من دون الاعتماد على الواقع الخارجيّ أعمّ من الإنسان والفطرة والطبيعة الإنسانيّة، خلافًا لمن زعم اعتباريّة الحقّ للإنسان .
3 - يُعدّ مبحث حقوق الإنسان في الأديان السماويّة، سيّما الإسلام وهو أكمل الشرائع وأجمعها، من أهمّ المباحث، وقد ورد التأكيد عليها في آيات وروايات كثيرة، فالزعم القائل بغير بصيرة أنّ الإسلام بسبب عدم اهتمامه بحقوق الإنسان لم يتطرّق إلى المباحث الحقوقيّة، وعليه لا يمكن تصوّر نظام حقوقيّ مستقلّ للإسلام، زعم باطل وغير صائب .
4 -ختلف المصادر والمباني والفروع بعضها عن بعض، فالفروع تؤخذ من المباني، والمباني تؤخذ من المصادر. الفروع هي المواد أو الملحقات أو الأمور الجزئيّة، وعلى سبيل المثال، يقال في الفقه: إنّ الفروع هي الأحكام الخاصّة الواردة في المسائل العمليّة، والمباني عبارة عن أصل البراءة والاستصحاب أو التخيير، وهذه المباني تؤخذ من المصادر، وكذلك الحال في مباني التكليف، لذا نتطرّق أوّلًا إلى مصادر الحقّ والتكليف ثمّ نبحث عن الآراء والنظريّات المختلفة.
قد يتعلّق المصدر بالأنطولوجيا وقد يتعلّق بالإبستمولوجيا، وفي المصادر الأنطولوجيّة يبحث عن إيجاد الظواهر وتكوينها، من أين جاء الدين ومن هو مكوّنه؟ أيّ مقام يليق بتكوين قوانين الدين وتدوينها؟ ومن الذي يضع تعاليم الدين ويبلّغها الناس. فهذه المباحث تدخل في دائرة أنطولوجيا الحقّ والتكليف.
ثمّ بعد الفراغ من تعيين مصدر تدوين الدين أو الحقّ والتكليف يُسأل عن دليل الواضع لوضع هذه القوانين وتدوينها. وللإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من الخوض في الحكمة النظريّة، فالمصدر الأنطولوجيّ يرجع إلى العلّة، والمصدر الإبستمولوجيّ إلى الدليل. وعندما اتّضح في البحث الأنطولوجيّ منشأ ظهور الدين والقانون والحقّ والتكليف، يتمّ التطرّق في الإبستمولوجيا إلى دليل ذلك، وما يطرح في الإسلام حول الدين والقانون، يمكن استخدامه في موضوع الحقّ والتكليف أيضًا، بل إنّ الحقّ والتكليف شعبة من أصل الدين وقانون الإسلام.
إنّ أصل الدين هو العقائد، الأخلاق، الفقه والحقوق، ومصدره الوجوديّ هو إرادة الله وعلمه الأزليّ. وهذا الموضوع لا يندرج في مباحث فلسفة الحقوق بل من مهامّ الإلهيّات والحكمة النظريّة. وذلك للزوم البحث عن أساس تلك الأمور - أيّ الإنسان والكون والعلاقة بينهما المستندة جميعًا إلى الله - في هذا العلم. فالكلام في الإلهيّات والحكمة الإلهيّة كلام عن أصل الوجود، فالله هو منشأ الوجود ومبدأه، وإنّه مضافًا إلى الخالقيّة، ربّ جميع الموجودات، وقد صرّح القرآن الكريم إلى أنّ الله ليس خالقًا للإنسان والكون فحسب، بل إنّه ربّهما أيضًا، فيقول بخصوص الخالقيّة:
(125)﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ﴾ ويقول بخصوص الربوبيّة: ﴿رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ﴾ فخالق الجميع ربّها أيضًا، غير أنّه يربّي كلّ موجود بحسب سعته الوجوديّة، فيقتضي مقام الإنسانيّة وسعته الوجوديّة، تربيته في ظلّ الحقوق والتكاليف والتعاليم الإلهيّة على ضوء الدين.
النتيجة الحاصلة ممّا مرّ، أنّ فلسفة الحقوق مدينة للفلسفة الإلهيّة. فنظرة الحقوقيّين تبتني على أُصول فلسفيّة، الأصول التي ترى أنّ مصدر الدين الأنطولوجيّ هو إرادة الله وعلمه الأزليّ، وقد ثبت في الفلسفة الإلهيّة أنّ هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب السماويّة، إنّما هو التعليم والتربية، وأنّ أساس الوحي والنبوّة خلق المعرفة وارتقاء البشريّة إلى مقام الإنسانيّة الرفيع.
فالحكمة النظريّة برؤيتها هذه صدّت بعض المزاعم الجاهليّة، منها: أنّ الإنسان المادّيّ هل يمكنه فهم الوحي؟ وقد أثبتت الفلسفة الإسلاميّة في علم النفس أنّ للإنسان روحًا مجرّدة وللروح قوى أرقاها القوّة القدسيّة، ولهذه القوّة القدرة على الارتباط بما وراء الطبيعة، وعليه فإنّ للوحي والنبوّة بُعدين ومعهما يكتملان؛ أي: المنشأ الفاعليّ للوحي والجانب القابليّ له. المنشأ الفاعليّ هو ذات الله المقدّسة، والمنشأ القابليّ نفس الإنسان الكامل القدسيّة. فالفلسفة تتكفّل في الإلهيّات بيان المبدأ الفاعليّ للوحي والإلهام، اما علم النفس فيتكفّل بيان المبدأ القابليّ، فالفلسفة الإلهيّة بركنيها هاتين
(الفلسفة الإلهيّة وعلم النفس) تكون من أهمّ أركان فلسفة الحقوق وعمادها العلميّ.
ان فلسفة الحقوق في الاسلام تجعل ارادة الله وعمله الأزلي مبدأ الوجود والدين والأحكام والحقوق والتكاليف. وعليه، فإنّ عماد فلسفة الحقوق هي الفلسفة الإلهيّة، ولا يمكن إهمال هذا الارتباط وهذه العلقة، فهذه المباحث كلّها تتعلّق بالمصدر الأنطولوجيّ للدين والحقّ والتكليف.
بعد إثبات وجود المبدأ لنظام الوجود، وهو القدرة الإلهيّة الأزليّة، وأنّ الإنسان ليس غريبًا في نظام التكوين، بل بينهما ترابط وثيق، وإنّ تلك الذات الربوبيّة تدبّر نظام الوجود وتدبّر الموجودات، وبما أنّه عالم بجميع المصالح وجميع المفاسد، ويعلم أسرار الأشياء والأفعال والأخلاق والأشخاص، وهي التي تكون ملاك التقنين ووضع القانون في نظام التكوين والتشريع، فبعد إثبات هذا قد يُطرح سؤال، مفاده: إنّنا من أين نعلم تقرير هذه الأحكام من قبل الله؟ يقول علم أصول الفقه المتكفّل لبيان المصدر المعرفيّ للدين: إنّ مصدر الأحكام وتعاليم الدين والحقّ والتكليف، هو الكتاب والسنّة والعقل والإجماع الكاشف للنقل، وكلّها تحكي عن إرادة الله. فهذه المباحث تعدّ جزءًا من المصادر الإبستمولوجيّة.
وللعقل معنى واحد عند أهل التوحيد والموحّدين، ولكن عند الملحدين فالمغالطة تعدّ عقلًا أيضًا ويطلق عليه العقل الإلحاديّ. كما ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام بخصوص معاوية استعمال كلمة الشيطنة والنكراء، ولا يستعمل لفظ العقل، فعندما سئل عليهالسلام عن العقل، قال: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان» وعندما سئل عمّا عند معاوية قال: «تلك
(127)النكراء والشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل فهكذا مباحث تدخل في المباحث الإبستمولوجيّة».
إنّ منشأ الحقّ عند أغلب مفكّري الغرب هي العقود الاجتماعيّة، وذهب أكثرهم إلى أنّ تكوين المجتمع يبتني على العقود الاجتماعيّة، وتتكوّن حقوق الإنسان جميعها على أساس هذه القوانين. لذا، لا يوجد شكّ [عندهم] بلزوم ابتناء حقوق الإنسان على العقود الاجتماعيّة هذه، ولا حاجة إلى البحث عن منشأ آخر. وذهبوا إلى أنّ الحقوق لا واقعيّة لها بمعزل عن المجتمع، وعندما يتشكّل المجتمع الإنسانيّ مع ما فيه من تدوين القوانين والعقود الاجتماعيّة، تنتزع حقوق الإنسان من تلك القوانين والعقود الاجتماعيّة، والمراد من العقود الاجتماعيّة ما يدوّنه الحكّام أو القوى المقنّنة من مجموعة قوانين وأحكام، كما يصرّح بذلك أحد مفكّري الغرب أي توماس هابز (1588 - 1679) من انّ جميع الحقوق تنشأ من الحاكم ولا توجد حقوق إلهيّة أو طبيعيّة، الوضع الطبيعيّ للإنسان هو الحرب إذ البشر يتعامل بشكل عشوائيّ ولا بدّ من وجود حاكم مطلق لمراقبته .
فاستيفاء الحقوق إنّما يتأتّى بواسطة العقود الاجتماعيّة التي يضعها الحكّام أو الحقوقيّين. وعلى فرض صحّة هذا المدّعى، فالسؤال المطروح: إنّ حقوق الإنسان هل يمكن تأمين جميعها عن طريق العقود الاجتماعيّة؟، وهل تشتمل هذه العقود على جامعيّة كافية؟ جواب هذه الأسئلة إيجابيّة عند أصحاب العقود الاجتماعيّة؛ لأنّ الحقّ عندهم ميزة يمنحها القانون للإنسان .
هذه الرؤية لا تتوافق مع المباني الإسلاميّة؛ لأنّ حقيقة الإنسان مسبوقة بما وراء الطبيعة وملحوقة به، أي إنّ للإنسان عدا جانبه الجسدي والمادّي، روحا أصيلة ومجرّدة لم تكن من التراب ولا تعود إلى التراب، وتصنع العقائد والأخلاق والأحكام والحقوق هويّته الكاملة، ولا بدّ أن تعتمد جميع قوانينه على أصول الخلقة الأوّليّة، وتعود إلى مرجعه النهائيّ بعد الموت.
وعليه، فإنّ جميع أوامره ونواهيه الحقوقيّة والتشريعيّة تبتني على الوجود والعدم التكوينيّ، بحيث إنّ تلك الحقائق التكوينيّة لو تجلّت على شكل التشريع مثلًا، لتبلورت على شاكلة المواد الحقوقيّة، ولو تجلّت هذه المواد الحقوقيّة والتشريعيّة على شكل التكوين، لكانت على شاكلة تلك الحقائق التكوينيّة، فباطن هذه القوانين وملكوتها حقائق، وظاهرها حقوق، بحيث إنّ التكوين والتشريع، الحقيقة والحقوق، الملكوت والملك، الظاهر والباطن وجهان لعملة واحدة. ومنطقة الفراغ التي هي موارد الإباحة، التخيير العقليّ، أضلاع الواجب النقليّ ونحوها، تعتمد على منطقة تكوينيّة حرّة ومفتوحة، وبحسب سعتها يحصل اتّساع في الحكم التشريعيّ.
ذهب بعض مفكّري الوحي والنبوّة إلى أنّ العقل البشريّ يكفي لهداية الإنسان وسعادته ولا حاجة إلى الوحي، فالعقل يلبّي جميع حوائج الإنسان، ومع وجوده يكون التمسّك بأيّ أداة أُخرى للوصول إلى السعادة عبثا وغير مفيد. هذه الرؤية التي نُسبت في الكتب الكلاميّة الشيعيّة إلى براهمة الهند، طرحت منذ فترة قديمة وتمّت الإجابة عليها في الكتب الكلاميّة، ولكن اليوم فقد تمسّك بعض أتباع المدارس الجديدة في الغرب بهذه الرؤية وروّجوا لها، وزعموا أنّ منشور حقوق الإنسان أكمل نظام
(129)حقوقيّ يضمن هداية الإنسان وسعادته. إنّهم يرون أن لا حاجة إلى بعثة الأنبياء، ولا يوجد دليل على حاجة الإنسان إلى الوحي والنبوّة؛ لأنّ ما جاء به الأنبياء إذا كان موافقًا مع العقل فلا حاجة للعقلاء إليه، ولا فائدة في التمسّك بالوحي، وإذا كان مخالفًا للعقل فلا فائدة في التمسّك به ولم يكن نافعًا .
وقد تمسّك بعض المسلمين والمسيحيّين في الظاهر بهذه الفكرة وروّجوا لها. فعند المسلمين ذهب من سلك في مسألة الحسن والقبح العقليّ طريق الإفراط، الى كفاية الأحكام الحقوقيّة المدوّنة من قبل الحكماء وأصحاب العقول الراقية، وأولى بعض المسيحيّين من قبيل غروسيوس (Grotius 1583-1645) الحقوقي الهولندي المعروف ، والمؤلف لكتاب (حقوق الحرب والصلح) المعروف بالمؤسس للحقوق الدولية في الغرب ، وكذلك بوفندرف (pufendorf) الالماني وديكارت (Descartes) الفرنسي ، أولوا أهمية قصوى للعقل ، وزعموا ان الحقوق الطبيعية تنتج من العقل البشري .
وحاصل كلام أصحاب النزعة العقليّة: إنّ العقل هو المنشأ الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لحقوق الإنسان وتكاليفه، وهو المصدر المؤثّر لتنظيم الأمور الفرديّة والاجتماعيّة، والإنسان مع وجود هكذا مصدر وثيق، لا حاجة له بالاستقاء من ينبوع آخر لتأمين حقوقه.
وقد اتّضح بطلان هذه العقيدة عند بيان الرؤية الإسلاميّة، ولكن مع هذا فالجواب الإجماليّ لهذه الشبهة إنّ إدراك العقل العميق وإن أمكنه أن