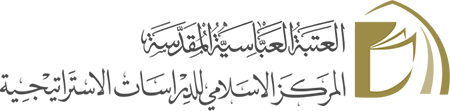
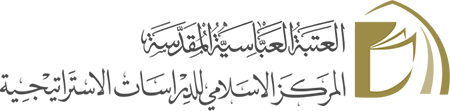
ما وراء نظريّة المعرفة (البارادايم) بين الأسطورة والحقيقة
تأليف: د. محمد حسين زاده
تعریب: د. محمّد علي إسماعیلي
(1)بسم الله الرحمن الرحيم
(2)مقدّمة المركز5
مقدّمة المؤلِّف7
الفصل الأوّل
البارادایم: التحليل الدلالي، الأصل والتقويم11
الفصل الثاني
البارادايم أو الأساس: إمكانه وأنواعه ودوره في المعرفة71
الفصل الثالث
الأسس المعرفيّة لمنهج البحث
من وجهة النظر المختارة ونتائج المناهج المستمدَّة منها111
قائمة المصادر والمراجع180
حسين زاده، محمد، 1381 هجري - مؤلف.
ما وراء نظرية المعرفة : البارادايم بين الاسطورة والحقيقة / تأليف محمد حسين زاده : تعريب د. محمد علي اسماعيلي. - الطبعة الاولى - النجف العراق : العتبة العباسية المقدسة، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية 2025.
186 صفحة : 20x12 سم. (سلسلة مصطلحات معاصرة : 47)
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة 180-186.
النص باللغة العربية مترجم من اللغة الفارسية.
ISBN: 9789922680446
1-البارادايم(نظريةالمعرفة).2.المعرفة--نظريات. أ. اسماعيلي، محمد علي، مترجم. ب. العنوان.
LCC: BD225.H87 2025
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
الفهرسة أثناء النشر
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (616) لسنة (2025م)
ـ الكتاب: ما وراء نظرية المعرفة؛ البارادايم؛ بين الأسطورة والحقيقة.
ـ تأليف: د. محمد حسين زاده.
ـ تعريب: د. محمد علي إسماعيلي.
ـ الناشر: العتبة العبَّاسيّّة المقدَّسة، المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة.
ـ الطبعة: الأولى 2025م - 1446هـ.
Website: www.iicss.iq
E-Mail: islamic.css@gmail.com
Telegram: @iicss
(4)تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة في سياق منظومة معرفيّة يعكف المركز على تظهيرها، وتهدف إلى بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ولمّا تزل مرتكزاتٍ أساسيّةً في فضاء التفكير المعاصر.
وسعيًا إلى تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة المشرفة خارطةً شاملةً للعناية بالمصطلحات والمفاهيم الأكثر حضورًا وتداولًا وتأثيرًا في العلوم الإنسانيّة؛ ولا سيّما في حقول الفلسفة، وعلم الاجتماع، والفكر السياسي، وفلسفة الدين، والاقتصاد، وتاريخ الحضارات.
أمّا الغاية من هذا المشروع المعرفي، فيمكن إجمالها بالآتي:
أوّلًا: الوعي بالمفاهيم وأهميّتها المركزيّة في تشكيل المعارف والعلوم الإنسانيّة وتنميتها وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتالي التعامل معها كضرورةٍ للتواصل مع عالم الأفكار، والتعرُّف على النظريّات والمناهج التي تتشكّل منها الأنظمة الفكريّة المختلفة.
ثانيًا: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي غالبًا ما تُستعمل في غير موضعها، أو يجري تفسيرها على خلاف المراد منها؛ لا سيّما وأنّ كثيرًا من الإشكاليّات المعرفيّة ناتجة عن اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقيّة.
ثالثًا: بيان حقيقة ما يؤدّيه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام الحضاري بين الشرق والغرب، وما يترتّب على هذا التوظيف من آثارٍ
(5)سلبيّةٍ بفعل العولمة الثقافيّة والقيميّة التي تتعرَّض لها المجتمعات العربية والإسلاميّة، وخصوصًا في الحقبة المعاصرة.
رابعًا: رفد المعاهد الجامعيّة ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكريّة بعملٍ موسوعيٍ جديدٍ يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته الاصطلاحيّة، ومجال استخداماته العلميّة، فضلًا عن صِلاته وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى.
وانطلاقًا من البعد العلمي والمنهجي والتحكيمي لهذا المشروع، فقد حرص المركز على أن يشارك في إنجازه نخبةٌ من كبار الأكاديميّين والباحثين والمفكّرين من العالمين العربي والإسلامي.
* * *
نواجه في ماوراء نظریّة المعرفة، والتي تمثّل مقدّمة لنظريّة المعرفة، العديدَ من القضايا المنهجيّة المتعلّقة بالبحث في مجال القضايا المعرفيّة، ومن أهم تلك المواضيع الرئیسة المنهجيّة التي لها علاقةٌ وثيقةٌ بنظريّة المعرفة، تلك المسائل المطروحة أو التي يمكن أن تُثار حول البارادایم. هل البارادایم أسطورة أم حقيقة؟ وهل للبارادایمات دورٌ في البحث وطریقة البحث والمعرفة والحصول علی الواقع؟ وهل یمکن البحث دون تحقيق البارادایمات والفرضیّات الذهنيّة، سواء في مجال العلوم الطبيعيّة أو العلوم الإنسانيّة، وحتى البحث في القضايا المعرفيّة؟ وهل يمكن تنظيم بحثٍ دونها؟
والحمد لله رب العالمين
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة
(6)باسم الخالق الحكيم والربّ العليم، وله الحمد والشكر، وخیر الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء الإلهيين محمّد وآله الخلفاء المعصومین، لا سیّما خاتم الأوصياء بقيّة الله الأعظم روحي لتراب مقدمه الفداء.
نواجه في ماوراء نظریّة المعرفة، والتي تمثّل مقدمة لنظريّة المعرفة، العديدَ من القضايا المنهجيّة المتعلّقة بالبحث في مجال القضايا المعرفيّة، ومن أهم تلك المواضيع الرئیسة المنهجيّة التي لها علاقةٌ وثيقةٌ بنظريّة المعرفة، تلك المسائل المطروحة أو التي يمكن أن تثار حول البارادایم. هل البارادایم أسطورة أم حقيقة؟ وهل للبارادایمات دورٌ في البحث وطریقة البحث والمعرفة والحصول علی الواقع؟ وهل یمکن البحث دون تحقيق البارادایمات والفرضيّات الذهنيّة، سواء في مجال العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية، وحتى البحث في القضايا المعرفية؟ وهل يمكن تنظيم بحثٍ دونها؟ وأساسًا، ما هو معنى البارادایم؟ و...
إن أصبحت مفردة (البارادایم) محطّ الاهتمام في النصف الثاني من القرن العشرين في فلسفة العلم، وذلك مع نشر كتاب (بنية الثورات العلميّة) وهو من أعمال توماس كُون، ولم يستغرق نقلُها السریع إلى غيرها من مجالات المعرفة الإنسانية وقتًا طويلًا، ودارت على الألسنة في مجالات مثل فلسفة الدين، والفلسفة، ونظریّة المعرفة، والمنهجية، و...
(7)على الرغم من شيوع استخدام كلمة البارادايم، إلّا أنّ استعمالها يشوبه الكثير من الغموض والإبهام، وليس من الواضح ما إذا كان المؤلّفون يقصدون بهذه الكلمة المبادئَ الکلیة والعامّة أم النموذج والمثال. وبالإضافة إلى ذلك، فحتّى لو كان المقصود بالبارادایم في الكتب أو المقالات هو المعنى الأوّل، بناءً على بعض الأدلة والقرائن، ولکن مع ذلك ليس من الواضح أن المقصود هو البنية العقليّة أم الأساس؛ ولذلك فإنّنا نستعمل في الفصل الأوّل من هذا الکتاب، وقبل البحث في الأسئلة المذكورة أعلاه، على محاولة إيجاد حلّ لها؛ لذا سوف نقوم بتحليل دلالات كلمة (البارادایم)، وسنرى ما هو المعنى المقصود من هذه الكلمة الجديدة نسبيًّا، وما هو أصل ذلك المعنى أو المصطلح.
وفيما يلي، سوف نصل إلى نتيجةٍ مفادُها أن جذور البارادایم بمعنى الإطار العقلي، تمتدّ إلی وجهة نظر فيتغنشتاين وتنشأ من فلسفته اللاحقة، وقد واجه هذا الرأي الكثير من الإشكالات والنقد؛ ولذلك فإنّ الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى فيتغنشتاين تشمل أيضًا جميع مؤيّدي البارادایم بمعنى الأطر العقلیّة.
ونستكشف في الفصل الثاني التمييزَ بين الإطار العقلي والأساس، ونبحث في إمكانيّة قبول البارادایمات بمعنى الأسس، ونبحث في مسألة تحدید الدور الذي تلعبه الأسسُ في المعرفة وتحقيق الواقع. وقد توصّلنا إلى نتيجةٍ مفادها أن البارادایم بمعنى (أساس الفكر) أمر حتميٌّ. ونجد علی ضوء الاستقراء أن كل مجموعة تتضمّن ما لا يقلّ عن ستّة فئات من الأسس، بینما أهمّها وأساسها هي الأسس المعرفيّة.
(8)وفي الفصل الثالث، وبعد التعرّف على حتميّة البارادایم بمعنى (أساس الفكر)، وبعد بيان الدور الذي لا يمكن إنكاره للأسس وخاصّة الأسس المعرفيّة في تنظيم البحث ومناهجه، فإنّنا نستكشف وندرس القضايا التالية: أوّلًا: ما هي الأسس المعرفية لمنهج البحث من وجهة نظر المنهج المختار؟ ثانيًا: ما هي طريقة أو طرق البحث التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الأسس؟ وهكذا نلقي في البداية نظرةً سريعة على أهم الأسس المعرفيّة لمنهج البحث من منظور المنهج المختار؛ أعني تلك المبادئ أو الأسس المعرفيّة التي هي نتيجة مجموعة أعمال وأبحاث المؤلف على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهي خلاصة منها. ثم نجيب على سؤالٍ مفاده أنّه ما هو طریق أو طرق البحث التي یمکن استنتاجها من المبادئ أو الأسس المعرفيّة المختارة؟
وأشعر في هذا الموقف، أنه من الضروري أن أعرب عن امتناني للمعلِّم الکبیر والحكيم حضرة آية الله مصباح اليزدي، الذي كنت دائمًا مدينًا له بلطفه وتوجيهاته. وأتوجّه بالشكر أيضًا إلى إخواني الأفاضل والعلماء الأستاذ عبد الرسول عبوديت وحجّة الإسلام والمسلمين الدكتور أحمد أبو ترابي اللّذين قَرَآ هذا الکتاب وذكّروني بنقاط مفيدة، كما أشكر كلّ من ساعدني في هذا الطريق. وأخص بالشكر المعاون المحترم لقسم الأبحاث في معهد الإمام الخمیني للتعلیم والبحث، والمدیر المحترم لقسم تحریر النصوص، وموظفي هذه الإدارة، المسؤولين في قسم النشر ورئیس قسم التحریر سماحة علي رضا تاجيك، الذي قام بتحرير هذا النص بدقّةٍ مثيرةٍ للإعجاب.
محمّد حسین زاده
1395/09/02هـ.ش
(9)لا بدّ قبل دراسة القضايا المعرفيّة من معالجة العديدَ من القضايا المنهجية في ماوراء نظریة المعرفة. إن من أهم تلك المواضيع الرئیسیة المنهجية التي لها علاقةٌ وثيقةٌ بنظريّة المعرفة، التعرُّف على دور البارادایمات في البحث وعلاقتها بطریقة البحث والمعرفة وتحقيق الواقع. وهل یمکن البحث دون تحقيق البارادایمات والفرضيّات الذهنيّة، سواء أكان في مجال العلوم الطبيعيّة أم العلوم الإنسانيّة، وحتى البحث في القضايا المعرفيّة؟ وهل يمكن تنظيم بحثٍ دونها؟ وإذا لم يمكن ذلك، فلماذا لا يكون البحث ممكنًا دونها؟ وإذا كان من الضروري استخدام الفرضیّات لإجراء البحوث، فما هي تلك الفرضیّات؟ وکیف هي؟ وما هو دورها؟ وهل لها دورٌ تمهیديٌّ في البحث؟ وبکلمة أكثر دقّة: هل لها دورٌ أَدَويٌّ أم دورٌ بنیويٌّ؟ هل هناك تفوّقٌ لبارادایمٍ علی بارادایماتٍ أخری، وبالتالي يمكن تفضيله على البارادایمات الأخرى على ضوء هذا التفوّق؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فأيٌّ منها لديه أفضلية وأيّ البارادایمات أنقص من الأخری وفيها نقائص أكثر؟ وعلى افتراض تفضيل بارادایمٍ على بارادایمٍ آخر، فما هو معيار تفضيله على الآخر؟ وهل من الممكن تجاوز البارادایم والتفكير بحريّةٍ خارجَه؟ وهل
(13)المعرفة التي يتمّ الحصول عليها بهذه الطريقة صحيحةٌ ولها قیمةٌ؟ وهل الجمع بين البارادایمات منطقي؟ وهل يمكن الحصول على بارادایماتٍ مختلطةٍ من خلال مزجها؟
ومن ناحية أخرى، یمکن عند تقويم البارادایمات وفحصها أن نستنتج أن كل شخص يفهم العالَم بلغته وفهمه الخاص، ولا توجد لغةٌ وفهمٌ مشترك بين البشر؛ ولهذا السبب لا يمكن تفضيل رأي على آخر. أليس هذا الموقف موقف من یعتبر الإنسان وحیدًا؟
بالإضافة إلى ذلك، وانطلاقًا من فرضية وجود البارادایم وضرورة وجوده، هل يجب علی الفكر الإنساني أن يعتمد على بارادایمٍ واحد أم على عدّة بارادایماتٍ؟ وهل يجب أن یفكّر فرديًّا أم جماعيًّا؟
کما أنّه يوجد أمام هذا البحث الكثيرُ من البارادایمات والمناهج المختلفة، ألا يدلّ هذا التعدّد في مجال البارادایمات والمناهج على ارتباك الفکر الإنساني وفشله واكتئابه؟ وألا يدفعنا هذا إلى الشكّ في الواقع؟ ومن ناحية أخرى، لماذا يجب أن نشك في الواقع ولا نشكّ في قدرتنا؟ ألا يدفعنا هذا التعدّد في مجال البارادایمات إلى الشكّ في قدراتنا المعرفيّة؟ وأنّ لدينا غشاوة على أعيننا؟
قبل البحث في هذه الأسئلة وإيجاد حلٍّ لها، لا بدّ من استكشاف كلمة (البارادایم) ومعانيها اللغویّة والاصطلاحيّة وتحدید المعنى المقصود من هذه الكلمة الناشئة نسبيًّا، فهل المقصود منها هو المُنتَج المُسبَق أو المعلوم المُسبَق، أو الإطار العقلي أو الأساس؟
(14)وأخيرًا، ما هو أصل ذلك المعنى أو المصطلح؟ ولذلك فقد خُصّص الفصل الحالي لاستكشاف التحليل الدلالي للبارادایم وتحدید أصله وتقويمه.
تحدید معنی البارادایم
إن کلمة (paradigm) مشتقةٌ من الكلمة اليونانية (paradigma) والتي تعني المثال والنموذج والقُدوة أو الأطروحة. ولا يختلف استخدامها في الفلسفة المعاصرة عن معناها اللغوي، ففي الفلسفة المعاصرة يُستخدم المثال لأجل التحليل أو النقد. ومثل هذا التطبيق لا يتعارض مع المعنى اللغوي لهذه الكلمة، بل هو أحد مصادیق ذلك المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي لهذه الكلمة هو النموذج أو المثال أو القدوة.
وبالإضافة إلى المعنى اللغوي، فإن للكلمة المذكورة استخدمین اصطلاحيَّین في الفلسفة:
1.استخدمه أفلاطونُ للإشارة إلى المُثُل (ideas or forms) من حیث إنها علائم تشیر إلی العالَم الخارجي؛
(15)2. وقد أطلقه توماس كُون على الأسس التي تُبنی عليها النظرياتُ العلميّة. وهو یری أن النظريّات العلمية تقوم على بارادایمات أساسية، وأن أيّ تغييرٍ في النظريات يتطلّب تغيير البارادایمات والحصول علی بارادایماتٍ جديدةٍ.
وبالطبع، فإنّ للكلمة المذكورة تطبيقًا اصطلاحيًّا في علم اللسانیّات أيضًا، وبناءً عليه فهي تعني الصيغ الصرفية.
أصبح مصطلح (البارادایم) محط الاهتمام في النصف الثاني من القرن العشرين في فلسفة العلم، وقد استخدمه توماس كُون في کتابه المشهور (بنية الثورات العلمية). وبعد ذلك، تم استخدام البارادایم في فلسفة العلم على نطاق واسع، ولم يستغرق وقتًا طويلًا نقلُها السریع إلى غيرها من مجالات المعرفة الإنسانيّة ووقعت على
(16)الألسنة في مجالات مثل فلسفة الدين، والفلسفة ونظریة المعرفة، والمنهجيّة، و...
یکتنف استخدام كلمة البارادایم في العلوم المختلفة وحتى في العلم الواحد من الغموض والإبهام غالبًا. وليس من الواضح أن ما يقصده المؤلف بهذه الكلمة هو النموذج والقدوة أو الأطر العقلية أو الأساس أو غیرها؛ ولذلك فإن استخدام البارادایم في كتاب (بنية الثورات العلمية) كان نقطة انطلاقٍ لنقد توماس كُون. وقد ادّعى مَستِرمَن وهو أحد منتقديه، أن توماس كُون استخدم البارادایم في كتاب بنية الثورات العلمية في 22 بمعنى مختلفٍ ومتميّزٍ.
وأخيرًا، أصبحت انتقادات النُقّاد فعّالة ومؤثِّرة، واستخدم توماس كُون كلمتي (matrix) و(exemplar) بدلاً من كلمة (paradigm). ومن وجهة نظره فإنّ الكلمتين الأخيرتين تحملان المعنيين نفسهما اللّذين قصدهما بالبارادایم.
توضیح ذلك أن توماس كُون واجه انتقادات كثيرة بعد نشر كتاب
(17)(بنية الثورات العلميّة). وقد أدرك أنّه يجب عليه توضيح البارادايم، وذلك عن طريق المادّة تقويم الانتقادات ومراجعتها؛ لأنّه رأی أنّ ثمّة بعض الصعوبات وسوء الفهم حصل من هذه الناحیة، وتوصَّل إلى أن البارادایم لا يُستخدم في الكتاب المذكور في أغلب الأحوال إلّا بمعنيين مختلفين، وذلك کالتالي:
ويتّضح من كلام كُون في التعلیقات أن المعنى الأول يمكن اعتباره معنی اجتماعيًّا، والمعنى الثاني، أي المثال والقدوة، يمكن اعتباره معنی فلسفيًّا. أمّا الخلافات وسوء الفهم التي أثارها كتاب (بنية الثورات العلميّة)، فإنها جاءت من المعنى الثاني.
وعلى أيّ حالٍ، بسبب هذه الصعوبات وسوء الفهم في فهم مصطلح البارادایم وجد كون أنّه من الراجح أن یستخدم مصطلح (مصفوفة
(18)السلسلة) بدلًا من ذلك. یشیر وصفُ المصفوفة بالسلسلة إلی الانتماء المشترك بين المتدربين في مجال خاص، کما أنّ المصفوفة أو الجهاز یشیر إلی أنه يتكوّن من عناصر منتظمة من أنواع مختلفة، كل منها يتطلّب وصفًا أكثر تفصيلًا.
یتکوّن المعنى الأوّل للبارادایم والكلمة البديلة له (مصفوفة السلسلة) من ستة مكوّنات من وجهة نظر كون، وهي:
1. المعادلات أو العلامات والتمثيلات الرمزيّة.
2. الأدوات.
3. معايير الصحة وإمكانية التكرّر التجريبي.
4. الفرضيّات الميتافيزيقيّة.
5. نطاق البحث.
6. الأمثلة والنماذج.
(19)المثال أو النموذج (exemplar) هو معنى آخر للبارادایم. یری توماس كُون أنه لا يمكن إنكار دور المثال والنموذج في البحث؛ ولذلك فإنّ من أهم عوامل تركيزه على النموذج أو المثال هو أن النماذج والأمثلة تعطي توجيهًا للبحث وتوجب تنظيمه.
نجد في بعض الأحيان أنه يتم تفسير جذور بعض الغموض في كتاب بنية الثورات العلميّة على النحو التالي: إن النموذج والمثال يمثّل أحد معاني البارادایم، لكنّه في الوقت نفسه يعدّ أحد مكوّنات المعنى الأوّل للبارادایم، وهو في الحقيقة مكوّنه السادس.
وعلى أيّة حالٍ، إذا استبدلنا المعنى الأوّل للبارادایم بمصطلح (مصفوفة السلسلة)، ومعناه الثاني بمصطلح المثال والنموذج (exemplar)، فهل سيقلّ الغموض وتزول الاعتراضات وتنتهي الانتقادات؟
البارادایم: الإطار أم الأساس؟
تم استخدام البارادایم في عدد كبير من الكتابات بعد توماس كُون. وتوجد العديد من المقالات التي تُعتبر هذه الكلمة جزءًا من موضوعها. ولا يقتصر استخدام البارادایم على فلسفة العلوم التجريبيّة التي تشكّل أصله الأساسي، بل استُخدم في كثير من العلوم، مثل فلسفة العلوم الاجتماعية، وفلسفة العلوم الإنسانية،
وفلسفة الدين، والإدارة، والعلوم السياسیة، وعلم الاجتماع، وما إلى ذلك...
والمهم في هذه الاستخدامات هو أن معنى هذه الكلمة يحيط به کثیرٌ من الغموض. وفي كثير من الأحيان، ليس من الواضح تحدید معناه؛ هل يعني المثال والنموذج والقدوة؟ أو بمعنى الإطار العقلي أو الأساس؟ ومن الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأساس والإطار العقلي. فإن الإطار العقلي یشیر إلی أنّ ثمّة أُطُرًا تحكم وتهيمن على العقل والفكر، والتي لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن للمرء أن يفكّر بحريةٍ دونها. بل الإنسان محاصَر بقيودها، ولا معنی للفكر دونها وبمعزل عنها. والإنسان ملزم بها، سواء أراد ذلك أم لا، ولا يستطيع اتخاذ قرارٍ دونها. ولقد اختار هذه النظریةَ النظامُ المعرفي لكانط وما بعد كانط والعديد من المدارس الأوروبيّة التي استلهمت من كانط، مثل الهرمنوطیقیا الفلسفيّة والبنيويّة. ویستحیل من وجهة نظرهم، التحرّرُ من الإطار والذهاب خطوة إلى الأمام. ولا يمكن التفكير إلّا ضمن حدوده وبناءً على قواعده. إنّ ذاتيّةكانط، وتليها ذاتيّة فيتجنشتاين، توصّلتا إلى مثل هذه النتيجة؛ وهي النتيجة
التي يصرّح بها فيتجنشتاين وأتباعه ويؤکّدون علیها. ولا بدّ هنا من تحليل مثل هذا الاستخدام وتقويمه معرفيًّا.
البارادایم کأساسٍ
یمکن أن يكون المعنى الآخر أو الاستخدام الآخر للبارادایم هو الأساس من دون الإطار العقلي. وبما أنّ هناك علاقات سببيّة ومنطقيّة بين بعض القضايا، فإن بعض القضايا قد تكون أسسًا لقضايا أخرى، وهي تعدّ البناء الفوقي لتلك القضايا. وهذه العلاقة هي علاقة وحدانیةٌ ولیست من الطرفین، فإنّ القضایا الفوقيّة مبنيّةٌ على القضایا التحتیّة الأساسيّة، وليس العكس.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يمكن استنتاج أيّ نتيجةٍ من أيّ قضیةٍ، ولا يمكن التوصّل إلى أيّ نتيجةٍ من خلال أيّ قضیةٍ؛ بل إن بعض القضایا فقط لها عواقب ونتائج خاصة. فعلی سبیل المثال: إذا تمّ قبول المبادئ والأسس المعرفيّة للتجريبيّة والاعتماد عليها، فإنّ هناك نتائج ستُبنى عليها ولا تقوم على غيرها من المبادئ والأسس. کما أن الأسس المعرفيّة والأنثروبولوجيّة والأنطولوجیّة للحكمة الإسلاميّة لها نتائج لا يمكن أن نتوصّل إليها عن طريق المعرفة الفيزيائيّة والتجريبيّة وما إلى ذلك. ومثل هذه الظاهرة تختلف عن أسطورة الإطار. فإنّه وفقًا للإطار، یکون الذهن مقيّدًا ومحصورًا بالفرضيّات المسبقة، ولا يستطيع الهروب منها؛ لكن وفقًا للأساس، فإنّ الذهن لیس محصورًا بأيّ فرضيّة وإطارٍ مسبقٍ، وإنّما یحصره إطار القضایا ولیس إطار الذهن. وهناك فرقٌ كبيرٌ بين هذين:
(22)المحصوریّة بالإطار العقلي والمحصوریة بإطار القضایا. فإنّ وجهة النظر الثانية هي الواقعيّة ووجهة النظر الأولى هي النسبيّة. ووفقًا لوجهة النظر الثانية، فمن الممكن تجاوز قضیّةٍ وتقويم الخيارات الأخرى، لكن وفقاً لوجهة النظر الأولى فإنّ مثل هذا الأمر غير ممكن. وعلی ضوء ذلك فإن النتيجة الواضحة للتمييز بين هذين المصطلحين هي أنه بناءً على مصطلح البارادایم بمعنى الأساس، يمكن الاختيار بين الأسس واختيار الأسس التي تتوافق مع الواقع، على ضوء المعايير الصحیحة والحقة. ولكن انطلاقًا من مصطلح البارادایم بمعنى الإطار العقلي، فإنّه لا يمكن اختيار أساسٍ وتفضيل وجهة نظرٍ واحدةٍ على وجهات النظر الأخرى، وسيكون الإنسان مقيّدًا بإطاره الذهني الخاص ولا يستطيع الهروب من سياجها.
وعلى هذا، فإنّه انطلاقًا من استخدام البارادایم بمعنى الأساس، يمكن القول إنّه ممّا لا شكّ فيه أن النظريات في العلوم، وخاصّة العلوم الإنسانيّة، وحلولها تَقوم على مبادئ خاصّة، أهمّها الأسس المعرفيّة والأنطولوجيّة والأنثروبولوجيّة. وکل أساسٍ مقبولٍ في نظريّة المعرفة أو الأنطولوجيا أو الأنثروبولوجيا، فإنّ نتائجه تظهر في حلول ونظريات العلوم الإنسانيّة. وسنعود في الفصل التالي، إلى هذا الاستخدام أو المصطلح الأساسي ونناقشه بمزيدٍ من التفصيل.
ویتبیّن من خلال الأبحاث التي أجریناها، ومن خلال وجهة
النظر المختارة التي سنتبعها في بقيّة الفصل أیضًا، أنّ البارادایم بمعنى الإطار العقلي، يمثّل وجهة نظر مستحيلة وغير مقبولة. وأمّا البارادایم بمعنی تأسيس النظريّات على الأسس والمبادئ، فهو وجهة نظر مقبولة، بل لا يمكن إنكارها. ومن أجل تجنّب سوء الفهم، ينبغي أن نتجنّب استخدام كلمة البارادایم والعمل على استخدم المعنى المناسب في كل مجالٍ: فإذا كان المقصود هو الأساس، فلا بدّ أن نستخدم الأساس بدلًا من البارادایم، وإذا كان المقصود هو الإطار متأثّرًا بآراء كانط وما بعد الكانطيّة، فينبغي التصریحُ بهذا المعنی واستخدامُ کلمة الإطار. وأخيرًا، إذا كان المقصود هو النموذج والمثال والقدوة، فلا بدّ أن نستخدمه، وبالتالي لا بدّ من تجنّب استخدام الكلمات المبهمة أو المشترکات اللفظیّة مثل البارادایم، أو على الأقلّ، لا بدّ عند استعمال کلمة البارادایم ونحو ذلك من الكلمات من تحديد المعنى المقصود، أو استخدام قرینةٍ واضحةٍ لتوضيح المعنى المقصود؛ لأنه يؤدي إلى سوء الفهم والخطأ والمغالطة. فإنّ من المغالطات، بل من أصعبها، غموضُ معنى الكلمة المستخدمة، حتّى لو لم يرغب المؤلّف في ذلك، فإنّ استخدام الكلمات الغامضة وعدم توضيح معناها يؤدّي إلى المغالطة.
البارادایم وکتاب بنية الثورات العلميّة
إنّ تفسير البارادایم بالأسس المعرفية والـ الأنطولوجية وما شابهها، أو تفسير البارادایم بالأطر المعرفيّة والوجوديّة وما شابهها، أمرٌ
(24)محتملٌ في حد ذاته وممكنٌ، بل يمكن القول بأن مثل هذا التفسیر قد تحقّق؛ ولكن إسناده إلى كتاب (بنية الثورات العلميّة) ومن تأثّر به يبدو مشكوكًا فيه، ويستحق بحثًا مستفيضًا، إذ من المؤسف أنّ استخدامات البارادایم في الكتاب المذكور غامضة مبهمةٌ، ولم يعط المؤلّف معنى واضحًا لهذه الكلمة في نصّ الكتاب. ولكنه كما تقدّم سابقًا، فإنّ الملحق الذي كتبه المؤلّف بعد سنوات قليلة وألحقه بالكتاب، يتضمّن توضيحًا للمقصود من البارادایم في هذا الكتاب معنيين فقط: المعنى العامّ الذي يمثّل مزيجًا کاملًا من المعتقدات والقيم والتقنيّات وما شابه ذلك، والمعنى الخاصّ الذي يمكن أن يكون حلًّا لبقية ألغاز العلم. وفي هذه المرحلة استبدله بكلمة النموذج والمثال (exemplar). ويعترف المؤلّف في الملحق المذكور، والذي يشير فيه إلى أقوال النُقّاد، بأن معظم الإشكاليات التي أوردت علی وجهة نظره إنّما جاءت من استخدام كلمة البارادایم وغموضها. ولذلك يحاول في هذا القسم إزالة غموض هذه الكلمة وتوضيح معناها من استعمالاتها.
ويمكن الحصول على شرح واضح للاستخدام أو المصطلح الأوّل من تصريحاته في شرح تقدّم العلم. وبناء على تلك الأقوال يمكن تفسير البارادایم بهذه الطريقة ويمكن تحديد نطاقه وحدوده: «يتكوّن البارادایم من الفرضيّات النظريّة العامّة وقواعد وتقنيّات تطبيقها، والتي تَشملها أعضاء مجتمع علمي معيّن. والباحثون
داخل البارادایم منخرطون فيما يسمّيه توماس كُون العلم العادي، سواء أكان ذلك ميكانيكا نيوتنیّة، أو علم البصريّات الموجيّة، أو الكيمياء التحليليّة، أو أيّ شيء آخر».
وأخيرًا، استخدم كُون في ملحق كتاب بنية الثورات العلمية، مصطلح (مصفوفة السلسلة) بدلًا من مصطلح (البارادایم) العام. واعترف في ذلك الملحق بأنه يستخدم البارادایم -والذي هو الكلمة المفتاحية في هذا الکتاب- في معنيين: 1. مصفوفة السلسلة؛ 2. المثال أو النموذج. إن مصفوفة السلسلة هي إجابة على أسئلة مثل: «ما هو نوع الكائنات الموجودة في العالم؟ وكيف يتفاعلون مع بعضهم بعضًا ومع حواسنا؟ ما هي الأمور التي تعدّ کشواهد علی صدق نظریةٍ من النظریات؟ ما هي الأسئلة المركزية [في العلم]؟ ما هي الأمور التي تمثّل حلولًا للمشکلة؟ ما هو الذي يُعتبر تفسيرًا لظاهرة ما؟ وما شابه».
إنّ مثل هذا التفسير للبارادیم أو مصفوفة السلسلة، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه، يتضمّن تقنیّات وأساليب عمليّة أيضًا؛ ولذلك فإنّ مصفوفة السلسلة تتضمّن التقنیّات التي جَعلت العلماءَ قادرين على استخدام المعدات التقنيّة، ويمكنهم استخدام المعدات التقنيّة بمساعدتها؛ وهذه التقنیّات مثل القدرة على تغيير تكبير التلسكوب أو القدرة على بلورة الملح من خلال تفاعل كيميائي.
ومن الواضح أنه بناء على استخدام البارادایم في هذا المصطلح الذي أسماه توماس كُون مصفوفة السلسلة، فإنّه يقصد بالمبادئ العامة تلك المبادئ المقبولةَ في العلوم التجريبيّة وحتى المهارات التمكينية، دون المبادئ المعرفيّة، أو ما شابه ذلك، أو الأطر العقلیّة والمعرفيّة الشائعة بين الكثيرين الآن.
إنّ البارادایم بمعنى النموذج ليس له مثل هذا الاستخدام أیضًا. والبارادایم بهذا المعنى (النموذج) يقدّم نموذجًا مناسبًا لتعليم الباحثین. يلعب التدريس من خلال النماذج دورًا مهمًّا في التعليم. ويمكن للطلاب من خلال النماذج والأمثلة أن یتعلّموا كيفيّة استخدام تلك النماذج في الحالات الأخرى. فمثلًا فيزياء نيوتن هي مثالٌ أو نموذجٌ يتضمّن العديد من المبادئ، بما في ذلك تفضيل التفسيرات السببيّة والتنبّؤات الكمّية على النوعيّة والعامّة، وقوانين الحركة والجاذبية، والتقنيّات الرياضيّة التي تُستخدم لتطبيق القوانين المذكورة في حركات الكواكب والبندولات ونحوها. إن للبارادایم بمعنى النموذج العديد من الأمثلة الأخرى، بما في ذلك علم الفلك البطلمي، ونظريّة فلوجيستون حول الاحتراق، وعلم بصريات الجُسيمات، وتدفّق السوائل للكهرباء، الفيزياء النسبيّة، وفيزياء الكم (التي لها موجات كهرومغناطيسيّة ولها أحجامٌ منفصلة وليست متّصلة).
وعلى هذا، فإنّ استخدام النموذج من وجهة نظر توماس كُون إنّما هو لشرح ماهية العلم التجريبي والتعبير عن خصائصه. وکان فلاسفة العلم قبل كُون، على الرغم من اختلاف آرائهم الكثيرة، قد ذکروا بعض خصائص العلم التجريبي وأوضحوا ماهیة العلم التجريبي على النحو التالي:
1. العلم التجريبي يتقدّم دائمًا، ويبني علماء اليوم نظرياتهم على إنجازات علماء الأمس.
2. العلوم التجريبيّة قابلة للتحويل إلى الفيزياء. وحتّى قوانين البيولوجيا یتمّ تحویلها إلى الفيزياء من خلال قوانين الكيمياء. وعلی هذا تُشتقّ قوانين البيولوجيا من قوانين الكيمياء، وأخيراً تُشتق قوانين الكيمياء من قوانين الفيزياء؛ ولذلك فإنّ العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة يحكمها منهج واحد.
3. يختلف موقف الاكتشاف عن موقف التبرير والبرهان، وأحدهما لا یستلزم الآخر. إنّ مدى تقديم الملاحظات بوصفها دليلًا لصالح النظريّة المطروحة لا علاقة له بمن اقترح النظريّة ومتى اقترحها.
4. النظريّات العلميّة محايدة ومستقلّة عن مشاعر العلماء وآرائهم غير العلميّة. ومن ثَم، فمن الممكن تقويمها بشكل محايد، ويمكن
(28)للمرء أن يقوّمها دون الاهتمام بمصالحه الخاصّة.
5. ثمّة فرقٌ شاسعٌ بين معتقدات ونظريّات العلوم التجريبيّة وغيرها من المعتقدات والنظريات.
6. يمكن اختبار المعرفة والنظريّات العلميّة من خلال الملاحظة والتجارب العلميّة، وتُعتبر الملاحظة والاختبار، بالإضافة إلى قدرتهما على التقويم، محايدتین في هذا التقويم؛ ولهذا هناك تمييزٌ واضحٌ بين المفاهیم القابلة للملاحظة والمفاهیم النظريّة مثل الإلكترون و...، ونتيجة لذلك، ثمّة تمييزٌ واضحٌ بين القضایا القابلة للملاحظة والقضایا النظريّة التي تتکوّن من تلك المفاهیم.
7. للمفردات العلميّة معانٍ ثابتة.
اتّخذ توماس كُون موقفًا ضد وجهة النظر الشائعة المشهورة، وأنکر كلَّ الفوارق والخصائص المذكورة أعلاه. وقد استدل علی أن تاريخ العلم ليس تراكمًا للمعرفة، وأنّ التجارب والملاحظات العلميّة ليست محايدة، بل هي تحمل نظريّات. ولا يوجد منطق واحد لتقويم المعرفة والنظريّات العلميّة، بل إنّ آراء العلماء واهتماماتهم وقيمهم المقبولة لدیهم تلعب دورًا في التقويم والحكم. ولا توجد طريقة لجمع الملاحظات المحايدة والموضوعيّة. وفي نهاية المطاف، ليس للمفردات معنًى ثابتًا. وبذلك أنكر جميع السمات المذكورة أعلاه،
وأوضح بکل وضوحٍ أن العلم ليس استقرائيًّا ولا معقولًا.
يمكن من وجهة نظر توماس كُون، رسم تقدّم العلم هکذا كخطّةٍ لا نهاية لها: ما قبل العلم ← العلم العادي ← الأزمة ← الثورة ← العلم العادي الجديد ← الأزمة الجديدة.
أطلق توماس كُون على الجزء الأكبر من العلم اسمَ العلم العادي. والبارادایم بمعنی النموذج مقبولٌ وموسّعٌ في العلم العادي. وتتم في العلوم العادية، محاولةُ جمعِ الملاحظات المتوافقة مع البارادایم أو النموذج، وحلِّ المشكلات الجزئیّة مع هذا النموذج. ولا يتخلّی العلماء عادةً عن نظريّاتهم، بل يدافعون عنها قدر الإمكان، ولا يعتبرونها باطلة بمجرّد تعارض النموذج مع بعض الملاحظات والشواهد. یری العلماء أنّه إذا كان البارادایم أو النموذج ناجحًا وأمكن تفسير معظم الظواهر في مجاله، فسيتمّ حلّ أوجه القصور والنقائص باستخدام هذا البارادایم. وأمّا إذا ازدادت أوجه القصور والنقائص، بحیث لم یمکن رفعها، فحینئذ يتركون النموذج جانبًا. وحینئذ يتم التشكيك في النموذج، ويفكّر العلماء في تقديم نموذجٍ جديدٍ، وهنا تَحدث الأزمةُ؛ وبطبيعة الحال، نادرًا ما تَحدث الأزمات، وإنّما تحدث الأزمات عندما تَعيق أوجهُ القصور والنقائص كفاءة البارادایم في حل القضايا المهمّة أو إذا أوجبت الأزماتُ التشكيكَ
في المبادئ الأساسيّة للنموذج. وهذه هي الحالة التي تحدث فيها الثورة من خلال قبول نموذج جديدٍ. وعلی هذا الأساس، إنما تحدث الثورة بعد الأزمة، والثورة هي تغيير البارادایم أو النموذج. وعلى سبيل المثال، یری كُون أن استبدال نظريّة اللاهوب بنظريّة الأكسدة تعتبر ثورة. فإنّه وفقًا للنظريّة الأولى، تنطلق من الأشياء بسبب احتراقها مادةٌ تسمى الفلوجستون. وبحسب هذه النظريّة فإن وزن معظم الأشياء مثل الخشب يتناقص بعد حرقها؛ ولكن تم اكتشاف بعض الفلزات والمعادن التي يزداد وزنها أثناء الاحتراق، وكان التعرّف على هذه المعادن والفلزات بمثابة تشويه أو مخالفة للنظريّة المذكورة. ومع تزايد حالات المخالفات في التجارب، وقعت النظريّة المذكورة أخيرًا في أزمة، ثم اقترح لافازير نظريّة بديلة. ووفقًا للنظريّة الجديدة، فإن الاحتراق ليس فقدانًا للفلوجيستون بل اكتساب للأكسجين.
یری كُون أن العلم لا يمكن رؤيته من خلال نفس العلم، بل یجب رؤيته في سياقه التاريخي والاجتماعي. وکان يؤكّد على دور العوامل النفسيّة والاجتماعيّة عند مواجهة النموذج، وبالتالي علی قبوله أو رفضه. وتلعب أخلاقُ العلماء دورًا في مواقفهم، وذلك مثل
(31)المخاطرة والمجازفة أو التحفّظ، والعوامل الاقتصاديّة مثل كونهم على وشك التقاعد أو تعيينهم مؤخرًا بموجب عقدٍ، وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب القيم المقبولة دورًا أساسيًّا في قبول النموذج الجديد. یعتقد کُون أنه عند دراسة النماذج والنظريات العلمية لا ينبغي تجاهل هذه العوامل وتجاوزها ببساطة؛ إذ النظريات العلمية ليست مستقلة عن العلماء والتزاماتهم واهتماماتهم.
يعتقد توماس كُون أنه في العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة، تعتمد طريقة رؤية العالم على البارادایمات التي تُحيط بالعلماء. ولكل بارادایمٍ إطارٌ مفهوميٌّ محددٌ يرى العلماء من خلاله العالمَ. وإذا تغیّر البارادایم، فإنهم سيرون العالم بطريقة مختلفةٍ. وعلی هذا الأساس، فإن أتباع البارادایمات المتنافسة يعيشون في عوالم مختلفة. فعلى سبيل المثال: لوحظت التغيرات السماوية بعد طرح النظريّة الكوبرنيكية، وأمّا قبل ذلك وبسبب هيمنة البارادایم الأرسطي الذي کان یعتبره ثابتًا، فلم يتم ملاحظة أيّ تغيراتٍ؛ وأمّا بعد قبول النظريّة الكوبرنيكيّة فقد لاحظوا التغييرات.
لا يمكن من وجهة نظر كُون، إثبات تفوق بارادایم على آخر بالمنطق ومن خلال الاستدلال المنطقي (بما في ذلك القياس والتجربة والاستقراء). وهذا له أسباب عديدة، منها أنّ ثمّة عدّة عوامل تلعب دورًا في حكم العلماء. على سبيل المثال: قد يكون معيار العلم هو
البساطة، أو قد يكون هناك معيار آخر، وهو توافقه أو عدم توافقه مع التعاليم الدينية. والسبب الآخر لعدم إمكانيّة تفضيل بارادیمٍ على آخر من خلال المنطق والتفكير المنطقي هو أنّ البارادایم لا يتمّ تقويمه من حیث هو، بل يجري تقویمه من خلال الأسس التي يقوم عليها. تعتبر الحجج المنطقيّة ملزمة إذا تمّ قبول مقدّماتها. وبما أنّ أنصار البارادایمات المتنافسة والمتضاربة لا يقبلون مقدّمات بعضهم البعض، فإنّ حججهم لا تعمل.
ونتيجة لذلك، لا يوجد معيار واحد لتقويم البارادایمات ولا يمكن تفضيل بارادایمٍ على آخر. وإن الغرض من الحوار بين البارادایمات المتنافسة هو التشجيع والإقناع، وليس الإلزام بالقبول؛ وهذا هو معنى قول كُون: النماذج المتنافسة غير قابلة للقياس والاستدلال.
یظهر من خلال نظرةٍ سريعةٍ إلی ادعاءات كُون الأخيرة والتأمّل فيها أنّ ما يعنيه بالبارادایم أو المصفوفة الانضباطية والمبادئ العامة ليس مجرّد مبادئ مقبولة في المعرفة التجريبيّة ومهارات التمكين، بل يتجاوزها إلى الأطر العقلیّة والمعرفيّة والوجوديّة وما شابه ذلك. وهي وجهة نظر شائعة الآن بين العديد من الفلاسفة الأوروبيّين، وهذا ما فهم العديد من الشارحین والنقاد لآراء كُون أيضًا. ویتّضح من خلال الاستمرار في شرح وجهة نظره، وخاصّة علی ضوء أن كل ملاحظةٍ تحمل نظريّة، أنّه كان يقصد مثل هذا الموقف.
نجد من خلال التأمّل في تصريحات كُون، أنّه يشير في إثبات ادّعاءاته إلى أن كل ملاحظةٍ إنّما تحمل نظريّة وإلی عدم القابلية للاستدلال أيضًا. وتوضیح ذلك أنه عند الحديث عن البارادایم، أثيرت مسألة معرفيّة مهمّة في فلسفة العلم، وهو تقويم العلاقة بين الملاحظة والنظريّة وإعادة فحصها. ومن وجهة نظر العلماء التجريبيين وفلاسفة العلم منذ عصر فرانسيس بيكون وحتّى الآن، فإنّ المنهج العلمي يبدأ بالملاحظة. والملاحظات محايدة، وبعد الاختبار ننظّمها، وفي النهاية نصل إلى المبادئ التي تحكمها. ونتيجة لذلك، فإنّنا نَعرف حقائق العالم الطبيعي بهذه الطريقة ومن خلال النظريات العلميّة. وعلى الأقلّ هكذا نفهم العالم من خلال المفردات القابلة للملاحظة؛ حتّی إذا لم یکن الأمر کذلك من خلال المفردات النظريّة مثل الإلكترون والشحنة الكهربائية والجاذبيّة.
وفي هذا العصر تعرّضت الطريقةُ المذكورة لانتقادات عديدة؛ منها أنّ طريقة البحث في العلوم التجريبيّة لا يمكن أن تخلو تمامًا من الفرضيّات؛ لأنه عند ملاحظة العالَم قبل اختبار معرفتنا العلميّة وتنظيمها، نقسّم الظواهر إلى أنواع مختلفة. فعلى سبيل المثال: قمنا
(34)بتصنيف الظواهر إلى الحركة والأجرام السماوية، والمدّ والجزر، والفصول الأربعة. وعلی ضوء العلم الحديث فإنّ هذه الظواهر مترابطة؛ ويتحقّق المدّ والجزر من خلال حركة القمر، وتتولّد الفصول عبر حركة الأرض حول الشمس. وإنّ البحث في هذه الظواهر كظواهر منفصلة سوف يقودنا إلى الخطأ.
ذهب توماس كُون أمام منهج البحث المذكور إلى أبعد من ذلك، وأکّد علی أنّ الملاحظة تحمل النظریّة، وأن کل مفهومٍ فإنه یحمل نظریة من النظریات. ومن قَبله، اتّخذ کارل بوبر أيضًا مثل هذا الموقف، وأكّد على أنّ جميع ملاحظاتنا تحمل نظريّاتٍ، ولا يمكن فصل النظريّة عن الملاحظة. وبالتالي، رفضوا الملاحظة المحايدة. أشار بوبر في كتابه «منطق البحث العلمي» إلى أنّه حتّى قضیة: (هنا كوب ماء) غير قابلة للإثبات ولا يمكن التحقق منها وإثباتها عن طريق الملاحظة؛ لأنّ (الکوب) و(الماء) ألفاظٌ کلّیّةٌ لا علاقة لهما بأيّ ملاحظة، ومثل هذه الألفاظ الکلیة تشير إلى مجموعة من
الأشياء الحقيقيّة التي لها سلوك یشرِّع القانون.
على أيّة حالٍ، وفقًا لما ذکره هنسون، فإنّ (الرؤية) لا تعني الحصولَ على تجربة الرؤية فقط، بل هي طريقة بها يتم الحصول على تلك الخبرة من خلال الطريقة المذكورة. وبما أن التعبير لا ينفصل عن الرؤية، فقد تكون التجربة البصريّة لراصدَين مختلفة؛ حتّى عندما تكون الصور الموجودة على شبكيّة أعینهما متطابقة. وتوجد أمثلة مشهورة تثبت اعتماد الإدراك التجريبي على مفاهيمنا السابقة؛ مثل صورة البطة، فعند ما ننظر إلیها من الجانب الأيسر يظهر في الذهن رأس أرنب، ومن الجانب الأيمن رأس البطة.
المثال الآخر هو شكل المكعب، والمثال الثالث هو الصور الشعاعيّة. ويجب أن يتعلّم الأطباء كيفيّة ملاحظتها وتفسيرها. وتلعب معلوماتهم السابقة دورًا في كيفيّة رؤيتهم. ويمكنهم من
(36)خلال النظر إلى مثل هذه الصور، رؤية أشياء كثيرة لا يمكن للآخرين رؤيتها.
وبناءً على ذلك، يستنتج توماس كُون وآخرون علی ضوء الاستشهاد بمثل هذه الحالات، أن إدراك العلماء وملاحظاتهم وخبرتهم يعتمد إلی حدٍّ مّا على معتقداتهم ويتحمّل نظريّة مسبَقة. ومثل هذا الرأي يشكّك في موضوعيّة اختبار النظريّات العلميّة؛ لأنه إذا اختلطت الملاحظات بالنظريّة، فلا يمكن أن تكون الملاحظة شاهدة على إثبات إحدى النظريّات المتعارضة والمتنافسة. يمكن العثور على العديد من الحالات في تاريخ العلم تثبت أنّ الملاحظات الرصدية موجهة من خلال الفرضيّات المسبقة للملاحظین. ومن تلك الأمثلة البقعُ الشمسية. وبينما عَرَفها علماء الفلك الصينيون قديمًا، فإنّها لم تسجّل في علم الفلك الأوروبي حتّى خطة كوبرنيكوس؛ لأنّ الاعتقاد بثبات السماوات مَنَع العلماء من رصد البقع الشمسيّة حتّى ذلك العصر.
يعتقد كُون وتشيرتشلاند وآخرون مثلهما، أن الملاحظات نفسها تتحمّل النظريّة، وليس اللغة المستخدمة لوصفها، وفقًا لما ذکره تشيرتشلاند نحن نتعلّم من الآخرين أن ننظر إلى العالم كما يرونه هم. وبالتالي فإنّ الكلام يدور حول الإدراك والملاحظة نفسها، وليس اللّغة المستخدمة لوصف الملاحظة. بینما يعتقد جيري فودر، في مقابل هذا الرأي، أنّه يمكن الحصول علی المعتقدات
من خلال الحواس والملاحظات الحسّيّة؛ ولذلك فإنّ مجموعة من المعتقدات يتمّ الحصول عليها مباشرة من خلال الملاحظات الحسّيّة والحواس؛ كما أنّ فئة أخری من المعتقدات الأخرى ليست كذلك ويتمّ الحصول عليها عن طريق الاستدلال. وبناء على هذه النظریّة، فإنّ رصد نقطة مضيئة في السماء يتمّ تحقيقه من خلال التجربة الحسّيّة ولا يتطّلب التنظير، لكن كون تلك النقطة المضيئة كوكبًا فإنّه يتطلّب التنظير.
والحاصل أنّا نجد حالات كثيرة يعتمد فيها إدراك الإنسان وملاحظته الحسّيّة على مفاهيمه ومعتقداته العقليّة، وعلى العكس من ذلك توجد أدلّة أخرى ضدّ هذا الادّعاء ونجد أنّ ملاحظاتنا لا تختلط بالمفاهيم والمعتقدات. والوهم البصري لمولر- لایر دليلٌ على هذا القول:
نرى حتّى بعد القياس أنّ السطر الأوّل أطول من السطر الثاني. والتجربة المذكورة هي دليل على إثبات الادّعاء بأنّ تصوّراتنا
وملاحظاتنا الحسّيّة لا تختلط مع معتقداتنا ومفاهيمنا.
ومن الواضح أن هذا الادّعاء العام والشامل بأن (جميع الملاحظات مصحوبة بنظريّة) لا يمكن إثباته من خلال الاستشهاد بأمثلة قليلة فقط في تاريخ العلم. إنّ إثبات أنّ ما يتمّ ملاحظته واقعًا يعتمد على النظريّة التي اختارها المُدرك، ليس بأمر سهل؛ مع أنّ هذا الادّعاء توجد تّجاهه بعض موارد الخلاف والنقض أیضًا.
استخدم توماس كُون وفايراباند في فلسفة العلم مصطلحَ (عدم القابلية للمقارنة)، وهو مصطلح مأخوذٌ من الرياضيّات. وکانوا یعتقدون بناء على هذا المفهوم أنّه لا يمكن مقارنة النظريّات العلميّة مع بعضها، وبالتالي لا يمكن تفضیلُ إحداها على الأخرى واكتشافُ إیجابیّات وعيوب كل منها. وبالفعل، إذا قبلنا أنّ الملاحظات والأدلّة الحسّيّة مبنيّة على البارادایمات، فكيف يمكن مقارنة البارادایمات مع بعضها بطريقة معقولة؟ إنّ قبول الرأي القائل بأنّ جميع الملاحظات مصحوبة بالنظريّة، يتطلّب عدم إمكانية الحصول على عيوب البارادایمات وإيجابيّاتها من خلال المقارنة وعن طريق الاختبارات التجريبيّة.
ومن ناحية أخرى، یعتقد كُون أن المفردات العلمية تستمدّ معناها من البنية الكاملة للنظريّة. على سبيل المثال: للكتلة في نظريّة نيوتن معنى مختلف عن الكُتلة في نظريّة أينشتاين. ولا يمكن مقارنة هذين الأمرين ببعضهما لأنّ لكلّ واحد متطلّبات مختلفة عن الآخر، وإنّما یمکن المقارنة بینهما إذا کان لكلمة (الکتلة) المعنى نفسه في كليهما؛ لذلك یعتقد كُون أن المفردات العلميّة لا تحمل دائمًا معنى ثابتًا ودقيقًا. وعدم القابليّة للمقارنة لكلمة معناه أن عالَمنا يتكوّن من نظريّاتنا. ومع تغيّر البارادایمات، يتغير العالَم أيضًا. يعيش أنصار البارادایمات المتنافسة في عوالم مختلفة. وبالتالي فإنّ عالم أينشتاين يختلف بالمعنى الدقيق للكلمة عن عالم نيوتن، وهكذا.
یعتقد توماس كُون أنّ ما يُعتبر شاهدًا وعاملَ تفضيلٍ عند المقارنة يعتمد على اعتراف المجتمع العلمي. وأنّ التقدّم العلمي يأتي من أحكام الناس لا من الأدلة؛ ولذلك فإنّ التأیید التجريبي للفرضيّات ليس أكثر من خداعٍ. وبناء على هذه النظريّة، لا يمكن التحقّق من صحّة النظريّات العلميّة من خلال توافقها مع الواقع، بل یتحدّد صدقُها من خلال العوامل الاجتماعيّة. والصدق أمرٌ یرتبط بالإجماع. بمعنی أنّه إذا أجمع أعضاء مجتمع علمي معين، کالفيزيائيّین أو علماء الأحياء مثلًا، فحینئذ يتمّ الحصول على الصدق، ويمكن اعتبار النظريّة صادقة. والصدق مُحاط بإطار خاصّ، ولا يمكن بعد الخروج عن هذا الإطار تقويم النظريّات من حيث الصدق. إنّ
(40)مطابقة النظريّة للواقع والبحث عن حقيقتها في الطبيعة والاقتراب من الحقيقة أمرٌ وهميٌّ. لکن هذا الرأي يُفضي إلى نسبيّة واضحة؛ لأنّ صدق النظريّات العلميّة یرجع إلى أنّها مقبولة في المجتمع العلمي کعلماء الفيزياء أو علماء الأحياء مثلًا.
يؤدي عدم المقارنة هذا إلى التشكيك في مفهوم الصدق العلمي وحتى الواقع الموضوعي. لذلك، فمن وجهة نظرهم المعرفة العلميّة ليست نسبيّة فحسب، بل إن الواقع العلمي يتمّ بناؤه بطريقةٍ اجتماعيّةٍ أيضًا. ومن هنا يقولون أحيانًا: إنّ الفيزيائيّين يصنعون الإلكترونات في مختبراتهم، لا أنّ الإلكترون له وجودٌ خارجي. وإنّ الوضع الأنطولوجي للإلكترون يشبه الوضع الأنطولوجي للحزب السياسي؛ وهذا يعني أنّ هذه الأمور إنما هي موجودة لأنّ الناس يؤمنون بوجودها.
يمكن القول: إنّ الادّعاء بأنّ جميع المفاهيم والنظريّات العلميّة مصطنعة، وأنّ معيار صدق النظريّات العلميّة هو اعتقاد المجتمع العلمي وقبوله، هو ادّعاء مبالغٌ فيه وغير عقلاني. ولا يصحّ قبول أن كل النظريّات العلميّة تنشأ عن أهواء وأحكام مسبقة ونحو ذلك، وعلى الرغم من أنّ مثل هذا الأمر ممكن في بعض الحالات، إلّا أنّه من الصعب جدًّا تعميمه. يسعى الإنسان في عالَم العلوم التجريبيّة
(41)إلى اكتشاف الحقائق الموضوعيّة؛ إلّا أنّه يَضل أحيانًا وتمنعه الأهواء والمصالحُ الشخصيّة والجماعيّة ونحوها من الوصول إلى هذا الهدف المهمّ.
علی الرغم من أنّه قد يبدو في البداية وبناءً على بعض الأدلّة أنّ البارادایم في كتاب (بنية الثورات العلميّة) لا يعني الأطر العقلیّة والمعرفيّة والأنطولوجیّة وغيرها، ولكن يتبيّن من خلال النظرة الشاملة إلى ادّعاءات توماس كُون والدراسة الموسّعة لأقواله أنّ هذا المعنى كان مقصودًا وهو مرتكز في ذهنه، بل هو غارقٌ في مستنقع هذا المعنى، لكن بما أنّه كان يخشى أن يُتّهم بالنسبیّة، فقد حاول بطريقة ما أن يحرِّر نفسه من هذا الاتهام.
وعلى أيّ حال، فإنّ مثل هذا الفهم للبارادایم بالمعنى العام -البارادایم بمعنى الإطار العقلي- أصبح شائعًا الآن، وقد فهم العديدُ من المعلِّقين والنقّاد لرأي كُون تصريحاته بهذه الطريقة. وقد وصل هذا التصور -وإن كان مع اختلافٍ طفيفٍ في بعض الأحيان- إلى العلوم الاجتماعيّة وفلسفة العلوم الاجتماعيّة أيضًا؛ فعلی سبیل المثال ذكر نيومان وميرجان بوضوحٍ أن البارادایم يُستخدم في العلوم الاجتماعية في أربعة معان:
1. البارادایم باعتباره رؤیة کونية.
2. البارادایم بمعنى الموقف المعرفي.
3. البارادایم بمعنى المعتقدات المشتركة في مجالٍ معينٍ من مجالات البحث.
4. البارادایم بمعنى القدوة والمثال والنموذج.
وللبارادایم بمعنى الرؤیة الکونية نطاق واسع جدًّا؛ ويشمل كلًّا من عالَم القيم ومجال الرؤى؛ فهو يشمل العقائد والأخلاق والقيم والأساليب ونحو ذلك. ولا سبيل إلى إثبات صدق البارادایم بهذا المعنى، والبارادایم لا يُقبل إلا على أساس الإيمان. وعلى هذا فإنّه من المستحيل إثبات صحة البارادایم، ولا توجد طريقة لإثباته. ولو كان هناك مثل هذا الأسلوب مُعتمدًا لما استمرّت الخلافات في هذا المجال حتّى الآن، بینما نجد أنّ الخلافات الکلامیّة والفلسفيّة وما شابه ذلك أصبحت أكثر تعقيدًا وأعمق وأكثر غموضًا كل يومٍ، وبدلًا من التوصّل إلى الاتّفاق تتزايد المسافات.
يتبادر إلى الأذهان عند دراسة أقوال كُون وأتباعه مسألةُ أنماط أو أساليب الحياة والألعاب اللغويّة لفيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة، ویختلفان في أنّ كُون استخدم كلمة (البارادایم) بدلًا من كلمة (اللعبة اللغویّة) ورتّب على البارادایم جميعَ قواعد الألعاب اللغويّة. كان كُون وفييرابند والعديد من الفلاسفة الآخرين مفتونين بشدةٍ
بنظریة الألعاب اللغويّة لفتجنشتاين وقاموا بتطبيقها في العديد من المجالات، بما في ذلك العلم والدين وعلم الاجتماع والتعليم والتربیة. ووفقًا لما یعتقده فيتجنشتاين، فإنّ الألعاب اللغويّة ليست قابلة للمقارنة مع بعضها. ولا يمكن مقارنة إحدى الألعاب اللغويّة بأخرى، ولا يمكن تفضيل إحداها على الأخرى. ولأجل فهم أيّ مجالٍ لغويٍّ ولعبته اللغويّة، يجب على المرء أن يكون حاضرًا في أسلوب الحياة هذا؛ ولذلك لا يمكن الحكم على أسلوب الحياة واللعب المرتبط به من خارجهما؛ فإن أسلوب الحياة واللعب المرتبط بها هو سياج يَحدّ الإنسان. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يهرب من أطره الذهنية، بل يكون مسجونًا فيها. إن أنماط أو أساليب حياة كل فرد تعطي فرضيّات للإنسان وتجعله ينظر إلى العالم بنظرة خاصة ومن وجهة نظر خاصّة. والصدق لا یعني توافق النظريّة مع الواقع. كرّر كُون وفييرابند وآخرون هذه الادّعاءات نفسها أیضًا بالضبط.
إنّ فييرابند وهو معاصر لتوماس كُون، والذي اختار وجهة نظر مماثلة والتزم بلوازم هذه النظريّة بشكل أكثر وضوحًا منه، قد أوضح العلاقةَ بين بارادایم توماس كُون ولعبة فيتجنشتاين اللغويّة. ولقد أصرّ على العلاقة الوثيقة بين بارادایمات كُون وألعاب فيتجنشتاين اللغويّة وأنماط الحياة عنده، وكأنه يعتبر ذلك أمرًا مفروغًا عنه: «يجب على المرء أن يفهم العلاقة الوثيقة بين ألعاب فيتجنشتاين اللغويّة أو أنماط الحياة عنده وبارادایمات كُون. ولا يمكن فهم أيٍّ منها بناءً على أوصاف بسيطة وانتزاعیّة... إنّ اللعبة اللغويّة
(44)والبارادایم ليسا حقائق أو هويّات لها تعريف دقيق، بل هما مفردات لنشاط لا یَعرف خصائصَه إلّا أولئك الذين يشاركون فيه».
بالإضافة إلى ذلك، أشار ريتشارد رورتي أيضًا إلی أن ادّعاءات كُون وكتاب بنية الثورات العلميّة تبتني علی انتقادات فيتجنشتاين: «إن [كتاب] بنية الثورات العلميّة مدين إلى حدٍّ ما لانتقادات فيتجنشتاين علی نظريّة المعرفة المشهورة...». ولقد قدّم مثل هذه الانتقادات بموقفٍ مقبول وبطريقةٍ جديدةٍ.
وبناءً على ذلك، فإنّ وجهة نظر كُون ليست نظريّة جديدة كما یظهر ذلك في البداية وبعد التفكير العميق أیضًا، بل هي وجهة نظر فتجنشتاين نفسها في فلسفته اللاحقة. ویعبَّر في فلسفة العلم عن اللعبة اللغويّة بالبارادایم ومصفوفة السلسلة علی ضوء ما عبّر عنه كُون. وتُذکر وجهة النظر نفسها والأحکام نفسها، ولکن بعبارة أخری، في شرح النظريّات العلميّة في العلوم التجريبيّة. وبما أن فكرة كُون ترتكز على وجهة نظر فتجنشتاين في فلسفته اللاحقة، بل هي وجهة النظر نفسها ولا تتضمّن أيّ مطلبٍ جديدٍ، فلا بدّ لتوضيح حقيقة البارادایم وشرح موقفنا منه، من إلقاء نظرة سريعة على أهمّ المسائل أو مواقف فلسفة فيتجنشتاين المتأخّرة.
واعتبر فيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة التي أدّت إلى ظهور فلسفة
(45)التحليل اللغوي، أنّ الفلسفة تعالج القضايا اللغويّة وتكشف عن الطريقة العمليّة لاستخدام الكلمات، وكان يرى أن للّغة وظائف ومجالات متنوّعة، وبالتالي يجب تقويم كلّ قضیّة من القضایا في سياقها الخاصّ بها. العلم نمطٌ من أنماط الحياة، والدين نمطٌ آخر منها؛ الفن هو النمط الثالث منها وهکذا... ويجب تقويم كل واحد منها بمعاييره الخاصّة ولا يجوز استخدام معايير التقويم الخاصّة بمجال ما في مجال آخر. إن مجال الدين والعلم والفن والأخلاق وما إلى ذلك، له وظيفة لغويّة خاصة ويَستخدم لغة خاصة للتعبير عن غرضه، ويستخدم كل مجالٍ استراتيجيّة مناسبة لتحقيق غرضه والتعبير عن غرضه، وبالتالي فإن كل مجال له لغة خاصّة، ولكل لغة منطقٌ خاصٌ بحیث لا تصلح قواعده وأحکامه في اللغات الأخرى. إن كل نظريّة إنما تجد معناها في السياق الذي يفكّر فيه الناس ويعيشون فيه. إنّ الدلیل والمبرِّر الذي يقبله الناس إنما يتحدّد حسب طريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم. ونتيجة لذلك، لا ينبغي تقويم البيانات في مجالٍ بالطريقة نفسها التي يتمّ بها تقويم البيانات أو المعتقدات في المجالات الأخرى.
وهو يعتقد أنه في أي لعبة لغويّة، أو في أي مجال، هناك فرضيّات أساسيّة لا يمكن التحقّق منها أو إثباتها بالاستدلال التجريبي أو غير التجريبي؛ بل لا يمكن إثباتها رأسًا. تَعتبر البراهينُ العلميّة في العلوم التجريبية وجودَ عالَمٍ خارجٍ عني أمرًا مفروضًا، ولا تُثبته البراهينُ
(46)العلمية؛ بل ليس هناك دلیلٌ علی إثبات وجود العالم الطبيعي. وهكذا الأمر بالنسبة إلی قضیة (الله موجودٌ) في الدين، فإن هذه المسألة مفترضةٌ في جميع المسائل الدينيّة. والأدلّة العلميّة والفكريّة والتاريخيّة بعیدةٌ عن هذا القول. وعلى هذا، فكما أنّ الإيمان بوجود العالم الخارجي أو قضیّة (العالم المادي خارج الذهن موجودٌ) هو أمر أساسي في العلوم التجريبيّة وغير قابل للإثبات، كذلك الإيمان بوجود الله في الدين؛ ولذلك فإنّ الإيمان بوجود العالم الخارجي والمعتقدات الدينيّة لا يثبت بالدلیل. إنّ هذه القضایا لا تقبل الزوال ولا تتزعزع؛ ولكن لا من أجل الدلیل، بل بسبب الدور الذي تلعبونه في مجال العلم والدين. ولا ينبغي لنا أن نسعى إلى مطابقة المعتقدات والقضایا للواقع؛ لأن المعيار ليس الصدق أو الكذب، بل المعیار هو الكفاءة والجدوى في الممارسة.
كان لفيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة تأثير واسع النطاق في تعزيز النسبية والدفاع عنها؛ لأنّه جميع الأساليب والأنشطة وأساليب الحياة متساوية من وجهة نظره؛ وليس لإحداها أفضليّة على الأخری؛ ولا يمكن تقويمها أیضًا؛ لأنه لا توجد معايير لتقويمها. ويجب أن نَعرف كل أسلوب حياة أو مجال لغةٍ من داخل نفسه، ولا
(47)يمكن تقويمه والتحقق منه من الخارج. وبناء على ذلك، لا ينبغي لأي لعبة لغويّة أن تحكم على الألعاب اللغويّة الأخرى، وهو يذكر بوضوحٍ أنّ اللغة هي أساس الواقع، وأنّنا نصنع العالم باللغة: «إن قواعد اللغة تحدّد كيفيّة وجود الشيء، مهما كان ما يريده». ومن الواضح أنّ هذا البيان هو في الواقع نسخة جديدة من الذاتية. على أيّة حال، فقد أعطى حياة جديدة للاتجاه النسبي والذاتي، وعلى الأقل أعطى شكليّة لهذه التيّارات بفلسفته اللاحقة.
یعتقد فيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة أن كل إنسان يولد بطريقةٍ أو نمط حياة خاص. وتصبح هذه الطريقة أو أسلوب الحياة الخاص أساسًا لمعرفة ذلك الشخص وتُوفِّر له بنية لغويّة خاصّة. وأن مصدر المعرفة الإنسانيّة هي اللّغة التي وُلد بها. يواجه كل شخص أشياء مختلفة من خلال البنية التي تفرضها عليه اللغة. هذه اللغة متجذِّرة في نمط الحياة والمساحة التي نعيش فيها. تشتق من اللغة أشكال دلالية مختلفة، وتعتمد على نمط الحياة الذي يعيش فيه الإنسان.
ولكن ماذا تعني اللعبةُ اللغويّة؟ لا يُقصد بها لغة مثل الفارسيّة أو الإنجليزيّة؛ بل أيّ مجال يتضمّن نوعًا من النشاط البشري الذي يجري فيه. وبناء على فلسفته اللاحقة، فإنّ هناك ألعابًا لغويّة متنوّعة بعدد وظائف اللغة وأدوارها العديدة، مثل لغة العلم، ولغة
(48)الدين، ولغة الفنّ. ومن المستحيل العثور على نقطة مشتركة بين هذه اللغات المختلفة. والشيء الوحيد المشترك بينها هو التشابه العائلي. وعندما تخضع لعبة لغویّة للتغيير والتطوّر، يحدث تغيير واسع في معاني الكلمات.
یعتقد فيتجنشتاين أنّ أسلوب الحياة والألعاب اللغويّة مرتبطان ببعضهما، وأنّ طريقة علاقتهما هي أنّ لكل أسلوب حياةٍ لغةً خاصة ومناسبة؛ کما أن لكلّ لعبةٍ لغويّةٍ مجالٌ یخصّها ولها قواعدها الخاصّة. إن كلّ واحد من الألعاب اللغويّة، هي جزء من أسلوب حياةٍ. ويجب على المرء، لفهم أي مجال لغوي ولعبته اللغويّة، أن يكون حاضرًا في أسلوب الحياة هذا؛ ولذلك لا يمكن الحكم على أسلوب الحياة واللعب المرتبط به من خارجهما. ولا تحتوي الألعاب اللغويّة وأساليب الحياة على قواعد ومعايير مشتركة بحيث يمكن الحكم عليها جميعًا بمعيار أو معايير مشتركة. وبهذا لا يمكن الحكم على أسلوب حياة وقواعد لغته من خارج ذاك المجال. وبکلمة أخری: لا يمكن تقويم لعبتها اللغويّة من الخارج. کما لا يمكن فحص جميع المجالات والألعاب اللغويّة وتقويمها بمعيار واحد. أو لا يمكن اعتبار حكم إحدى الألعاب اللغويّة صالحًا لألعاب لغويّة أخرى وقياس لغتها بذلك، وبالتالي إصدار الأحكام عليها.
(49)إنّ أسلوب الحياة واللعب المرتبط بها هو سياج يَحدّ الإنسان؛ ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يهرب من أطره الذهنيّة، بل يكون مسجونًا فيها. إن أنماط أو أساليب حياة كل فرد تعطي فرضيّات للإنسان وتجعله ينظر إلى العالم بنظرة خاصة ومن وجهة نظر خاصّة. يرى البشرُ العالمَ بطرق مختلفة من خلال قواعد اللغة المختلفة، وبعبارة أخرى، من خلال فرضيّات مختلفة. وهذه القواعد أو الفرضيّات كثيرة. إن هذه النقطة هي المفتاح لحل مشكلة، وهي أنه ما هو السبب لوجود مجالات وأساليب حياة مختلفة؟ ولماذا يوجد الكثير من اللغات؟ ولماذا تختلف القواعد التي تحكم معنى كل كلمة، في أي أسلوب حياة عن الطرق الأخرى؟ والجواب هو أن الفهم مبني على الفرضيّات. إن بناء الفهم على الفرضيّات والأطر يؤدي إلى ظهور العديد من الألعاب اللغويّة، ونتيجة لذلك تظهر مجالات مختلفة. «إن ما نقوم به في لعبتنا اللغويّة يعتمد دائمًا على فرضيّة ضمنيّة».
وهكذا، فإنّ كل مجالٍ أو لعبةٍ لغويّةٍ لها فرضيّة ضمنيّة أساسيّة، وهذه الفرضيّات لا يتمّ تأكيدها أو إثباتها بأدلّة تجريبيّة أو غير تجريبيّة؛ بل لا يمكن إثباتها رأسًا؛ كما أن الاعتقاد بوجود العالم الخارجي أو قولنا: «العالم المادي موجودٌ خارج الذهن» في العلوم التجريبية أمرٌ أساسيٌّ وغير قابل للإثبات. وهکذا الاعتقاد بوجود
(50)الله تعالی في مجال الدین. إنّ هذا الاعتقاد وغيره من المعتقدات الدينيّة لا يثبت بالدلیل؛ بل لا يحتاج إلى التبرير والدلیل. وعلی هذا الأساس، فإنّ كلّ مجالٍ أو لعبةٍ لغويّةٍ لها فرضيّات أساسيّة ولا يتم تأكيدها أو إثباتها بالدلیل، وهذا هو معنى قولنا: «ما نقوم به في لعبتنا اللغويّة يعتمد دائمًا على فرضيّة ضمنيّة».
للّغة وظائف ومجالات مختلفة، ولكلّ مجالٍ وظيفةٌ خاصّة، فمجال الفن له لغة غير لغة العلم. ومجال العلم له لغة غير لغة الدين وهکذا... يستخدم كل مجالٍ استراتيجيّة مناسبة لتحقيق غرضه والتعبير عن غرضه. وعلی هذا، فإن كل مجال له لغة خاصّة، ولكل لغةٍ منطق خاصّ، بحیث لا تنطبق قواعده وضوابطه على اللغات الأخرى. وعلى هذا فإن أي تبريرٍ يتم بأسلوب حياة خاص ولعبة لغويّة خاصة. وكل نظريّة، سواء أكانت دينيّة أم غير دينيّة، تجد معناها في السياق الذي يفكّر فيه الناس ويعيشون فيه. «إنّ الدلیل والمبرّر الذي يقبله الناس يتحدّد حسب طريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم». ولكل مجال أو أسلوب حياة معتقد أو معتقدات أساسية ومفترضة ولا تحتاج إلى تبرير وإثبات؛ بل هي التي تُبرِّر المعتقدات والأسس الأخرى. إن المعتقدات الأساسية في نص من النصوص أو مجالٍ من المجالات لا تحتاج إلى مبرر؛ ولكنها یمکن
(51)أن تحتاج إلیه في مجال آخر. ويستند عدمُ افتقارهم إلى التبرير إلى القواعد التي تحكم اللعبة اللغويّة. نحن محصورون في إطارٍ لا يمكن تغييره، ویمکن أن يتغيّر في أي لحظة. ومع تغير مجال الحیاة ونمطها تتغيّر بنية اللّغة الخاصّة به، وتصبح بنيتها اللغويّة الخاصّة هي المهيمنة.
وعلی هذا، وبناءً على العديد من الأبحاث والتأمّلات حول فلسفة فتجنشتاين اللاحقة، والاستعانة بتفسيرات شارحيه، يمكن رسم نظرة شاملة وموجزة لمواقفه وتعاليمه على النحو التالي:
1. للّغة وظائف ومجالات مختلفة، ولكلّ مجالٍ لعبةٌ لغویّةٌ ووظيفة خاصّة، ولكلّ مجال من مجالات الحياة وأنماطها والألعاب اللغويّة المتعلّقة به، منطقه الخاص، بحیث لا تسري قواعد وأحکام ذلك المنطق إلى المجالات واللغات الأخرى؛ ولذلك فإنّ لكلٍّ من مجالات الدين والعلم والفنّ وغيرها، منطق ولغة خاصّة لا ينبغي أن يمتدّ حکمه إلى الآخر.
2. لا يوجد معيار مشترك بين الألعاب اللغويّة المختلفة، ولذلك فإنّ النقد يتم داخل المجال لا داخل المجموعة أو خارجها. ولا يمكن انتقاد كلّ من أنماط الحياة وأساليبها ككل؛ لأن لكلّ واحد معاييره وقواعده الخاصّة.
3. لا يمكن الحكم على جميع الألعاب اللغويّة بمعيار عامّ
(52)ومشترك، ولا يوجد مبدأ أرخميدسيٌّ يمكن الحكم على ضوئه. وإنّ فَهْمَ أيّ لغة يعتمد على التواجد في أسلوب حياتها الخاصّ.
4. الشيء في ذاته أو الواقع المستقل عن أشكال فكرنا ليس له مکانٌ في هذا الموقف؛ بل الواقع هو العالم الذي تمنحنا إيّاه اللغة.
5. يتشكّل أساس المعنى من خلال الأنشطة البشريّة وأسلوب الحياة، ونحن نواجه الحقائق بناءً على البنية التي تفرضها علينا اللغة. إنّ نوع اللغة هو الذي يحدد نوع مواجهتنا للحقائق المختلفة.
إنّ التعاليم أو المبادئ المذكورة تتطلّب الذاتيّة، بل نوعها المتطرّف. وجهة النظر هذه هي البداية والأصل لقراءة خاصّة للذاتية كان لها تأثير عميق وشامل على مجالات الفكر الغربي المعاصر.
يمكن اعتبار تحليل توماس كُون التاريخي نقطة تحوّل في فلسفة العلم وردّ فعلٍ عنيد ضد وجهات النظر المتطرّفة للوضعيّين المنطقيّين. وعلى الرغم من بعض النقاط الإيجابيّة فیه، إلّا أنّ هناك انتقادات خاصّة لادّعاءات كُون وأتباعه، التاريخيّة والاجتماعيّة
والفلسفيّة، التي ذكرنا بعضها سابقًا، منها أنه حتّى لو افترضنا أن ادّعاءاته صحيحة في بعض الحالات، لکن العديد من تعميماته غیر صحیحةٍ. وبغض النظر عن هذه الانتقادات المحدّدة، فمن خلال النظر إلى موقف كُون حول البارادایم أو الإطار أو مصفوفة الانضباط ونظريّة فيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة ومقارنتها توصّلنا إلى استنتاج مفاده أنهما متشابهان جدًّا مع بعضهما، بل إن آراء كُون مستمدة من آراء فيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة وهي نفس الشيء؛ ولذلك فمن خلال انتقاد نظريّات فيتجنشتاين، يتمّ أيضًا انتقاد وتقويم آراء كُون. وحیث قمنا منذ وقتٍ سابقٍ في كتاب آخر، بوصف ونقد وتقييم مجموعة واسعة من مواقف ونظريات فيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة ونقدها وتقويمها بشكل تفصيلي نسبيًّا، ودرسنا بعض أهمّ إشکالیّاتها، فنمتنع هنا عن استعراضها جميعًا ونذکر بعضها فقط.
1. أسطورة الإطار
كما رأينا، یصرّح فيتجنشتاين بأنّ اللعبة اللغویّة مبنيّةٌ على فرضيّات
مسبقة. فهل للفرضيّات في الخطابات والكتابات والأقوال العقلانيّة دورٌ في عملیة الفهم؟ وإذا كان لها هذا الدور، فكم هو هذا الدور؟ وما هي المعرفة المسبقة اللازمة للفهم؟ هل كل شخص، متأثّر بثقافته وتاريخه، لديه إطار في ذهنه يرى العالم بناءً عليه؟
إنّ إجابة فيتجنشتاين على هذا السؤال إيجابية. وفي الواقع، فهو یقرب من مذهب ما بعد الكانطیة. وهنا تشمل الانتقاداتُ الموجّهةُ إلى البنى السابقة والمفاهيم الفطريّة عند كانط وأتباعه وجهةَ نظره أيضًا. وإنّ ادّعاء الإطار العقلي ليس أكثر من أسطورة. ولدى البشر مبادئ مشتركة في المجالات الأساسيّة للعلم والدين والفلسفة والرؤیة الکونیّة والأنثروبولوجيا وما إلى ذلك. ومن تلك المبادئ المشتركة قواعد الخطاب، والتي يمكن أن نطلق عليها (منطق الخطاب). والفئة الأخرى من هذه المبادئ المشتركة هي قواعد التفكير، بما فيها التعريف والاستنتاج، وهو ما يسمّى بـ(منطق التفكير).
إنّ الإنسان في كل بلد ومنطقة ومجتمع وُلد فیه، وبين كل أمّة وجنسيّة عاش فیها، وفي كل ثقافة نشأ معها، رجل الأمس ورجل
اليوم، منذ اللحظة التي يعرف فيها نفسه، يجد نفسه بحیث يواجه العديد من الأسئلة التي یشترك فیها جمیع الناس وجمیع الثقافات. تتعلق بعض هذه الأسئلة بالبعد الجسدي والمادّي للإنسان؛ مثل كيفية التغذية والصحّة وعلاج الأمراض والوقاية منها وتوفير الصحّة والحماية من البرد والحر. ويوجد عدد آخر من الأسئلة الشائعة بين البشر تتعلّق بالبعد الروحي للإنسان؛ مثل هذه الأسئلة: من أين أتيتُ؟ ما هو ومن هو أَصلِي؟ لم أكن من قبل وأنا الآن موجودٌ؛ والآن لماذا أتيتُ؟ أين أنا ذاهب؟ أين وجهتي؟ هل تنتهي حياتي بالموت؟ ما هي نهايتي؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هو الطريق الذي يجب أن أختاره لنجاحي وسعادتي؟ ما هو البرنامج الذي أحتاجه للسعادة؟ ما هو الطريق إلى سعادتي وخلاصي؟ وفي تصنيف آخر، ترتبط مجموعة من هذه الأسئلة الشائعة بالبُعد العملي سواء الأفعال الجوارحیّة والجوانحیّة. بینما يتعلّق بعضها الآخر بالبُعد الفكري. کما أنه في البعد الفكري وما شابهه، تتعلّق بعض هذه الأسئلة الشائعة يتعلّق بالمنطق وقواعد التفكير، وبعضها يتعلّق بالخطاب ونحو ذلك.
ومن الواضح أن كل سؤال من هذه الأسئلة يُطرح من خلال قضیة واحدة أو أكثر. کما أنّ كلّ قضیّة تتكوّن من عدّة مفاهيم. وكل هذه القضایا والمفاهيم التي تشكّل مكوناتها، مشتركةٌ بين الثقافات والمجتمعات والاجتماعات الإنسانيّة. وعلى سبيل المثال نقوم بتحليل وشرح الأسئلة المذكورة حول البعد الروحي، وهي أكثر تعقيدًا کما أن إجاباتها مختلفة أیضًا. وهذه الأسئلة هي الأسئلة
(56)الأساسيّة نفسها التي تجيب عليها دائمًا الأديان والمدارس الفلسفيّة والکلامیّة عبر التاريخ. ويعتمد معنى الحياة وانعدام معناها على إجابات هذه الأسئلة. ويمكن طرح هذه الأسئلة بصيغة أخرى وذلك كالتالي: من هو مبدئي؟ أين مَعادي؟ ما هو الطريق الذي يجب أن أختاره لتحقيق السعادة؟ إن المبادئ الأساسية للديانات التوحيديّة السليمة عن التحریف، هي رد فعل على هذه الأسئلة الثلاثة. وهذه الأسئلة عقلانيّة وليست مضادّة للعقلانيّة؛ وهي منطقيّة وليست غير منطقية، وهي قابلة للاستدلال المنطقي، وليست فوق الاستدلال، ولا غیر قابلة للاستدلال. وقد تثار هذه الأسئلة بالنسبة لأي شخص وفي أي ثقافة، بل وقد أثيرت بالنسبة للكثيرين. إن فتجنشتاين نفسَه هو من بين أولئك الذين لم تستطع روحهم القلقة والمضطربة أن تهدأ بوجهة نظر تلك الرسالة التي کتَبها وكانت أساس الوضعيّة المنطقيّة ونظریّة عدم المعنى لمثل هذه الأسئلة. واضطر إلى جعل الإيمان محصنًا ضد النقد العقلاني، وإلی منع العقلانيّة المقبولة في عصره من مهاجمة الإیمان. وعلى الرغم من أنه كان حزينًا جدًّا وكانت روحه مضطربة للغاية، إلّا أنّه حاول أن یجیب هکذا على هذه الأسئلة الأساسيّة وحلّ المشكلة الإنسانيّة. وعلى أيّة حال، فإنّ معنى الحياة يعتمد على الإجابات الصحيحة لهذه الأسئلة. والإجابة الخاطئة على هذه الأسئلة تسبّب العدمية والانتحار والقلق واليأس. والسؤال الآن هو: بغض النظر عن أي إجابة يقدمها الشخص على هذه الأسئلة، فهل من الممكن أن تجد شخصًا لا يفهم هذه الأسئلة؟ إن قواعد منطق الخطاب العقلاني ومنطق التفكير تثبت
(57)أن الجميع قد فهموا هذه الأسئلة الأساسيّة؛ بل إنّ الأدلّة التاريخيّة تُظهر أنهم كانوا يبحثون عن إجابات. وعلى أقصى تقدير يمكن القول: إنّ بعض الأشخاص لم يتمكّن من الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة، ممّا أدّى إلى الخطأ والانحراف. ويجب التأكيد على أنّ الجميع فهموا هذه الأسئلة وكانوا يبحثون عن إجابات لها، ولم يمنعهم أيّ مجالٍ لغويّ أو لعبة لغويّة من فهمها.
وكما رأينا، فإنّ الأسئلة العامّة والمفهومة لا تقتصر على الأسئلة المذكورة آنفًا. کما أنّ الفهم المشترك في أسئلة ومبادئ أخرى مثل وجود العالم الخارجي، وحجیّة ظهور الكلام، وإمكانيّة الاحتجاج بالظاهر وغيرها...، والمفاهيم التي تتکوّن منها القضایا المذكورة، کلّها متاحة للجميع.
إن القول بعدم وجود مفاهيم مشتركة بين الألعاب اللغويّة المختلفة، والقول بعدم إمكان وجود مثل هذه المفاهيم له نتائج كثيرة، ومن أهمّها إغلاق باب الحوار والمناقشة، ونقل الرسائل والمعلومات. إنّ عدم وجود فهم مشترك، بسبب عدم وجود كلمات ومفاهيم مشتركة، سيكون مصدرًا لعدم جدوى التحدّث والكتابة ونقل الرسائل وغيرها. ومثل هذا الأمر يتعارض مع الواقع القائم. وفي عالم اليوم، على الرغم من أنّ مجموعة من المعلومات والرسائل ترتبط بمجال لغويّ خاصّ، إلّا أنّه يتمّ تبادلها بسرعة البرق ويتم الفهم. وفي حين أنّ الألعاب اللغويّة مختلفة ومجالاتها كثيرة
ومختلفة، فإنّ الأخبار المتعلّقة بمجال الدين والسياسة والاقتصاد والعلوم التجريبيّة والعلوم التربويّة والأخلاق والأنثروبولوجيا وعلم الكونيّات والفلکیّات و... يتمّ تقديمها في مختلف المجالات. ويتمّ نشاط الفهم دون الاهتمام بالألعاب اللغويّة ومختلف المجالات؛ ولذلك يعتبر العالم اليوم بهذا المعنى قرية عالميّة، وتنتقل المعلومات الخاصّة بكل مجال إلى الآخرين، سواء أكان بشکلٍ مباشرٍ أو غیر مباشرٍ.
يمكن رؤية العديد من الحوارات في مجالات الدين والاقتصاد والسياسة والأسرة والتعليم والتربیة والبيئة والأخلاق والإعلام وغيرها. وسنحاول الحصول على لمحة عامّة عن المفاهيم المشتركة في مختلف المجالات، وتوضيح النتائج المترتّبة على النظرة القائمة على نفي المفاهيم المشتركة؛ لذا فإننا نلقي نظرة سريعة على الخطاب والحوارات الجارية في مجال الدين. نجد في مجال الدين أن العديد من أتباع الديانات المختلفة يشاركون في الحوار. ومن خلال إيجاد نقاط مشتركة، فإنهم يناقشون ويبحثون في القضايا الخلافية ويثبتون مذاهبهم. ويضاف إلى ذلك أن المناقشات المقارنة في مجال الدين والفلسفة والکلام والأخلاق ونحوها لیست قلیلة. وكل منها دليلٌ على أنه من وجهة نظر العقلاء يمكن تحصيل الفهم المشترك في غير مجالات العلوم أيضًا. ومن الواضح أن المؤمنين والملحدين يفهمون كلام بعضهم بعضًا ويتحاورون مع بعضهم. إن كلام کلّ واحدٍ من العقلاء مفهوم للآخرین؛ ولذا يتجادل الأفراد أو الجماعات ويستدلّون على أقوالهم. ومن ناحية أخرى، تنتقد مجموعة أخرى
(59)حجتهم؛ ومن ثم يقوم الطرف الآخر بدراسة الانتقادات والرد عليها. ويتمّ كل هذا علی ضوء أنهم يفهمون كلمات وكتابات بعضهم؛ ولذلك لا يمكن اعتبار لغة المؤمن والملحد منفصلين، واعتبار كل منهما خاضعًا لقواعد وضوابط معيّنة.
یضاف إلى ذلك أنّ المؤمنين أنفسهم يتناقشون مع أتباع الديانات والمذاهب المختلفة ويتحدّثون مع بعضهم؛ ويكتبون آراءهم ويدافعون عنها؛ أو يتناقشون ويتجادلون مع بعضهم. ولقد ألّف المسلمون العديدَ من الكتب واحتجّوا على اليهود والنصارى والثنویّة والملحدين؛ وكذلك يتحدث المسيحيّون مع المسلمين واليهود و... وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ علماء الطوائف من الدين نفسه، مثل الأشاعرة والمعتزلة من أهل السنة أو أتباع البروتستانتية المختلفة، دارت بينهم العديد من المناقشات داخل الدين الواحد وانتقدوا بعضهم وانتهكوا بعضهم؛ ولا تزال هذه العملية مستمرّة حتّى الآن. وكل هذه الأشياء مبنية على قبول أنهم يفهمون كلام وكتابات بعضهم. فإذا لم يفهموا كلام بعضهم، كانت النتيجة أنهم لم يكونوا قد كتبوا كتابًا أو مقالًا، ولَمَا كان لهم إعلام أو خطاب. فهل كتابة كل هذه الكتب والمقالات ونشرها وتأسيس الإعلام ملغى ولا معنى له؟ وهذه النتيجة لا تتفق مع تمييز لغة الدين عن لغة اللادين. وبالتالي، إذا تم قبول وجهة النظر هذه، فسيتم إغلاق باب النقاش والحوار والاحتجاج؛ وليس من الممكن أن نفهم، ولن يكون النقد المتبادل ممكنًا. فهل من الممكن أن نقبل هذه المحاذیر
(60)ونعتبر باب النقد والتفهیم والتفهّم مسدودًا؟
وبالإضافة إلى ما تقدّم، فإنّ من الممكن إجراء البحوث بطريقة موجهة نحو حلّ المشكلة في مجالات مختلفة مثل الدين والأخلاق وفلسفة الأخلاق والتعليم والتربیة والأنطولوجيا والأنثروبولوجيا واللاهوت، وما إلى ذلك. وإنّ التطبيق العملي لطريقة البحث هذه وفائدته، هي في حدّ ذاتها وثيقة قويّة ضدّ بطلان الرأي المذكور أعلاه. ومن أجل شرح طريقة البحث الموجَّه نحو المشكلة، نختار من بين المجالات المختلفة، مجالَ الدين والمعتقدات وتعاليم الأديان والمذاهب. ومن الواضح أنّ هناك الكثير من الديانات والمذاهب والمدارس المتناقضة أمام الإنسان. فمن ناحية، لا يمكن للشخص الساعي إلى الحق أن يختار دون دراسةٍ، ومن ناحية أخرى، فإن البحث فيها جميعًا يستغرق وقتًا طويلًا، ولا تكفي حياة الإنسان. والطريقة الوحيدة الممكنة والعقلانيّة هي الدراسة والبحث بطريقة موجّهة نحو حلّ المشكلة وتقويم الإجابات على المشكلات الأساسيّة. إذن مع الإجابة الصحيحة على سؤال (هل الوجود يساوي المادة؟) تغادر مدارسُ كثيرة ومع الإجابة الصحيحة على هذا السؤال وهو أنّ الله واحد، ينكشف انحراف وبطلان الثنويّة والتثلیث وأمثالها و... وهذا یبيّن العقلانيّة الشاملة والمشتركة بين العقلاء.
يتمّ استخدام أسلوب البحث نفسه الموجّه نحو حلّ المشكلة في العديد من مجالات البحث الأخرى، حتّى في مجال نظريّة المعرفة
(61)التي تعدّ أساس العلوم. یوجد على مرّ تاريخ الفكر الإنساني العديد من المدارس والآراء المعرفيّة التي لا يمكن دراستها وتقويمها في وقت قصير. إنّ أسلوب البحث الموجه نحو حلّ المشكلة هو طريق مختصر يمكن من خلاله، بالإضافة إلى الإشراف النسبي علی المدارس والآراء المعرفية، تقويم النظريّات بدقّةٍ، في القضايا المهمّة على الأقل.
كيف يمكن نفي المفاهيم المشتركة بين المجالات المختلفة والألعاب اللغويّة، في حين أن وجود مفاهيم مشتركة بينها أمر لا يمكن إنكاره؟ إن إنكار مثل هذه المفاهيم أمر متناقض داخلیًّا؛ لأن من ينفيها قد تصوّر وفَهم مفهومًا أو مفاهيم مشتركة للألعاب اللغويّة المختلفة؛ ثم يحكم عليها ويعطي مثل هذا الحكم السلبي عليها. إن الحكم وإصدار أي حكم، سواء أكان سلبيًّا أو إيجابيًّا، يعتمد على تصوّر وفهم مشترك للمجالات والألعاب اللغويّة المختلفة والمتعارضة والمختلفة. وكيف يمكنك الحكم؟ ومن ثم فإن نفي وإنكار المفاهيم المشتركة في المجالات اللغويّة والألعاب، یعتمد على تصورها وفهمها. ونتيجة لذلك، یلزم من النفي المطلق للمفاهيم المشتركة إثباتُها، ویتحصّل أن وجود عدة مفاهيم مشتركة أمر لا يمكن إنكاره ولا مفرّ منه، ولا يمكن نفي وجودها بشكل عام.
وبکلمة أخری ومختصرة: إنّ فكرة اللعبة اللغویّة هو وجهة نظر مبنيّة على لعبة لغویّة وبارادایم أو إطار ذهني خاص، ويَنتج عن أسلوب
حياة خاصّ. وإذا لم يقبل أنصارها مفاهيم أو معيار أو معايير مشتركة للتقويم، فإنّ ادّعاءهم هذا سينتقض، لأنهم حكموا بهذا البيان على كل الأفكار والألعاب والأساليب والأديان والثقافات.
يقول فيتجنشتاين وأتباعه: لا يوجد معيار واحد يمكن استخدامه لتقويم المجالات والألعاب اللغويّة المختلفة؛ لأنه لا يوجد مفهوم مشترك بينها. والآن نقول بکلمة ثالثة: هل هذا الادّعاء يشمل جميع الثقافات والألعاب اللغويّة أم أنّه مخصّص للعبة لغويّة خاصّة، وهي اللعبة اللغویّة التي نشأ فيها هو وأتباعه؟ إذا كان مختصًّا بمجال ولعبة لغويّة خاصّة، فإنّ حكمه ليس شاملًا، ولا يشمل جميع المجالات والألعاب اللغویّة، وبالتالي فهو يخالف نفسه. ولكن إذا كان ادّعاؤهم لا يقتصر على مجال ولعبة لغويّة خاصّة ويشمل جميع المجالات والألعاب اللغويّة، فكيف يحكمون على الثقافات والأديان والعلوم المختلفة، وعلی المجالات والألعاب اللغويّة المختلفة؛ مع أنه ليس لديهم مفهومٌ مشترك وشامل منها؟ هل يمكننا أن نحكم على شيء ليس لدينا فكرة عنه؟ وبهذه الطريقة، ینقض فيتجنشتاين نظريته بالفعل ویُصدر حكمًا عليها من خارج الألعاب اللغويّة.
ومن ناحية أخرى يمكن أن يُقال: إذا كان هو وأنصاره قد قدّموا دلیلًا علی إثبات نظريّتهم، فلماذا يمنعون التمسّك بالدلیل، وإذا لم يقدّموا حجّة أو دلیلًا، فلماذا تقبل هذه النظريّة؟
يعتقد فيتجنشتاين وأتباعه في فلسفته اللاحقة أنّ القضایا العلميّة والدينيّة يتمّ تقويمها بالنظر إلى مدى فائدتها وليس بالنظر إلى مدى صحّتها ومطابقتها للواقع. ومن وجهة نظرهم فإن السؤال (هل يوجد الإلكترون؟) يعتمد على الدور الذي يلعبه مفهوم الإلكترون في المجتمع العلمي وعند العلماء. إن مثل هذا التفسير لحقيقة الصدق هو قلبٌ لحقيقته. وكما ذكرنا سابقًا، فإنّ معنى الصدق في المنطق ونظريّة المعرفة وغيرها من العلوم المتجانسة هو الصدق الخبري أو المنطقي. ومثل هذا المفهوم بديهي ولا يحتاج إلى تعريف حقيقي. یُقصد بالصدق موافقةُ متعلَّقه للواقع، کما یُقصد بالکذب عدم موافقته للواقع. وهذا المعنى واضح ولا يمكن إنكاره، ولا يمكن إنكار ذلك بشكل جدّي. كل من يتحدث معنا أو يكتب شيئًا في مجال العلوم والمعرفة الإنسانيّة، فإنه يسعى إلى تقديم تصوّراته للحقائق، بالإضافة إلى تحليلاته. وعندما يكتب العلماء في الكتاب الهیوي: (القمر أصغر من الأرض) فإنّ هذا القول معناه أنّه لیس القمر أكبر من الأرض أو يساويها، بل الواقع والحقيقة هي أنّ القمر أصغر من الأرض. أو عندما يكتبون في كتاب الرياضيات: (الثلاثة أصغر من الخمسة)، فهذا يعني أن الواقع هو أن الثلاثة أصغر من الخمسة والخمسة أكبر منها. يسعى الباحث في نظريّة المعرفة لمعرفة كيف وبأي معايير يمكن الوصول إلى الواقع؛ ولذلك فإنّ القول الصادق هو القول الذي
يطابق الواقع، والقول الكاذب هو القول الذي لا يطابق الواقع.
وهكذا، ومن خلال التأمّل في كلمتي الصدق والکذب، والتأمّل في معناهما الواضح، وهو المطابقة للواقع وعدم المطابقة له، يمكننا أن نفهم أنّ تعريف الصدق والکذب لا ينطبق إلّا علی نظريّة المطابقة. إنّ القضیّة الأولى المذکورة أعلاه، المأخوذة من علم الفلك هي قضیة صادقة؛ لأنّها تقول إنّ القمر أصغر من الأرض، وهذا هو الحقّ الواقع. کما أنّ القضیّة الرياضيّة المذكورة صادقة أيضًا؛ لأنها تخبر عن هذه الحقيقة، وهي أنّ الثلاثة أصغر من الخمسة والخمسة أكبر منها، والحقيقة أيضًا هكذا. لكن قولنا: (الثلاثة أكبر من الخمسة) هو قولٌ کاذبٌ؛ لأن الحقيقة هي أنّ الثلاثة ليست أكبر من الخمسة بل أصغر منها. ولا يقتصر هذا المعنى على القضايا القبلیّة، بل يشمل القضايا البعدیّة أيضًا. وكما رأينا فإنّ المثال الأوّل من القضايا البعدیّة.
إنّ هذا التفسير للصدق، والذي يسمّى (نظريّة المطابقة) له تاريخ طويل جدًّا، ويتّفق عليه المفكّرون منذ الماضي البعيد إلى يومنا هذا، وحتى المتشكّكون لا يختلفون حول حقيقة الصدق وتعريفها، وقد قبلوا في تفسيره النظريّة المذكورة. وما يشكّكون فيه إنّما هو معيار الصدق، حیث يرون أنّ الإنسان عاجز عن الحصول علی معيار
لتمييز الصدق من الکذب، أو الصادق من الکاذب، وتمييز الحقّ من الخطأ؛ ولهذا يغرقون في هاوية الشك. وبهذا ينكرون الحصول علی المعرفة الحقيقيّة والصادقة التي هي القضیّة المطابقة للواقع، من دون أن یشکّکوا في تعریف الصدق. نعم، في نهاية القرن التاسع عشر فقط، تخلّى بعض الفلاسفة الغربيّين عن نظریّة المطابقة، واقترحوا نظريّات بديلة، وهم رأوا أنفسهم غير قادرين على معرفة الواقع، ولم يتمكّنوا من الحصول علی طريقة للحصول علیها. إنّ مثل هؤلاء الأشخاص، بدلًا من الإجابة على قضیّة معيار الصدق وتقديم طريقة لحلّه، غيّروا طبيعة المشكلة. والحقيقة أنّ عملهم كان بمثابة غطاء لإخفاء عجزهم عن مواجهة انتقادات المتشكّكين أو التخلّص من إشكاليّات تعريف الصدق. ونظرًا إلى عدم تمكّن هؤلاء من ذكر طريقةٍ للوصول إلى الحقيقة أو معيارٍ لإثبات أن أيّ قضیّةٍ من القضایا تطابق الواقع، فقد شکّکوا في تعريف صدق القضیة بکونها تُطابِق الواقع، بل أنكروا ذلك.
والحاصل أنّنا من خلال التأمّل في التعريف اللفظي للصدق الخبري أو المنطقي، ومن خلال شرحه الدقیق والتأمّل في حالات تطبيقه، نصل إلى نظريّة المطابقة؛ بل يمكن القول أبعد من ذلك: إن مثل هذا المعنى للصدق أمرٌ بدیهيٌّ ومرکوزٌ في أذهان جميع البشر حتّى الأطفال، ولا يحتاج إلى نقاش واستدلال. وکل من يتأمّل قضایاه الذهنيّة يجد أنّ الصدق والکذب، وبعبارة أوضح، یجد أنّ السؤال عن
الصدق والکذب في القضایا معناه أنها هل تُطابق الواقعَ؟ وهل تُظهرها بشكلٍ صحيحٍ؟ والآن، هل يمكن تجاهل هذا المعنى واستبداله بنظريّات مخالفة له، سواء أكانت براغماتيّة أو تماسكیّة أو...؟
وفي النهاية لا بدّ من التأكيد على أن هذه الانتقادات المقدّمة، والعديد من الانتقادات الأخرى، تشمل أنصار البارادایم أيضًا بمعنى الأطر العقلیّة؛ لأنّ أصل مذهب الإطار العقلي هو وجهة نظر فتجنشتاين في فلسفته اللاحقة، بل نظریّة الإطار العقلي هي نفسها، ولذلك فإنّ معظم الانتقادات التي يمكن توجيهها لوجهة نظر فتجنشتاين موجهةٌ إلى أنصار البارادایم بمعنى الأطر العقليّة أیضًا.
عندما نواجه البارادايمات، تُطرح أمامنا أسئلة كثيرة حول دورها في المعرفة وتحقيق الواقع. وقبل البحث في هذه الأسئلة وإيجاد حل لها، لا بدّ من استكشاف كلمة (البارادايم) ومعانيها اللغویّة والاصطلاحيّة ومعرفة المعنى المقصود من هذه الكلمة الجديدة نسبيًّا، وما هو أصل ذلك المعنى أو المصطلح.
أصبحت مفردة (البارادایم) محطّ الاهتمام بعد نشر کتاب (بنية الثورات العلميّة) في فلسفة العلم في النصف الثاني من القرن العشرين. ولم يستغرق نقلُها السریع إلى غيرها من مجالات المعرفة الإنسانيّة وقتًا طويلًا، ودارت على الألسنة في مجالات مثل فلسفة الدين، والفلسفة ونظریّة المعرفة، والمنهجيّة، و...
(67)اکتنف استخدام كلمة البارادایم في الکتاب المذکور أعلاه بالغموض والإبهام. وليس من الواضح أن ما يقصده المؤلف بهذه الكلمة هو النموذج والقدوة أو المبادئ الکلیة والعامّة. وكان هذا الغموض مصدر انتقادات كثيرة له. وردًّا على الانتقادات أشار في ملحق ذلك الكتاب إلى أن البارادایم يستخدم في معنيين مختلفين فقط في معظم صفحات الكتاب:
1.مجموعة من المعتقدات والقيم والأساليب والفنون وغیرها.
2. المثال والقدوة
والغموض الآخر الذي يمكن ملاحظته حول هذه الكلمة في كتاب بنية الثورات العلميّة والعديد من المؤلّفات الأخرى، هو أنّ المقصود بالبارادایم بالمعنى الأوّل هو البنية العقلیّة أو الأساس. وعندما راجعنا الكتاب المذكور توصّلنا إلى أنه على الرغم من أنه قد يبدو وبناءً على بعض الأدلّة، أنّ البارادایم لا يعني الأطر العقليّة والمعرفيّة والوجوديّة، ولكن یستنتج من خلال النظرة الشاملة إلى ادّعاءات كُون والتأمّل التامّ في أقواله وتصريحاته أنّ هذا المعنى هو وجهة نظره.
ثمّ توصّلنا إلى استنتاج مفاده أن فكر كُون حول البارادایم بمعنى الأطر العقليّة يعتمد على وجهة نظر فيتجنشتاين في فلسفته اللاحقة؛ بل هو مستمد من نظریة الألعاب اللغویة بل نفسها؛ ولذلك ومن أجل توضيح حقيقة البارادایم وتوضيح موقفنا تجاهه، ألقينا نظرة سريعة على أهم تعالیم أو مواقف فلسفة فتجنشتاين اللاحقة، ورأينا
عند تقويم تلك التعالیم أن انتقادات كثيرة موجّهة إليها. ومن أهمّها إغلاق باب الحوار والمناقشة ونقل الرسائل والمعلومات. ثم إن عدم وجود فهم مشترك بسبب عدم وجود كلمات ومفاهيم مشتركة سيكون مصدر عدم جدوى التحدث والكتابة ونقل الرسائل وما إلى ذلك، وهذا مخالف للحقائق الموجودة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الموقف مدمرٌ لذاته ویناقض ذاته. إن فكرة اللعبة اللغويّة هي وجهة نظر تقوم على لعبة لغويّة خاصّة، وتكون نتيجة لأسلوب حياة خاص. والذين لا يقبلون مفاهيم أو معايير مشتركة للتقويم، فإنهم ینقضون ادّعاءهم هذا، لأنهم حكموا بهذا القول نفسه على كل الأفكار والألعاب والأساليب والأديان والثقافات. وبکلمة أخری: هل هذا الشرح وصفٌ يتمّ من وجهة نظره وفق إطار وأسلوب حياة ولعبة لغويّة خاصّة؟ أم أنّه وصف بلا إطار وأسلوب حياة ولعبة لغويّة خاصة؟ ومن الواضح أن الخيار الثاني مخالف لتعاليم فلسفته اللاحقة وأتباعها. لكن الخيار الثاني یبطل نفسه ویناقض ذاته.
وفي النهاية أكّدنا على هذه النتيجة: بما أنّ أصل مذهب الإطار العقلي هو رأي فتجنشتاين ونشأ من فلسفته اللاحقة، فإنّ الانتقادات الموجّهة إلى فتجنشتاين تشمل أيضًا أنصار البارادایم بمعنى الأطر العقليّة.
(69)عندما نواجه البارادایمات، تُطرح أمامنا أسئلةٌ كثيرة حول دورها في المعرفة وتحقيق الواقع وتأثيرها على الإدراك. وقبل البحث في هذه الأسئلة وإيجاد حل لها، قمنا في الفصل السابق من باب المقدّمة، بتحليل كلمة (البارادایم) ومعانيها اللغویّة والاصطلاحيّة وبحثنا حول المعنى المقصود من هذه الكلمة الجديدة نسبيًّا وأصل ذلك المعنى. ورأینا أن هناك ثلاثة معانٍ رئيسية له على الأقل: الإطار العقلي، والأساس، والنموذج.
ثمّ بحثنا جذور البارادایم بمعنى الإطار العقلي وتوصّلنا إلى نتيجةٍ مفادها أنّ الإنسان لا يخضع لأي إطار عقلي ومعرفي، ولا يخضع لأيّ أسلوب حياة ولعبة لغويّة ملائمة له. ويمكن أن يتحرّر من سيطرتها. إنّ الأطر العقليّة یمکن أن تهیِّئ الأرضیّة وأن یکون لها دور المقتضي. ولذلك، لا یصحّ أن یکون لكلّ نمط حياة أو لكلّ مجموعة بارادایمیّة لغة خاصّة ومناسبة؛ کما أنّه ليس لكلّ لعبةٍ لغويّةٍ مجالٌ خاصٌّ أو قواعد خاصّة. وليس من الضروري أن یكون الإنسان حاضرًا في ذلك النمط من الحياة لفهم أيّ مجال لغوي أو فهم لعبته اللغوي. إنّ الألعاب اللغويّة وأساليب الحياة مثل العلم والدين والفلسفة، لها قواعد ومعايير مشتركة؛ ولذلك يمكن
(73)الحكم عليها جميعًا بمعايير مشتركة، ولذلك فإنّه من الممكن تقويم أسلوب الحياة والقواعد التي تحكم لغته تقویمًا من الخارج؛ کما أن من الممكن فحص جميع المجالات والألعاب اللغويّة وتقويمها بمعيار واحد.
وعلی هذا الأساس، لا تكون الأطر العقليّة جزءًا من بنية الإنسان الوجودیّة، وبالتالي يمكنه الهروب من فخّها. إنّ الحياة والألعاب المتعلّقة بها والتاريخ والثقافة وما إلى ذلك، ليست أسوارًا تحدّ الإنسانَ. إن أنماط الحياة أو الثقافات أو العوامل الأخرى ربما تعطي الناس فرضيّات مسبقة وتجعلهم ينظرون إلى العالم من وجهة نظر خاصّة؛ لكن الإنسان لا يخضع لها أبدًا، ويمكن أن يتحرّر من تأثيرها. مضافًا إلی أنّ النتائج التي تؤخذ من الفرضيّات والمبادئ الفرضیّة النظريّة وغير المثبتة ستكون افتراضيّة؛ إلا إذا رجعت إلى أسسٍ بدیهیّةٍ ومعصومةٍ وغير قابلة للزوال.
والآن، بعد ما رفضنا ونفينا مذهب الإطار، فإن أحد أهم المواضيع المنهجيّة الأساسيّة والأكثر أهميّة، والذي له ارتباطٌ وثيقٌ بنظريّة المعرفة، هو دراسة الدور الذي تلعبه البارادایمات بمعنى الأسس، في المعرفة والحصول علی الواقع؟ ثم هل یتفوّق أساسٌ على الأسس أو البارادایمات الأخرى، وهل يمكن علی ضوء ذلك تفضيلُه على البارادایمات الأخرى؟ وإذا كان الجواب إيجابيًّا، فأيّ منها لديه الأفضليّة؟ وأي البارادایمات الأخرى يتّصف بأفضليّة أقل؟ وعلى افتراض أفضلية بارادایم على بارادایمٍ آخر، ما هو معيار وجود
(74)الأفضليّة وتفضيله على آخر؟ هل من الممكن تجاوز الأساس أو البارادایم والتفكير خارجَه بحرّيّةٍ؟ وهل المعرفة التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة حجةٌ؟ هل البارادایمات نوعٌ واحدٌ أم عدّة أنواع؟ وإذا كانت متعدّدة فما هي أنواعها؟
وعلی هذا الأساس فنحن في هذا البحث وبعد نفي مذهب الإطار، نستكشف التمييز بين الإطار العقلي والأساس وكذلك خصائصهما، وندرس إمكانيّةَ قبول البارادایمات بمعنى الأسس، وندرس أیضًا دور البارادایمات بمعنى الأسس في المعرفة والوصول إلى الواقع. وفي النهاية سوف ندرس أنواع البارادایمات بمعنى الأسس.
رأينا سابقًا أننا من خلال استكشاف المعاني أو الاستخدامات الاصطلاحية لكلمة (البارادایم)، نحصل على ثلاثة معانٍ واسعة: الإطار، والنموذج أو الأطروحة، والأساس. ورأینا أیضًا أن من بين هذه الاستخدامات أو المعاني الثلاثة، یُعتبر البارادایم بمعنی الإطار العقلي وجهةَ نظر مستحيلة وغير مقبولة. وأمّا البارادایم بمعنى الأساس أو بناءِ النظريّات على الأسس والمبادئ، فليس مقبولًا فحسب، بل هو أمرٌ لا يمكن إنكاره أو تجاهله؛ لأنّه نظرًا إلى وجود علاقات منطقيّة وسببيّة بين بعض القضايا، فقد تكون بعض القضايا أساسًا لقضايا أخرى، وهي تعدّ البناء الفوقي لتلك القضايا. وهذه العلاقة هي علاقة
(75)ذات اتجاه واحد، وليست علاقة ذات اتّجاهين. إنّ القضایا التي تعدّ البناء الفوقي مبنيّة على القضایا الأساسيّة، وليس العكس.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه لا يمكن استخلاص أيّ نتيجة من أيّ قضیّةٍ، ولا يمكن التوصّل إلى أيّ نتيجة استنادًا إلى أيّ قضیةٍ، بل ليس لكلّ قضیّةٍ سوى نتيجةٍ خاصّةٍ. فإذا تمّ قبول القواعد والمبادئ والأسس التجريبيّة واعتبارها الأساس، فإنّ هناك نتائج تقوم عليها، ولا تقوم على أسس ومبادئ أخرى. وإنّ الأسس المعرفيّة والأنثروبولوجيّة والوجوديّة للحكمة الإسلاميّة، لها نتائج لا تتمتّع بها العلوم الفيزيائيّة والتجريبيّة وما إلى ذلك. ومثل هذه الظاهرة تختلف عن أسطورة الإطار، فإنّ الذهن بحسب مذهب الإطار أسير للمصنوعات المسبَقة ولا يستطيع الهروب منها؛ وأمّا بحسب نظریة الأساس، فليس الذهن محاصرًا بأيّ مصنوعٍ مسبقٍ أو بناءٍ، وإنّما هو مقيّد ببنية القضایا، لا ببنية الذهن. وبين هذين الأمرين فرق شاسع: أن تكون أسيرًا لبنية العقل، وأن تكون في سياج بنية القضيّة هو وجهة نظر واقعيّة، بینما النظرة الأولى هي وجهة نظر نسبيّة. ووفقًا لوجهة النظر الثانية، فمن الممكن تجاوز القضيّة وتقويم الخيارات الأخرى، ولكن بناءً على وجهة النظر الأولى، فإنّ مثل هذا الأمر غير ممكن.
وبالتالي، وبناء على هذا الاستخدام، يمكن القول أنّه: لا شكّ في أنّ النظريّات في العلوم وخاصّة في العلوم الإنسانيّة، وحلولَها تقوم على مبادئ خاصّة، أهمّها الأسس المعرفيّة والأنطولوجيّة
(76)والأنثروبولوجيّة. وأي أساس مقبول في نظريّة المعرفة أو الأنطولوجيا أو الأنثروبولوجيا، فإنّ نتائجه تحدث في حلول ونظريات العلوم الإنسانيّة. على سبيل المثال: فإنّ للمدرسة الوضعيّة في نظريّة المعرفة نتائج غير نظریّة المثالية فیها، كما أنّ للاتّجاهات الجندریّة نتائج مخالفة للاتّجاهات البديلة. إنّ تأثيرات هذه الاتّجاهات ونتائجها في مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والإدارة والعلوم التربويّة وغيرها من مجالات العلوم الإنسانية ملموسةٌ. يمكن فهم هذا الارتباط بسهولة من خلال النظر في العلوم الإنسانيّة والتفكير في الحلول والنظريّات المقترحة. فإثبات هذا الارتباط ليس بأمرٍ صعبٍ، بل يثبت الادّعاء المذكور من خلال النظر من الخارج إلى العلوم الإنسانيّة ومراجعة فرضيّاتها ونظريّاتها. توجد اختلافاتٌ جوهريّةٌ في الفكر الإسلامي بين المبادئ والأسس الحاصلة وبين بناءاتها الفوقيّة مع المناهج المعرفيّة الأخرى. ويمكن عن طريق ترتيب هذه المبادئ، سواء أكانت معرفيّة أو وجوديّة أو أنثروبولوجيّة وغيرها، بجانب بعضها بعضًا لتحقيقُ نظامٍ خاصٍّ منطقيٍّ وعقلاني. والعلوم الإنسانيّة هي إحدى البنى الفوقيّة الناشئة عن تلك الأسس، وهي متوافقة معها.
وعلی ضوء ذلك، فإن بناء النظريات على أسس ومبادئ خاصّة، ليس بلا محذورٍ فقط، بل هو في حدّ ذاته رمزٌ لنظریّة الواقعیّة. ويقصد بلفظ (المبادئ) أو (الأسس) القواعدُ العقليّة أو العقلانيّة العامّة التي هي الأسس. والحقيقة أن معناها اللغوي هو المقصود هنا. ولذلك فإنّ الأسس أو المبادئ المعرفيّة والوجوديّة والأنثروبولوجيّة
(77)هي أسس النظريّات والحلول في العلوم المختلفة، وخاصة العلوم الإنسانية. ومثل هذا الموقف مقبول ولا ریب فيه، بل ولا يمكن إنكاره.
ونستنتج ممّا سبق أنّ البارادایم بمعنى بناء النظريّات على الأسس والمبادئ، هو موقف مقبول بل لا يمكن إنكاره. وعلی ضوء استخدام البارادایم بمعنى بناء النظريات على الأسس، فإن البارادایمات هي الأسس لأيّ مجال من مجالات العلوم. ويتمّ تنظيم النظريّات العلميّة، بما في ذلك العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والطبيعيّة، بل النظريّات الفلسفيّة ومطلق النظريّات العلميّة أيضًا، على أساس البارادایمات بمعنى الأسس. ويمكن اختبار هذا الادّعاء وتقويمه من خلال تجربةٍ ذهنیّةٍ شهودیّةٍ.
وعلى هذا، يتم بهذه الأسس إنشاء نظام رؤيوي وعقدي للمفكر. إنّ هذا النظام الذي يمكن تسميته بالنظام الفكري مقابل النظام العملي، يقوم على أسس مختلفة. ويمكن ذكر أربع أو خمس فئات من الأسس على الأقل: الأسس المعرفيّة، والوجوديّة، والقیمیّة، والمنهجيّة والأسلوبیّة. بل يمكن إضافة أسس أنثروبولوجيّة إلى هذه المجموعة. وإذا أضفنا البارادایم الأنثروبولوجي، يصبح نطاق هذه المجموعة أوسع. فمثلًا وجهةُ النظر الخاصّة التي يختارها الباحث في الأنثروبولوجيا وإجابته الأساسيّة لهذه المسألة، وهي أنّ الإنسان هل يقتصر على البعد المادي والسلوك الجسدي أم أنّه يتعدّى ذلك، خاصّ في دراسة الباحث وفي الأساليب التي يستخدمها في تلك العمليّة.
(78)وعلى أيّ حالٍ، يتکوّن علی ضوء هذه الأسس أو البارادایمات نظامٌ فكريّ وعقديٌّ في الفكر الإنساني، ویعتبر هذا النظام أساسًا مفترضًا لأيّ بحث. ولا يمكن تنظيم أي بحث من دون مثل هذه الأسس أو الفرضيّات. وبما أنّ الأسس متنوّعة ومختلفة جدًّا، فإنّ نتائج الأبحاث ستكون عديدة ومختلفة جدًّا أيضًا. ويرجع أصل ظهور المدارس المختلفة إلى هذا السبب غالبًا. وظهرت بسبب تلك البارادایمات مدارسُ مثل الإنسانيّة والماركسيّة والليبراليّة والنسويّة والعنصريّة والقوميّة والتعصّب العرقي، وتختلف وجهة نظر كل منها وتتعارض أحيانًا، ومصدر هذه الاختلافات والصراعات هي الأسس المعرفيّة والوجوديّة والقيمیّة وغيرها والتي اختاروها. ويسعون من خلال النظرة المأخوذة من تلك الأسس، للإجابة عن القضایا الفرديّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والقانونيّة والأسريّة وما إلى ذلك.
لذلك لا بدّ للباحث، قبل البدء في أي بحث، من توضيح موقفه أمام تلك الأسس، وأن يرى أنّه اختار أي أساس في المجالات المذكورة، سواء أتمّ اختیاره بقصد أم بغير قصد. إنّ الشخص الملتزم بالوضعيّة المنطقيّة في مجال نظريّة المعرفة، والذي يعتدّ بالحواس الظاهریة ومنتجاتها فقط، فإنّ وجهة نظره الأنطولوجيّة تؤدّي إلى النزعة الطبيعيّة أو المادّيّة (الفيزيائيّة)، ويعتبر الوجود مساويًا للمادّة، ثمّ سينكر في مجال الأنثروبولوجيا الأبعادَ غير المادّيّة للإنسان، ثم سيعتمد في مجال المنهجيّة على الخبرةِ الحسّيّة والأساليب المبنيّة على الحواس الظاهریّة فقط. ويستند إلى المعرفةَ التي يتمّ الحصول
(79)عليها من مصادر وطرق أخرى باطلة وهکذا...
وعلی ضوء النموذج أعلاه يمكن الوصول إلى نقطة أخرى، وهي أنّ مجموعة الأسس أو البارادایمات المذكورة أعلاه ليست هي وحدها التي تلعب دورًا في ظهور النظريّات العلميّة، وبالتالي كلّ مجموعة من الأسس سيكون لها نظريّتها الخاصّة، بل هناك علاقة وثيقة وارتباط لا يمكن إنكاره بين فئات الأسس أو البارادایمات أيضًا. النظريّة المعرفيّة الخاصّة لا تكون منشأ لأيّ وجهة نظر، بل ينشأ منها موقف أنطولوجي أو أنثروبولوجي يتوافق مع تلك القراءة المختارة المحدّدة. وإذا ظهرت مثل هذه المجموعة من الرؤى التي يجب أن تكون مكوّناتها مرتبطة ببعضها، فيتمّ حینئذ إنشاءُ نظام يؤثّر على أسلوب البحث ونتائجه، فمثلًا عندما يواجه الفقيه الذي يبحث في مجال الأحكام العمليّة رواية يدلّ مضمونها على قیام الأئمّة المعصومين عليهمالسلام بفعلٍ مکروهٍ، فإذا كان اعتقاده مبنيًّا على أن الإمام المعصوم لا يفعل الفعل المكروه، فإنّه سوف یرفض تلك الرواية ویُعرِض عنها، حتّى إذا كانت معتبَرة من حیث السند، وذلك لأجل هذه المشکلة في مفادها. أو إذا صادف الباحث حديثًا يدلّ على سهو النبيّ أو سهو الإمام، فإذا كان اعتقاده مبنيًّا على أنّ النبي الكريم والأئمّة المعصومين لا يقعون في هذه الحالة، فإنّه یرفض هذه الأحاديث كما یرفض الأحاديث التي يخالف مضمونها كتاب الله، وإن صحّ إسنادها. وعلی هذا الأساس، عندما يستكشف الفقيه في مجال الفقه أو يستكشف المؤرخ في مجال التاریخ حياةَ النبي الكريم والأئمّة المعصومين، وما إلى ذلك، فإنّهما يُجريان
(80)بحثهما على أساس هذه الأسس أو البارادایمات التي سبق قبولها. والأحاديث التي تدلّ على سهو النبي تُعتبر باطلة ومرفوضة، وإن ترتّبت علیها عدّة أحكام، وحتی إذا کانت دلالتها نصًّا صريحًا من حیث المفاد ومعتبرة من حیث الإسناد.
ویتحصّل من ذلك، أنّ ظهور المدارس المختلفة هو نتيجة لبارادایمات أو مبادئ متعددة، فإنّ وجهات نظر هذه المدارس مختلفة، وغالبًا مّا تتعارض مع بعضها. وينشأ هذا الاختلاف في وجهات النظر عن الرؤی الکونیّة المختلفة، وتتكوّن كل رؤيةٍ کونیّةٍ من مكوِّنات وعناصر اعتقاديّة مختلفة. وإذا قَبِل الباحثُ تلك المكوّنات الاعتقاديّة، فإنه ينقلها إلى مجال البحث ليکوِّن منها نظريّةً أو نموذجًا يعتمد عليها.
وعلی ضوء ذلك، فإنّ المعرفة العلميّة والعلوم الطبيعيّة والاجتماعيّة بل والعلوم الإنسانية، تُفسِّر الواقع بناءً على الأسس والبارادایمات. ولا يمكنها تجاوز الأسس والبارادایمات، ولا يمكن من خلال المعرفة العلمية انتهاكُ بارادایمٍ أو رفضه؛ کما لا يمكن تأكيد ذلك وإثباته أیضًا؛ لأنّ المعرفة العلميّة مبنيّة على أساس أو بارادایمٍ، وبالتالي فإنّ المعرفة العلميّة والبارادایم ليسا في مرتبةٍ واحدةٍ، فمن حيث المرتبة لا يمكن للمعرفة العلميّة أن تطعن في البارادایم أو أن تُثبته. إنّ مرتبة كل معرفة علميّة تُساوي المعارف العلميّة الأخرى التي يتمّ الحصول عليها من خلال البارادایمات الأخرى والمبنيّة عليها، فمثلًا الإيمان بالله والتوحيد هو مبدأ عقديٌّ يمكن أن ينظِّم
(81)رؤية خاصّة عقدیّة، وهو أحد أسسها. ولا يمكن استخدام العلم لإثبات هذا المبدأ؛ لأنّ مستوياتها مختلفة، وهذا الأساس ليس في مستوى المعارف العلميّة. يمكن من خلال استخدام هذا المبدأ، الحصولُ على معارف تختلف بشكلٍ كبيرٍ عن المعارف القائمة على المبادئ الوضعيّة والتجريبيّة والفيزيائيّة وما شابه ذلك.
ولا بدّ من التأكيد على مسألة مهمّة، وهي أنّ المقصود بالبارادایم هنا هو الأساس دون الإطار. والقول بأنّ البنيات الفوقيّة لا تُسبّب الشك في الأسس والمبادئ، ولا یمکن هدمها بها، فمثل هذا الحكم هو نفس أحكام الإطار. وهذا الأمر المشترك لا يلزم منه أن يكون الأساس هنا بمعنى الإطار. نعم، بطبيعة الحال، يمكن تقويم كل بناء فوقي من خلال انتقادات البنية الفوقية، ولكن البنى الفوقيّة إنما تسقط من حیث الجذور عندما تم رفض أساسها أو أسسها وإبطالها وانتهاكها.
وعلى أيّ حالٍ، فإنّ الفرضيّات المسبقة للعلوم الطبيعيّة أو الإنسانيّة أو الاجتماعيّة، والتي تلعب دورا أساسيًّا في إعطاء هويّة للعلم، هي بارادایمات العلوم الإنسانيّة أو أسسها. وتوفّر تلك البارادایمات المعرفيّة والوجوديّة والقیمیّة والأنثروبولوجيّة والمنهجيّة والأسلوبیّة
مجموعة من القضايا التي يمكن من خلالها الإجابةُ على الأسئلة التي تفتحها المعرفة الإنسانيّة أو الطبيعيّة أو الاجتماعيّة أمام الإنسان، على سبيل المثال: يرتكز البارادایم الوضعي على مجموعة من الرؤى التي لا يمكن على ضوء نظريّة المعرفة فیها ومصادرها المعرفيّة، الحصولُ علی المعرفة الصحيحة إلّا من خلال التجربة الحسّيّة والحواس الظاهرة. ووفقًا لوجهة النظر هذه أو استنادًا إلى هذا الأساس، فإنّ المعرفة العلميّة يتمّ الحصول عليها من خلال الطرق العلميّة التجريبيّة ولا شيء غير ذلك الطریق. وفي مقابل هذا الموقف، فإنّ رأي أنصار الهرمنوطیقیا (الرومانسي) وأمثال ديلتاي هو أنّ مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة يختلف عن العلوم الطبيعيّة ولا يمكن إجراء البحث فيها بطريقة واحدة. يتمّ بناءُ الواقع الاجتماعي من وجهة نظر البارادایم التفسيري على أساس الفهم الذاتي للإنسان، بدلًا من كونه ظاهرة موضوعيّة. إنّ التنبّؤ غير ممكنٍ من وجهة نظر مؤيّديه. بينما من وجهة نظر الوضعيّين فإنّ التنبّؤ ممكن والسيطرة ممكنة.
نصل من خلال التأمّل والنظر العمیق في خصائص البارادایم أو الأساس، إلى نتيجةٍ مفادها أنّ البارادایم هو المفروض المسبق لأي بحث في العلوم البشریّة، بما فيها العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والتجريبيّة؛ بل يوفّر البارادایمُ طريقَ البحث والوصول إلی نتائج
خاصّة مبنيّة على نفس البارادایم. إنّ البارادایم أو الأساس هو الذي يحدّد کیفیّة العلاقة بين النظريّات العلميّة و طرق البحث في العلوم البشریّة. تُعطي البارادایمات مثل البارادایمات المعرفيّة والوجوديّة والمنهجيّة، التوجيهَ للعلاقة بين النظريّة العلميّة وطريقة البحث. وهي تحدِّد هويّة العلم. إنّ طريقة البحث هي في الواقع التقنياتُ أو المهارات الخاصّة لجمع المعلومات، ويتمّ فيها تناول مسألة كيفيّة الحصول على المعلومات الموثوقة وجمعها. إنّ منهجيّة البحث هي منطق البحث، ومسألتها الأساسيّة هي فحص المناهج والأسالیب الصالحة وتقويمها في كلّ من العلوم البشریّة المتعدّدة.
يتناولون في نظريّة المعرفة أسئلةً من هذا القبیل: كيف يمكن الحصول على المعرفة الصحیحة؟ ما هي المصادر التي يمكن الاعتماد علیها من أجل الحصول على معرفة صحیحة؟ و... يتمّ في مجال الأنطولوجيا تحديد ما هو موجودٌ. هل الوجود يقتصر على الأشياء المادّيّة التي يمكن فهمها من خلال الحواس الظاهریّة فقط، أم أنّه من الممكن تجاوزها؟ وكما ذكرنا سابقًا، هناك العديد من المدارس التي تكون إجاباتها على الأسئلة المذكورة أعلاه مختلفة وحتى متضاربة. کما أنّ هناك العديد من المدارس والاتّجاهات المختلفة والمتضاربة في مجال القيمة المعرفيّة أیضًا.
كما تقدّم سابقًا، فإنّه يتمّ توفير مجموعة منسّقة ومتناسبة تنظّم البحث وتوجّهه عن طريق عدّة بارادايمات أو أسس ذات صلة، وتشتمل كل مجموعة من البارادایمات، حسب الاستقراء، على ست فئات من الأسس على الأقل: المعرفيّة، والمنهجيّة والأسلوبیّة، والوجوديّة، والقيميّة، والأنثروبولوجيّة. ويمكن للمرء من خلال التفكير والنظر العمیق في المجالات التي تشكّل كل مجموعة من البارادایمات أن یصل إلى الأسئلة الأساسيّة والمحاور الرئيسيّة للبارادایمات. ولكلّ مجموعة بمجالاتها المختلفة مكوّنات وعناصر أساسيّة، وهذه المكوّنات هي المحاور الأساسيّة والمکونات التي تشكّل كل مجموعة. ولا بدّ من الإجابة على بعض الأسئلة قبل الدخول في أي علم، وذلك من خلال هذه المكونات ومع هذه البارادایمات أو الأسس، بحيث يكون الجواب ناشئًا من مجال البارادایمات. ولا ينبغي البحث عن مثل هذه القضايا داخل العلوم الإنسانيّة والطبيعيّة، بل ينبغي توفيرُ رأس المال المعرفي الناتج عن الإجابة على هذه الأسئلة قبل الدخول في أيّ علم. إنّ كل باحثٍ يسعى إلى حلّ مشكلة علميّة يواجه هذه المشكلات طوعًا أو كرهًا، ويجب أن يحصل على إجاباتها ويتعامل مع المشكلات الداخليّة للعلم استنادًا إلى هذه الأسس والمعطيات. وتلك المسائل التمهیديّة هي کالتالي حسب الاستقراء: ماهیة الواقع، وكيفیّة معرفته، وحقيقة الإنسانيّة، وما هو العلم والبحث العلمي، وتفسير نسبة العلم إلى القيمة.
(85)إنّ ماهیة الواقعیّة موضوع وجودي. ولمّا كانت المذاهب في الإجابة على هذا السؤال متنوّعة وكثيرة، فسوف تتعدّد البارادایمات أیضًا. على سبيل المثال: إن التجريبيّین والوضعيّین، بما أنّهم یعتبرون الوجود مقتصرًا على الكائنات الحسّيّة فقط، فإنّهم يعتبرون الواقع مساويًا لِما يمكن إدراكه من خلال الحواس الظاهرية.
بعد التسليم بهذا المبدأ وهو أن ثمّة حقيقة في الجملة، يُطرح أمامنا هذا السؤال: كيف يمكننا تحقيق الواقع ومعرفته بشكل صحيح؟ إن مثل هذه المواضيع هي أهم قضايا نظريّة المعرفة. وبما أنّ المدارس في الردّ على مثل هذه الأسئلة المعرفيّة متنوّعة وكثيرة، فإنّ البارادایمات سوف تتعدّد من هذه الناحیة.
من أهمّ المسائل التي يجب الإجابة عليها قبل الدخول في العلوم هي الأسئلة التالية: ما هي حقيقة الإنسان؟ هل هو هذا الجسد المادّي فقط أم أن له بُعدًا مجرّدًا يسمّى (الروح)؟ وهل حياته مؤقّتة أم أبديّة؟ هل هو مختار أم مجبر؟ تتنوّع إجابات المدارس على هذه الأسئلة، وبناء على ذلك، فإن البارادایمات ستكون عديدة أیضًا من هذا المنطلق.
إنّ تحدید الهوية العلميّة وحقيقتها یقومان على البارادایم؛ والبارادایم هو الذي يوجّههما. أمّا فيما يتعلق بالعلم فيطرح هذا السؤال: هل للعلم هويّة واحدة أم لا؟ هل العلم هو المعرفة العامّة نفسها أم أنّه يختلف عنها؟ هل يتمّ البحث في العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة أو الاجتماعيّة بطريقةٍ واحدةٍ، أم لأجل أن هويّتها مختلفة فإنّ طريقة البحث ليست واحدة فيها؟ وهذا النوع من الأسئلة یشکل البارادایم. وقبل الدخول في العلم والبحث، ينبغي إيجاد حل لهذه الأسئلة لأجل أن یتمکّن من التعليق على هدف البحث العلمي.
توجد اليوم اختلافاتٌ في حقیقة (الشرح والتفسیر). كان التفسير في السابق يعتبر مساويًا لانکشاف العلّة والسبب، ولكن الآن خضع معنى هذا المصطلح للتغييرات. إن توضيح معنى كلمة (التفسیر) يعتمد على توضيح ماهية العلم ونوع العلم الذي نناقشه. تُشرح ماهیة العلم في مجال بارادایم العلم؛ ولذلك يتمّ توضيح مفهوم التفسير في مجال البارادایم وقبل الدخول في العلم. ويتمّ تنظيم التفسير متوافقًا مع تعريف العلم، کما يجد معناه ويستخدم في العلم.
هل العلم محايد من حیث القيمة أم أنّ له قيمة؟ إنّ الحديث عن
قيمة العلم وأصل أيّ إجابة على هذا السؤال يتعلّق ببارادایمات العلم. تحدّد مجموعة بارادایمات العلم أنّ العلم محايد من حیث القيمة أم أن له قيمة. على سبيل المثال: من وجهة نظر الوضعيّين وبناء على أسسهم، فإنّ العلم له طابع نفعي، وبالتالي يفقد القيمة. وفي مقابلهم، يرى أنصار التفسيريّة أنّ العلم ينقل المعنى الذهني للفاعلين وله قيمة إنسانيّة.
توصّلنا ممّا سبق إلى نتيجة مفادها أنّ البارادایم بمعنى الإطار العقلي يتطلّب النسبيّة وهو غير مقبول. كما أنّ البارادایم بمعنى الأساس لا مشکلة فیه، بل هو وجهة نظر مقبولة. ولكننا الآن أمام هذه القضيّة الجوهريّة، وهي أنّه ما هو دور البارادایمات بمعنى الأسس في المعرفة وتحقيق الواقع؟ وبالتالي فإن هذا الموضوع إنما يُطرح بعد أن نقبل مثل هذه البارادایمات التي تعني الأسس، ولا نرفضها مثل المصطلح المذكور.
ويمكن القول باختصارٍ: نصل من خلال قليل من الاستكشاف والتأمّل في مجموعة معارفنا، ومع الخبرة الشهودیّة والداخليّة، إلى نتيجة مفادها أنّ البارادایم بمعنى (أساس الفكر) هو أمر مقبول،
بل هو حقيقة لا مفرّ منها. إنّ كل سلوك فإنّه مبني على فكرة، وكل فكرة فإنّها مبنيّة على أساسٍ أو أسس فکریّة وقيمیّةٍ خاصّة. وبالتالي، فإنّ مصطلح البارادایمات المقبول وغير القابل للإنكار يُقصد به مجموعة من المبادئ الفکریّة التي تحكم النظريّة. ويتم اكتشاف النظريّات والمسائل وتقويمها في أيّ معرفة، علی ضوء تلك المجموعة من الأسس. ويعتمد التقويم والحكم، مثل التفسير والتحليل، على تلك المجموعة من الأسس.
تنبع استراتيجيّات البحث من الأسس الفكريّة، ولذلك يتمّ تنظيمها وتشكيلها ضمن أسس فكريّة. وبما أنّ الأسس الفكريّة مختلفة، فإنّ استراتيجيّات البحث المبنيّة عليها ستكون مختلفة أيضًا. والأسس الفكريّة متنوّعة: حيث إنّ مجموعة منها معرفيّة؛ ومجموعة أخرى منها وجوديّة وهكذا. ويتبيّن من خلال الاستقراء التامّ أن مجموعة الأسس التي تقوم عليها النظريّات أو القضایا، أو على الأقل أهمها وأکثرها جوهريًّا، هي كما يلي:
1. الأسس المعرفيّة.
2. الأسس المنهجيّة.
3. الأسس الأسلوبیّة.
4. الأسس الأنطولوجيّة.
5. الأسس الأنثروبولوجيّة.
تمّ اقتراح نظريّات معرفيّة مختلفة ومتضاربة في العصر الحديث منذ بداية عصر النهضة حتّى الآن، وخاصّة في النصف الثاني من القرن العشرين، وعددها كثير؛ بما في ذلك نظريّة المعرفة العقليّة، ونظريّة المعرفة التجريبيّة. ولكلّ منهما أنواع کثیرة ومتنوّعة. يتنوّع أيضًا عدد النظريات الوجودیّة في هذا الوقت، وخاصّة في القرن العشرين. وللأسس الأخرى وخاصّة الأسس القيمیّة، وضع مماثل للأسس المعرفيّة والوجوديّة، وهي عديدة أیضًا.
والآن وبعد إلقاء نظرة سريعة على تعريف الأسس المعرفيّة وتعريف علم نظریة المعرفة، سنلقي نظرة سريعة على نظریّات المعرفة المقدَّمة في العصر الحالي. ومن أهمّ نتائج هذا البحث الكشفُ عن دور الأسس في المعرفة وتحقيق الواقع.
إنّ المبادئ الأساسيّة التي تلعب دورًا أساسيًّا وحاسمًا في العلوم والنظريّات والمسائل العلميّة هي البارادایمات أو الأسس المعرفيّة. ولوجهة نظر الباحث المعرفيّة أثر عميق في التصدیق العلمي والقبول القلبي لنظريات ومسائل العلوم، سواء أكان في العلوم الإنسانیّة أم غير الإنسانیّة (العلوم الطبيعيّة). إنّ نتيجة الاتجاه التجريبي أو التجريبيّة المتطرّفة في نظريّة المعرفة هي السلوكيّة المتطرّفة في العلوم الطبيعيّة والفيزيائيّة وإنكار العناصر غير المادّيّة المؤثّرة وهکذا... ومن الواضح أنّ لنظريّة المعرفة الإسلاميّة التي
هي وجهة النظر المختارة أثر خاصّ في مجالات متعدّدة، بما في ذلك مجال البحث ومجال منهجيّة البحث. ومن ثمّ، فمن وجهة نظر هذا المقال، لا یصحّ الفصل بين الأسس والنظريّات القائمة عليها، أو الناشئة عنها.
ومن ناحية أخرى: فإنّ هناك في مقابل وجهة النظر المختارة في مجال منهجيّة البحث، موقفًا شكوكيًّا أو نسبويًّا، تقوم أسسه على ما يلي:
1. يُنظر دائمًا إلى العالم الطبيعي أو الاجتماعي من زاوية معيّنة ويُنظر إليه بطريقةٍ خاصّة.
2. إنّ جميع الملاحظات والتصوّرات البشريّة تخضع للبارادایم، سواء أکان بوعي أم بغير وعي.
3. يتمّ جمع المعلومات دائمًا بناءً على الأطر العقليّة الموجودة وعلى أساس البارادایم بمعنى الإطار والبناء العقلي.
4. لا توجد ملاحظة محايدة، بل هي تصاحب النظريّة. إنّ كل إنسان إنّما يری العالم الطبيعي أو الاجتماعي بناءً على التصوّرات الخاصّة التي تشكّل جزءًا من بنية عقله، وعلی ضوء النظريّة الراسخة في عقله.
5. لا تعتمد الملاحظات وجمع المعلومات على البارادایمات أو الأطر العقليّة فقط، بل إنّ معيار أو معايير تقويم المعرفة أیضًا هي من نتائجها وهي تابعة لها.
6. لا توجد معايير ماوراء البارادایم يمكن على أساسها اختيار بعض البارادایمات؛ لأنّ تلك المعايير هي نتيجة للبارادایمات أیضًا ولا يمكن فصلها عنها. ولذلك لا يمكن تجاوز ذلك الإطار العقلي. والعقل البشري أسير لتلك الأطر العقليّة.
كما أنّه لا یصحّ الفصل بين الأسس والنظريّات المبنيّة عليها أو الناشئة عنها، کذلك الموقف الشكوكي أو النسبي المذكور آنفًا هو أيضًا خطأ جدًّا. وكما رأينا في الفصل السابق، يمكن تقديم العديد من الحجج ضدّ هذا الموقف، وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول: إنّ منهجيّة البحث هي العلم الذي يدرس قيمة أساليب البحث، ومهمّتُهُ تمهيد الطريق البحثي الصحيح والصالح. ونستنتج علی ضوء الموقف المذكور وتعاليمه، أنّ الناس لا يستطيعون أبدًا أن يقوموا بالبحث الصحيح للوصول إلى الحقيقة، بل هم دائمًا مسجونون في خيوطهم العقليّة مثل دود القز، غارقون في مستنقع الجهل، وهم تائهون في برهوت الظلام. إنّ نتيجة أي تحرّك هي المزيد من الغرق في مستنقع الأوهام والأفكار العقليّة الفارغة. ووفقًا لهذا الموقف، فإنّه بدلًا من السير عبثًا في محيط الجهل وبدلًا من مواجهة الأمواج الرهيبة، فإنّ الطريقة الأفضل والأكثر حكمةً هي أن يستسلم الناس ويتوقّفون عن البحث عن الحقيقة؛ لأنّهم مسجونون في مأزق معرفي ولا سبيل لهم إلى الحقيقة. وإذا كانت حيرة الإنسان لا نهاية لها، ولا يستطيع أن یعرف نفسه وعلّة وجوده والعالم الخارج عن نفسه، وهو يتجوّل في وادي التردّد، فلماذا ينخرط في منهج البحث ثمّ في البحث؟
یواجه المنهجيّون العديدَ من التحديات في مجال البحث؛ بما في ذلك التحدّيّات الشكوكیّة والنسبيّة، لكن هذه التحدّيّات يمكن حلّها، وبالتالي یمکن الوصول إلی الواقع، ولکن مع التنقيب العميق والصعب والجهد الدؤوب. إنّ المعرفة ليست ظاهرة اجتماعيّة، على عكس اللغة. يستطيع الإنسان أن يحقّق المعرفة في مجال الفلسفة والمنطق وحتّى في أجزاء من مجال الظواهر الحسّيّة والتجريبيّة. وعلى الرغم من أنّ معرفة الإنسان محدودة بحسب قدراته، ولا يمكن أن تتوسّع إلّا إلى حدّ معين، فإنّه يصل إلى الحقيقة بنفس ذلك الحدّ المعيّن. ويستطيع بشكل عامّ التعرفَ على الحقائق كما هي. إنّ خطّة البحث المسمّاة (التنقيب العميق في نظريّة المعرفة) التي جاءت في خمسة مجلّدات، هي وثيقة تشرح وجهة النظر هذه وتُثبتها.
إن الأسس المعرفیة مرکّبة من كلمتين؛ فمن الضروري لتعریفها تعريفُ كلتا الكلمتين بشكل منفصل.
من الكلمات الأساسيّة التي تحتاج إلى التوضيح في هذه المقالة
هي كلمة الأسس أو المبادئ. وتعني هذه الكلمات القواعد العقليّة أو العقلانيّة المشتركة التي هي أساس الأفكار والنظريّات. وفي الواقع إنّ المقصود منها في هذا الكتاب نفس معناها اللغوي. نعم، يكون ذلك المعنى اللغوي محدودًا ومخصّصًا بالقواعد العقليّة أو العقلائیّة. إنّ الأسس الفكریّة متنوّعة. وكما تقدّم سابقًا فإنّه یتّضح من خلال البحث والاستقراء الشامل، أنّ مجموعة الأسس التي تشكّل أساس النظريّات أو القضایا، أو على الأقل أهمّها وأکثرها أساسیًّا هي ما يلي: الأسس المعرفيّة، والأسس الأنطولوجيّة، والأسس الأنثروبولوجيّة، والأسس القيمیّة، والأسس المنهجيّة والأسلوبیّة. إنّ الأسس المعرفيّة هي المبادئ أو القواعد الأساسيّة التي تشكّل أساس النظريّات والعلوم الأخرى. إنّ هذه الأسس التي تتفوّق حتّى على الأسس الأنطولوجيّة، مأخوذة من علم نظریّة المعرفة.
إنّ أذهاننا هي مخزن للقضایا والمفاهيم. نحن نعلم العديد من المفاهيم والنظريّات؛ وليس لدينا علمٌ بعدد لا يُحصى من المفاهيم والقضایا التي لا حدود لها في العدد. یُطرح أمام كل مفكر هذا السؤال: إلى أيّ مدى نحكم على القضایا التي توصّلنا إليها، وعلى أي أساس نعتبر بعضها صحيحًا وحقیقیًّا وبعضها الآخر كاذبًا وغير صحيح؟ كيف وبأي طريقةٍ نحل هذه المشكلة ونميّز الصادق منها من الکاذب؟ وهل هناك معيارٌ وطريقة لتمييز الحق من الخطأ، والصدق من الکذب؟ هل يمكن استكشاف كل تصدیقٍ
(94)على حدّة ومعرفة صحّته أو كذبه، أم يجب أن نفحص مجموعة من الاعتقادات والأحكام والقضايا في شبكة؟ وهل يمكن اعتبار مجموعة من المعارف أمرًا مفروغًا عنه دون الاعتماد على مجموعة من المعلومات واعتبار تلك المبادئ فرضيّات مسلّمة، وحلّ مشاكل المعرفة الإنسانيّة بناءً عليها؟ ومن ناحية أخرى، هل توصف المفاهيم أيضًا بأنّها صادقة أم کاذبة؟
وبالإضافة إلى ما سبق، هناك مسألة أخرى أمامنا، وهي: ما معنى الحقیقة والخطأ أو الصدق والکذب؟ وما دام لم يتبيّن ما هو الحقیقة والخطأ أو الصدق والکذب لا يمكن مناقشة معيار تمييز الصدق والکذب.
ويمكن البحث بعنايةٍ ودقّةٍ فيما يتعلّق بمجموعة من القضایا ومنها: من أين تمّ الحصول عليها ومن أيّ مصدر أو أداةٍ حصلنا عليها؟ ومن خلال أيّ مصدر نقبل بعضها ونرفض بعضها الآخر؟
ومن ناحية أخرى، كم عدد المفاهيم أو التصوّرات التي یتكوّن منها كل تصدیقٍ أو قضیّةٍ؟ وما أصل هذه التصوّرات أو المفاهيم؟ وبأيّ مصدرٍ أو طريقةٍ يمكن التعرّف علی هذه التصوّرات أو المفاهيم التي هي مكوّنات هذه القضایا؟ وهل التصوّرات فطريّة للعقل، بمعنى أنّ العقل البشري عندما خُلق إنّما خُلق بحيث يعرف هذه المفاهيم، وهذه المفاهيم موجودة في الطبيعة البشريّة مثل بعض القوى؟ و...
(95)تعتبر هذه المواضيع من أهمّ قضايا نظريّة المعرفة. وبهذا يمكن اعتبار نظريّة المعرفة علمًا يبحث ويحلّ مثل هذه المواضيع التي تعتبر من أهم القضايا الإنسانيّة؛ ولذلك فإنّ نظريّة المعرفة هي علم يبحث في قضايا مثل ماهية المعارف الإنسانيّة، ومصادرها أو طرق الحصول علیها، وأنواعها وتقويم هذه الأنواع، وتحديد معايير صدقها وكذبها. ومن الواضح أنّ التعريف المذكور أعلاه هو تعريفٌ من خلال القضایا وإنّ مثل هذه التعريفات صحيحة ولها تطبيق أكثر واقعيّة.
إن عدد نظریّات المعرفة والمدارس المعرفيّة التي أصبحت حتی الآن الأسسَ المعرفيّة لعلم المنهجية لكثيرةٌ. يمكن العثور على العديد من الأنواع منذ عصر النهضة وحتى الآن وخاصّة في النصف الثاني من القرن العشرين. يبيّن الرسم البياني أدناه أهم المدارس المعرفية؛ ومع ذلك، هذه ليست جميع المدارس الموجودة، وهناك مدارس أخرى أقلّ أهميّة ولكنّها عديدة ولها قائمة طويلة.
(96)يمكن تصنيف مدارس نظريّة المعرفة المختلفة بطرق مختلفة: تاريخياً، ومن حيث العلاقة بين المُدرِك (العالِم) والظواهر أو الأشياء التي تتعلق بها المعرفة، وهكذا.
يمكن تصنيف وجهات نظر ومدارس نظريّة المعرفة من حيث العلاقة بين المُدرِك (العالِم) والظواهر أو الأشياء التي تتعلق بها المعرفة، على النحو التالي:
1. ترتكز مجموعةٌ من وجهات النظر على محور إمكانية التعرف على الأشياء وإمكانية معرفتها. وبناءً على هذا الموقف توجد الأشياء. على سبيل المثال: الشجرة شجرة، أو القطة قطة، وما إلى ذلك، بغض النظر عمّا إذا كان المُدرِك (العالِم) يعرفها أم لا. وفي الوقت نفسه فإنّ وجودها في ذاته یُعرف كما هو، ويمكن للإنسان العالم أن يحصل علی معرفة حقيقتها في ذاتها. وبکلمة أخری: يمكن للمرء من خلال البحث اكتشافُ مفهومها وصورها الذهنيّة من خلال العلم الحصولي الذي هو العلم مع الواسطة، وبالتالي یمکن للمرء أن یصل إلی معرفتها. ولهذه الظواهر أو الأشياء واقع مستقل عن الذوات العالمة بها. ولا يمكن للذات العارفة إلا أن تفهمها، ولا تستطيع أن تفرض إطارها العقلي عليها. وتسمّى الآراء التي تؤكّد على مثل هذه التعاليم (الموضوعیّة).
2. يوجد عدد آخر من المدارس والآراء المعرفيّة هي عكس الفئة الأولى. وفقًا لهذه المدارس، ليس للأشياء دور كبير في معرفتها، بل إنّ الإنسان العالم هو الذي يخلق المفهوم أو صورة منها ويفرضه على الكائن الخارجي. وبما أنّ دور الشخص العالِم أساسي من وجهة نظرهم، والمراقبون لديهم وجهات نظر مختلفة، فقد يكون لديهم مفاهيم وصور مختلفة عنها والتي لا یمکن اجتماعها وتتناقض مع بعضها، وإذا زادت عدد المراقبين فستكون المفاهيم الجديدة أكثر. ومن وجهة النظر هذه، فإنّ معيار الحقيقة هو الإنسان.
ومن أجل الحصول على المعرفة الحقيقيّة، يجب جعل الكائن الخارجي مفهومًا ومعلومًا ذهنیًّا. إن معرفة الأشياء الخارجية إنّما تتحقّق بتحویلها إلی مفاهیم ذهنیّة، فالأشياء لا تُظهِر أنفسها كما هي، بل الإنسان العالِم یفرض علیها الطريقة التي ينبغي أن تَظهر من خلالها. إن مثل هذه المواقف هي أنواع من الذاتيّة.
3. ترفض مجموعة ثالثة من المدارس والنظريّات المعرفيّة كلا الرأيين الأوّل والثاني. ومن وجهة نظرهم يمكن أن يقال أنّه: «من ناحية، لا يتمّ اكتشاف المعنى، بل يتمّ إنشاؤه. وبدلًا من أن یوجد المعنى في الأشياء، فإنّ المراقب يلعب دورًا نشطًا في خلق هذا
المعنى. ومن ناحية أخرى، فإنّ هذه العمليّة الإبداعيّة محدودة بماهیة الأشياء نفسها: فمعناها هو نتيجة تفاعل الراصد مع الأشياء، ويجب علينا أن نضيف فهمنا السابق لذلك الكائن إلى معناه».
وبالإضافة إلى ما سبق، تنقسم المدارس والاتّجاهات المعرفيّة على النحو الآتي، وذلك من حيث المصادر المعرفيّة التي استشهدت بها:
1. التجريبيّة.
2. العقلانیّة.
ولكلّ واحد منهما أيضًا أنواع عديدة؛ منها أن التجريبيّة تنقسم إلى الوضعيّة الإثباتیّة، والدحوضيّة، وما إلى ذلك.
وهكذا تنقسم مدارس المعرفة بناءً على کیفیّة العلاقة بين العالِم والأشياء، إلى الموضوعيّة، والذاتيّة والبنائیّة؛ وتقسّم على أساس مصادر أو طرق المعرفة إلى العقلانيّة والتجريبيّة. ظهرت العدید من المدارس على أساس كل منهما، مثل الوضعيّة المنطقيّة
(100)والدحوضيّة والبراغماتيّة والعديد من المدارس الأخرى التي تندرج تحت التجريبيّة.
ويتأثّر الباحثون بالموقف أو المدرسة المعرفيّة التي قبلوها، ويتابعون بحثهم بلون تلك الأسس المعرفيّة وغيرها من الأسس أيضًا، سواء شاؤوا هذا التأثّر أم أبوا. إنّ كل نظام ومدرسة ونظريّة معرفيّة، لها علاقة عميقة بنوع من الأنطولوجيا. وتكون الأنطولوجيّات بشكل عامٍّ نتيجة لوجهات نظر ومدارس معرفيّة، وكل وجهة نظر وجوديّة تنبع من موقف خاص في نظريّة المعرفة. تحتوي الأنطولوجيات أيضًا على أنواع واسعةٍ. وبهذا تكون الأسس المعرفيّة، بالإضافة إلى الأسس الأنطولوجيّة المشتقّة منها، بمثابة الأسس لنشوء النظريّات في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والطبيعيّة.
كما رأينا في الرسم البياني السابق، توجد العديد من المدارس والنظريّات المعرفيّة، وتحكم بعضها فقط النظريّات والعلوم الإنسانيّة الشائعة. ويمكن سرد أهم المدارس والأسس المعرفيّة التي تحكم العلوم الإنسانيّة المعاصرة على النحو التالي:
1. الوضعيّة المنطقيّة.
2. التفسيریّة.
3. البنیويّة.
وعلی ضوء الأسس والمدارس المعرفيّة المذكورة أعلاه، ظهرت نظريّات ومدارس مختلفة في المنهجيّة. وكلّها من نتائج تلك الأسس والمدارس المعرفيّة. ويتطلّب التفكير الإسلامي أيضًا منهجية خاصة. وتُنتج نظريّة المعرفة الإسلاميّة منهجيّة خاصّة تختلف اختلافًا جوهريًّا عن المنهجيّات الأخرى.
وبما أنّ هناك نظريات معرفيّة كثيرة، ولكل منها وجهة نظر وإجابة ونتيجة خاصّة في منهجيّة البحث، فإنّ نظرة خاطفة إليها ووصف نتائجها يحتاج إلى بحث واسعٍ؛ وهو بحث مملّ ويستغرق الكثير من الوقت. ما هي طريقة البحث التي يجب أن نختارها في هذا المجال؟ وحتّى إذا نظرنا نظرة سريعة إلى كثرة وجهات النظر والمدارس المنهجيّة المستمدّة من كثير من وجهات نظر معرفيّة، ألا نصل إلى نتيجة مفادها أنّ نتيجة هذا التعدّد غير المرغوب فيه هو الشكوکیّة في منهجيّة العلوم؟ هل من الممكن تفضيل أحدهما على الآخر وبالتالي اختياره؟
وإذا أضفنا الأسس الأنطولوجيّة والأنثروبولوجيّة والقيميّة والمدارس العديدة في هذه المجالات إلى الأسس المعرفيّة والمواقف القائمة،
فإنّ المشكلة المذكورة تتضاعف. ألا تترتّب الشكوکیّة في منهج العلوم على كثرة وجهات النظر والمدارس في مجال الأسس المذكورة؟
يجب إيجاد حلّ المشكلة المذکورة في نظريّة المعرفة. وتوضیح ذلك أن أي حجة وبحث وخطاب يتمّ تنظيمه على أساس عدّة أصول متعارفة (بدیهیّة) وعدد من الأصول الموضوعة والمسلَّمة. والأصول المتعارفة هي قضایا عامّة تعتبر أسس كل المعرفة الإنسانيّة وتعدّ من البديهيّات الأوّلیة. إن هذه الأصول غير قابلة للزوال ولا يمكن الشكّ فيها، کما أنها ليست قابلة للإثبات ولا للنفی. ولهذا السبب لا يمكن تقديم حجّة حقيقيّة لإثباتها. إنّ كلّ المعرفة الإنسانيّة تحتاج إلى هذه الأصول، وكلّ عاقل يصدِّق بها إذا تصوّر أجزاءها تصورًا تامًّا.
إنّ الأصول الموضوعة المسلَّمة هي قضایا أساسيّة تعتبر مقبولة ومسلَّمة؛ ولكنّ يتمّ إثباتها أو ينبغي إثباتها في علوم أخرى. وإنما تسمّى هذه الأصول بالموضوعة لأنّ المخاطب يأخذها كأمر مسلّم به في المناقشة ويقبل محتواها. قال العلامة الحلّي:
«المبادئ هي الأشياء التي يبتني العلم ذو المبادئ عليها، وهي
(103)إمّا تصوّرات أو تصديقات؛ أمّا التصديقات فهي المقدّمات التي تتألّف منها قياسات ذلك العلم، وهي قضايا إمّا أولية لا تفتقر إلى بيان ولا وسط لها مطلقًا، وتُسمّى الأصول المتعارفة، وهي المبادئ على الإطلاق؛ وإمّا غير أوّليّة لكن يجب تسليمها ليبتني عليها، ومن شأنها أن يتمّ تبيينها في علم آخر، فلا وسط لها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه، فهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبتني عليها ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر، فهي ليست مبادئ على الإطلاق. وهذه المبادئ إن كان تسليمها في ذلك العلم التي هي مبادئ فيه على سبيل حسن الظنّ بالمعلم ومع مسامحة ما سمّيت أصولًا موضوعة وإن كان مع استنكار وتشكّك فيها سمّيت مصادرات».
یعتمد علم المنهجيّة نفسه على مبادئ بديهيّة، والتي تسمّى المبادئ المتعارفة. وإذا كانت جميع قضایا هذا العلم نظريّة، فلا بدّ من وجود منهج بحث لها؛ ونتيجة لذلك، تستمرّ هذه السلسلة إلى ما لا نهاية ولن نكتسب معرفة جديدة. وهكذا فإنّ كل اكتشاف ومعرفة جديدة مبنيّةٌ على معلومات سابقة. إنّ قبول هذا النوع من المعلومات هو نقطة بداية البحث ومن خلال تلك المعلومات يمكن توضيح المجهولات.
وعلی ضوء ذلك، فإنّ علم المنهجیّة يقوم على هذه الإشكاليّة
الأساسيّة: هل يستطيع الإنسان أن يكتشف المجهول ويكتسب معرفة جديدة، أم أنّ الطريق إلى المعرفة مسدود؟ وإذا كانت المعرفة ممكنة وطريقنا إليها مفتوحًا، فما هي الأشياء التي يمكن معرفتها؟ وما هي الطرق التي يمكن من خلالها اكتساب المعرفة حول تلك الأشياء؟
ومن الواضح أنّه للإجابة على السؤال المذكور، وكذلك لحلّ مشكلة الحيرة في مواجهة الأسس والبارادایمات المختلفة والمتضاربة، لا بدّ من معالجة مشكلة إمكانيّة المعرفة. إنّ حلّ المؤلّف أمام مثل هذه المسائل الصعبة هو أنّ طريق المعرفة مفتوح ويمكننا حلّ المشكلة المذكورة علی ضوء رأس المال المعرفي الذي هو المبادئ المتعارفة. ويمكن أن نستنتج من خلال تعريف المبادئ المتعارفة أنّ المبادئ الأكثر عموميّة للعلم هي تلك المبادئ المتعارفة والتي تُدرس في نظريّة المعرفة. وإذا قمنا بحلّ هذه القضايا في نظريّة المعرفة أو مابعد نظریّة المعرفة، فيمكننا البحث واستكشاف أي فئة من المعارف الإنسانيّة أو قضايا العلوم مثل الأنطولوجيا والأنثروبولوجيا ومعرفة الدين والعلوم الاجتماعية والعلوم الفلسفيّة والعلوم الطبيعيّة والعلوم الرياضيّة. وبالتالي یمکننا أن نستكشف ما هو منهج البحث في كل واحد منها.
يمكن القول مع مزيد من التفكير الدقيق: تبدأ نظريّة المعرفة نفسها أیضًا بالمعرفة. والإنسان لديه معارف بديهيّة هي رأسماله المعرفي، ومن خلالها يمكن تمييز الحق من الخطأ. إن إمكانية الوصول إلى
(105)المعرفة تتم مناقشتها في علم ما بعد نظريّة المعرفة فقط. كما تقوم نظريّة المعرفة أیضًا على عدّة رأس المال المعرفي: مبدأ امتناع التناقض، مبدأ السببية، أو مبدأ استحالة الترجيح من دون مرجّحٍ، ومبدأ الهوهوية.
وعلى أيّة حال، يعتمد البحث في أيّ علم على عدّة مبادئ متعارفة. وإنّما یمكن المناقشة مع شخص آخر إذا قبل هذه المبادئ أيضًا. وبعد قبول هذه المبادئ المتعارفة يمكن للمرء منطقيًّا إجراء بحث في علمٍ معين من العلوم، وحینئذ یمکن تحدید طريقة البحث التي ينبغي اختيارها في ذلك العلم. ولذا فإنّ الحديث عن تحديد منهج البحث في ذلك العلم، والذي يعد من أهم القضايا الأساسيّة لمنهجيّة البحث، يرتكز على قبول تلك المبادئ المتعارفة. ولا يمكن قبولها دون مناقشة الطريقة أو الأساليب التي ينبغي استخدامها للبحث والاستدلال وحلّ المشكلات العلميّة.
ذُکر في علم المنطق أیضًا ما یشابه الإشکاليّة المذكورة آنفًا، وهي مشکلة الدور. قال المحقّق الطوسي: «لو كان كلّ علم محتاجًا إلى المنطق لكان المنطق محتاجًا إلى نفسه أو إلى منطق آخر ينحل به».
وبناءً على هذه الإشكال، فإنّ المنطق یکون علمًا، وكلّ علم مبني
على المنطق ويحتاج إليه. لذا فإنّ المنطق نفسه يحتاج إلى منطق، فهو یبتني على نفسه. يجیب المحقّق الطوسي عن هذا الإشکال من خلال استخدامه مفتاحًا خاصًّا حيث يقول: «والقول: بأنه آلة للعلوم فلا يكون علمًا من جملتها. ليس بشيء لأنّه ليس بآلة لجميعها حتّى الأوليات بل بعضها، وكثير من العلوم آلة لغيرها: كالنحو للغة، والهندسة للهيئة». ثمّ أجاب عن الإشکال علی ضوء استخدامه المقدّمة، کما یلي:
«وذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق، لا جميعها، والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات ينسبه عليها وأوّليات تتذكّر وتعدّ لغيرها ونظريّات ليس من شأنها أن يغلط: كالهندسيّات التي يبرهن عليها، فجميعها غير محتاج إلى المنطق، فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقيّة، فلا يكون ذلك الاحتياج إلّا إلى الصنف الأوّل فلا يدور الاحتياج إليه».
وعلی ضوء استخدام المفتاح أعلاه يمكن الإجابة عن الإشكال المطروح في منهجية البحث، وبالتالي يمكن ذکر جواب المحقّق الطوسي نفسه على هذا النقد أیضًا في المنهجية، وهو: أن كل علم لا يحتاج إلى علم المنطق والمنهجيّة، بل بعضها لا يحتاج إلى العلمين رأسًا ولا يقوم عليهما. فإنّ البديهيّات الأوّلیة، بل الوجدانیّات أیضًا من وجهة نظر عامّة المفكّرين المسلمين، وجميع العلوم الحضوریّة أيضًا، کلّها من هذا النوع؛ مع أنّ المحقّق الطوسي لم يذكر هنا الأخیرین (الوجدانیّات والعلوم الحضوریّة).
وعلى أيّة حال، فإنّ المنطق والمنهجیّة يبنيان على مثل هذه المعارف البديهيّة التي لا تحتاج إلى الاكتساب والنظر. ومن خلال هذا النوع من المعارف تكتسب المناقشات حول البحث ومنهجيّة البحث والمنطق معنى. ومن الممكن أن نخطو خطوة أبعد ونقول: إنّ علم نظریّة المعرفة أیضًا، والتي هي من العلوم ذات الدرجة الثانية، مبنيّة على المعرفة، ودون تلك المجموعة من رأس المال المعرفي الواضح الذي لا جدال فيه، فإنّ أيّ بحث في نظريّة المعرفة هو طريق غیر صحیح. يبدأ الإنسان في نظريّة المعرفة، بالمعارف الیقینيّة، وهذه المعارفة يمكن أن تكون أسس صعوده المعرفي. وبالإضافة إلى الإجابات النقضیّة لأتباع الشكوكيّة والنسبيّة، يمكن تقديم مجموعة من المعارف الیقینیّة وغير القابلة للزوال. ولذلك فإنّ الشكوكيّة غير معقولة وغير عقلانيّة، بل الادّعاء بإمكانيّة العلم وتحقيقه أمرٌ معقول ولا يحتاج إلى دليل.
قد تناولنا في هذا الفصل إمكانيّةَ قبول البارادایم بمعنی الأسس، والدور الذي تلعبه الأسس في المعرفة وتحقيق الواقع. وممّا سبق توصّلنا إلى أنّ البارادایم بمعنى «أساس الفكر» ممّا لا مفرّ منه. وتابعنا المناقشة لأجل شرح الحلّ المقترح، وذلك من خلال إلقاء نظرة مختصرة على الأسس الفکریّة وأنواعها ودورها في المعرفة الإنسانيّة، ورأينا أنّ كلّ مجموعة من البارادایمات تحتوي حسب الاستقراء على ستّ فئات من الأسس على الأقلّ، وهي کما یلي: الأسس المعرفيّة، والوجوديّة، والقيمیّة، والأنثروبولوجيّة، والمنهجيّة، والأسلوبیّة. ويتمّ من خلال البارادایمات أو الأسس المترابطة من بين الأسس الستّة، توفيرُ مجموعةٍ منسقة ومتناسبة تنظّم البحث وتوجّهه.
منذ بداية عصر النهضة حتّى الآن، وخاصّة في النصف الثاني من القرن العشرين، تمّ إنشاء أنطولوجيّات وأنثروبولوجيّات ونظريّات معرفيّة مختلفة ومتضاربة، وهي كثيرة العدد. وقد ألقینا في الفصل الحالي نظرةً سريعة على السیماء العامّة لنظریّات المعرفة المقدّمة في العصر الحالي، وذلك بعد إلقاء نظرة سريعة على تعريف الأسس المعرفيّة وتعريف علم نظریّة المعرفة. إنّ أحد النتائج الأساسيّة لهذا الاستكشاف هو الكشف عن دور الأسس في المعرفة وتحقيق الواقع.
(109)ثمّ واجهنا سؤالًا صعبًا للغاية مفاده: إنّ النظرة الخاطفة إلى كثرة وجهات النظر والمدارس المنهجيّة المستمدّة من الأسس المعرفيّة والوجوديّة، ألا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ هذا التعدد غير المرغوب فيه یُسبِّب الشكوکیّة في منهجية العلوم؟ وما هي طريقة البحث التي يجب أن نختارها في هذه الحالة؟ هل من الممكن تفضيل أحدها على الأخری وبالتالي اختيارها؟
وقد رأينا أنّ حلّ هذا السؤال الذي هو المسألة المنهجيّة الأهم، ينبغي أن يبحث في نظریّة المعرفة. وعلی هذا الأساس وبناءً على نظریّة المعرفة المختارة، أجبنا عن الإشكاليّة المذكورة وتوصّلنا إلى نتيجة مفادها أنّ علم المنهجيّة نفسه یقوم على مبادئ بديهيّة تسمّى الأصول المتعارفة. وبالتالي فإنّ حلنا لهذه القضيّة الصعبة هو أنّ طريق المعرفة مفتوح أمامنا ويمكننا حلّ المشكلة المذكورة من خلال رأس المال المعرفي وهي الأصول المتعارفة.
(110)
قد توصّلنا في الفصل السابق، وبعد أن أوضحنا الفرق بين الإطار العقلي والأساس، إلى هذه النتيجة وهي أنّ البارادایم بمعنى «أساس الفكر» ممّا لا مفرّ منه. وتابعنا المناقشة لأجل شرح الحلّ المقترح، وذلك من خلال إلقاء نظرة مختصرة على الأسس الفکریّة وأنواعها ودورها في المعرفة الإنسانيّة، ورأينا أنّ كل مجموعة من البارادایمات تحتوي حسب الاستقراء على أسس عدیدة. وأهمّها الأسس المعرفيّة. ويتمّ من خلال البارادایمات أو الأسس المترابطة من بين الأسس المذکورة، توفيرُ مجموعةٍ منسقة ومتناسبة تنظّم البحث وتوجّهه.
وتواجهنا في المقام مجموعة من الأسئلة، ومنها: أوّلًا: ما هي الأسس المعرفيّة لمنهج البحث من وجهة نظر الاتجاه المختار، وثانيًا: ما نوع منهج أو مناهج البحث التي يمكن الحصول عليها من مثل هذه الأسس؟ وبعبارة أخرى، ما هي نتيجة المناهج الناتجة منها؟
وقد خصّصنا هذا الفصل للبحث والعثور على أجوبة السؤالين
(113)أعلاه. ونبدأ النقاش بالأسس المعرفيّة لمنهج البحث من وجهة نظر الاتّجاه المختار. ثمّ بعد جولة مختصرة على أهم الأسس المعرفيّة وعرضها نتابع حلّ الإشكاليّة التالية: ما نوع منهج أو مناهج البحث التي يمكن الحصول عليها بناء على هذه الأسس؟
بناءً علی نظريّة المعرفة المختارة، فإنّ ثمّة مبادئ أو أسسًا خاصّة تحكم منهج البحث ومنهجيّته. وأهمّها کالتالي:
توجد هناك حقیقة أو حقائق خارج عقولنا. إنّ تحقيق هذا الواقع ومعرفته ليس أمرًا ممكنًا فحسب، بل موجودٌ أيضًا. ويمكن للمرء أن يذهب أبعد من ذلك ويقول: إنّه ليس متحقّقًا فحسب، بل بدیهيٌّ أيضًا. إن قضيّة: (هناك حقيقة) بدیهیّة للجميع؛ لأنّ لدينا العلم الحضوري ببعض مصادیقه؛ كعلمي بوجودي وواقعي الخارجي، وهو غير عقلي وشؤوني العقليّة؛ وکذا معرفتي بحالاتي ومشاعري وأفعالي الجوانحیّة مثل القرار والانتباه والتركيز وكذلك الأفعال الإراديّة مثل التخيّل والإحساس والتفكير.
وبناءً على ما تقدّم، فإنّه ليس من الممكن للبشر الوصول إلى الحقيقة فحسب، بل إنّ كل شخص لديه مجموعة من المعارف الیقینیّة. وعلى الرغم من كثرة مثل هذه القضایا، إلّا أنّها قليلة بالمقارنة مع القضایا النظريّة. حيث إنّ ثمّة عددًا من القضايا، منها: القضایا التي تحکي العلوم الحضوریّة العامّة أو الوجدانیّات، والبديهيّات الأوّلیة في الفلسفة كمبدأ استحالة اجتماع النقیضین، ومبدأ استحالة ارتفاعهما، ومبدأ السببيّة أو مبدأ استحالة الترجيح من غیر مرجّحٍ، والبديهيّات المنطقیّة وبديهيّات الهندسة الإقليديّة؛ مثل قولنا: (الکلّ أعظم من جزئه) وکذا الحدود والتعريفات مثل تعريف النقطة والخط والمثلّث.
إنّ الحقيقة أو الصدق هي القضیّة التي تطابق الواقعَ. ومن مراتبها العلم اليقيني الذي لا ریب فيه، والقضیّة التي تطابق الواقعَ. وبناء على هذا الموقف، ليس للذهن أيّ دور في الحقيقة، کما أنّ الحقيقة ليست نتاج تفاعل الذهن مع الخارج أو توافق الواقع مع الذهن، بل الحقائق هي مرايا للواقع. إنّ الذهن يصوّر فقط الكائن الخارجي أو الواقع كما هو، وعلی هذا الأساس فإنّ الحقيقة هي مطابقة الذهن والصور الذهنیّة للخارج، وهو ما يمكن تسميته بالصدق الموضوعي؛ وليست الحقیقة هي مطابقة الواقع للذهن والصور الذهنیة، والتي يمكن أن تسمى الصدق الذهني أو الذاتي.
یمکن الوصول إلی المعرفة الیقینیّة وهي هنا القضیة التي تُطابق الواقعَ. الإنسان يمتلك القدرة على معرفة الحقيقة وتحقيقها عن طريق قواه الإدراكيّة، والجميع يجد هذه القدرة في داخل وجوده؛ بل كما رأينا سابقًا، فإنّ كل شخص لديه عدد من هذه الحقائق أو القضایا التي تُطابق الواقعَ.
وبناءً على رأس المال المعرفي المذكور أعلاه، فإنّ ادّعاء الشكوکیّة أو النسبيّة المطلقة هو ادّعاء غير عقلاني؛ لأنّ كل إنسان يدرك من خلال تأمّله في نفسه أنه يمتلك مثل هذه المعطيات المعرفيّة. بل بالإضافة إلی ذلك، يلاحظ أن بعض تلك رؤوس الأموال المعرفيّة لا يمكن إنكارها، ولا يمكن للإنسان أن ينكر وجودها في نفسه.
تعتمد نظريّة المعرفة على رأس المال المعرفي المطلق (غير نسبي) ومبادئ قطعیّة لا ریب فیها. وبناء على هذا النهج فإنّ الحصول علی المعرفة القطعیّة لیس ممکنًا فحسب، بل هو أمرٌ متحقّقٌ أيضًا. إنّ الإنسان لديه معارف قطعیّة، ويستطيع بهذا الأساس المعرفي أن يحقّق العديد من المعارف القطعیّة مثل المعارف المتقدّمة في الرياضيّات والفلسفة والمنطق وعلم الکلام ونحوها. ولذلك فإنّ الدور الأساسي لنظريّة المعرفة هو توفير معيار لتمییز الأقوال
الصادقة من الأقوال الكاذبة، وبالتالي يمكن بهذه الطريقة تمييز الحقّ من الخطأ، والصدق من الکذب. وعلى هذا فإنّ نظریّة المعرفة تبدأ بالمعرفة اليقينيّة وقبول تحقّقها. ولیس من المعقول بل لیس من الممکن أن یشكّ في هذه الأسس ورأس المال المعرفي؛ كما لو وقع شخص ما في مستنقع الشكوکیّة أو النسبيّة، فلا يمكن تقديم أيّ حجّة حقيقيّة علیه؛ بل لا يمكن للمرء إلّا أن يستخدم الحجج النقضیّة أو الحَلّیة التنبیهیّة والجدليّة وقد قدّم السلف مثل هذه الحجج أيضًا.
عندما نواجه هذا السؤال الصعب: هل تسبق الأنطولوجيا نظريّةَ المعرفة أم العكس؟، فإن حل هذه المعضلة وإجابتها الصحيحة هو أن نظريّة المعرفة تسبق الأنطولوجيا؛ لأنه قبل البحث في الأنطولوجيا ودراسة مشكلاتها، لا بدّ أوّلًا من حل مصادر المعرفة ومعيار صدق القضایا وحل العديد من المشكلات المعرفية الأخرى، وإعداد الجواب المناسب لها.
وتبرز مشكلة أخرى في المقام وهي أنّ المعرفة هي من الصفات ذات الإضافة، فهي تبتني على الوجود. وبالتالي فما لم يكن هناك حقيقة، فإنّ تحقّق المعرفة لا معنى له. ومن ثمّ، فإنّ الأنطولوجيا لها الأسبقيّة على نظريّة المعرفة.
يمكننا الإجابة عن هذه الإشکالیّة، بعد قليل من التأمّل والاستكشاف، على النحو التالي: مع أنّ الوجود له الأسبقيّة على المعرفة، إلّا أنّ الأسبقيّة المذكورة لا تتطلّب أن تكون الأنطولوجيا سابقة على نظريّة المعرفة أيضًا. الأنطولوجيا تختلف عن (الوجود)، لأنّ الأنطولوجيا تتضمّن (المعرفة) أیضًا، فإنّ الأنطولوجيا هو علم معرفة الوجود، فتدلّ على إدراج المعرفة فيها؛ ولذلك فإنّ الأنطولوجيا تعني معرفة الوجود، ونظریّة المعرفة هي معرفة المعرفة. ولا يمكننا أن ندرس الأنطولوجيا بطريقة منطقيّة وصحيحة إلا إذا سبق لنا أن استكشفنا القضايا الأساسية لنظريّة المعرفة ووجدنا حلًّا لها. فمثلًا مع التشكيك في مصادر المعرفة وإنكار قدرة الإنسان على معرفة القضايا التركیبیّة المتقدّمة، أو حتّى مع الشكّ فيها، كيف يمكننا مناقشة وبحث مثل هذه القضايا؟ وإنّما یمکن البحث في مثل هذه القضايا، إذا توصّلنا سابقًا إلى طريقة عقلانيّة لحلّ هذه القضايا. ولذلك فإنّه مع التشكيك في قدرة الإنسان المعرفيّة على فهم القضايا الترکیبیّة المتقدّمة، لا يمكن البحث والفحص في المسائل التي تتكوّن منها هذه القضايا. فضلًا عمّا إذا وصل المرء إلى أن الطريق مسدود وأنّه لا يمكن التحقيق في مثل هذه القضايا وتقويمها واتّخاذ قرار بشأنها.
(118)وممّا سبق نخلص إلى النتيجة التالية: إنّ أسبقیة الوجود على المعرفة لا تقتضي أن يكون للأنطولوجيا أسبقیّة على نظريّة المعرفة؛ فإنّ الحكم بأسبقیّة الأنطولوجيا على نظريّة المعرفة، من خلال الحجّة المذكورة (أي: أسبقیّة الوجود على المعرفة) إنّما هو مغالطة ویظهر الجواب عنه إذا تأملّنا في اندراج (المعرفة) في الأنطولوجيا.
لا ینحصر عدد المعارف الإنسانيّة الیقینیّة التي لا ریب فیها، في ما ذكرناه، بل هي قابلة للتوسيع. بل يمكن للإنسان أن يحصل علی العديد من المعارف الیقینیّة الأخرى، من خلال استخدامه الأسس الیقینیّة وتطبيقها، والتي تسمّى البديهيّات. کما يمكنها اكتشاف العديد من المفاهيم النظريّة من خلال المفاهيم البديهية والكشف عن حقيقتها. ولذلك فإنّ كلًّا من التصدیقات والتصوّرات البديهيّة، لهما قوّة الإنتاج والتكاثر. ومن الممكن أن نحصل علی کشف الحقائق النظریّة المجهولة وتصییرها معلوماتٍ، وذلك من خلال ترکیب البدیهیّات. إنّ طريقة الحصول علی هذه العمليّة في النظريّات هو الاستدلال البرهاني، وفي المفاهيم هو التعريف الحقيقي.
ولا تقتصر قابليّة توسيع المعارف الیقینیّة، في القضایا الیقینیّة بالمعنی الأخصّ، بل من الممکن أن تُوصِلنا القضایا البدیهیّةُ إلی
العلم العرفي والمعرفة الاطمئنانیة المبنیّة علی الیقین بالمعنی الأخص والقابلة للرجوع إليه.
وينبغي أن يقال: إنّ الإنسان لا يبحث عن المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخصّ فقط، بل بالإضافة إلى هذا المستوى العالي من المعرفة، فإنّه يبحث عن الحجّة أيضًا. وتشمل الحجّة کلّ دلیلٍ يقود الإنسان إلى الواقع، وإذا كانت باطلة في حالات نادرة، ولم ترشده إلى الواقع، فالمرء معذور؛ لأنّه قد قام بواجبه العلمي من خلال الحصول علی الحجّة. ویحصل في أغلب الأحوال على علم صحيح. إن الإنسان في عالم القضايا غير الیقینیّة بالمعنى الأخصّ، سواء أكانت قضايا یقینیّة بالمعنى الأخصّ أو بالمعنى الأعمّ أو قضايا مفيدة للمعرفة العرفیّة أو الاطمئنان، إذا لم يمكنه الحصول علی اليقين بالمعنى الأخصّ، فإنّه إذا حاول تحقيق هذه الدرجة من المعرفة من خلال الاستدلال بالأدلّة ومن دون التأثّر بالأهواء والرغبات النفسانیّة يكون مثل هذا الشخص قد قام بوظيفته المعرفيّة وقد وصل إلی ما یصحّ الاحتجاج به. وليس من الضروري أن یصل الناس العادیون إلى المعرفة اليقينیّة بالمعنى الأخصّ، بل يبدو أن المعرفة العرفیّة أو الاطمئنان كافٍ لهم.
یجب على الإنسان من أجل وصوله إلى الحقيقة، بالإضافة إلى التفكير والبحث، تحقيق مستوى أو نوع من التهذيب والتقوى، والحدّ الأدنى منه هو أن يخضع الإنسان للحقّ، ولا تمنعهأهواؤه ومصالحه وکراهیّاتها الشخصیّة عن قبول الحقّ. إنّ التفكير والبحث شرطٌ ضروريّ في هذا المجال، ولكنّه غير كاف؛ ولذلك فكما لا يمكن تجاهل التفکیر والبحث، خاصّة في مجال الرؤیة الکونیّة، ويمكن الحصول على المعرفة من خلال المصادر والطرق المتعارفة، وبالتالي یمکن التحرّر من الشكوکیّة والنسبيّة، فكذلك الالتزام بالحقيقة والاستسلام لها أمر ضروريٌّ لا مفر منه. وإذا تحقّق هذا الشرط (أي التحرّر من سيطرة الميول والأهواء المضادّة للحق)، بالإضافة إلى شرط التفكير والبحث، فإنّ الإنسان يصل إلى الحقيقة. وبما أنّ مبادئ العلوم العقليّة، بل التعالیم الأساسیّة الإسلامیّة مثل وجود الله وتفرّده وصفاته، ممّا يمكن إثباتها بالعلم العرفي، وكذلك من خلال اليقين الفلسفي والرياضي (اليقين بالمعنی الأخصّ)، فإنّ الإيمان بها هو في الحقيقة التزام بالحقّ، والكفر بها عدم التزام بالحقّ.
إنّ الإنسان الذي لا يعاني من ضعفٍ أو نقصٍ في عقله وتفكيره وقواه الإدراكیّة، ولا يختلط عليه الأمر في مجال الإثبات والاستدلال بسبب الضعف وقلّة المهارة، فإنه يستطيع أن يحصل على المعرفة الصادقة والمطابقة للواقع، وهي الطريق للوصول إلى
الحقيقة، وبالتالي یمکنه الالتزام بها. وبطبيعة الحال، فإنّ مصادیق الحقّ متنوّعة، وتوجد درجات عديدة للمعرفة. ولکن ما يجب على الجميع تحقيقه إنما هو تحصیل الحجة فقط.
إنّ الحقيقة ثابتة دائمًا ولا تتغيّر أو تضمحلّ أبدًا. والحقيقة هي مطابقة القضیة للواقع. إن محکيَّ القضيّة أو ما تُظهره القضيّة دائمًا هو نفسه ما تُظهره القضيّة؛ سواء أكان ذلك المعلوم أو المحکي موجودًا مادیًّا ومتغیّرًا، أم كان ثابتًا و غير ماديٍّ. إن العلم والحقيقة لا يتغيران بتغير المعلوم. ومع أنّ الحقائق المادّيّة دائمة التغير، إلّا أنّ العلم بها ثابت لا يتغيّر؛ ولذلك فإنّ تغيّر المعلوم لا يتعارض مع ثبات العلم. إذا كان هناك في وقت معينٍ شجرةُ تفاح معيّنة في حقل معيّن يبلغ طولها مترٌ واحدٌ وقمت بالتقاط صورة ذهنيّة منها، فإنّ الصورة المذكورة تكون ثابتة دائمًا وتُظهِر خصائص تلك الشجرة في ذلك الوقت المعين. وهذا لا ينافي أنّ تلك الشجرة تتغير بلحاظ وجودها وتنمو دائمًا.
إنّ العلم بالحقائق وإن کان ثابتًا، بینما المعلوم في مجال عالم المادّة قابل للتغيير والتحوّل، إلّا أنّه من وجهة نظر أخرى يمكن القول: إنّ التصوّرات الحسّيّة والخياليّة المتعلّقة بها تتطوّر أيضًا؛ لأنّ هذه التصوّرات انفعالیّةٌ، ولتغيّر المحسوس الخارجي دورٌ
فعّالٌ في تغيّر هذه التصوّرات. ولكن من الواضح أنّ هذا النوع من الإدراك والمعرفة هو العلم بالتغيّر، ولیس تغيّر العلم. والحقيقة هو أن تُظهِر بشكل صحيحٍ لحظات النمو والتطوّر والتحوّل المختلفة للكائن المتغيّر؛ لكن الصورة التي تحكي عن لحظةٍ ما هي بالضبط ما یحکیها وستظل كما هي دائمًا. هذه الصورة نفسها غير قابلة للتغیّر.
إنّ الحقيقة أو الصدق كما ذكرنا أعلاه، هي مطابقة الذهن مع الخارج. وبکلمة أخری: هي مطابقة القضیّة الذهنیّة (مضافًا إلى القضيّة الملفوظة) للواقع. لكن الحقيقة في نظر كانط وأتباعه لها تفسير آخر غير التفسير الشائع. یری كانط أنّه نظرًا إلى المشاكل التي يواجهها هذا المبدأ وصعوبة تطبيقه خارجيًّا، يجب أن ينقلب هذا المبدأ رأسًا، ويجب تعريف الحقیقة بطريقة مختلفة: مطابقة الأشیاء للذهن. وعلی ضوء ذلك، لكي تعرف شيئًا ما، يجب أن یتطابق هذا الشيء مع الذهن، لا أن یتطابق الذهن معه. ووفقًا لهذا التفسير الجديد، فإنّ الحقيقة أو الصدق يعني إضفاء الطابع الخارجي على الذهن، ولیس مطابقةَ الذهن أو الصور الذهنیّة مع الأشیاء الخارجيّة؛ ولذلك فإن العالَم هو انعكاس للذهن وليس الذهن انعكاسًا للعالَم؛ ولذلك فإنّ الذهن هو الذي یعطي العینیّة والخارجیّة، وليس مُدركًا للخارجيّة.
ولا شكّ في أنّ كانط لا يدّعي أنّ العقل البشري يخلق الأشياء، بل يقول إنّ الشيء الخارجي أو الشيء في حدّ ذاته يجب أن يقبل لون البنى والقوالب والأطر العقليّة حتّى تصبح معلومة، ولذلك يتمّ العلم بالأشياء من خلال الإطار أو البنية العقليّة الخاصّة، ونكتسب المعرفة عنها. إنّ المادّة الخارجيّة للمعرفة (وهي الشيء في حدّ ذاته) عند دخولها إلى الذهن، تمتزج بالصور والقوالب الذهنیّة؛ ويفرض الذهن البشري هذه البنى على المواد الواردة إليه حتّى تصبح معلومة. ولا يمكن للمرء أن يعرف شيئًا ما من دون هذا النشاط الذهني. والمعرفة هي المنتج المشترك للذهن والشيء في حدّ ذاته. إن ما يستلمه الذهن من الانطباعات الحسّيّة يجعله مادّة للمعرفة. ثمّ بحسب بنيته المعرفيّة يغطي تلك المادةَ صورًا لا تنفصل. وهذه الصور هي البنی الذهنیّة ومفاهيم مثل الکلیة والضرورة. ونتيجة لذلك، يزعم كانط أن هناك فرقًا بين الأشياء كما هي والأشياء كما تظهر لنا. وليس لدينا سوى الوصول إلى الأشياء التي تظهر لنا ولا نستطيع معرفة الأشياء كما هي. إنّ مجموعة من المفاهيم والمقولات فطريّة وجزء من طبيعة العقل البشري. تحدث عملیّة الفهم عندما يختلط ما يأتي إلى الذهن مع المقولات الذهنيّة. ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما. ولا یمکن العلم بالشيء ذاته. وهكذا، فمن وجهة نظر كانط فإنّ الإدراك والفهم الإنساني هو نتاج تعاون الذهن والخارج؛ بمعنی أنّ الإدراك يتمّ الحصول عليه من امتزاج ما ينعكس في الذهن من الخارج، مع المفاهيم الفطريّة للذهن. ولذلك، لا يمكن معرفة الشيء الخارجي ذاته.
(124)والذین جاؤوا بعد کانط (کمؤسّس أو أحد مؤسّسي هذا الرأي)، وعلى الرغم من تمسّكهم بالخطوط العامّة لتفسيره، فقد قدّموا للذاتية قراءات مختلفة في مجالات المعرفة الإنسانيّة؛ بما في ذلك الصدق الذاتي بمعنى العاطفة والحب، والصدق الذاتي بمعنى أنّ عقیدة ما لا يمكن اعتبارها وتقويمها بمفردها. بل إنّ أيّ تبرير يتمّ في إطار مجال خاصّ ونمط خاصّ من الحياة ولعبة لغويّة خاصّة.
يمكن أن نعتبر هذا الرأي نتيجةً لعدم القدرة على فتح الطريق أمام کشف الحقائق. وكما جاء في المبدأ الأوّل، فإنّ الذاتيّة غير معقولة؛ إذ يمكن معرفة الحقيقة في بعض الحالات، بل الإنسان لديه مثل هذه المعارف بالحقائق. ويصبح هذا البيان أكثر وضوحًا من خلال المبدأ التالي.
يمكننا أن نعرف بعض الأشياء كما هي (الظواهر). إنّ المبدأ المعرفي القائم على التمييز بين (الشيء کما هو) و(الشيء کما یظهر لنا)، والقول بأننا لا نعرف الشيء إلا كما يظهر لنا وينعكس في الذهن، هو ادّعاء باطل ويتطلّب النسبيّة؛ إذ يتمكّن الإنسان ولو في بعض الحالات من الوصول إلى الواقع أو الشيء في حدّ ذاته، وبالتالي فإنّ طريق معرفة الحقائق أو الظواهر لا يكون مسدودًا تمامًا أمامنا.
إنّ الشهود أو العلم الحضوري هو إجابةٌ حلّیةٌ لهذه المشكلة. فإنّ العالم من خلال الشهود أو العلم الحضوري یعرف الواقع والظاهرة
دون ما یَظهر له. توضیح ذلك أن المعرفة تنقسم في نظريّة المعرفة الشاملة التي تشمل جميع مجالات المعرفة الحقيقيّة، إلی المعرفة الحضوریّة والمعرفة الحصولیّة. إنّ المعرفة الحضوریّة هي التعرّف المباشر والذي لا تتوسّط فیها المفاهيمُ والصور الذهنيّة. ويجد الإنسان في هذا النوع من المعرفة نفس الواقع كما هو، من دون المفاهيم والصور الذهنيّة؛ ولذلك فإنّ من أهمّ سمات المعرفة الحضوریّة أنّه لا يوجد فیه وسيط بين العالم والمعلوم، مثل المفاهيم والصور الذهنيّة. بل المعلوم نفسه موجود عند العالم ونجد حقيقة الشيء من دون وساطة المفاهيم والصور الذهنيّة. ولذلك فإنّ سرّ عصمة العلم الحضوري هو فقدان الواسطة فیه، فلا یتصوّر الخطأ في العلم الحضوري؛ بل الخطأ إنّما يتصوّر في الإدراکات التي یوجد فیها وسيط بين العالم والمعلوم. وأمّا الموارد التي نجد فیها الشيء نفسه من دون واسطةٍ مثل المفاهيم والصور العقليّة، فكيف يمكن تحقق الخطأ فیها؟
بالإضافة إلى ذلك، یمکن في المعرفة الحصولیّة أیضًا توضيح أنه في بعض الحالات يكون للإنسان إمكانيّة الوصول إلى الواقع أو الشيء في نفسه، ولا يكون طريق معرفته مغلقًا، وذلك علی ضوء المسألتين التاليتين:
1. أنواع المفاهيم وخصائصها الکلّیّة والتمييز بينها.
2. معيار صدق القضايا التي تعتبر المفاهيم من مكوّناتها.
والدراسة التفصيليّة لهاتین المسألتين تتطلّب مجالًا آخر، وقد تناولناه في کتاب آخر لحسن الحظ.
أضف إلى ذلك أن ادّعاء التمييز بين (الشيء في نفسه) و(الشيء کما یظهر لنا) ادّعاء متناقض مع نفسه. والتفسير هو أنّه قد يدّعي شخص ما أنّنا نعرف حقائق الأشياء ليس كما هي، بل كما تظهر لنا؛ لأننا لا نستطيع الوصول إلى الظواهر والكائنات، والظواهر تأخذ لون البنيات العقليّة بعد وصولها إلى العقل، ولا نستطيع أن نفهم الواقع الموضوعي دون تلك المفاهيم المسبقة عن البنية. والآن علينا أن نتساءل: كيف نفهم هذه الادّعاءات والقضایا المذکورة أعلاه؟ فهل نعرف الحقيقة التي تشير إليها مثل هذه الأقوال كما هي أو كما تظهر لنا؟ ومن الواضح أنّ أيّ إجابة على هذا السؤال تستلزم المشكلة المذكورة.
ويمكن التعبير عن مشكلة التناقض الذاتي بطريقة أخرى: إنّ هذه القضایا هل تشیر إلی الشيء في نفسه أو إنّما تحکي عن الشيء کما یظهر لنا؟ إذا قَبل كانط وأتباعه الخيار الأوّل، فإنّه يقتضي رفض ونقض الادّعاءات والقضایا المذکورة أعلاه؛ لأنهم في هذه الحالة
يكونون قد اعترفوا بوجود المعرفة والقضايا الدالّة على الأشیاء کما هي؛ وأمّا إذا اختاروا الخيار الثاني، فيمكننا الإجابة بأنّ صفة وحقيقة المعرفة والفهم إنّما هي کذلك من وجهة نظرهم فقط، وليس من وجهة نظر الآخرين؛ إذ ربّما يقول آخرون: إن الإنسان يستطيع فهم الظواهر والأشیاء کما هي، لا کما تظهر لنا فقط. يصل الإنسان إلى ذات الوجودات دون مظاهرها فقط؛ ولذلك فإن ادعاءاتهم تنتقض في كل الأحوال.
إنّ البارادایم بمعنى الإطار العقلي، له علاقة قويّة بنمط الحياة والألعاب اللغويّة، بل هو مستمدّ منهما. ويشمل البارادایم بهذا المعنى العقائدَ والأخلاق والقيم والأساليب ونحو ذلك. وبناء على ذلك، لا سبيل لإثبات صدق البارادایم، بل لا يُقبل البارادایم إلّا على أساس الإيمان، وبالتالي فلا یمکن إثبات صدق البارادایم ولا سبیل لإثباته. ولو كان هناك مثل هذا الطریق لإثباته، لما استمرّت الخلافات في هذا المجال حتّى الآن، ولما أصبحت الصراعات أكثر تعقيدًا وأعمق وأكثر غموضًا كل يوم.
ووفقًا لنظريّة المعرفة المختارة، فإنّ الإنسان لا یحکم علیه ولا يخضع لأيّ بارادایم أو إطار عقلي، وبالتالي يمكن أن يتحرّر من سيطرته. إنّ الأطر العقليّة التي هي أمورٌ مكتسبة ولیست أمورًا فطریّةً
ومرکوزة في طبیعة الإنسان، من الممکن أن تلعب دور الإعداد فقط، بأن تهیّئ الأرضیّة فقط ولیس لها إلّا دور الاقتضاء. إنّ الإنسان كما يستطيع أن يهرب من تأثير أهوائه وشهواته النفسانيّة، كذلك يستطيع أن يهرب من أحكامه المسبَقة ومعارفه غير الیقینیّة وأفکاره الظنیّة.
ولذلك ليس لكل أسلوب حياة لغة خاصّة ومناسبة. کما أنّه ليس لكلّ لعبة لغويّة مجالٌ خاصّ وقواعد خاصّة. وليس من الضروري لفهم أي مجال لغوي ولعبته اللغويّة، أن تكون حاضرًا في نمط الحياة هذا. إن الألعاب اللغويّة وأنماط الحياة مثل العلم والدين والفلسفة، لها قواعد ومعايير مشتركة. ولذلك، فمن الممكن الحكم عليها جميعًا بمعايير مشتركة، ولذلك يمكن تقويم أنماط الحياة والقواعد التي تحكم لغتها، تقویمًا من الخارج؛ کما أن من الممكن فحص جميع المجالات والألعاب اللغويّة وتقويمها بمعيار واحد.
وعلی ضوء ذلك، لا يكون الإنسان سجينًا في أطره العقليّة؛ ويمكنه الهروب من سياجها. إنّ الحياة والألعاب المتعلّقة بها، والتاريخ، والثقافة، وما إلى ذلك ليست أسوارًا تحدّ الناسَ. ربّما تمنح أنماطُ الحياة أو الثقافات أو العوامل الأخرى، فرضيّات مسبقة للإنسان وتجعل الإنسان ينظر إلى العالم من منظور خاص؛ لكن الإنسان لا يخضع لها أبدًا، ويمكن أن يتحرّر من تأثيرها. أضف إلی ذلك أنّ النتائج التي تؤخذ من الفرضيّات والمبادئ المفروضة النظريّة غير المثبَتة ستكون فرضيّة أیضًا، ما لم ترجع إلى أسس بدیهیّة ومعصومة لا تزول.
لا تنحصر المعرفة الإنسانيّة في العلوم الحصولیّة وهي المعرفة التي تتوسّطها المفاهيم والصور الذهنیّة، بل تشمل نوعًا آخر من المعرفة التي لا تتوسّطها. يجد الإنسان في هذا النوع من المعرفة، المعلوم نفسه لا صورته الذهنیّة. إنّ أهمّ سمة معرفيّة للعلم الحضوري هي عصمته من الخطأ؛ لأنّه المدرِك في هذا النوع من المعرفة یعرف ذاتَ المعلوم مباشرة ومن دون وساطة المفهوم أو الصورة الذهنیّة، ولا يوجد مفهومٌ أو صورة الذهنیة وسیطًا بين المدرِك والمدرَك.
إنّ للعلم الحضوري دورًا واسعًا في حلّ مشاكل نظريّة المعرفة، وهو يرفض بشكل أساسي النسبيّة الخفيّة التي تهيمن على العلوم الإنسانيّة الحديثة، کما یرفض الشكوکيّة والنسبيّة الواضحة. ووفقًا لهذه النظریّة تبطل وتنتقض دعوی أنّ الفهم الإنساني يقوم على بنيات عقليّة مسبقة، ودعوی عدم قدرة الإنسان على التحرّر من أطره العقليّة المستمدّة من التاريخ والتقاليد والثقافة وما شابه ذلك. ويُفتح تجاه المعرفة الإنسانيّة طريق حليٌّ دون الحل النقضي. ويتأكّد لكل عالمٍ طریق الوصول إلی الواقع من خلال تجربة شخصيّة وداخليّة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن التأکيد علی التعاليم المعرفيّة والمنهج المعرفي للمفكّرين المسلمين، على ضوء الشهود الداخلي الذي
هو العلم الحضوري؛ بما في ذلك تقسيم المفاهيم إلى البديهيّة والنظريّة وإثبات وجود المفاهيم البديهيّة، وتقسيم القضایا إلى البديهية والنظريّة وإثبات التأسيسیة في مجال القضایا أو التصدیقات، والتحقّق من صدق الوجدانیات من خلال إرجاعها إلى العلم الحضوري، وحتّى التحقّق من صدق البديهيّات الأوّلية بإرجاعها إلى العلم الحضوري.
بالإضافة إلى الشهود الذي نتاجُه المعرفة الحضوريّة، توجد مصادر وطرق أخرى فعّالة في عالم المعرفة الإنسانيّة الواسعة والمتعارفة، والتي تشمل الحواس الظاهریّة، والعقل أو الدلیل العقلي، والدلیل النقلي، والحافظة.
فمن ناحية، وبناء على المصادر المذكورة، تنقسم الأدلّة المعرفيّة إلى الشهودیّة، والعقليّة، والحسّيّة أو التجريبيّة، والنقليّة. وبالطبع، بما أنّ الحافظة عبارة عن مخزن وليست مولدة، فهي ليست مصدرًا مستقلًّا. ولکن في الوقت نفسه، فإنّ دورها المهم لجميع أنواع المعرفة، باعتبارها مخزنًا لها، أمر يستحق المناقشة. ومن ناحية أخرى، تتنوّع الإدراكات والمعارف من حيث توسّع مصادر
المعرفة الإنسانيّة وطرقها مثل الشهود أو العلم الحضوري، والإدراك الحسي، والإدراك الخیالي، والإدراك الوهمي (وفقًا لموقف كثير من القدماء)، والإدراك العقلي. ولذلك فإنّ کلًّا من التفكير والتخيل والتذكّر والحفظ هي أعمال مختلفة للقوى الإدراكيّة الإنسانيّة. ومن خلال تصنيف شامل يمكن إحصاءُ أنواع الإدراك والأفعال الإدراكيّة للإنسان، وبعبارة أخرى، إحصاء مراحلها ومراتبها على النحو التالي:
1. الشهود أو الإدراك الحضوري.
2. نوع من الإدراك الحسّي الذي يتمّ الحصول عليه عن طريق الحواس الظاهريّة.
3. نوع من الإدراك الحسّي الذي يتمّ الحصول عليه عن طريق الحواس الباطنیّة، كالتذکر والحفظ والتخيّل.
4. الإدراك العقلي.
إنّ الحواس الظاهریة لا تدرك إلّا ظواهر الأشياء، أي أعراضها، وليس من الممكن إدراك ذوات الأشياء والحصول على فهم عميق لها. ولا يمكن معرفة جوهر الأشياء وإثباته إلّا بالعقل والإدراك العقلي. ومع ذلك لا يمکن للإنسان الوصول إلی کنه الأشیاء وفصولها الحقيقيّة، لا من خلال الإدراك الحسّي ولا الإدراك العقلي.
إنّ الإدراك الحسّي معصوم من الخطأ، والأخطاء التي يمكن أن تقع ترجع إلى أحكام العقل وتأويلاته.
إنّ الإحساس یختلف عن الإدراك الحسّي، فإنّ الإدراك الحسّي معرفة حصولیّة، لكن المعرفة بالإحساس علمٌ حضوريٌّ. إنّ المعرفة المستمدّة من الحواس الخارجيّة لها حدود، ومنها:
1. الحواس لا يمكنها الوصول إلّا إلى ظاهر الأشياء، ولا يمكن فهم عمق الأشياء من خلالها، بل تدرك الأعراض فحسب.
2. يعتمد الإدراك الحسّي على الاتّصال والتواصل. ولا يتحقّق الإدراك الحسي إلّا إذا تمّ هذا الاتّصال.
3. يمكن للمرء من خلال استخدام الحواس، أن يفهم على الأكثر تقارنَ الأشیاء وتتابعها، وأمّا أنّه ما هي العلاقات بين الأشیاء وهل هناك علاقة سببية بينها أم لا، فهذا خارج عن نطاق إدراك الحواس. ويمكننا أن نذهب أبعد من ذلك ونقول: إننا مع تفكير أعمق، نصل إلى نتيجة مفادها أننا لا نستطيع أن نفهم من خلال الحواس الظاهریة تقارنَ الأشیاء وتتابعها.
إنّ القوّة المدرِکة من بين الحواس الباطنیّة لیست إلّا الواهمة
والحسّ المشترك. وإذا أنكرنا وجود الواهمة فإنّه يتمّ إنكار خزانته التي هي الحافظة أيضًا؛ ولذلك وفقًا لنظريّة وجود القوى الباطنيّة، فإنّ هناك قوة واحدة فقط تفهم المعاني الجزئيّة والصور المحسوسة معًا. وهذه القوّة لها مخزن، وهو خزانة المعاني الجزئيّة وخزانة الصور الجزئية معًا.
ولکن يلعب التخيّل دورًا مهمًّا في ظهور المفاهيم والمعرفة غير الحقيقيّة، وهي على قسمين:
1. الاعتباریّة.
2. الوهمیّة.
إنّ المفاهيم أو الأفكار الوهميّة هي مفاهيم یتمّ إنشاؤها بواسطة التخيّل. یمکن للإنسان أن یخلق معاني جديدة من خلال قوّة التخيّل وبالاستعانة بالمشاعر والعواطف ونحوها، ثمّ استعراض تلك المعاني من خلال التشبیهات والاستعارات ووصف الأشياء بها. وتنتمي إلى هذه الفئة تلك المعاني الجميلةُ أو القبيحة التي یبتكرها الفنانون، وخاصّة الشعراء.
على الرغم من أنّ المفاهيم الاعتباريّة غير حقيقيّة، إلّا أنّ لها تأثيرات ونتائج حقيقيّة؛ بحيث إذا لم تترتّب عليهما تلك النتائج
سيصبح اعتبارها وجعلها أمرًا عبثًا. إن المفاهيم أو إشارات المرور تنتمي إلى هذه الفئة.
إنّ القضايا التي تتكوّن من المفاهيم أو الأفكار غير الحقيقيّة، سواء أكانت اعتباریّة أم وهميّة، ليس لها علاقة تولیدیّة مع بعضها ولیس لها تلك العلاقة مع الإدراکات الحقيقيّة. ولا يمكن إثباتها من خلال القياس البرهاني، کما لا يمكن إجراء الأحكام الحقيقيّة بشأنها أیضًا. ولا يمكن القول بشأنها: «إن ذلك مستحيل»؛ وبدلًا من ذلك ينبغي استخدام القول: «یلزم منه اللغو».
أحد مصادر المعرفة الإنسانيّة هو الشهود أو العلم الحضوري، ورغم أنّ عدد العلوم الحضوریّة أقلّ من إدراکات مصادر المعرفة الإنسانيّة الأخرى، إلّا أنّ العلوم الحضوریّة هي الأكثر إتقانًا واعتبارًا، بل هي البنی التحتيّة للعلوم الحصولیّة. إنّ فئة من عواصم الإنسان المعرفيّة الیقینیّة، هي العلوم الحضوریّة العامّة والقضایا الحاکیة عنها. وبالتالي فإنّ العلوم الحضوریّة وبالطبع، العلوم الحضوریّة العامّة، هي البنی التحتيّة للعلوم الحصولیّة للإنسان. والنظام الضخم للمعرفة الإنسانيّة مبني على مثل هذه الأسس الصلبة.
أهمّ مصدر للمعرفة الإنسانيّة هو العقل. وتعتمد عليه صحّة بعض
الإدراکات مثل الإدراکات الحسّيّة. یُستخدم العقل في نظريّة المعرفة في معنيين شائعین:
1. القوّة الإدراكيّة الخاصّة للنفس الناطقة.
2. الإدراك العقلي، وهو نتاج القوّة الإدراكيّة المذكورة.
ينقسم العقل إلى قسمين:
1. النظري.
2. العملي.
يبدو أنّ كلًّا من العقل العملي والنظري تابعتان لقوّة واحدة، فالأوّل يُدرك الکلیات المتعلّقة بالوجود والعدم، والثاني يُدرك الکلیات المتعلّقة بما ینبغي وما لا ینبغي.
للعقل النظري وظائف مختلفة في مجال المعرفة الإنسانيّة. يحصل الإنسان علی معرفة عميقة وواسعة بالأشياء من خلال أنشطة العقل ووظائفه المختلفة، مثل انتزاع المفاهيم الکلّیّة وفهمها، والتعريف أو التحليل، والحكم في القضایا، والاستدلال، ونحو ذلك. إنّ التعريفات والتحليلات التي تُذكر للمفاهيم، أو الحجج التي تُذكر لإثبات بعض القضایا ونحوها، هي معارف يحصل علیها الإنسان بأداة العقل. إنّ التعاريف المنطقيّة للإنسان والنبات والجسم والزمان والمكان ونحو ذلك هي علومٌ حول كل من هذه المفاهيم. کما
أنّ الحجة التي تُقام لإثبات قولنا: (مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة) هي معرفة بهذه القضیّة. ومن الواضح أنّه في الهندسة والعلوم الرياضيّة الأخرى، التي هي الأكثر يقينًا من بین المعارف الإنسانيّة، فإنّنا نكتسب المعارف اليقينيّة عن طريق العقل. وعادةً ما يكون اكتساب المعرفة في العلوم الفلسفيّة -مثل الأنطولوجیا وعلم النفس وفلسفة الأخلاق وفلسفة الدين ونظريّة المعرفة- مبنيًّا على هذا المصدر أو الطريق. ولا يمكن إثبات أو نفي أي من قضایا العلوم والمعارف المذكورة بالحواس. إنّ هذه القضايا نفسها ومفاهيمها التي هي مكوّناتها يتم الحصول عليها عن طريق العقل.
إنّ أهم وظائف العقل وأدواره هو الاستدلال. والاستدلال هو عمليّة عقلانيّة يقوم بها العقل. وتوجد أنواع مختلفة من الاستدلال، وأكثرها صحّة يسمّى (البرهان). والبرهان هو الاستدلال الذي یکون یقینیًّا من حيث المحتوى ومن حيث الشكل وترتيب المقدمات معًا.
یعتبر الدلیل النقلي أو إخبار الآخرین من طرق تحصيل المعرفة؛ وهو يعني الاعتماد على كلمات أو كتابات الآخرين. ومن الواضح أنّ هذا الاعتماد لا یقوم على الاستنتاج؛ فإنّ كلمات وكتابات الآخرين ليست جزءًا من عمليّة الاستنتاج؛ ولذلك فإنّنا نتمسّك بالعديد من المعارف النقلیّة؛ مثل معرفتنا بوجود قمّة دماوند وارتفاعها، ومولد النبيّ الكريم، وفتح مكّة و...
يتمّ الحصول على معظم المعارف المتعلّقة بالجغرافيا والتاريخ
والأدب واللّغة، بل المعارف المتعلّقة بالأحکام العمليّة في الفقه الإسلامي، وكذلك بعض المعتقدات الإسلاميّة، من خلال الأدلّة النقلیّة. وبهذه الطريقة نتعرّف على العديد من أحداث الأمس واليوم. نكتشف مع قليل من التفكير، أنّ دور مصدر المعرفة هذا أوسع بكثير ممّا يبدو في بادئ الأمر. إنّ العديد من أفعالنا وقراراتنا ومعارفنا ومعتقداتنا مبنيّة على الأخبار التي نحصل عليها من ناحیة الآخرين. وبالتالي، بالإضافة إلى البعد المعرفي، فإنّ العديد من هذه الأخبار هي مصدر اتّخاذ القرار للإنسان وتوفّر الأرضیّة لقراراتنا وسلوكیّاتنا وأعمالنا.
وللدلیل النقلي أنواع مختلفة، أهمّها الخبر الواحد، والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعیّة، والخبر المتواتر. إنّ الفئتین الأخيرتین تفیدان الیقین؛ لكن القسم الأوّل یفيد الظنّ أو العلم العرفي أو الاطمئنان. إنّ مصدر حجیّة الدلیل النقلي وغيره من الأمارات العقلائیّة هو بناء العقلاء.
وينبغي القول: إنّ الدلیل النقلي حاله حال الذاكرة، فهو ليس دلیلًا مستقلًّا، وبالتالي، فهو ليس مولِّدًا للمعرفة؛ بل هو ناقلها. فیستخدم المُخبِر حواسه الظاهريّة، ویعتبر إخباره شهادة عن طريق الحسّ، وليس عن طريق الحدس. ولا يكون الخبر أو الدليل النقلي معتبَرًا وحجّةً ولا يمكن الاعتماد عليه إلّا إذا انتهی إلی مصدر مستقلّ كالحواس الظاهريّة. ويشير هذا البيان إلى أن الإخبار ليس مصدرًا مستقلًّا، بل هو مصدر ثانوي تدعمه المصادر الأوّلية. ولکن في الوقت نفسه وعلى الرغم من كون الدلیل النقلي ناقلًا للمعرفة، إلّا
(138)أنّه یلعب دورًا أساسيًّا ومهمًّا في المعارف الإنسانيّة، سواء أكانت دينيّة أم غير دينيّة. ويبدو أنّه علی الرغم من ضرورة توثيق هذا المصدر بالمصادر الأولية كالحواس الظاهريّة، إلّا أنّ حجیّته تكون في عرض اليقين أو اليقين، وليست في طوله. مع أنّ عموم العلماء یعتقدون أن حجیّته تقع في طول المصادر الأوّلية، لا في عرضها.
وعلی ضوء التعريف، فإنّ المعارف التي يتمّ الحصول عليها عن طريق العقل هي معارف حصولیّةٌ، وبالتالي تصدق علیها خصائص هذا النوع من المعرفة. وبالإضافة إلى ذلك، فرغم أنّه يبدو أن المنتَج المباشر للحواس الظاهریّة هي معارف حضوریّةٌ، إلّا أنّ قوّة الخيال الإنساني تحوّلها إلى علوم حصولیّة. ومن هنا تأتي أهميّة العلم الحصولي محطّ الاهتمام؛ لأنّ معظم المعارف الإنسانيّة علوم حصولیّة، بما فيها المعارف العقلیّة والتجريبيّة والنقلیّة ونحوها. ولذلك فمن الضروري الاهتمام بالمعرفة الحصولیّة ودراسة خصائصها. تقع المعرفة الحصولیّة تجاه المعرفة الحضوریّة؛ لأنّ المعرفة إمّا أن تكون بدون وساطة المفاهيم والصور الذهنیّة أو بواسطتها. الخيار الأوّل هو المعرفة الحضوریّة، بینما الخيار الثاني هو المعرفة الحصولیّة.
إنّ جميع العلوم والمعارف الإنسانيّة هي علوم حصولیّة ومشتقّة من القضایا أو التصدیقات. إنّ أحكام وقوانين جميع العلوم يتمّ عرضها على أساس القضايا، سواء أكانت اعتباریّة أم حقيقيّة، جزئيّة أم کلّیّة، برهانيّة أم غير برهانيّة، قبلیّة أم بعديّة، عقليّة أم تجريبيّة أو نقلیّة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمّ التعبير عن المبادئ البدیهیّة مثل مبدأ استحالة اجتماع النقیضین أو ارتفاعهما أو مبدأ العلّیّة، من خلال القضایا أيضًا. کما أنّه في مجال العلوم الحضوریّة تعبِّر القضایا عنها. تتكوّن القضایا نفسها من أجزاء وهي مكوّناتها. إنّ كلّ قضيّة مكوّنة من ثلاثة مفاهيم على الأقل (الموضوع والمحمول والنسبة بینهما في القضیّة الحمليّة، والمقدم والتالي والنسبة بينهما في القضیّة الشرطیّة، سواء أکانت النسبة هي التلازم أم التعاند). إننا قبل أن نفهم قضيّة ما ونقبل حكمها الإيجابي أو السلبي ونصدّقه، علينا أن نتصوّر ونفهم مفاهيمها. وبهذه الطريقة تتکوّن القضایا من المفاهيم أو التصوّرات. ولكي نتمكّن من الحصول على حكم أو تصدیقٍ أو قضیّةٍ، يجب علينا أوّلًا أن نصل إلى المفاهيم والتصوّرات التي تتكوّن منها. ولذلك تنقسم العلوم الحصولیّة إلى قسمين: التصوّرات والتصديقات، أو المفاهيم والقضايا.
يمكن تقديم تصنيف خاصّ للمفاهيم من خلال رؤى وأبحاث المفكّرين المسلمين وذلك مع مزيد من التأمّل في هذا الموضوع:
إنّ السمة البارزة للتصنيف المذكور أعلاه هو شموله، حیث تشمل أهمّ المفاهیم الموجودة لدی الإنسان.
تنقسم المفاهيم في تقسيم أوّلي إلى قسمين: 1. المفاهيم الواقعیّة؛ 2. المفاهيم غیر الواقعیّة. المقصود من المفاهيم غير الواقعیّة المفاهيم التي ليس لها أصل واقعيٌّ وخارجيٌّ؛ بمعنی أنّها ليست انعكاسًا للواقع؛ بل هي إمّا صورٌ تصنعها القوّة المتخیّلة بحسب الصور الموجودة في الذهن، كمفهوم العنقاء والحصان المجنّح. وإمّا هي مفاهيم تمّ وضعها واعتبارها بناء على معايير. ولذلك فإنّ هذا النوع من المفاهيم (المفاهيم غير الواقعيّة) ينقسم إلى قسمين: 1. المفاهيم الوهميّة؛ 2. المفاهيم الاعتباریّة. وبطبيعة الحال، قد يكون للمفاهيم الاعتباریّة أقسامٌ أيضًا.
وعلی کلّ حالٍ، لا يمكن إرجاع جميع المفاهيم غير الواقعيّة إلى فئة واحدة؛ بل هي تنقسم إلى فئتين على الأقل: الاعتباریّة والوهمیّة. وهاتان الفئتان لديهما اختلافات أساسيّة مع بعضها، والتي یلزم ذکرها في مجال آخر. ويمكن أن يقال باختصارٍ: المفاهيم أو الأفكار الوهميّة هي مفاهيم تمّ إنشاؤها بواسطة القوّة المتخيلة. ومن الممكن خلق معانٍ جديدة بسبب القوّة المتخيّلة وبالاستعانة بالمشاعر والعواطف ونحوها، ثمّ تقديمها من خلال التشبيهات والاستعارات ووصف الأشياء بها. إنّ المعاني الجميلة أو القبيحة التي يبدعها الفنّانون وخاصّة الشعراء، هي هكذا. والتفسيرات الشعريّة للأشياء
والظواهر ليست انعكاسات لواقعها الخارجي في العقل؛ بل يدلّ على الإبداع العقلي للفنان. إنّ هذه المعاني تخلقها قوّتُه المتخيّلة تحت تأثير مشاعره ورغباته الداخليّة؛ ولذلك فإنّ نظرة الفنان للعالم تعتمد على العواطف، وبما أنّ مشاعره تختلف باختلاف الظروف، فإنّ نظرته للعالم تتغيّر أيضًا. ففي بعض الظروف يرى شيئًا في قمة الجمال ويصوّر هذا الشعور، وفي ظروفٍ أخرى يعتبره قبيحًا للغاية أو مقزِّزًا ويرسم هذا الشعور أيضًا؛ ولذلك فإنّ هذه المفاهيم غير الواقعيّة قابلة للتغيير والتحوّل.
الفئة الثانية من المفاهيم غير الواقعیة هي المفاهيم الاعتباريّة. إنّ هذه الفئة من المفاهيم، رغم كونها غير واقعیّة، إلّا أنّ لها آثارًا واقعیّة تترتّب عليها؛ بحيث إذا لم توجد تلك الآثار سيصیر وضعها واعتبارها عبثًا ولغوًا. وتندرج في هذه الفئة إشارات المرور. ومن الواضح أن لاعتبارها تأثيرات حقيقيّة. ولكن في الوقت نفسه يمكن اعتبار المفاهيم والقضايا التي تقوم عليها بطريقة أخرى. إنّ هذه المفاهيم ليست انعكاسًا للحقائق الخارجيّة في العقل؛ بل إنّ احتياجات الإنسان المتغيّرة أو الثابتة هي التي قادته إلى هذا الاعتبار والعقد. إنّ جزءًا كبيرًا من هذه المفاهيم على الأقل متغيرٌ؛ لأن مجموعة من الاحتياجات الإنسانيّة تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان واختلاف الأحوال والظروف.
الذهن البشري مخزن للعديد من المفاهيم. نجد بالرجوع إلى أذهاننا
وفحص المفاهيم أنّها إمّا تنطبق على فردٍ واحد فقط أو تنطبق على عدد لا يحصى من الأفراد. فإذا كان من الممكن تطبيق المفهوم على فردٍ واحد فقط، فیسمّی (جزئيًّا)، وإذا كان من الممكن تطبيقه على عدد لا يحصى من الأفراد، فإنّه يسمّى (کلیًّا).
تنقسم المفاهیم أو التصوّرات الجزئیّة إلی عدّة أقسام کالتالي:
١. التصوّرات الحسّیّة.
٢. التصوّرات الخیالیّة.
يتمّ الحصول على التصوّرات الحسّيّة من خلال ربط الأعضاء الحسّيّة بالواقع المادي؛ كالمَشاهد التي نراها بأعيننا والأصوات التي نسمعها بآذاننا. ويعتبر معظم المفكّرين المسلمين أنّ هذا النوع من المعارف حصولیّةٌ.
إنّ التصوّرات الخيالیّة هي التصوّرات الحسّيّة التي يلتقط الخيال صورًا لها، عندما تحدث الصور الذهنيّة في النفس. بل من الممكن اعتبار وظيفة الخيال أبعد من ذلك واعتبارها قوّة تلتقط الصور من المنتجات الداخليّة والخارجيّة.
ذكرنا سابقًا أنّ المفاهيم أو التصوّرات الکلّیّة هي المفاهيم التي تصدق علی کثیرٍ من الأفراد. ليس من الصعب تحديد مثل هذه المفاهيم لفظيًّا. إنّ ما كان دائمًا صعبًا ومثيرًا للجدل طوال تاريخ الفلسفة هو حقيقة المفاهيم الکلّیّة، فالمفاهيم الکلّیّة هي نوع خاصّ من المفاهيم التي تتحقّق مع وصف الکلّیّة في مرتبةٍ محددة من مراتب الذهن، والقوّة التي تُدرك هذه المجموعة من المفاهيم تسمّى (العقل). يتمتّع الإنسان بقوّة إدراكيّة خاصّة، من وظائفها بناء المفاهيم العامّة وفهمها؛ كما أنّ إحدى وظائفها الأخرى هي بناء القضيّة والاستدلال والتعريف.
تلعب المفاهيم الکلیة دورًا أساسيًّا في المعرفة الإنسانيّة. وهي ثلاثة أنواع أو ثلاث فئات:
١. المفاهیم الماهویّة.
٢. المفاهیم المنطقیّة.
3. المفاهیم الفلسفیّة.
إنّ المعقولات الأولى أو المفاهيم الماهويّة هي قوالب مفهوميّة تُبيّن الحدود الماهويّة للأشياء؛ لكن المعقولات الثانية أو المفاهيم المنطقيّة والفلسفيّة هي صفات الوجود وتحكي عن أنحاء الوجود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ المفاهيم الماهويّة لها (ما بإزاء) خارجي
مستقلّ. ونقصد بکلمة (ما بإزاء) المحکي بالعرض أو المصداق، ولذلك فإنّ لكلّ مفهوم من المفاهيم الماهويّة وجوده وواقعه الخاص به خارج العقل. وتوجد حقائق خارجيّة بعدد المفاهيم الماهويّة، ولا يمكن أن تجد مفهومين ماهویَّین لا يوجد أمامهما سوى واقع واحد؛ لأنّ المفاهيم الماهويّة كما تقدم، هي حدود الوجود وتحکیها. فیقع تجاه كل منها محکيٌّ ووجود خاصّ.
إنّ المعقولات الثانية، بما في ذلك المفاهيم المنطقيّة والفلسفيّة، ليس لها (ما بإزاء) مستقلّ. ومثل هذه المفاهيم هي صفات الوجود وتعبّر عن أنحاء وجودات الأشياء. يعود التمييز بين المفاهيم الفلسفيّة والمنطقيّة إلى خارجیّة موصوفاتها وذهنیّتها (وهي الوجودات). فالمفاهيم الفلسفيّة تعبر عن أنحاء الوجودات الخارجيّة للأشياء والمفاهيم المنطقيّة تعبر عن أنحاء الوجودات الذهنيّة.
تنقسم المفاهيم أو التصوّرات (في النظر البدْوي وفي التقسیم الأوّلي) كالتصدیقات والقضايا، إلى البديهي والنظري، والمفاهيم أو التصوّرات البديهيّة هي مجموعة من المفاهيم أو التصوّرات التي لا تحتاج إلى التفكير والنظر، ولا تحصل من خلال مفاهيم أخرى. بینما المفاهيم والتصوّرات النظريّة هي التي یعتمد الحصول علیها علی التفكير والنظر. ولا يمكن الحصول عليها دون الفكر والنظر. إنّ منهج التفكير والنظر في مجال المفاهيم أو التصوّرات هو التعريف؛ بینما منهج التفكير والنظر في مجال التصدیقات والقضايا هو الاستدلال.
تمّ التأكيد في تعريف البدیهي على أنّ البدیهي لا يحتاج إلى التفكير والکسب. بینما النظري يتمّ الحصول عليه من خلال التفكير. وهنا يُطرح السؤال التالي: ما هي حقيقة الفكر؟ كيف لا يحتاج البدیهي إليه، لكن النظري مبني عليه؟ ثمّ ما هي العلاقة بین البدیهي والنظري بالفکر؟ ومن خلال استكشاف حقيقة الفکر، ستتّضح الإجابة على هذه الأسئلة.
التفكير هو عمليّة أو استكشاف عقلي لاكتشاف المجهول. وفي هذه العمليّة العقليّة يواجه المفكّر المجهول أوّلًا ويتعرّف على نوعه، ثمّ يعود إلى المعلومات المخزونة في ذهنه ومن خلال استكشافها يحدّد المعلومات التي تناسب المجهول ويختار منها المعلومات المناسبة المتعلّقة بالمجهول. ثمّ یقوم بتركيبها الصحيح وترتيبها
المنهجي، وبالتالي يحلّ المشكلة، ونتيجة لذلك يصبح المجهول معلومًا.
وهكذا فإنّ عملية الفكر والتفكير هذه تتحقّق من خلال عدّة مراحل:
1 مواجهة المشكلة.
2. تحديد نوعها.
3. الحركة الذهنيّة، أو بکلمة أدقّ: انتباه النفس إلى المعلومات.
4. البحث والاستكشاف بين المعلومات المتعلّقة بالمشكلة.
5. اختيار المعلومات ذات الصلة والمعلومات المناسبة للمجهول.
6. الترتیب الصحيح والمنهجي لتلك المعلومات.
7. حلّ المشكلة والحصول على الجواب.
ومن الواضح أنّ المرحلتين الأولى والثانية هما المراحل التمهيديّة لعمليّة التفكير، بینما المرحلة الأخيرة هي نتيجتها. وعلى أيّ حال، إذا كان المجهول مفهومًا من المفاهيم ففي هذه العمليّة العقليّة، يستطيع المفكّر اكتشاف المجهول وتبدیل المجهول إلى معلوم، وذلك من خلال التعريف الحقيقي في الحالات التي يكون فيها الحصول علیه ممكنًا؛ ولذلك يتمّ التوصّل في التعريف الحقيقي،
إلى فهم دقيق للمفهوم النظري للمجهول، وذلك من خلال ترتيب المفاهيم المعلومة التي هي المكوّنات الذاتیّة للمجهول. أمّا إذا كان المجهول تصدیقًا وقضیّةً، فيمكن استکشافه عن طريق الاستدلال -حيث يكون قابلًا للاستدلال- وذلك من خلال ترتیب القضایا المناسبة وذات الصلة بجانب بعضها.
ویتّضح من التحليل المذكور أعلاه أنّ التعريف والاستدلال نوعان أو طريقتان للتفكير، وقد يكون لكلّ منهما أنواع مختلفة. یتکوّن التعريف من جمع عدة مفاهيم مع بعضها بعضًا، وبالتالي يتمّ اكتشاف المفاهيم المجهولة من خلال المفاهیم المعلومة التي تعتبر المكوّنات الذاتیّة أو اللوازم لتلك المفاهيم المجهولة. ويُطلق على هذا النشاط العقلي اسم (التعريف) ويُخصَّص له جزء كبير من المنطق. يلعب العقل الدور الرئيسي في التعريف، کما في الطریق الآخر للتفكير (الاستدلال). وبالطبع تساعد في هذه الوظيفة القوّةُ المتصرفةُ العقلَ ویوظّفها. ونتيجة لذلك فإنّ العقل بمساعدة هذه القوة يجمع وينظّم المفاهيم المعلومة المرتبطة والمناسبة للمفهوم المجهول ويحصل علی معرفة المفاهيم المجهولة. كما أن العقل یلعب الدور الأساسي والأكثر أهميّة في طريقة التفكير الأخرى، وهي الاستدلال والاستنباط، فإنّ العقل يصنع الاستدلال من خلال ترکیب بعض القضايا المعلومة المناسبة والمرتبطة بالمشكلة المجهولة. ثمّ یصل علی ضوئه إلی معرفة المجهول التصدیقي. وبالتالي فإنّ الاستدلال هو نوع من التفكير أو الإنتاج العقلي الذي يتمّ الحصول عليه من خلال ترکیب وترتيب العديد من القضایا
(149)المعلومة والمرتبطة. ويعتقدون بشكل عامّ في علم النفس أنّ القوّة المتصرّفة تساعد في أداء الوظيفة العقليّة ولها دور في ترتيب المقدّمات العقليّة، وبالتالي تساهم في الاستدلال.
ونتيجة لذلك، فإنّ كلًّا من الاستدلال والتعريف هما نوعان من التفكير والإنتاج والتوليد الفكري واللّذان يتم الحصول عليهما من خلال ترکیب بعض القضایا أو المفاهيم. ولذلك فإنّ التفكير ليس إلّا تحليلًا وترکیبًا عقليًّا.
إنّ التفكير هو نوع من التحليل وجمع المعلومات للحصول على إجابة للمجهول وتوضيحه. ونكتسب معرفة جديدة من خلال هذا النشاط العقلي. فنحن نعرف المفاهيم النظريّة والمجهولة؛ ونحصل على نتيجة جديدة من خلال الاستدلال والجمع بين العديد من القضایا المترابطة والمعلومة مع بعضها. فمثلًا إذا جهلنا حقيقة الإنسان ومفهومه، فمن خلال الرجوع إلى المعلومات العقليّة واستكشافها والحصول علی المفاهيم المناسبة المتعلّقة به ومقارنة المفاهيم وتحليلها إلى المشتركة والمختصّة، نجد أن الإنسان حيوان ناطق. ونتيجة لذلك نصل إلى تعريف الإنسان. کما أنّه بالرجوع إلى المعلومات التصدیقیّة المخزونة في الذهن والبحث بينها والحصول علی القضايا والتصدیقات المناسبة والمرتبطة بقضيّة (العالم حادث) يمكن إثبات هذه القضیّة والبرهنة علیها وبالتالي يمكن معرفة هذه القضيّة المجهولة.
(150)إنّ الحدس یقع تّجاه التفكير الذي يتضمّن التعريف والاستدلال، لكن ما هو الحدس؟ يكتشف المدرِك في الحدس، المجهولَ فجأة؛ بمعنی أنّه يجد الأشياء ذات الصلة والمتعلّقة بها دون الرجوع إلى الذهن والبحث بين المعلومات. ولذلك لا توجد في الحدس الحرکةُ من المطالب إلی المبادئ والحرکة من المبادئ إلی المطالب. ونتيجة لذلك، فإن هاتين الحركتين لا تشاركان في تحقيق الحدس، خلافًا للتفکیر؛ حیث إنّه یتکوّن من هاتين الحركتين وتشاركان في تحقيقه.
يقتصر نطاق التفكیر أو مجال الفكر في العلم الحصولي؛ ولذلك فإنّ التقسيم إلی البدیهي والنظري والوصول إلى المجهول من خلال المعلومات والمبادئ لا يتحقّق إلّا في العلم الحصولي. مع أنّ التفكیر نفسه والصورة الذهنیّة معلومان بالعلم الحضوري. لا مورد للتفكير في مجال العلم الحضوري حيث إنّ العلم الحضوري أمرٌ وراء الذهن والمنطق، وهو نوع آخر یختلف عن العلم الحصولي؛ ولذلك فهو ماوراء التفكیر، ولا تجري فيه الأحکام الذهنیّة، بما في ذلك القواعد المتعلّقة بمناهج التفكير، وبما في ذلك التعريف والاستدلال.
يبدو أنّ معيار بداهة المفاهيم البديهيّة هو إرجاعها إلى العلوم الحضورية. المفاهيم التي يمكن اعتبارها بديهيّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الاستقراء: ١. المفاهیم الشهودیّة ٢. المفاهیم
الانتزاعیّة أو المفاهیم المنطقیّة والفلسفیّة ٣. المفاهیم الحسّیّة. وكل هذه الفئات الثلاث مستمدّة من المعرفة الحضوریّة.
إنّ أساس نظريّة المعرفة في مجال التصوّرات والمفاهيم يقوم على البنی التحتية البدیهیّة، وهي ترجع إلى العلوم الحضوریّة؛ ولذلك فإنّ المعرفة الحضوریّة هي مصدر انتزاعها ووصول الذهن إليها.
هناك عدّة نقاشات يمكن طرحها حول المفاهيم القيميّة مثل المفاهیم الفقهیّة والأخلاقیّة والقانونيّة والجماليّة: أوّلًا هل هذه المفاهيم حقيقيّة أم لا؟ ثانيًا: إذا كانت غير حقيقيّة فهل هي اعتباریّة أم ذوقیّة؟ ثالثًا، وإذا كانت حقيقيّة، فهل هي بديهيّة أم نظريّة؟
ومن الواضح أنّ نتائج أي إجابة على السؤالين الأوّل والثاني تظهر في القضایا المتکوّنة من هذه المفاهيم. إنّ کون هذه القضایا والعلوم التي تحتوي علی هذه المفاهیم حقيقيّة أو غیر حقيقيّة يعتمد على كيفيّة حكمنا حول هذه المفاهيم.
على أيّ حال، فيما يتعلّق بالمسألة الأولى، يبدو أنّ المفاهيم القيميّة كالمفاهيم الأخلاقيّة والقانونيّة ونحوها يمكن أن تدخل ضمن المفاهيم الفلسفيّة ونحوها. ووفقًا لهذا الموقف، فإنّ مفاهيم مثل الظلم والعدالة والأمانة والحسن والقبح، والينبغي واللاينبغي، والقبيح والجميل وما شابهها من المفاهيم هي مفاهيم حقيقيّة لها ما
بإزاءٌ خارجي، ولا تعتمد على عقود أو اعتبارات أو أذواق الخاصّة.
ووفقًا لهذا الرأي، فالسؤال الثاني سالبٌ بانتفاء الموضوع؛ لأنه يبدو أنّ هذه المفاهيم حقيقيّة وواقعیة؛ ولذلك فإنّ افتراض كونها غير حقيقيّة أو غير واقعیّة افتراضٌ منفيٌّ من وجهة النظر هذه.
لكن ما هو جواب السؤال الثالث؟ وإذا اعتبرنا هذه المفاهيم حقيقيّة وواقعیّة، فهل هي بديهيّة أم نظريّة؟ يبدو أنّ العديد من مفاهيم الموضوعات الأخلاقية مثل الظلم والسرقة والعدالة، وكذلك مفاهيم المحمولات الأخلاقيّة مثل القبيح والجميل، والحسن والقبیح بديهيّة ولا تحتاج إلى التعريف، والاختلافات التي يمكن رؤيتها حول هذه المفاهيم لا تتعلّق بتعريفها، بل ترجع في الواقع إلى شرح الهوية الفلسفيّة والتعرّف على مصادیقها، وأشياء من هذا القبيل. ومن الواضح أن هناك فرقًا جوهريًّا بين مسألة التعريف ومثل هذه المسائل.
وبناء على الاستقراء يمكن القول إنّه يوجد معنيان للتصدیق في المصطلح العلمي:
1. الميل والقبول والاعتقاد والإقرار والإذعان ونحو ذلك. ويمكننا أن نُطلق على هذا المعنى الذي یشیر إلی المیل والأفعال الجوانحیّة، اسم (التصدیق القلبي).
2. الإدراك أو فهم الصدق. وبعبارة أخرى: إدراك مطابقة القضيّة للواقع. کما أنّ التکذیب هو إدراك عدم مطابقتها للواقع. وحقيقة هذا المعنى هو العلم والإدراك، ويمكن أن يسمّى (التصدق العلمي).
یبدو في الوهلة الأولى أن يكون التصدیق في مصطلح المنطق ونظريّة المعرفة يعني إمّا إدراك الصدق أو الإذعان بالصدق؛ ولكن عند التأمّل نجد أنّ المقصود بالتصدیق في مصطلح المنطق وغيره من المعارف المتجانسة هو فهم الصدق أو إدراكه. إنّ الإذعان بالصدق أو الإقرار به هو فعل نفسانيٌّ؛ ولكن ما هي علاقة الفعل بالعلم؟ إن الفعل ليس علمًا؛ بل هو إمّا أن يدخل في مقولة الكيف، فيكون انفعالًا لا فعلًا، وإمّا كالحركة خارجٌ عن المقولات، بل هو من سنخ الوجود.
تنقسم التصدیقات أو القضایا في قسمةٍ أوّلیةٍ ونظریّة بدویةٍ إلى البديهيّة والنظريّة. إنّ التصدیقات أو القضایا البدیهیّة هي قضايا لا يحتاج قبولها إلى تفكير ونظرٍ؛ لكن التصدیقات أو القضایا النظريّة لا يمكن الحصول عليها دون تفكير ونظرٍ. إنّ طريقة التفكير والنظر في مجال التصدیقات والقضايا هي الاستدلال؛ کما أنّ طريقة التفكير والنظر في مجال المفاهيم أو التصوّرات هي التعريف.
ووفقًا للتعريف المذكور أعلاه، فإنّ البديهي لا یحتاج إلی الاستدلال. وهذا الحكم عامّ يشمل جميع التصدیقات أو القضایا
البديهیّة، سواء تلك القضایا التي لا تقبل الاستدلال أو التي تقبله. ومن هذا المنطلق يمكن استنتاج أنّ هناك فئتين من التصدیقات أو القضايا البديهيّة: بعضها لا يقبل الاستدلال ولا يمكن الاستدلال عليها، والصنف الآخر قابل للاستدلال لكنّه لا يحتاج إليه.
ولكي توصف قضيّة أو نظريّة بأنّها بدیهیّة، لا بدّ بالإضافة إلى هذه السمة (عدم الحاجة إلی التفكیر والنظر)، أن تكون لها سمات أخرى، وهي ما یلي: أن تكون صادقة أو مطابقة للواقع، وأن تکون يقينیة وثابتة وأن لا تزول. وإذا لم تكن القضيّة أو التصدیق بهذه السمة، فإنّه لا یطلق علیها اسم (البدیهي) و(الضروري) حتی ولو جُعلت مبدأ للاستدلال؛ ولذلك فإنّ التصدیق أو القضیّة البدیهیّة هو التصدیق أو القضیّة التي یتعلّق بها الیقین بالمعنی الأخص ويمكن أن یحصل به الاعتقاد الجازم الصادق الثابت؛ ولذلك فإنّ القضایا الیقینیّة بديهيّة لا جمیعها. ويبدو أن البديهيّات الأوّلیة والوجدانیّات فقط هي التي تتّصف بمثل هذا الوصف؛ لأنّه إنّما يمكنك الحصول علی الاعتقاد الجازم الصادق الثابت فیهما فقط؛ لأنّ البديهيّات الأوّلیة حسب التعريف المتقدّم، هي القضایا التي لا ينشأ التصدیق فیها إلّا من التصوّر الصحیح للموضوع والمحمول والنسبة بینهما، کما أنّ الوجدانیّات هي قضایا تعکس العلوم الحضوریّة؛ ولذلك لا یحتاج تصدیقها إلى الاستدلال.
إنّ الصدق والكذب في المنطق ونحوه هما وصفان للقضیة.
والقضیّة التي تتّصف بالصدق والكذب هي المعرفة مع الواسطة، والتي تحكي بالفعل عن الواقع الخارج عن ذاتها. وبما أنّ الواسطة قد لا تؤدّي دورها بشكل جيد، فمن المتصوّر وجود حالتين للقضيّة:
1. أن تكون القضیّة مطابقة للواقع، وفي هذه الحالة تكون صادقة.
2. أن لا تكون القضیّة مطابقة للواقع، وفي هذه الحالة تعتبر کاذبة.
وعلى هذا فإنّ الصدق الذي هو وصف للقضيّة عبارة عن مطابقة القضيّة للواقع ومَحکیّها. والکذب الذي هو أيضًا وصف للقضيّة، هو عدم مطابقة القضيّة للواقع ومَحکیّها.
ویُستنتج ممّا تقدّم أنّ القضایا فقط هي التي تتّصف بأنها صادقة أو كاذبة؛ وأمّا المفاهيم والتصوّرات فلا يمكن أن تتّصف بهما؛ لأنّ الصدق أو الباطل مبني على الحکم والأحكام لا توجد إلّا في القضایا. ولا سبیل للصدق أو الكذب في المعارف التي لا یوجد فیها الحکم.
إنّ العلم الحضوري لا يتّصف بالصدق والکذب أو المطابقة وعدم المطابقة للواقع أیضًا؛ لأنّه في هذا النوع من العلوم لا توجد واسطةٌ كالمفاهيم والصور العقليّة، بين العالم والمعلوم أو المدرِك والمدرَك؛ بل ذات المعلوم موجود لدی العالم، ويجد العالمُ ذات
الشيء دون أيّ واسطة كالمفاهيم والصور العقليّة. مضافًا إلی أنّ أشیاء مثل المطابقة، والصدق والكذب، والحکایة، والشكّ، والیقین، والتصوّر، والتصدیق والتفکير، والتعقّل، والاستدلال، والتعریف، والتفهیم والتفهّم، ممّا یختصّ بالذهن ولا تشمل الخارج. وبما أنّ العلم الحضوري هو أمر خارجيٌّ، وفي هذا النوع من العلم یکون ذات المعلوم موجودًا للعالم دون وساطة المفاهيم والصور الذهنيّة، فإنّ الصفات المذكورة أعلاه التي تُستخدم لوصف المعرفة الحصولیة لا تنطبق على المعرفة الحضوریّة. وعلى هذا فإنّ الأحكام المتعلّقة بالعلم الحصولي لا تصحّ فیها أيضًا.
أمّا المفكّرون المسلمون فقد أرجعوا القضايا النظريّة إلى القضايا البديهيّة أيضًا، وذلك بالإضافة إلى إرجاعهم المفاهيم النظريّة إلى المفاهيم البديهيّة. ومن وجهة نظرهم فإنّ معيار صدق جميع القضايا النظريّة هو إرجاعها إلى القضايا البديهيّة، سواء أكانت القضايا النظريّة قبلیّة أم بعدیّة، وعقليّة أم تجريبيّة، ونقلیّة أم غیر نقلیّة. إن القضايا البديهيّة التي يعتبرها حكماء المسلمين ومناطقتهم مبادئ الاستدلال، تنقسم حسب الاستقراء إلى عدّة أقسام: القضایا الیقینیّة، والقضایا المشهورة (المشهورات)، والقضایا المتخیّلة، و...
أمّا القضایا الیقینیّة أو الیقینیّات، فهي کثیرةٌ، ويمكن تقسيمها إلى القبلیّة والبَعدیّة. إنّ القضايا القبلیّة هي القضایا التي لا یمکن التعرّف علیها وتحدید صدقها وکذبها إلّا عن طريق العقل. وهذه القضايا لا تحتاج إلى الحواس والاختبار، وأمّا القضايا البَعدیة فهي القضايا التي لا يمكن التعرّف علی صدقها وکذبها إلّا من خلال الحواس.
وعلى كلّ حال، فإنّ معيار صدق القضايا النظريّة القبلیّة هو إرجاعها إلى البديهيّات، وعلى الأكثر إلى الوجدانیّات، کما أنّ معيار صدق القضايا النظريّة البَعدیّة هو إرجاعها إلى البديهيّات البَعدیّة. وعلى الأقل يمكن اعتبار القضایا الحسّیّة والمتواترة أسسًا للقضایا النظريّة البَعدیّة.
وينبغي أن يقال: إنّ جميع القضايا البَعدیة، حتّى المتواترة منها، تحتاج إلى القضایا الحسّیّة. ویحتاج وجود المحسوسات في الخارج إلی البرهان العقلي. ولذلك فإنّ القضايا الحسّيّة إنّما تکون یقینیّة ومفیدة للیقین، إذا أقیم البرهان عليها، وإلّا فهي غير مفیدة للیقین؛ لأنّها معرضة للخطأ ویوجد هناك احتمال للخطأ فيها.
ومن هذا المنطلق يمكن القول: إنّ القضايا الحسّيّة أو الحسّیّات، والتي هي مبادئ القضايا البَعدیّة، تقوم على الاستدلال والبرهان العقلي، وإنّ الاستدلال العقلي نفسه يتکوّن عن البديهيّات الأوّلية، أو على الأقل إنّ جزءًا من مقدّماته هي البديهيّات الأوّلية؛ ولذلك
ففي بعض الحالات یمکن إحراز صدق القضایا الحسّیّة من خلال صدق الأوّلیات أيضًا.
فمعيار صدق القضايا النظريّة، سواء القبلیّة منها والبَعدیّة، هو إرجاعها إلى البديهيّات الأوّلية. وإذا استُنبطت هذه القضايا من البديهيّات الأوّلية بشكل منطقي صحيح، فإنّها ستكون يقينيّة وصادقة ومطابقة للواقع؛ ولذلك فإنّ معيار صدق القضايا النظريّة السابقة هو إرجاعها إلى الأوّليات؛ كما أنّ معيار صدق القضايا النظريّة البَعدیّة أيضًا هو إرجاعها إلى القضايا الحسّيّة (الحسّيّات). وإنّما يمكن الحصول على صدق القضايا الحسّيّة التي هي مبادئ القضايا النظريّة البَعدیة، إذا تم توثیق تلك القضايا الحسّيّة بالأوّلیات، وبالتالي تمّ بمساعدتها استدلالٌ عقليٌّ. وبهذه الطريقة، فإنّ صدق القضايا الحسّيّة یعتمد أخيرًا على صدق الأوّلیات.
والآن يطرح هذا السؤال: كيف یُحرز صدق الأوّلیات؟ وبأي معيار يمكن الحصولُ علی صدقها واعتبارُ حكم العقل بتطابقها للواقع صحيحًا؟ أمّا بالنسبة إلی معيار صدق البديهيّات الأوّلیة فقد طرح المفكّرون المسلمون حلّين:
1. إحراز صدق البديهيّات الأوّلیة عن طریق کون المحمول أولیًّا للموضوع.
2. إحراز صدق البديهيّات الأوّلیّة عن طریق إرجاعها إلى العلوم الحضوریّة.
إن معیار صدق القضایا النظریّة الیقینیّة البَعدیة هو إرجاعها إلی القضایا البدیهیّة البَعدیة. وأمّا القضایا البدیهیّة البَعدیة کالقضایا الحسّیّة إذا أمکن إرجاعها إلی البدیهیّات الأوّلیّة والوجدانیّات، فهي تعطي الیقین بالمعنی الأخصّ، ویشملها معیارُ صدق القضایا القبلیّة في نظریّة المعرفة العامّة أو المطلقة. والآن نواجه هنا حقيقة مهمّة جدًّا، وهي أنّ العديد من القضایا البعديّة التي اعتبروها بدیهیّة لا يمكن إرجاعها إلى البديهيّات الأوّلیّة والوجدانیّات. وبالتالي فإنّ الحلّ المذكور سيواجه مشاكل صعبة. فإنّ مشكلة الحلّ المذکور هي أنّه ليس شاملًا ولا يشمل جميع المعارف البَعديّة، ولا یمکن الوصول إلی الیقین بالمعنی الأخصّ في كثير من المعارف البَعديّة. هذا من ناحيةٍ. ومن ناحية أخرى، إنّه حتّى في كثير من الحالات التي يمكن فيها الوصول إلی الیقین بالمعنی الأخصّ، فإنّ اكتساب هذه المعرفة لا يكون ميَسِّرًا للجميع. ما هو الحلّ الذي يمكن اقتراحه لتقويم وضمان هذه المعرفة من وجهة نظر نظريّة المعرفة؟
ولحلّ هذه المشكلة يمكن الاستفادة من مسألة أنّ حجّیّة الأدلّة
الیقینیّة ذاتیةٌ وأن حجّیّة الأدلّة الأخرى تعود إليها، وبالتالي یمکن القول: إنّ حجّیّة الأدلّة غير الیقینیّة العقلائیّة، مثل الأمارات العقلائیة، تبتني على الأدلّة اليقينيّة؛ وتکسب الأدلّةُ غير اليقينيّة العقلائیة حجّیّتَها من الأدلة اليقينيّة. وأمّا حجّیّة الأدلّة اليقينيّة فهي ذاتیةٌ لها ولا تبتني على شيء آخر خارج عن ذاتها. وعلی ضوء ذلك، تُعتبر حجّیّة الأدلّة غير اليقينيّة حجّیّة غیریّة (بالغیر) وتعود الحجّیّة المعرفیّة لمثل هذه الأدلّة إلی الأدلّة اليقينيّة. وبهذه الطريقة أو الحلّ يمكن حلّ المشكلة المذكورة أعلاه على أساس الاعتماد علی اليقين المنطقي أو اليقين بالمعنى الأخص. وبناء على هذا التحليل والحل الجديد يمكن القول إنّه بالإضافة إلى المعرفة اليقينيّة، فإنّ حجّیّة المعارف التي يتمّ الحصول عليها من خلال الأمارات العقلائیّة المعتبرة مثل خبر الواحد والظواهر، هي یقینیّة أيضًا؛ لأنّ حجّیّتها ثابتة عن طریق العقل، ویتمّ إحرازها بطریقة یقینیّة، وهي الیقین بالمعنی الأخص؛ ولذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الأمارات العقلانيّة لها الحجّیّة المعرفيّة، والدليل على حجّیّتها هي الأدلّة أو الحجج التي تعطي اليقين المنطقي دون اليقين النفسي.
وإذا توصّلنا إلى نتيجة مفادها أنّ الحلّ المبني على العلاقة بين القضیّة وواقعها (المحکي) لا يشمل ولا يصدق على جميع القضایا والمعارف غير اليقينيّة بالمعنى الأخصّ، وإنما يُحرَز به صدقُ القضایا اليقينيّة بالمعنى الأخصّ فحسب، فهل هناك حلّ لإحراز صدق القضایا التي ليس لدينا مثل هذا المستوى من المعرفة بها؟
(161)يمكن الاستفادة من حساب تراكم الاحتمالات كلّ هذه المشكلة، وقد يكون لتقديم الحل من خلال الاحتمال وتراکمه تفسيراتٌ مختلفة. ويعتبر آية الله الشهيد السيِّد محمّد باقر الصدر رائدًا في هذا المجال. وهو أوّل من استخدم حساب الاحتمالات في هذا المجال وفَتَح عقدة هذه المشكلة الصعبة بطريقة جديدة في الاستدلال والصعود المعرفي بطريقة مبتكرة. إنّ الشهيد الصدر من خلال ابتكاره حلًّا جديدًا لمشكلة الاستقراء، قدّم نظريّة بديلة لجميع العقلانيّين والحسّيّين، وهو من خلال استخدامه تفسيرًا جديدًا لحساب الاحتمالات، استنادًا إلى طريقة مبتكرة، حاول تقويم جميع التعميمات التجريبيّة، بل جمیع القضایا المتواترة والحدسیات والمحسوسات والفطریات، وأعطی لها الحجّیّة. والحل المذكور في حلّ مشكلة الاستقراء، والذي يسمّيه (الطریقة الذاتیّة)، يعطي معيارًا جديدًا في قيمة المعرفة وتقويم المعرفة.
ومن وجهة نظر الشهيد الصدر، فإنّ الطريقة الذاتيّة أو التوالد الذاتي (تجاه التوالد الموضوعي) هي تکوّن معرفةٍ من معرفة أخرى بناء على وجود التلازم بين هاتين المعرفتين. أو بکلمة أخری: الحصول علی درجة من الاحتمال من خلال درجة احتمال آخر، بناءً على وجود الملازمة بين التصدیق والإدراك. وأمّا التوالد الموضوعي فهو الحصول علی معرفةٍ من خلال وجود الملازمة بین موضوع المعرفة، وهي القضیّة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الجهة الذاتیّة للمعرفة ليست معنى نفسيًّا ومعتمدًا على العالِم، والذي یعتبر ظاهرة شخصيّة؛ بل تعني المعرفةَ أو درجة من التصدیق بالقضيّة، التي هي في حدّ ذاتها، مثل القضيّة، أمرٌ موضوعي وحقيقي وخارجي.
ويبدو أنّه من خلال إصلاح هذه النظريّة وتصحيح بعض نواقصها يمكن حلّ المشكلة المعرفيّة للقضایا البَعدیّة.
الصعود المعرفي في مجال القضايا هو الحصول علی القضایا النظريّة من خلال القضایا البدیهیّة، فكما أنّ معيار صدق القضایا النظريّة هو إرجاعها إلى البديهيّات، فإنّ طریق الحصول علی القضایا النظريّة هو الاستدلال. وبهذا یعتبر الصعود أو التوسّع المعرفي في مجال التصدیقات أو القضايا نوعًا من الاكتساب والنظر. وهذا النشاط العقلي يتمّ عن طريق الاستدلال.
ینقسم الاستدلال إلی نوعین: المباشر وغیر المباشر (الحجّة). إنّ الاستدلال المباشر هو استدلالٌ یتم فيه الحصول على النتيجة من
خلال قضیّة واحدةٍ فقط. وله طرق مختلفة؛ مثل النقض والعکس والتقابل. وأمّا الاستدلال غیر المباشر فهو استدلالٌ یحتاج إلى أكثر من قضيّة لأجل الوصول إلی النتيجة، وهو على عدّة أنواع: الاستقراء، والتمثیل، والقیاس. وذلك لأنّ السیر المنطقي في الاستدلال غیر المباشر إمّا أن یتم من الجزئي إلى الكلّي، وهو ما يسمّى (الاستقراء)؛ أو من الكلّي إلى الجزئي ويسمّى (القیاس)؛ أو من الجزئي إلى الجزئي، وهو ما يسمّى (التمثیل).
ینقسم القیاس نفسه من حیث الصورة والمادّة إلی أنواع عديدة ويختلف حكم كلّ نوعٍ من حيث الحجیّة والقيمة المعرفيّة. وإذا كان القياس يقينيًّا من حیث الصورة والمادّة، فإنّه يسمّى (البرهان).
وقد ذكرنا سابقًا أنّ الإنسان يستطيع أن يوسّع معرفته بالحقائق من خلال منهج الصعود المعرفي الصحيح وباستخدام العواصم المعرفية التي يحصل من خلالها على العلم بالحقائق والظواهر. ولذلك فمن الممكن توسیع المعارف اليقينيّة والحصول علی المعارف النظریة اليقينيّة المنتجة من المقدمات البدیهیّة، وذلك من خلال المعارف اليقينيّة البدیهیّة وبطريقة يقينيّة مثل الشکل الأوّل الذي هو بديهي. كما أنّ توسیع المعارف غير اليقينيّة أمر ممكن أيضًا.
إنّ نطاق المعرفة الإنسانيّة وإن کان محدودًا، إلّا أنّ معرفة الإنسان لا تقتصر على المحسوسات، بل تشمل أشياء أخرى أيضًا؛ وذلك لأنّ مصادر المعرفة الإنسانيّة لا تقتصر على الحواس الظاهريّة. إنّ بعض مصادر المعرفة كالعقل والشهود يتجاوز الزمان والمكان ويشمل الأشياء غير المادّيّة أيضًا. ولذلك فإنّ المدرَکات البشريّة تتجاوز المحسوسات. يستطيع الإنسان من خلال مصادره المعرفيّة أن یعرف المبدأ، والمعاد، والبرزخ، والمجرّدات التامّة، والنفوس المجرّدة، ویمکنه إثبات وجود بعض خصائصها. إنّ الاقتصار علی الحواس الظاهريّة يجعل الإنسان مسجونًا في سجن الطبيعة. ولا يستطيع في هذه الحالة حتّى إثبات وجود المحسوسات في الخارج، ونتيجة لذلك، يقع في دوامة الشكّ حتّى في مجال المحسوسات. إنّ نظریّة الاقتصار علی الحواس الظاهريّة تتطلّب الشكوکیّة. کما أنّ قبول حجیّة العقل والإقرار بحجیّة الحواس الظاهريّة علی ضوء العقل، يتطلّب الواقعيّة. ولذلك فإنّ الاعتماد والرجوع إلى الحواس الظاهریّة فقط والمنهج التجريبي في العلوم الإنسانيّة، هو خطأ واضح، بناءً على افتراض أن العلوم التجريبيّة ليست يقينيّة بمعناها الشائع.
للمعرفة مستويات ومراتب. وكما ذكرنا فإنّ المعرفة إمّا أن تكون حضوریّة أو حصولیّة، کما أنّ المعرفة الحصولیّة إمّا تصوّریّة أو
تصدیقیّة (معرفة القضایا). تتمتّع المعرفة بالقضایا من بين أنواع المعرفة، بميزة خاصّة. وفي هذا النوع من المعرفة ينبغي التمييز بين جهتین:
1. العلاقة بين القضيّة ومَحکیّها: توصف القضيّة من هذه الجهة بأنّها صادقة أو کاذبة. إذا كانت القضيّة مطابقة لمَحکیّها فهي صادقة، وإذا لم تكن مطابقة له، فهي کاذبة. تعدّ وجهة النظر هذه وجهة نظر منطقیّة. ومن هذا المنطلق فإنّ القضيّة المطابقة للواقع تسمّى (علمًا ومعرفة)، وإذا لم تكن مطابقة للواقع تسمى (جهلًا). ويسمّى هذا الجانب في الاصطلاح الجانب الموضوعي للقضيّة.
2. العلاقة بين القضیّة والمُدرِك: وفي هذه الجهة تؤخذ بعين الاعتبار کیفیةُ اعتقاد المُدرِك بالقضیّة، ویُهتمّ بأحواله المختلفة في التعامل مع القضیّة. وعادة ما تنقسم حالاته إلى الیقین والظنّ والشكّ والوهم. تعدّ وجهة النظر هذه وجهة نظر نفسيّة. وفي هذه الجهة یُهتمّ بحالات المُدرِك، بغض النظر عن مطابقة القضیة للواقع (وهو محکيّ القضیة) أو عدم مطابقتها له؛ ولا یُهتمّ بالجهة المنطقیّة للقضیّة؛ ولذلك يمكن دراسةُ معرفة القضيّة من وجهين، والحصولُ على أنواع من المعرفة علی ضوء أقسام كل جانب من تلك الجهات.
ووفقًا لما سبق، فإنّ للمعرفة عدّة استخدامات أو مصطلحات:
أ) المعرفة بمعناها العامّ، الذي یشمل الحضوریّة والحصولیّة.
ب) المعرفة الحصولیّة التي تشمل التصوّر والتصدیق أو المفهوم والقضیّة.
المعرفة المتعلّقة بالقضیّة، لها استخدامات أو مصطلحات مختلفة أيضًا:
أ) المعرفة اليقينيّة بالمعنی الأخص والمتعلّقة بالقضیّة. وهي الاعتقاد الجازم الصادق الثابت. تُعتبر في هذا الاستخدام علاقة القضیّة بالواقع وعلاقتها بالمُدرِك معًا؛ ولذلك فإنّ هذا النوع من المعرفة لا يشمل الجهل المركب. وقد تمّ تعريف هذا المستوى من المعرفة بحيث يمكن اعتبار عناصره ومكوّناته على هذا النحو: 1. التصدیق أو الاعتقاد بقضیّةٍ من القضایا (p) 2. الجزم بها 3. الصدق 4. الثبات.
یشیر العنصر الرابع (الثبات) إلی أنّ هذا النوع من المعرفة ليس تقلیدیًّا، بل إمّا أن يكون بیّنًا وبديهيًّا ولا يحتاج إلى الاستدلال، وإمّا أن يكون مبیَّنًا وقد استُدلّ له، وبالتالي فهو نظريٌّ وقد استدل لإثباته؛
ب) المعرفة اليقينيّة بالمعنی الأخصّ والمتعلّقة بالقضیّة. وهي الاعتقاد الجازم الصادق. تُعتبر في هذا الاستخدام علاقة القضیّة بالواقع وعلاقتها بالمُدرِك معًا. إن هذا النوع من المعرفة وإن کان يشمل المعرفة التقلیدیّة اليقينيّة إلّا أنّه لا یشمل الجهل المركب؛ ولذلك فإنّ هذا النوع من المعرفة یمتاز عن المرتبة الأولی بأنّ المرتبة الأولی لا تشمل المعرفة التقلیدیّة اليقينيّة، بخلاف هذه
المرتبة، فإنها تشمله أیضًا. إنّ عناصر ومكوّنات هذا النوع من المعرفة هي کالتالي: 1. التصدیق أو الاعتقاد بقضیّةٍ من القضایا (p) 2. الجزم بها 3. الصدق.
ج) المعرفة اليقينيّة بالمعنی الأعم والمتعلّقة بالقضیّة. وهي الاعتقاد الجازم. تُعتبر في هذا الاستخدام علاقة القضیّة بالمُدرِك فحسب، لا علاقتها بالواقع. تسمّی هذه المرتبة من المعرفة (الیقین النفسي) أیضًا.
ج) المعرفة الظنیّة والمتعلّقة بالقضیّة. وهي الاعتقاد الراجح. وهذا المستوى من المعرفة نفسه، له مستويات تبدأ من المستوى القريب من الشكّ وتستمر إلى المستوى القريب من الیقین، والمستوى الأعلى يسمّى (الاطمئنان). ومن الواضح أنّ هذا المستوی يُطلق عليه أيضًا اسم (المعرفة). وتنشأ حجیة هذا النوع من القضايا (أي القضايا الظنیّة) من حيث إنّها غالبًا ما تحکي عن الواقع، وتسمّى من هذه الجهة (الأمارة). وأمّا إذا حصل لنا الشكّ أو الوهم بقضیّةٍ من القضایا، فلا يُطلق علی هذا المستوی اسم (المعرفة) حتّى لو كانت درجة الاحتمال خمسین بالمئة.
ولذلك، لا يمكن الوصول إلی مستوى واحد من المعرفة في جميع العلوم، بل في جميع مسائل علمٍ واحدٍ أيضًا. وتختلف مستويات المعرفة، وتختلف مصادرها أو طرقها، ويحتوي كل منها على درجة
أو مرتبة خاصة؛ ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى أنّ العلوم الإنسانيّة، بل کلّ واحدٍ من مسائلها، تفید أيّ درجةٍ ومستوی من درجات ومستویات المعرفة.
كما ثبت في الأنثروبولوجيا، فإنّ عقائد الإنسان وأفعاله الإراديّة هي سبب ظهور الحالات ثمّ الملكات النفسانیّة سواء أکانت من الفضائل أم الرذائل. كما أن الملكات تلعب دورًا حاسمًا وأساسيًّا جدًّا في الهويّة الإنسانيّة.
و يمكننا أن نقول من خلال بحث أكثر تفصيلًا علی ضوء المصادر الإسلاميّة ومن منظور العرفان والتفسير والحكمة المتعالية: إنّ أفعال الإنسان وعقائده، بالإضافة إلى البقاء والخلود، ليست عديمة اللون؛ بل لديها هويّة بحسب حسنها أو قبحها، وحقيقتها أو بطلانها. وعلى العموم، فإنّ العمل الصالح له وجه حسن، والعمل السيّئ له وجه قبيح مكروه. وبالإضافة إلى ذلك، ليست الأفعال والعقائد وحدها هي التي تبقى وتوجد بأشكال جميلة أو قبيحة، بل لا شكّ في أنّ الأفعال والعقائد تؤدّي إلى ظهور ملکاتٍ تلعب دورًا أساسيًّا وحاسمًا في تحديد هوية الإنسان. ولا يقتصر تأثير الملكات على الإنسان على نفس المقدار أیضًا؛ بل يتم تحديد هويّة الإنسان من خلال هذه الملکات. إنّ الملکات التي تنشأ عن عقائد الإنسان وأفعاله الإراديّة، وبالتالي تكون الإرادة من عناصرها المقومِّة لها، تلعب دورًا أساسيًّا في نشوء هويّة الإنسان وتغيیرها.
ومن الناحية المعرفية أیضًا، فإنّ مسألة تأثير الأفعال والأحوال والملکات والعقائد في المعرفة الإنسانيّة تستحق البحث، بل هي من أهم المواضيع الأساسيّة والأكثر عمليّة وتأثیرًا في هذا المجال. وتوصّلنا في هذا الموضوع إلى نتيجة مفادها أن تأثيرها یکون علی حد الاقتضاء فقط. وأنّ أي حكمٍ مطلقٍ حول تأثير الذنوب أو الأفعال القبیحة والحالات والملکات الرذیلة على المعرفة الإنسانيّة هو أمر غير صحيح، سواء في مجال العلوم الحضوریة أو في مجال العلوم الحصولیة. لا یمکن إنکار جمیع أنواع التأثيرات على الإطلاق. هذا من ناحیةٍ. ومن ناحیة أخری، فإنّ تأثیرها لیس علی سبیل العلیة التامّة. بل يمكن القول: إنها توفّر الأرضیّة لإغلاق الطريق أمام بعض المعارف. ولذلك فإنّ تأثيرها علی حد الاقتضاء. إنّ الملكات الرذيلة ولذة المعاصي والذنوب تمنع الناس من البصيرة.
إنّ الأفعال الحسنة والأحوال والملكات ذات الفضيلة والتقوى تلعب دورًا في المعرفة الإنسانيّة أيضًا؛ لكن تأثيرها علی حدّ الاقتضاء أيضًا. وبغضّ النظر عن الصمود تجاه الفشل والافتتان وانعدام الثقة بالنفس ونحو ذلك، يمكن ذکر بعض آثارها على النحو التالي:
أ) التصوّر الصحيح للمسألة وعدم رؤية وتجاهل ما تهویه النفس أو عدم إهمالها.
ب) الاهتداء إلى الاستدلال الصحيح وتَلقِّي فیضَ أو إلهامَ الأدلّة الصحیحة للوصول إلى الحقيقة.
(170)
ج) عدم نسيان الأدلّة الدامغة ضدّ الشكوك والمغالطات وتذكّرها.
د) التعرّف على الأقوال والأدلّة المضلّلة وعدم خفائها عن بصيرة المدرك.
ه) كشف المغالطات الخادعة وإيجاد حلول للشكوك المعقّدة.
و) القدرة على شرح المتشابهات وإرجاعها إلى المحكمات.
إنّ طرق البحث عديدة ومتنوّعة؛ وبما أنّ تلك الأساليب مستمدّة من مصادر المعرفة وأنّ أكثر مصادر المعرفة الإنسانيّة الشائعة كفاءة هي: الحواس الظاهريّة، والشهود أو العلم الحضوري، والعقل والدلیل النقلي، فيمكن سرد أكثر الطرق شيوعًا على النحو التالي: 1. الطريقة العقليّة أو التعقّلیّة 2. الطريقة الحسّيّة والاستقرائيّة 3. الطريقة الشهودیّة 4. الطريقة التاريخيّة التي یكون مصدرها الدليل النقلي.
ليس من الممكن التحقيق في كل مسألة بأي طريقة تريدها؛ بل إنّ مسائل العلم متنوّعة وكل طریقة مخصّصةٌ لمجموعة خاصّة من المسائل؛ لأنّ مصادر معرفة الحقائق وطرقها مختلفة، ولكل مصدر أو طريقة نطاقٌ محدّد. كما أنّ كلّ مسألةٍ لها مسانخةٌ لدلیلٍ خاصٍ
وطريقة بحث خاص، ولا بدّ من الاهتمام بهذه المسانخة في مجال البحث.
توضيح ذلك أنّ كل مسألة تتكوّن من قضیّة واحدة أو أكثر. وكلّ قضیّة تتكوّن من عدّة مفاهيم أو تصوّرات. إنّ مجموعة من المفاهيم أو التصوّرات غير حقيقيّة ومجموعة منها حقيقيّة. والمفاهيم الحقيقيّة إمّا جزئية أو کلّیّة، والمفاهيم الکلّیّة إمّا فلسفيّة أو منطقيّة أو ماهويّة، والمفاهيم الماهويّة إمّا أن تكون محسوسة أو شهوديّة و... وكما تقدّم في مناقشة المفاهيم، فإنّ القضایا التي تكون مفاهيمها غير حقيقيّة، لا طریق فیها لقواعد المنطق والاستدلال، وبالتالي يعتمد البحث فيها على منهج خاصّ. إنّ القضایا المتکوّنة من المفاهيم الماهويّة المحسوسة تعتمد على الأساليب التجريبيّة أو الاستقرائيّة ولا يمكن التعرّف عليها وإثباتها بالطرق العقليّة. على سبيل المثال: ما الذي يسبب سرطان المعدة؟ وكيف يمكن علاج هذا المرض؟ وكيف يحدث الاكتئاب؟ وكيف يمكن علاجه؟، هي من المسائل التي تعتمد على الخبرة الحسّيّة ويمكن للعقل بمساعدة الحواس وبالاستقراء أن يصل إلى إجابتها. وبکلمة أخری: يمكن حل مثل هذه المسائل بالطريقة الحسّيّة أو الاستقرائيّة؛ بینما لا يمكن حلّ القضايا الفلسفيّة والتأريخيّة بهذه الأساليب. فإنّ القضايا التاريخيّة إنما تثبت بالأدلّة النقلیّة، کما أن القضایا الفلسفيّة إنّما تثبت بالأسلوب أو الدلیل العقلي.
وعلى الرغم من أنّ التجربة من وجهة نظر المنطقين المسلمين وغيرهم من المفكّرين المنتمين إليهم هي طريقة قیاسیّة، إلّا أنّها تتميّز اختلافًا جوهريًّا عن الطريقة العقلیّة، التي هي أيضًا قیاسیّة. إنّ المبادئ في القضايا التي يتمّ بحثها وإثباتها بالطريقة التجريبيّة هي الحسّیّات والتجریبیّات، وفي القضايا التي يتمّ بحثها وإثباتها بالطريقة العقليّة هي البديهيّات الأوّليّة، وأخيرًا هي الوجدانیّات. ومن الواضح أن القيمة المعرفيّة لهذه القضایا الأساسيّة تختلف عن بعضها بعضًا
وينبغي أن يقال: إنّ هناك فرقًا جوهريًّا بين الاستقراء والتجربة من وجهة نظر القدماء. فإنّ التجربة في حدّ ذاتها نوع من القياس. لکن الاستقراء هو تكرار الملاحظة والاعتماد على بعض الملاحظات المحدّدة، دون أن یعتمد التعميم فيها على القياس. إنّ العلوم التجريبية المعاصرة هي بشكل عامٍّ استقرائية وتعتمد على هذا الأسلوب. تختلف القيمة المعرفية لأنواع الاستقراء، فإنّ الاستقراء التام مفيد لليقين؛ لكن عادة لا وجود لها في العلوم التجريبيّة. ومن الصعب تحقّقها. إنّ الحصول علی الاستقراء الناقص أمر سهل، لكنّه لا یعطي الیقین. وقيمته المعرفيّة مبنيّة على الاحتمالات: فكلّما زادت الملاحظات في الاستقراء الناقص، زادت قيمته المعرفيّة، إلی أن تزداد الملاحظات إلی حدٍّ یفید الیقین.
بعد نظرة سريعة على الأسس المعرفيّة المختارة، يُطرح علينا السؤال الثاني: ما المنهج أو المناهج التي تقترحها للبحث مبادئُ أو أسس نظریّة المعرفة المختارة؟ وبناءً عليه، ما هي الأساليب التي يمكن عرضها للبحث؟
وللإجابة على هذا السؤال، نصل علی ضوء قليل من التأمّل، إلى النتيجة التالية:
أوّلًا: الأساليب الحسّيّة أو الاستقرائيّة، والشهوديّة والعقليّة والتأريخيّة أو النقليّة، لها القدرة على اكتشاف الحقائق، ومن خلال كلّ منها يمكنك الحصول علی مستويات من المعرفة اليقينيّة أو الاطمئنانیّة وغیرها. وكلّها صحيحة إذا استخدمت في مجالها الخاصّ، وسنتحدث إن شاء الله عنها وعن مميزاتها وحدودها في كتاب آخر.
ثانيًا: منهج البحث الكمّي صالح وحجّةٌ في مجاله الخاص ويفتح أمامنا بُعدًا جديدًا للواقع. إنّ الكمّية هي رمز المقدار والکثرة والتمايز في الوجود. والمنهج الكمّي يوضّح بُعدًا من أبعاد الظواهر المتکمّمة؛ ولذلك فإن المنهج الكمّي یعطي المعرفة.
ثالثًا: إنّ منهج البحث النوعي منتج للمعرفة وصحيح في مجاله الخاص، ويفتح أمامنا بُعدًا من أبعاد الواقع؛ لأنّ وجودها ودرجاتها
(174)وكمالاتها متوقّفة وتتميّز بالقوّة والضعف. ويمكن توسيع نطاق تطبيق الطريقة النوعيّة. وبهذا الأسلوب يمكننا الوصول إلى الوجود نفسه ومستوياته وكمالاته، بالإضافة إلى الظواهر النوعیّة (المتکیّفة)؛ لأنّ الوجود ودرجاته وكمالاته أمورٌ تشکیکیّةٌ، وبالتالي تتصف بالشدة والضعف. وبهذه الطريقة يمكننا اكتساب المعرفة حول الظواهر من خلال الطریقة التشکیکیّة أو النوعيّة. وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المولّدة للمعرفة المفیدة والموثوقة، وتزوّدنا بمعرفة صحيحة عن الظواهر.
وقد يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال: ألا يوجد هنا خلط بين منهج البحث والأمور الوجوديّة؟ أليس الأسلوب النوعي خاصًّا بالظواهر التي لها عَرضُ الکیف؟ باختصارٍ يمكن الإجابة بأنّ الطريقة النوعيّة يمكن تعميمها ولا يوجد ما یمنع من توسيع نطاقها، وبحسب التعريف الشائع فهي ليست خاصّة بالکیفیّات.
وعلى الرغم ممّا تقدّم، فإنّ الطريقة النوعيّة على الرغم من أنّها لا تختصّ بالظواهر التي لها عَرضُ الکیف، إلّا أنّها تختصّ بمجالٍ خاصٍّ ويتمّ استخدامها في مجال يمكن أن يتمتّع فيه الباحث بنفس تجربة الأشخاص الذين تتمّ دراستهم. توضیح ذلك أنّه علی ضوء تعريف البحث الكمّي، فإنّ الباحث من خلال الأسلوب الكمّي، يحاول اكتشاف العلاقات بين الظواهر، ويتمّ هذا النشاط المهمّ من خلال توزيع القيمة العدديّة على الظواهر المبحوثة. وعلی هذا
الأساس، ومن خلال الاعتماد على المنهج الكمّي، يتمّ تحليل الظواهر المذكورة باستخدام الأساليب الإحصائيّة؛ لكن في البحث النوعي يصف الباحث الظواهر ويتعرّف عليها من خلال وصفها.
ومن أبرز مميّزات منهج البحث النوعي أنّ الباحث يحاول النظر إلى الظواهر من عيون الأشخاص المدروسين ورؤية الحقائق من وجهة نظرهم، وبالتالي تجربة الظواهر والحقائق مثلهم. على سبيل المثال، لكي يتعرّف الباحث على حجم الظلم الذي تعرّض له السود في موطن المطالبين بحقوق الإنسان ويختبر مرارة حياتهم، غيّرَ لون بشرته وعاش كشخص أسود لمدّة ستّة أشهر، وبالتالي حصل علی اكتشافات مهمّة من خلال هذه الخبرة.
رابعًا: تمّ تقديم طرق ترکیبیّة مختلفة أو يمكن تقدیمها. عادة، يتمّ استخدام هذه الأساليب في العلوم متعدّدة التخصّصات.
خامسًا: البحث في النصوص والظواهر المماثلة، له منهج خاصّ ويتبع أسسًا خاصّة. وتحكمه بالإضافة إلى المبادئ أو الأسس المعرفيّة قواعدُ مستمدَّة من منطق الخطاب العقلاني، أهمها ما يلي:
أ) النص ونحوه لا يحمل أكثر من تفسير واحد ولا يسمح بتعدّد التفسيرات والقراءات. نعم، يمكن اعتبار النصّ مستقلًّا عن المؤلّف وعن قصده، وبالتالي تُعتبر القراءات المتعدّدة بل واللامحدودة
ممكنة، وتعتبر اللعبة المعنويّة التي لا نهاية لها محتملة. لكن منهج العقلاء هو أنّهم عادة ما يقصدون معنى معيّنًا من النصوص.
ب) يجب الحذر من الأفكار المسبقة الظنّیّة التي تؤدّي إلى التفسير بالرأي، مثل تفسير السماوات السبع بالأفلاك المبنیّة علی نظریّة الأفلاك البطلميّة. إنّ تدخّل مثل هذه الأفكار المسبقة يُبعدنا عن الفهم الصحيح للنصّ. إنّ تفسير النصوص على ضوء مثل هذه الأفكار المسبقة ممنوعٌ ومستهجن في منطق الخطاب والحوار العقلاني. وبطبيعة الحال، فإنّ مجموعة من الأفکار المسبقة لا تخلق مشكلة في مسألة الفهم فحسب، بل إنّ وجودها هو من ضرورات الفهم؛ مثل بعض القضایا المسبقة اليقينيّة التي تعتبر کفرائن لبیة.
ومن الممكن تعميمُ الأساس الأخير على جميع الظواهر ومحاولةُ تجنّب الأفکار المسبقة وتدخّل المفاهيم المسبقة الباطلة، في فهم أي ظاهرة. کما لا یحکم نظرتَنا للظواهر وفهمَنا لها، أيُّ تصور مسبق أو بنية عقليّة أو بارادایمٍ في عالم التکوین.
سادسًا: منهج البحث في نظريّة المعرفة المطلقة أو الشاملة منهجٌ شهوديٌّ وعقلي؛ لذلك ليس من الضروري عند نظريّة المعرفة دراسةُ وتقويم طرق البحث الأخرى، وهي متنوعة ومتعدّدة، ولا يلزم مناقشتها حتّى ولو كان من باب المقدّمة. وبالتالي فإنّ دراسة صلاحيّة كلّ منها لكلّ مجال مناسب لها يتطلّب فرصة واسعة غير متاحة الآن.
(177)ذکرنا في الفصل الحالي أنّ البارادایم بمعنی (أساس الفکر) أمرٌ لا بدّ منه، وقبلنا الدور الذي لا يمكن إنكاره للأسس في تنظيم البحث ومناهجه، وخاصة الأسس المعرفيّة. ثمّ حاولنا إيجاد حلّ لهذه القضايا: أوّلًا، ما هي الأسس المعرفیّة لمنهج البحث من وجهة نظر المنهج المختار، وثانيًا، ما هو منهج أو مناهج البحث التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الأسس؟ وبکلمة أخری: ما هي نتائج الطرق الناتجة عنها؟
ألقينا في البداية نظرةً سريعة على أهم الأسس المعرفيّة لمنهج البحث من منظور المنهج المختار، ورأينا أنه بناءً على نظریة المعرفة المختارة، هناك مبادئ أو أسس خاصّة تحكم منهجَ البحث ومنهجيّته؛ مثل بداهة وجود الأشیاء الخارجیّة، وبداهة وجود المعرفة في الجملة، وتفسير الحقيقة بمطابقة الذهن للخارج، وإمكانيّة الوصول إلى الحقيقة أو القضیّة التي تُطابق الواقعَ، وعدم معقوليّة ادّعاء الشكوکیّة أو النسبيّة المطلقة، وضرورة الالتزام بالحقيقة والتحرّر من النزعات، وبطلان الذاتيّة، والواقعيّة وإمكانيّة الحصول على الحقائق والظواهر، وعدم أهميّة البارادایمات بمعنی الأطر العقلیّة في المجالات المعرفيّة، ومعیار صدق القضایا النظریّة والبدیهیّة، بما في ذلك القضایا القبلیّة والبَعدیّة، والقضایا العقلیّة والتجریبیّة، والقضایا النقلیّة وغیر النقلیّة. إنّ هذه الأسس المعرفيّة المذكورة هي نتيجة مجموعة مؤلّفات وأبحاث للمؤلّف على مدى
(178)أكثر من ثلاثة عقود، وهي خلاصة لها.
ثمّ بعد عرض الأسس المعرفیّة من منظور المنهج المختار، قمنا بدراسة السؤال الثاني وأجبنا على هذا السؤال: ما هو منهج أو مناهج البحث التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الأسس أو المبادئ المعرفیّة؟
وللإجابة على هذا السؤال انتهينا إلى النتيجة التالية: إنّ منهج البحث في نظريّة المعرفة المطلقة أو الشاملة منهجٌ شهوديٌّ وعقليُّ، ولذلك ليس من الضروري أن نقوم بدراسة أو تقويم مناهج البحث الأخرى عند البحث في نظريّة المعرفة، خاصّة أنّ هذه المناهج متنوّعة ومتعدّدة. وإن ذکرنا بعض أهمّ تلك المناهج.
(179)1. آژدوکیویچ، کازیمیرتز، مسائل و نظریات فلسفه (مسائل ونظريات الفلسفة)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: منوچهر بزرگمهر، دانشگاه صنعتی شریف، طهران، ١٣٥٦هـ.ش.
2. آملي، سید حیدر، نقد النقود في معرفة الوجود، في: سید حیدر آملی، جامع الاسرار و منبع الانوار، تصحیح هنری کربن و عثمان اسماعيل يحيى، الطبعة الثانیة، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ایران شناسی فرانسه، طهران، ١٣٦٨هـ.ش.
3. ابنسینا، أبو علی حسین بن عبد الله، الشفاء، الإلهيات، مکتبة آیت الله مرعشي نجفي، قم، ١٤٠٤هـ.ق.
4. ابنسینا، أبوعلی حسین بن عبد الله، الشفاء، المنطق، 5. البرهان، تحقيق: أبوالعلاء عفيفي، الاميرية، قاهرة، ١٣٧٥هـ.ق.
5. استینزبي، دِرِك، علم، عقل و دین (العلم والعقل والدین)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: علي حقي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، ١٣٨٦هـ.ش.
6. ایمان، محمد تقي، فلسفهٔ روش تحقیق در علوم انساني (فلسفة طريقة البحث في العلوم الإنسانية)، الطبعة الثانیة، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ١٣٩٣هـ.ش.
7. باربور، أیان، علم و دین (العلم والدین)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: بهاءالدین خرمشاهي، مرکز نشر دانشگاهی، طهران، ١٣٦٢هـ.ش.
8. باطني، محمدرضا، فرهنگ معاصر (المعجم المعاصر)، نشر فرهنگ معاصر، طهران، ١٣٧١هـ.ش.
9. بلیکي، نورمن، استراتژیهای پژوهش اجتماعی (استراتيجيات البحث الاجتماعي)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: هاشم آقابیگ پوری، جامعه شناسان، طهران، ١٣٨٩هـ.ش.
10. بلیکي، نورمن، پارادایم های تحقیق در علوم انساني (بارادایمات البحث في العلوم الإنسانية)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: سید حمید رضا حسني وآخرون، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ١٣٩١هـ.ش.
11. بهمنیار بن مرزبان، التحصيل، تصحيح: مرتضى مطهري، دانشگاه طهران، طهران، ١٣٤٩هـ.ش.
12. چالمرز، آلن، چیستی علم (ماهیة العلم)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: سعید زیباکلام، الطبعة الثانیة، طهران، ١٣٧٩هـ.ش.
13. حسین زاده، محمد، پژوهشي تطبیقي در معرفت شناسي معاصر (بحث مقارن في نظريّة المعرفة المعاصرة)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٨٢هـ.ش.
14. ــــــــــــــــــــــــــــــ، در آمدي بر معرفت شناسي و مباني معرفت دیني (مدخل إلی نظريّة المعرفة وأسس المعرفة الدينية)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٠هـ.ش.
15. ــــــــــــــــــــــــــــــ، دین شناسي (معرفة الدین)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی، قم، ١٣٨٧هـ.ش.
16. ، فلسفه دین (فلسفة الدین)، (تنقیح جدیدٌ)، الطبعة الثالثة، بوستان کتاب، قم، ١٣٨٨هـ.ش.
17. ــــــــــــــــــــــــــــــ، مباني معرفت دیني (أسس المعرفة
الدينية)، الطبعة الرابعة، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٨١هـ.ش.
18. ــــــــــــــــــــــــــــــ، مباني معرفت شناختي علوم انساني در اندیشه اسلامي (الأسس المعرفية للعلوم الإنسانية في الفكر الإسلامي)، دفتر اول (الحلقة الأولی)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٣هـ.ش.
19. ــــــــــــــــــــــــــــــ، معرفت بشري؛ زیر ساختها (المعرفة البشریة؛ البنی)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٨٨هـ.ش.
20. ــــــــــــــــــــــــــــــ، معرفت دیني؛ عقلانیت و منابع (المعرفة الدينية؛ العقلانية والمصادر)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٨٩هـ.ش.
21. ــــــــــــــــــــــــــــــ، معرفت لازم و کافي در دین (المعرفة الضرورية والكافية في الدين)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٨٧هـ.ش.
22. ــــــــــــــــــــــــــــــ، معرفت؛ چیستی، امکان و عقلانیت (المعرفة؛ ماهیتها وإمکانها وعقلانیتها)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٦هـ.ش.
23. ، معرفت شناسي در قلمرو گزاره های پسین (نظريّة المعرفة في نطاق القضایا البَعدیة)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٤هـ.ش.
24. ــــــــــــــــــــــــــــــ، معرفت شناسي (نظریة المعرفة) (تنقیحٌ
جدیدٌ)، الطبعة الحادیة عشرة، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، 1385هـ.ش.
25. ــــــــــــــــــــــــــــــ، منابع معرفت (مصادر المعرفة) (تنقیحٌ جدیدٌ)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٤هـ.ش.
26. ــــــــــــــــــــــــــــــ، مؤلفه ها و ساختارهاي معرفت بشري؛ تصدیقات یا قضايا (مكوّنات وبنی المعرفة الإنسانية؛ التصدیقات أو القضایا)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٣هـ.ش.
27. ــــــــــــــــــــــــــــــ، نگاهی معرفت شناختی به وحی، الهام، تجربه دیني و عرفاني و فطرت (نظرة معرفیة إلی الوحی، الإلهام، والتجربة الدینية والعرفانية والفطرة)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٠هـ.ش.
28. الحلی، حسن بن يوسف، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، بيدار، قم، ١٣٨١هـ.ش.
29. رازي، فخرالدین محمد، المباحث المشرقية، مكتبـة الأسـدي، طهران، ١٩٦٩م.
30. رازي، قطب الدین محمد، شرح المطالع، کتبي نجفي، قم، [بلا تأریخ].
31. ساوي، عمر بن سهلان، البصائر النصيرية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩٣م.
32. سبزواري، ملاهادي، تعلیقة علی الأسفار، في: صدر الدین محمد شیرازی، الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة، مصطفوی، قم، [بلا تأریخ].
33. سهروردي (شیخ اشراق)، شهاب الدين يحيى، المشارع
والمطارحات، في: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هنري کربن، انجمن حکمت و فلسفه ایران، طهران، 1375هـ.ش.
34. الشیرازي، صدر الدین محمد، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، الطبعة الثالثة، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨١م.
35. طباطبائي، سید محمد حسین، تعلیقة علی الأسفار، في: صدر الدین محمد شيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨١م.
36. ــــــــــــــــــــــــــــــ، نهاية الحكمة، تصحیح غلام رضا فیاضي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٨٦هـ.ش.
37. طوسي، نصیرالدین، شرح الإشارات والتنبيهات، الطبعة الثانیة، دفتر نشر کتاب، طهران، ١٤٠٣هـ.ق.
38. ــــــــــــــــــــــــــــــ، منطق التجريد في: حسن بن يوسف حلي، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، بيدار، قم، ١٣٨١هـ.ش.
39. کریم زاده، صادق، روش تحقیق (منهج البحث)، جزوه درسي، مرکز آموزش مجازی و غیر حضوری وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني قم، ١٣٩٠هـ.ش.
40. كوهن، تامس، ساختار انقلابهای علمي (بنیة الثورات العلمیة)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: سعید زیباکلام، الطبعة الثالثة، سمت، طهران ١٣٩١هـ.ش.
41. لگنهاوسن، محمد، ایمانگروی (الإیمانیة)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: سید محمد موسو، في فصلیة: نقد و نظر، العدد 3 و٤، صيف وخريف ١٣٧٤هـ.ش.
42. ليديمن، جیمز، فلسفه علم (فلسفة العلم)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: حسین کرمي، حکمت، طهران ١٣٩٠هـ.ش.
43. محمدپور، احمد، روش در روش (المنهج في المنهج)، جامعه شناسان، طهران، ١٣٨٩هـ.ش.
44. مركز دايرة المعارف علوم عقلي وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، اصطلاح نامه معرفت شناسي اسلامي (موسوعة نظریة المعرفة الإسلامیة)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، قم، ١٣٩٢هـ.ش.
45. مصباح یزدي، محمد تقي، آموزش فلسفه (المنهج الجدید في تعلیم الفلسفة)، سازمان تبلیغات اسلامی، طهران، ١٣٦٤هـ.ش.
46. مطهري، مرتضی، مجموعه آثار (مجموعة الأعمال)، الطبعة الثامنة، صدرا، قم، ١٣٨٠هـ.ش.
47. مگي، برایان، مردان اندیشه (رجال الفکر)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: عزت الله فولادوند، طرح نو، طهران، ١٣٧٨هـ.ش.
48. هادسون ويليام دى، لودویگ ویتگنشتاین، ربط فلسفه او به باور دینی (علاقة فلسفته بالعقیدة الدیني)، ترجمه إلی اللغة الفارسیة: مصطفی ملکیان، کروس، طهران، ١٣٧٨هـ.ش.
Crotty, M., The Foundation of Social Research, Sage, London, 1998.
Dancy, Jonathan & Ernest Sosa, A Companion To Epistemology, Basil, Blackwell Ind., Cambridge, 1993.
Feyerabend, Paul K., Problems of Empiricism, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
(185)