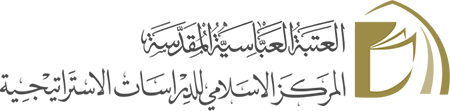
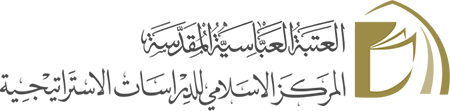
المنهجيّة التأسيسيّة للمشروع الفكري لمجتهد شبستري | 9
نقد ومناقشة رأي مجتهد شبستري بشأن جوهرة وصدفة الدين | 95
تأمُّل في الاستدلالات اللغويّة لنظريّة «القراءة النبويّة» | 125
قضيّة باسم القراءة الرسميّة | 167
دراسة تحليلية حول حقيقة الإيمان برؤية شبستري | 211
إلهيّة لغة القرآن الكريم | 243
الاعتقاد ببشريّة القرآن الكريم | 291
رؤى نقدية معاصرة 9
محمد مجتهد شبستري
دراسة النظريات ونقدها
مجموعة مؤلفين
العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
(3)العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
محمد مجتهد شبستري دراسة النظريات ونقدها / مجموعة مؤلفين - الطبعة الأولى - النجف العراق - العتبة العباسية المقدسة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 1445 هـ = 2023
386 صفحة : 21×15 سم . - ( رؤى نقدية معاصرة : (9)
ردمك :9789922680309
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.
۱. مجتهد شبستري، محمد، 1936 - أ. العنوان.
LCC: BP80.M85 M84 2023
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
فهرسة اثناء النشر
محمد مجتهد شبستري ، دراسة النظريات ونقدها (رؤى نقدية معاصرة - 9)
تأليف : مجموعة مؤلفين
الناشر : العتبة العباسية المقدسة ، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
الطبعة : الاولى ، 2023 م
Website: www.iicss.iq
E-Mail: islamic.css@gmail.com
Telegram: @iicss
مقدّمة المركز 7
المنهجيّة التأسيسيّة للمشروع الفكري لمجتهد شبستري 9
يحيى بوذري نجاد، مسلم طاهري كل كشوندي
نقد ومناقشة رأي مجتهد شبستري بشأن جوهرة وصدفة الدين95
محمّد كاشيزاده
تأمُّل في الاستدلالات اللغويّة لنظريّة «القراءة النبويّة»125
محمّد كاظم شاكر، السيّد روح الله شفيعي
قضيّة باسم القراءة الرسميّة 167
محمّد تقي سبحاني
دراسة تحليلية حول حقيقة الإيمان برؤية شبستري211
سيّد مرتضى حسيني شاهرودي، سيّد محراب الدين كاظمي
إلهيّة لغة القرآن الكريم243
أحمد حسين شريفي
الاعتقاد ببشريّة القرآن الكريم 291
حميد رضا شاكرين
تأملٌ في نظرة مجتهد شبستري إلى عصمة النبيّ الأكرم 315
قاسم ترخان
نقد نظرة شبستري إلى وسعة علم الأصول والاجتهاد الفقهي 357
محمّد عرب صالحي
الفكر المعاصر يعتبر مكوّنًا أساسيًّا في المنظومة الفكريّة الإسلاميّة، والتراث المعاصر لايختصّ بطبيعة الحال بالعالم الإسلامي فحسب، وإنّما له ارتباطٌ بجميع الثقافات والكيانات الجماعيّة التي تضرب بجذورها في تاريخ البشريّة.
يتبلور هذا الفكر على أرض الواقع حينما تشهد الساحة ظهور فكرٍ «آخر» بصفته ثقافةً وسلسلة مفاهيم دلاليّة منافسة، فالزمان والمكان إلى جانب المنافسة التي تحدث على ضوء مجموعةٍ مِن المفاهيم التي يطرحها «الآخرون»، كلّها أمورٌ تحفّز المدارس الفكريّة والثقافات الأصيلة للعمل على التأقلم مع الظروف الجديدة، وفي الحين ذاته تحفّزها على السعي للحفاظ على حيويّتها وخصوصيّاتها التي تميّزها عن «الآخر».
لو أنّ التاريخ شهد في بعض مراحله إقبال العلماء المسلمين على التراث الفلسفي الإغريقي، باعتباره نطاقًا منسجمًا مِن الناحية الدلاليّة وذا مضامين عميقة لدرجة أنّ بعض الفلاسفة مِن أمثال الفارابي وابن رشد ولجوا في فضائه الفكري وحاولوا إقامة تعريف معانيهم ورؤاهم الدينيّة متلائماً مع هذا الآخر الدخيل، ففي العصر الراهن باتت الثقافة والحضارة الغربيّتان الحديثتان المتقوّمتان على أسسٍ علمانيّةٍّ وتوسّعيّةٍ، تمثّلان «الآخر» بالنسبة إلينا ولسائر الثقافات غير الغربيّة.
النظام الدلالي المنبثق مِن الفكر الغربي قد أسفر عن إيجاد تحدّياتٍ كبيرةٍ
(7)لـ «ذاتنا الإسلاميّة» بفضل تفوّقه سياسيًّا واقتصاديًّا، ونطاق هذا التحدّي يتّسع أكثر يومًا بعد يومٍ؛ لذلك طرحت العديد مِن الحلول لمواجهته، وقد استسلم بعضهم لواقع الأمور بعد أنْ شعروا بالخشية مِن الغرور الغربي، فراحوا يبحثون عن الحلّ في العالم الغربي نفسه، لذا دعوا بانفعالٍ إلى ضرورة ملاءمة «ذاتنا» مع هذا «الآخر»، إلا أنَّ آخرين سلكوا نهجًا مغايرًا ودعوا إلى تفعيل تراث «ذاتنا»، وأكّدوا على أنّ الحلّ لا يتبلور في ديار منافسنا، وإنّما هو كامنٌ في ديارنا. نعم، تراثنا المعاصر هو ثمرةٌ لكلّ حلٍّ يمكن أنْ يطرح في هذا المضمار.
المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجيّة افتتح في مكتبه بمدينة قم المقدّسة فرع الفكر المعاصر بهدف تدوين دراساتٍ وبحوثٍ علميّةٍ حول الإنجازات الفكريّة التي تحقّقت على صعيد ما ذكر إلى جانب تقييمها، وفي هذا السياق بادر الباحثون فيه إلى استطلاع المشاريع الفكريّة لأبرز العلماء والمفکّرين في العالم الإسلامي مِن الذين تنصبّ نشاطاتهم الفكريّة في بوتقة نقد الفكر المعاصر، وثمرة هذا النشاط تنشر في إطار دراسات تتضمّن بحوثًا تتطرّق إلى بيان واقع مسيرة إنتاجهم الفكري وكيفيّة تبلور آرائهم بصياغتها النهائيّة.
سنتناول في هذا الكتاب نقد وتحليل آراء الباحث الايراني الدكتور محمّد مجتهد شبستري، وما طرحه مِن آراء ومعتقدات علمانيّة متأثّرة بالمناخ الغربي، ونأمل أنْ ينال رضا القارئ ويجد فيه بغيته. ولا يسعنا في الختام إلّا أنْ نتقدّم بالشكر والتقدير لكلّ مَنْ ساهم في إنجاز هذا العمل، لا سيّما الدكتور بيكي مدير ملفّ الفكر المعاصر، وكذلك السيّد محمّد رضا الطباطبائي مدير وحدة الإصدارات، وسائر الباحثين المساهمين في إنجاز هذا العمل.
(8)يحيى بوذري نجاد، مسلم طاهر كل كشوندي
يُعدّ محمّد مجتهد شبستري مِن المفكّرين الإيرانيين، وقد عمد إلى إبداء نظريّات في حقل القرآن الكريم والنصوص الدينيّة، وأصبحت هذه الآراء، بتأثير مِن الشرائط الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة للمجتمع قبل الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة وبعدها، منشأ لتبلور نقاشات في هذا المجال. يُضاف إلى ذلك، أنَّه حيث خاض في بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك بين سائر البلدان الإسلاميّة الأخرى؛ فقد حظيت هذه الآراء باستقبال المحافل العلميّة في الخارج، ومِن بينها البلدان الإسلاميّة أيضًا. ومِن الجدير ذكره أنَّ منشأ هذا الاهتمام لم يكن مقتصرًا على المسائل العلميّة البحتة، وإنَّما يأتي هذا الاهتمام في بعض الموارد في سياق دعم وتعزيز المشاريع التي تهدف إلى توسيع دائرة الرؤية الانتقاديّة للمباني المعرفيّة الفقهيّة والكلاميّة في المجتمعات الإسلاميّة.
لقد سبق لمحمّد مجتهد شبستري أنْ بدأ الكتابة في حقل مسائل العالم الإسلامي قبل أعوام مِن انتصار الثورة الإسلاميّة، إلّا أنَّه قام بنشر أوّل كتاب له في عام 1376ه.ش، تحت عنوان: «هرمنيوطيقا، الكتاب والسنّة». ثمَّ أردف ذلك بتحقيقات وأبحاث أخرى ترمي إلى شرح وإيضاح نظريّاته، وعمد في السنوات اللاحقة إلى اتّخاذ مواقف انتقاديّة تجاه الأوضاع القائمة في التفكير الديني، وأصدر مؤلَّفات أخرى، مثل: «الإيمان والحريّة»، و«نقد القراءة الرسميّة للدين»، و«تأمّلات في القراءة الإنسانيّة للدين». وفي عام 1386ه.ش، قام بتضمين أحدث نظريّاته في حقل هرمنيوطيقا النصوص الدينيّة الإسلاميّة (القرآن الكريم) في مقالة تفصيليّة بعنوان «القراءة النبويّة للعالم»، وفي مقابلة تحمل عنوان: «الهرمنيوطيقا: التفسير الديني للعالم»، حيث رفع النقاب فيهما عن أفكاره المختلفة في التعاطي مع مسألة الوحي وكيفيّة قراءته. وكان للمرّة الأولى أنْ تمّ التصريح في هذه المقالة بأنَّ القرآن الكريم هو «كلام نبويّ»وثمرة الوحي، وليس الوحي ذاته، وإنَّه ـ بحسب الحقيقة والواقع ـ قراءة توحيديّة عن العالم في ضوء الوحي. وأمّا الكتاب
الأخير لمحمّد مجتهد شبستري، فقد صدر في عام 1396ه.ش بعنوان: «نقد أسس الفقه والكلام» بنسخته الإلكترونيّة. وقد بحث في هذا الكتاب نسيج العلوم الناظرة إلى الحياة الإنسانيّة للمسلمين، مِن قبيل: الفقه والكلام، حيث كان يُنظر إلى هذين العلمين بوصفهما الممثّلين للعقلانيّة العمليّة والناظرة إلى حياة المجتمع الإسلامي، ويعملان على صياغة وبلورة محتوى وصورة هذا المجتمع في البُعد النظري وفي المساحة العمليّة أيضًا.
وعلى كلِّ حال، فإنَّه مِن المناسب العمل ـ بالنظر إلى بيان هذه النظريّات الخاصّة مِن قبل محمّد مجتهد شبستري ـ على دراسة وتحليل الأبعاد والزوايا المختلفة لمشروعه الفكري. وإنَّ هذه الدراسة تهدف بدورها إلى إخضاع مشروعه الفكري للتدقيق والتأمّل، حيث نسعى فيها إلى بحث هذا المشروع ضمن إطار الاتّجاه الموسوم بـ «المنهجيّة التأسيسيّة».
وفي إطار تحقيق هذه الغاية، سوف تكون لنا إطلالة على السيرة الذاتيّة لمحمّد مجتهد شبستري، وبعد ذلك سوف نعمل أوّلًا على بيان الخلفيّات المعرفيّة وغير المعرفيّة لأفكاره، لننتقل بعدها إلى تحليل مشروعه الفكري والنظريّات المختلفة التي تبلورت في صلب هذا المشروع، وفي الختام سوف نعمل على التدقيق في مناسبات المباني والأسس النظريّة له، وسوف نعمل في الوقت نفسه على نقد وتقييم نظريّاته.
إنَّ العناصر والعوامل المؤثِّرة في تعيين فكرة أو نظريّة ما في نسيج وعي المفكر، هي التي تعمل على بلورة الخلفيّات الوجوديّة لتلك الرؤية والنظريّة. إنَّ الخلفيّات الوجوديّة لرؤية ما إمّا هي عبارة عن خلفيّات معرفيّة، وإمّا شرائط غير معرفيّة تساعد على تعيّن آراء مفكِّر بعينه؛ وإنَّ الخلفيّات الوجوديّة المعرفيّة التي تضفي الهويّة على رؤية أو نظريّة ما، تشتمل على عوامل دخيلة في التكوين التاريخي للنظريّة، وتقيم كذلك ارتباطًا منطقيًا مع نظريّات المفكِّر؛ وذلك لأنَّ كلّ نظريّة أو فكرة تقيم نسبة مع التيّارات الفكريّة، وتتبلور تحت تأثير مفكِّرين بخصوصهم، كما تقوم على أساس المباني الأنطولوجيّة، والإبستيمولوجيّة، والأنثروبولوجيّة الخاصّة. ومِن هذه الناحية، فإنَّ النظريّة تقيم صلة أساسيّة مع هذه المباني، حيث تشكِّل في حدّ ذاتها موضوعًا لتأمّل ثانوي، وتعدّ الأرضيّة لبحث المناسبات بين المباني والأبنية. وإنَّ الخلفيّات الوجوديّة غير المعرفيّة بدورها، وإنْ لم يكن لها ارتباط منطقي مع نظريّات المفكِّر، ولكنَّها تحتوي في الغالب على ناحية تحفيزيّة. يتمّ في هذا الأفق بحث العوامل والخلفيّات التي لا يكون لها في تعيّن التفكير ماهية معرفيّة، وإنَّما تشتمل على الحواضن الاجتماعيّة والسياسيّة الموجودة لكلِّ فكرة أو نظريّة؛ وذلك لأنَّ كلِّ رؤية أو نظريّة، إنَّما تتبلور ضمن بيئة اجتماعيّة / سياسيّة خاصّة.
وفيما يلي، سوف نقوم أوّلًا ببحث الخلفيّات غير المعرفيّة لأفكار محمّد مجتهد شبستري، لننتقل بعد ذلك إلى بيان الخلفيّات المعرفيّة له:
إنَّ الخلفيّات غير المعرفيّة، عبارة عن العناصر والعوامل التحفيزيّة، مِن قبيل: الشرائط والظروف الشخصيّة والفرديّة، والأسريّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، والتي تتجلّى في الغالب ضمن مرحلة العثور على الأرضيّات واختيار المفكِّر لأهدافه وغاياته، وتكون سببًا في تعلّق المفكِّر أو ابتعاده عن موضوعات ومسائل خاصّة، ويعمل على توجيه متعلّق فکره بناءً عليها. ومِن المناسب لكي ندرك أسباب تبلور المشروع الفكري لمجتهد شبستري، أنْ نلقي نظرة على الشرائط الفرديّة والشخصيّة والأسريّة له مِن جهة، والشرائط والظروف السياسيّة والاجتماعيّة/ الثقافيّة التي عاش في كنفها مِن جهة أخرى.
ولد محمّد مجتهد شبستري سنة 1315ه.ش في مدينة شبستر (مِن محافظة أذربيجان الشرقيّة) في إيران. وقد ذاق مرارة فقد أمه وهو في عامه الخامس؛ حيث وافاها الأجل متأثِّرة بمرض السلِّ، وبسبب تعرّض والده الحاج ميرزا كاظم شبستري إلى الأذى والتضييق مِن قبل أجهزة السلطة في مدينة
شبستر، اضطرّ هو وأسرته إلى ترك هذه المدينة والانتقال إلى العيش والإقامة في مدينة تبريز، حيث فقد والده هناك وهو لم يتجاوز السنة الثانية عشرة مِن عمره. وقد تحدّث شبستري بنفسه عن هاتين الحادثتين بوصفهما مِن «الذكريات المريرة»و«التجارب الأليمة» التي أدّت إلى تأثّره على المستوى النفسي والروحي، وأضرّت بحياته على المستوى المادّي والمعنوي. وقال شبستري متحدّثًا عن تجربة والده: إنَّه سافر مِن شبستر إلى النجف الأشرف في طلب العلوم الدينيّة والإسلاميّة، وانخرط في سلك تلاميذ السيّد محمّد كاظم اليزدي، وكان يُعدّ مِن المراجع المعارضين للثورة الدستوريّة. وبحسب ما يروي محمّد مجتهد شبستري، فإنَّ والده على ما يبدو لم يكن في صفوف
الآخوند، وإنَّما كان مِن أنصار السيّد محمّد كاظم اليزدي في معارضته للثورة الدستوريّة (أو ما يُعرف بالمشروطة). عندما بلغ محمّد مجتهد شبستري عامه السابع أو الثامن، خرج به والده مِن البيئة الاجتماعيّة لمدينة تبريز، وبسبب النظام التعليمي الحكومي العلماني والمناهض ـ بعبارة أخرى ـ للدين في تلك المرحلة، أدخله أبوه في مدرسة باسم المدرسة «العلميّة» كان قد أسّسها في مدينة تبريز بنفسه، ولم تكن هذه المدرسة تحظى بغطاء داعم مِن وزارة التربية والتعليم. وتبعًا لذلك، لم تكن هذه المدرسة تمنح المنتسبين لها شهادات علميّة معتبرة مِن قبل الجهات الحكوميّة، ولم تكن بعض مناهج التربية والتعليم تدرّس في تلك المدرسة. وكان الطلاب الذي يسجّلون في هذه المدرسة ينحدرون مِن الأسر التي تؤمن بحرمة إرسال أبنائها إلى المدارس الحكوميّة. وكانت الدروس التي يتمّ تعلّمها في هذه المدرسة تقتصر على اللغة الفارسيّة والعربيّة، بالإضافة إلى التاريخ والجغرافيا والرياضيّات وما إلى ذلك. ولم يكن هناك درس للموسيقا في المدرسة العلميّة كما هو معهود في المدارس الحكوميّة، ولم يكن هناك درس للرياضة، وفي المقابل كان يتمّ الاهتمام بدلًا مِن ذلك بالدروس الدينيّة والقرآن الكريم والشرعيّات.
كان هناك سببان وراء انتساب محمّد مجتهد شبستري إلى حوزة العلوم الإسلاميّة؛ السبب الأول: أنَّ انتهاء العقد الأوّل مِن حياته قد اقترن بمرحلة انتشار أفكار أحمد كسروي في منطقة أذربيجان، الأمر الذي شكَّل جرس إنذار للأسر المتديّنة وأبنائها. والسبب الثاني: يعود إلى الأسلوب التربوي الخاصّ الذي أخضعه له والده؛ فقد كان أبوه يرغب في أنْ يصبح نجله طالبًا للعلوم الدينيّة حتمًا. ومِن هنا، فقد كان والده بالإضافة إلى ما يتلقّاه مِن الدروس في المدرسة العلميّة، قد خصّص له في البيت دروسًا خاصّة في الصرف والنحو مِن الأدبيّات العربيّة أيضًا. ولكي يطّلع على فضاء الخطاب الديني، كان يصطحبه معه إلى المساجد ليستمع إلى خطب وكلمات الواعظين. وبعد وفاة والده في عام 1327ه.ش، أراد تجربة الدراسة في المدارس الحكوميّة، ولهذا السبب فقد سجّل في مدرسة «فيوضات» الحكوميّة. وبقي بعد ذلك في مدينة تبريز على مدى ثلاث سنوات، ولكنَّه بقرار مِن الأسرة ورغبة منه، أراد الدراسة في حوزة العلوم الإسلاميّة، ولهذا السبب شدّ الرحال بعد ثلاث سنوات مِن رحيل والده؛ أي في عام 1330ه.ش؛ ليواصل دراسة العلوم الإسلاميّة في الحوزة العلميّة بقم، وانتقل إلى مدرسة الحجّتيّة للإقامة فيها.
وبسبب طبيعته الانعزاليّة التي ظهرت عليه بشكل مبكّر، آثر السكن في الطابق الثاني مِن مدرسة الحجّتيّة، حيث اختار حجرة لا تتّسع إلّا لشخص واحد فقط. وأمضى في هذه المدرسة ثمانية عشر عامًا، قضاها في التحصيل والتحقيق في حقل الفلسفة والكلام الإسلامي، بالإضافة إلى الفقه والأصول والتفسير.
وفي عام 1348ه.ش، أرسل آية الله السيّد محمّد حسين البهشتي، الذي كان يشغل في حينها منصب مدير المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ الألمانيّة، دعوة إلى محمّد مجتهد شبستري للحضور في هذا المركز الإسلامي، وقد حظيت هذه الدعوة بمباركة وتأييد مِن قبل مرجعين في حينها، وهما: آية الله الميلاني وآية الله الخونساري، فسافر إثر ذلك برفقة أهله إلى ألمانيا على نفقة آية الله السيّد البروجردي؛ ليتولّى هناك منصب إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ. وقد أقام في ألمانيا على مدى تسع سنوات تولّى خلالها إدارة هذا المركز الإسلامي. وقد أتاحت له هذه الأقامة الطويلة في أوروبا أنْ يطّلع، بعد تعلّم اللغة الألمانيّة، على الثقافة والحضارة الغربيّتين، ولا سيّما الفلسفة الجديدة واللاهوت المسيحي، وأنْ يقوم ببعض الدراسات والتحقيقات في هذا الشأن. وخلال هذه المدّة سافر مرارًا إلى مختلف البلدان الأوروبيّة والعربيّة والأمريكيّة لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات الدوليّة الفلسفيّة واللاهوتيّة وإلقاء الكلمات فيها، وحاور مختلف الشخصيّات المسيحيّة واليهوديّة والبوذيّة والإسلاميّة البارزة في مختلف أنحاء العالم، وتبادل معهم وجهات النظر حول تحدّيات العلم والفلسفة الحديثة بالإضافة إلى الإلهيّات في الأديان الكبرى.
لقد شهد محمّد مجتهد شبستري في صغره احتلالَ مدينة أذربيجان على يد القوّات الروسيّة، وبقاءهم فيها. وقد رأى معسكر الجنود الروس بأمّ عينه. وكانت تلك الحقبة مثيرة للقلق مِن ناحية سيطرة الحزب الديمقراطي على أذربيجان إلى حدّ كبير. لقد تركت تحدّيات تأسيس الدولة الحديثة على يد البهلوي الأول، تأثيرًا كبيرًا على شبستري الشاب، واستمرّ هذا التأثير بزخَم أكبر في فترة حكم البهلوي الثاني، وأمضى مرحلة الشباب يميل نحو التيّارات
الوطنيّة/ المذهبيّة ـ مِن قبيل تيار الدكتور محمّد مصدق (الوطني) ـ والابتعاد عن تيّارات مِن قبيل حزب تودة (الشيوعي). وبعد ثماني عشرة سنة مِن الدراسة في الحوزة العلميّة بقم، والمشاركة في الدروس الشائعة في الحوزة وهي عبارة عن: الفقه واصول الفقه والكلام والفلسفة ـ والتفسير إلى حدّ ما ـ أمضى السنوات الثمانية الأخيرة مِن وجوده في الحوزة ـ العلميّة مشاركًا في دروس خارج الفقه والأصول عند الأساتذة مِن الدرجة الأولى في تلك المرحلة. ومِن بين جميع هذه الدروس، كان الحضور في درس تفسير العلّامة الطباطبائي، يحظى بجاذبيّة أكبر بالنسبة إلى محمّد مجتهد شبستري؛ وبالإضافة إلى هذه الدروس الحوزويّة، كانت له بعض الدراسات الحقوقيّة أيضًا. وفي عام 1348ه.ش، قبل الدعوة المرسلة إليه لإدارة المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ الألماني، وقد أثّرت عليه الإقامة في ألمانيا والنسيج المعرفي والثقافي لهذا البلد، وكانت ثمرة ذلك تعلّم اللغة الألمانيّة للتركيز على رسالته الأصليّة،
والتي تمثّلت ـ على حدّ تعبيره ـ بالتعريف الاجتماعي لدين الإسلام. وكان مِن بين أهمّ نشاطاته خلال فترة إدارته في المركز الإسلامي لهامبورغ، افتتاحه لمشروع حواري للأطفال المسلمين الناشئين في ألمانيا، وتوسيع دائرة الحوار مع سائر الأعضاء في التجمّعات الدينيّة الأخرى في المجتمع الألماني.
بمعنى أنَّ إدارة المركز الإسلامي في بلد أوروبي، إذ كان يراجعه الكثير مِن المسلمين ومِن أتباع الديانات الأخرى ـ ولا سيّما المسيحيّون منهم ـ وضرورة إلقاء الكلمات والاستماع إلى خطابات الآخرين، والمشاركة في الحوارات، وكذلك الحضور في الندوات والمجالس الحواريّة بين الأديان في مدينة هامبورغ وسائر المدن الألمانيّة الأخرى، وكذلك البلدان الأوروبيّة، كانت تستوجب تعلّم اللغة الألمانيّة. وبعد إتقان اللغة الألمانيّة، أخذ يشارك في الحوارات الدينيّة والمحافل السياسيّة؛ إذ كان الفضاء الحاكم في جميعها، هو التفكير الانتقادي بمفهومه الكانطي. وفي تلك الظروف كان على حدّ تعبيره:
«كنت أشبه بشخص يعيش في برزخ الحياة. وقد ارتأيتُ أنْ أسبر غور ذهني، وفجأة وجدت نفسي منجرفًا مع تيّار الجهود المعرفيّة والإبستيمولوجيّة».
ونتيجة لذلك، فقد تركّزت جهوده في الغالب على فلسفة الغرب، وعثر على جاذبيّات في اللاهوت المسيحي الناظر إلى هذه المقدّمات الذهنيّة والمعرفيّة؛ هذا جعل منهجيّة اللاهوت المسيحي مهمّة بالنسبة له. وفي خضم ذلك، وبالإضافة إلى اللغة الألمانيّة والتفكير الانتقادي واللاهوت المسيحي،
(20)أخذ موضوع آخر يشغل ذهنه بالتدريج أيضًا، ولم يكن ذلك الموضوع سوى الديمقراطيّة السائدة في ألمانيا. إنَّ المراد مِن الديمقراطيّة بهذا المعنى، كانت تتمثّل عند محمّد مجتهد شبستري بقوله:
«لا أحد مِن الناس هناك يُزعج الآخرين، وكان متّفقًا بينهم أنْ يعتبروا حياتهم الاجتماعيّة/ السياسيّة على شكل عقد وتوافق يحصل فيه كلُّ واحد منهم على حقوقه».
الشخصيّات والاتجاهات الفكريّة المؤثّرة على المشروع الفكري لشبستري في البحث عن الشخصيّات الفكريّة المؤثّرة على المشروع الفكري لمحمّد مجتهد شبستري، تجب الإشارة إلى البُعدين الداخلي والخارجي في هذا الشأن؛ بمعنى أنَّ شبستري كان قد تأثّر بأشخاص موجودين في العالمين الإسلامي والغربي؛ کالدكتور محمّد مصدق.
وفي ضوء ذكره لأسماء بعض الشخصيّات الآخر في تضاعيف آثاره وأعماله، يمكن لنا أنْ نسمّي مِن بين الأشخاص الذين تأثّر بهم محمّد مجتهد شبستري ـ على مستوى الداخل ـ كلًّا مِن آية الله السيّد حسين البروجردي، وآية الله السيّد الإمام الخميني، وآية الله السيّد محمود الطالقاني، والمهندس مهدي بازرگان.
لقد كان محمّد مجتهد شبستري في مرحلة شبابه متأثرًا بحركة الدكتور محمّد مصدق، وكان سبب هذا التأثّر هو «صوت الناس واختيارهم» في وصول الدكتور مصدق إلى السلطة. ونظريّة مجتهد شبستري في هذه المسألة تبدو للعيان تحت عنوان «حرمة الأشخاص وحريّتهم في الانتخاب»في مقابل «مقام ترسيخ الشاه» الذي تمّ ربط سلطته ـ لأيّ سبب كان ـ بسلطة أبيه، ولم تكن لها أيّة صلة بإرادة الشعب الذي يجب أنْ يكون هو مصدر السلطات. ولهذا السبب، كان مجتهد شبستري في حالة التعارض بين الدكتور مصدق والشاه البهلوي الثاني (الابن)، ينحاز إلى الدكتور محمّد مصدق.
وكان تأثّر مجتهد شبستري بآية الله السيّد محمود الطالقاني يعود إلى أدائه أكثر مِن تفسيره. وفي تبرير حصول هذه الرؤية تجاه آية الله الطالقاني، يقول مجتهد شبستري: إنَّ الطالقاني كان يؤمن بأنَّ المعرفة الدينيّة، إنَّما تتحقّق لدى الإنسان مِن طريق العمل والجهاد، وليس مِن طريق التفكير؛ ومِن هنا كان مجتهد شبستري يعرّف بالسيّد الطالقاني بوصفه شخصًا مجاهدًا، وأنَّه كان مخلصًا في جهاده.
وبالنظر إلى تواجد مجتهد شبستري في أوروبا، وانحيازه إلى الفلسفة
القاريّة والتفكير الانتقادي مِن جهة، والاتجاه نحو تيّار اللاهوت الليبرالي والتفسير المسيحي الليبرالي للكتاب المقدّس في عالم المسيحيّة مِن جهة أخرى؛ كان في نقده للديمقراطيّة وانتشار وباء العدميّة بوصفه مِن الآفات الكبرى التي يعاني منها الغرب، يستند إلى آراء ماركوز وإريك فروم. وكان في اتخاذ الاتّجاه المفهومي بالنسبة إلى الحياة، متأثرًا ببعض المستنيرين المسيحيين، مِن أمثال: تيليش وبولتمان. وكذلك، فإنَّه في سياق إيمانه بأطر الهرمنيوطيقا الفلسفيّة والمنهجيّة، وتلفيقها في التعاطي مع النصوص الدينيّة مِن جهة، وعرض رؤيته في باب فهم الحياة الإنسانيّة مِن جهة أخرى، نجد في آرائه حضورًا ملحوظًا لنظريّات الفلاسفة الهرمنيوطيقيين، مِن أمثال: شلايرماخر، وفليلهم ديلتاي، وصولًا إلى هانس غادامير، وبيتّي وهيرش أيضًا.
إنَّ محمّد مجتهد شبستري يُنذر مخاطبيه، بأنَّهم إذا أرادوا أنْ يفهموا نظريّاته وأفكاره، يتعيّن عليهم الالتفات إلى المناشئ والجذور النظريّة والمعرفيّة التي قام باتّخاذها، ويدّعي أنَّهم إذا أرادوا فهم مشروعه الفكري، وجب عليهم أنْ يلتفتوا إلى ماهيّة المصادر الفلسفيّة التي تشبّع بها ذهن الشخص الذي يؤلِّف
هذه الكتب، ومِن أين يستقي هذه المصادر، وما هي المفاهيم المستقرّة في ذهنه وتعمل على توجيه طريقة تفكيره وكتابته.
يبدو أنَّ السيرة العلميّة لمجتهد شبستري ـ بتأثير مِن الثورة الإسلاميّة، وما تبعها بعد ذلك مِن تأسيس نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران ـ قد شهدت في الحدّ الأدنى ثلاث مراحل فكريّة، نجملها ضمن العناوين الآتية:
في المرحلة الأولى، مِن خلال حضوره ونشاطه في صحف ومجلّات، مثل: (مكتب إسلام)، و(مكتب تشيّع) في أواخر عقد الثلاثينيّات مِن القرن الهجري الشمسي، وكتابته لمقالات سعى مِن خلالها إلى إثبات جدوائيّة النصوص الدينيّة ـ في مواجهة المسائل الاجتماعيّة المعاصرة. وكان قد صبّ جهوده مِن أجل العثور على الاتجاه السائد في النصوص الدينيّة مِن قبيل القرآن الكريم والسنّة النبويّة ـ في المواجهة مع مختلف المسائل. ومِن هنا، فإنَّ منهج مجتهد شبستري في التعاطي مع النصوص الدينيّة توصيفي/ توضيحي، وبصدد الكشف عن المعنى والمفهوم الحقيقي، والعثور على علل وغايات تشريع مختلف الأحكام الإسلاميّة في هذه النصوص «كما هي».
يذهب محمّد مجتهد شبستري في هذه المرحلة إلى الاعتقاد بأنَّ مسائل مِن قبيل:
«إدراك الأصول المسلّمة في نظام الخلق، والإيمان بالخالق ومبدأ الوجود، وفهم أنَّ خلقه مستمرّ على الدوام، وأنَّ العالم لا يمكن أنْ يستغني عنه ولو للحظة واحدة، وما هو الموقع الصحيح للإنسان في منظومة الخلق الواسعة؟ وكيف يجب أنْ يكون ارتباطه مع الخالق والعالم والأشخاص الآخرين؟ وكيف يجب أنْ يعمل على تنظيم برنامج الحياة في هذا العالم ليصل إلى السعادة والكمال في كلا الدارين؟»، هي مِن المسائل التي «سعى الأنبياء إلى بيان رؤية صحيحة حولها، وأنَّ القوانين المدنيّة والجزائيّة للأديان، عبارة عن آداب ومناسك تمّ تشريعها مِن أجل إقامة التواصل بين الإنسان وخالقه، وترِد بأجمعها في إطار ضمان الأهداف المذكورة أعلاه».
يعمد مجتهد شبستري إلى التعريف بالإسلام بوصفه الدين الأكمل مِن بين جميع الأديان في حقل التعريف بأصول وأهداف الحياة الإنسانيّة، وفي معرض نقده لنهضة تشريع القوانين بما يتوافق والأسلوب الغربي في البلدان الإسلاميّة ـ «والذي تكون نتيجته التخلّي عن الكثير مِن قوانين الفقه الإسلامي على الرغم مِن تناغمها التام مع الأفكار والسنن والآداب والمقتضيات الطبيعيّة والمحليّة للبدان الإسلاميّة» ـ إلى الاعتقاد بضرورة
«الالتفات إلى التداعيات والتبعات السيّئة لهذه النهضة التشريعيّة وغير المنطقيّة، ويجب إزالة القوانين الغربيّة الناشزة، والتي تمّ فرضها على هذه المجتمعات، واستبدالها بالقوانين الأصيلة والمتناغمة مع الفقه الإسلامي»؛ إذ «إنَّ ما ورد في إعلان الحكومة الإسلاميّة العالميّة، لا ينشد هدفًا أسمى وأفضل مِن الإعلان العالمي للأمم المتّحدة» فحسب، بل «وإنَّ قوانين الفقه الإسلامي المنبثقة عن الوحي، قد ازدهرت في البدان الإسلاميّة وتكاملت على مدى القرون، وكانت وما تزال متماهية ومنسجمة مع هذه الأرضيّات بشكل كامل». وأدّت إلى «أنْ تكون للحقوق الإسلاميّة أصول وفلسفة خاصّة بها، لم تقتبس مِن أيّ مبدأ وأصل آخر، وإنَّ الحقوق الإسلاميّة ـ بحسب مصطلح الحقوقيين ـ حقوق إلهيّة؛ بمعنى أنَّها حقوق ذات أصول وجذور دينيّة، وإنَّ المسلمين إنَّما يرون قوانينها وأحكامها واجبة الإجراء والتطبيق؛ لأنَّ الله ـ خالق العالم ـ هو الذي أقرّها وقام بتشريعها»؛ وذلك لأنَّه قد عرّف بـ «القوانين السامية للقرآن الكريم والشخصيّة الاستثنائيّة والفذّة للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله»، بوصفها منشأ تبلور المجتمع الإسلامي ومنطق التطوّر الحاكم عليها، وذهب إلى الاعتقاد والقول:
«يجب العمل على تجزئة وتحليل الفلسفات الحقوقيّة للإسلام بشكل صحيح؛ كيما نثبت أفضليّة هذه الفلسفات ـ مِن حيث الصحّة والشمول ـ على الفلسفات السائدة في العالم الغربي».
لقد ادّعى محمّد مجتهد شبستري في مرحلة مِن حياته العلميّة أنَّ القرآن الكريم رواية واحدة قدّمها النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله عن الوجود والعالم، وكان في تلك المرحلة يذهب إلى الاعتقاد بوجوب «الفصل والتفريق بين الحقيقة الدينيّة التي تمّ وحيها على جماعة، وبين المفاهيم والتعابير التي يستخدمها أتباع تلك الحقيقة الدينيّة». لقد كان شبستري في هذه المرحلة، يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ القرآن الكريم خطاب واحد ينطوي على مفهوم مركزي، ويرى أنَّ كلّ جهود المؤمنين والمفسِّرين، يجب أنْ تصبّ على اكتشاف هذا المفهوم. إذ لو تمّت القراءة على هذه الشاكلة، فإنَّه لن يتمّ النظر إلى الأحكام الاقتصاديّة أو العباديّة المقتبسة مِن القرآن الكريم بوصفها نسيج وحدها. إنَّه يُنظر إليها بوصفها أحكامًا مرتبطة بزمانها، حيث تكون في خدمة بيان المفهوم المركزيّ للنصّ الوحياني، كما أنَّه لا يوجد في هذه الرؤية أيّ فهم مِن دون فرضيّة مسبقة. ومِن هنا، فإنَّ اختلاق الحجيّات السابقة ـ التي تنطوي في الغالب على المباني السياسيّة والحفاظ على الهويّات المذهبيّة والطائفيّة ـ تحول دون الفهم المستمرّ، وإنَّ الطريق إلى الخروج منها يكمن في العودة إلى اللوازم
الطبيعيّة للفهم، وليس الخوض والتمسّك بإضفاء المتقدِّمين للحجيّة على القضايا الدينيّة.
أمّا في المرحلة المتأخّرة، فقد تخلّى عن أسلوبه الانتقادي تجاه المناهج التفسيريّة الموجودة في العالم الإسلامي، وادّعى بأنَّ القول: «إنَّ جميع النصّ الفعلي للقرآن مِن الزاوية التاريخيّة أثر أو آثار لشخص واحد هو «النبيّ»، وأنَّه أوّلًا قد قرأ العالم قراءة وحيانيّة، وثانيًا أنَّ هذا الشخص هو النبيّ الأكرم محمّد بن عبدالله صلىاللهعليهوآله ادّعاء تاريخي غير كاف، بل إنَّ الشيء الوحيد الذي يمكن ادّعاؤه بشأن كتاب مِن قبيل القرآن الكريم، هو أنَّ «القراءة الظاهراتيّة»و«القراءة الروائيّة» بسبب ماهيّة هذا النصّ، تفتح الطريق بشكل ناجع.»
سوف نتعرّض في هذا الفصل إلى بيان أهمّ المباني الفكريّة لمجتهد شبستري، والتي يُنظر لها بوصفها القاعدة والأساس لنظريّاته. تقدّم أنْ أشرنا إلى أنَّ كلَّ نظريّة تقوم على سلسلة مِن المبادئ والمباني، ولكي تتبلور النظريّة في ذهن المفكِّر، يجب أنْ تنتظم مبادئ تلك النظريّة في ذهنه. بالنظر إلى بيان المدارس المؤثّرة وكذلك جذور التفكير عند مجتهد شبستري، مِن الواضح أنَّه في أخذ هذه المباني، قد تأثّر باتجاهات ومفكِّرين قد سبقوه في امتلاك تأمّلات في حقل اللغة والدين والمجتمع.
يتمّ الكلام في الأنطولوجيا حول ماهيّة ووجود العالم، وماهية الأشياء الموجودة في العالم، ومهامها وأدوارها. إنَّ تفكير محمّد مجتهد شبستري في هذا القسم، متأثّر بالفلسفة القارّية، ولا سيّما المنظّرون الذين يركّزون على تحليل المعنى وفهمه، مِن أمثال: هانس غادامير، وشلايرماخر. وفي التماهي مع سائر مباني تفكيره ـ مِن قبيل ماهيّة المعرفة والإنسان ـ يحمل نوعًا مِن الهرمنيوطيقا التي ينعكس فيها. وفي الحقيقة، فإنَّه بعد تغلّب الرؤية الهرمنيوطيقيّة على الوجود، وامتلاك هاجس «الفهم» بدلًا مِن «الكشف»، لا يبقى لمحمّد مجتهد شبستري شيء مِن الأنطولوجيا الذاتيّة بالمعنى المتعارف لها، وتنخفض القضايا الأنطولوجيّة إلى أفق مِن الأبحاث الهرمنيوطيقيّة الإبستيمولوجيّة؛ حيث لا يعود معيار الصدق والكذب فيها هو الحقيقة الذاتيّة. وإذا كان هناك مِن وجه باق للحقيقة في المشروع الفكري لمجتهد شبستري، فإنَّ البحث عن الحقيقة سوف يتبلور في مهد مِن اختزان التجارب الشخصيّة. ومِن هنا، فإنَّه يرى عدم إمكان العثور على الحقيقة بمعزل عن التدخّلات الفرديّة والجماعيّة في الحياة الإنسانيّة، الأعمّ مِن الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وما إلى ذلك. يذهب شبستري إلى القول: «لو كان للوجودات مِن لسان وأمكن لها أنْ ترفع النقاب عن ذاتها، ما الذي سوف يحدث يا ترى؟».
عندها سوف يتّضح أنَّه لم يكن خلف كواليس جميع هذه الأشياء سوى العدم؛ وذلك لأنَّ كلّ ما نقوم به نحن البشر ليس سوى الكلام والاستفادة مِن المفاهيم، ولا يمكن لنا بوساطة المفاهيم المرتبطة بالوجود أنْ نتحدّث عن الأمور الكائنة خلف الكواليس، ولا يمكن لنا أنْ نعمل على إظهار ما وراء الكواليس. إنَّ الذي يتمّ إظهاره بوصفه طورًا، طريقُه هو الاستخبار، ولا يمكن الذهاب إلى خلف الكواليس بأيّ مفهوم مِن المفاهيم الوجوديّة. وفيما يلي سوف نشير إلى أهم الدلالات الأنطولوجيّة لتفكيره.
يذهب مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ الحقيقة تظهر لكي تنتشر في الدائرة الاجتماعيّة/ التاريخية؛ إذ تتنافس فيها الكثير مِن القوى فيما بينها مِن أجل الوصول إلى القوّة والوصول إلى حقيقة رسميّة تعمل على تبرير القوّة وتضفي المشروعيّة عليها. يذهب مجتهد شبستري إلى الاعتقاد بأنَّ القول بأنَّ المعنى والمفهوم مِن الذاتيات الإلهيّة، وأنَّ العالِم يهتدي إليها بتوفيق مِن الله، مِن أصول الاجتهاد التقليدي، ولا ينتج عنه شيء سوى الجزميّة والاعتقاد الحتمي. ويقول في ذلك:
«لا ينبغي الاستيحاش والخوف مِن حقيقة عدم وجود محكّ متقن مئة بالمئة لإثبات فهم النصّ».
وادّعى قائلًا:
«إنَّ رجوعي ليس مِن باب الحصول على الأنطولوجيا كي يُقال لي: هلمّ وأثبت الحجيّة المعرفيّة أو الوثاقة التاريخيّة للنصّ أوّلًا، ثمّ قم بعد ذلك بفهمها وتفسيرها».
كما ويذهب إلى الاعتقاد قائلًا: «إنَّ مطالب القرآن، سواء في قسم الفهم التفسيري أو في قسم (الفهم الروائي)، إنَّما هي «رواية»، وليست إخبارًا عن الواقع».
ثمّ استطرد قائلًا في شرح هذا المدّعى:
«إنَّ معنى هذا الكلام هو أنَّ قائل القرآن في هذا القسم، لا يريد القول كيف تكون حقائق عالم الوجود، وإنَّما يخبر عن سلسلة مِن الحوادث التي وقعت أو تقع تباعًا أو سوف تقع في المستقل، وربَّما أمكن التعريف بأنطولوجيّات متنوّعة، بيد أنّي أقترح أنطولوجيّة الكلام، بمعنى أنطولوجيّة كلام مؤسّس الدين، وبعبارة أخرى وجود الكلام. وأرى ذلك بناء محكمًا في العصر الراهن بالنسبة إلى التديّن؛ بحيث أنَّ الكثير مِن المشاكل للتديّن في العالم المعاصر وعصر الحداثة، تحدث للأشخاص المتديّنين، ويبدو أنَّ الحياة الدينيّة والحياة في العالم الراهن غير قابلتين للجمع، وربَّما أمكن بهذه الأنطولوجيا حلّ الكثير مِن هذه الموارد»
(32)يرى محمّد مجتهد شبستري أنَّ بيان السؤال عن الذات أو الجوهر المتعالي عن الحقيقة ـ التي تكون موجودة في الحياة الإنسانيّة على شكل أعيان ثابتة ـ قليل التأثير، ويذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الخوض في ماهية الحقيقة النهائيّة والذاتيّة، مِن قبيل: العقل والجوهر والنفس وما إلى ذلك، يجب أنْ يخلي موقعه لصالح الخوض في مقدار تأثير هذه الحقيقة بشكل عام، والإيمان بها بشكل خاصّ، في حياة الإنسان، ويعطي مكانه إلى الخوض في الأبحاث الملحقة؛ إذ إنَّ كلّ ما هنالك، هو التفسير الإنساني وفهمه لمختلف الأمور المتنوّعة. ومِن هذه الزاوية، لا توجد هناك أيّ حقيقة مسبقة، وإنَّ روايتنا وفهمنا لتجربة العيش في الحياة الإنسانيّة، هي التي تصنع حقائق العالم وتعيد التفكير فيها على الدوام. وبعبارة أخرى: إنَّ الحياة الإنسانيّة ليس لها شكل ولا معنى لها، وإنَّما تكتسب شكلها ومعناها بوساطة الروايات المتأثّرة بالعوامل والعناصر المتعدّدة في كلِّ عصر مِن العصور. إنَّ جميع الحقائق مِن صنع الظروف والخصائص الاجتماعيّة/ التاريخيّة. وبشكل خاصّ يذهب محمّد مجتهد شبستري إلى الاعتقاد قائلًا:
«أوّلًا إنَّ الدين لم يأتِ مِن عالم الغيب، فليس الأمر كما لو أنَّ الله قد أنزل دينًا؛ إنَّ الدين بدوره ـ مثل الفلسفة والعلم والفن ـ أمر إنساني، وقد ظهر بواسطة الأشخاص طوال حياتهم التاريخيّة والاجتماعيّة».
إنَّه يحيل على كتابه «نقد أصول الفقه والكلام»، ويرى:
«أنَّ الله لم يُنزل دينًا، بل إنَّ الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابًا، وإنَّ هذا الكتاب بدوره إنَّما أنزل على النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وليس على أيّ شخص آخر، كما أنَّ المراد مِن ذلك الكتاب الذي أنزل على النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ليس كتابًا مشتملًا على حروف وألفاظ وكلمات وأصوات، إنَّما كان ذلك الكتاب هو كتاب الوجود، الذي تمّ اكتشافه مِن قبل النبيّ الأكرم، وإنَّ النبيّ قد دعا الوجود باسم الله، ونظر إلى جميع الكائنات بوصفها آيات إلهيّة، وقد كان هذا هو كتاب الوجود الذي نزل عليه. إنَّ الدين ليس له ذات، وعلينا أنْ لا نكون هنا بصدد تعريف الدين، بحيث نكون قد عرّفنا ذاته. إنَّ هذا هو آخر كلام يقوله البارزون مِن المختصّين المعاصرين في الشأن الديني، إنَّهم يقولون: حيث تُرى جميع الأمور بوصفها أمورًا تفسيريّة، فإنَّ ذات التعيين ليس مستحيلًا بالنسبة إلى الدين فحسب، بل لا يمكن تعيين الذات بشكل عام بالنسبة إلى أيّ شيء».
إنَّ الدين مِن وجهة نظر مجتهد شبستري لا ذات له، وإنَّ الموجود والذي يُرى في الحياة الإنسانيّة، إنَّما هو أشكال متنوّعة مِن التديّن، حيث تظهر طيلة تاريخ حياة الأشخاص على أشكال مختلفة. إنَّ الذي ظهر، إنَّما هو أنواع التديّن، وليس الأديان.
وبعد بيان هذه المدّعيات بالنسبة إلى ماهيّة الدين، يعمد إلى طرح سؤال
مفاده: «إذا كان الدين يروم إدارة العدميّة الموجودة في العالم المعاصر، وأنْ يقدّم أساسًا للحياة الإنسانيّة، فما الذي يعنيه ذلك؟»، وقد ذهب في الجواب عن هذا السؤال إلى الاعتقاد قائلًا:
«إنَّ تديّن المؤسّسين الدينيين لم يكن بمعنى تقديم المعرفة المقدّسة أبدًا، وإنَّما كان تديّنهم بمعنى الابتداء بهذه النقطة مِن الاعتراف والشهادة. إنَّ نقطة انطلاق تديّنهم تأتي مِن هنا، وبعد ذلك ليس سوى الشهادة، وهي الشهادة لدى الآخرين بحدوث مثل هذا الأمر. إنَّهم لم يتكتّموا هنا، وإنّما شاركوا الآخرين معرفتهم وأخبروهم بوقوع مثل هذه الحادثة، وقالوا لهم بأنَّ الله قد فعل معنا ذلك، وأخبروا الآخرين بهذه الواقعة. وهناك مَنْ فهم هذا الكلام الذي يقوله المؤسّس وآمن به، وهناك مَنْ لم يفهمه ولم يؤمن به».
إنَّ الذي يضمن استمرار الدين هو أنطولوجيا الكلام؛ بمعنى أنَّ الكلام يتمّ تفسيره، وهذا التفسير بدوره يتعرّض لعمليّة تفسير ثانية، وإنَّ هذه التفسيرات تستمرّ، وبذلك يتراكم نهر وتيّار زاخر وعظيم مِن الكلام وتأثير الكلام على شكل تقليد موروث، ويستمرّ على طول التاريخ. وعلى هذا الأساس، فنحن لدينا أنطولوجيّة هذا الكلام، ويمكن لنا أنْ نقيم الكثير مِن الأبنية على أساس هذا الصرح الأنطولوجي وتفسيرات هذا الكلام».
إنَّ محمّد مجتهد شبستري، وإنْ كان يؤمن بالله بوصفه أمرًا متعاليًا، وعلى هذا الأساس يرى إمكانيّة إقامة نوع مِن الارتباط معه؛ إلّا أنَّه يعتقد أنَّ حضور الله في الوجود الإنساني لا يمكن أنْ يحدث بشكل مباشر ومن دون واسطة، وإنّما سوف يتحقّق ذلك للإنسان بواسطة «تجربة مختلفة بالكامل». إنَّ هذه التجربة تؤدّي ـ مِن طريق اللغة البشريّة والمؤسّسات والأنظمة البشريّة وتفسير علماء الدين ـ إلى تبلور تصوّر خاصّ عن الله في المجتمع. يرى مجتهد شبستري عدم إمكانيّة الوصول إلى الله بشكل مباشر، بل هناك على الدوام وساطة بشريّة بيننا وبين الله، وإنَّ تلك الوساطة هي اللغة والأنظمة البشريّة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الذي يقوم به الأشخاص في البين هو تقديم تصوّراتهم وأفهامهم بما يتناسب وعصرهم وما يتوقّف على الإمكانات المعرفيّة لعصرهم.
وقد عمد محمّد مجتهد شبستري إلى بيان رأيه حول وجود الله سبحانه وتعالى على النحو الآتي:
«إنَّ مدخلي إلى وجود الله مدخل تجريبي/ عقلي؛ بمعنى التجربة الشهوديّة العقليّة للوجود. لا يمكن العثور في هذه التجربة الشهوديّة على دليل يثبت ما الذي يجب على الله أنْ يفعله أو لا يفعله، ومِن الممكن أنْ يأتي النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله أو لا يأتي. ليس هناك دليل إلزامي عقلي على وجوب أنْ يأتي النبيّ حتمًا، لكي نحدّد تكليفنا تجاه هذه المسألة. إنَّ أبحاث المتكلّمين حول النبوّة العامّة ليست مفروضة بالنسبة إلى أمثالي؛ بيد أنّي أعتقد أنَّ هذا الأمر قد
تحقّق، وأنَّ النبوّة والرسالة قد وقعت، وأنَّه قد جاء شخص وأعلن عن ارتباطه بذلك الإله الذي نعتقد به. إنَّ قصتنا نحن المسلمين وقصة دين باسم الإسلام ومسألة الوحي والنبوّة، تبدأ مِن أنّنا نواجه شخصًا يدّعي النبوّة، ويقول إنَّ هذا الكلام ليس منه، بل إنَّ هناك قوّة قاهرة قد مكّنته مِن قول هذا الكلام».
سوف نعمل فيما يلي ـ ضمن بيان عدد مِن النقاط ـ على نقد وتقييم أهمّ المباني الأنطولوجيّة لمجتهد شبستري:
كما سبق أنْ أشرنا، فإنَّ أنطولوجيّة شبستري تأتي استمرارًا لإبستيمولوجيّته. وبسبب غلبة الرؤية التفهميّة على الاتجاهات التوصيفيّة/ التفسيريّة، يكون طرح الأسئلة الأنطولوجيّة منتفيًا، وتنخفض الأنطولوجيا إلى إبستيمولوجيا. مِن الضروري الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنَّ كلّ محاولة أنطولوجيّة تقوم على مبنى إبستيمولوجي، إلّا أنَّ رفض طرق الوصول إلى الواقعيّة الذاتيّة، تهيمن على كلا عنصري الوجود والمعرفة. إنَّ اتّخاذ الزاوية الإبستيمولوجيّة في مواجهة فهم الوجود، تنشأ مِن محوريّة الوجود الإنساني. وضرورة وجود فرضيّات مسبقة للفهم وتحديد أفق معرفته بإطار المحسوس،
والقابل للتجربة الحسيّة، والتاريخيّة والثقافيّة، تُعدّ مِن نتائج التفكير المعرفي في المرحلة الحديثة. إنَّ العبور مِن هذه الوضعيّة الإيجابيّة، يقول بوجود منزلة لفهم الإنسان، ولكنْ ما يزال أفق هذا الفهم حبيسًا خلف قضبان التاريخ والثقافة والتجربة المحدودة لكلّ شخص عن العيش في المجتمع؛ إذ أضحى تحليل محمّد مجتهد شبستري للأنطولوجيا مشمولًا لمثل هذا العبور أيضًا.
على الرغم مِن أنَّ مجتهد شبستري لا يطيق النظرة الحديثة الجافّة وعديمة المعنى إلى الوجود، ويبحث لذلك عن نوع مِن المعنى والمفهوم للحياة الإنسانيّة؛ إلّا أنَّه يفاقم مِن أرضيّة الهرج والمرج والفوضى في العثور على معنى الحياة؛ إذ يمتلك نظرة أساطيريّة وملغزة إلى العالم. إنَّ الحقائق المتعالية تتحوَّل في إطار هذه الرؤية إلى أمور ظاهراتيّة، ويتحوّل «المعنى» إلى أمر ذي ماهيّة تطبيقيّة واستعماليّة؛ ليكون بمقدوره أنْ يلعب دورًا بنّاءً في الحياة الإنسانيّة. يزعم مجتهد شبستري أنَّ هذا المسار إنَّما يتحقّق في منظومة نظريّة تربط بداية المعرفة بوجود الإنسان، ولا يفترض وجود معرفة في المرحلة السابقة على بداية قيام الإنسان بعمليّة المعرفة. وهو الاتجاه الذي ينظر إلى المعرفة بوصفها معرفة للظواهر والتجليّات، وليس معرفة الذوات، ويفسّر الحقيقة بشكل
يتناسب مع مبناه. وفي حقل الدين يستند إلى التجربة البشريّة، لا إلى البراهين التوحيديّة، ويعتبر لغة الدين مسألة رمزيّة.
يذهب محمّد مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ القرآن الكريم لا يشتمل على أيّ آية تتحدّث عن وجود الله، ويقول في ذلك:
«لا يمكنكم العثور في القرآن على قضيّة وجود الله، وإنَّما كلّ ما هنالك هو الإحالة والإرجاع فقط. لا يوجد هناك سوى الإشارة إلى شخص. كما لو كان هناك شخص يجلس، وحيث يتمّ الكلام حول أيّ شيء، تقولون إنَّ هذا الكلام يتعلّق بهذا الشخص، لا أنَّه لا يمكن العثور في القرآن على أيّ آية أنطولوجيّة ... ولذلك فإنَّ القرآن إنَّما هو حكاية عن أفعال الله».
هذا في حين يشتمل القرآن الكريم على مئات الآيات حول وجود الله سبحانه وتعالى وعالم الوجود والكائنات. وفي الإجابة عن مجتهد شبستري يجب القول: ألا يرتبط البحث عن أصل وجود الله، والكون، والإنسان، والموجودات في عالم الطبيعة وما وراء الطبيعة، بالوجود والأنطولوجيا؟ وكذلك ألا يكون الإيمان بأفعال الله متفرّعًا عن وجود الله؟ وعندما تدّعي وتقول: هناك إحالة وإرجاع في القرآن، يأتي هذا السؤال ويقول: هل الإحالة أمر وهمي، وليس له مصداق خارجي؟ ما الذي تعنيه الإحالة على شخص؟
هل هذا الشخص المحال عليه حقيقي أم خيالي؟ إنَّ تصوّر وجود وصفات أو أفعال الله سبحانه وتعالى، ليس تصورًا لموجود حيادي في حياة البشر؛ بحيث لا يختلف الاعتقاد أو عدم الاعتقاد به بالنسبة إلى البشر؛ بل إنَّ ارتباط الذات والصفات الإلهيّة، يختلف عن الارتباط بين الصفة والموصوف في جميع الكائنات في عالم الوجود، وإنَّ الصفات الإلهيّة هي ذاته عينها؛ بمعنى أنَّه لا وجود لصفة زائدة على ذاته، بحيث يلزم مِن ذلك القول بالثنويّة.
إنَّ المراد مِن المباني هنا، هي تلك الطائفة مِن المباني التي تبحث في كيفيّة ارتباط الإنسان مع العالم واكتساب المعرفة. إنَّ إمكان المعرفة أو عدم إمكانها، وطريقة معرفة الوجود، ومصادر المعرفة، وأبحاث مِن هذا القبيل، تشكّل المباني المعرفيّة والإبستيمولوجيّة لكلِّ مفكِّر. إنَّ إقامة مجتهد شبستري في أوروبا واحتكاكه بالأبحاث المعرفيّة والإبستيمولوجيّة الحديثة بشكل عام، والعلوم الهرمنيوطيقيّة والظاهراتيّة الجديدة مِن جهة، وتأثّره باللاهوت المسيحي لهذه العلوم؛ قد شكّلت أرضيّة لحدوث تحوّل جذري في المسار الفكري عنده. وبالنظر إلى اهتمام محمّد مجتهد شبستري بالنصوص الدينيّة، مِن قبيل: القرآن الكريم، وبعض الروايات في العالم الإسلامي، وضرورة الخوض في المسائل المعرفيّة والنظريّة؛ فإنَّ الصراحة في بيان المباني المعرفيّة ملحوظة في آرائه.
إنَّ اهتمام محمّد مجتهد شبستري بالمساحتين: الفلسفيّة والمنهجيّة في الاتّجاه الهرمنيوطيقي، قد أدّى به إلى التركيز المعرفي على «فهم» الواقعيّة بدلًا مِن «اكتشاف» الحقيقة، وأنْ يقع الفهم ـ بوصفه متعلّقًا للتعريف ـ موضوعًا للمعرفة. إنَّه يرى، أنَّ فهم النصّ ليس مسألة بدهيّة، ويمكن أنْ تكون هناك لكّل نصّ تفسيرات متعدّدة. وفي هذا السياق، فإنَّ استحالة الوصول إلى الحقيقة ومراد مؤلّف النصّ، وكذلك انحشار المفسِّر ضمن نطاق معلوماته السابقة؛ تؤدّي إلى النسبيّة في الفهم، كما أنَّه يرى امتناع الوصول إلى فهم متطابق مع الواقع؛ وذلك لأنَّه يدّعي قائلًا:
«ليس هناك في عالم الإنسان واقعيّة باسم القراءة القطعيّة في تطابقها مع الواقع، وإنَّ جميع القراءات ظنيّة واجتهاديّة».
هذا في حين أنَّه يطرح أسئلة مبنائيّة حول ما إذا كانت لدينا أفهام وفرضيّات ثابتة أم لا؟ وما إذا كان النصّ يجيب عن جميع توقّعات وتطلّعات القارئ والمفسّر بالإيجاب؟ وهل يوجد هناك ملاك ومعيار للحكم والبحث بين الأفهام المختلفة أم لا؟ وهل نظريّة قابليّة القراءة في حدّ ذاتها قابلة للقراءة أم لا؟
إنَّ محمّد مجتهد شبستري يربط فهم النصوص «مئة بالمئة بصوابيّة المعلومات السابق وتعلّقات وتوقّعات المفسِّر»، ويرى أنَّ:
«الحكم بين التفاسير المختلفة لنصّ واحد بدورها، مِن دون الحكم بشأن مقدّمات ومقوّمات تلك التفاسير، أمر عقيم ولا يؤدّي إلى ثمرة أو نتيجة».
إنَّ مجتهد شبستري، على الرغم مِن قبوله بنظريّة القراءات المتعدّدة للنصوص، لكنَّه في الوقت نفسه لا يرى صحّة جميع أنواع القراءات؛ وإنَّما ينصح ـ من أجل إحراز صحّة التفاسير ـ بالتدقيق في المباني والفرضيّات السابقة للقارئ، والاهتمام مِن جهة أخرى بالهواجس التي تعمل على إيجاد النصّ أيضًا.
يرى مجتهد شبستري أنَّ المفسِّر إنَّما يتمكّن مِن الحصول على الإجابات التي يتوقّع الحصول عليها مِن النصّ. إنَّ هذه التوقعات مِن قبل المفسِّر، هي التي تعمل على رسم مسار السؤال، ويؤدّي به إلى عدم المطالبة بجواب تاريخي مِن النصّ الفلسفي، أو جواب فلسفي مِن النصّ التاريخي. إنَّه في مرحلة مِن آرائه، حيث كان يقول بأصالة النصّ الديني مِن ناحية المبدع؛ كان يعتقد بضرورة أنْ يكون هناك تطابق بين تعلّق وتوقّع المفسِّر مع التعلّق والتوقّع
الذي كان لدى مُبدع النصّ عند إبداعه. وأمّا في المرحلة الأخيرة، فإنَّه قد تخلّى عن هذه الرؤية، وذهب إلى الادّعاء قائلًا:
«نحن في المواجهة التجريبيّة مع نصّ القرآن، إنّما نواجه ذهن ولغة وتجارب الإنسان وبيئته التي عاش فيها، ولا نواجه واقعيّة سابقة على ذلك؛ ... وعلى هذا الأساس، فإنّنا نعتبر الكلام المستفاد مِن القرآن كلام النبيّ، وليس كلام شخص آخر».
ولذلك، فإنه يدّعي بأنَّ:
«ذات ظهور النبيّ محمّد في التاريخ؛ حيث لم يترك لنا القرآن فقط، وإنَّما قام كذلك بإبداع طريقة توحيديّة عالميّة تحتوي على مفاهيم متجدّدة بعيدة المدى، هو بدوره ذات كلام الله في عالم الإنسان، وإنَّ هذا الكلام هو كلام لجميع الناس».
وينصح لفهم النصّ، قائلًا:
«إنَّ على أولئك الذين يسعون اليوم في العالم الإسلامي ـ (ولا سيّما في إيران) ـ إلى تقديم تفسير جديد للكتاب والسنّة؛ أنْ يبحثوا في قراءة جديدة، إلى أيّ حدّ أمكن لتفسيراتهم أنْ تقرّب مخاطبيهم مِن الله سبحانه وتعالى. كما يتعيّن عليهم أنْ يشيروا إلى كيفيّة أداء التفاسير الرسميّة والحكوميّة إلى إبعاد المسلمين عن الله سبحانه وتعالى».
ويذهب إلى الاعتقاد قائلًا أيضًا:
«لست أشكُّ في أنَّ هذا المشروع يمكنه أنْ يفتح أفقًا جديدًا في الفضاء القاتم والمظلم الذي يحيط بالفكر الديني، ولربَّما أدّى ذلك بدوره ليكون منشأ في ظهور تيّار جديد مِن الفكر الديني في مجتمعنا».
يذهب محمّد مجتهد شبستري ـ في العثور على معيار لفهم الحقيقة، كما حصل عليها ـ إلى الاعتقاد قائلًا:
«إنَّ الذي يُسمّى في الخارج ـ بواسطة الموازين العقليّة ـ صدقًا وحقيقة، يجب أنْ يكون صدقه وحقيقته بالنسبة لي متطابقًا مع الخصائص التي أمتلكها، بحيث تقنعني وتزيد مِن تأجيج الضوء في داخلي، وهذا كلّه يعني الفهم، وليس معرفة كيفيّة العالم، وما هي القضايا المتطابقة مع الواقع».
وعلى أساس القول بـ (صنع الحقيقة)، يذهب إلى القول:
«إن هذه اللغات الإنسانيّة هي التي تأتي المعاني والمفاهيم في إطارها».
وعلى هذه الشاكلة، فإنَّ خلق المفهوم والمعنى يعتبر أمرًا شخصيًّا ونفسيًّا وثمرة لرؤية الفرد بشكل كامل، وإنَّ مواجهة الأفراد مع مختلف الأشياء والموضوعات، يخلق معاني متنوّعة.
وفي مقام الجمع والاستنتاج، يمكن القول بأنَّ الاعتقاد بعدم إمكان الوصول إلى الحقيقة كما هي، وسيادة الرؤية الصانعة للأشياء والموضوعات، والبحث عن معنى الحياة مِن طريق الاستعارة، والنظر إلى الأمور مِن الزاوية اللاحقة، ووضع الحدود العملانيّة بين الحسّ والعقل والإلهام، وعدم الشأنيّة المعرفيّة للقضايا الدينيّة، وكذلك عدم قابليّة اتّصاف متعلّق هذه القضايا بالصدق والكذب؛ يمكن أنْ تعتبر بوصفها مِن المباني المعرفيّة والإبستيمولوجيّة لمجتهد شبستري، حيث ألقت جميعها بظلالها على نظريّاته.
فيما يلي سوف نعمل ـ ضمن بيان عدد مِن النقاط ـ على نقد أهمّ المباني الإبستيمولوجيّة والمعرفيّة لمجتهد شبستري:
إنَّ مجتهد شبستري ـ بالإضافة إلى تشكيكه في قدرة الإنسان على الوصول إلى الحقيقة الغائيّة واكتشافها، بل وإنكاره لهذه القدرة ـ يذهب إلى التشكيك أيضًا في القدرة الاستيعابيّة لدى الناس في الاتّفاق حول مجموعة معرفيّة عقلانيّة، ومشتركة بين الأذهان. ومِن خلال إنكار إظهار الواقع مِن قبل المعرفة البشريّة، والتمسّك بتجريبيّة المعاني، والإفراط في إنكار الأمر نفسه للحقيقة والواقعيّة، وتجاهل الظرفيّات المعرفيّة للإنسان، تبعًا للتشكيك في
مسألة إمكان معرفة الواقع؛ يظهر تحدّي «النسبيّة» في المعرفة البشريّة بشكل عام، والنسبيّة في المعرفة الدينيّة. وكذلك، فإنَّ مجتهد شبستري، على الرغم مِن تأكيده على المباني الإبستيمولوجيّة ـ بدلًا مِن المبانى الأنطولوجيّة ـ لم يحقِّق نجاحًا في تبويب المعرفة والمسار والآليّة المحدّدة والمعيّنة لتكوين المعرفة وفهم الوجود وتعيّن مفهوميّة الحياة. وإنَّ المخاطب بآثاره لا يشاهد مجموعة العوامل والعناصر الدخيلة في المعرفة وطريقة وحدود تأثيرها، إلى الحدّ الذي يمكن الادّعاء معه بأنَّ مجتهد شبستري لا يمتلك مبنى معرفيًا وإبستيمولوجيًّا منقّحًا ومنسجمًا. إنَّ القبول بالتعدّدية في الفهم، وجعل المعنى للحياة الإنسانيّة؛ يؤدّي إلى التكثّر غير المتعيّن وغير الملائم واللامتناهي للسنن والتجارب الدينيّة، وسوف نشهد نوعًا مِن الأزمة المتمثّلة بـ «تحدّي المبنى» في حقل المعرفة؛ وذلك لأنَّ المعنى الحقيقي ـ في نصّ مثل القرآن الكريم ـ أمر ثابت وغير قابل للتغير، ولا دور لذهنيّة المفسِّر فيه. إنَّ النصوص الدينيّة في ـ ضوء هذا الفهم ـ تشتمل على خطابات إلهيّة إلى الناس. وإنَّ غاية المفسِّر لهذه النصوص، هي إدراك وفهم المراد الحقيقي للشارع. وإنَّ الوصول إلى هذه الغاية، إنَّما يتحقّق مِن طريق سلوك الأسلوب والمنهج المتعارف للفهم، والذي هو عبارة عن: الظهور اللفظي للنصّ مِن أجل الوصول إلى المعنى؛ وذلك لأنَّ مؤلّف النصّ قد بيّن مراده بواسطة الألفاظ. إنَّ دلالة الألفاظ على المعاني تابعة للوضع اللغويّ، والأصول والقواعد العُرفيّة والعقلائيّة للتحاور، وتتمّ مراعاتها في كلّ لغة مِن قبل المؤلِّف والمخاطب. وإنَّ تجاوز
هذه الضوابط العقلائيّة في التفهيم والتفاهم ـ والتي يمكن التعرّف عليها وتدوينها ـ تعرّض عمليّة فهم النصّ إلى الخلل. وبطبيعة الحال، فإنَّ مسار فهم غير النصوص، والتي تسمّى بـ «الظواهر»، على الرغم مِن أنَّ المفسّر لا يصل فيها إلى هذا اليقين (القطع)، بحيث يقطع بأنَّ المعنى الذي أدركه هو المعنى النهائي للنصّ؛ إلّا أنَّ هذا لا يعني زوال اعتبار التفسير، وعدم وجود معيار لتقييم التفسير المعتبر وتمييزه مِن التفسير غير المعتبر. وفي مقولة تفسير النصّ ـ ولا سيّما تفسير النصوص الدينيّة ـ يسعى المفسِّر إلى الحصول على فهم «معتبر» وتفسير مشتمل على الحجيّة، ويكون قابلًا للاستناد والاهتمام؛ إذ يكون منضبطًا، وناتجًا مِن خلال الحفاظ على الأصول العقلائيّة الحاكمة على التحاور والتفاهم. وعليه، فإنَّ التفسير المعتبر هو التفسير الذي يتمّ تصحيحه على أساس العُرف السائد بين العلماء.
مِن غير الواضح عند محمّد مجتهد شبستري ما هو سنخ الفرضيّات السابقة والسنن التي يواجهها المفسِّر أو الفاعل المعرفي مع متعلَّق المعرفة، وما هو حجم تأثيرها. هل هذه الفرضيّات السابقة والتقاليد تمتدّ بجذورها في الثقافة وأشكال الحياة والنماذج الحضاريّة، والأقاليم الاجتماعيّة والبيئات المحليّة
فقط؟ أم هي تجلّ وظهور للحقيقة الغائيّة، ولكنّها مجهولة وغير معروفة؟ أم هي خليط مِن جميع ذلك؟. وعلى كلِّ حال، فإنَّ الجواب عن هذا السؤال، يُعرّض مجتهد شبستري إلى نوع مِن الإبهام والغموض المنهجي في المواجهة مع الظرفيّات المعرفيّة للبشر. وبما أنَّ فهم الحقيقة ـ بالنسبة إلى مجتهد شبستري ـ والتحقّق المعرفي للحقيقة، محكوم بالأحكام والقواعد اللغويّة، والفرضيّات الثقافيّة السابقة، والسنن المتداولة في المجتمع الإنساني؛ وعليه فإنَّه على الرغم مِن أنَّ جوهر التجربة الدينيّة عبارة عن المواجهة مع الأمر المطلق؛ بيد أنّنا لا نواجه حقيقة «واحدة»، بل يمكن أنْ تكون هناك حقائق متكثّرة ومصاديق متعدّدة، لا سيّما عندما تتدخّل الفرضيّات السابقة وتعلّقات وتوقّعات المفسِّر في مسار الفهم. وعندما يكون كلّ فهم نسبيًّا، فإنَّ الأصول والمفاهيم الهرمنيوطيقيّة بدورها، لا يمكن أنْ يتمّ اعتبارها بوصفها قضايا مطلقة وغير نسبيّة. وفي الحقيقة، فإنَّه مِن شمول الفرضيّات السابقة بالنسبة إلى ذاتها نصل إلى عدم شموليّتها، ومِن التصديق بها يلزم صدق نقيضها. هذا في حين أنَّ الفرضيّات السابقة وتعلّقات وتوقّعات المفسِّر، ليست على وتيرة واحدة في تدخّلها، بل إنَّ حجم حضور وتدخّل الفرضيّات السابقة للمفسِّر تختلف بما يتناسب مع الأهداف والغايات التفسيريّة، والنشاط الذي يقصده المفسّر ويعتزم القيام به.
إنَّ التحليل الإبستيمولوجي لمجتهد شبستري لآيات القرآن، وإصراره على أنَّ القرآن الكريم لم يكن بصدد بيان ما هو موجود في العالم وما هو غير موجود؛ وإنَّما سعى في حقل الثقافة الجاهليّة للعصر النبويّ إلى إحالة كلّ ما يتصوّرونه موجودًا إلى الله، والتعبير عنه بوصفه آيات وتجليّات له؛ سوف تترتّب عليه تداعيات وتبعات معرفيّة وإبستمولوجيّة مهمّة. هناك، في قابليّة القضايا المعرفيّة على الاتّصاف بالصدق والكذب، بون شاسع واختلاف واضح بين «الوجود» وبين «ما يبدو». إنَّ الذي يضع على عينيه نظّارات ذات عدسات خضراء، سوف يرى كلّ شيء باللون الأخضر، وبذلك يمكنه القول ـ مِن الناحية المنطقيّة ـ إنَّ الأشياء «تبدو» بالنسبة لي خضراء اللون؛ ولكنَّه لا يستطيع أنْ يخبر حول خضرة جميع الأشياء والأمور إخبارًا واقعيًّا، ويدّعي إبداء قضايا معرفيّة قابلة للاتّصاف بالصدق والكذب، ويعلم أنَّ كلّ شيء أخضر. إنَّ الاستفادة مِن هذه العدسات، لا يحدث إيمانًا واعتقادًا بخضرة جميع الأشياء والأمور، لا بالنسبة إلى صاحب العدسات ولا إلى الذين يخاطبهم.
إنَّ هذا النوع مِن الرؤية إلى الآيات القرآنيّة والرسالة النبويّة، لا ينتج إيمانًا ولا يؤدّي إلى معتقد. فإذا كان تجلّي ورؤية جميع الأمور والتفسير التوحيدي
(49)للوجود والإنسان وأحداث الأمم السالفة والنظر إليها بوصفها آية؛ إذا كان ناجمًا مِن رؤية لا تقبل الاتّصاف بالصدق، ولا تُعدّ كشفًا عن الحقائق والوقائع، ففي مثل هذه الحالة لن يكون للتجارب النبويّة للأنبياء بشكل عام والنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ـ في مجال الدعوة إلى التوحيد، والسعي إلى تحصيل الإيمان بالله مِن قبل الناس ـ تفسير منطقي معقول. ولذلك، يمكن القول: إنَّ سلوك الاتّجاه المعنوي نحو فهم الحقيقة، ربَّما يكون ناشئًا مِن الجذور الإسلاميّة لمجتهد شبستري؛ إذ حال ذلك دون سلوكه نحو اتّجاه علماني إلى الوجود بالكامل، ولا ينكر المساحة القدسيّة للعالم بشكل تامّ. إنَّه يؤمن بشكل ما بوجود مساحة قدسيّة في العالم، ومِن هنا فإنَّه يبحث مِن أجل العثور على نوع مِن التجربة المعنويّة في الحياة الإنسانيّة. ولكنْ، لا بدّ مِن الالتفات إلى أنَّه لا يطيق المرجعيّة المطلقة والمُلزمة لله في الدائرة الأنطولوجيّة مِن الحياة الإنسانيّة في إطار القضايا المعرفيّة والإبستيمولوجيّة، وقد شبّه مسألة الإثبات والتطابق مع الواقع بالمرحلة القديمة للإنسان. يذهب مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ مِن مهام علم الكلام في العصر الجديد، هو أنْ «يتمّ اليوم السؤال ـ في الدرجة الأولى ـ عن دور الدين، وليس عن تطابق أو عدم تطابق القضايا الدينيّة مع الواقع، وكأنَّ الجواب عن هذا السؤال الثاني قد خرج مِن يد البشر».
لقد ذهب محمّد مجتهد شبستري ـ في ضوء سنخ مِن اللاهوت السلبي ـ إلى
جعل الحقيقة الغائيّة مشتملة على نوع مِن الغموض والإلغاز والأسطورة. وبحسب القاعدة، فإنَّ الحصول على إطار لأخذ منظومة تدبيريّة للحياة الإنسانيّة القائمة على القضايا الدينيّة، غير ممكن. وإنَّ مواصلة البحث عن ذلك غير مطلوب، ويجب على علماء الدين أنْ لا يقوموا بمثل هذه الجهود. وقد أدرك مجتهد شبستري بوضوح، أنَّ علماء الدين بل ـ وكلّ مسلم ـ ما لم يرجعوا إلى الكتب المقدّسة ـ على أساس هذه المبادئ والمباني ـ لا يمكنهم القبول بالكثير مِن القيَم الغربيّة. وهناك تعارض ونزاع دائم بين القيَم الإسلاميّة والغربيّة، ولا سيّما في حقل المعاملات والسياسات. ولهذا السبب، فإنَّه لا يرى الاجتهاد في الفروع الدينيّة كافيًا مِن أجل تطبيق الإسلام وجعله متماهيًا مع العلوم الجديدة، ويرى وجوب الاجتهاد في أصول الدين. ولهذه الغاية، عمل على الاستناد إلى الوحي ـ أكثر مِن أيّ شيء آخر ـ وسعى مِن خلال إبداء بيان جديد لماهية الوحي إلى تعبيد الطريق لإثبات مقاصده وغاياته. في حين أنَّ هذا الاتّجاه في الإلهيّات، يتعارض مع جامعيّة وخاتميّة الدين الإسلامي، ويجعل الإلزام بامتثال الأوامر الإلهيّة وترك النواهي الإلهيّة، مِن دون تأثير. يضاف إلى ذلك، أنَّه لا يمكن لهذا الأمر أنْ يجري في جميع الأفهام الدينيّة على نسق واحد؛ وذلك لأنَّ النصوص الدينيّة ليست بأجمعها مِن سياق واحد، فلا يمكن للمحكم والمتشابه، والباطن والظاهر ونظائر ذلك، أنْ يحظى بنمط واحد مِن التحوّل في الاتجاه التفهيمي والاجتهادي. والشاهد على ذلك، هو الحديث المأثور عن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، والذي جاء في مضمونه: «حلال وحرام
الشريعة، حلال وحرام إلى يوم القيامة». والإشكال الآخر الذي ينشأ مِن هذا الاتجاه، هو لغويّة إرسال الرسل، وإنزال الكتب، والهداية الإلهيّة؛ وذلك لأنَّه يعمل على نفي الضروريّات الدينيّة، ويشكّك في المعتقدات والأحكام الضروريّة للدين.
إنَّ محمّد مجتهد شبستري يتبنّى ـ مِن خلال اتّخاذه للاتجاه الأنثروبولوجي ـ رؤية تسيء الظنّ بذات الإنسان. وتتّضح هذه الحقيقة للعيان في مواجهته التفسيريّة بالنسبة إلى الآيات المرتبطة بالخلق في القرآن الكريم. مِن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ مجتهد شبستري، مِن خلال تمسّكه بالآية الثلاثين مِن سورة البقرة، يدّعي أنَّ الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة للإنسان تقوم على الشرّ. إنَّ الدور المفهومي الأهمّ للحياة بالنسبة إلى الإنسان ـ مِن وجهة نظر مجتهد شبستري ـ هو الاقتدار مِن أجل مواصلة حياته، ويجب على هذه المفهوميّة أنْ تتمكّن مِن المحافظة عليه مِن السقوط والانزلاق في هوّة «العدميّة الأخلاقيّة».
يرى محمّد مجتهد شبستري أنَّ الإنسان هو نتاج التاريخ وثمر المجتمع وحبيس خلف قضبان التاريخ والمجتمع. وأنَّ الأنثروبولوجيّة المنشودة ـ مِن وجهة نظره ـ تتمحور حول الإنسان الذي يكون مِن جهة عبارة عن ذات فاقدة للذنب ومجرّدة مِن النزعة الإيمانيّة؛ فهو بمنزلة اللوحة البيضاء التي يكتب لها التعيّن في ظلّ المجتمع وتحت الظروف الاجتماعيّة والثقافيّة؛ ومِن ناحية أخرى هناك الحريّة الفكريّة والإرادة الناظرة إلى الاختيار الموجّه لدفّة هذا التعيّن. وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار محوريّة الإنسان، وحريّة الإنسان، وارتباط الإنسان بالتاريخ والمجتمع، بوصفها مِن أهمّ المباني الأنثروبولوجيّة لمجتهد شبستري:
إنَّ هذا الأصل يعتبر محور الأنثروبولوجيا، وإنَّ مجتهد شبستري لا يؤمن به فحسب، بل ويجعل منه مبنى لجميع العناصر، ويعيد في إطار هذه الرؤية قراءة الحقوق الحيويّة للإنسان، الأعمّ مِن الأمور الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة.
إنَّ الخطابات الدينيّة تنظر إلى الإنسان نظرة عموديّة، وتعمل على تعريفه في سياق الارتباط بالله سبحانه وتعالى. في حين يذهب مجتهد شبستري، لا إلى القول:
«في العصر الراهن أصبح الاهتمام بكون كلّ إنسان شخصًا، قد فتح بابًا جديدًا في الأنثروبولوجيا الفلسفيّة واللاهوت المسيحي».
فحسب، بل ويقول أيضًا:
«إنَّ كون الإنسان شخصًا، بغضّ النظر عن دينه ومذهبه، هو مِن وجهة نظر الإلهيّات الإسلاميّة، أكثر مفهوميّة مِن اللاهوت المسيحي».
في النموذج الأوّل، يظهر الإنسان على شكل مخلوق تتمّ هدايته مِن الخارج، وتتمثّل هويّته في إطاعة أوامر ونواهي خالقه. وأمّا في النموذج الثاني، فيكون الإنسان قد بلغ مرحلة استقلاله الذاتي، ويأخذ القرارات بشأن أعماله بنفسه.
إنَّ روح الإنسان تميل ـ مِن وجهة نظر مجتهد شبستري ـ نحو الحريّة، وإنَّ الإنسان قد وُلد حرًّا، ولا ينبغي للأشخاص أنْ يفرضوا إرادتهم على الآخرين. إنَّ هذه الحريّة تشمل الحريّة في طريقة السلوك، والحريّة الفكريّة، وكذلك الحريّة في تقرير المصير، ونوع الحكم أيضًا. وقد ذهب ـ مِن خلال إجراء مقارنة بين الاختيار الإنساني والاختيار الإلهي ـ إلى الادّعاء بأنَّ اختيار الله بمعنى «أنَّ الله لا يخضع تحت تأثير قاهر خارجي». ولذلك، فإنَّه يأخذ مثل هذا المسار بالنسبة إلى الإنسان أيضًا، ويطلق على ذلك عنوان «تحقّق الاختيار». يجب العمل أوّلًا على تحديد «أيّ أنا؟»؛ فإنَّ لكلِّ أنا باطنًا، ويصدر
عنه صوت. إنَّ المشكلة تكمن في اختيار الإنسان لأيّ «أنا» مِن الأنوات. ربَّما أمكن للمتألّه والمتكلّم أنْ يقول: إنَّ مِن بين الأنوات المتنوّعة التي يمكن لي أنْ أتصوّرها لنفسي، أستطيع أنْ أختار الأنا الإلهيّة. ولكنْ ليس هناك إلزام وبيان عقلاني ـ حتّى بمعناه البرهاني ـ يمكنه أنْ يوجب على الآخرين أنْ ينتخبوا هذه الأنا الإلهيّة أيضًا. إنَّ تحقيق هذه «الأنا الإلهيّة»، هي أمر إنَّما يمكن رسم شعاع لها، وقد أسّست لمساحة روحيّة وعملت على توسيعها.
إنَّ الحريّة بمعناها الجديد المتمثّل بالاقتدار والتخلّي عن المرجعيّة الخارجيّة، تعني ـ بالنسبة إلى مجتهد شبستري ـ وضع القوانين مِن أجل ممارسة الحياة. كما عمد إلى تبويب وتصوير مفهوم الديانة على النحو الآتي:
«إنَّ الإنسان بعد التأمّل العقلاني الحرّ، أو في ضوء مجرّد الإيمان بالغيب، والإجابة عن خطاب الله للعالم والإنسان، يذهب إلى القول بمبدأ عالم ومقتدر ورحيم، ويعتمد عليه بالمطلق، مؤمّلًا أنَّ ذلك المبدأ لن يتخلّى عن الإنسان ولن يتركه وشأنه في وحدته وفنائه (الألم والموت). وكذلك أنْ يؤمن ـ برغبته واختياره ـ بالأصول والقيَم التي قام الأنبياء بعرضها وتقديمها باسم الله على طول التاريخ، ويجعل منها معيارًا لطريقته ومنهجه في الحياة».
إنَّ مِن بين المباني الأساسيّة لدى مجتهد شبستري في التعامل مع تفسير الماهيّة
والظرفيّات الوجوديّة للإنسان، والتي تتجلّى في فهم النصوص الدينيّة؛ البحث في مسألة اللغة. فهو يرى:
«أنَّ الله والإنسان ليس لديهما لغة لفظيّة ذهنيّة مشتركة، لكي يتمكّن الله مِن مخاطبة الناس بتلك اللغة على نحو ذهنيّ ولفظيّ».
وفي الحقيقة، فإنَّ مجتهد شبستري قد قبل بأنَّ الإنسان كائن ذو بعدين، ولكنَّه يراهما في بعدين منفصلين؛ بمعنى أنَّه لم يعمل على مجرّد ربط كيفيّة تدبير الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة بدائرة وحقل ارتباط المعاملات الإنسانيّة؛ وعلّق السعادة المعنويّة والتدبير المفهومي لحياة الإنسان الفرديّة بالتعامل مع الله، حيث تكون هناك مساحة الدين والإلهيّات فحسب، بل وحتّى الظرفيّات الوجوديّة للإنسان ـ مِن قبيل: اللغة، ويتمّ خلق شرخ بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى على مدار هذه الثنائيّة.
في حين أنَّ إيجاد التمايز بين هاتين المساحتين مِن الحياة الإنسانيّة مشكل؛ وذلك لأنَّ الدنيا وجميع الأعمال الدنيويّة، تؤثّر في حصول الإنسان على الكمال. ومِن هنا، فإنَّ هاتين المساحتين في رؤية الدين إلى الحياة الإنسانيّة، صارتا مشمولتين للأحكام الدينيّة أيضًا. وفهم هذه المسألة، وهي كيف يمكن للإنسان ـ القادر على تطبيق الدين والبُعد المعنوي المتناسب معه في الحياة الفرديّة ـ أنْ لا يستطيع إخفاء هواجسه الدينيّة في الحياة الجماعيّة، ولا يمكنه إدخال جزئيّات تلك المعتقدات ومفهوميّة الحياة في الحياة الجماعيّة.
«إنَّ علاقة الأشخاص بالله، ترتبط بسعادتهم المعنويّة وآخرتهم، وتعمل على تشخيص إمكانات تكاملهم وتعاليهم على المستوى الروحي».
إنَّه يذكر هذه العلاقة تحت عنوان «الارتباط العمودي أو العمقي»، ويسمّي النظام الحاكم على هذه العلاقة بـ «النظام الإيماني/ العرفاني»؛ إذ يتمّ بيان أحكامها في البُعد الداخلي مِن كلّ فرد، والهدف مِن ذلك هو تعريف الإنسان بأعمق حاجاته الوجوديّة. إنَّ هذه العلاقة ترتبط بحقل الديانة، وإنَّ الهدف مِن بعث الأنبياء هو تنظيم هذه العلاقة. إلّا أنَّ هذا السنخ مِن الارتباط عند مجتهد شبستري، تكتنفه هالة مِن الغموض والأسرار. وفي المقابل، فإنَّ علاقة الأشخاص فيما بينهم ترتبط بحياتهم السلميّة في هذه الدنيا. وقد عبّر عنها مجتهد شبستري تحت عنوان «الارتباط الأفقي». وهذا النوع مِن الارتباط ـ خلافًا لسنخ الارتباط السابق ـ يقوم على رؤية عرفيّة وعقلائيّة تنفي جميع أنواع الأسرار والألغاز في حقل السياسة والمجتمع، ولا تقبل بأيّ مصلحة خفيّة في الحياة السياسيّة / الاجتماعيّة.
نشير في هذا الفصل إلى بعض الانتقادات الواردة على المباني الأنثروبولوجيّة لمحمّد مجتهد شبستري.
يبدو أنَّ هناك تناقضًا في أسلوب تعاطي مجتهد شبستري في تعريف الإنسان؛
تحقيقها بأيّ شكل كان. ولذلك، فإنَّ تحقّق وتلبية الحاجات الماديّة والمعنويّة للإنسان، إنَّما يحدث بشكل متزامن وبالاقتران مع بعضهما. بيد أنَّ محمّد مجتهد شبستري، وإنْ كان معتقدًا بكلا البُعدين ـ الدنيوي والأخروي ـ للإنسان؛ إلّا أنَّه يرى أنَّ الطريق إلى إمكان التمسّك بالتعاليم الدينيّة ـ مِن قبيل: القرآن الكريم والسنّة المطهّرة ـ التي يمكن لها أنْ تضع حلولًا زمانيّة ومكانيّة في غير عصر النزول، وكذلك «كشف» معنى الحياة الإنسانيّة؛ طريق مغلق. وبدلًا مِن «كشف» هذا المعنى مِن الحياة، يذهب إلى الاعتقاد ببنائها وإيجادها بما يتناسب مع التحوّلات المعرفيّة لكلِّ عصر مِن العصور.
لقد قام محمّد مجتهد شبستري بقياس مع الفارق بين الاختيار الإنساني والاختيار الإلهي؛ ذلك أنَّ الاختيار الإلهي في ذات واجب الوجود يكون على نحو الضرورة، ولا يحصل عليه مِن الخارج، بل إنَّ وجود الضرورة في ذاته، وهو وجوده عينه. وأمّا في الذات الإنسانيّة التي هي إمكان محض، فالاختيار لا يكون على نحو الضرورة، وإذا كانت هناك مِن ضرورة، فقد أعطيت له مِن الخارج. وللخروج مِن هذا المأزق، يذهب مجتهد شبستري إلى الادّعاء بوجوب التخلّي عن مفهوم «الوجوب» في العبادات، وأنْ نستعمل بدلًا منه مفهوم التوصية؛ وذلك لأنَّ الأوامر والنواهي القرآنيّة والإسلاميّة في عصرنا، سوف تؤثّر على الاختيار الإنساني. ولكنْ ليس مِن المعلوم ما هو الإسلام ـ (الإلهيّات، والأوامر والنواهي القرآنيّة والإسلاميّة) ـ المنشود لمجتهد شبستري، كيما يمكّنه ـ مِن خلال الاعتراف الرسمي بالاختيار
(59)الإنساني ـ أنْ يزدهر في قباله؛ في حين أنَّه يدّعي أنَّ واجبات ومحرّمات حقوق الإنسان المعاصر، يتمّ فهمها بالنسبة إلى الجميع على وتيرة واحدة.
لقد سعى محمّد مجتهد شبستري ـ بزعمه ـ إلى إعادة النظر في أساليب فهم الدين، وأنْ يمهّد الطريق إلى تقديم أسلوب جديد لفهم النصوص الدينيّة وتفسيرها. وقد عرض آراءه في مختلف المقالات والآثار، مِن قبيل: (هرمنيوطيقا الكتاب والسنّة)، و(نقد القراءة الرسميّة للدين) ، و(تأمّلات في القراءة الإنسانيّة للدين) ، و(الإيمان والحريّة). وفيما يلي سوف نعمل ـ بالنظر إلى هذه الأعمال ـ على بيان نظريّاته، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى نقدها ومناقشتها.
سوف نعمل في هذا الفصل على بيان أهمّ الأفكار والآراء التفسيريّة لمحمّد مجتهد شبستري، وهي الآراء التي تشكّل القسم الأهمّ مِن تفكيره.
يرى مجتهد شبستري أنّنا بعد اندلاع الثورة الإسلاميّة في إيران، أخذنا نشهد استمرار «عدم المفهوميّة» في لغة التراث الديني؛ كان قد سبق لهذا الأمر أنْ ظهر في إيران منذ عصر المشروطة والثورة الدستوريّة في مستهلِّ القرن العشرين للميلاد. وبذلك، فإنّه ينشد نوعًا مِن مفهوميّة اللغة الدينيّة في المسار المتسارع
والناشئ مِن تحوّلات مرحلة عصر الثورة الدستوريّة وثورة عام 1357ه.ش. لم يكن مِن الواضح على مستوى التنظير والتفكير، ما الذي يجب قوله وفعله على نحو قاطع؛ ولكنَّهم في مقام العمل كانوا يعملون على نحو حازم ويمضون قدمًا. وقد رأى مجتهد شبستري في هذه الظاهرة نوعًا مِن العملانيّة الخالقة للأزمات، وقال: إنَّهم في مرحلة الثورة الدستوريّة (المشروطة) كتبوا دستورًا أعطوا فيه للناس حقَّ الانتخاب والاختيار، ولكنَّهم أدرجوا فيه مادّة تقول بأنَّ كلَّ شيء يجب أنْ يكون تابعًا لأحكام الفقه الموجود. وبذلك، فقد تمّ ترسيخ عدم المفهوميّة؛ إذ لم يُعلم في نهاية المطاف ما هو الحكم التكليفي للناس، فهل يتعيّن عليهم إطاعة فهم وفتاوى المجتهدين أو يمارسون حرّيتهم في التصويت والانتخاب، وتحديد أطر الحياة السياسيّة وقوانينها مِن خلال ما تراه الغالبيّة مِن الناس؟
وبذلك، فإنَّه يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ أبحاث الهرمنيوطيقا في الغرب، إنَّما ظهرت بدورها عندما حدث نوع مِن عدم المفهوميّة حول الموروث القديم؛ وذلك عندما أدرك الجيل الجديد، أنَّ لغة التراث القديم قد أصبحت غير مفهومة. يرى مجتهد شبستري أنَّ عدم المفهوميّة، إنَّما يحدِث عندما لا يعود التراث القديم ـ بسبب حدوث التغيير في المعايير القيميّة والأخلاقيّة والعقلانيّة ـ مفهومًا بالنسبة لكم، وتدخلون عندها في المتاهة والضياع، ويقول أحدكم: إذا كنت اليوم أعيش بهذه المعتقدات الأخلاقيّة والعقلانيّة،
فما هو المعنى الذي يمكن أنْ تحتوي عليه تلك القيَم والمعتقدات الموجودة في تراثي القديم والذي لا أريد التخلّي عنه؟ وفي مثل هذه الحالة مِن عدم مفهوميّة أفهامكم السابقة للدين والمعتقدات الدينيّة، تظهر أمامكم «حالة هرمنيوطيقيّة»؛ بمعنى «الوقوع في مقام إعادة الفهم والتفسير المتجدّد». يرى مجتهد شبستري أنَّه لا يمكن للإنسان أنْ يودع التراث في الدرج مرّة واحدة ويتخلّى عنه إلى الأبد؛ ولذلك فإنَّ الطريق الوحيد يكمن في العمل على إضفاء معنى جديد على التراث القديم. وفي المرحلة المعاصرة مِن العالم الإسلام، قد اقتضت الضرورة أيضًا أنْ يحدث تحوّل في لغة الأخلاق السياسيّة الدينيّة مِن جهة، وأنْ يحدث تحوّل تفسيري في لغة الفقه مِن جهة أخرى أيضًا. ومِن هنا، فإنَّ طريقة الحلّ عند محمّد مجتهد شبستري تتمثّل في هذه الحالة بوجوب تفسير التراث الديني مِن جديد، والعمل على إيجاد لغة جديدة، وتقديم تفسير تاريخي للأحكام السياسيّة الفقهيّة، والإعلان عن أنَّ الأحكام القديمة لم تعد شاملة.
وقد ذهب مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ تسلّل المفاهيم والقيَم الجديدة بفعل المواجهة مع الحداثة واختيار القيَم ومعتقدات الحياة الجديدة، قد أعدّ الأرضيّة لحدوث التحوّلات والتغيير الأساسي في البلدان الإسلاميّة، وحدث تغيير في المعتقدات والقيَم حتّى مِن دون أنْ يتمّ الالتفات إلى ذلك، فصرنا نؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، وتغليب آراء الشعب،
وما إلى ذلك مِن القيَم الجديدة التي لم تكن موجودة في التراث الإسلامي. يرى محمّد مجتهد شبستري أنَّ اللغة القديمة للتراث الديني، كانت عبارة عن لغة الطاعة؛ بمعنى إطاعة المحكوم للحاكم، وإطاعة الرعيّة للراعي.
يذهب مجتهد شبستري إلى الاعتقاد بأنّنا في المرحلة الراهنة ـ حيث تغيّر نمط حياة الناس، وتمّ إيجاد مؤسّسات وأبنية جديدة ـ لا نستطيع إدارة المجتمع بالفقه التقليدي الموروث، ويجب القيام بشكل وآخر بالاجتهاد في مباني وأصول الإسلام، والعمل على تحديثها؛ لكي نتمكّن مِن إدخال الأمور الحقوقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة الجديدة إلى البلدان الإسلاميّة. ولهذه الغاية، فإنَّه يعمل على نبذ الأساليب التقليديّة لتفسير الدين وفهمه؛ معتقدًا ضرورة الذهاب إلى فهم الدين مِن خلال الأسلوب الهرمنيوطيقي الجديد. إنَّ النقطة التي يلتفت إليها مجتهد شبستري، هي أنَّ الأسلوب التقليدي والفقه التراثي، يقوم على أسس فلسفيّة وكلاميّة وإنسانيّة؛ وإنَّ لازم تلك المباني هو هذا النوع مِن الاجتهاد، ولا يمكن القبول بالقيم الحديثة في ضوء تلك المباني. ومِن هنا، فإنّه يعلنها صراحة ويقول: يجب الاجتهاد في تلك المباني الأنثروبولوجيّة والفلسفيّة والكلاميّة، والعمل على تغييرها.
ماهيّة وضرورة الوحي مِن وجهة نظر محمّد مجتهد شبستري
لقد تمّ تعريف الوحي مِن قبل محمّد مجتهد شبستري بتعابير مختلفة، إذ قال في موضع: إنَّ الوحي عبارة عن تكلّم الله مع النبيّ. وقال في موضع آخر: إنَّ
الوحي عبارة عن تمكين النبيّ مِن الكلام. وعمد في موضع آخر إلى تفسير الوحي بمقولة التأثير وفتح الآفاق؛ بمعنى أنَّه يرى أنَّ الوحي هو «كلام الله» الذي مِن شأنه أنْ «يترك أثرًا لدى السامع».
والذي يبدو للعيان، هو أنَّ مجتهد شبستري قد افترض أنَّ دائرة الوحي واسعة جدًا؛ ويعمل على بيان النسيج لتحقّق هذا النوع مِن الوحي في إطار التجارب الشخصيّة للنبيّ، وكذلك فإنَّه يبحث عن منشأ تحقّق هذه التجربة في شخصيّة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وصلب الحقائق الاجتماعيّة والثقافيّة التي كانت تسود الحجاز في عصره. وقال في هذا الشأن:
«حيث يُنسب نصّ القرآن ـ مِن الناحية التاريخيّة ـ إلى نبيّ الإسلام، فإنَّ الذي كتبوه هو أقوال النبيّ نفسه؛ وهي الكتابات التي تعكس التجارب الشخصيّة لذلك النبيّ».
ومع ذلك يذهب مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ النبيّ الأكرم كان يطلب مِن مخاطبيه أنْ يعتبروا منشأ هذا الكتاب هو الله:
«إنَّ النبيّ عندما كان يقرأ نصًا، ويطلب مِن مخاطبيه أنْ ينسبوا ما يسمعونه منه بوصفه نصًّا نازلًا مِن عند الله، وأنْ يفهموه على هذا الأساس؛ كان يقرأ عبارات مترابطة كانت في ضوء تجربته وفهمه ترتبط بالغيب على نحو مِن الأنحاء ... وفي الحقيقة، فإنَّ
القرآن الكريم بالنسبة إلى المسلمين نصّ مرتبط بالله؛ بمعنى أنَّ نبيّ الإسلام قد فهمه مع الله».
يذهب مجتهد شبستري إلى الاعتقاد بضرورة التوجّه إلى القرآن الكريم بمثل هذا الأفق:
«إنَّ الاعتقاد القائل بأنَّ ألفاظ القرآن ومعانيه قد نزلت على النبيّ وحيًا مِن عند الله مباشرة أو بواسطة الملك، لا يزول ويرتفع فحسب، بل ويصبح ـ بالنظرة التجريبيّة إلى اللغة ـ غير قابل للدفاع أيضًا».
إنَّ النقطة المهمّة في البين، هي أنَّ الغموض يكتنف مجمل آراء مجتهد شبستري بشأن الوحي؛ فلم يتبيّن مِن كلامه بوضوح ما إذا كان الوحي هو كلام الله أو كلام النبيّ؟ وما هي النسبة بين هذين الاثنين؟ إنَّ مجتهد شبستري الذي يعتقد أنَّ النبيّ في ضوء تجربته وفهمه، كان يعتبر القرآن مرتبطًا بالغيب؛ يواجه الأسئلة الآتية: هل كانت هذه التجربة وهذا الفهم مِن قبل النبيّ صادقًا أم كان كاذبًا؟ وهل كان النبيّ ينسب آيات القرآن إلى الله عن كذب أو خطأ في الفهم، ويطلب مِن مخاطبيه أنْ يعتبروا ما يسمعونه منه على أنه مِن عند الله؟ أوكان النبيّ صادقًا في تجربته وفي فهمه، وعندها لا يكون هذا النصّ كلامه، بل هو كلام الله؟ وفي الأساس لماذا يجب على النبيّ أنْ ينسب النصّ الذي قرأه إلى الله؟ هل كان في ذلك بصدد خداع المخاطبين، حيث
ينسب كلامه إلى الله؟ وفي مثل هذه الحالة هل يمكن لمثل هذا الشخص أنْ يكون نبيًّا حقًّا؟
إنَّ هذه الأسئلة ونظائرها تشير إلى أنَّ إثبات وحيانيّة محتوى خطاب الأنبياء، يمثّل الركن الرئيس للأدلّة في إثبات ضرورة النبوّة، وإنَّ منشأ هذا النوع مِن المواجهة مع مسألة ارتباط النبوّة مع الوحي يمكن ملاحظته في الآيات القرآنيّة أيضًا. ومِن ذلك ـ على سبيل المثال ـ ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾..
وكذلك، فإنَّ القرآن الكريم ـ خلافًا لرؤية محمّد مجتهد شبستري ـ يحتوي على الكثير مِن الآيات التي تقول بأنَّ منشأ الوحي هو الله سبحانه وتعالى، وأنَّ ألفاظ القرآن وكلماته مِن عند الله أيضًا. ومِن ذلك نذكر الآيات أدناه على سبيل المثال دون الحصر:
ـ ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾.
ـ ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾.
ـ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.
ولذلك، كيف يمكن القول بأنَّ مدّعي النبوّة كان في بيان التجربة النبويّة التي تعرض له صادقًا في كلامه، ولكنَّه في بيان هذا المطلب، وهو أنَّ محتوى تجربته الذي هو الوحي أو كلام الله؛ لم يكن صادقًا؟!
كما أنَّ تأثير الكلام على المخاطب، لا يثبت بالضرورة أنَّ قائل الكلام هو الله حتمًا؛ فهناك الكثير مِن كلمات العرفاء والشعراء الكبار التي تركت بدورها التأثير المنشود لمجتهد شبستري، بل وربَّما كانت تلك الكلمات في بعض الموارد شديدة الوقع والتأثير أيضًا، وكذلك إذا اعتبرنا إيجاد الحيرة والذهول ملاكًا لوحيانيّة وإلهيّة الكلام، فإنَّ بعض آيات القرآن الكريم ـ مِن قبيل: آيات الأحكام أو القصص التاريخي ـ لا تثير مثل تلك الحيرة أو ذلك الذهول، فيجب ـ مِن وجهة نظر مجتهد شبستري ـ أنْ لا نعدّها مِن الوحي وكلام الله سبحانه وتعالى.
يلجأ محمّد مجتهد شبستري في مواجهة النظريّات والمفاهيم السياسيّة الجديدة ـ مِن قبيل: المداراة، والجمهوريّة، والديمقراطيّة، والشورى، والعدالة، والفقه السياسي، والحقوق الأساسيّة، وما إلى ذلك ـ في ضوء إعادة قراءة التراث
الإسلامي، إلى الاستفادة مِن مصطلح يشير إلى منهجه في التعاطي مع هذا النوع مِن المفاهيم؛ فهو يعتقد أنَّ تسلّل العلوم الإنسانيّة إلى البلدان الإسلاميّة ـ التي كانت تعاني مِن هاجس «الفهم» ـ قد خلق أرضيّة للمطالبة بالمفاهيم السياسيّة والاجتماعيّة الحديثة. ومِن ناحية أخرى، فإنَّ أسلمة الأفكار والمفاهيم الحديثة، قد خلقت ـ بسبب الحاجة إلى «التطابق مع الشريعة غير المستصلحة» ـ أرضيّة لحدوث الاختلال الجاد في المجتمعات الإسلاميّة. في حين يجب على المتشرّعين أنْ يتّجهوا بحكم الضرورة التاريخيّة إلى إصلاح الشريعة، وأنْ يعملوا على تنظيم مؤسّساتهم الاجتماعيّة بما يتطابق مع لوازم المفاهيم والمؤسّسات الحديثة التي يتمّ العمل في العصر الراهن على إدارة المجتمعات بوساطتها.
إنَّ تفشّي الظلم في الكثير مِن بقاع العالم في المرحلة المعاصرة، قد خلق ـ مِن وجهة نظر مجتهد شبستري ـ أرضيّة صلبة للمطالبة بتحقيق العدالة. ومِن هنا، يتعيّن على المسلمين بدورهم أنْ يقدّموا تفسيرهم لمفهوم العدالة أيضًا. وقد رأى شبستري إمكانيّة تبويب تعاريف العدالة ـ مِن خلال خصّيصتين ـ إلى طائفتين رئيستين؛ فهناك مَنْ يرى أنَّ للعدالة طبيعة، وأنَّ علينا أنْ نكتشف
تلك الطبيعة. إنَّ للعدالة ـ بغضّ النظر عن توافقاتنا وعقودنا حول ما نراه عادلًا وما نراه ظالمًا ـ حقيقة وطبيعة، ويجب علينا أنْ نتعرّف على تلك الحقيقة والطبيعة. بيد أنَّ هناك عددًا مِن الفلاسفة لهم كلام آخر؛ إذ إنَّهم يسألون الطبيعيين: أنتم تقولون على سبيل المثال: إنَّ طبيعة العدالة هي أنْ يُعطى لكلّ ذي حقّ حقّه الطبيعي. ولنا أنْ نسألكم: مَنْ هو الذي يحدّد ما هو حقّ كلّ ذي حقٍّ؟ وفي الأساس، ما الذي يعنيه حقّ كلّ ذي حقٍّ، بمعنى الحقّ الطبيعي؟ تقول هذه الجماعة: حيث أنَّ العدالة الطبيعيّة ليس لها معنى واضح، فإنّنا نقول كلامًا آخر، وهو: إنَّ معنى العدالة، هو ذلك الشيء الذي يتّفق عليه الناس في حياتهم الاجتماعيّة والسياسيّة بشكل تقريبي وعلى نحو الإجمال. إنَّ العدالة تكتسب معناها ومفهومها مِن خلال التقابل والتقاطع بين مصالح الناس فيما بينهم، والتوافق الذي يحصلون عليه في هذا المعترك. وإنَّ المصالح المشتركة للناس، تنشأ بدورها مِن احتياجاتهم أيضًا. وهكذا تتبلور العدالة، وتكتسب مفهومها ومعناها في جميع الشؤون والعلاقات الاجتماعيّة الأعمّ مِن السياسيّة وغير السياسيّة.
وقد أشار مجتهد شبستري ـ ضمن نقده لهذين الرأيين أعلاه فيما يخصّ معنى ومفهوم العدالة ـ إلى نظريّة ثالثة، وهي النظريّة التي تقول: إنَّ العدالة لا هذا ولا ذاك؛ إنَّ العدالة ليس لها هويّة وليس لها طبيعة يمكن اكتشافها، ولا يمكن فهمها مِن خلال الاتفاقات الناشئة مِن ضغط الاحتياجات والرغبات والمصالح. إنَّ العدالة في ماهيتها «أمر أخلاقي» يعمل الناس على تعريفها بأنفسهم، ولكنْ لا على أساس مِن مقتضى احتياجاتهم ورغباتهم، وإنَّما على
(69)أساس مِن إدراكهم وشعورهم بضرورة الأخلاق في الحياة الاجتماعيّة، ومِن خلال الحوار الحرّ. إنَّ العدالة التي ورد الحديث عنها في القرآن الكريم، هي دعوة الناس إلى «عدالة العصر» في إطار «لغة التوصية الأخلاقيّة»، وهي «التوصية التي تقوم على منطق رواية وحكاية هذا النصّ». يذهب مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ القرآن الكريم لم يقدّم تعريفًا للعدالة، وإنَّما اعتبرها بوصفها أمرًا أخلاقيًّا، وقد أوصى القرآن بالتبعيّة لتلك العدالة التي يعتبرها الناس عدالة. وبما أنَّ وجدان الناس وشعورهم وفهمهم للعدالة على الدوام، عُرضة للتحوّلات والمتغيّرات الثقافيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة، ولا يمكن الحصول على محتوى ثابت ودائم وأبدي لفهم العدالة؛ لذلك فإنَّ تفسير وشرح العدالة والمؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة العادلة، والحكم العادل في كلّ عصر، يجب أنْ يكون ناظرًا إلى الأحكام الأخلاقيّة العامّة في ذلك العصر.
يدّعي مجتهد شبستري قائلًا:
«إنَّ المطالبة بحقوق الإنسان أضحت ضرورة تاريخيّة بالنسبة إلى المسلمين؛ إنَّ المطالبة بالحريّة والمساواة لجميع الناس، تمثّل اللبّ اللباب في حقوق الإنسان».
وقد ذهب ـ في ضوء إعادته لقراءة الثقافة الإسلاميّة، ولا سيّما في عصر النزول ـ إلى الاعتقاد والقول:
«لقد كانت سطوة الدين وسطوة الرجل وسطوة الحاكم، هي الخصائص الثلاثة التي تميّز الثقافة الإسلاميّة في عصر النزول».
ويرى قائلًا:
«في ظلّ هذا المجتمع، لا يمكن الحديث بتاتًا عن حقوق للأفراد على غرار ما نراه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقال مجتهد شبستري أيضًا:
«نحن لا نجد في الكتاب والسنّة، أو لاحقًا في النظريّات الحقوقيّة للحقوقيين مِن المسلمين، نصوصًا تهدف إلى إحداث تغيير جذري لهذه العناصر الثلاثة وهذه الروابط الاجتماعيّة الثلاثة».
«وغاية ما هو موجود في هذه المصادر، هو تظهير سلسلة مِن الأهداف الأخلاقيّة، داخل ذات تلك الأبنية لغرض أنسنتها».
وقد ادّعى مجتهد شبستري لتبرير ضرورة إحداث التحوّلات والتغييرات في مواجهة الحقوق الإنسانيّة، قائلًا:
«إنَّ الادّعاء القائل بأنَّ الأنبياء إنّما جاؤوا وقاموا بإيجاد سلسة مِن التغييرات في المجتمعات المرتبطة بأساس بنيتهم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، ثمّ أعلنوا أنَّ هذه الأبنية التي قمنا بتعيينها هي الأبنية المثاليّة للإنسانيّة، ولن يكون هناك ما هو أفضل منها، ويجب اتّباعها إلى الأبد، غير مقبول، بل «إنَّ هذا الادعاء لا يستند إلى أيّ دليل، كما أنَّه مرفوض مِن الناحية التاريخيّة».
ثم ادّعى بعد ذلك قائلًا:
«لا بدّ مِن الإقرار بأنَّ أسلوب الحكومة الديمقراطيّة الذي اكتشفته البشريّة وتوصّلت إليه، واستحقّ أنَّ يعيش على هذه الشاكلة التي هي مغايرة للسلطة الذكوريّة والدينيّة وسلطة الحاكم، وهي أكثر تناغمًا مع الكمال الإنساني، وإنَّ هذا الأسلوب يساعد على ازدهار إنسانيّة الإنسان في الحياة الاجتماعيّة، وباختصار: يجعلها أكثر إنسانيّة».
إنَّ الذي كان وما يزال سائدًا بين جميع المسلمين، قديمًا وحديثًا وإلى هذه اللحظة؛ هو أنَّ القرآن الكريم بألفاظه ومضامينه قد نزل مِن عند الله على النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، وأنَّ النبيّ الأكرم بدوره، قد نقل ما نزل عليه مِن الله إلى الناس بعينه دون زيادة ولا نقصان. وبعبارة أخرى: إنَّ اعتقاد المسلمين قاطبة يقوم على أنَّ القرآن الكريم هو كلام الله، وأنَّ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله قد تلقّى هذا
الكلام مِن طريق الوحي. وبطبيعة الحال، فإنَّ المفكِّرين المسلمين ـ الأعمّ مِن العرفاء والفلاسفة والمتكلّمين ـ قام كلُّ واحد منهم ببيان وتفسير كيفيّة الوحي بشكل وآخر، ولكنْ لا أحد منهم شكّك أو ترديد في اعتبار القرآن الكريم هو كلام الله. وقد عمد مجتهد شبستري ـ مِن خلال اتّخاذه إطارًا نظريًّا مختلفًا عمّا كان يؤخذ في البيئة الإسلاميّة للتعاطي مع الوحي وماهيته ـ إلى إبداء آراء غير متعارفة عن هذه المسألة.
إنَّ مجتهد شبستري، مع علمه بهذه الآراء التي صدع بها الحكماء والمتكلّمون حول موضوع الوحي، يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ التحوّلات الاجتماعيّة والسياسيّة الجديدة تقتضي إعادة النظر في هذه المباني. وقد كتب في هذا الشأن قائلًا:
«إنَّ التحوّلات الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة الجديدة في العالم الإسلامي، التي نشأت مِن العصر الجديد، أدّت إلى ظهور مسألة كلاميّة تقول: ما هي النسبة والعلاقة التي يمكن أنْ تكون لهذه التحوّلات الجديدة مع الوحي الإسلامي؟».
إنَّ مجتهد شبستري في الاستنتاج الذي يستخلصه مِن اعتبار الوحي تجربة دينيّة، لا يرى التديُّن في الاعتقاد والإيمان بأصول العقائد، مِن قبيل: التوحيد، والنبوّة، والمعاد، والعدل، والإمامة. وقال في هذا الشأن:
«إنَّ القرآن الكريم لم يأت بمعنى مجموعة مِن القضايا الملقاة بواسطة الوحي لكي يؤمن بها الإنسان. لقد شاع في مجتمعنا ـ للأسف الشديد ـ أنَّ التديّن عبارة عن الإيمان ببعض الأصول الاعتقاديّة؛
فلو قال شخص: إنّي مؤمن بالتوحيد، ومؤمن بالعدل، ومؤمن بالنبوّة، ومؤمن بالإمامة، ومؤمن بالمعاد، كان ذلك الشخص إنسانًا متديّنًا. بيد أنَّ واقع الأمر ليس كذلك. فإنَّ الشخص المتديّن مِن وجهة نظر القرآن هو المؤمن، والشخص المؤمن هو الذي يمتلك هذه المعارف على أساس تلك التجارب الإيمانيّة».
وفي الحقيقة، فإنَّ محمّد مجتهد شبستري، يرى أنَّ المتديّن والمؤمن هو الشخص الذي يمتلك تجربة دينيّة، وليس الشخص الذي يؤمن بأصول اعتقاديّة، والذي يتمسّك بالأحكام والآداب الشرعيّة. وقال في هذا الشأن:
«إنَّ القرآن قد عرّف نفسه بوصفه وحيًا وآيات، وأنا أروم الاستفادة مِن هذين التعريفين؛ فإنَّ الوحي يعني الإشارة السريعة والخفيّة. إنَّ القرآن يقول: إنَّ هذا الكتاب عبارة عن إشارات الله السريعة والخفيّة. كما ويقول القرآن أيضًا: إنَّ هذا القرآن عبارة عن آيات؛ بمعنى أنَّه علامات ودلائل لله ... إنَّ التديّن الإسلامي مِن وجهة نظر القرآن هو أنْ يؤمن المخاطبون بهذه الإشارات والعلامات في ذات ماهيّة الإشارة والعلامات، وأنْ يذعنوا للإشارات والعلامات، لا أنْ يذعنوا للقضايا الفلسفيّة»
إنَّ مراد شبستري مِن هذه العبارات، هو أنَّ المتديِّن ليس هو الشخص، الذي يؤمن بمجموعة مِن المفاهيم والتعاليم الفلسفيّة، ويكون بصدد إثبات وجود الله وصفاته وكيفيّات أفعاله، ويكون مؤمنًا بيوم القيامة والنبوّة،
ويكون متعبّدًا ومذعنًا لأوامر الله مِن أجل التقرّب منه والاتصال به وما إلى ذلك. والسؤال الذي يرد هنا، هو أنَّ الإيمان إذا كان يعني تجارب الإنسان الناتجة مِن حضوره أمام ساحة الألوهيّة، فما هو مصير الأحكام والشريعة والتعاليم التي جاء بها النبيّ الأكرم وأبلغها إلى أتباعه؟
في البداية، لا بدّ مِن التذكير مجدّدًا بأنَّ الدين ـ مِن وجهة نظر شبستري ـ ولا سيّما الدين الإسلامي، يشتمل على ثلاثة أبعاد ومساحات، وهي: مساحة الأعمال والشعائر، ومساحة الاعتقادات، ومساحة التجربة النبويّة. وقد عمد شبستري إلى بيان العلاقة بين هذه الأبعاد والمساحات على النحو الآتي:
«إنَّ تلك التجربة التي تحدث بشكل خفي بالكامل، وتحصل للشخص مِن دون حدّ على شكل واقعيّة بحتة، تصبح على مستوى المعرفة بالنسبة إلى الإنسان مفهومة ومعقولة. وإن السطح الأوّل مِن هذه الدائرة الذي هو سطح الأعمال والشعائر، يستند إلى هذه النواة الأصليّة، ولولا وجود تلك التجارب، فإنَّ هذه الأعمال والشعائر سوف تكون مجرّد سلسلة مِن العادات العرفيّة والاجتماعيّة والثقافيّة لا أكثر».
ثم تحدّث مجتهد شبستري حول القرآن والشعائر الإسلاميّة، قائلًا:
«إنَّ النواة الأصليّة للدين، حتّى في هذا الكتاب عبارة عن ذات تلك التجارب، وإذا تمّ الحديث عن تلك المعارف، فقد تمّ الحديث عنها بوصفها تفسيرًا لتلك التجارب، وإذا ورد الحديث عن الأعمال
والشعائر، كان الحديث كذلك عن هذه الأعمال والشعائر بوصفها سلوكيّات إنسانيّة تستند في الأصل إلى تلك التجربة».
ولتوضيح رأي مجتهد شبستري وفهم مراده مِن القول بأنَّ الدين يشتمل على ثلاثة أبعاد ومساحات، وأنَّ مساحته المركزيّة هي مساحته المحوريّة؛ لا بدّ هنا مِن الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنَّه مِن بين هذه الأصول الاعتقاديّة، يبدي اهتمامه بالتوحيد، ويلتفت إلى هذه النقطة؛ وهي أنَّ التوحيد ليس بالمعنى الذي يقوله المتألّهون والعرفاء والحكماء، الذي هو عبارة عن الاعتقاد وإثبات الموجود الواحد والقادر وما إلى ذلك؛ بل إنَّ التوحيد أوّلًا: يعني أنْ يمتلك الشخص سلوكًا توحيديًّا، وثانيًا: يعني السعي مِن أجل إقامة المجتمع التوحيدي. وفيما يتعلّق بالقسم الأوّل؛ وهو أنَّ التوحيد يعني امتلاك السلوك التوحيدي، يقول مجتهد شبستري:
«إنَّ علم وتجربة السلوك المعنوي، هو علم وتجربة التوحيد. إنَّ التوحيد يعني السلوك النظري والعملي مِن أجل التغلّب على الألم الناشئ مِن الحُجُب الأصليّة الأربعة للكينونة في العالم؛ وهي: حجاب التاريخ، وحجاب اللغة، وحجاب المجتمع، وحجاب الجسد، والحجب الأخرى الموجودة بناء على تجارب العرفاء. وقد ورد التعبير عن هذه الحجب بالسجن أيضًا»
بالنظر إلى هذه العبارة لمجتهد شبستري، يتبادر إلى الذهن أنَّ التوحيد أو المجتمع التوحيدي، ليس هو المجتمع الذي يسعى مِن أجل تطبيق الشريعة
الإسلاميّة على نحو ما كان عليه الأمر في صدر الإسلام؛ بل إنَّ المجتمع التوحيدي هو المجتمع الذي يعيش ـ مع امتلاكه للتجربة الدينيّة ـ بحيث يتجرّد عن حجب وجبر التاريخ واللغة والمجتمع والجسد. ولكي نوضّح رأي مجتهد شبستري، لا بدّ مِن الإشارة إلى بعض الأمور.
يذهب مجتهد شبستري ـ في ضوء تفسيره للتوحيد بأنَّه تجربة دينيّة، والخروج مِن الحُجُب الأربعة ـ إلى الاعتقاد بأنَّ النبيّ في رسالته كان يحظى بأربع خصائص، حيث يمكن لنا بوصفنا أتباعه أنْ نعمل في هذه المرحلة ـ مِن خلال الاستناد إلى تلك الخصائص ضمن الحفاظ على المستوى الداخلي مِن الدين الذي هو ذات التجربة الدينيّة ـ على بيان سطوح أخرى مِن الدين، مِن قبيل: السطح الاعتقادي والشعائر بوساطة العلوم والمعارف المعاصرة. يرى شبستري أنَّ خطاب النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله يحتوي على أربع خصائص، وهي: العقلانيّة، والعدالة، والواقعيّة، والدعوة إلى الرحمة في قبال الدعوة إلى العنف. إنَّ التوحيد ـ مِن وجهة نظر مجتهد شبستري ـ يمثّل أساس دعوة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، وإنَّ هذا التوحيد كان منسجمًا مع العقل في عصر النبيّ، وحيث كان هذا الانسجام موجودًا، فقد أدّى هذا الأمر إلى أنْ يحظى هذا التوحيد بقبول الناس في ذلك العصر. وبطبيعة الحال، فإنَّ مجتهد شبستري يصرّح بهذه النقطة، وهي أنَّ مراده مِن عقلانيّة العقل الذي كان شائعًا في ذلك العصر؛ أي العقل الذي كان يحظى باهتمام الناس في تلك الأزمنة:
«إنَّ أهمّ دعوة للنبيّ هي دعوته إلى التوحيد ونفي وجود الشريك لله. لقد كان الشرك قبل دعوة النبيّ هو الغالب في الحجاز. إنَّ
(77)توحيد النبيّ كان مقولة يستحسنها عقل ذلك العصر. فقد كان عقل ذلك العصر يرى هذا النوع مِن التوحيد مقبولًا، وإنَّ تأكيدي على عقل ذلك العصر، يأتي مِن أنّنا على طول التاريخ نواجه عقولًا وعقلانيّات متفاوتة ومتناسبة مع عصورها».
في ضوء هذه العبارة لمجتهد شبستري، نحن لا نمتلك حقائق وأصولًا عقلانيّة ثابتة على طول التاريخ؛ بحيث يمكن أنْ تكون ملاكًا ومعيارًا لتمييز الحقّ مِن الباطل، أو الصحيح مِن الكذب. فهو يرى أنَّ هناك خطابات وعقلانيّات مختلفة، وأنَّها تحظى بالقبول في شرائطها الزمانيّة والمكانيّة. وإنَّ التوحيد وما قال النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله في مورد التوحيد، كان منسجمًا ومتناغمًا مع علانيّة ذلك العصر مِن عصور الحجاز. وبطبيعة الحال، فإنَّ مجتهد شبستري لا یشیر إلى هذه النقطة، وهي لماذا لم يقم أصحاب العلم والعقل مِن اليهود والمسيحيين وكبار قريش مِن الذين عاصروا النبيّ في تلك المرحلة الزمنيّة؛ بأخذ هذه الرؤية التوحيديّة مِن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، بل وقد حاربوه حتّى اللحظة الأخيرة، ولم يعتنقوا بالإسلام إلّا بعد أنْ خسروا الحرب مرغمين. وبطبيعة الحال، فإنَّ كاتب هذه المقالة، سوف يعمل على نقد ومناقشة رؤية مجتهد شبستري في السطور القادمة. وأمّا ما نقله مجتهد شبستري عن هذه الخصّيصة مِن خطاب النبيّ، فيعود سببه إلى أنّنا في المرحلة المعاصرة، حينما نتحدّث عن الإسلام وعن التوحيد، يجب أنْ يكون ما نقوله بدوره منسجمًا مع العقلانيّة الشائعة والسائدة والمقبولة في هذا العصر أيضًا؛ وإلّا فإنَّ التوحيد لو
لم يكن منسجمًا مع العقلانيّة المعاصرة، لما أمكن الحديث عن الدين في المرحلة الجديدة. وقد كتب في ذلك صراحة:
«وعليه، فإنَّ النبيّ الأكرم كان يدعو إلى الإعراض عن الجهل المتفشّي في عصره، ويدعو إلى الإقبال على العقل الموجود في عصره. نستنتج مِن هذا الأمر أنَّ الخطاب الديني لعصرنا ومجتمعنا، يجب أنْ لا يتنافى مع العقل المعاصر، وإلّا سوف تكون الخصّيصة المهمّة في الخطاب مخدوشة. لا نستطيع القول بأنّنا نقول ما يقوله الدين، سواء أكان متناغمًا مع عقل العصر أو لم يكن متناغمًا معه؛ فإنَّ هذا خطأ كبير».
طبقًا لما ذكره مجتهد شبستري، فإنَّ الأنبياء جاؤوا لكي يعملوا على تطوير العقل في عصرهم، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا العقل المعاصر قد استفاد مِن المباني الأنثروبولوجيّة والأنطولوجيّة المختلفة. هذا في حين أنَّ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وغيره مِن الأنبياء، كانوا على الدوام يحاربون ما كان يعتبره أبناء عصرهم مِن الأمور العقلانيّة، وكانوا يجابهون العقلانيّة التي ينكرون الوحي والنبوّة على أساسها. كما ورد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ*أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾.
إنَّ المشركين والكافرين ـ في ضوء هذه الآيات ـ قد استدلّوا على أساس مبانيهم الحسيّة والماديّة بهذه النقطة التجريبيّة، وهي: حيث كان نبيّ الإسلام شخصًا مثلهم، وأنَّ العالم بدوره عالم محسوس، فإنَّ ما كان يقوله النبيّ، لم يكن ينسجم مع مبانيهم العقليّة، ولا يمكن أنْ يكون له وجود وتحقّق خارجي. وفي الحقيقة، فإنَّ الإنسان مِن وجهة نظرهم، هو هذا الكائن الحيواني الذي ليس له حظّ مِن هذه الدنيا سوى المأكل والمشرب، ولا يحظى بأيّ بُعد آخر ممّا يقوله الأنبياء ويدعونهم إليه. إنَّ هذه الآيات تخالف ما ذكره محمّد مجتهد شبستري ـ مِن أنَّ التوحيد الذي جاء به النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله كان منسجمًا مع العقل الشائع في عصره ـ تمام الاختلاف.
أمّا الخصيصة الثانية التي كان يراها محمّد مجتهد شبستري للنبي الأكرم صلىاللهعليهوآله، فهي عدالته. وقد فسّر عدالة النبيّ الأكرم على النحو الآتي:
«لقد كان للعدالة في ذلك العصر تعريف محدّد، وكانت له بعض المصاديق. فحيث تكون مصاديق العدالة واضحة، كان النبيّ يؤكّد على مراعاة تلك المصاديق، وحيث تكون مصاديق الظلم واضحة، كان النبيّ يأمر باجتنابها. إنَّ النبيّ في هذه الشؤون لم يأتِ أبدًا بمسائل لا يمكن للناس إدراكها. لقد كانت غايته هي العدول عن الظلم في عصره إلى العدل في عصره، وكان الناس يعرفون ما هو الظلم وما هو العدل في عصرهم».
في ضوء هذه العبارة، لا يتمّ تشريع مصاديق الظلم والعدل مِن ناحية الله
والنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، بل إنَّ النبيّ ينظر إلى ما يعتبره الناس ظلمًا أو عدلًا، ويقوم بإمضائه وتأييده وتقريره.
وعلى أساس هذا الرأي، لا يرى مجتهد شبستري ثباتًا لما نراه يحظى بالثبات بوصفه مِن الأحكام والتعاليم الثابتة، بل يمكن لهذه الأحكام والتعاليم أنْ تتغيّر بحسب تغيّر الشرائط الزمانيّة والمكانيّة. مِن ذلك ـ على سبيل المثال ـ إذا كان الله قد أمر برجم الزانيات المحصّنات في عصر النبيّ، كان هذا النوع مِن الأحكام في ذلك العصر مصداقًا للعدل. وأمّا في المرحلة الجديدة، فحيث يكون الرجم مخالفًا لحقوق الإنسان؛ فإنَّه سيكون مصداقًا للظلم، ولا يمكن ولا ينبغي القيام بهذا النوع مِن التعاليم؛ في حين أنَّ هذا الحكم طبقًا لفقه الشيعة ـ القائم على أساس الحسن والقبح الذاتي للأفعال ـ يحظى بالحسن الذاتي مِن أجل سعادة وبقاء نوع البشر، وعليه يجب العمل بهذه الأحكام حتّى في العصر الحاضر. وأمّا مِن وجهة نظر مجتهد شبستري، فحيث تكون الأحكام والتعاليم الإسلاميّة، هي الاعتبارات ذاتها التي كان النبيّ قد أخذها مِن مجتمع عصره؛ فإنَّه لا يمكن تطبيقها على المجتمعات المعاصرة والشرائط والظروف الراهنة.
إنَّ الخصّيصة الثالثة التي يذكرها مجتهد شبستري للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، هي واقعيّته. فهو يرى أنَّ النبيّ الأكرم كان ملتفتًا لواقعيّات عصره، وكان يعمل على تطبيق نفسه على أساس تلك الشرائط. ولو سألنا مجتهد شبستري: ما هو مراده مِن الواقعيّة؟ فإنَّه قد أجاب عن ذلك بقوله:
«لقد تمثّل العمل الواقعي بأنْ قبل النبيّ ـ لتقوية وتعزيز دعوته ـ بمقترح تأسيس الدولة، وإقامة دينه بهذه الطريقة. وقد تحقّق فصل الدين عن
(81)الدولة بعد الكثير مِن التحوّلات الثقافيّة والاجتماعيّة وظهور المجتمع والدولة. وبطبيعة الحال، فإنَّ الواقعيّة المعاصرة تستوجب الفصل بين هذين الأمرين. وأمّا في عصر النبيّ الأكرم، فقد كانت الواقعيّة تتمثّل في إقامة الحكم. لقد كانت واقعيّة النبيّ الأكرم تقتضي أنْ ينظر إلى الإنسان في تشريعاته بوصفه كائنًا جامعًا يمتلك أبعادًا جسمانيّة وأبعادًا روحيّة، وهو بالإضافة إلى كونه كائنًا فرديًا، فإنَّه بالإضافة إلى ذلك كائن اجتماعي أيضًا. وبذلك فقد تمّ الاعتراف في تشريعات النبيّ بالأغراض والغرائز الإنسانيّة، وتمّ تحريم الرهبانيّة وترك الدنيا. وتمّ المنع مِن خوض الحروب واللجوء إلى استخدام العنف، إلّا في بعض الموارد الاستثنائيّة، وتمّ النهي عن جميع أنوع الإفراط والتفريط».
وعليه، فإنَّ الأحكام والتعاليم التي جاء بها النبيّ الأكرم، تصبح ـ في ضوء هذه القراءة الشبستريّة ـ متطابقة مع الأحكام والتعاليم والأعراف الاجتماعيّة؛ إذ كان الناس في عصر النبيّ يعيشون في ذلك الفضاء. إنَّ مشكلة مجتهد شبستري تكمن في أنَّه لا يريد أنْ يقبل بأنَّ هذه الأحكام بعينها قد نزلت على النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله مِن ناحية الله سبحانه وتعالى على أساس مِن المصلحة الذاتيّة لنوع البشر. في ضوء رؤية مجتهد شبستري، لو أنَّ النبيّ الأكرم بعث إلى الحياة مِن جديد، فإنّه سيعمل على إلغاء جميع أحكامه الشرعيّة، ويقرّ بدلًا منها جميع الأحكام الحقوقيّة والاجتماعيّة للعالم المعاصر بسبب واقعيّته؛ وذلك لأنَّ الأحكام الشرعيّة مِن وجهة نظر مجتهد شبستري مِن الاعتباريّات البشريّة، ولا تتمتّع بأيّ حقيقة.
الخصّيصة الأخرى التي يذكرها محمّد مجتهد شبستري للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، هي الدعوة إلى الرحمة والابتعاد عن العنف. وقد عمد شبستري في توضيح هذه الخصّيصة إلى التمسّك بمثال القصاص في فقه الشيعة، حيث قال:
«إنَّ الخصّيصة الرابعة في هذا الخطاب، هي الدعوة إلى الرحمة في قبال اللجوء إلى العنف والانتقام. مِن ذلك ـ على سبيل المثال ـ يمكن أنْ نستشهد هنا بقانون القصاص الذي يبدو مِن وجهة نظر البعض مثالًا على تشريع العنف في الإسلام، في حين أنَّ الواقع غير ذلك، فإنَّ هذا القانون كان في عصر النبيّ الأكرم نموذجًا في الرحمة والابتعاد عن العنف. فقد تمّ تشريع القصاص في القرآن الكريم مِن أجل كبح جماح الانتقام المفرط الذي كان شائعًا في ذلك المجتمع. ففي ذلك المجتمع، كان إذا قتل شخص مِن أفراد قبيلة ما، تبادر قبيلة القتيل إلى الثأر له بقتل عشرات الأشخاص مِن أفراد قبيلة القاتل. فجاء القرآن وقال لهم: إذا كنتم تريدون القصاص، فلا يحقّ لكم غير قتل شخص واحد فقط، على أنْ يكون ذلك الشخص هو خصوص القاتل، وعدم التعدّي إلى غيره. ثمّ استطرد القرآن الكريم بعد ذلك يقول في هذه الآية ذاتها: ولكنّكم إنْ عفوتم عن القاتل ولم تقتلوه، فسوف يكون ذلك أفضل بكثير مِن قتله؛ بمعنى أنَّ هناك شيئًا أفضل مِن العدل أيضًا، وهو العفو والرحمة ... إنَّ منطق هذا الخطاب، ليس هو منطق الانتقام والعنف، وإنمّا هو بالإضافة إلى مراعاة العدالة يدعو إلى الرحمة أيضًا. وعليه، ففي الخطاب الديني المعاصر يجب أنْ لا يحضر مقتضى العدل فحسب، بل ويجب أنْ
(83)يكون مقتضى الرحمة في هذا العصر حاضرًا أيضًا؛ بمعنى أنْ يتمّ أخذ العواطف البشريّة المتحوّلة في هذا العصر بنظر الاعتبار أيضًا».
وهنا يمكن أنْ نسأل عن مراد مجتهد شبستري مِن مقتضى الرحمة في العصر الجديد. وبالنظر إلى ما قيل، يمكن فهم الجواب على النحو الآتي: إنَّ مقتضى الرحمة المعاصرة، هو أنَّه لو صدرت معصية أو جريمة مِن شخص، كما لو صدرت عنه جريمة اجتماعيّة، مِن قبيل: قتل النفس وما إلى ذلك، لا يمكن القصاص مِن القاتل؛ وذلك لأنَّ العرف البشري في العصر الجديد، يرى في هذا القصاص عنفًا وقسوة، وعلى هذا الأساس يجب اجتناب القصاص.
إلى هنا، يكون محمّد مجتهد شبستري قد عمل على بيان عدد مِن القضايا مِن أجل إيجاد التماهي والتناغم بين الأحكام والمؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة الجديدة مع وحي الإسلام. فأوّلًا: إنَّ الوحي يعني التجربة الدينيّة للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله. وثانيًا: إنَّ التوحيد يعني امتلاك السلوك التوحيدي؛ بمعنى أنْ يعيش الشخص الموحّد بشكل يتجرّد فيه مِن أطر حجُب اللغة والجسد والتاريخ والمجتمع. وثالثًا: إنَّ خطاب النبيّ هو الواقعيّة والعدالة والعقلائيّة والدعوة إلى الرحمة.
والآن، لكي ندرك كيف عمد مجتهد شبستري ـ مِن خلال فهمه الجديد للوحي ـ إلى جعل المؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة في الغرب متناغمة مع الإسلام، يجب أنْ نتعرّف على رأيه في مورد الأحكام الشرعيّة للإسلام، ولا سيّما في حقل المعاملات والسياسات.
يرى مجتهد شبستري أنَّ المعاملات والسياسات أحكام تاريخيّة، لا تقوم على مصلحة ذاتيّة ثابتة في التاريخ. توضيح ذلك، أنَّ الأفعال ـ طبقًا لأصول الفقه والعقائد الكلاميّة عند الشيعة ـ تتّصف بالحُسن والقبح الذاتي، وأنَّ الله سبحانه وتعالى إذا أمر بفعل أو نهى عنه؛ فإنَّ ذلك الفعل في حدّ ذاته يتّصف بالحُسن أو القبح الذاتي، وليس الأمر كما لو كان حُسن وقبح الأفعال تابعًا لإرادة الإنسان وظروفه البيئيّة والاجتماعيّة. وفي قبال هذا الرأي، يقع رأي أولئك الذين يقولون إنَّ أوامر الله ونواهيه لا تستند إلى المصلحة الذاتيّة للفعل، بل إنَّ الفعل الحسن هو الذي يأمر به الله، وإنَّ الفعل القبيح هو الذي ينهى عنه الله. وبعبارة أخرى: إنَّ أوامر الله ليست ثابتة، بل مِن الممكن أنْ يكون الشيء حسنًا في بادئ الأمر، حتّى إذا نهى الله عنه صار قبيحًا. وهذا الرأي نراه اليوم في إطار عبارات أخرى، وبشكل آخر في عبارات محمّد مجتهد شبستري. إنَّه يدرك هذا الأمر جيدًا، ويعلم أنَّ القول بالحُسن والقبح الذاتي للأفعال، تكون نتيجته هي أنَّ أحكام الله وتعاليم النبيّ ثابتة في جميع أبواب العبادات والمعاملات وفي جميع الأزمنة والأمكنة. ومِن هنا، فإنَّه يرى أنَّ هذا النوع مِن العقلانيّة، لا يساعد على إيجاد التناغم بين الأحكام السياسيّة والاجتماعيّة والمؤسّسات السياسيّة والاجتماعيّة الحديثة، وبين الإسلام والفقه.
وعلى هذا الأساس، فإنَّ مجتهد شبستري يرى أنَّ الأحكام السياسيّة والاجتماعيّة أو المعاملات والسياسات، تابعة لعُرف عصر النبيّ الأكرم، ولا تحظى بأيّ حقيقة، وإنَّما هي مجرّد اعتبارات قد اعتبرها الناس في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله، وإنَّ النبيّ بدوره قد قبل بها أو عمل على تعديلها. وقد كتب في ذلك بشكل صريح:
(85)«إنَّ تدخّل الكتاب والسنة في العلاقات الأسريّة والاجتماعيّة وفي الحكم والقضاء وما إلى ذلك على ما كان الوضع عليه في الحجاز، لم يكن ناشئًا مِن أنَّ الشرع يريد أنْ يضع القوانين للناس في هذه المجالات؛ وذلك لأنَّ هذه القوانين كانت موجودة أصلًا، وإنَّ الناس كانوا يعيشون في ظلّها».
ثمّ استطرد قائلًا:
«إنَّ ما هو موجود في الكتاب والسنّة حول العلاقات الأسريّة، والعلاقات الاجتماعيّة، والحكومة والقضاء والعقوبات والمعاملات ونظائر ذلك، ممّا ورد على شكل تقريرات وإمضاءات مِن دون تصرّف أو تعديل، أو مقرونًا بالإصلاح والتعديل؛ لم يكن مِن إبداعات وتأسيسات الكتاب والسنّة لغرض تشريع قوانين وأحكام ثابتة وخالدة تتعلّق بالعلاقات الحقوقيّة في الأسرة أو العلاقات الحقوقيّة في المجتمع أو مسألة الحكم وما إلى ذلك».
سبق أنْ ذكّرنا أنَّ مجتهد شبستري كان يرى السلوك التوحيدي، يعني السلوك النظري والعملي مِن أجل التغلّب على الألم الناشئ مِن الحجُب الأصليّة الأربعة في العالم، وهي: حجاب التاريخ، وحجاب اللغة، وحجاب المجتمع، وحجاب الجسد. وبعبارة أخرى: إنَّ القوانين والمقرّرات الاجتماعيّة، يجب تنظيمها في كلّ عصر ومرحلة تاريخيّة، بحيث يتمّ القضاء على هذه الحُجُب الأربعة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ مجتهد شبستري يرى أنَّ ما
ذكره الفقهاء على أساس منهج أصول الفقه ويقوم على أساس الحُسن والقبح الذاتي للأفعال، ليس جديرًا بالتطبيق في المرحلة المعاصرة؛ وذلك لأنَّ الكثير مِن تلك الأحكام والقوانين يتعارض مع ما تمّ اعتباره بوصفه مِن القيَم الحديثة والمعاصرة. وقد ذكر مجتهد شبستري نتيجة مقدّماته على النحو الآتي:
«إنَّ الأصول والنتائج التي ذكرناها توصلنا إلى هذا الموضوع الأساسي، وهي أنَّه مِن اللازم في كلّ عصر مناقشة القوانين والمؤسّسات ذات الصلة بالعلاقات الحقوقيّة في الأسرة والمجتمع والحكم وشكله، والقضاء والحدود والديات والقصاص، والمعاملات، وما إلى ذلك مِن الأمور التي يتمّ العمل بها في مجتمع المسلمين، بمعيار مستوى انسجامها وتناغمها وعدم تناغمها مع إمكان السلوك التوحيدي للناس».
وهنا يتّجه هذا الإشكال المهمّ على مجتهد شبستري، وهو الإشكال القائل: مَنْ هو الشخص الذي يستطيع في مختلف العصور والمراحل أنْ يحدّد ما هو الشيء المتطابق مع السلوك التوحيدي أو لا يتطابق معه؟ وبعبارة أخرى: إنَّ علماء الدين في المذهب الشيعي، وحتّى العلماء في مذهب أهل السنّة، يعملون على أساس الأصول والمباني المأخوذة مِن القرآن والسنّة على استنباط الأحكام الشرعيّة للدين في مختلف الظروف والشرائط الزمانيّة والمكانيّة. ولكنْ مِن وجهة نظر مجتهد شبستري، لا يمكن التعايش في العصر الجديد حتّى مع هذه الأصول والأحكام الثابتة وأخذ الأحكام الجديدة منها، ولكنْ مَنْ هو الذي يجب عليه أنْ يحدّد ما إذا كانت هذه الأحكام تتناسب مع العصر؟ يرى
مجتهد شبستري أنَّ تشخيص هذا الأمر يقتصر على خصوص العلماء في حقل العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة الجديدة، وقال في ذلك:
«لا يمكن التشكيك في هذه المسألة، وهي أنَّ معرفة الحقائق والأسس وآليّات القوانين والأعراف والتقاليد والمؤسّسات في المجتمعات الجديدة والمعقّدة للمسلمين في العصر الراهن، وتناغمها وعدم تناغمها الخارجي والعيني مع موضوع السلوك التوحيدي والتجربة الدينيّة، وتعقيد أو تسهيل ما ليس ممكنًا منها، خارج عن عهدة علوم مِن قبيل: علم الأصول وعلم الفقه والفلسفة والكلام الإسلامي والعرفان والتفسير. إنَّ لكلّ واحد مِن هذه العلوم منزلته الخاصّة، ويمكن أنْ يساعد كثيرًا بالإضافة إلى سائر العلوم الأخرى على اكتساب المعرفة وتجربة السلوك التوحيدي مِن الكتاب والسنّة. وأمّا المعرفة المنشودة والمرتبطة بالدور الإيجابي أو السلبي للقوانين والمؤسّسات على السلوك التوحيدي، فهي تقوم على الإدراك الواسع للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة مِن جهة، وعلى الوعي العلمي والتجريبي الموسّع عن موضوع ومسار السلوك التوحيدي للإنسان مِن جهة أخرى».
اتّضح ممّا تقدّم ذكره، أنَّ مجتهد شبستري يسعى ـ مِن خلال تفسير الوحي بالتجربة الدينيّة ـ إلى تمهيد الأجواء لتقبّل اعتباريّات العصر الحديث (التي يتعارض بعضها مع أحكام الشريعة الإسلاميّة). يرى مجتهد شبستري أنَّ الثابت الوحيد في شريعة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله في كلِّ مرحلة، والذي يجب على أساسه تطبيق الإسلام في كلِّ عصر؛ لا يعدو العقلانيّة والعدالة والواقعيّة
والرحمانيّة. بيد أنَ ملاك وتحديد هذه الخصائص، إنَّما يقتصر على ذلك المجتمع والأعراف الاجتماعيّة؛ بمعنى أنَّ العقلانيّة والعدالة والواقعيّة والرحمانيّة في كلِّ مجتمع، يجب أنْ تتناسب مع الاعتبارات والعقود الاجتماعيّة لذلك المجتمع، وأنَّ المرحلة التاريخيّة لكلّ مجتمع، ومِن المحتمل في كلّ مرحلة، أنْ يعتبر المجتمع شيئًا عادلًا أو عقلانيًّا ولا يراه المجتمع الآخر كذلك. وعلى هذا الأساس، ليس هناك في الإسلام شيء بوصفه مِن الأصول الثابتة في الفقه أو بوصفه مِن الأحكام الثابتة، بل إنَّها بأجمعها تابعة للشرائط والظروف الزمانيّة والمكانيّة المختلفة والمتغيّرة.
تمّ السعي في هذه المقالة إلى مناقشة وتحليل أفكار وآراء محمّد مجتهد شبستري مِن زاوية ورؤية خاصّة تعرِّف بمنهجیّته الأساسیّة، وقد تمّ الاهتمام في هذا المسار بتبلور تفكيره في التعاطي مع العوامل والخلفيّات غير المعرفيّة (السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة)، وكذلك العوامل والخلفيّات المعرفيّة (المباني الفلسفيّة والمذاهب والشخصيّات المؤثّرة) أيضًا.
وفي ضوء ما تقدّم، فقد ذهب مجتهد شبستري إلى الاعتقاد بأنَّ منشأ التخلّف السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الإسلاميّة عمومًا، وإيران خصوصًا ـ في قبال التطوّر والازدهار الذي شهدته الحضارة الغربيّة ـ يكمن في تخلّف المعارف المؤثّرة في إدارة المجتمعات، وهي معارف مِن قبيل العلوم الفقهيّة والكلاميّة. وادّعى ضرورة العمل على إيجاد تحوّلات وتغييرات جوهريّة وجادّة في أسس هذه العلوم والمعارف، على أمل إحداث
(89)
الأسس والأصول الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. وبذلك فقد بدأ مشروعه تحت عنوان «جعل المعنى مِن أجل الحياة الإنسانيّة وتحويل إدارة المجتمعات إلى العقلانيّة الحديثة، في إطار الإجابة عن هذا السؤال. وقد بحث مجتهد شبستري ـ بتأثير مِن الأفكار اللغويّة والهرمنيوطيقيّة ـ أسباب تخلّف العالم الإسلامي في الأسس المعرفيّة المتمحورة حول النصوص الدينيّة لهذه المجتمعات. ومِن هنا، فقد عمل على نقد العقلانيّة الفقهيّة والكلاميّة الغالبة، وبنية العقل الديني، وأسلوب نشاطها وأدائها، وكذلك الآليّات التي أدّت إلى إنتاج الأنظمة الاعتقاديّة المتنوّعة والمغلقة. وقد عمد في هذا المسار ـ ضمن التعرّض إلى التأسيس للمفاهيم الحديثة ـ إلى بيان بعض المصطلحات المفتاحيّة في العالم الإسلامي، كما وقد سعى ـ مِن خلال دراسة نمط تبلور الآليّات التدبيريّة للعقلانيّة الفقهيّة والكلاميّة ـ إلى إثبات تاريخيّتها أيضًا، وعلى إبراز الماهيّة الإيديولوجيّة لكلّ ما يظنّه دينًا حقًّا على نحو الجزم والقطع واليقين؛ لكي يمهد الطريق بزعمه لطرح الفكر المتجدّد، والعمل على تحديث التراث الفقهي والكلامي.
وكما رأينا في تحليل آراء مجتهد شبستري، فإنَّه يميل إلى القيَم الحديثة، وإنَّ مراده مِن الأفكار والقيَم الحديثة هو التعاليم الجديدة وشبه الجديدة، ولا سيّما في حقل الفقه والقانون في المجتمعات المعاصرة، وإنَّ غايته مِن نقد التراث الإسلامي هي فتح الطريق أمام الأفكار الحديثة، واتّباع تلك التحوّلات والتغييرات.
(90)- أسعدي، محمّد وآخرون، آسيب شناسی جريانهای تفسيری (معرفة آفات التيّارات التفسيريّة)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392ه.ش.
- آشتياني، سيد جلال الدين، شرح مقدمه قيصری بر فصوص الحکم (شرح مقدّمة القيصري على فصوص الحكم)، قم، نشر بوستان كتاب، ط 5، 1380ه.ش.
- باربور، علم و دين (العلم والدين)، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: بهاء الدين خرمشاهي، طهران، نشردانشگاهی، 1384ه.ش.
- براودفوت، فين، تجربه ديني (التجربة الدينيّة)، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: عباس ديني، قم، موسسه فرهنگی طه، 1377ه.ش.
- بوذري نژاد، يحيی، تبيين فلسفی وحی از نظر ملاصدرا (البيان الفلسفي للوحي مِن وجهة نظر صدر المتألهين). فصلنامه علمی و پژوهشی انديشه نوين دينی، العدد: 11، انتشارات دانشگاه معارف اسلامی.
- جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينة معرفت (الشريعة في مرآة المعرفة)، قم، نشر إسراء، 1381ه.ش.
- السبحاني، جعفر، هرمنوتيك (الهرمنيوطيقا)، قم، نشر توحيد، 1385ه.ش.
- الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد (صلوات الله عليهم)، ص 148، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404ه.
- الطباطبائي، السيّد محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: محمّد باقر الموسوي الهمداني، قم، انتشارات جامعة المدرسين في الحوزة العلميّة بقم، 1374ه.ش.
- الطباطبائي، السيّد محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ط5، 1417 ه.
- الطوسي، محمّد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، مكتبة العالم الإسلامي، ط 1، 1409ه.
- العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، قم، مؤسّسة إسماعيليان، ط 4، 1412 ه.
- علي خاني، علي أكبر ومساعدوه، روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام (المنهج في الدراسات السياسيّة للإسلام)، طهران، نشر: جامعة الإمام الصادق عليهمالسلام، 1386ه.ش.
- فعالي، تجربه ديني و مكاشفه عرفاني، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1379ه.ش.
- القطان، مناع، تاريخ التشريع الإسلامي: التشريع والفقة، دار نشر المعارف الرياض، 1417ه.
- القيصري، محمّد داود، شرح فصوص الحكم، إعداد: السيّد جلال الدين الآشتياني، طهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375ه.ش.
- الكُليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1365ه.ش.
- لاريجاني، صادق، معرفت ديني: نقدي بر نظريّة قبض وبسط تئوريك شريعت (المعرفة الدينيّة: نقد على نظريّة القبض والبسط النظري للشريعة)، طهران، مركز ترجمه ونشر كتاب، 1372ه.ش.
- اللاهيجي، عبد الرزاق، سرمايه ايمان در اصول اعتقادات (كنز الإيمان في أصول العقائد)، تصحيح: صادق لاريجاني، ط 4، انتشارات الزهراء، 1372ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، گوهر مراد (الجوهر المراد)، طهران، نشر أنديشه، 1383ه.ش.
- مجتهد شبستري، محمّد، «حكومت جهاني اسلام: پايه هاي فكري (11): فلسفه خاص اسلام در مسئله (همزيستي مذهبي)» (حكومة الإسلام العالميّة: الأسس الفكريّة (11): الفلسفة الخاصّة بالإسلام في مسألة (التعايش المذهبي))، المنشور في مجلّة: درسهائي از مكتب اسلام، السنة الثامنة، العدد: 6، أرديبهشت عام: 1346ه.ش. (مصدر فارسي).
- ـــــــــــــــ «قرائت نبوي از جهان» (القراءة النبويّة للعالم)، نیلوفر، 31/5/1401.
https://neeloofar.org/category/professorsresearchers/mojtahedshabestari/prophetic-interpretation-of-the-world/
- ـــــــــــــــ ، ايمان و آزادي (الإيمان والحريّة)، طهران، انتشارات: طرح نو، 1379ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، نقدى بر قرائت رسمى از دين: بحران ها، چالشها، راه حل ها (نقد على القراءة الرسمية للدين: الأزمات، التحدّيات، الحلول)، طرح نو، 1381ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، تأملاتى در قرائت انسانى از دين (تأمّلات في القراءة الإنسانيّة للدين)، طرح نو، 1383ه.ش.
- ـــــــــــــــ ،«هرمنوتيك و تفسير ديني از جهان»(الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعالم)، فصلنامه مدرسة، العدد: 6، سنة 1386ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، هرمنوتيك: كتاب و سنت (هرمنيوطيقا الكتاب والسنّة)، طرح نو، ط 8، طهران، 1393ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، في حوار بعنوان: «شرح يك زندگي فكري و علمي در گفت و گو با محمّد مجتهد شبستري»(سيرة حياة فكرية وعلميّة في حوار مع محمّد مجتهد شبستري)، حاوره: جلال توكليان ورضا خجسته رحيمي، مجلّة (انديشه پويا) الشهرية، العدد الصادر في شهر إسفند عام: 1392ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، في المؤتمر الوطني، تحت عنوان «پرسش از امكان امر ديني در عصر حاضر: بازخوانی روايت بيژن عبد الکريمی از «امر دينی»» (السؤال عن إمكان الأمر الديني في العصر الراهن: إعادة قراءة رواية بيجن عبد الکريمي لـ «الأمر الديني») الذي انعقد في پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بتاريخ: 29 /مهر / 1397ه.ش.
- محمّد رضائي، محمّد، «خاستگاه اصلاحات دينی در ايران»(مناشئ الإصلاحات الدينيّة في إيران)، مجلّة قبسات، العدد: 22، شتاء عام 1380ه.ش.
(93)- ـــــــــــــــ ، ومساعدوه، بررسی نقد باورهای انسان محورانه حقوق بشر از ديدگاه برخی نوانديشان دينی (مناقشة ونقد الآراء الإنسانيّة حول حقوق الإنسان مِن وجهة بعض المجدّدين الدينيين)، مجلّة: دو فصلنامه علمی انسان پژوهی دينی، السنة السادسة عشرة، العدد: 24، ص 96، خريف وشتاء عام: 1398ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، محمّد، نوانديشی و احياگری دينی (التجديد الفكري والإحياء الديني)، قم، نشر بوستان كتاب، 1396ه.ش.
- ملاصدرا، صدر المتألهين محمّد بن ابراهيم، تفسير القرآن الکريم، تحقيق: محمّد خواجوي، قم، انتشارات بيدار، ط 2، 1366ه.ش.
- هادوي طهراني، مهدي، مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم (الأسس الكلاميّة للاجتهاد في فهم القرآن الكريم)، قم، مؤسسة فرهنگي خانه خرد، 1377ه.ش.
- واعظي، أحمد، هرمنوتيك (الهرمنيوطيقا)، طهران، مؤسّسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1380ه.ش.
محمّد كاشيزاده
إنَّ مِن بين الأبحاث التي تناولها محمّد مجتهد شبستري في كتاباته، بحث الذاتي والعرضي أو جوهرة وصدفة الدين. وقدّم في هذا الشأن رؤيتين؛ ففي مورد يرى أنَّ جوهر ولؤلؤ الدين تجربة دينيّة، وفي المورد الآخر يعرّف جوهر الدين بوصفه مقصودًا بالذات. يمكن تقييم هاتين الرؤيتين بشكل مستقل؛ ولكنْ يبدو أنَّ مراده مِن طرح بحث المقصود بالذات، هو العثور على نقطة اشتراك بين التجارب الدينيّة المتمايزة مِن بعضها مِن الناحية الماهويّة بشكل كامل. إنَّ نقطة الاشتراك آنفة الذكر تعمل على إيصال التجارب الدينيّة مع بعضها بلحاظ المقاصد إلى نقاط الاشتراك.
نسعى في هذه المقالة إلى بحث ومناقشة هاتين الرؤيتين؛ حيث سنعمد أوّلًا
إلى بحث العلاقة بين هاتين الرؤيتين، وثانيًا: سوف نبحث في منطق كشف ذاتيّات الدين مِن وجهة نظر شبستري. كما سنعمل على تقييم الأسلوب المتّبع في هذه النظريّة.
إنَّ الذاتي في قبال العرضي، يعادل مفردة «Substance»في قبال «Accident»؛ ولا بدّ ـ بطبيعة الحال ـ مِن الالتفات إلى أنَّ كلمة «Essence» تستعمل في اللغة الإنجليزيّة للدلالة على معنى الذاتي أيضًا. إنَّ جوهر وصدف الدين في مقام الاستعمال الاصطلاحي، يعدّ معادلًا لهاتين المفردتين. وفي معجم أوكسفورد اللغوي، تمّت ترجمة كلمة «Substance» إلى المادة، والماهية، والجزء الأساسي والمهم للشيء.
وأمَّا في المصطلح الفلسفي ـ حيث ورد استعمال هذه الكلمة للمرّة الأولى مِن قبل أرسطو ـ فقد تمّ استعمال مفردة «Substance» بمعنى «الجوهر» في قبال «العرَض»؛ بمعنى أنَّها تستعمل للدلالة على الكائن الذي يكون وجوده لنفسه ولا يكون تابعًا لغيره، وتستعمل مفردة «Accident» للدلالة على الكائن الذي يكون وجوده لغيره، ويكون في مقام التحقّق بحاجة إلى موضوع، مِن قبيل: الكيفيّات، والأفعال، والروابط، وما إلى ذلك.
إنَّ المعنى الذي يكون هو المراد، ويلاحظ في بحث الذاتي والعرضي مِن الدين، يقرب مِن الاستعمال الثالث لهذه المفردة؛ أي «الجزء الأساسي والهام
(96)مِن الشيء». وإنَّ العرضي «Accident» الذي يُستعمل في اللغة الإنجليزيّة للدلالة على مفهوم «الصفة العرضية»، يقع في قبال الجزء الذاتي.
يتمّ تقسيم نظريّة الذاتي والعرضي مِن الدين إلى قسمين: أصلي وفرعي. إنَّ هذه النظريّة تشتمل على مدخلين؛ إذ يتمّ بحث جوهر الدين إمّا في حقل «التديّن» وإمّا في حقل «الدين». إنَّ الاتجاه الذي يعتبر الذاتي وصفًا للدين، يرى أنَّ الذاتي هو ذلك الشيء الذي لا يكون الدين مِن دونه دينًا، وأنَّ تغييره يؤدّي إلى إلغاء الدين ونفيه وإبطاله. وفي المقابل، فإنَّ المراد مِن العرَضي هو الذي كان يمكنه أنْ يكون على شكل آخر، وإنْ كان الدين لا يخلو مِن نوع مِن أنواعه أبدًا. تقوم فرضيّة الاتجاه المذكور آنفًا على أنَّ جزءًا مِن الدين، عبارة عن عناصر تفوّق التاريخ والعالم، ولا تتغيّر أو تتحوّل بمرور الزمان، ويكون قوام الدين بهذه العناصر. وأمّا القسم الآخر الذي يُعدّ القشرة والصدف المحيط بالعناصر المقوّمة، فهو عبارة عن الأمور التي تفهم في ضوء الارتباط بالتاريخ والثقافة والظروف والشرائط الزمانيّة والمكانيّة، وبالتالي فإنَّ عرَضيّات الدين في هذا المعنى، هي الأمور التي تحمل على عاتقها مهمّة نقل الجوهر مِن ثقافة إلى ثقافة أخرى، وفي أثناء النقل الثقافي يجب أنْ يطرأ عليها تغيّر وتحوّل.
وفي المقابل، فإنَّ الاتجاه الذي يبحث عن جوهر (ذاتي) الدين في حقل «التديّن»، يرى أنَّ الذاتي وصفًا لحالة المكلّفين، وينظر إلى الدين بنظرة ورؤية داخليّة وذاتيّة. مِن خلال تقسيم «التديّن» إلى قسمين، يتمّ التعبير عن المراحل الظاهريّة والقشريّة مِن التديّن بالعرَضي، كما يُسمّى الوصول إلى لبّ وروح
(97)التديّن الذي يجعل الفرد مستغنيًا عن الطبقة والقشرة الظاهريّة بـ «ذاتي الدين». وبالتالي، فإنّه في الاتجاه الأول يتمّ النظر إلى المسألة بنظرة عينيّة وخارجيّة، وفي الاتجاه الثاني يكون المنظور هو أمر ذاتي وداخلي.
وفي بعض الأبحاث تمّت الإشارة إلى معنى آخر لجوهر أو ذاتي الدين. وعلى هذا الأساس، تمّ اعتبار المشتركات بين الأديان المختلفة بوصفها ذاتيّ الدين، كما تمّ التعبير عن نقاط الاختلاف بـ «صدف الدين». ولكنْ لا بدّ مِن الالتفات إلى أنَّ هذا المعنى، ليس هو مراد الذين يبحثون عن الذاتي والعرضي مِن الدين؛ إذ إنَّهم بصدد العثور على الطبقات المتغيّرة والنواة الثابتة للدين؛ ليتمكّنوا مِن تقديم وصفة ناجعة عن الدين في العالم الحديث.
إنَّ محمّد مجتهد شبستري برؤية عامّة، يرى أنَّ جوهر الدين تجربة دينيّة. وعلى هذا الأساس، يمكن لنا أنْ ندرج رأيه ضمن تلك المجموعة مِن النظريّات التي تبحث عن جوهر الدين في دائرة «التديّن». وعلى الرغم مِن أنَّ بحثه ينسحب إلى حقل «الدين» أيضًا، ولكنْ حيث أنَّ ملاك التقسيم في كلا الاتجاهين، هو الأمر المتّخذ بوصفه جوهر الدين، دون الموارد المستفادة. وهو بدوره يعتبر جوهر الدين عبارة عن التجربة الدينيّة، يمكن تصنيفه ضمن أولئك الأشخاص الذين يبحثون عن جوهر الدين في دائرة «التديّن».
يطرح محمّد مجتهد شبستري استعمالين مختلفين للذاتي والعرَضي للدين. إنَّ استعمال مفردة الذاتي في هذين الموردين ليس بمعنى واحد؛ ومِن هنا يجب
بحثهما بشكلٍ مستقلٍّ. ففي مورد، يرى أنَّ جوهر الدين تجربة دينيّة متأثّرة بالأبعاد الإنسانيّة الأربعة، وهي: التاريخ، واللغة، والمجتمع، والجسم. وعلى هذا الأساس، سوف يكون لجوهر الدين عدد مِن الخصائص الأصليّة، وهي عبارة عن:
أ) الحيويّة.
ب) الشخصيّة.
ج) الخفاء.
د) عدم الثبات.
لازم هذه الرؤية نفي البنية التشريعيّة للدين، وكذلك لزوم الانسيابيّة والحفاظ على بقاء التجارب الدينيّة وعدم الاكتفاء بالتجارب الدينيّة لعصر النزول. وبالتالي، فإنَّ الذي يُعدّ ملاكًا للتديّن، هو تطابق السلوك والأفعال مع التجارب الدينيّة في المرحلة الراهنة، لا أنْ نروم الوصول إلى ضبط عمل المؤمنين على أساس القواعد والضوابط الدينيّة.
والمعنى الآخر للذاتي المشار إليه في رؤية مجتهد شبستري، هو المقصود بالذات في قبال المقصود بالعرَض. فقد عمد في هذا التقسيم إلى بحث الدين بلحاظ مقاصده وقيَمه، وقال بأنَّ المقاصد الثانويّة، إنّما تكون ذات قيمة مِن حيث كونها مقدّمة فقط، وإنّما يتمّ طرحها بمقتضى الحقائق الاجتماعيّة لتلك المرحلة. إنَّه يرى أنَّ الأسلوب الوحيد المعتبر في كشف المقاصد مِن الدرجة الأولى والثانية، هو علم الظواهر التاريخيّة؛ ويذهب إلى الاعتقاد بعدم إمكان الوصول إلى هذا الأمر المهمّ بالأسلوب الديني.
(99)إنَّ لكلٍّ مِن الرأيين المقدّمين في باب الذاتي والعرضي للدين، قابليّة البحث والتدقيق المستقل، وفي الوقت نفسه مِن اللازم ملاحظة الارتباط بين هذين الرأيين. وفيما يتعلق بالارتباط بين هذين الرأيين؛ أي ماهية تعريف ذاتي الدين بـ «المقاصد بالذات» و«التجربة الدينيّة»، يمكن مناقشة وبحث مختلف الفرضيّات: أوّلًا إنَّ هذين الرأيين يمثّلان رؤيتين مختلفتين، ويجب بحث كلّ واحدة منهما بشكل مستقلٍّ؛ إنَّ «المقاصد بالذات» تنطلق بالبحث مِن زاوية غاية الدين، و«التجربة الدينيّة» من زاوية مبدأ الدين.
كما يمكن أخذ هذا الوجه في الجمع بين هذين الرأيين بنظر الاعتبار أيضًا: يقوم الفرض على أنَّ جوهر الدين هو التجربة الدينيّة، إلّا أنَّ واحدًا مِن ملاكات معرفة وتعيين جوهر الدين، هو كونه مقصودًا بالذات. توضيح ذلك، أنَّ الوحي يُعدّ نوعًا مِن التجارب الدينيّة، وأنَّ الدين في الأصل لم يكن له بنية تشريعيّة ـ كما نشاهده حاليًّا ـ وقد أوجد تحوّلات تاريخيّة واجتماعيّة لنظام عقائدي واجتماعي محدّد. وعلى هذا الأساس، فإنَّ حفظ وبقاء الدين، إنّما سيكون له معنى صحيح، إذا كانت الشريعة تقوم على تجربة إيمانيّة سيّالة وحيويّة وتواصل استمرارها على مرّ الزمن. وحيث أنَّ جوهر الدين، يشتمل على بعض الخصائص الأصليّة، والتي هي عبارة عن: الحيويّة، والشخصيّة، والخفاء، وعدم الثبات؛ فإنَّ التجربة الدينيّة سوف تكون أمرًا شخصيًّا بالكامل، وإنَّ جميع الهوية الدينيّة وملاك التديّن يكمن في امتلاك هذا الجوهر، وليس التبعيّة لنظام سلوكي. وكذلك بناء على أنَّ التجربة الدينيّة أمر شخصي وخفيّ وحيويّ وغير ثابت؛ فإنَّ الذي يمكنه العمل على ربط
(100)جوهرين شخصيين تمامًا ومنفصلين عن بعضهما بالكامل، هو الاشتراك في الغاية، وليس في ذات وماهية التجربة الدينيّة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ محذور عدم إمكان الاشتراك الماهويّ بين تجربتين دينيّتين شخصيّتين بشكل كامل، قد مهّد الأرضيّة لاتخاذ ملاك ومعيار مِن خارج التجربة الدينيّة، وهو معيار الاشتراك في غايات التجارب الدينيّة.
وعلى هذا الساس، فإنَّ الذي يتمّ طرحه بوصفه جوهر الدين، هو التجربة الدينيّة. إنَّ التجربة الدينيّة لكلِّ فرد أمر شخصي تمامًا، ويمتاز مِن التجارب الدينيّة للآخرين بما في ذلك شخص النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله أيضًا، وهذا الأمر يؤدّي إلى عدم إمكان نسبة دين واحد إلى شخصين مختلفين. إنَّ طريقة حلّ هذه المشكلة تكمن في تعيين ملاك يمكن مِن خلاله إدراج تجربتين دينيّتين ضمن ملاك واحد، وحيث لا يمكن القيام بهذا الأمر بلحاظ ماهيّة التجربة الدينيّة؛ فإنَّه يصار إلى اعتبار هذا الملاك بلحاظ غاية التديّن. ومِن هنا، عمد مجتهد شبستري إلى بحث غايات حركة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، ومِن خلال فصل الغايات بالذات عن الغايات بالعرض أو الغايات الوسيطة، قدّم ملاكًا جديدًا في اشتراك ووحدة مسار التديّن بين المؤمنين مع الاختلاف في أداء وسلوك المؤمنين، وكذلك الاختلاف الماهوي للتجارب الدينيّة.
إنَّ مِن بين المعاني التي يذكرها محمّد مجتهد شبستري بشأن الذاتي، هو «المقصود بالذات» في قبال «المقصود بالعرَض». إنَّ مجتهد شبستري في بحث التوحيد لا يرتضي العلاقة الخاصّة بين الله تعالى والفرد بوصفه نبيًّا، وإلقاء الوحي
(101)المنطوق عليه؛ وذلك بسبب محذور العلاقة بين الثابت والمتغيّر. ومِن ناحية أخرى، يذهب في البحث الأنثروبولوجي إلى الاعتقاد بأنَّ النبيّ ـ بوصفه إنسانًا ـ إنّما يبيّن رؤيته التفسيريّة للعالم، ولا يرى بيان النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ذا قيمة خبريّة؛ بل هو مجرّد تفسير وبيان إنشائي عن العالم المحيط به. استنادًا إلى هذين المبنيين ونفي الوحي المنطوق، لا يمكن بحث عن الوحي بلحاظ مبدئه في مقام معرفة الوحي؛ وبالتالي فإنَّه يبحث هذا المفهوم بلحاظ الغاية والقصد. وتفسيره النهائي للوحي، هو كلّ كلام يؤدّي إلى إحداث تغيير في المخاطب، مِن أيّ شخص صدر هذا الكلام وفي أيّ مكان أو زمان؛ والكلام النبويّ هو الكلام الذي يحدث تغييرًا. وعلى هذا الأساس، يصبح مبدأ الدين بشكل عام «معلقًا»، والذي يكون مهمًّا بالنسبة له في البحث الديني، هو غايته ومقصده. ومِن ناحية أخرى، حيث يمكن لمقاصد الدين أنْ تنقسم إلى مقاصد نهائيّة ومقاصد وسيطة، فإنه يُسمّي المقاصد النهائيّة بالمقصود بالذات، ويرى أنَّ المقاصد الوسيطة ـ التي تشكّل الأرضيّة للوصول إلى المقاصد النهائيّة ـ مقصودة بالعرَض. وقد عمد إلى بيان رأيه مِن خلال طيّ هذه المقدّمات:
المقدّمة الأولى: هناك في رسالة ودعوة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ـ مثل كلّ نبي وصاحب رسالة أخرى ـ هناك طائفتان مِن القيَم والمقاصد؛ حيث تكون طائفة مِن القيَم والمقاصد نهائيّة، وطائفة أخرى مِن القيَم تُعدّ مقدّمة ووسيلة إلى تحقّق المقاصد النهائيّة. إنَّ المقاصد مِن الدرجة الثانية إنَّما كانت منشودة للنبي بوصفها وسيلة فقط، وإنَّما يتمّ الركون إليها؛ لأنَّ الشرائط التاريخيّة والاجتماعيّة والاقصاديّة والسياسيّة ـ وبكلمة واحدة: الحقائق الاجتماعيّة
(102)لمنطقة الحجاز (المركز الجغرافي لدعوة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله) ـ هي التي كانت تستوجبها. لا يمكن إنكار هذه الحقيقة، وهي أنَّ رسالته كانت تترك تأثيرًا في الحقائق الاجتماعيّة؛ أي في المعتقدات والقيَم والأخلاق والآداب والتقاليد والمعاملات والقواعد السلوكيّة للناس فيما بينهم، وتعمل على تنظيمها.
المقدّمة الثانية: إنَّ سلوك النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله قد تبلور على أساس طرح وبنية عقلائيّة، ولا يمكن إنكار هذا الأسلوب مِن الناحية التاريخيّة. إنَّ دراسة طريقة وأسلوب تعامل النبيّ مع المجتمع المنظور، يثبت أنَّه في جميع مراحل حياته قد عمل بجهوده ـ التي لا تعرف الكلل والملل ـ على توظيف جميع الأساليب العقلائيّة في عصره.
المقدّمة الثالثة: تقوم على هذا الأصل القائل بأنَّ فهم ثنائيّة المقاصد والقيَم والأحكام المرتبطة بها، لم تكن قابلة للتشخيص بالنسبة إلى المخاطبين في عصر النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله؛ وذلك أوّلًا: لأنَّ المخاطبين في تلك المرحلة، كانوا يرزحون تحت تأثير القيادة والشخصيّة الكارزميّة للنبي الأكرم صلىاللهعليهوآله. وثانيًا: إنَّ الناس عادة لا يستطيعون الانفصال والابتعاد عن الزمان الذي يعيشون فيه، ليعثروا بأنفسهم على التفكيك والفصل بين ما بالذات وما بالعرض والاتفاقيّة في المقاصد والقيَم. فهذا لا يكون إلّا في مقدور اللاحقين؛ إذ يستطيعون بوساطة النظرة والرؤية الظاهراتيّة التاريخيّة تبويب مقاصد وقيَم أسلافهم.
وبالتالي، فإنّه مِن خلال تطبيق هذا الأسلوب، يصل إلى نتيجة مفادها: أنَّ رسالة ودعوة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ـ مثل كلّ رسالة ودعوة أخرى ـ تنطوي على
سلسلة مِن المقاصد والقيَم النهائيّة التي تمثّل ذاتيّات رسالته ودعوته، وسلسلة أخرى مِن المقاصد والقيَم الفرعيّة والثانويّة التي لا تكون منشودة ومطلوبة لذاتها، وإنّما هي مجرّد وسيلة لتحقّق الطائفة والسلسلة الأولى في ذلك العصر، ولا تكون مطلوبة إلّا بسبب الظروف التاريخيّة والاجتماعيّة التي تستوجبها.
إنَّ مجتهد شبستري بناء على أصل الظاهراتيّة التاريخيّة، يصل إلى نتيجة مفادها أنَّ الشهود الظاهراتي للدين بعد مضي أربعة عشر قرنًا مِن الزمن، يضع أمامنا واقعتين، وهما:
1. المركز الأصلي لظاهرة النبوّة والرسالة.
2. الإطار الاجتماعي المادّي والمعنوي/ التاريخي الذي حدثت فيه هذه الظاهرة.
وبعد تفكيك وبيان عناصر كلتا المقولتين، يذهب محمّد مجتهد شبستري ـ في ضوء الأسلوب المذكور آنفًا ـ إلى الاعتقاد بأنَّ اعتبار الحكم الشرعي في كلِّ عصر، يكمن في كيفيّة إمكان «السلوك التوحيدي».
والنتيجة، هي أنَّ الذي ينقسم بالأصالة إلى الذاتي والعرَضي، هي المقاصد والقيَم التي كانت منشودة للنبي الأكرم صلىاللهعليهوآله. وتبعًا لذلك، تنقسم القيَم والمقاصد والأعمال والأحكام بدورها إلى قسمين؛ إذ تنقسم إلى الذاتي والعرضي أيضًا. إنَّ الذاتيّات هي القضايا الوحيدة المقوّمة للتوحيد؛ إذ إنَّ التوحيد لا يتجلّى في أيّ ثقافة، إلّا وهو يصطحب هذه القضايا معه ضرورة،
وكلّ ما كان مِن غير هذه القضايا، وكان بحكم المقدّمة للوصول إليها؛ اكتسب حكم العرَضي، ويكون معيار اعتبارها عصري أوّلًا، ويكون ثانيًا تابعًا لشكل وطريقة تحقّق «السلوك التوحيدي».
هناك بعض الغموض والإبهامات والأسئلة الجادة أمام نظريّة المقصود بالذات:
فأوّلًا: هل المقصود بالذات هو الذاتي؟
وثانيًا: هل تعدّ الظاهراتيّة التاريخيّة أسلوبًا معتبرًا في كشف المقاصد بالذات؟
وثالثًا: لو كان توظيف هذا الأسلوب متناقضًا مع كلمات أصحاب الشريعة في مختلف المراحل الزمنيّة، هل يكون التقدّم لها أم لكلام أصحاب الشرائع؟
ورابعًا وأخيرًا: ما هو منطق الوصول مِن المقصود بالذات إلى ذاتي الدين؟ وكيف تمّ اجتياز هذا الطريق في ضوء هذه النظريّة؟
يذهب محمّد مجتهد شبستري إلى الادّعاء بأنَّ كلّ ما وصلنا مِن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله غير السلوك التوحيدي، يُعدّ مِن العرَضي للدين، ويجب تحقيقه على أساس الشرائط الزمنيّة الراهنة. لا بحث ولا نقاش في أنَّ العنصر الأكثر أصالة والهدف والغاية بالذات مِن تبليغ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، هي الدعوة إلى التوحيد؛ كيف يمكن أنْ نصل مِن خلال الظاهراتيّة التاريخيّة إلى القول بأنَّ كلّ ما يصلنا مِن غير التوحيد يعتبر مِن عرَضي الدين، ومِن مقتضيات مجتمع عصر نزول القرآن الكريم وتبلور الدين؟.
(105)إنَّ الادّعاء الآخر الذي يذكره مجتهد شبستري ولا يستند إلى دليل، هو وجوب تصرّم التاريخ للتعرّف على الأمر التاريخي ظاهراتيًّا. إنَّ سلوك الاتجاه الظاهراتي والكشف عن المقاصد بالذات، وتمييزها مِن المقاصد بالعرَض؛ ليس بالأمر الذي يحتاج إلى تعاقب الزمن. ومِن ناحية أخرى، يطرح هذا السؤال نفسه وهو: كيف غفل الأئمة المعصومون عليهمالسلام ـ وكانوا بأجمعهم قد عاشوا في أزمنة متأخّرة عن تبلور الدين ـ عن هذا الأمر الظاهراتي؟ ثم إنَّه لماذا لم يقم النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله نفسه بهذا التفكيك؛ مع أنّه كان يدّعي أنَّ دينه هو خاتم الأديان، وأنّه صالح للتطبيق في جميع الأزمنة والأمكنة؟ ألم يكن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله يعلم أنَّ جميع تعاليمه وأحكامه ـ غير ما كان منها مِن التوحيد ـ ليست سوى عرضيّات لا يكون الغرض منها سوى الوصول إلى التوحيد؟ ألم يكن مِن الواجب عليه أنْ يأمر بتغيير الأحكام عند تغيّر الظروف والشرائط، ويضع هذا الأمر بوصفه قاعدة تهدف إلى الحفاظ على حيويّة الدين وحفظه؟
يرى محمّد مجتهد شبستري أنَّ «المقصود بالذات» للدين الإسلامي، يقوم على أساس الظاهراتيّة التاريخيّة للسلوك التوحيدي. على فرض تسليم حجيّة الرؤية المتّخذة في معرفة المقصود بالذات، يبقى مجال هناك متّسع لبعض الأسئلة، ومنها:
أوّلًا: هل «سلوكه التوحيدي» وحده هو المقصود بالذات؟ أم «تجربة
(106)التوحيد« أو قضيّة «لا إله إلا الله«؟ إنَّ «السلوك التوحيدي» يعود إلى أعماله ونشاطاته، وقضيّة «لا إله إلا الله» تعود إلى رؤيته ومعتقداته، و«التجربة التوحيديّة» بدورها تعدّ ثمرة لسلوكه الداخلي وبنائه الفردي والشخصي لنفسه. إذا كان ملاك العمل توحيديًّا، يرِد هذا الإشكال؛ وهو أنّه ما لم يتم الإتيان بجميع أجزاء الدين الإلهي بشكل كامل، لا يُكتب التحقّق للعمل والأداء التوحيدي. وإذا كان المقصود هو الاعتقاد التوحيدي فقط، يمكن السؤال: أيّ تقرير عن التوحيد هو المراد؟ وما هو الدليل على اعتبار التوحيد ملاكًا للتبعيّة؟ وعلى أيّ أساس يكون صحيحًا؟ هل يكون التوحيد حجّة بسبب الدعامة الاستدلاليّة، أم الظاهراتيّة التاريخيّة بدورها ملاك لمعرفة المقصود بالذات وتشتمل كذلك على الحجيّة في التبعيّة أيضًا؟ على فرض اعتبار التجربة التوحيديّة للنبي الأكرم صلىاللهعليهوآله مقصودة بالذات، فمع القول بشخصيّة التجارب الدينيّة؛ كيف تثبت الحجيّة للتبعيّة للتجربة الدينيّة وكلام النبيّ؟ وإذا كانت التبعيّة للتوحيد هي الملاك بوصفها تجربة دينيّة، فحيث تكون التجربة الدينيّة أمرًا شخصيًّا بالكامل وسيّالة وصمّاء ومبهمة؛ لا يمكن أنْ نتوقّع مِن جميع التجارب الدينيّة أنْ تؤدّي إلى التوحيد. إنَّ التجربة الدينيّة أمر سيّال وغير قابل للتجسم والتشكّل، وإذا أردنا أنْ نحدّد لها ـ بشكل مسبق وعلى طول الزمان وبالنسبة إلى الأفراد ـ قيودًا وأطرًا؛ فسوف نحتاج أوّلًا إلى إطار معياري خارجي محدّد، وأنْ نعمل ثانيًا على إخراج التجربة الدينيّة مِن حالتها السائلة، وأنْ نقيّدها ـ بناء على فرصيّة مجتهد شبستري ـ في قالب بنيويّ تشريعي سابق ومتحجّر.
(107)
هل يمكن اعتبار المقصود بالذات هو الذاتي نفسه، والمقصود بالعرَض هو عرَضيّ الدين؟ ألا ينبغي ويمكن أنْ نحدث تفكيكًا بين أهداف الدين وذات الدين؟ إنَّ الذاتي والعرضی اللذين ينظران ـ بحسب المصطلح ـ إلى القضايا، إنّما يطرحان إذا تمّت المقارنة بين نوعين مِن القضايا فيما بينهما؛ وعندها فإنَّ تلك الطائفة مِن القضايا ذات البُعد الزمني والمؤقّت، تسمّى بـ «عرضي الدين». وفي المقابل، فإنَّ تلك الطائفة التي لا تختصّ بالشرائط الزمانيّة والمكانيّة والثقافيّة لعصر نزول الدين، وتتماشى مع الدين دائمًا، ولا يكون الدين مِن دونها دينًا، تسمّى بـ «ذاتي الدين». وأمّا عند التفكيك والفصل بين المقصود بالذات وبالعرَض، يتمّ تقييم سنخين مِن الأهداف ومقارنتهما إلى بعضهما. يمكن لنا في كلّ حركة أنْ نأخذ بعين الاعتبار نوعين مِن الأهداف الوسيطة والأهداف الغائيّة، وبطبيعة الحال فإنَّ الهدف الغائي النهائي، والذي يكون بالذات هو الهدف الذي تعدّ جميع الأهداف الأخرى بالنسبة له أهدافًا وسيطة؛ بيد أنَّ ترتيب الأهداف على بعضها واعتبار بعضها مقدّمة للبعض الآخر، لا يعني ذاتيّة بعضها وعرضيّة بعضها الآخر. مِن ذلك على سبيل المثال، أنَّه قد يرى شخص الدين جامعًا وكاملًا وخاتمًا، وعلى هذا الأساس يعتبر جميع القضايا الدينيّة ذاتيّة ويراها مِن ذاتي الدين، ويرى في الوقت نفسه أنَّ مقاصد الدين يمكن تقسيمها إلى ما بالذات وما بالعرض. ومِن هنا، فقد تمّ القول بأنَّ مِن بين آفات هذه الرؤية هو الخلط بين الذاتي والعرَضي مِن الدين، وبين المقصود بالذات والمقصود بالعرَض.
منطق الوصول مِن المقصود بالذات إلى الذاتي
كما سبق أنْ ذكرنا في البحث السابق، لا يمكن اعتبار المقصود بالذات والذاتي بمعنى واحد؛ وبالتالي فإنَّ على المنظّر أنْ يصل مِن المقصود بالذات إلى ذاتيّ الدين عبر مشروع ومسار منطقي. وبعبارة أخرى: على الرغم مِن عدم إمكان اعتبار المقصود بالذات مساويًا لذاتيّ الدين، ربَّما أمكن عبر مسار مِن الوصول إلى ذاتيّ الدين مِن المقصود بالذات. إنَّ مجتهد شبستري تعرّض إلى هذه المسألة بشكل مجمل للغاية، وهي ما هو منطق الوصول مِن المقصود بالذات إلى الذاتي؟ وعند الخوض في مقاصد الدين، قسّم الأقوال والأعمال والأحكام تبعًا لذلك إلى نوعين، وهما: الدرجة الأولى وبالذات، والدرجة الثانية وبالعرَض.
لا بحث في إمكان التفكيك والفصل بين مقاصد وأهداف حركة شخص، وتقسيمها إلى ما بالذات وما بالعرَض، كما أنَّه لا يوجد إشكال في أنَّ الأفعال تقبل هذا التقسيم تبعًا للأهداف أيضًا؛ بيد أنَّ البحث الأصلي هنا يكمن في السؤال القائل: ما هو المنطق المتّبع مِن قبل مجتهد شبستري في الوصول مِن المقصود بالذات إلى الذاتي، ومَنْ المقصود بالعرَض إلى العرضي؟ إنَّ معيار العرَضي في الدين، هو أنْ يكون بإمكانه في كلِّ مرحلة زمنيّة بل ويجب أنْ يتغيّر تبعًا لذات تلك الشرائط؛ وأمّا اعتبار هدف أو سلسلة مِن الأعمال ملاكًا بالعرَض، هو أنْ لا تكون قيمتها غائيّة ونهائيّة، بل تكون واسطة في الوصول إلى قيمة نهائيّة أخرى.
إنَّما يصحّ العبور مِن المقصود بالعرَض إلى العرضي ويكون منطقيًّا، إذا أمكن لنا أنْ نثبت أنَّ هناك طرقًا متنوّعة وقابلة للاستبدال مِن أجل الوصول إلى الهدف الغائي آنف الذكر، وأنَّ الأهداف الوسيطة مورد نظر الدين في مرحلة، إنَّما كانت هي واحدة مِن الطرق الممكنة ـ وليست الحصريّة ـ في ذلك الزمان، والتي اختارها النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله للوصول إلى الهدف الغائي، ولم يكن لديه أيّ إصرار على سلوك هذا الطريق الخاصّ وتوسيط الأهداف المذكورة آنفًا. وفي غير هذه الحالة، لا يوجد هناك ما يُبرّر استبدال أفعال وسلوك مخالف لما كان في عصر النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ؛ إذ مِن الممكن أنْ تكون هناك علاقة وارتباط حصري بين الأهداف الوسيطة والهدف الغائي.
وحتّى إذا لم يكن هناك طريق حصري، يجب على مجتهد شبستري أنْ يستدلّ على حجيّة الطريق المعروض البديل وإمكانيّة اختياره، وحجيّة التخلّي عن الطريق السابق المطروح مِن قبل الدين، لا أنْ يتحدّث عن تحديث وعصرنة التشريعات بشكل مطلق.
إنَّ الادّعاء بأنَّ جميع القضايا والمعارف الموجودة في الكتاب والسنّة، ليست في رتبة واحدة، ليس بمنزلة تقسيمها إلى الذاتي والعرَضي. وبعبارة أخرى: إنَّ اعتبار بعض المفاهيم والتعاليم الدينيّة مقدّمة لبعضها الآخر، ليس مِن باب المقدّمة في الحدوث فقط، بل إنَّ المفاهيم التمهيديّة في الشريعة، كما هي مقدّمة في الحدوث، فهي مقدّمة في البقاء أيضًا. توضيح ذلك، أنَّ بعض المقدّمات هي مِن قبيل السلم الموصل إلى السطح، حيث تكون نافعة في حدوث ذي
(110)
المقدّمة فقط، ولا يكون ذي المقدّمة محتاجًا إليها في بقائه؛ ولكنْ ليس كلّ المقدّمات على هذه الشاكلة، بل إنَّ بعض المقدّمات تعتبر شرطًا وجوديًّا لذي المقدّمة حدوثًا وبقاء، مِن قبيل التحصيل الدراسي في المرحلة الابتدائيّة بوصفه مقدّمة للوصول والانتقال إلى المرحلة المتوسّطة مِن الدراسة؛ بيد أنَّ مواصلة الدراسة في المرحلة المتوسّطة رهن ببقاء المعلومات التي حصل عليها الطالب في المرحلة الابتدائيّة، وعلى فرض نسيان الطالب للمعلومات التي حصل عليها في المرحلة الابتدائيّة، سوف يستحيل عليه البقاء والاستمرار في الدراسة في المرحلة المتوسّطة. إنَّ هذه المسألة مستعملة بشكل دقيق في المقدّمات وذواتها المحدّدة مِن قبل الدين. بمعنى: صحيح أنَّ بعض التعاليم تشكّل مقدّمة لبعض التعاليم الأخرى، بيد أنَّ وجود وبقاء ذوات المقدّمات الدينيّة رهن بوجود وبقاء هذه المقدّمات.
الذاتي بمعنى التجربة الدينيّة للأفراد
يذهب مجتهد شبستري إلى الاعتقاد بأنَّ الدين في بداية ظهوره، لم يكن يحتوي على بنية تشريعيّة، وإنَّما تمّ طرحه وبيانه على مجرّد الإيمان. ولكنْ أخذ النظام العقائدي والاجتماعي يبدأ بالتشكّل والظهور التدريجي في العالم الإسلامي بمرور الزمن وبفعل التحوّلات التاريخيّة والاجتماعيّة، وبذلك ظهر علم الفقه على نحو ما هو موجود حاليًّا، وكان هذا كلّه ثمرة سلسلة مِن التحوّلات التاريخيّة والاجتماعيّة طيلة تاريخ الإسلام.
ولكي يدخل مجتهد شبستري في بحث التجربة الدينيّة بشأن جوهر الدين في بحث التعدديّة الدينيّة، فإنَّه يُشير إلى المباني السابقة الضروريّة للقول بالتعدديّة، والتي لا يكون الدخول في التعدديّة مِن دونها ممكنًا. إنَّ مِن بين هذه المباني السابقة، هي التجربة الدينيّة بوصفها جوهر الدين؛ وذلك لأنّنا لو اعتبرنا التجربة الدينيّة جوهر تديّن الإنسان، فإنَّ تجليّات تلك الواقعيّة النهائيّة، سوف تظهر في كلِّ مكان على شكل مختلف. إنَّ التجربة الإنسانيّة أمر ظاهري، وليست هناك تجربة مِن دون تفسير، وعندما يتمّ تفسير التجربة، فإنَّها تتأثّر بالثقافة؛ إذ إنَّ القيود الأربعة المحيطة بالإنسان ـ وهي: القيود التاريخيّة، والقيود اللغويّة، والقيود الاجتماعيّة، والقيود الجسديّة ـ سوف تترك تأثيرها على تجربته. ونتيجة لذلك، فإنَّ القضايا التي يتمّ بيانها على شكل عقائد، يمكن لها أنْ تكون مختلفة، ويكون لها في الوقت نفسه حظٌّ مِن الحقيقة أيضًا. وعلى هذا الأساس، فإنَّ القضايا الدينيّة المطلقة التي تمّ بيانها للفرد مع بعض القيود، تبدو مطلقة، وفي الوقت نفسه لا تؤدّي إلى نفي القضايا الدينيّة المقبولة مِن قبل الآخرين.
إنَّ هذه النظرة المتمركزة على الاتجاه الوجودي، تعتبر جوهر الدين مشتملًا على بعض الخصائص الأصليّة، وهي عبارة عن: الحيويّة، والشخصيّة، والخفاء، وعدم الثبات. بمعنى أنَّ الفرد على الرغم مِن جميع القيود الزمانيّة والمكانيّة والتاريخيّة المحيطة به، قد تمكّن مِن إقامة الارتباط
مع المطلق، والاستفادة مِن ذلك الأمر المطلق بمقدار محدوديّاته الإنسانيّة. في هذه الرؤية، تمّ اعتبار الوحي بدوره نوعًا مِن التجارب الدينيّة أيضًا، ويتمّ التعرّض بهذا النموذج المعرفي لجميع مسائل الدين أيضًا.
مِن خلال اعتباره التجربة الدينيّة جوهر الدين، والتسليم بهذا الأمر القائل بأنَّ الدين كان في نهاية أمره قائمًا على الإيمان دون الشريعة؛ يعمد مجتهد شبستري إلى بيان فهمين للشريعة، وهما:
أ) الشريعة المتحجّرة أو الشريعة المترسّبة، وهي الشريعة المتبلورة على شكل آداب وتقاليد ونظام عقائدي واجتماعي.
ب) الشريعة التي تكون تجليّاتها التاريخيّة والاجتماعيّة والجسمانيّة واللغويّة دينيّة وحيويّة وناشطة.
يذهب شبستري إلى قبول المعنى الثاني مِن الشريعة فقط، وهو الذي يمكن أنْ يكون منسجمًا مع التجربة الإيمانيّة وسيّالًا وحيويًّا. إنَّ لازم هذا التفكيك، هو اعتباره ملاكًا ومعيارًا لتقييم الشريعة، والانسجام مع إحياء التجربة الدينيّة للمسلمين، والحفاظ على حيويّته. وعلى هذا الأساس، يتمّ الفصل بين حقل الفقه الذي يمثّل مبدأ لنظام حقوقي، وبين الشريعة بوصفها مِن المظاهر العمليّة للتجربة الدينيّة. إنَّ الفقه يعمل على تنظيم العلاقات الدنيويّة للأفراد فيما بينهم على مختلف السطوح والمستويات، بيد أنَّ العمل به ليس ملاكًا للتديّن؛ وإنَّما الذي يرتبط بالدين والتديّن، هو أنْ يتّضح
ما هو السلوك الذي يقوّي التجربة الدينيّة، وما هو السلوك الذي يعمل على إضعافها.
إنَّ الخلل الأهم الذي تعاني منه هذه النظريّة، والذي تعاني منه الاتجاهات المتمرکزة على التديّن بشكل عام، هو الخلل الذي يتّجه إلى مبنى معرفته الدينيّة. إنَّ هذا الاتجاه حوّل الدين إلى تجربة دينيّة، وعلى هذا الأساس فقد تورّط في الكثير مِن المشكلات.
إنَّ مِن بين الإشكالات التي يتمّ توجيهها إلى القائلين بأنَّ جوهر الدين عبارة عن تجربة دينيّة، هو أنَّهم يخفّضون الدين إلى حدود التجربة الدينيّة، ويعتبرونها في مقام التعريف مساوية لتجربة الشخص المتديّن. مِن ذلك، أنَّ وليم جيمس ـ على سبيل المثال ـ يُعرّف الدين قائلًا:
«التأثيرات والمشاعر والأحداث التي تقع لكلّ إنسان في عالم العُزلة، بعيدًا عن كلّ التعلقات، بحيث يُدرك الإنسان مِن هذه المجموعة أنَّ هناك علاقة بينه وبين ذلك الشيء الذي يعتبره أمرًا إلهيًا».
إنَّ التجربة الدينيّة أمر شخصي وحالة باطنيّة، في حين أنَّ الدين مجموعة مِن القوانين والتعاليم النازلة مِن الله سبحانه وتعالى، وهذه النظرة إلى الدين تنطبق في الحدِّ الأدنى على الدين الإسلامي، ولا يمكن للمؤمنين بهذا الدين
أنْ يحيدوا عنها أبدًا. إنَّ الإشكال الرئيس الذي يرِد على هذه التحويليّة بشكل عام، والنزعة التحويليّة الدينيّة في هذا الشأن (خفض الدين إلى مستوى التجربة الدينيّة)، هو أنَّ المجموعة المركّبة تنخفض إلى مستوى واحد مِن أجزائها ولوازمها. ولذلك، فإنَّ الأحكام واللوازم الصادرة، والدراسات المنجزة بعد هذا التحويل المذكور آنفًا، لن تكون هي أحكام ولوازم المجموعة المركبة؛ بل هي مجرّد أحكام ذلك الجزء أو تلك الحالة، في حين تمّت تسرية هذه الأحكام والعوارض إلى الكلّ. وبعبارة أخرى: إنَّ المركّب ـ في الدراسات القائمة على النزعة التحويليّة ـ لا يتمّ لحاظه مِن حيث هو مركّب وبلحاظ مجموعه، بل يتمّ الإصرار فيه على جزء واحد، وتتمّ دراسة ذلك الجزء فقط. ونتيجة لذلك، فإنَّ كلّ ما تتمّ دراسته بشأن الجزء، يُنسب إلى الكلّ. ولهذا السبب، فإنَّ النتيجة التي يتمّ بيانها تفقد محتواها؛ إذ في هذا النوع مِن الرؤية تتمّ الغفلة أو التغافل عن تأثير سائر العناصر وارتباطها ببعضها، وعن الاختلاف الموجود بين المركّب وجزئه بشكل عام.
كما تمَّ تحويل الدين إلى التجربة الدينيّة حتّى بشأن الحالة الراهنة؛ في حين أنَّ التجربة الدينيّة حالة متأخّرة عن تبلور المعرفة الدينيّة، وتتشكّل ويتمّ تبويبها على أساس المعتقدات والأفكار والأعمال.
إنَّ الإشكال الرئيس الذي يتّجه على اعتبار جوهر الدين تجربة دينيّة، هو اختلاف مراتب التجربة الدينيّة لدى المتديّنين. في هذه الرؤية، يتمّ اعتبار حتّى الشريعة والدين المنزل على النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله تجربة دينيّة. والآن يرِد هنا
(115)
هذا السؤال القائل: ما هو الملاك في صدق التجربة الدينيّة؟ ولو تناقضت التجربة الدينيّة بين شخصين، فأيّ التجربتين تكون هي الحجّة؟ هل يمكن تقييم التجربة الدينيّة بغربال منطقي؟ ثم إنَّه على فرض القول بالاتجاه البنيوي في التجربة الدينيّة، فإنَّ أصل الوحي وواقعيّة التجربة الدينيّة وتجلّي الله تعالى لعامل التجربة يخضع للتشكيك؛ إذ يحتمل أنْ لا يكون لأصل خطاب التجربة الدينيّة أيّ وجود في العالم الخارجي. وفي هذه الحالة، يقترب مدخل التجربة الدينيّة مِن مدخل الوحي النفسي. وكذلك، فإنَّ وحي وشهود الأنبياء يتمّ تنزيله ليلامس حدود التجربة الإنسانيّة والعاديّة وحيث أنَّ لكلّ فرد تجربته الخاصّة، لا يمكن تحديد ملاك خاصّ لإثبات صدق وكذب القضايا المستنبطة مِن التجربة الدينيّة المعيّنة؛ هذا في حين أنَّ التجربة الدينيّة لشخص النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ، تعتبر أمرًا ثابتًا ومِن ذاتيّات الدين الإسلامي، حتّى مِن قبل القائلين بالتجربة الدينيّة أيضًا.
إنَّ مِن بين الإشكالات الأخرى التي ترِد على اعتبار جوهر الدين تجربة دينيّة، هو هل يجب لحاظ التجربة الدينيّة للنبيّ على المستوى العملي، أم أنَّ وظيفة العمل بالتجربة الدينيّة أمر شخصي؟ وبعبارة أخرى: كيف يمكن لمن يعتبر التجربة الدينيّة هي جوهر الدين، أنْ يُلزم نفسه بواحد مِن الأديان التاريخيّة؟ ولو أنَّ صاحب التجربة وجد تجربته الدينيّة متناقضة مع التجربة الدينيّة
للنبيّ، هل سيُثبت الحجيّة لتجربته الخاصّة، أم يبقى قائلًا بحجيّة تجربة النبيّ الأكرم، ويرفض القول بحجيّة تجربته الخاصّة؟
والنتيجة هي أنَّ مِن بين اللوازم المترتّبة على القول باعتبار جوهر الدين تجربة دينيّة، القول بأنَّ الدين أمر شخصي ونفي النبوّة عن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله. وفي مثل هذه الحالة، لن يكون لختم النبوّة، بل لأصل النبوّة معنى؛ إذ يمكن لكلّ شخص أنْ يدّعي النبوّة، وكلّ مَنْ يشعر بوساطة تجربته الدينيّة أنّه مأمور، يمكن بعد إعرابه عن مثل هذا الإحساس والشعور أنْ نعتبره نبيًّا.
كيف تؤدّي التجربة الدينيّة إلى ظهور الشريعة؟ إنَّ شرط التجربة الدينيّة، هو أنْ يكون الله سبحانه وتعالى أو الحقيقة الغائيّة موضوعًا لتلك التجربة أو تُفهم بوصفها موضوعًا لتلك التجربة. بمعنى: إنَّ الشخص يعتبر متعلّق هذه التجربة كائنًا أو حضورًا يفوق الطبيعة ـ أي إنَّه هو الله سبحانه وتعالى أو تجليّاته في الظواهر والأفعال ـ أو يراه كائنًا مرتبطًا بالله تعالى بشكل وآخر ـ مِن قبيل: تجلّي الله سبحانه وتعالى أو شخصيّة مثل شخصيّة مريم العذراءعليهاالسلام ـ أو يظنّها حقيقة غائيّة، حقيقة تتعذّر على الوصف، مِن قبيل: الأمر المطلق غير الثنوي [برهمن] أو النيرفانا.
وفي هذه الحالة، كيف يمكن اعتبار أخلاقيّات وتشريعات الدين جزءًا
مِن التجربة الدينيّة للنبي الأكرم صلىاللهعليهوآله؟ إنَّ الذي يقول بأنَّ جوهر الدين هي التجربة الدينيّة، لا يمكنه إلّا أنْ يعدّ بعض حالات النبيّ جزءًا مِن تجاربه الدينيّة؛ إذ تصف الله سبحانه وتعالى. وأمّا سائر أركان الدين، فيجب نسبتها إلى شخص النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، وذلك لا مِن حيث أنَّه نبيّ. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تعريف التجربة الدينيّة والعرفانيّة بأمور غير قابلة للبيان، وبوصفها «موضوعًا للشعور الأبكم والأصم». إنَّ هذا النمط مِن فهم الوحي واعتباره تفسيرًا مِن قبل النبيّ لمحتوى تجربته، لن تكون نتيجته سوى اعتبار الأمور التشريعيّة والأخلاقيّة للدين أمرًا بشريًّا؛ في حين أنَّ هذا النوع مِن التعاطي مع الدين، يعني إلغاء ونفي أكثر القضايا الدينيّة، واعتبار الجزء الأعظم مِن الدين أمرًا بشريًّا.
إنَّ هذه الرؤية تقلّل مِن الدين بحيث يتمّ إنكار حتّى ضرورة وجوده أيضًا. ومِن خلال سلوك هذا الاتّجاه، يجب حمل الجزء الكبير مِن الدين ـ الأعمّ مِن المعتقدات والأحكام والأخلاقيّات التي هي عبارة عن أمور تصف الآخرة، وتصدر الأحكام الاجتماعيّة، وتتحدّث عن الأمور الغيبيّة والماورائيّة ـ على المجاز. وبعبارة أخرى: إنَّ الأصول الآنف ذكرها تُحمل بأجمعها على التمثيل، ولا يمكن لنا أنْ نتصوّر أيّ حقيقة غيبيّة أو ماورائيّة لها. وعلى أساس هذا الافتراض والاتجاه، لا نعود بحاجة إلى نظام معقّد باسم الدين، وعليه سيكون الإصرار الكبير مِن قبل أئمّة الدين على الاهتمام بالتشريعات والقوانين الدينيّة، وجميع التعاليم والمفاهيم التي أرساها رسول الله صلىاللهعليهوآله في عصره، لاغيًا
ولا ينطوي على حكمة، وسوف تكون للأديان الإبراهيميّة والتوحيديّة حجيّة متكافئة ومتساوية في عرض الأديان الأرضيّة والشرقيّة.
تركّز الأنظار الذهنيّة على الفصل والتفكيك بين الإيمان والعمل؛ بمعنى أنَّها تعطي الأهميّة والقيمة للإيمان والحالة الباطنيّة للفرد، ولا تمنح للعمل دورًا كبيرًا في الهداية والرشاد؛ في حين أنَّ الرجوع إلى النصوص الدينيّة يثبت ويؤكّد أنَّ هذين الأمرين لا ينفصلان عن بعضهما. صحيح أنَّ العمل دون إيمان لا يعني غير الرياء، ولكنْ لا بدّ مِن الالتفات إلى أنَّ الإيمان مِن دون عمل في الظروف العاديّة لن يجدي شيئًا أيضًا؛ وذلك لأنَّ حقيقة الإيمان ليست مجرّد العلم والمعرفة، بل لا بدّ للإنسان ـ بالإضافة إلى ذلك ـ أنْ يسلّم نفسه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنْ يُلزم نفسه بالعمل بلوازم ذلك الإيمان، ولأنَّ الإيمان اختياري والعمل ليس اختياريًّا. أجل، إنَّ الإيمان إنَّما يتحقّق إذا أعدّ الشخص قلبه اختيارًا ليؤمن بالله سبحانه وتعالى إلهًا له، وأنْ يلتزم بلوازم هذا الاعتقاد والإيمان. وعلى هذا الأساس، لا يصحّ القول بأنَّ الإنسان يمكن له أنْ يؤمن ولا يعمل بما يقتضيه هذا الإيمان؛ لأنَّ العمل هو ثمرة الإيمان، وحيث تتوفّر الظروف الخارجيّة لذلك ويتّجه التكليف إلى الشخص، يجب على المكلَّف أنْ يحقّق هذا التكليف على أرض الواقع.
ومِن ناحية أخرى، هناك علاقة تبادليّة بين الإيمان والعمل، وهناك تأثير وتأثّر مِن قبل كلّ واحد مِن هذين المفهومين على الآخر. إنَّ تلوّث ودنس الأخلاق، لا يؤدّي إلى الحيلولة دون إيمان الشخص أو يؤدّي إلى ضعف إيمانه فحسب، بل وقد يؤدّي حتّى إلى سلب إيمانه أيضًا؛ وعلى الرغم مِن إيمانه وعقده العزم على العمل بمقتضى إيمانه، إلّا أنَّه سوف يصل بالتدريج إلى حيث يفقد إيمانه بشكل كامل. وقد حذّر الله سبحانه وتعالى الإنسان ـ في القرآن الكريم ـ مِن مغبّة هذا النوع مِن الأخطار التي قد تحيق به بسبب عدم العمل بمدلول الإيمان. وفي الأساس، فإنَّ الإيمان هو مصدر القيام بالأعمال الصالحة. وفي المقابل، فإنَّ القيام بالعمل الصالح يؤدّي بدوره إلى زيادة الإيمان، كما أنَّ العمل الطالح يؤدّي بدوره إلى سلب الإيمان والعياذ بالله.
1. لقد ورد استعمال الذاتي والعرضي في كلام محمّد مجتهد شبستري بمعنيين، وهما:
أ) المقصود بالذات.
ب) التجربة الدينيّة.
وفي الرؤية الأولى يتمّ لحاظ الدين مِن زاوية القصد، ويكون المراد مِن ذاتي الدين المقاصد مِن الدرجة الأولى، وذاتي الدين، ويتمّ التعريف
بالمقاصد الوسيطة، والتي هي مِن الدرجة الثانية، بوصفها مِن عرَضيّات الدين. وفي الرؤية الثانية، يتمّ اعتبار جوهر الدين تجربة دينيّة، وتمّ التعريف بتشريعات الدين بوصفها أمورًا عرَضيّة وتابعة للشرائط والظروف الاجتماعيّة. إنَّ التجارب الدينيّة أمور حيويّة وشخصيّة وخفيّة وغير ثابتة، وهي تابعة للشخص بشكل كامل, وإنَّ ملاك التديّن هو العمل على أساس هذه التجارب، وليس التمسّك بالأطر العمليّة والقواعد التشريعيّة التي ترسّخت عبر الزمن.
2. هناك إمكان للبحث والنقاش حول ما إذا كان هذان الرأيان مختلفين عن بعضهما بشكل كامل، أو هناك إمكان للجمع بينهما. يبدو أنَّ نظريّة «المقاصد بالذات»، قد تمّ طرحها بسبب المعضلات التي تعاني منها نظريّة التجربة الدينيّة، وأنَّ مهمتها إظهار وجه الاشتراك بين التجارب المتباينة مِن حيث الماهية بشكل كامل. وقد استفاد محمّد مجتهد شبستري مِن «المقصود بالذات»، الاستفادة ذاتها التي حصل عليها في إعادة تعريف مفهوم الوحي على أساس الرؤية الغائيّة.
3. هناك بعض الغموض والإبهامات والأسئلة الجادّة أمام نظريّة المقصود بالذات: فأوّلًا: هل المقصود بالذات هو الذاتي؟ وثانيًا: هل تعدّ الظاهراتيّة التاريخيّة أسلوبًا معتبرًا في كشف المقاصد بالذات؟ وإذا كان توظيف هذا الأسلوب متناقضًا مع كلمات أصحاب الشريعة في مختلف المراحل الزمنيّة، هل يكون التقدّم لها أم لكلام أصحاب الشرائع؟ وأخيرًا: ما هو منطق الوصول مِن المقصود بالذات إلى ذاتي الدين؟ وكيف تمّ اجتياز هذا الطريق في ضوء هذه النظريّة؟
4. إنَّ اتّخاذ التجارب الدينيّة بوصفها جوهر الدين، ينطوي على آفات، ومِن بين هذه الآفات تحويل الدين ـ بوصفه أمرًا مركّبًا ـ إلى جزئه. ومِن الآفات الأخرى، عدم وجود ملاك للدلالة على حجيّة التبعيّة لتجربة الآخر ـ وإنْ كان نبيًّا ـ . وقصور هذه الرؤية عن بيان كيفيّة ظهور الشريعة مِن التجربة الدينيّة في الدين الإسلامي، يُعدّ مِن الآفات الأخرى التي تعاني منها هذه النظريّة.
- بيترسون، مايكل، وآخرون، عقل و اعتقاد دينی: درآمدی بر فلسفه دين (العقل والاعتقاد الديني: مدخل إلى فلسفة الدين)، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: أحمد نراقي وإبراهيم سلطاني، طهران، طرح نو، 1385ه.ش.
- جوادي آملي، عبدالله، دين شناسي (معرفة الدين)، قم، نشر إسراء، 1387ه.ش.
- جيمس، وليم، دين و روان (الدين والروح)؛ ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: مهدي قائني، قم، دارالفکر.
- سروش، بسط تجربه نبوي (بسط التجربة النبويّة)، طهران، نشر صراط، 1385ه.ش.
- عرب صالحي، محمّد، «ذاتی و عرضی در دين» (الذاتي والعرضي في الدين)؛ مجلّة معرفت کلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1390ه.ش.
- قدردان قراملكي، محمّد حسن، آئين خاتم (الدين الخاتم)، طهران، سازمان انتشارات فرهنگ و انديشه اسلامی، 1386ه.ش.
- كاشي زاده، محمّد وقدردان قراملكي، محمّد حسن، «تحلیل ذاتی و عرضی دین از منظر نومعتزله»؛ مجموعه مقالات جریان شناسی ونقد اعتزال نو: اعتزال نو ومسائل فلسفه اسلامی (التحليل الذاتي والعرضي للدين مِن زاوية المعتزلة الجدد: مجموعة مقالات معرفة التيّارات ونقد الاعتزال الجديد: الاعتزال الجديد ومسائل الفلسفة الإسلاميّة)، طهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1393ه.ش.
- اللاهوري، محمّد إقبال، بازسازی انديشه دينی (إصلاح التفكير الديني)، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: محمّد بقائي ماکان، طهران، نشر ماكان، 1368ه.ش.
- مجتهد شبستري، محمّد، نقدی بر قرائت رسمی از دين (نقد على القراءة الرسمية للدين)، طهران، طرح نو، 1379ه.ش.
- مصباح اليزدي، محمّد تقي، اخلاق در قرآن (الأخلاق في القرآن)، ج 1، قم، مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خميني، 1384ه.ش.
- ملكيان، مصطفى، مشتاقي و مهجوري: گفت وگوهائی در باب فرهنگ وسياست (الشوق والهجران: حوارات في حقل الثقافة والسياسة)، طهران، نگاه معاصر، 1380ه.ش.
- نصري، عبدالله، يقين گم شده: گفت و گوهائی درباره فلسفه دين (اليقين الضائع: حوارات حول فلسفة الدين)، طهران، نشر سروش، 1380ه.ش.
- نصري، عبدالله، كلام خدا: تحليل و نقد ديدگاه روشنفکران دينی درباره وحی و تجربه دينی (كلام الله: تحليل ونقد رؤية المستنيرين الدينيين بشأن الوحي والتجربة الدينيّة)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1387ه.ش.
- Ayers, M; “Substance”, In Routledge Encyclopedia of Philosophy; New, E. Craig York: Routledge, 1998.
- Whehmeire, S; Oxford Advance Learners Dictionary, 6th ed.); New York: Oxford, 2003.
(124)محمّد كاظم شاكر، السيّد روح الله شفيعي
بناءً للاعتقاد الشائع بين المسلمين، القرآن الكريم هو كلام الله المجيد والمتحدّث عن حقائق أنزلها الله على نبي الإسلام صلىاللهعليهوآله في إطارٍ لغوي مكونٌ بذلك نصٍ يُدعى القرآن. ومع تطوّر العلم البشريّ في مجالات فلسفة اللغة والألسنيّة، وكذلك ظهور بعض السياقات العمليّة والنظريّة في عالم الإسلام المعاصر؛ برزت أفكار وتصوّرات متفاوتة في هذا الخصوص. القراءة النبويّة للعالم هي عنوانٌ لسلسلة مِن الكتابات التي تتّبع عرض وجهة نظرٍ مختلفة عن الوحي القرآني. ومِن الأسئلة التي يحاول هذا الطرح الإجابة عنها بشكلٍ مختلف حول الاعتقاد الشائع الآنف الذكر، مَنْ هو راوي القرآن والمتحدّث
به؟ فمِن منظار هذا الطرح؛ النبيّ صلىاللهعليهوآله هوالمتحدّث بالقرآن وراويه. ويقيم هذا الطرح مِن أجل ادّعائها مجموعةً مِن الاستدلالات والحجج التي سيشكّل التأمّل حول إحداها ـ الاستدلال اللغوي ـ موضوعَ هذه المقالة. ولهذا السبب، سوف تصوغ هذه المقالة أوّلًا الاستدلال المذكور ثمّ تقيس المقدّمات الكبرى لفلسفتها اللغويّة والألسنيّة. وتدلّ التأمّلات في هذا الخصوص على أنّ الاستدلال المذكور يواجه بعض التحدّيات والعيوب التي تجعل مِن تقبّله والاعتراف به أمرًاصعبًا.
«القراءة النبويّة للعالم» هي عنوانٌ لسلسلة مِن الكتابات لمحمّد مجتهد الشبستري، والتي تعبّر عن فكرة ونظرة خاصّة ومختلفة حول الوحي القرآني وعمليّة فهمه وتفسيره. ويسعى هذا الطرح إلى الإجابة عن سؤالين: 1. «مَنْ هو راوي القرآن والمتحدّث به؟» 2. «ماذا» قال ذلك الراوي؟ ورغم أنّ أيًّا مِن هذين السؤالين ليس بجديد؛ ولكنْ تعتبر إجابات «القراءة النبويّة للعالم»، ومنهجيّة توصّل هذا الطرح إلى تلك الإجابات؛ جديدة وفريدة. وأحد أبرز خصائص هذا الطرح، والتي تجعله متمايز عن سائر التصوّرات الجديدة والمختلفة؛ أسسه المعرفیّة ـ وخاصّةً استناده إلى القضايا الجديدة في اختصاصات الألسنيّة؛ فلسفة اللغة والهرمنيوطيقا الفلسفيّة والأدبيّة. وللطرح الآنف الذكر، ادّعاءان إيجابيّان أساسيّان حول السؤالين السابقين:
[2]. مجتهد شبستري، «چرا عنوان «قرائت نبوی از جهان» را کنار گذاشتم؟».
(126)1. إنّ «المتحدّث» بالقرآن وراويه هو النبيّ صلىاللهعليهوآله، 2. إنّ «طبيعة» كلام القرآن هو القراءة (الفهم) والرواية. ونتيجة هذين الادّعاءين أنّ: «القرآن هو قراءة ورواية النبيّ صلىاللهعليهوآله عن العالم». وقد أقام هذا الطرح لأوّل مرّة حجج واستدلالاتٍ عدّة يمكن وضعها ضمن ثلاث فئات: انطولوجيّة، لغويّة وهرمنيوطيقيّة. وسوف يقتصر تأمّل هذه المقالة وبحثها على الفئة الثانية؛ أي الفئة اللغويّة؛ إذ إنّ البحث في حجج واستدلالات الفئتين الأخريين، وكذلك تقييم الادّعاء الثاني، كلٌّ يحتاج إلى مجالٍ منفصلٍ لا يسعه المجال في هذه المقالة.
الادّعاء الأوّل للقراءة النبويّة للعالم، هي أنّ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله هو راوي القرآن. بعبارةٍ أخرى: القرآن هو كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله. مِن وجهة نظر هذا الطرح، وبالاستناد إلى إنجازات اللسانيّات وفلسفة اللغة؛ لا يمكن اعتبار القرآن كلام الله مِن خلال قيودٍ مثل «لوحده»، «مباشرةً» و «مِن دون وساطة». وترتفع وتیرة العمل في هذا الوسط، عندما يكون التأكيد على نبويّة الكلمات القرآنيّة. وهكذا يتّضح الادّعاء
(127)الأوّل لـ «القراءة النبويّة...»: راوي القرآن والمتحدّث به، أوّلًا هو النبيّ صلىاللهعليهوآله، ومِن ثمّ الله. إذاً، القرآن هو كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله بدايةً. ونقطة ارتكاز الاستدلال اللغوي لهذا الطرح هو تقديم تعريفٍ جديدٍ عن «اللغة»:
«اللغة نظامٌ مِن أشكال التعبير، أوجده الإنسان وطوّره. ويطرح الإنسان هذا النظام ليعبّر به عن نفسه ويجعل نفسه مفهومةً للآخرين كما الآخرين مفهومين بالنسبة له، وليجسّد معارفه مِن خلال ذلك النظام ويُطلع الآخرين عليها، وليتحدّى عن طريقه أنواعًا مختلفة مِن الواقع، أو ليتماشى مع هذا الواقع».
وبعد هذا التعريف الذي طبقًا لصاحب فكرة «القراءة النبويّة....» مستوحىً مِن كيلر فيلسوف اللغة الألماني ـ يشير إلى الإطار العام (= نظام مِن أشكال التعبير) للغة، وإلى موجِدها (= الإنسان)، وظيفتها (= التعبير) وأركانها (= الراوي، المستمع، السياق، المجتمع والمضمون).
وفي الخطوة الثانية، يؤكّد هذا الطرح على أنّ اللغة «إنسانيّة/بشريّة تمامًا»؛ بمعنى أنّه لا سبيل لأيّ «غير إنساني» إليها. لا يمكن للّغة أنْ تظهر وتُعطي المعنى وتُفهم في عالمٍ غير بشري، بل إنّ كلّ ما ذُكر لا يمكن أنْ يتحقّق إلّا في مسار حياة البشر وفي عالمهم الذهني المشترك.
اللغة هي ظاهرة أنثروبولوجيّة/إنسانيّة جماعيّة، ولا تتحقّق إلّا عندما تتوفّر كلّ تلك الأركان والمقوّمات، ومع فقدان بعضها سيتمّ القضاء
(128)عليها تمامًا.
والكلام ذو المغزى ـ كما يمكننا تصوّره نحن البشر ـ هو ذلك الشيء يظهر في عالم البشر وبوساطة البشر، وفي خضمّ الحياة الاجتماعيّة ـ التاريخيّة للبشر وسياقها، وليس شيئًا آخر.
ويصرّح صاحب «القراءة النبويّة...»، في هذا القسم مِن استدلاله بدینه لأفكار فيتغنشتاين:
«إنَّ المزيد مِن التأمل في هذا الموضوع واستكشافه الشامل، هو الذي أوصل فيتجنشتاين، في مرحلته الفلسفيّة الثانية، إلى استنتاجٍ مفاده أنّ الكلام هو جزءٌ مِن أسلوب حياة الإنسان وسلوكه، وبالتالي طرح نظريّة ألعاب اللغة».
على هذا الاساس، إنّ معنى اللغة وفهمها بأكملها مناطٌ بكيفيّة استخدامها في لعبةٍ لغويّة، وهذا في حدّ ذاته يظهر في سياقٍ تاريخيٍ ـ اجتماعي محدّد.
إذاً، تستند «القراءة النبويّة...» إلى مفاهيم «الألعاب اللغويّة» و«أشكال الحياة» لفيتغنشتاين. في الجانب الإيجابي مِن هذا الاستنتاج، ضرورة «إنسانيّة» جميع مكوّنات اللغة وجانبها السلبي هو رفض «عدم إنسانيّة/بشريّة» إحداها.
(129)وفي هذا الصدد، يستند هذا الطرح إلى الجملة المشهورة لفيتغنشتاين:
«لو تكلّم الأسد، فلن نستطيع أنْ نفهمه».
ويمكننا أنْ نسمّي هذا القسم مِن استدلال صاحب فكرة «القراءة النبويّة...»، مركزيّة الإنسان اللغوي. مِن وجهة نظر هذا الطرح، اللغة هي لعبة إنسانيّة بالكامل، ولا تجد معناها إلّا في ذلك الشكل مِن الحياة البشريّة التي تُستخدم فيها.
وأمّا الخطوة الثالثة، فهي تشير إلى أحد عناصر اللغة؛ أي «المتكلّم/الراوي»، والتذكير بدوره في أيّ فعلِ اتصالٍ لغوي، دورٌ يشير إليه صاحب «القراءة النبويّة...» في اقتباسه مِن تعريف كيلر للّغة، وأيضًا مِن اقتباساته الأخرى مِن نموذج الارتباط اللغوي لجاكوبسون:
«مِن غير الممكن تحقّق نصٍّ بلغةٍ إنسانيّة، مِن دون متكلّم ـ وهو الإنسان ... على كلّ حال، يتوقّف تحقق اللغة الإنسانيّة على رواية إنسانٍ».
ويسعى صاحب «القراءة النبويّة...» حتّى إلى إسناد التأكيد على دور المتكلّم البشري ومكانته في اللغة إلى سوسّور. وأساس هذا الانتساب،
(130)تفكيك سوسّور بين «اللغة» و«الكلام».
إذ يوضّح صاحب «القراءة النبويّة..» مُراد سوسّور بما يلي:
«وكما يقول سوسّور؛ لا تنشأ اللغة مِن دون كلام، ونحن نعلم أنّ الكلام هو دائمًا كلام متكلّم ما. إذن يجب أنْ نقول؛ اللغة لا تنشأ مِن دون متكلّم. وفي هذه الحال، لا يمكننا التصوّر أنّنا سنواجه نصًا لغويًّا ذي بنيةٍ، مِن دون افتراض وجود الكلام البشري والمتكلّم البشري ـ بدون واسطة أو بواسطة ـ في إعطائه للمعنى».
إلى هنا، تمّ توضيح المقدّمات الكليّة والكبرى للاستدلال اللغوي الذي أقامه صاحب «القراءة النبويّة...» مِن أجل ادّعائه. وحان الوقت الآن لهذا الطرح أنْ يتعمّق في مقدّماته الجزئيّة والصغرى، ليستنتج تحديدًا ملاحظاته حول «القرآن».
الخطوة الأولى، هي أنّه لا شكّ في أنّ القرآن نصٌ لغوي. إذاً، القرآن بصفته نصًّا لغويًّا، لا يمكن استثناؤه مِن كلّ ما ذُكر لغاية الآن. وبما أنّ القرآن هو ظاهرة لغويّة، لذا سوف يصدق عليه كلّ ما قيل حول سائر الظواهر اللغويّة والنصيّة. وما يؤكّد عليه صاحب «القراءة النبويّة...»، امتلاك القرآن لمتكلّم وراوٍ بشريّ:
(131)«إذا كان مِن المفترض مثلًا تفسير نصّ القرآن، بصفته كلام الله أو النبيّ صلىاللهعليهوآله، إذن لا مفرّ مِن البحث حول راو للقرآن والمتحدّث به (الماتن). يجب أنْ نسأل؛ مَنْ هو راوي القرآن؟ والحقيقة هي أنّ كلّ نصٍّ مقدّس، يؤسّسه إنسانٌ ما كنصّ. ذلك الشخص الذي يقرأ نصًا ويقول إنّه سمعه مِن ملاكٍ أو مِن الله، أو أنّ الله قد جعله قادرًاعلى قول هذا النصّ، أو أنّ الله قد وضع هذا النصّ في فمه وما شاكل ذلك، فهذا الشخص، مع ادّعاءات الفهم التي لديه، سوف يؤسّس هذا النصّ في المجتمع والتاريخ كشكّلٍ مِن أشكال فهمه، وسيجعله على ما هو عليه».
وهكذا، القرآن أيضًا، كنصٍّ لغويّ محدّد، مثله مثل أيّ نصٍّ لغويٍ آخر؛ يجب أنْ يكون لديه متحدّث بشريّ. وهكذا، یتّضح وجوب الإسناد الحقيقي للقرآن لإنسانٍ متحدّثٍ به. إذا كان القرآن بمثابة نصٍّ لغوي، يجب أنْ يكون لديه متحدّث، ويجب أنْ يكون ذلك المتحدث إنسانًا. إذاً، يجب التوجّه إلى ذلك الإنسان المتحدّث به وسؤاله عنه. ولكنْ تاريخيًّا، إنّ الإنسان الوحيد الذي أُسند إليه القرآن هو النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله؛ إذاً القرآن كلامه:
«لأنّه مِن وجهة نظر المسلمين، يعتبر الإسناد التاريخي لنصّ القرآن إلى نبيّ الإسلام صلىاللهعليهوآله مِن المسلّمات والضروريّات ... [إذن] الفرض
المعقول ـ بل الذي لا بدّ منه ـ هو أن نقول أنّ هذا النصّ هو كلام [إنسانٍ]، يعني كلامٌ أدّاه النبيّ صلىاللهعليهوآله...».
تتعرّض هذه المقالة فقط إلى التأمّل في المقدّمات الكبرى للحجج والاستدلالات الآنفة الذكر. والرسم البياني التالي يتضمّن خلاصة عن هذه المقدّمات:
| القضية | الاستنادات |
|
اللغة، ظاهرة إنسانيّة تمامًا |
تعريف كيلر للغة |
|
← (2) إذا كان للغة أجزاء وعناصر؛ فكلّها إنسانيّة أيضًا |
مفهوم الألعاب اللغويّة وأشكال الحياة لفيتغنشتاين |
|
(3) للّغة أجزاء وعناصر والمتحدّث إحداها |
تعريف كيلر للّغة النموذج السداسي الأجزاء لـ«جاكوبسون» تفكيك سوسّور بين اللغة والكلام |
|
← (4) الإنسان هو فقط مَنْ يمكنه التحدّث باللّغة |
شكل الاستدلال |
يبدأ صاحب «القراءة النبويّة...» استدلاله اللغوي بتقديم تعريفٍ للّغة. ولكنَّ هذا التعريف ليس فعّالًا بمفرده، ويواجه الاستناد إلى ذلك عيبين منطقيين بالحدّ الأدنى. القصور المنطقي الأول، هو «عدم التحرّر مِن الافتراض
المسبق». وكما تمّت الإشارة سابقًا، إنَّ نقطة ارتكاز الاستدلال اللغوي لصاحب «القراءة النبويّة...»، هو التعريف المقدّم عن اللغة، ونتيجته وجوب إنسانية المتحدّث. ولكنَّ وجوب إنسانيّة اللغة وإنسانيّة المتحدّث، هما مِن الافتراضات المندرجة في التعريف المذكور، والافتراض يبقى في حدّ ذاته مجرد ادّعاء، ولا يمكن إثباته مِن دون إضافة مقدّمةٍ أخرى منسوبة إلى فيتغنشتاين. ويمكن إعادة بناء العمليّة المنطقيّة للاستدلال الآنف الذكر كالآتي:
لماذا يجب أنْ 1. يكون للقرآن متحدّثٍ إنساني؟
2. لأنَّ القرآن نصٌّ لغوي،
و
3. كلُّ نصٍّ لغويّ يجب أنْ يكون له متحدّثٌ إنساني.
4. لماذا يجب أنْ يكون لكلّ نصٍّ متحدّثٌ إنساني؟
5. لأنّه قد جاء في تعريف اللغة أنّ اللّغة ظاهرةٌ إنسانيّة،
و
6. المتحدّث أيضًا هو أحد أركان مبتکري اللغة.
7. لماذا جاء في تعريف اللّغة بأنّ اللغة هي ظاهرة إنسانيّة؟
8. لأنّ أفكار فيتغنشتاين أشارت إلى هذا الأمر.
إذا ما حذفنا شذرة رقم (8) مِن العمليّة أعلاه، سوف يعاني الاستدلال مِن عيبٍ منطقي، ولكنْ بإضافته إلى العمليّة، تمّ رفع ذلك العيب. إذاً، للشذرة (5) دورٌ مؤثّر في حجّة واستدلال هذا الطرح.
(134)كذلك في التعريف المذكور، تمّ تقديم «الإنسان» منذ البداية على أنّه المبتکر والمطوّر للّغة والتعبير عن البشر وجعلهم مفهومين كوظائف للّغة. ومِن الواضح، أنّه بناءً على ذلك، وفي نهاية عملية الاستدلال أيضًا، سيكون المتحدّث باللغة ـ بصفته جزءًا منها ـ هو الإنسان. ولكنَّ افتراض إنسانيّة اللغة هو «استقراءٌـ تجريبي». وهنا يظهر أيضًا العيب المنطقي مِن خلال «مصادرة المطلوب»، وخاصةً أنّه لم يُذكر في التعريف المذكور، أنّ اللغة «لا يمكن» أنْ يكون لها متحدّثٌ غير الإنسان. مِن هنا، مقابل قاعدة «إثبات الشيء، لا ينفي ما عداه»، لا يمكن الوصول مِن خلال التعريف المذكور إلى وجوب إنسانيّة المتحدّث. لو تمكّن صاحب «القراءة النبويّة ...» مِن تقديم أوّلًا تعريفٍ فلسفيٍّ وشامل للّغة، ومِن ثمّ قسّمها باعتبارٍ ما إلى نوعين إنساني وغير إنساني، وأشار في النهاية إلى عدم إمكانيّة النوع الثاني؛ عندها لكان رُفع العيب المنطقي المُشار إليه.
وهناك مسألةٌ يمكن أنْ تشكّل مقدّمة للقسم الآتي في هذه المقالة، وهذه المسألة هي أنّه على أساس النظريّة المنتخبة مِن قِبل صاحب «القراءة النبويّة ...» (فلسفة اللغة لفيتغنشتاين المتأخّر)، يجب النظر بعين الشكّ والترديد عند إعطاء إطارٍ كلّي لتعريف اللغة أو لطبيعة اللغة. فبدل أنْ يحاول فيتغنشتاين تعريف اللغة، اعتبرها مجموعة مِن الألعاب التي تشترك فيما بينها في «التشابه
(135)العائلي»، وأنّ كلّ واحدةٍ منها كاملةٌ في حدّ ذاتها. وبالتالي، اعتبر بعض المفسّرين أنّه لا يمكن بالأساس اعتماد رأي فيتغنشتاين كتعريفٍ لظاهرة اللغة. ولا يوجد أيّ نقطة أرخميدس خارج اللغة، حتّى يصبح بالإمكان تعريف اللغة بمساعدتها. كذلك، لا ينبغي أنْ ننسى أنَّ تحدّي فيتغنشتاين لموقف أوغسطين تجاه اللغة في بداية كتابه «التحقيقات»، یُرَدّ أيضًا على مقاربته. إنّ مقاربة فيتغنشتاين العلاجيّة للتفلسف أيضًا، تنمّي فيه الاتجاه الحسّي في دارسة اللغة العاديّة، إلى حدٍّ أنّه يتجنّب أيَّ نوعٍ مِن الخوض في اللغة مِن خلال المقاربات الكليّة والمجرّدة، ولذلك فإنّه يعتبر أيّ بحثٍ لطبيعة اللغة أمرًا غير مناسب. فمع تجنّبه لأيّ نوعٍ مِن الفكر الدوغمائي بهذا
(136)الخصوص، يقترح النظر إلى الألعاب اللغويّة كأدواتٍ للمقارنة فقط، حتّى لا يتوفّر السياق مِن أجل تقييد وظائف اللغة المتنوعة. على هذا الأساس، كأنّ صاحب «القراءة النبويّة...» باستناده المتزامن إلى التعريف المُنتخب حول ظاهرة اللغة والاستفادة مِن فلسفة اللغة لفيتغنشتاين المتأخّر، يخضِع إطار استدلاله اللغوي لنوعٍ مِن «عدم التوافق الداخلي».
لقد اتّضحت الأهميّة الكبيرة لاستفادة صاحب «القراءة النبويّة...» مِن أفكار فيتغنشتاين في القسم السابق، بحيث تشكّل هذه الأفكار لبّ كلام هذا الطرح حول وجوب إنسانيّة اللغة تمامًا. ولكنْ، حقًا إلى أيّ حدٍّ يتطابق فهم صاحب «القراءة النبويّة...» مِن هذه الأفكار ـ وخاصةً المقاربة السلبيّة المختارة لهذا الطرح ـ ويلتقي مع كلام فيتغنشتاين وتفسيراته؟ كذلك، على فرض صحّة الفهم المذكور، إلى أي حدٍّ يعتبر هذا الاقتباس فعّالًا وجديرًا مِن أجل إظهار صحّة ادّعاء صاحب «القراءة النبويّة...»؟ هل يعتبر اقتباس مفاهيم «أشكال الحياة» و«الألعاب اللغويّة» مِن أجل إظهار وجوب إنسانيّة تمام العناصر اللغويّة، اقتباسٌ مناسب؟ وأبعد مِن ذلك، هل مفهوما «الألعاب اللغويّة» و «أشكال الحياة» بعيدان عن أيّ نقدٍ؟ إنّه لمن الواضح، أنّ الإجابات عن هذه الأسئلة هو النفي. وفيما يلي مقتطفٌ يبرز خلفيّة ظهور هذين
(137)المفهومين في فكر فيتغنشتاين، وأيضًا بعض التحدّيات التي يواجهانها. والأمر متروكٌ لصاحب «القراءة النبويّة...» ليعلن علاقته بتلك الخلفيّات والسياقات، وكذلك الكشف عن الإجابات المحتملة على تلك التحدّيات.
فيتغنشتاين، في مرحلته المتأخّرة، يغسل فكره مِن فكرة تمثيل اللغة، ويعتبرها نوعًا مِن اللعبة المتّصلة بشكل الحياة. وهو يريد مِن طرح مفهوم «الألعاب اللغويّة»، تحقيق هدفين معًا بالحدِّ الأدنى. الأوّل، التأكيد على اتصال معنى الكلمة باستخدامها. ومِن خلال «الحجّة ضدّ اللغة الخاصّة»، يعتبر فيتغنشتاين بعض القواعد معيارًا للتحقّق مِن استخدام اللغة والناشئة بحدّ ذاتها مِن أشكال الحياة. كذلك، يعتبر المعنى مناطًا بفهم «سياقٍ»، والذي هو مِن أهم عناصره التمتّع بـ «شكل حياةٍ» مشترك. والهدف الثاني، محاولة معالجة التفلسف، وهذا الأمر مِن أبرز خصائص تمام أفكار فيتغنشتاين السابقة والمتأخّرة.
(138)ومع ذلك، فإنّ مفهوم الألعاب اللغويّة، يواجه أيضًا تحدّيات، قد يؤدّي جهلها وعدم معالجتها إلى سوء فهمِ قبولها العام. على سبيل المثال، إنّ نظريّة الاستخدام (بشكلٍ عام) والألعاب اللغويّة (بشكلٍ خاص)، مِن خلال إعادة سرد كيفيّة الإرجاع إلى أسماءٍ خاصّة فقط، تعجز عن إعطاء معنى لتلك الجمل التي يستخدمها ويحفظها المتحدّث فقط عن ظهر قلب أو مِن دون أنْ يفهمها، والاطّلاع على القواعد التي تحكم أجزاء كلامٍ، سوف يتمّ استخدامها في المستقبل، ولم تصبح بعد تعاقديّة. ومِن جهةٍ أخرى، إنّ مقارنة اللغة باللعبة، لهي مقارنةٌ غير صحيحة أيضًا؛ لأنّه يمكن استخدام اللغة مِن أجل الإخبار عن أشياءٍ بلا مصداق (مثل الحصان الأحادي القرن)، ولكنْ في اللعبة لا يمكن القيام بعملٍ ما خارج القاعدة. وكذلك، يمكن للشخص، الذي لم يلعب لعبةً مِن قبل، وليس لديه أيّ معرفة بهذا المفهوم مسبقًا، أنْ يتعلّم معنى اللعبة مِن خلال وصف الألعاب المتنوّعة. ولكنْ، لا يمكن تعليم شخصٍ لم يتكلّم أبدًا، ولا يعلم مفهوم التكلّم أيضًا، أنْ يتعلّم معنى التكلّم مِن خلال وصف مختلف الكلام. ومِن أجل إعادة سرد معنى اللعبة، ليس مِن الضروري أنْ يكون الافتراض المذكور أعلاه أيضًا نوعًا مِن اللعبة. فضلًا عن ذلك، إنَّ معرفة معنى اللعبة، يعني معرفة ما يفعله اللاعبون أثناء اللعب. ولكنْ، مِن أجل معرفة ماهية التكلّم، لا يمكن الاكتفاء بمعرفة ماذا يفعل المتكلّمون أثناء
(139)الكلام. كذلك، لا نظير لسمة «تحديد» قواعد الألعاب المهمّة في اللغة. بعبارةٍ أخرى: الكثير مِن قواعد اللغة يمكن أنْ تكون في معرض التبدّل في سياق التاريخ، ولكنَّ قواعد الألعاب مثل الشطرنج، لا تتبدّل أبدًا في سياق التاريخ. وفي النهاية، مثل هذا التلقّي والفهم، يبقى عاجزًا عن تبرير قدرة اللغة على الإرجاع إلى نفسها، وكذلك قدرة الأفراد والمجتمعات البشريّة مِن أجل ترقّيها ونقد ذاتها.
ليس لمثل هذه التحدّيات أيَّ أثرٍ أو انعكاس لدى صاحب «القراءة النبويّة...». وممّا لا شكّ فيه، أنَّ أهداف فيتغنشتاين الآنفة الذكر في تقديم هذا المفهوم، ليست فقط لا مكان لها بشکلٍ خاصّ في نطاق أهداف هذا الطرح فحسب، بل إنّه على أساس المقاربة العلاجيّة لفيتغنشتاين، سوف «يُلغى» بالأساس معالجة المسألة التي يسعى خلفها صاحب «القراءة النبويّة...». انطلاقًا مِن ذلك، سوف يواجه قبول أحد أهم مبادئ الاستدلال اللغويّ لهذا الطرح صعوباتٍ جديّة.
وحول مفهوم «أشكال الحياة»، فالمسألة أكثر تعقيدًا قليلًا، ويفسّر غريلينغ مُراد فيتغنشتاين مِن هذا المصطلح قائلًا:
(140)الإجماع الضمني للسلوكات اللغويّة وغير اللغويّة، الفروض، الإجراءات، السنن والميول الطبيعيّة التي يساهم فيها البشر ـ بصفتهم موجوداتٍ اجتماعيّة ـ وبالتالي في اللغة التي يستخدمونها، بمثابة افتراضٍ.
ولكنْ، ما هو هدف فيتغنشتاين مِن تقديم هذا المفهوم؟ باختصار يمكن القول: إنّه أراد مِن خلال معالجة مفهوم أشكال الحياة الانتفاض على الباراديغم الحاكم على فلسفة اللغة في زمانه؛ إذ إنّ أهمّ عناصرها ـ الفصل التام بين اللغات العلميّة والعرفيّة، التصوّر الرياضي للّغة والتمثيل اللغويّ، الفكر الحسابي والفهم اللغويّ، إرجاعيّة معنى الكلمة ومفهوم شروط صدق الجُمل ـ وكلّ ذلك يمكن العثور عليه في أفكار فيتغنشتاين الأولى وعند «راسل» و«فريجه».
وقبل التعرّض إلى الجهات الأخرى لهذا المفهوم، لا بدّ مِن التذكير بنقطتين: الأولى، أنّه رغم الأهميّة الكبيرة لأفكار فيتغنشتاين في استدلال صاحب «القراءة النبويّة...»، لا يُرى أيّ إرجاع مباشرٍ إلى فيتغنشتاين في تمام نصّ هذا الطرح، وذلك خلافًا لباقي النماذج (كيلر، سوسّور، جاكوبسون). في الواقع، الإرجاع الواضح الوحيد لهذا الطرح، يعود إلى تفسيرٍ مِن الشذرة
(141)11 القسم 2 مِن كتاب التحقيقات الفلسفيّة. وهناك سببٌ آخر، وهو أنّ أسلوب الكتابة الذي استخدمه فيتغنشتاين في الأيام الأخيرة لفكره، وخاصّة في كتابه «التحقيقات الفلسفيّة»، كان محیّرًا ومربكًا للغاية. ولذلك، يعتبر سوق شرح وتفسير أفكار فيتغنشتاين حارًّا جدًا، وأحيانًا مربكًا، ومضطربًا كثيرًا. ويمكن مشاهدة أحد أوضح النماذج على هذا الاضطراب في القراءات المتعدّدة/ الحصريّة لمفهوم أشكال الحياة. ومِن المهمّ دراسة هاتين القراءتين؛ لما لهما مِن تأثيرٍ كبيرٍ في مركزيّة الإنسان لدى صاحب «القراءة النبويّة...». ولا يشير هذا الطرح إلى القراءات المختلفة لمفهوم أشكال الحياة وإلى دليل صحّة القراءة المختارة، وهذا الصمت، يعتبر في حدّ ذاته عيبٌ؛ لأنّه يعزّز الوهم بأنَّ هذه هي القراءة الوحيدة الممكنة للمفهوم.
ولكنْ ما هي جذور القراءات اللامتوافقة والمتناقضة لمفهوم أشكال الحياة؟ فضلًا عن الأسلوب المعقّد لأفكار فيتغنشتاين وكتابته؛ فقد استخدم هذا المصطلح بصيغتي المفرد والجمع «شكل/أشكال الحياة» في الأيام الأخيرة مِن فكره حوالي خمس وعشرين مرّة، مِن دون أنْ يوضّح منظوره مِن ذلك أبدًا. ولهذا التناقض وعدم التجانس جذور تاريخيّة.
(142)وقد قاس الباحثون في فكر فيتغنشتاين مفهوم أشكال الحياة وفق معايير ثلاث: «بيولوجيّة»، «ثقافيّة» و «سلوكيّة». ويعتبر «كَفِل» المعيار البيولوجي «عموديًّا» والمعيار الثقافي «أفقيًّا». فباعتبار البيولوجي / العمودي، تنفصل أشكال حياة الإنسان عن «غير الإنسان»، وأمّا باعتبار المعيار الثقافي/ الأفقي، تنفصل أشكال حياة الإنسان عن «بعضها» البعض. وعلى أساس المعيار الأوّل، يعتبر فيتغنشتاين اللغة والفهم مقتصرًا على نوعٍ واحدٍ مِن المخلوقات الحيّة؛ أي الإنسان. وعلى أساس المعيار الثاني، يعتبر فيتغنشتاين اللغة والفهم ظواهر متعدّدة بين البشر، مِن دون قصد الحكم على أنواع الموجودات الأخرى. ولكنْ، باعتبار معيارٍ ثالث، إنَّ اللغة والفهم متعلّقان بسلوكاتٍ خاصّة. والآن، يجب أنْ نرى مِن أيّ معيارٍ نشأت مركزيّة الإنسان لدى صاحب «القراءة النبويّة...»؟
رغم أنّ ناتج حصريّة المعيار البيولوجي/ العمودي واضح؛ ولكنْ لا تقوم مركزيّة الإنسان لدى صاحب «القراءة النبويّة...» على هذا الأساس، ولا توجد أيّ إشارة لميلٍ إلى ذلك في كلّ نظريّته، کما أنَّ هذا المعيار يواجه العديد مِن التحدّيات.
ويؤكّد هاكر على أنَّ فيتغنشتاين يعترف بالتفاوت بين أشكال حياة
(143)المستخدِم وأشكال الحياة الأخرى، ولكنْ لم يعتقد أبدًا بشكلٍ واحدٍ للحياة، ونظر إلى اللغات المتنوّعة بمثابة أشكال حياةٍ متنوّعة. مِن هنا، لا يوجد شكل حياةٍ واحدة بين البشر، بل يجب الاعتراف رسميًّا بأشكالٍ للحياة لا تعدّ ولا تحصى. وعلى هذا الأساس، تحتّل أشكال حياة غير الإنسان مكانها خارج نطاق المفهوم الآنف الذكر، وكأنَّ الإنسان هو شكلٌ بيولوجي حصري مغطّى بطبقةٍ ثقافيّة. ويكمن عيب هذا الفهم، في خلطه بين نوعين مِن «الطبیعة الأوّلیّة» و«الطبيعة الثانويّة» للإنسان، والتي إحداها مشتركٌ بين جميع البشر؛ في حين أنَّ الأخرى ليست كذلك. فمن وجهة نظر فيتغنشتاين:
في بداية العمل... بعض أشكال الحياة أوّلية، وبعضها متطوّر. والمجموعة الثانية يمكن أنْ تظهر فقط في سياق المجموعة الأولى. فالمجموعة الأولى كانت موجودة قبل المجموعة الثانية.
المجموعة الأولى مِن أشكال الحياة، هي ما قبل لغويّة. وهذه المجموعة الأولى، هي ما قصده فيتغنشتاين بدقّة مِن مصطلح «أشكال الحياة»، وهذا هو مراده عندما اعتبر ردود الفعل الطبيعية هي المادّة الأوليّة للّغة، والإنسانَ
(144)مخلوق ما قبل لغوي. ولكنَّ المعيار الثقافي المقترح مِن هاكر وبيكر، يشير إلى المجموعة الثانية. هذا العيب والنقص هو ما واجهته نظرة صاحب «القراءة النبويّة..» التاريخيّة الاجتماعيّة إلى ظاهرة اللغة والفهم ـ وبالنتيجة ـ مركزيّة الإنسان فيها أيضًا.
ولكنْ، هذا ليس كلّ الكلام، فصاحب «القراءة النبويّة ...» مِن خلال استشهاده بقراءة «بيتشر» لجملة فيتغنشتاين: «إذا تكلّم أسدٌ...»، يشير إلى ميله نحو المعيار السلوكي أيضًا:
لنفترض أنَّ أسدًا قال: الآن الساعة تشير إلى الثالثة، ولكنَّه لم ينظر إلى أيّ ساعة؛ سوف نتصوّر أنّه لو كان كلامه صحيحًا حقًّا، فهذا يشير فقط إلى حظّه الجيّد. أو إذا فرضنا الأسد يقول: «يا ويلاه! الآن الساعة الثالثة، ويجب أنْ أسرع لأصل إلى موعدي»، ولكنّه ما يزال في مكانه يلعق ويتثاءب، ولا يبذل جهدًا للتحرّك... بناءً لفرض أنّ السلوك العام لهذا الأسد يشبه بشكل دقيق أسدًا عاديًّا مِن كلّ جانب ـ باستنثاء أنَّ لديه قدرة مبهرة في بيان الجمل ـ ؛ لا يمكننا القول إنَّ الأسد قد أعلن أو صرّح بأنَّ الساعة الثالثة، ورغم أنّه قد تلفّظ بكلماتٍ مناسبة، لكنْ لا يمكننا القول ما هو المطلب الذي أعلنه؛ لأنَّ نوع السلوك الذي يتمّ فيه نسج استخدام كلماته، متفاوت بشكلٍ أساسي عن نوع سلوكنا. نحن لا نستطيع فهمه؛ لأنَّه ليس شريكًا معنا في نوع الحياة.
(145)مِن الواضح أنَّ «بيتشر» يفسّر كلام فيتغنشتاين بمقاربةٍ سلوكيّة ـ تعاقديّة. لماذا لا يستطيع الإنسان فهم كلام الأسد؟ يجيب «بيتشر»: لأنَّ شكل حياتهم (= السلوكات والتعاقدات) لا يمكن قیاسها. وبخصوص صحّة إسناد المعيار السلوكي إلى فيتغنشتاين، لا يمكن الشكّ بذلك، ولكنَّ هذا لا يعني بالضرورة صحّة قراءة «بيتشر»؛ إذ إنّها تواجه نوعين مِن تحدّیات الاقتباس والمحتوى. ومِن أهمّ تحدّيات الاقتباس، السهو عن خلفيّة نصّ كتاب التحقيقات، الذي يؤكّد فيه فيتغنشتاين على عدم إخفاء مشاعر البشر عن بعضهم البعض ومِن هنا، فإنَّ تفسير بيتشر يعتبر نوعًا مِن «التفسير بالرأي».
ولكنَّ نطاق الانتقادات للمضمون أوسع بكثير. وقبل أيّ شيء، ليس للمعيار السلوكي مِن فعّالية عندما لا يكون هناك مِن انسجامٍ بين السلوك والكلام. على سبيل المثال، التظاهر على مستوى السلوك أو التكلّم بكناية. بعبارةٍ أخرى: لا يمكن دومًا اختزال شكلٍ للحياة في سلوكٍ علني وصريح. ومِن هنا، يؤكّد بعض المفسّرين على عدم صحّة إسناد «السلوكيّة» إلى فيتغنشتاين. وكذلك لا
(146)تكون قراءة بيتشر صحيحة، إلّا عندما يتبيّن الاعتقاد بالفصل الكامل لسلوكات الإنسان عن غير الإنسان في فكر فيتغنشتاين؛ لأنَّه إذا كان معتقدًا بوجود بعض السلوكات المشتركة بين الإنسان وغير الإنسان، وحصل أنْ صدر عن الأسد تلك السلوكات، لا يمكن قبول عدم فهم الإنسان لها. ولا ينبغي أنْ ننسى أنّه في هذا المثال الافتراضي، قد استوفي شرط التكلّم. ولكنْ، هل يمكن إسناد مثل هذا الاعتقاد إلى فيتغنشتاين؟ مِن وجهة نظره، هل عدم وجود خصائص مشتركة بني البشر والحيوانات، يعتبر أساس مثل هذا الانفصال الذي ينتهي إلى فصلٍ كاملٍ لأشكال حياتهم وـ بالنتيجة ـ عدم إمكان وجود أيّ نوعٍ مِن الفهم المتبادل فيما بينهم؟ الجواب هو النفي. فيتغنشتاين لا يعتبر هذا الوجوب منوطٌ بـ «الإنسانيّة». على سبيل المثال، يقول:
أنا متعبٌ ومرهقٌ تمامًا. إذا قالها أحدٌ ما، ولكنّه تصرّف بنشاطه المعهود، فلن نفهمه.
وعلى هذا الأساس، حتّى لو تكلّم شخصٌ ما بكلامٍ، ولكنْ لم يتلازم سلوكه مع كلامه، لا يمكننا أيضًا فهم كلامه. بعبارةٍ أخرى: إذا حلّ إنسانٌ مكان أسدِ بيتشر، الذي كان يقول: «الآن الساعة الثالثة، وربَّما لا أصل إلى موعدي»، ولكنْ لم ينظر إلى ساعته ولم ينهض مِن مكانه، لا يمكن فهم كلامه أيضًا. إذاً، ما يُستنتج مِن كلام فيتغنشتاين وجوب تقارن اللغة والسلوك معًا حتّى يظهر الفهم، وليس مركزيّة الإنسان. النقطة المهمّة هنا، هي أنّه يعتبر
عنصري اللغة والسلوك المشتركين ضروريين لظهور الفهم. ومع ذلك، هناك خطوة واحدة متبقّية مِن أجل استنتاج مركزيّة الإنسان، مِن ذلك: السلوك البشري يأتي فقط مِن الإنسان. بعبارةٍ أخرى: لا يوجد سلوك مشترك ممكن بين البشر وغير البشر. ولكنَّ فيتغنشتاين لا يخطو هذه الخطوة، فهو ليس في صدد إنكار أيّ نوعٍ مِن الخصائص المشتركة بين الإنسان والحيوان وقبول الفصل التام بين هذه الأشكال مِن الحياة.
ولا يجب أنْ نغفل عن أنَّ كلام أسد بيتشر الافتراضي، قد تمّ تصميمه بحيث أنّه غير مفهوم مِن دون العلم بالتعاقد الإنساني حول الزمان، وكذلك السلوكات الإنسانيّة المرتبطة بذلك. لو أنَّ أسد «بيتشر» نطق بالقضيّة الرياضيّة (4=2*2) أو المنطقيّة ([p→q]^p→q) بدلًا مِن التحدّث حول الوقت، كان عدم قدرة البشر على فهم ذلك أمرًا لا يصدّق.
من جهةٍ أخرى، هل إنسانيّة الإنسان تضمن السلوك الإنساني تلقائيًا؟ إنَّ جواب فيتغنشتاين عن هذا السؤال، هو النفي. فهو يشكّك عزو «الأمل» إلى طفل حديث الولادة أيضًا كعزو ذلك إلى كلبٍ. ويعترف أيضًا؛ أنّه عندما يسمع كلام فردٍ صيني، فإنّه لا يستطيع فهم شيءٍ، لدرجة أنّه حتّى لا يمكن التعرّف إلى إنسانيّته. كذلك يقول حول قبيلةٍ افتراضيّة، لا تعبّر عن مشاعرها:
«من المحتمل أنّ بمقدار ما يمكننا إفهام الكلب أنفسنا، لن نستطيع فعل ذلك» .
(148)هنا يشير فيتغنشتاين إلى إمكانيّة الفهم المتبادل بين الإنسان والكلب، في حين أنّه على أساس المفهوم المخالف لتفسير بيتشر، لا ينبغي للإنسان أنْ يكون قادرًا على التعبير عن نفسه للأسد.
ولكنْ هذا ليس كلّ الكلام؛ إذ يمكن فرض ظروفٍ يعجز فيها البشر عن فهم بعضهم البعض رغم لغتهم وسلوكهم المشتركين. ولذلك، يضيف هاكر شرط الثقافة المشتركة على شرطي الكلام والسلوك مِن أجل الفهم الناشئ عن أشكال الحياة. يبدو الأمر كما لو أنَّ الإنسان يمكن أنْ يعود بالزمن إلى الوراء، إلى حالة مِن القطع والانفصال الثقافي مع الناس مِن اللغة نفسها، ولكنّه ما يزال غير قادر على فهم ما يقولونه:
هل يشترك الناس، الذين كانوا يعيشون أيام اليزابيت، معنا في شكل الحياة، مع الالتفات إلى حقيقة أنّهم يتكلّمون باللغة نفسها التي نتكلّم بها؟ ولكنَّ الإجابة هي النفي مرّة أخرى. هل يشترك جميع الناطقين باللغة الإنكليزيّة في شكل حياتهم؟ هل يشترك ثنائيّو اللغة في شكل حياتهم؟ لا توجد إجابات عن الأسئلة خارج السياق .
تكمن النقطة الأساس في الجملة الأخيرة لهاكر، أنَّ ما يوفّر المعيار الأساس للفهم، هو السياق. والسياق لا يحدث عادةً سوى في العالم الإنساني، ولكنَّ إطلاق هذا الكلام، وبالحدِّ الأدنى مِن زاوية النظرة المتأخّرة لفيتغنشتاين، غير مقبول. وهذا ما ذهب إليه «غايير» في نظرةٍ إلى الشذرة 554 في باب
(149)اليقين؛ أنَّ الله يمكنه أيضًا التحدّث مع الإنسان فقط داخل سياقٍ مناسب ـ يعني تلك اللعبة اللغويّة نفسها وشكل الحياة الدينيّة الخاصّة ـ. وعلى كلّ حال، مهما كان منظور فيتغنشتاين مِن «إذا تكلّم أسدٌ...»، سيبقى هناك طريقٌ طويل لاستنتاج مركزيّة الإنسان الواردة لدى صاحب «القراءة النبويّة...» مِن أفكار فيتغنشتاين المتأخّرة. وطبق تشرشل:
لا يمكن اعتبار موقف فتغنشتاين مركزيةً للإنسان تمامًا وضيقة الأفق. [لأنّ] الفهم أمرٌ متدرج، تمامًا كما ينطبق على التشابه السلوكي والظاهري الذي هو أمرٌ متدرج أيضًا.
فشل الاستشهاد بـ «نموذج جاكوبسون المكوّن مِن ستّة عناصر»
ياكوسون أو جاكوبسون ينتمي إلى مجموعة علماء الألسنيّة الذين يعتبرون «التواصل» من أبرز وظائف اللغة. ويعرض جاكوبسون نظريّته في نموذجٍ مِن ستّة عناصر، وهذا النموذج مِن أكثر نماذج التواصل اللغوي رواجًا وشهرةً في التحليلات الأدبيّة وقبل جاكوبسون، قدّم بوهلر في كتابه نظريّة اللغة، نموذجًا مِن ثلاثة عناصر، عُرف بـ
(150)«أورغنون» والشامل فقط على: المتلقّي، المرسِل والموضوع/المرجع لأيّ حدثٍ أو فعلٍ تواصلي لغويّ. وبنظرةٍ لغويّةٍ صرف إلى التواصل اللغوي الإنساني، يمكن الارتضاء بنموذج أرغنون بوهلر. ولكنَّ جاكوبسون تقدّم خطوةً إلى الأمام، ومِن أجل الوصول إلى هدفٍ خاصّ قام بتوسيع ذلك النموذج، هدف إذا تمّ فهمه بشكل صحيح، مِن شأنه أنْ يمنحنا فهمًا أفضل لرؤية جاكوبسون.
ويعالج جاكوبسون في مقالته «اللسانيّات والشعريّات» الاتصال بين الألسنيّة وعلم الشعر. وضآلة جاكوبسون في هذه المقالة هي «البوطيقا/البويتيقا». وفي خطوته الأولى، يقوم ببسط نموذج بوهلر البسيط ـ خاصّةً في جزئه الوسطي؛ أي الموضوع/ الرسالة)؛ حتّى يتمكّن مِن عدّ جميع وظائف اللغة، ومِن خلال ذلك يوضّح الوظيفة «الشعريّة» للّغة. ومِن هنا، يرى جاكوبسون أنَّ كلّ تواصلٍ لغويّ، يتضمّن ستّة عناصر، هي: «المرسِل أو المتكلّم»، «المتلقّي أو المُرسَل إليه»، «الرسالة»، «السياق»، «العلامات أو السنن» و «قناة الاتصال» ويعرضها في الرسم البياني أدناه:
(151)السياق
الرسالة
المُرسَل ........................................................ المرسَل إليه
قناة الإتصال
العلامات/السنن
ثمّ يشرح الوظيفة الخاصّة لكلّ عنصرٍ مِن هذه العناصر (على التوالي: التعبيريّة أو الانفعاليّة، المرجعيّة، الشعريّة، الإفهاميّة، الانتباهيّة وما وراء اللغة)؛ حتّى يتمكّن مِن خلال ذلك توضيح الوظيفة الشعريّة للّغة والمتمركزة على «الرسالة» ـ ويمنع اللغويين مِن حصر وظيفة اللغة على «الإرجاع». وفي النهاية، يؤكّد جاكوبسون على:
التوجّه نحو الرسالة؛ يعني عندما تكون الرسالة في دائرة الاهتمام ومركزها، سوف يُطرح الدورالشعريّ للّغة.
وهكذا، لعلّه قد اتّضح هدف مقالة جاكوبسون إلى حدٍّ ما. وبجملةٍ واحدة، هذه المقالة هي محاولة لتوضيح الدور مِن أجل الإجابة بسؤالين: ما هو الشعر؟ ما هي الأدبيّات؟.
والآن بعد أنْ اتّضحت خلفيّة نموذج جاكوبسون، يجب الإشارة إلى
الاستفادة مِن كلمة «المُرسِل» الأكثر عموميّة بدلًا مِن كلمة «المتكلّم». إنَّ أداء المترجمين أكثر وفاء اًو قربًا إلى ما أراده جاكوبسون.
والنكتة الأخرى، هي أنَّ مقاربة جاكوبسون إيجابيّة، وليست سلبية. بعبارةٍ أخرى: لا يتطرّق في أيّ مكانٍ مِن مقالته إلى نواقص أو عدم صحّة النماذج التواصليّة الأخرى، التي ـ ولأيّ سببٍ كان ـ تمّ اختزال دور المتكلّم فيها أو لم يؤخذ بعين الاعتبار. إنَّ هدف جاكوبسون هو فقط إيضاح حدودٍ تفصل اللغة الأدبيّة ـ وخاصةًّ الشعر ـ عن اللغة اليوميّة والعامّة. وضمن هذا السياق، هو يؤكّد على الوظيفة الانفعاليّة الخاصّة للمتكلّم في تواصلٍ لغويٍّ إنساني.
وربَّما الآن، بعد اتّضاح نموذج جاكوبسون، لا يمكنه أنْ يكون داعمًا مناسبًا لتوكيدات صاحب «القراءة النبويّة...» الكثيرة على دور عنصر المتكلّم في الفعل التواصلي اللغوي ـ الذي يقوم على أساس «الاستدلال المناقض» للنموذج المقدّم مِن جاكوبسون. وإذا ما رجعنا إلى لغة منطق القضيّة، واعتبرنا كلّ عنصرٍ مِن هذه العناصر الستّة المطروحة مِن قِبل جاكوبسون، «شرطًا» منطقيًّا؛ فسوف يكون
(154)السؤال التالي في محلّه: هل «العامل/المشغّل» المنطقي بين هذه العناصر الستّة، لزامًا يجب أنْ تكون «و»، أم إنَّه يمكن أحيانًا أنْ يكون بعضها «أو»؟ وجاكوبسون نفسه لا يقول شيئًا حول هذا الأمر، ولكنْ ألا يمكن التفكير بذلك؟! على سبيل المثال، ألا يمكن فرض بعض الظروف التي يفقد فيها المُرسِل دوره التواصلي بالحدّ الأدنى أجزاء منه ويحلّ مكانه القارئ؟! في ظلّ هذه الظروف، ألا يمكن وبلسان فيتغنشتاين ـ الاعتقاد بنحوٍ ما بـ «التشابه العائلي»؟! وتزداد الشكوك أكثر، عندما نأخذ بعين الاعتبار بعض خصائص جاكوبسون، مثل وضوح وبساطة لغته، وكذلك اهتمامه بالتنظير في إطار كتاباته العلميّة القصيرة. ولعلّه مِن هذا المنطلق، لا يوجد ذكِرٌ معتدّ به لأسس التفكير عند جاكوبسون في تمام الدراسات المنجزة في مجالاتٍ مثل الألسنيّة، فلسفة اللغة، السيميائيّة، الميثولوجيا و .... وهكذا يبدو أنَّ استناد صاحب «القراءة النبويّة...» إلى نظريّة جاكوبسون مِن أجل التأكيد المتزايد على دور المتكلّم في عمليّة التواصل اللغوي، لا فائدة كبيرة منها.
(155)أحد قصور وفشل «القراءة النبويّة...» الأخرى، الفهم الخاطئ أو الاستفادة الخاطئة لأحد أبرز نظريّات سوسّور. تطرّق سوسّور في القسم الرابع مِن محاضرات في علم اللغة العام (أو محاضرات في اللسانيّات العامّة) إلى تفكيك «اللغة» عن «الكلام». والأساس الداخلي لهذا القسم ـ وهو عبارة عن أربع صفحات فقط ـ توضيح «موضوع» علم الألسنيّة الجديد. وباعتقاد كالر، إنَّ سوسّور يهدف مِن خلال ذلك إلى تمهيد الطريق أمام الدراسة «المنهجيّة» للّغة. مِن هنا، يجب عليه أوّلًا توضيح مراده مِن «اللغة» في عنوان «الألسنيّة». بعبارةٍ أخرى: يسعى سوسّور للإجابة عن هذا السؤال: أيّ «لغةٍ» يريد علم الألسنيّة الجديد معرفتها؟ هل هي أمرٌ مجرّد وانتزاعي، مثل قدرة النطق (= قوّة النطق)؟ أم إنّها ظاهرةٌ عامّة وشخصيّة يستخدمها كلّ فردٍ في تمام حياته مِن أجل إيصال مراده للآخرين ومدّ أواصر التواصل معهم؟ أم إنَّها شيء آخر بين الأمرين المذكورين؟ وكأنّ الأمر الأخير (الثالث) هو ما كان يفكّر به سوسّور:
«اللغة، في عين اشتراكها بين العموم وخروجها عن إرادتهم، فإنّها
(156)موجودة في كلّ فردٍ .... (ولكنْ) في الكلام لا يوجد أيّ عاملٍ عمومي. تعبيراته، فرديّة وعابرة... إنَّ التمييز بين اللغة والكلام وارتباط الكلام باللغة، يحلّ تمام القضايا».
وفي نهاية هذا القسم القصير، يخلص سوسّور إلى النتيجة التالية:
«سنتعامل حصريًّا مع لسانيّات اللغة، وإذا طلبنا المساعدة مِن دراسة الكلام في استدلالاتنا لتوضيح الأمر، فسنحاول دائمًا إبقاء الحدود بين هذين المجالين واضحة».
إنّ كلام سوسّور واضح كفاية. مِن هنا، لا يُرى بين مفسّري أفكاره عدم توافق ملحوظ بهذا الخصوص. وعلى أساس تفسير كالر، يعتبر تفكيك اللغة عن الكلام متناظر مع تفكيك الظواهر الأصليّة عن الفرعيّة والتابعة، والأمر الجمعي عن الأمر الفردي صرفًا، والظاهرة النفسيّة ـ الذهنية عن الظاهرة الماديّة. وهو يعتبر النسبة بين اللغة بالكلام كالنسبة بين المؤسّسة و«الحدث». وما تفسير مكاريك بأنَّ: «الكلامُ يشكّل الرسالةَ، واللغةُ تفهمها أو تفسّرها»؟.
وهكذا، يمكن امتلاك فهمٍ أفضل عن تفكيك سوسّور بين اللغة
(157)والكلام، وتقبَل أنَّ سوسّور مِن خلال هذا التفكيك، لم يكن أبدًا يسعى إلى إثبات وجوب إنسانيّة المتكلّم أو إنسانيّة عناصر اللغة. في إطار فكره، اللغة وكذلك الكلام ـ وحتّى القوّة الناطقة ـ كلّ ذلك، هي ظواهر إنسانيّة. وبالنظر إلى العمل الخاصّ الذي حددّه سوسّور لنفسه، مع تأسيسه لعلم الألسنيّة كعلمٍ تجريبي؛ لا يوجد عملٌ آخر مندرجٌ على جدول أعماله. وبتعبيرٍ فيتغنشتايني، كان سوسّور حقًا يتجنّب امتزاج لعبتين لغويّتين؛ هما الفلسفة والعلم التجريبي. والنكتة الأخرى الحاسمة، هي أنّ فكر سوسّور ملتزم تمامًا بالعلميّة والمنهجيّة، وحتّى مِن الصعب تصوّر أنَّه قد تخيّل ظروفًا لا يكون فيها المستخدمون للّغة مِن غير الإنسان. وهكذا، رغم أنَّ سوسّور كأيّ عالمٍ آخر، ربّما يكون ملتزمًا بالأسس العلميّة لعمله، ولكنّه يمكن أنْ يكون معتقدًا بوجوب إنسانيّة المتكلّم بكلامٍ ما، أو مستفيدًا مِن لغةٍ ما ـ بمثابة افتراضٍ تجريبي مِن بين مئاتٍ مِن الافتراضات في مثل هذه الدراسات ـ ، ولكنْ لا يمكن لأفكاره أنْ تكون داعمًا مناسبًا لاستنتاج مركزيّة الإنسان التي تبنّاها صاحب «القراءة النبويّة...».
بناءً لكلّ ما تقدّم في هذه المقالة، يمكن التأكيد على البنود أدناه كنتائجٍ لهذا البحث:
أ) يمكن إعادة بناء الاستدلال اللغويّ لصاحب «القراءة النبويّة للعالم» على الشكل الآتي:
(158)1. اللغة هي ظاهرةٌ إنسانيّة (بشريّة) بالكامل. على هذا الأساس، إذا كانت مؤلّفة مِن عناصر وأجزاء، فإنَّ كلّ عنصرٍ منها إنسانيّ أيضًا.
2. المتكلّم/المتحدّث هو أحد عناصر اللغة. لذا، المتحدّث باللغة لا يمكن إلّا أنْ يكون إنسانًا.
ب) رغم أنّ هذا الاستدلال مِن الناحية الصوريّة (الشكليّة) صحيح، ولكنَّه يعاني مِن فشلٍ على مستوى المضمون.
ج) على مستوى مضمون (مادّة البرهان)، يستند هذا الاستدلال إلى الموارد الآتية:
1.تعريف كيلر لظاهرة اللغة؛
2. فلسفة اللغة المتأخّرة لفيتغنشتاين قائمة على أساس وجوب إنسانيّة تمام أجزاء وعناصر اللغة و ـ في النتيجة ـ امتناع غير إنسانيّة أيٍّ مِن أجزائه وعناصره؛
3. النموذج السداسي العناصر لجاكوبسون مع التأكيد على عدم تفكيك مكانة المتكلّم في عمليّة التواصل اللغوي البشري؛
4. تفكيك سوسّور بين اللغة والكلام والتأكيد على مكانة المتكلّم.
على هذا الصعيد، إنَّ شذرة (2) هو الحجر الأساس في الاستدلال الآنف الذكر مِن أجل الدلالة على صحّة ادّعاء هذا الطرح إنسانيّة راوي/ قائل القرآن ـ .
د) خلاصة العيوب على مستوى المضمون لهذا الاستدلال كالآتي:
1. يواجه اللجوء إلى تعريفٍ خاصٍّ مِن أجل ظاهرة اللغة، وخاصّةً
عندما يستخدمه للاستنتاج النهائي، فشلين منطقيين: «عدم التحرّر مِن الافترضات المسبقة» و «مصادرة المطلوب».
2. كذلك إنَّ الاستناد المتزامن إلى التعريف المذكور والاستفادة مِن فلسفة اللغة المتأخّرة لفيتغنشتاين، يجعل إطار الاستدلال يواجه فشلًا بنيويًّا، وهو «عدم التوافق الداخلي».
3. إذا ما ذكرنا القراءات غير المتجانسة والتحدّيات العديدة لمقاربة فيتغنشتاين التطبيقيّة للّغة في إطار مفهومي «الألعاب اللغويّة» و«أشكال الحياة»، واكتفاء صاحب «القراءة النبويّة...» ببعض هذه القراءات والصمت أمام هذه التحدّيات؛ يزداد نطاق الشكوك حول طريقة مثل هذا الاستشهاد. وهكذا، هناك صعوباتٍ تواجه تقبّل هذا الطرح لمركزيّة الإنسان صراحةً.
4. إنَّ استناد هذا الطرح إلى «نموذج جاكوبسون المكوّن مِن ستّة عناصر» وتفكيك سوسّور بين «اللغة» و«الكلام» مِن أجل التأكيد على وجوب إنسانيّة أجزاء وعناصر اللغة أيضًا، أمرٌ غير فعّالٍ مِن حيث أنَّه غير متوافق مع دلالتها وهدفها وخلفيتها.
5. على أيّ حال، لقد كان لكلٍّ مِن فيتغنشتاين، جاكوبسون وسوسّور ضالّةً، لا يمكن مِن خلال تفاعل نتائجهم وطروحاتهم الوصول إلى ما كان يسعى إليه صاحب «القراءة النبويّة...».
- آديس، مارک، فيتغنشتاين، راهنمايي براي سرگشتگان (دليل للمفقودين)، ترجمة همايون کاکاسلطاني، طهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1393.
- برومر، وينسنت، دين در دنياي مدرن (الدين في العالم الحديث)، به کوشش سيدمصطفي شهرآييني ، ترجمة امير اکرمي (و ديگران)، طهران، پژواک کيهان /مرکز بين المللي گفتگوي تمدن ها، 1383.
- پورنامداريان، تقي، «بلاغت مخاطب و گفتگوي با متن» (بلاغة المخاطب والمحادثة مع النصّ)، فی: نقد ادبي، عدد 1، ربیع 1387.
- حق شناس، علي محمّد، «ياکوبسن، وجودي حاضر وغايب» (جاكوبسن. وجود حاضر وغائب)، فی: نامه فرهنگستان، شماره ي سي ام، 1385 .
- سرل، جان، «فيتغنشتاين»، فی: مگي، براين، فلاسفه بزرگ؛ آشنايي با فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة الغربيّة؛ عظماء الفلسفة الغربيّة)، ترجمه عزت اله فولادوند، طهران : خوارزمي، 1390 .
- سوسّور، فرديناند دو، دوره زبانشناسي عمومي (دورة اللسانيّات العامّة)، ترجمه کورش صفوي، طهران: هرمس، 1378 .
- صفوي، کورش، «فرديناند دو سوسّور»، فی: زبان و ادب، شماره بيست ودوم، 1383.
- کالر، جاناتان، فرديناند دو سوسّور، ترجمه کورش صفوي ، طهران : هرمس، 1390 .
- گريلينگ، اي، سي، فيتغنشتاين، ترجمة أبوالفضل حقيري، طهران: بصيرت، 1388 .
- لايکن، ويليام جي، درآمدي تازه بر فلسفه زبان (مقدّمة جديدة لفلسفة اللغة)، ترجمه کورش صفوي، طهران : علمي، 1391 .
- مجتهد شبستري، محمّد، «قرائت نبوي از جهان»، نیلوفر، 31/5/1401.
-neeloofar.org/category/professorsresearchers/mojtahedshabestari/
(161)prophetic-interpretation-of-the-world/
- مرواريد، جعفر، «فلسفه ازنظر ويتگنشتاين دوم» (الفلسفة مِن منظار فیتغنشتاین الثاني)، فی: پژوهشهاي فلسفي کلامي، شماره نوزدهم، 1383.
- مکاريک، ايرنا ريما، دانشنامه نظريههاي ادبي معاصر (موسوعة النظريّات الأدبيّة المعاصرة)، ترجمه مهران مهاجر و محمّد نبوي، طهران: آگه، 1383 .
- مک گين، ماري، ويتگنشتاين و پژوهشهاي فلسفي (فتغنشتاين أبحاث الفلسفيّة)، ترجمه ي ايرج قانوني، طهران: علم، 1389 .
- ويتگنشتاين، لودويگ، پژوهشهای فلسفی (أبحاث الفلسفيّة)، ترجمه ي فريدون فاطمي، طهران : مرکز، 1380.
- ـــــــــــــــ ، درباره رنگها (حول الألوان)، ترجمه ليلي گلستان، با پي گفتاري از بابک احمدي، طهران: مرکز، 1381الف.
- ـــــــــــــــ ، فرهنگ و ارزش (الثقافة والقیم)، ترجمه اميد مهرگان، تهران: گام نو، 1381ب.
- ـــــــــــــــ ، برگه ها (أوراق)، ترجمه مالک حسيني، تهران: هرمس، 1384 .
- ـــــــــــــــ ، کتابهاي آبي و قهوهاي (الكتب الزرقاء والبنية)، ترجمه ايرج قانوني، طهران: ني، 1385.
- ـــــــــــــــ ، درباب يقين(عن اليقين)، ترجمه مالک حسيني، طهران: هرمس، 1387.
- ـــــــــــــــ ، رساله منطقي ـ فلسفي، ترجمه و شرح سروش دباغ ، تهران: هرمس، 1393 .
- هريس، روي، زبان، سوسّور، و ويتگنشتاين؛ چگونه ميتوان با واژهها بازي کرد؟ (اللغة ، سوسّور، وفيتجنشتاين؛ كيف يمكنك اللعب بالكلمات؟)، ترجمه اسماعيل فقيه، تهران: مرکز، 1381.
(162)- هکر، پيتـر، «ويتگنشتاين و اسـتقلال درک انساني» (فتغنشتاين واستقلال الفهم البشري)، فی: آلن /تـروي، ريچارد/ملکم، ويتگنشتاين؛ نظريه و هنر، ترجمه فرزان سجودي، طهران: فرهنگستان هنر، 1389.
ـ ياکوبسن، رومن، «زبانشناسي و شعرشناسي» (اللغويّات والشعريّة)، ترجمه کورش صفوي، در: سجودي، فرزان، ساختگرايي، پساساخت گرايي، و مطالعات ادبي، طهران: سوره مهر، 1388.
ـ ياکوبسن، رومن (و ديگران)، زبان شناسي و نقد ادبي (اللغويّات والنقد الأدبي)، ترجمه مريم خوزان و حسين پاينده، طهران:ني، 1369 .
- Baker, Gordon, “The Private Language Argument”,in: Shanker/Kilfoyle, Stuart/David, LudwigWittgenstein; Critical Assessment of Leading Philosophers(Second Series), London/New York:Routeldge, v3,2002.
- Baker/Hacker, G.P/P.M.S., Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity; An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, 2nd edition, Extensively Revised by P.M.S. Hacker,Oxford: Wiley-Blackwell, 2009a.
- ___________, Wittgenstein: Understanding and Meaning; An Analytical Commentary onthe Philosophical Investigations, 2nd edition, Extensively Revised by P.M.S. Hacker, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009b.
- Boncompagni, Anna, “Elucidating Forms of Life; the Evolution of Philosophical Tool”, NordicWittgenstein Review, (Special Issue 2015; Wittgenstein and Forms of Life.
- Churchill, John, “If a lion could talk…”, in: Shanker/Kilfoyle, Stuart/David, LudwigWittgenstein; Critical Assessment of Leading Philosophers(Second Series), London/New York:Routeldge, v4, 2002.
- Gier, Nicholas F, “Wittgenstein and Forms of life”, in: Philosophy of the Social Sciences, N3,1980.
(163)ـ Hacker, Peter, “Forms of life”, Nordic Wittgenstein Review(Special Issue 2015; Wittgensteinand Forms of Life.
ـ Harris, James F, “Language, language-games, and ostensive definition”, in: Shanker/Kilfoyle,Stuart/David, Ludwig Wittgenstein; Critical Assessment of Leading Philosophers(Second Series),London/New York: Routeldge, v2, 2002.
ـ Hilmy, S. Stephen, “Tormenting questions in Philosophical Investigations Section 133”, in:Arrington/Glock, Robert L./Hans-Johann, Wittgenstein’s Philosophical Investigations; Text and
ـ Context, London/New York: Routledge,1992.
ـ Jakobson, Roman, “Linguistics and Poetics“, in: Sebeok, Thomas(ed.), Style in Language,Massachusetts: M.I.T Press, 1960.
ـ Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Massachusetts: Springfield, 2004.
ـ Moyal-Sharrock, Danièle, “Wittgenstein in Forms of Life, Patterns of Life, and Ways of Life”,Nordic Wittgenstein Review(Special Issue 2015); Wittgenstein and Forms of Life.
ـ Nicholson, Michael W, “Abusing Wittgenstein: The Misuse of the Concept of Language-GamesIn:Contemporary Theology”, Journal of the Evangelical Theological Society, N39, 1996.
ـ Rathert, Monika, “Bühler, Karl”, in: Strazny, Philipp(editor), Encyclopedia of Linguistics,New York: Fitzroy Dearborn, v1, 2005.
ـ Simpson/Weiner, J. A./S. C, The Oxford English Dictionary, Oxford: Clarendon Press, v1, 1991.
ـ Smith, Cam, “I’m Not Playing Games: Why Wittgenstein’s Language-Games Fail to Defeat
ـ the Unity of Language”, Marist Undergraduate Philosophy Journal, V2.
ـ Waugh, Linda R, “Jakobson, Roman”, in: Strazny, Philipp(editor)
(164)ـ Encyclopedia ofLinguistics, New York: Fitzroy Dearborn, v1, 2005.
ـ Wittgenstein, Ludwig, “Cause and Effect: Intuitive Awareness“, in: Philosophical Occasions:
- 1912-1951, Edited by: J. C. Klagge and A. Nordman, Indianapolis: Hackett Publishing, 1993.
ـ ____________ , Philosophical Investigations(Second edition), Translated by G. E. M, Anscombe, Oxford: Blackwell, 1999.
ـ ____________ , Remarks on the Philosophy of Psychology, Translated by G. E. M, Anscombe, G.E.M. Anscombe, Heikki Nyman, and Georg Henrik von Wright(Editors), Oxford: Basil, 1980.
(165)
محمّد تقي سبحاني
لقد كانت الحوزات العلميّة على مرّ التاريخ مركزًا للعلماء والمفكّرين، الذين أخذوا على عاتقهم حمل رسالة التفسير وترويج المعارف الوحيانيّة ونشرها. وكان هؤلاء المرجع الأوحد والملجأ لعامّة الناس في الإجابة عن أسئلتهم وحاجاتهم الدينيّة. وقطعًا، كان الخلاف يقع أحيانًا بين العلماء والنخب الإسلاميّة حول الاستنباط وفهم الدين، وكان يؤدّي أحيانًا أيضًا إلى حصول نوع مِن النزاع بينهم. إلّا أنَّ هذه النزاعات، كانت غالبًا في الطبقات السطحيّة والأساليب الجزئيّة لفهم الدين، ولا ترتبط نوعًا ما بالمباني الدينيّة والرؤى الأساسيّة والجوهريّة.
لكنْ في القرنين السابقين طرأت تحوّلات كبيرة في المجتمعات الإسلاميّة أدّت إلى فتح باب التأويل والتفسيرات الدينيّة مِن خارج بيئة الحوزات
العلميّة. وبالتالي، ظهرت مِن هنا ومِن هناك الكثير مِن الاستنتاجات المختلفة والمتباينة باسم الإسلام والشريعة. وهذه الاستنتاجات لم يكن لها أيّ جذور في التقاليد الإسلاميّة العريقة فحسب، بل إنّها، ومِن خلال تقديم نظرة جديدة حول الإنسان والكون، ومِن خلال نقد التراث الديني والتحدّي للهويّة والثقافة الإسلاميّة؛ قدّمت وجوهًا مختلفة عن الدين والتعاليم الإسلاميّة.
وقد عرف هذا التيّار باسم التنوير الفكري، وكان يبحث بشكل علني وخفيّ عن المذهب الصحيح للفكر والحياة في الثقافة الغربيّة الحديثة، وكان يرى ضرورة ولزوم مطابقة الدين والثقافة الإسلاميّة مع عناصر الحداثة.
في هذا الخضم تحدّى جماعة مِن الدارسين الإسلاميّين للتحقيق في المدارس (المذاهب) الغربيّة بقصد الإجابة والردّ عليها، أو بهدف إحياء وعصرنة الفكر الديني، وقدّمت نتاجاتها مِن المصادر الدينيّة في قالب «الإسلاميّات» (علم الإسلام) والتحقيق الديني.
وقد عرفت هذه الجماعة شيئًا فشيئًا باسم «التنوير الديني»، وعلى الرغم مِن انطلاق هؤلاء ابتداءً بنوايا سليمة في هذا الأمر الهام جدًّا، إلّا أنّه وبسبب ضعف البنى النظريّة عندهم مِن جهة، وقبولهم لمبادئ وقواعد الثقافة المادّيّة الغربيّة مِن جهة أخرى؛ فقد ابتلى هؤلاء عمليًّا بمجاراة المتنوّرين العلمانيّين وتقليدهم.
وهنا نشير إلى أنَّ أنصار «التنوير الديني»، وبالرغم مِن اتّفاق رأيهم حول الأصول والقواعد الكلّيّة، إلّا أنَّهم مختلفون فيما بينهم حول النظرة إلى المدارس الغربيّة، وكذلك مِن ناحية تحديد الأولويّات النظريّة والعمليّة.
(168)إنَّ التنوير الديني في العهد الحاضر للمجتمعات الإسلاميّة ورغم تحمّله لصدمة أيديولوجيّة قويّة، ومروره بمرحلة مِن الإحباط والضياع؛ إلّا أنَّه ما لبث في العقود القليلة الماضية مِن الظهور مجدّدًا عبر شخصيّات جديدة ووجوه مختلفة.
وفي هذه المرحلة، يسعى أنصار هذا التيّار غالبًا مِن منظور علم المعرفة وتفسير النصوص الدينيّة (الهرمنيوطيقا) إلى معالجة القضايا الاجتماعيّة، ومسألة السنّة والتجدّد، ومجاراة الحداثة عبر طريق التأويل، وإعادة قراءة النصوص الإسلاميّة، والتأكيد على تعدّدية فهم العلماء للدين (البلوراليزم المعرفيّة).
إنّ فشل المتنوّرين في العقود الماضية، مضافًا إلى تجربة الثورة في بعض الدول الإسلاميّة، وتقديم نموذج مِن الفكر الاجتماعي الجديد في الإسلام بوساطة بعض القادة الإسلاميّين؛ لقّن المتنوّرين الإسلاميّين درسًا مفاده أنّه بشكل جلي وواضح؛ ليس بإمكان أيّ مدرسة مِن المدارس الغربيّة أنْ تكون أنموذجًا في الفكر والعمل للمجتمعات الإسلاميّة.
ولهذا السبب، فإنَّ هؤلاء المتنوّرين، وبمنتهى الاحتياط، اعتمدوا السير بخطوات بطيئة وقصيرة في محاولة تجديد التراث الإسلامي، بناءً على التحوّلات الفكريّة في العهد المعاصر.
بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، قام السيّد محمّد مجتهد شبستري مباشرة بإطلاق مجلّة في الإسلام النظري تحت عنوان «انديشه اسلامى» (الفكر الإسلامي)، وأعلن في افتتاحيّة العدد الأوّل منها بأنَّ رسالة المجلّة تصبّ في مجال «خلق التفكير لجيل المجتمع المثقّف» وكتب قائلًا:
إنَّ خلق ذراع التفكير هذا للحفاظ على استمراريّة ثورتنا الإسلاميّة، ضروري كما هي الضرورة لخبزنا اليومي... إنَّ إيماننا الثوري أيضًا لا بدّ له أنْ يتغذّى بالفكر والثقافة حتّى يقدر على البقاء حيًا.
إنَّ المقالات المنشورة والمترجمة في هذه المجلّة حول نقد الحضاره الغربيّة، وكذلك حول تفسير المفاهيم الإسلاميّة، تشير بوضوح مِن خلال لونها ونوعها إلى الفضاء الحاكم على الإلهيّات الجديدة في المسيحيّة (وعبر شخصيّات أمثال: بولتهن، بارت، تيليش، إريك فروم و...)، والتي كان شبستري متأثّرًا بأفكارها خلال السنوات التي أمضاها في ألمانيا.
كما وتشير القرائن المتعدّدة إلى أنَّ شبستري كان في تلك السنوات، وكغيره مِن المجدّدين الإسلاميّين الكثرـ يسعى إلى البحث عن مشروع أساس لأجل الجمع بين الإسلام وبين الحداثة الغربيّة، وتقديم مفهوم جديد عن «النظام الاجتماعي في الإسلام».
وفي مقابلة له مع مجلّة كيهان الثقافيّة في شهر «مرداد» سنة 1363ه.ش، رأى شبستري بأنَّ طريق الفرار والنجاة مِن «العلمنة»، هو الجمع بين التعقّل والتعبّد، وأنَّ السبيل لتقديم الإسلام إلى الغرب يتمّ عبر عرض وتقديم: «أسلوب جديد مِن الحياة يشتمل على بُعد الرؤية الكونيّة الإسلاميّة وبُعد القيم، وبُعد النظام الاجتماعي».
نعم، منذ تلك البدايات تبيّن وجود أخطاء نظريّة في المنظومة الفكريّة للسيّد شبستري، وقد قاده هذا الزلل في نهاية المطاف ليس إلى «العلمنة» فحسب، بل
قادته عمليًّا إلى مشارف «العلمانيّة» أيضًا. وفي ذلك الوقت، عندما كان يتكلّم عن «النظام الإسلامي» أو عن «القيم الإسلاميّة»، كان في الواقع ينتقص الإسلام ويتنزّل به إلى حدّ أنّه مجموعة مِن المبادئ والقيم العامّة والكلّيّة.
وفي مقالة افتتاحيّة له في مجلّة «الفكر الإسلامي» تحت عنوان «اقتصاد إسلامي أم اقتصاد المسلمين»، يصرّح بما يلي:
يعتقد الكاتب أنَّ ما قُدّم في خصوص المسائل الاقتصاديّة بعنوان أنّها تعاليم الإسلام، والقيم الثابتة غير القابلة للتغيير، إنّما هي كلّيّة إلى حدّ أنّها في مرحلة أبعد بكثير مِن تشكيل «نظام اقتصادي خاصّ»... ويبدو لي أنَّ ما يمكن إعلانه كرأي إسلامي ثابت ومحدّد على الدوام للوضع الاقتصادي، ليس أكثر مِن ثلاثة أصول كلّيّة:
1. القضاء على الفقر والحرمان.
2. الحدّ مِن التكاثر (تحديد النسل).
3. الحدّ مِن طبقيّة المجتمع على أساس الاستثمار
وعلى هذا المنوال، فإنّ شبستري يعتقد بأنَّ كلّ الأحكام والأصول القطعيّة في القرآن الكريم والروايات المتعلّقة بالمجتمع، إنّما هي مؤرّخة وقابلة للتغيير. وقدّم المؤلّف تفسيرًا خاصًا عن الإسلام، فاقدًا للشريعة والنظام الحقوقي والأخلاقي الخاصّ والمتميّز جدًّا.
وبناء على ما يظهره السيّد شبستري، فإنَّ الاقتصاد الإسلامي يمكن أنْ يتطابق مع الاقتصاد الاشتراكي وغير الاقتصاد الاشتراكي.
في السنوات اللاحقة، ومِن خلال تدوين سلسلة مِن المقالات في المجلّة الشهريّة «كيهان الثقافيّة» تحت عنوان «العقل والدين»، تحدّث شبستري عن مدى تأثير العلوم الإنسانيّة الحديثة على المعرفة وتفسير الدين، وكذلك على الاستنباط وتنفيذ الأحكام أيضًا. هذه المقالات، وضمن عنوان فرعي «التديّن ميسّرٌ فقط في ظلّ العلوم والمعارف الإنسانيّة»، وبعد ثمانية أشهر مِن نشرها؛ أضحت في الاتّجاه نفسه الذي شرع به عبد الكريم سروش، بالأهداف والمضامين نفسها، عبر نشر سلسلة مِن المقالات في مجلّة كيهان الثقافيّة تحت عنوان «القبض والبسط في الشريعة».
شبستري، ومن خلال تقسيم التديّن إلى ثلاث مراحل:
1. معرفة الله والنبيّ صلىاللهعليهوآله.
2. فهم ما يقوله النبيّ صلىاللهعليهوآله.
3. توجيه الحياة على أساس ما يقوله النبيّ صلىاللهعليهوآله يبيّن ما يلي: «التفكّر الأوّلي عند المسلمين كان قائمًا على هذا الأساس المحكم، وهو أنْ تديّن الإنسان في المراحل الثلاث، كان ميسّرًا بمعونة العلوم والمعارف الإنسانيّة (العقل)».
في هذه المقالات خلط بشكل واضح بين الاستفادة الفعّالة للعقل والعلم لأجل رسالة الوحي، وبين تحميل وفرض الثقافة المادّيّة الغربيّة على قضايا وبيانات الكتاب الكريم والسنّة الشريفة. فالأولى، مورد اتّفاق كلّ علماء الدين. وأمّا الأمر الثاني، فإنّه يتعارض بشكل جليّ مع المسلمات الدينيّة والعقليّة.
وعلى الرغم مِن كلّ ذلك، فإنّ شبستري حتّى هذه المرحلة كان يسير بخطواته واستنتاجاته على أساس منهج الاجتهاد المعروف، ويستند فيها إلى أقوال علماء الدين، وكان إلى حدٍّ ما بعيدًا تقريبًا عن الوصول إلى هذه النقطة، التي تفيد بأنَّ كلّ المعارف وأحكام الوحي متغيّرة ومنسوخة ومرتبطة بمرحلة تاريخيّة خاصّة باعتقاده، وأنّه لا بدّ للمسلمين مِن القبول بكلّ نتاجات الحضارة الغربيّة أيضًا. إلّا أنّه بعد ذلك، وفي السنوات اللاحقة، ومِن خلال تدوين عدد مِن المقالات، وعبر بعض المقابلات الحواريّة، اقترب رويدًا رويدًا مِن القول بأنّ كلّ التفاسير والاجتهادات مِن علماء المسلمين مردودة عمليًّا، وألصق عليها ملصق «القراءة الأرثوذكسيّة» و«القراءة الرسميّة»، وبدل أنْ يتصدّى لنقد الحضارة الغربيّة، تصدّى مِن خلال قاعدة الحداثة لنقد الأحكام والمعارف الإسلاميّة.
في هذه المقالة الماثلة بين يديك، سوف نستعرض الأثر الأخير الذي نشر للسيّد شبستري في الفارسيّة بعنوان «نقدى بر قرائت رسمى أز دين» (نقد القراءة الرسميّة للدين). وضمن بيان خفايا هذا الكتاب، سوف نقوم إجمالًا بتحليل مضامينه ونقدها.
ولا بدّ مِن الإشارة هنا إلى أنَّ الأثر المذكور مأخوذ مِن مقالات متعدّدة وبحوث متفرّقة، وأنَّ هذه المقالة إنَّما هي مدخل فقط لنقد الكتاب. وأمّا النقد الشامل والكامل لمثل هذه الأثار والكتب، فإنّه يتطلّب الفرصة المناسبة الأخری.
صرّح المؤلِّف في مقدّمة الكتاب والفصول الأولى منه عن الهدف الأساسي لكتابه، ومِن ثمّ قام في الفصول اللاحقة بعرض المزيد مِن البيان والتحليل لذلك الهدف.
ويقصد المؤلِّف بقوله «القراءة الرسميّة للدين» تلك القراءة المقدّمة عبر الدوائر الرسميّة أو شبه الرسميّة كالراديو والتلفزيون، وعبر الكلمات التي تلقى غالبًا قبل خطبة صلاة الجمعة الأساسيّة، وكذلك عبر أكثر الصحف والمنشورات المرتبطة بمسؤولي الحكومة.
يعتقد شبستري بأنّ هذه القراءة تسبّبت في حدوث أزمة حادّة في مجتمعنا لسببين:
السبب الأوّل: هو إصرار البعض على هذه الدعوى الباطلة والفاقدة للدليل، وهي أنَّ الإسلام بوصفه دينًا يشتمل على منظومة كاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي، مستمدّة مِن علم الفقه، ويمكن التعايش معها في كلّ العصور.
السبب الثاني: هو الإصرار على هذه الدعوى الباطلة التي تقول بأنَّ وظيفة الحكومة عند المسلمين هو تطبيق الأحكام الإسلاميّة فقط.
في محاولة البحث على جذور هذه الأزمة، يعتقد المؤلِّف بأنَّ أسلوب وبيئة الحياة الاجتماعيّة للمسلمين قبل الدخول في عهد الحضارة الحديثة، كانت حياة زراعيّة تعتمد على الرعي، وكانت نصف إقطاعيّة، وتجاريّة، وفي
مثل هذه المجتمعات ومِن خلال الحلال والحرام الفقهيين، يعيش المسلمون حياتهم اليوميّة مِن جهة، ويطيعون أوامر الله مِن جهة أخرى. وفي هذا النمط مِن الحياة، فإنَّ علم الفقه هو المبيِّن لأحكام الناس العمليّة، وكان الحاكم أيضًا يؤمّن النظام الاجتماعي على أساس العمل بهذه الأحكام.
ولكنْ منذ ما يقرب مِن 150 سنة تقريبًا، استقبل المسلمون أسلوب حياة جديد يختلف كلّيًا عن أسلوب حياتهم السابقة، وقطعًا لم يكن لهم أيّ مناصبٍ للهروب مِن هذا الأسلوب الجديد:
«إنَّ روّاد القافلة لهذه الحياة الجديدة، هم البلدان الغربيّة والدول الصناعيّة، وهؤلاء هم الذين خلقوا هذا الواقع الجديد، والذي لا مناص لكلّ الأمم اليوم، ومن جملتها الأمّة الإسلاميّة، مِن قبول هذا الواقع، واختيار الحياة المتناسبة معه» (ص14 مِن الكتاب).
«ولا شكّ في أنَّ حياة المسلمين إذا لم تتطابق مع حياة العالم الحديث، فإنَّ هذه الأمّة ستفقد مِن يدها إمكانيّة ديمومة الحياة المتمدّنة في هذا العالم الجديد».
شبستري، ومن خلال تعداد الخصائص الأساسيّة لهذا النمط الجديد مِن الحياة الاجتماعيّة (الإرادة القويّة والرغبة في حياة أفضل، الاعتماد على نموّ العلوم التجريبيّة والاجتماعيّة، الاعتماد والتوجّه نحو الصناعة بشكل كامل 100%، التخطيط على المدى الطويل، قبول الكثرة والمشاركة في الحياة الاجتماعيّة، الإدارة العلميّة لعمليّة التنمية)، يشير إلى أنَّ هذا الأسلوب مِن الحياة، لا يستلزم وضع التديّن جانبًا والتخلّي عنه؛ إذ إنَّ الإنسان التقدّمي
بإمكانه أنْ يكون عارفًا بالله ومؤمنًا به، ولكنْ لا يمكنه التكلّم على التنمية والتطوّر الديني...
لا يمكن للتديّن أنْ يهضم التطوّر والتنمية وأنْ يصبغهما بصبغة الدين.
ومِن ثَمَّ لخّص المؤلِّف روح كلامه في هذه العبارة، حيث يقول:
«إنَّ الحياة الاجتماعيّة الجديدة التي ترتكز على محور التنمية البشريّة الشاملة، لا يمكن إدارتها مِن خلال الحلال والحرام الفقهيين... لأجل إدارة الحياة الاجتماعيّة الجديدة لا بدّ لنا مِن الفلسفة والعلوم السياسيّة وعلم الإدارة، وعلم الاقتصاد والحقوق مِن جهة، وكذلك الاعتراف الرسمي بالقيم السياسيّة والإنسانيّة في العصر الحاضر نظير الحريّة، المساواة والحياة الاجتماعيّة بمعناها المتحضّر (حقوق الإنسان) مِن جهة ، والتي لها الدور الأوّل والأساس في هذا المجال. نعم إنَّ نفخ المعنويّات (الروحانيّات) في هذه الحياة الاجتماعيّة الجديدة، هو مِن وظائف الدين، ولا يمكن لغيره القيام بهذه المهمّة، بل ينبغي له أنْ يتولّى عهدتها».
مِن خلال هذه المقتطفات ربّما لا نرى ضرورة لاستعراض جزئيّات كلامه الآخر، بل يمكن مِن خلال مثل هذه العبارات أنْ نستكشف نظريّات المؤلِّف وآراءه في قضايا الدين والعقل، العلوم التجريبيّة، النظام الاجتماعي، و...
ولكنْ لأجل تجنّب الأحكام المسبقة، ولأجل الاطّلاع على سائر الجوانب الفكريّة للمؤلِّف، مِن المناسب هنا أنْ نستعرض معًا في عدّة أقسام، خلاصة
مطالب أخرى وردت في ذلك الكتاب، وما سنورده لاحقًا منقول مِن كلمات الكاتب نفسه.
يرى السيّد شبستري أنَّ القراءة الرسميّة للدين، هي تلك القراءة الفقهيّة – الحكوميّة نفسها. وأنَّ هذه القراءة في مقام تحديد النسبة بين الإسلام وبين السياسة والحكومة، تستفيد مِن العبارات التكليفيّة نفسها الواردة، والمستخدمة في باب العبادات الفقهيّة.
إنَّ القراءة الرسميّة في مجال: الحكومة، البرامج والوظائف الحكوميّة وتعريف العدالة، لا تقدّم نظريّة فلسفيّة، وإنَّما تحدّد سلسلة مِن القرارات، الترتيبات، الآداب، الحلال والحرام. وتطلب مِن المؤمنين والحكومة أنْ يعملوا على أساسها، وحتمًا إنَّ أنصار هذه القراءة يتكلّمون أحيانًا على الاجتهاد المتناسب مع الزمان والمكان. إلّا أنَّ هذا، لا يعني تغيير اللهجة أو النظرة إلى الحكومة، بل هو بمعنى ضرورة تقديم حكم شرعي جديد في باب السياسة والحكومة بموازاة تغيّر الزمان والمكان.
إنَّ تأسيس الأنظمة السياسيّة، الاجتماعيّة والاقتصاديّة في عصر الحداثة، يستلزم وجود نوعٍ مِن «الاختيار». إلّا أنَّ هذا الاختيار، ليس بين الحق والباطل أو بين الصحيح والخاطئ، وإنّما هو اختيار مِن عدّة اختيارات
ممكنة، وربّما يكون أحدها غير قابل للاختيار بشكل قاطع أبدًا، وإنّما هو صرفًا ترجيح بعض الأمور على أمور أخرى.
إنَّ الاختيار مِن خلال مفهوم «حقّ الاختيار» (الانتخاب)، ينسجم مع منطق «الحقّ»، ولا معنى لجعل الاختيار تكليفيًّا، بل إنَّ الاختيار يقوم بطبيعته على أساس الغريزة العقلانيّة والداخليّة للإنسان.
بالطبع يمكن للسلطات الدينيّة في بعض المجتمعات أنْ تلزم الناس العاديّين بالحركة السياسيّة مِن خلال التكليف، إلّا أنَّ هذا الأمر غير ممكن في حقّ أهل الفكر والنخب؛ لأنَّهم مختارون.
في المجتمعات التقليديّة، كان يعتقد بأنَّ لنظام العائلة وللحكومة حالة مِن «الوضع الطبيعي»، وبالتالي فإنَّ وظيفة وتكليف الأشخاص، هو تشخيص الوضع الطبيعي والعمل على طبقه. لكنْ في وعي «الحداثة»، لا مكان لتصوّر الوضع الطبيعي المجهول مسبقًا لأجل النظام السياسي والثقافي والعائلي، بل وحتّى للنظام القيمي ذي الرتبة الثانية، والخادم للقيم ذي الرتبة الأولى.
يمكن القول إنَّ الرؤى الدينيّة السابقة، كانت متناسبة مع رؤية الوضع الطبيعي للأشياء. ولكنْ في العالم الجديد لا تحظى هذه الرؤية بالقبول عند أكثريّة الناس.
ولا بدَّ مِن ظهور ومجيء رؤية دينيّة جديدة لهؤلاء، وما هو المشترك بين كلّ الرؤى الدينيّة في مختلف العصور، هو أنَّ الإنسان بُعد أبعد مِن ذاته، وهذا العالم يرغب في الحصول على الواقع الهائل السامي.
(178)يجب على المؤمنين في العصر الحاضر أنْ يبدؤوا في مسائل الحكومة والسياسة مِن هذه النقطة، وهي أنَّهم يريدون مراعاة الحقوق الإنسانيّة لكلّ الناس، على أساس أنَّ كلّ فرد هو إنسان فحسب. وهذا يعني إعادة تنظيم كلّ النظم الاجتماعيّة على أساس «حقوق البشر». وأنا في كتابي أشرت بوضوح إلى ضرورة انسجام حقوق الإنسان مع المسلمين (بشرط العدول عن فتوى السابقين)، ليس هذا فحسب، بل برهنت بشكل واضح على أنَّ الواقع المسلّم به لتعايش المسلمين في العصر الحاضر والوفاء لرسالة النبيّ الأكرم للإسلام، هو أنْ نقبل «حقوق البشر»، وأنْ نجعلها الأساس لتنظيم المجتمع عندنا.
الواقع يشهد بأنَّ تمام ما جاء في الهداية الدينيّة، هو في حدّ ذاته جزء مِن ثقافة الإنسان المختار في عصرنا الحاضر، وليس شيئًا خارجًا عن ثقافة هذا الإنسان.
في عصرنا الحاضر، رسالة الدين عبارة عن رسالة «معنى الكون مع الله». وأمّا أزمة عصرنا الحاضر، فهي أزمة «معنى ومفهوم الحياة». وإذا قال مفسّرو الدين بأنّ الدين لا يتعارض مع حقوق الناس، وإذا اعترفوا بشكل رسمي باختيار الإنسان، وقالوا بأنّه لا بدّ مِن تنظيم المؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة عند المسلمين على أساس «حقوق البشر»، وأنَّ هدفهم هو ضرورة تعميم العدالة في الحياة الاجتماعيّة، فحينئذٍ يمكن القول بأنَّ رسالة الدين قد أبلغت بشكل صحيح في السياسة والحكومة، ويمكن أنْ يكون لها معنى في عصرنا الحاضر.
(179)وقطعًا، إنَّ هذه المسائل مرتبطة بعصرنا الحاضر. وأمّا في السابق، إذا تكلّموا في السياسة والحكومة بلغة التكليف، فتلك اللغة كانت توصل لسان رسالة الدين. وفي هذا العصر، يجب علينا أنْ نكون أبناء عصرنا الحاضر كما كان أولئك أبناء عصرهم السابق.
وفي رأينا، فإنَّ أنصار القراءة الرسميّة، لا يمكنهم حتّى مِن فهم القراءة الأرثوذكسيّة المتعلّقة بالمجتمع التقليدي.
إنَّ هؤلاء، وبدلًا مِن المعطيات التاريخيّة والتي ينبغي أنْ تكون المبنى الأصل لمعرفة القراءة الأرثوذكسيّة (التقليديّة)، جعلوا المفاهيم الذهنيّة والانتزاعيّة والمأخوذة غالبًا مِن الفلسفة اليونانيّة معيارًا لقراءاتهم. ومثالًا على ذلك يقولون: إنَّ القضايا المرتبطة بالأحكام، والتي وردت في القرآن الكريم أو سنّة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، إنّما هي قضايا حقيقيّة وليست قضايا خارجيّة. ولهذا السبب يقولون في تلك الأبواب بأنَّ الحكم مجعول لذات الموضوع.
ويعتبر هؤلاء بأنَّ هذه الأحكام هي أكبر مِن الأحكام المرتبطة بالواقع الموجود آنذاك في أرض الحجاز. ويرى هؤلاء بأنّ هذه الأحكام هي أحكام أبديّة بإمكانها تأمين المصالح المفترضة الدائميّة والواقعيّة غير القابلة للتغيير.
إنّ هذه الرؤية مبتنية على فرض «الذات» الموروثة مِن الفكر اليوناني والمسلّطة على كلّ علم الفقه. في حين أنّه إذا درسوا القراءة الأرثوذكسيّة (التقليديّة) على أساس منهج الظواهر التاريخيّة، لعلموا أنَّ أحكام المعاملات
والسياسات كانت مؤقّتة بحسب تاريخها، وأنَّ تلك الأحكام لم تكن على نحو القضايا الحقيقيّة، وإنّما على نحو القضايا الخارجيّة التي راعت فقط المصالح الوقتيّة في ذلك العصر وتلك البيئة، وأصلًا لا يمكن أنْ تكون على غير هذا النحو. في السابق كانت الحياة الاجتماعيّة للمسلمين حياة تقليديّة، ومِن باب إطاعة الرعية للراعي. وقد بنيت المفاهيم السياسيّة لذلك الزمان؛ كالبيعة والشورى والعدالة والإمامة و... على أساس ذلك المحور.
وأمّا في مقام الجواب عن هذا السؤال: «في المجتمع الديني، وبالنسبة لخصوص الكتاب والسنّة، ما هي القنوات وإلى أيّ حدّ بإمكانها، وكما ينبغي، أن تؤثّر على الحكومة؟» بداية لا بدّ أنْ أذكّر بهذه النكتة، وهي أنَّه في مجتمع مثل مجتمعنا الذي لديه دين وحياني، ينبغي لمجموعة الأحكام، الشعائر، المفاهيم، والقيم الدينيّة أنْ تكون جميعها مولودة وتابعة لتجربة كلام الله مع أهل المجتمع عبر طريق السنّة الدينيّة (وهي تجربة وحدة الإنسان الكون والله نفسها). وحتمًا إنَّ عامّة الناس محرومون ظاهرًا مِن مثل هذه التجربة. إلّا أنَّ النكتة المهمّة هنا، هي أنَّ ما يلتزم به عامّة الناس مِن مفاهيم وقيم وأحكام عباديّة وشعائر، ينبغي أنْ تكون قد نشأت مِن التجربة الدينيّة للخواص وتابعة لها ومولودة منها.
مِن خلال هذه المقدّمة، يرى شبستري أنَّ تأثير الكتاب والسنّة على الحكومة، ينبغي أنْ يتمّ عبر طريقين:
الطريق الأول: ما هو شكل الحكومة وأيّ نظريّة للعدالة يمكن أنْ يكونا أكثر انسجامًا مع تسهيل التجربة الدينيّة، وتسهيل الإيمان والتخلّق بالأخلاق الوحيانيّة؟.
(181)هذه الحالة هي حالة «الدين هو الحاكم النهائي في باب الحكومة والسياسة» نفسها، (وقطعًا هو متباين بالكامل مع «لسان التكليف» للقراءة الحكوميّة والفقهيّة).
والطريق الثاني: ينبغي على المؤمنين، مِن موقعهم الإيماني بعد الانتخاب العقلاني لنوع الحكومة وشكلها، أنْ يكونوا ناقدين لبرنامج الحكومة وسياساتها. وينبغي عليهم أنْ يدرسوا ويحلّلوا مثلًا مدى انسجام هذه الحكومة مع هدف العدالة. وفي رأيي، فإنَّ الخطاب السياسي والاجتماعي الوحيد لدين الإسلام، هو ضرورة تحقّق العدالة. إنَّ الخطاب السياسي للدين يتمحور في الترغيب الأخلاقي لعامّة الناس بمتابعة العدالة ورعاية الأخلاق في السياسة.
التديّن عمل الإنسان، والدين متعلّق بالإنسان. إنَّه نوع مِن العيش، تشغيله بيد الله، ولكنَّ السلوك هو شأن إنساني. وقد ورد في القرآن المجيد «إنَّ الدين عند الله الإسلام». فالإسلام والتسليم هو شأن إنساني. وحيث أنَّ الأمر على هذا النحو، فلا يمكن للدين أنْ ينفي الإنسان. ولا بدّ لنا أنْ نرى الأبعاد التي قدّمها الإنسان عن ذاته طوال تاريخ حياته. إنَّ تديّن الإنسان لا ينبغي له أنْ يسلب منه أيّ بُعدٍ مِن أبعاد وجوده، ولا يمكن للدين أنْ يأخذ مكان العلم والفلسفة والفن. نعم إنَّ الإنسان عبر طريق معرفة الله وسائر التجارب الدينيّة الأخرى، يعطي معنى لذاته، وبالتبع لها يعطي معنى لسائر أبعاده الوجوديّة أيضًا. إنَّ الدين يعطي معنى أيضًا لموضع الدين من: الفلسفة، العلم، الفنّ،
(182)القيم، والحقوق. إلّا أنَّ هذا الإعطاء للمعنى، لا يعني أنَّ أمثال هذه الأمور خالية مِن محتواها ومضمونها.
وعلى العكس تمامًا، فإنَّ القراءة غير الإنسانيّة أو «فوق الإنسانيّة» للدين والتديّن، تعتقد أنَّ الدين ليس هو السلوك المعنوي لنفس الإنسان ذي الأبعاد الوجوديّة المختلفة، وإنّما هو مجموعة مِن العلوم والأحكام الغيبيّة ما فوق العقل الإنساني جاءت مِن العلوم والأحكام الغيبيّة ما فوق العقل الإنساني، جاءت مِن عند الله إلى الناس؛ ليتعلّموها ويعملوا بها.
وينبغي على الإنسان أنْ يقايس كلّ ما يملك وما هو جزء مِن رأس ماله ومقدّراته مع ذلك العامل الوارد مِن الغيب، والذي ليس جزءًا مِن ممتلكاته ورأس ماله، وبالتالي يعلم صحّتها وسقمها مِن خلال ذلك العامل الغيبي، ويضع جانبًا كلّ ما لا يتوافق معه.
في هذا التفكّر، يصبح الوحي عبارة عن سلسلة مِن البيانات العلميّة، محتواها غير العلوم وغير مقدرات الإنسان نفسه وفوق العقل. وفي هذا التفكّر، يلزم وجود شقاق بين الله وبين الإنسان. ومعنى هذا الكلام، أنّه مع ورود الوحي تسقط كلّ معرفة عن اعتبارها الأصيل، ويتلاشى الإنسان وتذهب رؤوس المال البشريّة في مهبّ الرياح.
إلّا أنَّ هذا التصوّر عن الدين، لا ينسجم أبدًا مع التلقّي الأوّلي للمسلمين عن الدين والوحي، ولا مع تصوّر فلاسفة المسلمين أيضًا عن الدين والوحي. فالفلاسفة اعتبروا أنَّ الوحي والنبوّة، هما نوع مِن اتّصال النبيّ مع العقل الفعّال، وفسّروا ذلك بالقول أنَّ النبيّ إنسان، وبسبب الخصائص الإنسانيّة
(183)الخاصّة عند النبيّ، هو في حالة صعود وعروج عند الاتّصال بالعقل الفعّال. المرحوم العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وفي كلامه حول مباحث النبوّة، يصرّ ويصرّح بأنَّ الوحي والنبوّة هما مِن جملة قابليّات الإنسان نفسه. نعم ليس كلّ إنسان، بل الإنسان الخاصّ المميّز. ويقول الطباطبائي: إنَّ الوحي شعور خفيّ يظهر عند بعض الناس المميّزين خاصّة. وبشكل كلّي، إنَّ المعرفة القدسيّة بمعناها الموجود في المسيحيّة، لا نراها في عالم الإسلام سوى عند بعض العرفاء. وإذا كان الدين عبارة عن مجموعة مِن العلوم فوق البشريّة، والتي تسقط كلّ الأمور والعلوم الأخرى عن الاعتبار، فحينئذٍ مِن غير المعلوم أصلًا كيف يمكن للإنسان أنْ يفهم هذه العلوم وأنْ يرتبط بها.
إنَّ أوّل ما يطرح في الأديان الوحيانيّة، وقبل كلّ شيء، هو مسألة «فهم الخطاب». وعند بعض الأديان الأخرى، ليس الأمر على هذا المنوال، بل أساسًا لا يطرح فيها تجربة «الخطاب الواحد»، وإنّما نوع مِن التجربة الواقعيّة، أو نوع مِن التخلّي عن الواقع.
إنَّ «فهم الخطاب» على نحوين؛ أحيانًا يتمّ فهم الخطاب مِن خلال تحويل الخطاب إلى كائن (موضوع) مثل سائر الكائنات الأخرى. وبالتالي، فإنَّ الذين يذهبون بهذا الاتّجاه يسقطون الخطاب عن كونه خطابًا، ويجعلونه بشكل مجهول علمي، وفي حال التخاطب ليس بإمكاني أنا أنْ أدرسك ككائن (موضوع)، ولن يكون بإمكانك أيضًا أنْ تقوم بذلك تجاهي أنا.
(184)وهناك نوع آخر موجود لفهم الخطاب مِن نوع فهم الأشخاص لبعضهم البعض، ويبدو لي أنّه يجب علينا فهم النصوص الوحيانيّة بهذا الشكل. ولهذا السبب، فإنّني أرجّح منهج الهرمنيوطيقا الوجوديّة على منهج الهرمنيوطيقا الوضعيّة والوضعيّة الجديدة؛ لأنّها أكثر انسجامًا مع طبيعة هذه الأديان، وتساعد على بقاء تجربة الخطاب حيّة في السُنّة الوحيانيّة. وقطعًا، إنَّ هذا الكلام لا يعني أنّ الإنسان المتديّن المستفيد مِن عقلانيّة الهرمنيوطيقا الوجوديّة، لا حاجة له للعقل الانتقادي (الفكر النقدي) أو للعقل الآلي.
وعندما يقوم أيّ فرد بتفسير وبيان تجربته، ويجلس مع الآخرين للحوار معهم، ينبغي عليه أنْ يستمع لكلام مَنْ ينتقد عقلانيّته الوجوديّة وتأويله (هرمنيوطيقيّته). ومِن طرف آخر، إذا تقرّر أنْ تكون الحكومة بيد إنسان كهذا، فلا بدّ لها أنْ تستفيد مِن العقل الآلي لأجل أهدافها السياسيّة والدينيّة.
وبناء على ذلك، فإنّ كلّ النصب الديني «خطاب واحد»، ويجب علينا أنْ ندرس أجزاءه المختلفة في كُلٍّ واحدٍ، على أساس أنَّ التجربة النبوّیة قد تحقّقت بحيث تأخذ جذورها مِن الثقافة مِن ناحية، ومِن ناحية أخرى أيضًا تؤثّر في كلّ أبعاد تلك الثقافة، وتكون بشكل دائم في أخذٍ وردٍّ معها (في معاملة مستمرّة)، وبشكل عام تضع الأبعاد المختلفة للحياة وبأشكالها المختلفة أيضًا تحت تأثيرها.
وأساسًا، إنَّ المطالعة الجزئيّة وتفكيك الأجزاء عن بعضها البعض، غير صحيح. ولذا ينبغي مطالعة القرآن المجيد، على أساس أنّه «خطاب واحد» وله «ذاتيّات وعرضيّات». وبعبارة أخرى: له «معنى أساسي» و «معنى
(185)فرعي». إذا طالعنا على هذا النحو، فحينئذٍ لن نرى الأحكام الاقتصاديّة أو الأحكام العباديّة المأخوذة مِن القرآن المجيد، قد نسجت بشكل منفصل عن بعضها البعض.
كما ذكرنا فيما سبق، فإنَّ نقد كتاب وأقوال السيّد شبستري، يحتاج إلى مجالٍ أوسع ممّا لدينا ها هنا؛ حيث يُرى في سائر أنحاء هذا الكتاب الكثير مِن التعاريف والتحليلات الناقصة، والمستندات الخاطئة والخلط المفهومي. وبالتالي، فإنّ التعرّض لكلّ واحد منها على حدّة، يحتاج إلى كتاب بحجم كتابه، بل أكبر مِن ذلك.
لذا، ولأجل اطّلاع القرّاء المثقّفين لهذه المجلّة، سوف نكتفي هنا بالإشارة إلى المحاور الأساسيّة في أثناء نقد هذا الكتاب، ونوكل أمر متابعة هذه البحوث إلى القرّاء الكرام.
إنَّ ما قدّمه المؤلِّف المحترم تحت عنوان القراءة الرسميّة للدين، هو خليط مِن المطالب الصحيحة والخاطئة. وبالتالي، فإنّ التعرّف عليها سوف يلقي ظلالًا مِن الشكّ والتردّد على مشروع المؤلِّف النقدي. وسوف يتنزّل تصوّره عن القراءة الفقهيّة ـ الحكوميّة إلى حدّ الخيال المصطنع.
لقد اتّهم السيّد شبستري أنصار القراءة الرسميّة بأنّ هذه القراءة «في مجال الحكومة، البرامج ووظائف الحكومة، وتعريف العدالة، لا تقدّم نظريّة
(186)فلسفيّة، وإنَّما تحدّد سلسلة مِن الآداب والحلال والحرام، وتطلب مِن المؤمنين والحكومة أنْ يعملوا على أساسها».
وقد ذكر المؤلِّف في كتابه أسماء عدد مِن الشخصيّات المعروفة كالشيخ هاشمي رفسنجاني، والشيخ مصباح اليزدي، والشيخ جواد آملي، والشيخ محمّد تقي جعفري، بعنوان إنّهم ممثّلو القراءة الرسميّة.
وهنا أسأل حقيقة أيّ واحدٍ مِن هؤلاء العظماء يمكن أن يُنسب إليه القول بمثل هذه الأفكار؟
إنّ قليلًا مِن المعرفة بالسجّل الثقافي لهذه الشخصيّات كافٍ ليعلم أنّ هؤلاء مِن جملة أهل الحوزة العلميّة الذين عمل كلّ واحد منهم بمقدار وسعه لسنوات خلت قبل انتصار الثورة الإسلاميّة وإلى يومنا الحاضر في بيان فلسفة السياسة والحقوق الإسلاميّة، وكذلك في تقديم النظام الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في الإسلام، وتركوا العديد مِن الآثار والمؤلّفات في هذا المجال.
وهؤلاء أيضًا كانوا مِن السبّاقين في الحوزة العلميّة على مستوى الدراسات الحديثة وعلومها للوصول إلى هذا النوع مِن البحوث السالفة الذكر. نعم مِن البدهي جدًّا، ولعدم وجود سابقة لها في أدبياتنا الدينيّة، أنْ لا تكون أمثال هذه البحوث والعلوم قد وصلت إلى مرحلة النضج المطلوب وإعطاء الثمار، وكما هو الحال أيضًا في سائر الحوزات المعرفيّة الأخرى؛ إذ لا بدّ لها مِن مزيدٍ في التحقيق والبحوث العميقة. وبناءً عليه، فإنّ هذه الإشارة تبعد عدّة أميال عن دعوى المؤلِّف باتّهام هؤلاء بإنكار مثل هذه المقولات.
(187)كذلك صرّح شبستري مرارًا وتكرارًا بأنّ أنصار القراءة الرسميّة لم يسمحوا للخبراء والنخب في دراسة واختيار نوع المؤسسات الاقتصاديّة والسياسيّة أو النظريّات والبرامج الاجتماعيّة التي يمكنها أنْ تساهم في تحقّق المبادئ والقيم الدينيّة والمصالح الوطنيّة، بل اكتفوا فقط بتكليف مؤسّسة واحدة أو الاكتفاء ببرنامجٍ واحد.
إنّ هذا الاتّهام أيضًا يتنافي تمامًا مع المنهج المتّبع منذ عقدين، إذ تقدّم الخبرات اللازمة في الدولة والمجلس النيابي، ومع موافقة مجلس صيانة الدستور وعدم مخالفته القطعيّة لها، فإنّ كل البرامج أو المؤسّسات يتمّ قياسها على أساس الأحكام والقيم الدينيّة.
كذلك لا بدّ مِن التذكير ها هنا بأنّ الدستور الموجود حاليًّا، إنّما هو نتاج مناقشات كثيرة لأهل الخبرة وبالاستفادة مِن إنجازات سائر الدول الأخرى، وقد دوّن مِن قبل مجلس خبراء، أكثريّته كما يدّعي المؤلِّف، مِن أنصار القراءة الرسميّة.
وبناءً على ذلك، فإنّ ما نسبه المؤلِّف في هذا القسم إلى القراءة الرسميّة للدين، لا ينطبق على النهج الحالي في الجمهوريّة الإسلاميّة أو على المبادئ والقوانين الموجودة في الدستور الإيراني، ولا أنّ مثل هذه الأفكار قد نطق بها فقهاء وعلماء الدين العظام أو أنّها كانت مقبولة عندهم.
نعم لا بدّ مِن البحث في أماكن أخرى عن مواضع الخلاف بين السيّد شبستري وعلماء الحوزة والنظام، هناك حيث قام المؤلِّف بنسبة المسلّمات في القرآن والسنّة إلى القراءة الأرثوذكسيّة أو القراءة الرسميّة، ومع رفضه لها
(188)لم يبق في المذهب الجامع للإسلام سوى بعض المفردات الأخلاقيّة الكلّيّة وقليلًا مِن الروحانيّة (المعنويّات) والتجربة الدينيّة. وسوف نتابع عرض هذه المواضيع بالترتيب.
كما ذكرنا فإنّ المشكلة العويصة عند السيّد شبستري تكمن في رؤيته حول الدين والإسلام.
إنّ مفهومه النهائي عن الإسلام هو بالدقّة التصوّر نفسه الذي قدّمه بعض المتكلّمين الجدد مِن البروتستانت، والذين تأثّروا بالحداثة الغربيّة وقلّلوا مِن شأن الدين إلى حدّ أنّه تجربة روحيّة غامضة (مبهمة) وقابلة للتفسير. والعجيب هنا، أنّ المؤلِّف في مقام تبرير تعريفه، نسب تعريفًا للدين إلى القراءة الرسميّة قلّما يخطر في ذهن أقلّ عالمٍ مسلم. يعتقد شبستري بأنّه وفقًا للقراءة الرسميّة «الدين ليس هو السلوك المعنوي للإنسان ذي الأبعاد الوجوديّة المختلفة، بل هو مجموعة مِن العلوم والأحكام الغيبيّة وما فوق العقل الإنساني، جاءت مِن عند الله تعالى إلى الناس لأجل أنْ يعلموا بها ويقايسوا برامجهم ومقدّراتهم معها». واستنتج مِن خلال ذلك أنّه في هذا التفكير يوجد شقاق بين الله وبين الإنسان، ومع نزول الوحي تسقط كلّ معرفة أصيلة عن الاعتبار، ويتلاشى الإنسان وتذهب كلّ الاستثمارات الإنسانيّة في مهبّ الرياح.
في هذا الكلام المختصر والقليل لدينا خليط واضح مِن عدّة جهات:
(189)لم يميّز السيّد شبستري بين حقيقة الدين والتديّن؛ فجعل الدين بعنوان أنّه مجموعة مِن الحقائق السماويّة في مقابل التديّن، باعتبار أنّه السلوك الروحي للإنسان. في حين أنّ هاتين المقولتين لا تعارض بينهما فحسب، بل يصبح لهما معنى ومفهوم عندما يترافقان معًا.
إنّ الحقائق الوحيانيّة في الحقيقة هي البرنامج والمرشد الهادي لأفراد الناس في سلوكهم الروحي وسيرهم نحو الكمال المطلوب، ومن ثمّ فإنّ التديّن الناتج عن سعي الإنسان وهمّته، إذا لم يكن قائمًا على أساس نموذج وطقوس آمنة ومطمئنة تبيّن الطريق والمقصد مِن جميع الأبعاد والزوايا المختلفة، فلن يؤدّي إلى الانحراف والخرافات.
وخلاصة الكلام هنا، إنَّ الفكر الإسلامي قد أكّد على كلا الأمرين معًا «الدين النازل» و «السلوك الصاعد»، ولا يمكن بأيّ وجه مِن الوجوه جعل أحدهما مقابل الآخر.
إنّ المؤلِّف في جميع آثاره لم يعتقد فحسب بأنّ «الدين» هو السلوك المعنوي للإنسان نفسه، بل اعتقد أيضًا بأنّ «الوحي» هو نوع مِن التجربة الباطنيّة الإنسانيّة، وأنّ مصداقه موجود عند عامّة النّاس «بالقوّة» وعند العرفاء والخواص مِن المؤمنين «بالفعل». وصرّح أيضًا بأنّ الأحكام والعبادات في عصرنا إنّما تكون مشروعة ومُجازة، فيما لو نشأت مِن التجربة الدينيّة للنّاس والخواص، أو كانت منسجمة معها.
(190)وهنا نرى أنّ المؤلِّف ودون التفات إلى الاختلاف الأساسي لمفهوم «الوحي» في التقاليد الإسلاميّة والمسيحيّة، نسب ما هو مستفاد عند بعض المتكلّمين المسيحيّين الجدد مِن الأناجيل المحرّفة إلى الوحي بالمفهوم القرآني.
وهذه الملاحظة قد بيّنت بشكل واضح وجليّ في آيات متعدّدة مِن القرآن الكريم إلى حدّ أنّ كثيرًا مِن دارسي الإسلام في الغرب ومِن خلال مقايسة بسيطة جدًّا، وضعوا اليد على هذا المفرق بين الإسلام والمسيحيّة.
في نظر القرآن الكريم ورغم أنّ التجربة الدينيّة هي حاصل سلوك البشر في مسير العبوديّة للحقّ تعالى، إلّا أنَّ «الوحي» حقيقة سماويّة نازلة مِن عند الله على المصطفين مِن الناس (الأنبياء)، ومطلقًا ليس هو حاصل القدرات الذهنيّة والروحيّة للنبيّ نفسه.
نعم، لا شكّ ولا تردّد في أنَّ النبيّ إنسان، ولا بدّ له في مقام استقبال وتلقّي الوحي مِن امتلاكه للاستعداد والقابليّة الروحيّة والسلوكيّة، إلّا أنّ الوحي نفسه ذو جنبة إلهيّة ولا دخل النبيّ في شكله ومضمونه.
هذه النكتة يمكن استفادتها مِن آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم، وقد اتّفقت آراء المفسّرين الكبار حولها.
﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ والمشير للاهتمام هنا، وبحسب ما ورد في القرآن الكريم، فإنّ «بشريّة النبيّ» تدلّ بالدقة على «كون الوحي غير بشري»: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾.
وهنا يصرّح القرآن بأنّ الوحي حامل «علم الغيب»: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾؛ ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾. ويكرّر النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله دائمًا بأنّه تابع وخاضعٌ للوحي المنزّل مِن عند الله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾؛ ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾. وفي رأينا إنَّ هذا العدد مِن الآيات كافٍ لردّ دعوى المؤلِّف، وأنْ ما نسبه مِن استنتاجه عن الوحي إلى القرآن الكريم، لا أساس له وبعيد كلّ البعد عن ثقافة القرآن.
والمثير للاهتمام هنا أيضًا أنَّ السيّد شبستري استفاد مِن الآية الشريفة ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾ أنّ الإسلام هنا بمعنى التسليم الذي هو فعل بشري. ومِن هنا استنتج أنَّ الدين أيضًا فعل بشريّ، وأنّه نتاج التجربة الدينيّة للمؤمنين. وبغضّ النظر عن الآيات الكثيرة التي توضح معنى الإسلام بشكل جيّد، يكفي السيّد شبستري أنْ يلتفت إلى ذيل الآية المذكورة نفسها ليدرك وهن استنباطه؛ ففي الآية 19 مِن سورة آل عمران التي استند المؤلِّف إلى قسم منها ورد ما يلي: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. وكما هو الظاهر مِن هذه الآية، فإنّ الإسلام قد أطلق على «الدين» الذي يقوم على محور «الكتاب» ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، وهذا الدين والكتاب يحملان علمًا جاء مِن عند الله تعالى ﴿جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾.
وهنا نسأل طبقًا لرأي المؤلِّف كيف يمكن أنْ نفسّر «الإسلام» الوارد في الآيات التالية بمعنى تسليم الإنسان المؤمن؟ ومثال على ذلك الآية الشريفة: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ حيث عرَّف الإسلام بأنّه حقيقة ينبغي على الإنسان أنْ يعترف عليها ويكون تابعًا لها؛ أو في هذه الآية ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ عبّر عن الإسلام هنا بأنّه نعمة مِن الله أعطيت للإنسان، وأنّه قد جعله كاملًا. وكذلك ما ورد في الآيات نظير قوله: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ حيث أكّد بشكل واضح على أنّ الإسلام حقيقة فوق إنسانيّة يتمّ تعليمها للناس.
الدين والإنجازات البشريّة
إنّ السيّد شبستري، ومِن خلال التصوّر الغريب الذي ذكره عن القراءة الرسميّة، ومع الاستنتاج الأغرب والعجيب أيضًا، يتّهم العلماء المسلمين والحوزات الدينيّة بجعل الدين في مواجهة العلوم البشريّة؛ فهو مع نسبته هذا التعريف عن الدين إلى القراءة الرسميّة «الدين مجموعة مِن العلوم الغيبيّة وفوق العقل الإنساني...» استنتج بأنّه: «في هذا التفكّر يوجد شقاق بين الله وبين الإنسان، ومع ورود الوحي فإنّ كلّ معرفة سوف تفقد اعتبارها الأصيل وإنَّ الإنسان سيتلاشى وينهار...».
مع إهمالنا وتجاوزنا التفسيرات الشعريّة للمؤلِّف، فمِن غير المعلوم لنا
مَنْ هو وأي واحد مِن علماء الإسلام المعاصرين، الذي يعتقد بأنّ الدين كلّه فوق العقل الإنساني؟
وإذا قيل أنّ قسمًا مِن الدين يرتبط بعالم الغيب ولا يقع في نطاق الفهم البشري العادي عند كل النّاس؛ نسأل هنا كيف وبأيّ منطق وبأيّ منهجيّة يمكن الاستنتاج بأنّه قد تمّ تجاهل كلّ الإنجازات البشريّة؟
إذا اعتقد أحدٌ ما بأنّ الله تعالى أنزل إلينا حقائق وضوابط لأجل تنظيم حياة الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة، وفي الوقت نفسه، ومع احترام فكر وتجارب الناس، ألزم هؤلاء بمراعاة تلك المبادئ ودعا المؤمنين إلى اختيار وعرض برامجهم على أساس أنْ تكون في نطاق الأحكام والقيم الدينيّة لأجل الوصول إلى تحقيق المثل الإسلاميّة العليا والقطعيّة.
فكيف يمكن لمثل هذا الاعتقاد أنْ يؤدّي إلى حصول «شقاق ونزاع بين الله والإنسان» وأنَّ «كلّ معرفة سوف تفقد اعتبارها الأصيل»، والأنكى مِن ذلك كيف أنَّ «الإنسان سيتلاشى وينهار»؟!
ألا ينبغي لأحدٍ ما أنْ يسأله: مَنِ الذي صرّح بمثل هذا الكلام مِن علماء الدين والفقاهة، وأين صرّح بذلك؟!
كما قيل أيضًا، فإنَّ الخلاف الأساس للسيّد الشبستري، إنّما هو مع الآراء المشهورة والمتعارفة عند العلماء والفقهاء. ومن جملة ذلك، ينبغي البحث في هذه العبارة؛ حيث يعتقد بأنَّ «الخطاب الوحيد لدين الإسلام في السياسة والاجتماع هو إجراء العدالة». ويقلّل مِن ذلك إلى حدّ أنّه «الخطاب الأخلاقي للدين في نطاق السياسة».
(194)ويرى المؤلِّف بأنّ كلّ الأحكام العباديّة والقضائيّة والسياسيّة أحكامٌ غير ثابتة، وأنّها «قضايا خارجيّة تؤمّن مصالح ومفاسد مؤقّتة لذلك العصر وتلك البلاد». بل يرى أيضًا بأنّ الأحكام العباديّة ليست ثابتة بنحو أبديّ. ويعتقد بأنّ «مجموعة الأحكام والشعائر والمفاهيم والقيم الدينيّة ينبغي أنْ تكون كلّها مولودة وتابعة لتجربة كلام الله مع أفراد المجتمع بواسطة السُنّة الدينيّة». ويصرّح بأنَّ «ما يلتزم به عوام الناس على شكل المفاهيم والقيم والأحكام العباديّة والشعائر، قد نشأت مِن تجربة الخواص، وهي مولودة منها وتابعة لها».
وبناءً على ذلك، فإنّه يعتقد بضرورة مطالعة القرآن على أساس منهج الظواهر التاريخيّة، وأنّه مولود تجربة دينيّة خاصّة (التجربة النبويّة) في بلاد وشرائط خاصّة لأرض الحجاز، وينبغي على العالم الديني في عصرنا الحاضر أنْ يضع جانبًا الكلام عن التكليف وتبعيّة الوحي، وأنْ يعمل بالاستناد إلى ثقافة الحداثة ومؤشّرات المجتمع الغربي الحديث في المعاملات والسياسات على تأسيس وتدوين قوانين وقرارات حيّة وتنظيم العبادات والشعائر الدينيّة، طبقًا للتجربة الشخصيّة للأفراد.
كما نرى ودون أيّ شك وتردّد، فإنَّ هذه الآراء لا تنسجم فحسب مع تعاليم علماء المسلمين وإجماعهم، بل إنّها مخالفة بنحو قطعي للنصوص الإسلاميّة القطعيّة، وفي تضادّ واضح مع مقصود وسيرة الأنبياءوالأولياء.
وفي المقابل، فإنّ الرأي المشهور والنظريّة المعروفة عند عامّة علماء
(195)الدين ـ والذين يوصفهم شبستري بأنّهم أنصار القراءة الرسميّة ـ على النحو الآتي:
أ) الخطاب الإسلامي والاجتماعي في الإسلام لا ينحصر بأصل العدالة، بل يوجد غيره الكثير مِن الأحكام والأصول والقيم الدخيلة في ذلك، وقد بحثت في كتب العلماء المسلمين، ولا سيّما في العقد الأخير.
ب) في خصوص أصل العدالة، ينبغي القول أيضًا بأنّ للعدالة في تاريخ الفكر الاجتماعي العديد مِن التعاريف والقواعد والآليّات. وفي عصرنا الحاضر يدّعي كلّ مِن الاشتراكيّة واليبراليّة بأنّه مِن طلّاب العدالة، وفي الدين الإسلامي لم يكتف فقط بذكر عنوان العدالة، بل وضع لها، ولا سيّما في النظام العائلي والاجتماعي العديد مِن القواعد والأصول والمبادئ والأحكام الخاصّة، ومِن خلال تطبيقها فقط، تتحقّق العدالة وسائر الأهداف الإسلاميّة.
ت) بالرغم مِن وجود أحكام مؤقّتة ومؤرّخة بزمان خاصّ ضمن التشريعات الإسلاميّة، إلّا أنَّ أغلب الأحكام الإسلاميّة الفرديّة والاجتماعيّة، وبناءً على صريح الآيات القرآنيّة والروايات الشريفة أبديّة وغير قابلة للتغيير. ومِن ثَمَّ فإنّ تشخيص الأحكام المؤقّتة وتمييزها عن الأحكام الثابتة ممكن مِن خلال منهجيّة خاصّة في الاجتهاد وبالاستناد إلى الحجّة العقليّة والشرعيّة، وليس مِن خلال التمسّك بالتحوّلات التاريخيّة التي حدثت لظروف خاصّة في المجتمع الغربي.
ث) الدين الإسلامي لم يمنع إطلاقًا الاستفادة مِن التجربة والتفكير، بل وشجّع أيضًا على طلب العلم والإبداع والتأمّل والتطوير، ورغّب
(196)المسلمين في ذلك. ويرى الإسلام بلزوم ووجوب تحصيل أيّ علم له دخالة وتأثير في التنمية وتحقيق الأهداف الإنسانيّة المعقولة وتطبيق المقرّرات الدينيّة.
ج) السياسة والحكومة ولدت مِن التعاون والتعايش بين مؤسّستي «المعرفة الدينيّة» و «الخبرة العلميّة»، وكلاهما في محلّه ومكانه له تأثيره الخاصّ في بيان وتدوين الهيكليّة والمؤسّسات السياسيّة والاقتصاديّة البانية للتمدّن الإسلامي في كلّ عصر وفي أيّ ظروف خاصّة.
ح) في خضمّ التعاون بين المؤسّستين المذكورتين، وكما أنّ الدين ينبغي له أنْ يكون ناظرًا إلى الحاجات والشرائط الواقعيّة للزمان، وكذلك مطابقة القواعد والمبادئ والقيم للقدرات الاجتماعيّة والتاريخيّة بهدف تحقيق النموذج الأفضل والبرامج الموضوعيّة والتنفيذيّة، كذلك ينبغي للخبرات العلميّة أيضًا أنْ تجعل الافتراضات والأطر الدينيّة بديلة عن الافتراضات العاديّة والقيم العلمانيّة.
في عصرنا الحاضر يمكن الكشف عن هذا الأمر، وهو أنَّ العلوم الجديدة في الغرب، والتي بنيت على مبانٍ خاصّة في الإنسانيّات والكونيّات، وكذلك علم الاقتصاد والإدارة الغربيين؛ لا يمكنها أنْ تكون في خدمة تنفيذ المبادئ والأحكام الإسلاميّة وتحقّق الأهداف الدينيّة المطلوبة. وبناءً على التحقيقات الجديدة في فلسفة العلم، ولا سيّما في نطاق فلسفة العلوم الاجتماعيّة، اتّضح جليًّا أنَّ العلوم التجريبيّة والإنسانيّة موجّهة وتتأثّر بقيم وآراء العلماء وثقافة المجتمع.
(197)بالنظر إلى هذه المكوّنات والأفكار، والتي يمكن مِن خلالها مقايسة قراءة السيّد شبستري مع الفكر الإسلامي، ومع ما فهمه العلماء المسلمون مِن منابع الوحي، كان مِن الأنسب له بدل التعرّض إلى المسائل الجانبيّة والتصوّرات الخياليّة المصطنعة أنْ يعمد إلى طرح هاتين القراءتين مِن الكتاب والسنّة بشكل واضح وشفّاف، وأنْ يذكر أدلّته لإثبات مدعاه وردّ آراء الآخرين وإبطالها.
مع كلّ ما ذكرسابقًا، فلا عجب مِن نظريّة السيّد شبستري حول دور الدين في السياسة والحكومة!
فهو يعتقد بأنّه في كلّ مراحل التخطيط والإدارة السياسيّة، لا دخالة إلّا «للاختيار العقلاني» للخبراء، وفقط في نهاية المطاف لا بدّ أنْ نرى أيّ واحدة مِن المؤسّسات أو النظريّات أكثر انسجامًا مع «تسهيل التجربة الدينيّة» و«تسهيل الإيمان» عند أفراد المجتمع.
مِن الواضح هنا، إذا ظُنّ بأنَّ كلّ الأحكام والقيم الإسلاميّة منسوخة فرضًا، وكما أظهر بأنَّ «ما هو المشترك بين كلّ الرؤى الدينيّة في مختلف العصور، أنَّ للإنسان بعدًا ما وراء نفسه والعالم، ويرغب في الوصول إلى تجربة الواقع المتعالي».
مع هذه الفرضيّة طبعًا سوف يتخلّى عن الحكم الديني فيما يتعلّق بالحياة الاجتماعيّة لصالح أمور ذوقيّة واستحسانيّة نظير تسهيل التجربة الدينيّة وتسهيل الإيمان.
(198)وهنا يجب أنْ نسأل: بأيّ شاخص ومعيار يمكن إثبات أنَّ البرنامج الفلاني، أو في ذلك النموذج الاقتصادي، أو السياسي سيسبّب تسهيل التجربة الدينيّة؟
وأساسًا، مَنْ هو أو مَنْ هم الذين يجب أنْ يكونوا المعيار للتجربة الدينيّة؟
والأهمّ مِن كلّ ذلك ما هو تعريف التجربة الدينيّة؟ وعلى أيّ معطيات أو حالات روحيّة للإنسان يمكن أنْ تُبنى التجربة الدينيّة؟
إنَّ السيّد شبستري يعلم جيّدًا أنّه في الثقافة الغربيّة، وبعد مضيّ أكثر مِن قرنٍ على طرح قضيّة «التجربة الدينيّة» والبحوث الكثيرة حولها؛ لا يوجد حتّى الآن أيّ نظريّة واضحة وقطعيّة حولها. وبناءً عليه، كيف يمكن إيكال قضيّة تدخل الدين في الحياة الاجتماعيّة للبشر ـ والذي يعد أمرًا حسّاسًا وخطيرًا ـ إلى المفاهيم المبهمة والغامضة وذي الوجوه المتعدّدة؟
السيّد شبستري في تعريفه للتجربة الدينيّة والإيمان، استخدم عبارات مبهمة وغامضة مثل قوله «ما وراء الذات والعالم» أو قوله «تجربة الواقع المتعالي والسامي»، ولذا يبقى على عهدته أنْ يشير ويوضّح لنا مثلًا في مسألة تدخّل الحكومة في السوق أيّ الأمرين أكثر انسجامًا معه «تجاوز الإنسان للذات والعالم» أو آليّة السوق الحرّ؟ وأيّ الأمرين أكثر انسجامًا مع «الواقع الشامل المتعالي»، هل هو البنك الربويّ أم البنك اللاربويّ؟ و....
في المقابل، وكما أشرنا سابقًا، فإنّ الحياة الاجتماعيّة للمسلمين مِن منظور الفقه الإسلامي ومضافًا إلى المعايير الأخلاقيّة والإيمانيّة، لا بدّ أن تتبع جملة مِن القواعد والمقرّرات والتي يساهم تطبيقها الصحيح في تحقيق
(199)العدالة والرفاه العام مِن جهة، وكذلك في تحصين الإيمان والأخلاق الدينيّة وانتشارهما. ومِن هنا يعلم أنَّ ما ذكره السيّد شبستري بعنوان «دين الدولة» موضع نقاش وترديد، وبالتالي فإنَّ ضرورة التزام المؤسّسات والقوانين بالأحكام والقيم الدينيّة، لا يمكن التنديد به باسم «دين الدولة».
ومِن ثَمَّ فإنّ رفض هذا الأمر والقبول بالفصل بين الدين والدولة (من الناحية الماهويّة وليس مِن الناحية البنيويّة والشكليّة)، ليس شيئًا آخر سوى القول بالعلمانيّة. ولذا، ينبغي على المؤلِّف المحترم أنْ يتجنّب إطلاق هذا العنوان على نظريّته.
ويعتقد السيّد شبستري بأنّ تطبيق الدين والقيم الإلهيّة يستلزم صيرورة الدين دينًا حكوميًّا وزوال الحقوق الاجتماعيّة لسائر القراءات الأخرى، في حين أنّ تطبيق الأحكام والقيم الدينيّة وفي المجتمع لا يعني بتاتًا وإطلاقًا نفي واستبعاد سائر النتاجات والاستنباطات مِن النصوص الدينيّة.
ونحن أيضًا نعتقد أنّه لا ينبغي للحكومة مِن خلال التدخّل في النطاق المعرفي الديني أنْ تحدّ مِن التحديث والليونة في الاجتهاد الديني، بل لا بدّ مِن بقاء فضاء الحوزة والجامعات مفتوحًا لبيان وطرح النظريّات العلميّة والأفكار والعلوم الحديثة.
وبعبارة أخرى: نقول إنّه مع ضرورة بقاء الدولة الإسلاميّة على ارتباط وثيق ودائم مع الحوزات الدينيّة والعلميّة وتأمين الخدمات المتقابلة بين الحوزة والحكومة، إلّا أنَّ تدخّل الدولة في عمليّة توليد الثقافة والفكر في الحوزة والجامعة خطأ جسيم وله عواقب سيّئة.
(200)وهنا حتمًا لا بدّ بالضرورة مِن الإشارة إلى نكتتين:
أ) لا بدّ للاجتهاد والتجديد في الفكر الديني أنْ يكون منهجيًّا بالكامل، وأنْ يتمّ على أساس الأصول العلميّة؛ ولذا فإنّ طرح الاحتمالات الواهنة التي لا أساس لها، وكذلك تبليغ ونشر النظريّات غير المنطقيّة تحت مسمّى «القراءة الدينيّة»، غير مقبول إطلاقًا في أيّ محفل علمي.
وبصراحة هل يمكن في عصرنا الحاضر أنْ يقوم شخص ما في نطاق علم الفيزياء، ودون الأخذ بالمنهجيّة العلميّة والنتاجات السابقة في هذا العلم، بالتنظير الواهن وغير المستدلّ في هذا المجال وتقديم ذلك في المحافل الأكاديميّة على أساس أنّه نظريّة علميّة؟!
ب) خلافًا لرأي المؤلِّف ومَنْ يوافقه في الفكر، فإنّ تشخيص معيار صحّة وحقانيّة الاجتهاد أو أيّ نظريّة دينيّة لا يتمّ في المحافل غير التخصّصيّة والمحافل السياسيّة والانتخابات، بل وكما هو الحال في سائر الفروع العلميّة والاختصاصات الأخرى، لا بدّ أن تطرح الآراء والأفكار الدينيّة في جامعة علماء الدين، وعلى أساس المنهجيّة المعروفة عندهم. وفي نهاية المطاف، فإنّ الحكم النهائي هو لعلماء الدين في نطاق كل اختصاصاتهم. وبناءً على ذلك، كان حريًا بالسيّد شبستري بدل أنْ يطرح مثل هذه البحوث الفنيّة والتخصصيّة أمام طلّاب الجامعة في اختصاصات أخرى، أنْ يقوم بطرحها في المحافل الحوزويّة وبين المتخصّصين فيها لتعلّم الحقيقة بشكل أكبر سواء له أم لغيره.
(201)خلافًا لرأي المؤلِّف، فإنّ «التكليف» لا يختصّ بقراءة خاصّة للدين أو بنظريّة «الوضع الطبيعي»، بل إنّ التكليف موجود نوعًا ما في كلّ الأيديولوجيّات والمذاهب والنظريّات الاجتماعيّة. التكليف في الواقع هو نفس الأصول والمبادئ والقواعد وبديهيّات كلّ نظام أو مذهب اجتماعي، ومِن خلاله يصبح لكلّ الأفكار والتطوّرات في داخل تلك النماذج معنًى ومفهوم؛ ومثال على ذلك فإنّ «الربا» و «الاحتكار» حرام في العقيدة الإسلاميّة، بينما في العقيدة الليبراليّة هما واجب وضرورة.
كذلك يرى النظام الاشتراكي أنَّ تدخّل الدولة في تحديد القيمة واستقرار السوق واجب ومن لوازم العدالة الاجتماعيّة، في حين ترى بعض الأنظمة الأخرى أنَّ هذا النوع مِن التدخّل حرام، أو أنّه جائزٌ حصرًا في موارد الاضطرار.
وفي الدين الإسلامي تتحقّق العدالة في نطاق العائلة مِن خلال تقسم الحقوق والمسؤوليّات بين الزوج والزوجة. وأمّا التفكّر الغربي المادّي، فيرى أنّها على نحو التساوي بين المرأة والرجل في جميع الجهات.
في بعض الأديان لا بدّ للرجل والمرأة مِن اللباس والحجاب المناسب، وعند البعض الآخر فإنّ هذا اللباس أو الحجاب مخالف للعلمانيّة، أو يُعدّ عندهم نوعًا مِن التمييز الجنوسي، وبالتالي فهو حرام وممنوع.
وفي كلمة واحدة يقال إنَّ التكليف والمسؤوليّة مضافًا إلى الحقوق والامتيازات، تُعدّ مِن جملة العناصر التي لا تنفكّ عن أيّ نظريّة أو أيّ مذهب اجتماعي، وفي محلّه المناسب يمكن إثبات أنّ العقائد والتكاليف في
(202)الأيديولوجيّات المعاصرة بدءًا مِن الماركسيّة والاشتراكيّة ووصولًا إلى الليبراليّة، والنسويّة والفاشيّة، لا تقلّ بأيّ وجه عمّا هو موجود في الأديان الإلهيّة.
وهنا ينبغي أنْ لا نغفل عن ذكر هذه الملاحظة، وهي أنّه خلافًا لرأي السيّد شبستري، حيث توهّم بأنّ الحكومات السابقة كانت قائمة على أساس التكليف، وأنّ الحكومات الحديثة قائمة على أسباب الحريّة؛ فقد أظهرت الدراسات الانتقاديّة في الغرب أنّ دائرة تدخل الدولة في النطاق الخصوصي للأفراد في العالم الحديث كبيرة جدًا وأكثر اتّساعًا مِن غيرها. وإذا كانت الحكومات الاستبداديّة في السابق تأخذ الضرائب الباهظة وتفرض التجنيد الإجباري وتأمين مصاريف الحروب وتفرض السخرة (العمل المجاني) على بعض الناس، كذلك فإنّ الدول الحديثة المتمدّنة تتدخّل في حياة الناس في أكثر المناسبات الاجتماعيّة والخصوصيّة والعائليّة. كما وتعمل مِن خلال وضع القوانين وممارسة التضييق، وتوزيع وتخصيص المصادر والثروات، وفرض أنماط وآليّات محدّدة و... كلّ ذلك يساهم عمليًّا وبشكل خفي في التضييق أكثر فأكثر على حريّة المواطنين.
وهذا هو النمط نفسه الذي أطلق عليه توماس هوبز في بداية عصر الحداثة اسم العقد الاجتماعي والسلطة المطلقة، والنمط الذي دعا ميشيل فوكو في العقود الأخيرة إلى تطبيقه على أجزاء مختلفة مِن العالم الحديث.
وبناءً على ذلك، فإنَّ الاختلاف بين العصر الجديد للغرب مع المجتمعات السابقة، أو الاختلاف بين الفكر الإسلامي والحداثة الغربيّة ليس في «التكليف» و «الحقّ»، بل إنَّ ظهور التنوّع في المناسبات الاجتماعيّة
(203)وتعقيداتها مِن جهة، وخرق التقاليد والردّة عن الدين في المجتمع الغربي مِن جهة أخرى، أدّيا إلى تقديم مصاديق جديدة مِن التكاليف والمتطلّبات الإلزاميّة في قالب ديانات جديدة وأيديولوجيّات حديديّة، ولكنْ بمظهر يميني وتحرّري. إنَّ الفرق الجوهري بين العالم الحديث والعالم السابق يكمن في أنَّ السابقين ـ حتّى على مستوى حقوق الأفراد ـ كانوا يقدّمونها للآخرين على شكل تكاليف ويضعون الضمان التنفيذي اللازم لتطبيقها في ذات أفراد الشعب. ولكن في العالم الجديد، فإنّ كل التكاليف مخفيّة بشكل هائل، ويعمل على ترويجها في قالب الحقوق والحريّات الإنسانيّة، وبالتالي هي فاقدة عمليًّا للضمانات الباطنيّة والوجدانيّة.
وكما هو الظاهر، فإنّ المؤلِّف المحترم قد خلط بشكل واضح بين «نطاق التكاليف» الذي هو مجال قبول الأصول والمبادئ والأطر، وبين «نطاق الخبرات» الذي هو مجال تدوين وصياغة الإستراتيجيّات ووضع النظريّات والنمذجة والتخطيط.
في الأنظمة السياسيّه الجديدة، وكما هو المتعارف مِن خلال اختيار المبادئ والقواعد الحاكمةـ يتمّ ولمرّة واحدة تدوين تلك التكاليف في شكل قانون ودستور. ومِن بعد ذلك في عمليّة صنع القرار، تمهّد المحافل العلميّة والدينيّة والمؤسّسات والجمعيّات ووسائل الإعلام مِن خلال المشاركة والحوار البنّاء، الأرضيّة اللازمة لاختيار وانتخاب السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة مِن بين مختلف الخيارات الموجودة، وفي النهاية تشرف هيئة التحكيم على تطابق القوانين المقرّرة مع الحقوق الدستوريّة.
(204)لقد تهكّم المؤلِّف في موضوع كون الأحكام الشرعيّة على نحو القضايا الحقيقيّة، وقال بأنّ هذا الأمر قد تأثّر بنظريّة «الذات» المأخوذة مِن الفلسفة اليونانيّة. ويبدو لنا أنَّ المؤلِّف لم يميّز بين «الحقيقة» و«الاعتبار»؛ لأنّه وعلى فرض كون «الذات» الفلسفيّة محلّ ترديد، إلّا أنّه لا ربط لها بالذات الاعتباريّة المطروحة في نطاق الحقوق (القانون) والأخلاق. وفي الأساس، فإنَّ القوانين الحقوقيّة غالبًا ما تبيّن على نحو القضيّة الحقيقيّة ولا يمكن بيانها على نحو القضايا الخارجيّة كما توهّم المؤلِّف.
والعجيب ها هنا، أنّه مِن طرفٍ ما يتهكّم على الفقهاء لقبولهم بنظريّة الذات المأخوذة مِن فلسفة اليونان، ومِن طرف آخر وفي مقام تأييد دعواه في تعريف الوحي، يستند إلى نظريّة بعض الفلاسفة المسلمين حول «العقل الفعّال» التي هي أيضًا فلسفة يونانيّة. وأمّا ما ذكره حول كون القضايا الشرعيّة قضايا خارجيّة، فقد تعرّض لها علماء الأصول ضمن بحوث مبسوطة ومفصلّة، وكلامه حولها يشير بوضوح إلى عدم نضجه العلمي في أمثال هذه المسائل والبحوث.
لا بدّ هنا أنْ نضيف هذه الملاحظة، وهي أنّ المؤلِّف في هذا الكتاب أو في بعض الحوارات، قد استند في بعض أقواله إلى عدد مِن الشخصيّات؛ كالعلّامة الطباطبائي والشهيد مطهري، وهي تفتقد إلى الدقّة العلميّة اللازمة، وفي بعض الأحيان مخالفة للواقع؛ ومثال على ذلك، فقد قال في أحد الحوارات
(205)
إنَّ العلّامة الطباطبائي قدسسره قد عبّر عن حقيقة الوحي بأنّه «شعور خفي»، وإنَّ هذه النكتة تدلّ على إنسانيّة وتجريبيّة الوحي، في حين أنَّ العلّامة الطباطبائي نفسه، وفي كتاب له يحمل هذا الاسم نفسه «وحى يا شعور مرموز» (الوحي أو الشعور المبهم)، ذكر مطالب مخالفة تمامًا لهذا الكلام.[1]
تمسّك المؤلِّف لإثبات الاختلاف بين المجتمعات التقليديّة والمجتمعات الحديثة بهذه النقطة، إذ قال: الحياة الاجتماعيّة للمسلمين كانت حياة تقليديّة ومِن باب إطاعة الرعيّة للراعي، وبالتالي فإنَّ المفاهيم السياسيّة في ذلك الزمان؛ كالبيعة، الشورى، العدالة، الإمامة و... قد بنيت جميعها على هذا المحور.... .
أوّلًا: إنَّ المجتمع العربي في مكّة والمدينة، كان نوعًا خاصًّا مِن المجتمع القبلي، القائم على الانتخاب عن طريق شورى أهل الحلّ والعقد، وخلافًا للحكومة الملكيّة في إيران أو الإمبراطوريّة الروميّة، ولا يمكن تعريفه بأنّه مجتمع قائم على أساس طاعة الرعيّة للراعي.
ثانيًا: على فرض صحّة هذا المدّعى، ينبغي جليًّا التمييز بين المبادئ والقيم السياسيّة الثابتة، مثل الإمامة والبيعة والشورى و... وبين شكلها المعاصر.
العقائد الحديثة
يعتقد السيّد شبستري بأنّه في العهد الجديد لا يمكن بشكل كامل تشخيص الحقّ مِن الباطل والصحيح مِن الخطأ في أيّ موضع ومكان. ومع ذلك، فإنّه يفتي بشكل قاطع، إذ يقول: المقتضى المسلّم به لأنْ نعيش كمسلمين
(206)في عصرنا الحاضر ومقتضى الوفاء لرسالة نبيّ الإسلام الأكرم صلىاللهعليهوآله هو أنْ نقبل ميثاق «حقوق الإنسان»، وأنْ نجعله الأساس لتنظيم حياتنا الاجتماعيّة.
وهنا نسأل هذا السؤال: إذا كان بوسعنا في عالمنا الحديث الكلام بشكل صرف عن ترجيح إحدى المؤسّسات على غيرها أو أيّ نظريّة على نظريّة أخرى، فلماذا يعتبر المؤلِّف أنّ نظريّة القرآن في النظام العائلي أو في نظام العدالة الجنائيّة (الأحكام الجزائيّة) أو في المعاملات، أنّها غير مؤثّرة قطعًا وأنّها تقليديّة؟ ولماذا يدافع عن الحقوق المدنيّة والجنائيّة في الغرب باعتبارها النظام الوحيد المقبول؟ إنَّ لغة المؤلِّف في التعبير عن ادّعاءاته وافتراضاته حول الحداثة، الهرمنيوطيقا والمؤسّسات السياسيّة والحقوقيّة في الغرب، حاسمة وقطعيّة ومتعصّبة إلى حدِّ أنّه لا يتوقّع أنْ يتكلّم أيّ فقيه أو مفسّر بهذا الشكل القاطع.
كذلك، فإنَّ ما قدّمه مِن إنجازات تأويليّة (هرمنيوطيقيّة) في هذا الحوار وسائر آثاره الأخرى، وجعل ذلك في مقابل الاجتهاد والفقاهة الإسلاميّة العريقة؛ ليس إلّا جزءًا يسيرًا مِن الآراء الموجودة في علم الهرمنيوطيقا، وقد عرضها بشكل ناقصٍ وسطحي في آثاره. وحتمًا، فإنَّ هذه النظريّة ما زالت محلّ نقاش في العالم الغربي، وتدور حولها مناقشات كثيرة. لذا، فإنّ هذا الافتراض المنهجي الذي اعتمده موضع نقاش، وللأسف لا مجال للبحث فيه ها هنا.
كذلك، فإنَّ المؤلِّف المحترم قَبِل بثقافة الحداثة وإنجازاتها على أساس أنّها أصول قطعيّة، وجعلها المعيار والمبنى الأساس للحكم على القرآن والسنّة الإسلاميّة.
(207)كما يبدو أيضًا أنَّ افتراضاته الأخرى في فلسفة التاريخ هو ما ذكره حول نظريّة التقدّم والترقّي، إذ يعتقد بأنّ التاريخ البشري يتطوّر في سيره نحو التكامل، وبالضرورة فإنَّ ما وقع في العصر الحديث وتمّ القبول به، له الأفضليّة على ما كان موجودًا في العصر الماضي، وأكثر قيمة منه. وفي غير هذه الصورة، يجب عليه أنْ يقول بحتميّة التاريخ (الجبر التاريخي)، وأنْ يظهر بأنّه في العصر الجديد لا يمكن إحياء المناسبات الأخرى المرتبطة بأيّ مجتمع مِن نوع آخر.
ومضافًا إلى كلّ ذلك، يوجد قطعًا الكثير مِن الافتراضات الأخرى غير المعلن عنها وغير المكتوبة والموجودة في بحوثه وآثاره. وإجمالًا، ينبغي القول إنَّ هذه الآراء حتّى في الثقافة الغربيّة، لا تعد قطعيّة وأنّها أفضل مِن غيرها، ولا سيّما في هذه الأيّام؛ إذ تعرّضت الحداثة للكثير مِن الانتقادات المختلفة وتودي بضرورة إعادة النظر فيها ولزوم تقديم نظريّات بديلة عنها.
في ختام هذه المقالة لا بدّ أنْ نقول بأنّ السيّد شبستري ـ وكما هو حال الكثير مِن المتنورين المعاصرين ـ ومِن خلال تقديم تصوّر إفراطي وغير منطقي عن آراء العلماء المسلمين، سعى إلى إثبات نظريّته وأقواله مِن خلال هذا المنهج، ومضافًا إلى القراءتين الإفراطيّة والتفريطيّة اللتين قدّمهما، يوجد أيضًا الكثير مِن القرارات والتفسيرات الأخرى التي يمكن فرضها في هذا المجال.
نعم، إنَّ إثبات حقانيّتها لا بدّ أنْ يتمّ مِن خلال عرضها على الكتاب والسنّة.
النتيجة هي أنّه ومِن خلال نظرة فاحصة وأكثر دقّة، يمكن ملاحظة وجود تفسير للثقافة الإسلاميّة الأصيلة، ومكانتها في العالم وافق عليها
(208)ـ صريحًا أو تلميحًا ـ الأكثريّة العظمى مِن الفقهاء والعلماء المشهورين عند الشيعة، أو على الأقلّ عند أنصار القراءة الرسميّة كما عبّر عنهم.
بناءً على ما أشرنا إليه مِن أقوال، يعلم أنَّ المعارف الثمينة في الكتاب والسنّة والفهم المشهور في مجتمع علماء الدين، كانت وما زالت على نحو لا يمكن أنْ تتعرّض لأيّ أزمات كما أسماها المؤلِّف بالقراءة الرسميّة، ولا أنْ تنجرّ إلى تحدّيات مدمّرة بناءً على النتائج المنطقيّة لنظريّته.
طبعًا، لا يمكن إنكار وجود آثار مِن التحجّر والتفكير الجاف تظهر عند بعض العلماء والمؤمنين بين الفينة والأخرى، ولكن لا ينبغي وضع ذلك على عهدة مجتمع علماء الدين كلّه أو على أركان النظام كافّة.
في هذه المقالة انصبّ سعينا على التحرّك في إطار مواقف المؤلِّف، وكشفنا الستار عن خفايا كلامه.
ونشير هنا إلى أنَّ بحوث المؤلِّف النقديّة ومنهجها النقدي أيضًا، أدّى إلى اتّصاف البحث بشيء مِن التحدّي والنقاش الصعب، ولذا لم يُقرّر محلّ النزاع بشكل دقيق في بحث السنّة والتجديد.
إنَّ البحث الدقيق والجميل في هذا المجال، هو في إظهار ارتباط الدين وأحكامه وقيمه الخالدة مع تطوّر المجتمعات والتنمية البشريّة في التكامل (التطوّر) التاريخي وفي أسلوب تصميم الأنظمة والمؤسسات الاجتماعيّة.
هذا البحث كان موضع زللٍ لأكثر المثقّفين والحداثيّين المسلمين، وأدّى إلى ظهور تياري التجدّد والتحجّر على قطبي الإفراط والتفريط، وهذا ما ينبغي بحثه مفصّلًا في موضع آخر.
(209)القرآن الکریم
سروش، عبدالکریم، «القبض والبسط في الشريعة»، مجلّة كيهان فرهنگی (کیهان الثقافيّة)، شهر «ارديبهشت» سنة 1367ه.ش.
الطباطبائي، السيّد محمّد حسين، وحى يا شعور مرموز، قم، دار الفكر، دون تاريخ.
مجتهد شبسترِی، محمّد، «اقتصاد إسلامي أم اقتصاد المسلمين»، «انديشه اسلامى» (الفكر الإسلامي)، العدد 10، 21 شهر آذار، سنة 1358ه.ش.
ــــــــــ ، «نقدى بر قراءت رسمى أز دين» (بحرانها، چالشها، راه حلها) [نقد القراءة الرسميّة للدين، الأزمات، التحدّيات، الحلول]، طهران، دار النشر طرح نو، سنة 1379ه.ش.
ــــــــــ ، إيمان و ازادى (الإيمان والحريّة)، طهران، دار النشر طرح نو، سنة 1376ه.ش.
ــــــــــ ، مقابلة له مع مجلّة مجلّة كيهان فرهنگی (کیهان الثقافيّة)، شهر «مرداد»، العدد الثالث، 1363ه.ش.
ــــــــــ ، مقالات «العقل والدين»، مجلّة كيهان فرهنگی (کیهان الثقافيّة)، العدد السادس، السنة الرابعة، شهر «شهريور» سنة 1366ه.ش،
ــــــــــ ، هرمنوتيك كتاب وسنت، طهران، دار النشر طرح نو، سنة 1357ه.ش.
سيّد مرتضى حسيني شاهرودي، سيّد محراب الدين كاظمي
يتطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل آراء المفكّر محمّد مجتهد شبستري بخصوص حقيقة الإيمان، حيث اعتبره حالةً مِن سنخ التجارب الدينيّة ولا ارتباط له بالفكر والاستدلال، بل لا صلة له مِن الأساس بالعلم والمعرفة بشكل عامّ، وبالعقيدة بشكل خاصّ.
الإيمان برأيه يمكن أن يجتمع في باطن الإنسان مع الشكّ، لكنّه لا يجتمع مع اليأس، وعبر اعتماده على منهج بحثي فينومينولوجي تاريخي، ادّعى أنّ إيمان معظم المسلمين مستند إلى تجاربهم الدينيّة أكثر مِن استناده إلى معارفهم الدينيّة؛ لأنَّ إحياء الدين الإسلامي، مرهون بإحياء تجارب المسلمين الدينيّة،
وليس إحياء الفكر والمعارف الدينيّة التي هي في الواقع مستوحاة مِن التجارب الدينيّة نفسها، وتعدّ مِن أعمق طبقات الدين.
ضمن بيانه حقيقة الإيمان، حاول في بادئ الأمر اعتبار التجارب الدينيّة العامّة للمؤمنين كافّة كمعيار أساسي لمسألة الإيمان، بحيث تعمّ تجربة كلّ مِن يدّعيه. لكن حين حديثه عن حقيقة التجارب الدينيّة الأصيلة، توسّع في البحث والتحليل ليعمّمها على الكثير مِن جوانب حياة البشر، لذا عندما نسلّط الضوء على نظريّاته ونمعن النظر فيما تتضمّنه، نستنتج منها أنّ كلامه إزاء حقيقة الإيمان مشتّت ولا يتّسم بأيّ انسجام ذاتي.
مفكّرونا وباحثونا المتأثّرون بالمفكّرين والباحثين المتديّنين المسيحيين مِن أمثال سورين كير كيغارد، وعالم اللاهوت الغربي المعاصر بول يوهانس تيليش، يعتقدون بأنّ مباحث الإيمان وأسسه الارتكازيّة، قد طرحت في الأوساط العلميّة والأكاديميّة في بلدنا وفق رؤيةٍ جديدةٍ نسبيًّا.
خلال عقد التسعينيّات الميلادي مِن القرن الماضي إلى أوائل الألفية الثالثة، شهدت هذه المباحث نقطة تحوّل جذريّة، فخلال هذه الفترة مِن تاريخنا المعاصر وجد الفكر الغربي منافذ ليتغلغل في باطن أوساطنا العلميّة إلى حدّ ما. وفي
(212)هذا السياق، لا نجد سوى باحثين ومفكّرين معدودين اعتمدوا في كلامهم وآرائهم على أدلّة معتبرة؛ فالمفكّر محمّد مجتهد شبستري على سبيل المثال قال في ندوة علميّة: هدفنا مِن المواضيع التي طرحناها للبحث والتحليل، هو تذكيركم بأنْ تستعدّوا كما ينبغي لاستقبال ضيف غير مرحّب به.
لو كان صادقًا حقًّا في هذا الكلام، فهو يريد بالفعل أنْ يساعدنا لأنْ نسلك نهجًا صائبًا على الصعيد النظري ضمن بحوثنا العلميّة التي نتطرّق فيها إلى تحليل المواضيع المرتبطة بما ذكر. وعلى هذا الأساس، إذا ما واظبنا على طرح مباحث علميّة مِن جوانب مختلفة، سوف تتنامى قدرتنا التحليليّة، وتصبح رؤيتنا النقديّة ثاقبةً؛ لأنّنا كنّا متأهّبين للموضوع مسبقًا.
بناءً على ذلك، سوف نتطرّق في هذه المقالة إلى بيان آراء هذا المفكّر بخصوص حقيقة الإيمان وبنيته الأساسيّة؛ لأنّه امتاز عن سائر المفكّرين والباحثين مِن جهة طرحه مباحث الإيمان بأسلوب متمیز، إذ فاقهم فيما ذكروا على هذا الصعيد.
محمّد مجتهد شبستري ضمن حديثه عن الإيمان وحقيقته، تبنّى رؤيةً جديدةً. وعلى ضوء مباحث تاريخيّة فينومينولوجيّة، توصّل إلى نتائج جديدة طرحها لمخاطبيه، لكنْ ليس مِن السهل قبولها. لذا، لا بدّ مِن تسليط الضوء عليها بأسلوبٍ بحثي كي تتّضح مختلف أبعادها بأمثل شكل. وعلى هذا الأساس، قبل أنْ نتطرّق في هذه المقالة إلى بيان محور الموضوع، سوف نوضّح أوّلًا مفهوم الإيمان مِن الناحيتين اللغويّة والدلاليّة.
أوّلًا: الإيمان لغةً
كلمة «إيمان» مصدر مِن «أمن يأمن أمنًا»، ومعناها التصديق. وعلى هذا الأساس، فسّرت كلمة «مؤمن» في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ بالمصدّق. واستنادًا إلى هذا المعنى أيضًا، نقل ابن منظور عن كلٍّ مِن ابن عباس وابن جبير أنَّ الفرائض الدينيّة هي المقصودة مِن الأمانة الإلهيّة الملقاة على كاهل البشر.
ثانيًا: الإيمان اصطلاحًا
كلمة «إيمان» استخدمت في تراثنا الديني ضمن معاني متنوّعة. والخوارج هم أوّل مِن تطرّقوا إلى مسألة إيمان المسلم في تاريخ العقائد الإسلاميّة، وفي هذا السياق اعتبروا مرتكب الكبائر كافرًا. وأمّا المعتزلة، فقد طرحت هذه الكلمة كاصطلاح في تراثهم الفكري ضمن القصّة الآتية:
ذات يومٍ دخل رجل على الحسن البصري، وقال له: الخوارج يعتبرون مرتكب الكبائر كافرًا، والبعض يؤخّرون الحكم عليه ويعرفون بـ «المرجّئة».
لمّا سمع الحسن البصري هذا الكلام، تأمّل في نفسه وقبل أنْ يجيب السائل، بادر واصل بن عطاء قائلًا: أنا أقول إنَّ مرتكب الكبائر ليس كافرًا وليس مؤمنًا، بل هو بين الكفر والإيمان.
إذاً، العمل استنادًا إلى رأي المعتزلة، لا ينضوي ضمن حقيقة الإيمان. وأمّا الأشاعرة، فقد عرّفوه بأنّه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، لكنّ العمل ليس مِن أركانه. إلّا أنّه برأي علماء الكلام الشيعة ذو معنى مختلف عمّا ذكر، وغالبيّة علماء الشيعة تبنّوا رأي ابن بابويه في هذا المضمار، حيث عرّفه قائلًا: الإيمان عبارة عن تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
محمّد مجتهد شبستري اعتبر لبّ الإيمان وجوهره الحقيقي الانجذاب إلى مخاطِب مركزي والانعطاف نحوه والميل الفكري إليه، بحيث يسفر خطابه عن ارتباط المخاطَب به بالتمام والكمال، لذا فالإيمان يعني الاهتمام الناشئ مِن انجذاب.
ويعتقد بأنّنا لو أردنا تعريفه في منأى عمّا ذكر في آثار سائر المفكّرين، ينبغي لنا مراجعة الأحداث التي شهدها المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام وتجسيمها كي نطّلع على قصّة الإيمان الجذّابة؛ لأنّ التراث الفكري للباحثين والمفكّرين، متقوّم على فرضيات معيّنة تجعلنا في منأى عن معنى الإيمان الحقيقي.
هذه الرؤية في الواقع حصيلة لأصول نظريّة مهمّة لا يسعنا المجال بيانها هنا، ولا بدّ مِن ذكرها في محلّها. لكنْ خلاصة الكلام، هي أنّ مجتهد شبستري يعتقد بضرورة اللجوء إلى مصدرين أساسيين بغية معرفة حقيقة الإيمان، وهما كما يلي:
1. الكتاب والسنّة مِن جهة، وآراء علماء الكلام والعرفاء والفلاسفة المسلمين مِن جهة أخرى.
2. التجارب الدينيّة التي خاضها المسلمون، والتي أوجدت خلفيّةً تاريخيّةً.
نستشفّ مِن التعريف المذكور، أنَّ هذا المفكّر يرجّح المصدر الثاني أكثر مِن الأوّل. والواقع أنَّ هذا المصدر أكثر انسجامًا مع رؤيته بخصوص التجارب الدينيّة التي تعتبر مِن جملة الأصول التي ترتبط بالإيمان مِن وجهة نظره؛ وذلك مِن منطلق اعتقاده بأنّ الإيمان في الوهلة الأولى لا يحكي عن تصديق وعقيدة متعلّقهما مفهوم معيّن. وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يكترث بالجانب المعرفي والبنيويّ للإيمان، بل أكّد في مباحثه بشكل أساسي على مسألة إقبال الإنسان واهتمامه، حيث قال: لذا أعار علماء الكلام أهميةً للجانب المعرفي، وعرّفوا الإيمان بأنّه «تصديق بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله». إلّا أنَّ العرفاء سلّطوا الضوء بشكل أساسي على التجارب في سيرة المسلمين.
قبل أنْ نتطرّق إلى بيان تفاصيل البحث، نرى مِن الأنسب أوّلًا ذكر بعض الملاحظات المقتضبة حول تاريخ التجارب الدينيّة؛ لكونها ذات ارتباط وطيد بالموضوع.
لا شكّ في أنّ التجربة الدينيّة قد واكبت الدين منذ باكورة ظهور التديّن بين البشر. لكنَّ الاعتماد عليها كأسلوب مستقلّ في تحليل الحقائق
الدينيّة، شاع تزامنًا مع الضربات الموجعة التي تلقّاها الدين مِن نظريّات أمثال إيمانوئيل كانط وسائر فلاسفة العلم. وعلى هذا الأساس، حاول عالم اللاهوت المسيحي الشهير فريدريك شلايرماخر توسيع نطاق الدين؛ ليعمّ الأمور غير المرتبطة بالأخلاق أيضًا. فهو أوّل مَنِ اعتمد على التجارب الدينيّة بغية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق، أكّد على أنّ التديّن ليس علمًا ولا أخلاقًا، بل عبارة عن عنصر في التجارب البشريّة. ومِن هذا المنطلق، سلّط الضوء على الجوانب الشعوريّة والعاطفيّة في الدين، ثمّ حذا حذوه كلّ مِن رودولف أوتو ووليام جيمس.
بعد أنْ أشرنا إلى الخلفيّة التاريخيّة للموضوع، تجدر الإشارة أيضًا إلى هذه الملاحظة المهمّة، وهي أنّ المفكّر محمّد مجتهد شبستري، حينما تحدّث عن حقيقة الإيمان وحاول تعريفه، أكّد على تجارب المسلمين الدينيّة أكثر مِن تأكيده على أيّ أمر آخر. وفي هذا المضمار، اعتبر تجربة كلّ متدين بأنّها لبّ الإيمان والمرتكز الأساسي له، ثمّ استنتج مِن ذلك أنّ تشخيص حقيقة إيمان كلّ مسلم منوطة بمعرفة واقع تجارب المسلمين الدينيّة على مرّ التاريخ.
وأمّا بالنسبة إلى ما يعانيه المسلمون مِن ضعف وتخلّف وانحطاط، فقد اعتبر التجارب الدينيّة هي السبيل الوحيد للخلاص مِن هذه المعضلة، إذ يجب إحياء هذه التجارب كي يستعيدون قوّتهم ومجدهم.
كذلك يعتقد بأنّ بيان حقيقة الإيمان مرهون بدراسة وتحليل عناصره البنيويّة، لذا لا بدّ مِن تقييمه وبيان تفاصيله بدقّة على ضوء ارتباطه بهذه العناصر؛ كي تنشأ لدينا معرفة بحقيقته ونتمكّن مِن تقييمه وفهمه بشكل
(217)صائب. لذا، سوف نتطرّق في هذا البحث إلى بيان حقيقة الإيمان برأيه مِن عدّة جوانب، ثمّ نقيّم آراءه في هذا السياق.
التجربة التي تعتبر الركن الأهمّ أو العنصر الوحيد للإيمان، حسب رؤية المفكّرين المحدثين المختصّين بدراسة الدين، ذات دور أساسي في فكرهم. والمفكّر محمّد مجتهد شبستري أكّد عليها أكثر مِن أيّ مفكّر آخر، واعتبرها بنيةً أساسيّةً في حياة المتديّنين.
بما أنّ الارتباط بين الإيمان والوحي متبادل، فقد عرّف دعاة نظريّة التجربة الدينيّة الوحي بأنَّه أوّل تجربة دينيّة مصدرها تجارب الأنبياء، إذ انبثقت مِن نبوّتهم، وباتت زاخرةً بما فيها بفضل هذه التجارب، ثمّ تغلغلت في أعماق نفوس المؤمنين لتعمّ وجودهم برمّته وتثريه بما فيها بشكل تدريجي.
المسألة المهمّة في هذا الصعيد، هي أنّ التأكيد على تأثير التجارب الدينيّة واعتبارها مرتكزًا أساسيًّا للإيمان، يسفر عن عدم الالتزام بالقيود والمقرّرات العقائديّة الدينيّة، ومِن ثمّ يصبح الإيمان دائمًا في مقابل المعتقدات الدينيّة بحيث يتجاوز أصولها الارتكازيّة؛ لأنَّ مضمونه في هذه الحالة ليس سلسلة مِن هذه العقائد حسب ما هو ثابت في الأديان.
مجتهد شبستري على ضوء اعتقاده بمسألة بسط التجربة الدينيّة والتجربة النبويّة، والتي يعرّف الإيمان على أساسها كهويّة لأمرٍ خارج عن القانون؛ بالغ في هذا الأمر لدرجة أنّه اعتبر المعتقدات الدينيّة رواسب راكدة في قعر الإيمان ومضامين جامدة في باطنه. لذا، فهو برأيه ليس أمرًا فاعلًا ومؤثّرًا على الدوام،
(218)ومِن ثَمَّ لا يمكن أنْ يضفي إلى روح المؤمن طلاوةً وحيويةً باستمرار. كلامه في هذا السياق جذّاب بعض الشيء ويمنح المخاطب طمأنينةً بما يطرح فيه مِن الناحيّتين النفسيّة والعاطفيّة، بحيث يستهويه نحوه ويستحوذ على فكره. لكنْ، لو أردنا فهم جزئيّاته وتفاصيله الحقيقيّة ومعرفة النتائج التي تترتّب عليه، لا بدّ لنا مِن إمعان النظر فيه والتدقيق بمضمونه وفق رؤية موحّدة بين الباحثين كافّة، كي يطرح كلامه للقرّاء الكرام على حقيقته ويدركوا مغزاه الواقعي.
ولأجل أنْ لا يقع في فخّ إشكاليّات الرؤية النسبيّة المتقوّمة على فكرة التعدّدية الدينيّة، تنزّل بماهية الأديان إلى محض تجارب دينيّة. وقد بالغ في هذا السياق لدرجة أنّه اعتبر الوحي أيضًا مِن جملتها؛ أي ادّعى أنَّه تجربةً دينيّة في حياة الأنبياء.
وأمّا المنهج البحثي الذي اعتمد عليه في شرح وتحليل التجارب الدينيّة والنبويّة، فهو مِن نمطيّة البحوث الفينومينولوجيّة.
بناءً على رؤيته المشار إليها أعلاه، فقد أكّد على أنّنا لو حلّلنا واقع الدين وفق رؤية فينومينولوجيّة، سوف ندرك أنّ التجارب الدينيّة تمنحنا أنموذجًا جديدًا على صعيد تعامل الأديان فيما بينها وتضاربها مع بعضها، وقد وضّح قصّة الإيمان في الإسلام كما يلي:
«ياترى ما التغيير الذي حدث عندما ذكر النبيّ محمّد الآيات القرآنية لقومه بشكل شفهي؟ نحن لا نعلم حقيقة ذلك التغيير؛ لأنّ النصّ القرآني شاع بين المسلمين بعد وفاته بشكل مكتوب».
وقد تبنّى في أحد آثاره تفسيرًا تجريبيًا بحتًا بالنسبة إلى مسيرة الإيمان في التاريخ الإسلامي، وكيف انتقل مِن التجربة النبويّة إلى سائر المسلمين. وضمن تأليف آخر، سلّط الضوء على الإيمان والتجارب الدينيّة التي اعتبرها في غاية الوضوح، وهنا ذكر تفسيرًا آخر بخصوص الارتباط الوطيد بينهما قائلًا:
«الإيمان في الإسلام مِن الأحداث التي وقعت في ذلك الزمان، حيث جرى بين الناس كما يجري الماء الزلال المتدفّق مِن الينبوع بشكلٍ مفاجئ».
التجارب الدينيّة هي البنية الأساسيّة للإيمان برأيه، وليس العقائد؛ إذ اعتبر العقائد بأنّها مِن تراكمات التجارب الدينيّة؛ أي إنّ هذه التجارب تتراكم مع مرور الوقت لتخلق عقائد، فعندما يتحدّث الناس عن هذه التجارب، يطرحونها ضمن مفاهيم وأطر خاصّة. وعلى هذا الأساس، تنشأ المعتقدات الدينيّة؛ وهذا يعني أنّ الإيمان برأيه ليس عقيدةً، لذا لم تذكر هذه الكلمة ولا مشتقّاتها في النصّ القرآني؛ أي إنّنا لا نجد فيه كلمة عقيدة أو اعتقاد خلافًا لكلمة إيمان ومشتقّاتها التي ذكرت كثيرًا فيه. فضلًا عن ذلك، اعتبر الشريعة أيضًا مِن التداعيات المترسّبة على التجارب الدينيّة، وضمن بيانه طبيعة التجارب الدينيّة قال ما يلي:
«الأديان الثلاثة الكبرى في العالم ظهرت في نطاق ثلاثة مستويات كما يلي:
1. أعمال وشعائر: نحن على ارتباط مباشر وتامّ مع هذا المستوى، وهو أوّل المستويات التي نلمسها في الأديان الثلاثة. فالإسلام على سبيل
المثال يتضمّن أعمالًا دينيّة، مثل الصلاة، والصيام، وذبح الأضاحي، والإنفاق، والمشاركة في النشاطات السياسيّة والاجتماعيّة بدوافع وغايات دينيّة.
2. عقائد: في كلّ دينٍ مِن الأديان المذكورة توجد مجموعة مِن العقائد، مثل التوحيد والنبوّة والآخرة إلى جانب معتقدات خاصّة إزاء حقيقة الإنسان وغير ذلك؛ وفي هذا المستوى يتمحور الأمر حول المعرفة.
3. تجارب دينيّة: هذه التجارب تعتبر ثالث وآخر مستوى في الأديان المذكورة.
لو رسمنا هذه المستويات الثلاثة على شكل تحيط ببعضها، فالدائرة الثالثة التي هي المستوى الثالث ـ التجارب الدينيّةـ واقعة في باطن الدائرتين الأولى والثانية؛ أي المستويين الأوّل والثاني، حيث يحيطان بها مِن كلّ جانب».
وبعد أنْ ذكر تفاصيل أخرى في هذا السياق، واصل كلامه ليذكر إيضاحات بخصوص واقع التجارب الدينيّة في رحاب معطيات أدلّة دينيّة وغير دينيّة، ثمّ استنتج مِن التفاصيل التي أشار إليها، أنّ هذه التجارب هي أساس التديّن وجوهره، فقد قال:
«إذا أقررنا بأنّ التجارب الدينيّة هي أساس التديّن، سواًء استند إقرارنا هذا إلى رؤية متقوّمة على أدلّة غير دينيّة أو على أدلّة دينيّة، ففي هذه الحالة كيف يمكن تفسير مسألة إحياء الدين؟ مِن المؤكّد أنّ إحياء الدين مرهون قبل كلّ شيء بإحياء هذه التجارب».
وقد أكّد غاية التأكيد على رؤيته هذه لدرجة أنّه اعتبر معرفة مضمونها يجسّد روح علم الكلام الجديد في العالم الإسلامي. ومِن هذا المنطلق، قال لو تقرّر أنْ يولد علم كلام جديد في العالم الإسلامي، فلا بدّ حينئذٍ مِن اتّخاذ التجارب الدينيّة كمعيار أساسي فيه.
وحينما نسلّط الضوء على آرائه الإبستيمولوجيّة، نستشفّ منها معارضته الشديدة لإبستيمولوجيا أرسطو، فقد اعتبر منهجيّته الفكريّة تنتهي إلى عقيدة دوغمائيّة، ومِن ثمّ لا محيص مِن اعتبار كلّ قضية تطرح للبحث والتحليل بدهيّةً لا مجال لتفنيدها مطلقًا، بزعم أنّها تنطبق بالكامل مع الواقع؛ في حين أنّ التجارب البشرية تحكي عن شيء آخر غير هذه الرؤية الدوغمائيّة. وممّا ذكره في هذا الصعيد ما يلي:
«لماذا تذكرون أشياء نيابةً عن النبيّ؟ ما الذي يدعوكم لأنْ تذكروا كلّ شيء بشكل إملائي وتدّعون أنّه مطابق للواقع وتنسبونه إلى النبيّ؟ اسمحوا لنا أنْ نتعلّم مِن تجارب النبيّ والمسلمين الأوائل، فلو أمعنّا النظر في أفعالهم وأقوالهم على أساس رؤية فينومينولوجيّة، سوف نستكشف الكثير مِن القصص الجديدة الجذّابة».
إحياء الدين مِن وجهة نظر هذا المفكّر، مرهون بإحياء التجارب الدينيّة؛ إذ يرى أنّنا لو نظرنا إلى واقع الحال برؤية لا تستند إلى أدلّة دينيّة، سنلاحظ وجود مجموعة مِن التجارب الدينيّة التي شهدت شدًّا وجذبًا على مرّ التاريخ، ممّا يعني أنّ التجارب الدينيّة بشكل عامّ على غرار نهر تتدفّق مياهه مِن ينبوع
عذب زلال، وهذا الينبوع هو تجارب النبيّ، ويعتبر أساسًا لكلّ تجربة عرفانيّة وتجربة دينيّة يخوضها عامّة الناس.
وضمن طرحه دور التجارب الدينيّة في بيان حقيقة الدين على أساس وظائفي، لم يقصد تجاهل دور معرفتنا بديننا وكيفيّة إصلاحه، بل قصد مِن ذلك التأكيد على الأهميّة القصوى لهذه التجارب،؛ إذ اعتبر كلّ تعديل وإصلاح نقوم به مِن الناحيتين الإبستيمولوجية والإيديولوجيّة مرهونًا بهذه الجهود وامتدادًا لها، كذلك أيّد الدور الفاعل للعلم قبل حدوث كلّ تجربة دينيّة.
يجب أنْ نأخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار عند تحليل واقع العلاقة بين الإيمان والتجربة الدينيّة وفق نظريّة محمّد مجتهد شبستري:
1. الإيمان حسب نظريّته التي طرحها على صعيد التجارب الدينيّة وطبيعة ارتباطها به، لا يمكن تشخيصه؛ أي إنّنا غير قادرين على تقييم إيمان الآخرين؛ لأنّ إيمان كلّ إنسان عبارة عن تجربة فرديّة خاصّة لا تشابه غيرها. وعلى هذا الأساس، استنتج عدم وجود أيّ معيار لتقييم إيمان البشر، ومِن ثمّ ليس بمقدورنا أنْ نتكلّم عليه ونذكر تفاصيله، لذا يجب التزام جانب الصمت إزاءه.
2. هذه النظريّة متقوّمة على نظريّة الفيلسوف الغربي شلايرماخر، فهو الذي وضع حجر الأساس لمسألة التجربة الدينيّة وفقًا لقابليّات الديانة المسيحيّة وقدرتها على الصمود أمام نقد إيمانوئيل كانط، الذي تنزّل
بشأن الدين إلى مجرّد إدراكات العقل العملي. ومِن جهة أخرى، فإنّ ضعف هذه الديانة والنواقص الكثيرة الموجودة فيها وعدم قدرتها على مواكبة التغييرات التي طرأت في العالم خلال العصر الحديث وعجزها عن تنسيق نفسها مع التجدّد الفكري المعاصر، كلّها أمور ساعدت على ظهور هذه النظريّة. لكنْ، عندما نقارن هذه الظاهرة التي طغت على المسيحيّة مع واقع الدين الإسلامي الذي نشأ في رحاب مبادئ عقائديّة شيعيّة وتضمّن الكثير مِن التعاليم والأسس العقائديّة على صعيد العقلين النظري والعملي مثل الأخلاق والفقه، فهل يمكن اعتبار رؤيته ناقصة كما في المسيحيّة؟
3. أحد الدوافع الأساسيّة للولوج في التجارب الدينيّة، هو إظهار الجانب النفسي والعاطفي مِن الدين، وهذا الأمرأيضًا يضرب بجذوره في الديانة المسيحيّة، في حين أنّ الإسلام يتضمّن جوانب مختلفة تفوق الجانب النفسي والعاطفي، وكلّ جانب له خصائصه التي تميّزه عن غيره. وعلى هذا الأساس، فالدين ذو جوانب عديدة، أحدها نفسي وعاطفي، لذا ليس مِن الصواب قصر الدين على هذا الجانب فقط ثمّ تسرية حكم الجزء على الكلّ؛ أي إنّ هذا التعميم مِن سنخ مغالطة الكلّ والجزء.
محمّد مجتهد شبستري تبنّى رأيًا خاصًّا إزاء الإيمان؛ إذ اعتبر بنيته الأساسيّة غير معرفيّة. وضمن دراساته وبحوثه التي دوّنها في هذا المضمار، أكّد على
وجود أدلّة دينيّة وغير دينيّة تفيد بأنّ العقيدة ليست ثمرةً للإيمان؛ لأنّه أمر وجودي لا يتحقّق إلّا في رحاب التجربة الدينيّة. وبعد أنْ ذكر أدلّةً غير دينيّة استنتج ما يلي:
«حتّى الأدلّة الدينيّة والقرآنيّة إذا أمعنّا النظر فيها، لا نجد سوى تجارب دينيّة. فالدين في القرآن لم يذكر على هيئة مفاهيم جاء بها النبيّ يجب على الآخرين الإيمان بها».
هذه الرؤية يطرح عليها السؤال الآتي: كيف يمكن للإنسان أنْ يقوم بهذه الحركة المثمرة ويتّخذ مواقف حازمة على أساسها، مِن دون أنْ يمتلك معرفة بتفاصيلها؟ شبستري أجاب عن هذا السؤال بنحوٍ ما، فقد قال: ذروة الدين هي اعتبار كلّ شيء علامة على وجود الله.
مفهوم هذا الكلام هو المبدأ الوحيد الذي يجب إيمان المتدين به قبل كلّ شيء آخر ضمن مسيرته الدينيّة. وهو بطبيعة الحال يتقوّم على مرتكز إبستيمولوجي؛ أي لا بدّ مِن امتلاك معرفة للإقرار به، وهذا الموضوع وضّحه مجتهد شبستري في موضع آخر قائلًا:
«التجارب الدينيّة تختلف عن التجارب المتعارفة بين البشر؛ لأنّ ظروف حدوث التجارب الأخرى يهيّؤونها بأنفسهم. لكنَّ الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى التجارب الدينيّة؛ لكونهم خاضعين لموضوعها وليس العكس، حيث يسوقهم نحوه أينما يشاء، ولا محيص لهم مِن الثقة به دون علم حتّى لو سلكهم في طريق ضبابي».
لأجل أنْ نحلّل رؤيته بدقّة وعمق أكثر، نرى مِن الأنسب تسليط الضوء على أحد آثاره الأخرى. فقد تطرّق في كتاب آخر مِن مؤلّفاته، إلى بيان الرأي الشهير بين علماء اللاهوت والمتديّنين، ألا وهو «القراءة غير الإنسانيّة للدين»، إذ قال بهذا الخصوص:
«الدين في رحاب القراءة غير الإنسانيّة له، عبارة عن مجموعة مِن العلوم والأحكام الغيبيّة الخارجة عن نطاق العقل البشري لكونها صادرة مِن الله تعالى، لذا فهي حاكمة على البشر.
الذات الإنسانيّة وفق هذا الرأي تتلاشى ولا يبقى أيّ أثر لها»
ومِن الآراء الأخرى التي تبنّاها، هو أنّ ثقاتنا الدينيّة كمسلمين كانت شفهيةً؛ إذ لا أحد يعلم ما الذي حدث بين النبيّ وذلك الشخص الذي خاطبه. فهي استقرّت بعده وتحوّلت إلى تراث مدوّن. وقصّة الإيمان بدورها تغيّرت وفق هذه التغييرات الجذريّة. ومِن أقواله في هذا السياق ما يلي:
«... لأنّ هاجس هؤلاء هو الاستماع لخطاب موجّه إليهم وخبر يأتيهم ثمّ اتبّاع.، كانت حركتهم هادفة إلى إثبات وجودٍ، ولم تكن استدلاليّةً فلسفيّةً؛ إذ لم يرغبوا في ذكر برهانٍ لإثبات وجود الله، بل سمعوا خبرًا واتّبعوه.
لطالما تأثّرت بهذه الآية: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا... فَاسْتَجَبْنَا لَهُ...﴾ ».
صريح هذا الكلام يدلّ على أنّ عمليّة الاستدلال تختلف عن الإيمان؛ لأنّه مستقلّ عن الأمور العلميّة والمعارف المبرهنة. وعلى هذا الأساس، اعتقد بقدرة المؤمن بأنْ يتجاوز أحد المفاهيم ويتّجه نحو مفهوم آخر وفق المعطيات الموجودة بين يديه. إلّا أنّ هذه المفاهيم برمّتها غير ثابتة بشكل توقيفي، ولا شأن لها بالبنية الأساسيّة للإيمان.
أوّلًا: لا شكّ ولا ترديد في صواب الرأي القائل بأنّ حقيقة الإيمان ماهيته، عبارة عن حركة عموديّة للأبعاد الوجوديّة في الإنسان، حسب تعبير الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري. لكنَّ الخطأ يكمن في فصله عن العلم بالكامل ونسبته إلى أعمق طبقة في الوجود الإنساني. فهذا الأمر يقلّل مِن شأنه في نشاطات الإنسان الدنيويّة وجهوده العلميّة؛ لأنّ الإيمان دون تعقّل وتفكّر لا قيمة له. لذا، بما أنّ العقل بصفته حجّة الإنسان الباطنيّة، فهو قادر على فهم الوحي، بل لولاه يصبح الوحي مدار شكّ وترديد.
إذاً، الإيمان مِن منطلق ارتكازه على الإقرار بحقيقة الوحي، لا بدّ وأنْ يتقوّم على العقل، لذلك قال الاستاذ عبدالله جوادي الآملي:
«الوحي باعتقادنا مِن سنخ العلم والإدراك وليس مِن سنخ التحريك والعمل. إلّا أنّه يعتمد على الفكر حين العمل، بينما العلم والإدراك مِن سنخ الوجود ويتواكبان مع الوحي؛ وعلى هذا الأساس لعقل الإنسان قدرة على فهمه».
بناءً على ما ذكر، فالوحي الذي يعتبر مِن توابع الإيمان تابع للمعرفة أيضًا، ولربّما المعرفة الحصوليّة غير كافية في هذا المضمار. إلّا أنّ المعرفة الحضوريّةـ الشهودیّة ـ كافية في أنْ تعمّه. وهنا مسألة مهمّة تجدر الإشارة إليها بخصوص العلم، وهي أنّ العلم الحضوري حسب المبادئ الإبستيمولوجيّة الغربيّة يعدّ أمرًا مجهولًا.
ثانيًا: إحدى العبارات الشائعة التي عادةً ما تطرح ضمن البحوث التي تدوّن بخصوص مسألة التجربة الدينيّة وما يرتبط بها، هي: «ليست هناك أيّة معلومة إلّا وتمّ تفسيرها».طبقًا لهذا الكلام، ليس بمقدور كلّ مِن هبّ ودبّ خوض تجربة عمليّة دون أنْ يمتلك بنيةً معرفيّة. وعلى هذا الأساس، قال أحد منتقدي مجتهد شبستري ما يلي:
«على افتراض أنّ التجارب الدينيّة عبارة عن أمر مستقلّ، إذا أريد مِن استقلالها أنّها متقوّمة على استدلالات فلسفيّة، فهذا الأمر ممكن، لكنْ إذا أريد منه معتقدات ومفاهيم دينيّة، فهذا الأمر غير ممكن مطلقًا؛ لأنّ هذه التجارب مِن أساسها تولد مِن رحم معتقدات ومفاهيم دينيّة».
الجدير بالذكر هنا، أنّ السيّد شبستري في مواضع عديدة مِن مدوّناته، جعل الإيمان في أعمق طبقة مِن طبقات الوجود الإنساني، معتبرًا إيّاه عقيدةً قلبيّةً وتصديقًا باطنيًا، فالمعتقدات برأيه عبارة عن رواسب خلّفتها التجارب
الدينيّة. هذه الرؤية عرضة للنقد قطعًا، لذا يجب على هذا المفكّر أنْ ينقض ما يرِد عليها مِن نقد.
عناصر الإيمان
محمّد مجتهد شبستري تطرّق في كتاباته إلى بيان عناصر الإيمان، وقد صنّفها ضمن قسمين كما يلي:
ـ عناصر سلبيّة.
ـ عناصر إيجابيّة.
ويمكن بيان آرائه في هذا المضمار بشكل مقتضب كالآتي:
1. الإيمان ليس عقيدةً بوجود إله للكون، وليس يقينًا ولا علمًا ولا فلسفةً.
2. الجوانب الإيجابيّة للإيمان هي الثقة والمحبّة والشعور بالأمن والأمل.
وحاول إثبات أنَّ الإيمان أمر مستقلّ عن العقيدة؛ أي إنّهما مقولتان منفصلتان عن بعضهما، قائلًا:
«العقيدة عبارة عن أمر ذهني فكري، وقد تكون إحدى التجارب الأصيلة منشأ له، أو ربّما ينشأ مِن تلقين إنسان وتبليغه، أو ينشأ بفعل عوامل أخرى».
نستشفّ مِن هذا الكلام، أنّ العقيدة قد تكون غير أصيلة. لكنْ، كيف نقيّم التجربة الدينيّة في هذه الحالة؟ هذا المفكّر حينما طرح الموضوع بالأسلوب المذكور، رام مِن وراء ذلك إثبات أنَّ العقيدة تنشأ في ذهن الإنسان وفكره،
بينما التجربة ليست كذلك، ولا ارتباط لها بالفكر؛ لأنَّها تعمّ وجوده بأسره وتتفاعل معها جميع أعضائه ومكوّنات شخصيّته. وهذا هو أهمّ اختلاف بينها وبين العقيدة.
ولأجل أنْ تتّضح لنا حقيقة الإيمان بشكل أفضل حسب نظريّته، نذكر ما قاله في موضع آخر: «الأديان الكبرى في العالم ظهرت ضمن ثلاثة مستويات كما يلي:
1. أعمال وشعائر سطحيّة ذات ارتباط مباشر بنا، فالإسلام على سبيل المثال يتضمّن أعمالًا عباديّة، مثل الصلاة والصيام وغيرهما.
2. أفكار وعقائد مثل التوحيد والنبوّة وعلم الكونيّات والأنثروبولوجيا وغير ذلك.
3. تجارب دينيّة، حيث تعتبر آخر مستوى داخلي للدين، وهي النواة المركزيّة له».
استنادًا إلى ذلك، فالتجارب الدينيّة برأيه تعتبر أهمّ عنصر بنّاء للإيمان، وأعمق طبقة فيه.
حقيقة التجربة الدينيّة
لو أردنا شرح وتحليل حقيقة التجربة الدينيّة، يجب أنْ نأخذ النقاط الآتية بعين الاعتبار:
1. اللجوء إلى نظريّة التجربة الدينيّة، هدفه وضع حلول للإشكاليّات التي ترد على الثقافة المسيحيّة ومعتقداتها، مثل التثليث والتجسيم
والفداء والألوهيّة. وغالبيّة النقد المطروح على الديانة المسيحيّة ضمن الدراسات والبحوث التي تدوّن على صعيد مسألة التعارض بين العلم والدين، يرِد في الواقع على التعاليم والمعتقدات الدينيّة التي تتعارض مع حكم العقل. وهذا الموضوع طرح للبحث والتحليل مِن قبل الفيلسوف شلايرماخر، لذا ليس مِن الضروري اعتبار التجارب الدينيّة بأنّها مغزى الإيمان في الإسلام.
2. المسألة الأخرى الجديرة بالذكر على صعيد التجارب الدينيّة في العالم الإسلامي، هي أنّ هذه التجارب تصنّف إلى نوعين، فمنها تجارب سلبيّة، ومنها تجارب إيجابية؛ لأنَّ هذا المسلك الضيّق يسلكه الكثير مِن أصحاب المزاعم الكاذبة. لذلك صنّفوا عالم الوهم والخيال إلى نوعين أيضًا، أحدهما عالم متّصل، والآخر عالم منفصل. ومِن المؤكّد أنّ التمييز بينهما لا يتسنّى لأيّ شخصٍ كان. واللافت للنظر في هذا المضمار، أنّ اعتبار التجربة كحدّ فاصل بين الحقّ والباطل، مرتبط بهذين العالمين.
3. إذا أردنا تقييم التجارب الدينيّة والحكم على كلّ واحدة منها، فنحن بحاجة إلى مفهوم فكري مشترك. لكنَّ هذا الأمر غير ممكن؛ لأنّ كلّ تجربة دينيّة تعتبر شأنًا فرديًّا مختصًّا بشخصٍ معينٍ، ولا يمكن أنْ تسري بذاتها إلى غيره.
محمّد مجتهد شبستري لم يضع معيارًا محدّدًا يمكن الاعتماد عليه في الحكم على التجارب الدينيّة وتقييمها بغية التمييز بين ما كان سلبيًّا وإيجابيًّا منها،
ولربّما لا يرتضي بهذا التصنيف مِن الأساس. ومِن المباحث التي ذكرها في هذا المضمار، ما وصفه بالتجارب الأصيلة، لكنّه لم يضع لها معيارًا محدّدًا.
لو أذعنّا إلى رأي مَن اعتبر التجارب العرفانيّة والدينيّة مِن سنخ التجارب الحسّية، مِن الممكن حينها القول بأنّ هذه التجارب هي التي تبرّر المعتقدات الدينيّة؛ لأنّ المتديّنين بإمكانهم استنتاج عقيدة «الله تعالى هكذا» مِن مفهوم «جرّبت الله تعالى بهذا الشكل»؛ أي إنّهم يبرّرون عقيدتهم بالذات الإلهيّة على أساس نوع تجربتهم إزاءها. لكنْ، إذا اعتبرنا التجارب العرفانيّة والدينيّة مجرّد حالات بيانيّة، عندئذٍ لا يمكن ادّعاء قدرتها على تبرير المعتقدات الدينيّة؛ لأنّ الانتقال إلى سبب كلّ تجربة يتبلور على أساس تفسير مسبق لمضمونها.
إحياء المعتقدات الدينيّة مِن جملة المسائل المهمّة المطروحة في العالم الإسلامي في الآونة الأخيرة خلال قرن ونصف. فبعض الباحثين والمفكّرين المسلمين، لمّا وجدوا أنفسهم في مواجهة عالم جديد، حاولوا الحفاظ على نزاهة الدين وخلوصه مِن الشوائب التي قد تدنّسه، ومِن هذا المنطلق سلكوا سبلًا جديدةً وطرحوا آراء غير مسبوقة في العالم الإسلامي.
وفي هذا المضمار، أصدر السيّد جمال الدين فتوى أكّد فيها على ضرورة إصلاح السلوك الديني وفق نهج المسلمين الأوائل، ويمكن اعتبار فتواه بأنّها أوّل نظريّة تطرح بخصوص تحوّلات العصر الحديث ومسألة الإصلاح
الديني. والنظريّة الأخرى طرحها محمّد عبده، حيث تبنّى فيها فكرة إصلاح المعرفة الدينيّة. وأمّا آخر نظريّة في هذا المجال، فقد طرحت بالتأكيد على ضرورة الإصلاح وإحياء التجارب الدينيّة مِن قبل المفكّر محمّد مجتهد شبستري.
شبستري اعتبر التجارب الدينيّة كالنهر العظيم الذي ينبع مِن تجارب النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله، ويجري على امتداد تجارب الأولياء والعرفاء ويليهم المؤمنون؛ إذ تتراكم مع مرور الوقت، وإثر هذا التراكم تنشأ عقائد، وهذه العقائد بدورها تكوّن شريعةً. وممّا قاله في أحد مؤلّفاته:
«لو أذعنّا إلى الرأي القائل بأنَّ التجارب الدينيّة هي البنية الأساسيّة للتديّن، سواء اعتمدنا في ذلك على رؤية قوامها أدلّة دينيّة أو رؤية قوامها أدلّة غير دينيّة، ففي هذه الحالة يجب الإقرار بأنَّ إحياء الدين منوط بإحياء هذه التجارب أكثر مِن أيّ شيء آخر».
وبعد أنْ ذكر تفاصيل هذا الموضوع قال: بعض العرفاء وعلماء اللاهوت قالوا يجب معرفة حقيقة الدين كأمر وجودي، ممّا يعني وجوب معرفتها على أساس ثلاث ميزات:
الأولى: يجب أنْ يكون الدين فاعلًا ذا حيويّة، وهذا يعني أنَّ الإنسان يواجه تجربته الدينيّة الشخصيّة حین تؤثّر عليه هذه التجربة وتغيّر حقيقته، رغم المحدوديّات التاريخيّة والاجتماعيّة واللغويّة والبدنيّة التي تقيّد الانسان.
الثانية: الحقیقة الدينيّة عبارة عن أمر شخصيّة و حواریه؛ أي إنّها تحكي عن الارتباط بين «أنا» و «هو» وليس بين «أنا» و«ذلك».
الثالثة: هذه الحقيقة خفيّة وعرضة للنسيان. كلامه يدلّ بصريح العبارة على أنّ التجارب الدينيّة برأيه تتّصف بهذه الميّزات الثلاثة، وهناك نماذج لهذا النمط مِن إحيائها في سيرة الأولياء والعرفاء.
هناك بعض الملاحظات الجديرة بالذكر بخصوص الرؤية المشار إليها، وهي كالآتي:
1. محمّد مجتهد شبستري ادّعى أنّ جوهر الدين له ثلاث خصائص فارقة، وممّا قاله ضمن استدلاله على رأيه: «...بما أنّ هذه الخصائص الثلاثة موجودة في تجارب العرفاء تجاه الله»، فهذا الاستدلال يعتبر مصادرةً على المطلوب.
2. لو اعتبرنا كلّ إنسان مدركًا لحقيقة الدين المطلقة ضمن منظومته العقليّة، فجوهر الدين في هذه الحالة ليس عبارة عن تجربة أمرٍ متعالٍ.
إذا اعتبرنا جوهر الدين أمرًا متعاليًا، فالإشكال الذي يرِد على هذا الكلام، هو أنَّ الكثير مِن الناس لا يمكنهم خوض هذه التجربة المتعالية؛ نظرًا للقيود الأربعة التي تضيّق نطاق قدراتهم، ومِن ثمّ يجب الحكم عليهم بأنّهم خارجون عن الدين!
3. يا ترى هل التجارب الدينيّة مستقلّة عن المفاهيم أو أنّها مستقلّة عن الاستدلال؟ التجارب الدينيّة حسب الرؤية المتعارفة دائمًا تتواكب مع مفاهيم.
حياة الإنسان برأي محمّد مجتهد شبستري تصبح فاعلةً ومفعمةً بالحيويّة حينما يخوض تجارب دينيّة أصيلة، فهو في هذه الحالة يعيش في رحاب حياة لا تتوقّف فيها الحركة وتجري بشكل دائب، وكأنّه في سباق مع نفسه والغلبة له على الدوام؛ لأنّه دائمًا يهزم نفسه السابقة ليلج في نفس جديدة. وممّا قاله بهذا الخصوص:
«المؤمن دائمًا يعيش حالة نقدٍ وانتقالٍ مِن حالةٍ إلى أخرى، وهو يحذر مِن الدوغماتيّة والركود؛ لأنّه في واقع الحال يروم الخروج مِن أربعة سجون تقيّده، هي المجتمع والتاريخ واللغة والزمان، وجدل هؤلاء فحواه وجود خطاب يسمعه الإنسان فيما وراء هذه السجون، ومضمون هذا الخطاب يختلف عن سائر الأخبار المتعارفة، لكنْ لا محيص مِن بلورة هذه الأخبار ضمن السجون المشار إليها».
المسألة الأخرى الجديرة بالذكر في هذا الصعيد، هي أنَّ التجارب الدينيّة، وفق ما ذكرنا مِن آراء لهذا المفكّر، تعدّ أعمق طبقة في الدين، وهي التي تصوغ حقيقة الإيمان. لكنَّ المؤمن في هذا الطريق، يواجه أربع عقبات تعرقله دائمًا عن امتلاك تجربة دينيّة أصيلة؛ وعلى الرغم مِن تقييدها له وتلازمها لمسيرته في الحياة لدرجة أنّه يصبح عاجزًا عن التفكير بدونها، إلّا أنّه مكلّف بأنْ يسلك طريقًا فيما ورائها وخارج نطاقها ويفعل ما بوسعه لتحطيمها وتجاوزها.
عندما نحلّل كلام المفكّر محمّد مجتهد شبستري، ينبغي لنا معرفة النقاط الإيجابيّة فيه، وبعد أنْ نستكشف هذه النقاط ونطرحها على طاولة البحث والتحليل، فأوّل مسألة مهمّة للغاية في هذا الصعيد، هي تأكيده على أنَّ الرؤية الدوغماتيّة أهمّ سبب لتخلّف البشر فكريًّا، وهذا هو السبب في صيرورة نقد كلّ مِن رينيه ديكارت وإيمانوئيل كانط وفرنسيس بيكّون نقطة تحوّل في مسيرة تطوّر الفكر الفلسفي الغربي. فالنقد الجادّ الذي طرحه كانط على العقل النظري الدوغماتي الموروث في الثقافة والفكر الأوروبي، والذي كان مرتكزًا أساسيًّا للإبستيمولوجيا الغربيّة، أحدث تحوّلات جذريّة ومؤثّرة للغاية لدرجة أنَّ الفلاسفة الذين لحقوه لم يتمكّنوا مِن تجاوزه. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ السيّد شبستري عاش في ألمانيا لمدّة مِن الزمن، لذا هو مِن جملة الفلاسفة الذين عجزوا عن تجاوز نطاق النقد الكانطي. هذا ما أكّد عليه بعض الباحثين الذين تطرّقوا إلى تحليل الموضوع بدقّة وإمعان نظر. ونحن بدورنا نؤيّد هذا الكلام على ضوء ما توصّلنا إليه في بحوثنا المعدودة التي أجريناها بهذا الخصوص، لكنْ رغم ذلك لا نؤيّده بالتمام والكمال؛ إذ لو نظرنا إلى الإيمان بهذا الأسلوب، لوجدنا الكثير مِن الناس غير مؤمنين وغير مقيدين بشريعة خاصّة. ناهيك عن أنَّ الذين بذلوا جهودًا حثيثةً على صعيد البرهنة والاستدلال، ليسوا مؤمنين حقيقيين في هذه الحالة، إلّا أنّهم مؤمنون حقًّا حسب الرؤية الدينيّة.
(236)بناءً على ما ذكر، يصبح الإيمان المتقوّم على تجارب أصيلة مجرّد هدف بعيد المنال، إلّا أنّه في واقع الحال عبارة عن أمر موجود ذي مراتب خاصّة، حسب رأي أستاذ عبدالله جوادي الآملي، الذي تحدّث عنه قائلًا:
«الإيمان القلبي التقلیدی هو أوّل مراتب الإيمان، والقرآن الكريم اعتبر الإخلاص شرطًا فيه؛ وثاني مراتبه هي مقام (كأنّ) وثالث مراتبه هي مقام (إنّ) الذي هو مقام الأولياء والأنبياء».
بعد ذلك ذكر رؤيته التي يتبنّاها إزاء حقيقة الإيمان الذي يجري في حركة عموديّة باعتقاده، حيث قال:
«كون حركة السير والسلوك الروحاني عموديّة في التعاليم الدينيّة، معناه بلوغ الإنسان مكانةً أعلى وليس مكانًا أعلى»
وفي موضع آخر، ذكر تقسيمًا أكثر دقّة حول هذا الموضوع قائلًا:
«يمكننا تقسيم حياة الإنسان ضمن ثلاثة مستويات:
المستوى الأوّل: الإيمان العامّي؛ يكفي في هذا المقام مجرّد الالتزام بالواجبات وترك المحرّمات.
الثاني: الإيمان الحكيم؛ ولا يكفي في هذا الإيمان مجرّد الالتزام
بالواجبات وترك المحرّمات، بل يجب أيضًا تشذيب الملكات النفسانيّة وترسيخها في النواة المركزيّة للعدل.
الثالث: الإيمان العرفاني؛ والمؤمن في هذا المقام يصبح مظهرًا للأسماء الإلهيّة الحسنى كافّة، وضمن كلّ حقبة مِن الزمن يتجلّى في رحاب أحد هذه الأسماء ويسلك على أساسها تناسبًا مع ظروف زمانه».
المفكّر محمّد مجتهد شبستري حينما تحدّث عن حقيقة الإيمان، حاول في بادئ الأمر تصوير التجارب الدينيّة للمؤمنين كافّة بشكل كلّي، واعتبرها معيارًا للإيمان لأجل أنْ تعمّم على كلّ مَنْ يدّعي الإيمان. لكنّه عندما تطرّق إلى بيان حقيقة التجارب الدينيّة الأصيلة، طرح آراءه واحدًا تلو الآخر ليصوّرها كأمر لا يعمّ مستويات حياة البشر كافّة؛ أي إنّها وفق أسلوبه البحثي والنتائج التي توصّل إليها في هذا المضمار، لا تشمل الكثير مِن جوانب حياتهم.
الحصيلة النهائيّة التي يمكن استخلاصها مِن جملة آرائه ونظريّاته، تثبت وجود إشكاليّات في آرائه تتمثّل بعدم وجود انسجام بين ما يطرح فيها، ومِن جملة ذلك وصفه التجارب الدينيّة بالنهر الجاري النابع مِن تجارب النبيّ، والذي يصبّ أخيرًا في تجارب عامّة المؤمنين. إلّا أنّه مِن جهة أخرى، اعتبر هذه التجارب بكونها أعمق طبقة في الدين، لكنّ عامّة الناس عاجزون عن خوضها.
الإيمان وفق ما ذكرنا في آراء الأستاذ عبدالله الجوادي الآملي عبارة عن أمر موجود على أرض الواقع، وله عدّة مراتب. لذا، فهو ليس أمرًا ماهويًّا ومتواطئًا حسب الاصطلاح المنطقي؛ أي إنّه ليس مفهومًا كلّيًا ينطبق على مصاديقه كافّة بشكل متكافئ.
استنادًا إلى ما ذكرنا بخصوص حقيقة الإيمان، توصّلنا إلى نتيجة فحواها وجود نقطة اشتراك بين آرائنا وآراء المفكّر محمّد مجتهد شبستري ونقطة اختلاف. أمّا الجهة المشتركة التي نؤيّد على أساسها ما تبنّاه مِن آراء، فهي أنَّ الإيمان عبارة عن حقيقة وجوديّة متواصلة وفاعلة. وأمّا الجهة التي نختلف فيها معه، فهي مسألة أنَّ الإيمان ذو مراتب ودرجات، أدناها العمل وفق التعاليم الشرعيّة، والأعلى منها العقائد والملكات الأخلاقيّة الراسخة، والأعلى مِن كلّ ذلك صيرورة المؤمن مظهر تامّ لأحد الأسماء الإلهيّة الحسنى.
(239)- القرآن الكريم.
- ابن منظور، محمّد بن مكرم بن ، لسان العرب، لبنان، بيروت، منشورات «دار صادر»، الجزء الأوّل، الطبعة الثالثة، 2004م.
- بيترسون، مايكل وآخرون، عقل و اعتقاد ديني (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات «طرح نو»، 2004م.
- جوادي الآملي، عبدالله، تفسير موضوعي (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات «إسراء»، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، 2005م.
- ــــــــــ، تفسير موضوعي (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات «إسراء»، الجزء الحادي عشر، الطبعة الثالثة، 2005م.
- ــــــــــ، تفسير موضوعي (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات «إسراء»، الجزء الرابع عشر، الطبعة الثالثة، 2005م.
- الرازي، محمّد بن عمر فخر الدين، المحصّل، تحقيق حسين أتاي، منشورات الشريف الرضي، 1999م.
- الشهرستاني، الملل والنحل، تخريج محمّد بن عبدالله بدران، مصر، القاهرة، منشورات «إنجلوا»، الطبعة الثانية، بدون تاريخ طبع.
- الشيخ الصدوق، الأمالي، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات المكتبة الإسلاميّة، 2001م.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرّائي، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات «أسوة»، الجزء الأوّل، الطبعة الثانية، 2004م.
- قائمي نيا، علي رضا، تجربه ديني و گوهر دين (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات «بوستان كتاب»، 2002م.
- مجتهد شبستري، محمّد، نقدي بر قرائت رسمي از دين (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات «طرح نو»، 2000م.
- ــــــــــ، تاملاتي در قرائت انساني از دين (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات «طرح نو»، 2004م.
- ــــــــــ، هرمنوتيك كتاب و سنت (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات «طرح نو»، الطبعة السادسة، 2005م.
- مجموعة مِن الباحثين، باورهاي ديني (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات معهد الإمام الخميني للبحوث العلميّة، 2007م.
(241)أحمد حسين شريفي
يا ترى هل نصّ القرآن الكريم كلام الله تعالى أو كلام البشر؟ هذا السؤال طرح منذ عصر النزول، ففي تلك الآونة رفض منكرو نبوّة خاتم الأنبياء محمّدصلىاللهعليهوآله أنَّه كلام الله، وادّعوا أنّه مِن كلام البشر. وفي العصر الحديث أيضًا، بات هذا السؤال مدار بحث وتحليل جادّ مِن قبل المستشرقين وبعض دعاة التنوير الفكري في العالم الإسلامي.
وفي هذا السياق، فالمفكّر والباحث الإيراني محمّد مجتهد شبستري اتّبع بعض الآراء الفلسفيّة الهرمنيوطيقيّة؛ ليدّعي أنَّ الشرط الأساسي لفهم كلّ كلام، هو أنْ يكون بشريًّا. وعلى هذا الأساس، لو كان القرآن الكريم كلام الله حقًّا وليس كلام البشر، لا يمكننا مطلقًا فهمه وتفسيره.
تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى تحليل هذا الادّعاء وتقييم الأدلّة التي ارتكز عليها بأسلوب بحث فلسفي نقدي. وقد أثبت على ضوء النتائج التي توصّل إليها، عدم وجود أيّ تلازم بين مسألتي فهم القرآن الكريم وأنَّه كلام بشريّ. وكلّ الأدلّة التي ذكرت لادّعاء أنّ فهمه مشروط بأنْ يكون مِن كلام البشر، باطلة وفيها مغالطات واضحة.
يا ترى هل القرآن الكريم كلام الله تعالى أو كلام البشر؟ هذا السؤال طرح منذ عصر نزول القرآن وما زال مطروحًا إلى عصرنا الحاضر، لذلك أثار الكثير مِن النقاشات على مرّ التاريخ.
حينما كان رسول الله يتلو الآيات المنزلة عليه وهو في مكّة، أنكر بعض الناس أنّها منزلة مِن الله؛ أي رفضوا أنَّ القرآن الكريم كلام الله، وزعموا أنّه مِن تأليف الرسول نفسه. لذلك عارضوا رسالته، وادّعى بعضهم: ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ*إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾. هاتان الآيتان تشيران إلى ما قاله الوليد بن المغيرة الذي كان أحد زعماء قريش، فعندما شاهد اتسّاع نطاق الدعوة النبويّة وانتشارها السريع وعدم توقّفها أمام معارضة القرشيين وتهديداتهم، قرّر تحشيد المعارضين ليوحّد كلمتهم ضدّ هذه الدعوة المباركة، إذ أدرك عدم نجاعة بعض التّهم التي وجّهت للنبيّ الأكرم مثل ادّعاء كونه شاعرًا وكاهنًا ومجنونًا؛ لأنّ هذه التّهم الواهية لم يصدّقها الناس، بل أسفرت عن نتيجة معكوسة؛ لذلك بعد أنْ فكّر وتأمّل كثيرًا، اقترح اتّهام
القرآن الكريم بأنّه سحر ومِن كلام البشر؛ أي إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ساحر ابتدع النصّ القرآني بنفسه؛ إذ ادّعى أنّ مضمونه كالسحر الذي يفرّق بين حبيبين أو يحبّب عدوّين مع بعضهما.
سورة المدّثر مِن حيث ترتيب نزول القرآن تأتي بعد سور العلق والقلم والمزّمل. لذا، على أساس هذا الترتيب تعتبر رابع سورة نزلت على قلب النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله، وهذا يعني أنّ مضمونها مرتبط بالسنوات الأولى للبعثة.
معارضو الدعوة النبويّة أنكروا أنَّ القرآن الكريم كلام الله تعالى لأجل تفنيد النبوّة، ثمّ تبعهم آخرون آمنوا بالنبوّة، لكنّهم زعموا أنّ مضمون النصّ القرآني ومفاهيمه فقط، نزل على قلب النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله ثمّ صاغ بنيته اللغويّة بأسلوبه البياني. وأصحاب هذا الرأي انقسموا إلى فئتين كما يلي:
الفئة الأولى: ادّعى هؤلاء أنّ ألفاظ القرآن الكريم مِن صياغة النبيّ صلىاللهعليهوآله، لكنّها تدلّ في واقعها على مضامين نزلت عليه بوحي السماء.
الفئة الثانية: ادّعى هؤلاء أنّ الوحي المنزل على النبيّ صلىاللهعليهوآله عبارة عن أمر إجمالي وحقيقة بسيطة ـ أي إنّ الآيات القرآنيّة لم تنزل بالتفصيل ـ إلّا أنّ النبيّ اقتبس ممّا أوحي إليه أفكاره، وبسّطها بشكل تفصيلي ضمن آيات وسور تلاها على الناس في مختلف الظروف التي واجهها في تلك الآونة، وتناسبًا مع أوضاع المجتمع.
وأمّا بعض المفكّرين المعاصرين مِن أمثال الباحث محمّد مجتهد شبستري، فقد اعتبروا ارتباط النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله بالله تعالى وعالم الغيب مجرّد ادّعاء محض مِن قبل النبيّ؛ إذ لا يمكن إثباته على نحو القطع واليقين. وعلى هذا الأساس قال:
«ألفاظ القرآن ومعانيه جاء بها النبيّ نفسه، رغم أنّه خاض تجربةً دينيّة كان الله فيها معلّمه، حيث وصفها بالوحي».
هذا الباحث حذا حذو الذين عارضوا القرآن الكريم في عصر نزوله، وادّعوا أنَّه مجرّد نصّ لغوي عربي مِن صياغة البشر، ومِن المحال أنْ يكون كلام الله تعالى؛ إذ ذكر هذا المدّعي في سلسلة مقالات دوّنها تحت عنوان «القراءة النبويّة للعالم»، ذكر فيها تفاصيل كثيرة بهذا الخصوص، وأحد أهمّ ادّعاءاته هو: لو اعتبرنا القرآن الكريم كلام الله تعالى، ففي هذه الحالة لا يمكننا فهمه على الإطلاق.
في هذه المقالة سوف نتطرّق إلى تحليل رأيه المذكور في إطار دراسة نقديّة، وفق الأسلوب الذي اقترحه بنفسه لنقد كلامه.
على الرغم مِن تأكيد هذا الباحث على النتائج العقائديّة والسياسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي تترتّب على نظريّته التي ذكر معالمها في سلسلة مقالات تحت عنوان «القراءة النبويّة للعالم»، لكنّه مع ذلك قال مَنْ يريد أنْ ينتقد نظريّتي، يجب عليه أوّلًا إيراد نقد صائب على أدلّتها، وليس مجرّد نقد نتائجها، إذ قال:
«بدل وصف أفكاري بالمنحرفة وتحريض الجهلة ضدّي، مِن الأنسب تدوين عدّة صفحات تتضمّن استدلالات في نقدها وفتح باب البحث والتحليل بهذا الخصوص».
كذلك قال:
«لو انتقد المعارضون هذه النظريّة بأسلوب يتقوّم على أسس نقديّة واقعيّة، فأنا مستعدّ لأنْ أناقشهم برحابة صدرٍ».
بناءً على ذلك، سوف نتطرّق إلى نقد نظريّته حسبما طلب، وعلى أساس مبادئ البحث العلمي القويم، راجين منه أنْ يفي بوعده ويلتزم بمبادئ البحث عن الحقيقة، بحيث يقرأ نقدنا بدقّة ثمّ «يتناقش معنا برحابة صدرٍ»، وأنْ لا يتّبع نهجه السابق ويتورّع عن إكالة التّهم الواهية، ولا يدّعي أنّي دوغمائي كما اتّهم سائر ناقديه؛ فما يدعو للأسف، أنّه اتّبع الأسلوب ذاته المعهود عن دعاة التنوير الفكري في التعامل مع منتقديهم.
محمّد مجتهد شبتستري ادّعى أنَّ الشرط الأساسي لفهم وتفسير كلّ نصّ لغويّ، وبما في ذلك القرآن الكريم، هو اعتباره مِن صياغة البشر. ومِن هذا المنطلق، لو اعتبرنا النصّ القرآني كلام الله، ففي هذه الحالة لا يمكن فهمه وتفسيره على الإطلاق.
ذكر تفاصيل هذه الرؤية ضمن سلسلة مقالات دوّنها تحت عنوان «القراءة النبويّة للعالم»، حيث ابتدأ نشرها في شهر شباط / فبراير سنة 2008م وأتمّها في شهر أيّار / مايو سنة 2015م. وفي هذه المقالة الموجزة، سوف نتطرّق إلى نقد وتحليل الأدلّة التي استند إليها في هذا المضمار. وبإذن الله تعالى سوف نسلّط الضوء في مقالات أخرى مستقبلًا على سائر آرائه التي تبنّاها بهذا الخصوص.
نرى مِن الأنسب في بادئ البحث بيان مدّعاه على ضوء أقواله؛ إذ ذكر آراءه في هذا السياق ضمن مضامين وعبارات متنوّعة في الكثير مِن المناسبات والمدوّنات. وكما ذكرنا، فقد دوّن سلسلة مقالات تحت عنوان «القراءة النبويّة للعالم»، قال في أوّل مقالة منها ما يلي:
«لو أمعنّا النظر في أساليب كلام البشر وطرق التفاهم فيما بينهم، نستنتج أنّ النبيّ محمّد لو عرّف نفسه لقومه بأنّه كالسّماعة التي تقتصر وظيفتها على نقل الصوت للمخاطبين بأسلوب منظّم، بحيث يستمعون إلى ما تبثّه لهم، أو كالملاك الذي يتلو عليهم كلامًا... ففي هذه الحالة لا يمكنهم فهم كلامه على الإطلاق، ولكان كلامًا عاريًا مِن كلّ معنى ومفهوم. وإثر ذلك، لما استطاع الاعتماد على هذا الكلام كأساس لدعوته، ولما أصبح خطابًا تاريخيًّا مثمرًا، بل لما أمكن حدوث أيّ خطاب واضح وتفاهم بينه وبينهم على الإطلاق».
ووضّح مدّعاه في المقالة الثانية كما يلي:
«القرآن (المصحف الشريف) عبارة نصّ مدوّن باللغة العربيّة يفهمه كلّ قارئ (مؤمنًا كان أو غير مؤمن)، ولا يمكن أنْ ينسب إلّا إلى إنسانٍ (النبيّ محمّد)، لذا يجب اعتباره مِن كلام البشر.
لو نُسب النصّ القرآني كنصّ لغويّ عربيّ (على نحو الإسناد الحقيقي) مباشرةً ودون أيّة واسطةٍ إلى الله، لتجرّد عن عموميّته، بل لأصبح (فهمه) مستحيلًا مِن أساسه»
وفي مقالة أخرى، تطرّق إلى بيان الأدلّة والمزاعم التي ذكرها في مقالاته الخمسة عشر، التي دوّنها حول قراءة النبيّ للعالم؛ إذ وضّح آخر مدّعى له كما يلي:
«لا يمكننا فهم النصّ القرآني وتفسيره الشامل (على نحو الاشتراك الفكري) إلّا إذا اعتبرناه نصًّا كسائر النصوص اللغويّة المتعارفة التي أنتجها الفكر البشري؛ أي لا بدّ مِن اعتبار القرآن مِن كلام البشر كي نتمكّن مِن فهم معانيه».
يمكن تلخيص ادّعائه بشكل عامّ كما يلي: النصّ القرآني ليس كلام الله تعالى ولا يمكن أنْ يكون كذلك، بل هو كلام إنسان؛ أي إنّه مِن تأليف النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله. إذاً، بعد أنْ تعرّفنا على مغزى رأيه بالنسبة إلى القرآن الكريم، نشير فيما يلي إلى الأدلّة التي استند إليها في هذا المضمار على ضوء آرائه، ضمن بحث علمي منظّم ومتناسق، ثمّ نقيّمها فكريًّا بكلّ إنصاف بمعيار الحقيقة والبرهان.
أحد الأدلّة التي استند إليها الباحث محمّد مجتهد شبستري لإثبات ادّعائه بأنَّ النصّ القرآني مِن كلام البشر، هو اعتقاد مخاطبيه بأنّه مِن تأليف النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله؛ إذ لم يعتبروه ناقلًا لكلام الله تعالى، بل اعتبروه شخصًا يدّعي النبوّة على ضوء ما يذكره لهم مِن كلام لغويّ؛ وحتّى لو ادّعى أنّه مجرّد ناقل يحمل كلام الله تعالى لهم، فالأمر الوحيد المفهوم عندهم في هذه الحالة، هو الكلام الذي سمعوه بلسانه، وليس ذلك النصّ الذي يعتبر في الواقع كلام الله تعالى.
شبستري كرّر ادّعاءه هذا في عدّة مناسبات، وهنا نشير إلى العبارة التالية كمثال:
«ما سمعه المخاطبون هو كلام النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله وقد ذكره بصفته نبيًّا مِن البشر».
وعلى هذا الأساس، ادّعى أنّ فهم هذا الكلام بصفته خطابًا شفهيًّا في بادئ الأمر ثمّ تحوّل إلى نصّ مكتوب، مرهون بالاعتقاد بأنّ الذي جاء به إنسان يدّعي النبوّة حيث يتلو على الناس آيات منه في رحاب تجربة خاضها مع أناس مؤمنين وآخرين غير مؤمنين بنبوّته. وبالتالي، جرّبوا هذا «الفعل الخطابي» مباشرةً ودون وساطة فأصبح مفهومًا عندهم.
وأضاف قائلًا:
«بعد أنْ واجه مخاطبو النبيّ كلامه عن طريق النصّ القرآني، بدأت عمليّة فهمه وتفسيره عند المسلمين ثمّ تواصلت في العصور اللاحقة، وخلال هذه العمليّة حدثت الكثير مِن الأمور، وظهرت عقائد جديدة،
مِن جملتها أنّه منزل مِن الله تعالى مباشرةً على قلب النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله؛ أي إنّ كلّ ألفاظه وعباراته منزلة مِن الله.
هذا الاعتقاد شاع بين المسلمين على ضوء أحد أساليب فهمه وتفسيره، ولم يكن مطروحًا خلال فترة تجربة النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله الدينيّة، فقد ابتدعه مخاطبو النصّ القرآني، ولم يكن معروفًا عند نزوله».
وقال في آخر استنتاج ذكره بخصوص هذا الموضوع:
«النصّ القرآني فيه شواهد واضحة تدلّ على أنّ النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله ومخاطبيه كانوا يعتبرونه مِن كلام النبيّ نفسه».
وقال أيضًا:
«... كما أنّ ظاهر الفهم المشترك والتفسير المشترك للنصّ القرآني، يدلّ على أنَّ عامّة الناس يفهمون معانيه بشكل تجريبي مباشرةً ودون واسطة، بصفته مجرّد كلام ألقاه شخص يدّعي النبوّة على مخاطبيه. وعلى هذا الأساس، فما يفهمه ويفسّره المخاطبون بشكل مشترك، ليس سوى كلام إنسان مثلهم، لكنْ غاية ما في الأمر أنّه يدّعي النبوّة؛ وحتّى لو قال إنّ هذه الألفاظ والعبارات سمعها مِن غيره ثمّ تلاها عليهم، فعند فهمها وتفسيرها بشكل مشترك، لا يمكن أنْ يتمّ التعامل معها إلّا بصفتها ألفاظًا وعبارات صدرت مِن لسانه، ممّا يعني أنّ مسألة البحث والتحليل، تتمحور حول ادّعائه أنّه سمع النصّ مِن غيره، ولا تتمحور حول معاني ألفاظه وعباراته».
فيما يلي نسلّط الضوء على ما ذكر بأسلوب تحليل نقدي:
استدلال محمّد مجتهد شبستري، الذي أشرنا إليه، عبارة عن مغالطة غموض واضحة وصريحة بشكل لا يمكن إنكاره على الإطلاق، فهو لم يستطع بيان رأيه بأسلوب صحيح وشفّاف. لذا، يمكن تفسيره ضمن احتمالات عديدة كما يلي:
الاحتمال الأوّل: ربّما قصده هو أنّ مخاطبي النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله استمعوا ألفاظ القرآن الكريم وعباراته مِن لسان النبيّ، وليس مِن الله مباشرةً.
الاحتمال الثاني: السيّد شبستري ربّما قصد بيان قاعدة إبستيمولوجيّة وإدراكيّة؛ بمعنى أنّ ما يستطيع المخاطب فهمه وتفسيره، هو كلام ذكره النبيّ على لسانه؛ إذ لا يمكنهم فهم أيّ كلام ما لم يكن مِن تأليفه وصياغته. لذا، ما ذكره لهم مِن ألفاظ وعبارات، لا يعدّ مِن تأليف الله تعالى وصياغته نقل لهم على لسان النبيّ، فلو كان هكذا لما فهمه أحدٌ منهم أو استطاعوا تفسيره على الإطلاق.
الاحتمال الثالث: ما ذكره السيّد شبستري في هذا السياق، قوامه تقييم تاريخي؛ إذ ادّعى أنّ مخاطبي النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله في عصر نزول القرآن، لم يكن لديهم اعتقاد بأنّه ناقل كلام الله لهم، بل كانوا يعتقدون بأنّ ما يتلوه عليهم هو كلام صاغ ألفاظه وعباراته بنفسه.
نستشفّ مِن جملة ما ذكر، أنّ الأدلّة التي استند إليها لإثبات مدّعاه غامضة، وسوف نثبت لاحقًا وجود شواهد وقرائن مِن كلامه نفسه، تؤيّد هذه الاحتمالات الثلاثة، كما سنتطرّق إلى تحليلها واحدًا تلو الآخر.
(252)كما ذكرنا في مبحث «مضمون مدّعى شبستري»، فإنّ ادّعاءه الأساسي مغزاه: النصّ القرآني ليس كلام الله تعالى ولا يمكن أنْ يكون كذلك، بل هو كلام إنسان؛ أي إنّه مِن تأليف النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله. لكنَّ الدليل الذي استند إليه حسب الاحتمال الأوّل مِن الاحتمالات الثلاثة التي أشرنا إليها، هو أنّ مخاطبي النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكونوا على ارتباط مباشر مع كلام الله، بل النبيّ فقط خاض تجربة هذا الارتباط، فقد قال بهذا الخصوص:
«عندما قلت إنَّ مخاطبي النبيّ لم يكونوا على علم بما يجول في صدره، قصدت أنّهم لم يخوضوا تجربة كلام الله معه، ولم يتمكّنوا مِن الارتباط به بدنيًّا أو روحيًّا؛ لأنَّ هذه التجربة مِن مختصّات النبيّ نفسه فحسب، لذا لم يواجهوا آنذاك سوى كلام النبيّ نفسه».
إذا كان قصده مِن الدليل، الذي أشار إليه، هذا الكلام نفسه، فلا أحد يعارضه؛ إذ لم يدّع أحدٌ حتّى الآن أنّ مخاطبي القرآن الكريم كانوا يسمعون الكلام الذي وجّهه الله عزّ وجلّ للنبي محمّدصلىاللهعليهوآله مباشرةً، كذلك لم يدّع أحدٌ أنّهم سمعوا القرآن الكريم مباشرةً مِن الله تعالى.
فضلًا عن ذلك، نطرح عليه السؤال الآتي: ما هو وجه ارتباط هذا الدليل مع مدّعاك بأنَّ النصّ القرآني مِن كلام البشر؟ فقد ادّعيت أنَّ القرآن الكريم ليس كلام الله، ولا يمكن أنْ يكون كذلك، بل هو كلام بشر مِن تأليف وصياغة النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله؛ في حين أنّ الدليل الذي ذكرته في هذا السياق، مضمونه أنّ مخاطبي النبيّ بإمكانهم مواجهة كلامه مباشرةً، ولا يمكنهم أنْ
يخوضوا تجربة كلام الله معه كما خاضها بنفسه، ولا يمكنهم أنْ يرتبطوا به بدنيًّا وروحيًّا؛ لأنَّ هذه التجربة مِن مختصّاته فحسب.
بناءً على ما ذكر، نستنتج أنّ السيّد شبستري لا يشكّك بأنَّ النصّ القرآني كلام الله تعالى، وأنّ النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله قد نقله إلى الناس. فهذا الرأي ذاته الذي يقوله العلماء المسلمون كافّة، باعتبار أنّ تجربة الوحي مِن مختصّات النبيّ فقط. إلّا أنّ هذا الباحث ادّعى أمرًا آخر؛ إذ ذكر بصريح العبارة أنّ النصّ القرآني مِن المستحيل أنْ يكون كلام الله تعالى، بل كلّ ألفاظه وعباراته ومعانيه مِن تأليف النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله وصياغته، إذ قال:
«ليس مِن المعقول افتراض أنَّ النبيّ تلقّى النصّ القرآني، بكلّ ألفاظه وعباراته ومعانيه التي تتطابق مع كلام البشر؛ مِن الله، سواًء كان هذا التلقّي مباشرًا أو بواسطةٍ؛ إذ لا يعقل أنّه نقل ذات كلام الله إلى مخاطبيه وتلاه عليهم بذات الألفاظ والعبارات».
إذا كان الاحتمال الثاني هو المقصود مِن ادّعاء السيّد شبستري؛ أي إذا كان قصده بيان قاعدة إبستيمولوجيّة وإدراكيّة حول فهم النصّ القرآني وتفسيره، ففي هذه الحالة لا يعدّ ما ذكره دليلًا مستقلًّا؛ لأنَّ مضمون هذا الكلام هو الدليل الثاني ذاته الذي سنشير إليه لاحقًا.
ذكْر السيّد شبستري هذا الموضوع بمثابة دليل مستقلّ لإثبات مدّعاه، وهدفه مِن ذلك إيجاد تأثير نفسي على القارئ. وسوف نتطرّق إلى نقده
بالتفصيل لاحقًا، ونكتفي هنا ببيان إجمالي حوله: لو كان قصده عجز مخاطبي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن فهم كلام الله وتفسيره؛ لأنّ النصّ القرآني إذا كان كلام الله حقًّا، سوف لا يدركونه في هذه الحالة مطلقًا. وهنا يطرح عليه السؤال الآتي: هل هناك دليل يثبت عجز البشر عن مواجهة كلام الله بشكل غير مباشر؟ فهل يمتاز الإنسان بميزة تجعله غير قادر على فهم كلام ربّه أو تجعله يستحقّ الحرمان مِن فهمه؟ وهل يمكن ادّعاء أنّ الله عزّ وجلّ، فيه نقصٌ يجعله عاجزًا عن نطق كلام يفهمه عباده؟!
كما ذكرنا آنفًا، فمِن الممكن ذكر احتمال ثالث على رأي السيّد شبستري، إذ هناك شواهد تؤيّده؛ لأنّه ادّعى وجود قرائن تاريخيّة في هذا المضمار، مضمونها أنّ مخاطبي النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله في عصر نزول القرآن الكريم قاطبةً، لم يكن لديهم اعتقاد بأنّ ما يتلوه عليهم هو كلام الله؛ أي لم يعتقدوا أنّه ناقل لكلام تلقّاه مباشرةً مِن الله تعالى، بل كان اعتقادهم هو أنّ النصّ القرآني كلام النبيّ نفسه.
كذلك ادّعى قائلًا:
«النصّ القرآني يتضمّن شواهد واضحة تدلّ على اعتقاد النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله نفسه وكذلك مخاطبيه، بأنَّ الألفاظ والعبارات القرآنيّة التي تلاها عليهم مِن تأليفه وصياغته؛ أي إنّه مِن كلامه».
إذا كان قصده مِن هذا الكلام نقل خبر عن حدث تاريخي، فهذا الخبر يتعارض مع الواقع بالكامل، فزعم أنَّ مخاطبي القرآن كانوا يعتقدون بأنَّ
ألفاظه وعباراته مِن تأليف وصياغة النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله لا يوجد أيّ دليل تاريخي يؤيّده، بل الأمر على العكس تمامًا؛ لأنَّ الأدلّة والشواهد التاريخيّة كافّة تدلّ على بطلانه، ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة لإثبات ذلك:
المثال الأوّل: قصّة منع تدوين أحاديث النبيّ صلىاللهعليهوآله ورفع شعار «حسبنا كتاب الله» مِن قبل نظام الخلافة، تدلّ بحدّ ذاتها على بطلان دليل السيّد مجتهد شبستري.
وهنا نطرح عليه الأسئلة الآتية: في أيّة ظروف وقعت هذه الأحداث؟ لماذا قرّر بعض المسلمين إحراق ما تمّ تدوينه مِن أحاديث النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله بأمر مِن الخليفة والاكتفاء بالآيات القرآنيّة، بحيث بذلوا قصارى جهودهم للحفاظ عليها؟ إذاً، لو كانوا حقًّا يعتقدون بأنّ ألفاظ النصّ القرآني وعباراته مِن تأليف وصياغة النبيّ نفسه، لماذا لم يحرقوا الآيات التي تمّ تدوينها؟
المثال الثاني: في يوم غدير خمّ بعد أنْ أعلن النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله للمسلمين ولایه الإمام علي عليهالسلام بعده، سأله الصحابي النعمان بن حرث الفهري أو الحارث بن عمرو الفهري: هل قرّرت تنصيبه للولایه بنفسك أو بأمر مِن الله؟
إذاً، لو أنّ المسلمين، حسب ادّعاء السيّد مجتهد شبستري، كانوا يعتقدون بأنّ ما يتلوه النبيّ عليهم كلام مِن تأليفه وصياغته بنفسه ولم يعتقدوا مطلقًا بأنّه ناقل كلام الله لهم، فكيف يبرّر السيّد شبستري هذا السؤال الذي طرح على النبيّ وما شاكله مِن أسئلة ومواقف أخرى؟
المثال الثالث: أحد صحابة النبيّ كان يدوّن كلامه والآيات التي يتلوها على المسلمين، وذات يوم سأله: يا رسول الله، أكتب كلّ ما أسمع منك؟ أجابه النبيّ: «نعم»، فسأله أيضًا: في الرضا والغضب؟ أجابه: «نعم، فإنّي لا أقول في ذلك كلّه إلّا حقًّا».
وروي عن عبدالله بن عمر أنّه قال: قالت لي قريش: تكتب عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنّما هو بشر يغضب كما يغضب البشر؟! فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقلت: يا رسول الله، إنّ قريشًا يقول: تكتب عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنّما هو بشر يغضب كما يغضب البشر؟! فأومأ لي شفتيه فقال: «والذي نفسي بيده ما يخرج ممّا بينهما إلّا حقّ، فاكتب». هذه الرواية تدلّ بوضوح على أنَّ مخاطبي النبيّ في عصر نزول القرآن، كانوا يميّزون بين كلامه والآيات التي يتلوها عليهم كوحي منزل.
بغضّ النظر عن كلّ ما ذكر؛ أي حتّى إذا قبلنا بمقدّمات هذا الاستدلال، فهل يمكن التوصّل إلى نتيجةٍ تؤيّد ما ذكره السيّد شبستري؟ فيا ترى هل هناك ارتباط بين هذه المقدّمات والنتيجة المدّعاة مِن قبله، والتي فحواها استحالة فهم النصّ القرآني وعدم إمكانيّة تفسيره مِن قبل البشر، إلّا إذا اعتبرناه مِن تأليف وصياغة إنسان؟
خلاصة كلامه كما يلي: بما أنّ مخاطبي القرآن كانوا يعتقدون بأنّه كلام النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله، لذا فهو مِن تأليفه حقًّا، ولا يمكن اعتباره كلام الله.
وهنا نقول له: حتّى إذا افترضنا أنّ عامّة مخاطبي النبيّ، كانوا يعتقدون بأنّ آيات القرآن مِن تأليفه، فهل مِن الممكن الاستناد إلى اعقتادهم هذا وادّعاء أنّ القرآن حقًّا مِن كلام البشر وليس كلام الله؟ لا شكّ في وجود أسباب ودواع كثيرة وعوامل متنوّعة تحرم بعض الناس عن فهم الحقائق؛ لذا لا يمكن اعتبار رفض الأغلبيّة لأمرٍ ما دليلًا على حقّانية رفضهم وبطلان ما رفضوه.
من أقوال محمّد مجتهد شبستري ما يلي:
«حتّى إذا قال مدّعي النبوّة أنّ الألفاظ والعبارات التي يذكرها لقومه قد سمعها مِن غيره، ففي هذه الحالة لا يمكن طرح فهم وتفسير مشترك سوى بخصوص هذا الادّعاء ضمن مداليل عديدة».
يا ترى هل مِن المفترض أنْ يفهم مخاطبو النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله شيئًا آخر غير مضمون ما يسمعون منه؟! فما هو المتوقّع مِن الناس في فهم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ الذي تلاه عليهم النبيّ بعد نزوله بالوحي؟ هل يفهمون هذا الكلام، إذا كان مِن تأليف وصياغة النبيّ نفسه، ولا يفهمونه في غير هذه الحالة حسب رأي السيّد شبستري؟ وما هو المقصود مِن فهم هذا الكلام، وما هو المفهوم منه، وما هو مدلوله مِن الأساس؟ ألا يدلّ على التأكيد بأنّه ليس مِن تأليف وصياغة النبيّ لأنّه مجرّد ناقل له بصفته كلام الله؟
كذلك نقول لهذا الباحث: أنت تقول أنّ محمّدًا ادّعى النبوّة وتلا هذه الآيات على الناس: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ*فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ*ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ*ثُمَّ نَظَرَ*ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ*ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ*فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ*إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ*سَأُصْلِيهِ سَقَرَ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ*لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ*لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾،[1] ونحن نسألك هنا: ما الذي فهمه الناس مِن هذه الآيات؟ هل فهموا منها أنّها مِن تأليف وصياغة مدّعي النبوّة الذي جاءهم بها؟ وهل اعتبروه يتحدّث مِن تلقاء نفسه، وغاية ما في الأمر أنّه يذكر لهم تجاربه الشخصيّة مع أمر معنوي مقدّس أو شيء آخر على غراره؟ ويا ترى ما الذي سمعه الوليد بن المغيرة المخزومي ومَنْ لفّ لفّه مِن رسول الله حينما طلبوا منه دليلًا يثبت ادّعاءه النبوّة؟
لو أنّ الواقع كما يدّعي هذا الباحث بأنَّ عامّة مخاطبي النبيّ محمّد اعتبروا كلامه مِن تأليفه وصياغته بنفسه ويعكس فهمه الشخصي لعالم الوجود، ففي هذه الحالة ما السبب الذي دعاهم لأنْ يتعاملوا معه بالأسلوب الذي ذكرته لنا المصادر التاريخيّة المعتبرة؟ وما الأمر الذي دعا الوليد بن المغيرة لأنْ يتأمّل ويفكّر ويدّعي قائلًا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾؟! ألا يدّعي السيّد شبستري أنّ عامّة مخاطبي النبيّ كانوا يعتقدون بأنّ القرآن كلام بشر، وليس هناك مَن اعتقد بغير ذلك؟! ولماذا تكرّر قوله تعالى ﴿قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ مرّتين ردًّا على اتّهام القرآن بأنّه ﴿قَوْلُ الْبَشَرِ﴾؟! وكيف تمكّن هذا المعارض مِن طرح موضوع استند إليه لمحاربة الحقّ؟! وكيف استطاع أنْ يضع خطّةً شيطانيّةً لتحقيق غرضه؟!
السيّد شبستري أقرّ بأنّ مخاطبي النبيّ كانوا يفهمون كلامه، وعلى هذا الأساس نسأله: وضّح لنا كيف فهموا الآيات التي سنذكرها أدناه كنموذج فقط وليس على نحو الحصر؟ وكيف يمكن التنسيق بين فهمها وبين ادّعاء أنَّ النصّ القرآني مِن كلام البشر؟
الآيات كالآتي:
ـ ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ*نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ*عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ*بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾.
ـ ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾.
ـ ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ﴾.
ـ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ*إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ*فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾.
ـ ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ*إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.
ـ ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ*أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ*قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا
مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ*وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ*وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾.
أهمّ دليل استند إليه الباحث محمّد مجتهد شبستري لإثبات مدّعاه بأنَّ النصّ القرآني كلام بشر، وطرحه في كلّ مقالاته بأساليب وصور متنوّعة تسبّب الملل للقارئ أحيانًا، مغزاه ما يلي:
«القرآن عبارة عن نصّ لغويّ بشري، وكلّ نصّ لغوي حسب تجاربنا كبشر لا يؤلّف إلّا في رحاب بيئة عامّة تحكمها مشتركات تاريخيّة واجتماعيّة وفكريّة، حيث يكتسب معناه على هذا الأساس ثمّ يصبح (كلامًا) يمكن فهمه وتفسيره بشكل فكري مشترك.
إذا افترضنا حدوث معجزة وتمّ تأليف نصّ إعجازي مكوّن مِن ألفاظ وعبارات باللغة العربيّة أو بأيّة لغة أخرى، فهذا النصّ لا يمكن فهمه وتفسيره على نحو فكري مشترك».
بما أنّ هذا الكلام يعدّ أهمّ استدلال استند إليه هذا الباحث ضمن مختلف مدوّناته، فمِن الأنسب بيان مضمونه بشكل واضح ضمن قياس منطقي وذلك كما يلي:
أوّلًا: الهيكليّة الأولى للاستدلال
المقدّمة الأولى للاستدلال:«القرآن نصّ لغوي مِن صياغة إنسان».
المقدّمة الثانية للاستدلال:«اللغات الشائعة بين البشر تظهر في رحاب حياة دنيويّة مشتركة اجتماعيًّا وتاريخيًّا، ومتقوّمة على اشتراكات فكريّة، فعلى هذا الأساس تكتسب معانيها ويصبح مِن المقدور فهم وتفسير ألفاظها وعباراتها مِن قبل الجميع على ضوء نطاق فكري مشترك».
النتيجة: النصّ القرآني لا يمكن فهمه وتفسيره وفق رؤية فكريّة مشتركة، إلّا إذا كان مِن صياغة البشر وليس مِن عند الله، «وإذا افترضنا حدوث معجزة وتمّ تأليف نصّ إعجازي مكوّن مِن ألفاظ وعبارات باللغة العربيّة أو بأيّة لغة أخرى، فهذا النصّ لا يمكن فهمه وتفسيره على نحو فكري مشترك».
لا يوجد أيّ ارتباط بين مقدّمتي الاستدلال المذكور ونتيجته. وبيان ذلك كما يلي: ذكر السيّد مجتهد شبستري في المقدّمتين أنَّ لغة النصّ القرآني مِن سنخ اللغات المتداولة بين البشر، وهي ثمرة لحياة بشريّة تتقوّم على مشتركات تاريخيّة واجتماعيّة، لذا يكون مفهومًا لدى البشر وبالإمكان تفسيره؛ لأنّه ذو معاني ومداليل لغويّة متداولة بينهم.
(262)هذا الكلام صحيح ولا أحد ينكره، فضلًا عن ذلك ليس هناك مِن ينكر أنَّ القرآن نزل باللغة العربيّة وروعيت فيه كلّ قواعدها اللغويّة والبيانية بأروع أسلوب وأفضل شكل ممكن، لكنَّ النتيجة التي ذكرها الباحث بناءً على مقدّمتي الاستدلال ليست صحيحةً، بل لا ترتبط أصلًا بالموضوع؛ إذ ادّعى أنّ النصّ القرآني مِن تأليف وصياغة النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله.
يا ترى هل يمكن ادّعاء عدم قدرة أيّ كائن كان، حتّى إذا كان لديه شعور وإدراك، على استخدام اللغات الشائعة بين البشر بقصد وإرادة جادّة لمجرّد أنَّها لغات أوجدوها بأنفسهم؟! فهل يمكن ادّعاء أنّ خالقهم الذي علّمهم لغاتهم وأنطقهم بها غير قادر على الكلام بها؟!
ثانيًا: الهيكليّة الثانية للاستدلال
بإمكاننا مدّ يد العون للسيّد مجتهد شبستري وهيكلة كلامه ضمن إطار خاصّ يجعله في منأى عمّا فيه مِن خلط وأخطاء، وذلك كما يلي:
المقدّمة الأولى للاستدلال: فهم النصّ القرآني وتفسيره ميسّران لكلّ الناس، لذا يمكن فهمه في رحاب مشتركات فكريّة.
المقدّمة الثانية للاستدلال: كلّ نصّ لغويّ يمكن لجميع البشر فهمه وتفسيره إذا كان مِن صياغتهم أنفسهم.
النتيجة: النصّ القرآني مِن صياغة إنسانٍ وليس كلام الله.
ما يدعو للأسف أنَّ هيكلة الاستدلال التي ذكرناها كسندٍ لتأييد كلام السيّد مجتهد شبستري، لا يمكنها أيضًا إثبات مدّعاه؛ إذ غاية ما يمكن فعله إزاء ما
(263)
يدّعيه، هو صياغة البنية الاستدلاليّة لكلامه بأسلوب منطقي معتبر حسب أصول ومبادئ البحث العلمي القويم وهيكلته ووفق ما يقتضيه المدّعى الأوّل، إلّا أنَّ مادّته ـ مضمونه ومدلوله ـ عبارة عن ادّعاءات ليست مبرهنة؛ أي لا يوجد أيّ دليل يثبت صوابها، بل الأمر على العكس مِن ذلك؛ إذ توجد أدلّة واضحة وصريحة تفنّدها وتثبت ما يتعارض معها، وبيان ذلك كما يلي:
المقدّمة الأولى للاستدلال المذكور صحيحة ولا نقاش فيها، فكلّ إنسان لديه مصحف ـ حتّى إذا كانت معلوماته عن القرآن الكريم قليلة ـ يدرك أنَّ نصّه يمكن أنْ يفهم ويفسّر في رحاب أفكار مشتركة، بل حتّى أعداء الإسلام الذين ينكرون القرآن مِن أساسه يؤيّدون ذلك؛ لأنَّهم يعارضون نصًّا معانيه ومضامينه مفهومة. ولو افترضنا أنّهم اعتبروه غير مفهوم، فلا معنى حينئذٍ لأنْ يعارضوه؛ لأنّ تأييد أو مخالفة نصّ لغوي مرتبطان بما فيه مِن معان ومداليل ومفاهيم.
بناءً على ما ذكر، حتّى الملحدون يفهمون كلام القرآن الكريم رغم إنكارهم نسبته إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنّهم مِن الأساس كافرون بالله ولا يعتقدون بوجوده ـ أي إنّ الموضوع بالنسبة إليه على نحو القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع حسب القواعد المنطقيّةـ وبالتالي ليس لديهم أدنى اعتقاد بهدايته، ومِن البدهي أنّ نتيجة ذلك، هي عدم إيمانهم بالوحي والكلام المنزل على النبيّ صلىاللهعليهوآله. لذا، هذا المستوى مِن فهم مضمون النصّ القرآني لا يرتبط مطلقًا بمسألة الإيمان بمن نطقه، فالأمر هنا سيّان بين المسلمين وغيرهم باعتباره مجرّد فهم للنصّ؛ لأنّ القرآن الكريم مِن هذه الناحية، حاله حال
(264)سائر النصوص التي يفهمها الناس حسب قابليّاتهم اللغويّة، بغضّ النظر عمّن ألّفها؛ أي إنَّ فهم مضامينها لا صلة له بوجود أو عدم وجود مؤلّفها، وغير مرتبط بإنكاره أو الاعتقاد به.
النقاش هنا يتمحور بشكل أساسي حول المقدّمة الثانية للاستدلال المذكور، فيا ترى ما السبب في ادّعاء أنّ البشر لا يفهمون سوى كلامهم؟ أي لا يفهمون إلّا النصوص اللغويّة التي يصوغونها بأنفسهم؟
السيّد مجتهد شبستري ادّعى مرارًا وتكرارًا وفي مناسبات عديدة، أنّ كلّ نصّ لغوي يمكن لجميع البشر فهمه وتفسيره إذا كان مِن صياغتهم أنفسهم فقط، لكنّه عجز عن إقامة حتّى دليل واحدٍ لإثبات هذا الادّعاء. لذا، هو مرفوض عندنا، إلّا إذا تمكّن مِن إثباته بالدليل، بحيث يبرهن لنا على ما يلي: لو نطقت الكائنات التي تمتلك شعورًا وإدراكًاـ مثل الجنّ والملائكةـ بلغة البشر، لا يمكننا فهم كلامها مطلقًا، حتّى إذا تحدّثت بذات ألفاظنا وعباراتنا اللغويّة.
كذلك يجب أنْ يثبت لنا أنّ الإنسان يمتاز بخصائص تؤهّله لأنْ يفهم ما ينطقه أقرانه البشر مِن ألفاظ وعبارات فقط؛ أي إنّ بني آدم يفهمون كلام بعضهم فقط وما يصوغونه لغويًّا بأنفسهم، لكنّهم لا يفهمون أيّ كلام سوى ذلك، حتّى إذا كان متطابقًا مع قواعدهم اللغويّة. وعلى هذا الأساس، يجب عليه إثبات أنّ هذه الخصائص الإنسانيّة، تجعل البشر عاجزين عن فهم كلام الله إذا وجّه لهم.
وهناك سؤال يطرح عليه في هذا المضمار، هو كالآتي: أنت تدّعي أنَّ البشر عاجزون عن فهم كلام الله إذا وجّه لهم، فهل تعتقد بأنّه قادر على الكلام؟
فإذا كنت تعتقد بذلك، ما هي الميزة أو الميّزات التي يتّصف بها كلامه بحيث يعجز البشر عن فهمه؟ وما السبب في عدم توجيه كلامه لعباده على نحوٍ يكون مفهومًا عندهم؟ الله الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم ومنحه منظومة إدراك وتفاهم ونطق، هل يمكن ادّعاء أنّه عاجز عن ذكر كلام يمكن لمخلوقه هذا فهمه وتفسيره؟
هذه الأسئلة ترِد على مدّعى السيّد شبستري، بحيث لا يمكنه بتاتًا إثباته ما لم يجب عنها إجابات شافية ووافية تقنع مَنْ يطرحها عليه.
فضلًا عمّا ذكر أعلاه، فقد ادّعى محمّد مجتهد شبستري ما يلي: اللغات البشريّة لا تنشأ إلّا في رحاب بيئة عامّة تحكمها مشتركات تاريخيّة واجتماعيّة وفكريّة، حيث تكتسب ألفاظها وعباراتها المعاني المقصودة منها على هذا الأساس، ثمّ تصبح (كلامًا) يمكن فهمه وتفسيره على نحوٍ فكري مشترك.
يا ترى كيف يمكن تفنيد صدور ألفاظ القرآن الكريم وعباراته مِن قبل الله عزّ وجلّ؟ فما هي الأسس التي اعتمد عليها السيّد شبستري في هذا الرأي؟ هل دليله هو أنَّ نشأة لغة الإنسان في هذا العالم هي السبب في كونها مفهومة، وبالتالي لا يمكن لأيّ كائن ذي شعور وإدراك ـ حتّى الله تعالى ربّ الكون والكائنات ـ أنْ يستخدمها أو يتكلّم بها؟ ولو افترضنا أنَّ الله تعالى نقل رسالته إلى البشر في إطار ألفاظ وعبارات لغويّة مِن لغتهم ذاتها التي ينطقون بها، فهل في هذه الحالة يمكن ادّعاء أنّهم لا يفهمون ما يقول؟ فهل يمكن ادّعاء أنّ مِن لغته الأمّ الإنجليزيّة غير قادر على النطق باللغة الفارسيّة أو فهم ألفاظها
(266)وعباراتها لمجرّد أنّهم عاشوا في بيئة تحكمها مشتركات تاريخيّة واجتماعيّة وفكريّة فارسيّة، وهو بدوره عاش في بيئة تحكمها مشتركات تاريخيّة واجتماعيّة وفكرية إنجليزيّة؟ ولو افترضنا أنّ معجزةً حدثت وتمكّن إنسان ينطق باللغة الإنجليزيّة مِن صياغة عدّة ألفاظ وعبارات فارسيّة دالّة رغم أنّه لم يعش في بيئة فارسيّة، فهل يمكن حينئذٍ ادّعاء أنّ الناطقين بالفارسيّة لا يفهمون مداليلها؟
الجدير بالذكر هنا، أنَّ ما يلزم في نشأة إحدى اللغات ثمّ فهمها حسب قواعدها اللغويّة، هو مجرّد علم المتكلّم بقواعدها وقصده في نقل معانيها عن طريق الكلام، ولا ضرورة لوجود شيء آخر مثل المشتركات التاريخيّة والاجتماعيّة والفكريّة وغيرها؛ لأنّ الكلام يحكي عن المقصود بغضّ النظر عن الاعتبارات الأخرى، وكذا هو حال السيّد مجتهد شبستري بنفسه؛ إذ على الرغم مِن أنّه لم يمضِ حياته في مجتمع ينطق أبناؤه باللغة الفارسيّة، ولم ينشأ في رحاب مشتركات تاريخيّة واجتماعيّة وفكريّة فارسيّة، لكنّه يستخدم هذه اللغة ويسعى إلى بيان مراده ومقاصده، اعتمادًا على ألفاظها وعباراتها، مراعيًا في ذلك قواعدها وأصولها اللغويّة.
لربّما يمكن استكشاف أدلّة نثبت المقدّمة الثانية مِن استدلاله على أساسها فيما لو استقصينا كلامه ومدوّناته. وهذه المقدّمةـ كما ذكرنا آنفًا ـ كالآتي: كلّ نصّ لغوي لا يمكن فهمه وتفسيره مِن قبل الجميع، إلّا إذا كان مِن صياغة بشر.
وضمن إحدى مقالاته تطرّق إلى تحليل معنى «الفهم»، وفي هذا السياق ذكر سبعة أنواع له بهدف إثبات أنَّ حصوله متوقّف على أنَّ النصّ أو الكلام
لا يمكن أنْ يفهم مِن قبل البشر، إلّا إذا كان مِن صياغتهم أنفسهم فقط؛ إذ لا يمكنهم فهم كلام غير البشر على الإطلاق.
بعد أنْ ذكر المعاني السبعة للفهم، ادّعى قائلًا:
«النصّ القرآني (المصحف الشريف) لا يمكن أنْ يكون مفهومًا وفق أيّ معنى مِن معاني الفهم... إلّا إذا افترضنا أنّ قائله أو كاتبه إنسان».
نرى مِن الأنسب هنا تحليل المعاني السبعة للفهم وفق رؤية هذا الباحث؛ كي نرى هل حقًّا تدلّ برمّتها على أنّ فهم النصّ اللغوي مشروط بأنْ يكون قائله إنسانًا، بحيث لا يمكن فهم أيّ نصّ لغويّ إذا كان قائله كائنًا ذا شعور وإدراك مِن غير البشر.
على سبيل المثال، هل يمكن ادّعاء أنَّ فهم عبارة ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ متوقّف على كونها مِن تأليف وصياغة إنسانٍ؟ إذا افترضنا أنّها مِن كلام الله تعالى أو أيّ كائن ذي شعور وإدراك ـ مِن غير البشرـ فهل في هذه الحالة يستحيل علينا فهمها؟
الحقيقة أنَّ فهم معنى إحدى الجمل، يتوقّف فقط على معرفة قواعدها الأدبيّة واللغويّة؛ أي بما فيها مِن ألفاظ ومداليل. لذا، فهمها ممكن بغضّ النظر عن قائلها، سواء عرفناه أم لم نعرفه. مثلًا لو شاهد شخص نصًّا مكتوبًا في
صحراء ولا يعرف مَن الذي كتبه وما هدفه مِن وراء ذلك وما المعنى الذي قصده والظروف الزمانيّة والمكانيّة والفكريّة التي جعلته يفعل ذلك، فهذا الشخص بإمكانه فهم ألفاظ النصّ وعباراته إذا كان عارفًا باللغة التي دوّن بها.
فهم الكلام مِن حيث بنيته الذاتيّة مشروط بمعرفة القواعد اللغويّة والأدبيّة التي صيغ في رحابها. لكنْ، هل يمكن ادّعاء أنّ فهمًا كهذا مشروط بكون النصّ اللغوي مِن صياغة بشر؟
لا شكّ في ضرورة مراعاة القواعد اللغويّة والأدبيّة في كلّ نصّ وإلمام قائله أو كاتبه بها كي يتمكّن مِن تسخيرها بشكل أنسب لبيان مقاصده. لكنْ، هل هناك سبب وجيه يفترض على أساسه وجوب كون صاحب النصّ إنسانًا لا غير؟!
المقصود مِن هذا الفهم هو أنَّ القارئ أو المستمع يجب أنْ يفهم مَنِ الذي نطق بالنصّ أو كتبه، وما الذي قصده في تلك الظروف الخاصّة، كذلك ينبغي أنْ يدرك واقع الظروف الراهنة التي يتمحور كلام صاحب النصّ حولها.
إذاً، هل يمكن ادّعاء أنّ هذا الفهم لا يمكن أنْ يتحقّق إلّا إذا كان النصّ اللغوي ـ المنطوق أو المدوّن ـ مِن صياغة إنسانٍ فقط؟! فلو كان صاحب النصّ الله سبحانه وتعالى، هل يمكن القول حينئذٍ إنّنا عاجزون عن فهم كلامه؟!
موضوع الفهم في هذه الحالة هو فعل الفاعل الذي يحدث على ضوء مداليل
(269)لغويّةـ أي فعل قائل النصّ ـ وإلى جانب اشتراط معرفة الظروف الحاليّة التي ترتبط بها الجملة، مشروط أيضًا بمعرفة خصائص كلٍّ مِن المتكلّم والسامع. لكنْ، هل يمكن ادّعاء أنّ فهمًا كهذا متوقّف على أنْ يكون الفعل الكلامي صادرًا مِن إنسان فحسب؟ فهل هذا النوع مِن الفهم لا يمكن أنْ يتحقّق إذا كان الكلام صادرًا مِن غير البشر؟ ولو افترضنا أنّ الفعل الكلامي صادر مِن الله تعالى، فهل يمكن ادّعاء أنّنا عاجزون عن فهم كلامه حسب مدلول هذا الفعل؟
ما يلزم في هذا النوع مِن الفهم هو فهم خصائص الفاعل؛ أي صاحب الفعل اللغوي، لكنْ هل هناك سبب وجيه يدعونا لاشتراط أنْ يكون إنسانًا فقط؟!
السيّد مجتهد شبستري ادّعى ما يلي: عندما نفهم نصًّا لغويًّا بمثابته دالًا على حالة نفسيّة، ففهمُنا هذا مرهون بأنَّ قائل النصّ أو كاتبه شخص يمتاز بحالة نفسيّة خاصّة.
نحن أيضًا نؤيّد هذا الكلام، لكنّنا ننزّه كلام الله مِن كلّ نقص وضعف وخلل، بحيث ننسب إليه معناه الخالص مِن منطلق اعتقادنا بأنّ أوامره تبارك شأنه وصلتنا في رحاب جمل وعبارات تحكي عن نزاهته وعظمته. وهذا يعني أنّه يؤيّد كلّ موضوع تمحورت أوامره حوله ويشعر بالرضا ممّن يمتثل لها، وفي الحين ذاته لا يؤيّد كلّ موضوع تمحورت نواهيه حوله ويشعر بالسخط ممّن لا يتورّع عنها. وعلى هذا الأساس، يحبّ المحسنين والمتّقين والصابرين والصادقين والمتوكّلين والعادلين، ولا يحبّ المعتدين والفاسدين والكافرين والمسرفين وأمثالهم.
(270)الجدير بالذكر هنا، أنّ رضا الله تعالى وسخطه لا يمكن تشبيهه برضا البشر وسخطهم؛ لأنّهم كائنات ممكنة الوجود، وتعاني بكلّ وجودها مِن نقص وضعف، بينما البارئ تبارك شأنه كامل مطلق لا وجود لأيّ ضعف ونقص في ذاته المقدّسة.
إذاً، هذا المعنى مِن الفهم لا يتلازم مع ضرورة أنْ يكون النصّ اللغوي مِن صياغة البشر.
هذا الفهم يتحقّق على ضوء تأمّل جادّ وعميق في النصّ اللغوي، لكنْ هل يمكن ادّعاء أنَّ تحقّقه متوقّف على أنَّ قائل النصّ إنسان؟ فإذا اعتبرنا الله تعالى بأنّه قائل النصّ، ألا يمكن حينئذٍ امتلاك فهم عميق ودقيق بخصوصه، أو أنَّ الأمر على العكس مِن ذلك؛ أي إنّ المفسّر يراوده هاجس جادّ لامتلاك فهم عميق ودقيق بخصوص النصّ القرآني عندما يكون متأكّدًا مِن أنّه كلام الله الحكيم العالم القادر على كلّ شيء؟
مجتهد شبستري عرّف هذا النوع مِن الفهم كما يلي: «اتّحاد شخصين في أفق فكري مشترك».
لو كان المقصود مِن فهم النصّ اللغويّ هذا النوع مِن الاتّحاد، ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيقه على كلام الله؛ لأنّه ليس مِن كلام البشر كي يمكن تصوّر وجود اتّحاد فكري بين شخصين، فهذا النوع مِن الفهم مشروط بأنْ يكون قائله إنسانًا.
(271)الجدير بالذكر هنا، أنّ هذا الرأي مجرّد ادّعاء بلا دليل، فالشرط الأساسي لتحقّق فهم مشترك، هو وجود توافق بين المتكلّم والسامع، ولا يشترط أنْ يكونا بمستوى واحد أو كلاهما مِن البشر، فكما أنّ الوالد له القدرة على أنْ يتحدّث مع ابنه بأسلوب يتناسب مع مستوى فهمه وإدراكه وعلى أساس فهم مشترك بينهما، وكما يمكن للخبير أنْ يتحدّث مع مَنْ لا خبرة لديه بهذا الأسلوب أيضًا، كذلك غير الإنسان بإمكانه أنْ يتحدّث هكذا مع الإنسان على ضوء مراعاة فهمه وإدراكه. وعلى هذا الأساس، يمكن تنزيل المستوى اللغويّ للنصّ القرآني بالتناسب مع مستوى فهم الإنسان.
تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة سعي المخاطب لفهم مقصود المتكلّم، وليس مِن الصواب فرض رأيه عليه؛ أي لا ينبغي تفسير كلام الله وفق توجّهات ورغبات نفسيّة، مِن دون فهم مراده الحقيقي والمداليل الواقعيّة التي تستبطنها ألفاظ كلامه وعباراته، ولربّما هذا هو أحد أسباب رفض تفسير القرآن بالرأي. المطلوب منّا هو السعي لمعرفة المعنى الحقيقي للنصّ اللغوي الذي قصده قائله قدر المستطاع لأجل معرفة مراد الله تبارك وتعالى. وفهمٌ كهذا لا يتعارض بتاتًا مع اعتبار النصّ القرآني بأنّه كلام الله.
إلى هنا اتّضح لنا أنَّ هذا النوع مِن الاستدلال، يعتبر أيضًا مِن سنخ مغالطة الدليل غير المرتبط بموضوع الاستدلال.
وخلاصة الكلام، هي أنّ كلّ فهمٍ لكلام شفوي أو نصّ مدوّن وهذا الفهم بأيّ نحوٍ كان ـ يتوقّف على أنْ يكون المذكور بالقول أو الكتابة صادرًا مِن متكلّم أو كاتب، لكنْ مجرّد هذا الشرط لا يُعدّ وازعًا لادّعاء أنَّ مؤلّف النصّ يجب أنْ يكون إنسانًا لا غير بزعم أنّه لو لم يكن إنسانًا لا يمكن فهم مضمونه؛ فهذا دليل أعمّ مِن المدّعى حسب تعبير الفلاسفة.
السيّد مجتهد شبستري ادّعى أنَّ النصّ القرآني لو كان «كلام الله» حقًّا لعجز البشر عن فهمه، لكنّه لم يذكر دليلًا مقنعًا على ادّعائه هذا، بل الدليل الذي استند إليه، مضمونه أنّ فهم معنى الكلام مشروط بوجود «متكلّم» ذكره! فهل هذا دليل على الموضوع حقًّا؟! قطعًا لا.
هناك مسألة أخرى أضافها إلى كلامه، وهي ما يلي: بما أنَّ الأنواع السبعة مِن الفهم ـ التي أشير إليها أعلاه ـ كلّها تحكي عن حالات تجريبيّة، لذا مِن الواجب اشتراط فيمن يصوغ النصوص اللغويّة شفويًّا أو كتابيًّا أنْ يكون كائنًا تجريبيًّا يمتلك عقلًا بشريًّا.
بطلان هذا الاستدلال أوضح مِن أنْ نتطرّق إلى إثباته بشرح وتحليل، لكنْ نكتفي بتشبيهه بقول مَنْ يقول: بما أنَّ المصنوعات التي ينتجها النجّار كلّها مِن الخشب، لذلك يجب أنْ يكون النجّار نفسه مِن خشب! أو مَنْ يقول: بما أنَّ جميع مكوّنات عالم المادّة ملموسة ومحسوسة وخاضعة للتجربة، لذا لا بدّ وأنْ يكون خالقها ـ الله عزّ وجلّ ـ ملموسًا ومحسوسًا وخاضعًا للتجربة.
الدليل الآخر الذي ذكره محمّد مجتهد شبستري لإثبات أنَّ النصّ القرآني مِن تأليف إنسان، مضمونه ما يلي: اللغة عبارة عن اتّفاق بين أبناء اللغة الواحدة، وهذا الاتّفاق لا يمكن أنْ يحدث إلّا بين البشر فقط، لذا لا معنى لأيّ لفظ أو عبارة لغويّة، إلّا إذا كان صدورهما مِن لسان إنسان.
نلاحظ مِن استدلاله أنّ الألفاظ والعبارات عبارة عن علامات تدلّ على وجود اتّفاق بين أبناء اللغة الواحدة كي يتمكّنوا على أساسها مِن إيجاد ارتباط جماعي فيما بينهم وتبادل المعاني والمداليل المقصودة. لذا، تختلف هذه العلامات الدلاليّة مِن لغة إلى أخرى، وهذا الاختلاف بحدّ ذاته دليل على أنَّها قد وضعت باتّفاق جماعي.
ثمّ قرّر استدلاله قائلًا:
«دلالة كلّ لفظ على مدلوله أساسها الاتّفاق الذي حصل بين البشر عليها ضمن حياتهم الاجتماعيّة والتاريخيّة، لذا ما لم يعرف البشر تفاصيل هذا الاتّفاق اللغويّ والمداليل التي تترتّب عليه لا يمكنهم معرفة المعاني اللغويّة للألفاظ والعبارات؛ إذ ليس مِن الممكن بتاتًا ادّعاء أنَّ مجرّد استعمالها دالٌّ على معان محدّدة». وبعد أنْ وضّح هذا الموضوع واصل كلامه قائلًا: «هنا مسألة في غاية الأهميّة ينبغي لنا معرفتها، وهي أنّ العلامات الموجودة في لغة البشر، لا يمكن أنْ تعتبر علامات لغوية دالّة على معان محدّدة إلّا إذا استخدمت فيما تمّ الاتّفاق عليه لغويًّا. لذا، لو خرجت مِن فم حيوانٍ، فلا معنى لها حينئذٍ، ومِن ثمّ لا تعتبر علامات لغويّة، مثل الببغاء التي تقول على
(274)سبيل المثال (السلام عليكم)؛ إذ لا أحد يعتبر هذا الصوت الذي يخرج مِن فم طيرٍ بأنّه كلام ذو معنى، وبالتالي لا يراه سلامًا حقيقيًّا؛ لكونه عاريًا مِن جميع أنواع الأفعال اللغويّة المتعارفة بين البشر ولا تترتّب عليه أيّة آثار إنسانيّة، بل يبقى مجرّد صوت مسموع لا غير».
ـ هل المقصود لغة متّفق عليها أو اتّفاق لغويّ؟
ذكر العديد مِن الآراء بخصوص دلالة الألفاظ على المعاني مِن حيث أنَّ هذه الدلالة متّفق عليها أو لا، لكنْ لا يسعنا المجال إلى تسليط الضوء عليها وبيان تفاصيلها؛ لأنّها بحاجة إلى دراسة مستقلّة. لذا، نكتفي هنا بتقييم رأي السيّد مجتهد شبستري.
حتّى إذا افترضنا أنَّ دلالة الألفاظ على المعاني أمر متّفق عليه بين أبناء اللغة الواحدة، لكنْ هل يصحّ لنا ادّعاء أنّ هذه الدلالة متوقّفة على أنْ يكون الناطق بإحدى اللغات قد شارك في الاتّفاق الذي حصل بهذا الخصوص، أو يكفيه في ذلك الإلمام بقواعدها فقط؟ أي إنّ مَنْ لم يشارك في المراحل الأولى مِن نشأة اللغة التي يتحدّث بها، لكنّه يعلم بكلّ العلامات اللغويّة الدالّةـ يعرف معاني الألفاظ والعبارات ـ وكلّ ملحقاتها ومقتضياتها وقواعدها المتعارفة بين الناطقين بها، بحيث يستطيع استخدامها لبيان مقاصده حين الكلام؛ هل يمكن ادّعاء أنّ إلمامه التامّ هذا، لا يعدّ كافيًا كي نفهم كلامه لأنّه لم يشارك في وضع اللغة؟ على سبيل المثال، مَنْ لم يشارك في وضع معاني
اللغة العربيّة، لكنّه تعلّمها وأتقنها بالكامل، بحيث يتحدّث مع الناطقين بها دون أيّة مشكلة، هل يمكن تصوّر أنّ كلامه غير مفهوم لديهم؟ مِن البدهي أنّ المشاركة في الاتّفاق اللغويّ، لا يعدّ شرطًا لفهم كلام الناطق باللغة، بل ما يلزم في فهم كلامه، هو علمه بما تمّ الاتّفاق عليه وبيان قصده على أساس المداليل اللغويّة لهذا الاتّفاق.
يا ترى لو افترضنا أنّ أحد الكائنات ذات الشعور والإرادة والقصد مثل الجنّ والملائكة، ألقى التحيّة على الإنسان وقال له «السلام عليكم»، هل يمكن ادّعاء أنّ كلامه عديم المعنى أو غير مفهوم مِن قبل هذا الإنسان؟ أي هل يصحّ هنا ادّعاء السيّد مجتهد شبستري حينما قال: «لا أحد يعتبر الصوت المسموع كلامًا، لذا لا يمكن اعتبار هذه التحيّة سلامًا»؟.
نذكر مثالًا فيما يلي لبيان الموضوع: عندما دخل الملائكة على النبيّ إبراهيم عليهالسلام وألقوا التحيّة عليه، استقبلهم وردّ التحيّة عليهم، فيا ترى هل يمكن اعتبار كلامه هنا ـ ردّ التحية ـ لغوًا؟ لو كان يعلم أنّهم ليسوا بشرًا مِن البداية، هل كان يتجاهل سلامهم لمّا سمعه، ويعتبره مجرّد صوتٍ لا معنى ولا مفهوم له؟ كذلك هل يمكن ادّعاء أنّ البشرى التي جاؤوه بها لم يعرفها لأنّه لا يفهم كلامهم حينما قالوا له: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾؟
ربّما يبرّر السيّد شبستري رأيه في هذا المضمار قائلًا: بما أنَّ النبيّ إبراهيم عليهالسلام تصوّر أنّهم بشر لذلك اعتبر سلامهم كلامًا حقيقيًّا. وعلى هذا الأساس،
ذهب مسرعًا وذبح لهم عجلًا كي يأكلوه. لكنْ، لو كان يعلم منذ بادئ الأمر أنّهم ليسوا بشرًا حقيقيين وقد تظاهروا بذلك، لَمَا تصوّر مطلقًا أنّ سلامهم حقيقي، فعندما شاهد أنّهم لا يمدّون أيديهم لتناول الطعام، شعر بخيفةٍ ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً...﴾.
هذا التبرير غير صائب قطعًا بدليل ما حدث بعد ذلك، فهؤلاء الضيوف قالوا للنبيّ إبراهيم عليهالسلام بعد أنْ أوجس منهم خيفةً: ﴿...قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾. في هذه المرحلة مِن الحوار الذي جرى بين الطرفين، علم النبيّ إبراهيم عليهالسلام أنَّ ضيوفه ليسوا بشرًا، وعلى هذا الأساس أصبح لديه يقين أنّ كلامهم الذي يسمعه، ليس كلام بشرٍ، لكنّه بالألفاظ والعبارات المتداولة ذاتها بين قومه. بينما السيّد مجتهد شبستري، ادّعى أنّ دلالة العلامات اللغويّة مشروطة بأنْ يكون المتكلّم إنسانًا؛ أي يجب أنْ تخرج الألفاظ والعبارات مِن فم إنسان أو تكتب بقلمه كي تصبح ذات مداليل مفهومة ومعتبرة، ولا اعتبار لها مطلقًا لو صدرت مِن إنسانٍ آلي أو أيّ كائن آخر. بناءً على هذا الادّعاء، يجب الإذعان إلى أنَّ النبيّ إبراهيم عليهالسلام لم يتأثّر مطلقًا بما قال له ضيوفه الذين لم يكونوا مِن البشر؛ أي «لما تداعى في ذهنه أيّ معنى ممّا سمع مِن أصواتٍ لكون الناطق ليس إنسانًا» حسب ادّعاء هذا الباحث. في حين أنّ الواقع على خلاف هذا المدّعى، فقد راح يحاورهم وأراد أنْ يتوسّط لقوم النبيّ لوط عليهالسلام ويؤخّر نزول العذاب عليهم كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾.
فضلًا عن النبيّ إبراهيم عليهالسلام ، شهدت زوجته أيضًا ما حدث وحسب التعبير القرآني «فضحكت» عندما بشّرها الضيوف ـ الملائكة ـ بولد اسمه إسحاق:﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾، فقد تعجّبت مِن هذه البشارة وتكلّمت معهم وهي متعجّبة؛ لأنّها وزوجها شيخان فكيف يمكن أنْ ينجبا؟! لذلك أجابتها الملائكة: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾.
إذاً، لو أخذنا ادّعاء السيّد شبستري بعين الاعتبار، وقيّمنا هذه القصّة القرآنيّة وِفقه، فالنتيجة الحتميّة هي أنَّ سلوك النبيّ إبراهيم عليهالسلام وزوجته لم يكن عقليًّا على الإطلاق؛ إذ كان مِن الواجب عليهما أنْ لا يرتّبا أيّ أثر على ما سمعاه مِن «أصوات»؛ لأنَّ هذه الأصوات، رغم كونها ذات ألفاظ وعبارات تشابه ما هو متعارف في لغتهما، لكنْ بما أنّ مَنْ نطقها ليس إنسانًا، لذا لا يمكن اعتبارها ذات مداليل تحكي عن مقاصد حقيقيّة متّفق عليها لغويًّا.
هنا نطرح سؤالًا على هذا الباحث: حتّى إذا قبلنا بأنَّ النصّ القرآني مِن تأليف وصياغة النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله كما تدّعي، هل يمكن اعتبار إنسانيّة هذا النصّ دليلًا على استحالة تكلّم سائر الكائنات مثل الملائكة مع الإنسان؟ وهل هناك شروط خاصّة في الكلام لا تتوفّر لدى الملائكة بحيث تجعلها عاجزة عن أنْ تتكلّم مع البشر؟ أو هل الإنسان مقيّد بأمور تجعله عاجزًا عن فهم كلام الملائكة أو سائر الكائنات الماورائيّة حتّى إذا نطقت بلغته؟ إذا ادّعيت ذلك،
نسألك أيضًا: لماذا لم يعترض مخاطبو النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله حينما تلا عليهم القرآن ولم يقولوا له أحداث هذه القصص مستحيلة وهي مِن نسج الخيال؟ فهل للملائكة القدرة على النطق؟ ولو نطقت، هل يمكن للإنسان فهم كلامها؟!
السيّد مجتهد شبستري استند إلى نظريّة الفيلسوف الألماني ألبرت كيلر، وادّعى أنّ اللغة عبارة عن منظومة بيانات صاغها البشر أنفسهم ثمّ تطوّرت مع مرور الوقت، وقوامها خمسة أركان هي كالآتي:
الركن الأوّل: المتكلّم الذي تصدر منه الألفاظ والعبارات اللغويّة.
الركن الثاني: المستمع الذي توجّه إليه الألفاظ والعبارات اللغويّة.
الركن الثالث: النصّ اللغوي الذي تدرج فيه الألفاظ والعبارات اللغويّة.
الركن الرابع: أهل اللغة الذين تكون الألفاظ والعبارات اللغويّة وسيلة تفاهم بينهم.
الركن الخامس: المضمون الذي تدلّ عليه الألفاظ والعبارات اللغويّة.
استنتج مِن هذه النظريّة أنَّ الإنسان لو استخدم الألفاظ والعبارات اللغويّة وقال للناس إنّه مجرّد ناقلٍ لها وقائلها ليس إنسانًا، ففي هذه الحالة ليست في كلامه أيّة دلالة تصديقيّة ولا يمكن لأيّ مستمع أنْ يفهم منها مدلولًا معيّنًا؛ لأنّ الكلام لا يكون مفهومًا ودالًا إلّا إذا صدر مِن إنسان؛ أي لا بدّ وأنْ يصاغ مِن كائن ذي عقل اسمه «إنسان»، لذا لو صدر مِن غيره، لا يمكن اعتباره حينئذٍ كلامًا حقيقيًّا حسب رأيه، فقد قال:
«... جملًا كهذه ـ ولا يمكن اعتبارها جملًا مِن الأساس ـ ليس بمقدور أحدٍ فهمها وتفسيرها وتحليل مضمونها، بل لا يمكن قراءة الخطاب الموجّه فيها بأيّ نحو كان، فهي مفتقدة لشرطين أساسيين، أحدهما أنّها لم تصدر مِن لسان بشر، والثاني افتقارها للأركان اللغويّة الخمسة التي لا تتحقّق المداليل اللغويّة إلّا مع تحقّقها كما ذكرنا آنفًا؛ لذا لو صدرت باللغة العربيّة على سبيل المثال، ليس مِن الصواب اعتبارها جملًا عربيّةً دالّةً».
فيما يلي نوضّح هذا الاستدلال ضمن التحليل الآتي وفق قواعد علم المنطق:
المقدّمة الأولى: أركان الكلام خمسة، هي: المتكلّم، المستمع، النصّ، أهل اللغة، المضمون.
المقدّمة الثانية: تحقّق هذه الأركان مشروط بصدور الكلام مِن إنسان، وكلّ كلام يصدر مِن غير البشر، لا يمكن أنْ يتحقّق فيه أيّ واحد منها، لذا لا يمكن اعتباره كلامًا مِن الأساس، بل هو مجرّد أصوات.
النتيجة: إذا اعتبرنا الله تعالى بأنّه مؤلّف النصّ القرآني، ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار ألفاظه وعباراته كلامًا.
هذا الاستدلال مِن سنخ المصادرة على المطلوب، فلو قيّدنا الكلام بالألفاظ والعبارات التي يجب أنْ تصدر مِن متكلّم ذي عقل اسمه «إنسان»، ففي هذه
الحالة يبطل المدّعى بكلّ تأكيد؛ إذ ليس هناك أيّ دليل وجيه يثبت وجود اتّفاق لغويّ بهذا الشكل.
يا ترى ما الدليل على وجوب أنْ يكون المتكلّم إنسانًا صاحب عقل لا غير؟ طبعًا بإمكان كلّ شخصٍ طرح تعريفٍ للغة وادّعاء وجود أيّ نوع مِن الاتّفاق اللغويّ بين البشر، لكنْ يجب عليه قبل كلّ شيء أنْ يطرح رأيه وفق أسس معقولة ومقبولة؛ أي ينبغي له إثبات أنَّ الاتّفاق اللغويّ الذي طرحه مؤيّد مِن قبل العقل، ومِن المؤكّد بطلان هذا الاتّفاق إذا كان مِن سنخ المصادرة على المطلوب ثمّ تنزيله منزلة الدليل.
كيف استنتج السيّد مجتهد شبستري مِن كلام الفيلسوف الألماني ألبرت كيلر على أنّ الكلام لا يعتبر كلامًا حقيقيًّا إلّا إذا صدر مِن كائن ذي عقل اسمه «إنسان» لا غير؟ وحتّى لو تنزّلنا وافترضنا أنّه يدلّ على هذا المضمون، فهل هناك دليل معتبر يدلّ على أنّ المتكلّم إذا لم يكن إنسانًا لا يمكن اعتبار ما قاله كلامًا، ومِن ثمّ لا يمكن فهمه وتفسيره مطلقًا؟ ما السبب في ادّعاء أنّ الكلام الحقيقي قوامه أنْ يكون قائله إنسانًا، وفي غير هذه الحالة لا دلالة له؟ يا ترى لو كان المتكلّم كائنًا مِن غير البشر لكنّه متقن للقواعد اللغويّة ولديه إرادة وقصد إزاء ما يقول، هل هناك مسوّغ لاعتبار كلامه عبثيًّا ومجرّد أصوات لا مدلول لها؟!
ذكرت العديد مِن الآراء بخصوص قوام الكلام، فبعض علماء اللغة اعتبروه متقوّمًا مِن أساسه على «دالّه»، سواء كان بألفاظ أو بعلامات لغويّة أخرى
(281)ذات دلالات معيّنة، وفي هذا السياق أكّدوا على عدم اشتراط علم المتكلّم بالوضع اللغويّ، لذا حتّى إذا صدر صوت «دالّ» على معنى مِن حجر أو حركة تيّار ماء نهر أو احتكاك أغصان الشجر، فالكلام يتحقّق هنا.
وذهب آخرون إلى أنّ قوامه علم المتكلّم بالوضع؛ أي إنَّ هذا العلم برأيهم شرط لتحقّق الكلام، واشترط غيره قصد المتكلّم وإرادته. وعلى هذا الأساس، تصبح الألفاظ والعبارات اللغويّة كلامًا إذا صدرت مِن فاعل مريد، سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو مِن الجنّ أو سائر الكائنات التي تمتلك إرادةً؛ بينما ادّعى آخرون أنّ الكلام الحقيقي مشروط بكون قائله إنسانًا فقط ولا صدق لغيره.
خلاصة الكلام هي عدم وجود نظريّة عامّة وشاملة متّفق عليها مِن قبل علماء اللغة كافّة بهذا الخصوص. لكن، بشكل عامّ يمكن القول بضرس قاطع إنَّ أضعف نظريّة وأكثرها عرضةً للخدش والمؤاخذات، هي النظريّة الأخيرةـ اشتراط أنْ يكون المتكلّم إنسانًاـ والتي تبنّاها السيّد مجتهد شبستري ونسبها إلى الفيلسوف ألبرت كيلر بحيث بنى استدلاله عليها.
ولنقدها نقول: لو نقل لنا شخصٌ كلام شخصٍ آخر مؤكّدًا على أنّه لم يذكر سوى ما سمعه بحيث لم يحذف ولم يضف إليه حتّى كلمة واحدة، فهل مِن الصواب ادّعاء أنّنا لا يمكن أنْ نفهم كلامه لأنّه مجرّد ناقل؟ مِن البدهي أنّنا نفهم ما ذكره هذا الناقل رغم علمنا بعدم تأليفه له، لكنْ غاية ما في الأمر، ربّما نشكّ في أنّ ما نقله ونقول في أنفسنا: هل ما سمعناه منه ما سمعه ذاته مِن ذلك المتكلّم أو أنّه تصرّف به فحذف منه أو أضاف إليه شيئًا؟ لذا، لا
(282)يمكن ادّعاء أنّ كلامه غير مفهوم بالنسبة إلينا بذريعة أنّه ناقل له وليس له أيّ دور في تأليفه وصياغة ألفاظه وعباراته، فقد راعى الأمانة بالكامل، ونقل لنا ما سمعه ذاته مِن المتكلّم. وبغضّ النظر عن الناقل والمتكلّم، نحن هنا في مواجهة كلام ذي معنى مفهوم وواضح، بحيث لا يختلف تمامًا عمّا ذكره المتكلّم؛ فالكلام المكوّن مِن ألفاظ وعبارات لغويّة مدلوله ثابت، سواء سمعناه مِن متكلّمه مباشرةً أو نقله لنا شخص آخر.
إذا افترضنا أنَّ هذا الشخص نقل كلامًا مِن متكلّم ماورائي نؤمن بوجوده، وأخبرنا بأنّه مكلّف بإبلاغه لنا فقط، ولا يحقّ له التصرّف فيه بأيّ نحوٍ كان ولا قدرة له على ذلك مِن الأساس، ففي هذه الحالة هل يجوز لنا الاعتراض عليه كما ادّعى السيّد شبستري ونبرّر اعتراضنا قائلين: بما أنّك تنقل لنا كلامًا مِن كائن ماورائي ـ ليس بإنسانٍ ـ فنحن لا نفهم ممّا تقول شيئًا، وكلّ ألفاظك وعباراتك التي تخبرنا بها عارية مِن المعنى والمفهوم؟
لو افترضنا أنّ هذا الناقل أخبرنا بأنّه ذكر لنا كلامًا أوحي إليه مِن الله تعالى خالق الكون والكائنات مِن بشرٍ وغير بشرٍ، وأمره بأنْ يبلّغه لنا بذاته بصفته مكلّفًا بذلك ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾،ولو قال لنا إنَّ كلّ ما يقوله هو ما سمعه ذاته مِن وحي السماء دون حذف أو إضافة حتّى كلمة واحدة، بل حتّى حرف واحد، وأكّد لنا أنّه غير قادر على ذلك مِن الأساس؛ ففي هذه الحالة هل مِن المعقول أنْ نجيبه قائلين: نحن لم نفهم ما قلت مطلقًا؛ لأنّك
ذكرت لنا كلامًا ليس مِن تأليفك؟! نحن لم نسمع منك أيّة ألفاظ وعبارات ذات مداليل لغويّة مفهومة!
القرآن الكريم أكّد على عصمة خاتم الأنبياء محمّدصلىاللهعليهوآله في نقل آياته ضمن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ*لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ*ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ*فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى*مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى*وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى*عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾.
يمكن تلخيص النتائج التي توصّلنا إليها في هذه المقالة في النقاط الآتية:
1. الباحث محمّد مجتهد شبستري ادّعى ما يلي: «النصّ القرآني ليس كلام الله، ولا يمكن أنْ يكون كذلك، بل مجرّد كلام ألّفه وصاغه إنسان هو النبيّ محمّد»، وقد كرّر هذا الكلام بشكل مملّ وبأساليب متنوّعة في مختلف مدوّناته وفي شتّى المناسبات، لكنّه لم يذكر أيّ دليل مقنع لإثباته، بل كلّ الأدلّة التي استند إليها في هذا المضمار، عبارة عن مغالطات واضحة حسب الأسس المنطقيّة للاستدلال.
2. كلّ الشواهد والقرائن التاريخيّة تدلّ على بطلان الادّعاء الآتي: كلّ مخاطبي النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله ـ باستثناء الكفّار والمنكرين ـ كانوا يعتقدون بأنَّ النصّ القرآني مِن تأليفه وصياغته.
حتّى إذا تنزّلنا وأقررنا بصواب هذا الادّعاء الباطل تاريخيًّا، لا يمكن
اعتبار تصوّر مخاطبي الرسالة النبويّة دليلًا على أنّ النصّ القرآني ليس كلامًا إلهيًّا.
3. لا صواب لادّعاء السيّد مجتهد شبستري الذي استدلّ عليه بمسألة بنية الفهم البشري؛ إذ لا يمكن إثباته على هذا الأساس، فما هو الدليل على أنّ كلام البشر فقط مفهوم لنا ويمكننا تفسيره؟ هل هناك سبب وجيه يدعونا للاعتقاد بأنّ الكلام، حتّى إذا صدر بالألفاظ والعبارات اللغويّة ذاتها المتعارفة لدينا مِن قبل كائن ذي شعور وإدراك مثل الله أو الملائكة؛ هو غير مفهوم بالنسبة إلينا ولا يمكننا تفسيره؟ فما هي الميزة التي يمتاز بها كلام غير البشر كي يصبح فهمه مستحيلًا علينا؟ هل هناك سبب معقول يثبت لنا أنَّ الله عزّ وجلّ الذي خلق الإنسان ومنظومته الفكريّة والإدراكيّة واللغويّة، لا يمكنه أنْ يصوغ كلامًا يفهمه مخلوقه هذا، ويمكنه تفسير مدلوله؟
4. السيّد مجتهد شبستري قال: «اللغات الشائعة بين البشر تظهر في رحاب حياة دنیويّة مشتركة اجتماعيًّا تاريخيًّا، ومتقوّمة على اشتراكات فكريّة، فعلى هذا الأساس تكتسب معانيها ويصبح مِن المقدور فهم وتفسير ألفاظها وعباراتها مِن قبل الجميع على ضوء نطاق فكري مشترك».
هذا الكلام على فرض صوابه، لا يعدّ دليلًا يمكن الاستناد إليه لتفنيد أنَّ ألفاظ القرآن الكريم وعباراته صادرة مِن الله عزّ وجلّ، فيا ترى هل مجرّد نشأة لغة البشر في الحياة الدنيا، يعدّ سببًا لعدم قدرة أيّ كائن آخرـ حتّى الله ـ على أنْ يستخدم ألفاظها وعباراتها للدلالة على معانٍ معيّنة؟
5. مجرّد إثبات ضرورة وجود متكلّم صدر منه الكلام، لا يدلّ مطلقًا على حتميّة أنَّ القرآن كلام بشر، فهذا الدليل أعمّ مِن المدّعى حسب القواعد الفلسفيّة، وبيان ذلك كما يلي:
المدّعى: إذا كان الكلام صادرًا مِن الله تعالى، لا يمكن للبشر فهمه.
الدليل: الكلام لا يكون مفهومًا إلّا إذا نطقه متكلّم.
إذاً، هذا كلّ شيء، لذا ما هو الدليل الذي يحتّم ضرورة أنْ يكون المتكلّم إنسانًا كي يصبح الكلام مفهومًا للبشر؟ وهل هناك دليل يؤكّد على أنّ المتكلّم إذا لم يكن إنسانًا، لا يمكن وصف ما يصدر منه بالكلام، وبالتالي لا يمكن فهمه مطلقًا؟
6. ادّعى السيّد مجتهد شبستري أنَّ اللغة بما فيها مِن ألفاظ وعبارات متّفق عليها بين البشر وتختصّ بعالمهم فحسب، لذا لو صدرت مِن غيرهم ألفاظ وعبارات تنطبق مع لغتهم التي يتكلّمون بها، فهي غير مفهومة لديهم ولا تدلّ على أيّ معنى معتبر؛ لأنّ المدلول اللغويّ المعتبر مرتبط بكلام الإنسان فقط.
هذا الادّعاء باطل، إذ حتّى لو افترضنا أنَّ دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني أمرٌ متّفق عليه بين البشر، فهذا لا يعني ضرورة اشتراك كلّ ناطق باللغة في الاتّفاق على المداليل اللغويّة ونشأتها الأولى؛ إذ يكفي في كلّ لغة مجرّد معرفة المتكلّم بالعلامات اللغويّة الدالّة ـ معاني الألفاظ والعبارات ـ وكلّ ملحقاتها ومقتضياتها وقواعدها المتعارفة بين الناطقين بها بحيث يمكنه استخدامها لبيان مقاصده حين الكلام؛
أي يجب عليه استعمال ألفاظها وعباراتها بأسلوب صائب وفق ضوابط محدّدة معتمدة مِن قبل أهل اللغة أنفسهم.
7. كما أنّنا نفهم الكلام الذي ينقله شخصٌ لنا عن إنسانٍ، كذلك لنا القدرة على فهم الكلام الذي ينقله لنا عن غير إنسانٍ مِن كائناتٍ أخرى، مثل الجنّ والملائكة وغيرها، حتّى إذا شكّكنا في مدى مصداقيّته، فالقصد هو أنّه مفهوم لنا وبإمكاننا تفسيره، بغضّ النظر عن صدقه أو كذبه.
بناءً على ذلك، إذا نقل لنا إنسانٌ كلامًا منسوبًا إلى الله عزّ وجلّ، وقال لنا إنّه مجرّد حامل رسالة إلهيّة ومكلّف بتبليغها لنا، مِن المؤكّد أنَّ الكلام الذي يأتينا به مِن جانبه تعالى يكون مفهومًا عندنا، ومِن ثَمَّ نستطيع تفسيره ومعرفة مدلوله الواقعي. وعلى هذا الأساس، لا يمكن لأحدٍ الاعتراض عليه قائلًا: بما أنّ الكلام الذي جئتنا به ليس كلام بشر، بل كلام الله، لذا لا نفهم منه شيئًا ولا نعرف مدلوله؛ فلو جئتنا بكلام بشر لفهمناه!.
- القرآن الكريم
- البحراني، السيّد أبو المكارم هاشم بن سليمان بن إسماعيل، البرهان في تفسير القرآن، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات مؤسّسة «بعثت»، 1995م.
- البصري الزهري، محمّد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، لبنان، بيروت، منشورات دار الكتب العلميّة، 1418ه.
- جوادي الآملي، عبدالله، تسنيم تفسير قرآن كريم (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات «إسراء»، 1999م.
- الحاكم النيسابوري، أبوعبدالله محمّد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، لبنان، بيروت، منشورات دار الكتب العلميّة، 1411ه.
- الحسكاني، عبيد الله بن عبدالله، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تصحيح محمّد باقر المحمودي، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1411ه.
- الحسيني الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لبنان، بيروت، منشورات دار الكتب العلميّة، 1415ه.
- الذهبي، شمس الدين، تذكرة الحفّاظ، لبنان، بيروت، منشورات دار الكتب العلميّة، 1419ه.
- السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات مؤسّسة الإمام الصادق عليهالسلام، 1421ه.
- الشهرستاني، علي، منع تدوين الحديث، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات دار الغدير، 1425ه.
- الطباطبائي، السيّد محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم، منشورات جامعة المدرّسين، بلا تاريخ طبع.
- الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، مصر، القاهرة، منشورات مطبعة الاستقامة، 1357ه.
- الكوفي، أبوالقاسم فرات بن إبراهيم، تفسير القرآن (المعروف بتفسير فرات الكوفي)، تصحيح محمّد كاظم، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1410ه.
- المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، لبنان، بيروت، منشورات دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1403ه.
- مقالات الباحث محمّد مجتهد شبستري وهي مدوّنة باللغة الفارسيّة:
- محمّد مجتهد شبستري، محمّد: «چگونه مباني كلامي و فقهي فرو ريختهاند؟» (كيف انهارت الأسس اللاهوتيّة والفقهيّة؟)، نیلوفر، 26 / 4 / 2015م.
-http://mohammadmojtahedshabestari.com
- محمّد مجتهد شبستري، «قرائت نبوي از جهان») (قراءة نبوية للعالم)، نیلوفر، الثلاثاء 5 / 2 / 2008م.
- https://neeloofar.org/category/professorsresearchers/mojtahedshabestari/prophetic-interpretation-of-the-world/
حميد رضا شاكرين
باعتماده على بعض النظريّات المعاصرة في فلسفة اللغة، خاصّة نظريّة أفعال الكلام؛ استحصل محمّد مجتهد شبستري على نتائج، تجعل، بناء عليها، كلام الله تعالى مع الإنسان عن طريق الوحي الرسالي أمرًا غير ممكن، و[تُفضي إلى] الاعتقاد بسدّ باب تفاهمه [تعالى] اللغويّ مع الناس. النتيجة الواضحة لهذا الظن، هي أنَّه لا يمكن للقرآن أنْ يكون كلامًا إلهيًّا، بل هو كلام بشريّ في اللفظ والمعنى. ونحن الآن، مِن خلال إلقاء نظرة على الفلسفة المعاصرة للغة، بصدد شرح أهم مرتكز لشبستري في مجال معرفة القرآن الكريم، وإعادة التنقيب عن كيفيّة دلالتها في مجال معرفة القرآن و بشريّته.
يرى محمّد مجتهد شبستري أنّه فقط مِن خلال امتلاك معنى ومفهوم عن اللغة، يمكن حيازة تصوّر عن الكلام، الحوار، التفاهم وأمور مِن هذا القبيل. ومِن أجل توضيح المسألة؛ نقل الكلام التالي عن ألبرت كيلر، الذي يبيّن مِن وجهة نظره حقيقة اللغة والأركان الحتميّة لها:
اللغة هي نظام مِن أشكال الإبداءات، ظهر وتكامل مِن خلال الإنسان. يقدّم الإنسان هذا النظام ليُبدي نفسه مِن خلاله، وليجعل نفسه مفهومًا للآخرين، والآخرين مفهومين له، وليُنظِّم عبره معارفه، ويُطلع الآخرين عليها، وليتصارع بأشكال مختلفة مع الواقع، ويتواءم معه.
ثم ينقل أركان اللغة، بهذا النحو:
اللغة، بمثابة نظام مِن أشكال الإبداءات، تتقوّم بخمسة «محاور»:
«محور المتكلّم الذي يصدر عنه الكلام، محور السامع أو المُخاطب
(292)الذي يتوجّه إليه الكلام، محور سياق النصّ أو سياق الكلام، الذي هو محلّ اللغة، محور الجماعة وأهل اللغة، حيث اللغة بينهم هي أداة التفاهم المشترك ولغتهم جميعًا، ومحور «المضمون» الذي تبيّنه اللغة».
ثمّ يستنتج مجتهد شبستري هذه الملاحظات الفلسفيّة حول اللغة، التي تجد اليوم أكثر أنصارها بين فلاسفة اللغة، وتوضِّح أنَّ اللغة هي ظاهرة إنسانيّة جَمْعِيَّة، ولها أركان ومقوّمات مختلفة، وتتحقّق فقط في موضع تكون فيه جميع تلك الأركان والمقوّمات موجودة، وبفقدان بعضها؛ تنتفي اللغة بشكل كامل.
أشار أيضًا مجتهد شبستري إلى نظريّة «الألعاب اللغويّة» لفيتغنشتاين ونظريّة «أفعال الكلام» لأُوستن. وبناء على هذه النظريّات، يرى أنَّ الوحي اللغويّ؛ أي تكلّم الله تعالى ورسالته اللغويّة، يفتقر إلى المتكلّم وإلى أركان اللغة الأخرى، ويرى في النتيجة، أنّه أمر لا معنى له ولا يمكن التوصُّل إليه.
ويرى في موضع آخر، أنَّه في الفلسفة الجديدة، ومِن وجهة نظر أكثر مفكّري وفلاسفة اللغة، فإنَّ النسخة الأساسيّة للغة الإنسان هي الكلام
(293)الشفاهي، وهي ليست مجموعة مِن العلامات التي يوجدها شخص، والتي تدلّ على سلسلة مِن المعاني، بل إنَّ كلّ كلام شفاهي هو «نشاط إنساني» أو act [فعل]، ويُصنع ويُصاغ المعنى عبر الحوار ومرافقة السامع للمتكلّم.
والآن، وبما أنَّ مجتهد شبستري اعتمد كثيرًا على نظريّات فلاسفة اللغة المعاصرين، خاصّة على نظريّة أفعال الكلام، ونظّم، إلى حدٍّ ما، وجهة نظره بناء عليها؛ يتطلّب الأمر أنْ نشرح وجهة نظره مِن هذا المنظور. لذا، يلزم بداية إلقاء نظرة مقتضبة على هذه النظريّة، ثمّ تقييم دلالتها على وجهة نظر مجتهد شبستري في إفراغ الكلام الإلهي مِن أركان اللغة، وفي النتيجة الاعتقاد ببشريّة القرآن الكريم.
نظريّة أفعال الكلام هي نظريّة فلسفيّة حول اللغة، عرضها جون أوستن، ونُشرت بعد وفاته ضمن كتاب عنوانه How To Do Things With Words [كيف تصنع الأشياء بالكلمات]. المدّعى الأساس لهذه النظريّة، هو أنَّ «العنصر البنيويّ للتواصل اللغويّ هو الفعل الكلامي». قبل أوستن، أشار ستراوسون أيضًا إلى هذه المسألة، أنَّه لا يمكن تبيين وتحليل الجملة عن طريق البناء النحويّ وقواعده اللغويّة فقط. عوضًا عن ذلك، يجب دراسة التعابير اللغويّة بمثابة
أنَّها سلوك وأفعال المتكلّمين؛ إذ إنَّ هؤلاء يمكنهم القيام عبر الأقوال الكلاميّة بأعمال مختلفة.
مع ذلك، فإنَّ تبيين مباني ومبادئ نظريّة أفعال الكلام، وتنسيقها وتنظيمها، يدين في الدرجة الأولى إلى جون أوستن. هو يرى أنّه عندما يُجري المتكلّم كلامًا على لسانه ويؤدّي جملًا، فإنّه ينجز ثلاثة أفعال مختلفة، كالآتي:
أ) الفعل الكلامي؛ أي الجري على اللسان، وإبداء جملة ذات معنى.
ب) الفعل المُتَضَمَّن في الكلام الفعل الإنجازي؛ أي الأفعال التي يؤدّيها المتكلّم ضمن كلامه، مِن قبيل: الحُكم، الالتزام والتعهّد، التوضيح، الإخبار عن شيء، السؤال، المدح والثناء، الأمر والنهي و....
ج) الفعل التأثيري، أو [المُؤدّى] عبر الكلام. المراد بهذا القسم، الأثر أو ردود الفعل التي تُحدثها في السامع الأفعالُ المُتَضَمَّنة في الكلام. على سبيل المثال: عندما يخبر المتحدّث عن شيء، فإنَّ السامع إمّا أنه يُصدِّق أو يُكذِّب، وإمّا يُسَرُّ به أو لا يُسَرُّ به و....
(295)بعد أوستن، بيَّن تلميذه جون سيرل هذه النظريّة وإطارها النظري في كتاب «أفعال الكلام، بحث في فلسفة اللغة والعبارة والمعنى»، وكشف عن لوازمها ونتائجها. يرى جون سيرل أنَّ نظريّة أفعال الكلام تقبل التعميم والتوافق عليها؛ أي إنَّها غير مقيّدة بالأشخاص أو بإيديولوجيّات خاصّة، ويمكن لكلّ شخص أنْ يتأمل فيها. ورغم الالتزام بالفلسفات والإيديولوجيّات والأذواق المختلفة، فإنّه يمكن التوافق عليها.
بغضّ النظر عن البحث حول مقدار صحّة وفساد أو كمال ونقص نظريّة كهذه، فإنَّ الدور يصل الآن إلى إعادة التنقيب عن دلالتها في مجال معرفة القرآن. هل تقتضي هذه النظريّة أنْ يكون تكلّم الله سبحانه وتعالى أمرًا غير ممكن؟ [إذا كان الأمر كذلك] فهي تتعارض مع وجهة نظر المسلمين التي أجمعوا عليها على طول التاريخ، والقائلة بأنَّ القرآن الكريم كلامٌ إلهي، وأنَّ الوحي الرسالي له حقيقة لغويّة. أوليس لها مِن الأساس دلالة كهذه، ولا تتضمّن معارضة لتكلّم الله جلّ جلاله، ولأنَّ القرآن الكريم إلهيّ في اللفظ والمعنى؟ يتطلّب الأمر في هذا المجال تبيين الأركان الأساسيّة ومباني نظريّة أفعال الكلام ومرتكزات مجتهد شبستري الأخرى، والبحث حول دور ودلالة كلّ منها على تكلّم الله تعالى.
الأركان والمباني النظريّة الأكثر أساسيّة في نظريّة أفعال الكلام، هي كالآتي:
أوّل ركن في [نظريّة] أفعال الكلام، هو أنَّ كلّ ما يُقصد، قابل للتعبير عنه أيضًا، فلا يوجد معنى مقصود لا يمكن إبداؤه بألفاظ وعبارات. حتّى إذا كانت لغة خاصّة عاجزة مِن الناحية الصرفيّة والنحويّة أو فقر المفردات عن بيان بعض المقاصد، فإنّه يمكن إغناؤها وإثراؤها.
بناء على وجهة النظر هذه، فإنَّ أحد العناصر المهمّة في التفاهم اللغويّ، هو عنصر القصد. وهنا يطرأ هذا السؤال: ما المانع الذي يمكن أنْ يوجد في هذا المجال لتكلّم الله تعالى، ويكون [من خلاله] الاعتقاد ببشريّة الوحي أمرًا موجودًا لا محالة؟
مع أخذ النظريّة السابقة بعين الاعتبار، فإذا كان هناك مانع، فليس الأمر إلّا أنَّ الله جلّ جلاله لا يمكنه أنْ يقصد معنى وغرضًا، أو لا يمكنه أنْ يبديه ضمن إطار لغة وضعيّة خاصّة. إمّا إذا كان قادرًا على القصد واستعمال العلامات اللغويّة، فبأيّ نحو كان، لا يوجد مشكلة مِن هذه الناحية لإيجاد تواصل لغويّ. والآن، هل الله تعالى قادر على قصد المعاني وإبداء الكلمات، أم لا؟ حلّ هذه المسألة رهن أنْ نعلم ماذا يقتضي القصد وإبداؤه، وما الأمور التي يحتاجها؟ ثمّ ننظر ما هي العلاقة بين خصائص الله تعالى وتلك الميّزات والاقتضاءات:
أ) يتبع القصد قبل كلّ شيء الوعي والإدراك، ولا معنى للقصد والغرض مِن دون الإدراك، ولا إمكانيّة له. ولربّما لا يكون ممكنًا أيضًا قصد انتقال المعاني والمفاهيم في المستويات المتدنيّة للوعي والإدراك، لكنْ في المستويات الأعلى؛
(297)كالإدراك الإنساني، فلا شكّ في وجود قدرة كهذه، وإنّ آثارها واضحة وبيِّنة. مِن ناحية أخرى، نحن نعلم أنَّ الله تعالى هو علم مطلق، وله أسمى رتبة ممكنة مِن الوعي والإدراك، بل هو عينهما، وكلّ ما يتمتّع به المدركون الآخرون [من وعي وإدراك] فهو منه أيضًا، ولا معنى لأنْ يكون الإنسان أسمى منه في هذا الوصف الكمالي. بناء عليه، فإنَّ الله سبحانه وتعالى الذي له أسمى درجة مِن الوعي والإدراك، يمكن أنْ يقصد الإفهام وأنْ تكون له غاية يريد التعبير عنها.
ب) أيضًا فإنَّ استعمال العلامات اللغويّة يحتاج مِن جهة إلى العلم بالاعتبارات اللغويّة، ومِن جهة ثانية إلى نظام وأدوات كافية لإبداء تلك العلامات. بناء عليه، فإنَّ هذه المسألة تتبع مِن ناحية العلم، ومِن ناحية أخرى أدوات التعبير. مِن الناحية العلميّة، كما في الحالة السابقة، فإنّ العلم بالقواعد التي تحكم اللغة، وبالعلامات اللغويّة، لا يخرج عن حيطة العلم الإلهي المطلق، ومِن هذه الناحية لا يوجد مانع لتكلّم الله سبحانه وتعالى.
ج) يمكن إبداء العلامات اللغويّة بنحوين قولي وكتابي. وبعبارة أخرى: علامات سمعيّة؛ أي الأصوات والأنغام، وعلامات مرئيّة؛ كالأشكال الكتابيّة. والله سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق، وهو قادر على الإبداء الصوتي للعلامات اللغويّة في كلّ شيء، كما هو قادر على إبدائها كتابيًّا في الظواهر المختلفة. بعبارة أخرى: هو الذي جعل الإنسان قادرًا على وضع القواعد والعلامات اللغويّة، وإبدائها كلاميًّا وكتابيًّا، فمن باب أولى أنْ يكون هو أيضًا قادرًا على إيجاد العلامات بأشكال مختلفة، ومِن هذه الناحية فلا يتصوّر وجود مانع يعترض طريقه.
(298)من المباني الأخرى لـ [نظريّة] أفعال الكلام، أنَّ هذه الأفعال هي أفعال قصديّة، ولها معنى. معنى الجملة هو أمر وضعي واتّفاقي، وهو قائم مِن ناحية بقصد المتكلّم، ومِن ناحية ثانية تابع للمُواضعات اللغويّة.
يبدو أنَّه مِن هذه الناحية أيضًا، لا يوجد مانع يعترض طريق تكلّم الله جلّ جلاله. هذه المسألة تتبع مِن ناحية العلم، وكما مضى، فإنَّ العلم بالعلامات اللغويّة لا يخرج عن حيطة العلم المطلق الإلهي. مِن ناحية ثانية، تقتضي الحكمة الإلهيّة أنّه مِن أجل إيصال رسالته، فهو لا يحتاج إلى الاستفادة مِن لغة خاصّة. لذا، يمكنه أنْ يتكلّم مع الناس وفقًا للمواضعات اللغويّة المعهودة بينهم. والوحي اللغويّ هو بنحو دقيق على هذا النحو، والله تعالى يبدي غايته وقصده ضمن إطار اللغة الوضعيّة والعلامات المعروفة بين الناس.
المانع الوحيد المُدَّعى، هو أنَّه مِن وجهة نظر مجتهد شبستري، فإنَّ أركان اللغة غير موجودة في تكلّم الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى لا يكلّم الناس بنحو مباشر ووجهًا لوجه، ويبدو أيضًا أنَّ لازم إيصال رسالته غير المباشرة، هو ألّا يكون لوسيلة إيصال الرسالة إدراك عن الموضوع، وألّا يكون لديها القدرة على إيجاد تواصل لغويّ. فلا جرم أنَّ تواصل الله تعالى مع الإنسان عبر اللغة، لا يمكن إقامته في الأساس عبر اللغة، ولا يمكن أنْ يتحقّق تفاهم. كلامه في هذا المجال هو الآتي:
(299)إذا قال شخص: إنَّ ألفاظًا ومعاني معيَّنة تُتلى عليَّ بنحو خاصّ عبر وسيلة، مَلاك على سبيل المثال، ثمّ يقرؤها للمخاطَبين، ويقدّم نفسه كمكبِّر صوت، ويقول: لست أنا قائل هذه الجمل، ففي حدث كهذا، لن يكون هناك، كما يصطلح عليه علماء علم الأصول، «دلالة تصديقيّة»؛ لأنَّه لن يكون لهذا الكلام «قائل» بالنسبة للمخاطَبين... هذه الجمل ليس وحسب أنّه ليس لديها قائل، بل لا يوجد فيها ولا أيّ محور مِن المحاور الخمسة لتحقّق اللغة، ولا يمكن عدّها نماذج عن لغة؛ كاللغة العربيّة مثلًا. مِن الواضح أنَّ المقصود بقائل الكلام، الذي هو الركن الأوّل للكلام، ليس مَنْ يُحدث الصوت؛ كالببغاء أو مكبّر الصوت، المقصود بالقائل هو مَنْ يمكن لكلامه أنْ يُفهم، ويمكن أنْ يُنسَب الكلام إليه، والقول: إنَّ هذا الكلام يقوله الشخص الفلاني.
وينبغي الآن السؤال: مِن أيّ ناحية يُعدُّ الكلام الذي نزل، مِن ناحية قائل مدرك وله قصد، بلغة بشريّة على إنسان مختار، وهو يقرؤه للناس مِن دون أدنى خلل ونقصان؛ فاقدًا لقائل؟ فرضيّة مجتهد شبستري في هذا المجال، هي أنّه في هذه الحالة، فإنَّ الوسيلة في الكلام هي كالببغاء أو مكبّر الصوت، تُحدث الصوت فقط. إلّا أنّه بناء على النظريّات المعاصرة لفلسفة اللغة، فإنَّ القائل في التواصل اللغويّ، هو مَنْ يكون لديه قصد وغاية، ويريد إفهام معنًى ضمن إطار الاعتبارات اللغويّة. والحال، أنَّ الببغاء ومكبّر الصوت، ليسا متكلّمين، ويفتقران إلى أوّل أركان المعنى. إذاً، في هذه الحالة، لا يوجد
أيّ قائل، ولا جرم أنَّ الأركان الأخرى للغة أيضًا، والتي هي فرع لها؛ لن تتحقّق. بعض إشكالات هذا التصوّر، هي كالآتي:
أ) وقع مجتهد شبستري هنا بوضوح في مغالطة؛ إذ بناء على أيّ منطق يُفترض أنّه إذا نقل شخص رسالة مِن طرف آخر، مع مراعاة الأمانة الكاملة، ومِن دون أنْ يفسح مجالًا لأدنى خلل ونقص وزيادة، أنْ يكون كالببغاء أو مكبّر الصوت، اللذين ليس لديهما أيّ إدراك عن الكلام والاعتبارات اللغويّة، ولا يفهمان معنى تلك الجمل؟ مِن جهة، فقد رأى الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله الحقائق الوحيانيّة في الأفق المبين. مِن جهة ثانية، فهو نفسه إنسان أهل لغة، ويدرك معاني ما يسمع، ثمّ يعيد قولها كما سمعها، وهو أيضًا يتناول تبيينها وتفسيرها عند الضرورة، ويرفع إبهامات المخاطَبين.
ب) إذا افترضنا أنَّ الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله هو كالببغاء أو مكبّر الصوت، بحيث لا يدرك الكلام والاعتبارات اللغويّة، ولا يفهم معنى تلك الجمل، أو أنّنا في الأساس كنا نسمع ما نزل على الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله عن لسان ببغاء أو جسم جامد، فما الإشكال الذي يطرأ؟ لا شكّ أنّه في حالة كهذه أنَّ بعض الأعمال الخاصّة بالنبوّة وأدوارها ستُفتقد. على سبيل المثال، لن يتحقّق شأن التبيين، قيادة الأمّة و...، لكنْ، هل أنَّ باب التفاهم سيُسَدّ بنحو كامل، وسيُعدُّ ما كان يُسمع فاقدًا لقائل؟ ليس الأمر لزومًا كذلك، بل إنَّ هذه المسألة تتبع معارف وآراء أخرى. لا شكّ أنّه إذا علمنا سلفًا، بأيّ دليل كان، أو اكتشفنا مِن هذا الطريق وبمعونة مقدّمات أخرى أنّ ما
نسمعه هو رسالة متكلّم مدرك، أراد بأيّ دليل كان عبر إيجاد الصوت في وسيلة كهذه، أنْ يوصل رسالته إلى مسامعنا؛ فإنّه توجد الدلالة التفهيميّة والتصديقيّة، وتتحقّق أركان اللغة مِن قبيل المتكلّم و.... كما أنّنا نتلقّى في الحالات المختلفة رسائل الآخرين عبر أدوات تبليغ سمعيّة وبصريّة، ونستدلّ على مقصود القائل. وقد اتّفق أنَّ الله تعالى أيضًا أوصل في حالات رسالته إلى مسامع الأنبياء عبر إيجاد علامات صوتيّة في بعض الأجسام، وهم أيضًا تعرّفوا بسماع تلك العلامات على مُوجد تلك الأصوات، وتوصّلوا أيضًا إلى مقصوده. ومِن هذا القبيل، تكلّم الله سبحانه وتعالى مع النبيّ موسى عليهالسلام عبر صوت في الشجرة: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. بناء عليه، فإنَّ الدور التبليغي للنبيّ لا يُحدث أدنى خلل في أركان اللغة. ومن أجل ذلك وعلى طول التاريخ، عَدَّ الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله وكذلك المسلمون، القرآنَ الكريم الكلام الإلهي عينه، وكانوا يعتقدون بدلالته اللغويّة، وارتبطوا به، ووضعوه قيد الفهم والبحث. بالإضافة إلى عنصر المتكلّم، فإنَّ العناصر الأخرى للّغة مِن قبيل السامع، المضمون، سياق النصّ، الجماعة وأهل اللغة و... حاضرة أيضًا في الدور التبليغي للنبيّ. كما أنَّ الأمر هو أيضًا كذلك في كلّ تبليغ مع الوساطة، ولا داعي لشرحه والتفصيل فيه في هذه الوجيزة.
نُقل عن مجتهد شبستري كلام آخر، هو بناء على أنَّ القرآن الكريم إلهيّ، بمثابة دليل على نفي الدلالة التصديقيّة، هو كالآتي:
يُعلم بالنظر الدِّقي، أنَّ الأمر في حالة كهذه، هو على هذا النحو: أنّه بالنسبة للنبيّ، بناء على تجربته [النبويّة]، فإنَّ الجمل التي ينقلها لها قائل واحد، وهو الله أو المَلَك... أمّا بالنسبة لمخاطَبي النبيّ، فلا قائل لهذه الجمل؛ إذ لا يمكن للمخاطَبين أنْ يعلموا ماذا يجول في باطن النبيّ. هل هناك شخص يتحدّث معه؟ مَنْ هو الشخص الذي يتحدّث معه؟ كيف يتحدّث؟.
هذا التصوّر أيضًا مخدوش مِن جهات، مِن قبيل أنّه بناء على أيّ دليل وأيّ نظريّة في فلسفة اللغة، شرط المعنى وتحقّق التواصل اللغويّ، هو أنْ نعلم ماذا يجول في باطن المُبَلِّغ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي حدود وتخوم وعناصر هذا العلم؟ ما هو مهمّ في هذا المجال، هو أنْ يتحدّث المتكلّم، أعمّ مِن أنْ يكون مُعْرِبًا عن كلامه هو نفسه أو كلام غيره بناء على القواعد والعلامات اللغويّة. وأيضًا، أنْ يعتقد السامع أنّه يقصد تفهيم وانتقال تلك العلامات، حتّى إنّه لا دخل في المسألة لاعتقادنا أو عدم اعتقادنا بصدق القائل فيما يدّعيه مِن حيث [الصدق] الخبري أو المُخبِري. ومِن هذا الحيث، كان يتّضح للمؤمنين، اعتمادًا على ادّعاء الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله للأدلّة التي كانت تُثبت صدقه الخبري والمُخبري، أنَّ المَلَك الإلهي قرأ عليه صلىاللهعليهوآله كلام الله جل جلاله، وهوصلىاللهعليهوآله أعاد عليه [على المَلَك] قراءة كلامه تعالى عينه ذاك. مخالفو الرسول، وأيضًا أولئك الذين لم يكونوا يؤمنون لا بالوحي ولا بالملائكة ولا بالحقائق السماويّة الأخرى، أعمّ مِن أنْ يكونوا قد ظنّوا الرسول، معاذ الله، كاذبًا أو اعتراه وهم. كانوا شركاء مع الآخرين في فهم كلام الرسول الأكرم، وكانوا يحاورونه ويحاجّونه.
بناء على نظريّة أفعال الكلام، فإنَّ التكلّم، وبعبارة أخرى، إيجاد التواصل اللفظي ليس هو محض أداء الألفاظ؛ ذلك لأنَّ الألفاظ ليست لمجرّد النطق، بل نستعملها مِن أجل أهداف أخرى مِن قبيل: الإحالة، الإسناد ومضمون الجملة مِن قبيل: الإخبار، الوصف، الأمر، النهي و... التي هي الفعل المتضمّن في الكلام. بناء عليه، فإنَّ كلّ متكلّم يقوم عند أداء كلّ جملة، على الأقلّ بثلاثة أفعال مختلفة متزامنة: فعل كلامي، فعل أثناء الكلام، فعل بعد الكلام أو مِن خلال الكلام. أمّا عنصر التواصل اللغويّ والفعل الكلامي الكامل، فهو الفعل المُتَضَمَّن في القول [التأثيري]. يرى سيرل أنَّ مراد فريجه مِن مبدأ السياق، هو أنَّ «الألفاظ تُحيل فقط في إطار الجملة». لهذا، فإنّ عنصر التواصل اللغويّ، ليس الألفاظ المفردة والعبارات، بل الجملة، والجملة الكاملة هي التي يتحقّق بها فعل لفظي كامل. التنوّع المتزامن
(304)لأفعال الكلام، كما الأسس المذكورة سابقًا، لا يمكن له أيضًا أنْ ينتصب كعائق في طريق تكلّم الله تعالى، أنْ يقوم كلّ متكلّم عند أداء كلّ جملة على الأقلّ بثلاثة أفعال متزامنة، وأيضًا أنْ نستعمل الألفاظ لمقاصد مِن قبيل: الإحالة، الإسناد، ومضمون الجملة مِن قبيل: الإخبار، الوصف، الأمر، النهي و... فعلى فرض صحّة كلّ ذلك، فهي [أمور] يمكن أنْ تنطبق على تكلّم الله تعالى أيضًا. بعبارة أخرى: لهذه الأمور جانب نَعْتِي بشكل عام، وتعمل على تحليل أداء مستعملي اللغة، سواء كان ذاك المستعمل هو الله تعالى، أو الإنسان. وأيضًا، أنْ يكون عنصر التواصل اللغويّ هو الجملة، وليس الألفاظ. فهو يبيّن أنّه، بناء على هذه النظريّة، لا يمكن إقامة تواصل لغويّ مِن دون الجملة، ولن يتحقّق الفعل الكلامي. بناء على هذه النظريّة، فإذا أراد الله تعالى أيضًا أنْ يقيم تواصلًا لغويًّا مع الناس، فينبغي ألّا يكتفي بمجرّد أداء الألفاظ المفردة والعبارات. أمّا أنْ يكون استعمال الجملة يتحقّق فقط عند التخاطب مع الناس، وأنْ يكون الله تعالى عاجزًا عن استعمالها؛ فليس هذا مدلول هذا التصوّر.
مِن وجهة نظر سيرل، فعند افتراض شروط خاصّة، نجري كلامًا على ألسنتنا، وبمجرّد أنْ يفهم السامع ماذا نريد أنْ نقول؛ نكون قد نجحنا في نقل مقصودنا إليه. في هذه النظريّة، فإنّ المعنى يرجع إلى أثر الفعل المُتَضَمَّن في الكلام، لا إلى الأثر الحاصل مِن الكلام. بناء عليه، فإنَّ تحديد قصد المتكلّم، كافٍ للتواصل
اللغوي. أمّا أنّه ما هي ردّة الفعل التي يُبديها السامع بعد فهمه لقصد المتكلّم، فهي أثر نابع مِن الكلام ولا دور لها في معنى الجملة.
لا يدلّ هذا التصوّر أيضًا على اختصاصه بالإنسان، ويصدق على كلّ مستعمل يقصد معنى، سواء كان الله أو الإنسان. بعبارة أخرى: بناء على هذه النظريّة، إذا استطاع الله جلّ جلاله أنْ يُفهِم المخاطبين قصده، فقد تحقّق التفاهم اللغويّ، ولا يحتاج لشيء آخر. أمّا أنّه كيف يتحقّق هذا الانتقال؛ فهي مسألة أخرى، وسبيلها هو الاستعمال الصحيح للعلامات اللغويّة.
يجدر القول إنَّ مجتهد شبستري يرى أنَّ أثر القرآن الكريم في حياة مخاطبي عصر النزول، ومواجهتهم للرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، جهود الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله والمؤمنين به، معارضة المشركين والأعداء، مِن قبيل اتّهام الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله بأنّه ساحر، ثمّ بناء المجتمع والحضارة الإسلاميّة؛ دليل على تحقّق الفعل الكلامي؛ أي الحوار الحقيقي، الذي يمكن فهمه بين النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله والناس، وهو ما يتعارض مع كون النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وسيلة [لنقل] لفظ ومعنى القرآن الكريم، ودليل على أنَّ القرآن الكريم هو كلام الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، لا كلام الله تعالى.
بغضّ النظر عن الإشكالات المختلفة التي ترِد على هذا التصوّر، جدير بالقول إنَّ، أوّلًا: كما تقدّم سابقًا، فإنَّ جميع شروط التخاطب والتفاهم اللغويّ تنسجم مع الدور التبليغي للرسول، وتصادق الفلسفة المعاصرة للغة، التي هي مرتكز تصوّر مجتهد شبستري، على هذه المسألة. ثانيًا: بالإضافة إلى كون
النبيّ وسيلة لإبلاغ الوحي، فإنَّ للرسول شؤونًا أخرى أيضًا، ترافقت مع جهوده ومساعيه، إلّا أنَّ جميع هذه الشؤون هي في طول الدور الرسالي له صلىاللهعليهوآله. ثالثًا: بناء على نظريّة أفعال الكلام، فإنَّ معنى الفعل مُتَضَمَّن في الكلام، وكيفيّة تعامل المخاطبين، مِن قبيل اتّهامهم الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله بأنّه ساحر و... هي مسألة خارجة عن [موضوعة] المعنى ومقام التفاهم. على كلّ حال، سواء اعتقد أحد بأنَّ هذه المسألة داخلة في المعنى أو خارجة عنه، فالقدر المُتيَقَّن هو أنَّه لا يمكن مِن هذا الطريق استنتاج بشريّة الوحي الرسالي والقرآن الكريم.
أفعال الكلام تعني أنَّ أفعالًا مِن قبيل: إبداء الجمل، الأمر أو السؤال، الوعد و... تتحقّق مِن خلال قواعد خاصّة موجودة مِن أجل استعمال العناصر اللغويّة.
ليس المراد بالقواعد التي تمهّد لإمكانيّة القيام بأفعال الكلام، المواضعات الجزئيّة للغات المختلفة؛ كالفارسيّة والعربيّة والإنجليزيّة، بل المراد هو تلك المجموعة مِن القواعد التأسيسيّة والمباني الحاكمة على التكلّم بنحو عام. على سبيل المثال، الفعل الكلامي «الوعد»، هو في العرف الإنساني نمط مِن العهد والالتزام، والتعهّد بأداء وظيفة. يقال في الفارسيّة مِن أجل تحقّق فعل الكلام هذا: «من قول مىدهم...» [أنا أعِدُ...]، يجب أنْ يقال بالإنجليزيّة: «I promise…»، ويقول الفرنسيّون: «Je promets…». بناء عليه، فإنّ
(307)اللغات المختلفة تؤدّي فعلًا كلاميًّا واحدًا باستخدام ألفاظ مختلفة وأنماط صرفيّة ونحويّة متنوّعة. يشير هذا الأمر إلى أنَّ تحقّق الفعل الكلامي «الوعد»، يرتبط بالواقع الاجتماعي والمرتبط بالمؤسّسة؛ أي اعتبارات وقواعد عقلانيّة ماوراء اللغة وعالميّة، بحيث إذا أدّى متكلّمو كلّ لغة العلامات اللغويّة الدالّة على الوعد، بما يتطابق معها، فإنَّ ذلك يُعدّ وعدًا. لأجل ذلك، شدَّد أوستن وسيرل في تحقّق المعنى، بالإضافة إلى قصد التكلّم والقواعد الصرفيّة والنحويّة لكلّ لغة، على دور المؤسّسات الاجتماعيّة؛ أي اعتبارات وقواعد ما وراء اللغة، ورأيا أنّه في تحليل المعنى، يجب أيضًا أخذ حصّة القواعد التي تحكم اللغة بعين الاعتبار.
يطرح الآن هذا السؤال: هل يمكن لقاعديّة اللغة وارتباطها بالقواعد التأسيسيّة، التي هي أهمّ ركن اجتماعي للّغة، أنْ تُعدّ بمثابة مانع لتكلّم الله جلّ جلاله؟ الجواب هو: لا، أبدًا! ذلك لأنَّ هذه القواعد هي مجموعة اعتبارات وقواعد وضعيّة، تتحكّم في حيازة أفعال كلام المستخدمين للمعنى، ولن تتحقّق مِن دونها النتائج المرجوّة مِن اللغة. لا تدلّ هذه المسألة، كما المسائل السابقة، على أزيد مِن هذا: أنّه إذا تكلّم الله تعالى أيضًا، فإنَّ هذه القواعد ستكون مؤثّرة، وسيكون التواصل اللغويّ، علمنا أم لم نعلم؛ واقعًا تحت تأثيرها. المثير أنَّ أغلب مستعملي اللغة، يتحدّثون مِن دون علم بهذه القواعد، وينظِّمون أفعالهم الكلاميّة مِن دون أدنى مشكلة. إذا كان الأمر
كذلك، فالله الذي ليس أنَّه، وحسب، عالمٌ بجميع المواضعات اللغويّة للناس، بل هو الذي مكَّن الإنسان مِن هذا الأمر، وأنعم عليه بنعمة البيان؛ مِن باب أولى أنْ يكون قادرًا على إيجاد التواصل اللغويّ.
بالإضافة إلى مباني نظريّة أفعال الكلام، فإنَّ المسألة الأخرى التي يشدِّد عليها مجتهد شبستري، هي الجانب الحواري والجدلي للمعنى.
المراد بحوار أو جدليّة المتكلّم والسامع، هو في احتمال أنْ يحمل كلام وقصد المتكلّم شطرًا مِن المعنى، وأنْ ينتج السامع الشطر الآخر. أمر كهذا هو خلاف ما تفاهم عليه مستعملو اللغة، ولا يدلّ عليه أيّ مبنى مِن مباني نظريّة أفعال الكلام. الاحتمال الآخر هو أنْ يكون دور السامع هو مرافقة المتكلّم خطوة بخطوة، وتلقِّي الجمل والتمعُّن فيها فقط، واكتشاف قصد المتكلّم. تتوافق أيضًا توضيحات مجتهد شبستري مع هذا المعنى. بعد تبيينه أنَّ كلّ كلام شفاهي هو «نشاط إنساني» يتضمّن «حيثًا» التفاتيًّا وقصديًّا، يضيف:
إنَّه ليس فقط أنا المتكلّم الذي يؤدّي حركة «المُضِي»، السامع شريك هو أيضًا في هذه الحركة، والفهم نفسه هو فعل مُضِي. ينتظر السامع دائمًا [ليعرف] ما هي غاية المتكلّم، وما هو قصده، وإلى أين سيصل. هذا الانتظار، ومتابعة حركة المتكلّم لحظة بلحظة، هو فعل «مُضِي السامع».
مِن المناسب الآن أنْ نسأل: ما هو الفرق مِن هذه الناحية بين اللغة الكلاميّة والكتابيّة، وما هي التحفة الجديدة في هذا المجال التي اتحفتنا بها فلسفات اللغة التي يعتمد عليها مجتهد شبستري؟ على فرض المعنى في اللغة الكلاميّة، أو أنْ يكون التواصل اللغويّ بنحو عام، حصيلة تعاطي المتكلّم والسامع؛ فهل تحدث هذه المسألة مشكلة في التكلّم الإلهي إلى درجة أنّه يلزم على أساسها الاعتقاد بأنَّ القرآن كلام النبيّ في اللفظ والمعنى؟ أم أنَّه لا تأثير لها في هذا المجال؟ وعلى فرض الصحّة، فليست مانعًا لتكلّم الله تعالى وإلهيّة القرآن الكريم. بناء على وجهة نظر مجتهد شبستري، كما قلنا فيما تقدّم، فإنَّ أركان التواصل اللغويّ مِن قبيل المتكلّم والسامع و... غير موجودة في أنَّ القرآن إلهيّ، وسيكون إنتاج المعنى أمرًا غير ممكن. لكنّ هذه المسألة أُخذت سابقًا بعين الاعتبار مِن حيث فقدان المتكلّم، وهي تؤخذ الآن مِن حيث فقدان السامع؛ إذا لم يكن لي أنا المتكلّم أيُّ مخاطب، فلن أتمكّن مِن إنتاج المعنى، إلّا إذا افترضت لنفسي عدّة مخاطبين فرضيين، أو تحدّثت مع نفسي. أساسًا، إنَّ التكلّم له حقيقة حواريّة وتخاطبيّة.
يبدو أنَّ كلامًا كهذا أيضًا لا يمكن له أنْ يكون حجّة لمجتهد شبستري في الاعتقاد ببشريّة القرآن الكريم؛ ذلك لأنَّ كون القرآن الكريم هو كلام الله تعالى أو كلام الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله؛ لا يشكّل فرقًا كبيرًا مِن ناحية المخاطب. وفرقه الوحيد هو أنّه إذا كان القرآن الكريم كلامًا نبويًّا، فإنّ أناسًا آخرين أيضًا غير الرسول، هم مخاطبوه، أمّا إذا كان إلهيًّا، فإنّ الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله
هو أيضًا من ضمن المُخاطَبين، وتتّسع دائرة المُخاطَبين، إلّا إذا كان للسيّد مجتهد شبستري تعريفه الخاصّ للمخاطَب، وهو أمر جدير بالبحث بشكل منفصل.
كان المدَّعى الأساسي لمجتهد شبستري أنّه بناء على نظريّة أفعال الكلام، ففي الفلسفة المعاصرة للّغة، سيكون الاعتقاد بإلهيّة القرآن الكريم، لفظًا ومعنًى، مساويًا لنفي جميع الأركان الحتميّة للّغة، مِن قبيل: محور المتكلّم، السامع و... ولا مفرّ مِن أنْ نعتقد بأنَّ القرآن الكريم هو كلام الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله لفظًا ومعنًى. أمّا ما نتوصل إليه مِن خلال تحليل بعض ادّعاءات مجتهد شبستري ونظريّة أفعال الكلام، فهو الآتي:
1. اعتماد مجتهد شبستري على النظريّات المعاصرة لفلسفة اللغة، خالٍ مِن أيّ استدلال وتفسير منطقي، بحيث وكأنّه مِن وجهة نظره، فإنَّ محض ظهورها [النظريّات] في العصر الحديث، ولأنَّها مقبولة لدى بعض فلاسفة الغرب؛ كافٍ للدعوة إلى قبولها وقبول نتائجها، والإعراض عن الحتميّات المعرفيّة والدينيّة.
2. لا شيء مِن أركان ومباني نظريّة أفعال الكلام، مِن قبيل: 1. مبنى إمكانيّة التعبير، 2. تعلّق المعنى بقصد المتكلّم والاتّفاقات اللغويّة، 3. التنوّع المتزامن لأفعال الكلام، 4. تساوق المعنى الكامل للجملة مع الفعل المُتَضَمَّن في الكلام، 5. قاعديّة اللغة وتأثّرها بالوقائع المؤسسيّة واعتبارات ما وراء اللغة، ليس لديها أدنى تعارض مع الرأي
السائد بين المسلمين في مجال كون الوحي القرآني إلهيًّا، لفظًا ومعنًى، وهي تتناغم معه بشكل كامل.
3. بالإضافة إلى الاعتماد غير المعقول على النظريّات المعاصرة لفلسفة اللغة، ارتكب مجتهد شبستري مغالطات مِن قبيل: مغالطة القياس مع الفارق، واستدلالات معتلّة وعقيمة. مِن قبيل أنّه تصور أنَّ تبليغ رسالة الله جلّ جلاله مِن خلال الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، يستلزم الاعتقاد بأنَّ الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله كببغاء أو كمكبّر صوت، وأنّه يفتقر إلى أوّل أركان التواصل اللغويّ.
4. تفتقر بعض ادّعاءات مجتهد شبستري إلى التوضيحات الكافية، ويمكن أنْ تشتمل على استعمال غير صحيح ومُتَكَلَّف للعبارات، وخالٍ مِن الثمرة فيما يتعلّق بالاعتقاد ببشريّة القرآن الكريم. مِن هذا القبيل، يمكن تبيين نظريّة حواريّة أو جدليّة المعنى.
النتيجة، هي أنَّ جميع استنادات مجتهد شبستري على نظريّات فقه اللغة فيما يتعلّق بالاعتقاد ببشريّة القرآن الكريم؛ غير صائبة، ومتكلَّفة وتحميليّة، كما اتُّهم مِن قبله أيضًا نصر حامد أبو زيد بسوء فهم نظريّة سوسّور في فقه اللغة، وتحمليها على نظريّات معرفة القرآن.
- أحمدي، بابك، ساختار و تأويل متن (هيكليّة وتأويل النصّ)؛ طهران، منشورات مركز، 1370.
- توكلي بينا، ميثم، «بررسی تطبیقی آرای ابوزید و فردینان دو سوسور» (دراسة مقارنة لآراء أبو زيد وفرديناند دو سوسّور)؛ مجموعه مقالات جریانشناسی و نقد اعتزال نو (مجموعة مقالات معرفة ونقد تيار الاعتزال المعاصر)، ج4، طهران، منشورات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
- جون ر. سيرل أفعال گفتاري، ترجمة محمّد علي عبدالله، قم، منشورات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
- عبداللهي، محمّد علي، «نظریه افعال گفتاری»؛ مجلة پژوهشهای فلسفی ـ کلامی، عدد 24، 1384.
- مجتهد شبستري، محمّد، اللغة الدينيّة خالية مِن العنف، وسلامة المجتمع (محاضرة)، 16/09/2014،
- http://mohammadmojtahedshabestari.com/
- ــــــــــ ، «قرائت نبویح از جهان» (قراءة نبويّة عن العالم)؛ مجلّة مدرسة، العدد 6، 1386.
- Austin J.L.; How To Do Things With Words; Oxford University
- Press, 1962.
- Frege, G.; Die Grundlagen der Arithmetik; Breslau, 1884.
- Keller, Albert; Sprachphilosophie; 2. Allaye 1989, Verlay Karl
- Alber Freibury/ Muncher.
- Lepor, Ernest and Van Gulick (eds.); John Searle and His Critics; Blackwell, 1991.
(313)- Rosenberg, Jav F. and Travis, Charles (eds); Reading in The Philosophy of Language; Prentice-Hall inc. Inglewood cliffs, New Jersey, 1971.
- Searle, John; “Austin on Locutionary and Illocutionary Acts”; in: Travis and Rosenberg (eds.); 1971.
- ________; Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language; Cambridge University Press, 1969.
(314)قاسم ترخان
مِن جملة الموضوعات التي تطرّق إليها محمّد مجتهد شبستري، مسألة عصمة النبيّ الاكرم صلىاللهعليهوآله. ومِن خلال تقديمه لتفسيرٍ خاصٍّ حول مسألة العصمة، فقد حاول برهنة هذا التفسير والاستدلال عليه عن طريق الاستشهاد بشواهد نقليّة وسيرة الأولياء والمبنى الذي قبله بالنسبة لعلم النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ورغم التخبّط والارتباك في كلام شبستري حول هذه المسألة، فقد حاولت هذه المقالة، مِن خلال عرض تقرير رؤيته وأدلّته في بنيةٍ منظّمة؛ نقدها وتحليلها. وقد وصل هذا البحث إلى نتيجةٍ مفادها، أنّه فضلًا عن عدم توافق مباني شبستري وتفسيره للعصمة، فالأدلّة المقدّمة منه أيضًا تواجه تحدّياتٍ جدّية، وليس لديها قدرة إثبات إدعائه.
مِن الموضوعات المهمّة في علم الكلام، والتي طُرحت دائمًا حولها الأسئلة والشبهات في المجتمع الاسلامي، وشغلت بها المحافل العلميّة والنخبويّة، وقدّم علماء المسلمين حولها العديد مِن النظريّات؛ هي مسألة عصمة الأنبياء والأئمّةعليهمالسلام.
ومِن جملة المفكّرين المعاصرين، محمّد مجتهد شبستري الذي تطرّق إلى هذا الموضوع، وطرح نقاطًا مثيرة للجدل في الكلمة التي ألقاها في الثالث مِن شهر اسفند 1387 (21 شباط 2009) بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله في جامعة أصفهان الصناعيّة تحت عنوان «توقّعنا مِن الأنبياء»، ومِن ثَمَّ في فروردين 1388 (ربيع 2010)، في الإجابة على النقد الذي وجّهه آية الله السبحاني إليه بتاريخ 26 اسفند 1387 (3 آذار 2009).
ورغم التخبّط والارتباك في كلام مجتهد شبستري بهذا الشأن، تحاول هذه المقالة، مِن خلال عرض تقرير رؤيته وأدلّته في بنيةٍ منظّمة؛ نقدَها وتحليلها.
رغم أنّ مجتهد شبستري لا يعتبر نفسه منكرًا لعصمة النبيّ، إلّا أنّه وفقًا لمبادئ الوحي والإلهيّات، يفسّر العصمة على النحو الآتي: الوظيفة الأساس للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله هي الدعوة إلى الله الواحد، وهو، أي النبيّ، معصومٌ في أداء هذه الوظيفة؛ أي إنّه لم يدعُ أبدًا إلى حياةٍ غير موحّدة، ولم ينحرف أبدًا عن هذا المبدأ. وعلى هذا الأساس، إذا لم يؤدِّ ارتكاب النبيّ صلىاللهعليهوآله للمعصية إلى الإضرار بتلك
الدعوة الأساس، عندها لا تواجه الدعوة أيّة مشكلة، وهناك أدلّة تدعم ذلك.
كذلك، وبناءً للمبنى القائل أنَّ علم النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام هو فقط ما بيّنوه وعبّروا عنه، لا يرى مجتهد شبستري العصمةَ العلميّة ضروريّة لهم. فهو يعتبر أنَّ الذهاب إلى أبعد مِن هذه الحدود، إخراجٌ لأئمّة الدين مِن دائرة الإنسانيّة والغلوّ بشأنهم؛ إذ يعود جذور هذه المسألة إلى تأثّر علم الكلام الإسلامي والثقافة الإسلاميّة بعقيدة التجسّد في المسيحيّة.
بالنسبة لكلام مجتهد شبستري حول تأثير مسألة التجسّد في المسيحيّة على الثقافة الإسلاميّة؛ أوّلًا: هو ادّعاء لم يقم أيّ دليلٍ عليه. بينما في النقطة المقابلة، يوجد أدلّة واضحة على تأثّر بحث العصمة بالأبحاث القرآنيّة ـ الروائيّة وحكم العقل. فالقرآن الكريم ومِن دون استخدام كلمة «العصمة»، وبتصريحاتٍ متنوّعة، قد برّأ الأنبياء والأولياء مِن أيّ نوعٍ مِن الذنب والخطأ. ويقول النبيّ صلىاللهعليهوآله في تفسيره لآية التطهير:
«فأنا وأهل بيتي مطّهرون مِن الذنوب».
كذلك يقول صلىاللهعليهوآله:
«أنا وعلي عليهالسلام والحسن والحسين عليهماالسلام وتسعةٌ مِن وُلد الحسين مطّهرون معصومون عليهمالسلام».
كما يشير أمير المؤمنين علي عليهالسلام إلى حقيقةِ أنّه لا ينبغي على الله تعالى جلّ جلاله الأمر بالطاعة المطلقة لشخصٍ لا يكون في مأمنٍ من التلوّث بالذنب، إذ يقول عليهالسلام :
«إنّما أمر الله عزّ وجلّ بطاعة الرسول؛ لأنّه معصومُ مطهّرٌ لا يأمر بمعصيته، وإنّما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنّهم معصومون مطّهرون لا يأمرون بمعصيته».
ومع ذلك، لماذا لا يعتبر مجتهد شبستري نفسه متأثّرًا بهذه النصوص بما يتجاوز ما قَبِله هو نفسه مِن معنى العصمة، ويستند إلى عقيدة تجسّد المسيحيّة؟ ألا تتمتّع هذه النصوص بالسِعة والقوّة لكي يُستفاد منها عصمة الأنبياء والأئمّة عن أيّ نوعٍ مِن المعصية والخطأ؟
فضلًا عن ذلك، يواجه هذا الادّعاء تحدّيًا، هو أنّ علماء المسيحيّة يعتبرون المسيح هو الله أو جزءًا مِن الله الثلاثي الأقانيم؛ في حين أنّ موضوع بحث العصمة في الثقافة الإسلاميّة، هو الإنسان وليس الله. بعبارةٍ أخرى: رغم أنَّ الإماميّة تعتبر الأنبياء والأئمّة إنسانًا، ولكنّها تثبت لهم مقاماتٍ مثل العصمة. وهذا الأمر يدلّ على أنّ الإنسان لديه القدرة على أنْ يصبح ربانيًّا وإلهيًّا، وليس إلَه.
مِن الواضح جدًّا أنّ رؤية مجتهد شبستري حول العصمة على أساس تعريفٍ خاصٍّ للوحي والدين، وبغضّ النظر عن الانتقادات الواردة على مبناه في معرفة الوحي والدين، السؤال المطروح هو: ما هي مستلزمات هذه المباني حول العصمة؟
1. فيما يخصّ تعريفه للوحي، يقول:
«لقد وصلنا في هذا البحث إلى نتيجةٍ، مفادها أنّ ذلك النبيّ الذي جاء بالقرآن الكريم، لم يدّع أنّ القرآن الكريم ليس بكلامه فحسب، بل قدّمه على أنّه كلامه. إذن، ما هو ادّعاؤه الذي لم يقبله المعارضون؟ لقد كان ادّعاؤه أنّه إنسانٌ خاصٌ اختاره الله تعالى وبعثه بناءً لتجربته؛ أي تجربة النبيّ، وجعله قادرًا على قول هذا الكلام (تلاوة القرآن) عن طريق الوحي. وهذه القدرة على الكلام تُدعى، بحسب القرآن، الوحي.
ويُستنتج مِن مجموعةٍ مِن آيات القرآن الكريم أنّ ادّعاء النبيّ هو أنّ ما كان يقرؤه، إنّما هو نتيجة الوحي؛ بمعنى أنّه على أثر الوحي أصبح قادرًا على قول مثل هذا الكلام. في القرآن الكريم، الوحي هو نفس تلك الإشارة والاستثارة (التحفيز) اللتين هما مِن فعل الله تعالى. ولم تُستخدم تلك الإشارة والإستثارة مع الأنبياء فقط؛ على سبيل المثال، الحركة الغريزيّة للنحل سُمّي في القرآن
الكريم بـ «وحي الله»: ﴿وَ أَوْحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بُيُوتًا وَ مِن الشَّجَرِ....﴾. من جهةٍ أخرى، جاء في الآية 51 مِن سورة الشورى:﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُُ...﴾. في هذه الآية، الوحي هو نوعٌ مِن فعل التكلّم مباشرةً أو الوحي عبر الرسول (الملاك) الذي يمكن إسناده إلى الله تعالى. وعبر الجمع بين مفاد هذه الآية والنقاشات السابقة، يمكن القول إنّه مِن وجهة نظر القرآن الكريم، الوحي هو تكلّم الله تعالى مع نبيّ الإسلام صلىاللهعليهوآله الذي كان سببًا لبعث النبيّ، وتكلّمه يعني قراءة آيات القرآن الكريم. وآيات القرآن الكريم هي محصول الوحي وليس الوحي بذاته. وفي الوقت نفسه، فإنَّ هذه الآيات منسوبة أيضًا للنبيّ الذي سببها الطبيعي، وهو المتحدّث بهذا الكلام، وهي أيضًا كلام الله تعالى؛ كما جاء ذلك في الآية 6 مِن سورة التوبة: ﴿إِنْ أَحَدٌ مِن الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ﴾؛ لأنَّ الله تعالى جعله بوحيه قادرًا على هذا الكلام.
ومِن الممكن أنْ نتصوّر أنّ تكلّم الله تعالى مع نبيّ الإسلام صلىاللهعليهوآله عن طريق الوحي، هو نوعٌ مِن التعليم الإلهي عبر تواصلٍ لغوي خاصّ. ولكنْ مِن المسلّم به، هو أنّ التكلّم الإلهي مهما كان، فهو ليس مِن نوع التواصل اللغويّ ـ الإنساني؛ لأنّه غير متوفرٌ في تلك الساحة مقدّماتِ التواصل اللغوي ـ الإنساني، ولذلك السبب لا يمكن أنْ نمتلك تصوّرًا حول حقيقة ذلك التكلّم (الوحي)».
وفي مقالةٍ أخرى، يقول:
صحيح أنَّ مقالة «القراءة النبويّة للعالم» ليست نظريّة حول حقيقة كلام الله تعالى، ولكنّي قلتُ هناك، مستندًا إلى بعض آيات القرآن. إنَّ الكلام الإلهي النازل على نبيّ الإسلام وفقًا للقرآن، هو ذاته ما يسمّى بـ «الوحي» في القرآن. ويمكن القول إنّه ما يُفهم مِن القرآن، أنَّ الوحي كان هو سبب تكلّم النبيّ في المصحف، أو أنَّ المصحف يحتوي على كلام الله، أو أنَّ المصحف هو نتاج الوحي، وما شاكل مِن هذه التعبيرات. ولكنْ، لا يمكن القول إنَّ المصحف هو كلام الله عينه؛ فقد ذكرتُ في تلك المقالة أنّه، بناءً للقرآن، كان النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله يخوض التجربة، وأنّ الله هو الذي مكّنه «بطريقةٍ خاصّة» مِن تجربة تمام آيات الله في جميع أنحاء العالم، وأنْ يفهمها بطريقةٍ «موحِّدَة».
فهو باستشهاده بهذا الكلام، لا ينسب هذا الادّعاء، بأنّكم تعتبرون القرآن الكريم مِن صنع البشر، إلى نفسه ویقوم بإنكاره (م.س.، 1388).
وسؤالنا هو: ما المراد مِن هذا التمكين؟ وما هي وظيفته في بحث العصمة ووسعته؟ وإذا كان القرآن هو نتاج الوحي، والوحي هو تمكينٌ خاصّ، هل هذا التمكين في كلّ القرآن، أم في ذلك الجزء منه الضامن للهدف الأساس؟
إنّ قبول الاحتمال الثاني ـ أنّ جزءًا مِن القرآن الكريم هو نتاج تمكين الله تعالى؛ وفي النتيجة يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله معصومًا في الهدف الأساس ـ يعني أنّ
جزءًا مِن القرآن الكريم هو مِن صنع البشر؛ على هذا الأساس لا یمکنکم القول إنّكم لا تعتبرون القرآن الكريم مِن صنع البشر.
وإذا قبلنا الاحتمال الأوّل (عدم تخصيص التمكين الخاصّ فيما يتعلّق بالهدف الأساس)، ورغم توافقها مع عبارة أنَّ القرآن الكريم هو نتاج الوحي، ولكنْ يلزم مِن ذلك أمرٌ لن تقبلوه. بعبارةٍ أخرى: يلزم مِن هذا الاحتمال أنْ تكون تجربة وقراءة جميع القرآن الكريم معصومًا ولا يختصّ فقط بهدفٍ أساس.
ورغم أنّه مِن منطلق مبادئه، يمكن له القول إنّه في الأحكام الاجتماعيّة للقرآن الكريم، وعدم وقوع الخطأ فيها، إلّا أنّها خاصّة بمجتمع زمن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله؛ لأنّ الوحي قد مكّنه مِن إحضار أحكامٍ لذلك المجتمع مِن دون خطأ، ولا يوجد أيّ تلازمٍ بين هذا الأمر وفاعليّة هذه الأحكام في المجتمعات الأخرى. ولكنْ ماذا عن الأحكام في القضايا العلميّة؟ هل يمكن لشبستري طرح الاستدلال نفسه فيما يخصّ المسائل العلميّة؟ نعم، علم الناس في ذلك الزمن كان محدودًا، ولكنْ لا يمكن القول بأنَّ هذا الكلام ينطبق أيضًا على المستوى العلمي لذلك الزمن، ويمكن وقوع الخطأ في هذه المجموعة مِن القضايا، وإذا ما قبلنا هذا الأمر، لما كنا اعتقدنا بدورٍ ووظيفةٍ للتمكين الخاصّ أو الوحي.
فضلًا عن أنّه يجب أنْ يحدّد ما مقصوده مِن التمكين الخاصّ؟ هل يقصد أنّ النبيّ على أساس الإرادة التكوينيّة الإلهيّة قام بهذه التجربة والقراءة، وهو لم يستطع التخلّف عنها والقيام بالتجربة والقراءة بطريقةٍ أخرى، أم أنَّ مثل هذا الأمر غير ممكن؟
بمقتضى الشبه الذي أوجده بين الوحي الإلهي إلى الرسول (الملاك)
(322)والوحي الإلهي إلى النحل، وكذلك تكلّم الله تعالى مع الرسول في عمليّة الوحي، وتكلّم الله تعالى في مكانٍ قد اُستخدم بمعنى الخلق؛ يجب الاعتقاد بأنّها أمورٌ تكوينيّة ولا يوجد شيءٌ دخيل فيها إلّا الإرادة الإلهيّة. وفي هذه الحالة، يجب الاستنتاج بعصمة النبيّ المطلقة؛ لأنّ ما يجري في قالب هذا الوحي على لسان النبيّ، حتّى مع فرض أنّ القرآن هو كلام النبيّ، يجب أنْ يكون ما أراده الله تعالى نفسه. والشاهد على هذا الأمر، أنَّ شبستري يعتبر النبيّ بمثابة العلّة الطبيعيّة للقرآن، وبالتأكيد إنَّ العلّة الطبيعيّة لا تتخلّف عن الإرادة والتقدير الإلهي. وفقًا لهذا المبنى، ما معنى هذا الكلام وهدفه:
«القرآن هو قراءة (فعل القراءة) نبويّة للعالم، طبعًا في تمام هذه القراءة، تمّ الكشف عن شخصيّة النبيّ الاكرم صلىاللهعليهوآله بأشكالٍ مختلفة .... أوصاف الجنّة وجهنم، اللحن الرحيمي أو الغضبي لبعض الآيات، التشدّد مع الكفّار والكثير مِن مواصفات هذا النصّ الأخرى، هي مرآةٌ لخُلق نبي الإسلام وكيفيّته».
ومقتضى هذا الكلام أنَّ نصّ آيات القرآن ليست كلّها محلّ تأييد الله تعالى؛ وهذا يعني أنّ مجتهد شبستري لا يعتبر الوحيَ يؤدّي إلى صدور الآيات المصون عن الخطأ، بسبب تأثير مزاج وطباع النبيّ الأكرم في القرآن الكريم.
وإذا ما طرح الاحتمال الثاني، وقال إنّه لا يمكن مِن صرف التمكين الفهمَ بعدم وقوع الخطأ، وكأنّما يقول إنّ الله قد مكّن فردًا مثل يزيد، ولكنْ ليس
مِن مقتضى هذا التمكين عدم وقوع الخطأ مِن قِبله؛ وفي هذه الحالة هل يمكن بالاستناد إلى هذا التمكين دفع هذا الادّعاء عن نفسه بأنّه لا يعتقد أنّ القرآن هو مِن صنع البشر؟
والسؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن جمع هذا التعارض؟ وأساسًا، إنَّ الإصرار على «تمكين النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله مِن قِبل الله تعالى في عمليّة الوحي» أو «اعتبار القرآن الكريم كلام الله باعتبار هذا التمكين»، مادام أنّه لن يتضمّن المقبوليّة الكاملة لمضمون القرآن مِن عند الله ولن ينتهي إلى القول بالعصمة المطلقة للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله؛ فما هي النتيجة؟ هل يمكنه بالاستناد إلى ذلك عدم اعتبار القرآن مِن صنع البشر، ومِن جهةٍ أخرى ینکر العصمة المطلقة ويعترض على مضمون القرآن؟
2. وفي كلمته نفسها حول فهمه للدين، يعتبر الدين سلوكًا معنويًّا. وبتعبيرٍ أكثر وضوحًا: الدين عبارة عن الشعور بالاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس، مِن وجهة نظره الدين هو فقط أمرٌ داخلي وتجربةٌ شخصيّة.
في الواقع، إنّ مِن أسّس لهذه النظرة إلى الدين هو شلايرماخر الذي كان يعتبر الوحي مساويًا للتجربة الدينيّة المشتركة بين البشر (الانكشاف الداخلي لله على الإنسان). وبهذه النظرة، سعى إلى نقل مَسند الدين مِن
الكتاب المقدّس إلى القلب، ملجأ المؤمن، حتّى ينجّي بنظره أساس المسيحيّة مِن خطرٍ جدّي.
السؤال هو: ما وظيفة هذا المبنى في بحث العصمة؟ وبصرف النظر عن الإشكالات الواردة على هذا المبنى، حتّى لو قبلناه، فما هو الدليل على أنّه لم تقع تجربة النبيّ في الخطأ والشبهة فيما يخصّ ذلك الهدف الأساس، ومِن ثمَّ في بيان تلك التجارب في قالب الألفاظ والكلمات؟ مِن دون شكٍّ، إنَّ النبيّ يحتاج إلى ارتباطٍ ماورائي والذي عُبّر عنه في تعابيره ـ شبستري ـ بالوحي أو بالتمكين... مِن هنا، يجب طرح ذلك البحث مجدّدًا بأنّه ما النتيجة التي يستتبعها هذا التمكين؟
لقد طُرح العديد مِن الأدلّة في كلام مجتهد شبستري على الادّعاء القائل إنّه يمكن صدور الخطأ والذنب مِن إنسانٍ نبيّ. وسوف نلخصّها كما يلي:
يعتبر مجتهد شبستري أنّ ارتكاب المعصية مِن قِبل النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله مسألةٌ خلافيّة بين علماء المسلمين. ويوضحّ ذلك بالقول إنّه رغم اعتقاد الإماميّة بوجوب حصانة الأنبياء عن ارتكاب الذنوب الكبيرة والصغيرة، إلّا أنّ الكثيرين مِن المتكلّمين البارزين عند أهل السنّة، يقولون بإمكانيّة الجمع بين ارتكاب الذنوب الصغيرة و العصمة. على سبيل المثال، يعتبر المعتزلة أنّه مِن الجائز ارتكاب الأنبياء
(325)
للذنوب الصغيرة عن طريق السهو أو التأويل أو على أساس أنّ ثوابهم الكبير يجبر ذنوبهم. وكذلك قال الأشاعرة والحشويّة بجواز ارتكاب الأنبياء للذنوب الصغيرة والكبيرة، ما عدا الكفر والكذب. وفي كلامٍ له ـ شبستري ـ حول شرح المواقف، ينقل كلامًا أنَّ فِرق الشيعة لم تعتبر ارتكاب الأنبياء لأيّ نوعٍ مِن الذنوب الكبيرة منها والصغيرة أمرًا جائزًا؛ في حين أنّ جمهور متكلّمي الإسلام ـ ما عدا الجبائي ـ أجازت ارتكاب الذنوب الصغيرة عمدًا.
ويعتبر شبستري أنَّ منشأ هذه الاختلافات هو بعض آيات القرآن مثل تعبير «عصى» بالنسبة للنبيّ آدم صلىاللهعليهوآله و﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ حول النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآله والتي تصرّح بارتكاب الذنب. ويستدلّ أنَّ القرآن الكريم يقدّم النبيّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله على الشكل الآتي:
﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.
وهذا يعني أنَّ النبيّ مثلنا نحن البشر ولديه نفس تعلّقاتنا، ميولنا ورغباتنا ونقاط ضعفنا، ويجب عليه مثلنا إخراج نفسه مِن الأوهام، الخيالات والظلمات.
وعندها ينقل هذه الرواية كمؤيّدٍ لكلامه، وهي أنَّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال: «أنّه
ليُغان على قلبی وإنّي لأستغفر الله كلّ يومٍ سبعين مرة».
في هذه الرواية، يوضّح النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّ الظلمات تحيط بداخلي، وأنا أستغفر الله كلّ يومٍ 70 مرّة لإزالتها ورفعها. والاستغفار وطلب المغفرة بمعنى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يطلب ستر داخله بالله تعالى حتّى لا يكون فيه إلّا الله. وهذه إحدى الفضائل الكبرى للنبي صلىاللهعليهوآله؛ أنّه كان يجاهد نفسه وينصَب في إزاحة الظلمات، الأوهام والخيالات.
ويستند شبستري أيضًا إلى مقاطع مِن بعض الأدعية الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام :
««وكم مِن قبيحٍ سترته»؛ أي أنا أشكرك على أنّك سترت عليّ الأعمال غير اللائقة التي رأيتها منّي، أو «اللهم اجعلني خيرًا ممّا يظنّون بي»؛ أي اللهم اجعلني أفضل ممّا يتصوّر الناس حولي، يعني أنا لست كما يتصوّرني الناس، فهم يظنّون أنّي كلّي نورٌ، ولكنّي أنا أعلم أنّي لست كذلك، لذا اجعلني أفضل مِن ذلك».
كما أشار مجتهد شبستري إلى أنّه في القرون الأولى مِن تاريخ الإسلام، ظهرت مجموعة بين المتكلّمين المسلمين، مثل «الحشوية» مِن أهل السنّة، الذين كانوا
يستشهدون بالظواهر الأوليّة لبعض الآيات، ولم يعترفوا بعصمة الأنبياء مِن الذنوب؛ في حين أنّ المحقّقين الشيعة، مثل السيّد المرتضى قدسسره في كتاب «تنزيه الأنبياء»، وكبار علماء أهل السنّة، مثل الفخر الرازي في كتابٍ مشابهٍ؛ قد عملوا على إثبات العصمة مِن منظور العقل والنقل، وفسّروا الآيات التي كانت ذريعةً بيد المنكرين بشكلٍ صحيح. وتوضيح هذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى مقالةٍ مستقلّة. ولكنْ، بالإجمال يجب القول، رغم وجود آياتٍ في القرآن يفيد ظاهرها ارتكاب الأنبياء للمعاصي، مثل معصية النبيّ آدم عليهالسلام : ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ أو ما ورد حول نبي الإسلام:﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾؛ ولكنَّ الإجابة الكليّة على كلّ ذلك، هي أنّه إذا تعارض الدليل العقلي القطعي مع ظاهر الآيات، يجب التخلّي عن ذلك الظاهر. على هذا الأساس، قيل في آية: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ أنّه لم يكن يراد المعنى الظاهري، بل المراد مِن ذلك هو قدرة الله وسيطرته تعالى. وفي بحث العصمة، انطلاقًا مِن أنّه ثبت بالدليل العقلي أنَّ الأنبياء معصومون، يجب تأويل الآيات التي يؤيّد ظهورها ارتكاب الأنبياء للذنب وعدم الاستناد إلى هذا الظهور، فضلًا عن أنّ العصيان لا يعني دائمًا الخطيئة والذنب. فالعمل الذي قام به النبيّ آدم عليهالسلام كان مِن باب ترك الأولى، وقد عُبّر عنه بالعصيان؛ لأنّه لم يكن يُتوقّع مِن النبيّ آدم ذلك.
إنَّ قبول ظاهر هذه الآيات، لا يتعارض مع الدليل العقلي فحسب، بل يتعارض مع أدلةٍ نقليّة أخرى؛ لأنّ هناك آياتٍ أخرى تثبت عصمة الأنبياء عن الذنوب، بما في ذلك الصغيرة منها والكبيرة. على سبيل المثال، يدلّ جمع الآيات أدناه على عصمة الأنبياء المطلقة عن المعصية:
أ) ﴿الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾؛ ب) ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾؛ ج) ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾.
إنَّ ما ذكره القرآن الكريم في تعريف النبيّ صلىاللهعليهوآله بقوله أخبر الناس: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ...﴾ هو خلاف ما تظاهر به مجتهد شبستري بأنّه تعبيرٌ عن الشبه الموجود بين النبيّ صلىاللهعليهوآله وباقي البشر العاديين، وإنّما هو معبّر بدقّة عن التفاوت الأساس بين النبيّ والبشر العاديين، وهذا التفاوت هو مِن حيث تلقّيه للوحي مِن الله تعالى. إذاً، النبيّ مِن كلّ جهةٍ هو ليس مثل إنسانٍ عادي. صحيحٌ أنّه لا يختلف في إنسانيّته عن باقي الأفراد العاديين، إلّا أنّه يختلف عنهم في الرتبة الوجوديّة.
إنّ الروايات والأدعية التي استشهد بها مجتهد شبستري، وكما سيأتي توضيحه، هي أعمّ مِن الادّعاء ولا تدلّ على ارتكاب الذنب، وإنّما تدلّ فقط على أنّ للإنسان الكامل حالاتٍ متنوّعة في مسار صعوده إلى الله.
في النظرة الکلاسیکیّة للوحي، تُبحث عن مسألة العصمة على مراحل، مثل تلقّي الوحي وإبلاغ الوحي و...، وتُبنى الأدلّة والبراهين على عصمة الأنبياء. ومؤلِّف هذه المقالة يعتقد بأنّ تلك الأدلّة نفسها، تجري في التفسير الخاصّ لمجتهد شبستري حول العصمة، وتتحدّى حصريّة العصمة في الهدف الأساس.
توضيح ذلك، أنّه في النظرة الکلاسیکیّة، وبالاستناد إلى الأدلّة العقليّة والنقليّة، تثبت العصمة عن الكذب والخطأ للنبيّ أثناء تلقّي الوحي وإبلاغه. ومِن هذه الأدلّة، ذلك الدليل الذي أورده المحقّق الطوسي قدسسره في كتاب «تجريد الاعتقاد» حول العصمة عن المعصية، إذ يقول: «ويجب في النبيّ، العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض» ـ إذا لم يثق الناس فسوف يحصل نقضٌ للغرض. وهذا الدليل رغم إقامته مِن أجل عصمة النبيّ عن المعصية، لكنّه مِن الواضح أنّه يثبت العصمة في المرحلتين المذكورتين. وكذلك بالاستناد إلى الآيات 28 ـ 26 مِن سورة الجن: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾، يُستدلّ أنّ ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ تشير إلى الإبلاغ و﴿مِنْ خَلْفِهِ﴾ إلى التلقّي.
ولكنْ، ما هو موقف مجتهد شبستري بهذا الخصوص؟ بلا شكّ أنّه مع مبناه القائل إنَّ القرآن الكريم هو نتاج وحي وتفسير النبيّ للعالم وليس الوحي نفسه، لن يكون معتقدًا بالعصمة في مرحلة تلقّي الوحي، ويجب
طرح العصمة فقط في مرحلة التفسير، والتي تتطابق مع مرحلة العصمة في إبلاغ الوحي ومرحلة العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العاديّة في النظرة التقليديّة. بالطبع، لا ينبغي له أنْ ينكرالعصمة في مرحلة تلقّي الوحي، إلّا أنَّ فهمه عن الإبلاغ مختلفٌ عمّا نفهمه نحن؛ فهو يعتبر القرآن تفسير النبيّ للوحي، ولذلك يجب السؤال، هل كان النبيّ مبرًأ مِن الذنب والخطأ في هذا التفسير أو في سلوكه في الحياة العاديّة أم لا؟ وجوابه عن ذلك نظرًا إلى الوظيفّة الأساس: نعم. يعني ظاهر كلامه مِن أنَّ النبيّ معصومٌ في دعوته الأساس، هو أنّه معصومٌ في الإبلاغ، أو بحسب تعبيره، في تفسيره للوحي. وفي هذه الحالة، يجب قبول تأثّر النبيّ بثقافة ذلك الزمن، وفي الختام خطئه في غير الدعوة الأساس، ويعتبر القرآن محتملًا للخطأ والذنب في غير دعوته الأساس. بعبارةٍ أخرى: يُستنتج مِن مجموع كلام مجتهد شبستري أنّه مقابل هذا السؤال، ما هي المعصية التي لا تتعارض مع المهمّة الرئیسة؟ ستكون الإجابة: إنَّ ما لا يتعارض مع ذلك الهدف الأساس، هو فقط ارتكاب الذنوب الصغيرة. إذاً، بطريقٍ أولى يجب قبول الخطأ في الحياة اليوميّة والاعتراف بالعصمة عن الذنوب الكبيرة. بناءً عليه، يكمن اختلافنا معه في أنّنا نرى أنّ ارتكاب المعاصي والذنوب حتّى الصغيرة وتمام الأخطاء حتّى في الحياة اليوميّة، سوف يؤدّي إلى نقض الغرض؛ في حين أنّه ينبغي بحسب مبناهان لا يضرّ ذلك بالغرض. هنا يجب العمل على نقد أدلّته في هذا الادّعاء.
وبرهنة هذه المسألة، أنّه بقبول جواز ارتكاب الذنوب الصغيرة أو الخطأ في الحياة اليوميّة، هل سيؤدّي ذلك إلى نقض الغرض ويحدث الاضطراب في تلك الدعوة الأساس؟!
يلاحظ المؤلف أنَّه على الرغم مِن إمكانيّة اختبار نوعين مِن الأغراض الرئيسة والثانويّة، وأنَّ الخطأ في الثاني لا يؤدّي إلى الأوّل، والنقطة هي أنّ تفسير النبيّ وقراءته، وفق قراءة (فهم) مجتهد شبستري للعصمة، هو لهداية الناس أيضًا، ولا يمكن لشبستري إنكار أنَّ الغرض مِن البعثة هو دعوة الناس إلى الهداية. في هذه الحالة، يجب القول إنّه هل سيهتدي الناس مع جواز احتمال الخطأ في الصغائر، أو وفق تعبير مجتهد شبستري ما هو ليس بالهدف الأساس، ولن يسري احتمال الخطأ إلى تلك الدعوة الأساس؟
يبدو بهذه الطريقة، أنَّ إثبات عصمة النبيّ عن ارتكاب الخطأ يمكن أنْ يكون سبيلًا لحلّ المشكلة؛ لأنّه بطريقٍ أَولى سوف تثبت العصمة عن ارتكاب جميع الذنوب حتّى الصغيرة منها. فكما لو اعتبر أحدٌ ـ مثل المعتزلة ـ جواز الذنوب الصغيرة، فمِن الأَولى ألّا يعتبر عصمة الأنبياء في الأمور العاديّة أمرًا ضروريًّا. بالتأكيد، إذا اعتبر أحدٌ أنَّ النبيّ معصوم عن الذنوب الصغيرة، فمِن الأَولى له أيضًا أنْ يعتبره معصومًا عن السهو والخطأ. ولكنْ، في النظرة الکلاسیکیّة، ما هو الدليل على أنّ الأنبياء معصومون في تطبيق الشريعة والأمور العاديّة؟ على سبيل
المثال، أنْ لا يأتي النبيّ صلىاللهعليهوآله بصلاة الصبح ثلاث ركعات سهوًا و....، في هذا المجال طُرحت نظريّات متنوّعة: أجاز الأشاعرة السهو للنبيّ، وانقسم المتكلّمون الإماميّة إلى فئتين: فئة أجازت السهو للنبيّ (مثل الشيخ الصدوق قدسسره، أستاذه محمّد بن حسن الوليد)، وفئةٌ أخرى لم تُجز ذلك (مشهورمتكلّمي الإماميّة).
وفي تحليل هذه الأقوال، يجب القول إنّه أوّلًا، الروايات الناظرة إلى سهو النبيّ، ضعيفة وغير قطعيّة الصدور. فضلًا عن أنَّه لدينا الدليل العقلي بعدم إمكانيّة الدفاع عن سهو النبيّ، ويجب أنْ يكون معصومًا عن السهو. وهكذا، تُطرح العصمة عن الخطأ في مرحلتي تلقّي الوحي وإبلاغه، وكذلك مرحلة العصمة عن الخطأ في تطبيق الأمور العاديّة. إنّ تفكيك هاتين المرحلتين وفهمها ممكنٌ للباحثين؛ أي إنّهم إذا رؤوا سهوًا في الأمور العاديّة صادرًا عن النبيّ، يمكنهم عدم نقل هذا الأمر إلى مرحلة التلقّي والإبلاغ؛ وبالنتيجة لنْ تحدث مشكلة عدم الوثوق بقول النبيّ، ولن يحصل نقض الغرض. ولكنْ، هل يستطيع الناس العاديّون القيام بهذا التفكيك؟ حتمًا الإجابة هي النفي؛ لأنّ الناس العاديين إذا رؤوا اشتباهًا في الأمور العاديّة، سوف ينقلون هذا الأمر إلى مرحلة تلقّي الوحي والإبلاغ أيضًا. بعبارةٍ أخرى: إذا رأى الناس النبيّ في الحياة اليوميّة يرتكب الخطأ، لماذا لا يحتملوا وقوعه في الخطأ في مسائل الوحي أيضًا؟ في هذه الحالة، سوف تُطرح علامة استفهام على كلام النبيّ وفعله أيضًا. سوف يقول الناس إذا كان هناك احتمال في أن يُخطئ أحدٌ خطًأ واحدًا، فسوف يكون هناك احتمال غير محدود لوقوع خطأ آخر أيضًا. وإذا كان شخصٌ ما يخطئ في الأمور
(333)العاديّة والتافهة، فإنّه بلا شكّ سيخطئ في الأمور الغيبيّة وما يتجاوز إدراك البشر العاديين؛ بالنتيجة لن يثق الناس وسيحصل نقض الغرض مِن بعثة الأنبياء لجهة عدم تحقّق هداية الناس.
وادّعاؤنا هو أنَّ هذا الدليل نفسه يجري على قراءة مجتهد شبستري للعصمة، ويستلزم ألّا يحصر العصمة في الدعوة الأساس؛ لأنّ الناس العاديين بمشاهدة الخطأ فيما ليس هو بالهدف الأساس، سوف يحتملون وقوع الأنبياء في الخطأ في دعوتهم الأساس، وهذا يعني عدم الوثوق بالأنبياء، وفي النتيجة عدم هدايتهم.
بناءً لما قيل، يتّضح أنّ حصر العصمة في الدعوة الأساس، ليس فقط لا يوجد دليل يؤيّده، بل إنَّ الأدلّة المذكورة نفسها في النظرة الکلاسیکیّة على العصمة عن الصغائر والخطأ، تكفي في رفض ادّعائه.
يذكر مجتهد شبستري مناجاة وعبادات النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمّةعليهمالسلام كأحد الأدلّة، موضّحًا أنّه إمّا أنْ تكون هذه السلوكات مصطنعة وتمثيليّة وعمليّة يؤتى بها مِن مبدأ العادة، إلّا أنّ شأنهم يُبعد هذا الاحتمال، وإمّا أنْ تكون واقعيّة. فإنْ كانت واقعيّة، يجب عندها الاعتراف بأنّهم يشعرون بالنقص والظُلمة في أنفسهم، وإلّا لا معنى لمثل هذه السلوكات إنْ كانوا دائمًا في حالة الانفراج والانبساط؛ لأنّ تحصيل الحاصل لغوٌ، وكما يقول المثل: مَنْ لا يكون عطشانًا لا يبحث عن الماء.
ويقول بهذا الخصوص:
«نحن مِن جهةٍ، نُسند إلى أئمة الدين بأنّهم يناجون ويعبدون مِن صميم قلبهم؛ مثلًا قيل في حالات الإمام علي عليهالسلام أنّه كان يناجي ويتململ كتململ الملدوغ مِن الحيّة، وهذا في نهج البلاغة. هل يمكن لمَن لا يشعر في نفسه نقصًا أو ضعفًا ولا يُستثار كلّ وجوده كي يخرج مِن ذلك النقص والضعف، أنْ يعبد ويناجي بهذه الطريقة؟ وإلّا سيكون نوعٌ مِن التمثيل (التقليد). وهذا يدلّ على أنّ تصوّراتنا حول أئمّة الدين تصوراتٌ مبتذلة بسيطة بلا بحثٍ وتدقيق. فهم يتمتّعون بالقيود الإنسانيّة أيضًا، ويريدون الخروج مِن هذه القيود الإنسانيّة. والفرق بين عبادتهم وعبادتنا، أنّهم يملكون همّة عالية، والهمّة هي تلك الشيء الذي يؤكّد عليه العرفاء كثيرًا. الهمّة التي كانت لديهم منبثقة مِن الداخل باتجاه مقصدهم الأعلى. ونحن ليس لدينا همّة عالية؛ ولذلك نرسب دائمًا، وهو ما يُدعى بالكسل والبطالة والملل. فالنهوض يبدأ مِن الهمّة، وهذه هي فضيلتهم، ولا يعني ذلك أنّهم كانوا بلا قيودٍ أو حدود».
يُستفاد مِن ظاهر كلام مجتهد شبستري بأنّ واقعيّة استغفار النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام دليلٌ على أنّهم مذنبون؛ يعني ليس ارتكابهم للذنب مجرّد
احتمالٍ، بل حتمًا قد ارتكبوه، وإلّا لما كانوا يستغفرون؛ وبالطبع هو يتقبّل انتساب الذنب إليهم مادام أنّه لا يضرّ بدعوتهم الأساس.
وبهذا الخصوص، مِن الضروري التأكيد على نقطتين: أ) لا يجب الغفلة عن الجانب التعليمي والتربوي للأدعية ودورها العملي في تربية الأمّة الإسلاميّة، ويمكن اعتبار ذلك أحد وجوه استغفارهم وحكمته. ولكنَّ هذا لا يعني أنّ أدعيتهم واستغفارهم كانت فقط لأجل التعليم والتربية، ولم يكونوا جدّيين في التوبة والاستغفار. ب) لا تستلزم واقعيّة أدعيتهم واستغفارهم ارتكابهم للذنب الشرعي، ويمكن أنْ يكون على أساس أحد الوجوه أدناه:
لا يكون الاستغفار فقط بعد ارتكاب الذنب، بل إنّه عبادة عظيمة في حدّ ذاتها.وقد طُلب مِن الإنسان أداؤها. ويصف القرآن الكريم المؤمنين بحقّ: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾. ويقول في مكانٍ آخر: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾. ويتبيّن مِن هذه الآيات أنَّ أحد العبادات الدائمة للمؤمنين الاستغفار ليلًا؛ في حين أنّه لو كان الاستغفار فقط لأجل الذنوب، لا يجب تأجيله لوقت السحر، بل يجب القيام بالاستغفار فورًا بعد كلّ ذنبٍ؛ لأنّ التوبة والاستغفار واجبٌ فوري. ومِن هنا لا يمكن أنْ يكون صرف الاستغفار دليلًا على صدور الذنب والخطأ مِن قِبلهم.
كلّما ارتكب ولدٌ، وخاصّةً إنْ كان صغيرًا، عملًا معيبًا أو أضرّ بالآخرين، فإنّ والده يُحرج مِن ذلك، ويعمل على تعويض الخسائر ويطلب العفو والمعذرة مِن صاحب الحقّ. وقد ورد في الكثير مِن الروايات أنّ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله والإمام علي عليهالسلام هما أبوا الأمّة الإسلاميّة. على هذا الأساس، ذنوب الأمّة هي سبب حرج الآباء المعنويين، وهم ينسبونها إلى أنفسهم ويطلبون مِن الله العفو. وقد ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام بخصوص الآية: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ ما يلي: «ما كان له ذنبٌ ولا همّ بذنبٍ، ولكنَّ الله حمّله شيعته ثمّ غفرها له».
ويتّضح هذا الأمر جليًّا بالالتفات إلى مسألةٍ، هي أنْ نعلم أنَّ علاقة الإنسان الكامل بعالم الخلق، تشبه علاقة الروح بالجسد. ولهذا السبب، تتألّم الروح مِن أيّ ضررٍ يصيب عضوًا مِن الجسد، وهي ترى ضبط القوى وقيادتها، مثل قوّة الغضب والشهوة مِن وظائفها. والكُمّل مِن الناس أيضًا لا يهتمّون بشيعتهم الخاصّين فحسب، بل إنَّ قلوبهم تحترق مِن أجل أعدائهم والمسيئين إليهم أيضًا ويستغفرون لهم. بالطبع، إنَّ الاستغفار للأمة ممكنٌ في مرتبتين، حسب مستوى تواصل الآخرين واتصالهم بالأئمّة المعصومين:
أ) طلب المغفرة للآخرين مع لحاظ غيريّتهم وبينونتهم؛ يعني مِن دون انتساب أعمالهم إلى أنفسهم؛
ب) طلب المغفرة للآخرين مِن دون لحاظ غيريّتهم وبينونتهم، بل مع انتساب أعمالهم إلى أنفسهم. في هذه الحالة، يدعو وليّ الله باسمه ويطلب العفو لأجله، ولكنّه يقصد الآخرين وكأنّه يعتبرهم ذاته نفسها.
المعصومون مِن حيث أنّهم يشاهدون أنّهم لا يملكون شيئًا مِن أنفسهم، وأنّ كلّ ما لديهم هو مِن الله تعالى ويرون تمام وجود أنفسهم هو حاجة، يلهج لسانهم بالمغفرة. وكذلك عندما ينظرون الى أعمالهم، ورغم كلّ حسناتهم، فإنّهم يرونها لا شيء يُذكر، ومصدرًا للخجل والحياء أمام عظمة الله اللانهائيّة وحقّ الربوبيّة والألوهيّة. مِن هنا، يجب التمييز بين مَنْ يعتبر نفسه مذنبًا، وبين مِن هو حقًا وواقعًا مذنبٌ، ولا يجب اعتبار الأوّل دليلًا على الثاني.
الذنب الشأني هو نفس «ترك الأَولى» الذي تمّت الإشارة إليه سابقًا. وترك الأَولى يعني أنْ نختار الأصلح بين الصالح والأصلح، بحيث أنّنا حتّى لو لم نرتكب ذنبًا وقمنا بالعمل بالشكل المناسب وفي محلّه، ولكنْ كان بإمكاننا أداؤه بشكلٍ أفضل وقد غفلنا عن ذلك؛ فنبادر حينئذٍ إلى طلب المغفرة.
في هذا المجال، لنأخذ شابًا بعين الاعتبار لا يتحسّر على هدر أسابيع وشهورًا مِن عمره بمقدار ما يتحسّر عالم على هدره لساعةٍ واحدة مِن وقته، ونحن نعلم أنَّ حسرة ذلك العالم وندمه، ليس مِن منطلق التمثيل والتعليم، بل هي حسرةٌ واقعيّة.
وبالنسبة للأنبياء والأئمّة، ينبغي القول أيضًا إنّ توبتهم واستغفارهم كان مِن الذنب الشأني، وليس مِن الذنب الشرعي. وما يتعارض مع العصمة اللازمة لهم، هو الذنب الشرعي، وليس الذنب الشأني؛ ذلك أنّ الذنب الشأني في الحقيقة ليس بذنبٍ، بل هو عملٌ حسنٌ لا يتناسب مع شأن النبيّ والأئمّة ودرجتهم الوجوديّة. طبعًا، يتفاوت الذنب الشأني مع الدرجة الوجوديّة للأفراد، كما جاء في الرواية النبويّة: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين». ويوضّح الطباطبائي هذا الأمر قائلًا:
«إنّ الذنب الذي يتأوّه لأجل جبرانه المعصومون عليهمالسلام، ليس بسبب التلوّث للمحرّمات الإلهيّة. بل مِن حيث أنّ كلّ مَنْ هو أقرب إلى الله، سوف يجعل الله معيار قياس أعماله أكثر دقّة، وهذا الشخص بسبب عظمة المقام، يعتبر شيئًا ما ذنبًا يمرّ عليه الآخرون بكلّ بساطة ولا يلتفتون إليه».
على هذا الأساس، يمكن طرح أحد الإحتمالات الآتية:
للاستغفار والتوبة مراتب ودرجات تتناسب مع العاملين بها. توبة المذنبين مِن الذنب، وتوبة المستأنسين بالعبادة مِن ترك المستحبّ، وتوبة المستأنسين بالمعبود مِن الغفلة الآنيّة عن ذكر الله. وتوبة أولياء الله والمعصومين عليهمالسلام واستغفارهم أحيانًا لأجل التفاتهم إلى وسائط الفيض مِن دون إذنٍ خاصٍّ مِن الله تعالى. بناءً عليه، عندما جعل النبيّ يوسف عليهالسلام أحدًا وساطة مِن دون أمرٍ خاصٍّ مِن الله تعالى ليخبر الملك ببراءته مِن اقتراف الذنب، اعتبر نفسه مذنبًا وتضرّع إلى الله تائبًا؛ في حين أنّ ذلك ليس بذنبٍ شرعي، وقد يكون واجبًا على الأفراد العاديين، ولكنَّ ذلك لا يتوافق مع شأن النبيّ يوسف عليهالسلام.
الأنبياء دائمًا في حال توجّهٍ إلى الله تعالى. مِن هنا، كلّما غفلوا عن هذه الحالة للحظةٍ واشتغلوا بأعمالٍ مباحة، مثل: الأكل، الشرب والجلوس في مجالس قليلة الفائدة؛ كانوا يعتبرون هذا المقدار مِن الغفلة ذنبًا وخطًأ، ويطلبون مِن الله الغفران عن ذلك. بناءً عليه، ليس عجبًا أنْ تكون الأفعال المباحة أو المكروهة لدى الآخرين، «ذنبًا» بالنسبة لهم.
نظرًا إلى أنّ المعرفة الإلهيّة لامتناهية، فإنّ معرفة المعصومين عليهمالسلام بالله تعالى تزداد في كلّ لحظة، ولذلك فهم في اضطرابٍ دائمٍ خوفًا مِن أنْ يكون قد حصل قصورًا في المرتبة السابقة والمرحل الأدنى؛ على هذا الأساس يطلبون
(340)العفو مثل مَنْ يطلب العفو مِن شخصيّةٍ كانت ترافقه، ولكنْ لم يؤدّ الاحترام اللائق لشخصيّة ذلك الشخص؛ لعدم معرفته به، بل اكتفى باحترامه على وجه العموم. ومِن هنا، سوف يكون في استغفارٍ دائم. وبالطبع، فإنّ هذا النوع مِن الاستغفار لا يقتصر على الخوف مِن القصور العملي، بل يمكن أيضًا اعتبار القصور في الرتبة مِن العوامل المؤثّرة فيه.
ويوضّح الإمام الخميني رحمهالله أنّه أساسًا مِن لوازم طيّ مدارج السلوك والوصول إلى مرتبةٍ أعلى غفران ذنوب المرتبة السابقة والأدنى. بناءً لما تقدّم، الاستغفار واستمداد الغفران الإلهي للسالك أمرٌ إلزامي وضروري.
الاستغفار مِن رؤية نور الحقّ في حجاب الخلق
مِن الممكن القول إنَّ المعصومين الأربعة عشرعليهمالسلام ، هم أفضل مِن أنْ يأتوا بعملٍ مِن دون إذنٍ خاصٍّ مِن الله و.... بل إنَّ استغفار هؤلاء الخلفاء الإلهيين التامّين، سببه التوجّه إلى الكثرة الخَلقيّة في مقام القيام بوظيفة تبليغ الدين. ومِن هنا، قال الإمام الصادق عليهالسلام:
«إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يتوب إلى الله عزّ وجلّ كل يومٍ سبعين مرّةً مِن غير ذنب».
أو قال النبيّ صلىاللهعليهوآله:
«إنّه ليُغان على قلبي وإنّي لأستغفر بالنّهار سبعين مرّةً»،
أو قول الإمام الصادق عليهالسلام:
«إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان لا يقوم مِن مجلسٍ وإن خفّ حتّى يستغفر الله عزّ وجلّ خمسًا وعشرين مرّة».
ومعنى ذلك، أنَّ خاتم الأنبياءعليهمالسلام كان يشاهد بشكلٍ دائم نور وجه حضرة الأحّدية جلّ جلاله، مِن دون وساطة، ولكنْ أحيانًا أثناء مجالسته للنّاس وتبليغ الدين، يصبح خَلق أو وجود النبيّ حجابًا لذلك النور، وكما أنّ نور الشمس لا يُرى مِن خلف السحاب، كذلك النبيّ لم يكن يرى أيضًا نور الله تعالى في حجاب الخلق؛ ولذلك كان يستغفر سبعين مرّةً حتّى تزول تلك الحالة. والإمام الخميني في شرح هذا النوع مِن الرواية يقول:
«فالأنبياء العظام وأولياء الله الخاصّين، في ذات الوقت الذي كانوا يشابهون الآخرين في الاشتغال بالأعمال، لم يهتمّوا بالدنيا في أيّ وقت مِن الأوقات؛ لأنَّ اشتغالهم كان بالحقّ وللحقّ. وفي الوقت نفسه يروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال: «ليُغانُ على قلبي وإنّي لأستغفر الله في كل يومٍ سبعين مرّة». ربّما كان يحسب رؤية الحقّ في الكثرة كدورة..... ».
الإمام الخميني بتوضيحه لهذه المسألة، بأنَّ أولياء الله دائمًا في حالة انقطاعٍ إلى الله، ولكنْ بسبب رسالتهم ووظيفتهم الإلهيّة، فإنّهم أحيانًا يتوجّهون إلى حضرة الحق جلّ جلاله لا محالة في مرآة عالم الكثرات والتعدّد، وهذا الأمر يُعتبر بالنسبة لهم كدورةً واستياء ويطلبون المغفرة لإزالته، ويقول الإمام بهذا
الشأن: هذا الإمام السجّادعليهالسلام بعظمته يناجي الله ـ كما تلاحظون ـ ويخشى مِن المعاصي؛ .... كانوا جميعًا بدءًا بالنبيّ وانتهاء بصاحب الزمان يخشون الذنوب؛ بيد أنَّ ذنوبهم ليست كذنوبي وذنوبكم، أولئك وصلوا إلى مرحلة مِن العظمة والإدراك، فالاهتمام بالكثرة يُعدّ مِن الكبائر لديهم.
قال الإمام السجّادعليهالسلام ذات ليلة:
««اللهمُّ ارزْقنا التجافي عن دارِ الغرور، والإنابة إلى دارِ السرورِ، والاستعدادَ للموتِ قبلَ حلولِ الفَوتِ». الأمر أمرٌ عظيم، فعندما ينظر هؤلاء إلى أنفسهم ويرونها لاتعادل شيئًا أمام عظمة الله جل وعلا ـ وهذا هو واقع الأمر ـ ... ومع حضورهم أمام الله تعالى يدعون الناس للتضرّع والدعاء، ويحصل لهم مِن ذلك استياء وتبرّم. إنَّ الالتفات إلى المظاهر الإلهيّة بنظرهم ـ مع كونها إلهيّة ـ تعدّ مِن الكبائر، ومِن الذنوب التي لاتغتفر؛ لمخالفتها لذلك الغيب الذي يطمحون إليه، وهو «كمال الانقطاع إليه»..».
أحيانًا يكون الاستغفار لأجل دفع الحجب وليس لإزالتها؛ يعني أنّهم يستغفرون حتّى لا ينزلقوا ولا يحيط الذنب والحجاب بهم؛ كأن يتمّ وضع قطعة قماشٍ على مرآةٍ شفّافة حتّى لا يغطّيها الغبار، وليس مثل الذي يُلقي
قطعة قماشٍ على مرآةٍ مغبرّة لينظّفها مِن الغبار. بعبارةٍ أخرى: إنّهم يستغفرون حتّى لا تحجب السحب نظر القلب؛ لا أنّهم يريدون إزالة السحب الموجودة.
الإنسان الكامل مِن حيث أنّه داخلٌ في حصن التوحيد الخالص وفي مأمنٍ مِن لسعات الحجب الظلمانيّة، فإنّهم يسعون إلى دفع الحجب النورانيّة، لا الحجب الظلمانية؛ كالتوجّه إلى الملائكة أو التوجّه إلى ذات الوحي أو النبوّة، هي حجبٌ نورانيّة ولا يتقبّل محضر أمن الله إلّا شهوده ولا شيءٍ آخر. على هذا الأساس، إنّ استغفار الأنبياء هو دائمًا لأجل دفع هذا النوع مِن التوجّهات.
على هذا الأساس، ليس هناك مِن تعارضٍ بين استغفار النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام وبين عصمتهم فحسب، بل إنَّ بعض الموارد المذكورة أعلاه، تدلّ على تلازم التوبة والاستغفار مع العصمة، وخاصّةً في المراتب العليا للعصمة ومِن أجل رسوخها وارتقائها.
كما أُشير سابقًا، لا يعتبر مجتهد شبستري العصمة العلميّة للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام أمرًا ضروريًّا. ودليله في ذلك، أنّه لا يوجد أدلّة فلسفيّة وكلاميّة
يُستفاد منها عموميّة وإطلاق علم النبيّ والأئمّة. ويعتبر أنّ طريق بحث هذه الأمور، هو البحث التاريخي. وعلى هذا الأساس يقول:
«لقد كان عمل الرسول مختصًّا في تمهيد الطريق للإنسان نحو الله، والقرآن الكريم هو تفسير النبيّ التوحيدي بإمدادٍ إلهي حول الوجود ومعنى وأساس الوجود ومستقبل الوجود وبداية الوجود. وموضوع القرآن الكريم هو بيان دين الإنسان. وعندما لا يوجد شيء آخر نتعلّمه مِن النبيّ، فما السبب الذي يجعلنا نقول إنّ النبيّ كان يعرف الكيمياء والفيزياء؟ لا يوجد أيّ دليل على ذلك، وهذا الأمر ليس بنقصٍ ـ عیبٍ ـ لأحد. وما هو النقص لنبيٍّ يفتح طريق الإنسان إلى الله، إذا لم يتحدّث بالكيمياء والفيزياء أو لم يكن يعلم بهما، وهل هذا نقصٌ وعيبٌ؟».
بناءً لمبناه الذي أوضحناه، لا يعتبر مجتهد شبستري العصمة العلميّة أمرًا ضروريًّا، ويدّعي أنّه لا يوجد أدلّةٌ في الكلام والفلسفة تُثبت علم النبيّ بشكلٍ مطلق.
بادئ ذي بدء، مِن الضروري معرفة أنّ علم النبيّ يمكن طرحه بصفته أصلًا للعصمة مِن المعصية والخطأ. فمِن جهةٍ، يمكن اعتبار عدم ارتكاب المعصية مرتبطًا بمعرفته وعلمه بقبح الذنب. ومِن جهةٍ أخرى، يمكن القول إنّ النبيّ لا يرتكب الخطأ بسبب إشرافه العلمي على الوجود.
وعلى كلّ حال، إنَّ مبنى مجتهد شبستري، محلّ نقدٍ ونقاش مِن عدّة جوانب:
مِن الطرق التي يُثبت مِن خلالها علم النبيّ الشامل والكامل، الاستدلال على أساس الغرض مِن النّبوة، مع توضيح أنّ علم الكلام يُثبت ضرورة التكليف الديني بناءً للغاية مِن الخَلق، وعلى أساس الغرض مِن التكليف يستنتج وجوب النبوّة، وبناءً للغرض مِن النبوّة يثبت ضرورة العلم الشامل والكامل للنّبي في المسائل المتّصلة بالمعتقدات والأحكام الدينيّة؛ لأنّه مِن دون ذلك لن يتحقّق الغرض مِن النبوّة، وهو هداية البشر. ولكنْ، هل يُثبت هذا الطريق أنّ لدى النبيّ علمٌ لدنّي ومعصومٌ عن الخطأ في القضايا التاريخيّة والطبيعيّة أيضًا؟
ويجيب علم الكلام، أنّه أوّلًا تعليم الوحي لمثل هذه العلوم ضروريٌ في بعض الحالات، كأنّه يكون مِن غير الممكن للبشر في المراحل التاريخيّة الأولى تأمين حاجات حياتهم الضروريّة عن طريق التجربة والتفكير، ولذلك كان على الأنبياء تعليمهم الصناعات ومعرفة الغذاء والآفات والأدوية. هل يمكن تحقيق الغرض مِن إرسال الأنبياء مِن دون قبول علمهم المعصوم في هذا المجال؟ ثانيًا، في بعض الحالات يؤدّي عدم التمكّن مِن هذه العلوم أو الخطأ فيها إلى الضرر بالمصير المعنوي للبشر. مثلًا سوف يطرح الكفّار المجهّزون بعلومٍ وتقنياتٍ (فنون) أمام حقانيّة
الدين الإلهي، تحدّياتٍ جديّة أو سيشكّل ذلك أرضيّة لضلال مجموعة مِن الناس؛ بحيث يكون إثبات حقانيّة الدين الإلهي منوطًا بتجهيز المتديّنين بعلمٍ وفنٍّ موازٍ مع ما لدى الكفّار أو أفضل منهم. ومِن جهةٍ أخرى، إنَّ نيل ذلك واكتسابه عن طريق التجربة والتفكير يتطلّب وقتًا طويلًا. في هذه الحالة، هل يمكن رفض فكرة عدم علمهم، والاعتقاد في الوقت نفسه بدورهم في الهداية والإرشاد؟
أخيرًا، إنَّ عبادة الله القدير ومعرفته هي هدف خلق الإنسان، ويتمتّع الأنبياء الذين كانوا أفضل البشر بقابليّة تلّقي المعرفة الكاملة بالله. وعلى الرغم مِن تفوّق الأنبياء على الآخرين في المعرفة العقليّة والكليّة (الفلسفيّة) بالله سبحانه وتعالى، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ معرفة الأمور الطبيعيّة وإدراك الحقائق والقوانين الخاصّة بالعالم الطبيعي، سيؤدّيان إلى إتمام معرفتهم وكمالها. وبالنسبة للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله فهو يتمتّع بدور الهداية والإرشاد؛ لذلك بناءً على حكمة الله عزّ وجلّ، يجب أنْ يجعلهم على درايةٍ بحقائق الكون وأسراره.
مِن المنظور الفلسفي، يُقاس نطاق علم النبيّ بمقياس كماله الوجودي. وقيل إنّه إذا كان إنسانٌ ما مِن الناحية الوجوديّة في أعلى مراتب كمال الوجود، لن يكون بالإمكان أنْ لا يعلم أوليّات الحياة ويقع في الخطأ بما يخصّ الحياة اليوميّة.
وشرح ذلك، أنّه مِن وجهة نظر الفلاسفة، النبيّ هو إنسانٌ كاملٌ قد وصل إلى مرتبة العقل بالفعل والعقل المُستفاد، ويشاهد عالم العقول والنفوس وعالم المثال الأعظم وعلى علمٍ بها. فمن جهةٍ، إنّ حقائق عالم الطبيعة موجودةٌ في عالم العقول
(347)والنفوس والمثال؛ لأنّ عوامل الوجود تتطابق مع بعضها البعض، والعالم الأعلى هو علّة العالم الأدنى. وعلّيتها أيضًا مِن مقولة العلّة الفاعليّة، وليست مِن العلّة الإعداديّة. والعلّة الفاعليّة لديها علمٌ سابقٌ بمعلولها. طبعًا، يجب الالتفات إلى أنّ حقائق عالم الطبيعة موجودة بشكلٍ كلّي في عالم العقول وبشكلٍ جزئي وتفصيلي في عالم النفوس وعالم المثال، حتّى ولو لم يكن للمادّة والتغيّر إليها مِن سبيل.
بناءً لما تقدّم، النبيّ الذي يشاهد عالم العقول وعالم النفوس والمثال الأعظم ولديه علمٌ حضوريٌ بذلك، مطّلعٌ أيضًا على حقائق عالم الطبيعة. ومنشأ الأخبار الغيبيّة للأنبياء، هو ذلك العلم السابق. على هذا الأساس، لا يمكن القول إنّ علم الأنبياء بحوادث عالم الطبيعة وقوانينها، كان بمستوى علم أفراد زمانهم العاديين. فإذا كان النبيّ قد أدرك الوجود بعلمه الحضوري، ونظرًا إلى عدم نفوذ الخطأ والسهو والنسيان في العلم الحضوري، فما معنى الخطأ بعد ذلك؟ في العلم الحضوري، يكون وجود المعلوم حاضرًا عند العالِم، فلا يبقى للخطأ والسهو والنسيان مِن محلٍّ.
يُستفاد مِن النصوص الدينيّة أنّ نطاق علم النبيّ أمرٌ لا يذعن به مجتهد شبستري:
أ) يُفهم بكلّ وضوح مِن القرآن الكريم، بأنّ تمام وقائع عالم الطبيعة مسجّلة في كتابٍ مبين، حيث يقول: ﴿وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾. ويقول في آيةٍ أخرى بهذا المضمون نفسه: ﴿وَمَا
يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.
بتصريح القرآن الكريم، لا يوجد أيّ حادثة أرضيّة وبشريّة إلّا وقد سُجلت سابقًا في كتابٍ. ومهما كان الكتاب المبين، فهو غير الوقائع والحوادث الخارجيّة، ومتقدّمٌ عليها، ويبقى بعد فنائها والمضي عنها، مثل برنامجٍ قد كُتب قبل تنفيذه، ويبقى بعد حدوثه وإجرائه. وفي آية أخرى، ذُكر ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ بدلًا مِن ﴿كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ وصُرّح بأنّ كلّ شيءٍ قد أُحصي في ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾.
والإمام المُبين هو اللوح المحفوظ، إذ تمّ تسجيل تفصيل القضاء الإلهي. ولعلّ وجه تسميته بالإمام المبين، هو دوره المتبوع. والإمام بالنسبة لحوادث ووقائع العالم؛ لأنّه شاملٌ للقضاء الالهي الحتمي؛ أي إنّ اللوح المحفوظ هو نموذج حوادث العالم. وينطبق الإمام المبين على أمير المؤمنين عليهالسلام في بعض الروايات. ووجه ذلك، أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام عالمٌ بالكتاب المبين واللوح المحفوظ.
القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي النازل الناشئ مِن اللوح المحفوظ.
والكتاب المكنون يعني حقيقة وأصل القرآن الكريم في اللوح المحفوظ والكتاب المبين، ولا اطّلاع وعلم بحقيقة وأصل القرآن إلّا الذين لديهم تطهيرٌ إلهي خاصّ ومقام العصمة: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. وعلى أساس الأحاديث المسلّمة والمقبولة عند الشيعة وأهل السنّة، إنّ أهل الكساء (النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، علي عليهالسلام، فاطمةعليهاالسلام، الحسن والحسين عليهماالسلام) هم المصاديق القطعيّة للمطهّرون. على هذا الأساس، النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله عالمٌ بالكتاب المكنون واللوح المحفوظ. ومِن جهةٍ، إنّ تمام حوادث العالم مسجّلةٌ ومعلومة في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ؛ لذا النبيّ صلىاللهعليهوآله كان مطلعًا على تمام حوادث العالم، أو لو شاء لاستطاع الاطّلاع عليها والعلم بها.
ب) أنْ لا نعتبر علم النبيّ وأهل بيته عليهمالسلام شيئًا إلّا هذا القرآن الكريم، فهذا لا يعني أنّ علمه كان ضمن حدود أهل عصرهم وزمانهم، وأنَّ للخطأ سبيلًا إلى علمهم. ويبدو أنّ مجتهد شبستري بقوله هذا الكلام، قد غفل عن الآيات التي تعرّف القرآن الكريم بحامل علم الأوّلين والآخرين، وأنّهم ـ أي النبيّ وأهل بيته ـ حاملو علم الكتاب. وغفِل أيضًا عن عشرات الروايات التي يعرّف فيها أهل البيت عليهمالسلام أنفسهم علماء بجميع الأمور قائلين أنّها لديهم مِن القرآن الكريم. نعم، العلم الذي أظهره أهل البيت عليهمالسلام، هو
ذلك العلم الذي عبّروا عنه وبيّنوه، ومِن جملة بياناتهم وعباراتهم أيضًا أنّنا عالمون بجميع حقائق الخلق.
الكلام الأساس لمجتهد شبستري، هو أنّ النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله معصومٌ في أداء وظيفته؛ أي هداية النّاس والدعوة إلى الله الواحد، ولا يُشاهد أيّ انحرافٍ منه في هذه الدعوة. طبعًا، مِن الممكن أنْ يرتكب النبيّ ذنوبًا لا تضرّ بتلك الوظيفة الأساس.
وهو ضمن اعتباره أنّ عقيدة العصمة متأثّرة بالثقافة المسيحيّة، ينكر العصمة العلميّة للنبيّ أيضًا. وهو فضلًا عن استشهاده باختلاف المتكلّمين المسلمين حول مسألة العصمة، قد استند إلى شواهد أخرى: وجود أدلّةٍ مِن القرآن الكريم والروايات تُثبت هذا الادّعاء، مثل آية: «قل إنّما أنا بشرٌ مثلكم...» ورواية: «إنّه ليُغان على قلبی وإنّي أستغفر الله كلّ يومٍ سبعين مرّةٍ».
1. يمكن الاستنتاج مِن واقعيّة عبادة النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وطلبهم للمغفرة، أنّهم كانوا يشعرون بنقصٍ في أنفسهم و... .
2. عدم كفاية الأدلّة التي تثبت العلم المطلق لهم، وعلى هذا الأساس لا يمكن إثبات العصمة العلميّة للنبيّ عن الخطأ.
ولكن هذه الادّعاءات والأدلّة المطروحة محلّ نقدٍ:
1. تأثّر عقيدة العصمة بالثقافة المسيحيّة هو ادّعاء بلا دليل، وهناك أدلّة كثيرة تُثبت خلاف ذلك.
2. مِن خلال المباني التي يتبنّاها مجتهد شبستري حول تعريف الدين و...
يواجه ادّعاء قبول العصمة ضمن تلك الحدود المدّعاة تحدّياتٍ وغموضًا.
3. رغم أنّ مراحل العصمة في النظرة الکلاسیکيّة متفاوتة عن مراحل العصمة في وجهة نظر شبستري، ولكنَّ الأدلّة المطروحة في النظرة التقليديّة على العصمة المطلقة الناظرة إلى تمام المراحل، تجري أيضًا في نظرته. على سبيل المثال، أحد الأدلّة هو أنّ ارتكاب أيّ معصيةٍ وذنبٍ يضرّ بالغرض مِن البعثة التي هي هداية الناس. هذا الدليل ينطبق أيضًا على قراءة شبستري، ويجب عليه إثبات كيف أنّ تفسيره الخاصّ للعصمة لا ينتهي إلى نقض الغرض؟
4. رغم استدلال البعض بظهوراتٍ مِن القرآن الكريم والروايات، استنتج بعدم العصمة، ولكنْ تمّ إعطاء العديد مِن الإجابات عليها. فضلًا عن ذلك، إذا تمّ قبول ظواهر هذه الأدلّة، سوف تتعارض مع الأدلّة التي لها ظهورٌ في العصمة.
5. الآية التي استشهد بها شبستري، رغم تصريحها ببشرية النبيّ، لكنّها أيضًا تبيّن وجه امتياز ذلك العظم عن الآخرين. والكلام في أنّ مقتضى وجه الامتياز هذا، هو قبول العصمة للنبيّ.
6. يمكن الاستنتاج مِن واقعيّة استغفارهم، ارتكابهم للذنب. فطلب المغفرة لأجل مراحلَ مِن القصور أو التقصير، يعبّر عنه بترك الأولى ولا يصدق عليه عنوان الذنب.
لا يمكن الدفاع عن مبنى مجتهد شبستري حول علم النبيّ، وعلى أساس الأدلّة الكلاميّة، الفلسفيّة والنقليّة، يمكن إثبات شموليّة علم النبيّ، وبالتبع عصمته العلميّة.
المصادر
- ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة الله؛ شرح نهج البلاغة؛ ج 1، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404ق.
- ابن بابويه. محمّد بن علي، كمال الدين و تمام النعمة، تحقيق وتصحيح على أكبرغفارى؛ ج2، طهران: إسلاميّة، 1395ق.
- ابن طاووس، على بن موسى، إقبال الأعمال؛ ج2، طهران: دارالكتب الإسلاميّة، 1367.
- ابن مردويه، أحمد بن موسى، مناقب علي بن أبي طالب و ما نزل مِن القرآن في علي، تحقيق عبدالرزاق محمّد حرزالدين، ج2، قم: مؤسّسة علمى فرهنكى، دارالحدیث. 1424ق.
- ترخان قاسم؛ آفاق عصمت (تأملى در شبهات عصمت و گسترة آن) (آفاق العصمة (انعكاس لشكوك العصمة ومداها)، قم: خانه خرد، 1397ه.ش.
- جرجانى، سيدشريف علىبن محمّد، شرح المواقف للعضدالدين عبدالرحمن ايجى؛ج1، قم: الشريف الرضى، 1325ق.
- جوادى آملي، عبدالله؛ ادب فناى مقربان (أدب فناء المقرّبین)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم: منشورات «إسراء»، 1381 ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، تفسير موضوعي (باللغة الفارسيّة)، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، قم: منشورات «إسراء»، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، 1379ه.ش.
- حلبي، أبو الصلاح، تقريب المعارف؛ قم: دار الهادى, 1404ق.
- رازي، فخرالدين، الأربعين فى أصول الدين، ج 1، القاهرة: مكتبة الكليّات الأزهريّة، 1986م.
- ربانى گلپايگانى، على؛ وحى نبوى (الوحي النبوي) ج 1، طهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391ه.ش.
- سبحاني، جعفر، عصمة الأنبیاء، قم: معهد الإمام الصادق، 1381ه.ش.
- سليم بن قيس، أبو صادق، كتاب سليم بن قيس، قم: منشورات الهادي، 1415ق.
- سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، قم: المکتبة العامّة، سماحة آية الله العظمى مرعشي نجفي، 1404ق.
- شاكرين، حميد رضا؛ «عصمت واستغفار؛ تعاند, تلاؤم يا تلازم؟» (العصمة والاستغفار؛ التعاند، التلاؤم أو التلازم)؛ مجلّة معرفت کلامي؛ س2 ش2, 1390ه.ش.
- شریف الرضی، محمّد بن حسین، المجازات النبویّة، قم: دارالحدیث، 1422ق.
- شريفي، أحمد حسين وحسن يوسفيان؛ پژوهشى در عصمت معصومان (بحث في العصمة المعصومین)، طهران: منشورات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377ه.ش.
- طباطبائي، سيّد محمّد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج5، قم: مکتب نشر الإسلامي، 1417ق.
- طوسي، خواجه نصيرالدين، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل، ج2 بيروت، دار الأضواء. 1405ق.
- ـــــــــــــــ ، تجريد الاعتقاد، قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1407ق.
- علامة حلي، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، تصحيح ومقدمّة وتحقيق وتعليقات: آیت الله حسن زاده آملى؛ ج4، قم: مؤسّسة نشر اسلامى، 1413ق.
- كلّينى، محمّد بن يعقوب، الكافي، ج2، طهران: دارالكتب الإسلاميّة، 1362ه.ش.
- مجتهد شبسترى, محمّد، «انتظار ما از ييامبران» (نتوقع مِن الأنبياء)، متن سخئرانى مجتهد شبسترى در دانشگاه صنعتى اصفهان در تاريخ3/12/1387.
- ـــــــــــــــ ، ايمان و آزادى (الإیمان والحریّة)؛ طهران: طرح نو 1376 ه.ش.
- ـــــــــــــــ ، «پاسخ به نقد آیت الله سبحانى» (ردّ على انتقادات آية الله سبحاني)؛ نشر فی الموقع الأکتروني: محمّد مجتهد شبستری، 31/5/1401.
- http://mohammadmojtahedshabestari.com/پاسخ-مجتهد-شبستری-به-آیتاله-سبحانی-چ/
- ـــــــــــــــ ، «قرائت نبوى از جهان (1)» (القراءة النبويّة للعالم)؛ نیلوفر، 31/5/1401.
- https://neeloofar.org/category/professorsresearchers/mojtahedshabestari/prophetic-interpretation-of-the-world/
- مجلسى، محمّد باقر، بحار الأنوار، ج2، بيروت: دار إحياء التراث العربى، 1403ق.
- موسوى خمينى، سيدروح الله؛ چهل حديث (أربعین حدیث)؛ طهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376ه.ش
- ـــــــــــــــ ، صحيفة امام (صحیفة الإمام الخميني)؛ ج1، قم: طهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378ه.ش.
- ميلانى، سيّد علي، نفحات الأزهار، قم، مركز نشر آلاء، 1423ق.
(355)محمّد عرب صالحي
ادّعى السيّد محمّد مجتهد شبستري في إحدى مقالاته بعنوان «لماذا انقضى عصر علم الأصول والاجتهاد الفقهي؟» أنَّ الفقهاء منذ صدر الإسلام حتّى مرحلة ما قبل عصر النهضة، كانوا، بالاعتماد على نظريّة كلاميّة واحدة؛ يحدّدون في جميع مجالات حياة المسلمين الدينيّة أو الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، أحكام جميع المسائل، وذلك أيضًا بالاستنباط مِن القرآن الكريم والسنّة فقط، والاجتهاد الفقهي في هذين المصدرين. لكنَّ هذا المنهج استمرّ أيضًا بعد عصر النهضة، وهجوم المسائل الجديدة والمُستحدثة. لكنّه واجه بالتدريج مشكلة جديّة بعد الثورة الإسلاميّة؛ ذلك أنّه ظهرت مسائل ليس لها أيّ علاقة أو منشأ في الكتاب والسنّة. في النتيجة، ابتنيت جميع فتاوى الفقهاء في
هذا المجال أيضًا على الأمور العقليّة والعلوم المعاصرة فقط، ولا أصل لها في الكتاب والسنّة. في الحقيقة، إنَّ العلوم المعاصرة هي التي تحدّد أحكام المسائل المستحدثة، لا علم الأصول والاجتهاد الفقهي المُصطَلَح. بناء عليه، يمكن الادّعاء أنَّ عصر علم الأصول والاجتهاد الفقهي قد انقضى.
تعرّضت المقالة الآتية إلى نقد ادّعاءات مجتهد شبستري في هذا المجال مِن ناحيتين. بداية، سنعرض للانتقاد نقاط وجهة نظره حول نظريّة دعامة الاجتهاد الفقهي، ثمّ سنتناول بالتحليل استنتاجه الدالّ على عدم فاعليّة هذه النظريّة، وضمن الإشارة إلى مغالطاته وأخطائه العلميّة الفاحشة، سنتناول في إثبات هذه المسألة، أنَّ علم الأصول بترقيه وتطوّره، والاجتهاد الفقهي بسياليّته؛ يمكن لهما أنْ يستجيبا لجميع القضايا المستحدثة والجديدة. وسنثبت أنَّ الموارد التي تُوهِّم أنّها تتبع الأساليب العقليّة البحتة، وغير مستنبطة مِن الكتاب والسنّة، ليست في الأساس مِن سنخ المسائل الاستنباطيّة، بل هي أدوات إجراء الأحكام الأوليّة، أو مِن سنخ الأحكام الحكوميّة، وصلاحيات الحاكم بما هو حاكم، والتي لها منهجيّتها الخاصّة بها.
أثناء مرحلة حياة رسول الإسلام صلىاللهعليهوآله، كانت جميع معايير وأحكام الحياة الدينيّة والاجتماعيّة لأتباعه تتحدّد بإمضائه أو تأسيسه [لها]. لكنْ بعد ارتحاله، تصدّى جماعة مِن علماء الأمّة، لقّبوا لاحقًا بالفقهاء، للاجتهاد الفقهي ليستنبطوا في المجالات الثلاثة: «العبادات»، «المعاملات» و«السياسات» ضوابط وأحكامًا جديدة مِن الكتاب والسنّة. في القرون
(358)الأولى لصدر الإسلام، كان الفقهاء يبيّنون في جميع مجالات حياة المسلمين الدينيّة أو الاجتماعيّة، السياسيّة والاقتصاديّة، أحكام جميع المسائل. في تلك الحالة التاريخية، كان الفقهاء هم مَنْ كانوا يستنبطون جميع الأحكام الشرعيّة التي كانت تحتاجها الأمّة الإسلاميّة لبقائها واستمرار حياتها مِن الكتاب أو السنّة، مباشرة أو بنحو غير مباشر.
وقد صيغت وأعدّت أيضًا في القرنين الثاني والثالث نظريّة كلاميّة فلسفيّة لتسويغ وتثبيت استنباطات الفقهاء:
1. لأنَّ الله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد الواقعيّة لـ«أفعال العباد» (أفعال عباد الله) في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، حدّد بمقتضى حكمته وقدرته، لكلّ فعل مِن أفعال العباد التي تصدر عنهم في جميع العصور والأمكنة، حكمًا واقعيًّا؛ حتّى يؤدّي عباد الله بمقتضاها تلك الأعمال التي فيها مصلحة واقعيّة، ويتركوا ما فيه مفسدة واقعيّة.
2. سبيل الاطّلاع على الأحكام الواقعيّة لله تعالى، هو الرجوع إلى الكتاب (القرآن الكريم) والسنّة النبويّة، ويجب استنباطها مِن هذين المصدرين اللذين هما حجّة الله تعالى على الناس.
كانت الاستفادة مِن هذه النظريّة الكلاميّة ـ الفلسفيّة تحتاج إلى إبداع منهج مقبول، ويمكن الدفاع عنه لاستنباط الأحكام مِن الكتاب والسنّة. اقتبس هذا المنهج وأُبدع ونُظِّم تدريجيًّا بين المسلمين، وسمّي علم الأصول. باستعمال هذا العلم، كان الفقهاء يتمكّنون دومًا مِن إظهار أنَّ اجتهادهم الفقهي يثمر بفاعلية تامّة، وكان يضع بين يدي المكلّفين أحكام الله تعالى في
جميع الموارد، وكان يسدّ جميع احتياجاتهم، إلى أنَّ فتح باب الفتوى في المسائل المستحدثة مع ظهور عصر النهضة والمسائل الجديدة. ومِن خلال نظرة عامّة، يبدو أنَّ وسعة الأحكام التي بُيِّنت في كتب الرسائل العمليّة والكتب الفقهيّة وعدّة مسائل معدودة أخرى، هي سعة قدرات علم الفقه نفسها، وقد يمكن تقريبًا إضافة مسائل إليها أيضًا. في الحقيقة، فإنَّ الاستيعاب الأساسي لعلم الفقه، هو الذي يشاهد في الكتب الفقهيّة والرسائل العمليّة نفسها، وفي تلك المسائل الجديدة وما شابه، ولا شيء أكثر مِن ذلك.
منذ عام 1357 فصاعدًا، حين دوّن الدستور في إيران، ومضى فيه الحديث عن حاكميّة الشعب، الفصل بين السلطات، النظام الاقتصادي ثلاثي القطاعات: التعاوني، الخاصّ والحكومي، الانتخابات والمجلس، وحصل التوافق على حكومة عصريّة مِن جنس الشعب والدولة. ومع ذاك الإجراء الذي لا سابق له، ظهر مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورَجَّح عند اللزوم، المصالح العقلانيّة على التقيّد بالفتاوى والأحكام الشرعيّة، ومع تدوين وإقرار عدة برامج للتنمية، وبرنامج أفق العشرين عامًا و... وإقرار آلاف القوانين بالاستفادة مِن العلوم الجديدة والتجارب البشريّة في مجلس الشورى، وتأسيس مئات المؤسّسات الحقوقيّة والاقتصاديّة والسياسيّة بالاستفادة مِن تجارب الدول الأخرى و... للآلاف مِن نشاطات رجال الدولة، الذين ولا شكّ أنَّ لديهم مصالح ومفاسد، ولآلاف نشاطات أفراد
الشعب الذين يطبّقون القوانين في مقام العمل، ولا شكّ أنَّ لديهم مصالح ومفاسد؛ تحدَّدت وظائف مهمّة ومصيريّة. لكنْ ليس بالاستنباط مِن الكتاب والسنّة ـ فهي لم يكن ممكنًا ولن يكون ممكنًا استنباطها مِن الكتاب والسنّة، بل بالاستفادة مِن العلوم والأفكار والفلسفات المعاصرة والحضارة الحديثة والتجارب الحكوميّة للغربيين أو الشرقيين مِن أجل الاستمرار بالحياة في العالم. فإذا لم يكن أمامنا نحن المسلمين في هذا العصر الراهن إلّا هذا الطريق لنحدّد الآلاف مِن أفعالنا، التي تعيِّن مصير حاضرنا ومستقبلنا بالاستفادة مِن أفكار وآراء وعلوم وفلسفات الحضارة الحديثة، والتجارب الإنسانيّة المعاصرة المتطوّرة والمُفيدة، وكان أيّ رجوع إلى الكتاب والسنّة مِن أجل تحديد حكم تلك الأفعال غير مثمر وعقيمًا وعملًا عبثيًّا؛ فكيف لنا أنْ نتظاهر بالجهل، ثمّ نتحدّث مرّة أخرى عن مصداقيّة تلك النظريّة الكلاميّة ـ الفلسفيّة؟!
في هذه الحالة، يجب علينا نحن المسلمين أنْ نغلق في العصر الراهن ملفّ علم الأصول والاجتهاد الفقهي، اللذين كانا نحوًا مِن هرمنيوطيقا الحفاظ على الهويّة الجمعيّة للأمّة، وانقضى عصرهما، ونفسّر الكتاب والسنّة مِن خلال مقاربة الهرمنيوطيقا الفلسفيّة بمعناها الأعمّ الذي هو مقاربة عقلانيّة.
هذا أصل وأساس ذلك المنهج الذي يوصي به راقم هذه السطور منذ عشرين عامًا ويصرّ عليه.
مِن وجهة نظره، فإنَّ النظريّة الداعمة للاجتهاد الفقهي تشكّلت في القرنين الثاني والثالث، وهذا يعني أنَّ الاجتهاد الفقهي أُنجز وأُعْمِل أوّلًا، ثمّ في القرون اللاحقة تفطَّن أئمّة الفقه إلى التفكير للتنظير لمشروعيّته. يقول بصراحة في موضع آخر:
لم يتحدّث الرسول عن الدين الحقيقي الذي هو مخلوق الله تعالى، أو عن أنَّ لله تعالى حكمًا في كلّ واقعة. لا تلاحظ هذه القضايا في القرآن الكريم. لقد صاغها وجعلها علماء الأصول (مجتهد شبستري، ارديبهشت 1394 [بين 21 نيسان و21 أيار 2015]، موقعه الشخصي).
سنتناول فيما يأتي البحث في هذه النظريّة ووجهات النظر المختلفة حولها، ليتّضح أنَّ أساس هذه النظريّة، له أصل في آيات القرآن الكريم وأحاديث الأئمّة المعصومين عليهمالسلام، لا أنَّ الأصوليين والمتكلّمين تفطّنوا بعد مضي قرن أو قرنين لإبداع هذه النظريّة. ستتعرّض المقالة في التتمّة إلى اللوازم التي حمّلها السيّد مجتهد شبستري على هذه النظريّة؛ لتُثبت أنَّ موارد الأحكام التي توهَّم أنَّ لا أصل لها في الاجتهاد الفقهي ثمّ استنتج أنَّ عصر الاجتهاد الفقهي قد انقضى مِن الأساس؛ هو كلام لا أساس له، وناجم عن الخلط بين الأحكام الشرعيّة والأحكام الحكوميّة والتنفيذيّة. سنبحث فيما يأتي وجهات النظر حول دائرة نفوذ الأحكام الفقهيّة.
طبقًا لهذا الرأي، فما مِن واقعة تخلو عن حكم. استند القائلون بوجهة النظر هذه أحيانًا إلى الأدلّة النقليّة فقط، وهم لا يرون مانعًا عقليًّا لخلوّ واقعة عن حكم، إلّا أنَّ بعضًا أيضًا يرى أنّه محال عقلًا.
وفقًا لوجهة نظر صاحب الفصول، رغم أنَّ خلوّ واقعة عن الحكم لا محذور عقلي فيه، فإنَّه وفقًا للأدلة النقليّة، يوجد حكم لكلّ واقعة، بيّنه الله تعالى لرسوله، وهو بدوره بيّنه لأوصيائه. بناء عليه، فإنَّ جميع الأحكام مقرّرة عندهم ومخزونة، ولا يوجد أيّ واقعة خالية عن الحكم الواقعي.
الآيات التي يمكن الاستناد إليها في هذا المجال، هي كالآتي:
﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.
﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾.
أقلّ ما يمكن أنْ تدلّ عليه هاتان الآيتان، هو أنّه لم يُفَرَّط في أيّ شيء يتعلّق بهداية الإنسان وله مدخليّة في هذا الأمر.
واستُدل أيضًا لهذا القول بروايات كثيرة، نستعرض بعضها فيما يلي:
يقول أمير المؤمنين علي عليهالسلام:
«ذَلِكَ القُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ، وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ. أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ: إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَایَأْتِي إلى یَوْمِ الْقِیَامَة، وَحُكْمَ مَا بَیْنَكُمْ وَبَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ، فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَعَلَّمْتُكُمْ».
يقول أيضًا الإمام الصادق عليهالسلام :
«مَا مِن شَيءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتابٌ أَوْ سُنَّةٌ».
يقول أيضًا الإمام الكاظم عليهالسلام :
«قُلْتُ [سماعة] لَهُ: أَكُلُّ شَيءٍ فِي كِتابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيِّهِ، أَو تَقُولُونَ فِيه؟ قالَ عليهالسلام: بَلْ كُلُّ شَيءٍ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيِّه».
نقل عن الإمام الباقرعليهالسلام:
«سَمِعْتُهُ يقول: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئًا تحتاجُ إلَیهِ الأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي کِتَابِهِ وَبَيَّنَهُ لِرِسُولِهِ صلىاللهعليهوآله، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيءٍ حَدًّا، وَجَعَلَ عَلَيهِ دَلِيلًا يَدلُّ عَلَيهِ، وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذلِكَ الحدّ حدًّا».
يقول الإمام الصادق عليهالسلام في هذا المجال:
«إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالى أنْزلَ في القرآن تِبيانَ كُلِّ شيءٍ، حتَّى وَاللهِ مَا تَرَكَ اللهُ شيئًا يحتاجُ إليه العبادُ، حتَّى لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا أُنْزِلَ في القرآن؟ إلّا وقد أنْزَلَهُ اللهُ فِيه».
جدير بالقول، إنّه يمكن أنْ يكون مقتضى بعض الأدلّة السابقة، هو أنَّ الله تعالى بيّن تفاصيل جميع الأمور في كتابه أو في الكتاب وسنّة نبيّه. ومهمّة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام هي فقط تبيين هذه الأمور. بيد أنَّ بعض الأدلّة الأخرى السابقة، تتناسب أيضًا مع أنْ يكون الله تعالى قد عبّأ في القرآن الكريم كيفيّة تبيين جميع المسائل. على سبيل المثال، جعل الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله في فترة حياته مسؤول تبليغ وتبيين الأحكام الجزئيّة، وفي مرحلة ما بعد الرسول، نصب إلى يوم القيامة إنسانًا معصومًا إلى جانب القرآن الكريم، ليلبّي بناء على التعاليم القرآنيّة، جميع احتياجات الناس في مجال الهداية. تشير الروايتان الآتيتان إلى الأمر الثاني.
يقول الإمام الصادق عليهالسلام:
«مَا مِن أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثنان، إلّا وَلَهُ أصْلٌ في كتابِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ، وَلكِنْ لا تَبلُغُهُ عُقُولُ الرِّجال».
وهناك رواية أيضًا عن الإمام الرضا عليهالسلام، تتضمّن إشارات كهذه:
«وَأَمْرُ الإمامةِ مِن تَمامِ الدِّينِ، وَلَمْ يَمْضِ رسولُ الله صلىاللهعليهوآله حتَّى بيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعالِمَ دينِهم، وأوضَحَ لَهُم سبيلَهم، وتركَهم على قَصْدِ سبيل الحقِّ، وأقامَ لهم عليًّاعليهالسلام عَلَمًا وإمامًا. وما تركَ شيئًا تحتاجُ إليه الأمَّة إلّا بيَّنَهُ. فَمَنْ زَعَمَ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يُكْمِلْ دينَهُ، فقد ردَّ كتابَ اللهِ، ومَنْ ردَّ كتابَ اللهِ فهو كافرٌ به».
يتأتّى مِن مجموع هذه الآيات والروايات، أنَّ أساس النظريّة الداعمة للاجتهاد الفقهي، جاء في القرآن الكريم. والروايات أيضًا وردت مفسّرة أحيانًا لهذه الآيات، وورد بعضها أيضًا بنحو مستقلٍّ. بناء عليه، فالقول بأنَّ هذه النظريّة لا أثر لها ولا علامة في القرآن الكريم وكلام الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، بل صيغت وصُقِلت فيما بعد في القرنين الثاني والثالث مِن قبل الأصوليين والمتكلّمين؛ غير صحيح. طبعًا، العلّامة الشعراني رحمهالله استند لعدم خلوّ واقعة عن حكم بالدليل العقلي، وبما أنّه لا يخلو أمر عن حُسن أو قبح ذاتي، استنتج مِن باب ذلك أنَّه ينبغي ولا شكّ أنْ يكون هناك أيضًا حكم يتناسب مع رتبة الحُسن والقبح، إلّا بناء على ما نُسب إلى الأشاعرة، الذين لا يقولون بالحُسن والقبح. تمسّك بعض أيضًا بقاعدة لزوم اللطف، واعتبروا أنّ لازمها هو ضرورة بيان الأحكام الشرعيّة، حتّى الأحكام غير الإلزاميّة، في جميع الوقائع.
وفقًا لهذا الرأي، فإنّه أوّلًا، لم يُقم دليل على عدم خلوّ واقعة عن حكم. وثانيًا، يوجد دليل على خلافه؛ وهو أنّه إذا كان هناك مورد لا اقتضاء له، ولا يوجد أيضًا مصلحة في جعل الإباحة؛ فلا شكّ أنّه لن يكون له حكم أيضًا. أُطلق على هذه الموارد اسم «إباحة لا ـ اقتضائيّة»، وتوضيحه: أنَّ الإباحة قد تكون أحيانًا لجهة أنَّ الحكم نفسه بتساوي الفعل والترك، فيه مصلحة. في هذه
الحالة، فإنَّ حكم الشارع بالإباحة فيه مِلاك، أمّا إذا لم يكن في المورد أيّة مصلحة، فإنَّ حكم الشارع لغوٌ، وتنطبق هذه الموارد على الإباحة العقليّة، التي لا حُكم للشارع فيها.
ينبغي ألّا ننسى القول: إنَّ أمثال الشهيد الصدر رحمهالله القائل بمنطقة الفراغ في غير الإلزاميّات، هو أيضًا يتَّفق مع هذا الرأي؛ إذ إنَّهم يقولون: إنَّ الشارع أعطى للحاكم العادل الشرعي صلاحية صدور الحكم في هذه المنطقة. ومِن الواضح أنَّ المراد بخلوّ الواقعة عن الحكم، هو خلوّ الحكم الشرعي للشارع، لا [خلو] الحكم الحكومي للحاكم، وكما يقول الشهيد الصدر رحمهالله، فإنَّ هذه المنطقة غير خالية عن الحكم، ليلزم النقص في الشريعة، بل حكمها هو أنَّ [الشارع] أعطى الحاكم صلاحية وضع الأحكام في هذه المنطقة، ليُقدِّر حسب اجتهاده مصلحة واحتياج المجتمع، ويحكم. وبهذا النحو، يكون قد أمّن أيضًا أحكام جميع الجوانب المتغيّرة لحياة الإنسان.
ويرى بعضٌ أيضًا، أنَّه حيث تكون الواقعة لا أهميّة لها؛ كاللعب بالسُبحة، فلا إشكال في جواز الخلوّ عن الحكم، حتّى عن الحكم الإنشائي. وكذلك، فحيثما يكون الجعل الشرعي لغوًا، فلنْ يكون هناك حكم. أمّا حيث يكون الأمر مورد ابتلاء المكلفين، ومِن الأمور التي لها شأن، فيجب أنْ يكون لها حكم شرعي، وإلّا لزم النقص في الشريعة المقدّسة.
كاتب هذه المقالة، ضمن تأييده لوجهة النظر الأولى، إلّا في الموارد التي يوجد فيها مانع عن الحكم؛ يرى أنَّه لتبيين وتوضيح المسألة ينبغي القول بالفصل بين ثلاثة مقامات: أ) مقام الحُسن والقبح الذاتي للأمور، ب) مقام إرادة وكراهة المولى، ج) مقام الخطاب وإنشاء الحكم.
ولربّما تكون بعض الأمور حسنة، لكنَّها لم تقع مورد أمر الشارع، ولربّما يكون في أمور قُبحٌ، لكنّها لم تقع مورد نهي الشارع، إذ يمكن أنْ يكون الخطاب وجعل الحكم واجه موانع في مواردٍ، بل أكثر مِن ذلك، بحيث أنَّ الحسن والقبح أيضًا لا يستلزمان الإرادة والكراهة حتّى، بل يمكن أنْ يكونا باعثين على الرغبة أو الكراهية لدى العقل. على سبيل المثال، لا شكّ في قبح الظلم مِن الصبي المميّز غير البالغ، ولا شكّ أيضًا في المفسدة الإلزاميّة لهذا الظلم، ولا شكّ أيضًا في أنَّ المولى لا يريد أنْ يُظلم أحدٌ، حتّى مِن قبل غير بالغ. لكنْ، رغم كلّ هذه الأمور، فليس أيضًا للمولى حكم وجعل مولوي تكليفي. وكذلك في تزاحم الأهمّ والمهمّ، فكلاهما فيه مصلحة ملزمة، وكذلك فإنَّ المولى يريدهما كليهما؛ أي إنَّهما مورد إرادته؛ أي لا شكّ في أنَّ الصلاة مطلوبة للمولى. لكنْ، إذ إنَّها تزاحم الأهمّ، فبناء على بعض الأقوال، فثمّة مانع للخطاب والحكم بها. مع هذا البيان، فكلام السيّد مجتهد شبستري، الذي عدّ المسألة تعتمد على الحُسن والقبح فقط، غير تام.
المسألة الجديرة بالاهتمام هنا، هو أنَّ هذا النزاع والاختلاف بين الأصوليين، هو في موارد الحكم الشرعي للموضوعات والأفعال والوقائع والحوادث؛ أي الموارد التي تأخذ حكمًا، ولها قابليّة جعل الحكم، وهي تشكّل فقط أحد الأضلاع المختلفة للتعاليم الدينيّة. أمّا فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقيّة، القضايا الاعتقاديّة، القضايا المعرفيّة، قضايا علم الوجود، القضايا التربويّة، القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة؛ فلها بحث مِن نمط آخر. أساسًا، في هذه المجالات، في الموارد التي لم ترتبط بتكليف الحاكم أو أفراد المجتمع؛ فإنَّ الفقيه، بما هو فقيه، لا دخل له في فهمها واستنباطها. ليس الفقيه مختصًّا في القضايا التربويّة ومكلّفًا باصطياد واستنباط النظام التربوي للإسلام مِن مصادره. ليس الفقيه متعهدًا ومكلّفًا باستنباط النظام الأخلاقي للإسلام مِن الروايات والآيات والمصادر الأخرى. ليس عمله اقتصاديًّا والورود في علم الاقتصاد والتربية والأخلاق وعلم النفس، مع أنَّ الشطر الأعظم مِن التعاليم الدينيّة يتعلّق بمجال الأخلاق والتربية والعقائد. طبعًا، يجب على الفقيه المتبحّر أنْ يلج، بالسعي المضاعف، المجالات الفقهيّة الجديدة؛ كفقه التربية، فقه الاقتصاد، فقه السياسة وفقه الحكومة، ولربّما يكون في هذه المجالات الحديثة الظهور مسائل فقهيّة كثيرة، تكون موضوعًا للأحكام الخمسة. لكنْ على أيّ حال، فإنَّ الفقيه يبدي وجهة نظره في مجال الأحكام الفقهيّة فقط. وطبعًا، إذا كان فقيهًا جامعًا في هذا المجال، فهو متعهّد بتحديد أحكام جميع الموارد التي تحتاج إلى الحكم والفتوى والقانون. ومصادر الاستنباط الأربعة، لها هذه القدرة على أنْ تتصيّد وتستنبط بالاجتهاد السيّال والممنهج جميع هذه
(369)الأحكام منه. طبعًا، في كثير مِن الموارد غير الفقهيّة، مِن الواضح أنَّه لا يوجد أيّ إلزام لبيان جميع الموارد مِن قبل الشارع. يمكن أنْ تكون كثير مِن حقائق عالم ما بعد الموت غير مبيّنة لنا؛ لأن الشارع المقدّس لم يرَ حاجة لتبيينها، ولربّما يكون الشارع قد ألقى على عهدة الناس أنفسهم كثيرًا مِن القضايا الاجتماعيّة؛ لأنّه وجد فيهم هذه الاستطاعة.
انحصار مصادر الاستنباط بالكتاب والسنّة، هو مِن أخطاء السيّد مجتهد شبستري الأساسيّة، ويُستبعد أنْ يكون كلامه هذا قد صدر دون وعي أو عن غفلة. مصدر العقل هو مِن أهمّ المصادر الدينيّة، خاصّة في المنهج الاستنباطي الشيعي. يدلّ على هذا الأمر روايات كثيرة، مِن ضمنها الروايات الواردة بهذا المضمون، أنَّ لله جلّ جلاله حجّتين على الناس: حجّة ظاهرة؛ أي الأنبياء والأئمّة المعصومين عليهمالسلام، وحجّة باطنة؛ أي العقول. وإذا ما جاء في روايات ما يدلّ على أنَّ كلّ شيء هو في الكتاب والسنّة، فهو يتلاءم مع هذا أنَّ كون العقل مصدرًا، جاء أيضًا في الكتاب والسنّة، أو أنْ يكون قد فُوِّض إلى الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام مهمّة تبيين أو حتّى تشريع تفاصيل الأمور في الكتاب والسنّة. بمعزل عن أنَّ العقل أهمّ وسيلة لفهم الشريعة، بل أهمّ ضامن لصدقيّتها وحجيّتها أيضًا؛ فيجب أنْ يحظى
أساس قبول الدين وأصوله وأركانه على تأييد العقل، وسيكون التسليم للقرآن الكريم والسنّة والرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين ممكنًا أيضًا بعد إمضاء العقل. إنَّ مرجعيّة كهذه للعقل، بُيِّنت وأُيِّدت بصراحة مِن قِبل غادامير، حتّى في الهرمنيوطيقا والهرمنيوطيقا الفلسفيّة التي يحيلنا عليها السيّد مجتهد شبستري. يكتب غادامير في مواجهة هجوم عصر التنوير على مرجعيّة التقليد:
مفهوم المرجعيّة، بناء على الفهم الذي للتنوير عن العقل والحريّة، يمكن أنْ يؤخذ على أنَّه يعارض العقل والحريّة بنحو كامل. المرجعية والسلطة تعنيان في الحقيقة الطاعة العمياء. هذا هو المعنى الذي نعثر عليه في لغة نقد وانتقاد الديكتاتوريّات الحديثة.
لكنْ، حقيقة المرجعيّة ليست هي هذه. تعتمد مرجعيّة الأفراد في نهاية المطاف، لا على جعل العقل تابعًا ومطيعًا، بل على فعل التصديق والمعرفة. المراد بالمعرفة، معرفة أنَّ للآخر تفوّقًا في الحكم والبصيرة على نفس الشخص، ولهذا السبب فإنَّ حكمه مقدّم؛ أي له الأولويّة بالنسبة لحكم الشخص نفسه. تعتمد المرجعيّة على التصديق، ومِن هذا الطريق [تعتمد] على عمل العقل نفسه، العقل الذي مع علمه بمحدوديّاته، فإنّه يعتمد على البصيرة الأسمى للآخرين. مبنى المرجعيّة هو عمل الاختيار والعقل، وهو في الأساس يقبل مَنْ هو فوقه لجهة أنَّ لديه رؤية أوسع تجاه الأمور أو علمًا أكثر، وأيضًا بمعنى أنَّ لديه معرفة أكثر.
وعليه، فتصديق المرجعيّة يرتبط دائمًا بهذه الفكرة، أنَّ ما تقوله المرجعيّة
(371)ليس أمرًا غير معقول وجزافًا، بل أساسًا يمكن كشف صدقه. لبّ المرجعيّة التي يدّعيها المعلّم، الأعلى رتبة والمختصّ، هو هذا.
عنوان المسائل المستحدثة هو بمعنى المسائل حديثة الظهور. وخلافًا لاعتقاد السيّد مجتهد شبستري، فلا تنحصر بعصر النهضة إلى العصر الراهن. واجه الفقهاء في كلّ عصر مسائل جديدة، وعالجوا هذه المسائل باجتهادهم السيّال. ونظرًا إلى المباني والمصادر الدينيّة، استنبطوا الحكم الشرعي وأعلنوه. والشاهد عليه أيضًا، هو تطوّر وتوسّع علم الفقه وعلم الأصول في عصر ما قبل الحداثة، وظهور مجموعات فقهيّة وأصوليّة مكتوبة ومتنوّعة في تلك العصور. توسّع وتكامل علم الفقه وعلم الأصول في مرحلة ما قبل عصر النهضة، كما في مرحلة ما بعد عصر النهضة، هو أكثر ما يكون رهن ورود مسائل جديدة في هذه المجالات. واليوم أيضًا، فإنَّ المسائل الجديدة، طبعًا بمقدار عظيم وتنوّع أكثر بكثير، تتعرّض للتدقيق في مراكز الأبحاث الحوزويّة، وأحيانًا مِن قبل المجتهدين بنحو فرديّ، وتعرض نتائجها على المجتمع والناس بعد استنباط الحكم، ولا يوجد أيّ اختلاف حقيقي وأساسي في كيفيّة الاستنباط، بحيث يكون قد حصل تخطٍّ للفقه الاجتهادي. هذه المسائل نفسها التي يصطلح عليها اليوم بالمسائل المستحدثة، تنتقل بمرور الأيام إلى المسائل الأساسيّة لموضوع الفقه، وستطرح بعدها مسائل جديدة على طول الزمان. وطبعًا، فإنَّ السعي المتواصل للفقهاء وللمراكز الفقهيّة في كلّ زمان، يجب أنْ يلبّي احتياجات ذلك الزمان.
(372)هو يدّعي أنّه مع ظهور الثورة الإسلاميّة في إيران، بطُلت النظريّة الكلاميّة الفلسفيّة الداعمة للاستنباط الفقهي، وكثير مِن الفتاوى الجديدة مستنبطة مِن معطيات العلوم الجديدة، وليس لها أيّ مصدر في الكتاب والسنّة. مع أنَّ أصل كلامه هو محض ادّعاء، ولم يقم أيّ دليل على ادّعائه، فليته بيّن ولو حتّى موردًا واحدًا، موردًا واحدًا فقط مِن فتاوى الفقهاء في المسائل المستحدثة وقضايا ما بعد الثورة، ليس لها أصل في الكتاب والسنّة.
المسائل التي ذكرها السيّد مجتهد شبستري في هذا المجال ـ مِن قبيل أنَّ الفصل بين السلطات، خاصّة تأسيس مجمع تشخيص المصلحة، وتقدّم المصالح العقليّة على الفتاوى الشرعيّة، وتأسيس مئات المؤسّسات الحقوقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، وهي جميعها مِن ثمرات الحضارة الحديثة، التي لا أصل لها في الكتاب والسنّة ـ تشير إلى خلطه وتخبّطه بين الفتاوى الجديدة والموضوعات الجديدة. ترتبط جميع هذه الموارد بمرحلة إجراء الأحكام الشرعيّة، لا أنّها في حدّ ذاتها فتوى أو حكم شرعي. تبدو مغالطة كهذه مِن قبله أمرًا عجيبًا جدًا. إذا كان مراده الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالفصل بين السلطات أو مجمع تشخيص المصلحة أو... ففي هذه الحالة، يجب البحث عن السند والأصل الشرعي لهذه الموارد، ليس في الكتاب والسنّة وحسب، بل في ذينك المصدرين وفي العقل والإجماع، ولكلّ هذه الموارد سندها الشرعي.
مِن المستندات الشرعيّة التي يمكن أنْ تجيب في كثير مِن الموارد على إشكالات مِن هذا القبيل، صلاحيات الحاكم الشرعي، التي تستند بنحو دقيق إلى الكتاب والسنّة والعقل، وهي مِن أهمّ محاصيل الاجتهاد الفقهي. وبعد إثبات أصل صلاحيّاته مِن خلال الكتاب والسنّة والعقل، فإعمال الصلاحيات وكيفيّة تنفيذها، هي آنذاك بيده هو نفسه. إذا اقتضت المصلحة أنْ يدير الحكومة عبر فصل السلطات، فسيفعل ذلك، وإذا رأى صلاحًا في سلطة رابعة أيضًا إلى جانب السلطات الثلاثة الأخرى المعروفة والمعمول بها في العالم؛ فيمكن أنْ يضيفها، أو أنْ يؤسِّس إلى جانب مجلس الشورى الإسلامي مجمع تشخيص المصلحة عوضًا عن مجلس الشيوخ.. إلخ.
يجب البحث حول أساس شروط وخصائص وحدود صلاحيّات الحاكم بمنهجيّة الاجتهاد الفقهي والاستنباطي في المصادر الأربعة للاستنباط، وهذا مِن ضمن الأحكام الأوليّة للإسلام. لكنْ، بعد أنْ وصل الحاكم بتلك الشروط إلى الحكومة؛ يحكم ضمن الدائرة الوسيعة للصلاحيات التي يتمتّع بها. ومع أنَّ هذه الأحكام شرعيّة، وتتضمّن وجوب الالتزام والتبعيّة، فهي ليست في نطاق الشرع ومِن أحكام الشرع المقدّس؛ أي لا يشملها حديث: «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة». بعبارة أخرى: مصدر أحكامه هو الحاكم بما هو حاكم، لا الشارع بما هو شارع. طبقًا لوجهة النظر هذه، يبدو أنّه يمكن للأحكام الحكوميّة أنْ تحلّ المشكلة
الفقهيّة لأكثر الاحتياجات المتغيّرة للحياة الاجتماعيّة، وحتّى الحياة الفرديّة للناس، التي قد لا يمكن تأمينها بشكل مباشر عبر نصّ الشريعة الثابت. ويمكن لقدرة الفقه العظيمة هذه أنْ تكون أحد الأجوبة الرصينة، ردًّا على مَنْ يطرحون ويروّجون لضرورة انسيابيّة وتاريخيّة الأحكام الشرعيّة.
جميع الموارد التي أوردها السيّد مجتهد شبستري كشاهد على الخروج مِن أسلوب الاجتهاد الفقهي وعلم الأصول، على سبيل المثال الأحكام الحكوميّة، في الحقيقة ليست هذه الأحكام مِن الأحكام الاستنباطيّة المُصْطَلَحة، التي تتبع المنهج المتعارف عليه للاجتهاد. إنَّها أمور تنفيذيّة؛ أي أدوات يستعملها حاكم الوقت، بما يتوافق مع تشخيصه، وعبر استشارة ذوي الاختصاص، وهو يستمرّ في استعمالها ما دامت فعّالة، وفي أيّ وقت يعثر فيه على أدوات أكثر فاعليّة؛ فإنّه يستبدلها. طبعًا، فإنَّ منهج الوصول إلى مصاديق المصلحة بالنسبة للحاكم، هو أمر جدير بالبحث في محلّه، وليست المقالة التي بين أيدينا محلّه. المسألة هنا، هي أنّه حصل خلط فظيع في الموارد التي ذكرت مِن قبل السيّد مجتهد شبستري، ولربّما يكون سببها بُعد عهده لعدّة عقود عن الأبحاث العلميّة، والحوزويّة، والاجتهاديّة الدقيقة. ليس في الأساس عمل مجمع تشخيص المصلحة، الاستنباط ليقال: لم يجر فيه أيّ رجوع إلى الكتاب والسنّة. في الحقيقة، لقد خلط بين مقام التنفيذ ومقام الإفتاء، وحمّل خطًأ حكم أحدهما على الآخر.
الحكم الحكومي هو تلك المجموعة مِن الأحكام التي تُنشأُ مِن قبل الحاكم لإجراء الأحكام الشرعيّة، والوصول إلى مصالح ومقاصد الدين مِن جهة، ولتدبير شؤون المجتمع والحكومة مِن جهة ثانية. منهجيّة الحكم الحكومي تختلف بنحو كامل عن الأحكام الشرعيّة. وخلافًا للأحكام الأخرى التي هي استنباطيّة، فإنَّ هذا النوع مِن الأحكام يعتمد على تشخيص مصاديق موضوعات المصلحة، ومنهج تشخيصها هو عقلائي وعرفي، ولا سبيل للتعبّد هنا. الحكم الحكومي هو مقابل فتاوى المجتهدين، التي هي إخبار عن الأحكام الواقعيّة، أو إخبار عن الحجّة الواقعيّة؛ هو إنشاء. الأحكام الحكوميّة هي في طول الأحكام الشرعيّة، لا في عرضها. ومِن حيث أنَّ المِلاك في الأحكام الحكوميّة، هو حفظ المصالح العليا للإسلام والعباد والحكومة، فللتوصّل إلى هذه المصالح والاطمئنان إلى تحقّقها؛ اقترحت مناهج عقليّة وأحيانًا نقليّة. النقطة المهمّة والفرق الأساسي في المنهجيّة بين الأحكام الحكوميّة والأحكام غير الحكوميّة، هو أنَّ الفقيه يسعى في اجتهاده وراء مصدر موثوق ليستخرج منه الحكم الشرعي. لكنْ، في الأحكام الحكوميّة، فلأنَّ العمل الأوّلي للفقيه الحاكم، ليس هو استنباط الحكم؛ إذ إنّه هو نفسه مُنْشئُ الحكم؛ فإنَّ المهمّة الأساسيّة له هي الاستنباط والمعرفة الصحيحة للموضوع، وفي المحصّلة التطبيق الصحيح للأحكام الكليّة على المصاديق، وأيضًا إحراز وجود المصلحة. وبعد تشخيص وجود المصلحة، يُنشئ الحكم طبقًا لهذه المصلحة وبما يقتضيها. بعبارة أخرى: فإنَّ عمل الفقيه هو إعداد جميع المقدّمات لاستنباط الحكم، بينما عمل الحاكم هو إعداد المقدّمات
(376)لتشخيص صحيح للموضوع والمصلحة ومصداقها، ليُقدم هو نفسه على إنشاء الحكم بناء على ذلك.
وكما يقول بعض المحقّقين، فإنَّ الحكم الحكومي قسيم الحكم الإفتائي أو التشريعي والحكم القضائي، لا قسم مِن أيّ منها. الحكم التشريعي هو ذاك القانون الإلهي الثابت الذي لا يمكن تغييره. في الحقيقة، هو ذاك الذي ورد [عنه] في الروايات: «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال أبدًا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدًا إلى يوم القيامة» ولنْ يتغير ولنْ يتبدل أبدًا، وهو أيضًا هو اليوم مورد الفتوى واستنباط الأحكام مِن الأدلّة الشرعيّة. الحكم القضائي هو الحكم الذي يصدر عن منصب القضاء الذي للمعصوم عليهمالسلام أو لنائبه. وفي الحقيقة، فهو إجراء الأحكام الشرعيّة الثابتة في باب فصل الخصومات والدعاوى الدنيويّة على أساس البيّنة، القَسَم، الإقرار والأساليب الأخرى لإثبات الموضوع. لكنَّ الحكم الحكومي أو الحكم الولائي والإجرائي التنفيذي، هو الحكم الصادر عن الحاكم مِن حيث أنَّه حاكم ووالٍ، لا مِن حيث أنّه شارعٌ ومفتٍ وقاضٍ. ولا يدخل هذا القسم في مضمون رواية «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله...»، بل إنَّ طبيعة المسألة في هذه الموارد، تقتضي التوقيت، وقد أُطلق على هذا القسم اسم «الطرف المتغيّر للشريعة»، مع أنَّه في الحقيقة ما مِن حكم طرأ عليه هنا أيّ تغيير وتوقيت، بل كيفيّة إجراء الأحكام الثابتة هي التي تتغيّر بناء على المصالح.
إذا كانت الذاكرة الشريفة للسيّد مجتهد شبستري ما تزال تتذكّر مرحلة دراسته في الحوزة، فسيعلم جيّدًا أنَّ كلّ الآيات التي جاءت في القرآن الكريم، أو الروايات القصيرة التي صدرت عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام، تتضمّن بحارًا مِن المعارف، خاصّة إذا كانت في مقام إلقاء قاعدة أو تعليمٍ عام. على سبيل المثال، فإنَّ رواية «لا تنقض اليقين بالشكّ» ذات الثلاث [الأربع] كلمات، هي مِن بين الروايات التي تتضمّن تعليمًا أساسيًّا وعامًا وقاعدة عامّة للمكلّفين. هو يعلم جيّدًا أنَّ هذه الرواية، هي مصدر أنَّ أصل الاستصحاب معتبرًا في الأحكام الشرعيّة، ويصرف كلّ طالب علوم دينيّة في مرحلة دراسته ثلاثة أعوام على الأقلّ مِن عمره الدراسي لتعلّم هذه القاعدة. جميع علماء الأصول الذين كانوا مِن أهل القلم، ألّفوا كتبًا مسهبة في تدوين هذه القاعدة وفروعها المختلفة.
مثال آخر، الأدلّة العقليّة والنقليّة التي تتضمّن صلاحيات الحاكم الشرعي، رغم أنَّها مِن حيث الحجم ضئيلة وعامّة، فإنّ دائرتها ونطاق عملها ـ كما أشير إليه سابقًا ـ واسع جدًا جدًا ويشمل جميع الأمور التنفيذيّة. حتّى أيضًا إذا حصرنا، كما فعل الشهيد الصدر رحمهالله، نظريّة صلاحيات الحاكم في نطاق المباحات ومنطقة الفراغ؛ فإنَّ هناك أيضًا نطاقًا واسعًا جدًا يحكم فيه الحاكم تبعًا للأصول العقلائيّة. وفي هذا المجال الذي هو مجال تشخيص مصادق المصالح المستنبطة، لا حاجة إلى الاستنباط والاجتهاد الفقهي المُصطلح. لقد فتح الفقه هذا المجال الوسيع في وجه المجتهد.
مثال ثالث، يقول زرارة بن أعين، الذي هو مِن خواص أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ومِن رواة صدر الإسلام العظام:
«جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ أربعين عامًا فتفتيني؟ فقال: يا زرارة، بيت يحج قبل آدم بألفي عام تريد أنْ تفنى مسائله في أربعين عامًا؟».
مثال آخر، الآيتان اللّتان تأمران بالوفاء بالعقود والعهود، اللّتان وردتا بعبارتين قصيرتين جدًا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، و﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾، وبالرجوع إلى الكتب الفقهيّة والاجتهاديّة وكتب التفسير؛ ندرك المجال الواسع الذي اختصّت بهما هاتان الآيتان بشكل عام أو بنحو مطلق، وحدّدتا حكم جميع العقود والعهود إلى يوم القيامة. وكما يقول العلامة الطباطبائي رحمهالله، فإنَّ القرآن الكريم والمفسّرين أيضًا، عدّوا وجوب الوفاء بالعهد مطلقًا، فحتّى إذا كان طرف المعاهدة كافرًا أو مشركًا، وحتّى إذا كان المشرك في موقع ضعف، فما داموا أنّهم [المشركون] على عهدهم وميثاقهم، فلا يجوز النقض الابتدائي للعهد. يعدَّ عامّة المفسّرين «العقود» في الآية السابقة عامّة، ويرون أنَّ وجوب الوفاء بالعقد والعهد في القرآن الكريم، يشمل جميع عهود الإنسان، سواء إزاء ربّه، أو إزاء أبناء جنسه والناس الآخرين، أو إزاء العهود التي أبرمها مع نفسه أو العهود الفرديّة أو الاجتماعيّة، العهود الداخليّة أو الدوليّة،
العهد مع المسلمين أو الكافر أو المشرك، طبعًا مع مراعاة الشروط اللازمة في صحّة العقد والعهد.
وهنا يتّضح معنى قول الإمام الرضا عليهالسلام، إذ يقول: «عَلينا إلقاء الأصول، وعليكم التفرّع». إلى جانب الآيات والروايات كمصدرين غنيين للاستنباط، يجب أيضًا تبيين العقل كمصدر مستقلّ يلعب دورًا في الاجتهاد الفقهي كمصدر للاستنباط مِن جهة، وأيضًا كأهمّ أداة للفهم مِن جهة أخرى.
في النهاية، وبعد أنْ يرى السيّد مجتهد شبستري أنَّ ضرورة تجاوز الاجتهاد الفقهي وعلم الأصول، أمر مسلّم؛ يقترح العمل بالمقاربة الهرمنيوطيقيّة الفلسفيّة بالمعنى الأعمّ، والتي هي مقاربة عقلانيّة في التفسير والاستنباط.
أُبطل في هذه المقالة أساس فرضيّته، وتحدّينا فرضيّاته حول عدم فاعليّة الاجتهاد الفقهي، وعُلِم أنَّ الفقه والاجتهاد الفقهي يمتلك القدرة على الاستجابة لجميع المسائل حديثة الظهور. طبعًا، لا ينكر أحد ضرورة التحوّل في علم الأصول، وتوسيعه وتكميله؛ لكنَّ النقطة المهمّة هي ما هو المنهج والمقاربة المقترحة مِن قِبله، المأخوذة على حدّ قوله مِن الأبحاث الغربيّة في الهرمنيوطيقا؟ وما هي لوازمها وتبعاتها؟ وهو ما يجب بحثه ودراسته في مقالة على حدة. أساسًا ليس لدينا في الدراسات الغربيّة شيء باسم الهرمنيوطيقا
الفلسفيّة بالمعنى الأعمّ، وهذا المصطلح أيضًا، إلى الحدّ الذي وصل إليه علم الكاتب [كاتب المقالة]، هو مِن اختراعه، وما هو بالواضح والبيِّن كثيرًا. ما يتأتّى مِن مطالعة مجموعة آثاره وآرائه، نتيجته هو علمنة الدين وعلمنة الفقه، وعصرنته، وهو أيضًا لا يأبى عن قبول هذه اللوازم، وملتزم بها. وفي البداية طرح في آثاره ومقالاته وأقواله المختلفة، تاريخيّة الأحكام الاجتماعيّة للإسلام، لكنّه طرح أخيرًا ضرورة إعادة النظر في العبادات أيضًا، وهو يرى أنّه أساسًا ينبغي التخلّي عن لغة التكليف، وما جاء أيضًا في النصوص الدينيّة حول العبادات، هو مجرد توصية، إنْ شاء الإنسان أداها، وإنْ لم يشأ لم يؤدّها، وإذا شاء غيّر في مقدارها وكيفيّتها، أو أدّاها كما أوصي بها.
بدهي أنَّ نتيجة وجهة نظر كهذه، ستكون مسخ الدين والقضاء عليه، وتحويل الدين الإلهي إلى الأهواء العصرية البشريّة، ومِن المسلّم أنَّه ما مِن عقل يحكم بضرورة تبعيّة دين كهذا.
في نهاية المقالة، مِن الضروري التذكير بهذه النقطة، وهي أنَّه بما أنَّ الاجتهاد الفقهي مستجيب [للمسائل الحديثة]، ليس بمعنى أنَّ هذا المنهج لا يحتاج إلى تحوّل وتكامل، وأنَّ جميع الأبواب الفقهيّة الجديدة ستكون قابلة للاستنباط على هذا النحو، ومِن دون أيّ تكملة، كما أنّه سابقًا أيضًا لم يكن لهذا المنهج حالة مِن الجمود والسكون، ولطالما زيد على غناه غنًى، باكتشاف قواعد وضوابط جديدة؛ كذلك فليس مرادنا أيضًا هو أنَّ الفقهاء تمكّنوا حتّى الآن مِن الاستفادة مِن جميع قدرات الفقه والاجتهاد الفقهي، ووصلوا إلى
أقصى درجة في الفقاهة؛ إذ بدهي أنّه ما يزال هناك طرق كثيرة لم تفتح ولم تُسلك، وما تزال هناك مسائل كثيرة تنتظر ورود فقهاء العصر فيها والإجابة عنها. الغاية الأساسيّة للمقالة هي إثبات هذه المسألة، أنّه إذا تمكّن الاجتهاد الفقهي إلى الآن مِن تلبية، في الجملة، الاحتياجات؛ فإنّه سيتمكّن مِن الآن فصاعدًا أيضًا مِن ذلك، فقدرته عظيمة، شريطة أنْ يستفاد منها بنحو صحيح.
تُلخّص نتيجة القضايا التي طرحت في المقالة في النقاط الآتية:
1. النظريّة الداعمة للاجتهاد الفقهي لها أوّلًا أصل في القرآن الكريم، ولها ثانيًا مصدر روائي.
2. طبقًا لوجهة النظر المختارة [في هذه المقالة]، عدم خلوّ واقعة عن حكم، له دليل نقلي كما له دليل عقلي، ما دام أنّه لا يوجد منع مِن جعل الحكم.
3. منهج استنباط المسائل حديثة الظهور، هو الاجتهاد الفقهي مِن المصادر المعتبرة، رغم أنّه في نطاق هذا المنهج، فإنّ باب التكامل والتوسُّع ما يزال مفتوحًا.
4. مصادر الاستنباط لا تنحصر، وفقًا لإجماع أصوليي الشيعة، بالكتاب والسنّة، بل تشمل أيضًا العقل والإجماع.
5. السبب الذي جعل السيّد مجتهد شبستري يتوهّم عدم فاعليّة الاجتهاد الفقهي في الأمور الحكوميّة، هو الخلط بين الأحكام الشرعيّة والأحكام الحكوميّة ومنهجيّة كليهما.
6. وفي هذا المجال خلط أيضًا بين مقام الإفتاء ومقام التنفيذ، وخلط أمورًا مِن قبيل تأسيس مجمع تشخيص المصلحة وفصل السلطات و... والتي هي أدوات الحاكم لإجراء الأحكام الشرعيّة الأوليّة مع الأمور الفتوائيّة.
7. الاجتهاد الفقهي فعّال فقط في استنباط الأحكام الشرعيّة، أمّا في الأحكام الحكوميّة التي تختلف مِن حيث المصدر والمنبع والحقيقة، وليست في الأساس مِن سنخ الاستنباط؛ فإنَّ إعمال هذا المنهج هو أيضًا غير صحيح.
8. منهجه المقترح، الذي يبتنى على ضرورة المقاربة العقلانيّة الهرمنيوطيقيّة في التفسير، سيفضي إلى مسخ الدين والقضاء عليه، وسيتحوّل الدين الإلهي إلى الأهواء والرغبات العصريّة للبشر.
الآخوند الخراساني، الملا محمّد كاظم، فوائد الأصول، طهران، وزارة الإرشاد، 1407ق.
الحائري الأصفهاني، محمّد حسين، الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة؛ قم: دار إحياء العلوم الإسلاميّة، 1404ق.
الدربندي، آغا بن عابد، خزائن الأحكام: قم، مؤلف، [بلا تاريخ].
السبحاني التبريزي، جعفر، تهذيب الأصول، تقريرات درس الإمام الخميني رحمهالله، قم، دار الفكر، 1382.
سند، محمّد، ملكية الدولة، برمجيّات نور للحاسوب.
الشعراني، أبو الحسن، المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه، تحقيق رضا أستادي، قم، مؤسّسة الهادي، 1373.
الصادقي الطهراني، محمّد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ قم: مطبوعات الثقافة الإسلاميّة، ط12، 1406ق.
الصدر، محمّد باقر، اقتصادنا؛ قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1375.
الصدوق، محمّد بن علي، مَنْ لا يحضره الفقيه؛ الطبعة الثانية، قم، مركز المطبوعات الإسلاميّة، 1413ق.
ــــــــــ ، الأمالي، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1400ق.
ــــــــــ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام، طهران، مطبوعات جهان، 1378ق.
الطباطبائي، السيّد محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، مركز مطبوعات جماعة المدرّسين، الطبعة الخامسة، 1417ق.
عرب صالحي، محمّد، منهجيّة الحكم، الطبعة الثانية، طهران، معهد دراسات الثقافة
والفكر الإسلامي، طهران، 1394.
ــــــــــ ، «حقيقة الحكم الولائي ونتيجة منهجيّته»، فصليّة الحقوق الإسلاميّة، العدد 37، 1392.
الفيض الكاشاني، الملّا محسن، الأصفى في تفسير القرآن، قم، مركز مطبوعات مركز الإعلام الإسلامي، 1418ق.
قدسي، أحمد، أنوار الأصول، تقريرات درس ناصر مكارم الشيرازي، 1428ق، قم، مدرسة الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام، ط2، 1428ق.
الكاشاني، الملّا فتح الله، زبدة التفاسير، قم، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، 1423ق.
الكُليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، الطبعة الرابعة، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1407ق.
مجتهد شبستري، محمّد، «چرا دوران علم اصول واجتهاد فقهی سپری شده است؟» (لماذا انقضى عصر علم الأصول والاجتهاد الفقهي؟)، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز دائرة المعارف الإسلاميّة الکبری)، 31/5/1401.
www.cgie.org.ir/fa/news/129753/
ــــــــــ ، «در عبادات هم باید تجدیدنظرهایی بشود» (في العبادات أيضًا ينبغي إعادة النظر)، إنصاف نیوز، 31/5/1401.
www.ensafnews.com/54481/
ــــــــــ ؛ «اوامر و نواهی قرآن» (الأوامر والنواهي في القرآن)، نشر في موقعه الشخصي، 31/5/1401.
mohammadmojtahedshabestari.com/اوامر-و-نواهی-قرآن/
(385)
المجلسي، محمّد باقر، بحارالأنوار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1403ق.
مكارم الشيرازي، ناصر، التفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1374.
الموسوي الخميني، السيّد روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمهالله، 1415ق.
ــــــــــ ، صحيفة الإمام، ج20، طهران، مؤسّسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني رحمهالله، الطبعة الأولى، 1378.
Gadamer, Hans - Georg; Truth And Method(a); Second Revisd Edition Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshal, New York, 1994.
(386)