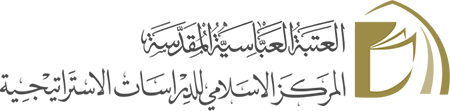
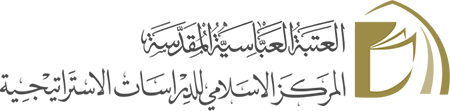
مقدّمة المركز 9
المنهجيَّة التأسيسيَّة لمشروع التراث والتجديد لحسن حنفي / نصر الله آقاجاني 11
المقدّمة 11
السيرة العلميَّة لحسن حنفي 13
خلفيّات تبلور فكر حسن حنفي 16
البيئة التي عاش فيها 17
المحيط الدراسي 18
المباني النظريَّة والمنهجيَّة لتفكير حسن حنفي 19
المباني النظريَّة لتفكير حسن حنفي 19
النزعة النسبيَّة 20
النزعة النفعيَّة 22
نفي القداسة 23
الرؤية التاريخيَّة والنزعة الحضاريَّة 24
النزعة الإنسويَّة 25
التفسير العلماني للدِّين 26
الاتِّجاه الظاهراتي 28
نقد المباني الفكريَّة لحنفي 33
المنهجیّة لفكر حسن حنفي 41
نقد الاتِّجاه المنهجي لحسن حنفي 45
بنية المشروع الفكري لحسن حنفي 47
النقد والتقييم لبنية مشروعه 54
حنفيّ والاستغراب 59
حنفي وعلم الاستغراب 60
الوعي الأُوروبي عند حسن حنفي 65
التقييم النهائي للنظريّة الاستغرابيَّة للحنفي 140
التعريف بالإسلام والتراث الإسلامي في فكر حنفي 150
ماهيَّة التراث الإسلامي 151
خصائص التراث 152
نقد وتحليل 159
إصلاح التراث 165
نقد وتحليل 174
حنفي وتجديد العلوم الإسلاميَّة 192
التجديد في التراث الكلامي وتبلور الإنسان والتاريخ 193
نقد وتحليل 199
التجديد في التراث الفلسفي 206
نقد وتحليل 214
التجديد في التراث التفسيري 222
نقد وتحليل 234
التقييم النهائي لاتِّجاه حنفي في تجديد التراث الإسلامي 246
التراث في مخالب المعاصرة 248
الإلهيّات في هامش السياسة 249
الأخطاء في تعريف التراث 250
تعيُّن الإنسان أو الحيرة والتحرُّر 251
النزعة الواقعيَّة أو الحكاية عن الواقع 252
الإسلام في ضوء التفسير العلماني والإلحادي والماركسي 253
الخلاصة 256
المصادر 258
دراسة تحليليّة ــ نقديّة لرؤية حسن حنفي في حقل الارتباط بين النظر والعمل / حسن عبدي 263
الخلاصة 263
المقدّمة 265
العلاقة بين النظر والعمل 266
أسباب الانفصال بين النظر والعمل 269
العامل الأوّل: عدم الاهتمام بالتجربة الحيّة 269
العامل الثاني: التخلّف العلمي 271
العامل الثالث: عبادة الأشخاص 275
العامل الرابع: الاغتراب 276
طرق التغلّب على الشرخ والانفصال بين النظر والعمل 278
طريقة الحلّ الأولى: تدوين الأيديولوجيّة 278
طريقة الحلّ الثانية: إعادة قراءة التراث 280
طريقة الحلّ الثالثة: إعادة قراءة العقل 283
طريقة الحلّ الرابعة: ديالكتيك النظر والعمل 284
ملاحظات نقديّة 287
الإشكال الأوّل: نفي أصول التراث 287
الإشكال الثاني: نفي الواقعيّة 288
الإشكال الثالث: النزعة الإيمانيّة 290
الإشكال الرابع: طريقة الحلّ غير المجدية 291
الإشكال الخامس: الثنائيّة 292
الإشكال السادس: عدم وجود المنهج الجامع 294
الإشكال السابع: عدم وجود التحليل العميق 295
الإشكال الثامن: وجود التهافت في آراء حسن حنفي 297
النتيجة 305
المصادر 307
بحث في القراءة الظاهراتيّة للدكتور حسن حنفي عن الصوفيّة / أحمد قطبي ميمندي 309
الخلاصة 309
المقدّمة 310
الدكتور حنفي وظاهراتيّة التصوّف 314
تحليل حسن حنفي لخلفيّات الاتجاه نحو التصوّف 317
بيان ظاهراتيّة التأويل في التصوّف 322
علوم التصوّف 327
1. التصوّف الأخلاقي 328
2. التصوّف النفسي 330
3. التصوّف الفلسفي 331
الدكتور حسن حنفي وتقييم إعادة قراءة تجربة التصوّف 334
إعادة قراءة التصوّف 338
1. العبور مِن القيَم السلبيّة إلى القيَم الإيجابيّة 339
2. إصلاح التصوّف الفلسفي 340
بحث نقدي لقراءة الدكتور حسن حنفي عن التصوّف 343
النتيجة 348
المصادر 351
رؤى نقدية معاصرة 8
حسن حنفي
دراسة النظريات ونقدها
مجموعة مؤلفين
العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
(1)بسم الله الرحمن الرحيم
(3)العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
حسن حنفي دراسة النظريات ونقدها / مجموعة مؤلفين - الطبعة الأولى - النجف العراق..
العتبة العباسية المقدسة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ١٤٤٥ هـ = ٢٠٢٣.
٣٥٢ صفحة : ٢١×١٥ سم رؤى نقدية معاصرة : (۸)
ردمك : ٩٧٨٩٩٢٢٦٨٠٢٦٢
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة ٣٥١-٣٥٢.
۱. حنفي، حسن، ۱۹۳۵-۲۰۲۱. ۲. الفلاسفة المسلمون. أ. العنوان.
LCC: B5344.H364 H37 2023
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة فهرسة اثناء النشر
حسن حنفى دراسة النظريات ونقدها رؤى نقدية معاصرة - (8)
تأليف: مجموعة مؤلفين
الناشر: العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية
الطبعة: الأولى، 2023 م
Website: www.iicss.iq
E-Mail: islamic.css@gmail.com
Telegram: @iicss
مقدّمة المركز 9
المنهجيَّة التأسيسيَّة لمشروع التراث والتجديد لحسن حنفي11
المقدّمة11
السيرة العلميَّة لحسن حنفي13
خلفيّات تبلور فكر حسن حنفي16
البيئة التي عاش فيها 17
المحيط الدراسي 18
المباني النظريَّة والمنهجيَّة لتفكير حسن حنفي19
المباني النظريَّة لتفكير حسن حنفي19
النزعة النسبيَّة20
النزعة النفعيَّة22
نفي القداسة23
الرؤية التاريخيَّة والنزعة الحضاريَّة 24
النزعة الإنسويَّة25
التفسير العلماني للدِّين26
الاتِّجاه الظاهراتي28
نقد المباني الفكريَّة لحنفي 33
المنهجیّة لفكر حسن حنفي41
نقد الاتِّجاه المنهجي لحسن حنفي 45
بنية المشروع الفكري لحسن حنفي47
النقد والتقييم لبنية مشروعه54
حنفيّ والاستغراب59
حنفي وعلم الاستغراب60
الوعي الأُوروبي عند حسن حنفي65
التقييم النهائي للنظريّة الاستغرابيَّة للحنفي140
التعريف بالإسلام والتراث الإسلامي في فكر حنفي 150
ماهيَّة التراث الإسلامي 151
خصائص التراث152
نقد وتحليل159
إصلاح التراث165
نقد وتحليل 174
حنفي وتجديد العلوم الإسلاميَّة192
التجديد في التراث الكلامي وتبلور الإنسان والتاريخ 193
نقد وتحليل 199
التجديد في التراث الفلسفي206
نقد وتحليل 214
التجديد في التراث التفسيري222
نقد وتحليل 234
التقييم النهائي لاتِّجاه حنفي في تجديد التراث الإسلامي246
التراث في مخالب المعاصرة 248
الإلهيّات في هامش السياسة 249
الأخطاء في تعريف التراث 250
تعيُّن الإنسان أو الحيرة والتحرُّر 251
النزعة الواقعيَّة أو الحكاية عن الواقع252
الإسلام في ضوء التفسير العلماني والإلحادي والماركسي253
الخلاصة 256
المصادر 258
دراسة تحليليّة ــ نقديّة لرؤية حسن حنفي في
حقل الارتباط بين النظر والعمل 263
الخلاصة 263
المقدّمة 265
العلاقة بين النظر والعمل 266
أسباب الانفصال بين النظر والعمل269
العامل الأوّل: عدم الاهتمام بالتجربة الحيّة 269
العامل الثاني: التخلّف العلمي271
العامل الثالث: عبادة الأشخاص 275
العامل الرابع: الاغتراب 276
طرق التغلّب على الشرخ والانفصال بين النظر والعمل 278
طريقة الحلّ الأولى: تدوين الأيديولوجيّة 278
طريقة الحلّ الثانية: إعادة قراءة التراث 280
طريقة الحلّ الثالثة: إعادة قراءة العقل 283
طريقة الحلّ الرابعة: ديالكتيك النظر والعمل 284
ملاحظات نقديّة 287
الإشكال الأوّل: نفي أصول التراث 287
الإشكال الثاني: نفي الواقعيّة 288
الإشكال الثالث: النزعة الإيمانيّة 290
الإشكال الرابع: طريقة الحلّ غير المجدية 291
الإشكال الخامس: الثنائيّة 292
الإشكال السادس: عدم وجود المنهج الجامع 294
الإشكال السابع: عدم وجود التحليل العميق 295
الإشكال الثامن: وجود التهافت في آراء حسن حنفي 297
النتيجة305
المصادر 307
بحث في القراءة الظاهراتيّة للدكتور
حسن حنفي عن الصوفيّة309
الخلاصة 309
المقدّمة 310
الدكتور حنفي وظاهراتيّة التصوّف 314
تحليل حسن حنفي لخلفيّات الاتجاه نحو التصوّف 317
بيان ظاهراتيّة التأويل في التصوّف 322
علوم التصوّف 327
1. التصوّف الأخلاقي 328
2. التصوّف النفسي 330
3. التصوّف الفلسفي 331
الدكتور حسن حنفي وتقييم إعادة قراءة تجربة التصوّف 334
إعادة قراءة التصوّف 338
1. العبور مِن القيَم السلبيّة إلى القيَم الإيجابيّة 339
2. إصلاح التصوّف الفلسفي 340
بحث نقدي لقراءة الدكتور حسن حنفي عن التصوّف 343
النتيجة 348
المصادر 351
يُعتبر الفكر المعاصر مكوّنًا أساسيًّا في المنظومة الفكريّة الإسلاميّة، ويتبلور هذا الفكر على أرض الواقع حينما تشهد الساحة ظهور فكرٍ «آخر» بصفته ثقافةً وسلسلةَ مفاهيم دلاليّة منافسة، فالزمان والمكان إلى جانب المنافسة التي تحدث على ضوء مجموعةٍ من المفاهيم التي يطرحها «الآخرون»، كلّها أمورٌ تحفّز المدارس الفكريّة والثقافات الأصيلة للعمل على التأقلم مع الظروف الجديدة، وفي الحين ذاته تحفّزها على السعي للحفاظ على حيويّتها وخصوصيّاتها التي تميّزها عن «الآخر». غير أنَّ التاريخ شهد في بعض مراحله، إقبال العلماء المسلمين على التراث الفلسفي الإغريقي باعتباره نطاقًا منسجمًا من الناحية الدلاليّة وذا مضامين عميقة، لدرجة أنّ بعض الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن رشد ولجوا في فضائه الفكري، وحاولوا إقامة تعريف لمعانيهم ورؤاهم الدينيّة متلائمًا مع هذا الآخر الدخيل. ففي العصر الراهن، باتت الثقافة والحضارة الغربيّتان الحديثتان المتقوّمتان على أسسٍ علمانيّةٍ وتوسّعيّةٍ، تمثّلان «الآخر» بالنسبة إلينا ولسائر الثقافات غير الغربيّة. النظام الدلالي المنبثق من الفكر الغربي قد أسفر عن إيجاد تحدّياتٍ كبيرةٍ لـ«ذاتنا الإسلاميّة» بفضل تفوّقه سياسيًّا واقتصاديًّا، ويتّسع نطاق هذا التحدّي أكثر يومًا بعد يومٍ؛ لذلك طرحت العديد من الحلول لمواجهته، وقد استسلم بعضهم لواقع الأمور، فراحوا يبحثون عن الحلّ في العالم الغربي نفسه،
(9)لذا دعوا بانفعالٍ إلى ضرورة ملاءمة «ذاتنا» مع هذا «الآخر»، إلا أنَّ آخرين سلكوا نهجًا مغايرًا، ودعوا إلى تفعيل تراث «ذاتنا»، وأكّدوا على أنّ الحلّ لا يتبلور في ديار منافسنا. نعم، تراثنا المعاصر هو ثمرةٌ لكلّ حلٍّ يمكن أنْ يطرح في هذا المضمار.
وفي هذا السياق، بادر المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجيّة عبر مجموعة من الباحثين إلى استطلاع المشاريع الفكريّة لأبرز العلماء والمفکّرين في العالم الإسلامي من الذين تنصبّ نشاطاتهم الفكريّة في بوتقة الفكر المعاصر؛ وذلك بهدف بيان واقع مسيرة إنتاجهم الفكري وكيفيّة تبلور آرائهم بصياغتها النهائيّة. وفي هذا النمط من الدّراسات، عادةً ما يتمّ تسليط الضوء على مسيرة الإنتاج الفكري الهادف إلى إيجاد خلفيّاتٍ ومبانٍ فكريّةٍ ونظريّاتٍ تحت عنوان «المنهجیّة التأسیسیّة» من خلال دراسة وتحليل مدى نجاح الفكر المعاصر أو إخفاقه بشكلٍ صريحٍ وشفّافٍ.
يتضمَّن هذا الجزء مجموعة من البحوث التخصّصية، خصّصت لدراسة وتحليل ونقد قضايا فكريّة مفصليّة ورئيسة طرحها حسن حنفي، علمًا بأنّه من المؤلِّفين المكثرين، حيث صنّف الكثير من المؤلّفات في هذا الحقل العلمي. ومن خلال هذا العمل، سنقوم كخطوةٍ أولى بتظهير ـ من خلال فكرة المنهجيّة التأسیسيّة ـ مسار تبلور مشروعه الفکري؛ حيث نقوم بطرح خلفيّاته و مبانيه وآرائه ونظريّاته. وفي الخطوة الثانية، وعبر مقالتین، نسعى إلى تبیين القضايا التي طرحها في آرائه ونظريّاته؛ حيث قمنا بدراساتٍ تحليليّة ذات طابع نقدي؛ بغية أنْ تتّضح لنا آفاق هذا المشروع ومدى نجاحه أو فشله في رحاب أسس الثقافة الإسلاميّة.
وفي الختام، نتقدّم بالشكر الجزيل لجميع الفضلاء الذين أسهموا بشكل أو بآخر في تحقيق هذا العمل، والحمد لله ربِّ العالمين.
(10)نصر الله آقاجاني
يُعَدُّ حسن حنفي من الشخصيّات المصريَّة المعاصرة، حيث أنفق خمسين سنة من حياته علىٰ مشروع التراث والتجديد، وقد ترك تأثيره علىٰ بعض النُّخَب والمنظِّرين العرب. يحتوي هذا المشروع علىٰ ثلاثة أبعاد أو محاور، علىٰ النحو الآتي: إعادة صياغة التراث الإسلامي، ومعرفة الغرب، والتعرُّف علىٰ المسائل المتعلِّقة بواقع المسلمين الراهن، ومن هنا فقد قام بعرض أفكاره حول هذه الحقول الثلاثة علىٰ المستويين العامِّ والخاصِّ.
وقد أصدر في إطار إصلاح وإعادة صياغة التراث الإسلامي كُتُبًا موسوعيَّة، مثل: من العقيدة إلىٰ الثورة، ومن النقل إلىٰ الإبداع، ومن النصِّ إلىٰ الواقع، ومن الفناء إلىٰ البقاء وغيرها من الكُتُب الأُخرىٰ. وقد عمد في كلِّ واحدٍ من هذه الكُتُب، علىٰ التوالي، إلىٰ إعادة قراءة علم أُصول الدِّين أو العقائد، وعلوم الحكمة، وعلم أُصول الفقه والعرفان. وفي حقل علم
الاستغراب، ألَّف حسن حنفي الكثير من الكُتُب، وإذا ما استثنينا المقالات والكُتُب التي ألَّفها حول المدارس الفلسفيَّة والشخصيّات الغربيَّة، فقد قام بجهد واسع في كتابه مقدّمة في علم الاستغراب حول معرفة الغرب، بحيث يمكن اعتباره من أكمل أعماله وآثاره في هذا المجال. ثمّ تابع إعادة التعريف بالمسائل المرتبطة بالواقعيَّة المعاصرة للمسلمين في كُتُبه الأُخرىٰ، من قبيل: مناهج التفسير، ومحاولة في علم أُصول الفقه، وتفسير الظاهريّات، والحالة الراهنة للمنهج الظاهراتي وتطبيقه في ظاهرة الدِّين وظاهريّات التفسير، ومحاولة لتفسير وجودي للعهد الجديد.
سوف نتناول في هذه الدراسة آراء حسن حنفي حول الغرب والتراث الإسلامي بالدراسة والتحليل. يقوم هذا التحليل علىٰ أساس منهج بعنوان المنهجيَّة التأسیسیَّة. يتمُّ في هذه المنهجيَّة توضيح كيفيَّة تبلور التفكير أو النظريَّة، والمسألة الأساسيَّة فيها بيان الأرضيَّة والظروف والمباني الفلسفيَّة التي قامت عليها نظريَّة ما. تعمد هذه المنهجيَّة من خلال بيان المباني الفلسفيَّة لنظريَّة ما، إلىٰ إعداد الأرضيَّة لتقييمها من خلال بحثها ونقد مبانيها.
ومن هنا تسعىٰ هذه المقالة، في إطار نموذج المنهجيَّة التأسیسیَّة، بعد إطلالة علىٰ السيرة العلميَّة لحسن حنفي، إلىٰ نقد بنائي لفکره من خلال دراسة خلفيّات تبلور المنهج الفكري لحنفي، وكذلك المباني النظريَّة والمنهجيَّة لتفكيره. كما سوف نهتمُّ بنقد بنائي لآرائه بغيَّة تقييم شامل لمشروعه الفكري، بعد بيان تركيبة وبنية هذا المشروع الفكري.
(12)وُلِدَ حسن حنفي مؤسِّس «اليسار الإسلامي» في مصر سنة 1935م في القاهرة. وعندما كان طالبًا في مرحلته الإعداديَّة سنة 1948م تعرَّف علىٰ فكر ونشاط الإخوان المسلمين، وقد تحدَّث عن ذلك قائلًا:
في عام 1952م دخلت رسميًّا ضمن جماعة للإخوان المسلمين التي كانت تجمع بين الإسلام والوطن؛ إذ كان حزب الوفد وطنيًّا، وكان الشيوعيُّون أصحاب فكر غربي، جماعة «مصر الفتاة» كانت تمارس العنف، فكان الإخوان هم الذين يجمعون بين الإسلام والثورة، والإسلام والوطن، ولذلك رجَّحت الانتساب إلىٰ الإخوان المسلمين. وقال بأنَّه تعرَّف علىٰ سيِّد قطب وتأثَّر بكتاباته الأُولىٰ، مثل: «العدالة الاجتماعيَّة في الإسلام»، و«معركة الإسلام والرأسماليَّة»، و«السلام العالمي والإسلام»، دون كتابه «معالم في الطريق».
لقد أنهىٰ حسن حنفي دراسته في فرع الفلسفة في جامعة القاهرة، وفي عام 1954 للميلاد انتقل إلىٰ جامعة السوربون في فرنسا لمواصلة الدراسة، حيث حصل علىٰ شهادة دكتوراه في الفلسفة سنة 1966م. وفي مدَّة إقامته، التي امتدَّت لعقد من الزمن في فرنسا، تعرَّف علىٰ عليٍّ شريعتي وحسن الترابي. وبعد العودة إلىٰ مصر سنة 1967م، مارس التدريس في جامعة القاهرة، وقام في الوقت نفسه بالتركيز علىٰ تأليفاته في مختلف السطوح العلميَّة والتخصُّصيَّة والثقافيَّة والعامَّة. وبالإضافة إلىٰ التدريس في جامعة مصر، كان يُدعىٰ إلىٰ
بلدان مثل: بلجيكا، والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، وفرنسا، واليابان، والمغرب، وبلدان الخليج؛ ليمارس التدريس في جامعاتها بصفته أستاذًا زائرًا. وحاليًّا يمارس تدريس الفلسفة في كلّيَّة الآداب في جامعة القاهرة. يُعَدُّ حسن حنفي من أشهر المفكِّرين العرب المعاصرين، وتعود شهرته إلىٰ ناحيتين، وهما:
أوَّلًا: تأسيس تيّار اليسار الإسلامي في مصر. وثانيًا: تحقيقه ومؤلَّفاته العديدة في مشروعه الضخم تحت عنوان «التجديد والتراث»، حيث أنفق علىٰ هذا المشروع الكثير من سنوات عمره.
لقد أصدر حسن حنفي سنة 1981م مجلَّة باسم «اليسار الإسلامي»، وعمد فيها إلىٰ بيان أهدافه وأفكاره، وقال بأنَّ الغاية الأساسيَّة لليسار الإسلامي تكمن في إيقاظ الأُمَّة الإسلاميَّة، والعمل علىٰ إطلاق نهضة جديدة، ونبذ الطُّرُق والأساليب الجزئيَّة والفرديَّة، وتقديم رؤية شاملة وعامَّة عن واقع الأُمَّة الإسلاميَّة في التاريخ. إنَّ تيّار اليسار الإسلامي يهدف، من وجهة نظره، إلىٰ بناء الوحدة الوطنيَّة، وحلِّ النزاع بين التيّار السلفي الإسلامي والتيّار العلماني الاستغرابي، وهذا الهدف المهمُّ إنَّما يتمُّ تحقيقه عبر تغيير الوضع القائم من خلال الرجوع إلىٰ التراث الماضي وتغييره بما يتناسب مع القراءة المعاصرة.
تندرج سلسلة مؤلَّفات وأعمال حسن حنفي ضمن ثلاثة حقول، وهي: حقل إعادة صياغة أو تجديد التراث الإسلامي، وحقل معرفة الغرب، وحقل
التعرُّف علىٰ المسائل المتعلِّقة بواقع المسلمين الراهن. وإنَّ أغلب وأهمَّ كُتُبه، هي تلك التي ألَّفها باللغة العربيَّة، وله بعض الأعمال التي كتبها باللغة الإنجليزيَّة والفرنسيَّة أيضًا. وفيما يلي نستعرض بعض أعماله وآثاره المهمَّة علىٰ النحو الآتي:
1. من العقيدة إلىٰ الثورة (خمسة مجلَّدات)، القاهرة، 1988م.
2. هموم الفكر والوطن (مجلَّدان)، الإسكندريَّة، 1996م.
3. قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، القاهرة، 1976م.
4. في الفكر الغربي المعاصر، القاهرة، 1977م.
5. الدِّين والثورة في مصر (ثمانيَّة مجلَّدات)، القاهرة، 1989م.
6. التراث والتجديد، القاهرة، 1980م.
7. مقدّمة في علم الاستغراب، القاهرة، 1991م.
8. دراسات إسلاميَّة، القاهرة، 1982م.
9. دراسات فلسفيَّة (مجلَّدان)، القاهرة، 1987م.
10. من النقل إلىٰ الإبداع (سبعة مجلَّدات)، 2000 ـ 2002م.
11. من النصِّ إلىٰ الواقع (مجلَّدان)، 2005م.
12. حصار الزمن الحاضر (مفكِّرون معاصرون)، القاهرة، 2002 ـ 2004م.
13. نموذج في الفلسفة المسيحيَّة، الإسكندريَّة، 1973م.
14. سبينوزا: رسالة في اللّاهوت والسياسة، القاهرة، 1973م.
15. ليسنج: تربية الجنس البشري وأعمال أُخرىٰ، القاهرة، 1977م.
16. جان بول سارتر: تعالي الأنا موجود، القاهرة، 1977م.
17. الحكومة الإسلاميَّة للإمام الخميني (تحقيق ومقدّمة).
18. جهاد النفس والجهاد الأكبر للإمام الخميني (تحقيق ومقدّمة).
19. المعتمد في أُصول الفقه لأبي الحسين البصري (مجلَّدان)، تحقيق، 1964م.
20. حوار المشرق والمغرب، حسن حنفي ومحمّد عابد الجابري.
21. ما العولمة؟ حسن حنفي وصادق جلال العظم.
22. الإسلام والحداثة.
23. جمال الدِّين الأفغاني.
كما أنَّ لحسن حنفي الكثير من المقالات باللغة العربيَّة والإنجليزيَّة، ولكنَّنا نعرض عن ذكرها خشية الإطالة. ويعود سبب اختيارنا لهذه الشخصيَّة المصريَّة، بالإضافة إلىٰ كونه مطروحًا في الأروقة العلميَّة العربيَّة، إلىٰ أنَّه يحظىٰ بأهمّيَّة لمجتمعنا العلمي أيضًا، إذ يُشار إليه في الكثير من المقالات والمصادر بوصفه «معتزليًّا جديدًا» ومؤسِّسًا لتيّار «اليسار الإسلامي» في مصر، ولربَّما تمَّ تقييم أفكاره واتِّجاهاته في إطار حركة الصحوة الإسلاميَّة. وعليه، فإنَّ التعرُّف علىٰ أفكاره، بالنظر إلىٰ الأعمال التي قام بها، سيكون مفيدًا لمجتمعنا العلمي.
يبدو أنَّ بالإمكان توضيح التكوين الفكري لحسن حنفي علىٰ أساس عاملين، وهما: المحيط الذي عاش فيه، والبيئة الدراسيَّة التي تلقّىٰ تعليمه فيها؛ وذلك لأنَّ المدارس الفكريَّة أو التيّارات السياسيَّة/ الاجتماعيَّة، إنَّما تركت تأثيرها علىٰ أفكاره في أحضان هذين العاملين.
وُلِدَ حسن حنفي ونشأ وترعرع في مصر، وهو البلد الذي كان في مقدّمة المواجهة بين الإسلام والتجديد في القرن التاسع عشر للميلاد، وقد شهد اتِّجاهات متفاوتة ومتخالفة بشأن الغرب. فمن جهة الاتِّجاهات المختلفة من قبيل الإخوان المسلمين، الذين نهضوا لمواجهة التجديد الغربي بهدف العودة إلىٰ الأُصول والمباني الإسلاميَّة، وقد اعترف حسن حنفي بأنَّه قد أمضىٰ شطرًا من شبابه مع هذه الجماعة، إلَّا أنَّه بعد القضاء عليها بشدَّة من قِبَل عبد الناصر، توجَّه إلىٰ فرنسا لمواصلة دراسته. ومن ناحية أُخرىٰ، فإنَّ التيّارات العلمانيَّة وغير الإسلاميَّة سعت، من خلال تعلُّقها بالمفاهيم الجديدة للحضارة الغربيَّة، إلىٰ إحداث تغيير أساسي في الثقافة والتركيبة السياسيَّة والاجتماعيَّة لمصر، ولا شكَّ في أنَّ هذين التيّارين قد عملا علىٰ تعميق الشرخ والصراع الاجتماعي.
إنَّ منعطفات التيّار الاستغرابي في مصر وفي العالم الإسلامي، قد ابتليت بمصير الآفة المحتوم والوباء الذاتي في عالم الإسلام. إنَّ المستغربين لم يكتفوا بعدم تقديم حلول لتخلُّف المجتمعات الإسلاميَّة ومصر فحسب، بل عمدوا من خلال تقديم الوصفات غير الذاتيَّة والموبوءة إلىٰ مفاقمة المشكلة، وتسبَّبوا بتشديد أزمة الهويَّة. إنَّ عدم جدوائيَّة التيّار أعلاه إلىٰ جوار تبلور تيّار الصحوة الإسلاميَّة، قد حمل رسالة واضحة لتيّار التجديد الدِّيني أو التجديد في التراث الإسلامي بهذا المضمون، وهو أنَّ لغة التراث والتغيير التدريجي وحده، هو الكفيل بحسم الوضع الراهن لمصلحة التجديد.
(17)إنَّ التقدُّم والنموَّ العلمي لحسن حنفي في أُوروبا، وفي جامعة السوربون الفرنسيَّة بالتحديد، قد ساهم بشكل طبيعي في تكميل شخصيَّته وإطاره المعرفي. فإنَّه مثل الكثير من المستنيرين الإسلاميِّين، لم يكن يستطيع أنْ يكون بمنجىٰ من التأثُّر بالمعارف والفلسفات الأُوروبيّة. إنَّ التربية الفكريَّة التي حصل عليها حسن حنفي في فرنسا، وتعرُّفه علىٰ المدارس الفلسفيَّة والتحوُّلات السياسيَّة والاجتماعيَّة للغرب، قد غرس لديه الاعتقاد القائم علىٰ ضرورة اتِّخاذ نموذج من هذه الاتِّجاهات لرسم خريطة تحوُّل في المجتمعات الإسلاميَّة. يقول حنفي: لقد أدركت في باريس أهمّيَّة علم أُصول الفقه بوصفه منهجًا فكريًّا وعلميًّا للمسلمين، وكتبت هناك رسالتي الأُولىٰ بعنوان مناهج التأويل في علم أُصول الفقه. وعلىٰ إثر تعرُّفه علىٰ نمط التفكير الأُوروبي، ولا سيّما مدرسة الظاهريّات لهوسرل، فقد كتب رسالته هناك تحت عنوان تفسير الظاهريّات وظاهريّات التفسير، وبالتالي فقد عمد من خلال هذا الاتِّجاه إلىٰ تفسير التراث والعلوم الإسلاميَّة.
يرىٰ الكاتب أنَّ نماذج التحوُّل في العالم الغربي كانت تُمثِّل بالنسبة إلىٰ حسن حنفي وسيلة وغاية، وعلىٰ الرغم من أنَّه يُنكِر غايتها، ولكنْ من خلال الدخول في أفكاره، يتَّضح كيف أنَّ أدبيّاته ومفاهيمه ومقاصده منبثقة عن الثقافة والحضارة الغربيَّتين، وأنَّه يُمثِّل ذلك التجدُّد الواضح علىٰ نحو دقيق. وأمَّا في الوقت ذاته، فقد صرَّح هو نفسه فيما يتعلَّق بكون المدارس
والاتِّجاهات الغربيَّة وسيلة. وفي كتاب التجديد والتراث قال صراحةً:
«ضرورة تعريف المثقَّفين والباحثين والمواطنين بأبحاث الغير، وجرأتهم الفكريَّة علىٰ السلطة، دينيَّة أو سياسيَّة، والتي جعلتنا نُقدِّم نصًّا آخر، هو رسالة اللّاهوت والسياسة لسبينوزا، والذي صدر سنة 1971م».
إنَّه بالإضافة إلىٰ التأثُّر بالظاهراتيَّة أو الفينومينولوجيا التي صدح بها إدموند هوسِرْل، قد تأثَّر بالتيّارات الغربيَّة الأُخرىٰ، من قبيل: الماركسيَّة والاشتراكيَّة أيضًا. إنَّ أدبيّاته وتحليلاته المادّيَّة بالنسبة إلىٰ الأُصول الإسلاميَّة الجوهريَّة، من قبيل: التوحيد والنبوَّة والمعاد، تنطوي علىٰ شبه تامٍّ بأفكارهم. تُمثِّل النزعة النسبيَّة والنفعيَّة ونفي القداسة والاتِّجاه العلماني والنزعة التجريبيَّة والإنسويَّة، مداخل تنتظم في ظلِّ الأرضيَّة الفكريَّة والثقافي لمباني رؤية حسن حنفي.
إنَّ اكتشاف المباني النظريَّة لمحقِّق ما، وكذلك الاهتمام بمنهجه الفكريّ، يلعب دورًا محوريًّا في فهم وبيان أفكاره. وفيما يلي سوف نعمل، بعد بيان مبانيه النظريَّة، علىٰ تحديد منهجيَّته في مشروع التراث والتجديد.
لقد عمد حسن حنفي، في إطار مشروع التراث والتجديد، إلىٰ نشر أعمال متعدِّدة، تراوحت ما بين كُتُب ومقالات، تحدَّث فيها بأدبيّات متنوِّعة. ومن هنا يأتي السعي من خلال الحصول علىٰ مبانيه النظريَّة، والتي تركت تأثيرها
بشكلٍ خاصٍّ علىٰ قراءاته للإسلام، إلىٰ توضيح أُسسه الفكريَّة، كي يقوم التعرُّف علىٰ الأفكار ونقدها ومناقشتها علىٰ أرضيَّة أنسب.
يمكن العثور في مجموع آثار وأعمال حسن حنفي، الأعمُّ من تلك المتعلِّقة بالاستغراب أو الإسلام، علىٰ تصريحات وعلىٰ رؤوس خيوط كثيرة من النسبيَّة. يرىٰ حسن حنفي أنَّ التراث الإسلامي يشتمل علىٰ مجموعة من القراءات المختلفة والاحتمالات المتنوِّعة التي لا تحتوي علىٰ أيِّ مقياس لتشخيص الخطأ والصواب من الناحية النظريَّة، ويجب البحث عن ملاكات عمليَّة من قبيل النفعيَّة، إلَّا أنَّ الملاك العملي من وجهة نظره لا يستطيع بدوره أنْ يُثبِت صحَّة أو سقم الاتِّجاهات المختلفة للتراث. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ اختيار قراءة من التراث القديم أو التراث الجديد، لا يعني تخطئة سائر قراءات التراث؛ لأنَّها تُمثِّل تفسيرات محتملة أُخرىٰ بما يتناسب مع ظروفها الاجتماعيَّة والتاريخيَّة. من ذلك علىٰ سبيل أنَّه يقول:
«فالتوحيد ثابت، ولكنْ تختلف أوجه فهمه طبقًا لحاجات العصر، وحرّيَّة الإنسان وعقله، ومسؤوليَّته ثابتة أيضًا، ولكنْ تختلف طُرُق ممارستها من عصر إلىٰ عصر».
ومن هنا فإنَّ حسن حنفي في مباحث الاستغراب يُنكِر نسبة الإلحاد إلىٰ بعض فلاسفة المدرسة الوجوديَّة، من أمثال جان بول سارتر، وموريس ميرلوبونتي، وألبير كامو، ويرىٰ أنَّ هؤلاء، بسبب دعوتهم إلىٰ التحرُّر
ودفاعهم عن شعوب العالم الثالث، لا يمكن أنْ يكونوا ملحدين.
يذهب حسن حنفي إلىٰ الادِّعاء بأنَّ تغيُّر الظروف والشرائط الاجتماعيَّة ومطابقتها، أصل ثابت، وقد سمحت به الأُصول الأساسيَّة في التراث الإسلاميَّة، بل إنَّ الوحي نفسه قد تعرَّض للتغيير بمقتضىٰ تغيُّر وتطوُّر الشرائط الاجتماعيَّة. (وبالتالي فحتَّىٰ الوحي ليس أمرًا ثابتًا ومطلقًا)، وإنَّ الشريعة قد تغيَّرت بسبب هذه المقتضيات المعاصرة، وقد قام الاجتهاد علىٰ أساس من هذه الفلسفة.
وحيث إنَّ التعدُّديَّة والنسبيَّة متلازمان، وإنَّ لازم القول بالنسبيَّة هو القول بالتعدُّديَّة، يذعن حسن حنفي بدوره إلىٰ القول بالتعدُّديَّة أيضًا، فهو يرىٰ أنَّ جميع الفِرَق الإسلاميَّة قد ظهرت علىٰ أساس مختلف الظروف الثقافيَّة، وأنَّ كلَّ واحدٍ منها يُمثِّل انعكاسًا عن تلك الظروف، ولذلك فإنَّه يدَّعي، خلافًا لتصوُّر أُولئك الذين یأخذون التراث الإسلامي دليلًا علىٰ عنصر الثبات في قُبال الواقعيَّة الاجتماعيَّة المتغيِّرة، أنَّ تعدُّد الفِرَق الإسلاميَّة والمذاهب الكلاميَّة يُؤكِّد علىٰ التغيُّر والثبات علىٰ السواء.كما أنَّه، حتَّىٰ بالنسبة إلىٰ مقولتي الإيمان والإلحاد، قد ذهب إلىٰ اعتبارهما مجرَّد مفاهيم نظريَّة لا تُعبِّر عن الواقعيَّة الخارجيَّة؛ إذ ما يُطلِق عليه البعض عنوان الإلحاد، ربَّما كان هو الإيمان عينه، وبعكس ذلك قد يكون ما يُسمّىٰ إيمانًا، هو الإلحاد عينه. وفيما
يتعلَّق بالحضارة الغربيَّة، يذهب حسن حنفي، بالالتفات إلىٰ تعدُّديَّة وكثرة المدارس الغربيَّة، إلىٰ القول:
«إذن لا يوجد لدينا فلسفة مطلقة ودائمة، بل هي نسبيَّة بأجمعها والحقيقة تخضع للتغيير، والحقيقة الثابتة الوحيدة هي روح العصر والشرائط الاجتماعيَّة وتاريخيَّة الإدراك والوعي الأوروبي».
وفيما يتعلَّق بتقييم مستقبل الحضارة الغربيَّة، وما إذا كانت هناك مؤشِّرات تدعو إلىٰ التفاؤل أم لا، يتَّخذ حنفي منهجًا نسبيًّا بالكامل، ويرىٰ أنَّ الحكم في هذا الشأن رهنٌ بالاتِّجاه السياسي والحضاري للمحقِّق.
يذهب حسن حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ تراثنا يحتوي علىٰ الكثير من العقائد والنظريّات المختلفة، التي تمَّ طرحها من قِبَل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، بيد أنَّه يجب علينا أنْ نختار من بينها ما هو الأوفق بحاجات عصرنا. والملاك في هذا الاختيار، يعود إلىٰ جدوائيَّة الأمر المنتخب واحتوائه علىٰ المنفعة والفائدة في ظلِّ الظروف والشرائط الاجتماعيَّة الخاصَّة. ففي السابق قد ارتضينا العقائد الأشعريَّة، فكانت إلهيّاتنا تنحصر بالربط بين الخالق والمخلوق، وبين الله والعالم، في حين أنَّ الظروف قد اختلفت حاليًّا، وأضحت المفاهيم الاعتزاليَّة هي الأقرب إلىٰ تلبية حاجات عصرنا. والمعيار الوحيد في القبول أو الرفض والنكول، هو المقياس العملي والفائدة الواقعيَّة، وإلَّا فليس هناك
من وجود للمعيار النظريّ للصواب والخطأ. وقال في معرض درء شبهة البراغماتيَّة عن نفسه:
«الصدق النظري والأثر العملي واحد في التراث؛ لأنَّه واحد في أُصول التراث، أعني الوحي، ومن ثَمَّ لا يصدق علىٰ (التراث والتجديد) أنَّه نزعة براجماتيَّة، كما لا يصدق عليه أنَّه نزعة مثاليَّة».
وهو يرىٰ أنَّ العقائد الإسلاميَّة لا تحتوي علىٰ معيار لإثبات صدقها الذاتي، وإنَّما المعيار الوحيد لصدقها هو مقدار التأثير الذي تتركه علىٰ الحياة الاجتماعيَّة والعمل علىٰ تغييرها. ولذلك فإنَّ الإيمان والإلحاد لا يعملان علىٰ بيان واقعيَّة من وجهة نظره، بل هما مجرَّد حافز داخلي لتبرير أعمال الأفراد وسلوكيّاتهم.
يعمد حسن حنفي إلىٰ فصل التراث القديم للمسلمين عن الدِّين، فهو يرىٰ أنَّ الدِّين، وإن كان جزءًا من التراث، إلَّا أنَّه لا یُحوِّل التراث إلىٰ تراث دیني. إنَّ نتيجة هذا الفصل، هي أنَّ التراث يعني مجموعة من التفسيرات التي كانت لدىٰ أسلافنا تجاه واقعهم وعالمهم الاجتماعي، ولذلك فإنَّهم كانوا يفهمون الجبر تارةً، والاختيار تارةً أُخرىٰ، وكانوا يعتنقون المذهب الأشعري حينًا، والمذهب الاعتزالي حينًا آخر، وسوف تستمرُّ هذه التفاسير المختلفة في المستقبل علىٰ أشكال مختلفة وجديدة. يذهب حسن حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ الإقبال علىٰ
رؤية والإعراض عن رؤية أُخرىٰ، لا ربط له بالدِّين والوحي كي يُؤدّي ذلك بنا إلىٰ الخروج عن دائرة التقديس، وحتَّىٰ العمل علىٰ إصلاح التراث لا يرتبط أبدًا بقدسيَّة الدِّين والعواطف الدِّينيَّة لدىٰ الناس تجاه التراث الدِّيني.من الواضح أنَّ جميع أنواع السعي والاجتهاد في أُصول الدِّين وفروعه، تعود إلىٰ حقل التراث الإسلامي، وبالتالي فإنَّ القراءات المختلفة لا تنطوي علىٰ أيِّة حرمة أو قداسة. وفي هذه الحالة سوف تخرج الأفكار الإسلاميَّة الجوهريَّة من الفقه والفلسفة والكلام والتفسير بأجمعها، من دائرة القداسة، ولا يكون للعمل علىٰ رفضها أو تغييرها صلة بالدِّين والقداسة. ويأتي تأكيد حسن حنفي وإصراره علىٰ ضرورة أنْ لا يتَّصف تراثنا بـ «الإسلاميَّة»، وأنَّه في حالة استعمال ذلك، لن يكون لـ «الإسلاميَّة» مفهوم ديني أبدًا، بل سيكون ذلك بمعناه الحضاري، كلُّه في سياق نفي القداسة عن التراث الإسلامي.
يعود السعي العلمي لحسن حنفي إلىٰ اتِّجاهه التاريخي والحضاري؛ لأنَّه يرىٰ روحًا لكلِّ مرحلة تاريخيَّة أو مرحلة حضاريَّة. وفي هذا الاتِّجاه تتبلور الأفكار في ظلِّ شرائط تاريخيَّة معيَّنة وفي بيئة حضاريَّة خاصَّة، ومن هنا تكون كلُّ فكرة، من وجهة نظر حنفي، رؤية حضاريَّة وتُمثِّل تعبيرًا عن روح عصرها. طبقًا لهذا المبنىٰ، يصل حنفي إلىٰ نتيجة مفادها أنَّ ذات وأصل الدِّين، إنَّما هو فرضيَّة إمكانيَّة لا وجود لها إلَّا من خلال التفسيرات التاريخيَّة للمفسِّرين. إنَّ الكتاب المقدَّس لا ينطق من تلقائه، ولا يتحوَّل إلىٰ فكر ديني، وإنَّما يتولّىٰ
شخص أو جماعة خاصَّة عمليَّة تفسيره، ومن خلال المجاز التاريخي يتبلور الفكر الدِّيني. طبقًا لهذا التحليل، تكون التفسيرات الدِّينيَّة مختلفة بالضرورة، بل وتكون متعارضة في بعض الأحيان، وتكون كلُّ واحدةٍ منها ردَّة فعل تجاه الأُخرىٰ؛ لأنَّ التاريخ والظروف الحضاريَّة ليست من الأُمور الثابتة. يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ القرآن الكريم كتاب تاريخي، إلَّا أنَّ الحديث أكثر تاريخيَّة من القرآن، والتفسير أشدُّ تاريخيَّة من القرآن والحديث، وكذلك السيرة أكثر تاريخيَّة من القرآن والحديث والتفسير، وبالتالي فإنَّ علم الفقه يُعَدُّ أكثر تاريخيَّة من بين جميع العلوم النقليَّة. ومن خلال القول بالمبنىٰ التاريخي للأحاديث، يذهب حنفي إلىٰ القول بأنَّ مفادها ومفهومها ناظر إلىٰ البيئة الجغرافيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والدِّينيَّة للعرب في عصر صدور الروايات، بل وعرب الجاهليَّة أحيانًا. كما يبذل حنفي في أبحاث الاستغراب جهودًا لإثبات أنَّ الغرب وأفكاره ومدارسه، إنَّما هي حصيلة ظروف تاريخيَّة وبيئيَّة خاصَّة، وفي الحقيقة فإنَّ كلَّ مدرسة هي ردَّة فعل علىٰ مدرسة أُخرىٰ سابقة عليها أو معاصرة لها.
إنَّ من بين مباني الاتِّجاه الذي يتبنّاه حسن حنفي في تجديد وإعادة صياغة الشريعة، تحويلها من محوريَّة الله إلىٰ محوريَّة الإنسان. فهو يرىٰ وجوب أنْ يقوم فهمنا للدِّين، بل وإعادة صياغته، علىٰ أساس الإنسان المعاصر، وليس
مفهوم الله والتوحيد. ولذلك فقد عمد في كتابه من العقيدة إلىٰ الثورة إلىٰ إعادة صياغة علم الكلام علىٰ أساس هذا المبنىٰ. إنَّ هذا هو المبنىٰ المهمُّ الذي تجلّىٰ تأثيره علىٰ تفسيرات حنفي للتراث الإسلامي. إنَّ الإنسان المنشود لحسن حنفي ليس هو الإنسان الذي يرِد تعريفه في الإسلام أو التراث الإسلامي، وإنَّما هو في إطار مبناه الظاهراتي ينتمي إلىٰ هذا العالم المادّي. إنَّه الإنسان الذي يخلق بمحوريَّته جميع الحقائق في عالم شعوره وإحساسه، وليس هناك من وجود لأيِّ كيان أو سلطة فوقه إلَّا وهي من صنع شعوره. كما يذهب حسن حنفي فيما يتعلَّق بالتراث الدِّيني للحضارة الغربيَّة في العصور الوسطىٰ إلىٰ القول بأنَّ لغتها ذات المحوريَّة الإلهيَّة، كانت هي السبب في لا عقلانيَّتها.
قد يبدو من العجيب أن يتمَّ تقديم تفسير علماني للدِّين، بمعنىٰ أنَّ المبدأ والمعاد وجميع الأُصول والمعارف التي تبلورت في ظلِّ محوريَّة الله تعالىٰ، تفقد هذه المحوريَّة فجأةً لتنخرط ضمن تفسير جديد في إطار محوريَّة الإنسان والحياة في هذا العالم. إنَّ الإسلام لا ينظر إلىٰ الدنيا ومقتضيات الحياة الدنيويَّة بشكلٍ مستقلٍّ ومنفصلٍ عن الحياة الأبديَّة في الآخرة وعن المبدأ المتعالي، وإنَّما يعمل علىٰ تعريف ذلك كلِّه في إطاره، وبوصفه مقدّمة للوصول إلىٰ تلك الغاية، وأمَّا في التفسير العلماني للدِّين تتغيَّر هذه الرؤية. يذهب حنفي في مشروعه التجديد والتراث إلىٰ الاعتقاد بأنَّه وفقًا لمقتضىٰ حاجات عصرنا
حيث ابتلينا بالتخلُّف، واحتلال أراضينا الإسلاميَّة، والركود الفكري، يجب أنْ يكون هدفنا الرئيس هو استقلال وتحرير هذه الأراضي، وبالتالي إذا كان هناك حاجة إلىٰ الإلهيّات والفلسفة والفقه والتصوُّف، يجب أنْ تتبلور لدينا إلهيّات الأرض، وفلسفة الأرض، وفقه الأرض، وتصوُّف الأرض، وشعر الأرض. ويجب أنْ يكون العرفان عرفانًا ثوريًّا، وأنْ يكون الفقه فقه تطوُّر، وأنْ يكون تفسير الدِّين تفسيرًا لدين التنمية والرقيِّ والازدهار. فإنْ تحقَّق لدينا مثل هذا التغيير، سوف نحصل علىٰ الأيديولوجيَّة اللازمة لإحداث التغيير الاجتماعي، وإلَّا سنبقىٰ سادرين فيما نحن فيه من التخلُّف.
والأعجب من ذلك، أنَّ حنفي يرىٰ أنَّ العلمانيَّة الغربيَّة تُمثِّل جوهر الدِّين وأساسه، ويدَّعي أنَّ الوحي في جوهره علماني، وأنَّ الدِّين أمر عارض وطارئ عليه من صنع التاريخ. فهو يرىٰ أنَّ العلمانيَّة في الغرب، إنَّما وُجِدَت لاستعادة حرّيَّة الإنسان (حرّيَّته علىٰ مستوىٰ التفكير والتعبير والسلوك)، ونفي جميع أنواع السلطة غير سلطة العقل، وعلىٰ هذا الأساس فإنَّ العلمانيَّة تُمثِّل أساس الوحي وجوهر الدِّين.
يذهب حسن حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ فكرة الإخوان المسلمين في مصر المعاصرة تحتاج إلىٰ تطوير، ويرىٰ هذا التطوير في تقديم الأيديولوجيَّة العلمانيَّة. وعلىٰ هذا الأساس يعتبر الإسلام دينًا علمانيًّا؛ إذ يقوم أساسه علىٰ رعايَّة مصالح الناس: «ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن»، وإنَّ
حاكميَّة الله تعني حاكميَّة الناس، ولا وجود للثيوقراطيَّة أو الحكومة الدِّينيَّة في الإسلام. إنَّ النظام الإسلامي من وجهة نظر حسن حنفي يقوم علىٰ نظام البيعة والشورىٰ والدستور الإسلامي الذي يراعي مصالح الناس، وفي هذه الحالة تكون الأيديولوجيَّة الإسلاميَّة أيديولوجيَّة إنسانيَّة واجتماعيَّة، وليست أيديولوجيَّة دينيَّة ولاهوتيَّة.
إنَّ من بين المباني النظريَّة الأُخرىٰ لحسن حنفي، والتي تركت تأثيرًا مهمًّا علىٰ إعادة قراءته للتراث، هو الاتِّجاه الظاهراتي والفينومينولوجي لهوسِرْل. إنَّ التعريف الذي يُقدِّمه حنفي عن التراث الإسلامي، وكذلك تحليلاته وتفسيراته، ليس لها أيَّ سابقة في الحضارة الإسلاميَّة أبدًا، وإنَّما تعود بجذورها إلىٰ الاتِّجاه الظاهراتي الذي ينتمي إليه. إذ عمد في مباحث الاستغراب إلىٰ تظهير الاتِّجاهات الظاهراتيَّة إلىٰ حدٍّ كبير بوصفها نهاية تبلور الوعي الأُوروبي. وقد أقرَّ حنفي بأنَّ هذا الأُسلوب قد تمَّ توظيفه في مشروعه التراث والتجديد، وقال في قُبال أُولئك الذين يرون أنَّ جذور جميع الأساليب غربيَّة، وما الآخرون إلَّا تبع لهذه الأساليب:
«إنَّ هذه الأحكام مجانبة للصواب؛ إذ الأساليب موجودة في جميع الحضارات، ومن بينها أُسلوب تحليل التجربة الداخليَّة، وهو أُسلوب إنساني وطبيعي وتلقائي، وهو موجود في جميع الحضارات البشريَّة. ويرىٰ أنَّ من بين هذه التجارب: النصوص
الشعريَّة والدِّينيَّة التي تصف مجرَّد التجارب الحيَّة للشعراء والأنبياء (مثل تجربة الحزن والفرح والانتصار والفشل)، وقد انعكس هذا النوع من التجارب في الكثير من الآيات القرآنيَّة، وإنَّ هذا الفراغ والامتلاء في الشعور والوعي يُمثِّل نوعًا من التحليل الظاهراتي».
وهذا هو مفهوم وتجسيد المسألة التي استحوذت علىٰ اهتمام هوسِرْل. إنَّ العين أو العينيَّة في ظاهريَّة هوسِرْل لا تُطلَق علىٰ مجرَّد الكائن المحسوس والمادّي فقط، بل تشمل جميع الأنواع الوجوديَّة الأعمّ، من الخيالي والانتزاعي والانضمامي والذهني والخارجي والجزئي والكلّي، وما هو كامن بالقوَّة وما هو كامن بالفعل. ومن هذه الناحيَّة تكون العين عبارة عن كلِّ شيء يُسجِّل حضورًا في قُبال الوعي، وهذا الحضور يساوق الوجود. إنَّ المعنىٰ يحضر في الذهن، وعليه يكون للمعنىٰ نوع من التعيُّن ويكون موجودًا. إنَّ مفهوم التعليق بمعنىٰ الوضع بين قوسين أو غضِّ الطرف عن بعض الأحكام والمعلومات وتوقيفها وتوقُّفها ممَّا يُمثِّل في رؤية هوسِرْل موضوعًا محوريًّا، موجودة بشكل واضح في الاتِّجاه الذي يتبنّاه حنفي بشأن التراث الإسلامي. لقد تمَّ العثور علىٰ أنواع من التعلُّق في آراء هوسِرْل، وإنَّ ثلاثة منها عبارة عن: التأويل الفلسفي، والتأويل الظاهراتي، والردِّ والإحالة إلىٰ الذات، أو التأويل بالصورة والمعنىٰ.
إنَّ مراد هوسِرْل من التعليق أو التأويل الفلسفي، نبذ جميع الفلسفات والرجوع إلىٰ الأشياء نفسها منْ دون إصدار أحكام مسبقة، ولذلك فإنَّه يقول:
«يجب علينا تعليق أحكامنا بشأن تعليم أيّ فلسفة سابقة، وأنْ نتابع أبحاثنا في حدود ما يقتضيه هذا التعليق للحكم. إنَّ البحث الجوهري يُمثِّل فلسفة تسير في اتِّجاه مخالف لجميع أنواع الوثنيَّة، ودون رعاية لجميع أنواع التراث، وعلىٰ خلاف جميع أنواع الأحكام المسبقة، وطبقًا لذلك لا يكون هناك اعتبار واحترام لغير حكم العقل في تشخيص وتمييز الحقيقة...، إنَّ الحذف القطعي والأُصولي لجميع أنواع الفرضيّات المسبقة، والرجوع إلىٰ الأشياء يُمثِّل واحدًا من المواضع العامَّة والمشتركة في الاتِّجاه الظاهراتي والفينومينولوجي».
إنَّ مراده من التأويل الفينومينولوجي هو تعليق بداهة كينونة العالم، حيث نعمل طبقًا لذلك علىٰ اجتناب إصدار الأحكام حول وجود أو عدم وجود العالم سلبًا وإيجابًا. بهذا التعليق لا يبقىٰ من جهة سوىٰ الأنا المحضة أو الموضوعيَّة النفسانيَّة الاستعلائيَّة أو الوجدان البحت مع بداهة متيقَّنة، ومن ناحية أُخرىٰ يتمُّ تعليق جميع العلوم المرتبطة بالعالم الأعمّ من العلوم الطبيعيَّة والعلوم الإنسانيَّة، بل وحتَّىٰ ما بعد الطبيعة التي تُمثِّل تفسيرًا للعالم. يرىٰ هوسِرْل أنَّ الذي يظهر علىٰ الذهن إنَّما يبقىٰ لأنَّه مجرَّد ظهور بحت وله حضور في الوجدان. وفي هذه الحالة يتمُّ التعرُّف علىٰ الظاهر من دون وساطة وبدون أدنىٰ شكٍّ. وعلىٰ هذا الأساس، إنَّما يكون الوجدان المحض وحده أو حالات الوجدان وظاهراتها مسرحًا للفينومينولوجيا، وحيث تسري حالات الوجدان في الزمان، يكون متعلَّق الظاهراتيَّة هو السيلان البحت لحالات الوجدان. وعندها يكون وصف ورسم السيلان البحت لحالات الوجدان
هو المطلوب من الزاوية الفينومينولوجيَّة، وليس تفسيرها وبيانها.
إنَّ الحيثيَّة الالتفاتيَّة للوجدان، أصل آخر من الأُصول الفينومينولوجيَّة لهوسِرْل، والتي علىٰ أساسها تكون ماهيَّة الوجدان هي التوجُّه وقيام النسبة مع متعلَّق الإدراك، وبعبارة أُخرىٰ: كلُّ حالة من حالات الشعور والوجدان بمعنىٰ امتلاك الوجدان بالنسبة إلىٰ شيء ما بغضِّ النظر عن كيفيَّة وجوده الواقعي. طبقًا لهذا الأصل، فإنَّ كلَّ نوع من أنواع التفكير أو كلِّ حالة من الحالات الوجدانيَّة، تستهدف شيئًا، وحيث إنَّها تلتفت إلىٰ ذلك الشيء، فإنَّها تشتمل عليه. ومن هنا لا يتمُّ التعرُّف علىٰ الوجدان بشكل تلقائي ولنفسه، بل بالنسبة إلىٰ متعلَّقاته. وفي هذا التعاطي القائم بين الوجدان والظاهرة يقوم نوع من التضايف، بمعنىٰ أنَّ الظاهرة لا تكون لسوىٰ الوجدان، والوجدان ليس له معنىٰ غير النسبة إلىٰ متعلَّق ما، ولا يمكن تعقُّل أحدهما دون تعقُّل الآخر.
يرىٰ هوسرل أنَّه:
«ليس هناك وجود للحقيقة المطلقة التي تُشكِّل فرضيَّة مشتركة بين الحتميَّة والتشكيك، وإنَّ الحقيقة إنَّما تُعرِّف عن نفسها في إطار الصيرورة بمثابة إعادة النظر والتصحيح والمضيِّ قدمًا، وإنَّ هذه العمليَّة الديالكتيكيَّة تقع علىٰ الدوام في صلب الراهن الحيوي...، إذن للإجابة الصحيحة عن السؤال عن الحقيقة، أي بغية التوصيف الصحيح لتجربة الحقيقة يجب الاستناد إلىٰ الصيرورة التكوينيَّة
(31)لإيجو بشدَّة: إنَّ الحقيقة ليست عينًا، بل هي حركة، ولا يمكن أن يتحقَّق لها من وجود إلَّا إذا صدرت هذه الحركة من قِبَلي».
إنَّ فلسفة عالم الحياة في مدرسة هوسرل تُمثِّل إجابة عن السؤال عن الحقيقة، إلَّا أنَّ الحقيقة ليست بمثابة تطابق التفكير ومتعلَّقه الخارجي، فإنَّ الفينومينولوجيا لا تعترف بمثل هذه العينيَّة، وكذلك لا يتمُّ تعريف الحقيقة بوصفها مجموعة من الشرائط المسبقة، بل إنَّ حقيقة شيء ليست سوىٰ أنْ نعيش تجربة الحقيقة التي يعتبرها هوسِرْل بداهة بالمعنىٰ الذي يلاحظه.
لقد عمد حسن حنفي في كتابه في الفكر الغربي المعاصر في البحث عن «فينومينولوجيا الدِّين عند هوسِرْل» إلىٰ نقل بعض الأبحاث عن هوسِرْل، ثمّ واصل ذات هذا الاتِّجاه في كتابه من العقيدة إلىٰ الثورة في تفسير جديد لعلم الكلام. من ذلك علىٰ سبيل المثال أنَّ هوسِرْل يعمل علىٰ تعليق موضوع الله بوصفه وجودًا عينيًّا ومتعاليًا في دائرة اهتمام الإنسان، ويراه خارجًا عن دائرة شعوره، معتبرًا إيّاه نوعًا من التوهُّم والخطأ والاختلاق. إنَّه يرىٰ أنَّ الله موضوع يحلُّ في الشعور، وإنَّ هذا الحلول هو حلول مطلق في الشعور، وفي هذه الحالة يكون بمثابة التجربة أو التيّار الحيويّ الموجود في شعور وإدراك الإنسان، وأنَّ الإنسان يعيش معه، لا أنَّه حقيقة عينيَّة من الممكن إثباتها. وفي الحقيقة، فإنَّ الإنسان خالق الله وواضعه في الشعور، وليس العكس.
إنَّ حسن حنفي يستخدم هذا الاتِّجاه ذاته لهوسِرْل في تفسير التوحيد والله في كتابه من العقيدة إلىٰ الثورة، إذ إنَّه يستعير مفاهيم، من قبيل: الشعور والوعي، من رؤية هوسِرْل والمدرسة الظاهراتيَّة. إذ إنَّ الشعور في لغة حسن حنفي وفي المفهوم الهوسِرْلي، ليس بمفهوم محلِّ تجلّي الحقائق الخارجيَّة والعينيَّة، بل هو بيان للارتباط وميل إلىٰ الحركة نحو شيء ما.
إنَّ المباني والأُطُر النظريَّة لحسن حنفي في علم الاستغراب، ولا سيّما إعادة التعريف بالتراث الإسلامي، مضطربة للغاية، ومن خلال هذه الأُسس والمباني لا نحصل علىٰ نتيجة سوىٰ الاستغراب المعكوس ومعرفة الإسلام بالمقلوب؛ وذلك للأسباب الآتية:
1. إنَّ النسبيَّة والنفعيَّة من بين المباني النظريَّة المهمَّة التي يعمد حسن حنفي إلىٰ توظيفها بشكل كبير، وطبقًا لها يعتبر التراث الإسلامي مجموعة من القراءات المختلفة والاحتمالات المتنوِّعة بما يتناسب والشرائط الاجتماعيَّة المتغيِّرة، بل ويعتبر حتَّىٰ الوحي عبارة عن تعاليم ومفاهيم متغيِّرة، ومجرَّد توابع للمتغيِّرات في الظروف الاجتماعيَّة. ونتيجة النسبيَّة هي عدم وجود ملاك نظري للصدق والكذب، وهذه هي النتيجة التي يلتزم بها حسن حنفي.
ومن هنا فإنَّه يبحث عن ملاكات عمليَّة ونفعيَّة، كما أنَّه يلتزم بالنتيجة الثانيَّة للنسبيَّة المتمثِّلة بالتعدُّديَّة، ويرىٰ أنَّ هذه التعدُّديَّة تُمثِّل انعكاسًا للشرائط الاجتماعيَّة والتاريخيَّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ النسبيَّة بدورها تقوم علىٰ الاتِّجاه التاريخي والحضاري لحسن حنفي في التراث الإسلامي، الذي أبعده عن حقيقة التراث الإسلامي إلىٰ حدٍّ كبيرٍ جدًّا. وفي هذا الاتِّجاه تتبلور الأفكار في ظلِّ ظروف تاريخيَّة معيَّنة وفي بيئة حضاريَّة خاصَّة، ولذلك فإنَّ كلَّ تفكير هو، من وجه نظر حسن حنفي، تفكير حضاري وتعبير عن روح عصره. وطبقًا لهذا المبنىٰ، يصل حنفي إلىٰ نتيجة مفادها أنَّ أصل وذات الدِّين، إنَّما هو فرضيَّة إمكانيَّة لا يُكتَب لها الوجود إلَّا من خلال التفسيرات التاريخيَّة للمفسِّرين. إنَّ الكتاب المقدَّس لا ينطق من نفسه، ولا يتحوَّل إلىٰ تفكير ديني، وإنَّما الأشخاص أو الجامعات الخاصَّة هي التي تعمل علىٰ تفسيره، ومن خلال التاريخ يُكتَب الوجود للفكر الدِّيني. وطبقًا لهذا التحليل، تغدو التفسيرات الدِّينيَّة مختلفة بالضرورة، ويكون بعضها متعارضًا، ويكون كلُّ واحدٍ منها ردَّة فعل تجاه الآخر؛ لأنَّ التاريخ والشرائط الحضاريَّة ليست ثابتة.
لا شكَّ في وجود مختلف القراءات والمدارس الفقهيَّة والكلاميَّة في التراث الإسلامي، والتي لا يُنكَر تأثير العوامل السياسيَّة والاجتماعيَّة في ظهور الكثير منها، بيد أنَّ مسألة نسبيَّة المعرفة شيء آخر لا رابط له بالبُعد الاجتماعي للمسألة آنفة الذكر؛ إذ ليست جميع العلوم ومفاهيم التراث الإسلامي تابعة للشرائط والظروف الاجتماعيَّة والتاريخيَّة. إنَّ التراث
الإسلامي لا يعني مجموعة من الاحتمالات الناظرة إلىٰ النفعيَّة، فلا تعبير الاحتمالات صحيح ولا منطق النفعيَّة. وكما تقدَّم في الإطار النظري للرسالة، فإنَّ الخصِّيصة الذاتيَّة للمفاهيم الذهنيَّة هي الكاشفيَّة، بحيث يُعَدُّ افتراض العلم دون الكاشفيَّة أو انعكاس الخارج فرضًا محالًا، وكذلك افتراض كاشفيَّة العلم دون المكشوف الخارجي فرض محال أيضًا. إنَّ الحقيقة أو الصدق في العلوم الحقيقيَّة، والذي يعني تطابق التصوُّرات والتصديقات الذهنيَّة اليقينيَّة مع الواقع الخارجي، ليس مؤقَّتًا أو قابلًا للتغيير أبدًا. إنَّ المفاهيم الذهنيَّة تتطابق مع واقعها علىٰ الدوام حتَّىٰ إذا كانت الواقعيَّة الخارجيَّة مؤقَّتة. وعلىٰ هذا الأساس، لا طريق للتغيير والتحوُّل في العلوم والمعارف الحقيقيَّة (دون الاعتباريَّة)، بحجَّة تغيُّر الشرائط الخارجيَّة أو الاجتماعيَّة، بل إنَّ جميع العلوم الحقيقيَّة الأعمّ من الطبيعيَّة والرياضيَّة والإنسانيَّة والإلهيَّة تحظىٰ بالإطلاق والثبات، وإنَّ دعوىٰ النسبيَّة في هذه العلوم لن يفضي إلىٰ غير التشكيك. وأمَّا في العلوم الاعتباريَّة والعلوم التجريبيَّة التي ليس لها من مستند سوىٰ التجربة، أو التي تظهر صحَّتها في الفوائد العمليَّة، فإنَّ هذه المجموعة من العلوم ليست يقينيَّة، ولا تحظىٰ بالثبات والإطلاق.
وكذلك فإنَّ القرآن الكريم، خلافًا لِما ذهب إليه حسن حنفي، ليس له لسان صامت، بل إنَّ بعض القرآن يُفسِّر ويُبيِّن ويُصدِّق بعضه الآخر، ولذلك كان هذا الكتاب المقدَّس من أهمِّ مصادر التفكير الدِّيني. إنَّ الأشخاص والجماعات ليسوا منتجين أو صانعين للتفكير الدِّيني، وإنَّما هم يكتشفونه ويُفسِّرونه اعتمادًا علىٰ الأساليب والمناهج التفسيريَّة الخاصَّة.
(35)وكذلك التفكير الدِّيني ليس تفكيرًا تاريخيًّا يتجلّىٰ معناه في حقلٍ خاصٍّ، وإنْ كانت الخلفيّات الاجتماعيَّة والتاريخيَّة تُشكِّل أرضيَّة للمسائل، بيد أنَّ المسائل تُطرَح في ضوء الأفكار والأُصول الدِّينيَّة الثابتة. وعلىٰ هذا الأساس، لا يمكن تفسير الكتاب المقدَّس علىٰ أساس الرؤية التاريخيَّة. ومع إلغاء الاتِّجاه التاريخي إلىٰ التراث الإسلامي، سوف تنتفي النسبيَّة بدورها من الأساس؛ لأنَّ التراث الإسلامي زاخر بالأُصول والعقائد البديهيَّة والنظريَّة الصحيحة الصادقة والقابلة للإثبات. وبطبيعة الحال، من الممكن أنْ توجد بعض الاختلافات النظريَّة، التي من الممكن أنْ تظهر حول كلِّ أصل بديهي أو نظري في التراث الإسلامي أيضًا، إلَّا أنَّ هذا لا يعني احتماليَّتها أو الافتقار إلىٰ معيار للصدق. وفي الأساس، فإنَّ حسن حنفي، طبقًا لمبناه، لا يبحث عن مثل هذا المعيار، والعجيب أنَّه لا يمكن أنْ يكون لديه كلام بشأن «الاحتمالات» أيضًا. إنَّ جميع الانتقادات الواردة علىٰ النسبيَّة والنفعيَّة تُقوِّض دعائم نظريَّته من الأساس. إنَّ النسبيَّة لا تمتلك طريقًا لإثبات ذاتها؛ لأنَّ إثباتها يُؤدّي إلىٰ نفيها وإثبات النزعة الواقعيَّة والعينيَّة. ليس هناك من فقيه أو مجتهد يدَّعي أنَّ الاجتهاد يعني الرؤية العصريَّة بمعزل عن الأُصول الثابتة. إنَّ اجتهادات الفقيه، طبقًا لرؤية حسن حنفي، ليس لها أيّ ملاك ومبنىٰ للصدق والكذب، وإنَّما تأتي في إطار النفعيَّة في الظروف والشرائط الاجتماعيَّة والتاريخيَّة، ولذلك تكون معطيات الاجتهاد علىٰ الدوام محدودة بالأزمنة والأمكنة الخاصَّة، ولنْ تكون قابلة للصدق والكذب أبدًا، وإنَّما تلاحظ في ضوء ملاك احتمال الفائدة. إنَّ هذا الاتِّجاه، بالإضافة إلىٰ كونه غير
(36)مسبوق في تاريخ الفقه والاجتهاد، بل وحتَّىٰ في تاريخ المسلمين ومباينًا له، فإنَّه كذلك يعارض المنطق المعرفي الإبستيمولوجي والأُصول البديهيَّة للفقه والفلسفة أيضًا. ثمّ إنَّه ما هو الدليل علىٰ اعتبار النفعيَّة؟ ليس هناك أيّ مناص من الواقعيَّة المفروضة لاعتبار الصدق والكذب، ويبدو أنَّ الاتِّجاه النفعي قد استبدل الواقعيَّة العينيَّة والخارجيَّة بأمر آخر باسم الربح والمنفعة، لا أنَّه قد تهرَّب من الواقعيَّة، في حين أنَّ هذا الاستبدال يُمثِّل خلطًا كبيرًا، ولا ينطوي علىٰ فائدة في الواقع أيضًا.
إنَّ الإشكال الأهمّ في تفكير حسن حنفي يكمن في تعميمه النسبيَّة والنفعيَّة علىٰ نصِّ الوحي، بغضِّ النظر عن الدوافع النفسيَّة والسياسيَّة/ الاجتماعيَّة التي تبتلى بها هذه الاتِّجاهات عادةً، وقد اعتبر الآيات الوحيانيَّة والقرآن الكريم أمرًا سيّالًا يتغيَّر بمقتضىٰ تغيُّر الشرائط الاجتماعيَّة، ولذلك يجب أنْ يكون، طبقًا لمبناه، قائلًا بصدق وكذب الوحي، وتفسير الجميع بمناط النفعيَّة، وفي هذه الحالة ستكون الآيات محدودة بعصرها، وسوف تفقد القدرة علىٰ إظهار الواقع!.
وبطبيعة الحال، هناك في إطار الخصائص الزمانيَّة والاجتماعيَّة لنزول الآيات مسألة باسم شأن النزول، وهو صحيح. إنَّ شأن النزول أو الأرضيّات الاجتماعيَّة والتاريخيَّة والمعرفيَّة، بل وحتَّىٰ المصاديق المورديَّة أحيانًا، لها تأثير معدٍّ في نزول الخطاب الإلهي، بمعنىٰ أنَّ هذه الأرضيّات كانت تقتضي نزول الوحي الإلهي. إلَّا أنَّ هذا لا يعني تغيُّر الوحي الإلهي أو تأثُّره، بل إنَّ آيات الوحي ناظرة إلىٰ الحقائق الإلهيَّة وبيان طريق السعادة والشقاء للإنسان،
(37)ولذلك لا نرىٰ أيّ اختلاف أو تغيير في أهداف وتعاليم ورسالة القرآن منذ نزول الآية الأُولىٰ منه وحتَّىٰ الآية الأخيرة، وعلىٰ حدِّ تعبير المفسِّرين: إنَّ شأن النزول لا يُشكِّل مانعًا من تعميم دلالة القرآن، فهو يجري في جميع الأزمنة.
2. إنَّ من بين الخصائص المهمَّة للإسلام هي القداسة، وقد سعىٰ حسن حنفي، من خلال نفيها وإلغائها، إلىٰ استعادة التعرُّف علىٰ التراث. إنَّ القداسة تعني أنَّ التعاليم السماويَّة، حيث لها مبدأ فاعلي (الله سبحانه وتعالىٰ)، ومبدأ قابلي (النبيُّ الأكرم صلىاللهعليهوآله) ـ لا يتطرَّق إليها النقص والقبح والبطلان أبدًا، وبالتالي فإنَّ المعرفة الدِّينيَّة، والسلوك الدِّيني، والأخلاق الدِّينيَّة، والشعائر الدِّينيَّة، تتمتَّع بالقداسة والتعالي. «إنَّ القداسة بما هي محور الإيمان ومدار الإسلام، بحيث يُشكِّل الاعتراف بها أساسًا ودعامة للإيمان، وإنكارها والنكول عنها سببًا في الكفر، والإيمان بها يُمثِّل سببًا إلىٰ السعادة، والكفر بها وسيلة إلىٰ الشقاء، وإنَّ السعادة المذكورة تُمثَّل أرضيَّة لدخول الجنَّة الأبديَّة، والشقاء المذكور يُمثِّل سببًا للسقوط في الجحيم»، من خصائص المعرفة الدِّينيَّة. كما تعني القداسة عدم إمكانيَّة نقد الدِّين والمعرفة الدِّينيَّة بسبب كونها حقًّا محضًا منزَّهًا عن جميع شوائب الباطل. ولذلك لو تمكَّن الفقيه أو عالم الدِّين من استنباط شيء من الدِّين، بحيث كان ذلك الشيء متطابقًا مع الدِّين، فإنَّه سينطوي قهرًا علىٰ صفة القداسة بمعنىٰ عدم إمكانيَّة نقده بسبب تمتُّعه بالحقّانيَّة والكمال والخلوص.
وقد عمد حسن حنفي في إطار نفي القداسة عن التراث الإسلامي في
المرحلة الأُولىٰ إلىٰ فصل الدِّين عن التراث، ببيان أنَّ التراث لا يقبل التوصيف بالدِّيني أو الإسلامي. وفي المرحلة الثانية، اعتبر التراث أمرًا حضاريًّا هو حصيلة تفسير المتقدِّمين لواقعهم وعالمهم الاجتماعي، وبالتالي فإنَّه لا يرىٰ في نقد وإصلاح التراث نقدًا للمقدَّسات. ولكنَّه أخطأ في كلتا المرحلتين؛ إذ لو اعتبرنا القرآن والسُّنَّة خارج التراث الإسلامي، واعتبرنا التراث عبارة عن تفسيرهما، عندها سيكون التراث المطابق لدين الله عبارة عن تجلّي الدِّين في فكر ووعي الناس، وكذلك في سلوكهم وشعورهم، وإنَّ هذا التجلّي والظهور هو الدِّين عينه ومتقدِّسًا بقداسة الدِّين. ومن ناحية أُخرىٰ، ما هو المبرِّر الذي يحتمُّ علينا الاقتناع بكلام حنفي القائل بأنَّ تراثنا هو تفسير المتقدِّمين لعالمهم الاجتماعي، وعلىٰ هذا الأساس كانوا يفهمون الجبريَّة والمدرسة الأشعريَّة من الدِّين حينًا، والاختيار ومذهب الاعتزال حينًا آخر؟ فلا التاريخ الفكري للمسلمين وتراثهم يسمح بمثل هذا التفسير حيث لا شاهد علىٰ تأييد ذلك، ولا مباني ومناهج حنفي تُؤدّي إلىٰ هذه الغاية. يبدو أنَّه يعيش هاجسًا من اتِّجاهه بين المسلمين خوف اتِّهامه بمحاربة الدِّين ونفي القداسة عن الدِّين، ولذلك لجأ إلىٰ القول بأنَّ إعادة إصلاح التراث لا ربط له بقداسة الدِّين والعواطف الدِّينيَّة.
3. إنَّ من بين المباني الفكريَّة لحسن حنفي في تجديد وإصلاح التراث الإسلامي، تغيير التراث من محوريَّة الله إلىٰ محوريَّة الإنسان، وهو من المباني المهمَّة التي تركت تأثيرها علىٰ تفسيرات حسن حنفي للتراث الإسلامي. إنَّ الإنسان المنشود له ناظر إلىٰ مبناه الظاهراتي، وهو ينتمي إلىٰ هذا العالم المادّي،
وهو الإنسان الذي يعمل بمحوريَّته علىٰ خلق جميع الحقائق في عالم شعوره وإحساسه، ولا وجود لأيِّ كينونة وقدرة فوقه إلَّا وهي من صنع شعوره. هذا في حين أنَّ جميع الخلق، طبقًا للتعاليم الدِّينيَّة والفلسفة الإسلاميَّة، عين الربط والتعلُّق بالعلَّة الموجِدة، وليس له أيّ استقلال وأصالة من ذاته. ليس للخلق هويَّة غير التعلُّق والحاجة المتواصلة إلىٰ الخالق المستغني، وإنَّ تصوُّر استقلال الإنسان والطبيعة من المبادئ العالية للوجود في التفكير العلماني والإنسوي، لن يكون إلَّا تصوُّرًا للمحال والعدم. إنَّ اختيار وحرّيَّة واستقلال الإنسان في الحقل التكويني والتشريعي، إنَّما تكتسب معانيها في إطار هذا الأصل، وإنَّ أيَّ تعارض معها يعود إلىٰ نفي هويَّة الإنسان ومعارضته لذاته. إنَّ استبدال الله بالإنسان ومحوريَّة الإنسان في إصلاح الدِّين، يصنع ماهيَّة جديدة للدِّين لا تكتفي بعدم إبقاء شيء من الدِّين فحسب، بل تُؤدّي إلىٰ استبداد وتفاهة الإنسان، وهذا هو المسار الذي سلكه الغرب. ومن جهة أُخرىٰ، فإنَّ التفسير العلماني الذي يُقدِّمه حسن حنفي للدِّين، والذي يُؤدّي، علىٰ حدِّ تعبيره، إلىٰ لاهوت الأرض، وفقه الأرض، وتصوُّف وعرفان الثورة والتطوُّر، ليس تفسيرًا للدِّين، وإنَّما تأسيسه كسائر الأيديولوجيّات من قبيل: القوميَّة، والاشتراكيَّة، والليبراليَّة، لا تحلُّ مشكلة من مشكلات المسلمين المعاصرة، بل تبتلي بذات ما ابتلت به الليبراليَّة والشيوعيَّة أيضًا. يُضاف إلىٰ ذلك، أنَّ التجربة التاريخيَّة قد أثبتت أنَّ المسلمين حيثما حقَّقوا نجاحًا وإنجازًا، سواء علىٰ مستوىٰ مقارعة الاستعمار الخارجي وإسرائيل، أو مواجهة الاستبداد الداخلي، وبناء الاتِّحاد والانسجام الداخلي، وما إلىٰ ذلك من الإنجازات
(40)والنجاحات الأُخرىٰ، إنَّما كان ذلك ناشئًا من الأدبيّات الدِّينيَّة والتراث الإسلامي، ولم يكن لبدعة التنوير أدنىٰ تأثير فيها. إنَّ الدِّين الإسلامي يمارس مهمَّته ورسالته السياسيَّة والاجتماعيَّة، بالالتفات إلىٰ التوحيد والنبوَّة والمعاد، في تطوير المجتمعات الإسلاميَّة. وتضطلع الفلسفة السياسيَّة والفقه الإسلامي ببيان دور التفكير الدِّيني في تطوير ورقيِّ المجتمعات الإسلاميَّة.
يقوم منهج التحقيق عند حسن حنفي في دراساته الإسلاميَّة، وحتَّىٰ الاستغرابيَّة، علىٰ مبانيه النظريَّة، ولاسيّما اتِّجاهه الظاهراتي. وقد صرَّح في بعض الموارد علىٰ ما تشهد به تحليلاته في توظيف الاتِّجاه الظاهراتي في بحث مسألة التراث الإسلاميَّة والاستغراب والتجديد والنزعة الاستغرابيَّة، بأنَّه يعمل علىٰ دراسة الظاهرات في المعيَّة الزمانيَّة بوصفها ردَّة فعل تجاه الظروف والشرائط التاريخيَّة والحضاريَّة. إنَّ الاتِّجاه الظاهراتي، مثل الاتِّجاه التاريخي، يُمثِّل مبنىٰ بالنسبة له، كما يُمثِّل أُسلوبًا أيضًا، وعندما تكون كلُّ منظومته الفكريَّة وتحليلاته متأثِّرة بهذين الاتِّجاهين، فإنَّهما يتحوَّلان إلىٰ مبنيين لأفكاره، ولكنْ حيث يستفيد منهما بوصفهما أُسلوبين في تحليلاته الجزئيَّة والموضوعيَّة، فإنَّهما يُعدَّان نوعًا من الأُسلوب. وهو في هذا المجال مدين إلىٰ حدٍّ كبير إلىٰ المدارس والمفاهيم النظريَّة والمعرفيَّة للأفكار الغربيَّة الحديثة، وعلىٰ الرغم من تصريحه بأنَّ دافعه الرئيس في بحوث التجديد والتراث يكمن في إعادة قراءة التراث من زاويته الخاصَّة، ورؤيته إلىٰ أنَّ قراءة التراث من زاويَّة الغرب،
تُعَدُّ من الانحرافات الكبيرة التي ابتُلي بها المستغربون، ولكنَّه يُعتَبر مع ذلك من طلائع النظرة إلىٰ الذات من خلال مرآة الآخرين، ويُقدِّم بشكل صريح تفاسيره المادّيَّة والماركسيَّة والظاهراتيَّة للإسلام.
وعلىٰ الرغم من أنَّ حسن حنفي قد تعرَّض إلىٰ إنكار الساحة الإلهيَّة الأنطولوجيَّة والإبستيمولوجيَّة المقدَّسة، ونظر إلىٰ أهمّ الأُصول والتعاليم الإسلاميَّة من الناحيَّة الظاهراتيَّة بوصفها نوعًا من الإحساس والإدراك الداخلي للإنسان، والذي يظهر بمقتضىٰ الشرائط الاجتماعيَّة والحياتيَّة للمجتمع في الحركة التاريخيَّة علىٰ أشكال مختلفة في الجماعات والنِّحَل الإسلاميَّة، إلَّا أنَّه بسبب توظيفه للأدبيّات الدِّينيَّة، فإنَّه يستخدمها في تفسيراته وتحليلاته التجديديَّة. يُكثِر حنفي من استعمال القواعد والمسلَّمات الفقهيَّة والأُصوليَّة والتفسيريَّة وما إلىٰ ذلك في إثبات مراده ومقصوده، حتَّىٰ إنَّ الذي ليس لديه إلمام بمبانيه النظريَّة والمعرفيَّة يخال له أنَّه أمام متكلِّم معتزلي أو مسلم معتقد بتعاليم الإسلام، ولكنْ كما سيأتي ضمن عنوان «إعادة قراءة الإسلام والتراث الإسلامي من وجهة نظر حنفي»، فإنَّ مفاهيم من قبيل: الإسلام والقرآن والوحي والنبيِّ والتفسير والفقه وما إلىٰ ذلك، إنْ هي إلَّا مفاهيم خاصَّة عنده، ليس لها من صلة بالعقائد الإسلاميَّة غير الاشتراك
اللفظي، وهي في تقابل واضح وصريح مع تعاليم الكتاب والسُّنَّة وحكم العقل. ولم يقل بهذا الاتِّجاه أحد من المتكلِّمين والمفسِّرين والأُصوليِّين من الشيعة والسُّنَّة علىٰ مرِّ التاريخ. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّه يتَّخذ من طريقة الجدل حول المسلَّمات الاعتقاديَّة للمسلمين وعرض تفسير محرَّف وزاخر بالمغالطات، منهجًا في مواجهة التراث الإسلامي.
كما أنَّ أُسلوب حسن حنفي في الاستفادة من الآيات والروايات في الكثير من آثاره، ليس من قبيل الأساليب التفسيريَّة أو تطبيق مدلول الآيات علىٰ مصاديقها، وإنَّما هو في الغالب من قبيل الاستناد إلىٰ الأشعار والتمثيل والأمثال والحِكَم، وربَّما لا تُستَعمل في مدلولها الأصلي، بل من قبيل طرق الباب وبشكل آلي.
يذهب حسن حنفي إلىٰ اعتبار المفاهيم والأدوات المعرفيَّة للأساليب الظاهراتيَّة من أنسب الأساليب في العلوم الإنسانيَّة، ويُكثِر في هذا الشأن من توظيف مفردات الشعور أو الإدراك أو الإحساس الداخلي. إنَّ الشعور أو الإدراك يُمثِّل أداة جوهريَّة في تحليله لتعاليم التراث الإسلامي. إنَّ مراده من التحليل الشعوري بالنسبة إلىٰ الظواهر الإنسانيَّة، هو تحليل التجارب المعاشة التي توجد علىٰ شكلٍ واعٍ وحيويّ في دخيلة أفراد البشر. وعلىٰ حدِّ تعبيره، يقع في عالم الشعور الإنساني جدل بين العقل والواقع الاجتماعي، وإنَّ الظواهر الاجتماعيَّة ظواهر حيَّة، والإنسان في مركزيَّة العالم الخارجي يعمل علىٰ توحيد الواقع الخارجي مع عقله وتفكيره في فضاء الشعور والتجربة الحيَّة. وعلىٰ
هذا الأساس، فإنَّ التحليل الشعوري يقتضي أنْ يكون الإحساس والوعي لدىٰ الأفراد عن الواقعيَّة هو الأصل، وجميع نصوص التراث متفرِّعة عنه، وبالتالي يجب أنْ لا يكون لها من مدلول سوىٰ مفهوم الإحساس والشعور.
إنَّ من خصائص أُسلوب حسن حنفي أنَّه في مجموع أعماله يعاني من ضعف، بل وفقدان الأدلَّة والشواهد الكافيَّة علىٰ مدَّعياته. فهو يُكثِر من اللجوء إلىٰ الأُسلوب الجدلي، ولا يتجاهل الاستشهاد بالآيات والروايات في تطبيقها علىٰ مراده؛ إذ هو ليس بصدد الكشف والدفاع عن الحقيقة، وربَّما كان من أجل ذلك يقول بعدم وجود الحقيقة، وأنَّ الحقيقة إنَّما هي من صنع شعور وإدراك الإنسان ومصالحه المعاصرة. ومن هنا فإنَّ أُسلوبه ليس أُسلوبًا استدلاليًّا وبرهانيًّا، ولا مؤيَّدًا بمؤيِّدات نقليَّة. يكتسب الوجدان والشعور والإدراك والإحساس في أدبياته معنىً خاصًّا لا رابط له بالثبات والحقيقة والرسالة الإنسانيَّة الثابتة، ولذلك لا يجد مناصًا من اللجوء إلىٰ استخدام الأُسلوب الخطابي والجدلي. وإذا لم يتسنَّ لشخص الاطِّلاع علىٰ أعماله المهمَّة، من قبيل: من العقيدة إلىٰ الثورة، ولا تكون رؤيته بشأن حقائق، من قبيل: «الله» و«النبيِّ» و«الوحي» و«المعاد» و«الإنسان»، واضحة بالنسبة إلىٰ قارئ أعماله الأُخرىٰ، لا يظنُّ أنَّ إلهه ومعاده ليس هو إله ومعاد المسلمين. وفي الحقيقة فإنَّ الأفكار ذاتها التي يطرحها العلمانيُّون والليبراليُّون والماركسيُّون بشكل صريح في مواجهة الأفكار الإسلاميَّة، يعمل حسن حنفي علىٰ اجترارها تحت غطاء الأدبيّات الدِّينيَّة وباسم إصلاح التراث القديم.
إنَّه علىٰ الرغم من تأثُّره بالقواعد المنهجيَّة والمعرفيَّة لعالم التجدُّد، يدَّعي
(44)أنَّه يمتلك نظرة حضاريَّة في تحليل المسائل والموضوعات، ومن هنا فإنَّه يُكثِر في مؤلَّفاته من استعمال عبارات مثل: أنا والآخر أو المسلمون والغرب، وقد صرَّح بأنَّ المسلمين يجب عليهم أنْ يتمتَّعوا بهويَّة مستقلَّة في مواجهة الحضارة الغربيَّة، وأنَّ علينا أن لا ننظر إلىٰ أنفسنا عبر مرآة الآخرين، بل إنَّه لا يرىٰ في الإسلام شيئًا سوىٰ جانبه الحضاري.
الخصِّيصة الأُخرىٰ في أعمال حسن حنفي تكمن في تكراره وتفصيله المملِّ، حيث يتكرَّر اتِّجاهه التاريخي والحضاري في أكثر أعماله، وفي بيان جميع المسائل والتحدّيات الماثلة أمام العالم الإسلامي الراهن. وقد أدّىٰ اتِّخاذ هذا المنهج إلىٰ تضخُّم في كُتُبه ومقالته من دون أنْ تضيف عمقًا لتفكيره.
إنَّ المباني الفكريَّة لحسن حنفي تعاني من عيوب جادَّة ونواقص جوهريَّة، فهي تعمل علىٰ تقويض جميع تحليلاته واستنتاجاته، ولذلك سوف نُرجئ نقدها ومناقشتها إلىٰ القسم الأخير من هذه المقالة.
إنَّ أُسس الاتِّجاه الظاهراتي قابلة للنقد من زاوية الأُصول الواقعيَّة للفلسفة الإسلاميَّة. إنَّ المفاهيم الموجودة في ذهن الإنسان، تُعبِّر في الفلسفة الإسلاميَّة عن العالم الخارجي والعيني، وعلىٰ هذا الأساس لا يمكن الحديث عن الأُمور الحقيقيَّة من خلال تعليق الحقائق من خارج الذهن والإحساس البشري، وفي الأساس سوف تفقد المعرفة مفهومها. إنَّ التحليل الظاهراتي للتعاليم الدِّينيَّة بمعناها الهوسِرْلي ليس له أيّ ارتباط بالدِّين؛ إذ إنَّ جميع التحليلات والتفسيرات التي قدَّمها حسن حنفي للتراث الإسلامي، قد عملت، مثل
(45)الكلمات الظاهراتيَّة لهوسِرْل، علىٰ تعليق وجود الحقائق الخارجيَّة والعينيَّة للتعاليم الدِّينيَّة (من قبيل: الله وصفاته وأفعاله، والقيامة، والوحي، وما إلىٰ ذلك)، مكتفيًا بمجرَّد التأكيد علىٰ البُعد الشعوري ووجودها المحسوس داخل الإنسان. بل يذهب حنفي إلىٰ أبعد من ذلك؛ إذ يقول بأنَّ حقائق الوحي ليست سوىٰ الإحساس الذي يعتمل في دخيلة الإنسان. إنَّ هذا النوع من التفسير يكمن في فضاء المنهج المادّي، وهو يحتوي علىٰ جميع النواقص والعيوب الفلسفيَّة والمعرفيَّة للظاهراتيَّة. يضاف إلىٰ ذلك، أنَّ هذا التفسير الظاهراتي لا ينسجم حتَّىٰ مع الحقائق التي تجري في إحساس وتفكير المسلمين، بمعنىٰ أنَّ هذا التفسير لا يُمثِّل تفسيرًا ظاهراتيًّا لعقائد المسلمين؛ وذلك لأنَّهم إنَّما يصلون إلىٰ معتقداتهم وإحساسهم وسلوكهم الدِّيني بوساطة اعتبارهم العقائد الدِّينيَّة أُمورًا واقعيَّة وحقيقيَّة، وإنَّ أشخاصًا مثل حسن حنفي من خلال إنكارهم لتلك الحقائق، يعملون علىٰ إظهار إحساسهم النفسي أو الظاهراتي، وهذا التفسير لا يمكن اعتباره تفسيرًا للتفكير الدِّيني للمسلمين.
لقد ارتكب حسن حنفي عددًا من الأخطاء المعرفيَّة في توظيفه للاتِّجاه الظاهراتي، ومن بينها أنَّه يزعم أنَّ النصوص الدِّينيَّة تُمثِّل توصيفًا للتجارب الحيَّة التي توصَّل لها الأنبياء. لقد ذكرت آيات القرآن الكريم بعض الحالات الروحيَّة لأشخاص، ومن بينهم الأنبياء، إلَّا أنَّ هذا لا يعني أنَّ الحالة الروحيَّة تُحوِّل نفسها إلىٰ نصوص سماويَّة ثمّ تجري علىٰ ألسنة وأذهان الأنبياء. إنَّ مسار الوحيد يتمتَّع بمبدأ وتيّار خاصٍّ لا يمكن تحليله إلَّا من طريق إثبات عالم الغيب والإيمان به. في الكثير من الموارد يُؤدّي نزول الوحي أو روايته لبعض
(46)الأشخاص إلىٰ حدوث تغيُّر في الحالات الروحيَّة والمعرفيَّة لديهم، إذاً نتحدَّث هنا عن تأثير للوحي في روح الإنسان، وليس العكس، وفي بعض الموارد يُخبِر الوحي عن الحالات الروحيَّة للأشخاص، لا أنَّه ينبثق عنها. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ التحليل الظاهراتي، خلافًا لتوهُّم حنفي، لا ربط له بماهيَّة الوحي أو استعماله في الوحي.
لقد أقام حسن حنفي أفكاره علىٰ مشروع نظري واسع تحت عنوان التراث والتجديد، ضمن محوريَّة الموضوعات الثلاثة الكبرىٰ الآتيَّة:
1. موقفنا من التراث القديم (2) أو نقد التراث العربي/ الإسلامي.
2. موقفنا من التراث الغربي (3) أو نقد التراث الحضاري للغرب.
3. موقفنا من الواقع المباشر (4) أو الواقعيَّة المعاصرة.
إنَّه يرىٰ أنَّ كلَّ واحد من المحاور أعلاه، يُمثِّل بيانًا ديالكتيكيًّا بين الـ «أنا» و«الآخر». فالمحور الأوَّل يُبيِّن نسبتنا إلىٰ تراثنا القديم، في حين أنَّ المحور الثاني يبحث نسبتنا إلىٰ الغرب المعاصر الذي يُمثِّل ظاهرة حديثة وافدة، والمحور الثالث يضعنا في دائرة الواقع الراهن والاقتضاءات والتهديدات والتحديّات، وبالالتفات إلىٰ ذلك يباشر عمليَّة التنظير. يرىٰ حسن حنفي أنَّ هناك ثلاثة عوامل في كلِّ موقعيَّة حضاريَّة، تتضافر فيما بينها، ليظهر الإبداع والتجديد، وهي كالآتي: التراث القادم من الماضي، والثقافة الوافدة التي تُمثِّل أمرًا حديث الظهور، والموقعيَّة المستلزمة للإبداع، والتي تُمثِّل البوتقة، حيث تصهر العاملين الأوَّلين وتمزجهما معًا. وفي الحقيقة فإنَّ المحاور الثلاثة المتقدِّمة
تواكب واحدًا من الأزمنة: الماضي والحاضر والمستقبل. وبعبارة أُخرىٰ: إنَّ حسن حنفي يرىٰ المحورين الأوَّلين أُمورًا نقليَّة، فهي إمَّا نقل عن الماضين، وإمّا نقل عن المعاصرين، رغم انبثاقهما من مصدرين ثقافيَّين وحضاريَّين مختلفين (التراث القديم والتراث الغربي)، فما نقوله هو ما يقوله أبو حامد الغزالي، أو إنَّ ما نقوله هو نقل عن جون ستيوارت ميل، وعلىٰ كلِّ حالٍ، فإنَّ ما نقوله إنَّما هو من مقولة النقل. ومن هذه الناحيَّة فإنَّ الاتِّجاه السلفي المعاصر، والاتِّجاه العلماني والتجدُّد يتشابهان في الاستناد إلىٰ النقل.
وبطبيعة الحال، خلافًا لما ذهب إليه حسن حنفي، لا يسعنا أنْ لا نقول بالتمايز بين نقل «التراث القديم» وبين نقل «التراث الغربي»، والقول بتساوي النقلين بالنسبة لنا؛ وذلك لأنَّ نقلنا للتراث القديم، إنَّما هو نقل لهويَّتنا وصورة عن أنفسنا، في حين أنَّ نقل التراث الغربي، إنَّما هو نقل للأجنبي وصورة للآخر المختلف. فهل يمكن لموقفنا أنْ يكون واحدًا تجاه النقلين؟! لا معنىٰ للموقف الحيادي هنا، إلَّا إذا كنّا لا نعتبر التراث القديم ترجمانًا لنا.
إنَّ كلَّ واحدٍ من المحاور الثلاثة، التي تناولها حسن حنفي، يشمل موضوعات واسعة عمد إلىٰ رسمها في مشروع التراث والتجديد، وتعرَّض إلىٰ الأبعاد النظريَّة لبعض (... يوجد نقص) من أهمّها علىٰ النحو الآتي:
أ) المحور الأوَّل، أي: «موقفنا من التراث القديم»، يتعرَّض إلىٰ دراسة تاريخنا القديم وتراثنا الثقافي، وهو يشتمل علىٰ سبعة موضوعات. خمسة منها تشير إلىٰ ضرورة الانتقال من مرحلة إلىٰ مرحلة أُخرىٰ، والموضوعان الآخران
غائبان عن تفكيرنا المعاصر من وجهة نظره، ويجب أنْ يكون لهما حضور في تفكيرنا. وهذه الموضوعات السبعة علىٰ النحو الآتي:
1. من العقيدة إلىٰ الثورة، إصلاح علم الأُصول أو علم الكلام.
2. من النقل إلىٰ الإبداع، لغرض إعادة صياغة العلوم الحكميَّة.
3. من الفناء إلىٰ البقاء، لغرض إصلاح علوم التصوُّف.
4. من النصِّ إلىٰ الواقع، لغرض إصلاح أُصول الفقه.
5. من النقل إلىٰ العقل، لغرض إصلاح العلوم النقليَّة (القرآن والسُّنَّة والسيرة والفقه).
6. الوحي والعقل والطبيعة، سعي لغرض إصلاح العلوم الرياضيَّة والطبيعيَّة.
7. الإنسان والتاريخ، لغرض إصلاح العلوم الإنسانيَّة (علم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسيَّة، والأدبيّات، والجغرافيا، والتاريخ).
ب) المشروع النظري لحسن حنفي في محور «موقفنا من التراث الغربي»، بيان مواجهة الـ «أنا» مع «الآخر»؛ أي الغرب المعاصر، وهو يشتمل علىٰ أربعة موضوعات عامَّة، وهي كالآتي:
1. ماهيَّة الاستغراب، أو معرفة الغرب.
2. تكوين الوعي الأُوروبي.
3. بنية الوعي الأُوروبي.
4. مصير الوعي الأُوروبي.
وقد تناول الموضوعات أعلاه في كتابه مقدّمة في علم الاستغراب. وحيث يدَّعي حنفي أنَّه مؤسِّس لعلم جديد باسم الاستغراب في هذا الكتاب، فإنَّنا سوف نناقش آراءه بشأن الغرب علىٰ أساس هذا الكتاب.
إنَّ مراد حنفي من التكوين هو دراسة الوعي الأُوروبي في التوالي الزمني والتاريخي ضمن المراحل الثلاثة الآتيَّة: الظهور، والتطوُّر، والمصير. ومن هذه الناحية يكون التكوين ظاهرة تاريخيَّة، تكتسب مفهومها ومعناها عبر تصرُّم الزمن، وإنَّ الوعي الأُوروبي أمر تاريخي ونتيجة له، ومن هنا يزدهر الاتِّجاه التاريخي في إطاره بشكل ملحوظ. وإنَّ مراده من بنية الوعي الأُوروبي العناصر الثابتة التي تتغلَّب علىٰ الثقافة والفكر الأوروبي علىٰ الرغم من تاريخيَّة «التكوين»، وتمنحه شكلًا خاصًّا. وأمَّا مصير الوعي الأُوروبي، فهو المستقبل الذي يعمل ماضي وحاضر الغرب علىٰ تعيينه.
يُرجِّح حسن حنفي اختيار مصطلح «الوعي» علىٰ مصطلح «الشعور» و«العقل»؛ لأنَّه يرىٰ الشعور مفهومًا نفسيًّا، في حين أنَّ «الوعي» أقرب إلىٰ الدلالة الحضاريَّة. كما أنَّه يرىٰ حتَّىٰ في استعمال «العقل الأُوروبي» أو «العقل العربي» مفهومًا عنصريًّا؛ لأنَّ العقل لا هو عربي ولا فرنسي ولا ألماني، ولا أيُّ عرقيَّة أو قوميَّة أُخرىٰ، ومن هنا يعمل إيمانوئيل كانط علىٰ نقد العقل النظري
أو العقل العملي، ويعمل جان بول سارتر علىٰ نقد العقل السياسي، ويعمل فلهالم دلتاي علىٰ نقد العقل التاريخي. وبطبيعة الحال، فإنَّه في كتابه في الفكر الغربي المعاصر، الذي ألَّفه قبل كتاب «مقدّمة في علم الاستغراب»، كان يستعمل مصطلح «الشعور الأُوروبي». كما يعمد حسن حنفي إلىٰ استخدام مصطلح «الأُوروبي» بدلًا من مصطلح «الغربي» بعناية خاصَّة؛ إذ المصطلح الأوَّلي ينطوي علىٰ مفهوم تاريخي وحضاري، في حين أنَّ «التراث الغربي» حصيلة إنتاجيَّة تحقَّقت في الغرب وفي المرحلة المعاصرة. يرىٰ حسن حنفي أنَّ الغرب صفة «التراث» (التراث الغربي)، إلَّا أنَّ أُوروبا صفة «الوعي»، وأنَّ الغرب حقيقة خارجيَّة وأُوروبا ماهيَّتها، وأنَّ التراث الغربي بمنزلة «الكمّ»، في حين أنَّ الوعي الأُوروبي بمنزلة «الكيف» بالنسبة له. وبطبيعة الحال، فإنَّه يُذعِن بأنَّ مفردة الغرب أكثر استعمالًا من مفردة أُوروبا في كلامنا، إلَّا أنَّه يرىٰ الغرب مفردة سياسيَّة وجغرافيَّة تُستَعمل في قبال الشرق. ويبدو بطبيعة الحال أنَّ هذا النزاع اللفظي لا يُؤدّي إلىٰ نتيجة، فنحن علىٰ كلِّ حالٍ أمام حقيقة باسم الغرب أو أُوروبا، مع ماهيَّة خاصَّة تتمثَّل في تراثهم وحضارتهم، والهدف الأصلي من الاستغراب هو التعرُّف الدقيق عليه وتنظيمه وتحليل النسبة التي يمكن أنْ تكون له تجاهنا «نحن».
من خلال ملاحظة الموضوعات التي أثارها حسن حنفي في محورَي «موقفنا من التراث القديم» و«موقفنا من التراث الغربي»، نشاهد اختلافًا فاحشًا في نوع رؤيته إلىٰ حضارتنا والحضارة الغربيَّة. ويرىٰ سبب ذلك في
تاريخيَّة الوعي الغربي، بمعنىٰ أنَّ الحضارة الجديدة، خلافًا لحضارة المسلمين التي تحظىٰ علومها بمركز واحد (الله) وتقوم علىٰ أساس هذا المركز، تعمل علىٰ تنظيم علومها ضمن دائرتين متداخلتين مع قوسين، أحدهما صعودي والآخر نزولي. بمعنىٰ أنَّها أوَّلًا في التعاطي مع القوّتين: الداخليَّة (في مواجهة الحقيقة التي كانت تواجهها)، والخارجيَّة (في مواجهة المسائل التي ظهرت ضمن المواجهة مع الآخر)، توصّلت علىٰ التوالي إلىٰ علم أُصول الدِّين أو العقائد والحكمة أو الفلسفة، علىٰ شكل دائرتين متداخلتين. وثانيًا من خلال إقامة ارتباطين مع الله، أحدهما نزولي والآخر صعودي، وبالتالي النزول من الله والصعود إليه، يتمُّ الوصول علىٰ التوالي إلىٰ علم أُصول الفقه وعلم العرفان.
في الوقت الذي تبلورت الحضارة الإسلاميَّة وأظهرت بنيتها من خلال التعاطي والتعامل مع المركز في نظام من العلوم، نجد الحضارة الغربيَّة حصيلة الطرد والنبذ المتواصل للمركز؛ فحيث لم يكن المركز متناغمًا مع العقل والواقع، لذلك فإنَّ الحضارة الغربيَّة الجديدة قد أوجدت ضمن مركزيَّة جديدة باسم الإنسان ومنهجيَّة تاريخيَّة، علومها العقليَّة والطبيعيَّة والإنسانيَّة، حيث يكون التغيير والتطوُّر والتاريخيَّة من أجزائها الذاتيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ رؤيته إلىٰ الحضارة الغربيَّة، بما يتناسب مع تاريخيَّتها، رؤية تاريخيَّة، في حين يرىٰ الحضارة والتفكير الإسلامي تفكيرًا ماهويًّا.
ج) إنَّ المحور الثالث الذي يرصده حسن حنفي في مشروع التراث والتجديد، عبارة عن «موقفنا من الواقع الراهن». إنَّ هذا المحور يتعاطىٰ مع
العالم الخارجي والواقعيَّة الاجتماعيَّة، التي هي بحسب تعبيره لا تحتوي علىٰ نصٍّ مدوَّن، بل يجب علىٰ النصوص أنْ تصفها وتُعبِّر عنها. وبعبارة أُخرىٰ: إنَّ التنظير يتمُّ في هذه المرحلة وبالالتفات إلىٰ العالم الاجتماعي والحياة الاجتماعيَّة. ويشير حسن حنفي في هذا الحقل من البحث إلىٰ ثلاثة اتِّجاهات، وهي:
1. اتِّجاه تبرير الوضع القائم، حيث يذهب حنفي إلىٰ هذا التقييم، سواء في حقل المعتقدات الدِّينيَّة، أو حقل النظم الاجتماعي، أو الاتِّجاه السلفي بالنسبة إلىٰ التراث الإسلامي، ومنهج العلمانيِّين تجاه تراث الغرب، ومنهج علماء السلاطين تجاه السلطة السياسيَّة.
2. اتِّجاه نبذ وطرد الوضع القائم، والتمرُّد علىٰ هذا الواقع، وهذا هو الاتِّجاه الذي يتبنّاه العلمانيُّون تجاه التراث القديم، والسلفيُّون تجاه التراث الغربي.
3. اتِّجاه اعتزال الوضع القائم، وعدم العمل علىٰ تبريره ولا رفضه وإنكاره، بل الاعتزال تحت ذريعة أنَّ العالم الاجتماعي عالم مؤلم، واللجوء بالتالي إلىٰ الوسائل التخديريَّة أو الهجرة إلىٰ الخارج، كما حدث للكثير من الشعراء. يرىٰ حسن حنفي أنَّ لا شيء من هذه الاتِّجاهات الثلاثة المتقدّمة قد غيَّر الواقع الاجتماعي، أو أنَّها لم تُدرِكه بشكل صحيح، ولم تقم معه ارتباطًا صحيحًا. ومن هنا فإنَّه يطرح اتِّجاهًا رابعًا علىٰ النحو الآتي:
4. الاتِّجاه التنظيري للواقع الخارجي دون وساطة، ومن طريق الإحساس الحاصل عبر العيش ضمن إطاره. إنَّ هذا التظير من وجهة نظره لا يقوم علىٰ أساس التبعيَّة للأفراد أو اتِّباع التراث المنقول (الأعمّ من
القديم والجديد)، وإنَّما ينبثق من صلب الحياة والواقعيَّة الاجتماعيَّة والشعور والإحساس المباشر. يرىٰ حسن حنفي أنَّ طريق معرفة عناصر الواقع القائم، يكمن في أساليب التحقيقات الاجتماعيَّة، من قبيل: الإحصاء والحوارات وطرح الأسئلة، والتي يجب العمل بعد ذلك علىٰ تحليلها طبقًا للأساليب الكيفيَّة.
يعمد حسن حنفي في المحور الثالث علىٰ التعريف بسبعة موضوعات جوهريَّة بوصفها من تحدّيات هذا المحور، وهي كالآتي:
1. تحرير الأرض، ولاسيّما فلسطين من الاستعمار الصهيوني.
2. الدفاع عن حرّيّات المواطنين، وسائر الحقوق الإنسانيَّة الأُخرىٰ.
3. العدالة الاجتماعيَّة، وإعادة النظر في توزيع الثروات الوطنيَّة.
4. الاتِّحاد الوطني في قبال التقسيم والقوميَّة والحروب الداخليَّة.
5. التقدُّم المقرون بالاستقلال في قبال التخلُّف والتبعيَّة.
6. الدفاع عن الهويَّة والأصالة في قبال النزعة الغربيَّة والاستغراب.
7. حشد الطاقات العامَّة والمشاركة الوطنيَّة في قبال الحياد السلبي.
يبدو أنَّ التقسيم الذي يُقدِّمه حسن حنفي للمسائل المتعلِّقة بمشروع التراث والتجديد، إلىٰ ثلاثة حقول عامَّة، وهي: (تراثنا، والتراث الغربي، والوضع الراهن)، تقسيم مقبول، وبطبيعة الحال فإنَّ هذه التقسيمات قابلة للتكثير أو التقليل باعتبارات مبرِّرة ومعقولة، وهذا بطبيعة الحال غير العيوب والنواقص المعرفيَّة والحضاريَّة التي يعاني منها مشروعه من الداخل. وعلىٰ
هذا الأساس، فإنَّ التراث الإسلامي في قبال التراث الغربي بوصفهما محورين عامَّين ومهمَّين إلىٰ جانب محور ثالث بعنوان مقتضيات العصر الراهن وحياتنا الاجتماعيَّة، يمكنها أن تُشكِّل إطارًا لمشروع التراث والتجديد. ولكنْ هناك نقاط تدعو إلىٰ التأمُّل وتستحقُّ النقاش في طرح حسن حنفي، وفيما يلي نشير إلىٰ بعضها:
1. إنَّ التراث الإسلامي، خلافًا لرؤية حسن حنفي، مجموعة كبيرة لا تحتوي جميع أقسامها ومحاورها علىٰ نسبة واحدة مع الزمان والتاريخ، وعلىٰ الرغم من أنَّ «الماضي» يُمثِّل ظرفًا لتحقُّقها بأجمعها، لكنَّه لا يُشكِّل قيدًا لكلِّ التراث الإسلامي. وعلىٰ الرغم من أنَّ الكثير من الأُصول وأُمَّهات الأفكار الإسلاميَّة، وكذلك الكثير من متفرِّعاتها، وإنْ كانت حصيلة الاجتهاد والتنظير من قِبَل علماء الإسلام علىٰ مختلف المراحل التاريخيَّة، إلَّا أنَّها ليست بأجمعها محدودة بالظروف والشرائط الجغرافيَّة والتاريخيَّة، وإنَّما مرجعها إلىٰ الدلالات الصريحة والقطعيَّة للنصوص الدِّينيَّة أو الأحكام العقليَّة. ولذلك يمكن الاستفادة منها بوساطة الضوابط التفسيريَّة للكتاب والسُّنَّة استفادة ما فوق تاريخيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، لا يمكن اعتبار التراث القديم تراثًا للقدماء بالمعنىٰ الدقيق للكلمة؛ إذ لربَّما كان حصيلة تفكيرنا الراهن والقادم، وترجمان هويَّتنا الثابتة والخالدة.
2. كيف يمكن تفسير واقعيَّة وحقيقة حياتنا المعاصرة من خلال الانفصال عن التراث؟ وكيف يجب أنْ ينبثق تفسير الواقع المعاصر من بين التراث القديم والجديد، في حين لا علاقة للتراث الغربي بنا؟ إنَّ اتِّجاه حنفي
في التنظير للواقعيَّة المعاصرة ينطوي علىٰ الكثير من الإبهام والغموض، وعلىٰ حدِّ تعبير حنفي، يجب العمل علىٰ تحليل الغرب والواقع الراهن من خلال النظر إلىٰ جذورنا وأصالتنا. وبالمناسبة، فإنَّ الغرب، بإقرار حسن حنفي، قد أصبح جزءًا من واقعنا المعاصر، حيث يجب إخضاعه للبحث، والآن بالنظر إلىٰ رؤيته القائلة بوجوب تجريد الواقعيَّة الخارجيَّة قبل كلِّ شيء من جميع أنواع النظريّات (الأعمّ من أنْ تكون تلك النظريَّة من تراثنا القديم أو من التراث الغربي)، ثمّ العمل علىٰ إلباسها ثوبًا جديدًا من النظريَّة، فالسؤال هو: بأيِّ جذور وأصالة يمكن تحقيق هذه الغايَّة المهمَّة؟ وهل تبقىٰ هناك أصالة بعد التخلّي عن التراث القديم لنعمل من خلالها علىٰ قراءة جانب من واقعيَّتنا المعاصرة المتمثِّلة بالغرب؟! لا شكَّ في أنَّ معرفة الذات المرتهنة للتراث الإسلامي المتقدِّم، من أهمّ المباني للاستغراب، وما لم يتحقَّق هذا الشرط، فإنَّ استغرابنا لن يكون له من حاصل سوىٰ الغرب في مرآة الغربيِّين.
3. يرىٰ حسن حنفي في موارد متعدِّدة من أعماله أنَّ نسبتنا إلىٰ الغرب هي نسبتنا إلىٰ المستقبل، كما يرىٰ التراث الإسلامي ماضيًا، ونسبتنا إليه هي نسبتنا إلىٰ الماضي. وكلا تعبيريه قابل للنقاش. ما هو معنىٰ مفهوم الماضي والمستقبل في كلامه؟ هل المراد من «الماضي» انقضاء عمر التراث الإسلامي وانتهاء تناسبه مع العصر الراهن؟ وهل المراد من «المستقبل» مرحلة تاريخيَّة أمام الحضارة الإسلاميَّة لا مناص لها من الدخول فيها؟ لماذا يكون الغرب «مستقبلًا» بالنسبة لنا؟
لقد وقع حسن حنفي في تناقض شديد، فهو من ناحية يرىٰ الحضارات والمظاهر الحضاريَّة، طبقًا لمبناه، تابعة لشرائطها الزمانيَّة والمكانيَّة الخاصَّة التي لا تقبل الانتقال، ومن ناحية أُخرىٰ لا يعتبر تغيير التراث الماضي بما يتناسب مع القراءة العصريَّة، انفصالًا عن الماضي. كما يُعبِّر عن الغرب بأنَّه للغرب ولا يقبل التعميم بالنسبة لنا، ويتابع الاستغراب بهذه الغاية، ولكنَّه يُعبِّر عن الغرب دائمًا بوصفه «مستقبلًا».
4. إنَّ التحدّي بين الاتِّجاه العلماني والأُصولي، إنَّما هو في تفسير الواقعيَّة المعاصرة فقط، في حين أنَّ هذا الحصر غير صحيح. إنَّ الاختلاف بين الاتِّجاهين المذكورين قبل أنْ يكون مرتبطًا بتفسير الواقع المعاصر، ينشأ من الاختلاف الجذري في الأبحاث الإبستيمولوجيَّة والأنطولوجيَّة والأنثروبولوجيَّة، وعندها يُؤدّي هذا الاختلاف في نهاية المطاف إلىٰ التحدّي في حقل الواقعيَّة المعاصرة. ولذلك، فإنَّ غياب الواقعيَّة المعاصرة عن ساحة التحدّي بين الاتِّجاه العلماني والأُصولي، خلافًا لرأيه، لا يجعل هذا التحدّي وهميًّا. كما أنَّ نزاعهم لا يدور حول الإحالة إلىٰ الماضي والمستقبل، بل إلىٰ العودة إلىٰ ثقافتين وحضارتين لهما خصائصهما الماهويَّة التي تُميِّزهما من بعضهما.
5. لقد تحدَّث حسن حنفي عن واقعيَّة باسم الوعي الحضاري، حيث يدرس الغرب في إطار وعيه الحضاري. ولكنْ ما هي حقيقة الوعي الحضاري؟ هل نسبة «الوعي» إلىٰ «الحضارة» نسبة حقيقيَّة؟ وهل يمكن اعتبار هذا الوعي بوصفه حقيقة واحدة اجتازت مختلف المراحل التاريخيَّة؟
إنَّ بحث هذه المسألة يعود إلىٰ حقل فلسفة التاريخ والحضارة، ولكنْ
يمكن القول علىٰ نحو الإجمال: إنَّ الحضارة ليست كيانًا حقيقيًّا ينبض بالروح، بل هي بمنزلة الوسيلة التي يتمُّ اتِّخاذها وتوظيفها لتبسيط التيّارات المعقَّدة للغاية والموجودة بين الثقافات للهروب من التعدُّديَّة وتعقيدات العالم الواقعي. إنَّ الحضارة تشتمل علىٰ تجلّيات حقيقيَّة، من قبيل: العمران، والآثار الفنّيَّة، والأعمال الفرديَّة والجماعيَّة للأشخاص، إذ هناك علىٰ الدوام جماعة من المنتجين وحملة النويّات العقلانيَّة والصور المؤسَّساتيَّة للحضارة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ الحضارة رغم أنَّها ليست كائنًا حقيقيًّا يجتاز مرحلة نموّ وكهولة وموت، إلَّا أنَّها تُمثِّل وحدة تحليليَّة لفهم المجتمعات البشريَّة. إلَّا أنَّ هذه الوحدة تُمثِّل، إلىٰ جوار الوحدة القيَميَّة والثقافيَّة والتنظيميَّة، شاهدًا علىٰ التعدُّديَّة والتباين والتضادِّ في الحضارات ذاتها أيضًا.
وعلىٰ هذا الأساس، لا يمكن لنسبة الوعي الحضاري أنْ تكون نسبة حقيقيَّة، بل هي باعتبار العناصر الاجتماعيَّة والمؤسَّسات والأنظمة الاجتماعيَّة والقِيَم الثقافيَّة. إنَّ الوعي الأُوروبي ومراحله الحضاريَّة لا يمكن أنْ يكون له معنىٰ، غير أنَّ للوجوه الحضاريَّة للغرب نقاط اشتراك، وإنَّ هذه النقاط المشتركة ذات تاريخ وتحوُّلات خاصَّة. ويبدو أنَّ حسن حنفي في نسبته الوعي إلىٰ أُوروبا والحضارة الغربيَّة، قد تأثَّر بإدموند هوسِرْل الذي يرىٰ للغرب روحًا وهويَّةً، حيث علىٰ الرغم من الاختلافات الجغرافيَّة والعرقيَّة، كانت تلك النواة المشتركة والمتمثِّلة بالروح الغربيَّة، باقيَّة منذ عهد الإغريق إلىٰ هذه اللحظة. إنَّ هذه الروح أو الصورة النفسانيَّة هي التي أدَّت إلىٰ توحيد أُوروبا
بجميع أفكارها ومجتمعاتها المتنوِّعة، وإنَّ هذه النفسانيَّة هي الصورة الفلسفيَّة التي تجلَّت في التاريخ الأُوروبي.
6. إنَّ الحضارة الغربيَّة من وجهة نظر حسن حنفي حضارة تاريخيَّة، ومن هنا يكون وعيها وعيًا تاريخيًّا، ويكون لها مراحل تكوين؛ أي: بداية وذروة ونهاية، إلَّا أنَّه يرىٰ الحضارة الإسلاميَّة ووعيها ماهويًّا، وهي تنطلق علىٰ الدوام من المركز إلىٰ الأطراف. وبغضِّ النظر عن تقييم هذا الكلام، نقول: أوَّلًا: إنَّ اعتبار الحضارة الإسلاميَّة أمرًا ماهويًّا ووعيًا للذات، يتعارض مع كلمات حنفي الأُخرىٰ؛ لأنَّه تحدَّث، في ضرورة إصلاح التراث الإسلامي، مرارًا عن تاريخيَّة التراث الإسلامي وتأثُّره بمختلف الشرائط التاريخيَّة والاجتماعيَّة، بحيث يتحدَّث حتَّىٰ عن تاريخيَّة القرآن والروايات، كما سنُثبِت ذلك في الأبحاث الآتية. يضاف إلىٰ ذلك، أنَّ هذا الفهم للتراث والحضارة الإسلاميَّة، التي تتبلور علىٰ أساس مركزيَّة السلطة والقدرة، لا ينسجم مع مجمل الواقعيَّة التاريخيَّة للمسلمين وحقائق التراث الإسلامي. كما أنَّ منعطفات الحضارة ليست رهنًا بماهويَّتها أو عدم ماهويَّتها، إنَّما الحضارة والثقافة مع افتراض تجاوز عناصرها الأصليَّة للتاريخ، تخضع في الوقت نفسه لتأثير الشرائط التاريخيَّة والعناصر الحضاريَّة، وتعمل علىٰ بلورة مراحلها التاريخيَّة المختلفة.
كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ من بين وجوه مشروع التراث والتجديد، بحث نسبتنا إلىٰ الغرب. ولكي يتمكَّن حسن حنفي من تحديد نسبتنا إلىٰ الغرب بشكل
علمي، عمد في البداية إلىٰ تأسيس علم جديد باسم علم الاستغراب، وقام بعرضه في إطار كتاب بعنوان مقدّمة في علم الاستغراب، كما تعرَّض في هذا الكتاب إلىٰ بيان مسار الوعي الأُوروبي بالتفصيل. وعلىٰ هذا الأساس، يتمُّ السعي في هذا القسم إلىٰ رسم رؤيته بشأن هذا العلم، وما ذكره حول الغرب والوعي الأُوروبي.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ الاستغراب علم جديد يخضع الغرب بوصفه موضوعًا لدراسته، ولكنْ لا من زاوية الغرب، بل من زاوية الشرق وفي مرآة المسلمين. كما تمَّ طرح علم الاستغراب من قِبَل الغربيِّين أيضًا؛ وذلك لأنَّهم قاموا بدراسة ونقد أنفسهم من زاوية «الوعي الأُوروبي» أيضًا، وتأمَّلوا في أنفسهم من خلال مرآة ذواتهم، إلَّا أنَّ هذا الاتِّجاه ليس هو المطلوب لنا من الاستغراب؛ لأنَّنا في الاستغراب لسنا تابعين لتوصيف الغرب لنا، كي نعمل علىٰ نقل معطيات تحليلهم تجاه الغرب.
وقد صرَّح بأنَّ رسالة الاستغراب المهمَّة تكمن في كسر عقد الحقارة التاريخيَّة التي كانت موجودة في نسبتنا إلىٰ الآخرين (الغربيِّين)، بحيث غدونا في موقع الموضوع لدراسة الغربيِّين. ولكنْ حاليًّا يجب تغيير هذه النسبة، وأنْ نصل إلىٰ المكانة الرفيعة بحيث لا نشعر بعقدة النقص في مواجهة الغرب، بل
(60)نتَّخذ من الغرب بوصفه موضوعًا للدراسة والتأمُّل وتنظيم نسبتنا إليه. إنَّ الاستغراب من خلال تأكيده علىٰ العودة إلىٰ الذات، يحفظنا من السقوط في الاغتراب عن الذات، وبالالتفات إلىٰ جذورنا وأصالتنا، نعمل علىٰ تحليل الغرب والواقع الراهن.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ واحدًا من الأهداف التي ينشدها من وراء الاستغراب المنظور له، نفي أُسطورة عالميَّة الغرب. إنَّ الاستغراب يرىٰ الغرب والحضارة الغربيَّة بوصفها ظاهرة تاريخيَّة مرتبطة بالظروف والشرائط البيئيَّة والاجتماعيَّة الخاصَّة، لا بوصفها ظاهرة عالميَّة ونتاجًا بشريًّا، بمعنىٰ أنَّ التراث الغربي يُمثِّل انعكاسًا للأفكار السائدة في بيئة خاصَّة، وهي التي تُمثِّل تاريخ الغرب. وعليه، من الخطأ اعتبار الحضارة الغربيَّة حضارة عامَّة لجميع البشـر، ومن هنا يجب أنْ يسعىٰ علم الاستغراب إلىٰ إلغاء النظرة إلىٰ الغرب في ضوء ثنائيَّة المركز والأطراف في الحقل الثقافي المهمِّ والمبنائي. وما دام هذا لا يحدث في حقل الثقافة، سنبقىٰ في تبعيَّتنا لمركزيَّة الغرب في حقل السياسة والاقتصاد أيضًا، وسوف تظلُّ جهود رجال السياسة والاقتصاد في القضاء علىٰ ثنائيَّة المركز والأطراف عقيمة.
يمكن لهذا العلم من الناحيَّة الأنطولوجيَّة، ومن خلال منحنا هويَّة مستقلَّة وخارجة عن سلطة الغرب، أنْ يُؤدّي إلىٰ تحرُّرنا الحضاري من
الغرب. ثمّ إنَّ وضع الغرب كموضوع، يُؤدّي إلىٰ الإحاطة بـ «الوعي الأُوروبي» والتوصُّل إلىٰ نقطة بداية ومراحل تكوين ونهاية، وفي مثل هذه الحالة يتمُّ النظر إلىٰ الغرب بوصفه أمرًا تاريخيًّا، ومجرَّد مرحلة من مراحل النهضة الإنسانيَّة، وليس أمرًا يتجاوز التاريخ واعتباره تجربة لجميع البشـر. إنَّ النظر إلىٰ الغرب بوصفه أمرًا تاريخيًّا يعني إعادة الغرب إلىٰ حدوده الطبيعيَّة والجغرافيَّة والتاريخيَّة المتعلِّقة بنشوئه ونموِّه، وإنهاء أُسطورته العالميَّة، ويمكنه استعادة سائر الحضارات من الأطراف إلىٰ المركز. وعليه، بدلًا من القول بمركزيَّة حضارة ما، سنشهد مراكز حضاريَّة متعدِّدة.
إنَّ الخصائص التي يذكرها حسن حنفي للاستغراب لا تجعل منه مجرَّد علم نظري يعمل علىٰ التحليل والتنظير، بل يعدُّ، بالإضافة إلىٰ ذلك، نوعًا من الممارسة العمليَّة في قبال جدل الأنا والآخر، ومن أجل تحرُّرنا الثقافي والحضاري والعلمي عن هيمنة الأجنبي. وعليه، يكون الاستغراب علمًا، ويكون أيديولوجا أيضًا.
علم الاستغراب ونفي الاستغراب المقلوب
لقد تحدَّث حسن حنفي، في قبال الاستغراب المنشود له، عن استغراب من نوع آخر، أطلق عليه مصطلح الاستغراب المقلوب، والذي يتمُّ فيه النظر إلىٰ
الأنا في مرآة الآخر بدلًا من النظر إلىٰ الآخر في مرآة الأنا. وقد أورد انتقادات مهمَّة علىٰ هذا النوع من الاستغراب، نُجمِلها فيما يلي:
1. اختيار جزئي من التراث الغربي، تراث الآخر، في أحد مذاهبه الشخصانيَّة أو الماركسيَّة أو الإنسانيَّة والوجوديَّة أو المثاليَّة أو الوصفيَّة، وليس الغرب ككلٍّ، وابتسار الحضارة الأُوروبيّة وردُّها إلىٰ أحد أجزائها مع ضياع جدل الكلِّ والأجزاء.
2. نزع هذه الأجزاء خارج بيئتها مع أنَّها نشأت كردَّة فعل علىٰ مذاهب أُخرىٰ، وقد ظهرت بوصفها ردَّة فعل تجاه بعضها البعض، ومن هنا فإنَّ طرح هذه المذاهب خارج بيئة ظهورها لا يعكس فلسفتها الوجوديَّة في البيئة الجديدة.
3. قراءة التراث الإسلامي، تراث الأنا، كلّه من منظور أحد المذاهب الغربيَّة الجزئيَّة، وتأويل الكلِّ الأصيل من منظور الجزء الدخيل، ممَّا يطمس خصوصيَّة التراث المقروء. وبالتالي يصبح التراث الغربي هو الإطار المرجعي لكلِّ قراءة لتراث آخر، وجعل المركز هو المقياس، والأطراف هي المقيس، وبالتالي تضيع هويَّة الأطراف التي يتمُّ إحالتها باستمرار إلىٰ المركز.
4. ابتسار الكلِّ وردُّه إلىٰ جزء مشابه في تراث الآخر حتَّىٰ يحدث التلقيح والتشابه؛ فتظهر الحضارة الإسلاميَّة في نزعاتها المادّيَّة عند الطبائعيِّين الأوائل أو في مثاليّات الفارابي أو في وجوديَّة أبي حيّان التوحيدي أو في إنسانيَّة الصوفيّة أو في شخصانيَّة القرآن أو في لسانيّات علم الأُصول.
نقد وتقييم:
لقد أكَّد حسن حنفي، مصيبًا، علىٰ ضرورة وفوائد علم الاستغراب، ولكنَّه فيما يتعلَّق بالفرضيّات النظريَّة وخصائص الآفاق التي تتعرَّض إلىٰ دراسة الغرب، لا يتحدَّث إلَّا علىٰ نحو الإجمال، مع أنَّ هذه الأُمور لا تقلُّ أهميَّةً عن أصل الاستغراب، بل إنَّ هويَّة وأصالة الاستغراب رهن بهذه الفرضيّات وخصائصها الأُسلوبيَّة. هناك العديد من الأسئلة التي من شأن عدم الإجابة عنها بشكل مستدلٍّ وصريح أنْ يُعرِّض فكرة الاستغراب للكثير من التحدّيات، من ذلك علىٰ سبيل المثال: ما هو موقع التراث الإسلامي في الاستغراب؟ وما هي نسبة تراثنا الإسلامي إلىٰ هويَّتنا؟ وما هي الأُصول الماهويَّة والأُسلوبيَّة من التراث الإسلامي التي تقوم عليها معرفتنا تجاه الغرب؟ وهل نعتبر التراث الإسلامي مثل التراث الغربي ظاهرة تاريخيَّة محدودة ومقيَّدة بالشرائط البيئيَّة أم أنَّ هذا التراث يفوق التاريخ، أم يجب القول بالتفصيل في هذا الشأن؟ وكيف تظهر المقتضيات الموجودة في حياتنا الاجتماعيَّة بوصفها من العناصر المهمَّة والمؤثِّرة في الاستغراب، وطبقًا لأيِّ قواعد وأُصول تفرض واقعها علينا؟ إنَّ هذا النوع من الأسئلة يُعَدُّ من فرضيّات ما قبل الاستغراب، التي يكون ظهور الاستغراب المطلوب أو المقلوب، رهنًا بالإجابة عنها. وسوف نترك الحكم بشأنها إلىٰ الأبحاث الآتية.
ومن بين هفوات حسن حنفي التي يُكرِّرها في هذا البحث، أنَّه يرىٰ أنَّ تحديد الغرب بمنزلته الطبيعيَّة والتاريخيَّة من مسؤوليَّة الاستغراب، ومن هنا يرىٰ الاتِّجاه الهجومي علىٰ الغرب خارجًا عن حقل الاستغراب وغير مناسب
(64)له. وفي الحقيقة فإنَّ تحديد الغرب بمكانته التاريخيَّة، لا يُمثِّل انتقادًا للغرب. إنَّ النقد يجب أنْ يعمل علىٰ بيان قيمة الغرب، إلَّا أنَّ تحديده وتقييده لا ينقض اعتباره بالنسبة إلىٰ تاريخه وجغرافيَّته، وهذه هي النسبيَّة المعرفيَّة والقيَميَّة والحضاريَّة. في حين أنَّ من شأن الاتِّجاه الهجومي أنْ يكشف عن تعارضنا مع جانب من الغرب، لا من ناحية عدم ارتباطه بمحيطنا وجغرافيَّتنا، بل من ناحية أنَّه لا ينسجم مع حقائق الوجود والقِيَم الإنسانيَّة.
كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ الطرح النظري لحسن حنفي في موضوع الاستغراب أو «نسبتنا إلىٰ التراث الغربي» يشتمل علىٰ المسائل الثلاثة الآتيَّة:
1. تبلور الوعي الأُوروبي.
2. بناء الوعي الأُوروبي.
3. مصير الوعي الأُوروبي.
ومن هنا سوف نتابع تحليل حسن حنفي للموضوع أعلاه من خلال ثلاثة محاور تحمل العناوين ذاتها المذكورة آنفًا.
يرسم حسن حنفي «تبلور الوعي الأوروبي» ضمن أربع مراحل، وهي: «مصادر الوعي الأوروبي»، و«بداية الوعي الأوروبي» و«ذروة الوعي الأوروبي»، و«نهاية الوعي الأوروبي». إنَّ المراد من مصادر الوعي الأوروبي تلك المنابع الواضحة والكامنة التي تغذَّت عليها الحضارة الغربيَّة من القرن
الأوَّل إلىٰ القرن الرابع عشر للميلاد. إنَّ بداية الوعي الغربي تشير إلىٰ عصر الإصلاح الدِّيني وعصر النهضة (ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد)، الذي شكَّل نقطة بداية للوعي الغربي، ولا سيّما بداية الكوجيتو الديكارتيّة القائلة: (أنا أُفكِّر؛ إذن أنا موجود) ، ثمّ جاءت العقلانيَّة في القرن السابع عشر للميلاد تُبشِّر بعصر التنوير والثورة في القرن الثامن عشر. يبلغ الوعي الأوروبي ذروته في القرن التاسع عشر للميلاد والفلسفات ما بعد الكانطيَّة. وأمَّا نهاية الوعي الأوروبي، فهي تبحث التحوُّل الجذري في مسار الوعي الغربي من «أنا أُفكِّر» في القرن السابع عشر للميلاد إلىٰ «أنا موجود» في القرن العشرين للميلاد، وكذلك إشارة إلىٰ المرحلة التي عمد فيها الغرب إلىٰ نقد ذاته، سواء في ذلك نقد الماضي، أو نقد الواقع الراهن والجديد الذي أسَّس له، من قبيل: نقد الواقعيَّة والوضعيَّة، وكذلك ظهور الاتِّجاه الثالث الذي يُمثِّل نقطة التقاء نقد الاتِّجاهين السابقين.
يطرح حسن حنفي مباحث واسعة في كلِّ واحدٍ من هذه المسائل الآنفة، ولاسيّما في موضوع تكوين الوعي الأوروبي الذي يشبه كُتُب تاريخ الفلسفة إلىٰ حدِّ التطابق. وقد سعىٰ في توصيف وتحليل المراحل التاريخيَّة آنفة الذكر إلىٰ تقييم الخلفيَّة التاريخيَّة والفلسفيَّة الخاصَّة لها كردَّة فعل تجاه بعضها.
يُقسِّم حسن حنفي مصادر الوعي الأوروبي إلىٰ قسمين، وهما: المصادر المعلنة والمصادر غير المعلنة، وإنَّ المصادر اليونانيَّة/ الروميَّة، واليهوديَّة/ المسيحيَّة تُعَدُّ
(66)من المصادر المعلنة، وإنَّ مصادر من الشرق القديم والشرائط البيئيَّة لأُوروبا، تُعَدُّ من المصادر غير المعلنة في الوعي الأوروبي. وفي الحقيقة فإنَّ المصادر غير المعلنة هي المصادر التي لا يبدي الأوروبيّون والفلاسفة والمؤرِّخون لفلسفة الغرب اهتمامًا بها، من ذلك أنَّهم يتعاملون مع مرحلة ما قبل الحضارة اليونانيَّة، وكأنَّها كانت مرحلة من الظلام والجهل المطلق، كما أنَّ عصر الآباء المسيحيِّين والعصر المدرسي كان جزءًا من مصادر الحضارة الغربيَّة أيضًا.
يذهب حسن حنفي، من خلال تأكيده علىٰ تأثير المصادر اليونانيَّة الروميَّة علىٰ المفاهيم والأفكار ولغة العصر الجديد في الغرب، إلىٰ القول: أعطىٰ الفكر اليوناني لغة مفتوحة يمكن بوساطتها عقد حوار بين المفكِّرين بدلًا من لغة العقائد المغلقة التي لا تحتمل التغيير أو التبديل في معانيها، والتي أصبحت مستقلَّة بمعانيها الاصطلاحيَّة التي أفقدتها توازنها أو فرصة إعطائها معاني جديدة قد تكون أكثر ضبطًا، كما كانت لغة عقليَّة محضة يمكن فهمها من مضمونها الخاصِّ بدلًا من اللغة العقائديَّة التي يتضمَّن مجرَّد استعمالها تقبُّل مضامينها. واستعمال اللغة العقليَّة كان من شأنه استعمال العقل أيضًا، فقد صاحب العقل اللغة، في حين أنَّ اللغة العقائديَّة القديمة تمنع من استعمال العقل، وكانت تفرض الإيمان والتسليم علىٰ الطريقة القديمة، وكانت لغة عامَّة يمكنها أنْ تضمَّ أكبر عدد من الوقائع، وتوجُّه أكبر عدد ممكن من الناس بدل اللغة القديمة التي كانت خاصَّة تصدق علىٰ أشخاص ووقائع معيَّنة، وموجَّهة إلىٰ فئة خاصَّة، هم الذين يُسلِّمون بعقائد الإيمان تسليمًا مسبقًا. في
(67)حين أنَّ اللغة القديمة كانت أبعد ما تكون عن المثاليَّة. كانت حسّيَّة شيئيَّة تاريخيَّة ترفض حتَّىٰ الاعتراف باستقلال الإنسان ووعيه. وأخيرًا، كانت لغة إنسانيَّة مرتبطة أشدّ الارتباط بالإنسان وعقله وحرّيَّته وسلوكه. وإذا كان المصدر اليوناني الروماني يُمثِّل الرافد العلماني في الوعي الأوروبي، فإنَّ المصدر اليهودي المسيحي يُمثِّل الرافد الدِّيني. ونتيجة ذلك، افتقار الوعي الأوروبي للعقلانيَّة؛ إذ كان هناك في كلِّ واحدٍ منهما شيء من العناصر اللّاعقلانيَّة.
إنَّ الغربيِّين يغضُّون الطرف عن ذكر مصادر الشرق القديم، وكذلك المصادر الإسلاميَّة رغم تأثيرها واتِّساع رقعتها في العمق الأوروبي، والتأثير الذي تركته ترجمة العلوم الإسلاميَّة، من قبيل: الفلسفة والكلام، وعلوم مثل: الرياضيّات والعلوم الطبيعيَّة. وقد ذهب حسن حنفي إلىٰ القول بأنَّ السبب في تجاهل الغرب للمصادر غير المعلنة في الوعي الأوروبي، يعود إلىٰ الشعور العنصري لديهم، حيث يريدون وضع أنفسهم في مركز العالم، والتعريف بالشرق علىٰ أنَّه بؤرة السحر والخرافات والأساطير.
كما لا يتمُّ التطرُّق إلىٰ تأثير الموقع الجغرافي والشرائط التاريخيَّة والعادات والتقاليد السائدة بين القبائل والشعوب الساكنة في أُوروبا قبل وبعد انتشار المسيحيَّة، في حين أنَّ الشرائط البيئيَّة والتاريخيَّة قد أضفت علىٰ الحضارة الأوروبية طبيعة خاصَّة. إنَّ الشرائط الجغرافيَّة وطبيعة السُّكّان والأساطير التي كانت سائدة بينهم، قد جعلت من المزاج الأوروبي مزاجًا حسّيًّا ومادّيًّا،
بحيث لم يعودوا يعرفون غير اللذَّة والألم والمنفعة والضرر المادّي، ولذلك كانت طبيعتهم أقرب إلىٰ المزاج الحسّي لدىٰ الرومان منها إلىٰ الفلسفة العقليَّة لدىٰ اليونان، كما كانت أقرب إلىٰ الوثنيَّة المادّيَّة منها إلىٰ المسيحيَّة الرومانيَّة.
عقائد الآباء (من القرن الأوَّل إلى القرن السابع للميلاد)
بالإضافة إلىٰ المصادر المعلنة وغير المعلنة في الوعي الأوروبي، تحدَّث حسن حنفي عن ظاهرة باسم التشكُّل الكاذب والتجوهر الكاذب الذي تحقَّق في عصر الآباء في الكنيسة.
إنَّ التشكُّل الظاهري أو الكاذب يأتي في قبال التجوهر الكاذب وكذلك البنيَّة الجوهريَّة والحقيقيَّة. إنَّ التشكُّل الجوهري أو الحقيقي يعني أخذ المضمون والمحتوىٰ من ثقافة الآخر، والتجوهر الكاذب يعني أخذ المحتوىٰ من ثقافة ما وإضفاء صورة جديدة عليه. وإنَّ التشكُّل الكاذب أو الظاهري يعني أخذ المحتوىٰ والصورة من ثقافة الغير، والعمل علىٰ تفريغهما من المضمون والمحتوىٰ. وفي عصر الآباء المسيحيِّين، أخذت المسيحيَّة تعلن عن نفسها بالتدريج من خلال صورتين: إحداهما من داخل الثقافة اليونانيَّة التي أوجدت المسيحيَّة اليونانيَّة، والأُخرىٰ من داخل الثقافة الرومانيَّة، والتي أوجدت المسيحيَّة اللاتينيَّة، وكان من الممكن أنْ يكون هذا الأمر قد تحقَّق علىٰ نحوين مختلفين؛ وذلك لاحتمال أنْ تكون المسيحيَّة في المضمون والمحتوىٰ قد استخدمت الثقافة اليونانيَّة والروميَّة بوصفهما تجسيدًا وتعبيرًا لها (التشكُّل
الكاذب)، وفي هذه الحالة، إنَّما يتمُّ الاكتفاء بأخذ مجرَّد شكل وصورة الثقافة اليونانيَّة دون المحتوىٰ. أو بالعكس؛ بأنْ تقوم الثقافة اليونانيَّة، من أجل الحفاظ علىٰ بقائها، بتوظيف المسيحيَّة (التجوهر الكاذب)، وفي هذه الحالة سوف تكتسب المسيحيَّة بدورها شكل أو صورة المحتوىٰ والمضمون الثقافي لليونان والروم أيضًا. وقد ذهب حسن حنفي إلىٰ ترجيح وتقوية الاحتمال الثاني؛ أي «التجوهر الكاذب» أو التضمُّن الكاذب في عصر الآباء المسيحيِّين، ثمّ الخروج التدريجي نحو «التشكُّل الكاذب» في الفلسفة المدرسيَّة (في القرن الثامن إلىٰ القرن الرابع عشر للميلاد).
ذهب حسن حنفي إلىٰ تسمية المرحلة الثانية من الفلسفة المسيحيَّة بعصر الفلسفة المدرسيَّة، حيث تستمرُّ هذه المرحلة من القرن الثامن إلىٰ القرن الرابع عشر للميلاد، وعمل علىٰ رسم تحوُّلات هذه المرحلة ضمن ستّ مراحل علىٰ النحو الآتي:
1. انتقال الثقافة اللاتينيَّة من الجنوب إلىٰ الشمال (في القرن الثامن للميلاد).
2. بداية الفلسفة المدرسيَّة (في القرن التاسع والعاشر للميلاد).
3. تطوُّر الفلسفة المدرسيَّة (في القرن الحادي عشر والثاني عشر للميلاد).
4. نقل الفلسفة الإسلاميَّة إلىٰ اللاتينيَّة (في القرن الثاني عشر للميلاد).
5. اكتمال الفلسفة المدرسيَّة (في القرن الثالث عشر للميلاد).
6. نهايَّة الفلسفة المدرسيَّة (في القرن الرابع عشر للميلاد).
لقد كانت ذروة الفلسفة المسيحيَّة في القرن الثالث عشر للميلاد، بسبب ظهور موضوعين مهمَّين في القرن الثاني عشر للميلاد، أحدهما: ترجمة التراث الإسلامي إلىٰ اللاتينيَّة، والآخر: تأسيس الجامعات بما يتطابق مع الأُسلوب الذي رآه الأوروبيّون أثناء الحروب الصليبيَّة في الجامعات الشرقيَّة. في حين كان منهج المسيحيَّة قبل التراث الإسلامي يقوم علىٰ أساس فصل العقل عن الإيمان والفلسفة، بحيث سلك أُوغسطين المنهج القائل: «أُؤمن كي أعقل»، وفي القرن الحادي عشر للميلاد احتدم النزاع بين الإلهيِّين والجدليِّين، حتَّىٰ اعتبر أبيلار لفظ «الفيلسوف» مرادفًا للمسلم. وقد أحدث دخول التراث الإسلامي هزَّة في الفلسفة المدرسيَّة المسيحيَّة. إنَّ الاتِّجاه العقلي للمتكلِّمين والفلاسفة الإسلاميِّين، أوجد تيّارات عقليَّة مماثلة في اللّاهوت المسيحي، ونتيجة لذلك أصبح العقل أساس الإيمان، وتمَّ الإعلان عن إمكانيَّة الوصول إلىٰ التوحيد العقلي، كما ازداد الاهتمام بالعلم والعلوم الطبيعيَّة أيضًا؛ إذ هناك في النموذج الإسلامي وفاق واتِّحاد قائم بين العقل والطبيعة، في حين أنَّ هذين المفهومين منفصلان عن بعضهما في النموذج المسيحي؛ إذ إنَّ التيّار الطبيعي لا يتمُّ بيانه علىٰ أساس القوانين العامَّة والقابلة للفهم العقلي، بل من خلال «الفضل الإلهي». وفي موضوع خلود النفس، كانت صورة الفلسفة الإسلاميَّة في الفلسفة المدرسيَّة، عن حقٍّ، هي القول بخلود النفس الكلّيَّة. والغالب علىٰ هذه الصورة أنَّها مستمدَّة من ابن رشد أكثر من صدورها من الكندي والفارابي وابن سينا،
في حين قد آثرنا الغزالي والصوفيّة علىٰ ابن رشد، كما آثرنا من قبل الأشعري والأشاعرة علىٰ الاعتزال.
وقد سعىٰ توما الأكويني إلىٰ تحرير أُرسطو من تفاسير المسلمين، والعمل علىٰ التفاسير المسيحيَّة التي كانت في إطار إيجاد التماهي بين أُرسطو والمسيحيَّة، والعمل بذلك علىٰ التأسيس للفلسفة المسيحيَّة. ومن هنا فإنَّه في التعاطي مع الفلسفة اليونانيَّة، قد استفاد، خلافًا لأُسلوب الفلاسفة المسلمين المتمثِّل بـ «التشكُّل الكاذب»، إلىٰ الاستفادة من «التجوهر الكاذب»، بمعنىٰ أنَّه في الوقت الذي كان الفلاسفة الإسلاميِّون يرون الإسلام حقيقة، والفلسفة الأُرسطيَّة لسانًا لها، وكان لهم مجرَّد شبه ظاهري باليونان، عمد توما الأكويني إلىٰ اعتبار الفلسفة الأُرسطيَّة حقيقة، والمسيحيَّة لسانًا لها، وبذلك قام بإيجاد توافق بين هذين الأمرين. لقد عمد توما الأكويني إلىٰ تأسيس اللّاهوت الطبيعي المسيحي في العصور الوسطىٰ، حيث أصبح بإمكان العقل أنْ يُثبِت وجود الله دون حاجة إلىٰ الإيمان، ولكنَّ الإيمان وحده هو القادر علىٰ إدراك سرِّ التثليث.
كانت نهاية الفلسفة المدرسيَّة قد تمثَّلت في تحوُّلات القرن الرابع عشر للميلاد؛ أي في التحوُّل من «الثيولوجيا» إلىٰ «الأنطولوجيا»، ومن «الفلسفة الطبيعيَّة» إلىٰ «العلم التجريبي»، ومن «أولويَّة الإرادة الإلهيَّة» إلىٰ «أولويَّة
(72)الإرادة الإنسانيَّة»، والانتقال إلىٰ التوحيد بين السلطتين الدِّينيَّة (الكنسيَّة) والزمنيَّة (الدولة) إلىٰ التمييز بينهما، وهذا التحوُّل كلُّه يُمثِّل إرهاصات العصور الحديثة. لقد شكَّل الوعي الأوروبي في نهاية القرن الرابع عشر للميلاد نهاية مرحلة وبداية عصر جديد؛ أي نهاية الفلسفة المدرسيَّة وبداية عصر العودة إلىٰ الأدب والعلوم والفنِّ القديم، والاتِّجاه نحو «الإنسان» الذي أدّىٰ في نهاية المطاف إلىٰ عصر الإصلاح الدِّيني وعصر النهضة.
إنَّ أهمَّ عنصر، في عصر الإصلاح الدِّيني وعصر النهضة، يمكنه أنْ يُبيِّن علىٰ نحو الإجمال الحركات والتيّارات الإصلاحيَّة في المسيحيَّة واليهوديَّة، هو الجرأة والشجاعة في مواجهة سلطة الكنيسة، ورفض استحواذها علىٰ السلطة في العقائد واحتكار تفسير الكتاب المقدَّس لنفسها، ونفي الوساطة بين الخالق والإنسان، ونبذ جميع أشكال المرجعيَّة الدِّينيَّة سوىٰ الكتاب المقدَّس، وتجاهل التراث الكنسي وتفسيره وعقائده. ومن هنا كان الإعلان عن استقلال الإنسان عقلًا وإرادةً وفهمًا وسلوكًا ونظرًا وعملًا، وإعطاء الأولويَّة للحظة علىٰ الديمومة، وللباطن علىٰ الظاهر، وللأخلاق علىٰ العقائد، وللتصوُّف علىٰ الشريعة، من أهمّ خصائص تيّار الإصلاح الدِّيني، ومن هنا كان هذا التيّار قد ارتبط بالفلسفة الأفلاطونيَّة والأُوغسطينيَّة والتصوُّف. انتهىٰ عصر الإمبراطوريَّة المسيحيَّة، وبدأت الدعوة إلىٰ تأسيس الدولة المستقلَّة والكنائس القوميَّة. كان عصر
الإصلاح الدِّيني ناظرًا إلىٰ الماضي ليعمل علىٰ إصلاحه، وأمَّا عصر النهضة فكان ناظرًا إلىٰ المستقبل. ومن هنا كان عصر النهضة إعلانًا لنهاية مرحلة المصادر، وبداية مرحلة جديدة في ظهور الوعي الأوروبي. لقد تمكَّنت هذه المرحلة من إيجاد شرخ بين الماضي والحاضر، وكانت سببًا في التحوُّل من الماضي إلىٰ المستقبل، وإعداد الأرضيَّة إلىٰ التحوُّل من سلطة أُرسطو إلىٰ سلطة العقل، والانتقال من سلطة الكتاب المغلق (الكتاب المقدَّس) إلىٰ سلطة كتاب الطبيعة المفتوح، والعبور من المركزيَّة بمحوريَّة الإله إلىٰ المركزيَّة بمحوريَّة الإنسان، والانتقال من البحث عن خلود الروح إلىٰ البحث عن طبيعة الجسد وتكوين الجسم، ونتيجةً لذلك ظهر علم الفسيولوجيا وعلم الأحياء والتشريح والطبّ الجديد وحلَّ محلَّ أُرسطو، وحلَّت الدولة الجديدة محلَّ الكنيسة.
يذهب حسن حنفي إلىٰ القول بأنَّ القرن السابع عشر للميلاد يُمثِّل بداية للوعي الأوروبي في المرحلة المعاصرة بالتزامن مع الكوجيتو الديكارتي. ينطلق من هذه البؤرة الأُولىٰ التي كانت حصيلة الإصلاح الدِّيني وعصر النهضة، تيّاران متباعدان منفرجان، ويزداد التباعد والانفراج بينهما كلَّما تقدَّم الوعي الأوروبي في الزمان وتكوّن له تاريخ حتَّىٰ تنشأ محاولات الجمع بينهما في فلسفة واحدة، كما حدث ذلك في فلسفة التنوير أوَّل مرَّة في القرن الثامن عشر للميلاد. ومن خلال ذكره لبعض الشواهد، اعتبر حنفي أنَّ رينيه ديكارت
إلىٰ فيلسوف الإيمان أقرب منه إلىٰ فيلسوف العقل، وقال في هذا الشأن: تبنّىٰ ديكارت النظريَّة التقليديَّة التي تقوم علىٰ التمييز بين النفس والبدن، ثمّ خلود النفس وفناء البدن. وبذلك وضع ديكارت أساس ثنائيَّة العصر الحديث بين النفس والبدن، الصورة والمادَّة، الجوهر والعرض، وطبع الفلسفة الحديثة كلَّها بهذا الطابع الثنائي الموروث عن الفكر اليوناني القديم. وهي الثنائيَّة التي قسَّمت الوعي الأوروبي إلىٰ تيّارين متباعدين متضادَّين، الأوَّل صاعد من الكوجيتو إلىٰ أعلىٰ، وله أسماء عديدة، من قبيل: المثاليَّة، الذاتيَّة، الرومانسيَّة، العقلانيَّة، الصوريَّة... إلخ. والثاني نازل من الكوجيتو إلىٰ أسفل، وله أيضًا أسماء عديدة: الواقعيَّة، الموضوعيَّة، المادّيَّة، الحسّيَّة، التجريبيَّة... إلخ. وعلىٰ هذا الأساس، يُمثِّل العقل الاتِّجاه الديكارتي الصاعد، وتُمثِّل النزعة التجريبيَّة الاتِّجاه الديكارتي النازل.
إنَّ الاتِّجاه الذي ينتهجه حسن حنفي في تقسيم وتفكيك أنواع المدارس والفلسفات التي تُكوِّن الوعي الأوروبي، يقوم علىٰ فرضيَّة أنَّ التيّارين العقلي والتجريبي هما اللذان يعملان علىٰ تشكيل الوعي الأوروبي، ولذلك نراهما موجودين في جميع الشعوب الأوروبيّة، ومع افتراض هذين التيّارين، فإنَّه يعتبر الوعي القومي لكلِّ شعب عنصرًا آخر في تبلور مختلف المدارس ضمن هذين التيّارين الرئيسين، وهو يُسمّي الكثير من الفلاسفة العقلانيِّين والتجريبيِّين في هذين القرنين.
يُعتَبر إيمانوئيل كانط (1724 ـ 1804م) النموذج البارز للعقلانيَّة في القرن الثامن عشر للميلاد، حيث كان الكوجيتو الخاصّ به، مثل الكوجيتو الخاصّ بديكارت، يعتبر الإنسان نقطة بداية الفلسفة الجديدة. إنَّ النموذج الكانطي [في الفلسفة] هو مثل الثورة الكوبرنيقيَّة [في علم الفلك]؛ حيث اعتبر الإنسان مركز العالم ومنطلق الفكر والوجود، وإنَّ كلَّ موضوع يدور حول ذات الإنسان، وليست ذات الإنسان هي التي تدور حول الموضوع. إنَّ لكانط نسبة إلىٰ كلِّ واحدٍ من الاتِّجاه العقلاني والتجريبي، فجمع بين الحسِّ والعقل، وعمد في الحقيقة إلىٰ بلورة التقسيم الثنائي في العصر الجديد ومنحه شكلًاومضمونًا، بمعنىٰ المادَّة الحسّيَّة غير المتبلورة في صور ذهنيَّة خالية.
إنَّ الفلسفة النقديَّة لكانط أضحت في نهاية المطاف جامعة لكلِّ أخطاء العصر الحديث وبداية لأزمة العلوم الإنسانيَّة، وهي باختصار عبارة عن: صوريَّة المذهب العقليَّة ومادّيَّة المذهب التجريبي ثمّ إلغاء العقل النظري لحساب الأخلاق والدِّين. ولكنَّ أهمّيَّة كانط ترجع إلىٰ أنَّه خلق عالمًا فلسفيًّا جديدًا طبع الفلسفة الأوروبيّة كلَّها بطابعه. لقد كان ديكارت قد وضع المنهج، وأمَّا كانط فقد وضع المذهب.
إنَّ فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر للميلاد تُمثِّل، من وجهة نظره، نقطة التقاء للاتِّجاه العقلاني والتجريبي، ويعمل علىٰ توظيفهما في خدمة النقد
الاجتماعي بهدف تغيير الأوضاع الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة. ومن خلال هذا التراكم التاريخي، حدث تغيير كيفي تمثَّل في اشتعال فتيل الثورة الفرنسيَّة، وأدّىٰ بدوره إلىٰ إحداث هزَّة عنيفة في الوجدان الأوروبي، وأدّىٰ ذلك إلىٰ إعادة بناء فرنسا، وغيرها من البلدان الأوروبيّة، من جديد. يرىٰ حسن حنفي خصائص مشتركة وعامَّة لفلسفة التنوير في أُوروبا كلِّها (من قبيل: اعتبار السلطة المطلقة للعقل واعتباره أساسًا للنقل، وامتلاك الاتِّجاه الحسّي نحو العالم، وبالتالي اعتبار العقل والطبيعة ركنين جديدين للوحي القديم)، ولكنَّه في الوقت نفسه يذهب إلىٰ الاعتقاد بأنَّ فلسفة التنوير تكتسب خصائص محدَّدة بما يتناسب وكلِّ منطقة، ومن هنا نجده يعمل علىٰ تقسيم فلسفة التنوير إلىٰ التنوير الفرنسي، والتنوير الإيطالي، والتنوير الألماني، والتنوير الإنجليزي، والتنوير الأمريكي، والتنوير الروسي.
يُمثِّل القرن التاسع عشر ذروة الوعي الأوروبي. إنَّ نقطة الذروة للتيّار العقلاني كانت بعد كانط من قِبَل الكانطيّون وهيجل، ونقطة الذروة للتيّار التجريبي بعد هيوم قد ظهرت علىٰ يد كانط، ودارون، وستيوارت ميل. وقد بيَّن حسن حنفي أنواع المدارس الفلسفيَّة في هذه المرحلة علىٰ النحو الآتي:
1. الكانطيَّة (الكانطيَّة التقليديَّة وما بعد الكانطيَّة).
2. الرومانسيَّة (الرومانسيَّة الشعريَّة والرومانسيَّة الفلسفيَّة).
3. الهيجليَّة (اليسار الهيجلي والهيجليَّة الجديدة).
4. تطوُّر المثاليَّة (المثاليَّة التقليديَّة والمثاليَّة الصوريَّة والمنطقيَّة والرياضيَّة).
5. الوضعيَّة (المادّيَّة والتطوّريَّة، الحسّيَّة والتجريبيَّة، النفعيَّة والوضعيَّة بالمعنىٰ الخاصِّ).
6. الليبراليَّة والاشتراكيَّة (الليبراليَّة والفوضويَّة والبرجوازيَّة الوطنيَّة، الاشتراكيَّة الطوباويَّة، الاشتراكيَّة المادّيَّة).
لقد قدَّم حسن حنفي توضيحات مستفيضة بشأن كلِّ واحدة من هذه المدارس، وفيما يلي نشير إلىٰ بعض شذراته التحليليَّة نسبيًّا:
إنَّ فلسفة كانط بسبب تشعُّبها في الحقل الحسّي والذهني والعقلي أو المراحل الثلاث: الحسّيَّة والتحليليَّة والجدليَّة، قد فقدت انسجامها، ومن هنا سعىٰ ما بعد الكانطيّون إلىٰ تجاوز الثنائيَّة الكامنة (بين الظاهر والشيء)، فذهب فيشته إلىٰ «الأنا المطلق»، وهيجل إلىٰ «التصوُّر المطلق أو الفكرة»، وشيلنج إلىٰ «الهويَّة»، وشوبنهاور إلىٰ «الإرادة»، وأعطىٰ هؤلاء الأولويَّة للعقل العملي علىٰ العقل النظري. لقد عمد هؤلاء الفلاسفة الكانطيّون جميعهم، في مواجهة العقلانيَّة النظريَّة للفلسفة الحديثة التي بدأت من ديكارت، إلىٰ رفع العقل شعارًا لهم، ولكنَّ هذا العقل كان يحمل معاني مختلفة عن العقل الديكارتي والكانطي.
إنَّ هيجل الذي له التأثير الأكبر في مسار الفلسفة الجديدة في أُوروبا، يُعتَبر مكمِّلًا للفلسفة الحديثة وإيجاد الحلول لمشكلاتها أو إلغائها، وعلىٰ رأسها
هذه الثنائيّات المتعارضة بين النفس والبدن، الظاهر والشيء في ذاته، النظر والعمل، المعرفة والأخلاق، الصورة والمادَّة، الروح والطبيعة، أو ما يقول هوسِرْل: الثنائيَّة بين العقلانيَّة والتجريبيَّة. يعمد حسن حنفي من خلال كلام لهوسِرْل إلىٰ العمل علىٰ تقييم هيجل قائلًا: إنَّه علىٰ الرغم من قيامه بمثاليَّته المطلقة بمعارضة كلِّ اتِّجاه تجزيئي للوعي الأوروبي (مثل العقلانيَّة والتجريبيَّة وما إليها)، إلَّا أنَّه لم يتخلَّص من رواسب الاتِّجاه التجريبي، بل إنَّه لم يتمكَّن من تحويل الفلسفة إلىٰ علم محكم ومتين، وقد ظلَّ هيجل في فضاء أُسطوري وشعري من الديالكتيك والجدل الغامض الذي يختلط فيه كلُّ شيء بكلِّ شيء.
كما كانت الرومانسيَّة بدورها ردَّة فعل علىٰ كانط، وبذلك كانت الرومانسيَّة دفعة جديدة في الوعي الأوروبي تُفجِّر ذاتيَّته وتُوحِّده بالطبيعة، وتُطهِّره من بقايا الموروث، وتساعده علىٰ الثورة علىٰ ما تبقّىٰ من القديم. ولكنَّها في الوقت نفسه تُمثِّل جذور العدميَّة فيه بما تتضمَّنه من ظلام وليل واشتباه وتشاؤم وانتحار وحلم وخيال، لا فرق فيها بين الواقع والوهم وبين الحقيقة والخيال. وهو ما تجلّىٰ بعد ذلك بوضوح عند نيتشه والوعي الأوروبي في طريقه إلىٰ النهاية. وقد تحوَّل الكثير من الفلاسفة الرومانسيِّين إلىٰ التصوُّف، فكان ذلك إيذانًا بانقلاب الوعي الأوروبي علىٰ عقبيه والانتقال من البداية نحو النهاية.
إنَّ اليمين الهيجلي لم يسمع عنه أحد كثيرًا، ولم يُؤثِّر في تاريخ الفلسفة، ولم يترك علامات بارزة في مسار الوعي الأوروبي. كانت أهمّيَّته في معارضته لليسار الهيجلي، ويُسمّىٰ أنصاره الهيجليّون الشيوخ في مقابل اليسار الهيجلي أو الهيجليِّين الشُّبّان. وكان اليسار الهيجلي أقرب إلىٰ نقد الهيجليَّة منهم إلىٰ تطويرها، وبالتالي كانوا أقرب إلىٰ الفلسفة المعاصرة منهم إلىٰ الفلسفة الحديثة، يُعبِّرون عن الفترة الثانية من الوعي الأوروبي الـ «أنا موجود» في مقابل الـ «أنا أُفكِّر». لذلك كانوا أحد مصادر الوجوديَّة (كيركيغارد) ، والفوضويَّة (شتيرنر) ، والإنسانيَّة (فيورباخ) ، وفلسفة اللغة والأساطير والأنثروبولوجيا المعاصرة (شتراوس، باور)، والماركسيَّة. وكان الهيجليُّون الجُدُد اتِّجاهًا آخر ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأوَّل من القرن العشرين، كردِّ فعل علىٰ الوضعيَّة والمادّيَّة، ودفاعًا عن الدِّين والفلسفة التأمّليَّة، في اسكتلندا وإنجلترا ثمّ امتدَّ إلىٰ أمريكا. إنَّ الهيجليَّة الجديدة تُمثِّل البُعد الغائب في فلسفة هيجل، ونعني به الفرديَّة. وانتهىٰ كثير من الهيجليِّين الجُدُد إلىٰ التجربة الدِّينيَّة أو الصوفيّة، وكان هذا يُمثِّل علامة لنهاية عصر التنوير.
واصلت المثاليَّة بقاءها بوصفها البُعد العقلاني من الوعي الأوروبي الذي يعود بجذوره إلىٰ ديكارت، وسبينوزا، ولايبنتس، وكانط والكانطيّون. وقد تطوَّرت المثاليَّة التقليديَّة عند ديكارت والديكارتيِّين بعيدًا عن هيجل
والهيجليِّين اليساريِّين والهيجليَّة الجديدة. ومن ثنايا المثاليَّة التقليديَّة خرجت مثاليَّة أُخرىٰ صوريَّة رياضيَّة منطقيَّة تتجاوز المذاهب الفلسفيّة وأمزجة الفلاسفة وأهواءهم إلىٰ تأسيس العلوم الصوريَّة الخالصة في الفلسفة؛ أي: الرياضيّات والمنطق. وقد أعطىٰ هؤلاء الأولويَّة إلىٰ العقل النظري في قُبال العملي، وأبدعوا واحدًا من فروع المنطق، ألَا وهو المنطق الرياضي.
لقد وضع حسن حنفي الوضعيَّة في القرن التاسع عشر، وفي مرحلة ذروة الوعي الأوروبي، اسمًا عامًّا يشمل جميع التيّارات المادّيَّة والتطوريَّة والحسّيَّة والتجريبيَّة والنفعيَّة والوضعيَّة بمعناها الكانطي الخاصّ. وعلىٰ مدىٰ القرن التاسع عشر من أُوجست كونت حتَّىٰ النصف الأوَّل من القرن العشرين، كانت هذه التيّارات المادّيَّة، بوصفها الوارث للنزعة التجريبيَّة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ما تزال باقية. وفي الحقيقة، فإنَّ حنفي يذكر ستَّة تيّارات، ولكنَّه بسبب اشتراكها في الخطوط والخصائص، وكذلك من أجل الحفاظ علىٰ الإطار العامِّ، يعمل علىٰ دمجها في ثلاثة تيّارات.
وقد شهد القرن التاسع عشر ظهور تيّار آخر في حقل الفكر السياسي الذي تجلّىٰ علىٰ الصيغة الليبراليَّة والاشتراكيَّة. وقد تنازعت هذه التيّارات السياسيَّة مع المذاهب الفلسفيّة التي سادت القرن التاسع عشر. وقد بحث حسن حنفي هذا التيّار السياسي ضمن الاتِّجاهين العامَّين، وهما: الليبراليَّة والاشتراكيَّة.
د) نهاية الوعي الأوروبي (في القرن العشرين للميلاد)
كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ حسن حنفي يرىٰ بداية الوعي الأوروبي في تيّارين أساسيَّين، وهما: العقلانيَّة والتجريبيَّة، وذلك ابتداءً من ديكارت، حيث أخذ
هذان التيّاران بالابتعاد عن بعضهما في اتِّجاهين مختلفين. وقد بلغت العقلانيَّة أو الواقعيَّة ذروتها مع هيجل وشيلنج، إلَّا أنَّ النزعة التجريبيَّة أو الواقعيَّة أو المادّيَّة، قد انتهت في ذروتها إلىٰ أُوجست كونت وستيوارت ميل. وأمَّا نقطة التقاء هذين التيّارين، فقد كانت في القرن التاسع عشر، حيث بلغت بالوعي الأوروبي في نهاية المطاف من نقطة انطلاقه المتمثِّلة بـ «أنا أُفكِّر» إلىٰ نقطة التلاقي والانضمام ونهايتها في «أنا موجود» أو الفلسفة الوجوديَّة.
يذهب حسن حنفي إلىٰ صعوبة تصنيف فلاسفة القرن العشرين ضمن اتِّجاهات متمايزة؛ نظرًا لاشتراكهم جميعًا إمَّا في نقد المثاليَّة (العقلانيَّة) وإمّا في نقد التجريبيَّة أو نقدهما معًا من أجل الجمع بينهما مباشرةً. ومع ذلك، فإنَّه يعمل علىٰ التمييز بين سبعة تيّارات رئيسة، وهي: نقد المثاليَّة، ونقد التجريبيَّة، ومحاولة الجمع بين المثاليَّة والواقعيَّة، والظاهريّات، والشخصانيَّة والتوماويَّة
الجديدة، ومدرسة فرانكفورت، والفلسفة التحليليَّة. ومن خلال توجيه النقد إلىٰ المثاليَّة أو العقلانيَّة من قِبَل البراغماتيَّة، اتَّحدت الوضعيَّة المنطقيَّة والواقعيَّة الجديدة، ومن خلال نقد النزعة التجريبيَّة، يبلغ الوعي الأوروبي اتِّحاده في المرحلة الأخيرة من تكوينه.
ومن خلال نقد التيّارين الأساسيَّين المثاليَّة والواقعيَّة في القرن العشرين بجميع مظاهرهما وأسمائهما، بدأ السعي إلىٰ الجمع بينهما في الوعي الأوروبي، وظهرت الكثير من الفلسفات في إطار هذه الغاية. وقد ذكر حسن حنفي الكثير من فلاسفة القرن العشرين في أُوروبا من الذين اختاروا طريقًا ثالثًا من بين الاتِّجاهين التجريبي الواقعي والعقلي المثالي، كي يُقصِروا المسافة بينهما وتحويل الوعي الأوروبي إلىٰ تيّار واحد. ومن هنا سواء قبل الظاهراتيَّة عند دلتاي وبرنتانو، أو في ظاهرتيَّة إدموند هوسِرْل وشيللر أو بعد الظاهراتيَّة في وجوديَّة غابرييل مارسيل وياسبرس ومارتن هايدغر وجان بول سارتر تمَّ تتبُّع هذا الطريق الثالث، وتحوَّل في حدِّ ذاته إلىٰ خصِّيصة عامَّة لمجمل الفلسفة المعاصرة.
وكان دلتاي أوَّل مَنْ حاول شقَّ هذا الطريق الثالث ابتداءً من «فلسفة الحياة»، فهو لا يرىٰ الحياة مجرَّد واحدة من موضوعات الفلسفة، وإنَّما هي الموضوع الوحيد فيها، حيث تشتمل علىٰ جميع الآمال والأفكار والقوانين
والأدب والفنِّ والتجارب الحيويَّة للإنسان، وفي الواقع فإنَّ جميع العلوم الإنسانيَّة تُمثِّل تعبيرًا عن روح عصرها ومرحلة محدَّدة من التاريخ. لقد عمل هذا الطريق في مراحل تحوُّله علىٰ بلورة مختلف أنواع الفلسفات، من قبيل: «فلسفة الشعور القصدي» لدىٰ برنتانو والفلسفة الطبيعيَّة الحيَّة عند وايتهيد، وكذلك فلسفة الدِّين والفلسفة الاجتماعيَّة، حتَّىٰ انتهىٰ في نهاية المطاف عند الظاهريّات لهوسِرْل.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ الظاهريّات عند هوسِرْل هي تقريبًا خاتمة المطاف في تكوين الوعي الأوروبي؛ لأنَّ الفلسفة الوجوديَّة هي تطبيق للمنهج الظاهريّاتي في الوجود؛ لأنَّ الشخصانيَّة حلقة اتِّصال بين الظاهريّات والشخصانيَّة لدىٰ الفلاسفة الفرنسيِّين والأمريكيِّين. كما كانت التوماويَّة الجديدة والأُوغسطينيَّة الجديدة تجمع بين فلسفة الحياة والظاهريّات والشخصانيَّة والتوماويَّة الجديدة. وهكذا مدرسة فرانكفورت والتفكير الاجتماعي كانا نموذجين للظاهريّات الاجتماعيَّة، وقد انبثقت الفلسفة التحليليَّة من صلب الظاهريّات أيضًا. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ ظاهريَّة هوسِرْل تُعَدُّ نهايَّة للوعي الأوروبي، وإنَّ جميع الفلسفات التي ظهرت لاحقًا إنَّما عملت علىٰ مجرَّد تطبيقها في الأخلاق والدِّين والسياسة والمنطق واللغة وما إلىٰ ذلك. ومن هنا يعمد حسن حنفي إلىٰ تناول الظاهرياتيَّة بالبحث والنقاش بشكل مسهب.
(84)إنَّ الشعور والوعي من وجهة نظر هوسِرْل عبارة عن وحدة ذات العالِم وموضوع المعرفة، حيث ينتهي في نتيجة التعارض بين الذات والموضوع والصراع التاريخي بين المثاليَّة (التي تُعطي الأولويَّة للذات علىٰ حساب الموضوع) وبين الواقعيَّة (التي تُعطي الأولويَّة للموضوع علىٰ حساب الذات). كان هوسِرْل يرىٰ أنَّ الذات والموضوع واجهتان لشيء واحد وهو الشعور، والشعور بدوره هو ذات عارفة كما هو موضوع للمعرفة أيضًا. وتهدف الظاهرياتيَّة إلىٰ تحليل هذا الشعور الذي هو عبارة عن تحليل الوجود كما هو تحليل المعرفة. يقول حسن حنفي: إنَّ الظاهراتيَّة عند هوسِرْل وهذه الوحدة بين الذات والموضوع، وبين المعرفة والوجود، وبين الصورة والمادَّة، وبين المثالي والواقعي، هي التي جعلت الظاهريّات في النهاية أقرب إلىٰ وحدة الوجود الصوفيّة، وبذلك ينتهي هوسِرْل إلىٰ مشروع غوتفريد لايبنتس لإقامة رياضيّات شاملة أو أنطولوجيا عامَّة، يتمُّ فيها التوحيد بين الممكن والواقع أو بين العقل والوجود.
وبذلك يرىٰ حسن حنفي أنَّ الخطَّين المتباعدين عن بعضهما (التجريبيَّة والعقلانيَّة) يلتقيان بوساطة الظاهراتيَّة عند هوسِرْل، ويتَّحدان في بؤرة واحدة هي «الشعور» بمعنىٰ «القصديَّة» (الشعور الفعّال الذي يصنع موضوعه في الإدراك). وقد ذهب إلىٰ الاعتقاد بأنَّ الظاهريّات قد استطاعت أنْ تكشف أزمة الوعي الأوروبي في تصوُّره للعالم، والتي انعكست علىٰ رؤيته للعلوم الإنسانيّة؛ وذلك لأنَّ الوعي الأوروبي في القرن التاسع عشر رغم اعتباره
الإنسان بؤرة الكون، إلَّا أنَّ أساليب العلوم الطبيعيَّة فرضت نفسها علىٰ العلوم الإنسانيَّة، وبذلك كان القرن العشرون بداية أزمة العلوم الإنسانيَّة، بل وبداية أزمة الضمير الأوروبي نفسه. وعمد فلاسفة من أمثال هوسِرْل وبرجسون ومونييه وآخرين إلىٰ التأكيد علىٰ اختلاف الظواهر الإنسانيَّة عن الطبيعيَّة. ومن ناحية أُخرىٰ رأىٰ البعض أنَّ المنهج الرياضي هو النموذج الأفضل في الوصول إلىٰ اليقين والخروج من الأزمة في العلوم الإنسانيَّة. ومن هنا بدأ السعي نحو بلورة الرياضيّات العامَّة والشاملة، كما كان لايبنتس قد صنع ذلك من قبل. ومع ذلك لم تنته المشكلة؛ وذلك لأنَّ الظاهرة الإنسانيَّة ليست صوريَّة محضة مثل الرياضيّات، وإنَّما هي ظاهرة حيَّة لا يمكن دراستها بمنهج موضوعي فارغ من كلِّ مضمون، كما هو الحال في المنهج الصوري الرياضي. ومن هنا كانت الظاهريّات دعوة للحياة، والتي تبلورت كردَّة فعل تجاه أخطاء العلوم الإنسانيَّة القائمة علىٰ العلوم الطبيعيَّة أو الرياضيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، كانت الظاهرياتيَّة من وجهة نظر حسن حنفي إعلانًا عن نهاية الوعي الأوروبي، وإنَّ جميع الفلسفات التي جاءت بعد ذلك، كانت من قبيل التطبيق أو الشرح والتحليل الموازي لها. وكانت الفلسفة الوجوديَّة من بين أشهر هذه الفلسفات.
1. إنَّ حسن حنفي، فيما يتعلَّق ببيان مصادر الوعي الأوروبي، قدَّم صورة جامعة، وكان في عمله هذا أفضل منه بالمقارنة إلىٰ ما كان منه في الأقسام
الأُخرىٰ من الاستغراب، ولكنَّه في الوقت نفسه يشتمل علىٰ نقاط تثير الكثير من النقد، وفيما يلي نشير إلىٰ أهمّها علىٰ النحو الآتي:
أ) إنَّه يُعرِّف التراث الفكري اليوناني الرومي بوصفه عقلانيًّا يحتوي علىٰ لغة منفتحة، وقابلة للحوار والعقلانيَّة، وإنَّها تضمن البُعد العلماني للوعي الأوروبي، وفي المقابل يصف التراث اليهودي المسيحي في الحضارة الغربيَّة بأنَّه فاقد للعقلانيَّة، ومغلق، وغير قابل للحوار، ومتطرِّف، ومتمحور حول الله. ويبدو أنَّ حنفي في كلا هذين الادِّعاءين قد اتَّجه نحو الإفراط، إذ لا يمكن وصف كلِّ الحضارة والتفكير الرومي اليوناني بالعقلانيَّة، وتنزيه ساحتها من جميع أنواع الخرافة، كما لا يمكن تقييم جميع التعاليم اليهوديَّة والمسيحيَّة في هذه الحضارة بأنَّها مغلقة، وغير عقلانيَّة، وغير قابلة للفهم. والعجيب أنَّه يعتبر محوريَّة الله في لغة هذا التراث هي السبب في عدم معقوليَّتها، حيث إنَّ حسن حنفي يرىٰ التراث الإسلامي بسبب محوريَّة الله غير عقلانيّ ولا إنسانيّ كما سيأتي في الأبحاث المقبلة. والحقيقة هي أنَّ الحضارة اليونانيَّة حتَّىٰ في حقل الفلسفة، الأعمّ من النظريَّة والعمليَّة، مشحونة بالمطالب اللّاعقلانيَّة والخرافيَّة، رغم سعي كبار الفلاسفة من أمثال سقراط وأفلاطون وأُرسطو إلىٰ بذل جهود حثيثة من أجل تقديم فلسفة معقولة. كيف يمكن اعتبار أفكار السفسطائيِّين عقلانيَّة، حيث يقول غورجياس: لا يوجد شيء حقيقي، وإذا وُجِدَ فالإنسان قاصر عن إدراكه، وإذا افترض وصول أحد الأفراد إليه، فإنَّه سيعجز عن نقله إلىٰ غيره من الناس. إنَّ المصادر الخاصَّة بتاريخ الحضارة
الغربيَّة زاخرة بالحديث عن انتشار الخرافات في اليونان وروما.
يضاف إلىٰ ذلك أنَّ الحضارات اليونانيَّة والروميَّة زاخرة بالأفكار حول الله أو الآلهة، ويمكن مشاهدة هذه الحقيقة، سواء في حقل الثقافة العامَّة التي تشتمل علىٰ التعبُّد بتعدُّد الآلهة والطقوس والمناسك العباديَّة، أو في التفكير الفلسفي لدىٰ أمثال أفلاطون الذي يُعبِّر عن الله بأنَّه «الخير الأسمىٰ»، أو أُرسطو الذي يصف الله بصفات، من قبيل: «المحرِّك بدون حركة» و«المحرِّك الأوَّل» أو «الفعليَّة المحضة» وما إلىٰ ذلك. فهل شكَّل ذلك سببًا إلىٰ اعتبار عدم عقلانيَّة الفلسفة والحضارة اليونانيَّة؟! وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ مجموع التراث والحضارة اليونانيَّة ليس علمانيًّا. ومن ناحية أُخرىٰ، فإنَّ اللغة والحضارة الغربيَّة في العصور الوسطىٰ، لم تكن بعيدة وأجنبيَّة عن الحضارة اليونانيَّة، فإنَّها علىٰ الرغم من اشتمالها علىٰ تعاليم غير عقلانيَّة، من قبيل: الأقانيم الثلاثة، والتجسيم، والتضحية، والفداء، إلَّا أنَّها في بيان وتفسير عقائدها عملت علىٰ توظيف أفكار أُرسطو وأفلاطون كثيرًا؛ ومن هنا إذا كان تراث العصور الوسطىٰ غير عقلاني من هذه الناحية، فإنَّه يجب أنْ يكون منبثقًا من التراث اليوناني.
ب) يرىٰ حسن حنفي أنَّ الروح المهيمنة علىٰ الوعي الأوروبي في العصور الوسطىٰ تتمثَّل في الفلسفة الطبيعيَّة، والتي تحوَّلت بالتزامن مع بدايَّة الوعي
الأوروبي الجديد إلىٰ فلسفة الروح، لتنتهي في نهاية المطاف إلىٰ فلسفة الوجود. ولذلك كانت مراحل الوعي الأوروبي من وجهة نظره عبارة عن:
أ) الفلسفة الطبيعيَّة في المصادر.
ب) فلسفة الروح في بداية العصر الجديد.
ج) فلسفة الوجود في نهاية الوعي الأوروبي.
إنَّ هذا التصنيف من حنفي لا هو جامع ولا هو مانع، فما هي الأُسُس التي استند إليها في تقديم هذا التقسيم؟
في أهمّ التيّارات الفلسفيَّة والعرفانيَّة في العصور الوسطىٰ حيث تتغذّىٰ علىٰ الفلسفتين الأفلاطونيَّة والأُرسطيَّة، لا وجود لدلائل علىٰ مثل هذا الاستنتاج القائل باشتمال فلسفة العصور الوسطىٰ علىٰ فلسفة طبيعيَّة، في حين أنَّ من بين خصائص الفلسفة في العصور الوسطىٰ في الفلسفة الأُوغسطينيَّة والأكوينيَّة تُحوِّلها إلىٰ كلام، ولا يمكن لذلك أنْ يكون فلسفة طبيعيَّة، وعلىٰ الرغم من أنَّ المدارس المخالفة للعقلانيَّة مثل الفلسفة الاسمانيَّة لوليام الأوكامي، ولكنَّها لم تُغيِّر روح الفلسفة القروسطيَّة. كما لا يمكن لمفهوم فلسفة الروح وفلسفة الوجود أن يكون ترجمانًا لكلِّ الوعي الأوروبي في بداية العصر الجديد أو نهايته.
ج) كما يذهب حسن حنفي خطأً إلىٰ اعتبار فلسفة ألبيرت الكبير وتوما
والفلسفة الأُرسطيَّة لسانًا وصورةً لها)، إلىٰ «التجوهر الكاذب» الذي تكون فيه فلسفة أُرسطو حقيقة، أمَّا المسيحيَّة فهي لسانها وصورتها. لقد وضع توما الأكويني الفلسفة ديباجة لخدمة اللّاهوت.
إنَّ المسيحيِّين لا يرتضون القول بأنَّ الفلسفة المسيحيَّة في العصور الوسطىٰ مجرَّد تغيير لصورة الفلسفة الأُرسطيَّة واليونانيَّة، وأنَّها كانت، علىٰ حدِّ تعبير حسن حنفي، مجرَّد تصوير كاذب، فإنَّهم، وإنْ كانوا متأثِّرين بتراث ابن سينا وابن رشد، ولكنَّهم أضافوا عناصر جديدة إلىٰ الفلسفة اليونانيَّة. إنَّهم كانوا يسعون إلىٰ بيان الحقائق الإيمانيَّة في المسيحيَّة، من قبيل: الله، والنفس، وارتباط الإنسان بالخالق، من خلال الفلسفة بيانًا عقليًّا، وكان من شأن ذلك أنْ يُؤدّي من تلقائه إلىٰ اتِّساع وتغيُّر حقل الفلسفة بسبب تبلور الموضوعات الدِّينيَّة الجديدة. عمد توما الأكويني بدوره إلىٰ بسط الفلسفة الأُرسطيَّة عبر البيان الفلسفي للعقائد الدِّينيَّة. وقد ذهب إتيان جيلسون، وهو أكبر متخصِّص في فلسفة العصور الوسطىٰ في العصر الراهن، فيما يتعلَّق بصلة المسيحيَّة بالفلسفة اليونانيَّة، إلىٰ القول: إنَّ المسيحيَّة، بوصفها دينًا، لم تكن بحاجة إلىٰ الفلسفة، وإنَّ بعض آباء الكنيسة الأوائل والمفكِّرين المسيحيِّين الذين جاؤوا بعدهم من الذين أقبلوا علىٰ الفلسفة، لم يكونوا يرومون استبدال دينهم بالفلسفة، وإنَّما أرادوا أنْ يتَّخذوا من الفلسفة وسيلة للدفاع عن الدِّين. وهو يرىٰ أنَّ هناك نوعًا من التفكير، بل وحتَّىٰ الفلسفة المسيحيَّة يمكن الادِّعاء أنَّها كانت
في روحها السائدة تختلف عن التراث اليوناني.
د) إنَّ حسن حنفي علىٰ الرغم من حديثه المسهب عن نهاية العصور الوسطىٰ وخصائص عصر الإصلاح وعصر النهضة، ولكنَّه لم يُقدِّم ما يشفي الغليل حول العناصر الاجتماعيَّة والسياسيَّة والمعرفيَّة التي أدَّت إلىٰ هذا الانحطاط، وإنَّما هو يكتفي بالإشارة إلىٰ أحداث وظهور التيّارات الجديدة، في حين أنَّ بيان الانحطاط الحضاري للغرب في نهاية العصور الوسطىٰ، يجعل تحليلنا بشأن التداعيات، وحتَّىٰ الخصائص التي تُميِّز المرحلة الجديدة، أكثر دقَّةً.
2. إنَّ حديث حسن حنفي حول بداية الوعي الأوروبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد، يواجه انتقادات أُخرىٰ:
أ) إنَّ الشواهد التي يذكرها حنفي علىٰ اعتبار رينيه ديكارت بوصفه فيلسوف الإيمان (وليس فيلسوف العقل) قابلة للنقاش؛ لأنَّ شواهد من قبيل: انطلاق ديكارت من البديهيّات والمسلَّمات الرياضيَّة لا تعني أنَّه قد انطلق من الإيمان، كي يكون هناك وجه شبه بينه وبين فلاسفة اللّاهوت في العصور الوسطىٰ. كما أنَّ اعتباره أنَّ الله ضامن لصدق اليقين في فلسفة ديكارت، لا يعني جعل النقل أساسًا ورافعةً للعقل، كي يُدَّعىٰ أنَّ ديكارت هو فيلسوف الإيمان. إنَّ حكم حسن حنفي في هذا الشأن يقوم علىٰ الفرضيَّة القائلة بأنَّ فيلسوف العقل هو الذي ينكر الحقائق الميتافيزيقيَّة، ويرفض الاعتقاد بالوحي الإلهي وأسرار العالم. وليس لهذا الحكم أيّ دليل معرفي وتاريخي يُؤيِّده سوىٰ المبنىٰ الإلحادي، وبطبيعة الحال فإنَّ هذا المعنىٰ، وإنْ
كان يصدق علىٰ الفلاسفة المادّيِّين، ولكنَّه لا يمكن أنْ يكون صادقًا علىٰ جميع الفلاسفة الأوروبيين في القرن السابع عشر والثامن عشر للميلاد. ومن هنا فإنَّ كابلستون يرىٰ عقلانيَّة هؤلاء الفلاسفة في سعيهم من أجل تقديم نظام برهاني واستنتاجي للحقائق يشبه النظام الرياضي الذي يبدأ من التعاريف والأُصول الموضوعة، وبعد إثبات القضايا بشكل منظَّم، يتوصَّلون إلىٰ تقديم مجموعة من القضايا التي يدَّعون صدقها بشكل يقيني. يضاف إلىٰ ذلك، أنَّ بعض المحقِّقين المعاصرين في الغرب لا يُنكِر انتماء ديكارت إلىٰ القرون الوسطىٰ فحسب، ولا حتَّىٰ تأثيره في الانتقال من العصور الوسطىٰ إلىٰ العالم الجديد، بل يرىٰ تأثيره في خطوة متقدِّمة ترتبط بالانتقال من عصر النهضة إلىٰ العصر الجديد. وبعبارة أُخرىٰ: إنَّ دور رينيه ديكارت لم يكمن في الانتقال من العصور الوسطىٰ إلىٰ العصر الجديد؛ وذلك لأنَّ العصور الوسطىٰ كانت في ذلك الحين قد أعلنت عن نهايتها مسبقًا، وأمَّا ديكارت فقد استطاع أن يلعب دورًا في الخروج من تشكيكيَّة مونتيني والدخول في مرحلة جديدة من الفلسفة. كما أنَّ التفكيكيَّة الموجودة في نظريَّة ديكارت بين النفس والجسد، لا يمكنها لوحدها أنْ تكون منشأ لظهور التيّارين العقلاني والتجريبي، فقد كان هذا التفكيك والفصل موجودًا حتَّىٰ في المرحلة السابقة لديكارت أيضًا؛ وعليه يجب اعتباره منشأ لهذين التيّارين حتَّىٰ قبل ديكارت! يصرُّ حنفي علىٰ التعريف بالتجريبيَّة بوصفها تيّارًا تجريبيًّا لديكارت، في حين لا وجود لمثل
هذه النسبة والتناسب؛ لأنَّ ديكارت القائل بالتمايز التامِّ بين الجسم والروح في بيانه الهندسي والميكانيكي عن حركة الجسم والأجسام، لا يُقدِّم علَّة طبيعيَّة لإيجاد الحركة، وإنَّما لديه كلام حول الانتقال الطبيعي للحركة، إلَّا أنَّه لا يسند إيجاد الحركة إلىٰ علَّة؛ لأنَّ عالم الأجسام، من وجهة نظره، ليس شيئًا غير الامتداد، وإنَّ الحركة لا تُخلَق من الامتداد، ومن هنا فإنَّه بحاجة إلىٰ إسناد الحركة إلىٰ الله، وبحسب التعبير الكنائي لباسكال: إنَّه لا يحتاج إلىٰ الله أبدًا إلَّا بوصفه قدحة لتحريك العالم. وإذا أمكن لنا أنْ ننسب التجريبيَّة بوصفها اتِّجاهًا نازلًا لديكارت، واعتبرنا العقلانيَّة في المقابل نقطته الصاعدة، كيف يمكن لذلك عندها أنْ ينسجم مع ادّعاء حنفي القائل بأنَّ عالم ديكارت عالم رياضي وصوري، وليس الخارج الذي يعيش فيه الإنسان؟.
ب) يرىٰ حنفي أنَّ الفصل والتفكيك بين النفس والبدن، وكذلك خلود النفس وفناء الجسد، يعود إلىٰ التفكير اليوناني، وأنَّ التفكير الدِّيني مجرَّد مقلِّد للتفكير اليوناني في هذا الشأن، في حين أنَّ مسألة الروح وخلودها بعد الموت ومفارقة الجسد، واحدة من الأُصول الأساسيَّة في الأديان التوحيديَّة، ولا سيّما في الإسلام. وعليه، فإنَّ التعاليم الدِّينيَّة في هذا الشأن لم تكن تقليدًا للتفكير اليوناني، بل تستند إلىٰ الوحي وتعاليم الأنبياء.
3. يرىٰ حسن حنفي أنَّ القرن العشرين يُمثِّل نقطة التقاء التيّارين العقلاني والتجريبي، وأنَّه في الحقيقة يُمثِّل السير النزولي لهذين التيّارين ونهاية الوعي الأوروبي، ورأىٰ أنَّ الشاهد علىٰ ذلك يتمثَّل في أُمور، من قبيل: نقد
هذين التيّارين، وظهور فلسفات الحياة التي جمعت بين المثاليَّة والواقعيَّة. وهذا الكلام قابل للنقاش من عدَّة جهات:
أ) لا يمكن اعتبار جميع الفلاسفة، الذين تحدَّثوا عن العقل بشكل من الأشكال وأكَّدوا علىٰ التفكير العقلي، من الفلاسفة العقلانيِّين بمعنىٰ واحد، ولذلك فإنَّ ظهور وأُفول كلِّ فيلسوف أو مذهب عقلي لا يعني بالضرورة ظهورًا وأُفولًا لمطلق التيّار العقلاني، وبالتالي فإنَّ نقد مدرسة عقليَّة بما يتناسب مع الشرائط التاريخيَّة، سيكون له معنىٰ خاصّ. إنَّ من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها حسن حنفي اعتباره الفلاسفة العقلانيِّين منتمين لتيّار عقلاني واحد، وقد كرَّر هذا الخلط في الحقل التجريبي أيضًا. وعلىٰ هذا فإنَّنا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين لا نواجه تيّارًا عقلانيًّا واحدًا وآخر تجريبيًّا واحدًا حتَّىٰ يكون لنا كلام حول نقطة ذروته أو سقوطه، بل كان هناك وجود لتيّارات مختلفة من العقلانيَّة والتجريبيَّة، وكان لكلِّ واحد منها منشؤه وخصائصه الفلسفيَّة الخاصَّة.
ب) من خلال نقد العقلانيَّة من قِبَل البراغماتيَّة، والوضعيَّة المنطقيَّة والمثاليَّة الحديثة، وكذلك من خلال نقد التجريبيَّة في علم النفس الجشتالتي وعلم الاجتماع الصوري والديالكتيكي والكانطيّون الجُدُد، لا يمكن لنا أنْ نستنتج تقليص المسافة بين العقلانيَّة والتجريبيَّة؛ لأنَّ جميع هذه التيّارات الفلسفيَّة تنبثق من صلب العقلانيَّة والتجريبيَّة، وإنَّها تشتمل في كلِّ مرحلة علىٰ منعطفات وصعود وأُفول، ولذلك من
(95)المتعذِّر أنْ نرىٰ تحقُّق وحدة بينها. في بداية القرن العشرين كانت هناك مدارس مختلفة من التجريبيَّة والمثاليَّة وفلسفات الحياة، والظاهراتيَّة، والواقعيَّة الجديدة. إنَّ التجريبيَّة والمادّيَّة في الفلسفة تواصل حضورها عبر مدارسها في هذا القرن أيضًا، ولا سيّما في علم النفس وفي سلوكيَّة واطسون، والتشريح النفسي لسيغموند فرويد، وعلم الاجتماع التجريبي لدىٰ دوركهايم. ويبدو بشكلٍ عامٍّ أنَّ التيّارات الأصليَّة للفلسفة المعاصرة للغرب ضمن استمرار التيّارين اللذين يُمثِّلان روح القرن الثامن عشر (التجريبيَّة والمثاليَّة)، قد أفرزت فلسفات جديدة، من قبيل: فلسفة الحياة، والفلسفة الظاهراتيَّة، والفلسفة الوجوديَّة، والتيّارات الحديثة في الميتافيزيقا الوجوديَّة. وعلىٰ هذا نشاهد تنوُّعًا وانفصالًا وتعدُّدًا في الوعي الأوروبي كما في السابق أيضًا.
ج) لقد تحدَّث حسن حنفي عن نيتشه الذي جمع بين المثاليَّة والواقعيَّة. فهذا الذي لم يتمكَّن في حياته الفكريَّة من بناء منظومة منسجمة من الفكر والإحساس يمكن لها أنْ تجمع بين العقل والغريزة، كيف يمكنه أنْ يُمثِّل وحدة الوعي الأوروبي في القرن العشرين؟! لقد أخفق نيتشه في فهم معنىٰ الحياة، وسعىٰ إلىٰ البحث عن علاج لعبثيَّته وتفاهته في الحيرة والضياع بين الفنِّ والعلم والسلطة، ولكنَّ هذا لم ينجِه من حيرته، بل فاقم من فشله وإخفاقه. كما لم يكن دلتاي وفلسفة حياته بحيث يُعَدُّ نقطة
قد سعىٰ إلىٰ تحويل الفلسفة إلىٰ علم، إلَّا أنَّ هذا العلم لم يكن علمًا تجريبيًّا؛ لأنَّ موضوع توصيف ظاهريّاته هو تحصيل الذوات أو الصور المعقولة والمعروضة في تجربة المدرك، والتي يمكن العثور عليها بحسب تعبير هوسِرْل بالمطلق في الشهود المباشر ومن دون وساطة. إنَّ هذه البداهة الشهوديَّة ليست بداهة حسّيَّة، وإنَّما هي بداهة الوعي من تلقائه. يُعتَبر هوسِرْل مثاليًّا من حيث بحثه عن الحقيقة في وعي وذهن الفاعل المدرك، بل ذهب، خلافًا لكانط الذي كان يقول بأنَّ أُمور التجربة الذهنيَّة يجب استنتاجها من واقع الأُمور التجريبيَّة، إلىٰ مرحلة أعلىٰ من سائر الفلاسفة المثاليِّين؛ فوضع الفواعل المعرفيَّة في مقام الكاشف للحقيقة وفي مقام الحقيقة نفسها. إنَّ موضوع فلسفته هو الموضوعات القصديَّة، وأمَّا الموضوعات التي هي متعلَّق الوعي، يرىٰ أنَّها بأجمعها ترتبط بصلب تجربتنا، وليس بالرجوع إلىٰ العالم المادّي الخارج عن وعينا. وبغضِّ النظر عن تماميَّة فلسفة هوسِرْل، نعيد السؤال الجوهري المتقدِّم ثانيَّةً، ونقول: هل يمكن لمثل هذه الفلسفة أنْ تُقلِّص الشرخ العميق القائم بين التيّار العقلي والتيّار التجريبي في القرن العشرين؟
يذهب حسن حنفي إلىٰ القول بأنَّ الوعي الأوروبي بعد اجتياز مختلف مراحل التكوين، الذي سبق أنْ أشرنا له، يتَّخذ شكلًا وبنية خاصَّة هي حصيلة تلك المراحل من التكوين. إنَّ هذه البنية إنَّما يتمُّ الحصول عليها بالنظر إلىٰ ذات وصلب الوعي الأوروبي وليس من خارجه، وإنَّه مجرَّد تحليل فكري ونظري
بحت. يسعىٰ حنفي في هذا المقال إلىٰ تعريف بنية الوعي الأوروبي من خلال ستّ خصائص، وفي الحقيقة يجب اعتبار هذا القسم من آراء حنفي، علىٰ حدِّ تعبيره، لُبّ «علم الاستغراب».
إنَّ العقلانيَّة الأوروبيّة علىٰ الرغم من تنوُّعها بحسب الشعوب المختلفة، إلَّا أنَّها تتمتَّع بلُبٍّ مشترك، وهو الذي يُكوِّن البُعد النظري من الوعي الأوروبي، ويشمل العاقل والمعقول، أو الذات والموضوع معًا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الخصائص العامَّة التي تتمتَّع بها الذهنيَّة الأوروبيّة؟ يشير حنفي إلىٰ خصِّيصتين من هذه الخصائص:
يُعتَبر عصر النهضة وعصر الإصلاح الدِّيني، من وجهة نظر حنفي، نقطة بدايَّة لـ «القطيعة المعرفيَّة» في الوعي الأوروبي عن ماضيه، وهي القطيعة التي يدين لها التطوُّر العلمي والاهتمام بـ «الإنسان». وبقدر ما تكون القطيعة مع الماضي، يكون التقدُّم نحو المستقبل. لقد تحوَّلت القطيعة المعرفيَّة إلىٰ واحدة من المفاهيم الجوهريَّة في فلسفة العلوم المعاصرة، وطرحت نفسها في الغرب المعاصر لدىٰ غاستون باشلار، ولوي ألتوسير، وميشال فوكو؛ لتأسيس نظريَّة المعرفة من جديد، وذلك بعد أزمة نظريَّة المعرفة التقليديَّة (بثنائيّاتها المعروفة بين القبلي والبعدي، والعقلي والحسّي، والتحليلي والتركيبي، والاستنباطي والاستقرائي،
القديمة للعالم، أصبح الواقع عاريًا دون غطاء نظري، وحدث انشقاق بين الأنا والعالم، لم يعد العالم مفهومًا، وأصبحت الذات قادرة علىٰ الفهم. ومن هنا بدأت محاولات بناء التصوُّرات الجديدة لتحلَّ محلَّ التصوُّرات القديمة، ولتملأ هذا الفراغ النظري، ولتعيد الوئام بين الأنا والعالم.
إنَّ حسن حنفي كما في البحث السابق يتمنّىٰ تحقُّق مثل هذه الظاهرة في العالم الإسلامي. فهو يدَّعي أنَّنا ما زلنا نرث تلك التصوُّرات القديمة بشأن عالم الواقع، وأنَّ الكتاب والتراث ما زالا يمتلكان السلطة، والواقع ما زال مغطّىٰ بنظريّات قديمة يتمُّ التسليم بها دون شكٍّ أو بحث عن بديل، وما زال الوئام النظري قائمًا بين الأنا والعالم، وبين الذات والموضوع: «الله موجود»، و«العالم مخلوق»، و«النفس خالدة». وشتّان ما بين الواقع العاري في الغرب، والواقع المغطّىٰ لدينا. إنَّما نظريَّة المعرفة لدينا هي التأويل والتفسير، تأويل القديم من أجل إعادة بنائه طبقًا لحاجات العصر.
يرىٰ حنفي أنَّ الوعي الأوروبي قد أظهر قدرة فائقة علىٰ التنظير منذ البداية في «أنا أُفكِّر» حتَّىٰ النهاية في «أنا موجود»، بحيث أصبحت وظيفة الوعي الأوروبي تحويل كلِّ شيء إلىٰ عقل، حتَّىٰ اعتبر التنظير إحدىٰ السمات الجوهريَّة للوعي الأوروبي يتميَّز بها علىٰ غيره من الشعوب، التي لم تصل إلىٰ هذه الدرجة
من القدرة علىٰ التنظير والثقة بالعقل باستثناء الحضارة الإسلاميَّة.
ظهر التنظير أوَّلًا في العلوم الرياضيَّة؛ فنشأت الرياضيّات الجديدة، وامتدَّ التنظير أيضًا إلىٰ العلوم الطبيعيَّة؛ فتمَّ تحويل الطبيعة إلىٰ رياضة علىٰ يد غاليليو، ثمّ اكتشاف قوانين الطبيعة عند نيوتن، وفي النظريَّة النسبيَّة ومصادرها في النظريَّة التموُّجيَّة، تحوَّلت العلوم الطبيعيَّة إلىٰ رياضيّات بحتة. وامتدَّ التنظير أيضًا إلىٰ العلوم الإنسانيَّة لبناء نماذج رياضيَّة لها بعد أنْ أثبتت الرياضيّات صدقها وتعيينها، بوصفها الدائرة الثالثة في حقل التنظير، وأصبح العقل حاكمًا علىٰ كلِّ شيء. كما تحوَّل الدِّين من مفهومه القديم العقائدي الإيماني الشعائري التاريخي الكنسي إلىٰ دين عقلي خالص. وحدث تحوُّل جذري في الوعي الأوروبي من العصور الوسطىٰ إلىٰ العصور الحديثة، من التأليه والتجسيم والتشبيه إلىٰ التنزيه، ومن الجبر والكسب إلىٰ الاختيار، ومن النقل إلىٰ العقل، ومن نظام الإمامة إلىٰ الدولة إلىٰ الوطنيَّة الحديثة. إنَّ حنفي يرىٰ هذا التحوُّل في لغتنا وأدبياتنا تحوُّلًا من الأشعريَّة إلىٰ الاعتزال، وما أعلنه ليسينغ في القرن الثامن عشر بانتهاء عصر النبوَّة، وببلوغ الإنسانيَّة ووصولها إلىٰ مرحلة النضج دون حاجة إلىٰ هداية أو إرشاد أو تدخُّل أو عون من الخارج. والعجيب أنَّ حنفي يعتبر أنَّ هذه العقلانيَّة إنْ هي إلَّا امتداد لذلك الشيء الذي أعلنه الإسلام قبل أكثر من ألف سنة، بمعنىٰ أنَّ العقلانيَّة الأوروبيّة ما هي إلَّا امتداد للعقلانيَّة الإسلاميَّة والاعتزاليَّة.
وقال حنفي في تحليل ظهور النزعة النسبيَّة في الوعي الأوروبي: وقد شمل التنظير أيضًا باقي مظاهر الحياة العلميَّة، في الحياة اليوميَّة وفي تنظيم العمل، وفي الإدارة والتصنيع، وفي الحياة السياسيَّة والقانونيَّة. وكانت نتيجة هذا المسار ظهور أنواع من التيّارات النظريَّة التي أخذ كلُّ واحدٍ منها يُفسِّر الكلَّ بأجزائه ويعمل علىٰ إلغاء الآخر، فوقع الوعي الأوروبي منذ بدايته في خطأ ردِّ «الكلِّ إلىٰ الجزء»: العالم مثال، العالم واقع، العالم عقل، العالم حسٌّ، وما إلىٰ ذلك، فكان كلُّ تيار يردُّ الكلَّ إلىٰ أجزائه، في حين ليس هناك جزء له الأفضليَّة علىٰ الأجزاء الأُخرىٰ، بل كانت المدارس المختلفة متساويَّة، ولم يكن هناك ترجيح في البين، فتحوَّلت التعدُّديَّة إلىٰ مذهب، وأصبح الاختلاف حول الحقيقة هو الحقيقة ذاتها، وأصبح الوعي الأوروبي يزهو بأنَّه وحده حضارة التعدُّد والاختلاف. ومن كثرة تراكم وجهات النظر وتضاربها بحيث استوت جميعها أمام العقل، لا فرق بين حقٍّ وباطل، صواب وخطأ، بدأت النسبيَّة تسري في الوعي الأوروبي حتَّىٰ أصبحت جزءًا من نسيجه. كلُّ شيء متغيِّر، وكلُّ شيء نسبي، ثمّ عبَّر عن ذلك هيجل في أنَّ التغيُّر هو المطلق الوحيد، وأنَّ المطلق الوحيد هو التغيُّر، وأعطىٰ كيركيغارد الأولويَّة للصيرورة علىٰ الوجود، ورأىٰ دارون التطوُّر في الطبيعة، وهكذا....
نظرًا لتهدُّم الأنساق القديمة وانهيار التصوُّرات الموروثة تحت معاول النقد العقلي والعلمي الجديد، بدأ الوعي الأوروبي بالشكِّ المنهجي عند ديكارت، ثمّ تحوَّل إلىٰ الشكِّ الهدفي والغائي، ثمّ تحوَّل الشكُّ من منهج إلىٰ
طبيعة، ومن أداة إلىٰ مزاج، ومن وسيلة إلىٰ غاية، حتَّىٰ ضاع الاعتقاد الجديد كما ضاع الإيمان القديم. لم يعد هناك شيء ثابت يُعرَف علىٰ نحو مطلق، ولم يعد هناك يقين دائم بشيء لا منهجًا ولا موضوعًا ولا غاية. انتهىٰ الوعي الأوروبي إلىٰ العدميَّة المطلقة، وانقلب المشروع المعرفي رأسًا علىٰ عقب؛ أي من العقل إلىٰ الإرادة، ومن اليقين إلىٰ الشكِّ، ومن البحث إلىٰ الأزمة، ومن الفكر إلىٰ الرغبة، ومن التفاؤل إلىٰ التشاؤم، ومن التقدُّم إلىٰ الانهيار، وهكذا، حتَّىٰ تجلّىٰ ذلك في أوضح صورة عند نيتشه ثمّ عند فلاسفة الوجود، خاصَّة عند هايدغر وسارتر، وفي الفلسفة التفكيكيَّة عند دريدا. فإذا كان هيجل قد أعلن أنَّ العقل هو الوجود، فقد بلغ الأمر في نهايته أنْ أعلن جان بول سارتر أنَّ الوجود عدم. وعليه، إذا كان الوعي الأوروبي في مرحلة الذروة قد اكتشف أنَّ العقل هو الوجود، فإنَّه في مرحلته النهائيَّة قد اكتشف أنَّ الوجود عدم. وبطبيعة الحال، فإنَّ العقل علىٰ الرغم من تمكُّنه من الوصول إلىٰ أعلىٰ الدرجات الممكنة من العموم والشمول (كما في الرياضيّات الشاملة عند لايبنتس)، كانت له حدود جعلته قاصرًا عن إمداد الوعي الأوروبي بكلِّ ما يحتاج؛ لأنَّ العقل الصوري المثالي، كان يسعىٰ إلىٰ الحقيقة خارج العالم علىٰ نحو تجريدي، وكان ارتباطه بالواقع قليلًا. إنَّ العقل المادّي الطبيعي رغم ارتباطه بالعالم الخارجي، إلَّا أنَّ هذا الارتباط ارتباط موضوعي بارد وفاقد للروح وخالٍ من العواطف والمشاعر، ومن هنا وُجِدَت الحركة الرومانسيَّة
في مقابلها.
يذهب حسن حنفي إلىٰ اشتمال الوعي الأوروبي علىٰ مشروعين مختلفين: أحدهما: المشروع المعرفي والنظري، والآخر: المشروع العملي والأخلاقي. وإنَّ الأوَّل كان يبحث عن غطاء نظري للواقع المجرَّد، والثاني كان يسعىٰ إلىٰ تأسيس مشروع عملي بديل عن الممارسات الدِّينيَّة القديمة للفرد أو الدولة. وإذا كانت المثاليَّة هي التي حملت لواء المشروع المعرفي بالأساس، فإنَّ التجريبيَّة هي التي حملت لواء المشروع العملي، ولو أنَّ كلًّا منهما تعرَّض للمشروعين معًا. فالمثاليَّة نظريَّة في المعرفة لها تطبيقاتها في الأخلاق، والتجريبيَّة نظريَّة في الواقع لها انعكاساتها في المعرفة. وعليه، فإنَّ قضيَّة الواقع والقيمة هي في حقيقة الأمر قضيَّة النظر والعمل في الوعي الأوروبي.
يبدو أنَّ حسن حنفي لم يُبيِّن هذا البحث بوضوح ودون مغالطة؛ لأنَّ مفاهيم الواقع والقيمة لا تتطابق مع التعاريف المتقدِّمة بالكامل؛ إذ إنَّ الطرح النظري والمعرفي ليس علىٰ الدوام ذلك الشيء الناظر إلىٰ الواقع الخارجي فقط، كما أنَّ الطرح العملي خارج الدائرة النظريَّة والمعرفيَّة، ليس مجرَّد ناظر إلىٰ الواقع أو دائرة الأخلاق فقط، ولم يتم التمييز بين هذه النِّسَب في كلمات حنفي بوضوح.
فهو يرىٰ أنَّ المشروع المعرفي للوعي الأوروبي في اختياريه الرئيسين؛ أي العقلانيَّة والتجريبيَّة، يمكّن في البدايَّة من إقامة نسبة بين الواقع والقيمة، وقال
بالاتِّحاد فيما بينهما؛ فالواقع هو القيمة، والقيمة هي الواقع، ويظهر ذلك بوضوح في التطبيقات العمليَّة لكلٍّ من التيّارين في الأخلاق والسياسة. ففي العقلانيَّة الجذريَّة التي مثَّلها اليسار الديكارتي عند سبينوزا، كانت القيمة من مقتضيات العقل ومن متطلِّبات الواقع علىٰ حدٍّ سواء. وفي السياسة، فرض العقل قيمة الحرّيَّة والديمقراطيَّة ضدَّ التبعيَّة للكنيسة والحكم الثيوقراطي لخلق نموذج لمجتمع مدني جديد. وقد بلغت قمَّة الوحدة بين العقل والواقع أو بين الروح والطبيعة عند هيجل في المثاليَّة المطلقة، وعند شيلنج في فلسفة الهويَّة، فالعقل إذاً قادر علىٰ أنْ يفرض القيمة ويُحقِّقها في الواقع. وقد قامت التجريبيَّة بنفس الشيء باسم التجربة ولتحقيق الهدف نفسه، وهو اتِّحاد القيمة والواقع؛ ففرض جون لوك قيمة التسامح في الدِّين، ووضع نسقًا عقلانيًّا للعقائد المسيحيَّة، وقد ذهب إلىٰ الاعتقاد بأنَّ العقل قد فرض الحكم البرلماني والانتخاب الحرَّ ضدَّ الحكم الإلهي والمجتمع الكنسي القديم. وكان هوبز يُؤكِّد علىٰ المجتمع المدني الحرِّ، وهيوم علىٰ الدِّين الطبيعي، ترسيخًا لقواعد العدل الاجتماعي. وقد تمَّ تدعيم ذلك أيضًا بنظريَّة تجريبيَّة في المعرفة وتحليل للواقع التاريخي حتَّىٰ يظهر اتِّحاد الواقع بالقيمة، واستمرَّ العقل قادرًا علىٰ رعاية القيمة وتحقيقها في الواقع.
وفي الوقت نفسه، ذهب حسن حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ انفصال الواقع عن القيمة قد بدأ تدريجيًّا منذ بداية الوعي الأوروبي حتَّىٰ بلغ ذروته في النهاية عند حدوث أزمة القرن العشرين، وكأنَّ العقل والقيمة كانا عاجزين عن احتواء الواقع كلِّه. كان العقل محدودًا باللّاعقل (أي الإرادة والانتماء ومجالات الحياة
وما إلىٰ ذلك)، وكانت القيمة محدودة بالقوميَّة والعرقيَّة، ويمكن مشاهدة ذلك في اليمين الديكارتي، وفي اليمين الكانطي، وفي اليمين الهيجلي، وفي اليمين الظاهراتي. وعندما لا يكون العقل قادرًا علىٰ تحصيل اليقين إلَّا في حقل العلوم والرياضيّات، ويُعتَبر عاجزًا في حقل الأخلاق وشؤون الحياة العمليَّة، يحصل انفصال بينه وبين الواقع وبين القيمة والواقع، وتصبح قيمة العقل صوريَّة محضة فارغة وبلا مضمون. بل إنَّ العقل قام أحيانًا بتبرير ما هو قائم دون أنْ يُغيِّره حتَّىٰ يتَّحد بالقيمة، وبلغ الفصام بين القيمة والواقع ذروته علىٰ نحو أشدّ في القرن العشرين عندما بدأت الأزمة ونشبت الحربان الأوروبيّتان، حتَّىٰ تحدَّث البعض عن انهيار القِيَم ونهاية عصر القِيَم. وتمَّ الفصل نهائيًّا باسم العلم والموضوعيَّة بين حكم الواقع وحكم القيمة، بين ما هو كائن وما ينبغي أنْ يكون، وبالتالي أصبح الواقع بلا قيمة والقيمة بلا واقع. وانتقلت هذه الأزمة إلىٰ العلوم الإنسانيَّة التي اتَّبعت النموذج الصوري مرَّة، فآثرت القيمة وضحَّت بالواقع، ثمّ اتَّبعت النموذج الطبيعي فآثرت الواقع وضحَّت بالقيمة، وأصبحت القيمة ذاتيَّة خالصة، نسبيَّة من فرد إلىٰ آخر، لا تناصرها إلَّا القوَّة المادّيَّة والإرادة العضليَّة، وتنتهي إلىٰ صراعات قِيَم لا يمكن الاحتكام فيها إلىٰ قيمة مستقلَّة، وإنَّما الغلبة تكون للأقوىٰ. وهنا سرعان ما انتهىٰ التفاؤل في البداية إلىٰ تشاؤم في النهاية، كما انتهىٰ دافع التقدُّم إلىٰ رصد مظاهر النكوص والانحطاط.
بالنظر إلىٰ ارتباط الفلسفة الأوروبيّة بأسماء الأشخاص والفلاسفة، فهي تحتوي علىٰ عناصر وتركيبات خاصَّة، كما أنَّ بعضها أضحىٰ منشأ لظهور بعضها الآخر. وقد ذهب حسن حنفي إلىٰ دراسة المذاهب الفلسفيّة في الغرب في ضوء الالتفات إلىٰ ثلاث موضوعات تتمثَّل بعناصر وبنية وتوالد المذهب.
يعمد حسن حنفي إلىٰ تقسيم هذه العناصر إلىٰ ثلاثة موضوعات، وهي: نظريَّة المعرفة، ونظريَّة الوجود، ونظريَّة القِيَم، وقد يضمُّ عنصرًا رابعًا، وهو الدِّين أو مبحث المقدَّس. فنظريَّة المعرفة أو «الإبستيمولوجيا» تجيب علىٰ سؤال: كيف أعرف؟ ونظريَّة الوجود أو «الأنطولوجيا» للإجابة عن سؤال: ماذا أعلم؟ أمَّا المبحث الرابع الذي هو الدِّين أو المقدَّس، فهو للإجابة عن سؤال: ماذا أعتقد؟ وما هي قواعد الإيمان؟
وبطبيعة الحال، فإنَّه علىٰ الرغم من ظاهر عبارة حنفي، فإنَّ الأسئلة والعناصر المتقدِّمة ليست منفصلة عن بعضها؛ لأنَّ الإجابة عن كلِّ شطر تُشكِّل مبنىٰ أو مقدّمة في الجزء الآخر. ومن هنا فإنَّه بعد افتراض هذه الأُمور بوصفها عناصر في المذاهب الفلسفيّة في الغرب، يجب علينا أنْ لا نتجاهل الارتباط فيما بينها؛ إذ إنَّ دائرة الدِّين والقِيَم شديدة القرب من الدائرتين السابقتين، ويمكن إحالتهما إليهما، ومكمن الاختلاف في نوع الأُسلوب فقط.
وقد عمد حنفي إلىٰ استعراض بعض المذاهب الفلسفيّة، ولا سيّما في
المحطّات الأربع الكبرىٰ في الوعي الأوروبي، وهي المتمثِّلة بفلسفة ديكارت، وفلسفة كانط، وفلسفة هيجل، وفلسفة هوسِرْل. فتجد، علىٰ سبيل المثال، نظريَّة المعرفة عند ديكارت في «قواعد لهداية الذهن» و«مقال في المنهج»، ونظريَّة الوجود في «التأمُّلات في الفلسفة الأُولىٰ»، ونظريَّة القِيَم في «مقال في الإنسان».
إنَّ للمذاهب الفلسفيَّة في الوعي الأوروبي ثلاثة أبعاد أو ثلاثة أجزاء: الأوَّل: يقوم علىٰ الهدم بنقض المذاهب السابقة ورفع الغطاء النظري السابق، والثاني: يقوم علىٰ إعادة صياغة مذهب جديد، والثالث: الهدف غير المعلن الذي من أجله تمَّ الهدم والبناء. كلُّ مذهب فلسفي يقوم بهدم النظريَّة السابقة ويُبيِّن عيوبها، فإنَّ تلك النظريَّة السابقة بدورها ردَّة فعل علىٰ النظريَّة الأسبق، وفي الواقع يتبلور وفقًا لمقتضىٰ الاحتياجات السابقة. واستمرَّت جميع الفلسفات المعاصرة بعمليّات الرفض هذه حتَّىٰ أصبح الرفض عند ماركوزه هو روح الفلسفة. وبَعد البُعد السلبي يأتي البُعد الإيجابي، حيث يظهر مذهب فلسفيّ جديد، يتعرَّض بدوره إلىٰ النقد والنقض اللاحق. فليس هناك سلب مطلق أو إيجاب مطلق، وأصبحت المذاهب نسبيَّة والحقيقة متغيِّرة، وكان العنصر الدائم في جدل الهدم والبناء هو روح العصر، والظروف الاجتماعيَّة، والمرحلة التاريخيَّة؛ أي تاريخيَّة الوعي الأوروبي. وأمَّا الجانب الثالث من المذهب، وهو الجانب المستتر الضمني، فهو الهدف غير المعلن الذي من أجله تمَّ الهدم
والبناء. فمثلًا كان هدف ديكارت إثبات الأنا وظهور الله في داخلها عودًا إلىٰ الأُوغسطينيَّة ولحاقًا بالبروتستانتيَّة، الصلة المباشرة بين الإنسان والله، وبداية بالذاتيَّة التي أغفلتها الفلسفة المدرسيَّة لحساب الأُرسطيَّة. وهكذا كان لكلِّ واحدٍ من المذاهب الفلسفيّة هدف في تبلوره، وهذا الحدس المستتر هو قلب الفيلسوف وليس عقله، وتارةً يكون هذا الهدف محطًّا للاهتمام الواعي، وتارةً أُخرىٰ لا يكون شعوريًّا. إلَّا أنَّ حنفي يرىٰ أنَّ هذا الهدف يكون منبثقًا في الغالب عن عقيدة دينيَّة، بحيث حتَّىٰ أنَّ أفرادًا من أمثال سارتر ونيتشه كانوا متأثِّرين بدورهم بدوافع دينيَّة مستورة، ولذلك فإنَّه يعدُّ إلحادهم إيمانًا مقلوبًا. وبطبيعة الحال، فإنَّ هذا خلط واضح من حنفي؛ إذ يعدُّ جميع أنواع الدوافع نحو الدفاع عن الدِّين أو نفيه دافعًا دينيًّا، بحيث يعدُّ حتَّىٰ الإلحاد هو من نوع الإيمان المقلوب.
في الوعي الأوروبي ظهرت مذاهب فلسفيَّة متنوِّعة بوصفها ردود فعل تجاه بعضها البعض وطبقًا للمقتضيات التاريخيَّة الخاصَّة، وبذلك ظهرت ثلاثة نماذج من توالد المذاهب: استمرار الماضي، واستمرار الماضي مع نوع من الانقطاع، والانقطاع التامّ عن الماضي. ويرىٰ حنفي إمكانيَّة إعطاء عدَّة نماذج من توالد المذاهب الفلسفيّة عن طريق التواصل والاستمرار من ديكارت إلىٰ لايبنتس ومالبرانش، ومن لوك إلىٰ هوبز وهيوم، ومن كركيغارد إلىٰ هايدغر وسارتر، أو من كريكيغارد إلىٰ ياسبرز ومارسيل، ومن لامارك إلىٰ
دارون وسبنسر وهيجل، رغم أنَّه لا يوجد تطابق تامٌّ بين أيّ مذهبين من هذه المذاهب. أمَّا نموذج التواصل مع الماضي مع الانقطاع، فيمكن بيانه من ديكارت إلىٰ سبينوزا (من الثنائيَّة إلىٰ الأُحاديَّة)، ومن كانط إلىٰ فيشته وهيجل وشيلنج وشوبنهاور (من ثنائيَّة النظري والعملي والظاهر والشيء في ذاته إلىٰ التوحيد بينهما في الذاتيَّة أو الجدل أو الهويَّة أو الإرادة)، ومن هوسِرْل إلىٰ شيللر (أي من المثاليَّة الأفلاطونيَّة إلىٰ الواقعيَّة الحيويَّة)، ومن هوسِرْل إلىٰ هايدغر (أي من الفينومينولوجيا إلىٰ الأنطولوجيا)، ومن ماركس إلىٰ ألتوسر، ومن هايدغر إلىٰ دريدا (أي من تحليل اللغة لاكتشاف الوجود الإنساني إلىٰ تحليل اللغة والانتهاء إلىٰ الصفر). وأمَّا النموذج الثالث، وهو الأشهر والأوقع، وهو نموذج الانقطاع والتضادِّ والتقابل التامِّ بالنسبة إلىٰ الماضي، فهو عبارة عن: جون لوك إلىٰ لايبنتس (الدفاع عن العقل ضدَّ الحسِّ)، ومن هيوم إلىٰ كانط (في الدفاع عن القبلي ضدَّ الشكِّ فيه)، ومن فولف إلىٰ كانط (في الدفاع عن النقد ضدَّ القطع)، ومن هيجل إلىٰ كركيغارد (في الدفاع عن الوجود ضدَّ العقل)، ومن هيجل إلىٰ ماركس (في الدفاع عن الواقع ضدَّ المثال)، ومن كانط إلىٰ برجسون (في الدفاع عن الحدس ضدَّ العقل)، ومن دارون وسبنسر ولامارك إلىٰ برجسون (في الدفاع عن التطوُّر الخلاق ضدَّ التطوُّر الآلي المادّي) وما إلىٰ ذلك.
ثمّ استطرد في تحليله قائلًا: نتيجة لهذا التوالد المذهبي طبعت العقليَّة الأوروبية بطابع خاصٍّ وتكوَّن لها مزاج خاصٌّ، أصبحت عقليَّة تقوم
بتصنيف الظواهر دائمًا إلىٰ طرفين متناقضين، وبالتالي كان الجدل يُعبِّر عن طبيعتها وجوهرها، الصراع والتناقض ثمّ المصالحة والوفاق. اتَّسمت العقليَّة الأوروبيّة بالتفرُّق والتشتُّت؛ أي ردَّ الكلَّ إلىٰ أجزائه (وتقسيم الأُمور إلىٰ تيّار واقعي ومثالي، وتيّار عقلي وحسّي، ورأسمالي واشتراكي وما إلىٰ ذلك). وعندما يتجرَّد الواقع من جميع أغطيته النظريَّة والدِّينيَّة السابقة، يغدو الحصول علىٰ نظريَّة واحدة من قِبَل الإنسان بحيث تحيط بجميع جوانب الموضوع، أمرًا في غاية التعقيد؛ لأنَّ رؤية الإنسان أُحاديَّة ومحدودة، ولذلك فقد ظهرت جميع هذه المدارس الفكريَّة وضاعت الحقيقة في زحمتها. وعلىٰ كلِّ حالٍ، فإنَّ المجتمعات غير الأوروبيّة لا يمكنها الأخذ بهذه المذاهب المختلفة التي تُعبِّر عن تحوُّل النظريّات بالنسبة إلىٰ واقعٍ خاصٍّ، ولكنْ في الوقت نفسه يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ هذه المذاهب نماذج وأمثلة فكريَّة للمجتمعات غير الأوروبيّة لعلَّها ترجع إليها عند مقارنتها بالأفكار القديمة والسعي إلىٰ إعادة تفسير الواقع مجدَّدًا. وبهذا المعنىٰ، تكون المعرفة بالحضارة الأوروبيّة وبغيرها من الحضارات، عوامل مشجعة ونماذج سابقة لوعي خاصٍّ في ظروف خاصَّة لإبداعٍ خاصٍّ.
وعلىٰ الرغم من سعي حنفي إلىٰ اعتبار أنواع المذاهب الفلسفيّة وأساليب تفكير الحضارة الغربيَّة خاصَّة بها، إلَّا أنَّه لا يستطيع إخفاء رغبته في استلهام هذه المذاهب من أجل نبذ تفسير التراث القديم وإبداع تفاسير جديدة للواقع.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ ظروف الوعي الأوروبي من القطيعة المعرفيَّة والتنظير والفصل بين الواقع والقيمة وتوالد المذاهب الفلسفيّة، هي التي أدَّت إلىٰ جعله وعيًا تاريخيًّا، وأصبح ذلك من خصائص الوعي الأوروبي. كان القدماء يعرفون الزمان كعدد للحركة، وكان الزمان مطروحًا في دائرة الطبيعة والمكان، إلَّا أنَّ الوعي الأوروبي استطاع أنْ ينقل الزمان من الخارج إلىٰ الداخل، ومن الطبيعة إلىٰ الإنسان، ومنحه بُعدًا إنسانيًّا وباطنيًّا. ومن ناحية أُخرىٰ، أدّىٰ توالي المذاهب الفلسفيّة وتراكمها إلىٰ اكتشاف بُعد آخر للزمان، وقد تمثَّل هذا البُعد بالبُعد التاريخي، فنشأ مفهوم «العصور الحديثة»، حتَّىٰ نشأت فلسفة التاريخ لتصف مسار هذا الوعي الأوروبي ومراحله بالالتفات إلىٰ تاريخيَّته. ومن هنا يذهب حنفي إلىٰ القول بأنَّ الوعي الأوروبي قد فاق أقرانه من جهتين، وهما: الإنسان والتاريخ، وكلاهما زمان، الزمان الفردي والزمان الجماعي. وهذا هو الشيء الذي يرىٰ حنفي أنَّ التراث الإسلامي مفتقر إليه. يرىٰ حسن حنفي أنَّ توالي الوعي الأوروبي، ولا سيّما تطوُّره في العصور الحديثة، قد تجلّىٰ في فلسفات أربع، وهي: (العقلانيَّة في القرن السابع عشر، والتنوير في القرن الثامن عشر، والعلم في القرن التاسع عشر، وأزمة الإنسان والعلوم الإنسانيَّة في القرن العشرين)؛ ليثبت بذلك تاريخيَّة الوعي الأوروبي. إنَّ هذه المراحل الأربع إنَّما هي مراحل طبيعيَّة وتلقائيَّة، كلٌّ منها تتولَّد عن الأُخرىٰ تولُّدًا طبيعيًّا، من العقلانيَّة إلىٰ التنوير، ومن الثورة
الاجتماعيَّة إلىٰ العلم، ومن الصناعة إلىٰ أزمة الوجود الإنسانيَّة. وبالإضافة إلىٰ هذه المراحل الأربع عبر القرون، حدث تراكم تاريخي بين المذاهب الفلسفيّة، فكان ديكارت مثلًا حاصلَ الجمع بين أنسيلم وأُوغسطين، وكان سبينوزا حاصل الجمع بين ديكارت وماري دي بيران، وكان كانط حصيلة الجمع بين ديكارت ولايبنتس، وهكذا، وكان كلُّ فيلسوف لاحق يبني فلسفته علىٰ تطوُّر الفلسفة السابقة أو إعادة قراءتها ونقدها أو تغييرها وقلبها رأسًا علىٰ عقب، وقد ازداد هذا التراكم التاريخي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين علىٰ نحو أشدّ.
إنَّ الوعي الأوروبي يشتمل علىٰ تاريخٍ خاصٍّ يُمثِّل تاريخ تكوينه (من القرن السابع عشر إلىٰ القرن العشرين). إنَّ هذا الموجود التاريخي، علىٰ حدِّ تعبير حسن حنفي، كان يتألَّف من بنية خاصَّة، وهذه البنية، وإنْ كانت من صنع التاريخ، إلَّا أنَّها من حيث وجودها في التاريخ وتأثيرها في نوع الرؤية إلىٰ الواقع، قد استقلَّت بذاتها وتركت أثرها في مجرىٰ التاريخ، ومن هنا يقوم نوع من الارتباط بين بنية الوعي الأوروبي وتاريخه، وبالتالي تكون بنيته تاريخيَّة، ويكون تاريخه مشتملًا علىٰ بنية. ومن هنا فإنَّ حنفي يتناول موضوعين، وهما:
1. «تاريخ البنية» في الوعي الأوروبي.
2. «بنية التاريخ» في الوعي الأوروبي.
إنَّ لبنية الوعي الأوروبي تاريخًا طويلًا ومسارًا تبلور حتَّىٰ بلوغه مرحلة تكامله بالتزامن مع بدايته ونهايته في القرن العشرين. وفي مرحلة مصادر الوعي الأوروبي (الأعمّ من المصدر اليوناني الروماني والمصدر اليهودي المسيحي والبيئة الأوروبيّة)، هناك بنية ثلاثيَّة، حيث يُمثِّل المصدر اليوناني الروماني التيّار العقلاني الصاعد، وتُمثِّل البيئة الأوروبيّة التيّار التجريبي النازل، ويُمثِّل المصدر اليهودي المسيحي التيّار المستقيم الذي ينبثق من داخل الإيمان والبُعد الباطني. وعليه، فإنَّ المصادر الثلاثة للوعي الأوروبي قد انتظمت في بنية ثلاثيَّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ المصدر اليوناني بدوره كان ثلاثي البنية أيضًا؛ أي في المذاهب الفلسفيّة الكبرىٰ؛ فكان أفلاطون يُمثِّل الخطَّ الصاعد، والصور المفارقة المستقلَّة عن المادَّة في فلسفته، من قبيل مفاهيم ما قبل التجربة في الفلسفة النقديَّة لكانط. لذلك كان كانط أفلاطون العصر الحديث، وكان سقراط يُمثِّل البُعد الإيماني الداخلي الباطني اليهودي المسيحي، لذلك اتَّحد بالمسيح في عصر آباء الكنيسة، وسُمّي «القدِّيس سقراط». وكان أُرسطو يُمثِّل الخطَّ النازل؛ أي الواقع الحسّي التجريبي والمتناغم مع مصدرها الآخر؛ أي البيئة الأوروبيّة نفسها. أمَّا المصدر اليوناني للوعي الأوروبي، فكان تحوُّلًا طبيعيًّا وتكرارًا للبنية اليونانيَّة الثلاثيَّة مع اختلال في التوازن بين الأبعاد الثلاثة. فكانت الأفلاطونيَّة، علىٰ سبيل المثال، قد قلَّت وانخفضت، بينما ازدهرت السقراطيَّة في الرواقيَّة الرومانيَّة، ثمّ ازدهرت الأُرسطيَّة من خلال الشكّاك الرومان والأبيقوريَّة.
وقد استمرَّت هذه التيّارات الثلاثة عبر العصور الوسطىٰ بفترتيها، سواء عصر آباء الكنيسة أو العصر المدرسي. وفي بداية مرحلة الوعي الأوروبي، ظهرت البنية الثلاثيَّة من جديد، حيث يُمثِّل ديكارت العقلانيَّة الأفلاطونيَّة الحديثة، وعند الديكارتيَّة بجناحيها النسبي عند مالبرانش ولايبنتس وصولًا إلىٰ سبينوزا وحتَّىٰ باسكال، حيث يُمثِّلون العقلانيَّة الأفلاطونيَّة الصاعدة، ويبينون الثنائيَّة الديكارتيَّة (الفكر والمادَّة، والنفس والبدن، والصوريَّة والمادّيَّة، والمثاليَّة والواقعيَّة، والله والعالم، والله وقيصر. ولكنَّها في الحقيقة أعطت ما لقيصر لله وما لله لله. أعطت كلَّ شيء إلىٰ الله، وردَّت البدن إلىٰ النفس، والمادَّة إلىٰ الفكر). وفي المقابل ظهر فرنسيس بيكون ليُؤسِّس الاتِّجاه الثاني؛ أي التجريبيَّة، والذي يُمثِّل الأُرسطيَّة التجريبيَّة. وعلىٰ الرغم من أنَّ بيكون قد سمّىٰ منطقه الآلة الجديدة في مقابل المنطق الأُرسطي القديم، فقد كان التقابل هنا بين منطق الاستقراء الحسّي الجديد والمنطق الاستنباطي العقلي القديم، وإلَّا فإنَّ التيّار الأُرسطي بوصفه تيّارًا طبيعيًّا في مقابل التيّار الأفلاطوني كمذهب مثالي، هو الذي ظهر وراء التيّار الثاني التجريبي. واستمرَّ هذا التيّار في المدرسة الأنجلوسكسونيَّة عند هوبز ولوك، وهيوم في إنجلترا، وفلاسفة التنوير في فرنسا، وبلغ إلىٰ غاية الدرجة النازلة. وقد حاول كانط أنْ يجمع بين هذين التيّارين ويُقلِّص الفجوة بينهما، فعرض فلسفته النقديَّة علىٰ هذا الأساس، ولكنَّه بدلًا من التوحيد بينهما، انتهىٰ إلىٰ تحكيم أحدهما (التيّار العقلاني) علىٰ الآخر (التيّار الحسّي)، وانتهىٰ بدلًا من الثنائيَّة السابقة إلىٰ إنتاج «ثلاثيَّة».
ثمّ أتىٰ الكانطيّون بعد كانط ليعيدوا الكرَّة من جديد في التقريب بين هذين التيّارين السابقين والوصول إلىٰ التوحيد (في ثنائيَّة النظري والعملي، والمعرفة والأخلاق، والمفاهيم القبليَّة والبعديَّة، والظاهر والباطن، والصورة والمادَّة، والشارط والمشروط، والله والعالم، والله وقيصر). وأراد يوهان فيشته وهيجل التوحيد بين طرفي الثنائيَّة الذات والموضوع عن طريق الجدل. وآثر شيلنج الهويَّة المطلقة بين الطرفين بين الروح والطبيعة، والله والعالم، معطيًا الأولويَّة للثابت علىٰ المتحوِّل. وآثر شوبنهاور العودة إلىٰ عالم الحياة عن طريق الإرادة، وأعطىٰ الأولويَّة للمشروع العملي علىٰ المشروع المعرفي.
وبدأ الخصام من جديد في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بين التيّارين المتباعدين، كلُّ واحدٍ يحاول أنْ يجعل من نفسه نموذجًا لعلوم الإنسان، وظلَّت الظاهرة الإنسانيَّة متأرجحة بين نمط العلوم الرياضيَّة العقليَّة تارةً، وبين نمط العلوم الطبيعيَّة الحسّيَّة تارةً أُخرىٰ؛ فنشأت أزمة العلوم الإنسانيَّة. وهنا ظهر الطريق الثالث؛ أي طريق فلسفات الحياة (علىٰ يد نيتشه وهنري برجسون وهوسِرْل وشيللر وغيرهم)، كما ظهر فلاسفة الوجود. ولكنْ في نهاية المطاف، أصبح الوعي الأوروبي متشعِّبًا إلىٰ ثلاثة اتِّجاهات: فلسفة الروح (العقلانيَّة)، وفلسفة الطبيعة (التجريبيَّة)، وفلسفة الوجود (الظاهراتيَّة)، وهي نفسها ثلاثيَّة المصدر: أفلاطون وأُرسطو وسقراط، فلم تتَّحد أبدًا. أمَّا الواقع الأوروبي وطبيعته، فهو مصدر واحد، ولكنَّه واقع روماني ومزاج مادّي وطبيعة دنيويَّة أقرب إلىٰ اليهوديَّة من المسيحيَّة، وإلىٰ
الرومان منه إلىٰ اليونان، وإلىٰ التجريبيَّة منه إلىٰ العقلانيَّة. يقول حسن حنفي: لو كنت أُوروبيًا لاخترت من بين النظريّات والفلسفات المختلفة، التي لم تتَّحد أبدًا، التحوُّل من المشروع المعرفي في الفلسفة الحديثة، أي مرحلة اليسار الهيجلي الذي قام فيه شتراوس بنقد الدِّين، وقام فيورباخ بنقد المثاليَّة، وكارل ماركس الشابُّ بنقد المجتمع، ولاخترت الماركسيَّة الجديدة.
إنَّ تاريخ هذه البنية الثلاثيَّة الأبعاد في الوعي الأوروبي، علىٰ حدِّ تعبير حنفي، تاريخ طويل يمتدُّ من المصادر الأُولىٰ من بداياته وحتَّىٰ نهاياته. ومن هنا تسوده بنية خاصَّة عبر هذا التاريخ الطويل، بحيث لا مندوحة للفرد الأوروبي من النظر إلىٰ الواقع الخارجي والعالم من زاويته. بمعنىٰ أنَّ الأوروبي إذا أراد أنْ ينظر إلىٰ شيء ما، فإمَّا أنْ ينظر إلىٰ أعلىٰ طبقًا للخطِّ الصاعد، وإمّا ينظر إلىٰ أسفل طبقًا للخطِّ النازل، أو ينظر إلىٰ الأمام محاولًا الجمع بين الاثنين، وهو الطريق الثالث في المرحلة المعاصرة.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ الدِّين يُمثِّل الخطَّ الصاعد، والعلم يُمثِّل الخطَّ النازل، والفلسفة تُمثِّل الخطَّ المستقيم، ومن هنا فإنَّه يحشر الإنسان الأوروبي ضمن هذه المحاور الثلاثة، فهو إمَّا متديِّن وإمّا عالم أو فيلسوف، بحيث لا يمكن الجمع والمصالحة بين الثلاثة، الله والطبيعة والإنسان، أو الإيمان والإدراك المباشر والحدس، أو أيّ اسم آخر يمكنه بيان الخطِّ الصاعد والنازل
والمستقيم. وعلىٰ كلِّ حالٍ، فإنَّ العلاقة بينهما هي علاقة التصادم والتعارض والتضادِّ، ولذلك فإنَّ الصراع بين العلم والدِّين مشهور في تاريخ الوعي الأوروبي، وكذلك التعارض بين الدِّين والفلسفة.
الوعي الأوروبي الفلسفة
كان الوعي الأوروبي في عصوره الحديثة قد مرَّ بفترتين كبيرتين وطويلتين، وهما: المرحلة الأُولىٰ (في القرن السابع عشر والثامن عشر) الفلسفة الحديثة الممتدَّة حول الـ «أنا أفكر»، بحيث أصبحت الأولويَّة للمشروع المعرفي القائم علىٰ العقل (رغم الاختلاف في تفسيره بين المدرسة العقلانيَّة والمدرسة التجريبيَّة)، وفي المرحلة الثانية (في القرن التاسع عشر والعشرين) الفلسفة المعاصرة الممتدَّة حول «الأنا موجود»، بحيث كانت الأولويَّة للمشروع السياسي القائم علىٰ الثورات وتأسيس الدولة الوطنيَّة الحديثة. وكان التحوُّل من المرحلة الأُولىٰ إلىٰ المرحلة الثانية تحوُّلًا جذريًّا أو انقلابيًّا من العقل إلىٰ العاطفة، ومن المعقول إلىٰ اللّامعقول، ومن الماهيَّة إلىٰ الوجود، ومن الفرد إلىٰ المجتمع، ومن التفاؤل إلىٰ التشاؤم، ومن التقدُّم إلىٰ النكوص، ومن البداية إلىٰ النهاية. وكان معظم فلاسفة الفترة الأُولىٰ من الرياضيِّين، بينما كان معظم فلاسفة الفترة الثانية من البيولوجيين وعلماء الأحياء والفنّانين.
1. لا شكَّ في أنَّ من بين خصائص بنية الوعي الأوروبي هو الشرخ المعرفي والانقطاع عن الماضي، بيد أنَّ حنفي يرىٰ أنَّ هذا الانقطاع كلَّما كان أكبر، كان التطوُّر الحاصل في المستقبل متحقِّقًا بالمقدار نفسه. إنَّه يرىٰ أنَّ التطوُّر والتقدُّم العلمي وتربُّع الإنسان في مركز اهتمام العالم الغربي مدين لهذا الانقطاع، ويرىٰ ضرورة مثل هذا النموذج من الانقطاع للعالم الإسلامي من أجل تحقيق التطوُّر والتقدُّم، ولكنَّه يرىٰ أنَّنا ما زلنا في منتصف الطريق، وأنَّنا نعيش، علىٰ حدِّ تعبيره، في فضاء المعارف التقليديَّة. والحقيقة هي أنَّ حسن حنفي قد أخطأ في كلا التقييمين، فإنَّ العالم الغربي بانفصاله المعرفي والأخلاقي عن ماضيه، وإنْ كان قد حصل علىٰ تقدُّم علمي في ظلِّ جهوده الحديثة، إلَّا أنَّه قد ابتلىٰ بالكثير من الأزمات المعرفيَّة والأخلاقيَّة والاجتماعيَّة. ومثل هذا الشرخ والانفصال، الذي اقترن بكلِّ هذه التداعيات الإنسانيَّة المريرة، لا يمكن أنْ يُثبِت أفضليَّته ورجحانه علىٰ ماضيه. يضاف إلىٰ ذلك أنَّ العودة إلىٰ الماضي أو مواصلته في جزء من الوعي الأوروبي كان قائمًا، وإنَّ الإيمان بالتعاليم المسيحيَّة واليهوديَّة لم يضمحلّ في المرحلة الجديدة. وعلىٰ الرغم من إشارة حنفي إلىٰ الشرخ والانفصال المعرفي للعالم الغربي عن ماضيه وتجرُّد الواقع من غطائه السابق، إلَّا أنَّه لا يتعرَّض إلىٰ أسباب ذلك، وجوابه يكمن وراء الأوضاع المؤسفة للكنيسة وواقع العلم، والنسبة القائمة بين العلم والدِّين، وكذلك علاقة العلم والدِّين بالسلطة في العصور الوسطىٰ.
2. يذهب حسن حنفي إلىٰ تعريف العقلانيَّة الأوروبيّة الحديثة بأنَّها عقلانيَّة إسلاميَّة، في حين أنَّ العقلانيَّة الأوروبيّة علىٰ شتّىٰ تفاسيرها المختلفة، ما هي إلَّا عقلانيَّة مادّيَّة، وذرائعيَّة، ونفعيَّة، وإنسانيَّة، وعلمانيَّة، وليس لهذه المفاهيم أيّ صلة بالعقلانيَّة الإسلاميَّة. إنَّ العقل في التعاليم الدِّينيَّة والتراث الإسلامي مصباح وسراج يُسلِّط الضوء علىٰ كتاب التكوين والتشريع الإلهي وصاحب الكتاب ليطَّلع عليه الإنسان، ولذلك يكون للعقل حضور مبرَّر وحيويّ في حقل التجربة والطبيعة وفهم عالم الخلق واكتشاف مقاصد ومفاهيم نصوص الشريعة. إنَّ العقلانيَّة الإسلاميَّة في قراءة مدرسة أهل البيت طيلة تاريخها الممتدِّ عبر القرون الأربعة عشر المنصرمة، لم تواجه تحدّيًا لم تستطع الإجابة عنه، في حين أنَّ العقلانيَّة الأوروبيّة كانت تعاني من الداخل تحدّيات وصراعات وعدم استقرار دائم. ومن ناحيَّة أُخرىٰ، فإنَّ التداعيات العمليَّة للعقلانيَّة الإسلاميَّة تختلف عن تداعيات العقلانيَّة الغربيَّة اختلافًا جوهريًّا. إنَّ الطمأنينة والأمل والهدوء واليقين والإيمان والتوكُّل، من أهمّ الآثار المترتِّبة علىٰ العقلانيَّة الإسلاميَّة، في حين أنَّ العقلانيَّة الغربيَّة تفتقر إلىٰ هذه المفاهيم بشدَّة.
3. قال حنفي في حقل الواقعيَّة والقيمة في الوعي الأوروبي: إنَّ العقلانيَّة هي حاملة لواء المشروع النظري والمعرفي، وإنَّ التجريبيَّة كانت تُمثِّل الطرح العملي لها، حيث كانت تريد الحلول محلَّ الدِّين والأخلاق.
ولكنَّ هذا الفصل لا يبدو صحيحًا، سواء من الناحية التاريخيَّة أو المعرفيَّة؛ وذلك أوَّلًا: لأنَّ العقلانيَّة ليست مجرَّد نظريَّة مثاليَّة غير ناظرة إلىٰ الواقع العيني، كما أنَّ التجريبيَّة بدورها لا تفتقر إلىٰ أيِّ نوع من أنواع النظريّات أو الفرضيّات الذهنيَّة. وثانيًا: أنَّ القِيَم التي تُفسِّر الفلسفة العمليَّة والضرورات والمحظورات قبل أنْ ترتبط بالتجربة والحسِّ، تنشأ من مبانٍ نظريَّة وأنطولوجيَّة خاصَّة مهما كانت مادّيَّة.
4. لقد خلط حسن حنفي في بحثه عن بنية الوعي الأوروبي والمسائل الأُخرىٰ بين شيئين، بين النسبيَّة بوصفها مدرسة فلسفيَّة، وبين استنتاج النسبيَّة من كثرة المذاهب الفلسفيّة، في حين أنَّ هذين الأمرين ليسا شيئًا واحدًا. إنَّ مشاهدة كثرة وتعدُّد الاتِّجاهات والتيّارات العقليَّة والتجريبيَّة في الوعي الأوروبي، يجب أنْ لا تدفع الباحث المعرفي الناظر إلىٰ هذه الكثرة من الخارج ليستنتج منها عدم وجود مذهب مطلق ودائم، بل إنَّ الجميع نسبي والحقيقة متغيِّرة، وإنَّ الاختلاف في الحقيقة هو الحقيقة عينها. أجل، إنَّ النسبيَّة بوصفها مدرسة أو واحدة من لوازمها وتبعاتها، لها حضور واسع في الغرب، إلَّا أنَّ هذا شيء آخر غير استنتاجها من المدارس المتكثِّرة والمتعدِّدة. يمكن لمدرسة مثل مدرسة ديكارت أو كانط أو أيّ مدرسة أُخرىٰ أن تدَّعي احتكار الحقيقة والإطلاق لنفسها وتنفي سائر المدارس الأُخرىٰ؛ لأنَّ الكثير منها، خلافًا لوجهة نظر حسن حنفي، يعترف بالصدق والكذب والحقيقة، رغم توظيفهم لمعايير مختلفة في هذا الشأن.
(122)5. لقد ذهب حنفي إلىٰ اعتبار الوعي الأوروبي وعيًا تاريخيًّا، وتحدَّث في هذا الشأن، وكأنَّ الغرب قد اكتشف عنصرًا جديدًا باسم التاريخ والزمان، وأضفىٰ عليه مفهومًا إنسانيًّا، بحيث نال الغرب بذلك أفضليَّة علىٰ أقرانه. وقد تحدَّث حنفي عن أربع مراحل في تطوُّر الوعي الأوروبي من القرن السابع عشر إلىٰ القرن العشرين بوصفها شاهدًا علىٰ تاريخيَّة الوعي الأوروبي. والحقيقة هي أنَّ مختلف المدارس الفلسفيَّة في الغرب كانت متناظرة مع بعضها أو كانت في بعض الأحيان ردَّة فعل تجاه بعضها، وإنَّ هذه المتغيِّرات لم تكن ناظرة إلىٰ حقيقة خاصَّة باسم التاريخ، بل كاشفة عن أزمات وعن معضلات تعرَّضت لها الحضارة الغربيَّة، ولا سيّما في المرحلة المعاصرة. ليس للتاريخ والزمان مقتضيات خاصَّة بشكل منفصل عن الأفكار وعن الأشخاص الذين يعيشون في كنفهما، بل إنَّ الأفكار والناس هم الذين يصنعون المقتضيات والتاريخ. ولذلك، فإنَّنا بالالتفات إلىٰ عدم ثبات المدارس الغربيَّة ومشكلاتها، نواجه علىٰ الدوام تغييرًا في عناصرها الذاتيَّة، يتمثَّل ذبولًا وازدهارًا.
6. لقد سعىٰ حنفي إلىٰ تنظيم الوعي الأوروبي ضمن بنية داخليَّة ثلاثيَّة الأبعاد، ليستنتج من ذلك العلاقة الإنتاجيَّة والتوليديَّة لمختلف المدارس من دون أنْ يُقدِّم شواهد كافية علىٰ ذلك. فهل يمكن حقًّا تنظيم الوعي الأوروبي ضمن بنية متعدِّدة الأبعاد؟ وهل لهذه البنية من وجود حقيقي؟ إنَّ مفهوم البنية مهما كان انتزاعيًّا وذهنيًّا، إلَّا أنَّه يُعبِّر
عن نظم خارجي وعيني تبعًا لأهداف وغايات خاصَّة. يمكن لبنية خاصَّة أنْ تكون ذات أجزاء متعدِّدة، إلَّا أنَّ تفرُّق وتشتُّت الأجزاء، وكذلك التنافي والتنافر فيما بينها، لا يمكن أن يُؤدّي إلىٰ بنية. من ذلك علىٰ سبيل المثال، أنَّ التشكيك والعدميَّة والسفسطة لا يمكن أنْ تجتمع مع الواقعيَّة والفلسفات اليقينيَّة والمفهوميَّة لتُشكِّل بنية متناغمة ومنظَّمة. وبطبيعة الحال، يمكن لنا بمعنىٰ من المعاني أنْ نعتبر مجموعة غير متجانسة بوصفها مجموعة واحدة، ولكنَّها لن تكون مجموعة منظّمة في مثل هذه الحالة. إنَّ البنية ثلاثيَّة الأبعاد التي يذكرها حسن حنفي للوعي الأوروبي مجرَّد مفهوم اعتباري وانتزاعي بحت ليس له نظام خارجي، كأنْ نعمد في دائرة التفكير الإسلامي إلىٰ مفهوم التوحيد والشرك، والإيمان والكفر، وغيرها من المفاهيم المتعارضة لنجعل منها بنية واحدة مختلفة الأبعاد! إنَّ الذي يُشكِّل محورًا لوحدة جميع المدارس والأفكار الغربيَّة هو الجغرافيا والتاريخ الغربي، إلَّا أنَّ هذه الجغرافيا وهذا التاريخ لا يحتويان علىٰ أضلاع متوازيَّة كي تُقدِّم لنا مجموعة ذات بنية متعدِّدة الأبعاد. إنَّ بعض الأمثال والتنظيرات التي يذكرها حنفي، وإنْ كانت جيِّدة علىٰ مستوىٰ العبارات الشعريَّة والعاطفيَّة، ولكنَّها قابلة للنقاش من الناحية المعرفيَّة، فهو مثلًا يعمل في نهاية المطاف علىٰ تقسيم الوعي الأوروبي إلىٰ ثلاثة فروع، وهي: فلسفة الروح، وفلسفة الطبيعة، وفلسفة الوجود، ويرىٰ أنَّها علىٰ التوالي تنبثق عن مصادر الوعي الأوروبي المتمثِّلة في أفلاطون وأُرسطو وسقراط، في حين أنَّ
(124)هذا التنظير لا يلامس الواقع. إنَّ محاولة حسن حنفي في إثبات تاريخيَّة هذه البنية ببيان أنَّها كانت موجودة في جميع مراحل الوعي الأوروبي من المصادر إلىٰ النهايات، لا تنسجم مع المسار التاريخي لهذا الوعي.
7. هناك سؤال جوهري بشأن بنية الوعي الأوروبي، وهو: هل يمكن للبنية التي يرسمها حسن حنفي لهذا الوعي أنْ تعكس جميع حقائق الوعي الأوروبي؟ ألَا يمكن العثور علىٰ عناصر أُخرىٰ لها حضور في جميع مراحل الوعي الأوروبي وتكون في حدِّ ذاتها جزءًا مهمًّا من بنيته؟ وبعبارة أُخرىٰ: ألَا يمكن اعتبار التغيُّر والتحوُّل المستمرّ والمتواصل في التفكير الغربي، والذي يُعَدُّ من الخصائص الذاتيَّة للحداثويَّة، كاشفًا عن حقيقة أُخرىٰ في الوعي الأوروبي ذاته، حيث تحقَّقت بوساطتها هذه التحوُّلات من المصادر وفي مراحل التكوين إلىٰ العصور الوسطىٰ وعصر الحداثة وما بعد الحداثة؟
من خلال التأمُّل في الجوانب الثلاثة التي يذكرها حنفي تحت عنوان «العقل»، و«الحسّ»، و«الاتِّجاه المستقيم بينهما» بوصفها ممثِّلة لبنية الوعي الأوروبي، يتجلّىٰ عدم الثبات والاهتزاز والزوال واضحًا فيها علىٰ نحو صارخ، وهذا من خصائص هذا العالم والدنيويَّة، وفقدان جميع أنواع الاتِّجاهات القدسيَّة العميقة والأُخرويَّة والإلهيَّة. يجب فيما وراء الصورة الظاهريَّة، التي يرسمها حنفي لبنية الوعي الأوروبي، أنْ نبحث عن حقيقة أُخرىٰ تُمثِّل هذه الصورة انعكاسًا لها. وقد كانت هذه الذات قائمة في الكينونة التاريخيَّة والثقافيَّة لدىٰ الغرب، وهي «العدميَّة» ذاتها، علىٰ حدِّ تعبير بعض المحقِّقين.
لقد عمد حسن حنفي في هذا المقال إلىٰ تظهير العديد من المسائل والموضوعات، وفيما يلي سوف نتعرَّض لها باختصار وعلىٰ نحو الإجمال بعيدًا عن الاستغراق في التفصيل:
إنَّ من بين الأبحاث التي تحظىٰ باهتمام حسن حنفي، مسألة التحدّي الحضاري بين «الأنا» و«الآخر». والمراد من «الآخر» هو الحضارة الغربيَّة، في قُبال «الأنا» أو الحضارة الإسلاميَّة. وقد رسم حنفي المسار التاريخي لهاتين الحضارتين ومنعطفات كلِّ واحدٍ منهما ضمن رسمين بيانيين بشكل منفصل، ثمّ عمد إلىٰ بيان نقاط تداخلهما. والنموذج البياني أدناه يُمثِّل منعطفات الحضارة الإسلاميَّة من وجهة نظر حسن حنفي:
الخطُّ البياني لمسار الأنا
يرىٰ حنفي أنَّ الحضارة الإسلاميَّة تتألَّف من ثلاث مراحل، ويمتدُّ طول كلِّ واحدٍ من هذه المراحل إلىٰ سبعمائة عام (سبعة قرون)، وتتمثَّل نقطة البداية
(126)في المرحلة الأُولىٰ من ظهور الإسلام وبداية الحضارة الإسلاميَّة وظهور العلوم الإسلاميَّة في القرنين الأوَّل والثاني، ثمّ بعد عصر الترجمة في القرن الثاني. ثمّ بلغت العلوم الإسلاميَّة كلُّها الذروة في القرنين الرابع والخامس. وقد اقتربت هذه المرحلة من نهايتها من خلال قضاء الغزالي علىٰ العلوم العقليَّة في نهاية القرن الخامس للهجرة، وبداية توقُّف العلوم في القرنين السادس والسابع بالرغم من محاولة ابن رشد. ثمّ ظهر ابن خلدون في نهاية المرحلة الأُولىٰ ليُؤرِّخ لازدهار الحضارة الإسلاميَّة وانهيارها. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ من القرن الثامن للهجرة وتستمرُّ إلىٰ القرن الرابع عشر وتنتهي بالتحرُّر من عصر الاستعمار، يتوقَّف العقل عن الإبداع، ويحلُّ محلَّه الشرح والتلخيص وتدوين الموسوعات الكبرىٰ. وأمَّا في المرحلة الثالثة، التي تبدأ من القرن الخامس عشر للهجرة، فتبدأ المرحلة الثانية من الإبداع بعد المرحلة الأُولىٰ وهي الفترة التي سمَّيناها فجر النهضة العربيَّة، ونحن الآن في نهاية المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة، لذلك نحن في حاجة إلىٰ ابن خلدون جديد، يُؤرِّخ للمرحلة الثانية، ويضع شروط النهضة للمرحلة الثالثة، وقد ذكر حنفي في بعض مؤلَّفاته أنَّه يحمل علىٰ عاتقه تمثيل دور ابن خلدون. وبطبيعة الحال، فإنَّ حنفي لا يُنكِر وجود بعض عناصر الإبداع حتَّىٰ في المراحل النهائيَّة من كلِّ دورة، كما هي الحال بالنسبة إلىٰ ابن رشد في القرن السادس في الأندلس، أو صدر المتألِّهين الشيرازي في منتصف المرحلة الثانيَّة (القرن العاشر للهجرة)، بيد أنَّ هذه الموارد جزئيَّة، وإنَّ تلك المراحل الثلاثة هي الغالبة علىٰ روح الحضارة ومسارها في التاريخ.
وأمَّا المخطَّط البياني لمراحل الحضارة الغربيَّة، فهو علىٰ الشكل أدناه:
الخطُّ البياني لمسار الآخر
المرحلة الأُولىٰ عصر آباء الكنيسة، والمرحلة الثانية العصر المدرسي، والمرحلة الثالثة العصور الحديثة.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ الحضارة الأوروبيَّة، خلافًا للحضارة الإسلاميَّة التي تحظىٰ بالثقة بسبب امتلاكها للدافع الحيوي فيما يتعلَّق بمرحلتها الثالثة، مفتقرة إلىٰ الثقة فيما يرتبط بمرحلتها الرابعة (من القرن الثاني والعشرين إلىٰ القرن التاسع والعشرين للميلاد)، بعد أنْ خفَّ الدافع الحيويّ في الوعي الأوروبي. وعليه، يطرح الآن هذا السؤال نفسه: هل ستكون هناك مرحلة رابعة للوعي الأوروبي، أم أنَّ الحضارة الأوروبيَّة ستُسلِّم الريادة لحضارة أُخرىٰ؟.
وبعد رسم المنحني البياني للحضارتين الإسلاميَّة والغربيَّة، عمد حسن حنفي إلىٰ بيان نقاط التداخل بينها في ثلاث مراحل تاريخيَّة، علىٰ النحو أدناه:
تداخل مساري الأنا والآخر
في النقطة الأُولىٰ من التداخل كان «الآخر» (أُوروبا) يمكث في نهاية عصر آباء الكنيسة؛ أي القرن السابع للميلاد الذي يُمثِّل بداية ظهور الإسلام. وفي نقطة الالتقاء الثانية في القرن الرابع عشر للميلاد بالنسبة لمسار الآخر، كان مسار الآخر قد بدأ في الارتفاع من جديد، وذلك بفضل التحوُّل من الأفلاطونيَّة إلىٰ الأُرسطيَّة، واكتشاف العقل والطبيعة، وأثر الحضارة الإسلاميَّة عبر الترجمات من العربيَّة إلىٰ اللّاتينيَّة. أمَّا بالنسبة إلىٰ مسار الأنا، فقد بدأت الحضارة الإسلاميَّة منذ القرن السابع إلىٰ القرن الرابع عشر للهجرة تسلك سبيل النزول والانحدار. نقطة الالتقاء الثالثة هي المرحلة التي يبلغ فيها «الآخر» بعد اجتيازه مراحل البداية ليصل ذروة منتهاه في العصور الجديدة، حيث يتَّجه نحو الأزمة والأُفول، في حين بدأت الحضارة الإسلاميَّة مرحلة جديدة في الصعود. والنتيجة التي يصل إليها حسن حنفي من خلال نقاط الالتقاء بين هاتين الحضارتين طبقًا لهذا المخطَّط البياني، هي أنَّه كلَّما كانت دورة الأنا في القمَّة تكون دورة الآخر في القاعدة، وإذا كانت دورة الأنا في القاعدة تكون دورة الآخر في القمَّة. وعندما يكون الأنا أو الآخر في القمَّة يكون هو الأُستاذ، وعندما يكون في القاعدة يكون هو التلميذ، ويأخذ العلوم والمعارف من الرأس والقمَّة. وفي المرحلة الأُولىٰ كان «الأنا» في القمَّة، وأمَّا في المرحلة الثانية فقد كان في القاع والحضيض، وفي هذه المرحلة (القرن التاسع عشر والقرن العشرين للميلاد) قامت حركة الترجمة من الآخر (الغرب) إلىٰ الأنا (الشرق). يرىٰ حسن حنفي أنَّه بالنظر لتداخل المسارين، فقد كوَّن كلٌّ من الأنا والآخر صورة ذهنيَّة في وعيه عن الآخر، فكانت صورة الآخر في
(129)وعي الأنا صورة كريمة وعاقلة ومستنيرة، بينما كانت صورة الأنا في وعي الآخر كريهة ومقيتة ومتخلِّفة، حتَّىٰ إذا كان «الأنا» في مرحلته الأُولىٰ التي تحتلُّ القمَّة والذروة.
إنَّ السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا: ما هو مصير الوعي الأوروبي؟ يقول حسن حنفي في هذا الشأن: إنَّ الوعي الأوروبي بعد أنْ اجتاز مراحله المختلفة، بلغ به الأمر إلىٰ ارتداء ثوب التشاؤم واستحوذت عليه روح العدميَّة. إنَّ الفلسفات العدميَّة تُمثِّل واحدة من المظاهر المهمَّة للعدميَّة في الوعي الأوروبي. وقد تراكمت فلسفات العدم في الوعي الأوروبي في مرحلة بداية النهاية، بحيث أصبحت إحدىٰ علاماته الرئيسة ومؤشِّرًا علىٰ مصيره المحتوم. وعلىٰ الرغم من أنَّ نيتشه قد سبق أوانه في التعبير عن أزمة العصر، إلَّا أنَّه يُعَدُّ أكبر ممثِّل لها في انتهائه إلىٰ العدميَّة الشاملة. لقد كان الإعلان عن موت الإله، ورفض كلِّ الفلسفات الميتافيزيقيَّة، تأسيسًا للاهوت جديد باسم «لاهوت موت الإله»، حيث يتمُّ فيه الحديث عن كلِّ شيء إلَّا عن الله، أو اللّاهوت العلماني إذ يتجلّىٰ الله في كلِّ شيء إلَّا في ذاته وصفاته وأفعاله. وكان موت الإله قد انتهىٰ لحساب الإنسان، ولم يعد هناك أيّ معيار عامٍّ وشاملٍ، ولم يبقَ إلَّا النسبيَّة في الطبيعة وفي الأخلاق، في الإنسان وفي العالم، وأصبح الإنسان المتغيِّر علىٰ أساس الظروف الزمانيَّة والمكانيَّة والخاضع للأهواء المختلفة مقياسًا لكلِّ شيء. وفي نهاية المطاف، خلصت الظاهريّات وانتهىٰ الوجوديُّون إلىٰ وصف الواقعيَّة الإنسانيَّة بأنَّها عدم وعبث
وثرثرة وغثيان، حتَّىٰ أضحىٰ الإنسان عند هايدغر وجودًا من أجل الموت، وعند غابرييل مارسيل وجود شخص يموت، وعند جان بول سارتر كان الوجود عدمًا وغثيانًا، وعند ألبير كامو كان الوجود الإنساني تناقضًا وسخفًا ولا معقولًا بلا غاية أو هدف، وعند سورين كيركيغارد كان الوجود الإنساني تناقضًا وفضيحةً وعارًا، حتَّىٰ انتهت كثير من الفلسفات الوجوديَّة إلىٰ العبث واللّامعقول علىٰ عكس الوعي الأوروبي في البداية عندما كان يتَّسم بالعقل والهدف والغاية والحُرّيَّة والتقدُّم. وحدث الأمر ذاته بالنسبة إلىٰ الفنِّ والموسيقا والرواية والرسم أيضًا، حيث سادت العدميَّة وموت الروح. وقد كانت هذه الأزمة في مجال الفنِّ تعبيرًا عن أعمق أزمة في الوعي الأوروبي في مرحلته الأخيرة.
لقد تجلَّت أزمة الوعي الأوروبي في المذاهب السياسيَّة، وفي الأيديولوجيّات، وفي القِيَم، وفي الاقتصاد، وفي الطاقة، وفي سباق التسلُّح والخطر النووي، وهو الأمر الذي عبَّر عنه الغربيُّون أنفسهم بانهيار الغرب وسقوط الغرب ونهاية الغرب. والغريب أنَّ الغرب بعد ذروة فلسفة التنوير وما بلغه الوعي الأوروبي، ينهار ذلك كلُّه في حربين أُوربيّتين طاحنتين قامتا علىٰ أيديولوجيّات عنصريَّة وفاشيَّة.
علىٰ الرغم من وجود الكثير من تجلّيات العبثيَّة والعدميَّة في الوعي الأوروبي، هل هناك من مظاهر أمل تلوح في الأُفق تجاه المستقبل والانبثاقة الجديدة؟
يذهب حسن حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ الحكم في هذا الشأن يتعلَّق بالموقف السياسي والحضاري للباحث، وما إذا كان ينظر إلىٰ النصف المملوء من الكأس أم إلىٰ نصفه الفارغ. فبالنسبة إلىٰ «الآخر» الأوروبي المتفائل من المركز والداخل، إنَّما ينظر إلىٰ النصف المملوء من الكأس، وبالنسبة إلىٰ المتشائم بالنسبة لمصير الوعي الأوروبي و«الأنا» من الأطراف إلىٰ الداخل، إنَّما ينظر إلىٰ النصف الفارغ من الكأس. ومن وجهة نظر حنفي، فيما يتعلَّق بالموقف السياسي والحضاري للباحث، ليس هناك من مجال للصواب والخطأ، بل الميزان والمعيار في هذه المعركة للرأي الذي سيثبت كلمته في المستقبل.
وعلىٰ حدِّ تعبير حنفي بالنظر إلىٰ النصِّ الفارغ من الكأس ومن جهات مختلفة، لا يمكن أنْ نرىٰ أيَّ مظهر من مظاهر الأمل في مصير ومستقبل الوعي الأوروبي، فلا كثرة الإنتاج الاقتصادي، ولا القوَّة العسكريَّة، ولا ثورة المعلومات، ولا وفرة إمكانات الرفاهيَّة والخدمات، ولا هبوب رياح الحُرّيَّة في أُوربا الشرقيَّة، يمكنه أنْ ينتشل أُوروبا من الواقع الذي تعيشه. كما أنَّه يرىٰ أنَّ العالم الثالث والشرق في المقابل مشتمل علىٰ مظاهر من الأمل، وأنَّها تُمثِّل النصف المملوء من الكأس.
د) الحركة الحضاريَّة من الغرب إلىٰ الشرق
يذهب حسن حنفي إلىٰ القول بأنَّ التقابل بين الغرب والشرق تقابل حضاري،
رغم اشتماله علىٰ منشأ جغرافي. وهو يرىٰ أنَّ هذه هي سُنَّة الوجود حيث لا تنتمي الروح في التاريخ إلىٰ عصر وحضارة معيَّنة، بل تنتقل من حضارة إلىٰ حضارة أُخرىٰ، ونحن اليوم نشهد أُفول الحضارة الغربيَّة وظهور عصر جديد في العالم الثالث، وكأنَّ روح التاريخ أثناء بزوغ الحضارة البشريَّة قد بدأت من الشرق، ثمّ اتَّجهت إلىٰ الغرب، من الصين إلىٰ الهند وفارس وما بين النهرين والشام، وصولًا إلىٰ مصر حيث يكتمل مسار الروح. وبعد ظهور الإسلام وانتقال الحضارة الإسلاميَّة في العصور الوسطىٰ من الشرق إلىٰ الغرب، استمرَّت حركة الروح في المرحلة الجديدة من الغرب. إنَّ عودة مسار الحضارات من الغرب إلىٰ الشرق من جديد، هو عود إلىٰ العمق التاريخي في الوعي الإنساني. إذ الوعي التاريخي في العالم الثالث يمتدُّ إلىٰ سبعة آلاف عام في الصين والهند وفارس وما بين النهرين ومصر، في حين أنَّ الوعي الأوروبي لا يمتدُّ لأكثر من ألفي عام. ومن هنا تقتضي المسؤوليَّة بنا أنْ نكتب فلسفة جديدة للتاريخ تردُّ الاعتبار إلىٰ الشرق.
إنَّ المخطَّط البياني الذي يرسمه حسن حنفي لمنعطفات الحضارتين الإسلاميَّة والغربيَّة يجب أنْ يستند إلىٰ العناصر الحضاريَّة المهمَّة؛ أي الفلسفة والعلوم والعرفان والفنّ والتكنولوجيا والنظام الاجتماعي، في حين يبدو أنَّ المعيار الرئيس الذي اعتمده حنفي في رسم هذا المخطَّط يقوم علىٰ ملاحظة التفكير الفلسفي أو العلوم الإسلاميَّة في بعض الأحيان، ولا سيّما في عصر الترجمة.
من ذلك مثلًا أنَّه يعتبر القرن الرابع والخامس الهجريين نقطة الذروة في العلوم الإسلاميَّة من ثلاث جهات، وهي: الكثرة والعقلانيَّة والعلميَّة، إلَّا أنَّه يعتبر نهاية القرن الهجري الخامس، بسبب هجوم الغزالي علىٰ العلوم العقليَّة، نهاية لتقدُّم الحضارة الإسلاميَّة، وبداية لتوقُّفها في القرن السادس والسابع للهجرة. وقد سمّىٰ المرحلة الثانية من هذا التاريخ إلىٰ القرن الرابع عشر مرحلة التوقُّف والركود والاشتغال بشرح المؤلَّفات السابقة وتدوين الموسوعات الكبرىٰ. وهناك الكثير من النقاش حول هذا المخطَّط البياني والتعابير التي يستخدمها حنفي في هذا الشأن:
أوّلًا: ما هي الأُسُس والمباني التاريخيَّة والمعرفيَّة التي قام عليها تقسيم مراحل الحضارة الإسلاميَّة إلىٰ مرحلتين قد انقضتا ومرحلة أُخرىٰ بدأت؟ وثانيًا لماذا تمَّ تحديد طول كلِّ مرحلة حضاريَّة بسبعة قرون؟ إنَّ المراحل التي حدَّدها حسن حنفي للحضارة الإسلاميَّة، والتي ترصد في الحقيقة مرحلتي الصعود والأُفول حتَّىٰ القرن الرابع عشر للهجرة، لا تنسجم مع تاريخ الحضارة الإسلاميَّة. يمكن بيان مراحل الحضارة الإسلاميَّة علىٰ نحو الإجمال كالآتي:
أ) إنَّ إقامة صرح الحضارة الإسلاميَّة في منتصف القرن الأوَّل للهجرة، تُعَدُّ أهمّ مرحلة في الحضارة الإسلاميَّة، حيث تمَّ غرس جذورها وأُصولها، وبالالتفات إلىٰ خصائص وحسّاسيَّة هذه المرحلة التاريخيَّة، فهي بحاجة قطعًا إلىٰ بحثها بشكل مستقلٍّ. وقد تبلورت هذه المرحلة بانطلاق دعوة النبيِّ الأكرم في مكَّة المكرَّمة وتأسيس الدولة النبويَّة واستقرارها في المدينة المنوَّرة.
ب) كانت مرحلة ظهور واتِّساع وازدهار الحضارة الإسلاميَّة قد بدأت
(134)بإرسال النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله رسائله إلىٰ الإمبراطوريّات العالميَّة الكبرىٰ في تلك المرحلة التاريخيَّة، ثمّ عصر الخلفاء الراشدين، وتوسَّعت رقعتها في عصر الخلفاء الأُمويِّين ومنتصف العصر العبّاسي لتبسط سيطرتها علىٰ ثلاث قارّات، وهي: (أفريقيا وآسيا وأُوروبا). وقد تمثَّلت الخصائص البارزة لهذه المرحلة في إقامة النُّظُم الاجتماعيَّة الجديدة، ووجود الهدف المشترك بين مختلف الأقوام والشعوب، وتبلورت العلوم الإسلاميَّة، والفتوحات، وترجمة التراث العلمي والفلسفي من الحضارات اليونانيَّة والهند وإيران. إنَّ الحضارة الإسلاميَّة في هذه المرحلة، علىٰ الرغم من افتقار الحكومة والنظام الاجتماعي إلىٰ نعمة وجود أهل البيت والأئمَّة الأطهارعليهمالسلام، والذي عرَّض بدوره الحضارة الإسلاميَّة إلىٰ الكثير من الأضرار، إلَّا أنَّها بسبب امتلاكها لبعض الأُصول الجوهريَّة للتفكير الإسلامي، تمكَّنت من السير في ركب اكتساب العلوم واجتذاب العناصر النافعة من سائر الحضارات الأُخرىٰ. إنَّ هذه النهضة العلميَّة في عصر البويهيِّين (نهاية القرن الهجري الرابع)، قد انفصلت من الناحية الكمّيَّة عن مركزها الأوَّل في بغداد وانتشرت علىٰ ربوع العالم الإسلامي كافّة، ومن الناحية الكيفيَّة يُعتَبر عصر البويهيِّين عصر النهضة العلميَّة والثقافيَّة الجديدة.
إنَّ هذه المرحلة، ولا سيّما منذ القرن الرابع إلىٰ بداية القرن السابع للهجرة، علىٰ الرغم من الحروب الصليبيَّة [أو حروب الفرنجة] والحروب الداخليَّة، تُمثِّل نقطة الذروة في الحضارة الإسلاميَّة، حيث أفرزت أفضل الآثار العلميَّة
في مختلف العلوم، وأشهر الشخصيّات العلميَّة في العالم الإسلامي، من أمثال: ابن سينا والفارابي. وأمَّا في أواخر القرن السادس وبدايات القرن السابع للهجرة، فقد ظهرت بوادر الركود بسبب ما يُسمّىٰ بالحروب الصليبيَّة والحروب الداخليَّة وانعدام الأمن.
ج) مرحلة التوقُّف والركود من القرن السابع إلىٰ القرن العاشر للهجرة، حيث أدَّت الحروب الداخليَّة، واندثار المراكز العلميَّة في العالم الإسلامي، والاختلافات المذهبيَّة بين المسلمين، والاختلاف بين الدولة العبّاسيَّة والفاطميِّين، والشرخ بين شرق وغرب الحضارة الإسلاميَّة، والهجمة المغوليَّة، إلىٰ تحطُّم البقيَّة الباقيَّة من الحضارة الإسلاميَّة. وبطبيعة الحال، شهدت هذه المرحلة ذاتها، ولا سيّما منذ النصف الأوَّل من القرن السابع إلىٰ نهاية القرن العاشر للهجرة، ذروة العرفان النظري، وخلافًا لما ذهب إليه بعض المنظِّرين، ومن بينهم حسن حنفي، فإنَّ التصوّف في حركته المعتدلة لم يكن هو السبب في أُفول الحضارة الإسلاميَّة، بل أسَّست في هذه المرحلة لـ «عصر المعرفة» في الحضارة الإسلاميَّة، حيث شهدت هذه المرحلة ظهور كبار العرفاء الإسلاميِّين من أمثال: محيي الدِّين بن عربي، ونجم الدِّين الرازي، ومولانا جلال الدِّين الرومي، وعبد الرزّاق الكاشاني، والسيِّد حيدر الآملي، وغيرهم من كبار العرفاء. وعليه، فإنَّنا في هذه المرحلة لا نشهد أُفولًا مطلقًا للحضارة الإسلاميَّة في هذا الشأن.
د) مرحلة تجديد الحضارة الإسلاميَّة من القرن العاشر إلىٰ الثالث عشر للهجرة، وفي هذه المرحلة تزامن ظهور ثلاث دُوَل إسلاميَّة تمثَّلت بالإمبراطوريَّة العثمانيَّة والصفويَّة والمغوليَّة (دولة الهند المغوليَّة)، وقد حملت هذه الدُّوَل لواء تجديد بناء الحضارة الإسلاميَّة. فقد تمكَّنت الإمبراطوريَّة العثمانيَّة في حدود جغرافيَّتها السياسيَّة من إقامة حركة حضاريَّة جديدة، كما تمكَّنت الدولة الصفويَّة من تأسيس مختلف حقول الفنِّ والفلسفة والتصوُّف والرياضيّات والفلك والطبِّ وما إلىٰ ذلك، لتقيم حضارة جديدة في ربوعها.
ه) مرحلة الانحطاط في القرن الثالث عشر والرابع عشر للهجرة، حيث شهدت هذه المرحلة ضعف الدولة العثمانيَّة والصفويَّة والمغوليَّة، ويجب اعتبار أحد أهمّ أسباب هذا الضعف في الهجوم الجديد للغرب علىٰ العالم الإسلامي. وفي هذه المرحلة نجد أنَّ تطوُّر الغرب واستيلاءه علىٰ عالم الإسلام، قد دفع النُّخَب من المسلمين إلىٰ الإجابة عن تخلُّف الدُّوَل الإسلاميَّة، وتقديمهم وصفات غربيَّة في هذا الشأن.
و) مرحلة اليقظة الإسلاميَّة أو تجديد حياة الإسلام، ولا سيّما بانتصار الثورة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، حيث شهدت هذه المرحلة صحوة شاملة من أجل العمل علىٰ إحياء الدِّين والقِيَم الإسلاميَّة في العالم الإسلامي. ويمكن بيان أهمّ خصائص هذه المرحلة في التفكير السياسي للإسلام أو الحكومة الإسلاميَّة، حيث تجلَّت مظاهرها البارزة في العالم السُّنّي والشيعي، ولاسيّما في
إيران الإسلاميَّة. ومن بين خصائص هذه المرحلة انتشار الإسلام في القارَّتين الأمريكيَّتين وفي أُوروبا وأفريقيا، وتجديد البناء الثقافي والقِيَم الإسلاميَّة لهذه المرحلة الحضاريَّة، واليوم يقوم النظام الإسلامي في إيران باستعراض المفاهيم الإسلاميَّة والجمهوريَّة والتقدُّم في جميع مجالات الحياة الاجتماعيَّة أمام مرأىٰ العالم علىٰ المستوىٰ العملي.
ثانیًا: خلافًا لرؤية حسن حنفي، لم تكن المرحلة الثانية، التي حدَّدها بالقرن الثامن إلىٰ القرن الرابع عشر للهجرة، مرحلة نهاية الإبداع والعمل علىٰ مجرَّد كتابة الشروح والموسوعات الكبرىٰ. فعلىٰ الرغم من اعتبار القرن السابع إلىٰ القرن العاشر للهجرة مرحلة الركود وتوقُّف الحضارة الإسلاميَّة بسبب الاستعمار الخارجي والحروب الداخليَّة، ولكنْ لا يمكن اعتبار الانحطاط في جميع الأبعاد والأنحاء الحضاريَّة لتلك المرحلة؛ حيث نشهد ذروة الفنِّ والعرفان في هذه المرحلة. يضاف إلىٰ ذلك أنَّ حنفي لم يأخذ بعين اعتباره مرحلة تجدُّد الحضارة الإسلاميَّة في العصر العثماني والصفوي والمغولي، في حين كان لهذه المرحلة نصيب كبير في الثقافة والعلوم والفنون والبنية الاقتصاديَّة والأنظمة الإداريَّة والسياسيَّة للعالم الإسلامي.
ثالثًا: خلافًا لرأي حنفي، فإنَّ مرحلته الثالثة التي يُعبِّر عنها بمرحلة الصحوة الإسلاميَّة، أو تجديد حياة الإسلام علىٰ حدِّ تعبيرنا، لا يمكن الوصول إلىٰ شرائط تحقُّقها علىٰ أساس نظريَّته؛ إذ إنَّ ذلك يُعَدُّ عين العودة
إلىٰ الغرب واستمرار الانحطاط الفكري والثقافي للمرحلة السابقة. وقد بدأ حنفي هذه المرحلة بالإسلام السياسي والعودة إلىٰ الثقافة الإسلاميَّة، والتي اعتبر الثورة الإسلاميَّة الإيرانيَّة تجلّيًا عينيًّا لها، وأصبحت نموذجًا ومثلًا للعالم الإسلامي والصحوة الإسلاميَّة.
رابعًا: لقد اعتبر حسن حنفي نقطة الذروة في الحضارة الغربيَّة بعد عصر النهضة إلىٰ القرن العشرين للميلاد متزامنة مع نقطة حضيضنا في هذه المرحلة، ورأىٰ أنَّ نسبة منزلة الحضارة الغربيَّة إلينا في هذه المرحلة هي نسبة الأُستاذ إلىٰ التلميذ، حيث تجري فيها المعارف والعلوم من الرأس إلىٰ القاعدة. بيد أنَّ هذه الصورة تنطوي علىٰ مغالطة؛ فأوَّلًا: أنَّ هذه النسبة هي صنيعة أُسلوب التعامل الاستعماري الذي انتهجه العالم الغربي تجاه المجتمعات الإسلاميَّة، وعليه لا يُعَدُّ ذلك فخرًا للغرب. وثانيًا: أنَّ نزولنا وهبوطنا في الحقيقة يُمثِّل نزولًا وهبوطًا عن المسار المتعالي للحضارة الإسلاميَّة في الماضي، ولذلك فإنَّ هبوطنا وصعودهم لم يكن علىٰ نسق واحد. وثالثًا: أنَّ الذي وصل إلينا منهم بوصفهم أساتذة لنا، طبقًا لتعبير حنفي، لم تكن ثمرته سوىٰ الاستغراب والتخلُّف. وعليه، لم نكن في تلك المرحلة بمنزلة التلميذ، ولم يكونوا بمنزلة الأُستاذ، وإنَّما العلاقة بيننا كانت استعماريَّة ومن قبيل العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر، في حين كانت العلاقة بيننا وبينهم في العصور الوسطىٰ والحضارة الإسلاميَّة هي علاقة الأُستاذ والتلميذ بكلِّ ما للكلمة من معنىٰ، حيث كانت الحضارة الغربيَّة تستقي الدروس من الحضارة الإسلاميَّة.
خامسًا: ينتهج حنفي في تقييمه لمستقبل الحضارة الغربيَّة وما إذا كانت
(139)تنطوي علىٰ مظاهر من الأمل أم لا، منهجًا نسبيًّا بالكامل، ويرىٰ أنَّ الحكم في هذا الشأن منوط بالاتِّجاه السياسي والحضاري الذي يسلكه المحقِّق، وما إذا كان ينظر إلىٰ النصف الممتلئ من الإناء أم إلىٰ نصفه الفارغ، وإلَّا ففي غير هذه الصورة ليس هناك، من وجهة نظره، ملاك وحقيقة أُخرىٰ للتمييز بين الصواب والخطأ. وفي نهاية المطاف يخلص حنفي إلىٰ نتيجة مفادها أنَّ علينا، فيما يتعلَّق بالعالم الثالث والشرق، أنْ ننظر إلىٰ النصف الممتلئ من الكأس، وأنْ نعتبر مظاهر الأمل بالمستقبل أمرًا واقعيًّا. وأمَّا بالنسبة إلىٰ أُوروبا، فيجب أنْ ننظر إلىٰ النصف الفارغ من الكأس، وأنَّ المستقبل وحده هو الكفيل بإثبات ما سوف تنتهي له الأُمور من خلال استعراض قوَّة كلا الرأيين وميزان وملاك اعتباره. والحقيقة هي أنَّ فنَّ النقد يقوم علىٰ أساس تقييم النصف الممتلئ من الإناء والتحليل الصحيح للنصف الفارغ من الكأس، وهذا النقد يحشد الاستعانة بجميع المباني الأنطولوجيَّة والأنثروبولوجيَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة. ومن الواضح أنَّ نسبيَّة حسن حنفي في تقييم الحضارة الغربيَّة سوف تبتلي بجميع العيوب والنواقص المعرفيَّة والمنهجيَّة التي تعاني منها «النسبيَّة».
بغضِّ النظر عن الانتقادات المرتبطة بكلِّ جزء من الآراء الاستغرابيَّة لحسن حنفي المطروحة في محلِّها، فإنَّ استغرابه في تقييم كلّي يواجه إشكالات جوهريَّة تُؤدّي باستغرابه إلىٰ التحوُّل إلىٰ استغراب مقلوب، وهو الاستغراب الذي عبَّر عنه حنفي نفسه بـ «الاستغراب المعكوس». وفيما يلي نُقدِّم أبعادًا من استغرابه المعكوس:
(140)1. إنَّ من بين الأسئلة المهمَّة حول ماهيَّة وغاية الاستغراب هو السؤال القائل: هل الاستغراب ينشد هدفًا آخر وراء نفي مركزيَّة أُوروبا وإعادته إلىٰ حدوده ومكانته الطبيعيَّة أم لا؟ ينصبُّ جلُّ نشاط حسن حنفي في مجمل مباحث الاستغراب علىٰ أنَّ الغرب وأفكاره ومدارسه نتاج شرائط تاريخيَّة وبيئيَّة خاصَّة، وفي الحقيقة فإنَّ كلَّ مدرسة من المدارس الغربيَّة إنْ هي إلَّا ردَّة فعل وانعكاس عن مدرسة أُخرىٰ قبلها أو معاصرة لها. وطبقًا لهذه الحقيقة، يجب الحدُّ من شموليَّة الغرب، والنظر إليه من الزاوية الاجتماعيَّة للغرب واعتباره حصيلة للشرائط والظروف الاجتماعيَّة الغربيَّة، وعدم القول بانتشاره في سائر المجتمعات الأُخرىٰ لاختلاف ظروفها الاجتماعيَّة. إنَّ هذه الرؤية الاجتماعيَّة لن تكون قادرة علىٰ النقد المعرفي والفلسفي الوارد في سياق التقييم الذاتي لظاهرة ما؛ إذ إنَّ حنفي ليس بصدد مثل هذا النقد علىٰ أساس مبنىٰ النسبيَّة، وكلُّ ما يمكنه هو الحفاظ علىٰ الغرب في إطار الغرب، والشرق في إطار الشرق. إنَّ هذا النوع من الاستغراب الذي يتنفَّس في فضاء النسبيَّة، ولا يكون لانتقاده الحضارة الغربيَّة من جوهر سوىٰ النسبيَّة، لا يستطيع الحيلولة دون انتقال العناصر الثقافيَّة والحضاريَّة للغرب. إنَّ الأفكار والتطوُّرات الثقافيَّة والحضاريَّة في أُوروبا، وإن كانت مرتبطة بالظروف التاريخيَّة والبيئيَّة لها، تُعتَبر تاريخيَّة من هذه الناحية، بيد أنَّ الأفكار لا تحبس نفسها ضمن حصار التاريخ والجغرافيا، ومن هنا فإنَّ نقدها لا يقوم علىٰ مجرَّد إرجاعها إلىٰ التاريخ ومصادر نشوئها. إنَّ ما هو متوفِّر في رؤية الاستغراب المريض والمعكوس، هو اتِّجاه «المركز ـ الأطراف»، بيد أنَّ الاستغراب
الحقيقي في إطار حذف هذه الرؤية، يحتاج قبل التفكير في نسبيَّة المنشأ إلىٰ إثبات الحقائق والملاكات الثابتة والمطلقة في نقد الثقافات والحضارات، وفي هذه الصورة يمكن نقد وتقييم الوعي الأوروبي. إنَّ هذا النوع من الاتِّجاه لا مكانة له في استغراب حنفي إلَّا في القليل من الموارد.
2. إنَّ حنفي إنَّما يقتصر في الجزء المتاخم للكلِّ من استغرابه علىٰ تاريخ الفلسفة الغربيَّة فقط، وخاض كما الفيلسوف في الجانب التاريخي من هذه الفلسفة، وهذه رؤية تقليليَّة ومجتزأة. وعلىٰ الرغم من أنَّ الفلسفة تُشكِّل عماد الغرب، ولكنَّها ليست الغرب كلَّه، وإنَّما ينبغي النظر إلىٰ الغرب بجميع تجلّياته الحضاريَّة. وقد ارتكب حنفي ذات الغفلة فيما يتعلَّق بتناوله لحقل التراث الإسلامي أيضًا، ومن هنا فقد تمَّ تجاهل الكثير من المواطن الحضاريَّة في التراث الإسلامي. ومن هذه الناحية يمكن القول بأنَّ حنفي قد تأثَّر بهوسِرْل حيث اعتبر في أعماله، ومن بينها رسالته في تأزُّم العلم الأوروبي، الفلسفة والهويَّة الوجوديَّة لأُوروبا شيئًا واحدًا. إنَّ الاستغراب عند حنفي لا يُقدِّم للقارئ معلومات عن معتقدات الحضارة الغربيَّة في الحقل الأنثروبولوجي والفلسفات السياسيَّة والأنظمة الاقتصاديَّة والآراء الثقافيَّة.
3. إنَّ حنفي حتَّىٰ في رؤيته الفلسفيَّة أو التأريخيَّة، كما هو شأن سائر المؤرِّخين أو فلاسفة الغرب، إنَّما يقتصر علىٰ النقل التاريخي للفلسفات، وقلَّما يخوض في حقل التحليل والربط بينها، لا سيّما وأنَّه لا ينتقد من زاوية تفكيره الوعي الغربي (بثوبه الفلسفي). لا يستوحي القارئ لأدبيّاته في الأجزاء المرتبطة بمصادر الوعي الأوروبي في بدايته وذروته ونهايته أنَّه مفكِّر
شرقي قد كتب ذلك بداعي التعرُّف علىٰ الغرب. وقد التفت محمود أمين العالم إلىٰ ما يشبه هذا النقد أيضًا. بل إنَّ حنفي في كتابه (مقدّمة في علم الاستغراب) بسبب الحجم الكبير لموضوع تحقيقه؛ أي الفلسفات الغربيَّة من اليونان والروم إلىٰ القرن العشرين، لم يُحقِّق نجاحًا ملحوظًا في تاريخ الفلسفة؛ إذ اكتفىٰ بمجرَّد تقرير عامٍّ للفلسفات الغربيَّة فقط. يبدو أنَّ غايتنا الرئيسة في الاستغراب قبل التعرُّف إلىٰ الغرب كما هو في حدِّ ذاته، تقوم في الغالب علىٰ معرفة الغرب من زاويتنا، بمعنىٰ العمل علىٰ الدوام علىٰ مقارنة الغرب في جميع مراحله التاريخيَّة بأنفسنا، وإلَّا سنكون قد تناولنا الغرب كما هو، وهذا في الحقيقة هو ما تكفَّل به الغربيُّون أنفسهم وتاريخ الفلسفة.
هذا في حين أنَّ الجزء المتاخم للكلِّ من كتاب «مقدّمة في علم الاستغراب» لا يُلبّي هذه الغاية، وإنَّما القسم الأخير منه الخاصُّ بـ «مصير الوعي الأوروبي» قد استوعب بيان نسبته إلىٰ التراث الإسلامي، وحتَّىٰ في هذا القسم لم يتمّ بحث الموضوع بالشكل المناسب؛ إذ اكتفىٰ بمجرَّد بيان رسم بياني لتداخل الحضارة الإسلاميَّة والحضارة الغربيَّة، دون مزيد من التوضيح والتحليل، ولا يخفىٰ أنَّ هذا لا يفي ببيان المطلوب طبعًا. ربَّما كان المقال الخاصُّ بـ «بنية الوعي الأوروبي» لوحده كافيًا عن جميع الأبحاث التفصيليَّة السابقة؛ إذ إنَّه يُعرِّفنا بعموم الوعي الأوروبي وخصائصه في مجمل تاريخه، وهذا المقدار يكفي ليكون مقدّمة لتنظيم ارتباطنا بالغرب ورسم معالمه في المستقبل.
4. إنَّ هذا الادِّعاء لافت من جانب حنفي، حيث لا يعتبر استغرابه مجرَّد
تحليل تنظيري للوعي الغربي وحضارته، بل هو نوع من الممارسة العمليَّة في قبال جدل «الأنا والآخر»، حيث يسعىٰ إلىٰ التحرُّر الثقافي والحضاري من هيمنة الآخر، في حين لا نرىٰ في أيِّ واحدٍ من فصول هذا الكتاب الضخم فصلًا مستقلًّا خاصًّا بهذا البحث رغم أهمّيَّته الكبيرة. إنَّ شعوب الشرق، ولاسيّما المجتمعات الإسلاميَّة منها، التي عانت من وطأة الاستعمار المقيت والنفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي للعالم الغربي، تحتاج إلىٰ طرح نظري وعملي محدَّد من أجل الخروج من هذا الوضع البائس، في حين أنَّ مشروع حنفي لا يُقدِّم لنا أيَّ طريق واضح في مواجهة الغرب، فلا هو يُقدِّم العناصر التي يمكن لنا الانتقاء من بينها، ولا هو يُبيِّن لنا سُبُل الخروج منها والعمل علىٰ مواجهة العناصر السلبيَّة.
5. يعترف حسن حنفي بأنَّ تراثنا القديم في مواجهة الحضارة اليونانيَّة والروميَّة قام في بداية الأمر بالترجمة، واستمرَّ ذلك قرنًا من الزمن، ولكنَّه لم يكتفِ بهذا المقدار، وإنَّما عمل علىٰ نقده علىٰ مدىٰ قرنين من الزمن، وأقبل نحو بناء الاتِّجاه التأسيسي، في حين أنَّنا في الاتِّجاه المعاصر ما نزال بعد قرن ونصف نواصل أعمال ترجمة التراث الغربي فقط. والسؤال الجوهري يقول: ما هي الأشياء التي تُشكِّل مناطًا لظهور آرائنا الحضاريَّة المعاصرة بالنسبة إلىٰ الحضارة الغربيَّة؟ وهل أمكن لاستغراب حنفي أنْ يبلغ بهذه الرسالة إلىٰ غايتها؟ إنَّ أكثر التقييمات تفاؤلًا لهذا الكتاب تذهب، علىٰ حدِّ تعبير حنفي
نفسه، إلىٰ أنَّه مجرَّد استعراض المدارسة الفلسفيَّة الغربيَّة علىٰ أساس بيئتها وتاريخها الخاصِّ، وإنَّ كلَّ واحدة من هذه المدارس تُمثِّل ردَّة فعل ناظرة إلىٰ بعضها، ولا يمكن فهمها وإدراكها إلَّا من خلال إحالتها إلىٰ وضعها التاريخي والبيئي، ولذلك لا يمكن نقلها إلىٰ حضارة أُخرىٰ. وحاصل هذا الكلام أنَّها ليست ناظرة إلينا. إذاً، للغرب تاريخه وجغرافيَّته الخاصَّة، ولا يمكن تعميمه علىٰ الجغرافيّات الأُخرىٰ. إنَّ هذا الاتِّجاه لا يُنتِج تحليل الغرب من زاوية الأنا، بل ويعجز عن تقييمه أيضًا؛ إذ لا يمكن بمجرَّد إحالة الفلسفة والحضارة الغربيَّة إلىٰ تاريخها وجغرافيَّتها المنع من توسيعها وتعميمها، إلَّا إذا كان منطقنا غير قائم علىٰ مجرَّد مصادر نشوء الثقافات، بل أنْ نُثبِت بالمنطق الفلسفي والمعرفي الخاصِّ أنَّ الغرب غير جدير بالعالميَّة، في حين أنَّ حنفي لم يُؤلِّف الاستغراب في هذا الاتِّجاه، فقد أعلن صراحةً بأنَّنا في بنية المدارس الفلسفيَّة للغرب لا نمتلك مذهبًا مطلقًا وثابتًا، وإنَّما الجميع عبارة عن أُمور نسبيَّة، والحقيقة متغيِّرة، وإنَّ الحقيقة الثابتة الوحيدة هي روح العصر والشرائط الاجتماعيَّة والتاريخيَّة للوعي الأوروبي.
وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ حنفي لم يتمكَّن حتَّىٰ هذه المرحلة من تحقيق واقعة حدثت في تراثنا القديم أي الاتِّجاه التأسيسي. ما هي نسبة الحضارة الغربيَّة بكلِّ ما تشتمل عليه من العلوم والفنون بالنسبة لنا؟ وما هي نقاط التفوُّق والضعف والتي يمكن اقتباسها أو تغييرها أو الموارد التي يمكن إضافتها أو حذفها في المواجهة بين هاتين الحضارتين؟ لا يمكن للاستغراب
أنْ يتَّخذ موقف الحياد والسكوت تجاه هذه الأسئلة الجوهريَّة، في حين أنَّ حنفي لم يُجِب عن هذه الأسئلة في استغرابه. قد يُدَّعىٰ أنَّ مشروعه تجاه تراثنا القديم وقراءته الجديدة التي قدَّمها في علوم التراث الإسلامي، تشبه الاتِّجاه التأسيسي للمتقدِّمين. والجواب عن هذا الادِّعاء واضح، وذلك أنَّ المتقدِّمين في اتِّجاههم التأسيسي لم يعملوا علىٰ إجراء التغيير والتحوُّل في تراثهم بغية جعله متناغمًا مع تراث الآخرين، بل عملوا علىٰ استخدام وتوظيف تراث الآخرين بما يتناسب مع تراثهم، في حين أنَّ حسن حنفي قام بمشروعه «نسبتنا إلىٰ التراث القديم» وإعادة قراءته بهدف إيجاد التغيير والتحوُّل ورفض التفاسير القديمة.
إنَّ الإلهامات التي يقتبسها حنفي من كثرة ظهور المذاهب الفلسفيّة في الغرب، ويعتبرها مفيدة لمجتمعاتنا، جديرة بالالتفات:
أ) الردُّ والرفض المهيب للتراث القديم، مهما كان هذا التراث مشتملًا علىٰ مراتب من الصدق والصواب؛ إذ إنَّ الواقعيَّة سوف تُبطِلها حتمًا.
ب) إنَّ تجريد الواقعيَّة من كلِّ غطاء فكري واعتقادي سابق، يُؤدّي إلىٰ إيجاد دافع قويٍّ لظهور نظريَّة جديدة من قِبَل المحقِّق.
ج) يمكن لمختلف مذاهب الحضارة الغربيَّة أنْ تعرض نماذج لمواجهة تقليد التراث القديم والسعي من أجل كشف الواقع إلىٰ الحضارات الأُخرىٰ.
د) إنَّ هذه المدارس تكشف قوَّة العقل البشري في الوصول إلىٰ الحقائق وما إلىٰ ذلك.
إنَّ هذه الدروس التي يستلهمها حنفي من الحضارة الغربيَّة المعاصرة، لن تُؤدّي إلَّا إلىٰ انهيار التراث القديم.
6. كما سبق أنْ أشرنا، فإنَّ حسن حنفي في العديد من الموارد يعمد إلىٰ القيام بتشبيهات وتطبيقات خاطئة بين التيّارات والمذاهب الفلسفيّة للغرب وتيّارات ومدارس من الحضارة الإسلاميَّة، وفيما يلي نشير إلىٰ جانب من هذه الموارد:
أ) إنَّه يعتبر تركيب وتقارن الفلسفة الأُرسطيَّة مع المسيحيَّة من نوع التجوهر الكاذب، حيث يتمُّ إظهار الجوهر الأُرسطي بلغة وأدبيّات مسيحيَّة، وهذه الصياغة تُمثِّل تجوهرًا كاذبًا. ثمّ ظهر مثل هذا التقارن والتركيب في الفلسفة الإسلاميَّة علىٰ يد الفلاسفة المسلمين، وتحدَّث حنفي عن تشكُّل أو تصوير كاذب في هذا الشأن، كما كان الأمر كذلك في الفلسفة الأُرسطيَّة والمسيحيَّة. وفيما يتعلَّق بالفلسفة الإسلاميَّة، ولا سيّما في تراث فلاسفة من أمثال: الفارابي، وابن سينا، والخواجة نصير الدِّين الطوسي، وصدر المتألِّهين الشيرازي، ظهرت حقيقة جديدة عن الفلسفة مختلفة جدًّا عن فلسفة أُرسطو، وإنَّ مثل هذا الحكم يبدو من خلال الرجوع إلىٰ الفلسفة الإسلاميَّة مجانبًا للإنصاف العلمي إلىٰ حدٍّ كبير، بل حتَّىٰ التجوهر الكاذب بشأن الفلسفة المسيحيَّة مخالف للواقع، فإنَّ الرجوع إلىٰ بعض المصادر ذات الصلة، يُثبِت أنَّ الفلسفة المسيحيَّة تختلف عن الفلسفة الأُرسطيَّة في الكثير من الموارد.
ب) إنَّ حسن حنفي في الكثير من الموارد يعتبر كلَّ نوع من أنواع العقلانيَّة في
العقائد المسيحيَّة مشابهًا للتيّار الاعتزالي في قبال التيّار الأشعري، في حين أنَّ هذا النوع من التشابه والتناظر لا يمكن أنْ يكون صحيحًا، ولا يتناسب في الأساس مع هدفه في الاستغراب. من ذلك، علىٰ سبيل المثال، أنَّه يرىٰ الاتِّجاه العقلاني بمعنىٰ عقلنة القضايا والمعتقدات الدِّينيَّة المسيحيَّة في إطار العقل الأوروبي، مشابهًا لاتِّجاه المعتزلة في التراث الإسلامي، في حين أنَّ تيّار المعتزلة ليس له أيَّ شبه بالعقلانيَّة بالنسبة إلىٰ النصوص الدِّينيَّة.
هناك الكثير من المغالطات في كلام حنفي بهذا الشأن، من ذلك مثلًا أنَّ ليسنج ينقل في القرن الثامن عشر للميلاد أنَّ عصر النبوَّة قد انتهىٰ؛ لأنَّ الإنسان قد بلغ مرحلة من الرشد بحيث أصبح غنيًّا عن الهداية والتدخُّل الخارجي، وعندها قال حنفي: إنَّ الإسلام قد أعلن عن هذا الأمر قبل أكثر من ألف سنة، ومن هنا كانت العقلانيَّة الأوروبيّة الجديدة تُمثِّل امتدادًا للعقلانيَّة الإسلاميَّة والاعتزاليَّة. في حين أنَّ هذه المقارنة وهذا الاستنتاج باطل من الأساس، إذ لم يُترَك الإنسان في أيِّ مفهوم ديني إلىٰ عقله، بحيث يكون في غنىٰ عن الهداية والوحي والنقل أبدًا.
7. إنَّ من بين التناقضات الواضحة في كلام حنفي في الاستغراب أنَّه في بداية كتابه «مقدّمة في علم الاستغراب» يتحدَّث عن ضرورة إعادة الغرب إلىٰ حدوده الطبيعيَّة والجغرافيَّة، وقال بأنَّ استغرابه يستطيع الإعلان عن نهاية الأُسطورة العالميَّة للغرب، في حين أنَّه في البحث عن «بنية الوعي الأوروبي» يذكر للذهنيَّة الأوروبيةّ خصوصيَّتين، وهما: «الانفصال المعرفي» للوعي الأوروبي عن تراثه القديم، و«تجرُّد الواقعيَّة عن النظريَّة»، ثمّ عرَّف بهاتين
الخصوصيَّتين بوصفهما خير مثال يمكن تعميمه علىٰ حضارتنا إذا أردنا التقدُّم والتطوُّر. إنَّ التمسُّك بوجهة نظر محمّد أركون ومحمّد عابد الجابري القائمة علىٰ ضرورة الفصل بين الماضي والحاضر بوصفه من مسؤوليَّتنا الحضاريَّة، لا يعني في الحقيقة غير الاحتماء بظلال الآخرين؛ إذ إنَّه يقول صراحةً: إنَّ تجرُّد الواقعيَّة والعالم الخارجي عن النظريّات السابقة، كما حدث في أُوروبا، لم يتحقَّق بعد في مجتمعاتنا المعاصرة، بل إنَّنا ما نزال نعيش مرحلة تفسير العالم في ضوء نظريّات التراث، فهل يأتي هذا الاستنتاج في سياق تحجيم الغرب وحشره ضمن حدوده الطبيعيَّة، أم في سياق تعميمه علىٰ ما هو أبعد من أُوروبا؟!
إنَّ حنفي علىٰ الرغم من قوله بأنَّ المجتمعات غير الأوروبيّة لا تستطيع الأخذ بهذه المذاهب المختلفة التي تُعبِّر عن تحوُّل النظريّات بالنسبة إلىٰ واقعها الخاصِّ، إلَّا أنَّه من خلال بيانه اللاحق يُفرِّغ هذه الجملة من خاصّيَّتها وتأثيرها؛ إذ يقول: إنَّ المدارس المختلفة في الوعي الأوروبي تُمثِّل نماذج فكريَّة للمجتمعات غير الأوروبيّة، لعلَّها ترجع إليها عند مقارنتها بالأفكار القديمة والسعي إلىٰ إعادة تفسير الواقع مجدَّدًا.
8. هل الوعي الأوروبي أفضل من أمثاله في البُعد الإنساني والتاريخي؟ إنَّ الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب يقتضي نوعًا من الحكم القِيَمي والأخلاقي في ترجيح الوعي الأوروبي علىٰ سائر الحضارات. في حين إذا كان مراد حنفي أنَّ حضارة الغرب والوعي الأوروبي من حيث التحوُّلات السريعة التي اتَّسعت رقعتها، شديدة التاريخيَّة وناظرة إلىٰ شرائط عصرها، فإنَّ هذا الادِّعاء يُثبِت أنَّ الوعي الأوروبي «أكثر تاريخيَّة»، دون أفضليَّته كما يبدو من عبارة حنفي.
إنَّ شدَّة تاريخيَّة الوعي الأوروبي عبارة أُخرىٰ عن نسبيَّته، وعليه فإذا لم تكن جميع الأفكار الوطنيَّة الأُخرىٰ من السنخ الزماني والمكاني، بل كانت تفوق الزمان والمكان، ولكنَّها إنسانيَّة في الوقت نفسه، فما هي المزيَّة التي سوف تترتَّب علىٰ تاريخيَّتها؟! ثمّ ما هو الدليل الذي يجعل من أهمّيَّة مفهوم التاريخ والزمان بالنسبة إلىٰ الإنسان الغربي، أكثر إنسانيَّة وأفضل من سائر الناس، أو أنَّ هذه الفلسفة التي أعطت إلىٰ الإنسان بُعدًا زمانيًّا ستبدو أفضل من سائر الاتِّجاهات الإنسانيَّة الأُخرىٰ؟!
يتعرَّض حسن حنفي في جميع هذه الموارد إلىٰ أفضليَّة الوعي الأوروبي من الناحية التاريخيَّة والإنسانيَّة من دون تقديم أيَّ دعامة نظريَّة، بل وحتَّىٰ من دون مقارنة بين المعطيات الحضاريَّة، في حين أنَّ توظيف هذه المفاهيم التي هي أشبه بالمشتركات اللفظيَّة، زاخرة بالمغالطات.
لقد اشتمل التراث الإسلامي علىٰ أكثر الحقائق والقِيَم الإلهيَّة والإنسانيَّة أصالةً، وقد شكَّل ذلك أُسُس الهويَّة الإسلاميَّة للمسلمين، وإنَّ هذه الأُصول والقِيَم ليست تابعة للاعتبارات الزمانيَّة والتاريخيَّة حتَّىٰ تتقبَّل التفسيرات العصريَّة والميثولوجيَّة السائدة في العالم الغربي. ومن هنا فقد سعىٰ حنفي من خلال الاتِّجاه التجديدي إلىٰ إصلاح التراث الإسلامي، وبذلك يكون قد ابتلىٰ بالمصير ذاته الذي ابتلىٰ به سائر أقرانه من المستنيرين المتأثِّرين بالغرب. بل إنَّ المنزلق الذي سقط فيه حنفي في هذه الناحية أكثر تجذُّرًا علىٰ ما سيأتي بيانه في نقد أفكاره. ولهذه الغاية سنعمل في البداية علىٰ بحث ومناقشة ماهيَّة وخصائص التراث
(150)
الإسلامي من وجهة نظر حنفي، لننتقل بعد ذلك إلىٰ بيان وتقييم آرائه في حقل إصلاح التراث، وأساليب الإصلاح، وتطبيقاته في إصلاح العلوم الإسلاميَّة.
ماهيَّة التراث الإسلامي
يرىٰ حسن حنفي أنَّ التراث مجموعة من العناصر التي ورثناها من الماضي ومن صلب الحضارة والثقافة السائدة في كلِّ عصر، ولهذا التراث خصوصيَّتان؛ فهو من جهة يحتوي علىٰ مقتضيات المتقدِّمين، وبذلك يكون متعلِّقًا بالماضي، ومن جهة أُخرىٰ ينتمي إلىٰ مقتضيات الشرائط الراهنة في المجتمع والثقافة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّنا من وجهة نظر حنفي لسنا أمام ظاهرتين، وهما: «التراث» و«التجديد»، بل أمام نقطة انطلاق باسم «التراث»، وعلينا أنْ نُفسِّره بوصفه «مسؤوليَّة ثقافيَّة وقويَّة» بما يتطابق مع حاجة العصر.
يرىٰ حنفي أنَّ التراث يُمثِّل بداية للتجديد كما هو وسيلة له؛ لأنَّ إصلاح التراث الإسلامي أو التراث القديم يعني، من وجهة نظره، تفسيرًا جديدًا له بما يتطابق مع حاجة العصر، وبذلك يكون التراث وسيلة، والتجديد هو الغاية. والنتيجة الأُخرىٰ التي يصل إليها حنفي هي أنَّ التراث ليس قيمة في ذاته إلَّا بقدر ما يُعطي من نظريَّة عمليَّة في تفسير (الواقع المعاصر) والعمل علىٰ تطويره. ومن هنا فإنَّه يقول: إنَّ التراث يجب أنْ يكون «نظريَّة للعمل» والتقدُّم، وليس متحفًا للأفكار نفخر بها.
يذهب حسن حنفي، طبقًا للمبنىٰ الظاهراتي، إلىٰ القول بأنَّ التراث يُمثِّل
تعبيرًا عن الماضي، له حضور في صلب شعور المجتمع، وأنَّ التجديد يُعبِّر عن الحال الحاضر الدالِّ علىٰ تغيير التراث بما يتناسب مع الحاضر، وإنَّهما يتظاهران ويُؤسِّسان علمًا جديدًا باسم «التراث والتجديد». كما يُؤكِّد حنفي علىٰ أنَّنا من خلال نموذج التراث والتجديد نستطيع إظهار البُعد التاريخي من وجداننا المعاصر، ونأمن بذلك من آفتين ومشكلتين، وهما: مشكلة الجمود والتوقُّف، ومشكلة التقليد والتبعيَّة للآخرين.
نعالج فيما يلي ماهيَّة وخصائص التراث الإسلامي، وكذلك ضرورة إصلاحه من وجهة نظر حسن حنفي. فقد ذكر حنفي خصائص خاصَّة للتراث الإسلامي علىٰ النحو الآتي:
يرىٰ حنفي أنَّ التراث ذخيرة وطنيَّة وقوميَّة، يمكن ادِّخارها بوصفها ثروة ومسؤوليَّة قوميَّة وثقافيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ التراث ناظر علىٰ الدوام إلىٰ شرائطه وظروفه الزمنيَّة وبما يتناسب معها، بل هو جزء من تلك الواقعيَّة التي يُفسِّرها. إنَّه يعتبر الواقع العيني مؤلَّفًا من جزأين، أحدهما يُمثِّل القاعدة الشاملة للأوضاع الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة، والآخر يرتبط بالبناء وهو يشتمل علىٰ الآراء والنظريّات والتراث. إنَّ هذين الجزأين يتَّحدان في بنية الإحساس والشعور الاجتماعي، ويعملان علىٰ توجيه سلوك آحاد الناس.
وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ الواقع الاجتماعي من وجهة نظره هو الاتِّجاهات الروحيَّة والنفسيَّة والسلوك الاجتماعي ذاتها للأفراد كافّة، وإنَّ التراث القديم جزء من هذه الواقعيَّة الحيَّة. كما أنَّ التراث في حدِّ ذاته ليس له وجود فعلي، بل إنَّما يمكن إدراكه عندما يلعب دورًا في التغيير الاجتماعي، أو يتمُّ توظيفه من قِبَل السلطة بوصفه أداة للسيطرة أو التغيير الاجتماعي.
إنَّ التراث تعبير عن روح العصر الذي تبلور في صلبه، وهو مجموعة من التفاسير التي يُقدِّمها كلُّ جيل بناءً علىٰ متطلَّباته. إنَّ هذه التفاسير إمَّا هي بالنسبة إلىٰ ظواهر كلِّ عصر وإمّا بالنسبة إلىٰ نزاعاته الفكريَّة، وعليه فإنَّ التراث ليس أمرًا سماويًّا، بل هو ظاهرة تاريخيَّة واجتماعيَّة، من ذلك علىٰ سبيل المثال، أنَّ جميع المفاهيم والنظريّات الكلاميَّة المختلفة من وجهة نظر حنفي بشأن الإيمان والعمل، والكفر والفسق، والعصيان والنفاق، ومسألة الإمامة، تُمثِّل نوعًا من التنظير تجاه الأحداث السياسيَّة التي يختلف الناس حولها. إنَّ الإصلاح والتجديد لا يكون بداعي الاحترام وتقديس التراث، بل بداعي انتساب الفرد المتجدِّد إلىٰ أرضه وشعبه. ومن هنا فإنَّ التراث والتجديد كلاهما مسألة وطنيَّة وجزء من الواقعيَّة في حياتنا.
يتحاشىٰ حنفي استعمال وصف التراث بـ «الإسلامي»، ويرىٰ أنَّ
مصطلح الإسلامي إذا أُريد له أنْ يكون صفة لحضارة ما، فإنَّ ذلك يعني تبلور الحضارة في صلب الإسلام بوصفه ظاهرة تاريخيَّة، وبالتالي فإنَّ التراث فيما وراء ذلك لا ينطوي علىٰ أيِّ مفهوم ديني. وفي الأساس، فإنَّ الإسلام من وجهة نظره ظاهرة حضاريَّة حدثت في التاريخ، وإنَّ الذي يحظىٰ بأهمّيَّة بالنسبة لنا هو دراسة الإسلام بوصفه حضارة. وفي الوقت نفسه لا يعتبر فهم الإسلام بوصفه ظاهرة تاريخيَّة، حضاريَّة، إنكارًا للوحي. إنَّ حنفي من خلال التمييز بين الإسلام السماوي والإسلام الحضاري، وعزل الإسلام السماوي، يسعىٰ إلىٰ التأسيس لمبنىٰ، كي لا يُتَّهم، في قبال إنكار بعض الأُصول الجوهريَّة في التراث الإسلامي، بإنكار الوحي، ومن هنا فإنَّه يلجأ إلىٰ تاريخيَّة التراث.
إنَّ التراث بالالتفات إلىٰ الخصوصيَّة الأُولىٰ، لا يمكن أنْ ينطوي علىٰ قيمة مطلقة تفوق الزمان، بل إنَّ قيمته رهن بالفائدة التي يُقدِّمها في مختلف الأزمنة من حيث حلِّ المشكلات وتفسير الظواهر المعاصرة والعالم المعاصر. وعلىٰ هذا الأساس، لن يكون هناك أيُّ ملاك نظري لتحديد الصواب والخطأ في التراث، وإنَّما يعتمد ذلك علىٰ مقياس عملي والمنفعة، حيث يمكن الحكم بتناسب أو عدم تناسب التراث بشرائط عصريَّة مختلفة. وبذلك فإنَّ حنفي يتخبَّط في ورطة النسبيَّة، ويتجاهل السؤال القائل: كيف يتمُّ ترجيح المعيار العملي والمصلحي في أجواء النسبيَّة المعرفيَّة؟ ثمّ ألَّا يُمثِّل الحكم بتناسب أو عدم تناسب التراث مع ظروف العصر نوعًا من الأحكام المعرفيَّة؟
يرىٰ حسن حنفي أنَّ تيّار العودة إلىٰ التراث القديم يُمثِّل نوعًا من الهروب من الواقع الراهن واللجوء إلىٰ المثاليَّة السابقة، حيث تتمُّ قراءة الوضع المعاصر في ضوء الماضي. كما أنَّه يُعبِّر عن الاتِّجاهات الاستغرابيَّة بوصفها قفزة نحو مستقبل (الغرب) منفصلة عن التراث بالمرَّة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّه يدَّعي أنَّ الإصلاح والتجديد يجب أنْ يقوم علىٰ أساس التراث؛ لأنَّ التراث موجود في صلب واقعنا الاجتماعي، ولا يمكن الانطلاق نحو التجديد دون تغيير هذا التراث، ومن هنا يكون التجديد والتراث متلازمين. والتجديد في التراث يعني التغيير في سلوك الناس بما يتطابق ومقتضىٰ الواقعيَّة الخارجيَّة للمجتمع.
إنَّ التراث علىٰ مستويين، وهما: المستوىٰ المادّي والمستوىٰ الصوري. والمستوىٰ المادّي منه يشمل المكتبات والمتاحف والمساجد وأمثالها، وأمَّا المستوىٰ الصوري أو النظري الذي يُشكِّل حقيقة التراث، والذي يضمن الشعور والوعي العامَّ للناس بوصفه مصدرًا روحيًّا وداخليًّا (... يوجد نقص). ومن هذه الناحية لا يكون التراث متعلِّقًا بالماضي فقط، بل يعمل علىٰ هداية وتوجيه السلوك العامِّ للناس في حياتهم اليوميَّة، ولذلك فإنَّنا نعيش كلَّ يوم مع الكندي والفارابي وابن سينا والمتصوِّفة. كما يرىٰ حنفي
أنَّ التراث مركَّب من التراث الدِّيني والقومي والمقدَّس والدنيوي حيث يوجد في اللّاوعي التاريخي للأُمَّة وذاكرتها الجماعيَّة.
يرىٰ حنفي أنَّ التراث أمر اجتماعي، وأنَّه وليد الصراعات السياسيَّة والاجتماعيَّة، وليس متقدِّمًا عليها. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّه يُقسِّم التراث إلىٰ نوعين، وهما: تراث السلطة، وتراث الصراع. إنَّ تراث السلطة تمارسه الحكومات من أجل بقائها والتصدّي للعناصر الأُخرىٰ التي تُهدِّد وجودها، وأمَّا تراث الصراع، فهو الذي يمارسه المحكومون في مواجهة السلطة. إنَّه يعتبر تراث السلطة متضمِّنًا لأُصول الدِّين والنقليّات، وأمَّا تراث الصراع، فيتمُّ تعريفه ضمن استقلال الإنسان في العقل والحُرّيَّة. وهو يرىٰ تراث المسلمين بأجمعه تعبيرًا عن هذين التراثين. وقد ذهب حنفي إلىٰ القول بأنَّ تراث السلطة قد تجلّىٰ في علم أُصول الدِّين (الذات والصفات وأفعال الله وكذلك مسألة الإمامة)، وعلىٰ هذا الأساس فإنَّ جميع التقديرات تصدر من قِبَل الله، وليس أمام الإنسان سوىٰ التسليم، ولن تكون لديه أيّ أصالة من نفسه. وفي التراث السائد يكون الإنسان مكلَّفًا بالإيمان فقط دون العمل، ولذلك فإنَّ الإنسان في تراث الحاكم لا يخرج عن الإيمان إذا لم يكن عاملًا. وأمَّا في تراث المحكوم، فإنَّ الإيمان إنَّما يكون له مفهوم بالعمل، وإنَّ عدم العمل قد يُؤدّي إلىٰ الكفر أحيانًا. وفي تراث السلطة لن يكون للعقل موقع في دائرة النقل والنبوَّة، ولن يكون قادرًا علىٰ إدراك الحسن والقبح،
وأمَّا في تراث المعارضة، يمكن للعقل أن يُدرك الحسن والقبح. إنَّ هذه التنظيرات، التي هي في حدِّ ذاتها وليدة الشرائط السياسيَّة والاجتماعيَّة، قد تجلَّت علىٰ شكل أنواع من تراث الفِرَق الإسلاميَّة والمذاهب الكلاميَّة، وإنَّ تراث السلطة هو تراث أهل السُّنَّة والجماعة، وتراث المعارضة هو تراث الشيعة والخوارج والمعتزلة. والنتيجة التي يصل إليها حنفي من تحليله، هي أنَّ الأولويَّة في التراث تكون علىٰ الدوام من نصيب الواقعيَّة والشرائط العينيَّة، دون النصوص، بمعنىٰ أنَّ النصوص يتمُّ تفسيرها بحسب الشرائط الواقعيَّة دائمًا.
يعمد حنفي إلىٰ تعريف تاريخ التراث من القرن الهجري الخامس بالتزامن مع هجوم الغزالي علىٰ العلوم النقليَّة بأنَّه تراث أُحاديّ، بمعنىٰ أنَّه تراث أشعري ويفتقر إلىٰ التعدُّديَّة والتكثُّر. وبعبارة أُخرىٰ: إنَّ الغزالي قد وضع تراث السلطة ضمن الأشعريَّة، وتراث المحكومين ضمن التصوُّف (الخوف، والرضا، والتسليم، والقناعة، والصبر، والزهد، والقضاء والقدر وما إلىٰ ذلك). وقد رأىٰ حنفي استمرار هذه الحالة حتَّىٰ بداية النهضات الإصلاحيَّة المعاصرة في العالم العربي، ويعتقد بأنَّ التعدُّديَّة قد بدأت بعد هذا التاريخ. وأمَّا بعد الثورة العربيَّة المعاصرة وتأسيس الحزب الواحد في مصر، اتَّجهت الحكومات المختلفة مجدَّدًا إلىٰ تراث السلطة، ولكنْ هذه المرَّة تمَّ تفسير التراث بشكل مختلف، فتارةً يكون اشتراكيًّا، وتارةً أُخرىٰ رأسماليًّا. ومن ناحية
أُخرىٰ تبلورت المعارضة للسلطة ضمن أيديولوجيَّة سياسيَّة جديدة، من قبيل: القوميَّة والليبراليَّة والماركسيَّة، ولكنَّه باستثناء الخاصَّة لم يترك تأثيرًا شاملًا علىٰ المجتمع.
يرىٰ حنفي أنَّ تراثنا هو تراث معكوس، بمعنىٰ أنَّ مسائل الإلهيّات وما كان من قبيل الذات والصفات وأفعال الله، يجب أنْ يتمَّ تغييره إلىٰ محوريَّة الإنسان، وأنْ يتمَّ الحديث عن الذات الواعيَّة والصفات والأفعال الإنسانيَّة، كي يتمكَّن من الوصول إلىٰ الاستقلال في الحُرّيَّة والعقل.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ التراث الإسلامي يعاني من الرؤية الثنائيَّة. إنَّ نظريَّة الفيض والرؤية الهرميَّة أو سلسلة المراتب إلىٰ الوجود، أدَّت إلىٰ ظهور الثنائيَّة في مفاهيم التراث، من قبيل: الله والطبيعة، والمادَّة والصورة، والعلَّة والمعلول، والجوهر والعرض، والروح والجسم، والدنيا والآخرة، والخير والشرّ، والمؤمن والكافر، والحاكم والمحكوم وما إلىٰ ذلك. ويرىٰ حنفي أنَّ نفوذ وتسلُّل هذه الرؤية إلىٰ التراث يُشكِّل خطرًا جدّيًّا عليه.
يذهب حسن حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ الدين والتفكير الدِّيني ليس مجرَّد مفاهيم ذهنيَّة أو تنظير، بل هو أيديولوجيَّة تهدف إلىٰ تغيير المجتمع والتاريخ.
ولذلك فإنَّه يرىٰ في شأن النزول بيانًا علىٰ هذه الواقعيَّة، وتأكيدًا علىٰ البُعد الأيديولوجي للدين في التغيير الاجتماعي.
إنَّ من بين عناصر حيويَّة التراث القديم هو التعاطي مع سائر الحضارات، ومن ذلك استعمال لغاتها (اللغة العصريَّة)، فإنَّها تُقدِّم مفاهيمها ضمن شكل وإطار جديد، يتمُّ التعبير عنه بالتبويب الكاذب.
1. يرىٰ حسن حنفي أنَّ التراث ذخيرة قوميَّة ووطنيَّة وحضاريَّة، ومن هنا فإنَّ عصريّته وتغيُّره بما يتناسب مع الزمان والمكان، سوف يكون من لوازمه التلقائيَّة. والحقيقة هي أنَّ التراث الوطني لكلِّ مجتمع سيكون له بما يتناسب مع ذلك المجتمع معنىً ومفهومًا خاصًّا في البعدين المادّي والمعنوي من الثقافة، وإنَّ أحد أهمّ مواريثه في المجتمعات الإسلاميَّة هو التراث الإسلامي. وخلافًا لرؤية حنفي، فإنَّ جميع مصاديق التراث، ومن بينها التراث الإسلامي، لا يكون مشمولًا للتعريف والخصائص التي ذكرها للتراث. كما تقدَّم في بحث المفاهيم، فإنَّ التراث الإسلامي عبارة عن مجموعة من النصوص الدِّينيَّة (الأعمّ من الكتاب والسُّنَّة وروايات أهل البيت عليهمالسلام)، وما قام به علماء الدِّين من تفسير الكتاب والسُّنَّة، وأضافوا إليه من الآراء علىٰ مدىٰ التاريخ الواسع والعريض، وأوجدوا بذلك مجموعة ضخمة باسم
العلوم والتراث الإسلامي. إنَّ الإشكال الجوهري الذي يرد علىٰ حنفي، هو أنَّ تراثنا الإسلامي ليس مجموعة من التفاسير القوميَّة والحضاريَّة التي تغيَّرت منذ الأزمنة الماضية إلىٰ يومنا هذا بما يتناسب مع الشرائط الزمانيَّة المتغيِّرة، أو بما تقتضيه روح العصر إلىٰ (الحاجة المعاصرة)، علىٰ حدِّ تعبيره، بوصفها عنصرًا مقوِّمًا له، أو يتمُّ التأكيد علىٰ تغيير وإعادة التفسير المجدَّد للتراث الإسلامي، من خلال الاستدلال علىٰ تغيُّر ونسبيَّة الاحتياجات. إنَّ هذا النوع من الكلام زاخر بالمتناقضات ومفعم بأوهام السراب.
إنَّ الإسلام الذي يُمثِّل أساس وأصل تراث المسلمين، ليس أمرًا خارجيًّا صامتًا كي يتلبَّس بثوب اللفظ والمفهوم في وعاء المعارف البشريَّة بيراع المقتضيات العصريَّة، بل يحتوي بنفسه علىٰ نظام من المعاني والمفاهيم وحتَّىٰ الألفاظ الخاصَّة التي تلعب دورًا محوريًّا وجوهريًّا في تقييم المعارف البشريَّة وما له دخل في سعادتهم. إنَّ الدِّين يشتمل علىٰ مجموعة من المعاني والمفاهيم العالية والثابتة التي تمَّ تدوينها في القرآن الكريم علىٰ مدىٰ ثلاث وعشرين سنة، وتمَّ بسطها ونشرها علىٰ ما يقرب من قرنين ونصف القرن علىٰ يد الأئمَّة المعصومين الأطهارعليهمالسلام. وعليه، فإنَّ الحقيقة التي لا يمكن أنْ تتقوَّم بالزمان، لا تُبقي متَّسعًا لإصلاحها وإعادة صياغتها طبقًا لمقتضيات تغيُّر العصور والأزمان. وبطبيعة الحال، فإنَّ طريق التأمُّل في النصوص الدِّينيَّة وإعادة فهمها موضع تأكيد مستمرّ من قِبَل الإسلام. إلَّا أنَّ التأمُّل والتدبُّر في الدِّين من أجل الوصول إلىٰ فهم عميق أو جديد، أمر مختلف عن إصلاح التراث والمعارف الإسلاميَّة؛ إذ في عمليَّة الإصلاح يتمُّ النظر إلىٰ المعارف
(160)والتعاليم الدِّينيَّة بوصفها تجربة اجتماعيَّة وتاريخيَّة أو فرديَّة بما يتناسب مع العصر والزمان مثل سائر التجارب البشريَّة الأُخرىٰ، إنَّما يتجلّىٰ في إطار النظريّات البشريَّة، وأمَّا في التأمُّل والتدبُّر أو تفسير الدِّين، فإنَّ المعارف الدِّينيَّة إنَّما تُظهر نفسها، بمعزل عن الزمان والمكان، بوصفها فهمًا أوسع وأعمق، ولها بطبيعة الحال أُطُرها المنهجيَّة والمعرفيَّة الخاصَّة.
وعلاوة علىٰ المنطق المعرفي والإبستيمولوجي والسماوي الذي يُؤكِّد علىٰ ثبات المعرفة الدِّينيَّة وعدم زمنيَّتها، فإنَّ التجربة التاريخيَّة والاجتماعيَّة للمسلمين ووجدانهم وشعورهم الجماعي، بوصفه نقدًا بنائيًّا، يُمثِّل خير شاهد علىٰ هذه الحقيقة، وهي أنَّ المفاهيم والتعاليم الدِّينيَّة منذ عصر النزول إلىٰ يومنا هذا تحتوي علىٰ دلالات واحدة ومشتركة، ولم يُنظر إلىٰ التراث الإسلامي كما يُنظر إلىٰ التكنولوجيا والتراث المادّي للثقافة أو الآداب والتقاليد التي هي عرضة للتغيير التاريخي. إنَّ تعبير حنفي عن التراث بوصفه «مسؤوليَّة وذخيرة قوميَّة وثقافيَّة» يُمثِّل تعبيرًا علمانيًّا عن تراث المسلمين، ولا ينسجم مع حقيقته.
2. في هذه الرؤية حيث يكون التراث الإسلامي أمرًا إنسيابيًّا وتابعًا للتحوُّلات التاريخيَّة، عندها يتمُّ نفي بيان التراث للواقع. طبقًا لتعريف حنفي لن يكون هناك معنىٰ للحقِّ والباطل والصحيح والخطأ في التراث الإسلامي، ولذلك فإنَّه يرىٰ أنَّ الفائدة هي المعيار الوحيد في تفسير التراث، وبذلك يحكم بتناسبه أو عدم تناسبه، وليس بصحَّته أو سقمه. وهذا المدَّعىٰ مخدوش
من عدَّة جهات. فأوَّلًا: أنَّ نظريَّة عدم بيان التراث للواقع وقيامها علىٰ معيار الفائدة، هي في حدِّ ذاتها نظريَّة بشأن التراث، وهي، طبقًا لرؤية حنفي، منبثقة عن شرائطها التاريخيَّة الخاصَّة، وسوف يكون اعتبارها باشتمالها علىٰ فائدة، ولذلك يحقُّ لشخص أنْ يقول: إنَّ هذه النظريَّة ليست غير مفيدة فحسب، بل تُلحِق الكثير من الأضرار بثقافتنا وهويَّتنا؛ لأنَّها تُسبِّب الانفصال عن الهويَّة والحضارة القديمة، وتقضي علىٰ الوحدة الدِّينيَّة وتنشر الاختلاف وترفع من التشويش والقلق النفسي في المجتمع. وثانيًا: أنَّ مبنىٰ النفعيَّة باطل من الأساس؛ إذ، خلافًا لرؤية حنفي، هناك في الإبستيمولوجيا شيء باسم الحقِّ والباطل والصحيح والسقيم، وإنَّ تفكيرنا يتَّجه علىٰ الدوام إلىٰ الحكاية عن واقعيَّة تتَّصف بالصحَّة والغلط. وثالثًا: بالرجوع إلىٰ التراث الإسلامي والمنظِّرين الذين ظهروا طوال تاريخ التفكير الدِّيني، لن نجد أيَّ مؤشِّر علىٰ صحَّة اتِّجاه حنفي. إنَّ هؤلاء كانوا بصدد تفسير الدِّين والكشف عن مقاصده الحقيقيَّة، ولم يكونوا يسعون من خلال معيار النفعيَّة إلىٰ البحث عن نظريَّة لرفع الاحتياجات المعاصرة.
3. إنَّ حنفي في تقييمه لتراث المسلمين متأثِّر باتِّجاهه الخاطئ في مسألة التراث والتجديد. فلو اعتبرنا التراث مجرَّد أداة وليس مبنىٰ للتغيير والإصلاح، فإنَّه في مثل هذه الحالة، وعلىٰ حدِّ تعبيره، ستكون له قيمة آليَّة، وسوف تكون قيمته رهنًا بمدىٰ فائدته. وطبقًا لهذا الاتِّجاه، كلَّما تمَّ التشكيك في نفع التراث من خلال تغيير المجتمع واكتشاف أدوات ومفاهيم ومذاهب جديدة، ستكون قيمتها مخدوشة أيضًا. ومن هنا فإنَّه يُصرِّح بأنَّ اللّاهوت
القديم ليس مفيدًا لهذا العصر؛ وذلك لأنَّ هذا اللّاهوت قائم علىٰ مجرَّد الخالق والمخلوق وأولويَّة الخالق في الفعل والعمل والحكم وملاك التقييم، وهذا النوع من اللّاهوت لا يناسب المجتمع المعاصر! وهناك عدَّة إشكالات علىٰ هذه النظريَّة، ومن بينها:
أوَّلًا: أنَّ التراث الإسلامي ليس أداة اجتماعيَّة منبثقة عن الحياة الاجتماعيَّة، بل هو نتاج الجهود التي بذلها المفكِّرون وعلماء الدِّين في دراسة المصادر المعرفيَّة، ولاسيّما النصوص الدِّينيَّة منها. ومهما كانت الخلفيّات الاجتماعيَّة مؤثِّرة في قبض وبسط جهود العلماء، إلَّا أنَّ التراث الإسلامي لم يكن أبدًا علىٰ مستوىٰ الأداة المفهوميَّة أو المنظومة المفهوميَّة بحيث تكون تابعة للأوضاع الاجتماعيَّة واعتباراتها النسبيَّة؛ لأنَّ دلالات النصوص الدِّينيَّة ناظرة إلىٰ الحقائق الثابتة وغير القابلة للتغيير، بالإضافة إلىٰ أنَّها تتمتَّع بقيمة ذاتيَّة وليست آليَّة.
وثانيًا: أنَّ النتيجة التي يحصل عليها حنفي من خلال تقييم اللّاهوت القديم، ستكون باطلة بالنظر إلىٰ مبناه. إنَّ الإلهيّات الإسلاميَّة، وإنْ كانت تدور حول محور التوحيد بحيث تتقوَّم حول محوريَّته جميع الأُصول الاعتقاديَّة والعمليَّة والأخلاقيَّة، ولكنَّها سوف تقتضي، في الوقت نفسه، تحوُّل وصيرورة الإنسان والمجتمع في مسار التوحيد. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ التحوُّل والتغيير والانقلاب سوف تكتسب معناها وفعليَّتها في ضوء الالتفات إلىٰ الإلهيّات الإسلاميَّة. إنَّ التوحيد في العبوديَّة والتشريع لا
المقتبسة من النصوص الصريحة في القرآن الكريم والسُّنَّة الشريفة وحكم العقل، ليست بالقليلة، ومن ذلك أنَّ مذهب الشيعة علىٰ الرغم من امتلاكه أدبيّات المعارضة في مواجهة حُكّام الجور والمدارس والتعاليم الخاطئة التي ظهرت في تاريخ الإسلام، إلَّا أنَّ التشيُّع لا يكتسب أُصوله وقواعده المعرفيَّة وكذلك ماهيَّته من الأُسس الاجتماعيَّة، وإنَّما يقوم علىٰ أساس من تعاليم القرآن والسُّنَّة وسيرة النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته الأطهارعليهمالسلام، وعليه فإنَّ التشيُّع سوف يُعارض بوضوح تامٍّ كلَّ ما هو مغاير لهذه المفاهيم تلقائيًّا. وعلىٰ هذا الأساس، لا يمكن، بشكل عامٍّ، إعادة منشأ ظهور جميع المدارس الإسلاميَّة والأفكار الكلاميَّة إلىٰ الصراع في مجال السياسة فقط، ولا يمكن لنا أنْ نستنتج أنَّ التراث (بجميع أنواعه) أمر اجتماعي، وأنَّه وليد المعارضة السياسيَّة وليس متقدِّمًا عليها.
5. والخصائص الأُخرىٰ التي ذكرها حسن حنفي للتراث الإسلامي، من قبيل: التراث المعكوس، والتقسيم الثنائي، والتصوير الكاذب، تقوم بأجمعها علىٰ مبانيه التي هي من قبيل: العلمانيَّة والنزعة الإنسانيَّة، كما أنَّها تعكس عدم التزامه بأُصول التحقيق.
لقد ذهب حسن حنفي إلىٰ القول بأنَّ ضرورة تجديد وإصلاح التراث الإسلامي تنشأ من وجوب دفع المخاطر الداخليَّة والخارجيَّة التي تُهدِّد الحضارة الراهنة. فكما اقتضت في السابق مخاطر من قبيل: التشبيه والتجسيم والشرك وأمثال ذلك، تبلور علم الكلام في التراث الإسلامي للدفاع عن
التوحيد وإثبات الذات والصفات والأفعال الإلهيَّة. هناك اليوم مخاطر داخليَّة، من قبيل: المعارضة الداخليَّة بين المسلمين، والانحطاط، والتخلُّف، والتبعيَّة، ومخاطر خارجيَّة، من قبيل: الاستعمار، والنظام الرأسمالي، والصهيونيَّة، ممَّا يقتضي تبديل جهل الإنسان إلىٰ علم، وعجزه إلىٰ قوَّة، وموته إلىٰ حياة، وصممه وعماه إلىٰ سمع وإبصار، وانفعاله إلىٰ إرادة. يذهب حنفي إلىٰ الادِّعاء بأنَّ دراسة التراث القديم تُثبِت أنَّ مسائله ومضامينه، لا تتناسب أبدًا مع أوضاعنا الراهنة، سواء في ذلك الفقه وأُصول الفقه أو الفلسفة والكلام أو التصوُّف والعرفان. وعليه، يجب اليوم العمل علىٰ تغيير جميع العلوم في إطار محوريَّة الإنسان كي تتناسب مع الإنسان المعاصر واحتياجاته والمخاطر التي تُهدِّد الحضارة الإسلاميَّة من الداخل والخارج. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ الذي نحتاجه اليوم هو استبدال علوم التراث بالعلوم الإنسانيَّة.
يذهب حنفي في هذا الشأن إلىٰ الاعتقاد بوجوب تبديل العلوم الأربعة، وهي: الكلام، والفلسفة، والتصوُّف، وأُصول الفقه، إلىٰ علم واحد؛ ليكون مرادفًا لـ «الحضارة». وقد أطلق علىٰ هذا العلم الجديد، المشتمل علىٰ جميع العلوم، اسم مشروعه، أي «التراث والتجديد». فهو يزعم أنَّ العلوم المرتبطة بالتراث القديم، إنَّما هي نتاج توظيف العقل في النصوص الدِّينيَّة، أمَّا في العصر الراهن الذي هو عصر العلوم الإنسانيَّة، فإنَّ هذا العلم الجديد يتكفَّل بمهمَّة تبديل علوم التراث إلىٰ العلوم الإنسانيَّة. وإنَّ هذا التبديل والتغيير في بعض العلوم أسهل، وفي بعض العلوم الأُخرىٰ أصعب، وهذا
الأمر يعود إلىٰ مقدار قرب وبُعد هذه العلوم من العلوم الإنسانيَّة. ومن هنا فإنَّه يرىٰ أنَّ استبدال علم أُصول الفقه إلىٰ علم «منهج البحث»، واستبدال الفقه بعلم الاقتصاد والحقوق والسياسة، واستبدال التصوُّف بعلم النفس والأخلاق، واستبدال علم الحديث بعلم النقد التاريخي أسهل، إلَّا أنَّ هذا التبديل والتغيير في الكلام والفلسفة يقترن بشيء من الصعوبة والتعقيد، ولكنَّه ليس بعيد المنال. وأمَّا الإمامة، فيمكن إرجاعها إلىٰ علم السياسة، كما تعود أبحاث العقل والنقل إلىٰ علم المعرفة والمنهج، والتوحيد يتعلَّق بعلم النفس الاجتماعي. يرىٰ حنفي أنَّ الغاية الأخيرة بعد استبدال العلوم الإسلاميَّة بالعلوم الإنسانيَّة، هو تحوُّل العلوم الإنسانيَّة في نهاية المطاف إلىٰ «أيديولوجيا». إنَّه خلافًا لما كان سائدًا في السابق من تعريف الإنسان بوصفه «حيوانًا ناطقًا»، يذهب إلىٰ تعريف الإنسان بوصفه «حيوانًا مؤدلجًا». ومن خلال استبدال العلوم الإنسانيَّة بالأيديولوجيا، يغدو من الممكن الإجابة عن المسائل المعاصرة. إنَّ الأيديولوجيا ليست مجرَّد نظريّات علميَّة، بل هي مزيج من العلم النظري والعملي. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ الهدف الرئيس في التراث والتجديد عند حنفي، هو استبدال الوحي بالأيديولوجيا بوصفها علمًا، وفي الحقيقة تبديل علوم التراث إلىٰ علم واحد.
يذكر حنفي خمسة مفاهيم جوهريَّة بوصفها من أُصول ومقوّمات التجديد، ويرىٰ أنَّ هذه الأُصول موجودة في الإسلام رغم بقائها مجهولة في التراث
الإسلامي، أو اكتسبت معاني أُخرىٰ بما يتناسب وشرائط عصرها. أمَّا اليوم، فيجب أنْ تكون لدينا قراءة أُخرىٰ لها. إنَّه يسعىٰ، من خلال التفاسير المنشودة له، إلىٰ نسبة هذه الأُصول إلىٰ الإسلام؛ كي تكتسب صورة مغايرة لأدبيات التنوير المعارض للإسلام. وهذه الأُصول الخمسة هي كالآتي:
يذهب حنفي إلىٰ اعتبار السيطرة علىٰ الطبيعة واكتشاف قوانينها في إطار مصالح الإنسان والمجتمع خطوة أُولىٰ في التجديد، وقال في ذلك: علىٰ الرغم من اشتمال القرآن الكريم علىٰ مثل هذا التصوُّر بالنسبة إلىٰ الطبيعة، حيث تعرَّض إلىٰ بيان الظواهر الطبيعيَّة ومصالحها، إلَّا أنَّ الطبيعة في تراثنا تُشكِّل مقدّمة لإثبات وجود الله في علم الكلام أو في مقدّمة الإلهيّات في الفلسفة، أو يتمُّ الحديث عن وحدة الله مع الطبيعة في نظريَّة وحدة الوجود عند التصوُّف.
يذهب حسن حنفي إلىٰ القول بعدم إمكان فهم قوانين الطبيعة إلَّا بوساطة العقل. ومراده من العقل جميع الأدوات المعرفيَّة الشاملة للحسِّ والتجربة والذوق والوجدان، وإنَّ عقلانيَّة المجتمع تكتسب مفهومها ومعناها في هذه الأجواء. يرىٰ حنفي أنَّ القرآن الكريم رغم تأكيده علىٰ العقل، وما ورد في التراث أحيانًا من اعتبار العقل أساسًا للنقل، ومرادفًا للسمع أحيانًا، حتَّىٰ يكون الفيلسوف في مرتبة النبيِّ، ولكنْ بسبب سيطرة الدُّوَل والحكومات التي تسعىٰ إلىٰ تحكيم سلطتها وأمنها، فقد تمَّ سلب الأولويَّة من العقل
(168)ومنحها إلىٰ النقل، وبالتالي أصبح النقل منسجمًا مع السلطة، وانحاز العقل إلىٰ صفوف المعارضة، فكان النقل بحاجة إلىٰ سلطة تُفسِّره، في حين أنَّ العقل كان يسعىٰ إلىٰ نفي جميع السلطات. ومن هنا فإنَّ حنفي يرىٰ أنَّ مهمَّة التجديد تكمن في تحرير العقل من سلطة النقل.
إنَّ المفهوم الجوهري الثالث في التجديد هو «الإنسان»، حيث يرىٰ حسن حنفي أنَّ مهمَّة التجديد ومسؤوليَّته الرئيسة تكمن في تلبية احتياجاته الجسديَّة والروحيَّة من المأكل والملبس والمسكن والأمان. وقد ذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ الإنسان، مثل الطبيعة، قد شكَّل واحدًا من المحاور الأصليَّة في القرآن الكريم، حيث يرِد الحديث عنه في الغالب عن ضعفه وحرّيَّته ومسؤوليَّته وسعيه في هذه الدنيا. لقد تحدَّث القرآن الكريم عن الإنسان بوصفه خليفة لله في الأرض كي يستعمرها ويستثمرها. وهو علىٰ الرغم من تقييمه في أعماله لحضور الإنسان في التراث الإسلامي بوصفه حضورًا تبعيًّا وغير استقلالي، إلَّا أنَّه يقول في هذا المقطع: إنَّ الإنسان في التراث الإسلامي يُشكِّل مبنىٰ للمسائل العقليَّة (في أُصول العقائد)، وهو حرٌّ، وعاقل، ومسؤول عن نفسه وعن المجتمع والطبيعة. وكذلك في الفلسفة، يعتبر الإنسان مركز الوجود ونقطة التقاء الإلهيّات والطبيعيّات، وفي أُصول الفقه تكون حقوق الإنسان مبنىً للتشريع، إلَّا أنَّ سيطرة الدولة ونجاحها في حلبة المعارضة، قد تسبَّبت في إحلال الله محلَّ الإنسان، واعتبر الحاكم ممثِّلًا كامل الصلاحيَّة عن الله سبحانه وتعالىٰ، وبالتالي فقد تحوَّل الإنسان في اللّاشعور الوطني والقومي
(169)لدينا إلىٰ كائن ضعيف وجاهل وعاجز عن تطوير نفسه، وإنَّ مهمّة التجديد تكمن حاليًّا في إعادة الإنسان إلىٰ مكانته ومنزلته الرئيسة.
المجتمع
يرىٰ حنفي أنَّ التجديد حالة اجتماعيَّة تسعىٰ إلىٰ توفير الحدِّ الأقصىٰ من المنافع لأكبر عدد من الناس. وهذا الأمر إنَّما يتمُّ من خلال التوزيع العادل، وضمان الخدمات العامَّة، والصحَّة، والتعليم، والمساواة وما إلىٰ ذلك من الأُمور بين المواطنين. إنَّه ضمن تأكيده علىٰ اهتمام الإسلام بالمجتمع، واعتباره المجتمع الإسلامي أُمَّة واحدة لا تعاني من شرخ عميق بين الفقير والغني، يرىٰ التراث الإسلامي مشتملًا علىٰ المصالح الاجتماعيَّة للناس، وفي أُصول الفقه تكون المصالح العامَّة مبنىً للتشريع، وفي الحكمة يكون الفيلسوف علىٰ رأس المدينة الفاضلة وليس الجنرال العسكري أو الأمير. وأمَّا في وعينا الوطني، فقد اكتسب الفرد قيمة مطلقة، وهو وحده صاحب الحقِّ، وأموال الناس ملك له.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ التجديد يُمثِّل واحدًا من المراحل التاريخيَّة، حيث ينقل المجتمع من مرحلة التقليد إلىٰ مرحلة الإنتاج، كي لا يرجع إلىٰ الماضي مثل السلفيين، ولا يقفز إلىٰ المستقبل مثل العلمانيين، ولذلك فإنَّ التجديد من هذه الناحيَّة يرتبط بالتقدُّم وفلسفته. وقد ذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ القرآن الكريم قد أبدىٰ الاهتمام اللازم بالتاريخ ودور الأنبياء في تطوُّر التاريخ حتَّىٰ أصبح التاريخ جزءًا من وعي المسلمين، وصار بإمكانهم من خلال الوعي
(170)التاريخي فهم حاضرهم ومستقبلهم. كما أنَّ للتاريخ والتقدُّم مكانة خاصَّة في التراث الإسلامي، فقد اعتبرت فرقة الكرّاميَّة أنَّ الله محلّ للحوادث، وعلىٰ حدِّ تعبير هيجل (إنَّ الله هو التاريخ)، وذهب المعتزلة إلىٰ الاعتقاد بأنَّ القرآن مخلوق، بمعنىٰ أنَّه في القراءة والفهم والتحقيق أمر بشري، كما كان للنبوَّة تطوُّر تاريخيّ، حتَّىٰ يصل الوحي إلىٰ نهايته في ختم النبوَّة وبلوغ وعي الإنسان مرحلة كماله؛ إذ أمكن للإنسان بعد ذلك أنْ يعتمد علىٰ عقله وحرّيَّته بشكل مستقلٍّ. ثمّ صار حنفي إلىٰ رسم التاريخيَّة والتقدُّم بقراءته الخاصَّة في سائر علوم التراث، ثمّ قال: إنَّ التطوُّر في وجداننا القومي قد تحقَّق علىٰ نحو معكوس، بمعنىٰ أنَّنا تحوَّلنا إلىٰ الانحطاط، وجنح التاريخ نحو الأُفول «جاء الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا». أمَّا الآن، فرسالة التجديد تكمن، من وجهة نظره، في العودة إلىٰ المرحلة التاريخيَّة الجديدة والإذعان لمقتضياتها.
منحىٰ حنفي في الإصلاح الجوهري للتراث
1. الاكتفاء الذاتي بالتراث الإسلامي.
2. الاكتفاء الذاتي بالمدارس الغربيَّة.
3. التوفيق بين التراث والتجديد.
إنَّه ضمن نقده لكلِّ واحدٍ من هذه الاتِّجاهات الثلاثة، يعمل علىٰ تقديم رؤيته الخاصَّة. إنَّ اتِّجاه الاكتفاء الذاتي بالتراث الإسلامي يبحث عن حلِّ
جميع المسائل والمشكلات الراهنة في التراث القديم. وقد اتَّهم حسن حنفي هذا الاتِّجاه بالنفاق والعجز والنرجسيَّة.
وأمَّا اتِّجاه الاكتفاء الذاتي بالمدارس الغربيَّة، فلا يرىٰ أيَّ قيمة غائيَّة أو آليَّة للتراث القديم، بل يراه جزءًا من تاريخنا المتخلِّف، في حين يرىٰ التجديد والتراث الغربي عالميًّا وعلميًّا. يرىٰ حنفي أنَّ هذا الاتِّجاه علىٰ حقٍّ من حيث المبدأ، ولكنَّه بالالتفات إلىٰ الواقعيَّة الخارجيَّة والاجتماعيَّة يراه علىٰ خطأ؛ وذلك لأنَّ الاتِّجاه أعلاه يقفز علىٰ الواقعيَّة الخارجيَّة ويسارع إلىٰ إعادة البناء وممارسة الإصلاح الجديد قبل تقويض البناء القديم بالكامل. يرىٰ حنفي أنَّ التراث القديم جزء من الذخائر الروحيَّة للمعاصرين، وأنَّه مثل الآداب والتقاليد والسُّنَن والأمثال الشعبيَّة، من أجزاء الواقع الاجتماعي التي لا يمكن تجاهلها.
وأمَّا اتِّجاه التوفيق بين التراث والتجديد، فهو يهدف إلىٰ إقامة الوئام بين التراث القديم والجديد. وقد عمد حنفي إلىٰ تقسيم هذا الاتِّجاه إلىٰ قسمين: «التجديد من الخارج»، و«التجديد من الداخل». ويعني التجديد من الخارج أنْ ننتقي واحدًا من المدارس الغربيَّة ونقارنه بما يشبهه في تراثنا القديم. وفي التجديد والإصلاح من الداخل يتمُّ العمل علىٰ إبراز أهمّ الجوانب التقدُّميَّة في تراثنا القديم، وإبرازها تلبية لحاجات العصر من تقدُّم وتغيُّر اجتماعي، من ذلك علىٰ سبيل المثال يتمُّ استخراج الاتِّجاه العقلي لدىٰ المعتزلة المفيد
في عصرنا من التراث القديم، أو يتمُّ توظيف نظريّات الإسلام في موضوع «الشورىٰ» و«الملكيَّة العامَّة» وأمثال ذلك وتوظيفها بما يتناسب والحاجات المعاصرة. وفي الوقت نفسه، يذهب حسن حنفي إلىٰ اعتبار هذا النوع من الجهود لاستخراج بعض أبعاد التقدُّم من صلب التراث القديم، سعيًا جزئيًّا لا يفي بإعطاء صورة شاملة للتراث تساعد علىٰ تجديده وإصلاحه بما يتناسب والحاجات المعاصرة.
وبعد فراغ حسن حنفي من نقد الاتِّجاهات الثلاثة المتقدِّمة، قام بعرض اتِّجاهه تحت عنوان «التراث والتجديد»؛ وذلك بهدف إجراء إصلاح جوهري علىٰ التراث وحلِّ مشكلة التخلُّف والركود الفكري بأُسلوب نقدي. وتمَّ في هذا الاتِّجاه، بما يتناسب مع حاجة العصر، نقد التراث الإسلامي القديم والتراث الغربي الجديد.
يجب العمل في هذا الاتِّجاه علىٰ تأسيس علم جديد، علىٰ أنْ تكون نقطة بدايته تغيير النظرة إلىٰ أُصول الدِّين، وتبعًا لذلك تكتسب الفروع بدورها تفسيرًا جديدًا. وفي هذا العلم، يجب الانتقال من العقل إلىٰ الطبيعة، ومن الروح إلىٰ المادَّة، ومن الله إلىٰ العالم، ومن النفس إلىٰ البدن، ومن وحدة العقيدة إلىٰ وحدة السلوك. إنَّ هذا الإصلاح الجديد، من وجهة نظر حنفي، لا ينتهي باسم العقل أو الشرع، وإنَّما باسم الواقع ومن أجل تغييره؛ وذلك لأنَّ أُصول ومصادر التراث المتمثِّلة بالوحي، بزعمه، قد قامت علىٰ أساس
الواقع الخارجي، وقد طالها التغيُّر تبعًا لتغيُّرها، كما أنَّ أُصول التشريع ليست سوىٰ التنظير للواقع العيني والاجتماعي. وبعبارة أُخرىٰ: فإنَّ الإصلاح والتجديد ناظر إلىٰ تغيير وتطوير الواقع، وليس تطوير الواقع شيء آخر غير تغيير وتطوير التشريع.
والذي يتبقّىٰ في البين هو السؤال القائل: كيف يجب أنْ يتمَّ التحوُّل والإصلاح الجوهري للتراث القديم؟
وباختصار، فإنَّ حسن حنفي لا يرىٰ الطريق إلىٰ ذلك في التوفيق بين تراثنا القديم والتراث الغربي الجديد، بل في استثمار جميع الوسائل والشرائط التي يضعها عصرنا الراهن بين أيدينا (من قبيل: الأساليب والمفاهيم واللغة)، وهي شرائط منبثقة عن بيئتنا وثقافتنا المعاصرة واحتياجاتنا الراهنة. وعلىٰ هذا الأساس، يجب أنْ تكون المقتضيات المعاصرة هي الدعامة والأساس، كي يمكن إقامة صرح باسم التراث علىٰ قواعدها.
1. إنَّ الأُصول الخمسة للتجديد؛ أي: الطبيعة، والعقل، والإنسان، والمجتمع، والتاريخ بالمعنىٰ المقصود من قِبَل الحداثة، خلافًا لرؤية حنفي، لا وجود لها في الإسلام. إنَّ القرآن يدعو الإنسان إلىٰ التأمُّل فيه والتدبُّر في آياته
لغايتين، وهما أوَّلًا: التعرُّف علىٰ الطبيعة بوصفها آية تدلُّ علىٰ عظمة الخالق، وفي هذه الحالة لن يكون للعلم والطبيعة صورة علمانيَّة. وثانيًا: تنظيم علاقة الإنسان مع الطبيعة، كي يسلك، بعد التعرُّف علىٰ قوانينها، التصرُّف المناسب والمشروع في ضوء القِيَم الأخلاقيَّة وبالسلطة التكنولوجيَّة. إنَّ التعرُّف علىٰ الطبيعة في كلِّ علم من علوم التراث يتَّجه بما يتناسب وذلك العلم، ولذلك فإنَّ المقدّمة في علم الكلام والإلهيّات تتمثَّل في إثبات الصانع وصفاته، وأمَّا في العلوم الطبيعيَّة، فإنَّ التراث يأتي في سياق الهدف الثاني للقرآن الكريم.
وثانيًا: بالنسبة إلىٰ العقل، فإنَّ دائرته أوسع بكثير من العقل التجريبي والحسِّ والذوق، والعقلانيَّة الإسلاميَّة عقلانيَّة تستعين بالتجربة، بل هي التي تقيم بناءها، وتبلغ إلىٰ ما يقرب من عرصة الحضور وشهود حقائق الوجود. إنَّ الإبستيمولوجيا الإسلاميَّة تتكفَّل بمثل هذا البحث في الحقلين العقلي والعرفاني. إنَّ العلاقة القائمة بين العقل والنقل، كما يرسمها حنفي، لا تحظىٰ بالواقعيَّة، وبطبيعة الحال نشهد في تاريخ الإسلام إساءة استغلال كلٍّ من العقل والنقل، فلطالما عمد حُكّام الجور إلىٰ توظيف النقل لمصلحتهم وإلىٰ الضدِّ من التفكير العقلاني للإسلام، كما يقوم المستنيرون في المرحلة المعاصرة بتفسير المفاهيم والتعاليم الإسلاميَّة لمصلحتهم، ومع ذلك ليس كلُّ التراث الإسلامي والقرآن والسُّنَّة منسجمًا مع الصورة التي يرسمها حنفي، بمعنىٰ أنَّه خلافًا لرؤية حنفي في التراث الإسلامي، فإنَّ النقل لم يكن في خدمة السلطة وتبريرها وتحكيم دعائمها علىٰ الدوام، وإذا تمَّ توظيف هذا النوع من الروايات لدىٰ بعض الفِرَق الإسلاميَّة في تمكين بعض الحُكّام وتبرير
(175)أعمالهم، فهي من الروايات الموضوعة قطعًا. إنَّ العقل والنقل في الإسلام جناحان متناظران لفهم فعل وكلام الله في كتاب التكوين والتدوين، ولذلك فإنَّهما يُشكِّلان مصدرين من مصادر المعرفة الدِّينيَّة، لا أنْ يكون العقل خاضعًا لسلطة النقل.
وثالثًا: هناك اختلاف ماهوي بين الإنسان في عالم التجديد والإنسان في منطق القرآن، في حين أنَّ حنفي يُخطئ في نسبة الإنسان الحداثوي إلىٰ القرآن. فعلىٰ الرغم من تربُّع الإنسان في مركز اهتمام كتاب التكوين والتشريع الإلهي، وعلىٰ الرغم من كون الإسلام دينًا إنسانيًّا، إلَّا أنَّ هذا الإنسان هو الإنسان الربّاني الذي رفعته شدَّة اتِّصاله المعرفي والعبادي بالله إلىٰ مستوىٰ العزَّة والرفعة، دون الإنسان الذي أباح لنفسه أنْ يحلَّ محلَّ الله، ويجعل من نفسه محورًا لجميع الأشياء.
ورابعًا: أنَّ التجديد، خلافًا لرؤية حنفي، ليس واحدًا من المراحل التاريخيَّة التي تُؤدّي إلىٰ خروج الإنسان من الأفكار المظلمة والتقليديَّة البحتة. إنَّ التجديد، طبقًا لمبنىٰ حنفي نفسه في الاستغراب، يرتبط بتاريخ وجغرافيا خاصَّة، ولا يمكن اعتبار العالم الإسلامي جغرافيَّة له. فإن كانت فرقة الكرّاميَّة تذهب في علم الكلام إلىٰ القول بأنَّ الله محلّ للحوادث، هناك في المقابل مجموعة هائلة في التراث الإسلامي، ولاسيّما في مذهب الشيعة والمذاهب الأُخرىٰ، لا ترىٰ هذه الرؤية بشأن الله سبحانه وتعالىٰ، كي يُستَنتج منها أنَّ الله هو التاريخ علىٰ حدِّ تعبير هيجل. فهو يدَّعي أنَّ الله هو التاريخ، وأنّ
الوحي والنبوَّة ظاهرة تاريخيَّة، وسيأتي نقد هذا الكلام في الأبحاث الكلاميَّة. وعليه، فإنَّ الأُصول التي ذكرها حنفي للتجديد، لا صلة لها بالإسلام.
2. إنَّ حسن حنفي في بيان الاتِّجاهات النظريَّة للمسلمين لم يُقدِّم وصفًا وحكمًا صحيحًا فيما يتعلَّق بمسألة «التراث والتجديد»، فأوَّلًا: أنَّ اتِّجاه الاكتفاء الذاتي بالنسبة إلىٰ التراث الإسلامي، لا يُمثِّل تعبيرًا جامعًا بالنسبة إلىٰ جميع الذين تشبَّثوا بالتراث الإسلامي؛ لأنَّ «الاكتفاء الذاتي» ينفي جميع أنواع الجهود الخارجيَّة، في حين أنَّ هناك في الجبهة الإسلاميَّة المعاصرة، إذا ما استثنينا بعض الأشخاص والتيّارات المتطرِّفة من قبيل الوهّابيَّة، ولا سيّما في الاتِّجاه الشيعي رغم تعلُّقه بالتراث، مَنْ يستفيد من العناصر الإيجابيَّة والمناسبة لدىٰ الحضارات الأُخرىٰ، كما يُستفاد من إبداعاتها العلميَّة والعقليَّة. إنَّ التعابير التي ينسبها حنفي إلىٰ هذا الاتِّجاه، ليس لها نصيب من الحقيقة إلَّا في تلك الموارد المتطرِّفة.
وثانيًا: يتَّضح من خلال الثناء والتبجيل الذي يُقدِّمه حسن حنفي لاتِّجاه «الاكتفاء الذاتي بالتراث الغربي» أنَّ اتِّجاه «التراث والتجديد» الذي يتبنّاه لا يختلف عنه اختلافًا ماهويًّا، وإنَّ الفرق الوحيد بينهما يكمن من الناحية الأُسلوبيَّة، ولذلك فإنَّ جميع الانتقادات الواردة علىٰ ذلك الاتِّجاه، سوف ترد عليه أيضًا. إنَّ إشكاله الأصلي علىٰ الاتِّجاه المتقدِّم إنَّما هو أُسلوبي من حيث إنَّه حتَّىٰ ما قبل التغيُّر التدريجي للتراث القديم والذي يتمُّ من طريق إصلاحه، لا ينبغي العمل علىٰ طرده ونبذه؛ لأنَّه جزء من الواقع الاجتماعي. يبدو أنَّ الهاجس الرئيس الذي دفع حنفي إلىٰ اتِّخاذ هذا الأُسلوب، يكمن في التجربة التاريخيَّة الراهنة التي عاشها المسلمون في قبال المستغربين، والتي علىٰ أساسها
لم يكونوا يتقبَّلون الأفكار الغربيَّة، ولا يتنازلون عن التراث الإسلامي، ومن هنا فإنَّ حنفي بحاجة إلىٰ ذلك، كي يرفع هذه العقبة الكأداء من طريق التفسير الجديد للتعاليم الإسلاميَّة.
وثالثًا: أنَّ من بين المسائل الأساسيَّة هي الإجابة عن هذه الأسئلة: كيف يتمُّ تعيُّن الواقعيَّة العينيَّة المعاصرة لنا ومقتضياتها وحاجاتها؟ وما هو الدليل علىٰ ضرورة خروج عينيَّتنا الاجتماعيَّة من سلطة التراث الإسلامي؟ ما هو عالمنا الاجتماعي وما هي عناصره الرئيسة؟ إنَّ حنفي لم يلتفت إلىٰ هذه الأسئلة بشكل صحيح، ولم يُقدِّم ما تقتضيه من الإجابات، واكتفىٰ بالتأكيد علىٰ ضرورة الخروج من التراث القديم. وإنَّ كلامه في هذا الشأن أشبه بالخطاب الإنشائي منه إلىٰ الكلام العلمي.
أساليب تجديد وإصلاح التراث الإسلامي
إنَّ حسن حنفي يرىٰ رسالتين لمشروعه في إصلاح التراث الإسلامي أو «التراث والتجديد»: الرسالة الأُولىٰ: في حقل تغيير وجودنا الاجتماعي، وهذه الرسالة تفوق التنظير، والأُخرىٰ في حقل الأزمة التي أحاطت بأساليب الأبحاث الإسلاميَّة، ويجب العمل علىٰ إصلاح التراث عبر التخلّي عنها. وهو يرىٰ أنَّ الأبحاث الإسلاميَّة تعاني من أزمتين، وهما:
1. النعرة العلميَّة.
2. النزعة الخطابيَّة.
والأُولىٰ توجد في الغالب في أبحاث المستشرقين، والتي يخوض فيها المسلمون أحيانًا تبعًا لهم. وأمَّا الثانية، فهي الأزمة التي نشاهدها في أغلب
الدراسات الإسلاميَّة لدىٰ المسلمين، إلَّا أنَّ هذا الاختلاف علىٰ كلِّ حال يعود، من وجهة نظره، إلىٰ الخصائص الحضاريَّة لكلِّ واحدٍ منهما. يرىٰ حنفي أنَّ المناهج العلميَّة التي استخدمها المستشرقون في تحقيقاتهم الإسلاميَّة عبارة عن: المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، والمنهج الإسقاطي، ومنهج الأثر والتأثير. ثمّ ينتقل بعد ذلك إلىٰ نقد ومناقشة الموارد التي يذكرها كنماذج للنزعة الخطابيَّة، من قبيل: الأُسلوب التكراري، والأُسلوب الدفاعي، والأُسلوب الجدلي، وأُسلوب الحدس قصير المدىٰ.
إنَّ تجديد التراث من وجهة نظر حنفي يتمُّ من خلال أساليب خاصَّة، ويعود بعضها إلىٰ اللغة والمفردات، وبعضها إلىٰ المعاني والمفاهيم، وبعضها الآخر إلىٰ الأشياء ذاتها والموضوعات ذات الصلة؛ لأنَّ الفكر يشتمل علىٰ ثلاثة أبعاد، وهي: اللفظ، والمعنىٰ، والشيء.[3] وقد عمد حنفي ضمن الأبحاث الثلاثة، أي: إصلاح اللغة، وكشف المعنىٰ، والبيئة الثقافيَّة، إلىٰ توضيح هذه الأُمور الثلاثة.
إنَّ حسن حنفي يرىٰ أنَّ ارتباط اللغة بالعلم من العُمق بحيث أنَّ اكتشاف لغة جديدة يعني اكتشافًا للعلم. ومن هذه الناحية يكون تطوُّر العلوم وانفراج أزمتها باكتشاف اللفظ أو المفهوم، ومن ثَمَّ يصبح التجديد من طريق اللغة
بداية العلم الجديد. وعليه، فإنَّ اللغة وسيلة للتعبير، وكلُّ فكرة جديدة تحتاج إلىٰ لغة جديدة. وعندما تتطوَّر الحضارة وتمتدُّ وتتَّسع معانيها، تضيق بلغتها القديمة الخاصَّة التي لم تعدّ قادرة علىٰ إيصال أكبر قدر ممكن من المعاني لأكبر عدد ممكن من الناس؛ فتنشأ حركة تجديد لغويَّة، وتسقط فيها الحضارة لغتها القديمة الخاصَّة، وتضع لغة جديدة أكثر قدرةً علىٰ التعبير.
يتَّهم حنفي التراث الإسلامي باستعمال الألفاظ والمصطلحات القديمة والتقليديَّة نفسها، والتي يصفها بالقصور التقليدي. بمعنىٰ أنَّ الأدبيّات الموجودة في التراث الإسلامي عاجزة عن إيصال المضامين الجديدة والمفاهيم المتناسبة مع الحاجات المعاصرة. وإنَّ الألفاظ المستعملة في أُصول الدِّين والعقائد من قبيل: الله، والرسول، والجنَّة، والنار، والثواب، والعقاب، أو المصطلحات الفقهيَّة أو القانونيَّة، مثل: الحلال، والحرام، والواجب، والمكروه، أو مصطلحات الفلسفة، مثل: الجوهر، والعرض، والممكن، والواجب، والعقل الفعّال، أو كما في العرفان والتصوُّف، من قبيل: الرضا، والتوكُّل، والورع، والصبر، والخشية، والخوف، والحزن، والبكاء، تكون كلُّها مشمولة لهذا الحكم أيضًا؛ لأنَّ الاقتران الدائم بين لغة التراث ومصطلحاته بالمعاني والمفاهيم القديمة، قد سلبته القدرة علىٰ بيان المعاني الجديدة.
ولا يتمُّ تجديد الألفاظ بطريقة آليَّة بإسقاط لفظ ووضع أيِّ لفظ آخر محلَّه، بل بطريقة تلقائيَّة صرفة في وعي الباحثين والمحقِّقين، حيث يسعىٰ
المحقِّق والباحث إلىٰ إرجاع الشعور من اللفظ التقليدي إلىٰ المعنىٰ الأصلي الذي يفيده ثمّ يحاول التعبير من جديد عن هذا المعنىٰ الأصلي بلفظ ينشأ من اللغة المتداولة، كما كان اللفظ التقليدي متداولًا شائعًا في القديم. وعليه، فالمعاني هي معاني التراث، واللغة لغة التجديد. وبطبيعة الحال، فإنَّ التجديد والإصلاح اللغوي ليس شكليًّا فقط، بل يسري إلىٰ المضمون أيضًا، بمعنىٰ أنَّه يخلق هذه الأرضيَّة التي يمكن للمضمون معها أنْ تكون له القدرة علىٰ التعبير والكشف عن كلِّ إمكانيّاته. وعليه، فإنَّ دور اللغة في بناء العلم دور أساسي، بل يمكن القول: إنَّ العلم هو لغة، وإنَّ تأسيس العلم هو إنشاء اللغة.
إنَّ الأُسلوب الثاني من أساليب تجديد وإصلاح التراث القديم من وجهة نظر حنفي، يكمن في اكتشاف المعاني المستورة والمستويات الحديثة المطويَّة في التراث علىٰ نحو غير بارز. وإنَّ مراد حنفي من المستويات الحديثة هي الزاوية التي ينظر المحقِّق من خلالها إلىٰ التراث، ولا يأتي ذلك إلَّا من خلال الرؤية العصريَّة للمحقِّق. يرىٰ حنفي أنَّ التراث يمكن قراءته بمنظورات متعدِّدة كلِّها ممكنة، وأمَّا التجديد والإصلاح فهو إعادة قراءة التراث بمنظور العصر. ليس معنىٰ ذلك أنَّ القراءات القديمة له خاطئة أو أنَّ القراءات المستقبليَّة له غير واردة، بل يمكن أنْ تكون كلَّها صحيحة، ولكنَّ الخطأ هو قراءة التراث من قِبَل المعاصرين بمنظور غير عصري.
يذهب حنفي إلىٰ القول بأنَّ أهمّ هذه المستويات في إبراز وإصلاح التراث هو مفهوم الشعور؛ لأنَّ هذا المفهوم يُشير إلىٰ بُعد خاصٍّ من الإنسان الذي هو علىٰ حدِّ تعبيره: أهمّ من العقل، وأدقّ من القلب. إنَّ الأهمّيَّة التي أولاها تراثنا إلىٰ اللّاهوت والطبيعيّات، لم يولها إلىٰ الإنسان وشعوره، رغم وجودها علىٰ نحو ضمني ومستور داخل اللّاهوت وعلوم التراث، ولكنْ ينبغي العمل علىٰ إظهارها في عمليَّة التجديد والإصلاح. ففي علم الكلام نجد التوحيد، علىٰ سبيل المثال، عندما يتحدَّد بعلاقة الذات بالصفات والأفعال، هو في الحقيقة وصف للإنسان الكامل أو «الإنسان كما ينبغي أنْ يكون». ومسائل المعاد كلُّها وصورها الذهنيَّة تُرجِعنا إلىٰ الشعور من حيث هو تصوير لنهاية العالم من أجل التأثير فيه. والنبوَّة تفترض أساسًا وجود الشعور، ومسائل الإمامة هي أيضًا في نهاية المطاف وصف لشعور الحاكم وشعور المحكومين والعلاقة بينهما، وفي سائر العلوم، من قبيل: الفلسفة والتصوُّف، نواجه الشعور أيضًا. إذاً، جميع هذه الأُمور وجميع العلوم منبثقة عن الشعور والوعي، وإنَّ معرفة الكائنات والأشياء إنَّما تتحقَّق من خلال الشعور، وفي الوقت نفسه فإنَّ الوجود الإنساني ليس شيئًا مغايرًا للوعي والشعور. وعليه، فإنَّ نقطة التلاقي بين المعرفة ووجود الإنسان تكمن في هذا الشعور. لذلك كانت مسألة عصرنا هي مسألة «الشعور»، وليس لدىٰ المصلح المجدِّد من غاية سوىٰ إيقاظ هذا الشعور. وعندما يتمُّ الحديث اليوم عن الفقر واحتلال الأوطان والآلام والمرارات، إنَّما يُراد بذلك الشعور بها. إنَّ مفردة «الشعور» موجودة في المخزون الروحي لكلٍّ من التراث
(182)والتجديد، ولذلك نشهد هذا المعنىٰ في مفهوم الكوجيتو الديكارتي، وفي قصديَّة الظاهريّات عند هوسِرْل أيضًا.
المستوىٰ الثالث المؤثِّر في تجديد وتحليل التراث الإسلامي يكمن في البيئة الثقافيَّة؛ وذلك لأنَّ تراثنا قد نشأ في واقع معيَّن له ظروفه وملابساته وثقافته التي أدَّت إلىٰ نوع معيَّن من الحالة الثقافيَّة والمادَّة العلميَّة التي تعكس تمامًا المشكلات التي تُعرضها هذه الظروف والملابسات. نشأت العلوم التقليديَّة من واقع الحضارة القديمة وعلىٰ مستواها الثقافي وفي واقعها التاريخي والاجتماعي، وهذا الواقع حدَّد بناء كلِّ العلم: ماهيَّته ومناهجه ونتائجه ولغته؛ فالعلوم القديمة بهذا المعنىٰ ليست علومًا مطلقة تثبت مرَّة واحدة وإلىٰ الأبد، بل هي علوم نسبيَّة حاولت التعبير عن الوحي في إطار نوعيَّة الثقافة الموجودة في العصر القديم. وعلىٰ هذا الأساس، يذهب حنفي إلىٰ القول بأنَّ الفقه القديم، علىٰ سبيل المثال، يغلب عليه طابع العبادات، ولا تأتي المعاملات إلَّا في الدرجة الثانية، في حين أنَّ مشكلاتنا الراهنة تكمن في المعاملات والأحكام المرتبطة بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم (الحكومة والشعب). ومشكلات الأُسرة حاليًّا ليست مشكلات فرديَّة ترجع إلىٰ أخلاق الناس بقدر ما هي مشكلات اجتماعيَّة يُحدِّدها وضع الأُسرة الطبقي وطبيعة النظام السياسي الذي تعيش فيه، لذلك فقد تغيَّر موضوعنا الفقهي. أو في علم الكلام كان الخطر يأتي من القول بالتجسيم والتشبيه والتأليه (بمعنىٰ إعطاء الأشياء أو الأشخاص
صفات إلهيَّة) أو الشرك، وعليه فقد ظهر التوحيد القديم في هذه المادَّة. أمَّا الآن، فالوضع قد اختلف، وأضحت الأرض هي الضائعة والناس مهزومة والنظم تتساقط، والروح مستذلَّة ومستعبدة، ومن ثَمَّ يمكن لمادَّة التوحيد أنْ تتغيَّر. وعليه، يجب أنْ يكون توحيدنا هو لاهوت الأرض، ولاهوت الثورة، ولاهوت التحرُّر، ولاهوت التنمية، ولاهوت التقدُّم.
من الواضح بطبيعة الحال أنَّ موقف مراد حنفي من لاهوت الأرض ولاهوت التحرُّر، ليس هو استخراج مباني أو مفاهيم هذه الأُمور من الدِّين، وإنَّما هو بصدد البحث عن الأرض والحُرّيَّة والثورة والتنمية برؤية عصريَّة زاخرة بطبيعة الحال بالنظريّات المعاصرة، ثمّ يُطلَق علىٰ تطبيق النصوص السماويَّة عليها بحث التوحيد المعاصر. يُعبِّر حسن حنفي عن مجموع التراث الإسلامي بـ «المادَّة» أو الموضوع الخاصِّ بالأزمنة القديمة، ومن أجل الإجابة عن تلك المسائل، واليوم حيث اختلفت مسائل عصرنا، فإنَّ تلك المادَّة يجب أنْ تتغيَّر بدورها أيضًا.
يمكن تجديد مادَّة العلم القديمة باتِّباع ثلاث مراحل:
1. التصفية: بمعنىٰ تخليص وإزالة الشوائب الحضاريَّة العارضة علىٰ موضوعات النصِّ. وهذه الشوائب تشمل الحُجَج العقليَّة التي أُقيمت علىٰ ذلك الموضوع، وكيفيَّة تفسير النصِّ ونتائج تحليله. وبعد التصفية يجب الرجوع إلىٰ المعنىٰ الأصلي والأوّلي للموضوع في النصوص.
2. إعادة البناء: ويُراد منه أنَّ المعنىٰ الأوَّل للنصِّ يجب إعادة بنائه داخل الشعور، حيث يتمُّ بناء الموضوع في الشعور عن طريق البدء المطلق، ومحاولة العثور علىٰ نقطة بديهيَّة ويقينيَّة يتمُّ عليها باقي البناء النظري، ثمّ يبدأ في بناء الموضوع خطوة خطوة حتَّىٰ يتمَّ بناؤه كلّيَّة، وفي هذه الحالة تكون أُسُس البناء النظري أُسُسًا شعوريَّة؛ إذ إنَّ الموضوع يتمُّ بناؤه في الشعور.
3. التعميم: بمعنىٰ إطلاق المعنىٰ حتَّىٰ يتجاوز الحدود اللفظيَّة، ويصبح نوعًا آخر من الوجود المطلق، وتصبح المعاني مبحثًا من مباحث الوجود العامِّ. ويمكن إطلاق المعنىٰ ابتداءً من المعنىٰ الاشتقاقي (اللغوي) للفظ، والذي يكشف عن الأصل الحسّي في العالم الخارجي، كما يمكن القيام بذلك من طريق إطلاق المعنىٰ المجازي للفظ الذي يحوي في باطنه إمكانيَّة إطلاق المعنىٰ وتجاوزه من المعنىٰ الأصلي عن طريق التشابه أو الالتزام أو الاستعارة، أو العمل علىٰ ربط المعنىٰ المطلق الحاصل من اللفظ بالمعنىٰ العُرفي الكامن في روح الشعب.
يذهب حنفي إلىٰ القول بأنَّ الفقهاء قد استفادوا من المرحلة الأُولىٰ، وأنَّ المتصوِّفة قد استفادوا من المرحلة الثانية، وأمَّا الفلاسفة فقد استفادوا من المرحلة الثالثة، وحاليًّا فإنَّ تفكيرنا المعاصر يحتاج إلىٰ الاستفادة من جميع هذه المراحل الثلاثة. وقد قام الفقهاء في الماضي بإزالة جميع الشوائب الحضاريَّة عن النصِّ، وجعلوا من النصِّ الخامِّ مرجعًا لهم وتحفَّظوا علىٰ معناه، ومن هنا كان الفكر الفقهي فكرًا تطهيريًّا وتنقيحيًّا للنصوص من الشوائب. أمَّا المتصوِّفة، فقد سعوا إلىٰ فهم المعاني الأوَّليَّة للنصوص السماويَّة علىٰ أساس
الوعي الذاتي، رغم أنَّهم تنكَّبوا الطريق في تحليل الوحي الذاتي؛ وذلك لأنَّهم بدلًا من دراسة الوعي الذاتي للفرد ضمن الوعي الذاتي للمجتمع والجماعة، عمدوا إلىٰ تحليله بمعزل عن شعور المجتمع. وقد اتَّخذ الفلاسفة الخطوة الثالثة، بمعنىٰ أنَّهم حوَّلوا عالم الأذهان إلىٰ عالم الأعيان، وتحوَّلت المعاني إلىٰ وجود، كما تحوَّل المعبود ذاته من «ثيولوجيا» إلىٰ «أنطولوجيا»، أي من نظريَّة في الله إلىٰ نظريَّة في الوجود.
إنَّ القيام بهذه المراحل الثلاثة لا يُمثِّل نهاية الطريق، بل تبقىٰ هناك ثلاث خطوات مهمَّة أُخرىٰ:
4. بعد مرحلة التصفية والإصلاح والتعميم، يجب العمل علىٰ تحليل الفكرة القديمة، وبيان الاحتمالات المختلفة وما هو الأظهر من بينها، وفي مثل هذه الحالة يخرج التراث من الحالة المنقولة، ومن تعلُّقه بالماضي، ويتحوَّل إلىٰ تراث معقول.
5. تحليل الواقع المعاصر، وذلك عن طريق التنظير المباشر للواقع وإدراك روح العصر من الأمثال العامّيَّة والنكات الشعبيَّة والأعمال الأدبيَّة للشعراء، والملاحظة المباشرة علىٰ رجل الشارع وعلىٰ سلوك الجماهير، والمعاناة من مآسي العصر والعيش في مآسيه، والانفعال بأحزانه وأفراحه. فالباحث ابن عصره كما كان الصوفي ابن وقته.
6. في هذه الخطوة يجب العمل علىٰ المقارنة بين الاحتمالات المعقولة بشأن التراث وبين الواقعيَّة المعاصرة (التي تمَّ بحثها في المرحلة الثانيَّة)، كي يتعيَّن
المعنىٰ المناسب لروح العصر. وتتلخَّص مسؤوليَّة المحقِّق في هذه المرحلة بالربط بين القديم والجديد، وإحياء التراث، وتأصيل العصر.
1. بالالتفات إلىٰ أنَّ حسن حنفي يرىٰ أنَّ التراث الإسلامي، وكلُّ تراث آخر، يمتلك لغة خاصَّة تنشأ بمفاهيمها الخاصَّة من بيئة ثقافيَّة خاصَّة، لذلك فإنَّه يُفسِّر تجديد التراث بالالتفات إلىٰ الأضلاع الثلاثة، وهي: اللغة، والمفاهيم، والبيئة الثقافيَّة. وبطبيعة الحال، يجب أنْ تكون حصَّة البيئة الثقافيَّة أو الشرائط الحضاريَّة أكثر من العنصرين الآخرين؛ إذ إنَّ هذا العنصر، طبقًا لمبناه، هو الذي يُحدِّد الأفكار والحاجات، وبالتالي فإنَّه هو الذي يعمل علىٰ تعيين اللغة. إنَّ التصوير الحضاري أعلاه، والذي يُشكِّل الإطار الأصلي لذهن حنفي، لا يصدق علىٰ الإسلام والتراث الإسلامي. إنَّ الإسلام، وإنْ كان صانع حضارة، إلَّا أنَّ الحضارة الإسلاميَّة تحتوي علىٰ مجموعة من التعاليم الإسلاميَّة، ويشتمل أحيانًا علىٰ بعض العناصر من التعاليم غير الإسلاميَّة، بل وحتَّىٰ مغايرة للتعاليم الأصليَّة للكتاب والسُّنَّة، ولذلك لا بدَّ في التعرُّف علىٰ الإسلام واستعادة التعرُّف علىٰ التراث الإسلامي من الرجوع إلىٰ الموازين الأصليَّة له؛ أي القرآن والروايات. وعليه، فإنَّ التعاليم الأصليَّة للكتاب والسُّنَّة كان لها لغة ناطقة، ولذلك تكون هي الأصل، وعلىٰ الأفكار أنْ تعمل علىٰ اكتشاف معانيهما الحقيقيَّة والأصيلة. وفي هذا الاتِّجاه يجب عرض مسائلنا وحاجاتنا وهواجسنا
علىٰ الكتاب والسُّنَّة، كي يتمَّ الكشف عن الأفكار الدِّينيَّة من الطريق العقلي والنقلي وبشكل منهجي.
2. مع الحفاظ علىٰ المبنىٰ المتقدِّم، فإنَّ الإصلاح والتجديد اللغوي علىٰ النحو الذي ذكره حنفي لا يصحُّ علىٰ إطلاقه. إنَّ اللغة والفكر متلازمان، وإنَّ التغيير في التفكير يخلق لغة وأدبيّات جديدة. وعندما تحصل حضارة علىٰ مفاهيم جديدة، فإنَّ نسبتها إلىٰ اللغة القديمة ستكون رهنًا بنسبتها إلىٰ المعاني القديمة. إنَّ الحضارة منظومة تاريخيَّة متماسكة لا ترضخ للتغيير بسهولة، ولكنَّها ما إنْ تتقبَّل التغيير حتَّىٰ تعمل علىٰ تذويبه في سائر أجزاء منظومتها، وإلَّا فإنَّها ستتعرَّض إلىٰ التعارض والانسلاخ وعدم التجانس. إنَّ الإبداع يدعو تفكير الإنسان إلىٰ خلق لغة جديدة أو نقلها من المجتمعات البشريَّة الأُخرىٰ. إنَّ اللغة الجديدة والأفكار المستحدثة بحاجة إلىٰ تقييم، كما هو الشأن في تقدُّم العلم، وإنَّ معيار تقييمها في الحضارة الإسلاميَّة يكمن في تعاليم الإسلام. وفي هذه الحالة، فإنَّ تسلُّل اللغة الجديدة، بل وحتَّىٰ الأفكار المستحدثة، لا يعني بالضرورة أنَّ اللغة والفكر القديم يصبح باليًا، يُضاف إلىٰ ذلك أنَّ القبول بها يحتاج إلىٰ معيار، وهو ما حدَّد الإسلام مناطه. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّه من خلال الاجتهاد والإبداع الفكري واللغوي، إنَّما تنحسر بعض الألفاظ عن التراث الإسلامي ممَّا كان له حضور في بعض أدبيات التراث (لا أنْ تكون في صُلب الكتاب والسُّنَّة)، إلَّا أنَّ محدوديَّتها أو الخطأ فيها يظهر من خلال الاجتهاد والسعي العلمي
المنظَّم. وعليه، فإنَّ الانبهار بالمفاهيم واللغة الجديدة للحضارة الغربيَّة لا ينبغي أنْ يُشكِّل دليلًا علىٰ قِدَم لغة التراث الإسلامي برمَّته. ومن هنا ما الذي سيبقىٰ من التراث الإسلامي إنْ نحن قمنا بحذف أهمّ ألفاظ ومفردات التراث الإسلامي، من قبيل: الله، والنبيّ، والجنَّة، والنار، والثواب، والعقاب، والمفاهيم الأخلاقيَّة والعرفانيَّة، التي هي من قبيل: التوكُّل، والرضا، والخشية، والبكاء وما إلىٰ ذلك ممَّا هو مقتبس بأجمعه من النصوص الصريحة في الكتاب والسُّنَّة؟! فهل يدخل هذا في الإصلاح والتجديد أم في الهدم والتخريب؟! وبطبيعة الحال، فإنَّ حنفي صادق في قوله: إنَّ وجود هذه المفاهيم الجوهريَّة في التراث الإسلامي يحول دون تسلُّل الألفاظ والمعاني الجديدة التي هي من نتاج الحضارة الغربيَّة؛ لأنَّ أُصول العقيدة الإسلاميَّة تعمل علىٰ مكافحة الكفر، والشرك، وحبِّ الدنيا، والفوضىٰ المعرفيَّة.
3. إنَّ المشكلة والضعف الذي ينسبه حنفي إلىٰ التراث الإسلامي، هو في الحقيقة ليس مشكلة التراث، وإنَّما يعود إلىٰ المشكلات المعرفيَّة التي يعاني منها حنفي نفسه. فإنَّ الاتِّجاه المادّي والماركسي الذي يسلكه حنفي في الإلهيّات، لا يترك له مجالًا لهضم واستيعاب المعارف الإسلاميَّة. إنَّه يرىٰ مشكلة التراث في محوريَّة التوحيد واللغة الإلهيَّة، في حين أنَّ أصل التوحيد الإسلامي هو الذي يُشكِّل العنصر المقوِّم للتراث الإسلامي، وإذا عملنا علىٰ حذف وتقويض هذا العنصر، لنْ يكون هناك تراث أصلًا حتَّىٰ يمكن لنا أنْ ننسبه إلىٰ الإسلام. وخلافًا لرؤية حنفي، فإنَّ
الأدلَّة الكلاميَّة والفلسفيَّة والنقليَّة (الأعمّ من الكتاب والسُّنَّة) ليست بصدد تحديد أو تعيين الذات الإلهيَّة، بل تسعىٰ إلىٰ التأسيس لمعرفة وإيمان الإنسان بالوجود الإلهي المطلق. إنَّ حنفي يُنكِر دون دليل جميع الأدلَّة الأنطولوجيَّة علىٰ إثبات وجود الله، وبطبيعة الحال فإنَّه في فضاء التفكير الظاهراتي، يُنكِر كلَّ واقعيَّة قابلة للاتِّصاف بالصدق والكذب. إنَّه يعمل علىٰ تفسير مفهوم الله من منظور ظاهراتي، ومن هنا يعمل علىٰ تنزيل هذا المفهوم إلىٰ ظاهرة نفسيَّة مخلوقة للرغبات والآمال الإنسانيَّة. وعندما يتعرَّض إصلاح مفردة الله إلىٰ مثل هذا الدمار، فإنَّ سائر المفاهيم الأُخرىٰ، من قبيل: الوحي، والقرآن، والنبوَّة، والمعاد وما إلىٰ ذلك، سوف تتعرَّض بدورها إلىٰ مصير مؤسف. إنَّه حتَّىٰ علىٰ طبق مبناه الظاهراتي لا يحقُّ له الإنكار، ولا يمكنه القول: إنَّ الوجود الحقيقي لمصداق «الله» ينطوي علىٰ استحالة؛ لأنَّ اتِّجاهه لا يسعىٰ إلىٰ إظهار الواقع والصدق والكذب.
4. إنَّ الخصائص التي يذكرها حسن حنفي للغة التراث، من قبيل: الحقوقيَّة والصوريَّة والاشتمال علىٰ المعاني المختلفة، لا تقتصر علىٰ التراث الإسلامي فقط، وإنَّما هي موجودة في جميع المدارس واللغات المعاصرة. ثمّ إنَّ الخصائص التي ذكرها حنفي للغة الجديدة ونصح التراث الإسلامي بامتلاكها، بعضها يعاني من التناقض الداخلي، وبعضها الآخر غريب عن روح الإسلام، ويتعارض مع النصوص القرآنيَّة الصريحة. من ذلك، علىٰ سبيل المثال، أنَّ قوله بأنَّ اللغة
الجديدة لغة عامَّة ويمكن أنْ نخاطب بها جميع الناس من أيِّ حضارة كانوا، يشتمل علىٰ تناقض ذاتي؛ لأنَّ المفاهيم الغربيَّة الجديدة أو اللغة الجديدة، علىٰ حدِّ تعبير حنفي نفسه، ليس لها الكثير من المخاطبين في العالم الإسلامي في الحدِّ الأدنىٰ، بل إنَّها حتَّىٰ في العالم الغربي تواجه قراءات مختلفة ومخاطبين متعدِّدين. ومن ناحية أُخرىٰ، إذا كان هناك من الناس مَنْ لا يفهم مصطلح العلم والتكنولوجيا، أو لا يرىٰ قيمة لفلسفة الأخلاق، هل يمكن اعتبار هذه المصطلحات غير عقلانيَّة؟ ثمّ إنَّه ما هو الدليل الذي يدفعنا إلىٰ اعتبار اللغة الدِّينيَّة الزاخرة بالمفاهيم والمعارف الإلهيَّة وغير التجريبيَّة لغة غير عقلانيَّة؟ إنَّ جميع الألفاظ التي يذكرها حنفي بوصفها مشكلة التفكير المعاصر، لا يمكن حلُّها في المنطق الوضعي، في حين أنَّ هذا المنطق قد أعلن عن قِدَمه مسبقًا.
5. إنَّ الوحي إنَّما يعمل علىٰ تفسير وتغيير المسائل الإنسانيَّة في إطار خدمة أهدافه، لا أنَّ هذه المسائل والاتِّجاهات المعاصرة كانت هي الأصل، وقد فرضت نفسها علىٰ النصوص الدِّينيَّة. وهذا الاتِّجاه هو المعروف بـ «التفسير بالرأي»، والذي ورد ذمُّه بشدَّة في القرآن والسُّنَّة. ما هو الدليل الذي يجعل من الشعور أو الوعي الذاتي الظاهراتي يفرض نفسه علىٰ التراث بذريعة الاتِّجاه العصري؟! لقد حدث هذا الاتِّجاه في جزء من تاريخ الغرب، وكانت له مشكلاته وتحدّياته المعرفيَّة والأنطولوجيَّة الخاصَّة. وبالإضافة إلىٰ هذا الاتِّجاه، هناك الكثير من
الاتِّجاهات الأُخرىٰ في الغرب أيضًا، ويجب، طبقًا لمنطق حنفي، أن تُفرَض علىٰ التراث والنصوص الدِّينيَّة؛ لأنَّها عصريَّة!
6. إنَّ المراحل التي ذكرها حسن حنفي لتجديد التراث، إنَّما تكتسب مفهومها في الإطار الذهني له فقط، بمعنىٰ اعتبار التراث الإسلامي أمرًا تاريخيًّا وحضاريًّا، وتنزيل جميع حقائقه إلىٰ الشعور الظاهراتي. وقد سلك حنفي في هذه المرحلة طريق التطرُّف بحيث عمد في البداية إلىٰ اعتبار جميع المفاهيم والمعاني والأدلَّة المستعملة في التراث أُمورًا نسبيَّة ومرتبطة بمرحلة تاريخيَّة خاصَّة من الحضارة الإسلاميَّة، ويتعيَّن علىٰ التراث أنْ يتغيَّر الآن تبعًا لتغيُّرها. وفي الخطوة اللاحقة عمد حنفي إلىٰ تجاوز حتَّىٰ الحدود والمعاني اللفظيَّة، ويسعىٰ بمختلف الذرائع إلىٰ استعمال هذه الألفاظ في المعاني الجديدة للمعاني المعاصرة بحجَّة التعميم.
كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ حنفي يُؤكِّد علىٰ ضرورة تجديد التراث الإسلامي، ويطرح منهجًا وأُسلوبًا خاصًّا في هذا الاتِّجاه، ولاحظنا أيضًا أنَّ حنفي لا يرىٰ العلوم الإسلاميَّة مشتملة علىٰ دلالات ذاتيَّة وثابتة ومطلقة، وإنَّما يعتبرها انعكاسًا عن واقعيَّة العصر وتجلّيًا عن الوحي بما يتناسب مع الشرائط التاريخيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة القديمة. ومن هنا فقد اعتبر تجديد جميع العلوم الإسلاميَّة واحدًا من أهداف مشروعه، وقد اتَّجه علىٰ المستوىٰ العملي إلىٰ تقديم قراءة جديدة عن هذه العلوم، وقدَّم هذه القراءة في كُتُبه الكثيرة الناظرة إلىٰ كلِّ واحدٍ من العلوم الإسلاميَّة، مثل: الكلام، والفلسفة، وأُصول
الفقه وما إلىٰ ذلك. وفي هذا المقام سوف نعمل علىٰ نقد ومناقشة أفكاره في الحقول الثلاثة الآتية، وهي: الكلام، والفلسفة، والتفسير.
إنَّ لعلم الكلام مساحة واسعة جدًّا تشمل جميع الأُمور العامَّة التي تقتبس من الفلسفة وتكون ذات ماهيَّة فلسفيَّة وصولًا إلىٰ إثبات الصانع وصفاته وأفعاله، وكذلك سائر الأُصول الاعتقاديَّة لدىٰ المسلمين، من قبيل: النبوَّة والإمامة والمعاد وما إلىٰ ذلك، وقد عمد حسن حنفي في كتابه «من العقيدة إلىٰ الثورة» (والذي يقع في خمسة مجلَّدات)، إلىٰ التجديد في جميع الموضوعات والمسائل الكلاميَّة العامَّة والتفصيليَّة. وعلىٰ الرغم من قوله: إنَّ هذا الكتاب يأتي في إطار نقد الأشاعرة، ولكنَّه في الحقيقة قد اشتمل علىٰ جميع التيّارات والأفكار الكلاميَّة لجميع المسلمين، بل يمكن القول: إنَّه يُبطِل الأُصول المشتركة لجميع الأديان السماويَّة، وإنَّك لترىٰ جميع مباني ومناهج حنفي في تجديد التراث الإسلامي متجليَّة في هذه المساحة.
يتابع حنفي التجديد في علم الكلام من هذه الزاوية، إذ يقول: إنَّ علم الكلام قد تبلور في الماضي بالالتفات إلىٰ المخاطر والهواجس التي كانت تحيط به في تلك الأزمنة. من ذلك، علىٰ سبيل المثال، أنَّ البحث عن التوحيد ووحدانيَّة الله قد تبلور في ضوء مواجهة الثنويَّة والشرك و[التثليث عند] النصارىٰ، وظهر البحث في إثبات الصفات التنزيهيَّة في إطار نفي التجسيم والتشبيه في الأديان القديمة، وتبلور إثبات أزليَّة وأبديَّة الله في سياق مواجهة
أزليَّة المادَّة وقِدَم العالم في الثقافة اليونانيَّة، وجاء البحث عن إثبات المعاد لنفي التناسخ في الثقافة الهنديَّة، وظهرت الإمامة لمواجهة سياسة الملوك الإيرانيِّين وقياصرة الروم. إنَّ الثقافة القديمة كانت بحاجة إلىٰ كلام قديم، وأمَّا الآن فقد تغيَّرت الثقافة القديمة من الأساس، وأصبحت الثقافة المعاصرة تحتاج إلىٰ كلام معاصر. إنَّ كلامنا المعاصر يجب أنْ يكون متناسبًا مع هزيمة المسلمين، واحتلال البقاع الإسلاميَّة، وسلب الحرّيّات، وعروض الانحطاط، وعشرات المسائل الأُخرىٰ من هذا القبيل، والعمل علىٰ إبداع مسائل ومفاهيم جديدة، وعلىٰ المتكلِّم المعاصر أنْ يخرج من المجالات الكلاميَّة القديمة من قبيل: إثبات وجود الله، وخلق العالم، وخلود النفس وما إلىٰ ذلك، والتفرُّغ إلىٰ الدفاع عن مستقبل الأُمَّة في إطار التأسيس لكلام معاصر، وتقديم تعريف جديد، ومسائل جديدة، وأساليب وأهداف مستحدثة ومتناسبة ومنسجمة مع روح العصر.
ويرىٰ حنفي أنَّ الكلام الجديد كان موجودًا علىٰ الدوام، بمعنىٰ أنَّ الشرائط التاريخيَّة والعصريَّة كانت تدفع بعلم الكلام قسرًا نحو التطوُّر والتحوُّل، وفي كلِّ عصر كانت تظهر مسائل جديدة لم تكن مطروحة في السابق، فقد أدّىٰ تطرُّف المعتزلة إلىٰ ظهور الأشاعرة، ومع ملاحظة نقاط ضعف الأشاعرة ظهرت الماتريديَّة، وكان كلُّ واحدٍ من هذه التيّارات يُمثِّل كلامًا جديدًا بالقياس إلىٰ التيّارات السابقة.
إنَّ علم الكلام، من وجهة نظر حنفي، سيكون له تعريف جديد وموضوع
ومسائل وأساليب جديدة لا تشبه الكلام القديم (الكلام الإسلامي). ففي السابق كانت المسألة الأصليَّة تتمثَّل بالمخاطر التي تُهدِّد عقيدة التوحيد، بمعنىٰ الذات والصفات والأفعال الإلهيَّة. وقد أدَّت هذه المخاطر إلىٰ بلورة علم الكلام بمحوريَّة «الله»، أمَّا اليوم فلا يمكن لهذا العلم أنْ يكون بمنزلة العقائد التي تدافع عن الله، أو أنْ تكون كلامًا صادرًا عن الله، بل يجب أن تتحوَّل إلىٰ عقائد من أجل الدفاع عن البلدان الإسلاميَّة والعدالة والثقافة والهويَّة والاتِّحاد بين المسلمين. وفي الكلام الجديد، بدلًا من الاستدلال حول «نظريَّة العلم أو المعرفة الإسلاميَّة»، يجب الخوض في الدراسة المباشرة للواقعيَّة والإحصائيَّة الدقيقة لعناصرها، وبدلًا من البحث عن الوجود والمقولات الطبيعيَّة والميتافيزيقيَّة، من قبيل: الجواهر والأعراض، والأُمور العامَّة من قبيل: الواحد والكثير، والماهيَّة والوجود، والعلَّة والمعلول، والوجود والعدم، والوجوب والإمكان، والقِدَم والحدوث وما إلىٰ ذلك، يجب البحث عن الوجود الاجتماعي للإنسان ومفاهيمه الأصليَّة من قبيل: الحُرّيَّة والتقدُّم والعدالة والمساواة والمجتمع والتاريخ. إنَّ هدف الكلام الجديد هو تأسيس علم نظري لتوجيه الواقع وملء الفضاء النظري الخالي، ورفع الركود العملي في حياتنا المعاصرة. وسوف تكون مسائل وفروع علم أُصول الدِّين والكلام الجديد، عبارة عن موضوعات من قبيل: لاهوت التغيير الاجتماعي، ولاهوت التحرُّر، ولاهوت التنمية، ولاهوت الثورة، ولاهوت المقاومة، ولاهوت العدالة الاجتماعيَّة، ولاهوت الوحدة، ولاهوت التاريخ وما إلىٰ ذلك. وهذه هي رسالة التوحيد.
الأمر الآخر أنَّ رسالة علم الكلام ليست مجرَّد رسالة نظريَّة، بل إنَّها تشتمل علىٰ رسالة عمليَّة أيضًا. وفي الأساس، فإنَّ حنفي يرىٰ أنَّ هذه الرسالة لا تعمل علىٰ بيان حقائق عينيَّة في الخارج من قبيل مفهوم الله وأسمائه وصفاته وأفعاله والوحي والقيامة، بل إنَّها عبارة عن علم الأيديولوجيا السياسيَّة للعمل والتغيير الاجتماعي وتنطوي كذلك علىٰ دوافع للسلوك أيضًا.
وبالإضافة إلىٰ الرؤية الجديدة التي قدَّمها حنفي في علم الكلام ورسائله، فقد عمد كذلك إلىٰ تقديم قراءة جديدة عن المسائل الكلاميَّة، من قبيل: التوحيد والعدل والنبوَّة والمعاد والإمامة أيضًا. وبزعمه أنَّ هناك خلوًّا وغيابًا أو خفاءً في الكلام والتراث الإسلامي لعنصرين أساسيَّين، وهما: الإنسان والتاريخ. وهو يسعىٰ إلىٰ إعادة مباحث اللّاهوت أو العقليّات الكلاميَّة إلىٰ الإنسان، وإرجاع السمعيّات أو النبوّات، وكذلك الإمامة، إلىٰ البُعد الثاني المتمثِّل بالتاريخ.
إنَّه في هذه القراءة للمسائل الكلاميَّة يعتبر اللّاهوت نوعًا من الأنثروبولوجيا المقلوبة، ويسعىٰ من خلال تغيير محور علم الكلام من الله إلىٰ الإنسان، وإعادة هذا العلم إلىٰ شكله الأصلي؛ إذ يعتقد أنَّ الإنسان في غير هذه الحالة سيقبع في اغتراب عن الذات خلف الذات والصفات والأفعال الإلهيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، يتمُّ تفسير الله، بوصفه أهمّ أصل في حقل اللاهوت، بـ «الوعي الخالص»، أو ذات وشعور الإنسان بذاته، وأنَّ صفاته مجموعة من الأُصول والمبادئ المعرفيَّة التي توجِدها الذات، وأنَّ أفعاله تشير إلىٰ تحقُّق هذا الوعي
في التاريخ. وبالتالي فإنَّ الذات والصفات والأفعال إنَّما تنظر إلىٰ البُعد النظري والعملي في وعي الإنسان، لا أنَّها تدلُّ علىٰ وجود متشخِّص في الخارج.
إنَّ حسن حنفي من خلال القراءة المقلوبة للاهوت، يرىٰ أنَّ الصفات التي يتمُّ إثباتها ونسبتها إلىٰ الله هي في الحقيقة صفات الإنسان، وأنَّها تُنسَب إلىٰ الله مجازًا، وهي صفات من قبيل: السمع، والبصر، والقدرة، والعدل وما إلىٰ ذلك. ومن هنا فإنَّ حنفي يُعبِّر عن هذا الإنسان بالإنسان الكامل، ويرىٰ أنَّ الإنسان في ظلِّ ظروف روحيَّة واجتماعيَّة خاصَّة، من قبيل: الفقر والعجز والظلم والتعسُّف، ينسب هذه الصفات حدَّ الإطلاق واللاتناهي إلىٰ الغير، ثمّ يقرأ هذه الصفات بشكل فنّي كي تترك تأثيرها علىٰ النفوس الإنسانيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ الإلهيّات ليست غير طرح عملي ونظام مثالي لوعي الإنسان، وأنَّ المتكلِّمين يذهبون إلىٰ القول بوجود حقيقة عينيَّة في الخارج وراء الأوصاف الذاتيَّة للشعور.
وطبقًا لهذا التوجُّه تكون جميع أسماء الله وصفاته وأوصافه بمثابة المشجب الذي تعلَّق عليه البشريَّة تاريخها إيجابًا أم سلبًا، فهو القويُّ لشعب يريد القوَّة أو يعيش الاستضعاف، والعليم لمجتمع تقوم حياته علىٰ العلم أو يعاني من وطأة الجهل، وعادل في نظام اجتماعي يرعىٰ العدل أو يقوم علىٰ الظلم. وبهذا المعنىٰ تصبح الأسماء والصفات الإلهيَّة مفتوحة لكلِّ العصور والأجيال والطبقات الاجتماعيَّة، لتأخذ منها ما يتناسب وحاجاتها وتطلُّعاتها.
يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ هذا التفسير للإنسان في تاريخنا وتراثنا حيث جنح نحو الانحطاط، فإنَّ الإنسان لم يتمكَّن من العثور علىٰ مكانته، وتحوُّل الإنسان الكامل (أي: التوحيد في التراث القديم) إلىٰ مثال ورمز، كي يداري الإنسان المقهور والمفتقر إلىٰ الإرادة والعقل المستقلِّ بها نفسه. وفي ظلِّ هذه الظروف لجأ الإنسان المغلوب علىٰ أمره إلىٰ التصوُّف والإشراق، كي يهرب بذلك من العالم الخارجي، ويحلُّ التصوُّف محلَّ اغترابه الذاتي.
كما ذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ السمعيّات والنبوّات (أي: النبوَّة والمعاد)، قد حلَّت محلَّ التاريخ، وأنَّ التاريخ الإنساني العام قد ظلَّ في الماضي والمستقبل مغتربًا عن ذاته وراء موضوع النبوَّة والمعاد. ومن هذه الزاوية تشير النبوَّة إلىٰ تطوُّر الوحي في الماضي، والوحي هو التاريخ. وبالتالي كان الوحي والنبوَّة يُمثِّل التاريخ الماضي للإنسان، بينما المعاد يرتبط بالتاريخ القادم ومستقبل الإنسان، ولا نعني بالمستقبل هنا ما بعد الموت بالضرورة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ النبوَّة والمعاد يُشكِّلان التاريخ العامَّ للإنسانيَّة. وعليه، فإنَّ النبوَّة في هذه الرؤية تُمثِّل تاريخ تطوُّر وتنمية الشعور والوعي الذاتي للإنسان في الماضي، في حين أنَّ المعاد يرتبط بنتائج أعمال الإنسان في المستقبل، والذي يُمثِّل الاستقلال العقلاني للإنسان من جميع المصادر الخارجة عن ذاته، وتحقُّق حُرّيَّة عمله وسلوكه.
إنَّ التاريخ الخاصَّ والمتعيَّن الذي يشير إلىٰ تاريخ الفرد الإنساني أو الحكومات في مختلف المراحل التاريخيَّة، يُمثِّل حصيلة تفكير الإنسان
وعمله، وقد ظهر التاريخ الخاصُّ في فكر الإمامة. يرىٰ حنفي أنَّ مسألة وجوب الإمامة أو عدم وجوبها، هي المسألة العامَّة المتمثِّلة بضرورة الحكومة في الفلسفة السياسيَّة. ويعتقد بأنَّ أصل السلطة والحكومة في المجتمع تنطوي علىٰ ضرورة طبيعيَّة من أجل ضمان المصالح وتنظيم وتدبير أُمور المجتمع، إلَّا أنَّ السلطة يجب أنْ تقوم علىٰ عقد اجتماعي شفهي أو مكتوب
1. لقد خلط حنفي بين تاريخيَّة مراحل الظهور وعلم الكلام، وهو أمر صحيح، وبين تاريخيَّة ماهيَّة المسائل الكلاميَّة. إنَّ علم الكلام رغم تأثُّره بالخلفيّات التاريخيَّة والاجتماعيَّة، وقد تحتوي بعض الفِرَق الكلاميَّة علىٰ أفكار لا تنسجم مع الكتاب والسُّنَّة ولا توافق حكم العقل، وإنَّما هي من صنع العوامل السياسيَّة والاجتماعيَّة، إلَّا أنَّ الكثير من تعاليم علم الكلام، ولاسيّما الكلام الشيعي، وقسم كبير من كلام أهل السُّنَّة، مقتبس من القرآن والسُّنَّة وحكم العقل، وليس من سنخ المسائل التاريخيَّة.
من ذلك مثلًا أنَّ غاية علم الكلام لم تكن منحصرة بمواجهة الأخطار والآفات الاجتماعيَّة التي هي من قبيل: الشرك والثنويَّة وأمثالهما، بل كان للتوحيد والأبحاث التوحيديَّة مطلوبيَّة ذاتيَّة، وقام هذا العلم بالدفاع عنها والاستدلال عليها بوصفها حقائق قائمة بذاتها. وإنَّ جميع أنواع النفي الحاصلة في علم الكلام، من قبيل: نفي التجسيم، ونفي التشبيه، ونفي الشرك، ونفي الثنويَّة، ونفي أزليَّة المادَّة، ونفي التناسخ، وما إلىٰ ذلك، إنَّما كان مقدّمة لإثبات
التوحيد، وهو من جهة أُخرىٰ من لوازمها ونتائجها. يضاف إلىٰ ذلك أنَّ هذا السؤال يمكن أنْ يتمَّ توجيهه إلىٰ حنفي، وهو: ما هو الشيء الذي تُهدِّده هذه المخاطر؟ فما لم يتمّ افتراض أصل أو حقيقة ثابتة، لن يكون هناك معنىٰ لدفع الخطر عنها. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ التوحيد حقيقة خالدة، ويأتي توجيه جميع الجهود الكلاميَّة والفكريَّة في سياق هذا المفهوم القرآني. كيف لا يكون التوحيد والأسماء والصفات الإلهيَّة من أهمّ المسائل الإنسانيَّة في جميع العصور بما في ذلك عصرنا الراهن، في حين أنَّ حنفي نفسه والكثير من أضرابه من المفكِّرين في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي قد عملوا علىٰ نفيه أو إثباته، وعليه ألَّا يُمثِّل نفي التوحيد، ولا سيّما في الأبعاد العباديَّة والتشريعيَّة، هو الخطر الأساسي لهذا العصر؟ نحن في هذا العصر، خلافًا لرأي حنفي، بحاجة إلىٰ علم الكلام أو الفلسفة الإلهيَّة المتقنة أكثر من أيِّ عصر آخر للإجابة عن الشُّبُهات والإشكالات المستحدثة، والتي تعمل في بعض الأحيان تحت نقاب الأدبيّات الدِّينيَّة علىٰ إنكار أهمّ الأُسُس الإسلاميَّة.
2. إنَّ من بين المشكلات التي يعاني منها حنفي، هو الخلط بين المسائل الكلاميَّة والمسائل الاجتماعيَّة. وفي هذا الشأن لا بدَّ من الالتفات إلىٰ أنَّ علم الكلام والفلسفة الإلهيَّة تتكفَّل بالبحث عن مبادئ الوجود والذات والصفات والأفعال الإلهيَّة، بغية بيان واتِّضاح الأهداف والغايات من الخلق وما هي الرسالة والغاية الملقاة علىٰ عاتق الإنسان، وتكون في حدِّ ذاتها أرضيَّة للمفاهيم السياسيَّة والاجتماعيَّة. يشتمل الإسلام علىٰ تعاليم ومفاهيم كثيرة بشأن كلِّ واحدة من المقولات ذات الصلة بالدفاع عن المسلمين، والبلاد،
والحُرّيَّة، والعدالة، والهويَّة، والاتِّحاد بين المسلمين، وكذلك المفاهيم الاقتصاديَّة والسياسيَّة والثقافيَّة، وهي مجموعة في الفقه الإسلامي وغيره من العلوم الخاصَّة بهذا الشأن، وبطبيعة الحال يمكن للاجتهاد الإسلامي أنْ يُؤدّي إلىٰ الإبداع والتجديد وتوسُّع رقعة الفقه والعلوم الإسلاميَّة، ولا يُؤدّي في الوقت نفسه إلىٰ الخلط والتداخل بين حدود العلوم.
3. يعمد حنفي من خلال مبناه الظاهراتي والاتِّجاه التقليلي إلىٰ التنزُّل بأكثر حقائق الوجود أصالةً إلىٰ مستوىٰ المشاعر الباطنيَّة للفرد والوعي، كما أنَّه من خلال التسليم بالعلوم الإنسانيَّة الغربيَّة يسعىٰ إلىٰ تطبيق التراث الكلامي عليها. إنَّ اتِّجاهه لم يُبيِّن سبب اختياره لمثل هذه التأويلات غير المناسبة، وبذلك عمد إلىٰ تقويض أُسُس العقائد الدِّينيَّة عبر مرحلتين، في المرحلة الأُولىٰ قام بتأويله إلىٰ تنزيل أُصول من قبيل التوحيد والعدل من الساحة الإلهيَّة وحقل الارتباط المعرفي للإنسان مع الله، أو تحريفها، وفسَّرها بتكلُّف واضح بالدائرة البشريَّة البحتة، بل وحتَّىٰ الدائرة غير المرتبطة بالحقل الإنساني للمسلمين. وفي المرحلة الثانية اعتبر جميع الموضوعات المهمَّة المرتبطة بالنبوَّة والمعاد والإمامة والعمل الصالح أُمورًا ظنّيَّة وغير قابلة لليقين، وخارجة عن حقل الصواب والخطأ، كي يأمن من شظايا تكفير المسلمين. ويتمُّ العمل علىٰ تجديد علم الكلام بوساطة هذا الاتِّجاه في كتابه من العقيدة إلىٰ الثورة. وبأدنىٰ تأمُّل، يتَّضح أنَّ أُسلوب «اختيار القراءة المناسبة للعصر»، والأُسلوب السابق عليه، لا يحمل رسالة غير أُسلوب التأويل، ومدَّعياته لا تنسجم مع العقل والنقل، بل وحتَّىٰ تاريخ الفِرَق الكلاميَّة المعروفة بين المسلمين.
إنَّ جوهر كلامه يعود إلىٰ تأويليَّة النصوص وتبديل المعتقدات الدِّينيَّة إلىٰ قراءات ومعانٍ خاصَّة خالية من الجوهر الأصلي للنصوص، ولا تعترف بأيِّ ضابطة لهذا التطبيق والتحميل.
4. يمكن العثور علىٰ ذروة الاتِّجاه المادّي والماركسي والظاهراتي لحسن حنفي في تفسيره الخاصّ لأُصول العقائد الإسلاميَّة. إنَّ التوحيد بوصفه حقيقة عينيَّة، كان علىٰ رأس دعوة جميع الأنبياء، ولم يكن مجرَّد بيان لشعور داخلي، وله مصاديق عصريَّة عديدة وكاشفة عن آمال وتطلُّعات كلِّ قوم أو قبيلة علىٰ مختلف العصور. إنَّ لفظ «الله» المحدَّد في دلالته علىٰ وجوده المطلق، مثل دلالة لفظ «اللامتناهي» المحدَّد علىٰ معنىٰ اللامتناهي. أمَّا المغالطة الأُخرىٰ التي يرتكبها حنفي، فتكمن في موضوعيَّة ذات شيء بالنسبة إلىٰ علم ما. إنَّ مفهوم الذات الإلهيَّة يُشير إلىٰ معنىٰ وحقيقة لا متناهيَّة تخلو من جميع أنواع النقص والمحدوديَّة، ومنزَّهة من جميع العيوب، مثل هذا المفهوم هو الذي يصبح موضوعًا لعلم الكلام، وليس الوجود العيني وحقيقة الذات؛ لأنَّ اكتناه ذات الله والإحاطة به، تُعتَبر من المحال بالنظر إلىٰ عدم محدوديَّته. إنَّ العلوم التجريبيَّة التي تدرس الظواهر الزمانيَّة والمكانيَّة، لا تمتلك القدرة علىٰ إثبات الصفات الإلهيَّة، ولا أيّ موضوع ميتافيزيقي آخر، إلَّا إذا استعانت بالعقل الفلسفي، وكانت مقدَّمة في برهان فلسفي. إنَّ المشكلة التي يطرحها حنفي بوصفها مشكلة معرفيَّة تتعلّق بالانتقال من الذهن إلىٰ الخارج، إنَّما هي مشكلة ترتبط بفلسفة كانط، ومنه انتقلت إلىٰ ظاهريَّة هوسِرْل، وقد حبس حنفي نفسه داخل الأسوار المعرفيَّة الكانطيَّة، في حين أنَّ المشكلات المعرفيَّة
في العالم الغربي إنَّما تخصُّ الغربيِّين، فكيف يمكن تسرية أزماتهم إلىٰ الفكر والحضارة الإسلاميَّة؟!
5. إنَّ تفسير الذات والصفات والأفعال الإلهيَّة بـ «الإنسان الكامل»، إنَّما هو تفسير خيالي ومخدوش من ثلاث جهات، فأوَّلًا: أنَّ المبنىٰ الظاهراتي والمادّي لهذا التفسير، وكذلك هذا التفسير نفسه، لا يستند إلىٰ أيِّ مبنىٰ عقلي أو نقلي، بل هو مخالف لصريح الكتاب والسُّنَّة وحكم العقل. وثانيًا: أنَّ وجدان وعرف المسلمين لا يرىٰ لهذا القول قيمة، والشاهد علىٰ ذلك ردود أفعالهم الشديدة في قبال هذه التفسيرات، وعليه فإنَّ هذا التفسير يخالف حتَّىٰ المشاعر والواقعيَّة المعاصرة للمسلمين أيضًا. وثالثًا: أنَّ هذا التفسير لن يعجز عن حلِّ المشكلات المعاصرة للمسلمين فحسب، بل إنَّه سيعمل علىٰ مفاقمة المشكلات الراهنة، وينقل أزمات المجتمعات الغربيَّة إلىٰ العالم الإسلامي أيضًا.
6. يأتي تعبير حسن حنفي عن «الإنسان المتعيَّن» في قبال تعبيره بـ «الإنسان العامِّ». إنَّ الإنسان المتعيَّن ناظر إلىٰ كلِّ فرد إنساني من الذين يشعرون باستقلاليَّتهم ويرون لأنفسهم هويَّة محدَّدة ومتعيَّنة. إنَّ تعيُّن الإنسان في المنطق الدِّيني يعني صيرورة وتبلور شخصيَّته التي تغدو ممكنة من طريق الإرادة (الاختيار) والعمل. ويعتبر الإيمان والعمل الصالح في الإسلام بوصفهما ركنين يُحدِّدان شخصيَّة الإنسان المسلم وهويَّته الإسلاميَّة. إنَّ الإيمان والعمل الصالح بحاجة إلىٰ معرفة وفكر ديني صحيح، وإنَّ العقل والنقل كاشفان أساسيّان في الوصول إلىٰ الفكر الدِّيني. إنَّ حُرّيَّة واختيار الإنسان، خلافًا لحسن حنفي، لا بمعنىٰ الاستقلال المطلق للإنسان في حقل «أنا أُريد»، وإنَّما
حُرّيَّته واستقلاله من القيود التي تأسر تفكيره وإيمانه وعمله الصالح. كان يتعيَّن علىٰ حنفي أنْ يجتنب خلطين: الخلط الأوَّل: اعتبار المساواة بين الإرادة الإلهيَّة والإرادة السياسيَّة للسلطان، في حين أنَّ المفاهيم القرآنيَّة قد حكمت بنفي سلطة الطواغيت، وإنَّما عرَّف عن إرادة النبيِّ وأولياء الله بوصفها إرادته وحكومته، وأنَّها سلطة إلهيَّة وزاخرة بالمعرفة والمحبَّة والعدالة، وتقدُّم وسعادة الإنسان، وبطبيعة الحال فإنَّ هذه الحكومة، إنَّما هي في قبال سلطة الطاغوت والمعاندين. وعلىٰ هذا الأساس، لا يمكن القول بعدم تحديد إرادة الإنسان من قِبَل أيِّ سلطة وإرادة؛ إذ إنَّ تعيُّن الإنسان لا يكمن في إطلاق العنان لإرادته، وإنَّما بالمعرفة والإيمان والعمل الصالح. والخلط الثاني في إيجاد الملازمة بين صفات الله (العلم والسلطة والإرادة)، وإرادة واختيار الإنسان، في حين أنَّ إرادة الإنسان تقع في طول إرادة الله وليس في عرضها، حتَّىٰ لا يمكن الجمع بين الإرادتين. وفي الواقع فإنَّ نفي اختيار الإنسان، من قِبَل الأشاعرة، بهدف إثبات صفات الله، ونفي الصفات الإلهيَّة، من قِبَل حسن حنفي، بهدف إثبات اختيار الإنسان، إنَّما يُمثِّلان طرفي الإفراط والتفريط في طيف واحد.
7. إنَّ تفسير حنفي للوحي والنبوَّة وكذلك المعاد، إنَّما يُمثِّل تقويضًا وتخريبًا لقواعد وأُسُس جميع الشرائع والأديان السماويَّة، وليس من تجديد الإسلام في شيء أبدًا. فهو يدَّعي أنَّ الوحي والنبوَّة يُمثِّلان التاريخ الإنساني العامَّ قديمًا، وأنَّ المعاد هو التاريخ البشري في المستقبل من دون أنْ يقيم أيّ دليل عقلي أو معرفي علىٰ هذا الادِّعاء. في حين لا النبوَّة تُمثِّل التاريخ
الإنساني العامَّ، ولا المعاد يُمثِّل مستقبل البشريَّة في هذه الدنيا بزعمه؛ إذ الماضي الإنساني لا يقتصر علىٰ تاريخ النبوَّة فقط، بل هو مزيج من تاريخ الحقِّ والباطل وتاريخ رسالة الأنبياء وشيطانيَّة الطواغيت، ولم يكن التاريخ عبارة عن مجرَّد تطوُّر ونبوغ تلقائي، وأنَّه هو الذي أفرز ظاهرة الوحي أو عمل علىٰ تطويرها. إنَّ تفسير حنفي للمعاد من زاوية الإنسان المستقلِّ عن أيِّ مصدر خارج ذاته، بالإضافة إلىٰ معارضته لصريح حكم الدِّين والعقل، لا ينسجم حتَّىٰ مع التفسير التاريخي الذي يُقدِّمه حنفي نفسه عن النبوَّة؛ لأنَّ التاريخ لا ينسب تطوُّره إلىٰ شيء حتَّىٰ يصل في المنتهىٰ إلىٰ النقطة المقابلة له. إذا كان الوحي بحسب تعبيره قد أدّىٰ إلىٰ تطوُّر الشعور الإنساني في التاريخ الإنساني، وإذا كان تطوُّر الوحي يُمثِّل نقطة ذروة التاريخ، فإنَّ المعاد لا يمكنه أنْ يكون بمعنىٰ وصول الإنسان إلىٰ نقطة الاستقلال عن الوحي؛ لأنَّ الاستقلال عن الوحي في المراحل التاريخيَّة الماضية، كان له وجود بدوره بوصفه نقطة الحضيض الإنساني أيضًا. إنَّ حنفي يُغمِض عينيه علىٰ النصوص القرآنيَّة، حيث يشتمل القرآن من أوَّله إلىٰ آخره علىٰ الكثير من الآيات الخاصَّة بموضوع القيامة، وهي آيات تحتوي، بالإضافة إلىٰ البعد النقلي، علىٰ الاستدلال العقلي أيضًا، وتدعو الناس إلىٰ التأمُّل فيها. فهو يُسمّي المعاد أُمنية نفسيَّة لدىٰ الناس، وطبعًا مع فارق أنَّ تحليله لا ينسجم حتَّىٰ مع علم النفس الاجتماعي والتاريخي، وعلم الاجتماع المعرفي الخاصِّ بالمسلمين أيضًا.
8. لا شكَّ في أنَّ وجود أصل الإمامة كاشف عن هدف سياسي وجوهري في التفكير الدِّيني، إلَّا أنَّ هذا الهدف السياسي، خلافًا لتصوُّر حنفي، ليس
من سنخ الأهداف أو التنظيرات السياسيَّة أو المسيَّسة من قِبَل الأحزاب والتيّارات السياسيَّة. بل إنَّ هذه السياسة هي الدِّين والتدبير الإلهي عينهما في تنظيم ودعم شريعته، كما كانت السياسة والتدبير الإلهي كذلك في أصل النبوَّة أيضًا.
يرىٰ حسن حنفي أنَّ التراث الفلسفي قد أثَّر في جميع حقول تفكيرنا ونشاطنا، كما ترك تأثيره في روحيَّتنا وفي سلوكنا الاجتماعي وحتَّىٰ في متغيِّراتنا الاجتماعيَّة. كما أنَّه يرىٰ أنَّ التراث يحتوي علىٰ ما يعيق تقدُّمنا وازدهارنا، كما يشتمل علىٰ أرضيَّة وظرفيَّة لتطوُّرنا وتقدُّمنا، وهذا، بحسب تعبيره، يتوقَّف علىٰ رفع الاتِّجاهات والأفكار الخاطئة التي أصبحت تُمثِّل عقبة كأداء في حقل تفكيرنا ونشاطنا. كما أنَّه يرتبط من جهة أُخرىٰ بالتفسيرات الحديثة التي تتبلور في إطار مقتضيات الاحتياجات المعاصرة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ التراث الفلسفي، من وجهة نظر حنفي، يُعَدُّ وسيلة ونقطة انطلاق للتفسيرات الفلسفيَّة الجديدة بما يتناسب مع الاحتياجات المعاصرة، ومن هذه الناحية يجب التعرُّف علىٰ الخصائص العامَّة والإيجابيَّة للتراث الفلسفي القديم، والعمل علىٰ الاقتباس منه، واجتناب خصائصه السلبيَّة واتِّجاهاته الخاطئة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ التجديد في التراث الفلسفي، من وجهة نظر حنفي، يقتضي رفع هذه الموانع الفكريَّة والعودة إلىٰ الخصائص الإيجابيَّة.
إنَّ التراث الفلسفي، أوَّلًا: بسبب تأكيده علىٰ العقل واليقين، قد أدّىٰ
إلىٰ تعميق الفكر الدِّيني والكلامي. ويمكن ملاحظة تأثير ذلك في القرون الثلاثة ذاتها من ارتقاء الفكر الفلسفي، في ازدهار وتطوُّر أفكار المتكلِّمين وعلماء الدِّين، وبالتالي فقد اكتسب الكلام صبغة فلسفيَّة. وثانيًا: بسبب عمقه وغناه، فإنَّه في مواجهة سائر الحضارات الأُخرىٰ، من قبيل: الحضارة الفارسيَّة والهنديَّة والإغريقيَّة، عمد إلىٰ استيعابها وتأثَّر بكلِّ واحدٍ منها بدرجات متنوِّعة. وثالثًا: لقد تمكَّن تراثنا الفلسفي من خلال تعاطيه الإيجابي والبنّاء مع سائر الحضارات، من ترجمة بعض آثارها لأهداف خاصَّة، والعمل علىٰ شرحها لاحقًا. وقد جاء هذا الشرح في إطار تكميل النواقص النظريَّة لتلك الآثار التي أفضت بدورها إلىٰ تأليف مستقلٍّ في التراث الفلسفي. ورابعًا: كما أنَّ التراث الفلسفي في مواجهة الحضارات الكبرىٰ بغية التعاطي الفكري معها، قد أبدع لغة جديدة وقام بتوظيفها. يرىٰ حنفي أنَّ المفردات الدِّينيَّة، من قبيل: الله، والخالق، والإيمان، والكفر، والمعصية، والكبائر، والجنَّة، والجحيم، والدنيا، والآخرة، وما إلىٰ ذلك، لم يكن بإمكانها التحاور مع اللغات الحضاريَّة الأُخرىٰ. ومن هنا بدأ تفكيرنا الفلسفي يفتح الباب علىٰ مفاهيم جديدة، من قبيل: الجوهر والعَرَض، والزمان والمكان، والكمّيَّة والكيفيَّة، والعلَّة والمعلول، والمادَّة والصورة، والوجود والماهيَّة، وما إلىٰ ذلك، وقام بفتح الحوار علىٰ هذا الأساس وانحسرت الأدبيّات والمصطلحات الدِّينيَّة والعقائديَّة البحتة تدريجيًّا، واختارت الحضارة الإسلاميَّة لغة الفلسفة الجديدة بدلًا من اللغة العقائديَّة. وخامسًا: في تراثنا الحِكَمي لم يكن العلم منفصلًا عن الفلسفة، وكان الفلاسفة الأوائل يمتهنون الطبَّ والكيمياء
(207)وما إلىٰ ذلك أيضًا، وكانت الفلسفة تهتمُّ بالطبيعة قبل اهتمامها باللّاهوت والحكمة، وقد ترك الفلاسفة المتقدِّمون الكثير من الآثار والمؤلَّفات في مختلف الحقول العلميَّة. وسادسًا: طبقًا للخصِّيصة السابقة، فقد كان الفلاسفة المتقدِّمون يحملون فكرًا موسوعيًّا، وكانوا في الوقت نفسه متخصِّصين في مختلف الحقول العلميَّة والفنّيَّة والفلسفيَّة. لقد كان إحصاء العلوم وتبويبها شاملًا لجميع الأفكار والإبداعات التي تمسُّ الحاجة إليها في ذلك العصر، ومن هنا كان الفيلسوف علىٰ صلة علميَّة بالعلوم والفنون، كما كان العالم التجريبي علىٰ صلة بالفلسفة المعقولة.
كان التراث الفلسفي، منذ القرن الهجري الثالث بالتزامن مع أبي يوسف الكِندي وحتَّىٰ القرن السادس للهجرة حيث انتهىٰ إلىٰ ابن رشد الأندلسي، يتحلّىٰ بالخصائص الإيجابيَّة أعلاه، ولكنَّ التفكير الفلسفي آل إلىٰ الجمود بالتدريج.
توضيح ذلك: أوَّلًا: إنَّ الفلسفة عندما واجهت التيّار الهجومي من قِبَل الفقهاء أُصيب فكرنا الكلامي والدِّيني بالسطحيَّة والتعصُّب. ومن ناحية أُخرىٰ، فإنَّ الفلاسفة الذين كانوا يمارسون نقد التفكير الدِّيني، قد اتُّهموا بالكفر والإلحاد والزندقة، وبالتالي أصبح التفكير الفلسفي عاجزًا، وأخذ التفكير الدِّيني يعاني من التحجُّر. واللافت في البين أنَّ حسن حنفي بعد هذا التحليل، وبعد أنْ أثبت في البحث عن التجديد الكلامي أنَّه مدين إلىٰ الأفكار الفلسفيَّة الغربيَّة، قال في تقييم تفكيرنا الفلسفي المعاصر: إنَّ تفكيرنا المعاصر بدلًا من أنْ يسعىٰ إلىٰ رفع موانع التفكير الفلسفي، لجأ إلىٰ فلسفة التنوير
الغربيَّة وأصبح ناطقًا باسمها. وثانيًا: واجهنا الأفكار الجديدة من منطلق الخصومة بالتدريج، واتَّخذنا منها بضاعة مستوردة للقضاء علىٰ أصالتنا. في حين أنَّ الغرب في العصور الوسطىٰ قد استفاد من الفكر الإسلامي، وما يزال حتَّىٰ في الوقت الراهن يسعىٰ إلىٰ التغلُّب علىٰ مشكلاته من خلال الاستعانة بإشراقة الشرق. وكذلك بدلًا من أنْ نفتح باب الحوار مع المجتمعات الشرقيَّة، من قبيل: الهند والصين وإيران، شددنا الرحال نحو الاستغراب. وثالثًا: منذ هجمة نابليون بونابرت علىٰ مصر، انشغلنا علىٰ مدىٰ قرنين من الزمن بترجمة التراث الغربي من دون أنْ نستفيد منه أدنىٰ استفادة في رفع مشكلاتنا، بل إنَّ ذلك قد شكَّل عقبة أبعدتنا عن التفكير في واقعيَّة وجودنا. ورابعًا: لقد ابتعدنا اليوم عن المصطلحات الجديدة والمناسبة للعصر، من قبيل: اليسار، واليمين، والاستثمار، والطبقة، والحضارة، والكفاح، وما إلىٰ ذلك، بل ونَتَّهم الذين يعملون علىٰ توظيفها، وبالتالي لم تزدهر الاتِّجاهات والتيّارات الفكريَّة المختلفة في ثقافتنا، ولم يتمّ فتح باب الحوار، وإنَّما اتَّجهنا نحو التكفير بكلِّ سهولة. وخامسًا: لقد عملنا علىٰ جعل الفلسفة ذهنيَّة فقط، وفصلنا الطبيعة عن الحكمة. وسادسًا: لقد اقتنعنا بمجرَّد التفكير الموسوعي للتراث، ولم نحصل علىٰ أيِّ تخصُّص في جميعها، وبالتالي فإنَّنا لا نقوم بأيِّ دور في تطوير العلم.
إنَّ تراثنا الفلسفي بالإضافة إلىٰ فقدانه لخصائصه الإيجابيَّة، قد ابتلىٰ ببعض الخصائص والتوجُّهات السلبيَّة التي حالت دون ازدهار وتطوُّر الحضارة
الإسلاميَّة، وأدَّت إلىٰ تخلُّفها. ويمكن بيان هذه الخصائص علىٰ النحو الآتي:
1. لقد انكبَّ تراثنا الفلسفي علىٰ المنطق الصوري، واهتمَّ بالشكل والقالب الفكري أكثر من أيِّ شيء آخر، ولم يحفل بالتبعات المترتِّبة علىٰ هذا المنطق من إهمال المنطق الواقعي والتجريبي، وبالتالي فقد تمَّت الغفلة عن الواقع السياسي والاجتماعي للمسلمين. ومن هنا فإنَّ نقطة الإنطلاق والخروج من هذا المأزق، تكمن في الإقبال علىٰ المنطق الواقعي؛ أي المنطق المادّي والتجريبي. إنَّنا قبل الفلسفة البحتة بحاجة إلىٰ المنطق التجريبي للعلوم الإنسانيَّة، كي نستفيد من تجارب العصر، ونزيل الموانع التي تعترض طريق الرقيِّ والازدهار.
2. لم يكن هناك عقل ناقد في تراثنا الفلسفي كي يتمكَّن من جعل نقد الأفكار والمذاهب الفكريَّة علىٰ سُلَّم أولويّاته، بل كان العقل في الغالب متمِّمًا للنواقص وساعيًا إلىٰ قبول كلِّ شيء (من أُرسطو وأفلاطون وأضرابهما) وتبويبها في أرشيف معلوماته، ولا نجد سوىٰ النزر القليل الذي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الآثار الناقدة للأفكار، من قبيل: «نقد النبوَّة» للرازي أو الراوندي، وكان أصحابها بدورهم يتعرَّضون لتهمة الكفر والإلحاد. وقد تسلَّل عدم النقد في مجال الفكر الفلسفي إلىٰ السياسة والأنظمة السياسيَّة أيضًا.
3. في مستهلِّ تفكيرنا الفلسفي كانت الغلبة للعقل علىٰ الإشراق، ولكنْ
بالتدريج أخذ الإشراق يهيمن علىٰ الفلسفة، حتَّىٰ لم يعد بالإمكان فصل الفلسفة عن العرفان إلَّا بمشقَّة بالغة، والمثال البارز علىٰ ذلك نجده في الإشارات والتنبيهات لابن سينا. وطبقًا لذلك، تمَّ التعريف بالعلم الإلهي بوصفه منبعًا ومصدرًا للعلم الذي يُلهَم ويُقذَف في القلوب، وأخذت جميع العلوم تنشأ من التجربة الباطنيَّة، وليس من طريق الحسِّ والتجربة والإحساس. ونتيجة لذلك، فقد أهملنا العقل واتَّجهنا بدلًا من ذلك نحو التصوُّف والفكر الأشعري. إنَّ بسط الإشراق ونظريَّة الفيض في التراث الفلسفي قد أدَّت بالإنسان إلىٰ السعي من أجل الوصول إلىٰ مراتب القرب والعروج السماوي، وفقدان فرصه التاريخيَّة والانصياع للجبر، وتبرير المعاصي والشرور.
4. يرىٰ حنفي في طرح المباحث الطبيعيَّة في التراث الفلسفي مجرَّد مقدّمة للدخول إلىٰ الإلهيّات؛ أي إنَّها دون الاستناد إلىٰ التجربة والاختبار، إنَّما هي من صنع العقل المجرَّد، ولذلك فإنَّه لم تؤدِّ إلىٰ تطوير العلوم الطبيعيَّة، ولم يُستَفد من الطبيعيات إلَّا من أجل ترسيخ قواعد الإلهيّات. ومن هنا يتمُّ تقسيمها علىٰ أساس ملاك القيمة والشرف والكمال: النفس والجسم والنبات والجماد، ومن بين العناصر الأربعة، يكون التراب هو الأدنىٰ من الجميع، وبعده النار، وبعد ذلك الماء والهواء.
5. إنَّ رؤيتنا إلىٰ الطبيعة والترجيح القِيَمي لبعضها علىٰ بعض، قد أدّىٰ
بنا إلىٰ الرؤية الثنائيَّة إلىٰ الطبيعة والوجود في التراث الفلسفي، وطبقًا لذلك تبلورت ثنائيّات في مفاهيم من قبيل: الصورة والمادَّة، والعلَّة والمعلول، والحركة والسكون، والزمان والمكان، والجوهر والعَرَض، والحسُّ والعقل، والجسم والنفس، والدنيا والآخرة، والخير والشرُّ، والشيطان والملائكة، والمؤمن والكافر وما إلىٰ ذلك، بل إنَّ جذور هذه الرؤية تعود إلىٰ تاريخ التفكير الدِّيني والحضارة اليونانيَّة والإغريقيَّة. إنَّنا لن نعمل علىٰ إقامة علاقة صداقة بين هذه المفاهيم الثنائيَّة، ولذلك اتَّسع الشرخ لدينا بين مفاهيم المولىٰ والعبد، والحاكم والمحكوم.
6. لقد أولىٰ تراثنا الفلسفي أهمّيَّة أكبر للحكمة والفضائل النظريَّة، من قبيل: الإلهيّات، والمنطق، والرياضيّات، والعلوم. ولم يولِّ تلك الأهمّيَّة للحكمة العمليَّة والفضائل العمليَّة، من قبيل: العمل، والإنتاج، والأخلاق، والسياسة، وعلم الجمال، ومن هنا كان هذا التراث يقصر النظر علىٰ النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله بوصفه حكيمًا ومفكِّرًا أكثر من اعتباره مجاهدًا وقائدًا سياسيًّا أو مؤسِّسًا لنهضة اجتماعيَّة.
7. يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ تراثنا الفلسفي قد قسَّم الحكمة إلىٰ المنطق والطبيعيّات والإلهيّات، وعمد في هذا السياق إلىٰ تقسيم الإنسان إلىٰ بُعدين، فهو باعتبار الجسم يندرج ضمن الطبيعيّات، وباعتبار النفس يندرج ضمن الإلهيّات، وعلىٰ هذا الأساس فلا
الإنسان ولا العلوم الإنسانيَّة كان لها وجود مستقلٌّ في تراثنا. لقد تمَّ تجاهل الإنسان ما بين الطبيعيّات والإلهيّات وفي خضمِّ القدرة المطلقة لله والجبر المهيمن علىٰ الطبيعة، ولذلك فإنَّ الإنسان لا يحظىٰ بحرمة عندنا، وإنَّ مؤسَّساتنا السياسيَّة والتعليميَّة لا ترعىٰ حرمة الإنسان. هذا وقد ذكر حسن حنفي خصائص أُخرىٰ بوصفها من الخصائص السلبيَّة في التراث الفلسفي، من قبيل: الافتقار إلىٰ الرؤية التاريخيَّة، وانعدام الوعي التاريخي.
يعمد حسن حنفي، من خلال تشخيص آفات التراث الفلسفي في إطار إحياء الفلسفة والخروج من الحالة التي يتَّسع فيها الشرخ بين النقل أو الترجمة والإبداع أو التجديد، إلىٰ رسم أُفق مستقبل الفلسفة. يرىٰ حنفي أنَّ تراثنا ينتمي إلىٰ ما قبل ألف سنة، ولو قُيِّض للفلاسفة، من أمثال: الفارابي، وابن سينا، وابن باجة، وابن الطفيل، وابن رشد، أنْ يعودوا إلىٰ عالمنا المعاصر، فإنَّهم سيُبدعون تراثًا من نوع آخر. يمكن للكِندي في عصرنا الراهن أنْ يعمل علىٰ إحياء دوافع الارتباط بين الحضارات مجدَّدًا؛ لينتج عن ذلك لغة جديدة. إنَّ الفارابي المعاصر يمكنه الجمع بين الفكر اللّاهوتي لهيجل والفكر المادّي لماركس، ويبني بذلك مدينة فاضلة جديدة قائمة علىٰ العقود الاجتماعيَّة والمنظَّمات الحقوقيَّة وحقوق الشعوب، وليس علىٰ أساس نظريَّة الفيض والإمامة. ويمكن لإخوان الصفاء الجُدُد أن يُؤلِّفوا رسائل جديدة في منطق جديد، ورياضيّات جديدة، وطبيعيّات جديدة، وعلوم حقوقيَّة،
وتشريعات، وعلم اجتماع وسياسة واقتصاد جديد. كما يجب علىٰ ابن سينا وابن رشد المعاصرَين أنْ يُحدِثا تحوُّلًا جوهريًّا وجذريًّا في فلسفتيهما. ويمكن للفلسفة الإسلاميَّة الجديدة أنْ تعيد اكتشاف نظريَّة المُثُل التنويريَّة (العقل، والحُرّيَّة، والإنسان، والطبيعة، والمساواة، والتقدُّم، وحقوق الإنسان)، ثمّ تعمل علىٰ تجاوزها بعد هضمها.
يُصِرُّ حسن حنفي علىٰ ضرورة تجديد وإصلاح العلوم الفلسفيَّة؛ أي: المنطق، والطبيعيّات، والإلهيّات، والإنسانيّات. وقد ذهب إلىٰ الاعتقاد بأنَّ المنطق الصوري القديم يجب أنْ يُستَبدل بمنطق حسّي جديد. كما أنَّه يعتقد بأنَّ الطبيعيّات القديمة طبيعيّات عقليَّة ولاهوتيَّة، ويجب تغييرها إلىٰ طبيعيّات شعريَّة وشعوريَّة، بمعنىٰ أنَّ العالم في لحظة وعينا بهذه الطبيعيّات، يأخذ بالتبلور في شعورنا.
يمكن تقسيم أبحاث حسن حنفي إلىٰ ثلاثة أقسام، وهي:
1. الخصائص الإيجابيَّة في التراث الفلسفي.
2. الخصائص السلبيَّة في التراث الفلسفي.
3. مستقبل الفلسفة.
مع ذكر بعض الانتقاد في هامش كلِّ واحدٍ من هذه الأقسام الثلاثة.
ففيما يتعلَّق ببحوث حنفي بشأن الخصائص الإيجابيَّة في التراث الفلسفي، علينا أنْ نعرف ما يلي:
1. هل سلك تراثنا الفلسفي منذ عصر ابن رشد (القرن السادس للهجرة) فصاعدًا مسار الجمود والتحجُّر بالتدريج؟ هذا ما يراه حنفي، ولكنَّنا لو ألقينا نظرة إجماليَّة علىٰ تاريخ الفلسفة الإسلاميَّة، لأمكن لنا الوقوف علىٰ الكثير من المنعطفات، ممَّا يعكس حالة من الحيويَّة والنشاط علىٰ الحياة الفلسفيَّة في عصورها.
لقد عمد يعقوب بن إسحاق الكندي، وهو أوَّل فيلسوف عربي، إلىٰ تنظيم رؤية فلسفيَّة مدوَّنة إلىٰ جانب التفكير الدِّيني والسماوي، وتمكَّن من أنْ يُؤدّي دورًامؤثِّرًا في النهضة الفلسفيَّة/ الكلاميَّة في العالم الإسلامي في القرن الثالث للهجرة. كما كان أبو نصر الفارابي، في القرن الثالث والرابع للهجرة، مؤسِّسًا لمنظومة فكريَّة في الفلسفة، وقد كانت منظومته الفكريَّة تلفيقًا بديعًا من ثلاثة أنظمة فلسفيَّة، وهي: الأُرسطيَّة، والأفلاطونيَّة، والأفلاطونيَّة الجديدة، ولكنْ تهيمن عليها روح التعاليم الإسلاميَّة، بحيث أنَّه يقول بوحدة الحقيقة الدِّينيَّة مع الحقيقة الفلسفيَّة.
كما يُشكِّل ابن سينا منعطفًا ثالثًا، حيث أسَّس لأعمق وأبقىٰ تأثير علىٰ النظام والتفكير الفلسفي. كان ابن سينا، مثل الكِندي والفارابي، يقول بالتماهي بين الفلسفة والدِّين، حيث تزخر مؤلَّفاته القيِّمة بروح التعاليم الإسلاميَّة وبيانها الفلسفي. وقد كان مؤسِّس الفلسفة المشّائيَّة في التراث الإسلامي، وإنَّ فلسفته جديرة بعنوان الفلسفة الإسلاميَّة. وفي القرن
السادس للهجرة قام ابن رشد بإحياء الفلسفة المشّائيَّة الأُرسطيَّة في الأندلس والمغرب الإسلامي، بيد أنَّ الفلسفة لم تتوقَّف بموته عن الازدهار والتقدُّم؛ إذ نجد الشيخ شهاب الدِّين السهروردي في الشرق الإسلامي قد مثَّل منعطفًا في حكمة الإشراق في العالم الإسلامي، ولا سيّما مع ظهور ابن عربي في القرن السابع للهجرة، حيث تمكَّن التصوُّف والعرفان النظري بشكل فذٍّ من إيصال الأفكار النظريَّة في حقل التصوُّف إلىٰ منعطف آخر. وفي هذا القرن تمكَّن نصير الدِّين الطوسي، أكبر الفلاسفة في إيران بعد ابن سينا، في عصر الاجتياح المغولي وبعد تشكيكات أبي حامد الغزالي والفخر الرازي، من إحياء الفكر الفلسفي لابن سينا، وعمل علىٰ إشاعة الحكمة الشيعيَّة. ثمّ ظهر بعد نصير الدِّين الطوسي، فلاسفة آخرون من أمثال: قطب الدِّين الشيرازي، والمير سيِّد شريف الجرجاني، وجلال الدِّين الدواني، من الذين مهَّدوا الأرضيَّة، مع عرفاء كبار من أمثال: ابن تركة الأصفهاني، لظهور الفيلسوف الكبير صدر المتألِّهين الشيرازي. ففي المدرستين (المدرسة الفلسفيَّة والعرفانيَّة) في كلٍّ من أصفهان وشيراز، سواء في الفترة ما بين القرن السابع إلىٰ العاشر للهجرة، وسواء في العصر الصفوي في أصفهان، لم تشهد الفلسفة فترة انحطاطها وركودها، بل أعدَّت الأرضيّات والأفكار الضروريَّة كافّة، بالإضافة إلىٰ ازدهارها التدريجي، لظهور مدرسة صدر المتألِّهين.
إنَّ مدرسة صدر المتألِّهين تُمثِّل منعطفًا آخر في الفلسفة الإسلاميَّة، حيث يبرز فيها التماهي بين العقل والوحي والشهود بشكل واضح. وبعد ذلك عمد تلاميذه إلىٰ شرح وبسط مدرسته. وفي المرحلة المعاصرة أثبتت الفلسفة
(216)الصدرائيَّة قدرتها الاستيعابيَّة علىٰ المزيد من الإبداعات والحضور في سائر المجالات المعرفيَّة، وحتَّىٰ السياسيَّة والاجتماعيَّة أيضًا.
2. لقد أشار حسن حنفي إلىٰ مشكلة الاستغراب في المجتمعات الإسلاميَّة في ترجمة وبيان الأفكار الفلسفيَّة للغرب بشكل جيِّد، حيث قال: إنَّ هذه الأفكار لم تنجح أبدًا في حلِّ مشكلاتنا، ولكنَّه لم يُبيِّن سبب هذه الظاهرة. ومن خلال دراسة أفكار المستنيرين الذين عملوا علىٰ ترويج ونشر المدارس الفلسفيَّة الغربيَّة، يتَّضح أنَّهم لا يمتلكون أيَّ صلة فكريَّة مع الفلسفة الإسلاميَّة، بل وحتَّىٰ الفكر الإسلامي، ولذلك فإنَّه ليس لمشروعهم أيَّ شبه بمشروع عصر الترجمة في القرن الثاني والثالث للهجرة، وليس هناك أيُّ تناسب بين لغتهم وفكرهم وبين التراث الإسلامي.
3. ومن جهة أُخرىٰ، فإنَّ التراث الفلسفي، خلافًا لرأي حنفي، بالإضافة إلىٰ توظيفه للغة الفلسفة الجديدة، حيث يستعين باللغة الوحيانيَّة، قد أضاف إلىٰ دائرته اللغويَّة، وعمد إلىٰ إبداع لغة الفلسفة الإسلاميَّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ حنفي يعمد هنا، كما هو شأنه في الكثير من الموارد الأُخرىٰ، إلىٰ الخلط بين أدبيّات علم الكلام وأدبيّات الفلسفة، في حين أنَّ الفلسفة الإسلاميَّة لم تكن بصدد الحلول محلَّ الكلام الإسلامي أو التفسير. ومن هنا فإنَّ كلمات من قبيل: الجنَّة، والنار، والدنيا، والآخرة وأمثالها، إنَّما تكون مورد اهتمام الفيلسوف من الزاوية الأنطولوجيَّة فقط، حيث يستلهم منها في توسيع دائرة
وإطار تفكيره الفلسفي. ومع ذلك، فإنَّ الكثير من الألفاظ الدِّينيَّة، خلافًا لرؤية حنفي، لها حضور ملحوظ في التراث الفلسفي، وقد عمد الفلاسفة إلىٰ بيانها فلسفيًّا، من قبيل: الوحي، والمعاد، والملائكة، والروح، والذات، والصفات، والباري تعالىٰ، كما أنَّ للأدبيّات الدِّينيَّة حضورًاواسعًا للغاية في فلسفة الأخلاق أيضًا، وهذا ما لا نشاهده في اللغة الجديدة لدىٰ المترجمين والمروِّجين للفلسفة الغربيَّة. وإنَّ الكلمات الجديدة التي يدعو حنفي إلىٰ استعمالها، من قبيل: اليسار، واليمين، والطبقة، والحضارة وأمثالها، ليست من المفاهيم والمسائل الأنطولوجيَّة، وإنَّما ترتبط بحقل العلوم الاجتماعيَّة والسياسيَّة، والتي لها دائرة أبحاثها الخاصَّة.
4. إنَّ من بين الخصائص الإيجابيَّة لتراثنا الفلسفي، ارتباط الفلسفة بالعلم، بمعنىٰ أنَّ الفلاسفة المتقدِّمين كانوا في الوقت نفسه علماء في الطبيعة وفي العلوم التجريبيَّة أيضًا، بيد أنَّه تمَّ تجاهل تحصيل العلوم التجريبيَّة لاحقًا بالتدريج، الأمر الذي أدّىٰ إلىٰ عروض بعض الآفات. كما تجاهل البعض الفلسفة والتعاليم الإلهيَّة والأفكار الفلسفيَّة، واقتصروا علىٰ تحصيل العلوم التجريبيَّة والإنسانيَّة، فأدّىٰ ذلك بدوره إلىٰ آفات أُخرىٰ.
5. كما ذكر حنفي، فإنَّ هناك ارتباطًا بين العقل والإيمان في تراثنا الفلسفي، بيد أنَّ بيان حنفي في هذا الشأن ينطوي علىٰ مغالطة. لقد سعىٰ تفكيرنا الفلسفي إلىٰ تقديم تفسير فلسفي لتعاليم الإسلام العقليَّة، وبيان أهمّ تعاليمه المعرفيَّة والأخلاقيَّة، كي تتَّضح المباني العقليَّة للإيمان، إلَّا أنَّها اعترفت في هذا الشأن بدائرة النقل كما اعترفت بالعقل. لا يقتصر مبنىٰ الإيمان
في الفلسفة الإسلاميَّة علىٰ العقل فقط؛ لأنَّ النقل يورّث الاطمئنان ويُؤدّي إلىٰ الإيمان أيضًا، ولذلك حيث لا تكون هناك قدرة لدىٰ العقل في البيان، فإنَّه يقبل ببيان النقل المعتبر. لا نعلم ما هي المقدّمات التي استقىٰ منها حنفي هذه النتيجة القائلة بأنَّ مسار تطوُّر المجتمعات يكمن في الانتقال من الدِّين إلىٰ الفلسفة، ومن الإيمان إلىٰ العقل! في حين لا يوجد هذا النوع من الانتقال في التراث الفلسفي.
وفيما يتعلَّق بالخصائص السلبيَّة للتراث الإسلامي، فإنَّ ما يذكره حنفي بوصفه من الخصائص السلبيَّة، أدعىٰ للنقد والخدش بكثير من كلامه السابق، وذلك للأسباب الآتيَّة:
1. لقد اهتمَّ الفلاسفة بالمنطق الصوري ومادَّة القضايا كليهما، إلَّا أنَّ المنطق الواقعي ليس بمجرَّد امتلاك مفهوم المنطق التجريبي أو الاجتماعي. إنَّ المسائل والمشكلات المعرفيَّة والإيمانيَّة من أهمّ المسائل الواقعيَّة والعينيَّة. ومن هنا فإنَّ التوحيد، خلافًا لرؤية حنفي، من أهمّ المسائل الإنسانيَّة، وهو موضوع لأهمّ العلوم الإنسانيَّة؛ أي الفلسفة والعرفان. تكمن مشكلة حنفي في أنَّه يغضُّ الطرف عن المشكلات والأزمات التي حاقت بالعالم الغربي بسبب العلوم الطبيعيَّة والإنسانيَّة العلمانيَّة، ويتخلّىٰ عن الثروة الفكريَّة الفلسفيَّة القيِّمة للمسلمين تحت ذريعة افتقارها إلىٰ التطوُّر التجريبي، في حين أنَّ لهذا الافتقار أسبابًا أُخرىٰ.
2. كما أنَّ للعقل النقدي بدوره مراتب، فتارةً يرتبط بمسائل وأساليب علم ما، وتارةً يرتبط بمبانيه وأُصوله، ويوجد كلا النقدين في تراثنا
الفلسفي، بيد أنَّ كلا النقدين ناظر إلىٰ كشف الحقائق الثابتة، وليس نسبيَّتها، ولذلك فإنَّ النقد الهدّام علىٰ نحو مطلق، سوف يفتقر إلىٰ المعنىٰ. وقد كان لكلٍّ من الفلاسفة الكبار، ولاسيّما الفارابي وابن سينا والسهروردي وصدر المتألِّهين، انتقادات بنائيَّة ومبنائيَّة وأُسلوبيَّة علىٰ الفلسفات السابقة لهم، وتوضيح ذلك يرتبط بفلسفاتهم.
3. لقد تحدَّث الفلاسفة في بعض الأحيان عن الطبيعة بلغة الفلسفة، فأبدعوا الطبيعيّات الفلسفيَّة، ومثل هذه الأبحاث ضروريَّة لكلِّ مدرسة فلسفيَّة، وفي بعض الأحيان تحدَّثوا بلغة علميَّة وقاموا، كما يفعل العالم التجريبي، بدراسة الطبيعة أو جسم الإنسان، فأبدعوا مختلف العلوم، مثل: الطبِّ، والكيمياء، والفيزياء، وعلم المعادن وأمثال ذلك. وعليه، ينبغي عدم الخلط بين حقلين من دراسة الطبيعة، ونسبة عدم التطوُّر في حقل العلوم التجريبيَّة إلىٰ نمط تفكيرنا الفلسفي عن الطبيعيّات. وعلىٰ الرغم من إمكان أنْ تكون بعض الأفكار الفلسفيَّة في حقل الطبيعيّات مخدوشة، إلَّا أنَّ طريق إصلاحها لا يعود إلىٰ الحقل التجريبي فقط، بل إنَّنا نحتاج في ذلك إلىٰ الفكر الفلسفي أيضًا.
4. لقد أخطأ حنفي في تحليله حيث أرجع سبب ثنائيَّة المفاهيم الفلسفيَّة والكثير من المفاهيم الدِّينيَّة إلىٰ رؤيتنا الثنويَّة والقِيَميَّة إلىٰ الطبيعة. فبالنظر إلىٰ خصائص المفاهيم الفلسفيَّة، يتَّضح أنَّ هذه المفاهيم مجرَّد تحليل عقلي، وهي بلحاظ اعتبارٍ خاصٍّ تدور بين النفي والإثبات. إنَّ الكثير من المفاهيم، بما في ذلك المفاهيم الدِّينيَّة، تنبثق عن أنطولوجيا
خاصَّة، وإنَّ كلَّ مَنْ يمكث ضمن هذا الإطار المعرفي، فإنَّه سوف يرىٰ مفاهيم، من قبيل: الخالق والمخلوق، والدنيا والآخرة، والمولىٰ والعبد، والحسُّ والعقل وما إلىٰ ذلك، ناظرة إلىٰ حقائق الوجود.
5. إنَّ للإنسان في التراث الفلسفي، خلافًا لتصوُّر حنفي، مكانةً خاصّةً، وإنَّ الأبحاث المرتبطة بالنفس، ومباحث العلم، وما يعود إلىٰ الاتِّجاه الفلسفي للإنسان، قد حظي بالاهتمام في الفلسفة، ولا سيّما العرفان الإسلامي. كما أنَّ الفقه الإسلامي موضع للحقوق والمعايير الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، وإنَّ العلماء هم الذين يجب عليهم أنْ يعمدوا إلىٰ بناء الأنظمة المختلفة علىٰ أساس من مفاهيمها.
فيما يتعلَّق بما ذكره حنفي بالنسبة إلىٰ الرسالة الراهنة أو أُفق مستقبل الفلسفة، هناك نقطتان جديرتان بالتأمُّل، وهما:
1. لا شكَّ في أنَّ الفلسفة الإسلاميَّة قد قطعت مسارًا تكامليًّا، وأنَّ مستقبل هذه الفلسفة رهن بإبداعات الفلاسفة، إلَّا أنَّ تاريخ كبار الفلاسفة المسلمين يُثبِت أنَّ للتفكير الفلسفي الإسلامي أُصولًا ومصادر معرفيَّة مشتركة، وهذا لا ينسجم مع ادِّعاء حنفي القائم علىٰ التخلّي عنه والانطلاق من بداية جديدة.
2. وعلىٰ الرغم من أنَّ الفلاسفة الإسلاميِّين الكبار، من أمثال الفارابي وابن سينا وإخوان الصفاء، لو عادوا إلىٰ عصرنا الحاضر لكان واقع الفلسفة أفضل ممَّا هو عليه الآن، إلَّا أنَّ حنفي فيما يتعلَّق بنسبة هؤلاء الفلاسفة إلىٰ الفلسفات الغربيَّة الحديثة، قد حكم بشكل مسبق،
وادَّعىٰ أنَّهم سيختارون جميع مفاهيم التجديد، أو يجمعون بين الفلسفة الهيجليَّة والفلسفة الماركسيَّة، في حين أنَّ ماهيَّة الفلسفة الإسلاميَّة وتجربتها التاريخيَّة، لا تتحمَّل مثل هذا الادِّعاء حتَّىٰ في مواجهة الفلسفة اليونانيَّة والرومانيَّة.
إنَّ من بين الحقول المهمَّة في التراث الإسلامي، تفسير النصوص الدِّينيَّة الأعمّ من الكتاب والسُّنَّة. وقد عمدت مختلف المذاهب الإسلاميَّة، بالالتفات إلىٰ آرائها الخاصَّة بشأن موقع العقل والنقل والشهود، إلىٰ القيام بتفاسير مختلفة، اعتمادًا علىٰ الأساليب العقليَّة والنقليَّة والعرفانيَّة والفقهيَّة والاجتماعيَّة وما إلىٰ ذلك. ومقدار اعتبار كلِّ واحدٍ منها رهن بصحَّة اتِّجاهه وقرب فهمها إلىٰ معاني النصوص الدِّينيَّة. إنَّ تفسير النصوص الدِّينيَّة وأساليب التفسير واحد من المحاور المهمَّة التي يسعىٰ أصحاب الرؤية التجديديَّة من خلال مبانيهم وفرضيّاتهم المعاصرة إلىٰ إعادة النظر فيها. وقد كتب حسن حنفي بعض الكُتُب في هذا الشأن باللغة العربيَّة والفرنسيَّة، وقد اتَّجهت جهوده نحو نقد الأساليب والمناهج التفسيريَّة لدىٰ المسلمين، وتقديم تفسير حديث علىٰ أساس المنهج الظاهراتي، وتطبيق النصوص علىٰ التجارب الداخليَّة الحيَّة وتحليلها.
إنَّ أهمّ مبنىٰ نظري للاتِّجاه التفسيري لدىٰ حنفي يتمثَّل في ديالكتيك الواقع والوحي والتفسير. إنَّ من بين عقائد المسلمين إيمانهم بأحقّيَّة القرآن الكريم
(222)بوصفه كلام الله. إنَّ القرآن هو كلام الله الذي نزل بوساطة جبرائيل علىٰ النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، وبذلك يكون هذا الكتاب من عند الله ومنسوبًا إليه، ومن هنا يجب أنْ يتمَّ فهمه في إطار المقاصد الإلهيَّة. إلَّا أنَّ حنفي يقول: إنَّ هدف القرآن هو الإنسان ومصالحه، رغم كونه نازلًا من عند الله، ولكنَّه إنَّما ينظر إلىٰ مصالحنا، وإنَّ إرجاعه إلىٰ الله مخالف لمقاصد الوحي. وأمَّا أنْ يكون القرآن قد نزل مباشرةً من عند الله، أو أنَّه موجود في اللوح المحفوظ، وأنَّه كيف نزل بوساطة جبرائيل علىٰ النبيِّ، فليس له أيّ أهمّيَّة من وجهة نظر حنفي؛ لأنَّه قد اعتبر وجود الله وعالم المجرَّدات والملائكة وأمثال ذلك منتفيًا بنحو من الأنحاء. وعليه، فإنَّ الوحي من وجهة نظره هو القرآن المحسوس الذي يُتلىٰ، ويُسمَع، ويتمُّ فهمه وتفسيره من قِبَلنا، وأمَّا سائر أبحاثه الأُخرىٰ، فلا يدخل ضمن مسألتنا وماهيَّة الوحي.
يرىٰ حنفي أهمّيَّة كبيرة لشأن النزول أو ما يُعبِّر عنه بالواقع الذي نزل القرآن متناظرًا معه. يأتي بحث شأن نزول الآيات من قِبَل حنفي في إطار غايته؛ «أي: تقدُّم الواقع علىٰ الآية»، وأنَّ فهم الآيات إنَّما يكون في إطار شرائطها التاريخيَّة والاجتماعيَّة. يرىٰ حنفي أنَّ شأن النزول يُثبِت تقدُّم الواقع علىٰ الفكر، وأولويَّة الظاهرة علىٰ الآية، ولذلك فإنَّ الأولويَّة الأُولىٰ تكون للمجتمع والناس، ويأتي القرآن والوحي في المرحلة الثانية.
وعلىٰ هذا الأساس، تكون حقيقة الوحي متفرِّعة عن حاجة عصر النزول، وليست شيئًا غير الاستجابة لهذه الحاجة. وهو يرىٰ أنَّ الحاجة
[1]. حنفي، هموم الفكر والوطن، ج 1، ص 20.
الأساسيَّة لعصر النزول في شبه الجزيرة العربيَّة، تكمن في طرح الرؤية التي تُمثِّل تعبيرًا عن واقعيَّتهم، والأيديولوجيَّة الضروريَّة لاتِّحاد قبائلهم، وكذلك قيادتهم من أجل تحقيق رسالتهم، وبهذا المعنىٰ يكون الإسلام دينًا واقعيًّا.
كما ذهب حنفي إلىٰ اعتبار النزول التدريجي للوحي شاهدًا آخر علىٰ تناظر الوحي بالنسبة إلىٰ الواقع الخارجي له، ومن هنا فإنَّه يرىٰ أنَّ الاتِّجاه التفسيري المناسب هو وحده الاتِّجاه الإنساني الذي يُمكِنه إدراك القرآن في الشرائط الروحيَّة الخاصَّة، وفي هذه الحالة لن يكون شأن النزول شيئًا غير الأوضاع والحالات الإنسانيَّة. يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ منشأ النصوص الدِّينيَّة، ومن بينها النصُّ الوحياني، ليس سوىٰ التجارب الحيَّة للناس في عصر النزول. وبطبيعة الحال، فإنَّه لا يأتي علىٰ ذكر المنزل؛ لكونه يرىٰ أنَّ ذلك خارج مسألة الوحي، إلَّا أنَّ أسباب النزول من وجهة نظره، هي التجارب الداخليَّة ذاتها للأفراد، وأنَّ الوحي ناظر إليها. ومن هنا يكون تفسير الوحي بمعنىٰ تحليل هذه الأحاسيس والمشاعر والتجارب الداخليَّة الحيَّة كي يتمَّ فهم معاني الوحي، وليس اكتشاف المقاصد الإلهيَّة ومعانيها. إنَّ فهم التجربة الحيَّة لا يحتاج إلىٰ نقل المأثور أو التفسير بالرأي، بل يجب إدراك وتحليل ذات هذه التجربة، بمعنىٰ أنَّ المفسِّر يعمل علىٰ تحليل النصِّ وإدراكه من خلال الرجوع أوَّلًا إلىٰ تجربته الشخصيَّة، ثمّ يخضع النصوص الدِّينيَّة بالالتفات إلىٰ هذه التجربة الحيَّة للإدراك الحدسي مباشرةً، وبالتالي فإنَّه من
غير ما حاجة إلىٰ شرح وتفسير معاني النصوص، وإنَّما يكتفي بمجرَّد توصيف التجربة الحيَّة ووعيه الذاتي فقط. وبعد هذه المرحلة يمكن للمفسِّر أن يُشرك الآخرين في تجربته، أو أنْ يرجع إلىٰ تجارب غيره من المفسِّرين أو المخاطبين، وهذا سيكون سببًا للمزيد من اليقين بتجربته وتعميمها علىٰ الآخرين. إنَّ المفسِّر في الوقت الذي يُعتَبر تاليًا وقارئًا للقرآن، يعمل، بمقدار ما يختزنه في حياته اليوميَّة من التجارب الحيَّة، علىٰ تفسير آيات القرآن، وفي هذه الحالة سوف تتحوَّل النصوص الدِّينيَّة إلىٰ ظواهر إنسانيَّة عامَّة.
يزعم حنفي أنَّ الواقع العيني هو مصدر الوحي والنصِّ، وأنَّ الرجوع إلىٰ هذا الواقع العيني رجوع إلىٰ مصدر وأساس الوحي. والنتيجة الأُخرىٰ التي يستنتجها حنفي هي حيث أنَّ القرآن، بالالتفات إلىٰ الوقائع التاريخيَّة وأسباب النزول، قد نزل بشكل تدريجي، ولذلك لا تمسُّ الحاجة إلىٰ جميع الآيات في جميع العصور، ونحن بدورنا يجب علينا الرجوع في حياتنا إلىٰ خصوص الآيات التي تساعدنا علىٰ حلِّ مشكلاتنا المعاصرة، وليس كلُّ الآيات. فإذا كان المجتمع يعاني من الفقر، أو الاختلاف الطبقي، أو الحكومات الجائرة وما إلىٰ ذلك، فإنَّ آيات الجنَّة والجحيم، والصلاة والصوم، ورفع الناس بعضهم علىٰ بعض، لن تجدينا نفعًا في حلِّ مشكلاتنا، ولن تلعب دورًا في حياتنا. ولذلك يكون بيان الآيات وتفسيرها من هذه الزاوية منحصرًا بالآيات التي تفتح لنفسها طريقًا إلىٰ حلِّ مشكلاتنا المعاصرة، وبقراءة معاصرة.
إنَّ حسن حنفي إنَّما يرىٰ التفسير مهمًّا وضروريًّا من جهة أنَّ القرآن بوصفه كتابًا نازلًا علىٰ النبيِّ يجب تحويله إلىٰ كلام بشري ناظر إلىٰ مختلف الجماعات البشريَّة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه بوساطة التفسير. فإذا كانت مفردة التفسير في النصوص الدِّينيَّة ومصطلح المفسِّرين، تعني الكشف عن المعاني والمقاصد الثابتة في الكلام الإلهي، فإنَّها تعني في منهجيَّة حنفي المتغيِّر البشري علىٰ طبق المقتضيات الزمانيَّة والمكانيَّة الخاصَّة. وإنَّ منهج التفسير سوف يكون علىٰ الدوام تابعًا للشرائط والمتغيِّرات الزمانيَّة والمكانيَّة المحدودة.
إنَّ حنفي ينظر إلىٰ مختلف المناهج والأساليب التفسيريَّة في التراث القديم، من قبيل: التفاسير اللغويَّة والروائيَّة والفقهيَّة والفلسفيَّة والعرفانيَّة والكلاميَّة، وبالتالي المنهج العلمي والاصطلاحي، من الأساليب والمناهج الناظرة إلىٰ الشرائط والظروف العصريَّة، وعمد إلىٰ تقييمها علىٰ هذا الأساس، ويرىٰ أنَّ المنهج التفسيري المناسب في عصرنا وحده هو منهج التفسير الاجتماعي؛ لاعتقاده أنَّ زمن اللغة والرواية والفقه والتصوُّف والفلسفة والعقائد قد ولّىٰ، وأنَّ عصرنا هو عصر العلوم الاجتماعيَّة، وفي مقدّمتها العلوم السياسيَّة والاقتصاديَّة.
يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ العصر الراهن هو عصر العلوم الاجتماعيَّة، ويرىٰ أنَّ المنهج التفسيري المناسب لهذا العصر هو المنهج الاجتماعي. وقد رصد خصائص هذا المنهج علىٰ النحو الآتي:
(226)أ) تفسير جزئي قائم علىٰ مقتضىٰ حاجة المجتمع الإسلامي، ومن هنا لا يكون ناظرًا إلىٰ جميع الآيات، من ذلك، مثلًا، عندما تكون مشكلتنا الأساسيَّة هي تحرير الأرض، ومواجهة الاستعمار، ومواجهة الطغيان، يجب أنْ تقع آيات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علىٰ سُلَّم الأولويّات، وليس آيات الرفاه والتنعُّم بزينة الدنيا، والآيات المرتبطة بالطاعة والعبوديَّة. فإذا لم تكن الموضوعات جزءًا من الاحتياجات المعاصرة، لا ينبغي أنْ تقع موردًا للقراءة والتفسير؛ لأنَّ التفسير إنَّما هو للفهم، والفهم إنَّما يتحقَّق إذا كان متطابقًا مع الحاجة؛ أي التجربة الاجتماعيَّة. ولذلك عندما تمسُّ الحاجة إلىٰ العلم، يجب أنْ نخوض في تفسير آيات العلم دون آيات الكشف والشهود، وعندما نُدعىٰ إلىٰ واقعنا الخارجي وعالمنا العيني، يجب علينا تفسير آيات عالم الشهادة دون الآيات المرتبطة بعالم الغيب.
ب) إنِّ الاتِّجاه الاجتماعي في التفسير والتفسير الموضوعي يبحث في مسائل المجتمع. يرىٰ حنفي أنَّ التفسير الموضوعي يجب أنْ يشتمل علىٰ الخصائص الآتيَّة:
يجب أنْ يهتمَّ أوَّلًا بدراسة البناء اللغوي والأدبي للآيات، من ذلك مثلًا، أنَّ الفعل غير الاسم، والفعل بمعنىٰ الحركة، والاسم بمعنىٰ الثبات. أو علامات الإعراب من الرفع والنصب والجرِّ، حيث يكون لكلِّ واحدٍ من هذه العلامات معنىٰ خاصّ؛ فالرفع علامة علىٰ الفاعليَّة، والنصب علامة علىٰ المفعوليَّة، والجرُّ بمعنىٰ اللحاق والتبعيَّة. وفي المرحلة التالية، يجب تبويب وتحليل معاني الآيات ضمن مجموعة من العناصر الأصليَّة، وليس المفاهيم
(227)الأصليَّة والفرعيَّة، والإيجابيَّة والسلبيَّة، والإلهيَّة والإنسانيَّة، والمادّيَّة والمعنويَّة، والفرديَّة والاجتماعيَّة. والخطوة الثالثة: إعطاء الأولويَّة للموضوعات التي تُلبّي حاجة العصر، من قبيل: الأرض، والمال، والفقر، والثروة، والتخلُّف، والتقدُّم، والأُمَّة، والإنسان، والجهاد، وإسرائيل. والمرحلة الأخيرة تكمن في تكوين الموضوعات علىٰ نسق عقلي، بحيث يُكوِّن تصوُّرًا إسلاميًّا في حقل الإنسان والمجتمع والطبيعة والتاريخ.
ج) إنَّ هذا الاتِّجاه يعكس تفسيرًا معاصرًا، وهو لزمان ومكان معيَّن، ولذلك لا رابط له بالتفاسير السابقة، ولن يكون مُلزمًا للأجيال القادمة. إنَّ للتفسير المعاصر غاية عمليَّة وهي تغيير واقع المسلمين، وليس اكتشاف الحقائق النظريَّة، ومن هذه الناحية تكون مسألة «الصدق» في التفسير بمعنىٰ التغيير والتأثير العملي. إنَّ حنفي لا يرىٰ التفسير الحقيقي تفسيرًا يتحدَّث عن الإسلام العامِّ العابر للزمان والمكان؛ فهذا التفسير يُحلِّق فوق الواقع، ولا رابط له بالمسائل العينيَّة والخارجيَّة. كما أنَّه لا يرىٰ التفسير الواقعي تفسيرًا يدافع عن الله والإسلام؛ لأنَّ الله لا يحتاج إلىٰ مَنْ يدافع عنه، كما أنَّ للإسلام ربًّا يحميه! بل ينبغي للتفسير أنْ يدافع عن المسلمين ومصالحهم.
د) إنَّ التفسير يجب أنْ ينبثق عن التجارب الحيَّة التي يعيش فيها، ولذلك فإنَّ التفاسير الإصلاحيَّة وكذلك التفاسير العرفانيَّة، علىٰ الرغم من بعض العيوب، تحتوي علىٰ هذه الخصائص، بل إنَّ حنفي يرىٰ أنَّ النصوص الدِّينيَّة ليست سوىٰ هذه التجارب المعاشة، من قبيل: شهادة الأنبياء، وخشية الأتقياء، وطغيان الأُمراء، وصراع القوىٰ المتخاصمة في المجتمع.
(228)ه) فيما يتعلَّق بالتفسير الاجتماعي يجب العمل أوَّلًا: من أجل رصد المسائل الواقعيَّة في المجتمع، علىٰ الاستعانة بعلماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد؛ إذ من شأن هذه العلوم أنْ ترصد هذه المشكلات الاجتماعيَّة، ثمّ وضع هذه المسائل ضمن منظومة واحدة بحسب الأولويّات، من قبيل: تحرير الأرض المحتلَّة، والحُرّيَّة، والديمقراطيَّة، والتسامح تجاه مختلف الآراء، والتطوُّر في قبال مظاهر التخلُّف، وحشد الجماهير ضدَّ التهاون والخمول.
و) إنَّ الطبقة الاجتماعيَّة للمفسِّر هي التي تُحدِّد نوعيَّة تفسيره، وإنَّ اختلاف التفاسير باختلاف المفسِّرين يعود إلىٰ الطبقات الاجتماعيَّة التي ينتمون إليها، وما إذا كانوا يريدون الحفاظ علىٰ الواقع القائم أم الثورة علىٰ هذا الواقع، وما إذا كانوا جزءًا من النظام السياسي أم خارجه، وما إذا كانوا من الطبقات العليا أو من الطبقات الدنيا. بيد أنَّ المهمَّ هو الوعي الطبقي وليس التبعيَّة الطبقيَّة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ اختلاف القراءات في التفسير ناشئ من اختلاف الظروف والشرائط الروحيَّة والنفسيَّة والاجتماعيَّة للمفسِّرين، الأمر الذي يستدعي بدوره اختلافًا في المصالح. وبالتالي فإنَّ حنفي يقول: إنَّ هذا الاتِّجاه متَّهم بالعلمانيَّة والإلحاد والشيوعيَّة والاستغراب، في حين أنَّ الإسلام يشتمل علىٰ جميع هذه الخصائص والأُمور، رغم أنَّ المفاهيم المذكورة أعلاه قد جاءت من العالم الغربي، وبما يتناسب مع شرائطها التاريخيَّة!
كما يذهب حسن حنفي حتَّىٰ في حقل الروايات إلىٰ الادِّعاء بأنَّه يجب العمل
علىٰ توظيف العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة الحديثة، بالالتفات إلىٰ تاريخيَّة شكل وبنية ومضمون الأحاديث، والاستفادة من طريقة القدماء في «نقد السند» والانتقال إلىٰ المرحلة المعاصرة الجديدة، ونعني بها «نقد المتن». يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ بنية وشكل الحديث تابع لقوانين وعوارض النقل الشفهي، كما أنَّ مضمونه أو موضوعه مرتبط بعصر صدور الرواية وشرائط وعادات وسُنَن ومقتضيات ذلك العصر أيضًا. إنَّ الأمثلة التاريخيَّة والروائيَّة التي يسوقها حنفي لإثبات مدَّعاه، مأخوذة بأجمعها من صحيح البخاري، ومن دون أنْ يجري عليها أيَّ نقد للسند. إنَّ تاريخيَّة الروايات تعني من وجهة نظره أنَّ بنية الرواية تابعة للنقل الشفهي وعوارض من قبيل الزيادة والنقصان. فقد كان الرواة يتدخَّلون في نقل الحديث؛ لأنَّ ذاكرة الإنسان لا تعمل علىٰ غرار آلة التسجيل، وإنَّما هي ذاكرة تأويليَّة ومبدعة وخلّاقة، وتعمل علىٰ إدخال تجاربها ودوافعها، بيد أنَّ الأحاديث لها نقطة بداية تتكرَّر في مختلف الأبنية الأدبيَّة، وأنَّ الزيادات آخذة بالازدياد جيلًا بعد جيل. يضاف إلىٰ ذلك أنَّنا نقف علىٰ الكثير من الاختلاف في التأويل، وأنَّ النبيَّ بنفسه كان من جملة المأوِّلين، وكان يُكثِر من توظيف المجاز، ولذلك كانت لغة الحديث أكثر تاريخيَّة من لغة القرآن وأعقد منها. ثمّ يعمد حنفي إلىٰ الاستشهاد ببعض الروايات من صحيح البخاري من دون العمل علىٰ نقدها من الناحية السنديَّة؛ ليُثبِت بذلك تاريخيَّة مضمون الروايات، والقول بأنَّ النبيَّ الأكرم طيلة مدَّة عصره وفي مختلف مراحل عمره، قد تعرَّض إلىٰ تغيير مواقفه والانتقال إلىٰ
اختيار الأفضل، ولا يدخل هذا التغيير في حقل النسخ بالضرورة، بل هو تناغم وانسجام مع الأوضاع والظروف المستجدَّة، وحتَّىٰ النسخ نفسه يُعبِّر عن تغيُّر وتحوُّل في السُّنَّة. يزعم حنفي أنَّه يُقدِّم شواهد مختلفة لإثبات تاريخيَّة المضمون، من ذلك مثلًا، أنَّه يقول: إنَّ حكم الرجم كان من تعاليم اليهود، وأنَّ النبيَّ قد أخذه منهم، أو أنَّ قطع يد السارق كان من تقاليد الجاهليَّة في شبه الجزيرة العربيَّة. كما يعتقد حنفي أنَّ بالإمكان العثور في التراث والسُّنَّة علىٰ موارد يمكن الاستناد إليها في إثبات إمكانيَّة تعطيل الحدود بسبب تغيُّر الشرائط الاجتماعيَّة. فاليوم أضحت هناك حرمة وقدسيَّة للجسد، ولا يمكن المبادرة إلىٰ استئصال الأعضاء إلَّا في إطار المنظومة الطبّيَّة ولغايات علاجيَّة، حيث يتوقَّف إنقاذ حياة الإنسان علىٰ إجراء عمليَّة جراحيَّة أو بتر بعض أعضائه. يرىٰ حنفي أنَّ تاريخيَّة مضمون الأحاديث يُثبِت قِدَم الكثير من المسائل والموضوعات، من قبيل: الجزية، والغنائم، والصيد، والذباحة الشرعيَّة، وتعدُّد الزوجات، والعبيد، والإماء. وإنَّ عصرنا ليس عصر الهويَّة الدِّينيَّة، وإنَّما هو عصر الانتماء الوطني.
وفي نهاية المطاف يصل حنفي إلىٰ نتيجة مفادها أنَّ القرآن الكريم، وإنْ كان تاريخيًّا، إلَّا أنَّ الحديث والروايات أكثر تاريخيَّةً من القرآن، وأنَّ التفسير أكثر تاريخيَّةً من القرآن والحديث، وأنَّ السيرة أكثر تاريخيَّةً من القرآن والحديث والتفسير، وبالتالي فإنَّه يُعرِّف علم الفقه بوصفه من أكثر العلوم النقليَّة تاريخيَّةً. وعلىٰ أساس من مبناه القاضي بتاريخيَّة الأحاديث والروايات،
يرىٰ أنَّ مفادها ومفاهيمها ناظرة إلىٰ البيئة الجغرافيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والدِّينيَّة للعرب في عصر صدور الروايات، بل والمجتمع الجاهلي أحيانًا، ويزعم أنَّه يذكر شواهد علىٰ ذلك من صحيح البخاري.
إنَّ حنفي من خلال بيان تاريخيَّة بنية ومضمون الروايات والأحاديث، ونظرها إلىٰ البيئة الاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والدِّينيَّة لعصر النبيِّ الأكرم، وكذلك من خلال بيان تأثُّرها بالسُّنَن والمعتقدات والأعراف والأساطير والأديان السابقة، وكذلك دور الإبداع والتصوير الأدبي/ الفنّي للرواة في الأدب القَصصي والتقريري للروايات، يسعىٰ إلىٰ إثبات هذه المسألة، وهي أنَّ الأحاديث تتمتَّع بروح وجوهر لا يتغيَّر في صلب الحقائق والواقعيّات الاجتماعيَّة المتغيِّرة، ولذلك يجب حصر الاهتمام بروح وجوهر هذه الأحاديث، وأمَّا سائر لوازمها، فهي مجرَّد أُمور تاريخيَّة لا تقبل التعميم. إنَّ جوهر الأحاديث من وجهة نظر حسن حنفي عبارة عن: التعقُّل، والمحبَّة، والتدرُّج في التربية، والتساهل في التشريع، والصحَّة، ومراعاة الحُرّيّات الأساسيَّة للإنسان، والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، والمحافظة علىٰ الطبيعة، ومحوريَّة الأخلاق وما إلىٰ ذلك. وهذا هو روح التنوير الذي يباهي به الغرب، والعلمانيَّة التي تتعلّق بأهدابها.
كما يعمل حنفي، بالإضافة إلىٰ توظيف علم الظاهريّات وتحليل التجربة الباطنيَّة في تفسير القرآن والحديث، علىٰ توظيف ذلك في إصلاح علم أُصول
الفقه أيضًا، ويقول في هذا الشأن: كما أنَّ العالم الأُصولي كان في السابق يعمل علىٰ تفسير النصوص علىٰ أساس من تجربته وأحاسيسه الداخليَّة المتأثِّرة بالشرائط الحضاريَّة لعصره، كذلك يجب علىٰ الأُصوليِّين المعاصرين والمتجدِّدين أنْ يعملوا علىٰ تفسير النصوص، استنادًا إلىٰ تجربتهم الداخليَّة ووعيهم المعاصر أيضًا. وعلىٰ مستوىٰ أشمل وأعمق، يذهب حنفي إلىٰ الاعتقاد بأنَّ جميع مصادر وأدلَّة التشريع الأربعة؛ أي: الكتاب والسُّنَّة والإجماع والاجتهاد (القياس عند أهل السُّنَّة)، تُمثِّل تجلّيًّا للوعي التاريخي، ويواصل تفسيره بشكل تلقائي وقسري في التحليل الظاهراتي لـ «الشعور»، وهو يقول في تحليل المصادر المتقدّمة: إنَّ «الوعي التاريخي» يتجلّىٰ في مساره من خلال العبور من المجازات الإنسانيَّة في التاريخ للوهلة الأُولىٰ علىٰ شكل «التجربة الإنسانيَّة العامَّة» المتناغمة والمنسجمة مع جميع الشعوب، وهذا هو الكتاب (القرآن)، ثمّ تعمل هذه التجربة العامَّة، في إطار سعيها إلىٰ تطبيق ذاتها وتعيُّنها في الزمان والمكان، علىٰ إيجاد تجارب أُخرىٰ، وأوَّلها «التراث» أو «التجربة النموذجيَّة»، تليها بعد ذلك «التجربة المشتركة» أو «الإجماع» في كلِّ عصر. وأمَّا التجلّي الرابع للتجربة الإنسانيَّة العامَّة، فيكمن في «التجربة الفرديَّة»، وهي التي تتجلّىٰ في كلِّ زمان باسم «الاجتهاد» أو القياس. وعليه، فإنَّ التفسير طبقًا لهذا النموذج من تحليل المصادر الفقهيَّة، ليس أمامه سوىٰ تحليل التجارب والوعي الداخلي علىٰ أساس من المباني الظاهراتيَّة.
1. إنَّ القرآن الكريم الذي نتلوه ونستمع إلىٰ تلاوة آياته ونراه، هو الكتاب الذي نزل علىٰ النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وحيًا، بيد أنَّنا لا نستطيع فهم حقيقة أو ماهيَّة هذا الوحي. وإذا حذفنا المبدأ الفاعلي والقابلي للوحي، فإنَّ ماهيَّة هذا الكتاب سيعتريها التغيُّر، ولن يمكن اعتباره وحيًا. وهذا ما قام به حنفي؛ إذ اعتبر القرآن منقطعًا عن المبدأ الفاعلي والمبدأ القابلي! كما يجب، بالالتفات إلىٰ مُنزل الوحي، اعتبار هذا الكتاب حاملًا لمقاصد وغايات المُنزل له وهو الله. يضاف إلىٰ ذلك، أنَّ القرآن في حدِّ ذاته يشتمل علىٰ لغة ناطقة، والذي له أدنىٰ إلمام بهذا الكتاب، يعلم أنَّ القرآن قد تحدَّث عن الله بشكل متواصل، وأنَّ من خصائصه وصفاته: الرحمة والغضب، ويتكلَّم بعبارة واحدة عن هدايته وضلاله، وعليه كيف يمكن القول، والحال هذه، بأنَّ إحالته إلىٰ الله علىٰ خلاف قصد وغاية الوحي؟!
2. لقد سلك حنفي، في تقييمه للارتباط بين أسباب النزول وآيات الوحي، طريق الإفراط. لا شكَّ في أنَّ لفهم أسباب النزول دورًا كبيرًا في فهم معاني القرآن الكريم وحلِّ المشكلات والمعضلات التفسيريَّة في حقل الأُصول والفروع؛ لأنَّها تكشف النقاب عن الكثير من آيات القرآن الكريم. ولكنْ في الوقت نفسه، وبالنظر إلىٰ اللغط الكثير الذي أُثير حول أسباب النزول، بالإضافة إلىٰ كثرة الروايات غير الصحيحة والموضوعة والمتعارضة في هذا الشأن، لا يبقىٰ لنا ممَّا يُعتَمد عليه من أسباب النزول غير النزر اليسير.
بيد أنَّ هناك أهمّيَّة قصوىٰ تترتَّب علىٰ الالتفات إلىٰ النقاط الآتيَّة:
أ) إنَّ أسباب النزول لا تُمثِّل الواقع المنحصر للآيات، كي نحدَّ أو نُفسِّر الآيات من خلال أُطُرها الزمانيَّة والمكانيَّة والموضوعيَّة. ليس لسبب النزول غير استدعاء نزول الآيات كي يمكن لنا تفسيرها وبيانها، وعليه لا تكون لسبب النزول واقعيَّة ذات روح بحيث تجعلها مقدّمة علىٰ آيات القرآن الكريم، فتكون سببًا لنزولها ومفسِّرة لدلالتها. إنَّ تناظر القرآن (أو بعض آياته) مع أسباب النزول يعني الاستجابة للاحتياجات وتفسير وبيان المسائل، لا أنْ تكون الفلسفة الوجوديَّة للآيات أو تفسيرها رهنًا بشأن النزول. ومن هنا نجد المفسِّر المعاصر للقرآن العلّامة السيِّد محمّد حسين الطباطبائي يقول في هذا الشأن: «ليُعلَم أنَّ الأهداف القرآنيَّة العالية التي هي المعارف العالميَّة الدائمة... لا تحتاج كثيرًا، أو لا تحتاج أبدًا، إلىٰ أسباب النزول».
ب) وعلىٰ هذا الأساس، فإنَّ حنفي يرتكب هنا مغالطة جوهريَّة؛ إذ يحصر فهم الآيات في خصوص الأُطُر التاريخيَّة والاجتماعيَّة، ويعتبر تقدُّم شأن النزول علىٰ الآيات، بمعنىٰ تقدُّم الواقع علىٰ الآيات. وتبعًا لهذه المغالطة، وقع حنفي في مغالطة أُخرىٰ، حيث يقول: بما أنَّ أسباب النزول هي المشاعر والأحاسيس والتجارب الداخليَّة للأشخاص، لذلك فإنَّ تفسير الآيات يعود إلىٰ تفسير تلك التجارب الداخليَّة. والسؤال الذي يتوجَّه إلىٰ حنفي هو: إذا كانت المشاعر
والتجارب الداخليَّة الحيَّة للأفراد، علىٰ حدِّ تعبيره، تصلح لتكون مرجعًا للتفسير، فما هي الحاجة إلىٰ نزول الآيات؟! وما هي نسبة تفسير التجارب الحيَّة للأفراد إلىٰ القرآن الكريم؟ ولماذا يجب فرضها وتحميلها علىٰ آيات القرآن الكريم؟ هل يمتلك الأفراد في كلِّ عصر مشاعر متشابهة وتجارب حيَّة واحدة؟! وعشرات الأسئلة الأُخرىٰ التي ليس لها من جواب سوىٰ الإنكار. وفي نهاية المطاف، يصل حنفي إلىٰ هذه النتيجة المحتومة، وهي تفسير الآيات [لا] علىٰ أساس معانيها ومداليلها اللفظيَّة، بل علىٰ أساس ما يختلج في صقع الأفكار والمشاعر الداخليَّة للأشخاص (بما تشتمل عليه من الأوهام والخرافات وما إلىٰ ذلك) علىٰ نحو الحدس. وقد أطلق حنفي علىٰ هذا النوع من التفسير اسم التفسير الإنساني. من الواضح أنَّ التفسير الظاهراتي للقرآن، وهو المنهج الذي اتَّخذه حنفي، ليس تفسيرًا للقرآن، بل هو مجرَّد بيان للأحاسيس والمشاعر الداخليَّة لدىٰ كلِّ شخص، وبذلك لا يكون هذا البيان مشتملًا علىٰ منطق واقعي، ولا يمكن نسبة هذه الأوهام والخيالات إلىٰ الوحي.
ج) إنَّ الخلط الذي يرتكبه حنفي بين ما يستدعي النصَّ وما هو مصدر للنصِّ، قد أدّىٰ به إلىٰ اعتبار المجتمع والناس أصلًا، واعتبار القرآن فرعًا، في حين أنَّ القرآن الكريم هو الهادي والموجِّه، والناس هم التابعون له ولتوجيهاته. وطبقًا لرؤيته، فإنَّه بالرجوع إلىٰ مصدر الوحي؛ أي الناس، لا تعود هناك حاجة إلىٰ الوحي، وربَّما كان هذا الرجوع
(236)مناسبًا لمجرَّد التأييد أو إسقاط وتطبيق عنوان الإسلام علىٰ مثل هذا الرجوع، ولكنْ هل يمكن تسمية ذلك إصلاحًا للتراث الإسلامي؟!
أمَّا المغالطة الأُخرىٰ التي يرتكبها حنفي، أنَّه من خلال تدريجيَّة نزول القرآن، يتَّضح أنَّ جميع القرآن ليس موردًا لحاجة عصر واحد، كما كان الأمر كذلك في عصر النزول أيضًا، في حين أنَّ التدريج في نزول القرآن كان ينطوي علىٰ فلسفة تربويَّة وتعليميَّة خاصَّة للمسلمين حديثًا، ولكنْ بعد إتمام نزول جميع الآيات، أصبح مجموع القرآن موردًا للتلاوة والتدبُّر والعمل وتقرُّب الإنسان إلىٰ الله. وبطبيعة الحال، من الممكن في بعض الأحيان أنْ لا تكون الشرائط المصداقيَّة لبعض الخطابات القرآنيَّة أو مفاهيمها متوفِّرة لدىٰ فرد أو جماعة، بيد أنَّه ينبغي الاهتمام بمجموع المجتمع الإسلامي بل والمجتمع البشري لا في عصر واحد، بل في مجمل التاريخ وإلىٰ الأبد، والعمل علىٰ استخراج الاحتياجات والتكاليف علىٰ أساس القرآن والسُّنَّة. يضاف إلىٰ ذلك، أنَّه لا مجال للتبعيض في آيات القرآن الكريم، بمعنىٰ أنَّ الجهاد الإسلامي مطلوب من قِبَل الدِّين إلىٰ جانب الاعتقاد بالتوحيد والصلاة أيضًا، وليس أيُّ حرب أُخرىٰ، أو أنَّ القضاء علىٰ الفقر والاختلاف الطبقي، ليس وحده هو الهدف الذي ينشده الإسلام، بل لا يمكن تحقيق العدالة في المجتمع إذا تمَّ تجاهل التعاليم الإسلاميَّة الجوهريَّة الأُخرىٰ. إنَّ الكثير من آيات القرآن الكريم تعمل علىٰ بيان المعارف التوحيديَّة التي يحتاج لها جميع الناس في كلِّ الظروف والأحوال.
(237)3. إنَّ أُسلوب تفسير القرآن هو، خلافًا لرؤية حنفي، مثل القرآن، أُسلوب ثابت وغير تاريخي. إنَّ أهمَّ أُسلوب في التفسير، والذي هو تفسير القرآن بالقرآن، غير متأثِّر بالظروف العصريَّة، بل هو أُسلوب أوصىٰ به القرآن الكريم نفسه، كما أوصىٰ به أهل البيت عليهمالسلام أيضًا. لا شيء من الأساليب والمناهج التفسيريَّة في التاريخ، من قبيل: التفسير الروائي، والتفسير الفقهي، والتفسير الفلسفي، والتفسير العرفاني، والتفسير الكلامي، لم يكن من قبيل الأساليب والمناهج العصريَّة المتغيِّرة، رغم أنَّ الظروف والشرائط الفكريَّة والثقافيَّة في كلِّ عصر، قد تنصح بانتهاج أُسلوب خاصٍّ بما يتناسب مع موضوع ما، إلَّا أنَّ هذا لا يعني عصريَّة الأساليب. وما يزال المفسِّرون ينتهجون هذه الأساليب في عصرنا الراهن، وفي الوقت نفسه فإنَّ ماهيَّة هذا الكتاب السماوي لا تسمح بفرض وتحميل أيِّ أُسلوب عليه. ومن هنا لا يمكن تفسير القرآن الكريم بالأُسلوب التجريبي، ولا يمكن العثور علىٰ بيان تجريبي لتفسير جميع الآيات. إنَّ حنفي يتحدَّث بما يتناسب وأجواء الثقافة الغربيَّة، ولا يأخذ بعين الاعتبار حتَّىٰ الظروف والشرائط التاريخيَّة للعالم الإسلامي. إنَّه يرىٰ العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة الغربيَّة بأنَّها هي الوصفة الوحيدة للعلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة، وتبعًا لهذه الأساليب يعمد إلىٰ تفسير التعاليم الإسلاميّة، بل إلىٰ تحريف التعاليم القرآنيَّة بعبارة أصحّ، ولذلك فإنَّ انتقاداته لأساليب التفسير، إنَّما تكتسب معناها ومفهومها ضمن هذه المنهجيَّة. إنَّ كلَّ واحد من هذه الأساليب والمناهج التفسيريَّة، بمقتضىٰ محدوديَّتها، لا يمتلك القدرة علىٰ بيان معاني جميع الآيات، أو جميع معاني
الآية الواحدة، ولذلك كانت محدوديّات ونواقص هذه الأساليب محطّ اهتمام المفسِّرين. بيد أنَّ العيوب أو الانتقادات التي يذكرها حنفي علىٰ الأساليب التفسيريَّة من سنخ آخر، فقد عمد إلىٰ دراسة وانتقاد هذه الأساليب في إطار الشرائط التاريخيَّة والعصريَّة، في حين أنَّ أصل مبناه وبنائه كلاهما خاطئ.
يمكن العمل في التفسير علىٰ توظيف جميع الأساليب التفسيريَّة المتداولة، وإنَّ الكثير من تحليلات وانتقادات حنفي في هذا الشأن غير واردة. ففيما يتعلَّق بالتفسير الروائي، يمكن للرواية المأثورة عن النبيِّ الأكرم والأئمَّة المعصومين أنْ تساعد بشكل كبير علىٰ فهم الآيات والتعرُّف علىٰ مصاديقها. إنَّ الروايات ذاتها تشتمل علىٰ ملاك صدقها الدلالي، ومن بينها التناغم والانسجام مع الأحكام العقليَّة الأوَّليَّة، والتطابق مع النصوص السماويَّة. إنَّ التفسير الفقهي ليس أُسلوبًا في التفسير، وإنَّما هو تفسير موضوعي في حقل الفقه، حيث يُستفاد فيه من الروايات والعقل والأساليب الاجتهاديَّة الفقهيَّة. كما أنَّ التفسير العرفاني، خلافًا لحسن حنفي، ليس منبثقًا عن إحباط طبقة اجتماعيَّة من ساحة الجهاد، لينكبّوا علىٰ العرفان، بل هو اتِّجاه قرآني، وله مصادر في القرآن الكريم والروايات. وإنَّ التجربة العرفانيَّة ليست من سنخ التجارب أو الأحاسيس الظاهراتيَّة المنشودة لحسن حنفي، بل إنَّها تتبلور علىٰ محوريَّة الإيمان والإخلاص في التوحيد، وإنَّ العيوب التي ذكرها لا يمكن أنْ تشمل جميع أنواع التفسير العرفاني، فلا يمكن اتِّهام جميع التفاسير العرفانيَّة والفلسفيَّة بالنزعة التأويليَّة والعبور علىٰ النصِّ، واعتبار ذلك من مزايا هذين التفسيرين.
4. إنَّ اتِّجاهه الاجتماعي، وبعبارة أصحّ: اتِّجاهه الظاهراتي في التفسير، يواجه إشكالات جوهريَّة، نجملها علىٰ النحو الآتي:
أ) إنَّ التفسير الموضوعي والجزئي لآيات القرآن، إنَّما يصل إلىٰ الخواتيم القرآنيَّة المطلوبة، إذا تمَّ فهمه ضمن تفسير كلِّ الآيات، وليس منفصلًا عنها، ولا سيّما التفكيك والفصل الذي قام به حنفي، فإنَّه يهمل أهمّ تعاليم القرآن الكريم؛ أي: التوحيد، وعالم الغيب، والتسليم لله، ومثل هذا التفسير لا يمكن أنْ يكون تفسيرًا للقرآن، بل هو محاربة للقرآن. إنَّ فهم التعاليم القرآنيَّة، ولا سيّما الإيمان والعمل بها، رهن بفهم وتصديق سائر التعاليم المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنبوَّة والعمل بها، وإنَّ الذي له أدنىٰ معرفة بمنطق القرآن الكريم يدرك أنَّ جميع معارفه وتعاليمه متَّصلة ببعضها ومنسجمة فيما بينها، ولذلك فإنَّ التفسير الموضوعي، إنَّما يكتسب معناه من خلال القبول بهذا الأصل.
ب) إنَّ القواعد العربيَّة تلعب دورًا مهمًّا في التفسير، ولكنْ لا يمكن تحميل وإسقاط بعض الذوقيّات والاستحسانات علىٰ هذه القواعد، فمثلًا لا يمكن لنا أنْ نستنبط مفاهيم اجتماعيَّة من إعراب الرفع والنصب والجرِّ.
ج) إنَّ التفسير الحقيقي للقرآن، والذي يتطابق مع الظواهر والنصوص القرآنيَّة، خلافًا لرأي حنفي، له قابليَّة الصدق، والتفسير الذي لا يكون كذلك لن يكون إلَّا كاذبًا. إنَّ التفسير الصادق والمتطابق مع مراد القرآن يجب أنْ يشتمل علىٰ هدف عملي حتمًا، وهذا يقع علىٰ عاتق المفسِّرين، حيث يستخرجون البرامج والآليّات العمليَّة من التعاليم القرآنيَّة.
د) إنَّ تفسير القرآن يستتبع الفكر والإحساس القرآني، وتبعًا لذلك يوجد السلوك والثقافة القرآنيَّة لدىٰ الفرد والمجتمع، لا أنْ يكون التفسير عبارة عن فرض جميع أنواع الأحاسيس الداخليَّة للفرد علىٰ القرآن. ثمّ إذا كانت التجارب الداخليَّة الحيَّة للأشخاص هي الملاك، فما هي الحاجة بعد ذلك إلىٰ القرآن؟!
ه) إنَّ التفكير الماركسي لحسن حنفي في البحث البنائي والمبنائي، بمعنىٰ أنَّ الطبقة الاجتماعيَّة للمفسِّر هي التي تُحدِّد اتِّجاهه النظري، مخدوش وأجنبي عن أُسلوب التفسير. فإنَّ الشرط الأوَّل للتفسير، هو التخلّي عن الانتماءات الفئويَّة والطبقيَّة والحزبيَّة؛ إذ إنَّ للقرآن منطقه الخاصّ في الفهم والتفسير، وهو مقياس لجميع أنواع التعلُّق والتفكير. إنَّ حنفي قد أفرط في تنكُّب الطريق إلىٰ درجة بحيث عمد في نهاية المطاف إلىٰ تعريف الإسلام بأنَّه مشتمل علىٰ الأفكار العلمانيَّة والماركسيَّة وحتَّىٰ الإلحاديَّة! بمعنىٰ أنَّ الإسلام يتضمَّن نقيضه!
5. إنَّ كلام حنفي في حقل تفسير الروايات، أو علىٰ حدِّ تعبيره «نقد المتن» بدلًا من «نقد السند»، يحتوي علىٰ الكثير من الإشكالات، ونذكر منها:
أ) إنَّ اتِّجاه حنفي في حقل «نقد متن» الحديث، مأخوذ من أُسلوب الغربيِّين في نقد متن الأناجيل، الذي شاع في القرن العشرين، ولا سيّما في ألمانيا من قِبَل (رودولف بولتمان). فإنَّهم بالالتفات إلىٰ ماهيَّة الأناجيل، حيث يعتقدون أنَّه من كتابات أتباع السيِّد المسيح عيسىٰ بن مريم عليهاالسلام، عمدوا
إلىٰ تفسيره من جديد ليكون مقبولًا في العصر الجديد. ومن هنا فقد قدَّم بولتمان تفسيرًا وجوديًّا جديدًا للإنجيل علىٰ أساس الفلسفة الوجوديَّة لمارتن هايدغر. إنَّ اختلاف النصوص الإسلاميَّة (القرآن والسُّنَّة) في عقلانيَّة المفاهيم والتعاليم عن نصِّ الإنجيل، يجعل الاستفادة من الأُسلوب التفسيري لبولتمان في مكافحة الأساطير أمرًا غير معقول. يضاف إلىٰ ذلك، أنَّ الدقَّة الكبيرة لعلماء الحديث في ضوابط الراوي من قبيل: التقوىٰ، والعدالة، والوثاقة، والضبط وما إلىٰ ذلك، في نبذ رواية الوضّاعين والساذجين والذين يعرض عليهم النسيان، يُبطِل هذا الكلام من حنفي القائل بأنَّ الرواة كانوا أُناسًا عاديِّين يعرض عليهم الخطأ والنسيان ويتأثَّرون بثقافاتهم أو أهوائهم البشريَّة أو يتأثَّرون بالصراعات السياسيَّة في عصرهم، لا يمكن القبول به علىٰ نحو الموجبة الكلّيَّة. يُضاف إلىٰ ذلك، أنَّ نقد المتن قد تناوله علماء الإسلام بأُسلوب غير الأُسلوب الذي سلكه حنفي، فقد كانوا يعملون علىٰ نقد الروايات من خلال عرضها علىٰ القرآن والعقل وسائر الروايات الأُخرىٰ.
ب) إنَّ حنفي قد تخلّىٰ في تفسير الروايات عن نقد السند بالمرَّة، أو أنَّه قلَّل من أهمّيَّته، في حين أنَّ نقد السند لا يقلُّ أهمّيَّةً عن نقد المتن. فإذا كانت الرواية ضعيفة من حيث السند أو مخدوشة، تمَّ نبذها والإعراض عنها، ولن يصل الأمر إلىٰ نقد المتن والنصِّ، في حين أنَّ الغربيِّين بسبب فقدان سلسلة السند في الأناجيل، يفتقرون إلىٰ هذا الأُسلوب.
ج) لا شكَّ في أنَّ الأحاديث لها تركيبة خاصَّة من الناحية الشكليَّة والمضمونيَّة، بيد أنَّ بنيتها لا تحتوي علىٰ جميع خصائص النقل الشفهي أو البنية الأدبيَّة. فإذا كان صدور الروايات من قِبَل النبيِّ الأكرم والأئمَّة الأطهارعليهمالسلام قطعيًّا، فإنَّ من أهمّ خصائصها البنيويَّة، التي تمَّت الغفلة عنها أو رفضها من قِبَل حنفي، أنَّها من الكلام المعصوم الذي يخلو من النقص والخلل، ويكون مثل الوحي؛ إذ ورد في القرآن الكريم أنَّ النبيَّ لا ينطق عن غير الوحي: ﴿وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى﴾. إنَّ الروايات، مثل الآيات، ناظرة إلىٰ الشرائط الخارجيَّة، ولكنَّها غير محصورة بها، كما أنَّها لا تنبثق عن ثقافة العصر والتقاليد والأعراف، إلَّا إذا كانت من جملة الأحكام الإمضائيَّة في الإسلام، وفي مثل هذه الحالة سوف تحظىٰ بالاعتبار المطلق علىٰ غرار الأحكام التأسيسيَّة.
د) إنَّ تأكيد حنفي علىٰ تدخُّل الذهن الخلّاق والتأويلي لدىٰ جميع الرواة في نقل الحديث من دون أنْ يُثبِت ذلك بدليل، هو من نتائج ومتفرِّعات مبناه الظاهراتي، حيث يُؤكِّد، من خلال نفي البُعد الروائي للأفكار، ومن بينها الروايات القابلة للصدق بالنسبة إلىٰ الواقعيّات العينيَّة والخارجيَّة، علىٰ الخلّاقيَّة والإبداع الداخلي والفنّي. ويبلغ به التطرُّف حدًّا يقول معه حتَّىٰ بتدخُّل الذهن المتخيِّل والمجازي للنبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله في الأحاديث النبويَّة! إنَّ هذه النسبة إنَّما تنشأ من إنكار ماهيَّة الوحي والنبوَّة، كما تُؤدّي إلىٰ إنكار رواية كلام المعصومين
للحقائق العينيَّة المرتبطة بالمبدأ والمعاد أو حقيقة السعادة الإنسانيَّة، في حين أنَّ أصل مبناه والنتائج المترتِّبة عليه، مرفوضة من جهة العقل والوحي. ولو قبلنا بمبناه ألَا يكون كلام حنفي نفسه من مصاديق الخيال والذهن التأويلي له؟ فإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن للذهن الخيالي أنْ يتحدَّث عن حقيقة تاريخيَّة باسم الروايات ودور الرواة بكلام واقعي قائم علىٰ تدخُّل الرواة في الحديث؟!
ه) إنَّ كلمات حنفي في إثبات تاريخيَّة الأحاديث، بالإضافة إلىٰ كونها مخدوشة من الناحية المبنائيَّة، كذلك هي مخدوشة وناقصة من ناحية الأُسلوب أيضًا. إلىٰ أيِّ شيء يرمي حنفي بكلامه القائل: «إنَّ النبيَّ الأكرم طوال مدَّة عصره وفي مختلف مراحل عمره قد تعرَّض إلىٰ تغيير مواقفه والانتقال إلىٰ اختيار الأفضل»؟ وكيف يمكن له أنْ يُثبِت ذلك؟! لقد كان النبيُّ الأكرم في مختلف الموارد، وطبقًا لما تقتضيه الظروف، يتَّخذ خيارات معصومة من الخطأ، اعتمادًا علىٰ الوحي الذي لا يأتيه الباطل أبدًا، ولكنْ ما علاقة هذا بالتأريخيَّة المنشودة لحسن حنفي؟! إنَّ الشواهد التي يذكرها علىٰ تاريخيَّة مضمون الروايات لا تُثبِت مراده أبدًا؛ إذ هناك مشتركات بين الأديان الإبراهيميَّة، ومن بينها ما هو داخل ضمن حقل العقوبات والقضاء الإسلامي، كما جاء ذلك في القرآن الكريم، إلَّا أنَّ منشأ جميع ذلك هو الوحي الإلهي، ولا رابط لذلك بتاريخيَّة المسألة.
ومن بين الادِّعاءات التي يُسوِّقها حنفي دون أنْ يدعمها بدليل، ما يرتبط
(244)ببعض الأحكام الإسلاميَّة، من قبيل: الحدود، والجزية، والغنائم، والصيد، وتعدُّد الزوجات، وما إلىٰ ذلك. إنَّه لا يقول ذلك علىٰ وفق المباني والأساليب المرعيَّة في استنباط الأحكام الشرعيَّة، وإنَّما يقول ذلك علىٰ أساس المباني الإنسانيَّة والعلمانيَّة الغربيَّة، حيث جعل من الشرائط المعاصرة في العالم الغربي شرائط تاريخيَّة لحاضر البشريَّة، وبعد التخلّي عن الهويَّة الدِّينيَّة وعدم الرجوع حتَّىٰ إلىٰ الوجدان العامِّ لدىٰ المسلمين وظروفهم الروحيَّة والاجتماعيَّة، أفتىٰ بتعطيل مفاد الروايات الإسلاميَّة.
و) إنَّ بنية الروايات ليست من سنخ البنية الأدبيَّة بحسب المصطلح الحديث. فإنَّ بنية الأُسلوب الأدبي قد تكون ناظرة إلىٰ التقاليد والمعتقدات والأعراف والأساطير، وقد تستعمل فيه الإبداع والتصوير الأدبي، الفنّي، إلَّا أنَّ الروايات والأحاديث لها أُسلوبها الخاصّ، وهي في الوقت نفسه تشتمل علىٰ دقائق الأدب العربي من حيث الفصاحة والبلاغة المختلفة عن أدب الفنِّ القَصصي والتقريري. ثمّ إنَّه كيف يمكن، من خلال المبنىٰ التاريخي للأحاديث، القول بفصل شيء باسم الروح أو الجوهر الثابت للأحاديث ولوازمه التاريخيَّة، في حين أنَّه طبقًا لهذا المبنىٰ لا يجب أنْ يكون هناك شيء باسم «روح الحديث»؟! إنَّ للأحاديث في المنطق الإلهي، بطبيعة الحال، غاياتٍ وأهدافًا وأُصولًا كلّيَّة خاصَّة، إلَّا أنَّ تعيينها وفصلها عن مصاديقها المنصوصة في الروايات، ليس أمرًا ذوقيًّا ومزاجيًّا وعصريًّا، كي يعمد حنفي إلىٰ أخذ أُصول التجدُّد بوصفها روح الأحاديث بعين الاعتبار.
(245)إنَّ الدراسات الإسلاميَّة تحظىٰ بأهمّيَّة ودقَّة خاصَّتين، وإنَّ أيَّ انحراف منهجي أو فهم غير واقعي في هذا الشأن، لن تكون نتيجته سوىٰ فهم مقلوب للإسلام، لا سيّما إذا قامت هذه الدراسات علىٰ وجهة نظر غربيَّة، واعتمدت علىٰ مدارسهم وأفكارهم. إنَّ الدراسات الإسلاميَّة التي قام بها حنفي أكثر بُعدًا عن الواقعيَّة من دراساته الاستغرابيَّة؛ لأنَّ قراءة الكثير من المستشرقين للإسلام أقرب إلىٰ الإسلام الصحيح من قراءة وفهم حنفي. إنَّ التفسير الذي قدَّمه حنفي للإسلام لا يحتوي علىٰ أدنىٰ صلة بالإسلام والتراث الإسلامي، وإنَّما هو مجرَّد عرض للأفكار والأدبيّات الظاهراتيَّة والاشتراكيَّة والمادّيَّة الغربيَّة، باسم إصلاح الإسلام وتجديد التراث الإسلامي.
تكمن الرسالة الأصيلة والخطيرة لمعرفة الإسلام في الفهم الصحيح للتعاليم الإسلاميَّة علىٰ أساس الكتاب والسُّنَّة ومن طريق العقل والنقل، وإنَّ العلوم المرتبطة بالتراث الإسلامي تُوفِّر مادَّة كبيرة لهذه الغاية المهمَّة وأرضيَّة للمزيد من التحقيق. وأمَّا إذا تمَّ اقتباس الفرضيّات الأصليَّة من جغرافيَّة أُخرىٰ وخلفيّات فلسفيَّة وثقافيَّة خاصَّة، لتكون هي المرجعيَّة لتأويل النصوص الدِّينيَّة، عندها سنكون أمام إسلام مقلوب، حيث تتمُّ نسبة الأفكار العلمانيَّة، بل وحتَّىٰ الإلحاديَّة، إلىٰ الإسلام!
إنَّ أهمَّ أداة مفهوميَّة تلعب دورًا في رسم الإسلام المقلوب، وخفض التراث الإسلامي إلىٰ مجرَّد ظاهرة تاريخيَّة، وبناءً علىٰ ذلك سيكون التراث ثمرة للشرائط الاجتماعيَّة الخاصَّة والمحدودة بتلك الحقبة والمرحلة التاريخيَّة.
(246)إنَّ إصرار حنفي علىٰ الرؤية التاريخيَّة تجاه التراث الإسلامي، يهدف إلىٰ نتائج هذه الرؤية، بمعنىٰ سلب القداسة عن الإسلام وإثبات النسبيَّة، وبالتالي ضرورة إحداث التغيير في التراث الإسلامي من دون أنْ يواجه أيَّ نوع من أنواع المقاومة الاجتماعيَّة. إنَّ معرفة الإسلام المعكوس قد أثبتت أنَّها تُرحِّب بأيِّ نوع من أنواع التغيير في الرؤيَّة الإسلاميَّة في ضوء ما تقتضيه المفاهيم والأفكار في العالم الغربي، وأنَّها ستواصل نهجها حتَّىٰ التغيير في أُصول الدِّين من التوحيد والنبوَّة والإمامة والمعاد؛ لأنَّ مثل هذا التغيير الجوهري من شأنه إعداد الأرضيَّة للقبول بجميع الأفكار السياسيَّة والاجتماعيَّة الحديثة.
إنَّ معرفة الإسلام عند حنفي إنَّما تكون معكوسة بالنظر إلىٰ أنَّه بدلًا من تأصيل الوحي والنصوص الدِّينيَّة، يمنح التأصيل للشرائط التاريخيَّة والروحيَّة للأفراد، ويجعل الوحي تابعًا لهذه الشرائط، ويقرأ التراث الإسلامي لا من الداخل، بل في مرآة الأفكار الأجنبيَّة، وبدلًا من أنْ يعتبر التاريخ إسلاميًّا ودينيًّا، يعتبر الدِّين والتراث الإسلامي تاريخيًّا، ويقلب الإلهيّات الإسلاميَّة إلىٰ إنسانيّات علمانيَّة، حيث تحلُّ الآلهة المجازيَّة محلَّ الإله الحقيقي. ثمّ إنَّ حنفي نفسه يعاني من العيوب والآفات ذاتها التي ينسبها إلىٰ الدراسات الإسلاميَّة للمستشرقين. ويبلغ حنفي نقطة الذروة في تقديم الإسلام المعكوس في تفسيره لتعيُّن الإنسان، حيث إنَّه بدلًا من اعتباره تعيُّن الإنسان المنشود من وجهة نظر الإسلام بالإيمان والعمل الصالح، يذهب إلىٰ اعتبار تعيُّن الإنسان في تحرُّره العملي واستقلاله الفكري من كلِّ شيء، حتَّىٰ من الإسلام نفسه، وهذا يعني أنَّ الإسلام يحمل في أحشائه بذرة ضدِّه. ويمكن بيان بعض وجوه الإسلام المعكوس عند حنفي في الأبعاد الآتية:
(247)إنَّ من بين الانحرافات الجوهريَّة لحسن حنفي أنَّه يعتبر التراث الإسلامي ذخيرة وطنيَّة وقوميَّة وحضاريَّة واقعة في براثن العصرانيَّة. والإشكال الجوهري الذي يرِد علىٰ حنفي هو أنَّ التراث الإسلامي ليس عبارة عن مجموعة من التفاسير الوطنيَّة والحضاريَّة المتغيِّرة منذ القِدَم إلىٰ يومنا هذا، بما يتناسب مع الشرائط الزمنيَّة المتغيِّرة، أو علىٰ حدِّ تعبيره بمقتضىٰ روح العصر، كي تكون «الحاجة المعاصرة» عنصره المقوِّم، أو يتمُّ التأكيد علىٰ تغيير التراث الإسلامي مجدَّدًا تبعًا للاستدلال علىٰ تغيُّر ونسبيَّة الاحتياجات. إنَّ هذا النوع من الكلام مليء بالمغالطات وزاخر بالسراب. إنَّ الدِّين يشتمل علىٰ مجموعة من المعاني والمفاهيم العالية والثابتة، وهي لا تتقوَّم بالزمان والعصر، وعليه لا يكون هناك مجال لتجديده أو إصلاحه علىٰ طبق المتغيِّرات الزمنيَّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ طريق التأمُّل والتفكير في النصوص الدِّينيَّة للوصول إلىٰ الفهم العميق يبقىٰ مفتوحًا، ولكنَّ هذا غير الإصلاح والتجديد في التراث الإسلامي. إنَّ انسيابيَّة التراث، من وجهة نظر حنفي، قد أخرجته من المبنائيَّة، وحوَّلته إلىٰ وسيلة وأداة طيِّعة وقابلة للتغيير، حتَّىٰ إنَّه يُصرِّح بأنَّ الإلهيّات القديمة لم تعد صالحة أو مفيدة لهذا الزمان، وأنَّها لا تستطيع أنْ تحلَّ مشكلات هذا العصر. إنَّ الإلهيّات الإسلاميَّة في إطار التوحيد تُمثِّل، خلافًا لحسن حنفي، محورًا لسعادة الإنسان، وإنَّ التوحيد في العبوديَّة والتشريع لا يقتصر علىٰ تنظيم علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالىٰ فقط، بل يعمل كذلك علىٰ ضمان أيديولوجيَّة التحوُّل الاجتماعي وبلورة الفلسفة السياسيَّة
(248)والاجتماعيَّة للإسلام أيضًا، ومن هنا فإنَّ هذه المباني الإلهيَّة من شأنها أنْ تحلَّ المسائل العصريَّة أيضًا.
إنَّ العصريَّة في التراث الإسلامي دفعت بحنفي إلىٰ اختزال جميع الفِرَق الإسلاميَّة وعلم الكلام ضمن إطار تراث السلطة والمعارضة، ووضع الإلهيّات في هامش السياسة. يذهب حنفي إلىٰ الادِّعاء بأنَّ علم أُصول الدِّين في مجمله كان له تبلور سياسي، بل إنَّ علم أُصول الدِّين هو في الأساس علم سياسي، تحوَّل فيه الدِّين إلىٰ أيديولوجيَّة سياسيَّة، وإنَّ عقائد مختلف الفِرَق ليست سوىٰ تنظير للواقع السياسي الذي يتبلور في إطار ترسيخ دعائم السلطة أو تغييرها. في حين أنَّ علم أُصول الدِّين، خلافًا لوجهة نظر حنفي، في الكثير من المذاهب الكلاميَّة لا يُعَدُّ جزءًا من تراث السلطة فحسب، بل إنَّ الأُصول المشتركة في المدارس الكلاميَّة مقتبسة من النصوص الصريحة في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة وحكم العقل. وإنَّ المذهب الشيعي، رغم امتلاكه أدب المعارضة في مواجهة حُكّام الجور والمذاهب والمفاهيم الخاطئة التي ظهرت في تاريخ الإسلام، لا يكتسب ماهيَّته من الأُسُس الاجتماعيَّة، وإنَّما يقوم علىٰ تعاليم القرآن والسُّنَّة وسيرة النبيِّ الأكرم صلىاللهعليهوآله وأهل البيت عليهمالسلام، وبذلك فإنَّه يعارض كلَّ ما سوىٰ ذلك. وعلىٰ هذا الأساس، لا يمكن بشكل عامٍّ إعادة منشأ ظهور جميع المذاهب الإسلاميَّة والأفكار الكلاميَّة إلىٰ حقل السياسة، ولا يمكن أنْ نستنتج من ذلك أنَّ التراث (بجميع أنواعه) أمر اجتماعي، وأنَّه وليد المعارضة السياسيَّة، وليس متقدِّمًا عليها.
إنَّ حنفي في إعادة التعريف بالتراث الإسلامي أو إصلاحه وتجديده، علىٰ حدِّ تعبيره، يعمل علىٰ توظيف أساليب هي في واقعها تنكُّر للتراث. فهو في البداية يتَّهم التراث الإسلامي بقِدَم الألفاظ، ويعتبر إلهيَّة لغة التراث هي عنصر ضعفه؛ إذ إنَّ هذا الأمر يسلب هذه اللغة القدرة علىٰ إيصال المضامين الجديدة والمفاهيم المتناسبة مع الاحتياجات المعاصرة، ثمّ يعتبر تجديد اللغة وكشف المعاني الجديدة طريقًا إلىٰ التحرُّر من التراث. إنَّ الخصائص التي ذكرها حنفي للغة الجديدة (من قبيل: الشموليَّة، وقابليَّة التغيير المفهومي، وقابليَّة النقد، وإمكانيَّة التجربة)، سوف تسلبها قابليَّة بيان معاني التراث والتعاليم الإسلاميَّة، لذلك لن تكون لحسن حنفي مندوحة من تغيير وتحريف معانيه، ليتحدَّث عن مفاهيم لا صلة لها بالتراث إطلاقًا، بمعنىٰ أنَّه يُفسِّر جميع الأُصول الاعتقاديَّة بمحوريَّة «الوعي الذاتي» الظاهراتي. وهذا في الحقيقة يُمثِّل أسوأ أشكال التحريف والانحراف الذي حدث في تاريخ الإسلام. إنَّ حنفي من خلال مبناه الظاهراتي والاتِّجاه التقليلي يعمل علىٰ خفض أشدّ حقائق الوجود أصالةً، من قبيل: وجود الله، إلىٰ ظواهر نفسيَّة ومن صنع الرغبات والآمال الإنسانيَّة التي توجد في صقع الشعور الداخلي للفرد. كما أنَّه من خلال افتراض بداهة العلوم الإنسانيَّة الغربيَّة يسعىٰ إلىٰ إسقاطه علىٰ التراث الإسلامي، وبذلك يعمل علىٰ تقويض وتهديم صرح العقائد الإسلاميَّة عبر مرحلتين:
المرحلة الأُولىٰ: عمد إلىٰ خفض أو تحريف أُصول من قبيل: التوحيد
(250)والعدل بتأويله عن الدائرة الإلهيَّة وعن حقل الارتباط المعرفي للإنسان مع الله، وتفسيره بتكلُّف واضح بالحقل البشري المحض، بل وحتَّىٰ غير المرتبط بالحقل الإنساني لدىٰ المسلمين، بحيث لا يصدق عليه حتَّىٰ التفسير الظاهراتي لعقائد المسلمين أيضًا.
المرحلة الثانية: اعتبر جميع الموضوعات والمسائل المهمَّة المرتبطة بالنبوَّة والمعاد والإمامة والعمل الصالح أُمورًا ظنّيَّة وغير قابلة للقطع واليقين، وخارجة عن دائرة الخطأ والصواب، كي يبقىٰ بمأمن من شظايا تكفير المسلمين. يعود جوهر جميع كلمات حنفي إلىٰ تأويل النصوص وتحويل العقائد الدِّينيَّة إلىٰ قراءات متعارضة ومعانٍ خاصَّة فارغة من الجوهر الأصلي للنصوص، ولا يعترف بأيِّ ضابطة لهذا التطبيق والتحميل أبدًا. وكما تقدَّم، فإنَّه لا يمتلك غير استعراض استعاري جديد يعتمد التراث المادّي القديم الذي عمد طيلة التاريخ في قبال المنطق الواضح إلىٰ اتِّهامات من قبيل: الجنون، وأساطير الأوَّلين، والشعر، وبالتالي إلىٰ الأدبيّات الانفعاليَّة الظاهراتيَّة.
يرىٰ حنفي أنَّ تعيُّن آحاد الناس الذي يصلون فيه إلىٰ شعور مستقلٍّ وهويَّة محدَّدة، رهن بركنين أساسيين، وهما:
1. الحُرّيَّة والاختيار.
2. العقل.
وإنَّ الفعل الإرادي، من وجهة نظر حنفي، هو الفعل الشعوري والواعي للإنسان، وأنَّ حُرّيَّته تعني الحُرّيَّة في العقيدة والسلطة، ونتيجة ذلك، من
وجهة نظره، أنَّه لا ينبغي لأيِّ إرادة خارجيَّة أنْ تعمل علىٰ تقييدها، سواء أكانت هذه الإرادة إلهيَّة أم غير إلهيَّة. إنَّه يرىٰ أنَّ الحُرّيَّة صفة للوعي والشعور الإنساني، وهي إلىٰ ذلك أمر قابل للاكتساب، وأنَّه ليس لها أيّ ارتباط طولي مع الله أو العالم، ولا تخضع لأيِّ إرادة من خارج الإنسان. كما يقول حنفي بشأن العقل: إنَّ العقل إذا كان في إدراك الحُسن والقبح تابعًا لإرادة الله ورضاه وسخطه، سوف يفقد استقلاله ويتحوَّل إلىٰ مجرَّد عقل تبريري فقط، وليس له أيّ إرادة من نفسه. إنَّ هذا الكلام لا يُقدِّم شيئًا جديدًا أو مختلفًا عن الأنثروبولوجيا الإنسانيَّة والليبراليَّة، وهو الأمر الذي أثبت نتيجته في حيرة وضياع الإنسان الغربي. إنَّ تعيُّن الإنسان في المنطق الدِّيني، إنَّما يمكن من طريق المعرفة والإرادة (الخيارات) والعمل. وإنَّ الإسلام ينظر إلىٰ الإيمان والعمل الصالح بوصفهما ركنين يُحدِّدان شخصيَّة الإنسان المسلم والهويَّة الإسلاميَّة. إنَّ الإيمان والعمل الصالح يُمثِّلان حاجة في المعرفة والتفكير الدِّيني الصحيح، وإنَّ العقل والنقل كاشفان رئيسان في الوصول إلىٰ التفكير الدِّيني. إنَّ إرادة الإنسان واختياره، خلافًا لوجهة نظر حنفي، لا يعني استقلاله المطلق عن كلِّ ما هو خارج عنه، بل الإرادة تعني حرّيَّته واستقلاله عن جميع القيود التي تعيق تفكيره وتعرقل إيمانه وعمله الصالح.
إنَّ الشعار الأهمّ الذي يرفعه حنفي في تجديد التراث الإسلامي، يكمن في تفسير هذا التجديد بالاقتضاءات الواقعيَّة المعاصرة للعالم الإسلامي. إنَّ النزعة الواقعيَّة في اتِّجاه حنفي في تفسير التراث تكمن في حلِّ المشكلات
(252)والمسائل الماثلة أمام المسلمين، ولذلك فإنَّه يخفض جميع حقوله النظريَّة إلىٰ حقوله العمليَّة، أو يتحدَّث عن تحويل العلوم الإسلاميَّة إلىٰ علوم إنسانيَّة، ومن ثَمَّ تحويلها إلىٰ أيديولوجيَّة. هذا في حين أنَّه عندما يُقدِّم تفسيراته عن أُصول الدِّين الجوهريَّة، بالإضافة إلىٰ أنَّه لا يُقدِّم تفسيرًا للتراث والمفاهيم الإسلاميَّة بما يتطابق مع الانتقادات السابقة، بل ليس لما يُقدِّمه أيّ ارتباط مع حلِّ مسائل العالم الإسلامي أبدًا، وإنَّما هو في ذلك يزيد من التحدّيات والمشكلات الماثلة أمامه. إنَّ التفسير المادّي الذي يُقدِّمه حنفي للوحي والمعاد لا يُمثِّل حتَّىٰ نوعًا من تحويل المسائل النظريَّة إلىٰ مسائل عمليَّة، أو ناظرة إلىٰ الواقع، بل هو مجرَّد سراب يحسبه الظمآن ماءً، وسوف يترتَّب عليه أكثر أزمات الهويَّة والتحدّيات المعرفيَّة والاجتماعيَّة تجذُّرًا.
وأمَّا خاتمة الكلام في هذه الدراسة، فهي أنَّ حنفي يذهب إلىٰ الاعتقاد بأنَّ المنهج والأُسلوب التفسيري المناسب لهذا العصر، هو الأُسلوب والمنهج الاجتماعي. وإنَّه في هذا الأُسلوب لا شأن له بجميع الآيات والنصوص الدِّينيَّة، وإنَّما هو في ذلك يُمثِّل مصداقًا بارزًا لقول الله تعالىٰ: ﴿نُؤْمنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾، حيث يعمل علىٰ تقطيع النصوص ويأخذ منها ما يناسبه ويذرّ ما لا يناسبه، ولذلك يرىٰ أنَّ الموضوعات التي لا تناسب حاجة العصر يجب عدم قراءتها والتعرُّض إلىٰ تفسيرها؛ لأنَّ التفسير إنَّما هو للفهم، والفهم إنَّما يحصل إذا كان متطابقًا مع الحاجة المتمثِّلة بالتجربة الاجتماعيَّة. وفي مثل
هذه الحالة، فإنَّ التجربة هي التي يجب عليها أنْ تحكم وتُقرِّر أيَّ جزء من الإسلام يجب أنْ يكون موردًا للعمل، وليس الله الذي أنزل القرآن وأرسل النبيَّ برسالة الإسلام! وعلىٰ حدِّ تعبيره، إنَّ خصوصيَّة تفسيره العصري تكمن في اتِّباع الأهداف والغايات العمليَّة المتمثِّلة بالعمل علىٰ تغيير واقع المسلمين، وليس اكتشاف الحقائق النظريَّة، ولذلك فإنَّ مسألة «الصدق» في تفسيره تعني الاشتمال علىٰ التأثير العملي. وفي ذلك فإنَّه يتجاهل حقيقة أنَّ كلَّ اتِّجاه عملي، إنَّما يقوم علىٰ اتِّجاه نظري. وفي الاتِّجاه الذي يذهب إليه حنفي يجب أنْ يكون التفسير منبثقًا من التجارب الحيَّة التي يعيشها المفسِّر، ومن هنا تكون التجارب والحالات النفسيَّة لمختلف الأفراد مبنىٰ للتفسيرات المتعدِّدة، كما لو أنَّ النصوص الدِّينيَّة عبارة عن ألواح بيضاء غير مكتوبة، وأنَّ بإمكان كلِّ شخص أنْ يعمل علىٰ تسويدها في كلِّ لحظة بما يتطابق مع حالاته وانفعالاته النفسيَّة! لا سيّما وأنَّه طبقًا لرؤية حنفي (... يوجد نقص)، فإنَّ الطبقة الاجتماعيَّة للمفسِّر هي التي تُحدِّد نوعيَّة تفسيره، وأنَّ اختلاف القراءات في التفسير إنَّما تنشأ من اختلاف الشرائط الروحيَّة والاجتماعيَّة للمفسِّرين. وبهذا الاتِّجاه النظري الماركسي، يسعىٰ حنفي إلىٰ تحقيق نتائج عمليَّة، وهو بنفسه يعترف بأنَّ هذا الاتِّجاه متَّهم بالعلمانيَّة والإلحاد والماركسيَّة والاستغراب، ولكنَّه مع ذلك يعتقد بأنَّ الإسلام يشتمل علىٰ جميع هذه الأُمور، رغم أنَّ هذه المفاهيم قد جاءت من العالم الغربي بما يتناسب مع الشرائط والظروف التاريخيَّة لهذا العالم!
من خلال دراسة المباني النظريَّة لحسن حنفي، ولا سيّما اتِّجاهه في الحقول الثلاثة؛ أي: الكلام، والفلسفة، والتفسير، يمكن اكتشاف نواقصه الواضحة، كما يمكن مشاهدة تأثير هذه النواقص في تحليله الخاطئ لمختلف الحقول الثقافيَّة والسياسيَّة، الأعمّ من الأبحاث المرتبطة بالحضارة والعولمة والتعريف بالتيّارات الاجتماعيَّة في العالم الإسلامي، وتحليل أزماته وتحدّياته بشكل واضح. كما اتَّضح أنَّ الجهود التي تمَّ القيام بها تحت عنوان «تجديد الفكر الدِّيني» أو «التجديد الدِّيني»، تُعرِّض أصالة وسلامة الإسلام الخالص إلىٰ خطر الالتقاط والتحريف، وأنَّه يتَّجه إلىٰ الطريق ذاته الذي سبق لتيّار التجديد الغربي أنْ سلكه. بل إنَّ حنفي لم يستطع حتَّىٰ دراسة التحدّيات الاجتماعيَّة والثقافيَّة والحضاريَّة للمسلمين في ضوء الاتِّجاه الظاهراتي والتاريخي والحضاري للمسلمين؛ لأنَّه إنَّما قد اتَّجه إلىٰ قراءة «الأنا» بمنظار «الآخر».
(255)لقد عمد المفكِّر المصري المعاصر حسن حنفي إلىٰ تقديم مشروعه القائم علىٰ فكرة التراث والتجديد من أجل التغلُّب علىٰ التحدّيات الناشئة من مواجهة الإسلام مع التجديد والحداثة. وقد قدَّم مشروعه الفكري ضمن حقول ثلاثة، وهي: حقل إعادة صياغة أو تجديد التراث الإسلامي، وحقل معرفة الغرب، وحقل التعرُّف علىٰ المسائل المتعلِّقة بواقع المسلمين الراهن. وكما لاحظنا، فإنَّنا قد تناولنا أفكاره في الحقلين الأوَّلين، حيث تمَّ الاهتمام في هذه الدراسة بالخلفيّات التي أدَّت إلىٰ تبلور المنظومة الفكريَّة لحسن حنفي أوَّلًا، ثمّ تناولنا بعد ذلك مبانيه الفكريَّة، لنواصل البحث حول أفكاره ضمن ثلاثة حقول، وهي:
1. حسن حنفي وعلم الاستغراب.
2. حنفي و التراث الإسلامي.
3. حنفي وتجديد العلوم الإسلاميَّة.
إنَّ النسبيَّة، وظاهراتيَّة هوسِرْل، ومذهب المنفعة، ونفي القداسة، والنزعة الإنسانيَّة أو الإنسويَّة، والاتِّجاه العلماني، والنزعة التاريخيَّة والحضاريَّة، هي مجموعة المفاهيم التي تُشكِّل المباني النظريَّة في هذا المشروع الفكري. إنَّ حنفي فيما يتعلَّق بحقل الاستغراب، علىٰ الرغم من تأكيده علىٰ ضرورة التعرُّف علىٰ الغرب من الزاوية الذاتيَّة، وإعادة الغرب إلىٰ حدوده الطبيعيَّة، إلَّا أنَّه، مثل الكثير من المفكِّرين، قد أُصيب بالاستغراب المقلوب.
إنَّ حنفي مؤمن بتجديد التراث الإسلامي، بيد أنَّه مدين في ذلك إلىٰ التفكير الغربي، حيث يتَّبع أُسلوبًا جديدًا في عصرنة الدِّين والتجديد والإبداع
في الفكر الدِّيني. إنَّه لا يمتلك وضوح وصراحة المفكِّرين الغربيِّين في تعرُّضه لنفي الدِّين، ولا يدافع عن الدِّين في إطار الأُصول والمناهج الدِّينيَّة المتَّبعة، بل يرىٰ التراث الإسلامي أمرًا تاريخيًّا وحضاريًّا، ويدَّعي تجديده وإصلاحه بما يتناسب مع المرحلة المعاصرة واحتياجاتها.
وفي هذا الاتِّجاه ينظر إلىٰ الدِّين بوصفه أمرًا فاقدًا للبيان الناطق والواضح، بل وحتَّىٰ فاقدًا للذات، وإنَّ الشرائط والظروف الحضاريَّة والتفاسير المختلفة أو المتعارضة، هي التي تعمل علىٰ بلورة الفكر الدِّيني. بل إنَّ حنفي يُخفض التراث الإسلاميَّة إلىٰ مستوىٰ الظاهرة التاريخيَّة التي هي حصيلة الشرائط الاجتماعيَّة المتغيِّرة. إنَّ الرؤية التاريخيَّة لحسن حنفي تُؤدّي إلىٰ نفي القداسة وإثبات النسبيَّة، وبالتالي ضرورة التغيير في التراث الإسلامي من دون أيِّ مقاومة اجتماعيَّة تُذكَر. إنَّ هذه الرؤية تشير إلىٰ نوع من المعرفة الإسلاميَّة المقلوبة التي تتقبَّل جميع أنواع التغيير في الرؤية الإسلاميَّة، طبقًا لمقتضىٰ المفاهيم والأفكار السائدة في العالم الغربي، ولن تتوقَّف حتَّىٰ تصل إلىٰ إحداث التغيير حتَّىٰ في أهمّ الأُصول الإسلاميَّة المتمثِّلة بالتوحيد والنبوَّة والإمامة والمعاد.
(257)- أكبريان، رضا، مناسبات دين وفلسفه در جهان اسلام (روابط الدِّين والفلسفة في العالم الإسلامي)، طهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، ط 1، 1386 ه ش.
- اميني نجاد، علي، آشنايي با مجموعه عرفان اسلامي (معرفة مجموعة العرفان الإسلامي)، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، ط 1، 1387ه ش.
- بالمر، ريتشارد، أ، علم هرمنوتيك (علم الهرمنيوطيقا)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: محمّد سعيد حنائي كاشاني، طهران، انتشارات هرمس، ط 1، 1377 ه ش.
- بوخنسكي، أ. أم، فلسفه معاصر أروپايي (الفلسفة الأوروبية المعاصرة)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: شرف الدِّين الخراساني، طهران، انتشارات علمي وفرهنگي، ط 2، 1379 ه ش.
- جاودان، محمّد، «نقدي بر «از نقد سند تا نقد متن»»، فصليَّة: علوم حديث، العدد: 21، خريف عام 1380ه ش، وكذلك العدد: 23، ربيع عام 1381ه ش، ص 82 ـ 102.
- جعفريان، رسول، «نگاهي به ادوار تمدن اسلام» (إطلالة علىٰ مراحل الحضارة الإسلاميَّة)، المنشور في: كتاب ماه تاريخ وجغرافيا، السنة التاسعة (شهري: شهريور ومهر)، سنة 1385ه ش، صص 11-6
- جمادي، سياوش، زمينه وزمانه پديدارشناسي (أرضيّة وتاريخ الظاهراتيَّة)، طهران، ققنوس، 1378ه ش.
- جوادي الآملي، عبدالله، شريعت در آيينه معرفت (الشريعة في مرآة المعرفة)،
طهران، مركز نشر فرهنگي رجاء، ط 1، 1372ه ش.
- ــــــــــ ، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني (منزلة العقل في هندسة المعرفة الدينيَّة)، قم، مركز نشر إسراء، ط 1، 1386ه ش.
- جيلسون، إتيان، نقد تفكر فلسفي غرب (نقد التفكير الفلسفي في الغرب)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: أحمد أحمدي، طهران، سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1380 ه ش.
- ــــــــــ ، روح فلسفه قرون وسطى (جوهر فلسفة العصور الوسطىٰ)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: ع. داودي، طهران، نشر شركة انتشارات علمي وفرهنگي، ط 2، 1370ه ش.
- حنفى، حسن، من العقیدة الى الثورة، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشـر، ط1، 1988م.
- ــــــــــ ، هموم الفكر والوطن، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1998م.
- ــــــــــ ، «از نقد سند تا نقد متن» (من نقد السند إلىٰ نقد المتن)، فصليَّة: علوم الحديث، الأعداد من: 15 إلىٰ 21، المقالة الرابعة.
- ــــــــــ ، «انديشه وتمدن اسلامي ومباحثي پيرامون آنها» (الفكر والحضارة الإسلاميَّة وأبحاث حولها)، فصليَّة علوم إنساني، العدد: 2، صيف، 1379 ه ش، صص44-25.
- ــــــــــ ، «تاريخمندي دانش كلام» (تاريخيَّة علم الكلام)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: محمّد مهدي خلجي (ترجمة حواريَّة عن كتاب: هموم الفكر والوطن، ج 1)، مجلَّة نقد ونظر، السنة الثالثة، العدد الأوَّل، شتاء عام 1375 ه ش،
صص 57-37.
- ــــــــــ ، «قم تسأل والقاهرة تجيب»، حوار مع حسن حنفي، في مجلَّة: قضايا إسلاميَّة، العدد: 5، 1418ه، صص 98-63.
- ــــــــــ ، التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)، أ، بيروت، المؤسَّسة الجامعيَّة للدراسات والنشر والتوزيع، ط 4، 1992م.
- ــــــــــ ، التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم، ب، بيروت، المؤسَّسة الجامعيَّة للدراسات والنشـر والتوزيع، ط 4، 1412ه.
- ــــــــــ ، الدِّين والثورة في مصر: الأُصولية الإسلاميَّة، القاهرة، مكتبة مدبولي.
- ــــــــــ ، الدِّين والثورة في مصـر، الدِّين والتحرُّر الثقافي، القاهرة، مكتبة مدبولي.
- ــــــــــ ، في الفكر الغربي المعاصر، بيروت، المؤسَّسة الجامعيَّة للدراسات والنشـر والتوزيع، ط 4، 1410 ه.
- ــــــــــ ، قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، القاهرة، دار الفكر العربي.
- ــــــــــ ، مقدّمة في علم الاستغراب، بيروت، المؤسَّسة الجامعيَّة للدراسات والنشر والتوزيع، ط 1، 1412ه.
- ــــــــــ ، من النصِّ إلىٰ الواقع (محاولة لإعادة بناء علم أُصول الفقه)، بيروت، دار المدىٰ الإسلامي، ط 1، 2005 م.
- ــــــــــ ، وغيره من المؤلِّفين، ميراث فلسفي ما (تراثنا الفلسفي)، إعداد: فاطمة گوارايي، طهران، نشر ياد آوران، ط 1، 1380 ه ش.
- ديورانت، ويل، تاريخ تمدُّن (قصَّة الحضارة)، طهران، انتشارات آموزش انقلاب إسلامي، ط 3، 1370 ه ش.
- الرفاعي، عبد الجبّار، قضایا إسلامیة معاصرة، الاجتهاد الكلامی، إعداد: عبدالجبار الرفاعي، دار الهادي، ط1، 1423ه.
- روجيه، فيرنو، وفال، جون وآخرون، نگاهي به پديدارشناسي وفلسفههاي هست بودن (رؤية إلىٰ الظاهراتيَّة وفلسفات الكينونة)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيّة: يحيىٰ مهدوي، طهران، انتشارات خوارزمي، ط 1، 1372 ه ش.
- زيبائي نجاد، محمّد رضا، تاريخ وكلام مسيحيت (التاريخ والكلام المسيحي)، قم، دفتر نشر معارف، ط 1، 1375ه ش.
- سولومون، روبرت، ك.، فلسفه اروپایي از نيمه دوم قرن هجدهم تا واپسين دهه قرن بيست (الفلسفة الأوروبيّة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلىٰ نهاية القرن العشرين)، ترجمه محمّد سعید حنایى كاشانى، طهران، مؤسّسة قصیدة، ط1، 1379 ه ش.
- صدري، أحمد، مفهوم تمدن ولزوم احياى آن در علوم اجتماعى (مفهوم الحضارة وضرورة إحيائها في العلوم الاجتماعيَّة)، طهران، مركز بين المللي گفتگوى تمدنها، ط 1، 1380ه ش.
- طباطبایى سیّد محمّد حسین، قرآن در إسلام، قم، دفتر انتشارات إسلامى، ط8، 1375 ه ش.
- عدالت نژاد، سعید، نقد و بررسىهایى درباره اندیشههاى نصر حامد ابوزید، ناشر مشق امروز، ط1، 1380 ه ش.
- كابلستون، فردریک، تاريخ فلسفه (تاريخ الفلسفة)، ج 1، طهران، انتشارات سروش، ط 2، 1368 ه ش.
- ــــــــــ ، تاريخ فلسفه (تاريخ الفلسفة)، ج 4، طهران، انتشارات علمي
فرهنگي، سروش 1368 ه ش.
- كرد فيروزجائي، يار عليّ، چنين گفت نيتشه (هكذا تكلَّم نيتشه)، طهران، انتشارات كانون انديشه جوان، ط 1، 1386ه ش.
- لاسكيم، ديفد، تفكر در دوره قرون وسطى (التفكير في مرحلة العصور الوسطىٰ)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: محمّد سعيد حنائي كاشاني، طهران، مؤسَّسة قصيدة، ط 1، 1380 ه ش.
- مجتهدي، كريم، فلسفه در قرون وسطى (الفلسفة في العصور الوسطىٰ)، طهران، انتشارات أمير كبير، ط 1، 1375 ه ش.
- معرفت، محمّد هادي، التمهيد في علوم القرآن، قم، مؤسَّسة النشر الإسلامي، 1416ه.
- نصر، سيد حسين، سنت عقلاني اسلامي در إيران (التراث العقلاني)، طهران، قصیده سرا، ط 1، 1383 ه ش.
- ــــــــــ ، وأوليف ليمان، تاريخ فلسفه اسلامي (تاريخ الفلسفة الإسلاميَّة)، ج 3، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: مجموعة من المترجمين، طهران، انتشارات حكمت، ط 1، 1386ه ش.
- هوسرل، إدموند/ هايدگر، مارتين، ياسبرس، كارل وغيرهم، فلسفه وبحران غرب (الفلسفة وأزمة الغرب)، ترجمه إلىٰ اللغة الفارسيَّة: رضا داوري، ومحمّد رضا جوزي وپرويز ضياء شهابي، طهران، انتشارات هرمس، ط 2، 1382 ه ش.
- ولايتي، علي أكبر، پويايي فرهنگ وتمدن اسلام وايران، ج 1، طهران، نشـر مركز چاپ وانتشارات وزارت أمور خارجه، ط 4، 1384 ه ش.
حسن عبدي
يُعدّ حسن حنفي من المفكّرين المعاصرين الذين عالجوا، بزعمهم، مشكلات العالم الإسلامي والعربي، وقد صنّف أهمّ مشكلة في العالم الإسلامي والعربي في إطار التنسيق بين التراث والتجديد، كما يمكن تصنيف هذه المشكلة في إطار الشرخ بين النظر والعمل. إنَّ التبويب الجديد يساعد على فهم أبعاد جديدة من تفكير حسن حنفي. يرى حسن حنفي أنَّ هناك أربعة عناصر لتبلور الشرخ بين النظر والعمل، وهي عبارة عن:
أ) عدم الالتفات إلى التجربة الحيّة.
ب) التخلّف العلمي.
ج) عبادة الأشخاص.
د) الاغتراب.
وفي المقابل فإنّه يشير إلى أربعة طرق للتغلّب على «الانفصال بين النظر والعمل»، وهي عبارة عن:
أ) التدوين الأيديولوجي.
ب) إعادة قراءة السنة.
ج) إعادة قراءة العقل.
د) الديالكتيك بين النظر والعمل.
إنَّ الدراسة النقديّة لرؤية حسن حنفي تحكي عن وجود بعض المشكلات والصعوبات في رؤيته. وإنَّ بعض هذه الصعوبات عبارة عن:
أ) نفي أصول التراث.
ب) نفي الواقعيّة.
ج) النزعة الإيمانيّة.
د) عدم جدوائيّة طرق الحلّ الموجودة.
ه) الثنائيّة.
و) فقدان المنهج الجامع.
ز) فقدان التحقيق العميق.
ح) وجود بعض التهافتات في رؤية حسن حنفي.
يبدو أنَّ التحاور والتباحث حول آراء المفكّرين المعاصرين، يمثّل واحدًا من ضرورات الازدهار والتقدّم في العالم الإسلامي؛ وذلك لأنَّ هذا الأسلوب سوف يوضح مدى تطابق أساليب ومناهج المفكّرين مع الحقائق والواقعيّات، وما هو مدى بُعدها عنها.
(264)لا شكَّ في أنَّ حسن حنفي (1935 ـ 2021 م) يُعدّ واحدًا من المفكّرين البارزين في العالم العربي. وقد عمد ـ من خلال التركيز على مشكلات العالم الإسلامي والعربي إلى بحث هذه المشكلات. ومن خلال الرجوع إلى أعماله ومؤلّفاته يمكن العثورعلى قائمة بمشكلات العالم الإسلامي والعربي حسب رأیه، وهي مشكلات من قبيل: التكفير، والبدع، وانعدام العدالة الاجتماعيّة، وانعدام الحريّة الفكريّة، والتخلّف في العلم والتكنولوجيا، والحكّام المستبدين، وتفشّي الرأسماليّة، والخطر الصهيوني، وما إلى ذلك. ثمّ سعى إلى تحديد المشكلة الأهمّ من بين المشكلات العديدة في العالم الإسلامي والعربي، وعمد ـ من خلال التركيز على هذه المشكلة ـ إلى بحث مختلف أبعادها، وتقديم الحلّ الأساسي لها. فهو يرى أنَّ المشكلة الأصليّة والأهمّ من بين جميع المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي والعربي، هي مشكلة «عدم التناغم بين التراث والتجديد». ومن خلال التركيز على مؤلّفات حسن حنفي، يمكن تقرير التعرّف على المشكلة وتقديم الحلّ على أساس معضلة «الشرخ بين النظر والعمل». توضيح ذلك أنَّ الإنسان يمتلك أبعادًا مختلفة، وأنَّ البعدين المهمّين من الأبعاد الوجوديّة للإنسان، عبارة عن النظر والعمل. إنّ المراد من «النظر» هي المدركات التي يصل إليها الإنسان بوساطة الاستفادة من قواه الداخليّة، والمراد من «العملن» هو التجلّي الخارجي للمدركات التي تتّضح في إطار السلوك. إنَّ من بين الأبحاث المهمّة التي شغلت أذهان
المفكّرين منذ القدم، هو بحث العلاقة بين النظر والعمل. وإنَّ مساحة وعمق الأبحاث المطروحة في هذا المجال تبلغ حدًّا بحيث تبلورت في ضوئها مختلف الحقول العلميّة الناظرة إلى بحث «النظر» و«العمل». من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ الإبستمولوجيا، وعلم النفس الإدراكي، وعلم الاجتماع المعرفي، ومؤخرًا العلوم المعرفيّة، هي بعض العلوم العلميّة، تعمل على دراسة الأبعاد المختلفة من «النظر»، وأنَّ علم النفس، والعلوم التربويّة، والعلوم السياسيّة، والإداريّة ـ بدورها ـ تعمل على دراسة بعض الحقول العلميّة التي تتعرّض إلى بحث الأبعاد المختلفة من «العمل». وإنَّ من بين المفكّرين الذين تعرّضوا لبحث مسألة العلاقة بين النظر والعمل، هو الدكتور حسن حنفي. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ مسألة النظر والعمل ـ على الرغم من عدم الاهتمام بها في الفكر والتراث الإسلامي ـ تحظى بأهمّية كبيرة للغاية، وقد تعرّض إلى بحث هذه المسألة بشكل آخر في مختلف أعماله ومؤلّفاته. والآن، فإنَّ السؤال الأوّل الذي يتمّ طرحه، يقول: ما هو رأي حسن حنفي بشأن العلاقة بين النظر والعمل؟
إنَّ المراد من الفعل والعمل هو الشيء ذاته الذي يُعدّ في اللغة والعُرف عملًا وفعلًا أيضًا. إنَّ الأفعال تنقسم ـ من وجهة نظر حسن حنفي ـ إلى قسمين، وهما: الأفعال الجوارحيّة، والأفعال الجوانحيّة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ النظر
والعمل ـ من وجهة نظر حسن حنفي ـ ثنائيّة ناظرة إلى مطلق الإدراك والنظر ومطلق العمل والسلوك الخارجي، ولا تعني بالضرورة ثنائيّة «النظر» بمعنى مجموعة من القضايا المرتبطة والمنسجمة الناظرة إلى مسألة علميّة، ولها منهج خاصّ ـ و«العمل» بمعنى الفعل الإنساني أو الاجتماعي. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بوجوب أنْ يكون هناك تناغم بين النظر والعمل. وإنَّ لكلٍّ من النظر والعمل بعض القواعد والأصول. لقد تمّ الاهتمام في التراث الإسلامي بأصول وقواعد النظر وأصول وقواعد العمل، وإنَّ مختلف العلوم الإسلاميّة قد تكفّلت ببيان هذه الأصول والقواعد. من ذلك على سبيل المثال: أنَّ الأصول المرتبطة بالنظر قد تمّ بيانها في علم «أصول الدين»، وأنَّ الأصول المرتبطة بالعمل قد تمّ بيانها في علم «أصول الفقه». وبعبارة أخرى: إن َّعلم أصول الدين ناظر إلى القواعد النظريّة ومباني المعتقدات الدينيّة، في حين أنَّ علم أصول الفقه ناظر إلى القواعد الناظمة للسلوك والعمل. وعندما يصل الدور إلى علم الفقه، سوف نواجه علمًا عمليًّا بالكامل. إنَّ العلاقة بين علم أصول الدين وبين علم أصول الفقه ـ من وجهة نظر العلماء المسلمين ـ على هذه الشاكلة، وهي أنَّه في علم أصول الدين يتمّ العمل على بيان مجموعة من القواعد اليقينيّة والمشتملة على محتويات نظريّة، ثمّ يتمّ العمل في علم أصول الفقه على بيان مجموعة من القواعد الظنيّة الناظرة إلى كيفيّة السلوك والعمل. وبطبيعة الحال، فقد تمّ السعي إلى إقامة القواعد الظنيّة لعلم أصول الفقه على القواعد اليقينيّة لعلم أصول الدين، على
الرغم من بقاء نمط العلاقة بين هذين العلمين على ما هو عليه من الغموض والإبهام.والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي العلاقة القائمة بين النظر والعمل؟ إنَّ الجواب الذي يقدّمه حسن حنفي عن هذا السؤال، هو القول بأنَّ النظر والعمل «وجهان لعملة واحدة». وقد عمد في بعض الموارد ـ من خلال الإشارة إلى كلام محمّد عبده القائل: «ما أكثر الكلام وأقلّ العمل» ـ إلى التصريح بأنَّ النظر والعمل يجب أنْ يكونا مقترنين. وقد ذهب حنفي إلى الاعتقاد بإمكانيّة أنْ نرصد أربعة أبعاد للشعور، وهي عبارة عن: المعرفة، والتصديق، والإقرار، والعمل. ومن بين هذه الأبعاد الأربعة يعدّ بُعد المعرفة والتصديق من الأبعاد الداخليّة للشعور، ويُعدّ بُعد الإقرار والعمل من الأبعاد الخارجيّة للشعور. وعلى هذا الأساس، فإنَّ كلًّا من النظر والعمل من أبعاد «الشعور»، وليس الأمر كما لو أنَّ النظر والعمل متباينان فيما بينهما أو متباعدان من الأساس. وهنا يظهر سؤال آخر: هل كان النظر والعمل متناغمان معًا في تاريخ الحضارة الإسلاميّة؟ يرى حسن حنفي أنَّه على الرغم من أنَّ التناغم بين النظر والعمل كان موجودًا في بداية ظهور الإسلام، بيد أنَّ شرائط وظروف العمل قد تغيّرت في المرحلة الجديدة، في حين يسعى الأشخاص إلى التأكيد على الرأي القديم. مع أنَّه يجب أنْ يتحوّل النظر بما يتطابق مع موقعيّة العمل. ومن هنا فقد ظهر
نوع من عدم الانسجام بين النظر والعمل، وبعبارة أخرى: بين العقل النظري والعقل العملي. وقد اعتبر الدكتور حسن حنفي غايته الرئيسة من التفكير، هي العثور على طريقة لرفع الشرخ بين النظر والعمل، وبعبارة أخرى: إيجاد التناغم والانسجام بين العقل النظري والعقل العملي. ولكنْ لكي نزيل هذا الشرخ، يجب التعرّف قبل كلّ شيء على أسباب إيجاد الشرخ بين النظر والعمل. وعلى هذا الأساس، فإنَّ السؤال الذي يتمّ طرحه هنا هو: ما هي أسباب الشرخ بين النظر والعمل؟
لم يعمل حسن حنفي على دراسة أسباب الانفصال بين النظر والعمل بشكل متمركز، ولذلك يتعيّن علينا في الوصول إلى رؤيته في هذا الشأن أنْ نبحث عن ذلك في مجموع أعماله وكتبه. ومن خلال هذا البحث والتتبّع يتّضح أنَّه يتحدّث عن أربعة أسباب بوصفها علل وعوامل تبلور الانفصال بين النظر والعمل.
إنَّ السبب الأوّل الذي يقول حسن حنفي إنَّ له الدور الرئيس في حدوث الانفصال والشرخ بين النظر والعمل، هو عدم الاهتمام بالتجربة الحيّة. يذهب حسن حنفي إلى وجوب جعل الحاجات الزمنيّة هي الأصل والمبنى من أجل إيجاد أيّ نوع من أنواع المناغمة والمواءمة بين النظر والعمل.
وإنَّ هذه الاحتياجات يتمّ التعرّف عليها من خلال التجارب الحيّة. إنَّ هذه الاحتياجات لا تنحصر بالاحتياجات الفرديّة والشخصيّة فقط، بل هي احتياجات اجتماعيّة في الأعمّ و الأغلب. بيد أنَّ المسألة هي أنَّه قلّما نجد عالمًا قد استفاد في آثاره وكتبه من التجربة. نعم يمكن القول إنَّ العلماء الذين استفادوا من التجارب، إنَّما ذكروا فيها خصوص التجارب الصوفيّة، في حين أنَّ هذا النوع من التجارب يخلو من جميع المضامين الاجتماعيّة. نواجه أحيانًا في مؤلّفات حسن حنفي مصطلح روح العصر، ومراده من روح العصر هو تجارب الحياة. وهو يرى أنَّ أذهان الناس تنساق نحو الأمور المتناغمة مع العصر. ومن هنا فإنَّ علم التوحيد إذا لم يتمكّن من التماهي مع حاجة العصر، فإنَّه سيخرج من حيّز اهتمام الناس وتعلّقهم. وكما يتّضح من هذا الكلام، فإنَّ «الدافع» الأصلي لحسن حنفي من أجل إيجاد التماهي والتناغم بين النظر والعمل، هو العمل على توجيه «أذهان الناس» نحو التناغم والانسجام مع روح العصر، وإنَّ حاجة العصر أمر متغيّر وتاريخي. والآن لا بدّ من بيان هذا التساؤل القائل: ما هي الأسباب التي أدّت إلى تجاهل التجارب الحيّة من قبل المفكّرين الإسلاميين وتبعًا لهم عموم المجتمعات الإسلاميّة؟ وجواب الدكتور حسن حنفي عن هذا السؤال، هو باختصار: «التخلّف العلمي».
يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ التخلّف العلمي يمثّل واحدًا من الأسباب المهمّة في حدوث الشرخ بين النظر والعمل. ومراده من التخلّف العلمي هو عدم التطوّر والتقدّم في مختلف الحقول العلميّة بالمقارنة مع البلدان المتطوّرة. لا يكتفي حسن حنفي في كتبه وأعماله بالاقتصار على ذكر هذا العامل فقط، وإنَّما يسعى كذلك إلى بيان أرضيّة وجذور تبلور هذا التخلّف أيضًا. وفي ذلك يذهب حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ سبب تخلّف المجتمعات الإسلاميّة يكمن في تقليد هذه المجتمعات لأسلافها، وعدم سعيها إلى مواكبة مقتضيات العصر. يرى حسن حنفي أنَّه على الرغم من أنَّ الإسلام هو دين خير أمّة أخرجت للناس، إلّا أنَّ هذه الأمة قد تحوّلت إلى مجتمع يسوده التخلّف ويرزح تحت نير الاستعمار. ومن هنا يجب العمل في الخطوة الأولى على إصلاح العلوم. ويرى حسن حنفي أنَّ عمليّة إصلاح العلوم يجب أنْ تبدأ من إصلاح العلوم الإسلاميّة. بيد أنّنا نواجه الكثير من المشكلات في بحث هذه العلوم، من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ انفصال علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، قد أدّى إلى مخاطر في العالم المعاصر. ومن بين هذه المخاطر، هو ابتعاد العقائد عن الاستدلال واكتسابها صبغة عاطفيّة. ومن هنا لا يعود بمقدور علم أصول الدين أنْ يوفّر الأرضيّة اللازمة للقيام بالعمل. وهذا الأمر بدوره أدّى إلى غلق باب الاجتهاد؛ إذ أوجب هذا التصوّر القائل بأنَّ جميع الأحكام الفقهيّة لها مبدأ واحد وثابت. ومن هنا فإنَّ هذا الأمر قد فاقم من تصوّر أنَّ شرائط
الزمان والمكان لا تنعكس على الأحكام الفقهيّة، وبذلك سوف يحدث شرخ وانفصال بين العقيدة والمصلحة. ونتيجة لذلك تصبح الأرضيّة معدّة لحلول العلمانيّة بوصفها بديلًا عن علم أصول الدين. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ علم أصول الدين يتكفّل ببيان العقائد والدفاع عنها، في حين أنَّ الكثير من الكتب الكلاميّة قد تمّ تدوينها في إطار تقليد النصوص السابقة. كما ذهب حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ العلماء المتقدّمين قد ارتكبوا هذا الخطأ المتمثّل في جعلهم مسائل علم أصول الدين مسائل نظريّة وذهنيّة بحتة؛ بحيث أنَّها من جهة لا تكون لها صلة بمقام العمل، وتتحوّل من جهة أخرى إلى مسائل فرديّة وداخليّة، وهذا الأمر بدوره يؤدّي إلى النفاق والانفصال الذهني والفكري، في حين أنَّ أصل التوحيد ـ على سبيل المثال ـ يحتوي على أبعاد نظريّة وعلى أبعاد عمليّة أيضًا. وعلى هذا الأساس، حتّى أصل «التوحيد» ـ الذي يبدو للوهلة الأولى أصلًا نظريًّا بحتًا ومجرّدًا من جميع أنواع الأبعاد العمليّة ـ يحتوي من وجهة نظر حسن حنفي على أبعاد نظريّة وعلى أبعاد عمليّة أيضًا. ويرى حسن حنفي أنَّه بعد توقّف البحث العلمي حول أصول الدين، تشكّل علم العقائد الذي كان ناظرًا إلى التعاليم والمفاهيم الدوغمائيّة والجزميّة. إنَّ هذه المفاهيم الدوغمائيّة غير الثابتة كانت تعدّ معيارًا للعمل، ومن هنا كانت تنشد الثبات في العمل. وقد ذهب إلى القول بأنَّ العلماء في
بعض الموارد قد جعلوا هذا البحث نظريًّا، بحيث عمدوا إلى تحويله إلى تاريخ للعقائد المقارنة، وبادروا إلى مقارنة العقائد الإسلاميّة إلى عقائد سائر الأديان الأخرى. وقال في هذا الشأن:
«وکثير من المؤلّفات لها شروح وحواش، وقد ساد هذا اللون من التأليف في العصور المتأخّرة حين جدب الفکر؛ لانفصاله عن الواقع وکرّر ذاته وعاش على نفسه، کما تأکل الرأس الذيل. في النهاية يوافق کلّ شارح المؤلّف الأصلي ويزيد عليه من الحجج أو يضيف إليه من المادّة التاريخيّة، أو يعبّر عن نفس الفکرة في عبارة أخرى، دون أنْ ينقد أو يعدّل أو يغيّر أو يرفض أو يبدأ من جديد».
وعلى الرغم من أنّه يقبل بوجود هذه التغييرات الطفيفة في هذه الطائفة من النصوص، وذلك ـ بطبيعة الحال ـ في إطار الانتقادات القليلة جدًا:
«قد تحتوي بعض الشروح والملخّصات على بعض الانتقادات الجزئيّة، ولکنَّها لا تغيّر من المضمون شيئًا».
كان حسن حنفي يعتقد أنَّ القدماء كانوا على علم بـ «الكم»، وأنَّ المؤلّفين الجدد هم الذين عمدوا إلى تجاهل الكمّ، فوقعوا في التطويل المملّ أو
الإيجاز المخلّ.
يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الأبحاث الكلاميّة في حدّ ذاتها
واحدة من موانع العمل؛ وذلك لأنَّ الأدلّة التي يتمّ توظيفها في الدفاع عنها أدلّة جدليّة، ويمكن استعمالها في إثبات المتناقضين في وقت واحد، تبعًا لغرض المستدلّ. يرى حسن حنفي أنَّ علم الكلام بصدد الدفاع عن العقائد، وأنَّ الذي يُعدّ عقيدة ليس سوى أداة بيد المصلحين الاجتماعيين لغرض إحداث التغيير في المجتمع، من دون أنْ يكون لديهم تقرير بشأن الواقعيّة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ رؤيتنا إلى العقائد يجب أنْ تكون ـ من وجهة نظر حسن حنفي ـ رؤية آليّة، وأنْ تكون في إطار توفير الأرضيّة اللازمة لإحداث التغيير الاجتماعي. ومن هنا نرى أنَّ منهج علم أصول الدين ـ عند حسن حنفي ـ أوّلًا: ليس منهجًا يؤدّي إلى اكتشاف الحقيقة والواقع. يرى حنفي أنَّه لا يمكن البحث عن ذات الله في علم أصول الدين؛ وذلك لأنَّ ذات الله مطلقة، في حين أنَّ أفهام الناس محدودة، وإنَّ الأسلوب الشهودي الذي يتمّ ذكره في العرفان والتصوّف، لا مكان له في علم أصول الدين. إنَّ علم الكلام لا يفيد شيئًا سوى الظن، ومن هنا لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس علم أصول الدين. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الطريق الوحيد للبحث حول الله في علم أصول الدين، هو الإيمان فقط. وثانيًا: إنَّ الدكتور حسن حنفي من خلال بيان ضرورة إعادة النظر في العلوم الإسلاميّة يسعى إلى العثور على الأيديولوجيا؛
وذلك لأنَّه بصدد الوصول إلى علم يؤدّي إلى الحركة الاجتماعية، وهذا العلم هو علم أصول الدين أو الأيديولوجيا الإسلاميّة التي يمكنها العمل على توجيه دفّة الحركة الاجتماعيّة في قبال الأيديولوجيات الموجودة الأخرى. وثالثًا: إنَّ حسن حنفي يعمل من أجل تطوير أهدافه وغاياته إلى التفريق بين الدين والتفسير الديني، ويرى في الأساس أنَّه لا يمكن الوصول إلى الدين ذاته حتّى يتم الدفاع عنه. وعلى هذا الأساس، يذهب الدكتور حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ جهود المتكلّمين وغيرهم، إنَّما كانت تصبّ في الدفاع عن تفسير خاصّ للدين، وهذا الأمر هو الذي أدّى إلى تخلّف المجتمعات الإسلاميّة. والآن يطرح هذا السؤال نفسه ويقول: ما هو السبب الذي أدّى إلى تعرّض المفكّرين الإسلاميين ـ وتبعًا لهم المجتمعات الإسلاميّة ـ إلى التخلّف العلمي؟ وجواب الدكتور حسن حنفي عن هذا السؤال هو باختصار: «عبادة الأشخاص».
العامل الثالث: عبادة الأشخاص
إنَّ من بين الأسباب والعوامل المهمّة في حدوث الشرخ والانفصال بين النظر والعمل، هو عامل «عبادة الأشخاص». ويرى الدكتور حسن حنفي أنَّ بعض المسلمين يتطرّفون في هذا الشأن بحيث يبزّون نظراءهم من المسيحيين في ذلك:
«کثيرًا ما نقف في حياتنا المعاصرة على الأشخاص ونترک أفکارهم، ونتمسّك بالأفراد ونترک رسالاتهم».
وبطبيعة الحال، فإنَّ الدكتور حنفي يسعى من وراء هذا الكلام إلى التأكيد على تفسيره الخاطئ لمفهوم «الشفاعة»، إلّا أنَّ أصل كلامه يُشير إلى نقطة صحيحة، وهي أنَّ اهتمامنا بالأشخاص ينبغي أنْ لا يكون على أساس التضحية برسالاتهم وأهدافهم. يذهب الدكتور حسن حنفي إلى القول بأنَّ الإنسان يغفل عن النظر في بعض الأحيان، حيث يتبع الهوى أو التقليد أو المصلحة طلبًا للرئاسة أو سعيًا وراء منصب أو إيثارًا للسلامة والسكون، و... . إنَّ هذا الكلام يُشير إلى أنَّه يرى أنَّ منشأ التقليد هو نوع من عبادة الأشخاص. والآن يطرح هذا السؤال نفسه: ما هو السبب الذي أدّى بالمفكّرين الإسلاميين ـ وتبعًا لهم المجتمعات الإسلاميّة ـ إلى الابتلاء بآفة عبادة الأشخاص؟ والجواب الذي يقدّمه حسن حنفي عن هذا السؤال هو: «الاغتراب».
إنَّ من بين أسباب الشرخ والانفصال بين النظر والعمل هو «الاغتراب»؛ إذ يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ الاغتراب هو في الأساس نوع من الانفصال بين النظر والعمل. وقد قام في كتابه (الهويّة) إلى مناقشة وتحليل مختلف أبعاد «الاغتراب» بالتفصيل. وقد تعرّض في البداية إلى تقرير آراء المفكّرين الغربيين في هذا الشأن، ثمّ سعى بعد ذلك إلى بيان تحليله لهذه المسألة. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ واحدًا من أبعاد الاغتراب هو الاختلافات
الفكريّة بين العلماء المسلمين. ويرى أنَّ سبب الاختلاف الفكري بين الكثير من الجماعات في الفكر الإسلامي، يكمن في اختلاف مصادر المعرفة. يرى حسن حنفي أنَّ الهويّة هي أساس المواطنة، والوعي الذاتي، والثقة بالنفس، والإبداع الحضاري. إنَّ العلوم الإسلاميّة ليست من النوع الذي يمنح المواطنين في المجتمعات الإسلاميّة وعيًا ذاتيًّا أو ثقة بالنفس. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ ما نراه في المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة بوصفه من التنظيرات، ويتمّ التعبير عنه بـ «النظريّات الجديدة»، إنَّما هو انعكاس للأفعال تجاه النظريّات السابقة. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ بحسب رأي حسن حنفي في التراث الإسلامي، حيث تمّ أخذ الطبيعة بوصفها أمرًا حادثًا أو عرضًا وممكنًا، وتمّ اعتبارها بوصفها أمرًا خارجًا عن حقيقة الإنسان، لم تؤخذ بوصفها مصدرًا للمعرفة، ولم تبذل جهود للتعرُّف عليها. والآن بعد أنْ تعرّفنا على الأسباب التي تؤدّي إلى تبلور وظهور الشرخ والانفصال بين النظر والعمل، ننتقل إلى التعرّف على الطرق التي ذكرها الدكتور حسن حنفي للخروج من الانفصال بين النظر والعمل. وعلى هذا الأساس، فإنَّ السؤال الذي سوف نبحث عنه يقول: ما هي طرق الحلّ للتغلّب على الشرخ والانفصال بين النظر والعمل؟
يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ مشكلة العالم الغربي والعالم الإسلامي مشكلة مشتركة، ولذلك تكون طرق حلّها مشتركة أيضًا. إنَّ المشكلة الأساسيّة ليست سوى «الشرخ بين النظر والعمل». وفي إطار تقديم حلّ لهذه المشكلة، يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الرؤية اليساريّة في هذا البحث، تقتضي أنْ يكون الإيمان والعمل وجهين لعملة واحدة. وعلى هذا الأساس، لو بحثنا عن طرق للتغلّب على هذه المشكلة، ينبغي لهذا الطرق أنْ توصلنا في نهاية المطاف إلى هذه النقطة. ومن هنا فإنَّ البحث في آثار ومؤلّفات الدكتور حنفي للكشف عن هذه الطرق، يثبت أنَّه قد رصد أربعة حلول للتغلّب على الشرخ والانفصال بين النظر والعمل.
بالنظر إلى أنَّ إقامة أيّ نوع من التناغم بين النظر والعمل يحتاج إلى أيديولوجيّة، وعلى رأس احتياجات العصر هي الحاجة إلى الأيديولوجيا التي يمكنها أنْ تعمل ـ في قبال الأيديولوجيّات الموجودة الأخرى ـ على توجيه الحركة الاجتماعيّة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الحلّ الأوّل للمواجهة مع تحدّي الانفصال والشرخ بين النظر والعمل، يتمثّل في القيام بوضع أيديولوجيّة. وقد سعى الدكتور حنفي في أعماله المختلفة إلى بيان بعض
التوجيهات من أجل وضع الأيديولوجيّة المنشودة له. يذهب حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ جميع الجهود لوضع أيديولوجيّة في إطار تعيين مسار الحركة الاجتماعيّة، يجب أنْ يسير في جهة لا تؤدّي إلى الحركة الدينيّة المحافظة، ولا إلى الحركة العلمانيّة.
إنَّ الحلّ الثاني الذي يرى الدكتور حنفي ضرورة أنْ تكون له السيطرة والسيادة لحلّ هذه المعضلة، هو «الوحدة الاجتماعيّة». إنَّ الأيديولوجيّة التي تمّ وضعها بغية إيجاد التناغم بين النظر والعمل، يجب أنْ تسعى إلى إيجاد الاتحاد الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، فإنَّ علومًا، من قبيل علم الكلام المتداول ـ الذي يؤدّي إلى الاختلاف والتفرقة ويُفضي بالتالي إلى الاختلاف العملي أيضًا ـ لا تحتوي على الظرفيّة اللازمة لوضع الأيديولوجيّة المطلوبة؛ إذ بالنظر إلى أنَّ الاختلاف الفكري والاعتقادي يشكّل مانعًا يحول دون القيام بأيّ نشاط أو عمل سياسي. وقد يؤدّي الاختلاف الفكري إلى اندلاع الحروب وسفك الدماء. يجب العمل على تجنّب جميع أنواع الاختلاف الفكري والاعتقادي. وكما أظهر تاريخ الفكر الإسلامي ـ بدوره ـ أنَّ علم الكلام قد عمل في البداية على إعداد الأرضيّة لظهور الفِرَق الإسلاميّة، ثمّ تحوّل لاحقًا إلى علم يبحث في اختلاف الفِرَق والنِحَل.
للوصول إلى الأيديولوجيّة لا بدّ من الذهاب إلى السنّة. بيد أنَّ مكمن النقطة المهمّة، هو أنَّ السنّة تشتمل على لغة صوريّة لا نرى فيها القدرة على توجيه دفّة الحركات الاجتماعيّة. ومن هنا يجب علينا العمل على إعادة قراءة التراث والسنّة، ولا يكون ذلك إلّا من خلال إعادة النظر في العلوم الإسلاميّة. ولكي ندرك كيفيّة العمل على إصلاح العلوم، يجب التعرُّف أوّلًا على العلوم السابقة. ومن بين العلوم التي عمد حنفي إلى التركيز عليها بغية إيجاد التماهي والتناغم بين العمل والنظر، هو علم أصول الدين. وقد رأى أنَّ علم أصول الدين يجب أنْ يخضع لإعادة النظر على أساس الاحتياجات المعاصرة. إنَّ تدوين علم أصول الدين بما يتناسب والحاجات المعاصرة من شأنه أنْ يعمل على إزالة الفراغ النظري والركود العملي الراهن. إنَّ عمليّة إصلاح علم أصول الدين يتمّ على أساس منهج الاجتهاد، وبذلك يمكن الجمع بين النظر والعمل. وبذلك فإنَّ الاجتهاد هو الكوّة التي تدلّنا على الاحتياجات المعاصرة. إنَّ علم أصول الدين يجب أنْ يكون ناظرًا إلى الاحتياجات المعاصرة، ويرى حنفي أنّنا لن نتقدّم إلّا إذا قمنا بتحويل الإلهيّات إلى إنسانيّات. وعلى هذا الأساس، فإنَّ تحويل الإلهيّات إلى إنسانيّات سوف يكون ـ من وجهة
نظر حسن حنفي ـ أداة لمعرفة الحاجات المعاصرة والإجابة الصحيحة عن تلك الاحتياجات. وعلى أساس هذا الاتجاه يمكن لنا أنْ نواجه «التكفير» الذي كان يشكّل أداة للدفاع عن العقائد بين المسلمين. وما لم يتم العمل على تحويل الإلهيّات إلى إنسانيّات، فسوف تتحوّل العقائد والمعتقدات إلى سلاح لمواجهة الخصوم والمخالفين. ومن هنا يجب أنْ تدخل فيه أبحاث من قبيل: الثورة، والحريّة، والتقدّم، والتغيير الاجتماعي، والمقاومة، والتنمية، والعدالة الاجتماعيّة، والوحدة، والشعب، والتاريخ. وبالنظر إلى عدم وجود ذكر لهذه الموضوعات في السنّة والتراث الإسلامي، فإنَّ لغة السنّة لغة تخلو من هذه المفاهيم. وعليه، ليس هناك من حلّ في البين سوى التوجّه إلى لغة جديدة، إذ إنَّ من بين طرق الوصول إلى التجربة الحيّة هي الاستفادة من اللغة الجديدة؛ لأنَّ لغة التراث ولغة السنّة لغة صوريّة بحتة لم تنعكس فيها المقتضيات الجديدة. وبطبيعة الحال، فإنَّ اقتباس اللغة الجديدة، وإنْ كان شرطًا لازمًا، ولكنّه لا يُعدّ شرطًا كافيًا. إنَّ اللغة الجديدة تعرّفنا على الموضوعات الجديدة وعلى المقتضيات المعاصرة، وبطبيعة الحال فإنَّ مسار الحركة في كلّ واحد من هذه الموضوعات، يجب أنْ يكون بحيث يؤدّي إلى «الثورة». وللقيام بأيّ تغيير، هناك حاجة إلى التنوير الذهني والفكري، وإنَّ أركان التنوير الذهني عبارة عن: العقل، والحريّة، والإنسان، والطبيعة، والمجتمع، والتاريخ.
وبطبيعة الحال، فإنَّ من بين أبعاد الحريّة، هي الحريّة في التفكير. وحيث أنَّ التغيير المنشود للدكتور حنفي هو «التغيير الثوري»، فإنَّ هذه الثورة يجب أنْ تحدث أوّلًا في الذهن. وفيما يتعلّق بتأثير فيلسوفَي عصر التنوير ـ وهما: جان جاك روسّو وفولتير ـ يذهب الدكتور حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّهما قد عملا في البداية على غرس بذور الثورة في أذهان الناس، ثمّ تحقّقت الثورة لاحقًا على أرض الواقع. وعلى هذا الأساس، فإنّه يعتقد أنَّ ما هو المهمّ في البين، هو الانتقال من التغيير إلى الثورة؛ وذلك لأنَّ التغيير الاجتماعي يتمّ على ثلاث مراحل، وهي: التغيير من الوضع الراهن إلى الإصلاح، والتغيير من الإصلاح إلى النهضة، والتغيير من النهضة إلى الثورة. وبالنظر إلى أنَّ كلّ واحد من هذه المحاور الثلاثة أعلاه يحتوي على أبعاد سياسيّة، وأنَّ الهدف الذي ينشده علم أصول الدين ـ بدوره ـ هو إرشاد الأشخاص إلى السلوك والعمل، بل ويمكن القول بأنَّ البُعد السياسي له غالب على سائر الأبعاد الأخرى، ويمكن الادّعاء بأنَّ الذي أدّى إلى الجمع بين النظر والعمل، هو الإسلام السياسي. بيد أنَّ السؤال الأصلي يقول: ما هو العنصر الذي شغل اهتمام الدكتور حسن حنفي من بين عناصر «الاجتهاد»، بحيث أخذ يبحث
فيه عن الجذور الأصليّة لإيجاد التناغم بين النظر والعمل؟ وجواب حنفي عن ذلك هو: «عنصر العقل».
يذهب حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ أيّ تغيير في مسار حركة عمل وسلوك الأشخاص، إنّما تكون من طريق تغيير نظرتهم إلى العالم. ومن هنا فإنّنا من خلال التركيز على الاجتهاد، سوف تكون لنا عودة إلى العقل الذي كنا نستفيد منه في يوم من الأيام، وقد عمدنا إلى التخلّي عنه حاليًّا. عندما يتحدّث حنفي عن العقل، فإنّه يراه متبلورًا فی أفراد البشر، ومن هنا فإنّه يرى العقل واقعًا في حصار الشرائط الزمانيّة والمكانيّة، ويقول في ذلك:
«لکنَّ العقل أيضًا موجود في بيئة معيّنة، وصاحبه ذو مزاج معيّن مرتبط بالأهواء والانفعالات، وتسيّره المصالح الخاصّة والعامّة».
وفي إشارة من حنفي في هذا الشأن إلى رأي الأشاعرة، عمد إلى إثارة هذه المسألة، وهي أنَّ الأشاعرة قد عملوا على إضعاف العقل كثيرًا، ثمّ طرح هذا السؤال القائل: هل يمكن القيام بنهضة في المجتمع على أساس القول بالجبر؟ ومن الواضح أنَّ جواب الدكتور حنفي عن ذلك هو النفي.
يرى حنفي أنَّ القول بالجبر يقضي على الحياة الاجتماعيّة؛ وذلك لأنَّ هذا القول يرفع المسؤوليّة عن كاهل الأشخاص، ولا يحمّلهم مسؤوليّة أعمالهم وأفعالهم. ثمّ أقرّ بعد ذلك بأنّنا طيلة تاريخ الفكر الإسلامي نواجه بعض العلماء الذين توجّهوا نحو العقل، في سعي منهم إلى إيجاد التماهي والتناغم بين الفكر الإسلامي واحتياجات العصر. إنَّ حسن حنفي ضمن إقراره بهذا الأمر، ذهب إلى التصريح بأنَّ بعض العلماء والمؤلّفين ـ من أمثال: محمّد عبده في (رسالة التوحيد) ـ قد عمدوا إلى إصلاح علم الكلام للمزيد من التأكيد على محوريّة الإنسان. إلّا أنَّ حنفي يقترح إصلاح علم أصول الدين على أساس علم أصول الدين الاعتزالي. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الاجتهاد الذي يكون بمنزلة طريقة إيجاد التناغم بين النظر والعمل ـ من وجهة نظر حسن حنفي ـ هو الاجتهاد القائم على أساس «العقل الاعتزالي».
إنَّ تأكيد الدكتور حنفي على أهمّية وموقع النظر، وكذلك أهمّية وموقع العمل؛ بحيث نشاهد فی الظاهر نوعًا من التهافت في كلامه، في حين يمكن العثور على حقيقة الأمر من خلال التدقيق في آثاره. توضيح ذلك أنَّ كلام حسن حنفي قد تحدّث في بعض الموارد بحيث يوحي وكأنَّه لا يرى الأصالة إلّا إلى النظر. فهو يقول: إنَّ الحركات الإصلاحيّة المعاصرة بدلًا من الخوض في
النظر، إنّما تؤكّد على العمل فقط، وهذا من آفات الإصلاح حيث يتمّ التأكيد على العمل بدلًا من إصلاح النظر. كما يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الشخص الذي يؤكّد على العمل دون أنْ يهتمّ بالنظر والأبعاد النظريّة من العمل، يكون بمثابة الوسيلة الصمّاء، ولا يعدو أنْ يكون شخصًا مصابًا بالعمى. وقال في مورد آخر: حيث أنَّ النظر يشكّل أساسًا للعمل، يكون تحصيل النظر لذلك واجبًا. كما وقد أقرّ بأنَّ الاهتمام بالنظر هو الذي يمهّد الأرضيّة إلى تصحيح الأخطاء. ومن ناحية أخرى، يعترف بأنَّ النظر مقدّمة للعمل، ومن هنا يكون العمل جزءًا من النظر. وهو يرى أنَّ كبار علماء الإنسانيّة كانوا يقيمون نوعًا من الاتحاد بين النظر والعمل، الأمر الذي يُستفاد منه نوعًا من القول بأصالة العمل. ومن هنا يذهب الدكتور حسن حنفي إلى القول بأنّ سبينوزا يرى أنَّ العمل الصادق مهما كان قائمًا على نظريّات غير صحيحة أفضل من العمل الكاذب مهما كان قائمًا على نظريّات صحيحة. وبالنظر إلى أنَّ الدكتور حسن حنفي لم يوجّه نقدًا إلى هذه النقطة، فإنّه يوحي بأنّه يتبنّى هذا التوجّه أيضًا. بل إنَّه بعد ذلك يدافع في الهامش رقم 91 من الصفحة 80 صراحة عن تقدّم العمل على النظر، ويقول في ذلك:
«ونجد هذا التيار أيضًا واضحًا في القرآن ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾، وکذلك الأحاديث الکثيرة حول أولويّة العمل على النظر مثل: «والله لو اعتقد أحدکم في حجر على أنْ ينفعه لنفعه»، أو عندما سئل الرسول صلىاللهعليهوآله عن يوم الساعة؟ فقال: «ما أعدّدت له». (رواه البخاري ومسلم)».
وعليه، من خلال الجمع بين هذه الكلمات، نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ الدكتور حنفي يذهب إلى القول بوجود علاقة ديالكتيكيّة بين النظر والعمل. وبعبارة أخرى: ليس الأمر كما لو أنَّه لا يوجد تأثير للنظر على العمل، وكذلك ليس الأمر كما لو كان العمل مجرّدًا من جميع أنواع التأثير على النظر، بل إنَّ هذين الأمرين يعملان على جرح وتعديل بعضهما. والشاهد على ذلك هو الكلام الذي قاله في هذا الشأن. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّه يقول: إنَّ الناس إنَّما يفكّرون في إعادة النظر في مسألة النظر إذا شاهدوا توقفًا في العمل. كما قد أذعن بأنَّ النظر وحده لا يكفي في النجاة وتحقيق الفوز والانتصار، بل لا بدّ للمعلّم من أنْ يخوض في الإرشاد العملي أيضًا. والنقطة الأصليّة تكمن في عبارته التي تدلّ على أنَّ حنفي يرى أنَّ العمل يتحوّل في بعض
الأحيان إلى طريق للوصول إلى النظر. والعبارة الأخرى التي تدلّ على هذا الأمر، هي قوله: «والنظر أساس للعمل، والعمل يقوم على النظر ويولّده». وعلى هذا الأساس، هناك ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ نوع من العلاقة الديالكتيكيّة بين النظر والعمل.
ما تقدّم حتّى الآن كان عبارة عن إعادة قراءة للمشروع الفكري للدكتور حسن حنفي لحلّ المشكلة الرئيسة، التي يعاني منها العالم الإسلامي والعربي، على أساس العلاقة بين النظر والعمل. وحان الوقت الآن لتقييم ومناقشة ونقد هذا المشروع الفكري.
لقد عمد حنفي في تقديم طريقة حلّه لمشكلة الشرخ بين النظر والعلم، إلى وضع التراث والسنّة في كفّة، ووضع الواقعيّة ـ ولا سيّما منها الواقعيّة الاجتماعيّة ـ في كفّة أخرى. وإنَّ إطلالة على أفكاره تثبت أنَّه ينكر كلا هذين الركنين المذكورين. توضيح ذلك أنَّ من بين إشكالات رؤية الدكتور حنفي، أنَّها تؤدّي إلى إنكار ونفي التراث. ببيان أنَّ الدكتور حنفي يذهب إلى الاعتقاد بأنَّه لا يمكن النظر إلى النصوص بوصفها معيارًا؛ وذلك لأنَّ النصوص عبارة عن قوالب يمكن أنْ نصبّ فيها كلّ نوع من أنواع الفكر. والسؤال الذي
يمكن طرحه هنا، هو أوّلًا: هل هناك فهم معياري يشكّل أساسًا لتقييم سائر الأفهام الأخرى؟ وثانيًا: إنَّ الرجوع إلى القرآن الكريم والروايات، يثبت أنَّ القرآن الكريم كما يشتمل على آيات متشابهات، يشتمل كذلك على آيات محكمات أيضًا. وإنّ الآيات المحكمات هي الآيات التي يكون معناها واضحًا وتقبل التفسيرات والأفهام المختلفة. وعلى هذا الأساس، عندما يتحدّث القرآن الكريم عن وجود المحكمات، ألا يكون مدعاكم بمعنى إنكار وجود المحكمات؟ وثالثًا: في ضوء ادّعائكم ما هو الفرق بين نصوص ومتون المفكّرين، أفلا يمكن اعتبار نصوص المفكّرين بوصفها قالبًا يمكن لنا أنْ نصبّ كلّ مسألة فيه؟! هذا في حين أنَّ وجود المحكمات يمثّل واحدًا من الأصول المهمّة في التراث، وإنَّ وجودها واعتبارها ليس رهنًا بالزمان والمكان. يُضاف إلى ذلك، أنَّ الدكتور حسن حنفي يذعن بنفسه بأنّنا لكي ندرك كيف يمكن العمل على إصلاح العلوم، يجب أنْ نتعرّف أوّلًا على العلوم السابقة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ رفع الشرخ بين النظر والعمل من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي، إنَّما هو في مقدور الشخص العالم بالتراث والسنّة، والعالم كذلك بمقتضيات العصر أيضًا. والآن إذا كانت الأفهام من النصوص الدينيّة مختلفة، كيف يمكن الاطمئنان إلى تحقّق الفهم والإدراك بالنسبة إلى التراث والمصادر الدينيّة؟
الإشكال الآخر الذي يتّجه إلى رؤية الدكتور حسن حنفي، هو أنَّه ينكر
الواقعيّة من الأساس. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ المطابقة مع الواقع في دائرة النظر ليست ملاكًا صحيحًا، بيد أنَّ المطابقة مع النفس والتجربة يمكن أنْ توفّر مضمونًا ليشكّل أساسًا للعمل. كما لا يوجد من وجهة نظره فرق بين الفلسفة والأدب، وإنَّ الفلسفة في الحقيقة والواقع عبارة عن تحليل لتجارب الحياة. يرى حسن حنفي أنَّ الكلام عن وجود تناقض ـ من الزاوية الحضاريّة ـ في فكرة ما وعدم انسجامها ليس مطروحًا؛ إذ إنَّه يدّعي أنَّ كلام كلّ شخص ـ على كلّ حال ـ ينطوي على تناقض. كما أنَّه يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ «فكرة الخطأ» غير موجودة من وجهة نظر حضاريّة. وإنَّ الذي يُعدّ خطأ ـ من هذه الزاوية ـ هو أنْ يقوم مفكّر باتخاذ موقف حضاري مخالف في لحظة لم تكن تقتضي اتّخاذ مثل ذلك الموقف. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ الموقف الخاصّ باللحظة السابقة والذي يتّخذه السلفي في اللحظة الراهنة، أو الموقف الخاصّ باللحظة القادمة والذي يتّخذه العلماني في اللحظة الراهنة. يُضاف إلى ذلك، أنَّ الدكتور حنفي يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ المطروح من هذه الزاوية هو التمايز بين النظريّات المؤثّرة والنظريّات غير المؤثّرة، وليس الصحيح والخطأ.
إنَّ هذه العبارات تثبت أنَّ الواقعيّة ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ إمّا أنْ لا تكون موجودة أصلًا، وإمّا إذا كانت موجودة، فهي غير قابلة للفهم والإدراك، بالإضافة إلى أنَّ طرح مسألة تأثير أو عدم تأثير نظريّة ما، يدخلنا في عالم ثالث يتمّ فيه طرح آليّات مختلفة عن آليّات الموقف الحضاري، كما أنَّ الآليّات الصحيحة والخاطئة ليست مطروحة أيضًا؛ إذ إنَّ الكثير من الحكومات تبادر إلى دعم نظريّة تساعد على تثبيت أركان حكمها. ومن هنا لا ينبغي تجاهل دور الحكومات والقوى السياسيّة في تأثير النظريّات العلميّة أو عدم تأثيرها. وأمّا فيما يتعلّق بأنّ الدكتور حنفي ـ حيث يكون في مقام التعرّف على آفات التفكير الإسلامي ـ يقرّ في بعض الموارد بوجود تحدٍّ جادٍّ بين الفكر الإسلامي وبين الواقعيّة، وأنّه يسعى إلى علاج ذلك، فيجب التساؤل: إذا لم تكن هناك معرفة تجاه الواقعيّة، فكيف يمكن الحديث عن وجود مثل هذا التحدّي؟
الإشكال الثالث: النزعة الإيمانيّة
إنَّ الإشكال الثالث الذي يرِد على رؤية الدكتور حسن حنفي، هو أنَّه عندما يتحدّث عن ترتيب العلوم، يرى أنَّ علم المبادئ وحيٌ يُعبّر عن نوع من الرؤية الإيمانيّة لديه؛ إذ ما لم يتمّ إثبات وجود الله، لن يكون الكلام عن الوحي واعتباره وجيهًا. كما يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الوحي يمثّل نقطة انطلاق اليقين للبدء في عمليّة التفكير. في حين أنَّ هذه المسألة
تؤدّي إلى النزعة الإيمانيّة. إنَّ تجاهل منزلة العقل في النزعة الإيمانيّة أكبر بكثير من تجاهل العقل في نظرة الأشاعرة إلى العقل.
بالإضافة إلى الإشكالات الآنفة، فإنَّ الإشكال الآخر الذي يرِد على رؤية الدكتور حنفي، هو أنَّ طريقة الحلّ التي يذكرها غير مجدية. توضيح ذلك أنَّ مقترح الدكتور حنفي هو إصلاح علم أصول الدين على أساس علم أصول الدين الاعتزالي. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الاجتهاد الذي يعتبره بمنزلة الطريق إلى إحداث التناغم بين النظر والعمل، إنَّما يقوم على أساس «العقل الاعتزالي». ولكنْ يجب علينا التدقيق في مفهوم «العقل» ـ ولا سيّما من وجهة نظر المعتزلة ـ لندرك: هل فهم المعتزلة لـ «العقل» يساعد على حلّ مشكلة الشرخ والانفصال بين النظر والعمل أم لا؟ إنَّ المعتزلة يؤمنون بالعقل النظري كما يؤمنون بالعقل العملي أيضًا، إلّا أنَّهم في فهمهم للعقل قد عملوا أوّلًا على إعطاء الأصالة للعقل النظري. وثانيًا إنّ العقل العملي المنشود للمعتزلة هو «العقل الفردي» دون العقل الجمعي؛ ذلك أنَّ الدكتور حسن حنفي قد تحدّث في كتابه (في الفكر المعاصر العربي) عن بعض الإشكالات الموجّهة إلى العقل، وسعى إلى الإجابة عنها. وقد ورد في بعض الإشكالات أنَّ بعضهم يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ العقل يسعى إلى توجيه النظر، في حين أنَّ الحياة تتحقّق في العمل، حيث العقل لا يخوض في ذلك. وعلى هذا الأساس، إذا كان المراد من طريقة الحلّ التي يذكرها
الدكتور حسن حنفي، هو اللجوء إلى «العقل» على أساس فهم المعتزلة؛ فحيث أنَّ العقل المذكور يكون أوّلًا ناظرًا في الكثير من الموارد إلى العمل، وثانيًا إنَّه في الموارد التي يكون ناظرًا إلى العمل، يجعل العمل الفردي هو الملاك، وعليه فإنَّ هذا الحلّ لن يكون أسلوبًا مجديًا لإيجاد التناغم بين النظر والعمل. قد يقال بأنَّ مراد الدكتور حنفي من العقل، تقرير جديد من العقل يتطابق مع ما هو موجود في الفلسفات الغربيّة الجديدة ـ من قبيل فلسفة هيجل ـ والذي على أساسه يكون المراد من العقل هو «العقل التاريخي»، وعندها يتعيّن على الدكتور حنفي أنْ يُذعن بأنَّ طريقة حلّه تؤدّي إلى إلغاء التراث. وبطبيعة الحال، فإنَّ الدكتور حنفي نفسه كان مدركًا لبعض الإشكالات الواردة على هذه الرؤية الغربيّة، وهو يرى أنَّ إشكال الانفصال بين النظر والعمل وارد على بعض المدارس الفلسفيّة، والتي هي في الغالب من الفلسفات المثاليّة. وبطبيعة الحال، فقد تمّ الاهتمام بالعقل العملي من قبل بعض المدارس الفلسفيّة في الغرب أيضًا؛ بمعنى ذات العقل الناظر إلى مقام العمل، فإنَّ العقل العملي حتّى في النظام الفلسفي لإيمانوئيل كانط يقع بوصفه أساسًا للعقل النظري. بيد أنَّ إشكال هذه الطائفة من المدارس ـ وعلى رأسها مدرسة إيمانوئيل كانط ـ يكمن في أنَّ المراد فيها من العمل في باب العقل العملي، هو العمل الفردي.
إنَّ من بين الإشكالات الأساسيّة في طريقة حلّ الدكتور حنفي للتغلّب على معضلة الانفصال بين النظر والعمل، هو أنَّه مغلوب للوقوع في ثنائيّة باطلة تتمثّل في «اليمين واليسار». توضيح ذلك أنَّه في إطار تقديم طريقة حلّ لهذه
(292)المشكلة، يذهب الدكتور حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الرؤية اليساريّة في هذا البحث، تقتضي أنْ يكون الإيمان والعمل وجهين لعملة واحدة. وكما نرى فإنَّ ثنائيّة «اليسار واليمين» تمثّل ـ في رؤية الدكتور حسن حنفي ـ واحدة من الثنائيّات الأساسيّة. إنَّ هذه الثنائيّة قد استوعبت جميع الأعمال الفكريّة لحسن حنفي، وقد بلغت أهميّة هذه الثنائيّة حدًّا ذهب معه حنفي إلى تخصيص واحد من كتبه لبحث هذه المسألة، بل وقد صرّح في كلام له بأنَّه يسعى إلى الجمع بين أفكار هيجل وكارل ماركس. وبعبارة أخرى: إنّه في أعماله وآثاره بصدد الجمع بين أفكار شخصين كانت آراؤهما تُعدّ مصدرًا للتيّار اليساري. وهو يرى أنَّ الموقع والشرائط السياسيّة والاجتماعيّة لمصر تحتّم المضي على أساس النظرة اليساريّة. ولكنْ بالإضافة إلى أنّنا نشاهد في الفضاء الثقافي تيّارات لا تندرج في إطار اليمين ولا في إطار اليسار، كما هو الحال في التيّارات الليبراليّة، فإنَّ هذا التبويب الذي تشكَّل في الظروف والشرائط السياسيّة والاجتماعيّة الخاصة لعالم الغرب، لا يمكن له أنْ يعكس الشرائط الثقافيّة والاجتماعيّة للعالم الإسلامي، ولا سيّما مصر. إنَّ الكثير من المفاهيم الدينيّة الأصيلة، من قبيل: «المساواة»، و«الأخوّة»، و«العدالة»، و«حقوق الإنسان»، موجودة في المصادر الدينيّة، بحيث يمكن لها أنْ تغني المحقّقين عن التبعيّة والتعلّق بالأفكار المستوردة من الغرب، بل ويمكن من خلال الرجوع إلى المصادر
الدينيّة أنْ نعثر على مفاهيم لا وجود لها في الرؤية الاجتماعيّة الغربيّة، أو إذا كانت موجودة فهي في غاية الندرة، من قبيل: مفهوم: «الإيثار»، و«حقوق الحيوان»، و«حقوق البيئة»، وما إلى ذلك.
إنَّ من بين إشكالات رؤية الدكتور حنفي، هي الافتقار إلى المنهج الجامع. فعندما يتعرّض حنفي إلى التعريف بمشكلات العالم الإسلامي وبيان طريقة حلّ لها، ولا سيّما فيما يتعلّق بالمشكلة الأصليّة المتمثّلة بانفصال النظر والعمل، فإنَّه يركّز رأيه على بُعد خاصّ من المسألة ويغفل عن أبعادها الأخرى. توضيح ذلك أنَّه في تحليله لمسألة الارتباط بين النظر والعمل، إنّما ينظر إليها من الزاوية «الحضاريّة» فقط. فمن وجهة نظر الدكتور حسن حنفي لا وجود للحديث عن التناقض ـ من الزاوية الحضاريّة ـ في الفكرة وعدم انسجامها. يذهب الدكتور حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ المطروح من هذه الزاوية هو التمايز بين النظريّات المؤثّرة والنظريّات غير المؤثّرة، وليس الصحيح والخطأ.صحيح أنَّه يمكن النظر إلى النظريّات من زاوية «التأثير أو عدم التأثير»، بيد أنَّ هذه الرؤية إنَّما هي واحدة من أبعاد وزوايا النظريّات، وليس الأمر كما لو أنَّ النظريّات فاقدة لأبعاد أخرى، ولا سيّما منها «الصحّة أو عدم الصحّة». وفي الأساس، فإنَّ الفلسفة الوجوديّة لبعض العلوم، من قبيل: المنطق، وعلم المعرفة، ومنهج التحقيق، هي
بيان معايير للتعريف بالنظريّات الصحيحة وفصلها عن النظريّات الخاطئة. وبعبارة أخرى: إنَّ كلَّ نظريّة قبل أنْ تدخل فی میدان الثقافة والعلاقات بين مختلف مراكز القدرة، يجب أنْ تشتمل على معايير وملاكات الاتّصاف بـ «العلميّة». من ذلك ـ على سبيل المثال ـ لو تمّ بيان نظريّة في حقل العلوم التجريبيّة، وكان الأسلوب والمنهج المستعمل فيها هي «المنهج الاستقرائي»، يجب أنْ تحتوي على حدّ النصاب اللازم للاستقراء المعتبر. وعلى هذا الأساس، لا ينبغي التهاون ـ لمجرّد «تأثيرها» ـ بالنسبة إلى بلوغها حدّ النصاب اللازم، أو العمل على تجاهلها. وعليه، يتعيّن على حنفي في بيان حلوله ونظريّته المنشودة أنْ يلتفت إلى اللوازم المنهجيّة والعلميّة، وأنْ لا يعمل على تجاهلها. وعلى هذا الأساس، فإنَّ تأكيده على مجرّد «تأثير» النظريّات، خير شاهد على عدم جامعيّة أسلوبه في بيان طريقة الحلّ المنشودة له.
إنَّ من نقاط قوّة الحلّ ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ هي الاهتمام باحتياجات ومقتضيات الزمان. ومن هنا فإنَّه إنّما يَعدّ النظريّات مطلوبة إذا كانت تلبّي الحاجات المعاصرة. وقد عبّر عن الاحتياجات والمقتضيات المعاصرة بـ «روح العصر». والمراد من روح العصر هي تجارب الحياة ذاتها. وبعبارة أخرى: إنَّ حاجات العصر قد تبلورت ضمن تجارب الحياة. وعلى هذا الأساس، يجب أنْ تكون النظريّات منسجمة مع تجارب الحياة. ومن هنا فإنَّ
أذهان الناس تتّجه نحو الأمور المتناغمة مع العصر. وقد ذهب الدكتور حسن حنفي ـ ضمن التأكيد على هذه المسألة ـ إلى الإقرار بأنَّ علم التوحيد إذا لم يتأقلم مع حاجة العصر، فإنّه سيخرج عن حيّز اهتمام الناس. وبعبارة أخرى: إنَّ الملاك الأصلي ـ أو أحد الملاكات الأصليّة في الحدّ الأدنى ـ لتقييم علم التوحيد، يكمن في مقدار تناغمه مع تعلّقات الناس. من المناسب أنْ نتوقّف هنا عند هذه النقطة شيئًا ما، لنرى ما هو مقدار ما تحظى به هذه الرؤية من قبل حسن حنفي من العمق والدقّة. وفيما يلي سوف نعمل أوّلًا على تقديم خلاصة بالمسار الفكري للدكتور حسن حنفي في مسألة انفصال النظر والعمل. فقد بدأ مشروعه من خلال التعرّف على هذه المشكلة، ثمّ صار بصدد تقديم حلّ لهذه المشكلة، مؤكّدًا أنَّ غايته ترمي إلى تقديم قراءة عن الإسلام بما ينفع الناس. وكما يتّضح من هذا البيان، فإنَّ «الدافع» الأصلي الذي دفع الدكتور حسن حنفي إلى العمل على إيجاد التماهي والتناغم بين النظر والعمل، هو أنْ يعمل على توجيه «أذهان الناس» نحو التناغم والانسجام مع العصر. والذي قام به من البيان حتّى الآن واضح، ولكنْ يبدو أنَّ الدكتور حسن حنفي قد غفل عن هذه النقطة المهمّة، وهي أنَّ «توجيه أذهان الناس» بدوره يتبلور في ضوء تأثير بعض العلل والعوامل. وبعبارة أخرى: إنَّ «التوجّهات الذهنيّة للأفراد» ظاهرة لها أسبابها وعللها الخاصّة. وقد شكّلت هذه الظاهرة موضوعًا للدراسات والتحقيقات العلميّة أيضًا، وإنَّ بعض الحقول العلميّة يتعرّض إلى بحث
ومناقشة «الأفكار العامّة» وجذورها وأسبابها. تتمّ الاستفادة في هذه الحقول العلميّة من أساليب التحقيقات الميدانيّة، من قبيل مختلف مناهج استطلاع الرأي، في إطار التعرّف على التوجّهات والتطلّعات الذهنيّة لدى الأفراد. إنَّ النقطة التي غفل عنها الدكتور حسن حنفي، هي أنَّ العوامل والأسباب التي تعمل على توجيه وهداية الأفكار العامّة مختلفة، وإنَّ بعض هذه الأسباب ينبثق من الضغوط التي تمارس بشكل غير مباشر من قبل مصادر القوى السياسيّة، ولا سيّما الدول والحكومات الغربيّة، وكذلك فإنَ بعض هذه الأسباب يمكن أنْ يكمن في «منافع التكتّلات الاقتصاديّة»؛ إذ إنَّ الكثير من هذه التكتّلات على استعداد تام للعمل حتّى على تغيير «أذواق» الناس من أجل الوصول إلى المزيد من الأرباح الماديّة. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ سلسلة مطاعم ماكدونالد قد عملت من خلال توظيف ماكنة إعلاميّة ودعائيّة ضخمة على توجيه أذهان الكثير من الناس في مختلف نقاط العالم، بحيث تمكّنت من إقناع الناس بأنَّ منتجاتها من الأطعمة أفضل بكثير من أطعمتهم المحليّة. ويمكن لما يُشبه هذا الأمر أنْ يتحقّق في مجال الثقافة والتفكير أيضًا. وعلى هذا الأساس، يبدو أنَّ حنفي لم ينجح في تحليله لخلفيّات وجوب إعادة النظر في التراث، وإنَّه قد أخذ بنظر الاعتبار مسألة الانفصال بين النظر والعمل في أدنى مراتبها، ولم يلتفت إلى عمق المسألة.
بالإضافة إلى الإشكالات المتقدّمة، فإنَّ مطالعة آثار الدكتور حنفي تدلّنا على بعض أنواع «التهافت»، الأمر الذي يخفض من قيمة واعتبار رؤيته إلى مسألة
(297)
الانفصال بين النظر والعمل. وفيما يلي نشير إلى هذه التهافتات:
التهافت الأوّل: كشف الواقع غير المكشوف؛ إنَّ أحد أنواع التهافت الذي نجده في رؤية الدكتور حسن حنفي، أنَّه من جهة يقرّ بأنَّه عندما يقع الاختلاف في التفاسير، هناك مَنْ يلجأ إلى النقل، وهناك مَنْ يلجأ إلى العقل. ومن ناحية أخرى، يذهب الدكتور حنفي إلى الادّعاء قائلًا بأنّنا نلجأ إلى الواقع، ونتّخذ من الواقع معيارًا لتقييم العقل والنقل. وفي هذه العبارة تمّ وضع الرجوع إلى الواقع في قبال العقل والنقل. والآن لو أردنا أنْ نتكلّم على أساس رؤية الدكتور حسن حنفي نفسه، من الواضح أنَّ الواقع في حدّ ذاته لا يملك لسانًا كي يتحدّث إلينا بوساطته. وعليه، ليس هناك بدّ من قيام الواقع بإظهار نفسه لنا. والآن إذا لم يكن هذا الواقع هو العقل، ولم يكن هو النقل، فما هو الأمر الآخر الذي سوف يكون في البين ويعمل على إيصالنا إلى الواقع ويكشفه لنا؟!
التهافت الثاني: الاعتزال أو التصوّف؛ إنَّ الدكتور حسن حنفي يصرّح من جهة أنَّ رؤيته الأصليّة تقوم على أساس الاعتزال، ولكنَّه يرى من جهة أخرى أنَّ الغزالي والمتصوّفة ـ من بين التيّارات الفكريّة في العالم الإسلامي ـ هم الذين كانوا يؤكّدون على «مسألة العمل». إنَّ التصوّف في تاريخ التفكير
الإسلامي ـ من وجهة نظر حسن حنفي ـ بمنزلة واحد من أساليب التأكيد على العمل في قبال النظر، لا سيّما وأنَّهم كانوا يؤكّدون على الطريقة أكثر من تأكيدهم على الشريعة. ويذهب الدكتور حنفي في هذا السياق إلى الاعتقاد بأنَّ غاية الدين غاية عمليّة، وليست غاية نظريّة وعلميّة. وهنا يمكن لنا أنْ نتساءل: هل الغزالي والمتصوّفة إنّما كانوا يعملون على تأصيل العمل فقط ـ كما يدّعي حسن حنفي ـ أم كانوا بالإضافة إلى ذلك يؤكّدون على «الكشف» و«الشهود» الذي هو أسلوب من أساليب النظر أيضًا؟! إنَّ جولة في آثار الغزالي والمتصوّفة، لا تؤيّد ادّعاء الدكتور حسن حنفي. يضاف إلى ذلك، ما هو البيان والتفسير الذي يمكن للدكتور حنفي أن يقدّمه ـ بعد قبول رؤية المعتزلة ـ على المعارضة الشديدة من قبل المتصوّفة مع «العقل»؟! فهل كانت غايته من قبول رأي المعتزلة مجرّد ذريعة في إطار ضرب رؤية الأشعري، وإنَّه في الحقيقة والواقع لا يؤمن برؤية المعتزلة ولا يوافق على رؤية الأشاعرة؟!
التهافت الثالث: أولويّة الخارج أم الداخل؛ يذهب الدكتور حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الطبيعة حيث تكون في التراث الإسلامي حادثة وعرَضًا وممكنة، وتعتبر أمرًا خارجًا عن حقيقة الإنسان، فإنَّها لم تؤخذ بوصفها مصدرًا للمعرفة، ولم يتمّ السعي إلى معرفتها. إنَّ هذه النقطة تشير إلى أنَّ النظر مقدّم على العمل. ومن ناحية أخرى، فإنَّ حسن حنفي يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ المجتمع
الإسلامي قد أعطى الأولويّة إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل، وإلى الصورة بالنسبة إلى المضمون. والغموض والتهافت الموجود هنا هو أنَّه لم يتّضح من كلامه ما إذا كان المجتمع مهتمًّا بأمر داخلي أم كان مهتمًّا بأمر خارجي!
التهافت الرابع: تقديس الشخصيّة أمر إيجابي أم سلبي؛ إذا كانت عبادة الشخص تمثّل في الحقيقة واحدة من أسباب الشرخ والانفصال بين النظر والعمل، لن يكون هناك فرق بين أنْ يكون الشخص المعبود «شرقيًّا» أم «غربيًّا». من هنا يجب على الدكتور حنفي أنْ يجيب عن هذا السؤال الأساسي لمخاطبيه؛ إذ يقولون: ما هو السبب الذي دعاه إلى هيجل وكارل ماركس ـ من بين جميع الشخصيّات الفكريّة المختلفة ـ وسعى في جميع آثاره وأعماله إلى إيجاد التناغم بين أفكار وآراء هذين الشخصين فقط؟ ألا يتعيّن على المفكّر «الواقعي» أنْ يتّخذ من الواقعيّة معيارًا لتقييم الآراء والأفكار التي ينتقيها، ويسعى إلى عدم تغلّب الشخصيّة عليه؟ كما أنَّه فيما يتعلّق بتقديم حلّ لمشكلة الشرخ بين النظر والعمل ـ في ضوء إعادة قراءة علم التوحيد وتقديم تفسير إنساني عن الله ـ قد تأثّر بسبينوزا؛ وذلك لأنَّ باروخ سبينوزا هو الذي تصدّى لكي يحلّ الإنسان محلّ الله. هذا إذا تجاوزنا أنَّ سبينوزا قد سعى في هذا الأمر من خلال نظريّة الحلول، في حين عمد الدكتور حنفي إلى ذلك من خلال إلغاء الله وتنزيله إلى مستوى الصفات الإنسانيّة. يُضاف إلى ذلك أنَّ حسن
حنفي في تحليله لمبحث صفات الباري تعالى ـ المذكورة في الكتب الكلاميّة ـ يقدّم بيانًا يكشف عن تأثرّه بفويرباخ. يذهب حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ هذه الصفات صفات حميدة يشتاق الإنسان إلى تحصيلها، ولكنْ حيث يخفق في ذلك، فإنَّه ينسبها إلى مصداق أعلى. وإنَّه يذهب في هذا الشأن إلى الحدّ الذي يذهب معه إلى اعتبار عنصر «محوريّة الله» عنصرًا لعدم العقلانيّة حتّى في الحضارة الغربيّة، الأمر الذي يدلّ بدوره على تأثّر الدكتور حسن حنفي بشخصيّة فويرباخ أيضًا.
التهافت الخامس: العقائد بوصفها أدواتٍ أو مباني للعمل؛ وبطبيعة الحال لا بدّ في نقد ومناقشة هذا الرأي لحسن حنفي من الالتفات إلى أنَّه يذهب من جهة إلى القول: إنَّ ما يُعدّ عقيدة ليس سوى أداة بيد المصلحين الاجتماعيين لغرض إيجاد التغيير في المجتمع، دون أنْ يكون تقريرًا عن الواقعيّة. ومن ناحية أخرى، يعتبر العلاقة بين الاعتقادات والواقعيّة منفصلة. في حين أنَّ العقائد إذا لم تكن شيئًا سوى الأداة، فإنَّها لن تكون بصدد الحكاية والتقرير عن الواقعيّة، كي يكون انفصالها عن الواقعيّة إشكالًا عليها.
التهافت السادس: التراث الخيالي أو التراث الواقعي؛ يذهب حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الغرض الأصلي للنصوص ـ في أغلب الموارد ـ هو «إثارة الخيال»
وليس إقناع العقل. ولكنّنا نرى من ناحية أخرى أنَّ الدكتور حنفي يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ علم الحديث من أكثر أجزاء التراث عقلانيّة، حيث عمد التراث إلى جعله ليكون العقل هو الأساس في مناقشة النصوص ونقدها. وعلى كلّ حال، يرِد هذا التساؤل القائل: هل التراث واقعي حتّى نعدّه عقلانيًا أم هو بصدد إثارة الخيال كي نطبّق عليه معايير الخيال؟! إذا كانت الغاية الأصليّة هي إثارة الخيال حقًا، فإنَّ الخيال في الأساس ليس بصدد البحث عن الحقّ وغير الحقّ، ولكنَّه في العبارة التي نقلها عن الفقهاء ـ ويبدو أنَّه يؤمن بها ـ يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الحقّ في مقام النظر متعدّد وفي مقام العمل واحد.
التهافت السابع: الثورة أو الوفاء للعقد الاجتماعي؛ يذهب الدكتور حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ أساس الحياة الاجتماعيّة يقوم على العقد الاجتماعي، ويرى أنَّ الذين يحصلون على السلطة من طريق العقد الاجتماعي، عليهم أنْ يحترموا بنود هذا العقد، ويُعدّ التخلّف عنه من «العصيان»، ولا يخفى بطبيعة الحال أنَّ طاعة الأفراد للسلطة مشروطة بتنفيذ السلطة لبنود العقد الاجتماعي، إذ بموجب الأدلّة الشرعيّة، ومنها: «لا طاعة لمخلوق بمعصيّة الخالق». إنَّ هذه الرؤية تتعارض مع توصياته بلزوم إحداث الثورة، ويرد عليه هذا السؤال القائل: هل يتعيّن على الناس أنْ يفكّروا في الثورة، أم يقنعوا
بالواقع القائم في إطار الوفاء للعقد الاجتماعي؟
التهافت الثامن: يقينيّة علم الكلام أو عدم يقينيّته؛ إنَّ الدكتور حسن حنفي يذهب من جهة إلى التأكيد على أنَّ العلاقة بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه من وجهة نظر علماء الإسلام على النحو الآتي، وهي أنَّه في علم أصول الدين يتمّ العمل على بيان مجموعة من القواعد اليقينيّة التي تشتمل على محتوياتٍ نظريّة، ثمّ يتمّ العمل في علم أصول الفقه على بيان مجموعة من القواعد الظنيّة الناظرة إلى كيفيّة السلوك والعمل. وبطبيعة الحال، فقد تمّ السعي من أجل إقامة القواعد الظنيّة لعلم أصول الفقه على أساس القواعد اليقينيّة لعلم أصول الدين، مهما ظلّت كيفيّة العلاقة بين هذين العلمين على ما هي عليه من الغموض والإبهام. ومن ناحية أخرى، يقرّ الدكتور حسن حنفي بأنَّ علم الكلام لا يفيد شيئًا سوى الظن، ومن هنا لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس علم أصول الدين.
التهافت التاسع: إمكان النظر أو عدم إمكانه؛ يذهب الدكتور حسن حنفي من جهة إلى الاعتقاد بأنَّ الواجب الأوّل على المكلّف ليس هو الإيمان، بل هو النظر؛ وذلك لأنَّ الإيمان يجب أنْ يقوم على أساس النظر. ومن ناحية أخرى، لا يمكن البحث عن ذات الله في علم أصول الدين؛ وذلك لأنَّ ذات الله مطلقة، في حين أنَّ أفهام الناس محدودة، وإنَّ الأسلوب الشهودي الذي
يرِد ذكره في العرفان والتصوّف، لا محلّ له من الإعراب في علم أصول الدين، وإنَّما الطريق الوحيد للبحث حول الله سبحانه وتعالى في علم أصول الدين، هو الإيمان فقط.
التهافت العاشر: القول بالفطرة أو رفضها؛ يذهب الدكتور حسن حنفي من جهة إلى التأكيد على تقدّم العمل على النظر، ومن الواضح أنَّ الخصّيصة الأساسيّة في العمل هي الزمانيّة والمكانيّة، ومن هنا فإنَّ مسار العمل لا يخضع للقوانين الكليّة والشاملة. ومن ناحية أخرى، فقد ذهب الدكتور حنفي إلى الإقرار ـ في بعض آثاره ـ بوجود فطرة واحدة لدى جميع الأشخاص، حيث يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الفطرة عبارة عن الطبيعة الثابتة في جميع البشر، وأنَّها تفوق الزمان والمكان والأعراق.
التهافت الحادي عشر: نجد في موضع آخر نسيان الدكتور حسن حنفي لأصل تقدّم العمل على النظر، وذهب في تعريف الدين إلى القول:
«الدين هو الفکر، مهمّته المراقبة الشعبيّة على السلطة کما هو واضح في «الحسبة» عند الفقهاء المسلمين، أي: الرقابة الشعبيّة على أجهزة الدولة، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر».
فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر يمثّل رسالة الدين، فإنَّ هذا
الأمر لا يمكن أنْ يكتب له التحقّق إلّا من خلال معرفة المعروف والمنكر. هذا في حين أنَّ الدكتور حنفي يجيز الجهل بالأمور حتّى على الأنبياء، ناهيك عن علماء الدين، ومن ذلك قوله:
«كان الأنبياء بشرًا، ولا يُنقص جهلهم بعلل الظاهر الكونيّة من تقواهم ومن إخلاصهم شيئًا».
وعليه، إذا كان من الممكن أنْ يجهلوا ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يجوز لهم القيام بمهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟!
التهافت الثاني عشر: يذهب الدكتور حسن حنفي من ناحية إلى القول بأنَّ الهويّة هي أساس المواطنة، والوعي الذاتي، والثقة بالنفس، والإبداع الحضاري. ومن ناحية أخرى، ينقل الدكتور حسن حنفي رأي كارل ماركس القائل بأنَّ الإنسان لا يستطيع استعادة هويّته إلّا إذا تمّ تصحيح واقعه الاجتماعي، ولن يتحقّق ذلك إلّا من طريق الحصول على نتائج عمله. والآن يرِد هذا السؤال القائل: هل التقدّم يكون للعلم والإدراك أم للتغيير الاجتماعي؟
يمكن التوصّل من خلال مجموع الأبحاث المتقدّمة إلى هذه النتيجة، وهي أنَّ الدكتور حسن حنفي ـ بوصفه واحدًا من المفكّرين المعاصرين في العالم العربي ـ
قد عمل على تجزئة وتحليل مسائل العالم الإسلامي والعربي، وقد تعرّف في هذا الشأن على بعض المسائل والمشكلات، وذهب إلى الاعتقاد بأنَّ المشكلة الأهمّ التي يعاني منها العالم الإسلامي والعربي، هي مشكلة «عدم الانسجام بين التراث والتجديد«، ويمكن إعادة قراءة هذا التنافي في إطار جديد تحت عنوان «الشرخ بين النظر والعمل». إنَّ هذا الأمر من شأنه أنْ يضع ظرفيّة جديدة تحت تصرّف المحقّق؛ لكي يتعرّف على أبعاد جديدة من المشروع الفكري للدكتور حسن حنفي، ويطّلع في الوقت نفسه على بعض موارد النقص في رؤيته أيضًا.
يرى حسن حنفي أنَّ هناك أربعة عناصر لتبلور الشرخ بين النظر والعمل، وهي عبارة عن:
أ) عدم الالتفات إلى التجربة الحيّة... ب) التخلّف العلمي.. ج) عبادة الأشخاص... د) الاغتراب.
وفي المقابل، فإنَّه يشير إلى أربعة طرق للتغلّب على «الانفصال بين النظر والعمل»، وهي عبارة عن:
أ) التدوين الأيديولوجي. ب) إعادة قراءة السنَّة. ج) إعادة قراءة العقل. د) الديالكتيك بين النظر والعمل.
إنَّ الدراسة النقديّة لرؤية حسن حنفي تحكي عن وجود بعض المشكلات والصعوبات في رؤيته. وإنَّ بعض هذه الصعوبات عبارة عن:
أ) نفي أصول التراث. ب) نفي الواقعيّة. ج) النزعة الإيمانيّة. د) عدم جدوائيّة طرق الحلّ الموجودة. ه) الثنائيّة. و) فقدان المنهج الجامع. ز) فقدان التحقيق العميق. ح) وجود بعض التهافتات في رؤية حسن حنفي.
(306)يبدو أنَّ التحاور والتباحث حول آراء المفكّرين المعاصرين يمثّل واحدًا من ضرورات الازدهار والتقدّم في العالم الإسلامي؛ وذلك لأنَّ هذا الأسلوب سوف يوضّح مدى تطابق أساليب ومناهج المفكّرين مع الحقائق والواقعيّات، وما هو مدى بُعدها عنها.
(307)- حنفي، حسن، التراث والتجديد، بيروت، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، 1992 م.
- ــــــــــ ، في الفکر العربي المعاصر، القاهرة، الموسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، ط 4، 1990 م.
- ــــــــــ ، الدين والثورة، القاهرة، مکتبة المدبولي، 1988 م.
- ــــــــــ ، الهويّة، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2012 م.
- ــــــــــ ، حديث الفرقة الناجية، المنامة، جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة، 2007 م.
- ــــــــــ ، دراسات فلسفيّة، القاهرة، المکتبة الأنجلو مصريّة، 1988 م.
- ــــــــــ، قضايا معاصرة فی فکرنا المعاصر، القاهرة، دار الفکر العربي، 1983 م.
ــــــــــ، مقدّمة في علم الاستغراب، بيروت، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، 1412 ه.
- ــــــــــ، من العقيدة إلى الثورة، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1988 م.
- ــــــــــ، من النصّ إلى الواقع، القاهرة، مرکز الکتاب للنشر، 2004 م.
- ــــــــــ، هموم الفکر والوطن، مجلّدان، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1998 م.
- سبينوزا، باروخ، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمه وتقديم حسن حنفي، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 2005 م.
- مجموعة من الباحثين، إلى أين يذهب العرب؟ (رؤية 30 مفكّرًا في مستقبل الثورات العربيّة)، بيروت، مؤسّسة الفکر العربي، 2012 م.
أحمد قطبي ميمندي
إنَّ البحث والتحقيق حول العرفان والتصوّف في عصرنا يواجه الكثير من الصعوبات والتعقيدات الناشئة عن توظيف الأساليب والمناهج الجديدة في العلوم الإنسانيّة لفهم تعاليم التصوّف، الأمر الذي عرّض هذه التعاليم في بعض الموارد إلى خطر التحريف، وهذا الأمر يجعل من الضروري القيام بأبحاث ودراسات جديدة عن التصوّف. وقد عمل الدكتور حسن حنفي ـ في إطار بيانه لمشروعه البحثي تحت عنوان «التراث والتجديد» ـ على تقديم بيان جديد للعناصر الأصليّة في التراث؛ أي: علم الكلام، والفقه، والحكمة، والتصوّف، في سعي منه إلى تقديم تفسير لهذه العلوم؛ ليتمكّن بوساطتها من تنظيم وإصلاح الوضع الراهن، وإنقاذ العالم الإسلامي من الآفات المحدقة به في المرحلة المعاصرة بزعمه. قد عمد في هذا السياق إلى بيان قراءته الخاصّة
عن التصوّف؛ حيث تحتوي على تغييرات جوهريّة في الهيئة العامّة له، ومن بين أهمّها تغيير الرأي المطروح في مورد صيرورة الإنسان والمقتضيات ما بعد الطبيعيّة والأخلاقيّة له.
والغرض من هذه المقالة هو بيان مدى تطابق وتناغم قراءة الدكتور حسن حنفي للتصوّف مع حقيقة التصوّف. وبعبارة أخرى: هل تمّ حقًا تقديم قراءة جديدة في هذا الشأن أم تمّ بيان ظاهرة أخرى بدلًا منها؟. وفي هذا الإطار سوف نعمل في البداية على بيان الدكتور حسن حنفي لخلفيّات تبلور التصوّف، وماهيته من وجهة نظره، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى بيان المسار الذي ينتظم من خلال تلك القراءة. وفي الختام سوف نعمل على مناقشة ونقد هذه القراءة من حيث مدى تطابقها مع حقيقة التصوّف، وكذلك مقدار النجاح الذي حقّقته هذه القراءة في الأهداف المنشودة منها.
يذهب بعض من العلماء إلى القول بأنَّ الذي يمنح الحياة في كلّ مرحلة وعصر، هو التجارب الخاصّة المتعلّقة بتلك المرحلة وذلك العصر. وحيث أنَّ شرائط الحياة في كلّ مرحلة تختلف عن سواها، فإنَّ تجارب وخصائص كلّ مرحلة سوف تختلف عن سائر المراحل الأخرى. ومن هنا فإنَّ السعي إلى فهم هذه التجارب من خلال تكرارها يؤدّي إلى نوع من الانفصال عن الماضي وعن الحاضر أيضًا. إنَّ كلّ تجربة تتضمّن عناصر صورية خاصّة لا يمكن تطبيقها إلّا على شرائط ماديّة خاصّة. ومن خلال تغيير الشرائط الماديّة، يكون التأكيد على حفظ العناصر الصوريّة بمعنى الانفصال عن الشرائط الجديدة، التي لا
(310)
يمكن تجربتها إلّا بوساطة صوَر أخرى. إنَّ هذا الموضوع ينطبق على مورد التصوّف أيضًا، ومن هنا فإنَّ الكثير من العلماء يرى أنَّ تكرار التجارب الصوفيّة في العالم المعاصر ليس مستحيلًا فحسب، بل وإنَّ فهمها بدوره يواجه الكثير من الصعوبات والتعقيدات أيضًا. وللتغلّب على هذه الصعوبات تمّ وصف الكثير من الحلول والأساليب، ومن بينها الأسلوب الظاهراتي الذي يتمّ السعي بوساطته إلى فهم تجارب الصوفيين في عالمهم الخاصّ.
إنَّ الدكتور حسن حنفي بدوره هو من بين الأشخاص الذين عملوا على توظيف الأسلوب الظاهراتي من أجل فهم التصوّف، إلّا أنَّ بحثه في هذا الشأن إنَّما يكتسب خصوصيّته من أنَّه بالإضافة إلى فهم التصوّف، يسعى، بزعمه، كذلك إلى إصلاحه أيضًا. إنَّ التصوّف يكتسب أهمّيته عند الدكتور حسن حنفي من خلال ارتباطه بتوجّهه إلى التراث والتجديد، ولا بدّ من أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، وهي أنَّ تجديد المجتمع والثقافة من وجهة نظره لا يمكن من دون العمل على تقديم قراءة جديدة للتراث؛ وذلك لأنَّ التراث منطبع في ذهن وروح الأفراد الموجودين في المجتمع. وعلى هذا الأساس، فإنَّ التجديد بالإضافة إلى تحقّق فهم متطابق مع الواقع للتراث، يحتاج إلى تقديم قراءة جديدة عنه أيضًا. إنَّ هذا الموضوع صادق في مورد التصوّف ـ بوصفه واحدًا من الأجزاء الأصليّة للعلوم التي تقع بين أيدينا من التراث ـ أيضًا. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الدكتور حنفي يرمي إلى التغيير في المعتقدات والتوجّهات المطروحة في التصوّف، لتتغيّر ماهيته بحيث يمكن الاستفادة منه في إطار أهدافه المنشودة في مشروع «التراث
والتجديد». يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ هذا التغيير يستلزم تقوية عناصر تعمل على تظهير وإبراز حضور ودور الإنسان، لكي تتمكّن المجتمعات العربيّة والإسلاميّة بهذه الطريقة من أنْ تكون لها السيادة على مصيرها. يرى الدكتور حنفي أنَّ تظهير دور وموقع الإنسان وتحوّله من حالة المنفعل إلى حالة الفعّال، ثورة سوف تستبطن في حدّ ذاتها ثورة في سائر المجالات؛ «لأنَّ كلّ تحوّل في الحضارة تابع لثورة في ذات الإنسان». إنَّ الإحياء في هذا المعنى يستلزم الوعي الذاتي والتفاعل في حقل تغيير المجتمع والثقافة، بمثابة الأمور القائمة بذاتها، وهذا النوع من التغيير يقوم على صيرورة أفقيّة. إنَّ حنفي على الرغم من اعتقاده بأنَّ بيان الأبحاث المرتبطة بالوعي والإدراك قد تمّت قبل أيّ شيء في التصوّف، ولكنَّه مع ذلك يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ
«الإنسان الذي يرِد ذكره في التصوّف، هو الإنسان الذي يجب أنْ يصل إلى فنائه، أو يسعى إلى تحقيق هذه الغاية. يرى الدكتور حنفي أنَّه ما دام هذا النوع من الأفهام عن الإنسان موجودة، فإنَّ توقّع أيّ تغيير في الحياة سيكون ضربًا من العبث؛ وذلك لأنَّ الأفكار ليست أمورًا مجرّدة عن الحياة، بل هي طرق للحياة، وأساليب للسلوك».
يرى حنفي أنَّه على الرغم من أنَّ الأبحاث المرتبطة بالوعي يمكن العثور عليها في التصوّف أكثر من أيّ موضع آخر، إلّا أنَّ هذه الأبحاث لم تؤدّ إلى ظهور الوعي الذاتي. وقد ذهب الدكتور حنفي إلى القول بأنَّ فقدان الوعي
(312)الذاتي يكمن في أنَّ الأبحاث المرتبطة بالإنسان ووعيه قد وقعت في هامش الأبحاث المرتبطة بوجود الله وصفاته وأفعاله. ومن هنا يذهب إلى الاعتقاد بأنَّه على الرغم من الأبحاث المرتبطة بالإنسان الكامل ـ الذي يراه مساويًا للإنسان المثالي ـ يمكن العثور على أرضيّات الوعي الذاتي، ولكنْ حيث أنَّ مسألة أمسنا كانت شيئًا آخر، فإنَّ هذا الأمر لم يتحقّق.
إنَّ الذي وجده الدكتور حسن حنفي في تجربة الصوفيين «طريق صاعد من أسفل إلی أعلی، من الإنسان إلی الله، يبدأ بالتوبة، وينتهي بالفناء، وبين البداية والنهاية المقامات والأحوال». بيد أنَّ الذي ينشده الدكتور حنفي هو تغيير سياسي واجتماعي وثقافي يستلزم اتجاهًا أفقيًّا. وعلى هذا الأساس، فإنَّه يواجه تهافتًا في الاتجاه بين التصوّف وبيات التراث والتجديد، وغايته هي إيجاد التماهي والتناغم بين هذا الاتجاه، وينصبّ سعيه في هذا الإطار؛ إذ يحاول أنْ يجعل تراث التصوّف منسجمًا مع الاتجاه المنشود له. ولهذا السبب يتّجه الدكتور حسن حنفي نحو قراءة التصوّف.
إنَّ غرضنا من هذه المقالة هو بحث قراءة الدكتور حنفي عن التصوّف، وفي هذا السياق سوف نتعرّض أوّلًا إلى الشرح الأوّل للدكتور حنفي عن التصوّف، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى التحوّلات التي يجب أنْ تحدث ـ من وجهة نظره ـ في التصوّف ليكون له دور في مشروعه التجديدي. بيد أنَّ مسألتنا الأصليّة في هذه المقالة هي: هل يمكن اعتبار قراءة الدكتور حنفي للتصوّف تصوّفًا؟ وبعبارة أخرى: هل المسار العمودي في التصوّف من ذاتيّاته أم هو
أمر عرضي يتمّ الحفاظ في تحوّله إلى المسار الأفقي على بنيته وتركيبته العامّة؟ ربَّما أمكن القول إنَّ بحث هذا الجانب من الموضوع ضروري في جميع القراءات الظاهراتيّة عن التصوّف والعرفان والمدارس الحكميّة الإسلاميّة، من قبيل: الحكمة المشرقيّة لابن سينا، وحكمة الإشراق، والحكمة المتعالية، وسائر المدارس الشرقيّة. ولكنْ يمكن القول إنَّ هذا الموضوع قلّما حظي بالاهتمام. بيد أنَّ الذي يضاعف أهميّة بحث ودراسة هذا الموقف في مورد الدكتور حسن حنفي، يكمن في أنَّ قراءة التصوّف لم تحدث هذه المرّة من قبل أحد المستشرقين، بل من قبل شخص يعتبر نفسه منتميًا إلى التراث الإسلامي، ويدّعي ضرورة إحياء هذا التراث. ومن الضروري الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أنَّنا لا نجد بين المستشرقين الذين قاموا بقراءة التصوّف، بمَنْ فيهم هنري كوربان ـ الذي يبدي تماهيًا وتعاطفًا كبيرين مع التراث الإسلامي ـ مَنْ تحدّث عن ضرورة التحوّل في الرؤية العرفانيّة. ومن هنا فإنَّ اهتمام وتأكيد الدكتور حسن حنفي على هذه الناحية من الموضوع، هو الذي يُضاعف من أهمّية قراءته. ولهذه الغاية سوف نعمل أوّلًا على بيان فهم ظاهراتيّة الدكتور حنفي للتصوّف.
كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ المسألة الأساسيّة التي ينشدها الدكتور حسن حنفي هي تجديد التراث بشكل عام والتصوّف بشكل خاصّ، بحيث يساعد ذلك على حلّ المشكلات الماثلة أمام العالم الإسلامي. يتعيّن على الدكتور حنفي في إطار تحقيق هذا الأمر أنْ يصل إلى فهم عن التصوّف، بحيث يبقى التصوّف
(314)في سياق هذا التجديد تصوّفًا، ولازم هذا الأمر فهم الذات العامّة والشاملة لظاهرة التصوّف، والتي يمكن الوصول إليها من خلال وصف بنية وعي المتصوّفة. بيان ذلك أنَّ لوعي جميع الأشخاص ـ في الظاهراتيّة ـ بنية مشتركة، وأنَّ توصيف هذه البنية سوف يكشف عن ذات الظاهرة مورد التجربة. ومن هنا فإنَّه يعمد إلى تعريف أسلوبه المستفاد في فهم التصوّف، بقوله:
«تحليل الخبرات الشعوريّة لمعرفة مدی صدق التجارب التي يحلّلها الصوفيّة، ومدی تطابقها مع التجارب الإنسانيّة العامّة».
ليس هناك ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ سوى حقيقة واحدة لا أكثر، وهي تجربة الوعي، وإنَّ هذه الحقيقة رهن باحتياجات ومقتضيات العصور المختلفة من الحياة الاجتماعيّة، وتتغيّر بتغيّرها، وتكتسب صوَرًا مختلفة تبعًا لذلك. إنَّ تعميم هذه التجربة يؤدّي إلى جعل فهم تجربة أخرى في مقطع زمني أو جغرافي آخر ـ من خلال تجربة الذات ـ أمرًا ممكنًا، وبذلك يصبح من الممكن إقامة التواصل والارتباط بين الماضي والحاضر.
يرد البحث في مورد المتصوّفة عن تجربة عوالم ومراتب أخرى من الواقعيّة؛ حيث يكون هناك في تلك التجربة نوع من الاتحاد بين المدرِك والمدرَك.
«كما يتمّ السعي في الظاهراتيّة ـ من خلال ملاحظة الحيثيّة الالتفاتيّة للوعي ـ إلى اعتبار العلاقة بين المدرِك والمدرَك بوصفها نوعًا من الاتحاد الأصيل، إلّا أنَّ هذا الاتحاد يتمّ تصويره من خلال وضع الأعيان الخارجيّة جانبًا ـ بعد القيام بعمليّة تعليق الحكم أو وضع
جميع الأحكام المسبقة بين قوسين ـ ولا يبقى في البين أمر بدهيّ غير الظاهر، ليحصل بذلك الاقتراب من الماهيّة».
وبهذه الطريقة يتمّ وضع أكثر الفرضيّات المسبقة أصالة ـ أي الحكم بالوجود الخارجي للعالم ـ في حالة من التعليق. يدّعي إدموند هوسِرْل أنّنا بذلك ندخل في عالم جديد نوعًا ما تحت عنوان «التجربة الاستعلائيّة»، والذي تكون مساحته ـ من وجهة نظره ـ مساحة الحقيقة ذاتها، و«يوجد فيه أصل جميع مساحات الوجود الأخرى». وفي الحقيقة فإنَّه على هذا الأساس تكون ماهيّة التجربة العرفانيّة في الظاهراتيّة قابلة للفهم من خلال توصيف ذات تلك التجربة، بمعنى أنَّ العوالم العرفانيّة ليست منفصلة عن ذات العرفاء وتجاربهم. وفي الحقيقة فإنَّ الخوض في تجارب وعي الصوفيين يعني غضّ النظر عن الوجود ومراتبه، وإنَّ هذا الغضّ للنظر يعني أنَّه بدلًا من الاهتمام بمتعلّق التجربة ـ الذي هو في مورد العرفاء ذات الوجود ومراتبه، ويبدو أنَّه ذات الموضوع الذي يميّز حياتنا المعاصرة من حياة العرفاء ـ يتمّ تركيز البحث على ذات تجربة الوعي بوصفها أمرًا مشتركًا. وقد ذهب الدكتور حسن حنفي من خلال علمه بهذا الموضوع إلى تعريف مفاهيم التصوّف بوصفها موضوعًا منبثقًا عن تجاربهم، لا سيّما وأنَّ المتصوّفة أنفسهم يؤكّدون على أهمّية الذوق والتجربة، ومن هذه الناحية يكتسبون في التراث القديمة حالة استثنائيّة وفريدة.
إلّا أنَّ هذه التجارب إنَّما تكتسب أصالتها ـ من وجهة نظر الدكتور حسن
حنفي ـ إذا كانت تنطوي على مضمون اجتماعي، وبذلك يمكن إدراجها ضمن التراث، وقراءة التراث بوساطتها. وفي الحقيقة فإنَّ التجارب إنَّما يمكن أنْ تتحوّل إلى فكر، ويتمّ وضعها في مشروع التجديد بهذه الطريقة. وعلى هذا الأساس، فإنَّه يورد عليها هذا الإشكال أيضًا، وهو أنَّ هذه التجارب العرفانيّة هي في الغالب أمور شخصيّة، وقلّما تكون علميّة ونظريّة، ومن هنا فإنَّها تكون مفتقرة إلى جميع أنواع المضامين الاجتماعيّة. إنَّ هذا النوع من التجارب يمكن له ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ أنْ يكون بمنزلة التدارك والتعويض عن خسارة وإفلاس علمي حقيقي أو غطاء لا شعوري للخسائر في الحقل الاجتماعي والحضاري. ومن هنا فإنَّ الدكتور حنفي يعمل ـ من أجل بيان هذا الموضوع ـ على بحث خلفيّات تبلور التجارب الخاصّة للصوفيّة، ليجعل بذلك فهم بعض العناصر ـ التي تبعد المتصوّفة عن الشكل الأصيل للتجربة ـ أمرًا ممكنًا.
يذهب الدكتور حسن حنفي إلى اعتبار علوم التصوّف بوصفها من جملة العلوم التراثيّة، كما هو الحال بالنسبة إلى علم الحكمة، وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، مع فارق أنَّ علوم التصوّف تقوم بشكل محدّد على الأسلوب الذوقي، إلّا أنَّه يعزو سبب خلوّ هذا الأسلوب الذوقي من أيّ مضمون اجتماعي إلى نشوئه من الأحداث التاريخيّة التي جعلت الفكر والنشاط في مورد الحقائق الاجتماعيّة يواجهان طريقًا مسدودًا، ويؤدّيان إلى تبلور تيار التصوّف والاتجاه
إلى شكل خاصّ من التجربة. يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ الأرضيّة الاجتماعيّة والسياسيّة لتبلور التصوّف، تعود إلى المرحلة الزمنيّة لتشكّل تيّارين في المجتمع الإسلامي، وهما تيّار المتّقين، وتيار أهل الدنيا؛ حيث كان الإمام علي ابن أبي طالب عليهالسلام يرأس تيّار المتّقين، بينما يرأس معاوية بن أبي سفيان تيّار أهل الدنيا. وفي الحقيقة فإنَّ الدكتور حسن حنفي من خلال تعريفه بجبهة المتّقين، إنَّما كان يعمل على التعريف بالتيّار الذي كان يتمتّع في التراث الإسلامي بتجربة الوعي الأصيل؛ إذ كانت غايتهم تكمن في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، والعمل من أجل تطابقه مع الشريعة. وقد اعتبر التعامل الظالم والقمعي مع جبهة المتّقين واستشهاد الأئمّة الأطهار وأهل البيت عليهمالسلام ولا سيّما فجيعة كربلاء، بوصفه عاملًا حاسمًا في تبلور التصوّف؛ إذ إنَّ هذه الأحداث كانت تعني بالنسبة إلى البعض أنَّ السعي من قبل جبهة الحقّ من أجل تغيير الواقع الاجتماعي وإحياء دولة الشرع، لم يكن ناجحًا، ويجب اتخاذ أسلوب آخر؛ وذلك لأنَّ أهل الدنيا لم يتمكّنوا من الاستيلاء على الحكم والسلطة إلّا بعد ارتكابهم لتلك الفجائع وحرمان أهل الحقّ من حقوقهم. وبعد ذلك تبلورت ردّة فعل تجاه الوضع القائم؛ إذ اختار فيه بعض الأشخاص سلوك طريق تهذيب النفس والإعراض عن الدنيا، وبدلًا من الخوض في العالم الخارجي، بنوا لأنفسهم عالمًا روحيًّا باطنيًّا جديدًا، وعملوا بذلك على تحويل الخسارة الخارجيّة إلى انتصار داخلي، والسلطة الخارجيّة إلى حريّة داخليّة، وبذلك تبلور التصوّف بما هو نشاط روحي يأتي كردّة فعل على الإسراف والتطرّف الدنيوي.
(318)كما أنَّ هناك عوامل أخرى حالت دون أنْ يلعب العقل دورًا في التجربة العرفانيّة، وكان هذا الوضع قائمًا في القرن الهجري الخامس؛ وقد تحوّل العقل والطبيعة ـ في ضوء تحليل الدكتور حسن حنفي ـ في هذه المرحلة، إلى المصدر المعرفي الوحيد. بيد أنَّ النشاط العقلي الذي كان قد بدأ منذ القرن الرابع للهجرة، أدّى في القرن الخامس للهجرة إلى ظهور واسع للمدارس الفكريّة، وهذا الأمر لم يكن مطلوبًا بالنسبة إلى الذين يعتبرون الحقيقة أمرًا واحدًا. إنَّ هذا الأمر قد أدّى إلى حالة جعلت من الحقيقة أمرًا متعدّدًا، كما تكثّرت أساليب الوصول إلى الحقيقة أيضًا، وكانت تعرّض الأشخاص إلى التشويش في اختيارها؛ إذ لم يكونوا يعملون على انتخاب شيء حتّى يقام دليل على الضدّ منه، وكان هناك في هذا المجال تكافؤ في الأدلّة. إنَّ هذا الموضوع أدّى بالبعض إلى الاعتقاد بأنَّ هذه الوضعية ناشئة من محوريّة العقل، وقد لجؤوا إلى الأسلوب الذوقي للخلاص من ذلك. ومن ناحية أخرى، كان الدين قد تحوّل في هذه المرحلة إلى مجرّد مناسك خارجيّة تخلو من الحياة الباطنيّة، وكان بمقدور الاستناد إلى الذوق واللجوء إلى الأمور الباطنيّة أنْ يعيد روح المناسك إليها. وبالنظر إلى أنَّ المجتمع الإسلامي بدوره كان قد وصل في هذه المرحلة إلى حالة الإفراط في اكتناز الثروة والإسراف، وكان الجميع يسعى وراء الحصول على الثراء، فإنَّ اللجوء إلى الأمور الباطنيّة كان من شأنه ـ من وجهة نظر هذه الطائفة ـ أنْ يشكّل سدًّا منيعًا أمام هذا التيّار.
كما أنَّ الدكتور حسن حنفي يرى أنَّ المنشأ المعرفي لتبلور التصوّف هو
(319)العقائد الأشعريّة، أو أنَّه يشعر بوجود ارتباط وثيق بينهما. لقد كان التيّار الأشعري مطروحًا منذ بداية قيام الحضارة الإسلاميّة، وعلى أساس الرأي المطروح فيه، كان الله يحكم العالم الخارجي والإنسان بما يتّصف به من الذات والقدرة المطلقة، ولا يمكن لأيّ شخص أنْ يقف في وجه إرادته. إنَّ هذا الفهم الديني لله سبحانه وتعالى ينطوي ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ على معنى خاصّ لمفهوم التعالي، حيث يشتمل على بعد أنطولوجي. إنَّ تصوير الله سبحانه وتعالى بوصفه وجودًا مطلقًا وقادرًا على كلّ شيء، مهّد الأرضيّة لترجيح القدرة على العلم، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تبلور أنظمة سياسيّة واجتماعيّة يكون فيها الحاكم قادرًا مطلقًا، وأنَّ قدرته أكبر من علمه. كما أنَّه يصوّر مفهوم خلق العالم من العدم على أنَّه معدوم يتعلّق به الوجود بعد العدم، وعلى هذا الأساس، لا يكون في ذاته مبنى للوجود، وما دام أنَّه موجود من اللاشيء، فإنَّه سوف يتّجه نحو العدم. وعليه، فإنَّ وجود العالم في البداية والنهاية مقرون بالعدم، بخلاف الله سبحانه وتعالى الذي هو موجود على الدوام، وقد ساعد هذا الرأي الكلامي على تقوية رؤية الصوفيّة. ومن هنا فإنَّ المنهج الباطني والاهتمام بالتحوّل الداخلي للمتصوّفة، بما هو سعي إلى الاتحاد مع تلك الذات المتعالية إلى بلورة السير إلى الفناء، قد أدّى إلى تبلور تجارب خاصّة في الحياة العمليّة للمتصوّفة، وعلى هذا الأساس يكون المتصوّف قادرًا على بيان المفاهيم التي يعتبرها مفيدة للباحثين. إنَّ زيادة حجم هذه التجارب يؤدّي إلى خلق بيئة يمكن للأفراد فيها أنْ يجدوا
أنفسهم واجدين لتجارب مشتركة مع بعضهم، وإنَّ هذا الأمر يؤدّي بهم إلى القول بنوع من العينيّة لتجاربهم، وأنْ يحكموا ـ على أساس الرأي الطبيعي ـ بالوجود العيني والخارجي لمنشأ تجاربهم، وذلك على شكل كما لو أنَّ العوالم التي تمّت تجربتها موجودة بشكل مستقلّ عن عوامل التجربة.
يذهب الدكتور حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ هذه المسائل بأجمعها قد أدّت ـ بعد خسارة تيّار المتّقين وانتصار أتباع الدنيا ـ إلى عودة التقوى إلى أصلها في النفس الإنسانيّة، وتخلّى المتّقون عن الدنيا أو أُجبروا على فعل ذلك. إنَّ أكثر الأشخاص بدلًا من التبعيّة للمُثُل المتعالية، قد نظروا إليها بوصفها أحلامًا جميلة لا تتجاوز التفكير البحت، واتّبعوا في حياتهم العمليّة آثار الجماعة الأخرى، فبدلًا من أنْ يعملوا على تغيير الآخرين، قاموا بتغيير أنفسهم، وبدلًا من أنْ يخضعوا الدنيا لإرادتهم، طوّعوا إرادتهم لتكون مطيعة للأمور الدنيويّة. وعلى هذه الشاكلة، فقد تمّ تفريغ الإرادة من المحتوى، ولم يعد بمقدورها أنْ تفعل شيئًا أو أنْ يصدر عنها عمل، وأصبحت فاعلة ومفعولة.
وكان في ظلّ هذه الظروف أنْ تبلورت التجربة الصوفيّة الخاصّة، وأضحت أساسًا لتبلور علوم التصوّف. وحيث أنَّ كلّ تجربة إنَّما تتبلور في إطار الارتباط مع شيء، فإنَّ الدكتور حسن حنفي قد تعرّض في بيان التجربة الصوفيّة إلى توضيح متعلّقها، ومن خلال تحليله لنوع النسبة القائمة في هذا الشأن، عمد أولًا إلى بيان أسباب وعلل الاتجاه الخاصّ ـ من قبل المتصوّفة ـ نحو متعلّق تجربتهم، وقام بعد ذلك بشرح مسار تبلور هذا المتعلّق، وتعرّض في نهاية المطاف إلى بيان نتائج ومعطيات هذه التجربة. وقد عمل حنفي ـ في
(321)معرض بيان الموارد المذكورة ـ على الاستفادة من موقع التأويل في التصوّف، ودرس أهمّية ودور النصّ في الارتباط مع تجربة التصوّف، موضحًا كيفيّة نشوء علوم التصوّف ـ ونعني بذلك: علم الأخلاق، وعلم النفس، وعلم ما بعد الطبيعة ـ ضمن هذه العلاقة.
كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ الدكتور حسن حنفي يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ جذور الاتجاه نحو النصّ وتأويله، تقع في طريق مسدود من التغيير الاجتماعي. وبعد أنْ وصل أنصار إحياء الشريعة إلى طريق مسدود، جنحوا نحو الباطن وتغيير الداخل، وبدلًا من أنْ يعملوا على توظيف النصّ من أجل تغيير المجتمع والثقافة والسياسة، تعاملوا معه بوصفه مرشدًا في عمليّة التغيير الباطني. وكان ذلك من وجهة نظرة الدكتور حنفي بمعنى التغيير في دائرة مساحة الفعل والانفعال:
«في مرحلة من الزمن تخلّى النزوع نحو إصلاح المجتمع عن مكانه لصالح التصوّف، وحيث تمّ التخلّي عن السياسة والمجتمع بوصفهما حقلًا للعمل، فقد سعى المتصوّفة إلى أنْ يشكّلوا حقلًا للفعل البديل للنشاط في الحقل السياسي، وحيث كان مبنى فعليّتهم هو الشرع، والشرع بدوره تمتدّ جذوره في القرآن، فقد عمدوا من هنا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم بوصفه أساسًا للشرع، وسعوا إلى العثور على مبنى العرفان لا في العالم، وإنَّما في القرآن».
(322)لقد اقترن هذا الأمر بنوع من العودة إلى الماضي. وبعبارة أخرى: بعد أنْ يئس بعض الأشخاص من تغيير الوضع القائم، أصيبوا بنوع من الاغتراب عن الزمن الحاضر، وتخلّوا عن الوضع القائم، واتجهوا نحو الماضي الذي لم يكن قد ابتلى بالمصائب الراهنة. إنَّ الماضي الجميل الذي كان فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله هو المحور، كان أنسب بالنسبة لهم من الزمن الراهن الذي لم يعد متشرّعًا، وكانت مدينة النبيّ أفضل من المجتمع الدنيوي. وعلى هذه الشاكلة فقد كان للنبيّ في أذهانهم ـ بوصفه أستاذ العرفان ـ منزلة خاصّة، وكانوا يعدّون الصحابة تلاميذ النبي في العرفان، وقد تحوّل القرآن بدوره إلى نصّ عرفاني.
كان بإمكان الصوفيّة ـ من خلال تقديم القرآن الكريم بوصفه نصًّا عرفانيًّا ـ أنْ يتحرّروا من قيود اللفظ؛ إذ مع القول بمعنی وراء الألفاظ المتكثّرة، فإنَّ كثرة الألفاظ التي كانت تمثّل نموذجًا لكثرة بيان الحقائق، وكانت تمثّل أداة بيد المغرضين، كانت تسوق التصوّف نحو حقيقة وراء الألفاظ، حيث كانت الألفاظ تعدّ تصويرًا عن تلك الحقيقة. إنَّ الصوفيّة بعد سقوط العالم المادّي تحت يد الأشرار، حيث رؤوا استحالة التغيير والإصلاح، صاروا بصدد البحث عن عالم آخر، عالم ينتمي إلى مرتبة أعلى وأسمى؛ أي: عالم المعنى، ولهذا السبب لم يقعوا في عرض الكون والفساد.
إنَّ الذي كان يساعد المتصوّفة ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ في الارتباط مع العالم المذكور، هو التأويل. لقد كان التأويل أداة بيدهم، لكي يغلقوا أعينهم عن أيديهم الفارغة في العالم المادّي، ليجدوها مملوءة في عالم
(323)المعنى، وبذلك فإنَّهم سوف يصلون من مضيق اليأس إلى واحة الأمل. كما أنَّ الأنس مع النصّ من طريق التأويل كان ينطوي على هذه الخصّيصة، وهي أنَّهم من الناحية النفسيّة ينزعون إلى التخلّص من التضادّ والنزاع المرتبط بالوضع القائم، ويقبلون نحو القيَم السلبيّة، من قبيل: الصبر، والتوكّل، والرياضة، والتقوى، والعزلة، والتسليم، وما إلى ذلك. وبذلك فقد شكّل التأويل وسيلة للعودة إلى الأحاسيس الداخليّة، وسجّل مسارًا تؤدّي مراحله المختلفة إلى بلورة المقامات العرفانيّة. إنَ هذا الطريق الجديد عمد إلى تحويل سلوك الجدال بين المثاليّة والانتصار للوضع القائم إلى الاتحاد بين الله والعالم، وحوّل الخسارة السياسيّة في العالم إلى انتصار فيما وراء التاريخ.
إنَّ الدكتور حسن حنفي في بيان نسبة تأويل النصّ إلى التصوّف، يستفيد من توضيح الجذر اللغوي لذلك؛ فقد عمد أوّلًا إلى بحث هذه المسألة، وهي أنَّ المعنى اللغويّ لمفردة «النصّ» هو الخروج والظهور والبروز، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار النصّ بوصفه شيئًا يشير إلى شيء آخر ويدلّ عليه، وبناء على ذلك يكون لكلّ نصّ مدلول. ومن ناحية أخرى، فإنَّ الجذر اللغويّ لكلمة التأويل يعود إلى «الأوّل»، وعلى هذا الأساس يكون معنى تأويل النصّ هو إعادة النصّ والحرف واللفظ والعبارة إلى المصدر الأوّل، ورجوع الفرع إلى أصله. وعلى أساس هذا الفهم، يكون التأويل عبارة عن مسار إعادة النصّ إلى المعنى الذي رصد له في الأصل، وهو المعنى الكامن والخفيّ، ونصل إليه بوساطة النصّ الواضح والمحسوس، ومن هنا يكون
(324)التأويل عبارة عن الذهاب من الظاهر إلى الباطن، ومن الخارج إلى الداخل، ومن المكان إلى الزمان، ومن الحرف إلى الروح. إنَّ هذا النوع من المواجهة مع النصّ يميّز التأويل من التفسير. ومن خلال المقارنة بين كلمتي (Exegesis) و(Interpret)، واللتين تعنيان على التوالي: التفسير والتأويل، فإنَّ حرفي (Ex) في بداية الكلمة الأولى يدلّان على الخارج، وإنَّ حرفي (In) في بداية الكلمة الثانية يدلّان على الداخل، وعلى هذا الأساس يكون التفسير هو التحليل اللفظي والنحويّ للعبارة، وأمّا التأويل فهو إدخال النصّ إلى الداخل وإلى أعماق النفس.
كما سبق أنْ أشرنا، فإنَّ الدكتور حسن حنفي يرى أنَّ جذور جميع علوم التراث ـ ومن بينها التصوّف ـ تعود إلى الوحي، وفي البين فإنّ بعض العلوم، من قبيل: الفقه والنحو والتاريخ، ترتبط بأصحاب الظاهر، وإنَّ مواجهتها مع النصّ تكون في إطار التفسير، وإنَّ التصوّف هو الذي يتعامل مع الباطن، ويعمل على تأويل النصّ. بالنظر إلى أنَّ التأويل يعني عودة المعنى إلى الأصل، فإنَّ الدكتور حسن حنفي يطرح ـ في سياق فهم التصوّف ـ هذا السؤال فيما يتعلّق بالتأويل، ويقول: أين يكمن الأصل في رأي المتصوّفة؟ فهل هو في الذهن، أم هو في الوعي، أم في الواقع؟ وحيث أنَّ مقدّمة رجوع الصوفيّة إلى النصّ كانت عبارة عن الإعراض عن الواقع، وبالنظر إلى أنَّهم كانوا بصدد البحث عن مرتبة أسمى من الواقعيّة، وكانوا يبحثون عن ذلك في النصّ، وكذلك بالنظر إلى أنَّ التأويل
يعني إعادة المعنى إلى أعماق النفس، يكون الأصل ـ على هذا الأساس ـ مستقرًّا في أعمق الطبقات الداخليّة من النفس. وحيث يكون هناك على الدوام ارتباط بين الداخل والخارج، وتخرج الواقعيّة السياسيّة والاجتماعيّة والمحسوسة من مركز الاهتمام، فقد عمد الصوفيّون ـ من خلال اللجوء إلى المراتب الأخرى من الواقعيّة ـ إلى إصلاحها بوساطة قوّة الخيال، وقاموا بتأسيس نظام أخلاقي ووجودي، وعمدوا إلى قراءة النصّ على هذه الشاكلة. كما أنَّهم بالرجوع إلى الماضي، عمدوا إلى إصلاحه على هذه الشاكلة أيضًا، وعمدوا إلى تبويب بيانهم عن شخصيّة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوأصحابه وتعاليمهم، وكذلك سائر الأولياء والأنبياءعليهمالسلام على هذا الأساس أيضًا. يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ هذا الأمر قد دفع الصوفيين إلى سلوك مسار آخر، وبدلًا من أنْ يأتوا بمشروع جديد لتغيير الواقع الذي يبدو الزمان فيه غير قابل للتغيير، بادروا إلى بناء عالم آخر، وسعوا إلى التأقلم معه. وقال في هذا الشأن ما نصّه:
«يُبدع التصوّف عالمًا من صنع الخيال الخلّاق بديلًا عن عالم الواقع الذي تمّ نفيه واستبعاده والتراجع عنه بعد أنْ أصبح عصيًّا علی الطاعة لا يمکن تغييره: علم الخيال ميسور خلقه، يسهل اتّباعه».
وبعد بيان أنَّ المراد من الخيال من وجهة نظر الصوفيّة ليس من صنع الوهم، بل هو حقيقة بديلة تصنعها الروح وينسجها الخيال، يعمد الدكتور حسن حنفي إلى التعريف بالعالم الذي يُبنى على هذه الشاكلة، هو عالم الأقطاب والأبدال، وعالم الأرواح المتآلفة، وعالم الملأ الأعلى.
يذهب الدكتور حسن حنفي إلى الاعتقاد بأنَّ الذي يحدث بعد هذا الاستبدال، هو سعي الصوفي من أجل الحصول على شرائط العضويّة والانتساب إلى هذا المجتمع. ومن هنا فإنَّه يقبل نحو القيَم السلبيّة التي تدعو إلى الفقر والخوف والجوع والصبر والتوكّل والرضا والقناعة. وعلى الرغم من كلّ ما يحدث في إطار الدفاع عن النفس، إلّا أنَّ الاتجاه العام والرئيس يسير في طريق تضعيف النفس؛ وذلك لأنَّ الفضائل التي يذكرها الصوفيّون، إنَّما هي للصبر على المصائب الناشئة من الحياة في عالم الواقع. إنَّ المهمّة الأصليّة للعقل ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ هي تحليل الواقع، وإنَّ الصوفيّة بسبب يأسهم من هذا الأمر، أخذوا يطرحون بحث القلب، والذي يؤدّي إلى معارف لا تقوم على العقل، وإنَّما يكون منشؤها هو القلب. وعلى هذا الأساس، يذهب الدكتور حسن حنفي إلى القول بأنَّ الصوفيّة حيث لا يرون وجودًا للعلم، وتكون المعرفة مفقودة، فإنَّهم يعملون على طرح علم آخر يتمّ الحديث عنه تحت عنوان العلم اللدني، ويقيمون حياتهم على أساسه، ويزرعون هذا الأمل في المخاطب بأنْ يحدث لديه، خلال العديد من الأسفار الروحيّة، حالة من الكشف ورفع الحجاب، ويكتب التحقّق للغاية الخاصّة التي تمّ التأسيس لها من طريق الخيال، وتكتسب صورة الفعليّة أيضًا.
ورد البيان الجامع والكامل لعلوم التصوّف من قبل الدكتور حسن حنفي في مجلّدين من كتابه (من الفناء إلى البقاء)، ويتبيّن اتّجاهه في قراءة التصوّف حتّى من عنوان هذا الكتاب بوضوح لا غبار عليه؛ فهو في تحقيق مفاهيم وآراء المتصوّفة
(327)يبحث النماذج التي تحدّد النشاطات والتكاليف الاجتماعيّة للمتصوّفة، وتعمل على تشكيل وبلورة حياتهم. لقد تمّ بيان هذه المفاهيم والأصول في إطار علوم التصوّف، وكذلك تمّ بيان المراحل التي تتحقّق فيها تلك المفاهيم المذكورة. إنَّ مسائل الدكتور حسن حنفي في هذا الشأن، تقع في مورد الاتجاهات التي تسلكها حياة الإنسان في هذه العلوم، وما هي الغاية التي تنشدها هذه العلوم. وكذلك فإنَّ التحقيق حول منزلة الإنسان في التصوّف واحد من أهمّ المسائل التي يسعى الدكتور حنفي إلى تحقيقها، وعلى هذا الأساس، فإنّه يعمل على بيان علوم التصوّف، وهي عبارة عن: علم التصوّف الأخلاقي، وعلم التصوّف النفسي أو الداخلي، وعلم التصوّف الفلسفي.
إنَّ العلم الأوّل المطروح في التصوّف، والذي يعمل الدكتور حسن حنفي على بيانه، هو علم التصوّف الأخلاقي.وهو عبارة عن بيان السير من الفقه إلى الأخلاق، ومن الرذائل إلى الفضائل. في التصوّف الأخلاقي الذي يختار له الدكتور حسن حنفي عنوان الوعي الداخلي، يأخذ الوعي الداخلي بعين الاعتبار بوصفه تجربة عرفانيّة. وفي الحقيقة فإنَّ التصوّف الأخلاقي بيان للطريقة، ويتبلور من خلال التمايز بين العمل بالشريعة والعمل بالطريقة، والتمايز بين الأعمال البدنيّة والأعمال القلبيّة في الأحكام الخمسة. إنَّ بيان الطريقة كان لغرض تدارك وجبران نقص سبق له أنْ ظهر فيما يتعلّق بالمناسك، والغاية من ذلك إرجاع روح الأعمال إليها. في هذه الرؤية يكون الوصول إلى
الحقيقة من طريق أعمال القلوب أمرًا ممكنًا، ولكنْ في الوقت نفسه لا يمكن لأعمال القلوب أنْ تتحقّق من دون المناسك والعمل بالشريعة. في هذه الرؤية يكون ظاهر الشعائر في علم الفقه، وباطنها في علم التصوّف، ويكون هذان العلمان متلازمين. وعلى هذه الشاكلة يتبلور التصوّف الأخلاقي من خلال تبديل الحلال والحرام من موضوع فقهي شرعي إلى موضوع أخلاقي في نفس الإنسان، ومن خلال الرجوع إلى النصّ وتأويله، والتعلّق بالماضي الذي هو الدافع من الرجوع إلى الحديث والسيرة وكلام الزهّاد والصوفيّة. وفي المرحلة التالية يعمد علم التصوّف الأخلاقي إلى بلورة علم الرذائل والفضائل، حيث يتمّ التعرّف عليهما في إطار الجدل المستمرّ بينهما، ويكون همّ الصوفي منعقدًا على تخلية النفس من الرذائل تمهيدًا لإفساح المجال للفضائل؛ وهذا يعني أنَّ السلب متقدّم على الإيجاب، وما لم يتم تفريغ النفس من الرذائل، لا يمكن تحصيل الفضائل. إنَّ تقابل الرذائل والفضائل ليس هو من قبيل تقابل الخير والشر؛ وذلك لأنَّ الفضائل والرذائل مكتسبة، بينهما الخير والشرّ من الأمور الفطريّة. إنَّ الرذائل والفضائل تستنبط من النصّ، ولا رابط لها بالواقع الاجتماعي الذي تحقّقت في صلبه؛ لأنَّ الأخلاق بيان لما يجب أنْ يكون، وليس توصيفًا لما هو كائن. يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ الامر البارز في التصوّف الأخلاقي، هو فرديّة الأخلاق، وقد تعرّض في ختام قسم الرذائل إلى ذكر مطالب تحت عنوان فساد العصر، حيث نقل فيه رذائل الأزمنة المختلفة عن
كلام العرفاء، وأنَّه كيف ترتبط الرذائل مع الزمان، وبالتالي مع المجتمعات الخاصّة. بالنظر إلى أنَّ الحركة في التصوّف الأخلاقي من الرذائل إلى الفضائل، وبالنظر إلى تأكيد الدكتور حسن حنفي على أنَّ مفهوم «الأدب» إنَّما هو لبيان تغيير النفس دون الآخر، يبدو أنَّ الدكتور حنفي يستفيد من هذا الموضوع لبيان المسار المتصاعد لفرديّة الأخلاق عند العُرفاء.
إنَّ التصوّف الداخلي أو النفسي بيان لمقتضيات العلم النفسي للتصوّف الأخلاقي، حيث يتعرّض إلى بحث موضوع النفس ومقاماتها وأحوالها. إنَّ هذا القسم من التصوّف الأخلاقي يمكن اعتباره من الأنثروبولوجيا الفلسفيّة التي تتضمّن بيان العلاقة بين النفس والجسد، وتعريف النفس، وبيان مراتبها، وكذلك توضيح مراتب الوجود الإنساني فيما وراء النفس؛ أي الروح والقلب والعقل من وجهة نظر العرفاء. إنَّ بيان هذه المراتب قد أخذ في الواقع بوصفه مقدّمة لبيان المسار العمودي للسلوك الإنساني، وبيان كيف تكون معرفة النفس من وجهة نظر العرفاء بوصفها معرفة الله سبحانه وتعالى. لقد وجد الدكتور حسن حنفي أنَّ القلب ـ من وجهة نظر العرفاء ـ محلّ للفضائل، وأنَّ النفس محلّ للرذائل، وأنَّ القلب هو العامل الرئيس في المعرفة عند الصوفيّة، ومن خلاله يتحقّق الكشف والشهود، وأنَّ العقل هو العامل في تشخيص النفع والضرر وتشخيص طرق الخلاص من الضرر والوصول إلى النفع، وبطبيعة الحال، فإنَّ النفع الأساسي لا يتحقّق إلّا بالتحرر من الدنيا. إنَّ الصوفي يحصل ـ من طريق الابتعاد عن الرذائل
وتحقيق الفضائل ـ على مقامات وأحوال في تجربته الداخليّة، ومن هنا لا تكون مجرّد مصطلحات بحتة، بل هي معان وحقائق وراء الألفاظ وفي القلوب والتجارب الداخليّة والوعي والإدراك. إنَّ مسار تحقّق الأحوال والمقامات يكون على النحو الآتي: حيث يكون الإنسان ـ من طريق ظهور صلاحيّة ـ مشمولًا للحصول على حال بمثابة موهبة إلهيّة، وإنَّ هذه الخصوصيّة التجريبيّة ليس لها استمرار ودوام، وإنَّما تتحوّل إلى المقام بوساطة مجاهدة النفس. ومن هنا فإنَّ المقامات تكون اكتسابيّة، وإنَّ التحقّق مشروط بظهور الحال المتناسب معها، وإنَّ الاستيفاء الكامل للحقوق في المقام هو الذي يمنح الإنسان صلاحيّة الدخول إلى المقام الأعلى. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الحالات والمقامات علامات ومراحل لمسار يجتازه الإنسان في طريق القرب من الله سبحانه وتعالى، ويكون له اتجاه عمودي. إنَّ المقامات التسعة عبارة عن: التوبة، والصبر، والشكر، والرجاء، والخوف، والزهد، والتوكّل، والرضا، والمحبّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ الصوفيّة يختلفون في عدد المقامات وفي ترتيبها وتسلسها، وإنَّ التبويب الأوّلي من قبلهم، يتحقّق من طريق التأمّل في القرآن الكريم، والأحاديث النبويّة، وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الصوفيّة، ويشكّل أفقًا لمسار سوف يسلكه العارف بوساطة التجربة.
إنَّ موضوع التصوّف الفلسفي هو التوحيد، والإنسان الكامل، والنبوّة، والمعاد. وقد عمد الدكتور حسن حنفي في مسألة التوحيد إلى بحث علم
الكلام الصوفي، والذي يمثّل في الواقع قراءة جديدة لمسألة الذات والصفات على أساس رؤية الأشاعرة، ويُعدّ من هذه الناحية ردًّا على سائر الفرق الكلاميّة الأخرى. يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ علم الكلام الصوفي يهدف إلى تحقيق غايتين، إحداهما توفير الغطاء الشرعي لعقائد الصوفيّة، وإثبات أنَّ العقيدة الصوفيّة لا تخرج عن العقيدة الإسلاميّة، ومن هذه الناحية يدخل التصوّف في علم أصول الدين. لقد وجد الدكتور حسن حنفي أنَّ علم أصول الدين الصوفي علم من أجل تمييز الأصول من الفروع، وهو علم يسعى ـ من خلال التأكيد على الناحية التأسيسيّة للعلوم ـ إلى الحيلولة دون انقلاب النسبة بين الأصول والفروع. ومن هذه الناحية تعدّ العبادات نقطة انطلاق صيرورة الصوفي، إلّا أنَّ هذا لا يمثّل أصل التديّن، وإنَّ الغاية التي تتحقّق بهذه الطريقة ـ ونعني بها معرفة الله ـ تُعدّ هي الأصل. والغاية الثانية هي إرجاع الكلام الصوري إلى جذوره في التجربة المعاشة، وبذلك يعود الكلام الصوري إلى المادّي، والكلام الانتزاعي إلى الكلام الخارجي، والكلام العقلي إلى الكلام القلبي، والكلام الجدلي إلى البرهان الكشفي.
قد يجب في التصوّف في بعض الموارد العمل على مراعاة بعض القواعد من أجل الحصول على تجربة معنويّة أصيلة، ومن ذلك الانقطاع عن الأصدقاء، والهجرة من الوطن، ونسيان العلم والجهل، وعدم ادّخار المال وما إلى ذلك. ويرى الدكتور حنفي أنَّ هذه هي الأمور التي لا تنسجم مع
التجربة المعاشة في عصرنا الراهن. إنَّ إيمان الصوفيّة هو الإيمان الأشعري ذاته ـ والذي يكون من وجهة نظرهم ـ مقرونًا بالعمل، وبطبيعة الحال فإنَّ اهتمام الصوفيّة بأعمال القلوب وضرورة التجربة الباطنيّة، لا يُلاحظ من وجهة نظر الدكتور حنفي بوصفه عنصر تمايز جوهري. كما يُشير الدكتور حسن حنفي إلى هذه المسألة، وهي أنَّ مبنى العرفاء في بحث التوحيد هو الوجود، وهذا الأمر يستوجب بيان تمايز جوهري آخر بين الصوفيّة والأشاعرة؛ إذ يخالفون على هذا الأساس نظريّة الأشاعرة القائمة على زيادة الوجود على الماهيّة، وزيادة الصفات على الذات، كما أنَّهم لا يطيقون التمايز الأنطولوجي والوجودي بين الخالق والمخلوق. إنَّ الوجود في هذه الرؤية إنَّما يتعلّق بالله سبحانه وتعالى، وإنَّ الفعل الحقيقي ـ بدوره ـ إنَّما يتعلّق به، وإنَّ الآخرين فاعلون على نحو المجاز.
يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ نظريّة الإنسان الكامل تمثّل دليلًا على الاتجاه الإنساني في التصوّف، وفيها يتمّ توضيح الانتقال من الإنسان الوجودي إلى الإنسان الإلهي. إنَّ مراحل تحقّق الإنسان الإلهي تبدأ بالإنسان الواقعي والمادّي، وبعد ذلك الإنسان المثالي، حيث تكمن خصّيصته الجوهريّة بالفكر والروح. وفي المرحلة اللاحقة يأتي الإنسان القطب الذي هو نتيجة لتحوّل الإنسان المثالي إلى واحد من العوالم، وإنَّ الإنسان هو محور الأفلاك. وبعد ذلك يقع الإنسان الذي هو نموذج الوجود، وهو الحقيقة المحمّدية ذاتها المساوية للعقل الأوّل، والمرحلة الأخيرة من الإنسان الإلهي. إنَّ الذي يحظى
بالأهميّة ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ فيما يتعلّق بالنظريّات الصوفيّة حول النبوّة، هو نوع من القراءة الفلسفيّة لديهم عن تطوّر النبوّة في التاريخ، وتكمن أهمّيته في المخالفة مع الرأي الشائع في مورد الوحي، والذي على أساسه يكون الوحي ثابتًا وخارجًا عن التاريخ. والنقطة الأخرى المهمّة هي وحدة الأديان، والتي على أساسها تكون الأديان في الحقيقة شيئًا واحدًا، وإنَّما تتعدّد في الفروع. كما أنَّ المعاد أیضًا یتصوّر لديهم ـ حسب قراءة حنفي ـ من بين مضامير الخيال وقياس الغائب على الشاهد، ونوع من توظيف الأدبيّات الإنسانيّة واللغة المقتبسة من العالم الحسّي فی بيان المعاد.
وبشكل عام، فإنَّ الذي وجده الدكتور حسن حنفي في التصوّف، يمكن رؤيته في القيَم التي تعمل على تحديد الإنسان في الحقل الفردي، وعزلته عن التغيير الاجتماعي، وتسوقه نحو التغيير الفردي والداخلي. يرى الدكتور حسن حنفي أنَّ هذا الاتجاه يرسم أفقًا للحياة الإنسانيّة يتضمّن صيرورة عموديّة يتمّ التعبير عنها بـ «الطريق إلى الله»، وفيها يتجرّد الإنسان من الصفات والخصائص الإنسانيّة، ويسعى إلى تحقيق الخصائص والصفات الإلهيّة في وجوده. وفي الحقيقة فإنَّ الإنسان في هذا المسار يقع في هامش الله، ويغترب عن ذاته، ويفقد الارتباط مع الواقع أيضًا.
إنَّ الوحي من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي، هو المحور الأصلي في الحضارة الإسلاميّة، وحيث أنَّ بإمكانه أنْ يقيم الارتباط مع الواقع في جميع مراحله
التاريخيّة، فإنَّه يكون هو المنشأ الأصلي لتبلور وتأسيس العلوم الإسلاميّة. ويقول الدكتور حنفي في ذلك:
«النصّ هو الواقع علی ما هو معروف من «أسباب النزول»، وهي الوقائع الأولی التي جاء النصّ واصفًا ومشرّعًا لها، وکذلك «الناسخ والمنسوخ» اللذان يدلّان علی تکيّف الوحي طبقًا لتغيّرات الواقع وقدرات الإنسان وإمکانيّات التحقيق».
إنَّ هذا الموضوع يمكنه بيان مسألة التأويل بشكل مختلف عن الذي يقوله المتصوّفة. وقد عمد الدكتور حنفي من أجل تجاوز أسلوب تأويل المتصوّفة إلى بيان نظريّته في هذا الشأن؛ فهو يرى أنَّ ماهيّة الوحي القرآني بحيث يمكن للوعي أنْ يقيم الارتباط والتواصل معه في مختلف المراحل. يرى حنفي أنَّ النصَّ ـ بسبب تعدّد الإدراك، ووجود المجاز في المعنى اللغويّ، والظنّ في وجود الإنسان، ومختلف السطوح الثقافيّة، والسلوك، ومختلف مستويات الفهم ـ ليس له معنى واحد. إنَّ معنى اللفظ يتمّ فهمه بالنظر إلى موقعه في النصِّ، وارتباطه مع خارج النصِّ. وعلى هذا الأساس، فإنَّ معناه يقع في التجربة الفرديّة والاجتماعيّة، وعليه فإنَّ النصَّ يقع موردًا للفهم باعتبار التجربة المعاشة. إنَّ النصَّ في البين بمثابة المرآة التي تعكس النزعات الداخليّة والتصوّرات الذهنيّة للإنسان، كما أنَّها تمثِّل انعكاسًا لمحدوديّات وإمكانيّات عالم الواقع أيضًا. إنَّ التأويل إنَّما يتحقّق عندما يكون هناك توافق بين الذهن والنصِّ، ويأخذ الذهنُ العالمَ بوصفه مسرحًا لعمله ونشاطه.
وعلى هذا الأساس، فإنَّ الذي تكون له المحوريّة في جميع التأويلات في الواقع، هو الإنسان ووعيه. وإذا كان المتصوّفة قد منحوا المحوريّة لله أو الوجود المطلق، فإنَّهم في الواقع قد منحوا هذه المحوريّة لتلك الصورة المثاليّة للإنسان. إنَّ الدكتور حنفي في ضوء آراء فويرباخ حول ماهيّة الألوهيّة في ذهن الإنسان، يراه الصورة المصنوعة من قبل الإنسان ذاته، ومن هنا يكون قد أضفى الألوهيّة على صورته المثاليّة. وعلى هذا الأساس، فإنه يقول:
«الإنسان الكامل هو الله، الإنسان كما ينبغي أنْ يكون وليس ما هو كائن، صورة الإنسان المُثلى عن نفسه. فالإنسان يخلق مثله الأعلى خارجه».
وهذا هو سبب اشتراك الإنسان مع الله في الصفات من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي، وهذا الأمر لا يختصُّ بعلم الكلام فقط، بل إنَّ التصوّف الفلسفي يتبع هذه القاعدة أيضًا؛ لأنَّ كلا العلمين يتّفق في الغاية المتمثّلة بالله سبحانه وتعالى.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنَّ التأويل بدوره شيء مغاير لإعادة قراءة كلام الإنسان المثالي من طريق الإنسان المتعيّن، الذي يعمل على تأويل النصِّ في ضوء شرائطه التاريخيّة الخاصّة، ومن هنا تمتاز التأويلات عن بعضها. إنَّ الذي يحدث في البدء ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ هو تأويل الذات، الذي يتقدّم على تأويل النصّ، بمعنى أنَّنا نقوم في البداية بالتعرُّف على
أنفسنا من خلال إرجاعها إلى ذواتنا المثاليّة، ثمّ نعمل بعد ذلك على تأويل النصِّ. يرى الدكتور حنفي أنَّ «الأوّل» المندرج ضمن كلمة التأويل:
«ليس في تجربة المفارقة أو المتعالي، الأوّل في اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي، کما يقول الصوفيّة، بل في الذات، ومعرفة الذات سابقة علی معرفة الغير».
بيد أنَّ معرفة الذات بسبب الحيثيّة الالتفاتيّة للوعي، ترتبط مع معرفة الآخر؛ وذلك لأنَّ الذات تعمل على بلورة صورة الوعي، والآخر هو محتوى الوعي، وإنَّ هذا الأمر يصدق في مورد الآخر على ذات هذه الصورة أيضًا، ومن هنا لا يكون التأويل فهمًا للذات فقط، بل هو فهم لروابط الذات مع الآخر أيضًا. وإنَّ الروابط الاجتماعيّة بدورها تتبلور حول محور العواطف والمشاعر والمصالح أيضًا، وبذلك فإنَّها تؤثّر على فهمنا للنصّ. ومن هذه الناحية يكون التأويل ـ من وجهة نظر حنفي ـ مرتبطًا مع روح العصر والمصالح الجماعيّة، ولا يمكن اعتباره أمرًا فرديًا، وإنَّ تجاوز التأويل للفرديّة هنا ـ الضامن لكلّيته ـ يجب أنْ يكون متضمّنًا لمنافع الجماعة. وعلى هذا الأساس، يمكن القول: إنَّ التأويل في نفسه ليس هو الغاية، وإنَّما هو ناظر إلى غاية يريدها الإنسان منه، وهذا هو الموضوع الذي يتمّ التعبير عنه في التراث الإسلامي تحت عنوان التوافق بين القصد الإلهي ومصلحة الناس، ويؤخذ على أساس مصالح الأمة بعين الاعتبار بوصفه الغاية النهائيّة للتأويل. وعلى
هذا الأساس، فإنَّ الاختلاف في التأويل يعود في الواقع إلى الاختلاف بين الأفهام المختلفة عن المصلحة والخير، وأساس ذلك هو الصراع الاجتماعي. ومن هنا يجب تقديم التأويل بلحاظ الطبقات المحكومة دون الطبقات الحاكمة، ويجب تتبّع المصلحة العامّة من هذه الناحية. ولازم هذا الأمر هو العبور من محوريّة الله والذهاب إلى محوريّة الإنسان. وعلى هذا الأساس، يذهب حنفي إلى إعادة قراءة التصوّف ضمن ثلاث مراحل، وهي: مرحلة التصوّف الأخلاقي، ومرحلة التصوّف النفسي، ومرحلة التصوّف الفلسفي.
إنَّ الشرائط والظروف الراهنة تقتضي ـ طبقًا لما تقدّم ذكره، ومن وجهة نظر الدكتور حنفي ـ قراءة جديدة عن التصوّف، والدليل على ذلك أنَّنا نواجه اليوم بعض القيَم التي يكون الحفاظ على كينونتنا رهنًا بمراعاتها، وأنَّ جميع الأمور التي نواجهها اليوم مرتبطة بها بشكل وآخر. إنَّ الشرخ بين الفقر والثراء، وبين الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجيّة، ومسألة المواطنة والانتماء الجغرافي، قد نشأت بأجمعها بسبب ابتعادنا عن التنمية والقيَم المرتبطة بها، وليس أمامنا من حلّ لهذه المشكلة سوى إعادة قراءة التراث بحيث يتطابق مع القيَم المذكورة أعلاه. إنَّ أساس هذه القراءة المتماهية يكمن في استعادة الإنسان لموقعه، بمعنى العمل على إضفاء المحوريّة على الإنسان. وبعد ذلك يجب العمل على إعادة قراءة التراث، ومن ذلك إعادة قراءة التصوّف. وقد قام حنفي بهذه القراءة في مورد التصوّف عبر ثلاث مراحل، وذلك على النحو الآتي:
يرى حنفي أنَّ المقامات والأحوال والفضائل والرذائل في التصوّف، قد تمّ تنظيمها وتبويبها، بحيث يمتلك الإنسان حماية سيكولوجيّة في مواجهة الإخفاقات السياسيّة في قبال الأعداء والخصوم. إنَّ المقامات الأخلاقيّة، من قبيل: التوبة، والصبر، والشكر، والفقر، والزهد، والتوكّل، والتسليم، تشكِّل آليّات دفاعيّة (المنجيات) في مواجهة التهالك على طلب الدنيا وهوى النفس (المهلكات). بيد أنَّ الظروف والشرائط قد تغيّرت في العصر الراهن، ويجب لذلك أنْ تتغيّر الآليّات الدفاعيّة أيضًا، بمعنى أنَّ هذه الآليّات أخذت تؤدّي إلى ظهور الضعف والانفعال في الإنسان، ويجب تحويلها إلى عنصر قوّة لدى الإنسان. من ذلك أنَّ التوبة ـ على سبيل المثال ـ يجب أنْ تتحوّل إلى يقظة مباشرة وعاجلة، بحيث يتغيّر سلوك الإنسان على أساسها عمّا كان عليه الأمر في السابق، بشكل لا يتمّ السماح معه بالظهور للحالة والوضعيّة السابقة. والصبر بدوره يجب أنْ يتحوّل إلى تحمّل الظروف بعد تحليلها، ومن أجل تحقّق غاية في المستقبل بما يرتبط بهذه الدنيا. والشكر يجب أنْ يتحوّل من القناعة بالقليل إلى طلب المزيد بما يتيح للمجتمع الخروج من حالة الركود، وينطلق نحو التطوّر والازدهار والتحوّل. وهكذا الفقر ـ بوصفه ردّة فعل على الاستئثار وطلب المزيد ـ يجب أنْ لا يتمّ نصح الفقراء به، بل يجب أنْ تتحوّل الثروة إلى مطلب عام، واعتبار الفقر بوصفه نتيجة لعمل الإنسان نفسه، الذي يحظى بالقيمة في الارتباط مع الله الغني، ولا رابط له بالقيَم الأخرى.
(339)العبور من الحالات والمقامات إلى المواجهة الاجتماعيّة: إنَّ الحالات والمقامات التي كانت حتّى الآن تعمل في إطار الركود وعدم الواقعيّة، يجب من الآن فصاعدًا أنْ تتحوّل وتعمل في اتجاه الحركة والحيويّة وبناء مشروع واقعي بالنسبة إلى المستقبل. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أنَّ الخوف والرجاء لا يمكن تبويبهما في إطار جديد، وجعل الخوف من الله من دون مبرر؛ وذلك لأنَّ الله لا يخاف، ويجب على المؤمنين بدورهم أنْ لا يخافوا؛ لأنَّ الله هو نموذجهم وقدوتهم الخالدة، وإنَّ أملهم بالمستقبل بدوره لا ينبغي أنْ يتّخذ صورة مرتبطة بالآخرة، بل يجب أنْ يقوم على أهداف واقعيّة تتعلّق بالفرد والمجتمع.
إن للتحوّل في التصوّف ـ من وجهة نظر الدكتور حنفي ـ اقتضاءات فلسفيّة كذلك، ويجب البحث حولها أيضًا. وفي الحقيقة فإنَّ جميع المتغيّرات تبدأ بالظهور في الفلسفة، وإنَّ هذه التحوّلات يجب أنْ تتحقّق ـ من وجهة نظر الدكتور حنفي ـ في أربعة أبعاد، وهي عبارة عن: التحوّل في اتجاه حركة الإنسان، وتحوّل المراحل الأخلاقيّة إلى مراحل تاريخيّة، والتحوّل من النظرة الأخرويّة إلى النظرة الدنيويّة، والتحوّل في الوحدة الخياليّة إلى الوحدة المحقّقة.
1. يرى حنفي أنَّ مسار الصيرورة الإنسانيّة في التصوّف إذا كان من الأمر الخارجي (المرتبة الأخلاقيّة) إلى الأمر الداخلي (المرحلة النفسيّة)، وبعد ذلك إلى المراتب الأعلى من الوجود، فإنَّه يجب لهذا المسار أنْ ينعكس، وأنْ يتحوّل إلى هذه الشاكلة؛ بأنْ نتحرّك من المرتبة الأعلى
(التخطيط) إلى المرتبة الداخليّة (الإدارة)، ومنها إلى مرتبة الاستنتاج والمعطيات (المرتبة الخارجيّة). وفي هذا الاتجاه يكون الله إله السماء وإله الأرض، وإنَّ هذا الأمر سوف يعمل على إظهار أهميّة الأرض، وسوف تتّضح بذلك ضرورة تحريرها.
2. التغيير الآخر الذي يجب أنْ يحدث ـ من وجهة نظر حنفي ـ هو تحويل المقامات الأخلاقيّة إلى مراحل تاريخيّة. وعلى أساس هذه الرؤية يتعيّن علينا بدلًا من المقامات ذات الاتجاه الصاعد، استبدالها بمراحل التطوّر. وعلى هذا الأساس سوف يتمّ استبدال المراحل العليا من الناحية الأخلاقيّة بالمراحل التاريخيّة للتقدّم والازدهار والرقيّ، وسوف ترتبط الرذائل بالتخلّف والتأخّر. إنَّ هذا الاتجاه لا يستلزم التعلّق بالماضي، ولا ينظر إلى المستقبل اليوتوبي، وإنَّما يركّز على هذا الموضوع فقط، وهو أنَّ وضعيّة المجتمع في تغيّر متواصل، وعلى هذا الأساس يجب أنْ نعمل دائمًا على تغيير أنفسنا بما يتطابق مع الأوضاع والمتغيّرات الجديدة.
3. التغيير الآخر ـ من وجهة نظر الدكتور حنفي ـ هو الحركة والانتقال من النزعة الأخرويّة إلى النزعة الدنيويّة. طبقًا لرؤية حنفي، يعود سبب اتجاه الصوفيّة إلى الآخرة ويوم القيامة، إلى إخفاقهم في الدنيا الحقيقيّة، ومن ناحية أخرى لم يتمّ تقديم أيّ دليل معقول لإثبات وجهة نظر الصوفيّة في مورد الآخرة، وإنَّ الأدلة التي تقام في هذا الشأن تعود في
(341)نهاية المطاف إلى النقل. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الدكتور حنفي يستنتج من ذلك وجوب التركيز على الحياة وتحسين وضعها في هذه الدنيا بدلًا من التركيز على الموت والحياة بعده.
4. كما سبق أنْ ذكرنا، فإنَّ الغاية القصوى والنهائيّة للصوفي هي البحث عن وحدة الوجود، بمعنى المرتبة التي يتحقّق فيها الاتحاد بين العاقل والمعقول. إنَّ هذا الاتحاد ـ من وجهة نظر الدكتور حنفي ـ اتّحاد متخيّل، ويجب أنْ يحدث اتّحاد حقيقي يتحسّن فيه العالم الحقيقي والواقعي للمسلمين. إنَّ هذا الأمر يتحقّق ـ من وجهة نظر الدكتور حسن حنفي ـ من خلال قيام الاتّحاد الحقيقي بين المسلمين، وإنَّ الحدود المصطنعة بينهم سوف تحول دون تحقّق هذا الاتّحاد. إنَّه من خلال الخلط بين وحدة الوجود والاتّحاد الوجودي، يرى إمكان تحقّق الاتّحاد الوجودي في العالم المعاصر من طريق القوميّة الإسلاميّة، حيث يتمّ له التحقّق بهذه الطريقة.
في ضوء ما تقدّم، يمكن لنا أنْ ندرك أنَّ قراءة الدكتور حسن حنفي للتصوّف مقرونة بمحوريّة الإنسان، ويأخذ في ذلك بعين الاعتبار اتجاهًا أفقيًّا وتاريخيًّا للإنسان. إنَّ هذه القراءة قد تمّت في إطار الغاية التي ينشدها الدكتور حنفي من ورائها في سياق ما تقتضيه التنمية، ولهذا السبب فإنَّه يعمل على تحميل العناصر المذكورة على التصوّف. ولكنْ هل سيبقى التصوّف تصوّفًا
(342)بعد تحميل هذه الخصائص عليه؟ هذا موضوع آخر سوف نبحثه في القسم اللاحق إنْ شاء الله تعالى.
يمكن على نحو الإجمال اعتبار القراءة الظاهراتيّة للدكتور حسن حنفي عن التصوّف مشروعًا لجعل التصوّف دنيويًّا؛ وذلك حيث يكون جوهر التصوّف هو الإعراض عن الدنيا، وإقبالًا على المراتب المعنويّة وغير الماديّة. يسعى الدكتور حنفي إلى إنجاز هذا المشروع من خلال اجتياز عدد من المراحل، وهو في جميع هذه المراحل يواجه بعض الانتقادات، وهو ما سوف نتعرّض إلى بحثه في المطالب الآتية:
1. فيما يتعلّق بخلفيّات تبلور التصوّف، يمكن الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنَّه على الرغم من أنَّ الخلفيّات السياسيّة والاجتماعيّة مؤثّرة في تبلور المذاهب المختلفة، إلّا أنَّه لا يمكن القول بالتأثير المباشر والحاسم لهذه الأمور في تأسيس وبلورة ماهية تلك المذاهب. إنَّ هذا الأمر يصدق في مورد التصوّف أيضًا؛ لأنَّ الاتجاه نحو الباطن ومشروع الوجود ومراتبه، لا يمكن أنْ يكون مجرّد ردّة فعل على الواقع الموجود، وفي أفضل الحالات الممكنة يمكن لهذه الخلفيّات أنْ تكون بمثابة المحرّك لاستذكار واستعادة المعنى ومراتب الوجود وحقيقة ودور الأمور ما وراء الإنسانيّة. يمكن لبيان الاتجاه نحو المعنى ومراتب الوجود الأسمى العثور على ذلك في نظريّات العرفاء أنفسهم، وذلك بمعنى أنَّ الشخص عندما يجد النظام السياسي والثقافي الحاكم خاليًا من المعنى وغير مرتبط بالتجربة الباطنيّة، فإنَّه سوف يطلب جبران وتدارك هذا النقص من ذات الله سبحانه وتعالى، وسوف يحصل منه على الجواب
المناسب. من ذلك أنَّ الهجويري الغزنوي ـ على سبيل المثال ـ يذهب إلى الاعتقاد بأنَّ العارف يريد الحصول على ذلك الهدف السامي منه، وهو يعلم ذلك. ثمّ يقول:
«إنَّ الله سبحانه وتعالى إذا أراد، فإنَّه سيهدي عبده إلى ما يريد، ويفتح عليه باب معرفته».
وعلى هذا الأساس، فإنَّ الله سبحانه وتعالى يريد إخراج الإنسان من حضيض المادةّ والتعلّقات الماديّة، وإيصاله إلى ذروة الكمال، ويفتح له أبواب العرفان من هذه الناحية.
2. إنَّ الاتجاه الظاهراتي للدكتور حسن حنفي في مورد التصوّف يبدأ بتعليق مساحة الأمر المقدّس مع الأمر المتعالي، وإنَّ غاية هذا الاتجاه تعيين نوع من الموضوعیّة المتماهية مع الاتجاهات الجديدة في حقل المعرفة. إنَّ الاتجاه نحو هذا الأمر بدوره كان بدوافع اجتماعيّة وسياسية من أجل الاستفادة من التصوّف، وطرح وتقديم رؤية أيديولوجيّة تخدش في الموضوعیّة مورد الادّعاء. وفي الحقيقة فإنَّ الاتجاه الظاهراتي للدكتور حسن حنفي، إنّما يعمل على التعريف بالخلفيّات الاجتماعيّة والسياسيّة بوصفها منشأ للتصوّف، بحيث لا يُمكن لها الذهاب إلى أبعد من السطوح. وعلى الرغم من امتلاكه معلومات واسعة حول التصوّف، إلّا أنَّه عند الدخول في تحليلها وتوضيحها، يبدو وكأنَّه شخص بعيد كلّ البُعد عن المفاهيم المذكورة، في حين أنَّ القسم الأكبر من المفاهيم والتعاليم ومعارف الأديان السماويّة، الناظرة إلى بيان
وإثبات الحقائق الميتافيزيقيّة وما وراء الطبيعيّة والماديّة والأمور الغيبيّة، ومن بينها منشأ الوحي وعالم المجرّدات (... يوجد نقص). وفي الأساس، فإنَّ قسمًا كبيرًا من التصوّف يعمل على التعريف بالمراتب ما فوق الماديّة من الوجود، والعوالم الأسمى من المادّة، والحقائق الغيبيّة، ومرتبة من النفس تتردّد بين عالم المادّة وعالم العقل. وكذلك فإنَّ الارتباط الإدراكي والتدبيري لمراتب الوجود في النظام الطولي، يمثّل عنصرًا آخر تذهب جميع مذاهب التصوّف باتجاه الاهتمام به، وقامت بتوضيحه في إطار البحث عن وجود عوالم الطبيعة والمثال والعقل، وتحقّق تلك المراتب في حقيقة وجود الإنسان، ونعني بذلك نفسه. إنَّ الارتباط بين هذه المراتب في حقلي العمل والإدراك الإنساني، موضوع دقيق وواسع ومستحكم للغاية، وقد اختصّت به مصادر واسعة في العرفان النظري، وإنَّ التصوّف الأخلاقي يقوم عليها. والآن لو تمّ حذف هذا القسم من مفاهيم التصوّف، وتمّ اعتبارها بوصفها أمورًا وهميّة، لن يبقى من التصوّف شيء على الصعيد العملي.
3. إنَّ تأويل الظواهر الاجتماعيّة بوساطة الأساليب الظاهراتيّة، يقوم على هذا الافتراض القائل بأنَّ باطن وجوهر وذات وأصل الظواهر الاجتماعيّة والتاريخيّة، هي الثقافة أو النفس الإنسانيّة أو الوجود المقيّد للإنسان. إنَّ سعي الباحث والمحقّق ـ في هذا الاتجاه ـ من أجل العبور من مستوى ظاهر الظواهر الاجتماعيّة، إنَما يوصله إلى مجرّد باطن لا يعدو أنْ يكون شيئًا غير التاريخ والثقافة أو النفس الإنسانيّة، ومن هنا يحصل على الدوام فهم تاريخي وثقافي أو إنساني عن الظواهر الاجتماعيّة. وأمَّا فی الحکمة الاسلامیّة، وخصوصًا
في الحكمة المتعالية لصدرالدین الشیرازي، وعلى أساس القول بالوحدة الشخصيّة للوجود، تعدّ جميع الظواهر تجلّيًا للحقّ تعالى، وعلى أساس تطابق التجلّيات على بعضها، تكون حقيقة وأصل كلّ ظاهرة وباطنها واقعة في المراتب ما فوقها، وعلى هذا الأساس تقع حقيقة الظواهر المحسوسة والطبيعيّة في المرتبة المثاليّة، وحقيقة الظواهر المثاليّة في مرتبة العقل، وحقيقة مرتبة العقل في مرتبة الأسماء والصفات الإلهيّة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ:
«التأويل الذي يعمد في نهاية عمله إلى التعريف بالتاريخ والثقافة أو النفسانيّة الإنسانيّة بوصفها باطنًا وأساسًا للظواهر الاجتماعيّة، أو بعبارة أدقّ: أساسًا لجميع الظواهر، لن يعدو أنْ يكون شيئًا أبعد من التأويل المفهومي، على الرغم من ظنّ المؤوِّل أنّه قام بتأويل وجودي، وهو ظنّ متأثّر بحجاب أشدّ غلظة؛ إذ يرى الوجود والحقيقة ظواهر تاريخيّة وثقافيّة، أو نتيجة من نتائج النفس الإنسانيّة».
4. لقد أشار الدكتور حسن حنفي في توضيح مفهوم التوحيد إلى هذه المسألة، وهي أنَّ القول والشهادة بالتوحيد والتسليم له، لا يعني القبول بالعبوديّة لغيره، ويعمل على توظيف هذه المسألة في بيان ما يرد ذكره تحت عنوان الثورة المتعالية. وعلى الرغم من تقديمه تفسيرًا مختلفًا عن التعالي، إلّا أنَّ الحقيقة هي أنَّ كلامه في مورد التعالي في معناه التقليدي الناظر إلى بحث مراتب الوجود، صادق أيضًا. إنَّ القول بتعالي الحقّ، ونظريّة الفيض والصدور، وهرم
(346)الوجود، لا يعني القبول بأيّ نظام من أنظمة سلسلة المراتب في حقل السياسة والاجتماع. وبالمناسبة فإنَّ المفاهيم المرتبطة بهذا الأمر تحتوي على قواعد تضع الملاكات اللازمة بيد الفرد للمواجهة الصحيحة مع المسألة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ القول بسلسلة مراتب الوجود لا ينطوي على التالي الفاسد، الذي قال الدكتور حسن حنفي بارتباطه الضروري مع المفهوم المذكور.
5. لقد عمد الدكتور حسن حنفي في نقد القول بالمعاد في التصوّف، إلى وضعه في عرض الآراء والنظريّات الصادرة عن النزعة التاريخيّة؛ إذ يتمّ العمل فيها على الترويج للوعد بالمدينة الفاضلة في المستقبل، مع حرماننا من نعيم اللحظة الراهنة. في حين أنَّ المعاد في التصوّف هدف متعال يعمل الإنسان على تنظيم أعماله على أساس تلك الأهداف المتعالية. إنَّ هذا الهدف لا يجعل الإنسان غير مغترب عن ذاته فحسب، بل إنَّ هذه الهدفيّة ذاتها تعمل على تنظيم البنية الذاتيّة لجميع الأفعال الممكنة لكلّ مستقبل ممكن. وبعبارة أخرى: إنَّ الإنسان إنَّما يمكنه على الدوام أنْ يتصوّر مساحات جديدة للحياة والنشاط بوساطة المعاد، وليس من خلال نفي المعاد، وكما يقول هنري كوربان:
«إنَّ القول بالمعاد وانتظار القيامة، يمتدّ بجذوره في أعماق وجداننا نحن أهل الكتاب، وإنَّ هذا الانتظار ليوم القيامة هو الذي يسمح لنا بعدم الرضوخ والاستسلام في مواجهة مخاطر التاريخ. فإنْ لم نحصل على وعي بالنسبة إلى هذا الأمر، وتساهلنا مع ما يعتبر إلغاء لوجودنا وشخصيّتنا، فإنَّ الخطر سيكون محدقًا بنا».
إنَّ قراءة الدكتور حسن حنفي عن التصوّف، تمثّل نتيجة طبيعيّة لانحصار أهداف وغايات حياة الإنسان في تغيير الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي، وتحقيق التنمية في المجتمعات الإسلاميّة. ويبدو أنَّ الدكتور حنفي قد وجد في الظاهراتيّة الأفق الأنسب لتحقيق هذه الغاية؛ حيث يمكن من خلال ذلك القول بتعليق الحكم في مورد جميع تلك الأمور الخارجة عن البرنامج الأيديولوجي للتغيير. إنَّ الذي يتمّ بيانه في رؤية الدكتور حسن حنفي بوصفه واقعيّة، يتناظر مع مرتبة متدنيّة من الخير؛ أي النفع المادّي، ونتيجته هو المجتمع المتجدّد، والذي هو بالقياس إلى تطلعات المجتمع التقليدي، عبارة عن مجتمع متدنٍّ وفي حدّه الأقلّ؛ إذ لا ينشد خيرًا فوق الرفاه المادّي، وإنَّ تحقّقه يحتاج إلى الحدّ الأدنى من الحريّة. ومن هنا فإنَّ الأشخاص في المجتمع المتطوّر لا يسعون وراء الحريّة الداخليّة، وإنَّما حيث يتحقّق تعريف الإنسان التقدّمي في إطار نسبته إلى الدولة والحكومات، فإنَّه يكتفي بالحريّة السياسيّة والاجتماعيّة. وعليه، فإنَّ الإنسان ـ في هذه الرؤية ـ قبل أنْ يكون مخاطبًا من قبل الله أو الوجود، وقبل أنْ يرى نفسه مسؤولًا عن التغيّرات الكيفيّة في المجالات الأخلاقيّة والمعنويّة، وكذلك تحسين الواقع الاجتماعي والسياسي، يعتبر نفسه مسؤولًا عن الدولة والمجتمع الإنساني. وإنَّ اتّخاذ مثل هذا الموقف يعني أنَّ الإنسان لن يتمكّن من عدم إضافة شيء إلى ثروته المعنويّة فحسب، بل وسوف ينفق كلّ ما حصل عليه بوصفه من التراث في
(348)سبيل تحقيق الأهداف الأيديولوجيّة أيضًا. ومن خلال توجيه أنظار الإنسان إلى هذه الغايات، وتعليق القضايا الفاتحة لأبواب السماء، يسلب الإنسان إمكانيّة العودة المجدّدة إلى الحياة المعنويّة والأخلاقيّة الحقيقيّة، أو أنْ تضع دون تحقّق هذه الغاية ـ وهي إحياء التراث في معناه الأصيل ـ مزيدًا من العقبات والعراقيل.
وبالنظر إلى ما تقدّم ذكره، يمكن القول: إنَّ الاعتقاد بالصيرورة العموديّة القائمة على مفهوم سلسلة مراتب الوجود، هي من ضروريّات التصوّف. وإنَّ كلّ قراءة تعمل على سلب ونفي هذه الخصوصيّة من التصوّف، تمثّل في الحقيقة تفريغًا للتصوّف من مضمونه ومحتواه. وعلى هذا الأساس، فإنَّ الذي يتمّ بيانه وتقديمه بوساطة القراءة الظاهراتيّة للدكتور حنفي، يجب اعتباره في الغالب الظاهراتيّة ذاتها التي يُستفاد في بيانها من المفاهيم المذكورة في التصوّف. ومن ناحية أخرى، فإنَّ الموارد التي يذكرها الدكتور حسن حنفي لنقد التصوّف، ويستفيد منها لبيان ضرورة إعادة قراءة التصوّف، لا ترد في سياق عدم إضعاف الإنسان فحسب، بل ويمكن اعتبارها نافعة في تقوية الإنسان في سياق العمل على رفع الكثير من آفات عصرنا، كما كان الأمر على هذه الشاكلة في الكثير من الموارد على ما يعترف به الدكتور حنفي نفسه أيضًا. كما ويمكن لتبديل هيئة المفاهيم العرفانيّة أنْ تفرِّغ الإنسان المسلم من محتواه الداخلي، وتضعه على مسار لا يتحرّك فيه نحو التعالي، ولا يكون نافعًا في عمليّة التنمية، وهذا خطر يأتي من ناحية القراءات الجديدة للتراث. وفي
(349)المجموع، فإنَّ قراءة الدكتور حسن حنفي عن التصوّف، لا تنسجم مع حقيقة التصوّف، ولا يمكن تصديق النقاط السلبيّة التي ينسبها إلى التصوّف، ولا الأفق الذي يقدّمه لقراءته الخاصّة عن التصوّف يبدو قابلًا للتحقّق أيضًا.
(350)- بيل، ديفد، انديشههاي هوسِرْل (أفكار هوسيرل)، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: فريدون فاطمي، طهران، نشر مركز، 1386 ه ش.
- جمادي، سياوش، زمينه وزمانه پديدارشناسی (الخلفيّات المكانيّة والزمانيّة للظاهراتيّة)، طهران، انتشارات ققنوس، ط 3، 1389 ه ش.
- حنفي، حسن، التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، القاهرة، الناشر: مؤسّسة الهنداوي، سي آي سي، 2017 م.
- ــــــــــ ، الهويّة، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2012 م.
- ــــــــــ ، حصار الزمن، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ط 1، 2004 م.
- ــــــــــ ، من العقيدة إلى الثورة، ج 1، القاهرة، الناشر: مؤسّسة الهنداوي، 2017 م.
- ــــــــــ ، من الفناء إلى البقاء: محاولة لإعادة بناء علوم التصوّف (الوعي الموضوعي)، دار المدار الإسلامي، 2009 م.
- كوربان، هنري، فلسفه تطبيقی و فلسفه ايرانی، ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: السيّد جواد الطباطبائي، طهران، نشر مينوي خرد، 1396 ه ش.
- ملائي، رضا، وبارسانيا، حميد، صورتبندي روش تأويل و تأثير آن بر علوم اجتماعي با تأكيد بر انديشه آيت الله جوادي آملي (تبويب منهج التأويل وتأثيره على العلوم الاجتماعيّة في ضوء التأكيد على فكر آية الله جوادي الآملي)، نشر حكمت إسراء، العدد: 3 (العدد المتسلسل: 25)، خريف عام: 1396 ه ش.
- الهجويري الغزنوي، علي، كشف المحجوب، تقديم: قاسم أنصاري، طهران، نشر طهور، 1376 ه ش.
- Hanafi, Hassan. "Mysticism and development: a dialogue with al-Ghazālī, Revivification of religious sciences (Iḥyā' ʿulūm al-dīn) or Revivification of worldly sciences (Iḥyā ʿulūm al-dunyā)?." JAMES: Annals of Japan Association for Middle East Studies 1 (1986): 62-105
- Hanafi, Hassan, “The Revolution of The Transcendence”, Kanz Philosophia, Volume I, Number 2, August – December. 2011.
- Husserl. E, Phenomenology, translated by Kockleman, JJ, in Husserls Phenomenology, (Indiana).
(352)