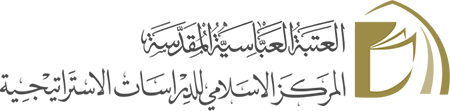
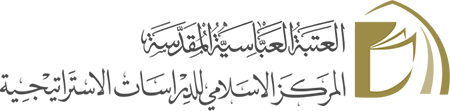
الإيمان بالله تعالى
في اللاهوت الغربي المعاصر
(1)بسم الله الرحمن الرحيم
(2)العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
سلسلة نقد الإلحاد 5
الإيمان بالله تعالى
في اللاهوت الغربي المعاصر
تأليف :
مجموعة مؤلفين
إعداد وتحرير :
د. حامد فياضي
(3)العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
الايمان بالله تعالى في اللاهوت الغربي المعاصر / تأليف مجموعة مؤلفين : إعداد وتحرير د. حامد فياضي - الطبعة الأولى - النجف العراق : العتبة العباسية المقدسة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية. 2025
464 صفحة : 24 سم. (سلسلة نقد الإلحاد ، 5)
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.
النص باللغة العربية مترجم من اللغة الانجليزية.
ISBN: 9789922680729
1. الالهيات - فلسفة. 2. الله (اسلام) 3 اللاهوت المسيحي. 4. الاسلام والديانات الاخرى، أ. فياضي.
حامد 1982 معد. ب العنوان.
LCC: BP166.2.E43 2025
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
الفهرسة أثناء النشر
رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (۳۸۷۷) لسنة ٢٠٢٥ م
الإيمان بالله تعالى في اللاهوت الغربي المعاصر (سلسلة نقد الإلحاد - 5)
تأليف : مجموعة مؤلفين
إعداد وتحرير : د. حامد فياضي
تعريب : هبة ناصر
إشراف : السيد محسن الموسوي
الناشر : العتبة العباسية المقدسة / المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
الطبعة : الاولى / 2025 م
www.iicss.iq
islamic.css@gmail.com
(4)
كلمة المركز7
المقدمة 13
الحجة الأنطولوجية 17
جايسن ميغيل
الحجة الأنطولوجية: ترقيعُ حجة بلانتينغا الأنطولوجية
عبر خُطوة مورداك 45
إليزابث بِرنز
الحجة الكونية 69
و. دايفيد بك
الحجة الكونيّة الكلاميّة 131
ويليام لين كريغ
الحجج الغائيّة 165
ستيفن إيفانز
حجة الضَّبط الدقيق 179
مايكل روتا
حجة أخلاقية على وجود الله طِبقًا للاستدلال الاستخلاصي209
دايفيد باغيت
الحجّة المبنيّة على التجربة الدينية 241
كاي-مان كوان
حجّة الرِّهان 279
جوشوا غولدينغ
الإيمانُ الدينيّ من دون دليل 297
ويليام جاي وُود
طبيعةُ الإيمان وعقلانيّته 317
ليز جاكسون
هل فرضية الله مُستبعدَة؟ ردٌ على دوكينز 345
لوغان بول غايج
صانعُ الساعات الأعمى: التطوُّر وإلغاء الله؟ 377
أليستر ماكغراث
هل نحن أفضل بدون الدّين؟
أضرار (وفوائد) الاعتقاد الدّينيّ 437
كريستيان ب. ميلر
﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾
(فصلت: ٥٣)
لا شكّ في أنّ مسألة وجود الله تعالى تُعَدّ من أقدم وأعمق المسائل في تاريخ الفكر البشري، إذ حظيت باهتمام دائم ومتواصل في سياقات حضارية ودينية وفلسفية متعدّدة، وتنوّعت أنماط تناولها وتشكيلها عبر العصور. ففي الديانات التوحيدية يُعَدّ الإيمان بوجود الإله المتعالي نقطة البداية ومركز المنظومات اللاهوتية والأخلاقية. ولا يُنظَر في هذه الديانات إلى الله بوصفه مبدأً نظريًا فحسب، بل بوصفه مصدر الوجود، ومُشرِّع الأحكام، والغاية النهائية للوجود والإنسان. غير أنّ هذا التوجّه الإيماني لم يكن يومًا بمنأى عن نزوع عقلي لتفسير وتبرير الإيمان بوجود الله، وهو ما تجلّى في محاولات عقلانية لصياغة براهين فلسفية تثبت وجوده.
في تاريخ الفلسفة الغربية، تُعدّ براهين وجود الله من أبرز تجلّيات الجهد العقلي لتأسيس الإيمان الديني على أساس من التحليل والاستدلال الفلسفي. وقد احتلّت هذه البراهين موقعًا مركزيًا في النقاشات الميتافيزيقية والكلامية والإبستمولوجية منذ نشأتها في البيئة اليونانية، ومرورًا بتحوّلاتها في الفلسفة التحليلية المعاصرة.
بدأت مسيرة هذه البراهين في الفلسفة الغربية مع أفلاطون وأرسطو، ثم تطوّرت على أيدي فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين من أمثال أوغسطين وتوما
الأكويني، ثم أعيدت صياغتها ضمن أطر جديدة على أيدي الفلاسفة العقلانيين المحدثين كديكارت ولايبنتس وسبينوزا. وفي العصر الحديث، أعيدت قراءتها ونقدها في سياق الردّ على إشكالات ديفيد هيوم وكانط والفلاسفة التحليليين.
ومع مطلع القرن العشرين، ومع صعود الفلسفة التحليلية، عاد الاهتمام بالبراهين على وجود الله. وقد سعى فلاسفة كالفين بلانتينغا، وريتشارد سوينبرن، وويليام لين كريغ إلى تقديم صيغ جديدة للبراهين التقليدية، مستفيدين من المنطق الرمزي، ونظرية الاحتمالات، ومنجزات العلوم المعاصرة. فمثلًا، قدّم بلانتينغا نسخة من البرهان الأنطولوجي (الوجودي) تعتمد على منطق الإمكانات، يطرح فيها «الوجود الضروري» لله كمسلّمة معقولة. أمّا كريغ فقد أعاد بناء البرهان الكوني الكلامي – المستمد من التراث الإسلامي وعلم الكلام – وسعى إلى توظيفه في مناظراته العامة ضد الإلحاد.
إنّ الحاضر المعاصر، بما فيه من تحدّيات كالإلحاد العلمي، والنسبية المعرفية، والعلمانية المتزايدة، وأزمة المعنى، يشهد مواجهة أو تفاعلاً جديدًا بين العقل والإيمان والتجربة الدينية. وفي هذا السياق، لا يمكن الدفاع عن الإيمان الديني دفاعًا معقولًا ومبدعًا إلّا من خلال مقاربة دقيقة وفلسفية وحوارية لبراهين وجود الله ونظرياته المعاصرة.
أمّا في العالم الإسلامي، فمع أنّ الإيمان بوجود الله كان مسلّمةً مشتركة بين جميع المدارس الكلامية والفلسفية، إلا أنّ تبرير هذا الإيمان عقليًا شغل حيّزًا مهمًا في تلك المدارس، من علم الكلام المعتزلي والأشعري إلى الفلسفة المشائية والإشراقية والحكمة المتعالية. وتدلّ براهين مثل برهان الحدوث، وبرهان
(8)الإمكان والوجوب، ولا سيّما برهان الصدّيقين، على الجهود الجادة التي بذلها مفكرو المسلمين في هذا المضمار. غير أنّ العلاقة بين هذه البراهين ونظائرها أو بدائلها في التراث الغربي لم تحظَ بكثير من الاهتمام، وهو ما أدّى أحيانًا إلى إغفال الطاقات الغنية للحوار الفلسفي التبادلي.
ومن جهة أخرى، فقد شهدت العقود الأخيرة في الفلسفة الغربية، ضمن حقل فلسفة الدين الذي يُعدّ مجالًا حديث النشأة وديناميكيًا، موجةً جديدة من إعادة قراءة وبناء براهين وجود الله. وقد ظهرت هذه التحوّلات في صور متعدّدة: كإعادة تقديم البرهان الأنطولوجي بصيغ منطقية وإمكانية (مثل نماذج بلانتينغا)، أو في صيغ حديثة للبرهان الكوني (كطرح كريغ المستند إلى الكلام الإسلامي)، أو حتى في استخدام معطيات الكوسمولوجيا والفيزياء الحديثة في صياغة برهان الضبط الدقيق. وهذه الآفاق الجديدة تفرض على المفكرين المسلمين أن ينخرطوا فيها برؤية تحليلية ومعمّقة.
مع أنّ براهين إثبات وجود الله في التقليدين الفلسفيين الكبيرين، الغربي والإسلامي، تختلف في كثير من المفاهيم والمسلّمات، فإنّها تُعدّ في كلا السياقين محاولات عقلانية لتأسيس الإيمان الديني وتفسير العلاقة بين العقل والإيمان. وإلى جانب الفروقات الصورية بين هذه البراهين، فإنّ ما ينبغي الانتباه إليه في المقارنة، هو الاختلاف في الأُسس الأنطولوجية والإبستمولوجية. ففي التقليد الإسلامي، ولا سيما في الحكمة المتعالية، لا يُعدّ الوجود أمرًا ذهنيًا مجرّدًا، بل هو أصدق مراتب الواقع. فالوجود أصيل ومشترك على نحوٍ تشكيكي، ومراتب الوجود تُعادل مراتب القرب والبعد من المبدأ المتعالي.
في المقابل، أصبح الوجود في كثير من صِيغ الفلسفة الغربية، لا سيما بعد
(9)كانط، مقولة منطقية أو مفهومية، وغالبًا ما يُغفل التمييز بين «الوجود الذهني» و«الوجود الخارجي» على نحو ما هو مألوف في الحكمة الإسلامية. كما أنّ منزلة الوحي، والشهود، والعقل الحضوري في المعرفة الإسلامية تختلف جذريًا عن البنية المعرفية التجريبية-التحليلية في الغرب. ولهذا، فإنّ كثيرًا من الانتقادات التي وجّهها الفلاسفة الغربيون إلى البراهين الإلهية – كاعتراض كانط على البرهان الوجودي، أو نقد هيوم لنظرية النظم – تُعدّ غير كافية في سياق التقليد الإسلامي.
إنّ مقارنة براهين إثبات وجود الله في هذين التقليدين ليست مجرّد تمرين نظري، بل ضرورة معرفية وحضارية. ففي عالمٍ يشهد تنامي الإلحاد الجديد، والشكّ العلمي، والنسبية الأخلاقية، تُعدّ إعادة التفكير في أسس الإيمان العقلاني أمرًا مصيريًا. والتقليد الإسلامي، بما يمتلكه من إرث ميتافيزيقي، وعرفاني، وكلامي غني، يملك القدرة على أن يقدّم مساهمة أصيلة وفاعلة في هذا الحوار.
إنّ المقالات التي يتضمّنها هذا الكتاب قد اختيرت من بين أبرز وأحدث النصوص والدراسات الأكاديمية، ويعكس كلٌّ منها – على نحوٍ خاص – اتّجاهات وقضايا ومقاربات بارزة في اللاهوت الطبيعي وفلسفة الدين الحديثة في الفكر الغربي. فبعضها يُعيد قراءة البراهين الكلاسيكية – كبرهاني الكوسمولوجيا والوجود – قراءة نقدية ويُعيد بنائها باستخدام أدوات المنطق الصوري وتحليل اللغة الفلسفية. بينما تركّز أخرى على الأسس الإبستمولوجية والأنطولوجية لهذه البراهين، وتتناول تقييمها من زوايا متعدّدة، كالمعرفية الفضيلتية أو فلسفة العلم. ويجمع هذه المقالات جميعًا انشغالها – بشكلٍ أو بآخر – بالسؤال الجوهري حول العلاقة بين العقل والإيمان، وكيفية تقديم تفسير عقلاني للمعتقد الديني.
إنّ ترجمة هذه النصوص إلى اللغة العربية تتيح، في المقام الأول، فرصة ثمينة للباحثين والمفكرين للتعرّف على الصيغ الدقيقة، وغالبًا الجديدة، للبراهين الإلهية في التقليد الفلسفي الغربي؛ وهي صيغ تختلف أحيانًا اختلافات دقيقة لكن حاسمة عن النماذج الأقدم، وقد نشأت في آفاق جديدة كالفلسفة التحليلية، ومنطق الإمكانات، والتحليلات المعرفية المعاصرة. إنّ التعرّف على هذه النصوص لا يساهم فقط في فهمٍ أدقّ لمنطلقات ومنهجيات الفكر الفلسفي الغربي، بل يُمكّننا من إعادة صياغة مواقفنا ومصادرنا. فضلًا عن ذلك، يمكن أن تُشكّل هذه الترجمات أساسًا لحوار بين الثقافات والأديان. فرغم أنّ العالمين الإسلامي والمسيحي يشتركان في الإيمان بإله واحد متعالي، إلا أنّ طريقة فهم هذا الإيمان وإثباته سارت في مسارين متمايزين إلى حدّ كبير.
مع ذلك، تبقى ترجمة النصوص الفلسفية – ولا سيّما في مجالٍ يتّسم بالدقّة والعمق كمجال فلسفة الدين – محفوفة بتحدّيات عدّة. من أبرزها إيجاد المعادل الدقيق للمفاهيم الفلسفية الخاصة، واستعادة النبرة التحليلية-الاستدلالية للنصوص الأصلية، والحفاظ على اتّساقها المفهومي. ذلك أنّ لغة فلسفة الدين، لا سيّما في العصر الحديث، تمتاز بالإيجاز المنطقي، والدقّة الاصطلاحية، والحساسية العالية تجاه المفاهيم؛ ومن ثمّ، فإنّ نقلها إلى اللغة العربية يتطلّب إلمامًا عميقًا بالمنطق الفلسفي، وبالتراث اللغوي-الفكري الإسلامي. ونأمل أن يكون هذا العمل قد وفّق – بقدر الإمكان – في الحفاظ على هذا التوازن.
وفي الختام، نتوجّه بخالص الشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب ونشره، لا سيّما فضيلة حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد هاشم الميلاني، رئيس المركز المحترم، والمترجمة القديرة الأستاذة هبة ناصر، وفضيلة حجّة
(11)الإسلام والمسلمين الدكتور حامد فيّاضي الذي تولّى اختيار المقالات وتقييمها والإشراف العلمي على ترجمتها، والأستاذ السيّد محمد رضا الطباطبائي، مسؤول قسم النشر، وسائر الزملاء الكرام.
ونأمل، بتوفيق الله تعالى، أن يُسهم هذا العمل في الارتقاء المعرفي والروحي للمجتمع في سبيل الحياة الطيّبة الإلهية، والاستنارة بنور التوحيد، ونيل سعادة العبودية، بمنّه وكرمه، إنّه وليّ التوفيق، والحمد لله ربّ العالمين.
السيّد محسن الموسوي
المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية - فرع قم
(12)في هذا العصر الذي تتعدّد فيه التيّارات الفكرية والفلسفية، وتتشابك أحيانًا بتناقضاتها، ومع الانتشار المتسارع للنزعات الإلحادية والعلمانية، تزداد الحاجة إلى الدفاع العقلي والمنهجي عن الإيمان بالله، بوصفه من المهام الأساسية المناطة بالعلماء والمفكّرين المؤمنين.
يأتي هذا الكتاب، الموجّه بالدرجة الأولى إلى المثقّفين العرب، استجابةً لهذه الحاجة، إذ يضمّ نخبة مختارة من المقالات الفلسفية المنشورة في الإطار الأكاديمي الغربي المتخصّص في فلسفة الدين، والتي تتناول بالدراسة والتحليل قضيّة إثبات وجود الله، في مواجهة التحدّيات الإلحادية المعاصرة. ولا يقتصر هدف الكتاب على عرض نماذج من الفكر الفلسفي الغربي، بل يسعى أيضًا إلى تمكين القارئ من أدوات عقلية واستدلالية تعينه على فهم الأسئلة الإلحادية والردّ على شبهاتها. ورغم أنّ هذه المقالات نابعة من سياقات ثقافية وتاريخية مغايرة للسياق الإسلامي، فإنّها تظل تقدّم محتوىً غنيًّا، قابلًا للتفاعل والتوظيف في الخطاب الفكري الإسلامي، بما يعزّز من قدرة هذا الخطاب على مواكبة التحوّلات المعاصرة.
وقد اختيرت هذه المقالات بعناية من أحدث ما نُشر عن دور النشر الأكاديمية الغربية، وهي تمثّل طيفًا غنيًّا من المناهج والمدارس الفلسفية، وتتناول موضوع إثبات وجود الله من زوايا متعدّدة. تتناول المقالتان الأولى والثانية ما يُعرف
(13)بـ«الحجّة الأنطولوجية»، وهي حجّة عقلية خالصة تنطلق من تحليل مفهوم الله لإثبات وجوده دون الاعتماد على معطيات تجريبية. يعرض المقال الأول تطوّر هذه الحجة منذ أنسلم وصولًا إلى صيغها الحديثة التي تستفيد من منطق الجهة، بينما يقدّم المقال الثاني قراءة نقدية لصيغة بلانتينغا، مع اقتراح تعديلٍ مستلهمٍ من أفكار آيريس مورداك لتعزيز قوّة البرهان. أما «الحجّة الكونية» القائمة على الملاحظة التجريبية للكون، فتتناولها المقالتان الثالثة والرابعة؛ تتتبّع الأولى تطوّرها من أرسطو وتوما الأكويني إلى صيغها المعاصرة، فيما تركّز الثانية على «الحجّة الكونية الكلامية» باعتبارها صيغة معاصرة تستلهم جذورًا إسلامية. وتعالج المقالةُ الخامسة «الحججَ الغائية» المستندة إلى النظام والغاية في الكون، وتوضح كيف استخدمها فلاسفة كتوما الأكويني وويليام بيلي، ومفكّرون معاصرون مثل ريتشارد سوينبورن، للاستدلال على وجود مصمّم ذكي. في حين تتناول المقالةُ السادسة «حجةَ الضبط الدقيق» التي ترتكز على التناسق الدقيق في الثوابت الفيزيائية لبيان استبعاد المصادفة، واعتبار وجود خالق عاقل تفسيرًا مرجّحًا. أما المقالة السابعة، فتركّز على «الحجّة الأخلاقية»، من خلال تحليل الواقع العيني واللزوم الموضوعي للقيم الأخلاقية، وتعرض صورتين من البرهان: إحداهما قياسية، والأخرى تفسيرية ترى في وجود الله أفضل تفسير لواقع الإلزام الأخلاقي، وترجّح المقالة الصيغة التفسيرية بوصفها حجة قويّة تواجه الإلحاد المعاصر. وتتناول المقالةُ الثامنة «التجربةَ الدينية» بوصفها أساسًا معقولًا للإيمان بالله. ومن خلال تحليل الخبرة الشخصية للشعور بحضور إلهي، تُبيّن المقالة كيف يمكن للتجربة الدينية أن تشكّل أساسًا لحجّة معرفية معتبرة على وجود الله.
(14)أما المقالة التاسعة، فتعيد قراءة «رهان باسكال»، مبيّنةً أنّ الإيمان بالله - حتى مع غياب اليقين البرهاني - يُعدّ خيارًا عقلانيًا راجحًا من منظور الموازنة بين الأرباح والخسائر. وتعرض المقالة العاشرة إمكان عقلانية الإيمان بوجود الله حتى في غياب دليل مباشر، مستندة إلى نظريات معاصرة في الإبستمولوجيا، تُظهر أنّ كثيرًا من معتقداتنا تنشأ بطرق غير استدلالية، لكنّها تبقى مبرَّرة ومعقولة، وأنّ الإيمان بوجود الله قد يندرج في هذا النمط من الاعتقاد. وفي آخر أربع مقالات، يركّز المؤلّفون على نقد الإلحاد المعاصر، من خلال تحليل منطقي وفلسفي يكشف تناقضاته الداخلية وهشاشة بعض فرضيّاته.
وإلى جانب تقديمه لأحدث النتاجات الفلسفية الغربية في الدفاع عن وجود الله، يكشف هذا الكتاب خطأ التصوّر الذي يروّجه بعض الملاحدة بأنّ الإلحاد يُعدّ من لوازم التقدّم العلمي والتقني، كما هو شائع في تصوّرهم عن الغرب، ويُظهر في المقابل الحضور الفاعل والقوي للمؤمنين في الساحة الفكرية الغربية.
وفي الختام، أتقدّم بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى جميع من أسهم في إنجاز هذا العمل، وفي مقدّمتهم فضيلة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد هاشم الميلاني، رئيس المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، على دعمه الكريم وتوجيهاته السديدة، كما أتوجّه بالشكر إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محسن الموسوي على رعايته الكريمة ومتابعته الدقيقة لهذا المشروع حتى اكتماله. ولا يفوتني أن أعرب عن بالغ تقديري للأستاذ السيد محمد رضا الطباطبائي، مسؤول وحدة النشر، ولزميله الدكتور أحمد قطبي، لما بذلاه من جهود مشكورة في مراحل إعداد هذا العمل ونشره. كما أتقدّم بخالص الشكر للدكتور علي محمد بورإبراهيم على ما قدّمه من تنسيق ومتابعة فعّالة كان
(15)لها دور ملموس في إنجاز هذا المشروع. وأشكر الأستاذ محمدرضا الخاقاني على ملاحظاته القيّمة التي زادت النص وضوحًا وبيانًا.
ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الجهد مساهمة صادقة في ترسيخ الوعي الإيماني والمعرفي، وخطوة مباركة على طريق السلوك إلى الله، ابتغاءً لوجهه الكريم. نرجو أن يكون فيه ما يُعين على إنارة البصيرة، والتقرّب إلى الله، بفضله ومنّه. إنّه سميع الدعاء، وهو وليّ التوفيق، والحمد لله ربّ العالمين.
حامد فياضي
(16)جايسن ميغيل
ألهمت الحجج الأنطولوجية على وجود الله كمًّا كبيرًا من المؤلّفات التي صدرتْ خلال الألفيّة المنصرِمة، وما زال الجدالُ حول هذه الحجج مُستمرًا. شكّلت السنوات الخمسون الماضية على وجه الخصوص عصرًا ذهبيًا شهدته هذه الحجج حيث صدرتْ مؤلفاتٌ مثيرة للاهتمام تتمحورُ حولَ نماذج أقدم منها، فضلًا عن صياغة نماذج موجّهاتية أحدث منها.
في العام 1078، أنشأ القدّيس أنسيلم الحجة الأنطولوجية الأولى التي أثارت مقدارًا هائلًا من النقاش على مدى القرون العشرة التالية، وهو نقاشٌ ما زال حيًا إلى يومنا الحالي. تُقدِّمُ هذه المقالة نظرةً عامة حول هذا النقاش. سوف أتناولُ في القسم الأوّل الحجة الأصليّة وبعضَ الاعتراضات القديمة الموجّهة ضدّها من قِبل غاونيلو. في القسم الثاني، سوف أُناقشُ الجهودَ الفكرية حول الحجة التي برزت في الحقبة الحديثة المبكّرة، مُركِّزًا على صيغتَيْ كلٍّ من ديكارت
(17)ولايبنتس للدليل فضلًا عن الاعتراضات الجديرة بالملاحظة التي طرحها هيوم وكانط -من بين آخرين- ضدّ الحجة. أمّا في القسم الثالث، فإنّني سوف أُناقشُ المحاولات الرامية إلى إعادة تأهيل الحجة في القرن العشرين باستخدام منطق الجهة، مع تركيزٍ خاص على صيغة ألفين بلانتينغا للحجة الأنطولوجية. وفي القسم الرابع، سوفَ أختِمُ بمناقشة المؤلّفات المعاصِرة حول الحجة.
يعودُ أصلُ الحجة الأنطولوجية إلى كتاب القدّيس أنسيلم تحت عنوان «بروسولجيون». ثمّة خلافاتٌ تأسيسية متنوّعة تُحيطُ بالحجة. أشارَ أُوبي إلى أنّ البعض قد أنكرَ أنّ أنسيلم كان في طور إثبات وجود الله أصلًا. رغم ذلك، تتّفقُ الأغلبية أنّ أنسيلم كان يُحاولُ إثباتَ وجود الله، ولكن يختلفُ آخرون حول مكان وجود الدليل في النص. ثمّة اختلافٌ أيضًا حول عدد الحجج الأنطولوجية المتمايِزة التي قدّمها أنسيلم، بينما يُجادِلُ آخرون حول ماهية الدليل.
(18)بالفعل، ناقشَ أُوبي خمسَ محاولاتٍ مُتمايزة بُغية أن يذكرَ بوضوحٍ حجة أنسيلم.
رُغم ذلك، ثمّة «شرح معياري» لحجة أنسيلم، وهي من النوع الذي قد يصلُ إلى أسماع الفرد في دورةٍ تعليمية عنوانها «مقدّمة إلى الفلسفة» مثلًا، وسوف أُركِّزُ على هذه «الرواية المعيارية». يُعتَقَدُ بشكلٍ واسعٍ أنّ المقطع التالي هو مقطعٌ مهمٌ من صيغة أنسيلم للحجة:
«وعليه، حتّى الأحمق يقتنعُ بأنّ الشيء الذي لا يُمكنُ تصوُّر شيءٍ أعظم منه هو موجودٌ في الفهم، لأنّه حينما يسمعُ ذلك يفهمه، وكلُّ ما يتمُّ فهمه هو موجودٌ في الفهم. ومن القطعي أنّ الشيء الذي لا يُمكن تصوُّر شيء أعظم منه لا يُمكن أن يكون موجودًا في الفهم فقط، لأنّه إذا كان موجودًا في الفهم وحده، يُمكن تصوُّر وجوده في الواقع أيضًا وهذا أعظم. وعليه، إذا كان الشيء الذي لا يُمكنُ تصوُّر شيءٍ أعظم منه موجودًا في الفهم وحده، فإنّ الشيء الذي لا يُمكن تصوُّر شيءٍ أعظم منه هو نفسه ما يُمكنُ تصوّر شيء أعظم منه، وهذا قطعًا مُحال. وعليه، من دون ريب، الشيء الذي لا يُمكنُ تصوُّر أعظم منه هو موجود، في الفَهم وفي الواقع.»
يؤخَذُ الدليل بشكلٍ عام كالتالي:
1. الله، وفقًا للتعريف، هو «أعظم موجود قابل للتصوُّر». لا يُمكنُ أن نتصوّر موجودًا أعظم من الله.
(19)2. المؤمنون والملحدون (أو «الحمقى») على السواء يُمكنهم أن يتّفقوا بأنّنا نملكُ -على الأقل- فكرة الإله، ولكنّهم يختلفون حول إذا ما كانت تتطابقُ هذه الفكرة مع شيءٍ ما في الواقع. مع ذلك، لدينا فكرة عن هذا الموجود الأعظم القابل للتصوُّر.
3. فلنفترض، وفقًا لقياس الخُلف، أنّنا نملكُ فكرة الموجود الأعظم القابل للتصوُّر ولكنّ هذا الكيان غير موجود بالفعل. كما أنّنا نتصوّر وجود حصان وحيد القرن ولكن لا وجود فعلي له، فإنّنا نملكُ تصورًا عن الله ولكن لا وجود له.
4. ولكنّ هذا تناقض، فمن المؤكّد أنّ الوجود الواقعي هو أعظمُ من الوجود فقط في أذهاننا كتصور. الكائن الموجود كتصوّرٍ فقط ليس عظيمًا كالكائن الموجود كتصوّر والموجود أيضًا بشكلٍ فعليٍ في الواقع. في النهاية، هل تُفضِّلُ أن تملك مئة دولار في المصرف، أو تُفضِّلُ مُجرّد فكرة وجود مئة دولار في المصرف؟ لا يُمكنُ أن يكون الموجود الأعظم القابل للتصوُّر موجودًا فقط كتصوُّرٍ في أذهاننا، وعليه يتحتّمُ أن يكون هذا الموجود -الذي هو، استنادًا إلى التعريف، الموجود الأعظم القابل للتصوُّر- موجودًا في الواقع أيضًا.
5. وعليه فإنّ الافتراض الثالث هو خطأ، فلا يُمكنُ لهذا الموجود الأعظم القابل للتصوُّر أن يوجد فقط كتصوُّرٍ في أذهاننا وأن يفشل في أن يُوجد في الواقع. وعليه، فالله موجود.
حاولَ أنسيلم أن يُثبتَ وجود الله من الدعوى البسيطة المتمثّلة في أنّنا نملكُ تصوُّر الإله. نظرًا إلى الشرح المعياري للحجة الأنطولوجية، ثمّة اختلاف بين هذه الحجة وبين المحاولات العديدة الأخرى لإثبات وجود الله، وهو أنّ الحجة
قَبلية، أي إنّه لا يلجأ إلى الدعاوى التي يُمكن اكتسابها معرفيًا فقط من خلال التجربة. تعتمدُ كثيرٌ من الأدلة على وجود الله على مقدمة واحدةٍ على الأقلّ يُمكنُ إدراكها عبر التجربة فقط. على سبيل المثال، بُرهان التصميم الذكيّ يعتمدُ على الدعوى التجريبية التي تُفيدُ أنّ المخلوقات الحيّة تُظهِرُ البُنية والنظام، وهذا يدلُّ على أنّ مُصمِّمًا ذكيًا قد أنشأها. ولكن لا تلجأ الحجة الأنطولوجية إلى أيّ ادّعاءاتٍ تستلزمً مُراقبةَ طبيعة العالم. إضافة إلى ذلك، كثيرًا ما يُقالُ بأنّ الحجة هي «تحليلية»، وهذا يعني على وجه التقريب أنّ المرء يحتاجُ فقط للجوء إلى معاني الكلمات المتضَّمَنة للتوصّل إلى النتيجة؛ وقد حاول أنسيلم أن يُثبت وجود الله من معنى عبارة «أعظم موجود يُمكن تصوُّره». على سبيل المثال، يُمكن أن نسنتنج بأنّ رجلًا ما هو غير مُتزوّج إذا كان «أعزبًا»، وكذلك يُمكنُ أن نسنتنج (كما يُزعَم) أنّ شيئًا ما هو موجود إذا كان هو الموجود الأعظم القابل للتصوُّر.
تتمثّلُ إحدى الإستراتيجيات لإبطال الدليل في إنكار المقدمة (2)، وبالفعل لقد أنكر البعض أنّنا نملكُ فكرة الإله. قد يتّخذُ هذا الإنكار أشكالًا متنوّعة. لعلّ مفهوم الإله مُتلاحِم أو متّسق تمامًا، ولكنّ العقول البشرية -ربما بسبب المحدوديات المتنوّعة أو ببساطةٍ بسبب عدم إمكانية فهم الله- تفتقدُ للقدرة على إدراك هذا المفهوم. لعلّ المفاجئ هو أنّ أكويناس، الذي عُرف عنه محاولته لإثبات وجود الله، قد رفضَ الدليلَ الأنطولوجي، ويعودُ السبب وراء ذلك -على الأقلّ جزئيًا- إلى هذه المخاوف. وفقًا لأكويناس:
«بينما يُمكنُ أن نسردَ عبارة «الموجود الذي لا يُمكن تخيُّل أعظم منه» في
(21)أذهاننا، إلا أنّنا لا نملكُ فكرةً عن المعنى الحقيقي لهذه السلسلة من الكلمات. وفقًا لهذا الرأي، يختلفُ الله عن أيّ حقيقةٍ أخرى نعرفها. بينما يُمكن أن نفهم ببساطةٍ مفاهيم الأشياء المحدودة إلا أنّ مفهوم الكائن العظيم لانهائيًا يُحجِّمُ الفهمَ البشري المحدود. يُمكننا بالطبع أن نُحاول ربطَ عبارة «الموجود الذي لا يُمكن تخيُّل أعظم منه» مع مفاهيم محدودة هي أكثر إلفة، ولكنّ هذه المفاهيم المحدودة هي بعيدة جدًا عن أن تكون وصفًا ملائمًا لله، وعليه من المنصِف أن نقول بأنّها لا تُساعدنا في حيازة تصوُّر تفصيلي حول الله. »
ثمّة اعتراض شهير وقديم جدًا صاغه غاونيلو في وجه الدليل الأنطولوجي. أنتجَ غاونيلو «مُحاكاةً تهكُّمية» لحجة أنسيلم، أي إنّه قد صاغ نسخة معدّلة يسيرًا عن حجة أنسيلم لإثبات وجود شيءٍ مُنافٍ للعقل، وهذا يُلقي بظلال التشكيك على دليل أنسيلم. خُذ مثلًا «أفضل جزيرة يُمكن تصوُّرها»، وهي أكمل جزيرة يُمكن تخيُّلها حيث تتمتّع شواطئها بالعدد المثالي من حبوب الرمال وتتميّزُ حبّاتُ جوز الهند فيها من كلّ النواحي وما إلى ذلك. افترِض أنّنا استحضرنا فكرة هذه الجزيرة التي هي أفضل جزيرة يُمكنُ تصوّرها. وفقًا لاستدلال أنسيلم، من الأفضل أن توجد هذه الجزيرة في الواقع بدلًا من تحقّقها كفكرةٍ فحسب (لأنّ الوجود الفعلي يجعلها أعظم)، وبالتالي فالجزيرة موجودة. ولكنّ هذا مُنافٍ للعقل، ومن الواضح أن لا وجود لهذه الجزيرة. إذا كان بالإمكان توظيف الشكل الأساسي لدليل أنسيلم لإثبات هذه الأمثلة المنافية للعقل، فثمّة شيء
(22)خطأ في دليل أنسيلم. ما زال يُثيرُ اعتراضُ غاونيلو النقاشَ إلى يومنا الحالي. للاطّلاع على مُحاولتين حديثتَين لتقويض هذا الاعتراض، راجع ما كتبه دانييليان ووارد .
شكّلَ اعتراضُ غاونيلو مخطّطًا تبعه الخصومُ اللاحقون للأدلة الأنطولوجية. حتّى في يومنا الحالي، ثمّة إستراتيجية شائعة لإبطال الأدلة الأنطولوجية تتمثّلُ في مُحاكاتها تهكُّميًا. كما كتبَ أُوبي:
«الأدلة الأنطولوجية الإيجابية، أي الأدلة لصالح وجود الإله (الآلهة)، تقبل دائمًا أنواعًا مُختلفة من المحاكاة التهكُّمية، أي الأدلة الموازية التي تبدو على الأقلّ مقبولةً بالتساوي لغير المؤمنين ولكنّها تؤسِّسُ لاستنتاجاتٍ مُنافية للعقل أو مُتناقِضة. في كثيرٍ من الأدلة الأنطولوجية الإيجابية، ثمّة عدد من حالات المحاكاة التهكمية التي تزعمُ إثبات عدم وجود الإله (الآلهة)، وفي كثيرٍ من الأدلة الأنطولوجية الإيجابية ثمّة أعدادٌ كبيرة (غالبًا لانهائية هائلة!) من الأدلة المماثلة التي تزعمُ إثباتَ وجود أعداد كبيرة (غالبًا لانهائية هائلة) من الكائنات المتمايزة الشبية بالآلهة. »
استخدمَ أُوبي كلمة «دائمًا» التي تُشيرُ إلى أنّه يُمكن تطبيق المحاكاة التهكمية، بطريقةٍ أو بأخرى، بحقّ كلّ موجود وحتّى بحقّ كل دليلٍ أنطولوجي مُمكن. هذا قابلٌ للخصام (وقد خاصمه البعض فعلًا)، ولكنّ النقطة الأساسية في مقطع أُوبي تبقى صامدة: قابلية التعرُّض للمحاكاة التهكُّمية هي مسألةٌ جدية تتّصلُ
(23)بكثيرٍ من الصيغ الموجودة للدليل الأنطولوجي، وحينما يُواجِهُ الخبراء دليلًا أنطولوجيًا جديدًا يشرعُ كثيرٌ منهم فورًا بالبحث عن مُحاكاةٍ تهكُّمية.
ثمّة مشاكل إضافية مُتّصلة بدليل أنسيلم، وسوف نُناقِشُ بعضها أثناء مُناقشة أدلةٍ أنطولوجية أخرى أحدث.
شكّلت الحقبة الحديثة المبكِّرة حقبةً محوريةً في تاريخ الأدلة الأنطولوجية، وقد شهدتْ تطوُّرَ بعضٍ من أفضل الصيغ المعروفة للدليل الأنطولوجي والاعتراضات عليها. صاغَ ديكارت في كتاب «التأمُّلات» دليلًا أنطولوجيًا يؤخَذُ عمومًا كالتالي:
1. يملكُ الله جميعَ صفات الكمال، أي إذا وُجدتْ خاصية يمكن أن يتّصف بها شيءٌ ما وهذه الخاصية هي كمالية، فالله يملكها.
2. الوجود كمال.
3. بالتالي، الله موجود.
يتّسمُ هذا الدليل بفضيلة البساطة، ولكنّه يُواجِهُ اعتراضات. إحدى الاعتبارات المباشرة هي أنّه من غير الواضح إذا كان الوجودُ كمالًا. على فرض وجود مجموعةٍ فرعيةٍ من جميع الصفات يُمكنُ تسميتها «كمالات»، وعلى فرض إمكانية أن نعرف أيًا من هذه الصفات هو موجودٌ في هذه المجموعة وأي منها هو غير موجود، فليس واضحًا أن يندرج الوجود في هذه المجموعة. قد يبدو غريبًا أن ندّعي بأنّ الوجود كمال؛ أليست بعضُ الأشياء موجودة ولكن كان من الأفضل أن لا توجَد؟ على سبيل المثال، كيف يكون سرطان البنكرياس
(24)الذي يملكُ خاصية الوجود أكثر كمالًا؟ أليس من الأفضل أن ينعدم سرطان البنكرياس؟ أثار دليلُ ديكارت الأنطولوجي كمًّا كبيرًا من المؤلفات؛ يُمكنكم أن تُراجِعوا ما كتبه نولان للاطّلاع على مقدّمةٍ تفصيلية حول دليل ديكارت الأنطولوجي، وأن تُراجعوا على سبيل المثال ما كتبه ألستون وأبروزيسي وفورجي للاطّلاع على مزيدٍ من النقاش.
أنجز لايبنتس أيضًا مجهودًا مهمًا حول الحجة الأنطولوجية. فلنستحضِر الآن إحدى النقاط المتعلّقة بهذه الحجة التي ناقشناها آنفًا: إذا كان مفهوم الله غير مُتناغم بنحوٍ ما، فلا نملكُ في الواقع تصوُّرًا حول الله وبالتالي لا يُمكن أن نُظهر بجهدٍ بسيطٍ أنّ وجودَ الله ينبثقُ مباشرةً من ذاك التصوُّر. كان لايبنتس مُدركًا بشدّة لهذا القلق، وكان هذا هو الدافع وراء أغلب مؤلّفاته حول الحجة. ذكرَ لايبنتس أنّ الحجة الأنطولوجية ينجحُ فقط إذا:
«صدقَ أنّ الكائن الأكمل أو الكائن الواجب الوجود هو مُمكنٌ ولا يستلزمُ تناقضًا، أو -ما يُساوي الأمر نفسه- أنّ الجوهر الذي ينشأ منه الوجود مُمكنٌ. ولكن ما دامَ لم يتمّ إثبات هذا الاحتمال، لا يُمكنُ بأيّ نحوٍ من الأنحاء أن نعتقد بأنّ وجود الله يُثبَتُ بشكلٍ كاملٍ عبر هذا الدليل».
(25)كثيرًا ما يذكرُ لايبنتس «أنّ الدليلَ الأنطولوجي نفسه يُثبِتُ فقط أنّه إذا كان وجودُ الله مُمكنًا، فالله موجود». بالفعل، لا يُمكنُ اعتبارُ الدليل تامًا حتى يتمّ إظهار أنّ الله أو واجب الوجود أو الكائن الذي ينبثقُ وجوده عن الجوهر هو مُمكن. سعى لايبنتس إلى أن يُظهر إمكانية وجود الله إذ:
«يُعرّف «الكمال» على أنّه «خاصية بسيطة إيجابية ومُطلقة، أو الخاصية التي تُعبِّرُ من دون أيّ قيود عمّا تُعبّر عنه». ومع هذا التعريف في اليد، لايبنتس إذًا قادرٌ على أن يدّعي عدم إمكانية وقوع التعارض بين الكمالات، لأنّ الكمال، بما هو بسيط ووضعي، غير قابل للتحليل ولا يُمكنُ حصره بحدود.»
تتمثّلُ إحدى وسائل تفسير دليل لايبنتس كما يلي: خُذ بعين الاعتبار الكمالَين (أ) و(ب). لا يُمكن أن يتجزّآ فهما «بسيطان»، وإذا أُخذ كلّ واحدٍ منهما بشكلٍ فرديٍ فلا يُمكنُ أن ينقسما إلى مكوّناتٍ إضافية قد تُناقِضُ بعضها بعضًا. حينما يؤخَذ (أ) معزولًا فلا يُمكن أن يُنتِجَ تناقضًا، والأمر نفسه ينطبق على (ب) وكذلك على أي كمالٍ آخر. إضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أنّ (أ) و(ب) هما بسيطان، لا يُمكن استمدادُ تناقضٍ بينهما من خلال تجزأة (أ) و(ب) إلى قطعٍ، والعثور على قطعةٍ من إحداهما تُناقِضُ قطعةً من أخرى. إضافة إلى ذلك، لا يُمكن لكمالٍ آخر أن «يحدّ» أو «يتدخّل» أو يُناقِض (أ) و(ب) أو أيَّ كمالٍ غيرهما، وذلك لأنّ الكمالات من حيث التعريف لا يُمكنُ أن تكون محدودة. وعليه، يُمكن جمع أيّ
(26)كمالٍ مع أيّ كمالٍ آخر، من دون الخوف من الوقوع في التناقض. بذلك، يُمكن جمع كلّ الكمالات بشكلٍ متناغمٍ في الكائن نفسه، وبالتالي يكونُ الكائن الذي يحوي الكمالات كلّها مُمكنًا منطقيًا.
مع ذلك، لم يعتبر لايبنتس أنّ الحجة الأنطولوجية هي كاملة. كان يحملُ لايبنتس همًّا إضافيًا (ناقشناه آنفًا): لماذا نعتبرُ أنّ «الوجود هو كمال»؟ يذكرُ لوك ما يلي:
«يتحتّمُ على لايبنتس أيضا أن يُظهر بأنّ الوجود بحدّ ذاته هو كمال، وعليه يُمكنُ أن يُقال إنّ الكائن الذي يملكُ جميعَ الكمالات، الكائن الأكمل، هو موجود. بشكلٍ أدق، ينبغي أن يُظهر لايبنتس أنّ الوجود الواجب ينتمي إلى جوهر الله، وهذا ما يفعله في مقطعٍ قصيرٍ آخر يعودُ إلى هذه الحقبة حيث كتب: «مُجددًا، واجب الوجد هو عينه الكائن الذي ينبثقُ عن جوهره الوجود، لأنّ واجب الوجود هو ذاك الذي يوجد بالضرورة بحيث إنّ عدم وجوده يستلزمُ تناقضًا وبالتالي يتعارضُ مع مفهوم هذا الكائن أو جوهره». بتعبيرٍ آخر، لو كان الحال هو أنّ واجب الوجود هو عينه الكائن الذي ينبثقُ وجوده عن جوهره، ينبغي إذًا أن يكون الوجود بالفعل أحد خصائصه الأساسية».
بعبارةٍ وجيزة، وفقًا للتعريف، فإنّ واجب الوجود هو ذاك الذي يتحتّمُ وجوده، ومن التناقض أن لا يوجَد واجبُ الوجود. وعليه، فإنّ وجود واجب الوجود مُترتِّبٌ منطقيًا على مفهوم الوجود الواجب.
بينما كان ديكارت ولايبنتس أنصارًا للدليل الأنطولوجي، لم يكن جميعُ الفلاسفة في الحقبة الحديثة المبكِّرة كذلك. ساورَ القلق كُلًا من هوبز وهيوم -كما
(27)أكويناس قبلهما- من افتقادنا للإدراك اللازم لمفهوم الله ممّا يحولُ دون نجاح الأدلة الأنطولوجية. [إضافة إلى ذلك] لم يعتقد هيوم أنّ بإمكاننا إثبات وجود الله بحجة قَبلية:
«ثمّة شيءٍ مُنافٍ للعقل بوضوح في التظاهر بالبرهنة على أمر واقع أو إثباته بالحجج بطريقة سابقة على التجربة. ليس ثمّة شيء قابل للإثبات إلا إذا كان المنافي تناقضًا. لا شيء يُمكن تصوّره بشكلٍ مباشر يقتضي تناقضًا. كلُّ ما نتصوّرُ أنّه موجود، يُمكنُ أن نتصوّر أيضًا أنّه غير موجود. وعليه، ليس ثمّة كائن يقتضي عدمُ وجوده تناقضًا. بالتالي، لا يوجد كائن يُمكن إثبات نقيضه. »
يُمكن أن نتخيّل وجودَ وحيد القرن، ولكن يُمكنُ بسهولةٍ مُماثلة أن نتخيّل عدم وجوده. كذلك، يُمكن أن نتصوّر وجودَ واجب الوجود ويُمكنُ بسهولةٍ مُماثلة أن نتصوّر عدم وجوده. ولماذا نظنُّ أنّه يُمكن أن نُبرهن على وجود شيءٍ ما بطريقة قَبلية، فقد يُحتجّ أنّه لا يُمكنُ معرفةُ القيمة الحقيقية للادّعاءات على الوجود إلا من خلال مُراقبة العالم. لا يُمكنني على سبيل المثال أن أستدلّ على الادّعاء القاضي بوجود 24 كرسيًا في الغرفة، فعليّ أن أنظر إلى العالم كي أتحقّق من ذلك.
إحدى الاعتراضات الموجّهة ضد الحجج الأنطولوجية، الجديرة بالملاحظة والمنسوبة إلى الحقبة الحديثة المبكّرة، هي الادّعاء بأنّ «الوجود ليس محمولًا»، وما زال يُطرَح هذا الاعتراض بشكلٍ شائعٍ اليوم. يبدو أنّ صيغة ديكارت للدليل (وقد يُحتجّ أنّ ذلك يظهرُ أيضًا في صيغة أنسيلم وبعض الصيغ الأخرى على الأقل)، تفترضُ سلفًا أنّ الوجودَ هو خاصيةٌ يُمكنُ أن تملكها الأشياء،
(28)كالاتّصاف باللون الأزرق أو الحجم الكبير أو التمتُّع بالقوّة المطلقة، ولكن هل إنّ الوجود كذلك؟ هل الوجود خاصية أصلًا؟ كان هذا الاعتراض مُتوقَّع البروز بعد صدور كتاب ديكارت «التأمُّلات»، ويُرجَّحُ أنّ أول من أثاره كان غاسيندي. كتبَ نولان ما يلي:
«واجه العالِمُ التجريبي بيار غاسيندي الذي عاشَ في القرن السابع عشر ديكارت بهذا النقد في المجموعة الخامسة من الاعتراضات (ويستحقّ التقدير لأنّه كان أول من أفصح عنه): «الوجود ليس كمالًا، لا في الله ولا في أيّ شيءٍ آخر؛ بل إنّه ذلك الشيء الذي من دونه لا يُمكن أن تتحقّق أي كمالات». كما هو الحال مع أغلب الردود التي قدّمها ضدّ غاسيندي (والذي اعتبره ماديًا ومُراوغًا مقيتًا)، أجاب ديكارت ببعض الاقتضاب».
ساورَ هيوم قلقٌ مماثل، ولكنّ هذا الاعتراض يُنسَبُ عمومًا إلى كانط. حينما يعترضُ أحدُهم على الأدلة الأنطولوجية من خلال إنكار أنّ الوجودَ هو محمول، فيُحتملُ أنّه يقصدُ صيغة كانط لهذا الاعتراض. خُذ على سبيل المثال فكرةَ ورقةٍ مالية من فئة 100 دولار. تملكُ هذه الفكرة عدّة خصائص كاللون الأخضر والشكل المستطيل وما إلى ذلك. الآن، خُذ بعين الاعتبار إضافة خاصية الوجود المزعومة إلى هذه الفكرة. إنّ إضافة تلك «الخاصية» إلى الفكرة لا يُغيِّرُ طبيعةَ الفكرة بأيّ نحوٍ من الأنحاء؛ بمعنىً ما، إنّ فكرة ورقة المئة دولار هي نفسها سواء كانت هذه الورقة موجودة أم لا. يدلّ هذا في نظر كانط على أنّ الوجودَ
(29)ليس خاصيةً كاللون الأخضر أو الشكل المستطيل، بل إنّ الوجود ليس خاصيةً مُطلقًا. نظرًا إلى أنّ حجة ديكارت تفترضُ مُسبقًا أنّ الوجود يُشكِّلُ خاصية، ونظرًا إلى أنّ الوجود ليس خاصية، لا يُمكنُ أن ينجحَ حجة ديكارت. إحدى الأسئلة المثيرة للانتباه هي فيما إذا كانت تقعُ الصيغ الأحدث للدليل الأنطولوجي -التي سوف نناقشها قريبًا- فريسةً لاعتراض كانط. في الختام، تجدرُ ملاحظة أنّ البعض يُنكرُ أنّ هذا الاعتراض ينطبق حتى على جميع الصيغ الأقدم من الدليل. مثلًا، أنكرَ لوكهيد خضوعَ نموذج أنسيلم من الدليل لهذا الاعتراض.
طوّر علماءُ المنطق في القرن العشرين أنظمةً للمنطق الرسميّ قادرةً على التعامل مع مفاهيم الإمكان، أي ما يُمكنُ أن يحصل، ومع الوجوب، أي ما ينبغي أن يحصل. تُسمّى الأنظمة المنطقية القادرة على التعامل مع الإمكان والوجوب «منطق الجهة». يتمُّ التوصُّل إلى أنظمة منطق الجهة عمومًا من خلال إضافة مُسلَّمةٍ واحدة أو أكثر تتعلّقُ بالإمكان أو الوجوب إلى المنطق المعياري من الدرجة الأولى. يُعتقدُ عمومًا أنّ هذه المسلّمات هي غير إشكالية؛ مثلًا، لا أحدَ يُجادِلُ في ما يُسمّى المسلَّمة T (إذا كان P بالضرورة، فـP إذًا) ولكن عارضَ البعضُ أحيانًا الأنظمة الأقوى من منطق الجهة مثل S5 (التي سوف نشرحها في المقطع التالي).
إحدى المفاهيم المهمّة في منطق الجهة المعاصِر هو «العالم الممكن». يُشكِّلُ العالمُ الممكن إحدى الطرق التي يمكن أن يكون عليها الكون. العالمُ الفعليّ
هو عالمٌ ممكن؛ الكون الذي نعيشُ فيه هو بشكلٍ واضحٍ طريقةً واحدة لتحقُّق الكون. ولكن يبدو أنّ الأمور كانت لتكون مُختلفة عمّا هي عليه الآن من عدّة طرق. مثلًا، كان من الممكن أن يخسرَ ترامب الانتخابات الرئاسية في العام 2016. وعليه، يُفتَرضُ وجودُ عالمٍ ممكن حيث لا يكونُ ترامب رئيسًا. إذا كان شيءٌ ما صحيحًا في عالمٍ مُمكن واحدٍ على الأقل، فهو مُحتملُ الصحّة ويُمكن أن يكون صحيحًا. إذا كان الشيء صحيحًا في جميع العوالم الممكنة، فهو واجب الصحّة، ويجبُ أن يكون صحيحًا. وإذا كان الشيء غير ممكن، فهو لیس صحيحًا في أی عالمٍ ممكن. في ما يُحتملُ أنّه أهمّ تطورٍ في الدليل الأنطولوجي منذُ الحقبة المبكّرة المعاصِرة، قام بعضُ الفلاسفة بتوظيف منطق الجهة لتطوير نماذج جديدة ومتقدّمة إلى حدٍّ بعيد للدليل تُسمّى بـ«الحجج الأنطولوجية الموجّهاتية».
تمّت صياغة عدّة حجج أنطولوجية موجهاتية هامّة في القرن العشرين، ومن الأمثلة عليها نموذجَا غودل ومالكوم. سوفَ أُركِّزُ فيما يلي على النموذج الذي قدّمه بلانتينغا في العام1974. الصيغةُ الأولية التي طرحها بلانتينغا لحجّته هي
(31)مُعقَّدة، فقد طوّر وانتقد أدلةً مُتنوّعةً في جُهده الرامي للعثور على نموذجٍ صالح للتطبيق. تستندُ حجّة بلانتينغا النهائية على تعريفَين. يذكرُ بلانتينغا أنّ الموجود يكونُ «مُتميزًا بالحدّ الأعلى» إذا امتلكَ جميعَ الخصائص التي يُعتقَدُ أنّ الله يملكها في التراث اللاهوتيّ الغربيّ -أي القدرة المطلقة والعلم المطلقة وما إلى ذلك- في عالمٍ مُمكن. يكونُ الموجود «عظيمًا بالحدّ الأعلى» إذا كان مُتميزًا بالحدّ الأعلى بالضرورة، أي إنّ الموجود مُتميزٌ بالحدّ الأعلى في جميع العوالم الممكنة، وهذا يقتضي أيضًا الوجود في جميع العوالم الممكنة. وعليه، على سبيل المثال، فلنفترِض وجودَ عالَمٍ مُمكنٍ نُشيرُ إليه بـ(ع) يحوي الله، والله يملكُ جميعَ الخصائص التقليدية لصناعة العظمة، ولكن في عالمٍ آخر يفتقدُ هذا الموجود لإحدى الصفات الإلهية (مثلًا ربما لا يملك القدرة المطلقة). هذا الموجودُ مُتميِّزٌ بالحدّ الأعلى في (ع) ولكنّه ليس عظيمًا بالحدّ الأعلى (لأنّه يفتقدُ لبعض العظمة في عالمٍ واحدٍ على الأقل). ولكن إذا كان هذا الموجودُ مُتميزًا بالحدّ الأعلى في جميع العوالم الممكنة، فهو عظيم بالحدّ الأعلى. فلنفترِض الآن إمكانيةَ أن يتواجد كائنٌ عظيمٌ بالحدّ الأعلى، أي أن يوجد عالَمٌ ممكنٌ يحوي كائنًا عظيمًا بالحدّ الأعلى. ولكن بما أنّ هذا الكائن هو عظيمٌ بالحد الأعلى، وبما أنّ العظمة القصوى تستلزمُ التميُّز الأقصى والوجود في جميع العوالم الممكنة، يُمكننا أن نستدلّ بأنّ هذا الكائن هو «واجب بالإمكان». هذا الكائن مُمكن لأنّه موجودٌ في عالمٍ واحدٍ على الأقل، ولكّنه واجبٌ لأنّه وفقًا للتعريف يتواجدُ في جميع العوالم الممكنة، فهو واجبٌ بالإمكان.
تُشكِّلُ S5 إحدى المسلَّمات في منطق الجهات، وتنصُّ على أنّه إذا كان شيءٌ ما واجبًا بالإمكان، فهو واجب. وعليه، وفقًا لـS5، إذا وُجِد واجب الوجود في
(32)عالَمٍ واحدٍ مُمكن فإنّه يوجد في جميع العوالم الممكنة. (قد تبدو مُسلَّمة S5 غريبةً، ولكن يمكن القول أنّها ناجمة عن المعنَيَين البحتَين لـ«الإمكان» و«الوجوب» في منطق الجهة). وعليه، نظرًا لـS5، ونظرًا للادّعاء بأنّ الكائن العظيم بالحدّ الأعلى هو واجبٌ الإمكان، ينتجُ عن ذلك أنّ الكائن العظيم بالحدّ الأعلى هو واجب وبالتالي يوجدُ في جميع العوالم الممكنة، ومن ضمنها عالمنا. اللهُ موجود.
فيما يلي، نُقدّمُ الدليلَ بشكلٍ أكثر منهجية:
1. استنادًا إلى التعريف، يكونُ الموجود «عظيمًا بالحدّ الأعلى» إذا كان «مُتميِّزًا بالحدّ الأعلى» وموجودًا في جميع العوالم الممكنة.
2. من الممكن أن يوجد كائنٌ عظيم بالحدّ الأعلى؛ عالَم ممكن يحوي موجودًا عظيمًا بالحدّ الأعلى. بما أنّه عظيمٌ بالحدّ الأعلى، فإنّ هذا الكائن يوجد على نحوٍ واجب (وفقًا للتعريف). وعليه، الكائن العظيم بالحدّ الأعلى هو واجبٌ بالإمكان.
3. إذا كان الموجود العظيم بالحدّ الأعلى واجبًا بالإمكان، فإنّ الموجود العظيم بالحدّ الأعلى هو واجب الوجود. هذا مثال عن المسلّمة الموجهاتية S5.
4. وعليه، الموجود العظيم بالحدّ الأعلى هو واجبُ الوجود. هذا ينتجُ عن (2) و(3) وفقًا لقانون الاستلزام. هذا يعني أنّ الله موجودٌ في جميع العوالم، ومن ضمنها عالمنا.
يتّخذُ بلانتينغا موقفًا متواضعًا حيال دليله، فهو لا يدّعي أنّ الدليل يُشكِّلُ بُرهانًا غير قابل للدحض على وجود الله، ولكنّه يدّعي أنّ الدليل يجعلُ على الأقل الإيمان عقلانيًّا. يذكرُ بلانتينغا ما يلي:
«ينبغي أن يكون حُكمُنا على هذه النماذج التي أُعيدت صياغتها حول دليل
(33)القدّيس أنسيلم كما يلي: ربما لا يُمكنُ أن يقال بأنّها تُبرهن أو تُثبت نتيجتها، ولكن بما أنّه من العقلاني القبول بمقدمتها المركزية (أي أنّ هكذا كائن هو ممكن على الأقل)، فإنّها تُظهِرُ أنّه من المنطقيّ القبول بذلك الاستنتاج. »
مع ذلك، يُنكرُ البعض أنّ بلانتينغا قد نجحَ في إثبات هدفه المتواضع، وقد أثارت حجّته جدلًا حيويًا. يشكُّ أُوبي بأن يُقنع الدليل غير المؤمنين أو حتّى بضرورة أن يُقنعهم، وقد كتبَ ما يلي:
«أي شخصٍ يملكُ القسط الأدنى من العقلانية، ويفهمُ مقدمة الحجة ونتيجتها، وتُساوره الشكوك حيال الادّعاء بأنّه مقبولٌ عقليًا الاعتقاد بوجود كائنٍ يملكُ العظمة القصوى، سوفَ تُساوره الشكوك نفسها حيال الادّعاء بأنّه مقبولٌ عقليًا الاعتقاد بوجود عالمٍ ممكن يوجد فيه كائنٌ يملكُ العظمة القصوى. »
قد يُظنُّ أنّ الادّعاء بأنّ الله ممكن هو ادّعاءٌ معقولٌ وضعيفٌ نوعا ما؛ في النهاية، ربما يتّفق المؤمنون وغير المؤمنين على إمكانية وجود الله (رغم أنّ الملحد يُنكر وجوده). وعليه، ننتقلُ مع منطق الجهة إلى الادّعاء بوجود الله، وهذه هي الطريقة التي يُفترَضُ أن يسير عليها دليلُ بلانتينغا، ولكن يرفض أُوبي هذا الأمر. أيضًا قد يتساءل المرء حول إمكانية أن يُواجه دليلُ بلانتينغا مُناسباتٍ من المحاكاة التهكُّمية من الطراز الذي قدّمه غاوينيلو. يبدو أنّه يُمكنُ أن نُوظِّف دليل بلانتينغا لإثبات وجود كائناتٍ متنوّعة مُنافية للمنطق. كتبَ تولي ما يلي:
«فلتدلّ P على خاصيةٍ ما، وليتمّ تعريفُ خاصية الاتّصاف بأقصى قدرٍ من P على أنّها تلك الخاصيّة التي يملكها الشيءُ إذا -وفقط إذا- كان موجودًا ويتّصفُ بـ Pفي كلّ عالَمٍ ممكن. فإذا تمّ التسليم بأن خاصية الاتّصاف بأقصى قدرٍ من P
(34)هي مُثبَتة بالإمكان، فينتجُ عن ذلك أنها مُثبَتة. سوف يؤدّي هذا إلى عالمٍ مُزدحم بالسكّان، وسوف يؤدّي أيضًا إلى تناقضات».
خُذ على سبيل المثال خاصية «الإذابة». افترِض أنّه من الممكن لشيءٍ ما أن يكونَ مُذيبًا لغيره بالحدّ الأقصى، وبما أنّه يتمتّعُ بأقصى حدٍ من القدرة على الإذابة فهو موجودٌ في جميع العوالم الممكنة. ولكن لماذا لا نتصوّر حيازة شيءٍ آخر بشكلٍ ممكن لخاصية مُقاومة العوامل المذيبة بالحدّ الأقصى؟ بالتالي، يوجدُ هو أيضًا. وعليه، يُمكنُ أن نسنتج وجودَ كيانَين مُنافيَيْن للمنطق، وإضافة إلى ذلك فإنّ وجود كيانٍ منهما يُناقِضُ الآخر (لأنّ أحدهما يُذيبُ كلَّ شيء بينما الآخر غير قابل للإذابة).
الأعمالُ الفكرية الأحدث
شهدتْ العقودُ القليلة الماضية اهتمامًا متواصلًا بالأدلّة الأنطولوجية التقليدية والأدلّة الأنطولوجية الموجهاتية، فقد ظهرَ عددٌ من المقالات الحديثة في مجال مراجعة الأدلّة الأنطولوجية. كما يذكرُ أُوبي، وردت كثيرٌ من الأبحاث الحديثة حول الأدلة الأنطولوجية في الخلاصات والكتب التفصيلية والموسوعات وما إلى ذلك. على سبيل المثال، ثمّة نقاشاتٌ في مجال مراجعة الأدلّة الأنطولوجية فيما
(35)ألّفه:ليفتو، ماثيوز، لُو،أُوبي، ومايدول.
بالفعل، كُرِّستْ كتبٌ كاملة للأدلّة الأنطولوجية، وإحدى الأمثلة هي ما ألّفه شاتكوفسكي. سوف أختتمُ هذه المقالة بتقديم نظرةٍ عامة واسعة حول بعض المؤلّفات الحديثة.
تتمثّلُ إحدى التطوّرات المهمة في صياغة عددٍ من الأدلة الأنطولوجية الموجّهاتية الجديدة. إحدى الأمثلة الحديثة المثيرة للاهتمام هي «حجة الكمال الموجهاتي» من تأليف مايدول حيث سعى إلى إثبات وجود «الكائن الأعلى»، أي أعظم كائن ممكن بالضرورة. كما العديد من الحجج الأجدد، فإنّ حجة مايدول تقنيةٌ إلى حدٍ بعيد وتمّت صياغتها ضمن منظومة 2QS5 من منطق الجهة. ولكن رُغم تقنيتها، يُمكن أن نشرحَ مقدمات حجّته بعباراتٍ عادية. تستندُ الحجة إلى ثلاث مقدمات.
أولًا نفيُ أي «كمال» هو ليس كمالًا بذاته. مثلًا، على فَرض أنّ القدرة المطلقة هي كمال، فإنّ عدم هذه القدرة الكلية لا يُعدُّ كمالًا.
ثانيًا، الكمالاتُ تستلزمُ فقط كمالاتٍ أخرى. فمثلًا، إذا كان الخير اللامحدود كمالًا، وهذه الصفة تقتضي خصائص أخرى (كاللطف أو ما إلى ذلك)، فإنّ هذه المقتضيات هي كمالاتٌ أيضًا.
(36)ثالثًا، الاتّصاف بـ«العلوّ» أو أن يكون الموجود أعظم كائن ممكن بالضرورة، يُعدُّ كمالًا.
ثمّة أشياء كثيرة مُثيرة للإعجاب في حجة مايدول؛ على سبيل المثال، يُعرِّفُ مايدول بشكلٍ صريحٍ مُصطلح «الكمال» (إذا كان من الأفضل الاتّصاف بخاصيةٍ مُحدّدة عوضًا عن عدم الاتّصاف بها، فإنّ هذه الخاصية هي «كمال»). الحجة صحيحة بوضوح؛ وإذا كانت المقدمات صحيحة (وإذا قبلنا بمنظومة 2QS5)، يُمكنُ أن نستمدّ منطقيًا الدعوى بوجود كائنٍ أعلى. وظّفَ مايدول مقدماته كي يُظهِر أنّ الموجود الأعلى الفريد ممكن، وقد استننتجَ من مقدماته على سبيل المثال إمكانية وجود كائن على نحوٍ يستحيلُ لكائنٍ آخر أن يكون أعظم منه وبعد أن أثبت مايدول أنّ هذا الكائن ممكن، استطاعَ أن يستنتج ضمن منظومة 2QS5 أنّ هذا الكائن واجب، وبالتالي هو موجودٌ في جميع العوالم الممكنة.
ولكن كما جميع الأدلة الأنطولوجية، واجه الدليلُ اعتراضات. إحدى نقاط القلق هي أنّ مايدول وظّفَ صيغة باركان في بُرهانه؛ ويرى مايدول أنّ الاعتماد على هذه الصيغة هو أكبرُ ضعف في دليله. تقتضي صيغة باركان بعض الادّعاءات الموجهاتية التي يجدُ البعضُ أنّها غير معقولة. على سبيل المثال، وفقًا لصيغة باركان، فإنّ أي شيء ممكن الوجود في العالم الفعلي، فإنّه يوجَدُ فيه. ولكن أليس من المؤكّد أنّ بعض الأشياء هي مُمكنة الوجود في عالمنا ولكنّها ليستْ مُتحققة فيه (ولن تتحقّق قط)؟ قد يُظنُّ أنّ هذه النقطة واضحة أنّ التنِّين مثلًا رغم أنّه ممكن الوجود ولكن لن يوجَد قطّ أيُّ تنّين في عالمنا. ولكن وفقًا لصيغة باركان، إذا كان التنّين مُمكن الوجود فعليه أن يخرج إلى عالم الوجود في مرحلةٍ
(37)ما من الزمن. أقرّ أُوبي أنّ صيغة باركان هي مُثيرة للجدل وربما ينبغي رفضُها، إلا أنّه شنّ هجومًا مُختلفًا فقد رفضَ الفرضية الثانية للدليل التي تنصُّ على أنّ الكمالات تستلزمُ الكمالات فقط. ذكر أُوبي ما يلي:
«خُذ بعين الاعتبار صفة العلوّ أو السّفك الجماعي للدماء. وجودُ هذه الصفة مضمونٌ من قِبل مبدأ التجريد غير المقيَّد الذي ينتمي إلى 2QS5. فضلًا على ذلك، من الواضح إلى حدٍ كبير أنّ أيَّ شيءٍ يملكُ صفةَ العلوّ فإنّه يملكُ هذه الصفة الإضافية. ولكن من غير البديهي تمامًا أن نفترض أنّ الاتّصاف بإمّا العلوّ أو سفك الدماء يُعدُّ كمالًا. هذا واضحٌ على نحو الخصوص حينما نأخذُ بعين الاعتبار التفسير البديهي الذي منحه مايدول للكمالات: من الواضح أنّ الأمر ليس على نحوٍ بحيث إنّ الاتّصاف بإمّا السموّ أو سفك الدماء يُعدّ صفةً يُفضَّلُ الاتّصاف بها من عدمه. كان من الأفضل بكثير أن لا يتّصف ستالين أو هيتلر بهذه الصفة. هذه النقطة لا تقبل النقاش. »
ردّ مايدول على أُوبي، وردّ أُوبي عليه بدوره. راجع ما كتبه ميتكالف للاطّلاع على مزيدٍ من النقد على حجة مايدول. صاغ آخرون حديثًا نماذجَ جديدة من الحجة الأنطولوجية الموجهاتية. سعى بيرنستين مثلًا إلى أن يستنتجَ
(38)وجودَ الله من ادّعائين فقط: الله موجودٌ بالإمكان، والوجود الواجب هو كمال. دافعَ بيرنستين أيضًا على حجته في وجه بعض الاعتراضات التقليدية.
لا تُعدُّ كلُّ المؤلّفات الحديثة حول الحجج الأنطولوجية مُحاولاتٍ للعثور على نماذج جديدة عن الحجة، سواء كانت مُوجّهاتية أم غير ذلك. يتمُّ حاليًا مناقشةُ عددٍ من القضايا في المؤلفات الحديثة. على سبيل المثال، ابتكر البعضُ دفاعاتٍ جديدة عن دليل/أدلة أنسيلم. احتجّ ماثيوز وبايكر أنّ بعضَ الأشياء تملكُ قوىً سببية مباشرة، بينما تملكُ أشياء أخرى مثل بيغاسوس قوىً سببية غير مباشرة، أي يُمكنها أن تُسبِّب الأمور «عبر الأفكار والتصويرات والمؤلّفات التي يردُ فيها (بيغاسوس) ». مُسلّحًا بهذا التمييز، قاموا بصياغة نموذجٍ من دليل أنسيلم يُزعَم أنّه لا يعتمدُ على كون الوجود محمولًا. عارضَ مان دليلهم مُدعيًا مثلًا أنّهم قد فشلوا في إظهار أنّ الكائن الأعظم الذي يُمكنُ تصوّره هو ممكنٌ منطقيًا (كما شاهدنا، هذا اعتراضٌ ثابت على الأدلّة الأنطولوجية). بينما يبحثُ البعضُ عن طرقٍ جديدة للدفاع عن بُرهان أنسيلم، كشف آخرون مشاكل جديدة لم تُلحَظ من قبل في دليل أنسيلم. إحدى الأمثلة الجديرة بالملاحظة هي ما
(39)طرحه ميليكان الذي احتجّ أنّ دليل أنسيلم يُعاني من خطأٍ منطقيٍ بسيط، وهو غموضٌ في النطاق يُقوِّضُ الحجّة بشكلٍ كاملٍ ويُمكنُ تعميمه على نماذج أخرى من الدليل. كذلك، ما زال آخرون يُحاولون أن يُدافعوا عن الأدلة الأنطولوجية السابقة غير دليل أنسيلم أو أن يُفنّدوها. على سبيل المثال، حاول براس أن يُحسِّن الدليل الأنطولوجي الذي قدّمه غودل من خلال تأسيس إمكانية وجود الله عبر مبادئ أكثر معقوليةً من تلك التي وظّفها غودل.
برزت أيضًا بعضُ الجدالات الحديثة حول طبيعة الصفات الإلهية واتّساقها، وهذا الجدالُ مُتّصلٌ بشكلٍ مباشر بالدليل الأنطولوجي واللاهوت الأنسيلمي عمومًا. على سبيل المثال، استندَ ويتكوم إلى جدالاتٍ حديثة حول مفهوم «التأسيس» مُحتجًا بأنّ العلم المطلق مُحال، وبالتالي لا يُمكن أن يوجد إلهٌ كامل على الطراز الأنسيلمي. أمّا بيلز، فقد قدّم ردًا مُثيرًا للاهتمام على رأي ويتكوم، مُحتجًّا من بين أمورٍ أخرى أنّه لو كان ويتكوم مُحقًا فلا شيء حقيقي إذًا وأغلبُ
(40)الناس يؤمنون فقط بأشياء باطلة، وهذا يبدو غير معقول.
ربما، في مرحلةٍ ما، سوف يتلاشى الاهتمامُ المكثَّف بالأدلة الأنطولوجية، ولكن نظرًا إلى أنّ عُمر هذا الدليل هو ألف عام وما زال يُنتِجُ نقاشًا مُستعرًا إلى يومنا الحالي، فمن المستبعد أن يُهمَل هذا الدليل كليًا.
(41)المصادر
إليزابث بِرنز
يذكرُ ويليام رو أنّه «لا يُوجد عَرضٌ للدليل الأنطولوجي تم تطويره بعناية وقوة ووضوح مثل صياغة بلانتينغا ونقاشه للدليل في الصفحات 198-202 من [كتاب] «طبيعة الوجوب»، ودفاعه عن نموذجٍ موجّهاتي من ذلك الدليل في الصفحات 213-221».
(45)يرى رو، مع ذلك، أنّ دليلَ أنسيلم، كما أعادَ بلانتينغا صياغته، هو مُصادرة على المطلوب، وذلك لأنّه من أجل معرفة صِدق المقدمة الرئيسية –«يُمكن أن يوجد الله في الواقع»- يجب أن نعرف، بشكلٍ مُستقلٍ عن الدليل، أنّ الله موجودٌ فعلًا في الواقع. أحتجُّ في هذه المقالة أنّ رو يُركِّزُ على إعادة صياغة بلانتينغا لدليل أنسيلم على حساب النسخة المؤثرة لبلانتينغا نفسه من الدليل، وأنّه في الواقع، استبقَ بلانتينغا اعتراضَ رو وتناوله. رغم أنّني أعترفُ بأنّ ردَّ بلانتينغا ليسَ مُرضيًا تمامًا، إلا أنّني أقترحُ أنّه قد يكونُ من الممكن البناء على مجهود بلانتينغا وذلك من خلال زيادة خطوةٍ إضافية إلى الدليل المستخرَج من مؤلّفات آيريس مورداك تُظهِرُ أنّ وجودَ الله ليس مُمكنًا فحسب بل ضروري، وبالتالي فإنّ وجوده فعليّ.
يسعى بلانتينغا في كتاب «الله، الحرية، والشر» أن يُقدِّم نموذجًا عن دليله يُمكنُ أن يفهمه «المبتدئ [في] الفلسفة و... القارئ العام المفترض». تلخيصُ الدليل هو كالتالي:
1. ثمّة عالم ممكن حيث يكون للعظمة القصوى مصداق.
2. بالضرورة، يكونُ الكائن عظيمًا بالحدّ الأقصى فقط إذا كان يملكُ التميُّز
(46)الأقصى في كلّ عالم.
3. بالضرورة، يملكُ الكائن التميُّز الأقصى في كلِّ عالَمٍ فقط إذا كان يملكُ العلم المطلق والقدرة المطلقة والكمال الأخلاقيّ في كلّ عالَم.
4. إذا كان (1) صحيحًا، فثمّة عالَم ممكن «ع» حيث –لو كان حقيقيًا- لوُجِد كائن عليمٌ وقديرٌ وكامل أخلاقيًا قد ملكَ هذه الخصائص في كلّ عالَمٍ ممكن.
5. إذا كان عدمُ وجود كائن عليمٍ وقدير وكاملٍ أخلاقيًا مُستحيلًا في عالَمٍ ممكنٍ واحدٍ على الأقلّ، فهو مُحال في كلّ عالَمٍ ممكن لأنّ ما هو ممكن لا يختلفُ من عالَمٍ إلى آخر.
6. وعليه، فإنّ عدم وجود كائنٍ عليمٍ وقديرٍ وكاملٍ أخلاقيًا هو مُستحيل في عالمنا الفعليّ وفي كلّ عالَمٍ ممكن.
بعبارةٍ وجيزة، يُعادِلُ الدليل ما يلي:
أ. من الممكن وجود كائنٍ يملكُ العظمة القصوى، أي كائن يملكُ التميُّز الأقصى في كلّ عالَمٍ ممكن.
ب. بما أنّ عالمنا هو عالَمٌ ممكن، فيجب أن يتضمّن كائنًا يملكُ العظمة القصوى.
بتعبيرٍ آخر:
لا يوجد عالَم قابل للتصوُّر لا يوجد فيه كائن عظيمٌ يالحدّ الأقصى قابلٌ للتصوُّر.
(47)يضمُّ كتاب «طبيعة الوجوب» الذي نُشِر في نفس العام الذي صدر فيه كتاب «الله، الحرية، والشر» كمًا كبيرًا من مُحتوى الكتاب الثاني ولكن «بشكل أكثر دقة وكمالًا»، ويقدّم حجّة تستبدلُ «العظمة القصوى» بـ»العظمة التي لا يُعلى عليها». يحتجُّ بلانتينغا أنّه في حين أن هناك بعض الخصائص (مثل «كونه شخصًا بشريًا») التي تتحقق فقط في بعض العوالم، فإن هناك خصائص أخرى (مثل «كونه شخصًا في كل عالم») لا يمكن أن تتحقق في بعض العوالم فقط؛ هذه الخاصيّة هي «خاصية شاملة»، أي لها مصاديق إمّا في كلّ عالَم أو ليس في أيّ عالَم. يدّعي بلانتينغا أنّ «العظمة التي لا يُعلى عليها» هي خاصيةٌ على هذا النحو لأنّ عبارة «يملكُ العظمة التي لا يُعلى عليها» تُوازي الخاصيّة الشاملة المتمثِّلة بـ»امتلاك التميُّز الأقصى في كلِّ عالَم»، وبالتالي تلك العظمة التي لا يُعلى عليها لها مصداق في هذا العالم.
رُغم عنوان مقالته -«ألفين بلانتينغا والدليل الأنطولوجي»- يتمحورُ تركيزُ رو في الواقع على إعادة صياغة بلانتينغا لنموذج أنسيلم عن الدليل. هذا له أهمية لأنّه، كما يذكرُ بلانتينغا نفسه: «وجود النماذج المختلفة بشكلٍ هام يجعلُ أغلب «التفنيدات» التي يجدها الفرد في الكتب الدراسية تبدو سخيفةً للغاية».
فيما يلي نموذج عن إعادة صياغة بلانتينغا لدليل أنسيلم على نحوٍ يضمُّ تعديلاتٍ لاحِقة:
1. الله موجودٌ في الفَهم وليس في الواقع.
(48)2. الوجود في الواقع هو أعظم من الوجود في الفَهم وحده.
3. من الممكن أنّ الله موجودٌ في الواقع.
4. إذا كان الله موجودًا في الواقع، فإنّ الله سيكون أعظم ممّا هو عليه الله (من 1 و2).
5. من الممكن أن يوجد كائن أعظم ممّا هو عليه الله (من 3 و4).
6. من الممكن أن يوجد كائن أعظم من الكائن الذي ليس من الممكن وجود شيء أعظم منه (من 5، من خلال تعريف «الله».)
ولكن:
7. ليس من الممكن وجود كائنٍ أعظم من الكائن الذي ليس من الممكن وجود أعظم منه.
بالتالي، بما أنّ (6) و(7) مُتناقضان:
8. من الباطل أن يوجد الله في الفَهم ولكن ليس في الواقع.
رفضَ رو المقدمة الثالثة من هذا الدليل على الأسُس التالية: «إنّه مُصادرة على المطلوب إبستمولوجيًا لأنّه من أجل معرفة أنّ المقدمة الحاسِمة «من الممكن أنّ الله موجود في الواقع» هي صادقة، يجب أن نعرف أنّ الله موجودٌ بالفعل في الواقع». إذا كان وجودُ الله ممكنًا فقط بمعنى أنّ الله قد يوجد في الواقع وقد لا يوجد، فإنّ الله ليس أعظم كائن ممكن وذلك لأنّه سوف تحلّ مكانَ عظمة هذا الإله عظمةُ الكائن الذي لا يُمكن الشك في وجوده الفعليّ. ربما يُمكن تفادي
(49)انتقال رو إلى الإبستمولوجيا هنا من خلال الادّعاء بأنّ الدليل يعتمدُ على صدق المقدمة الحاسِمة التي ستتطلب حجةً إضافية لإثباتها. وعليه، يقترحُ رو أنّ علينا أن نقبل «فكرة أنسيلم بأنّ الله كائن قدير وعليم وخيِّر بشكلٍ كامل موجودٌ ليس بالإمكان بل بالوجوب»، ولكنّه يحتجُّ أنّ السؤال عن وجود هذا الكائن يبقى من دون جواب.
استبقَ بلانتينغا اعتراضَ رو في كتابيه «الله، الحرية، والشر» و»طبيعة الوجوب» حيث تناول تطبيق هذا الاعتراض على دليله. في المقطع ما قبل الأخير من كتاب «الله، الحرية، والشر»، لاحظَ بلانتينغا أنّه ما دام أنّ استنتاج نموذجه من الدليل يترتّبُ على مقدمته المركزية («أنّه من المحتمل أنّ العظمة القصوى لها مصداق»)فإنّ الدليل صحيح، ولكنّه يعترفُ أنّه رغم أنّه هو نفسه قد قبلَ بصدق هذه المقدمة وبالتالي يعتقدُ أنّ الدليل سليم، لن يفعل الجميع ذلك. مع ذلك، وفقًا لبلانتينغا، من الواضح أنّه «لا يوجد شيءٌ مُناف للعقل أو غير منطقي في القبول بهذه المقدمة». وعليه، يدّعي بلانتينغا أنّ الدليل «يُقيمُ ليسَ صدق الإيمان بالإله، بل مقبوليته العقلانية» وبالتالي يُنجز «واحدًا على الأقلّ من أهداف تُراث اللاهوت الطبيعي».
في كتاب «طبيعة الضرورة»، يتعمّق بلانتينغا في ادعائه بأن دليله –المشار إليه هنا بـ«الدليل أ»- ليسَ صحيحًا فحسب بل سليمًا أيضًا. استبقَ بلانتينغا اعتراضَ رو على صياغته لنسخة أنسلم من الدليل، مُلاحظًا اعتراض بعض الفلاسفة أنّه
(50)رغم أنّ دليله «أ» هو صحيح إلا أنّه «دائري أو مُصادرة على المطلوب بوضوح». في بعض الأحيان يلاحظ بلانتينغا أنّ «هذا التحفظ لا يحمل أكثر من الاعتراف بأنّ... مقدمة الحجة لا يمكن أن تكون صحيحة ما لم تكن نتيجتها كذلك». يُشير بلانتينغا إلى أن هذا «ليس اعتراضًا ذا أهمية كبيرة»—ومع ذلك، بالتأكيد، هذا هو الاعتراض نفسه الذي صاغه رو بعد خمسة وثلاثين عامًا. يدّعي بلانتينغا أنّ دليله ليس دائريًا على أساس أنّ نتيجته –العظمة التي لا يُعلى عليها لها مصداق في كلّ عالَم- لا يُشكِّلُ حجّةً على المقدمة الرئيسية للدليل: «العظمة التي لا يُعلى عليها هي مُتمثّلة احتمالًا». يرفضُ بلانتينغا أيضًا الادّعاءَ بأنّ دليله هو مصادرة على المطلوب، وذلك على أساس أنّه رُغم أنّه من الممكن بوضوح إنشاءُ دليلٍ يكون مصادرة على المطلوب، إلا أنّه فيما يتعلّقُ بالدليل «أ» «من غير الواضح بأيّ نحوٍ أنّ أي شخصٍ يقبلُ مقدّمته المنطقية يفعلُ ذلك فقط لأنّه يستخلصها من النتيجة». مع ذلك، يعترفُ بلانتينغا أنّ «الدليل ’أ‘ ليس جزءًا ناجحًا من اللاهوت الطبيعي» لأنّ مقدمات الأخير تُستمدُّ عادة من القضايا التي يقبلها تقريبًا كلُّ شخصٍ عاقل أو رشيد. استشهدَ بلانتينغا بالطرق الخمسة
(51)التابعة لأكويناس، والتي يبدأ كلٌّ منها بمقدمةٍ لا يُقدِم على مُنازعتها إلا القليل من قبيل أنّ بعض الأشياء تتحرّك، أنّ الأشياء تتغيّر، أو أنّه توجد كائنات ممكنة. يعترفُ بلانتينغا أنّ المقدمة المركزية في الدليل «أ» –أي أنّ «العظمة القصوى مُتمثّلة احتمالًا»- هي ليستْ من هذا النوع لأنّ الشخصَ العاقل والرشيد قد يرفضها، أو يبقى لاأدريًا، أو يقبل بدلًا من ذلك احتمال عدم الحالة القصوى –أي احتمال أنّ العظمة القصوى لا توجد في أيّ عالَمٍ ممكن. ولكن يمضي بلانتينغا إلى أن يقترح أنّه إذا كان من المسموح–كما احتجّ هيلاري بوتنام -التخلّي عن قوانين منطقية مُحدّدة كمبدأ التوزيع (الذي يقتضي أن يكون كلّ قضية إمّا صحيحًا أو باطلًا) لصالح تبسيط النظرية الفيزيائية، فمن المعقول القبول بمقدمة أنّ «العظمة القصوى مُمثّلة احتمالًا» من أجل تحقيق نفس الهدف في علم اللاهوت. بالفعل، قد يبدو أنّ اقتراح بوتنام لم يُقبَل بشكلٍ واسع، ولكنّ بلانتينغا يُقدّمُ لنا حالتين مُوازيتَين للتأمُّل فيهما:
1. «تُوجد، أو يُمكن أن تُوجد، أشياء ممكنة ولكن ليست فعلية.»
2. فيما يتعلّقُ بشيئين هما x وy والخاصية P، إذا كان y=x، فإنّ x يملكُ P إذا -وفقط إذا- كان y يملكُ P» (قانون لايبنتس).
يُشيرُ بلانتينغا أنّه في الحالتين، بالرغم من عدم وجود حججٍ مُقنعة إمّا لصالح القضية أو نقيضه، إلا أنّه ليس من غير المناسب فلسفيًا في أيٍّ من الحالتين القبول
(52)به أو توظيفه كمقدمة. يدّعي بلانتينغا أنّ هذا ينطبقُ على أغلب الادّعاءات الفلسفية وأنّه لو «اعتقدنا فقط بما هو غير مُتنازع عليه أو لصالح الأمر الذي يحظى بحججٍ غير قابلة للنزاع مُستمدّة من مقدمات غير مُتنازَع عليها، سوف نجدُ أنفسَنا مع فلسفةٍ هزيلة جدًا ومملّة جدًا». بالفعل، يحتجُّ بلانتينغا أنّنا نملك في هذا الوضع شيئًا هو أكثر بقليل فقط من القياس الاستثنائي مع وضع المقدَّم. بالتالي، يستنتجُ بلانتينغا أنّه ينبغي قول الشيء نفسه عن مقدمة «العظمة القصوى مُتمثّلة احتمالًا». وعليه، بينما لا يُمكن أن يُقال إنّ إعادات صياغة بلانتينغا لدليل أنسيلم تُثبتُ أو تؤسس نتيجتها إلا أنّه «بما أن قبول المقدمة الأساسية يُعد عقلانيًا، فإنها تُظهر أنه من العقلاني قبول تلك النتيجة». إضافة إلى ذك، يقترحُ بلانتينغا أنّه «ربما ذلك هو كلّ ما يُمكن توقّعه من أيّ حجّةٍ على هذا النحو».
ولكنّني أقترحُ أنّ بلانتينغا يُسلّم بأكثر مما يجب. يحتجُّ بلانتينغا أنّ الحالة الموازية الأولى التي قدّمها -»تُوجد، أو يُمكن أن تُوجد، أشياء ممكنة ولكن ليست فعلية»- تُشبه عبارة «العظمة القصوى مُتمثّلة احتمالًا» ما دامَ أنّه «إذا كان مُمكنًا، فهو صحيح وبالفعل صحيح بالضرورة». يعترض رو على نسخة بلانتينغا من حجة أنسلم قائلًا إنه إذا كان وجود الله ممكنًا فقط بمعنى أن الله قد يوجد في الواقع وقد لا يوجد، فإن الله ليس أعظم كائن ممكن، لأنّ عظمة هذا الإله ستتجاوزها عظمة كائن لا يمكنه ألا يكون موجودًا. وعليه، فإنّ أعظم
(53)كائن مُمكن هو ليسَ الكائن الذي قد يُوجد في الواقع وقد لا يُوجد، ولكن الكائن الذي لا يُمكن أن يفشل في الوجود – أي كائن موجود بالضرورة- وهذه هي النقطة التي حاولَ بلانتينغا أن يُبرزها في نموذجه الخاص عن الدليل. ولكن لا يُرينا بلانتينغا كيفَ يُمكن أن نبني دليلًا للاعتقاد بإلهٍ موجود بالضرورة، وأنا أقترحُ أنّه في هذا الموضع قد تُساعدنا خطوةٌ إضافية عن الدليل تُقدّمها مورداك.
ينتقلُ بُرهان مورداك الأنطولوجي من ادّعاء نورمان مالكوم أنّ كانط كان مُخطئًا في الاعتقاد بأنّ القضية «الله هو موجودٌ واجب» تعادل القضية الشرطية «إذا وُجِد الله، فهو موجود وجوبًا»، ومن ادعاء تشارلز هارتسثورن أنّه «ينبغي أن نقول بدلًا من ذلك «إذا كانت عبارة «الوجود الواجب» ذات معنى، فإنّ ما تعنيه موجودٌ بالضرورة، وإذا وُجِد بالضرورة فهو موجود من باب أولى». وفقًا للباحثَين، فإنّ وجود الله ليس كما هو في مُثّلث كانط حيث يُمكن أن نُنكر وجوده الممكن من دون الوقوع في التناقض. خاصية الوجود الضروري تخص الله وحده، مما يعني أنه من غير المناسب الإشارة إلى أنه «في موارد أخرى (مثلثات
(54)أو جزر) لا تُعدّ الوجود صفة».
وعليه، تحتجُّ مورداك أنّ دليل أنسيلم المبنيّ على الوجود الضروري هو ليس على هيئة «إن كان الله موجودًا فهو موجودٌ بنحو ضروري»، بل يحتجُّ أنسيلم أنّه «إذا كان مفهومُ الله ذا معنى (ليس مُناقضًا لذاته) يجب أن يوجد الله بنحوٍ واجب». هذا يثير التساؤل حول ما يُعدّ ذا معنى. رغم أنّ كلمة «الله» تملكُ المعنى بنحوٍ واضحٍ في الجُمل التي تحوي هذه الكلمة، وتاريخًا مُتاحًا لكلٍ من المؤمنين وغير المؤمنين، رفضت مورداك الرأي –الذي زُعِم أنّ مالكوم يعتقدُ به- بأنّ المفهوم يملكُ المعنى فقط ضمن اللعبة اللغوية للاعتقاد الدينيّ. تعتقدُ مورداك أنّ هذا التفسير هو «تحوّل خاطئ»؛ قد يُنقذ الدليل الأنطولوجي من انتقادات كانط، ولكنّ الدليل الذي يتمّ إنقاذه هو «[دليل] فارغٌ مع ميزاتٍ نحوية فحسب».
وعليه، تبحثُ مورداك عن توضيحٍ في حجة أنسيلم التكميلية، وهي «حجة درجات الخير»[6]، من الفصل الثامن من ردّه على غاونيلو:
«كلُّ شيءٍ أقلّ خيرًا، إلى الحدِّ الذي يكونُ خيرًا، هو كالخير الأعظم. وعليه من الواضح لأيّ عقلٍ رشيد أنّه من خلال الارتفاع من الخير الأدنى إلى الأعظم
(55)يُمكن أن نُشكِّل فكرةً وافرة عن موجودٍ لا يُمكن تصوُّر أعظم منه».
بعبارةٍ وجيزة، يُمكن أن نستنبطَ من تجربتنا المتعلّقة بمستوياتٍ مُختلفة من الخير وجودَ خيرٍ لا يُمكن تصوُّر أعظم منه.
نسخة مورداك عن هذه الحجة هي حجةٌ مبنية على التجربة الأخلاقية وتُعرف باسم «حجة انتشار الخير» لأنّها تلجأ إلى «إحساسنا بالله (الخير) على أنّه مُستَكشَف في كلِّ مكانٍ في العالَم». وفقًا لهذه الحجة، فإنّه، في تجارب الحياة اليومية:
«يُبيَّنُ لنا باستمرارٍ حقيقة ما هو أفضل والطبيعة الوهمية لما هو أسوء. نتعلّمُ عن الكمال والنقص من خلال قدرتنا على فهم ما نراه كصورةٍ أو كظلٍ لشيءٍ أفضل لا يُمكننا أن نراه لغاية الآن».
(56)تقترحُ مورداك أنّ وعينا بالفشل يُمكنُ أن يخدم أيضًا كمصدرٍ للمعرفة:
«نحن باستمرارٍ في عملية التعرُّف على بطلان «خيراتنا»، وعدم أهمية ما نعتبره مهمًا... نحنُ نكتشفُ في أدقّ تفاصيل حياتنا أنّ ما هو خير هو حقيقي». . وعليه، قد يُمكّننا الدليل الأنطولوجي من الادعاء «بمكانة ضرورية فريدة للقيمة الأخلاقية كشيء من المستحيل (بشكل فريد) أن يتم استبعاده من التجربة الإنسانية، وكشيء معروف بكونه حقيقيًا، إذا تمّ تصوره».
وعليه، احتجَّ كلٌّ من بلانتينغا ومورداك أنّ طبيعة الله/الخير تقتضي عدم إمكانية أن يفشلَ الله/الخير في أن يُوجد –أي أنّ الله/الخير موجود بالضرورة. ولكن بقيتْ في مواجهة بلانتينغا معضلةُ تتمثل في أنّه يمكن ببساطة رفض مفهوم إله لا يمكن أن يفشل في أن يوجَد. رُغم أنّ بلانتينغا يصفُ طريقَ أكويناس الرابع -وهو دليل غير مُختلف عن «دليل انتشار الخير» التابع لمورداك– على أنّه «أقلّ
(57)إثارة للإعجاب بكثير» من طريقه الثالث، إلا أنّني أقترح أن حجة مردوخ تمثل محاولة جريئة لمعالجة هذه المشكلة. تحتجُّ مورداك أنّ قُدرتنا على تحديد الأمثلة الكثيرة للخير التي هي ميزة مُشتركة لتجربتنا المتعلِّقة بالعالَم لا يُمكن أن تُفسَّر فقط بالوجود الضروري لمعيارٍ مثاليٍ للخير، وأنّ هذا، أو الحقيقة النومينية التي تكمنُ خلفه، هو ما يرمز إليه إله الإيمان الكلاسيكي.
وعليه، يُمكن تقديم دليلٍ مُتجدِّد مؤلّف من جزئين، يستفيدُ من أقوى عناصر مؤلّفات أنسيلم و بلانتينغا ومورداك كما يلي:
1. تملكُ العظمة التي لا يُعلى عليها التميُّز الأقصى (جميع الخصائص الجيّدة التي يُمكن أن يملكها منطقيًا إلى الحدّ الأقصى) في كلّ عالَم ممكن.
2. من الممكن أن توجد العظمة التي لا يُعلى عليها.
أ) بالضرورة، يوجد التميُّز الأقصى في أيّ عالَمٍ يحتوي مُستوياتٍ من الخير.
ب) الخير بمستوياته المتفاوتة مُنتشر في عالمنا.
ج) بالضرورة، يوجد التميُّز الأقصى في عالمنا.
ولكن من الواضح أنّه حتّى لو كان هذا الدليل المؤلَّف من جُزئين صحيحًا
(58)وسليمًا، ففي أفضل الأحوال لا يأخذنا أبعد من إمكان وجود العظمة التي لا يُعلى عليها، والتي يُدعَم الاعتقاد بواقعيتها إلى حدٍّ محدود من خلال دليل مورداك على الوجود الضروري للعظمة القصوى في عالمنا. وعليه، كما أنّ البعض (مثل براين دايفيس) قد احتجّ أنّ أدلّة أنسيلم في بروسلوجيون 2 و3 لا تُمثِّلُ –خلافًا لما اقترح آخرون (مثل هارتسثورن ومالكوم)- نوعين مُختلفين من الدليل الأنطولوجي، بل جزئين من الدليل نفسه، نحنُ بحاجةٍ إلى إعادة بناء إضافية لدليل أنسيلم/بلانتينغا/مورداك على نحوٍ يُشكِّلُ دليلًا واحدًا.
قد يُفيدُ هذا الدليل ما يلي:
أ) من الممكن وجود عظمةٍ لا يُعلى عليها –أي التميُّز الأقصى في كلِّ عالَمٍ مُمكن.
ب) بالضرورة، توجد العظمة القصوى في أيّ عالَمٍ يحتوي مُستوياتٍ من الخير.
ج) الخير بمستوياته المتفاوِتة مُنتشرٌ في عالمنا.
د) إن صحّ (ج)، بالضرورة، التميُّز الأقصى موجودٌ في عالمنا.
ه) إن صحّ (ج)، فمن المعقول أن نفترض أنّ كلّ عالَمٍ ممكن يحتوي مُستوياتٍ من الخير.
و) إن صحّ (ه)، بالضرورة، التميّز الأقصى موجودٌ في كلّ عالم ممكن.
ح) إن صحّ (و)، فإنّ العظمة التي لا يُعلى عليها موجودة فعلًا.
سوف أتناولُ في هذا القسم ثلاث اعتراضاتٍ مُمكنة على الدليل المعاد بناؤه.
1. الدليل ليس سليمًا لأنّه يُمكن رفض المقدمتين الأوليين («أ» و«ب»).
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا الاعتراض مُوازيًا لاعتراض رو على تفسير
بلانتينغا لدليل أنسيلم –أي أنّ مقدمة «من الممكن أن يوجد الله في الواقع» هي مُصادرة على المطلوب. ولكنّ المقدمتين الأوليين من الدليل المعاد بناؤه ليستا مدعومتَين باللجوء إلى المعرفة المسبَقة المخفيّة بل بالاستدلال الاستخلاصي من الظواهر (المقدمة «ج») إلى فرضيةٍ تبدو معقولة في غياب البدائل المنطقية. طوّرَ جين فِندت دليلًا كان أفلاطون هو أول من طرحه، وادّعى أن العدالة بحد ذاتها هي التي تمكّننا من تصنيف مدى عدالة خمسة رجال. إضافة إلى ذلك، يقترحُ فِندت أنّ وجودَ العدالة يختلفُ من حيث النوع عن العدالة التي يُظهرها الرجال الخمسة العادلون، وإذا أنكرنا جوهر ما يوجد من خلاله أيُّ مقياسٍ للعظمة فلا يُمكننا أن نُصدر أيّ أحكامٍ مُطلقًا. وهكذا، فإن العدالة والخير هما الشرطان لتمكننا من وضع تنوعات العدالة والخير على مقياس. لا تُبطِل الاختلافات الدليل، لأنّنا إذا اختلفنا حول مكان وضع أمثلة العدالة أو الخير على المقاييس المناسبة، قد يُعتبَر أنّ هذا يُشيرُ إمّا إلى أنّ خصمنا قد أساءَ فهم طبيعة المعيار المثالي موضع السؤال أو أنّنا قد اختلفنا فيما يتعلّقُ بمدى تمثُّل المعيار المثالي مصداقيًا.
2. حتّى لو كان وجودُ التميُّز الأقصى ضروريًا في عالمنا، لا يترتّب على ذلك أن يحتوي كلُّ عالم مُستوياتٍ من الخير وبالتالي أن يحتوي كلُّ عالَم التميُّز الأقصى.
على سبيل المثال، قد يتساءلُ الفرد إذا كان يُعدّ عمومًا من الخير على كوكبٍ في كونٍ آخر توفير كائنٍ عاقل آخر بوسائل المعيشة ولكن من الأكثر خيرًا إلى حدٍّ كبيرٍ التضحية بالحياة الشخصية للحفاظ على حياة فردٍ آخر. جوهر الحجة، مع ذلك، هو أنه لا توجد مجموعة من الظروف يمكن تصورها لا يُعتبر فيها بعض الأشياء أفضل من غيرها، حتى لو اختلفت طبيعة الخيرات في التسلسل الهرمي بين عالم وآخر نتيجة للاختلافات في طبيعة تلك العوالم.
(60)3. الدليل ليسَ دليلًا أنطولوجيًا.
في الختام، قد يتمّ الاعتراض بشكلٍ منطقيٍ أنّ هذا ليسَ نوعًا أصيلًا من الحجة الأنطولوجية لأنّ الاستدلال الذي يُوظّفه ليسَ سابقًا على التجربة تمامًا؛ بما أنّه يعتمدُ بشكلٍ كبيرٍ على التجربة البشرية المتعلّقة بانتشار مُستويات الخير، فإنّ استدلاله هو بالدرجة الأولى بعد التجربة وبالتالي ينبغي إلغاءُ عضويته في مجموعة الحجج الأنطولوجية. ولكنّ «عنصر مُستويات الخير» مُستمدٌّ من «دليل مُستويات الخير» العائد إلى أنسيلم، ويُمكن العثور على نموذجٍ منه أيضًا في مؤلّفات الفارابي يعودُ إلى قرنين سابِقَين [على زمن أنسيلم]. وعليه، فإنّه حتّى أنسيلم، الذي يُعدّ بشكلٍ عام مُبدع الدليل الأنطولوجي، قد لاحظَ الحاجة لإنتاج دليلٍ داعمٍ على سبيل الردّ على اعتراض غاونيلو بأنّه غير قادر على التفكير بـ«ذاك الذي لا يُمكن التفكير بأعظم منه». احتجَّ أنسيلم أنّه إذا كان مفهومُ «ذاك الذي لا يُمكن التفكير بأعظم منه» ذو معنى، فالله موجود بنحوٍ واجب، ويُظهِرُ الدليل الداعِم أنّ مفهوم «ذاك الذي لا يُمكن التفكير بأعظم منه» هو بالفعل ذو معنى. فقط من خلال دعم الدليل بوسائل اللجوء إلى التجربة الأخلاقية يُمكن أن ندّعي بشكلٍ منطقيٍ أنّ مفهوم الله له مصداق؛ إنّها التجربة البشرية التي تُقوّي القسم السابق على التجربة من الدليل. كما يقترحُ فِندت، فَهِمَ أنسيلم أنّ معنى «الذي ليس أعظم منه» يُمكن أن يُدرَك فقط «من خلال استنتاج ذاك الذي لا يُمكن التفكير بأعظم منه على قاعدة تلك الأشياء التي يُمكن التفكير بما
(61)هو أعظم منها». بما أنّ البشر لا يُمكن أن يفهموا الطبيعة الحقيقية للبُعد الإلهيّ بشكلٍ كامل أو أن يُدركوه بشكلٍ مباشر، فإنّ أفضل طريقة يُمكن أن نأملها هي أن يُمكِّننا عنصرٌ ما من ذاك الذي نستطيعُ فهمه أو إدراكه من التقاط لمحاتٍ بينَ حينٍ وآخر للشيء المخفيّ عنّا بسبب محدوديات إنسانيتنا. كما تقترحُ مورداك، يُمكن أن تُوفِّر التجربة الأخلاقية البشرية بشكلٍ معقول هذا التبصُّر المفيد.
وعليه، فإنّ هذا الدليل هو بشكلٍ أساسيٍ دليل أنطولوجي لأنّه يستفيدُ من فكرة الكائن المثالي من كتاب أنسيلم «بروسولوجيون 2» (المقدمة «أ») وفكرة الوجود الواجب من «بروسولوجيون 3» (المقدمة «د»، من «ج»)، ولكن يحتوي أيضًا عناصر من كُلٍّ من الدليل المبنيّ على التجربة الدينية (المقدمة «ج») والدليل الأخلاقي (المقدمة «د»). يمكن القول إنّه ما دامَ يعتمدُ على «التأمُّل بالكَون الممكن أو... جزء منه»–وذاك الجزء هو، بالطبع، مصاديق الخير– فهو إذًا يحوي أيضًا عناصر من الدليل الكوزمولوجي؛ الله هو مصدر سلسلة الأشياء الجيّدة. بالفعل، قد يقولُ الفرد إنّ الدليل الأنطولوجي يتطلّبُ دعمَ دليلٍ كوزمولوجي -على خلاف ادّعاء كانط بأنّ الدليل الكوزمولوجي يتطلّبُ دعمَ الدليل الأنطولوجي على أساس أنّ الأخير فقط يُمكن أن يُوفِّر مفهومًا مُحدَّدًا تمامًا عن واجب الوجود.[4] ولكن لعلّه يكون أكثر دقّة أن نقول إنّ هذه
(62)الأدلّة يعتمدُ بعضها على البعض. وفقًا لكانط، فإنّ الدليل المعيوب التالي للتجربة يعتمدُ على دليلٍ معيوب سابق على التجربة، ولكنّ الدليل الأنطولوجي المعاد بناؤه يدّعي أنّه يُمكنُ إصلاح نموذج الدليل السابق على التجربة المعيوب عبر دليلٍ داعمٍ مُستمد من تجربتنا الأخلاقية.
يلجأ الدليل الكوزمولوجي أيضًا إلى التجربة ليدّعيَ أنّ الإله هو التفسير النهائي لوجود كلّ شيءٍ نختبره في الكَون. يمكن فهم هذا على أنه شخصي بمعنى مجازي، وبالتالي قد ننجذب إلى ما هو أبعد من مفهوم الخير غير الشخصي الذي دافعت عنه مورداك، مقتربين من التوحيد الذي يجادل بلانتينغا لصالحه. هذا التفسير الأعلى هو الذي يُحدِّد ما هو خيرٌ للكَون، بما فيه كائناته الواعية التي يُشكّلُ البشر مجموعةً فرعيةً منها– أي طبيعة إنسانيتنا المخلوقة هي التي تُحدِّد ما هو صالح أو غير صالح للبشر، سواء كأفرادٍ أو كنوع بشري. وبالتالي، وهكذا، يمكن اعتبار الإله بمثابة العملية الخلاقة والخير الذي تحدّده، ويدعم الدليل الكوزمولوجي الاعتقادَ بوجود الحقيقة التي يُشيرُ إليها الدليل الأنطولوجي.
لقد احتججتُ أنّه رُغم عنوان مقالته -«ألفين بلانتينغا حول الحجة الأنطولوجية»- ما يعترضُ عليه رو في الواقع هو تفسير بلانتينغا لحجة أنسيلم الأنطولوجية. ولكن مع ذلك، يُمكن الاحتجاج بأنّ اعتراضَ رو ينطبقُ أيضًا على نموذج بلانتينغا نفسه عن الدليل الأنطولوجي، وبالتالي يفشل دليل بلانتينغا لأنّ المقدمة «من الممكن وجودُ كائنٍ عظيمٍ بالحدّ الأقصى في الواقع» تصح فقط
(63)إذا سبقَ وأن قبِل الفرد بنتيجة الدليل. استبقَ بلانتينغا نفسه هذا الاعتراض وردَّ عليه، ولكنّه أقرَّ أنّ الإنسان العاقل والرشيد يُمكن أن يرفض بشكلٍ مشروع المقدمة المركزية في دليله –أي أنّ «العظمة القصوى مُتمثَّلة احتمالًا»- لأنّه لا توجد أدلّة مُقنعة إمّا لصالحها أو ضدّها.
لقد أشرتُ إلى أنّ بلانتينغا يتنازل كثيرًا. لاحظّ بلانتينغا أنّه قد يقول أحدهم عن مقدمته المركزية إنّه «إذا كانت مُمكنة، فهي صحيحة وبالفعل صحيحة بالضرورة». ولكن إذا كانت مُمكنة فقط بمعنى أنّ الله قد يوجد في الواقع أو قد لا يُوجد، فإنّ عظمة كائن كهذا تتضاءل أمام عظمة كائن لا يمكن أن يفشل في الوجود. لقد احتججتُ أنّ مورداك هي التي استخرجتْ من مؤلّفات أنسيلم خطوةً إضافية في الدليل –أي خطوة تدعمُ الاعتقادَ بالوجود الواجب للحقيقة النومنية التي يكونُ كلٌّ من «الله» و«الخير» رمزين لها- مما يقرّبنا من نسخة متكاملة تمامًا من الدليل الأنطولوجي.
لقد قدّمتُ نموذجًا مُتجدِّدًا من الدليل مُستخدمًا عناصر من مؤلّفات أنسيلم وبلانتينغا ومورداك. لقد احتجّيتُ أولًا أنّ العظمة التي لا يُعلى عليها تملكُ جميع الخصائص الخيِّرة التي يُمكن أن تمتلكها منطقيًا في كلِّ عالَمٍ مُمكن، وأنّه ثانيًا، وجودُ هذه العظمة التي لا يُعلى عليها هو ضروري لتفسير تجربتنا البشرية المتعلِّقة بمستويات الخير.
ختامًا، وبالرغم من ادّعائي بأنّ بلانتينغا يتنازل كثيرًا، يجب أن أختم بتنازلي الخاص، وهو أن الحجة التي أعدت صياغتها ربما لا تُعتبر حجة أنطولوجية في شكلها النقي، لأنها تتضمن عنصرًا استدلاليًا تاليًا للتجربة يشترك في بعض
(64)الجوانب مع الحجج الأخلاقية والكوزمولوجية لوجود الله. ولكنّ العناصر الأنطولوجية والأخلاقية والكوزمولوجية مُتشابِكة بإحكام؛ وعليه، فهذه ليست حالة تراكمية، أو مجموعة من الحجج المستقلة التي يدعم كلّ منها الإيمان بإله يمتلك بعض الصفات الإلهية، بل هي حجّة مندمجة أو متكاملة لوجود الله — أي حجّة تحتوي على خصائص عدّة حجج في حجّة واحدة. يقترحُ ماجد فخري أنّ الفارابي قد تأرجح بين الدليلَين الأنطولوجي والكوزمولوجي من دون إدراك التضارُب في هذين المسارين من الاستدلال، ولكنّني أقترحُ أنّه من المحتمل أنّ الفارابي قبل وقتٍ طويلٍ من أنسيلم ومورداك أدركَ أنّه فقط من خلال دمج عناصر من أدلّة أخرى على وجود الله يستطيعُ الدليل الأنطولوجي –أو المتكامل- أن يُثبت وجودَ الله. وهكذا، فإنّ الصعوبة التي يواجهها نسخة بلانتينغا من الدليل الأنطولوجي –مع العديد من النماذج السابقة والتالية- هي أنّ الوجود الممكن لا يستلزمُ الوجودَ الواقعي. بمساعدة نسخة مورداك من الدليل، حاولتُ إعادة صياغة نسخة مندمجة أو متكاملة من الحجة الأنطولوجية تسعى إلى إظهار أنه، في حالة العظمة التي لا يُعلى عليها، فإن الوجود الممكن يستلزم الوجود الضروري، وبالتالي الوجود الفعلي.
أنا مُمتنّة لمؤسّسة بايلر لدراسات الدِّين لتمويلها حضوري في المؤتمر حيث قدّمتُ مُسوّدة أولى عن هذا الفصل، وإلى ترِنت دوكرتي لملاحظاته التفصيلية حول المسوّدات اللاحقة.
(65)و. دايفيد بك
سوف نتطرّقُ إلى قصّة الحجة الكونية (الكوزمولوجية)[3] في الماضي القريب. بقيَت الحجة في أغلب الدوائر الفلسفية، باستثناء الدوائر الكاثوليكية في مطلع القرن العشرين، خاملةً إلى حدٍّ كبيرٍ على مدى أكثر من قرنٍ ونصف. كان النقاش المحدود يميلُ إلى أن يكون تفسيرًا للأدلّة التي قدّمها ثوماس، وكانَ هذا إلى حدٍّ بعيدٍ نتيجةً للنقد الفتّاك ظاهريًا الذي طرحه إيمانويل كانط في كتابه «نقد العقل المحض» الصادر في العام 1781. احتجَّ كانط في الكتاب أنّ الدليل الأنطولوجي باطل، وبما أنّ الدليل الكوزمولوجي يعتمدُ على الدليل الأنطولوجي فهو باطلٌ أيضًا. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حازَ الدليل الغائي على كثيرٍ من الاهتمام مع تطوُّر ثقافة العلم الطبيعي، خصوصًا بعد أن بدا وكأنّ داروين قد وضعَ عقبةً في طريقه. أمّا أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، فقد شهِدا عودة شخصيةٍ أخرى في روايتنا: الدليل الأخلاقيّ.
[1]. Beck, W. David. “Cosmological Argument.” In Does God Exist? A History of Answers to the Question, 48-109. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2021.
[2]. أستاذ فخري في الفلسفة في جامعة ليبرتي (Liberty University).
[3]. Cosmological Argument
(69)خلال عقود مُنتصف القرن العشرين، بدا في أغلب البيئات الأكاديمية أنّ نظرية التطوُّر قد أزاحَتْ أخيرًا أيّ نقاشٍ منطقيٍ عن الله. أهملت الكتب الدراسية والأنثولوجيات التي تتناولُ فلسفة الدِّين النقاشَ حول الأدلة على وجود الله أو إنّها قد أدرجت بعضَ المختارات القليلة فقط من باب الفضول التاريخي. ثمّة استثناء يُثبِتُ هذه النقطة، وهو المناظرة التي وقعتْ في 28 كانون الثاني 1948 وبثّتها قناة الـBBC وجمعتْ بين مؤرّخ الفلسفة الكاثوليكي العظيم فريدريك كوبلستون والفيلسوف البريطاني الإلحادي برتراند راسل.
كان للمناظرة تأثيرٌ ضئيلٌ آنذاك. في الواقع، كان راسل مُقتنعًا للغاية بأنّه قد عبّر عن رأيه بفاعليةٍ إلى حدّ أنّه أدرجَ نُسخةً مكتوبة عن المناظرة في الطبعات اللاحقة من كتابه «لماذا أنا لستُ مسيحيًا». الأمر المثير للاهتمام هو أنّ كوبلستون قد وظّفَ هنا شكلًا مُختلفًا من الدليل، وهو شكلٌ يعتمدُ على مبدأ
(70)«السبب الكافي» الذي يعودُ إلى لايبنتس. سوف نتناولُ هذا الشكل في مقطعٍ مُنفصل يأتي لاحقًا، وهو يلعبُ دورًا مهمًا في روايتنا لأنّه على ضوء دليل السبب الكافي بدأ الدليل الكوزمولوجي يسترجعُ مكانته خلال أعوام الستينيات.
أودُّ أولًا أن أتناول مثالًا يُوضِّحُ كلَّ شيءٍ حصلَ في المئة وخمسين عام قبله ويُمهّدُ لما سوف يبدأ بعد عدّة سنوات. نشرَ بول إدواردز في العام 1959 مقالته التي تُعدُّ كلاسيكيةً الآن والتي ينتقدُ فيها الدليل الكوزمولوجي الذي قدّمه ثوماس.
بول إدواردز: حرَّر بول إدواردز (1923-2004) «موسوعة الفلسفة» وألّفَ العديدَ من الكتب والمقالات. ممّا لا شكّ فيه أنّه كان أحد الفلاسفة الأمريكيّين البارزين في القرن العشرين. كان إدواردز أُستاذًا في جامعة نيويورك، وكلّية بروكلين، والمدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية وصولًا إلى التسعينيات. سُرعان ما عُدَّتْ مقالته «نقد الدليل الكوزمولوجي» مقالةً معيارية حول الموضوع وأُعيدتْ طباعتها في العديد من الأنثولوجيات. سوف نُورد فيما يلي المقتطفات النقدية حيث يُركِّزُ إدواردز بالتدرُّج على المشكلات الجوهرية في دليل ثوماس.
يبدأ إدواردز من خلال الملاحظة أنّه، في أيّ حال، لا يُقدِّمُ لنا ثوماس شيئًا جديرًا بلقب «الله» لأنّه يفتقد لبعض الخصائص الرئيسية. مع ذلك، يعتقدُ إدواردز أنّ أنصارَ الدليل سوف يعترفون طوعًا بهذه النقطة ويحتجّون على أنّ الاستنتاج مع ذلك يتمتّعُ بعمقٍ كاف. هل إنّ ثوماس، خصوصًا في الطريقة الثانية، ينجحُ في التخلُّص من السلسلة اللانهائية من الأسباب؟ إنّه يدعمُ هذا الافتراض عبر التأكيد بأنّ الاعتقاد المضاد يتضمّنُ استحالةً واضحة. أن نفترض
(71)وجود سلسلةٍ لانهائية من الأسباب يستلزمُ منطقيًا عدم وجود شيءٍ الآن، ولكنّنا نعلمُ أنّ الكثير من الأشياء هي موجودة الآن، وبالتالي فإنّ أيّ نظرية تُشيرُ إلى عدم وجود شيءٍ الآن يجب أن تكون خاطئة. يُواصلُ إدواردز ويقول:
«يفشلُ هذا الدليل في أن يُنصف مُناصر السلسلة اللانهائية من الأسباب. لقد فشل أكويناس في التمييز بين العبارتَين:
1. (أ) لم يوجد؛ و:
2. (أ) ليس غير مُسبَّب.
أن يُقال بأنّ السلسة لانهائية يُفيدُ (2) ولكنّه لا يُفيدُ (1). المعتقِد بالسلسلة اللانهائية لا يقومُ بإزالة (أ) ». إنّه يُزيلُ المكانة الامتيازية لـ(أ)، إنّه يُزيلُ «تسبّبها الأول». إنّه لا يُنكر وجودَ (أ) أو أيّ عنصر مُحدَّد من السلسة. إنّه يُنكرُ أنّ (أ) أو أيّ شيءٍ آخر هو العنصر الأول في السلسلة. بما أنّه لا يُزيلُ (أ)، فإنّه لا يُزيلُ (ب) وبالتالي لا يُزيلُ أيضًا (ه)، (و)، أو (ي) بعيدًا... إنّه مُلتزمٌ فقط بإنكار أنّ هذا الكائن، إن كان موجودًا، هو غير مُسبَّب. إنّه ملتزمٌ في الاعتقاد بأنّه مهما تكن الصفات الأخرى المثيرة للإعجاب التي قد يملكها كائنٌ خارقٌ للطبيعة، فإنّ صفة كونه السبب الأول ليست من بينها.
حتّى لو كان على خلاف ذلك صحيحًا، فإنّ الدليل لا يُثبت سببًا أولًا وحيدًا، إذ لا يبدو أنّ هناك أيّ أساسٍ جيد للافتراض بأنّ السلسلات السببية المتنوّعة في الكون تمتزجُ في النهاية. وعليه، حتّى لو افتُرض أنّه لا يُمكنُ لأيّ سلسلةٍ من الأسباب أن تكون لانهائية، فإنّ إمكانية وجود تعدُّدية في الأسباب الأولى لم يُستبعَد. وكذلك لا يُرسي الدليل الوجودَ الحالي للسبب الأول.
(72)قد يُجادلُ كثيرٌ من المدافعين عن الدليل السببيّ أنّ بعض هذه الانتقادات على الأقل تستندُ إلى سوء فهم... قد يُميّزون في هذا الصدد بين نوعين من الأسباب -ما يُسمّونه «أسباب كينونة الشيء»وما يُسمّونه «الأسباب المحافِظة على كينونة الشيء». سبب كينونة الشيء هو العامل الذي حقّق أو ساعد في تحقيق وجود أثرٍ ما. أمّا السبب المحافِظ على كينونة الشيء فهو العامل الذي «يُحافظ» أو يُساعدُ في المحافظة على الأثر «في الوجود».
من خلال توظيف هذا التمييز، يستدلُّ المدافع عن الدليل الآن بالطريقة التالية. أن يُقال بوجود سلسلةٍ لامتناهية من «أسباب كينونة الشيء» لا يؤدّي إلى أيّ استنتاجاتٍ مُنافية للعقل. ولكنّ أكويناس مُهتمٌ فقط بـ«الأسباب المحافِظة على كينونة الشيء»، والسلسلة اللامتناهية من هذه الأسباب هي مُستحيلة.
ولكن إذا تركنا هذا وجميع الاعتراضات المماثِلة، فإنّ إعادة صياغة الدليل على ضوء الأسباب المحافِظة على كينونة الشيء لا تتفادى إطلاقًا الصعوبة الأساسية المذكورة آنفًا. سوفَ يؤكّدُ المعتقِد بالسلسلة اللامتناهية أنّه قد أُسيء تمثيل موقفه الآن كما سابقًا. إنّه لا ينزعُ عنصرًا من السلسلة يُفترض أنّه السبب الأول المحافِظ على كينونة الشيء كما أنّه لا ينزعُ العنصر الذي أُعلِن أنّه السبب الأول لكينونة الشيء. إنّه، مرة أخرى، فقط يُنكرُ أن تكون له مكانة مُتميِّزة... إنّه، مرة أخرى، فقط يُزيلُ «تسبّبه الأول».
لن يستسلم أيُّ مُدافعٍ عنيد عن الدليل الكوزمولوجي في هذه المرحلة. حتّى لو وُجدت سلسلةٌ لامتناهية من أسباب كينونة الشيء أو الأسباب المحافِظة على كينونة الشيء، فإنّه يؤكِّد أنّه حتّى هذا لا يُزيلُ الحاجة للأقصى، لسببٍ أول...
[1]. causes in fieri
[2]. causes in esse
(73)مطلب العثور على سبب السلسلة ككل يستندُ إلى الافتراض الخاطئ أنّ السلسلة هي شيءٌ أعلى وفوق العناصر التي تتألّفُ منها... على افتراض أنني شاهدتُ مجموعةً من خمسة [أشخاص من شعب الإنويت] يقفون على زاوية الجادة السادسة والشارع 50، وأردتُ أن أشرح سبب قدوم المجموعة إلى نيويورك. يكشفُ التحقيق القصص التالية:
[الإنيوت] (1) لم يَرُق لها البرد الشديد في المنطقة القطبية وقرّرت الانتقال إلى مناخٍ أدفأ.
[الإنيوت] (2) هو زوج (1)، وهو يُحبّها كثيرًا ولم يشأ أن يعيش من دونها.
[الإنيوت] (3) هو ابن (1) و(2)، وهو صغيرٌ وضعيف للغاية لكي يُعارض والديه.
[الإنيوت] (4) رأى إعلانًا في مجلة نيويورك تايمز يدعو إلى ظهور أحدٍ من [شعب الإنويت] على التلفاز.
[الإنيوت] (5) هو مُحقِّق خاص وظّفته وكالةُ بينكرتون لكي يُراقب [الإنويت] (4).
فلنفترض أنّنا قد شرحنا سبب وجود كلّ واحدٍ من هؤلاء الخمسة في نيويورك. ثمّ يسألُ أحدهم: «حسنًا، ولكن ماذا عن المجموعة ككل، لماذا هي موجودة في نيويورك؟» من الواضح أنّ هذا سؤالٌ سخيف... إنّه من السخيف كذلك السؤال عن سبب السلسلة ككل، على خلاف السؤال عن أسباب وجود أفراد.
من المثير للاهتمام أنّ إدواردز يفتتحُ المقطع الثاني عبر الملاحظة، مُجددًا، أنّه من غير المرجّح أن يستسلم المدافع عن دليل ثوماس لغاية الآن. إنّه مُحقٌ بالتأكيد.
(74)لم يدّعِ إدواردز إلى الآن أمرًا لم يُقدِّم له ثوماس نفسه جوابًا أو أمرًا ينطبقُ فعلًا على صيغته من الدليل. كما رأينا، فإنّ أرسطو سبقَ وأن قدّمَ دفاعًا ضدّ التسلسل اللانهائي من الأسباب المحافِظة على كينونة الشيء. ما يفوتُ إدواردز هو أنّ الاحتمالات الرياضية لا تحلّ أسئلة الإمكان الميتافيزيقي. بالطبع يُمكنني رياضيًا أن أُفكّر دائمًا بوجود عددٍ أصليٍ إضافيٍ في أيّ سلسلة. لكلّ n، ثمّة n+. ولكن لا ينتجُ أن ينطبق ذلك على سلسلةٍ من الممكنات التابِعة سببيًا. إضافة إلى ذلك، سبقَ وأن برهن أرسطو على ضرورة وجود سببٍ أول وإلا لما وُجدَ أثر، ولا يُمكن أن يحصل ذلك مع الأسباب المتوسِّطة اللانهائية. وعليه، يجب أن يملك السبب الأول في سلسلةٍ من الأسباب الممكنة صفة التسبُّبية الأولى.
إضافة إلى ذلك، فإنّ قصّة إدواردز حول الأفراد الخمسة من شعب الإنويت هي مُريبة. أولًا، إنّها لا تبدو صادقة ببساطة. حتّى لو وُجِدَ فعلًا خمسةٌ من شعب الإنويت فعلًا، بلباسهم التقليدي، على زاوية شارعٍ في نيويورك، إلا أنّ تفسيرات إدواردز الخمسة لسبب وجودهم هناك -رغم أنّها ربما قد تكونُ صحيحةً ظاهريًا- إلا أنّها تقتضي بوضوحٍ تفسيرًا أعمق يُغطّيها جميعًا. هذه صدفةٌ كبيرةٌ جدًا. الأمر نفسه ينطبقُ على الكون. ثمّة صِلات عميقة واضحة في هذا المحيط البيئي تتطلّبُ تفسيراتٍ مُوحِّدة. قصّة أفراد الإنويت هي مثالٌ سيء. إدواردز مُخطئ أيضًا في أن يعتقد أنّ هذا هو خطأ في المقولة. المطالبة بتفسيرٍ لكامل سلسلة الممكنات لا يعني أنّني أفكّر بالسلسلة نفسها كشيءٍ فوق أفرادها وبعيدًا عنهم. المشكلة هي أنّ أيّ ممكن لا يُفسِّرُ ذاته بذاته. الطريقة الوحيدة لتفسير كلّ واحدٍ منها فرديًا كأسباب هو من خلال إحالتها إلى سببٍ أول وغير ممكن. خُذ القطار على سبيل المثال!
هذا يوصلنا إلى الاعتراض الأخير الذي يُقصَد منه حسم التفنيد، ولكنّه يحتاجُ
(75)إلى إنذار مُسبَق سريع. ينتقلُ إدواردز هنا فجأة إلى صيغةٍ مُختلفة من الدليل، أي الصيغة التي طرحا صموئيل كلارك كما قدّمها كوبلستون في مُناظرته الشهيرة مع راسل. ولكن بما أنّه يعتقدُ أنّ هذه هي صيغة الدليل التي وظّفها ثوماس بالطريقة الثالثة، يُمكنُ أن نتناولها هنا. كما سبق وأن قلت، يبدأ إدواردز القسم الخامس عبر ملاحظته أنّه «من غير المرجّح للغاية أن يستسلم المدافِع المصمِّم عن مسار الاستدلال الكوزمولوجي حتّى ولو هنا». يذكرُ إدواردز أنّ هذا الدليل يتعارضُ مع نقد كانط القائل بأنّ الوجود ليسَ محمولًا. في أيّ حال، يفترضُ إدواردز أنّه يُمكنُ تجاوز هذا الأمر أيضًا هنا. في النهاية، الاعتراض الذي يعتقدُ أنّه يحمل «وزنًا عظيمًا» هو الاعتراض الذي ذكره راسل والذي سبق أن ناقشناه -أي إنّ فكرة أنّ التفسير ينبغي أن يكون «كليًّا» لكي يفي بالغرض هو سوء فهم لماهية التفسير. يستنتجُ إدواردز أنّه أن «نفترض من دون تأخير أن الظواهر تملكُ تفسيراتٍ أو تفسيرًا بهذا المعنى هو بمثابة المصادرة على المطلوب فيما يتعلق بالنقطة موضع النظر... ولكن هذه مغالطة منطقية».
سوف نتناولُ هذا الاعتراض حينما نناقشُ مناظرة راسل-كوبلستون لاحقًا. يكفي الآن أن نقول إنّ اعتراض إدواردز هو نقطة مناسبة تمامًا بالإشارة إلى الحياة العملية بالإضافة إلى البحث العلمي العادي. إذا كنتَ تبحث عن جورب ضائعٍ أو عن علاجٍ للسرطان، فأنت بحاجةٍ فقط إلى أن تلتفت إلى بعض الروابط
(76)السببية المباشرة لكي تنجح. ولكن إذا كنتُ أبحث عن تفسيرٍ كاملٍ لأيِّ شيء، أو إذا كنتُ أتناول الفلسفة، وخصوصًا إذا كان ما أريده فعلًا هو أن أقول شيئًا عن المعنى الأعم لحياتي، فإنّني أحتاجُ إلى أن أتعقّب كل رابط: السلسلة الكاملة وصولًا إلى السبب الأول. وعليه، يُخفق اعتراض إدواردز وراسل.
نظرًا إلى اعترافه بأنّ الاعتراضات الأخرى تفشلُ في النهاية، يجب أن أستنتجَ أنّ إدواردز لم يكن ناجحًا ببساطة في تقديم أيّ اعتراضاتٍ فعّالة على دليل ثوماس.
سوف نتناولُ في الأقسام التالية النقاشَ الجديد حول صيغة الدليل المتمحوِرة حول الإمكان كما وردتْ بشكلٍ رئيسيٍ في الثمانينيات وما بعدها. كانت كليّات الفلسفة في أغلب الجامعات الغربية في تلك المرحلة ما تزالُ بشكلٍ كبيرٍ غير مُرحِّبة بالإيمان بالإله وأدلّته. ولكن هبّتْ بعضُ رياح التغيير: افتُتحتْ «جمعية الفلاسفة المسيحيين» في العام 1978 كجزءٍ من «الرابطة الفلسفية الأمريكية». أمّا السنة التي قبلها فقد شهدتْ ولادةَ «الجمعية الفلسفية الإنجيلية». أحد مؤسّسي هذه الجمعية كان نورمان غايسلر. دافعَ كتابُه «فلسفة الدِّين» الصادر في العام 1974، والذي أصبحَ كتابًا دراسيًا شهيرًا، عن نموذج دليل ثوماس وبدأ يجعله مُتاحًا في الدوائر المسيحية مُجددًا، خصوصًا للتلاميذ في الكليات والجامعات الإنجيلية البروتستانتية وليس فقط الكاثوليكية.
استغرق الأمر عدّة عقود لكي تستجمع هذه الحركة قواها فعلًا، ولكن يملكُ الاثنان في يومنا الحالي صوتًا قويًا بشكلٍ مُتنامٍ، في الجامعات الأمريكية قطعًا ولكن
(77)أيضًا في أوروبا وأستراليا. كنتيجةٍ لذلك، اكتشفَ العديدُ من الفلاسفة ثوماس ودليله، وقدّموه إلى الجيل الجديد.
مورتيمر آدلر: وردَ بيانٌ عن الدليل بحجم كتاب في العام 1980 من قِبل مورتيمر آدلر (1902-2001). وُلد آدلر في عائلةٍ يهودية، ولكنّه وجدَ في مرحلةٍ مبكّرة أفكارَ ثوماس أكويناس جذّابةً فكريًا. صدرَ كتابه بعنوان «كيف نُفكّر بالله: دليلٌ إرشادي لوثنيِّ القرن العشرين» بعد بحثٍ طويلٍ عن حقيقة الله. كلمة «وثني» تُشيرُ هنا إلى المؤلِّف نفسه آنذاك، ولكنّه بعد أربع سنوات عُمِّدَ كعنصرٍ في الكنسية الأسقفية. كان آدلر أحد مؤسّسي «مؤسّسة الكتب العظيمة» وكان عضوًا في هيئة التحرير في موسوعة بريتانيكا. نورد فيما يلي احتجاجه الملخّص الذي وردَ في الفصل الرابع عشر، قريبًا من نهاية الكتاب:
1. وجود المسبَّب يتطلّبُ الوجود والفعل المتزامنَين لمسبِّبٍ فعّال، وهذا يقتضي وجود ذلك المسبِّب وفعله. حينما يتمّ التعبير عن مبدأ السببية بهذه الطريقة، فهو صحيح بنحوٍ بديهي...
2. الكون ككل موجود. لدينا هنا التأكيد الوجودي الذي لا يُستغنى عنه كمسلَّمةٍ في أيّ استدلالٍ وجودي. رغم أنّه لا يملكُ القطعية نفسها التي يملكها تأكيدي لوجودي الشخصي أو تأكيدك لوجودك، إلا أنّه يُمكن بالتأكيد الجزم به من دون أدنى شك معقول.
3. وجود الكون ككل هو ممكن بشكلٍ جذري، وهذا يعني أنّه رغم أنّه ليس بحاجةٍ إلى سببٍ فعّال في حدوثه لأنّه أبدي إلا أنّه بحاجةٍ إلى سببٍ فعّال لبقائه
(78)لكي يحفظ وجوده ويمنع العدم من الحلول مكانه. على ضوء كلّ ما مرّ، لا ينبغي أن يكون هناك أيّ صعوبة في فهم ما تقوله هذه القضية. السؤال الوحيد هو هل إنّه صحيح...
4. إذا احتاج الكون إلى سببٍ فعّال لبقائه ليمنع فنائه، إذًا يجب أن يكون ذلك السبب كائنًا خارقًا للطبيعة، خارقًا للطبيعة في فعله، ووجوده غير مُسبَّب، أي بتعبيرٍ آخر: الكائن الأسمى أو الله. لقد فهمنا أنّه لا يُمكنُ لأيِّ سببٍ طبيعيٍ أن يكون سببًا يَخلقُ من العدم، وأنه لا يُمكن لأيِّ سبب طبيعي أن يكون غير مُسبَّب في وجوده أو فعله. على ضوء هذا الفهم، نحنُ في موقعٍ لكي نؤكّد صِدق القضية الافتراضية، هذه المقدمة المتكونة من إذا-فإذًا. بما أنّ «الطبيعي» و«الخارق للطبيعة» يُمثِّلان مجموعةً شاملة من البدائل، فإنّ السبب الذي نسعى ورائه يجب أن يكون خارقًا للطبيعة إذا لم يكن بالإمكان أن يكون طبيعيًا.
كما ذكرَ آدلر، فإنّ السؤال المتبقّي يتعلّقُ بصدق المقدمة الثالثة، وقد كرّسَ لهذا كامل الفصل التالي. الحجّة لصالحها هي جوهريًا كما يلي. أولًا، يجب أن تتفادى التأكيدات عن الكون كلّه مُغالطة التركيب. لا يُمكن أن نستمدّ الاستنتاجات حول خاصية الكل بناءً على خاصية أجزائه. المشكلة الآن هي أنّه ثمّة أوقات حينما تكون هذه الاستدلالات مشروعة، ولكن لكي يكون ذلك هو الحال ينبغي استيفاء شرطين. أولًا، يجب أن تكون الخاصية موجودة في جميع الأجزاء، وهذا صحيح بوضوح هنا. ثانيًا، يجب أن تكون الخاصية مُماثِلة في الأجزاء وفي الكل، ويحتجّ آدلر أنّ هذا ليسَ هو الحال هنا. نوع الإمكان «الظاهري» الموجود في
(79)الأشياء الفردية هو مختلفٌ تمامًا عن الإمكان «الجذري» في الكون، وهو جذريٌ ليس بمعنى أنّه كان يُمكن أن يكون مُختلفًا ولكن بمعنى أنّ البديل الآخر الوحيد هو العدم. وعليه، فإنّ هذا الخيار لإثبات إمكان الكلّ يفشل.
ولكن هذا يأخذُ آدلر إلى الخيار الثاني. الإمكان الجذري للكون على وجه التحديد هو الذي يُشيرُ إلى أنّه «ما كان ليتحقّق مُطلقًا لو لم يكن وجوده مُسبَّبًا». وعليه، يستطيع آدلر أن يستنتج التالي:
«الكون الممكن فقط لا يُمكن أن يكون كَونًا غير مُسبَّب. الكونُ الذي يكونُ مُمكنًا جذريًا في وجوده ويحتاجُ إلى سببٍ لذلك الوجود، فإنّه بحاجةٍ إلى سببٍ خارقٍ للطبيعة -سبب موجود ويعمل لإخراج الكون الممكن فقط من العدم، وبالتالي يمنعُ تحقيق ما هو دائمًا ممكن لكونٍ ممكن فقط، أي عدمه المطلق أو استحالته إلى العدم».
تتحلّى هذه الحجّة بالفرادة بما أنّها تُحاولُ أن تقول شيئًا عن الكون كلّه. إضافة إلى ذلك، فإنّها تفعلُ ذلك من دون اتّخاذ خطوة حجةٍ تركيبية مُبرَّرة. مع أنّ هذا كلّه يبدو غير ضروري -لم يُتعب أرسطو ولا ثوماس أنفسهما به- إلا أنّه يكونُ مفيدًا في إنتاج استنتاجٍ أتمّ، أي تعريفٍ أكمل عن الله. مع ذلك، فإنّه يستجلبُ النقد الذي يُفيدُ أنّه لا نعرف ببساطة ما يكفي عن الكون كلّه لكي نُقدّم هكذا ادّعاء عن الإمكان الجذري. مع ذلك، يتّفقُ علماء الفيزياء المعاصرين قطعًا على
(80)التالي: إذا نشأ الكون الواحد أو الأكوان المتعدِّدة من العدم من جرّاء الانفجار الكبير، فإنّه حَدَثٌ ممكن جذريًا ويمكننا أن نتحدّث بشكلٍ مشروع عن الكون كلّه.
روبرت كونز: لقد ظهرتْ العديد من حالات إعادة الصياغة أو النماذج المعدَّلة والمستحدَثَة عن دليل الإمكان في السنوات الأخيرة. سوف أنتقي دليلًا من أحد أفضل الفلاسفة لكي أشرع في النقاش. روبرت كونز (المولود في العام 1957) هو أستاذٌ في جامعة تكساس. نشرَ في العام 1997 مقالته بعنوان «نظرة جديدة إلى الدليل الكوزمولوجي» في إحدى المجلات الريادية وهي «الفصلية الفلسفية الأمريكية». نذكرُ الحجّة نفسها فيما يلي:
1. جميع أجزاء الحقيقة الواجبة هي بذاتها واجبة.
2. كلّ حقيقةٍ مُمكنة تملكُ جزءًا ممكنًا بتمامه.
3. إذا وُجِدت أيُّ حقيقة ممكنة، فإنّ الكون هو حقيقة ممكنة بتمامه.
4. إذا وُجِدت أيُّ حقيقة مُمكنة، فإنّ الكون له سبب.
5. كلُّ حقيقة ممكنة تتداخلُ مع الكون.
6. وعليه، إذا وُجِدت أي حقيقة ممكنة، فإنّ الكون له سببٌ وهو حقيقةٌ واجبة.
يتجاوزُ هذا الدليل عدّة اعتراضات تقليدية، وهو يتعاملُ مع الكون كحقيقةٍ
(81)ممكنة من بين حقائق ممكنة أخرى وبالتالي فهو ليس عرضة لقضايا التركيب. لا يُقدِّمُ الدليل نفسه أيّ أسباب لتحديد الله في النتيجة، ولكنّ كونز يتناولُ هذا في نقاشٍ إضافي كما فعلَ ثوماس. وعليه، يُظهِرُ كونز أنّه لا يُمكن أن يتواجد الله في المكان والزمان، أو أن يكون ماديًا، أو أن يتشكّل من أجزاء مادية، ويجب أن يمتلك الصفات غير القابلة للقياس فقط. يوظّف الدليل أيضًا المنطق الجهاتي -ويطرح كونز مُقدّمة إليه- خصوصًا في الفرضيتين (1) و(2). في الختام، وكما ذُكر، فإنّ الدليل ليس بحاجةٍ إلى عامل هازم للتسلسل اللانهائي.
بالطبع ثمّة اعتراضات ممكنة، ولكنّ كونز يقضي أغلب المقالة في تقويضها. ثمّة اعتراض واضح يُوجَّه إلى استخدام كونز لمبدأ السببية الشاملة في الفرضية (4). يذكرُ كونز أنّ هذا مُبرَّر من الحقيقة التي تقول إنّ كلّ «نجاحٍ للتفكير السليم والعلم الطبيعي في إعادة إنشاء السوابق السببية لأحداث مُحدّدة وأصناف الأحداث يُوفِّرُ الإثبات». إضافة إلى ذلك، فإنّ أيّ مُحاولة لإنكاره تتطلّبُ التشكيك الراديكالي. في أيّ حال، فإنّ الدليل على النهج الأرسطيّ-الثوماسيّ لا يحتاجُ إلى هذا فعلًا، إلا كوسيلةٍ لجعل الدليل يتناولُ الكونَ كلَّه.
مايكل مارتن: حاز مايكل مارتن (1932-2015) شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد ودرّس لسنواتٍ مديدة في جامعة بوستون. يأتي نقاشه حول الدليل الكوزمولوجي في ثلاثة أقسام. يتضمّنُ القسم الأول اعتراضاتٍ عامَة
(82)على الدليل الأرسطيّ-الثوماسيّ البسيط. بعدها، يُناقشُ مارتن بعضَ القضايا المحدّدة التي تتعلّقُ فقط بالطريقَين الثاني والثالث اللَّذَين قدّمهما ثوماس، ويختتمُ بمشكلاتٍ مُحدّدة أخرى موجودة في بعض النماذج الحالية.
يدّعي مارتن أنّ اعتراضاته الموجّهة إلى الصيغة البسيطة تهزمُ كلّ نماذج الدليل تقريبًا. وعليه، يكفيني أن أتناولها فحسب إذ يبدو أنّ مارتن يسمح (مرّتين في هذا المقطع الوجيز التالي!)، بمعزلٍ عن هذه الاعتراضات، أن يكون الدليلُ ناجحًا.
«لعلّ المشكلة الكبيرة مع هذا النموذج من الدليل هي أنّه حتّى لو كان ناجحًا في إثبات سببٍ أول، فإنّ هذا السبب الأول ليس الله بالضرورة. لا يحتاج السبب الأول أن يمتلك الخصائص المنسوبة عادة إلى الله. على سبيل المثال، لا يحتاج السبب الأول أن يمتلك علمًا أو خيرًا عظيمًا، فضلًا عن كونه لانهائيًا. يُمكن أن يكون السبب الأول كائنًا شريرًا أو الكون نفسه. تجعلُ هذه المشكلة بنفسها الدليلَ عديمَ الفائدة تمامًا في دعم الرأي الذي يُفيدُ وجودَ الله. رغم ذلك، لديه مشكلة واحدة أخرى على الأقل هي بالقدر نفسه من الخطورة.
يفترضُ الدليل عدمَ إمكانية وجود سلسلةٍ لانهائيةٍ من الأسباب، ولكن من غير الواضح لماذ يجب أن يكون هذا هو الحال. لا تكشفُ الخبرة عن تسلسلاتٍ سببية تملكُ سببًا أولًا، سببًا غير مُسبَّب. وعليه، فإنّ فكرة عدم إمكانية وجود تسلسلاتٍ لانهائية وضرورة وجود سببٍ أول، سبب من دون سبب، لا تجدُ دعمًا في التجربة.
إضافة إلى ذلك، لا نملكُ تجربةً بالتسلسلات السببية اللانهائية، ولكنّنا نعلم بوجود سلاسل لانهائية كالأرقام الطبيعية. قد يتساءلُ الفرد لماذا، إذا كان من الممكن أن توجد تسلسلاتٍ لانهائية في الرياضيات، عدم إمكانية وجود واحدةٍ في السببية. لا شكّ بوجود اختلافاتٍ حاسمة بين السلاسل السببية والرياضية؛
(83)ولكن مع عدم وجود حججٍ إضافية تُظهِرُ بالضبط ماهيتها فليس هناك سبب لكي نعتقد بعدم إمكانية وجود تسلسل لانهائي من الأسباب. قدّمَ بعض المدافعين قريبي العهد عن الدليل الكوزمولوجي هكذا أدلّة بالذات، وسوف أفحصُ هذه الأدلة لاحقًا. ولكن حتّى لو كانت ناجِحة، إلا أنّها لا تُظهرُ بنفسها أن السبب الأول هو الله».
لقد لاحظنا هذان الاعتراضان من قبل. شهدَ الاعتراض الأول الذي يدّعي أنّ السبب الأول ليس الله ردودًا منذ عصر أرسطو، وبشكلٍ مسهب من قبل ثوماس. أما الاعتراض الثاني الذي يدّعي أنّ التسلسلات اللانهائية ليست ممكنة الوقوع فحسب بل هي تحصل فعلًا، فقد ردّ عليها أرسطو أيضًا. في الواقع، هذا بالفعل هو النقطة الرئيسية في الدليل الكوزمولوجي نفسه. بالطبع ثمّة تسلسلات لانهائية، ولكنّ السلسلة اللانهائية من الممكنات السببية الفعلية لا يُمكن أن تُوفّر أثرًا. كما يحتجّ أرسطو، لتحقّقتْ فقط الأسباب المتوسِّطة -حتّى لو كان عددًا لانهائيًا منها- ولكان لما تحقّق السبب الأولي والمنشئ لكي يُنتج أي أثرٍ نهائي.
ويليام لين كريغ: بالتأكيد، لم يكن أحدٌ أكثر تأثيرًا من ويليام لين كريغ (المولود في العام 1949) في إعادة إحياء الدليل الكلامي مؤخّرًا. كان هذا الدليل همّه
(84)المتكرِّر في عددٍ من المنشورات منذ تقديم أطروحته في جامعة بيرمينغهام في العام 1977 تحت إشراف جون هيك، والتي نُشرتْ تحت عنوان «الدليل الكلاميّ الكوزمولوجي» في العام1979. أُثير اهتمامه بالدليل من خلال استخدام ستيوارت هاكيت المؤثّر لمصطلح الكلام في كتابه الصادر في العام 1957 تحت عنوان «انبعاثة الإيمان». تعبيرُ كريغ الموجز عن الدليل هو كما يلي ببساطة:
1. كلُّ حادث له سبب.
2. الكون حادث.
3. بالتالي، الكون له سبب.
يستغرقُ الدليل لصالح الفرضية الأولى بضعَ صفحاتٍ فقط، وهو يتطلّبُ مقدارًا قليلًا من الدفاع لأنّ كريغ يعتقدُ أنّه من البديهي حدسيًا أن لا يوجد شيء من العدم، وهو ما يبدو أنّه البديل الآخر الوحيد. لا شيء يأتي من لا شيء!
مع ذلك، دافعَ كريغ بإيجاز عن الفرضية بطريقَين: الطريق الأول هو الحجّة المبنيّة على الحقائق التجريبية: «[هو] مُثبتٌ دائمًا وغير مُبطَل مُطلقًا، يُمكن أن تؤخَذ القضية السببيّة كتعميمٍ تجريبيٍ تتحلّى بأقوى دعمٍ تُقدّمه التجربة». ثانيًا، صاغَ كريغ حجّةً مبنيةّ على الطبيعة السابقة على التجربة لمقولة السببية -أي إنّنا
(85)نملكُ معرفةً تأملية بالمقولات؛ وبالتالي لا يُمكنُ حصرها بميدان التجربة الحسية. لا يُمكن أن يتحقّق تفكيرنا الإراديّ والواعي بالعالَم من دونها.
أمّا الفرضية الثانية فهي مسألةٌ مُختلفة، ويستغرق الدفاع عنها أكثر من ثلث الكتاب. تتألّفُ الفرضية من دليلَين فلسفيَّيْن سبقَ وأن لاحظناهما من قبل: الدليل على استحالة وجود لانهائيةٍ فعلية [من الأشياء]، والدليل على استحالة تشكيل لانهائيةٍ فعلية عبر الإضافة المتتالية. يعتمدُ كلٌّ من هذين الدليلَين على التمييز الحاسِم بين اللانهائيات الرياضية أو المحتمَلة (خصوصًا كما عرّفها عالِم الرياضيات الألماني الكبير جورج كانتور التي تملكُ وجودًا مفهوميًا، ولانهائيات العالم الواقعي أو الفعلية التي (إن وُجِدتْ) توجدُ حقًا في هذا العالم الفعلي.
يستندُ الدليل الفلسفيّ الأول على منافاة اللانهائي الفعليّ للمنطق: «ما أحتجّ عليه هو أنّه رغم أنّ اللانهائي الفعلي قد يكون مفهومًا مُثمرًا ومتّسقًا في المجال الرياضي، إلا أنّه لا يُمكن أن يُترجَم من العالَم الرياضي إلى العالَم الواقعي لأنّ هذا يتضمّن لامعقولياتٍ مُنافية للحدس». وظّفَ كريغ عددًا من الأمثلة التقليدية هنا، ولكنّ أكثر الأمثلة تكرارًا في منشوراته كان مثال «فندق هيلبرت» الذي طرحه لأول مرة ديفيد هيلبرت، عالِم الرياضيات الألماني الكبير في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. يقولُ كريغ: تخيّل فندقًا يحوي عددًا
(86)لانهائيًا من الغرف، وجميعها مشغولة. وصلَ ضيفٌ جديد، ورحّب به مُدير الفندق بسرور وأنزله في الغرفة رقم واحد التي أصبحت فارغة بما أنّه قد نقلَ نزيل الغرفة رقم واحد إلى الغرفة رقم اثنين، ومن ثمّ نزيل الغرفة الأولى إلى الغرفة الثالثة وما إلى ذلك حتّى تمّ نقلُ جميع العدد اللانهائي من الضيوف. بعدها، افترِض أنّ عددًا لانهائيًا من الضيوف الجدد وصل. قام مُدير الفندق الآن بنقل الضيف في الغرفة الأولى إلى الغرفة الثانية، والضيف في الغرفة الثانية إلى الغرفة الرابعة، والضيف في الغرفة الثالثة إلى الغرفة السادسة، وما إلى ذلك، حتّى شغل الآن العددُ اللانهائي من الضيوف الحاليّين العددَ اللانهائي من الغرف ذات الأرقام الزوجية. تمكّنَ المدير الآن من نقل العدد اللانهائي من الواصلين الجدد إلى العدد اللانهائي من الغرف الفارغة ذات الأرقام الفردية، وكلّ شيءٍ هو على ما يُرام.
يبدو أنّ المشكلة الحقيقية الآن هي أنّ هذا الوضع ينتهكُ قاعدةً رئيسية في علم الحساب، أي إنّ الحساب نفسه المنفَّذ بالأرقام نفسها يجب أن يُنتِج دائمًا نتيجة مماثلة. ولكن لا يعملُ الأمر هنا بشكلٍ صحيح. في السيناريو الأول، اللانهائية ناقص اللانهائية تُساوي 1. ولكن في السيناريو الثاني، اللانهائية ناقص اللانهائية تُساوي اللانهائية. هذا الأمر يُنافي الحدس بشكلٍ مُحيِّر. إذا كانت جميعُ الغرف مشغولةً في العالم الواقعي، فإنّ أيَّ نقلٍ للضيوف لن يُتيح غرفةً فارغة. أمّا رياضيًا، فإنّ جميع الانتقالات الواردة في المثال هي معقولة تمامًا نظرًا إلى خصائص اللانهائية. استنتجَ كريغ -كما فعلَ هيلبرت- من هذا المثال وغيره من
(87)الكبيرة الناتجة من بداية العام 1965، وأمّا الثاني فهو قوانين الديناميكا الحرارية. يحتجُّ كريغ أنّ الاثنان هما برهانَين علميَّين على وجود بدايةٍ مُطلقة للكَون -أي إنّ الكون كان له مدة محدودة في الوقت.
جاءت الردود على دليل كريغ، من دون استثناء تقريبًا، على هيئة تأكيداتٍ تتعلّقُ بالإمكانات و/أو المستحيلات الرياضية. وبشكلٍ دائمٍ تقريبًا جاء الردُّ نفسه: الحجج الرياضية أو المفهومية أو الاحتمالية هي خالية من المعنى هنا بالنسبة إلى ميتافيزيقيا العالَم الواقعي الفعلي. سوف نطّلع على مثالٍ وردَ مؤخّرًا.
جيمز إيست: بالطبع، توجد العديد من الاعتراضات الحالية التي تُقدَّم ضدّ هذا الدليل من جميع الجهات. أغلب الاعتراضات تتعلّق بالدليل ضدّ اللانهائي الفعلي، الذي تعودُ جذوره إلى الوراء إلى زمن فيلوبونوس وسیمبلیکیوس. احتجَّ جيمز إيست (المولود في العام 1980)، وهو عالِمُ رياضيات موجودٌ حاليًا في جامعة ويسترن سيدني أنّ استدلال كريغ ينطبقُ على الأعداد المحدودة ولكن لا ينطبق على الأعداد فوق المنتهية واللانهائية. فيما يلي دليله، بدءًا بالاستنتاج:
إذا وُجِدتْ مجموعاتٌ لانهائية فعلية، فإنّها بشكلٍ طبيعيٍ سوف تمتلكُ خصائص لم تُشاركها [به] المجموعات المحدودة. كمثالٍ واضح، إذا حاول
(89)الفرد أن يعدّ مجموعةً لانهائية فعلية بمعدّل ثابت، فإنّه لن ينتهي قط (وهذا هو الحال أيضًا مع المجموعات اللانهائية المحتملة كأبدية مستقبلية متكوّنة من أيام منفصلة). تُبرز قصّة فندق هيلبرت ببساطةٍ خاصية أخرى تُميّز المجموعات اللانهائية الفعلية من المحدودة: مجرّد معرفة أنّ مجموعةً فرعية لانهائية قد أُزيلتْ من المجموعة اللانهائية من الأشياء لا يسمحُ للفرد أن يُحدِّد عدد الأشياء المتبقّية. ولكنّ هذه الخاصية نفسها لا تستلزمُ استحالة المجموعات اللانهائية الفعلية.
النقطة التي يُقدّمها إيست هي أنّه في المجموعات المحدودة، تُطاعُ القواعد العادية أو مبرهنات الإضافة والطَّرح. ولكن في مثال فندق هيلبرت الذي قدّمه كريغ، تُفضي عمليّتَيْ طَرح مُماثلتين إلى نتيجتين مُختلفتَين. يستنتجُ كريغ من هذه المفارقة أنّ اللانهائيات الفعلية هي مُنافية للعقل. ولكن يحتجّ إيست: ما كان ينبغي أن يستنتجه كريغ هو ببساطة أنّ النظريات تنطبقُ فقط على الأعداد المحدودة ولا تنطبق على الأعداد فوق المنتهية. وعليه، فإنّ كريغ ليس من حقّه أن يصل إلى أيّ نتيجةٍ مُطلقًا عن اللانهائيات الفعلية بناءً على أمثلةٍ كمثال فندق هيلبرت.
آندرو لوك: من بين المدافعين الحاليين عن الدليل الكلامي هو آندرو تير إيرن لوك (المولود في العام 1975) الموجود حاليًا في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ. احتجَّ لوك في كتابه تحت عنوان «الله والأصول العليا» لصالح دليلٍ كوزمولوجيٍ جديد -لكن ما زالَ على النهج الكلامي- وقدّم ردودًا على عدّة نُقّاد، من بينهم جيمز إيست. طرحَ لوك دليلًا يتمتّعُ بجميع إيجابيات كُلٍّ من الدليل الثوماسي والدليل الكلامي ولكنّه يتفادى المزالق المحتملة للاثنين. أولًا، نذكرُ دليله «الجديد»:
(90)1. توجد كيانات هي: أ) عناصر في سلسلةٍ سببية زمنية؛ وب) حادثة.
2. كلّ حادث له سبب.
3. إذا وُجِد كائن هو: أ) عنصر في سلسلةٍ سببية زمنية؛ وب) حادث، فثمّة إذًا كائن غير مُسبَّب X.
4. يوجد X، وهو غير مُسبَّب وغير حادث (من 1، 2، و3).
5. إذا كان X غير مُسبَّب وغير حادث، لا يوجد شيءٌ قبله وبالتالي هو سببٌ أوّل.
6. X هو سببٌ أوّل (من 4 و5).
يُقصَد من هذا الدليل أن يكون دليلًا كلاميًا بمعنى أنّه يتناولُ تعقُّب الأحداث إلى الوراء زمنيًا بهدف استنتاج سببٍ للـشيء الأول في الوقت. الدليل هو ثوماسيٌ بمعنى أنّ خاتمته تعتمدُ على إنكار التسلسل اللانهائي، ولو الزمني منه، بدلًا من اللانهائي الفعليّ. نعم، يتّفقُ لوك مع الإنكار ذي الشعبتين الذي وجّهه كريغ للانهائيات الفعلية، وقد دافعَ بالفعل عن هذه المقاربة في مقابل الاعتراضات الأخيرة. في هذه العملية، تناولَ لوك حجّة إيست وقدّم ردًا عليها. هذا هو همُّنا الأساسي هنا.
لكي نبدأ، نمط الردّ الذي يُقدّمه إيست لا يُثبت بأيِّ نحوٍ إمكانية اللانهائيات الملموسة الفعلية. ينبغي أن نذكر أنّ ما هو ممكنٌ رياضيًا ليس دائمًا ممكنًا ميتافيزيقيًا. على سبيل المثال، يُمكن للمعادلة التربيعية x2-4 = 0 أن تملك نتيجتين ثابتتَين رياضيًا لـ«x»: 2 أو -2، ولكن إذا كان السؤال «كم شخصًا حمل الحاسوب إلى المنزل» لا يُمكن أن يكون الجواب «-2»، لأنّه من المستحيل ميتافيزيقيًا في العالَم الملموس أن يحمل «-2 شخصًا» الحاسوب إل المنزل. وعليه،
(91)فإنّ استنتاج «شخصين 2» عوضًا عن «-2 شخصًا» ليس مُستمدًّا من المعادلات الرياضية وحدها بل أيضًا من الاعتبارات الميتافيزيقية: «-2 شخصًا» يفتقدون للقوى السببية لحمل الحاسوب إلى المنزل. هذا يُظهِر أنّ الاعتبارات الميتافيزيقية هي أكثر أساسيةً من الاعتبارات الرياضية.
لا شكّ أنّ هذا النقاش سوف يستمر. على وجه التحديد، فيما يتعلّق بدليل لوك، هل يُمكن الدفاع عن الفرضية (3) المذكورة آنفًا بشكلٍ إضافي؟ بغضِّ النظر عن ذلك، ثمّة أمران يبدوان واضحَين: أولًا، ينبغي أن تخضع الإمكانات الرياضية أو المفهومية إلى الإمكانات الميتافيزيقية حينما يتعلّق الأمر بقضايا العالَم الواقعي. هذا لا يعني أن نقول بعدم وجود رابطةٍ بين المنطق والواقع، بل يُشيرُ فقط إلى قُدرة العقل البشري على تكوين المفاهيم حول الإمكانات -ومن بينها الإمكانات الرياضية- التي لا يُمكن أن توجد فعلًا في العالَم الواقعي، أي إنّها لا تملكُ فاعليةً سببية.
ثانيًا، لا شيء في هذا الحوار يُظهِرُ إمكانية وجود لانهائيات فعلية، وقد وضّح ذلك كلٌّ من إيست ولوك. ردّ إيست كالتالي:
«إنّني أُوافق بشكلٍ عام مع كلّ ما يقوله لوك هنا؛ على وجه التحديد، لم تَسْعَ مقالتي إلى الاحتجاج بأنّ اللانهائيات الملموسة الفعلية هي مُمكنة بل [إلى أن تُظهِر] أنّ حجّةً واحدةً مُحدّدة (تابعة لكريغ) ضدّ إمكانيتها كانت معيوبة. ربما كنتُ لأقول إنّ [عبارة] «-2 شخصًا» لا معنى لها بدلًا من [قولي] إنّ « -2 شخصًا« يفتقدون للقوى السببية لحمل الحاسوب إلى المنزل». كنتُ لأضيفَ أيضًا أنّه بينما يُمكن للاعتبارات الميتافيزيقية أحيانًا أن تُساعد في استبعاد بعض
(92)الإمكانات الرياضية المحدّدة، فإنّ هذا ليسَ هو الحال دائمًا؛ على سبيل المثال، إذا كان عدد الأشخاص الذين حملوا الحاسوب إلى المنزل يُلبّي [معادلة] x2-3x+2=0، فإنّ الإمكانَين الرياضيَّين (x=1 وx=2) هما ممكنان ميتافيزيقيًا. ولكن لا شيء يقوله لوك هنا يدحضُ موقفي من أنّ دليل كريغ معيوب، وأنا لستُ حتّى متأكِّدًا إذا كان يدّعي لوك أنّه يدحضُ موقفي. كما أشرحُ في مقالتي، يستندُ دليلُ كريغ إلى افتراضٍ غير صحيح: أنّه إذا كانت المجموعات اللانهائية مُمكنة، فإنّ عبارة «كثرة لانهائية من الأشياء قد أُزيلَت من مجموعةٍ لانهائية» ينبغي أن تكون معلومة كافية لحساب عدد الأشياء المتبقِّية».
ردّ لوك من خلال إعادة التأكيد على نقطته الأساسية.
«في الرد، فإنّ سبب كون x=1 وx=2 مُمكنان هو لأنّ هذين الجوابين ليسا مُمكنَين رياضيًا فحسب بل أيضًا مُمكِنَين ميتافيزيقيًا، أي إنّها لا تنتهكُ أيَّ حقائق ضرورية ميتافيزيقيًا على خلاف «-2 شخصًا يحملون الحاسوب إل المنزل». فكرتي هي أنّه إذا كانت الإجابات مُستحيلة ميتافيزيقيًا، فهذا يهزمُ الإمكان الرياضي، وتُظهِرُ الاعتبارات الميتافيزيقية التي قدّمتها على الصفحات 55-61 أنّ اللانهائيات الملموسة تنتهكُ الحقيقة الضرورية ميتافيزيقيًا وبالتالي تكونُ مُستحيلة ميتافيزيقيًا.»
أستنتجُ أنّه ما زالتْ توجد أُسُسٌ كافية لكي نؤكّد على عدم إمكانية وجود لانهائيٍ فعلي، وبالتالي فإنّ الدليل الكلامي الذي يرجعُ إلى زمن فيلوبونوس يبدو أنّه يقفُ كدليلٍ فلسفيٍ يقتضي أن يكون الكون قد بدأ مع الوقت وبالتالي ضرورة أن يكون له خالق.
(93)بول درايبر: ثمّة اعتراضٌ مهم آخر، وهو الاعتراض الذي وجّهه بول درايبر (المولود في العام 1957)، الأستاذ في جامعة بيردو، إلى دليل كريغ. ينصُّ اعتراضُ درايبر أنّ دليل كريغ يُطبِّقُ المواربة في حق عبارة «أن يحدث». قد يعني هذا، فيما يُسمّيه درايبر المعنى الضيِّق، أن شيئًا قد حدثَ في الزمن بحيث لم يكن موجودًا في نقطةٍ زمنية سابقة. ولكن قد يملك أيضًا المعنى الأعم المتمثِّل بالحدوث من دون افتراض زمنٍ سابق، وقد يُشيرُ إلى بداية الزمن.
احتجّ درايبر بعدها أنّ مقدّمة كريغ الأولى «كلّ حادث له سبب» تُوظِّفُ المعنى الأول بينما مقدّمته الثانية «الكون حادث» تُوظِّف المعنى الثاني الأعم. وعليه، يُعاني الدليل من المواربة. الأمر الأسوء هو أنّه من غير الواضح كيف يُمكن أن ندعم الفرضية الأولى. يقولُ درايبر إنّ كريغ يعتبرها تعميمًا تجريبيًا.
«التجربة تدعمُ فقط الادّعاءَ بأنّ أيّ شيءٍ حادث داخل الزمن له سببٌ لوجوده إذ لا نملكُ تجربةً على الإطلاق عن الأشياء الحادِثة مع الزمن. هذه الأشياء تحتاجُ إلى أسبابٍ غير زمنية. وحتّى لو كان مُمكنًا من الناحية المفهومية لحدثٍ زمنيٍ أن يملك سببًا غير زمني، فإنّنا لا نملكُ قطعًا أيّ تجربة بذلك. بالطبع، يدّعي كريغ أيضًا أنّ المقدّمة (1) هي واضحة بداهةً وأنّها ليست بحاجةٍ إلى أيّ دفاعٍ مُطلقًا. ولكنّه من البعيد عن الوضوح أن يكون الكون الذي خرج إلى الوجود مع الزمن بحاجةٍ إلى سببٍ لوجوده. كما أنّ الكون القديم لانهائيًا
(94)
(95)
بخصوص الأمور الممكنة معروف بعدم الموثوقية -ولهذا السبب فإنّ العديد من الفلاسفة المعاصرين هم، بنحوٍ مُبرَّر تمامًا، «علماء تجريبيون عنيدون».
هذا بالطبع هو دليلٌ استقرائي إلى حدٍ كبير، ولكنّه ببساطة غير معقول ميتافيزيقيًا ولم نشهد قطّ حدوث شيءٍ من دون سبب، سواء كان من العدم أو من شيءٍ آخر. لا شكَّ أنّ هذا ليس بُرهانًا رياضيًا، ولكنّه بغياب هكذا أدلّة يكون أفضل دليلٍ يُمكن أن نتوقّع الحصول عليه.
صموئيل كلارك وغوتفريد فيلهلم لايبنتس: ألقى صموئيل كلارك (1675-1729) في العام 1704 «مُحاضرات بويل» السنوية في كاتدرائية القدّيس بولس. نُشرت هذه المحاضرات في العام 1714 تحت عنوان «كينونة الله وصفاته» مُرفقةً مع مُحاضرات العام 1705. كان الهدف من هذه المحاضرات الدفاع عن إسحاق نيوتن ومُواجهة ثوماس هوبز وباروخ سبينوزا. في العام نفسه، نشرَ غوتفريد فيلهلم لايبنتس (1646-1716) كتابه «مونادولوجيا»، وهو نموذجٌ مُلخّص - وذلك في مقاطع وجيزة مُرقَّمة - عن الميتافزيقيا العامة التي تبنّاها. أمّا الدليل على وجود الله الموسَّع كثيرًا، فقد ظهرَ لأوّل مرةٍ في كتابه «ثيوديسيا» الصادر في العام 1710. بعد صدوره، راسلَ كلارك ولايبنتس بعضهما خلال العام 1715 ولغاية وفاة لايبنتس في العام 1716.
(96)حاولَ الاثنان صياغة ميتافيزيقيا منهجية تُوفِّر إطارًا للعلم الطبيعي وفَهمًا كاملًا للكَون. أراد الاثنان من هذه العملية أن يُثبِتا أنّ وجود الله هو الأساس الضمنيّ لكلّ العلم الطبيعي. دارَ الكثير من الجدال حول من جاءت أفكاره أولًا، ولكن من المرجّح جدًا أنّ أفكارهما معًا قد خرجتْ من النقاش الأعم حول أُسُس العلم الطبيعي التي انخرط فيها العديد من -وربما أكثر- علماء العلم الطبيعي وعلماء الرياضيات والفلاسفة وعلماء اللاهوت البارزون في أوروبا في ذلك العصر.
يسهلُ قطعًا تمييزُ الدليل الذي قدّمه الاثنان على أنّه دليلٌ كوزمولوجي مُعدَّل بعدّة طرق. أولًا، بما أنّها تُشكِّل قاعدة ميتافيزقيا ناضجة تمامًا التي تُشكّل بدورها أساسَ فيزياء كاملة، فإنّها ينبغي أن تكون أدلة على كلّ شيء. وعليه، على خلاف النموذج الأرسطي/الثوماسي، فإنّها لا تبدأ بملاحظاتٍ مُحدَّدة حول أشياء مُعيَّنة في الكَون، بل بقضايا عامة عن الكلّ.
ثانيًا، تُشكِّلُ الأدلة منظومةً قياسية وبالتالي تحتاج أن تمضي قُدمًا عن طريق مبدأٍ عام يسمحُ للدليل أن ينتقل من هذه المقدمة الأولى إلى السبب الشامل الذي هو الله. هذا هو مبدأ السبب الكافي، وهو ما يُفسِّر إطلاق صفة السبب الكافي على الأدلة.
ثالثًا، تُتيحُ هذه الشمولية في المقدمات نتيجةً أكثر اتّساعًا. لم نعد بحاجةٍ إلى الحجج الفرعية البارمنیدية لكي نستنتجَ وجود خالقٍ وحيد، قوي وعليم ولانهائي. يبدو أنّ مبدأ السبب الكافي يقتضيه بشكلٍ مباشر.
يَظهرُ أنّ هذه هي ميزة كبيرة. ننتقلُ من مبدأ بسيط مُعترَف به عمومًا إلى
(97)
(98)
الكليّ، الأحدية، الذكاء، الحرية، القدرة الكلية، واللانهائية في الحكمة والخير والعدل والصدق.
نذكرُ فيما يلي احتجاجَ لايبنتس من كتابه «مونادولوجيا» الصادر في العام 1714:
مع ذلك، ينبغي أن يوجد أيضًا سببٌ كافٍ للحقائق الممكنة أو حقائق الواقع، أي لسلسة الأشياء المفهومة في عالَم المخلوقات. يُمكن هنا إكمالُ التقسيم [للوصول] إلى أسبابٍ خاصة من دون حدود، إذ إنّ التنوُّع في الأشياء الطبيعية هائل، والأجسام منقسمة بشكلٍ لانهائي. ثمّة لانهائية في الأشكال والحركات، الماضي والحاضر، التي تُساهم في السبب الفعّال لكتابتي الآن لهذه [الكلمات]. وثمّة لانهائية في الميول الدقيقة لروحي ونزعاتها، التي تُساهِم في السبب النهائي لكتابتي.
الآن، كلّ هذه التفاصيل تُشيرُ مُجددًا إلى مُمكنات سابقة أو أكثر تحديدًا، وكلّ واحدٍ منها يقفُ مُجددًا في حاجةٍ إلى تحليلٍ مماثل لكي يتمّ تفسيره، وعليه لا يُكتسَب شيءٌ من هكذا تحليل. لذلك، ينبغي أن يوجد السبب الكافي أو النهائي خارج التتابع أو سلسلة الجزئيات الممكنة، حتّى لو كانت هذه السلسلة لانهائية.
بالتالي، السبب النهائي لجميع الأشياء ينبغي أن يستمرّ في جوهرٍ لانهائي حيث يُمكن أن تتحقّق جميع التغيُّرات المحدَّدة افتراضيًا فقط كما في مصدره: هذا الجوهر هو ما نُسمّيه الله.
الآن، هذا الجوهر هو السبب الكافي لكلِّ هذا الوجود المحدَّد الذي هو، فضلًا على ذلك، مُترابط من أدناه إلى أقصاه. وعليه، يوجد إلهٌ واحد فقط، وهذا الإله كاف.
(99)لا شكّ أنّ هذين المفكّرَين كانا يملكان قاعدةً مُختلفةً نوعًا ما لمبدأ السبب الكافي. كلارك هو أقرب إلى التجريبي البريطاني، بينما لايبنتس هو أقرب إلى العقلاني الألماني. سوفَ يكونُ لذلك بعض التأثير على نقد مبدأ السبب الكافي، ولكن في النهاية أراد الاثنان منه أن يكون مبدأ شاملًا حاكمًا على كلِّ الفيزياء. هذه الشمولية بالذات لمبدأ السبب الكافي هي التي سوف تلعبُ دورًا مهمًا في الاعتراضات المعاصِرة على الدليل.
برتراند راسل وفريدريك كوبلستون: لعلّ أشهر مُناظرة فلسفية في التاريخ الحديث حصلت في 28 كانون الثاني 1948 في بثٍّ مُباشر على قناة الـBBC .كان برتراند راسل (1872-1970) -إيرل راسل الثالث، الأرستقراطي (كان جدّه رئيسًا للوزراء في عهد الملكة فيكتوريا)، الليبرالي والناشط الاجتماعي، الحائز مُستقبلًا على جائزة نوبل (1950)، خرّيج وأستاذ جامعة كامبريدج - تقدُّميًا ومُلحدًا مشهورًا. لم يرد في كتابه الدراسيّ التمهيدي في الفلسفة تحت عنوان «مشكلات الفلسفة»، المعتمَد بشكلٍ واسع، ذكرٌ لله. أمّا فريدريك كوبلستون (1907-1994)، فكان قسًّا يسوعيًا، وخرّيجًا من جامعة أكسفورد، وأُستاذًا في كلية هيِيْثروب. رغم أنّ كوبلستون كان شابًّا، إلا أنّه كان قد وصل إلى مكانةٍ راسخة في حياته المهنية الفلسفية، وقد نال أكبرَ تقديرٍ لاحقًا لكتابه الهام تحت
(100)عنوان «تاريخ الفلسفة» الممتدّ على تسعة أجزاء (1946-1974).
بالكاد كانت بريطانيا خلال هذه المرحلة الزمنية في طَور استرداد عافيتها بعد الحرب العالمية الثانية. كان اقتصادها مُحطَّمًا ولا تزالُ تخضعُ جميع السلع الأساسية للتقنين. ولكنّ الشعب البريطاني كان يبتهجُ بالفوز ومُتفائلًا إذ كان يبزغُ فجرُ عصرٍ جديد. للمستمع العادي، لا بدّ أنّ راسل، المرح والمحبّ للحياة (تزوّج أربع مرات)، بدا مُعاصرًا ومُطّلعًا. أمّا القسّ كوبلستون، فقد بدا وكأنّ أدلّته ولغته هما من الطراز القديم بشكلٍ يائس، رُغم أنّه كان أصغر بكثيرٍ من راسل ورغم أنّ أغلب المستمعين في ذلك الوقت كانوا يتّفقون مع استنتاجاته. كان راسل واثقًا للغاية من أنّه قد فاز، إلى درجة أنّه قد ضمّ لاحقًا نُسخةً مكتوبة من المناظرة في كتابه «لماذا أنا لستُ مسيحيًا»، وذلك بعد العام 1957 (صدر الكتاب لأول مرةٍ في العام 1927).
بدأ كوبلستون بتمهيدٍ مألوف حول دليل لايبنتس ومن ثمّ دافع عنه باقتدار كبير. بما أنّني مهتمٌ بشكلٍ رئيسيٍ باعتراضات راسل، سوف أذكر كلامه فيما يلي وأحذف ملاحظات كوبلستون التي تخلّلته:
أفضلُ نقطةٍ أبدأ منها هي مسألة واجب الوجود. أؤكّدُ أنّ كلمة «واجب» يُمكن أن تنطبق فقط بشكلٍ ذي معنى على القضايا. وفي الواقع، [يُمكن أن تنطبق] فقط على القضايا التحليلية، أي القضايا التي يكونُ من المناقض ذاتيًا إنكارها. يُمكن أن أعترف [بوجود] واجب الوجود فقط إذا وُجِد كائنٌ يكونُ من المناقِض ذاتيًا إنكارُ وجوده... أنا لا أعترفُ بفكرة واجب الوجود ولا
(101)أعترفُ بوجود أيّ معنى خاص في تسمية الأشياء الأخرى «ممكنة». لا تملكُ هذه العبارات معنىً بالنسبة لي، إلا ضمن منطقٍ أرفضه.
قدّم كوبلستون حينئذ تعريفًا مألوفًا للموجود الممكن بأنّه الشيء «الذي لا يملكُ بذاته السبب الكامل لوجوده». أجابَ راسل: ««هل إنّ سبب العالَم موجود؟» هذا سؤالٌ له معنى. ولكن إذا قُلتَ: «نعم، الله هو سببُ العالم» فإنّك تستخدم الله كاسم عَلَم؛ إذًا «الله موجود» لن تكون عبارة ذات معنى، هذا هو الموقف الذي أؤكِّد عليه». من هنا، انتقلت المناظرة إلى مسألة كيفية تعريف «السبب الكافي».
وعليه، ينصبُّ كلّ شيء على مسألة السبب الكافي، وعليّ أن أقول إنّك لم تُعرِّف «السبب الكافي» بطريقةٍ يُمكن أن أفهمها -ما هو الذي تعنيه من السبب الكافي؟ لا تعني السبب؟
ولكن متى يكونُ التفسير كافيًا؟ افترض أنّني على وشك أن أُشعل نارًا من عود ثقاب. يُمكن أن تقول إنّ التفسير الكافي لذلك هو أنّني أجعله يحتكّ مع العلبة.
إذًا، يُمكن فقط أن أقول إنّك تبحث عن شيءٍ لا يُمكن أن يُنال، شيء لا ينبغي للفرد أن يتوقّع الحصول عليه.
لأنّني لا أرى سببًا للاعتقاد بوجوده. مفهوم السببية بتمامه هو مفهومٌ نستمدّه من مُلاحظتنا لأشياء مُحدّدة؛ إنّني لا أرى سببًا على الإطلاق لكي أفترض أنّ المجموع له أيّ سبب على الإطلاق.
يُمكن أن أوضِّح ما يبدو لي أنّه مُغالطتك. كلُّ رجلٍ موجود لديه أم، ويبدو لي أنّ حجّتك تُفيدُ أنّه بالتالي ينبغي أن يكون للبشرية أم، ولكن من الواضح أنّ البشرية ليس لديها أمًّا -ذلك نطاقٌ منطقي مختلف.
(102)أعتقد -يبدو لي وجود امتداد محدَّد غير مُبرَّر هنا؛ عالِم الفيزياء يبحثُ عن الأسباب؛ وهذا لا يقتضي بالضرورة وجود الأسباب في كلّ مكان. قد يبحث الرجل عن الذهب من دون أن يفترض وجود الذهب في كلّ مكان؛ إذا وَجَدَ الذهب، حسنًا وجيد، وإذا لم يجده فقد واجهَ حظًا عاثرًا. ينطبقُ الأمر نفسه حينما يبحثُ علماء الفيزياء عن الأسباب. أمّا بالنسبة لسارتر، فلا أزعمُ أنني أعلمُ ما يقصده، ولا أحب أن يُعتقَد بأنني أفسّره، ولكن من جهتي أعتقدُ أنّ مفهوم امتلاك العالَم لتفسير هو خطأ. لا أرى لماذا يتوقّع الفرد أن يكون للعالَم تفسير.
من ثمّ، ختمَ كوبلستون الموضوع عبر السؤال عمّا إذا كان راسل يدّعي أنّه لا ينبغي للفرد حتّى أن يطرح السؤال عن سبب العالَم، فأجابَ راسل: «نعم، هذا موقفي».
طرحَ راسل ثلاثة اعتراضات في هذا القسم من الجدال. أولًا، ثمّة مسألة أنّ مصطلح «الوجوب» يمكن تطبيقه فقط على القضايا. بالتالي، استخدامه في السياق الميتافيزيقي بحقّ كائنٍ ما يخلو من المعنى. ثانيًا، لم يتفهّم راسل فكرة «السبب الكافي»، على الأقلّ بعيدًا عن المفهوم البسيط للسبب. وثالثًا، اعتقدَ راسل أنّ التحدُّث عن الكَون ككيانٍ واحدٍ يُعدُّ مُغالطةً صريحة. وعليه، لا يُمكنُ للفرد أن يسأل عن سبب الكَون نفسه، بل يسأل عن الخصوصيات فقط.
سبقَ وأن تمّت الإجابة عن جميع هذه الاعتراضات، وكان أرسطو وثوماس من بين من قدّموا الإجابات، ولكن أقدمَ جون هيك وآخرون مُجدّدًا على تقديم إجاباتٍ عليها.
جون هيك: كما رأينا، يتعلّقُ اعتراضُ راسل الرئيسي على لايبنتس وثوماس وكوبلستون بمفهوم «واجب الوجود». كان هذا اعتراضًا مُتكرِّرًا وناجمًا عن النظرة الوضعية المنطقية إلى اللغة في القسم الأول من القرن العشرين. أكّد الاعتراض أنّه ثمّة نوعين فقط من البيانات: التحليلية، أي البيانات عن منطق اللغة، وتقارير المعطيات الحسيّة، أي البيانات عن الحقائق المتعلّقة بتجربتي أو مُلاحظتي. بما أنّه، من خلال التعريف على ما يبدو، لا يُمكن للبيانات التي تتحدّثُ عن الله أو التي تُشيرُ إليه أن تكون تقارير عن المعطيات الحسيّة، فيجب أن تكون ادّعاءات منطقية، خالية عن أيّ إشارة إلى العالَم الحقيقي. وعليه، يجب أن تُشير الادّعاءات على الوجود الواجب لله إلى نوعٍ من الوجوب المنطقيّ. وعليه، ادّعى راسل أنّه ببساطةٍ لا يرى أيَّ ادّعاءٍ ذي معنى هنا.
احتجَّ جون هيك (1922-2021)، وهو صاحب درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة أكسفورد، أنّه يوجد طريقٌ واضحٌ يُقصَد فيه من الوجود الواجب أن يكون فعليًا. في مقالةٍ رائدة -أو قُل رائدة من جديد- في «مجلة الفلسفة» تحت عنوان «الله كواجبٍ للوجود» ، بدأ هيك بهذا التمييز:
«يُمكن أن يتمّ التعبير -وقد تمّ التعبير- عن مفهومَين مُختلفَين بنحوٍ مهم من خلال عبارة «واجب الوجود». يمتلكُ «الواجب» عادةً قوة «الواجب المنطقي»، ويُنشىءُ في اللاهوت مفهومَ الموجود الذي يكونُ من المستحيل منطقيًا
(104)عدم وجوده. ولكن، وبشكلٍ أقلّ شيوعًا، يُفيدُ «الواجب» ما يُمكنُ أن نُميّزه كـ«واجب فعليًا»- والوجوب «التجريبي» و«المادي» و«السببي» هي أنواع من الوجوب الفعليّ».
واصلَ هيك بتطوير مفهوم الوجوب المنطقيّ كما يُلاحَظ من قبل عددٍ من الفلاسفة في الخمسينيات. يُظهِرُ هيك كيف اعتُبِرَ هذا معنى «الوجود الواجب» في الطريق الثالث الذي قدّمه ثوماس. لقد رأينا للتوّ أنّ هذا هو أيضًا فهمُ راسل لمبدأ دليل السبب الكافي التابع للايبنتس، وبالتالي إقدامه على دحض نموذج كوبلستون عن حجّة لايبنتس. ولكن احتجَّ هيك أنّ هذا يُعدُّ سوء فهم لكيفية استخدامهم للـ«الواجب» فيما يتعلّقُ بوجود الله. من الواضح أنّ جميعهم كانوا يقصدون أن يقولوا ما يلي: لا أنّ عدم وجود الله هو مُتناقض أو أنّه يُصبِح كذلك، بل أنّه ينبغي تمييزُ وجوده عن الموجود الممكن. إنّه وجودٌ لا يحصل صدفة ولا يُمكن أن ينتهي عن الوجود.
الأبدية هي إحدى مُكوِّنات مفهوم الشيء اللائق بعبادة الإنسان، ولكنّها ليست كافية بذاتها لأنّه من الممكن تصوُّر وجود شيءٍ أبديًا، ليس لأنّه على نحوٍ حيث لا توجد قوةٌ قادرة على إزالته ولا يُمكن أن توجد، بل فقط لأنّه، رغم وجود قوىً قادرة على إزالته، فإنّها تُحجم دائمًا عن ذلك. سيكون مثل هذا الكائن أبديًا بفضل حقيقة أنه لا يتم تدميره أبدًا، ولكن ليس من خلال الفضيلة الإيجابية أو قوة كونه غير قابل للتدمير. من المؤكّد أنّه جزءٌ لا يتجزأ في المفهوم التوحيدي لله أنّ الله، بما أنّه الربّ الأعلى للجميع، ليس قابلًا للإفناء.
يجب أن نضيف عند هذه النقطة أن الله، باعتباره الرب المطلق للجميع،
(105)