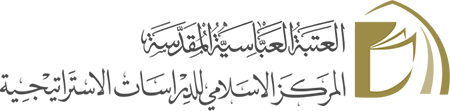
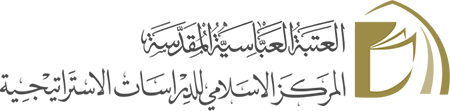
الفصل الأول: الحاجة إلى التدبير
التَّدْبير في القرآن والسنّة | 23
الفصل الثاني: استراتيجية للحياة الطيبة
استراتيجيّة للحياة الطيِّبة | 34
ثانيًا: العمل والسعي الحثيث | 37
ثالثًا: استثمارُ المالِ تمامُ المروءَةِ | 40
آياتٌ قرآنيّة مشجِّعة على الاستثمار | 42
آثار شريفة مشجِّعة على الاستثمار | 46
رابعًا: عملية الرقابة والإشراف | 49
2. الفرق بين الشورى والمشورة | 55
5. من عواقب الاستبداد بالرّأي | 60
6. اتّخاذ القرار بعد المشورة | 60
سادسًا: ضرورة الحزم في اتّخاذ القرار | 61
1. من لوازم اتّخاذ القرار الصحيح | 62
سابعًا: الأولويّة في الإنفاق | 65
ثامنًا: التّخطيط لشؤون العائلة | 71
الفصل الثالث: أكمل طرق التدبير
1. أهمّيّة الاستهلاك في مفهوم الِاقْتِصَاد | 83
2. قواعد الاستهلاك الأمثل في الإسلام | 85
أ. وجوب البعد عن الإسْراف | 85
ب. وجوب البعد عن التَّبْذِير | 91
من مصاديق الإسْراف والتَّبْذِير | 93
الفرق بين الإسْراف والتَّبْذِير | 95
من عواقب الإسْراف والتَّبْذِير | 97
ضرورة البعد عن الإفراط في التجمُّل | 103
الآثار السلبية لحياة المترفين المتجملين | 104
القَصدُ يذهب بالإسْراف والتَّقتير | 109
ح. الإنفاق في المعروف ومساعدة الفقراء | 113
استفادة الفقراء من الأغنياء | 114
3. النزعة الاستهلاكيّة المفرطة | 116
أ. من أسباب النزعة الاستهلاكيّة | 118
2. حُب الأثرياء لحياة البذخ | 120
5. الدعايات ووسائل الإعلام | 123
ب. العواقب السيئة لشره الاستهلاك | 124
ت. المعيار الأنسب في الاستهلاك | 126
ث. استهلاك الثروة وفق مصالح النظام الإسلاميّ | 129
ج. ضرورة التصدّي لشره الاستهلاك المُفرِط | 129
2. أنواع التوفير والادّخار | 134
أ. الادّخار والتوفير الممدوح | 134
ب. الادّخار والاكتناز المذموم | 138
3. الأسلوب الأمثل في حفظ المال المدّخر | 139
الفصل الرابع: نتائج حسن التدبير، وعواقب سوء التدبير
نتائج حُسن التَّدبير، وعواقب سوء التَّدبير | 142
أوّلًا: النتائج الحميدة لحُسن التَّدبير | 142
1. التنعُّم بحياةٍ مثاليّةٍ | 142
3. نمو الإنتاج وارتفاع مستوى الدخل | 146
5. ارتفاع مستوى الادّخار والاستثمار | 148
6- التنميّة الِاقْتِصَاديّة | 149
7- الحفاظ على عزة النَّفْس | 150
ثانيًا: عواقب وخيمة لسوء التَّدْبير | 152
ب. ابتلاء الإنسان بالتَّبذِيرِ | 153
التَّدبيرُ في المعيشَةِ
تأليف
عبد الله عمّار الحموي
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
(2)العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
سلسلة نمط الحياة
التَّدبيرُ في المعيشَةِ
تأليف
عبد الله عمّار الحموي
(3)
العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
الحموي، عبد الله عمار، مؤلف.
التدبير في المعيشة / عبد الله عمار الحموي. - الطبعة الأولى - النجف العراق : العتبة
العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ١٤٤٦ هـ . = ٢٠٢٥.
١٦٧ صفحة ؛ ٢١١٤ سم . - (سلسلة نمط الحياة )
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة ١٦١-١٦٧.
ردمك : ٩٧٨٩٩٢٢٦٨٠٤٨٤
1 . التدبير المنزلي. أ. العنوان.
LCC: TX321 H36 2025
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة فهرسة اثناء النشر
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (۱۲۹۹) لسنة (٢٠٢٤م)
الكتاب: التدبير في المعيشة
تأليف: عبد الله عمار الحموي
الناشر : العتبة العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية.
الطبعة: الأولى ٢٠٢٥م - ١٤٤٦هـ.
Website: www.iicss.iq
E-Mail: islamic.css@gmail.com
Telegram: @iicss
(4)
التَّدبيرُ في المعيشَةِ 3
مقدّمة المركز11
مقدّمة المؤلّف14
الفصل الأول: الحاجة إلى التدبير
الحاجة إلى التَّدْبير18
من آثار حُسن التَّدْبير 20
من عواقب سوء التَّدْبير 21
مفهوما التدبير والمعيشة 22
التَّدْبير في القرآن والسنّة23
الفصل الثاني: استراتيجية للحياة الطيبة
استراتيجيّة للحياة الطيِّبة 34
أوّلًا: نَظْم الأمْرِ 34
ثانيًا: العمل والسعي الحثيث37
ثالثًا: استثمارُ المالِ تمامُ المروءَةِ 40
آياتٌ قرآنيّة مشجِّعة على الاستثمار42
آثار شريفة مشجِّعة على الاستثمار46
فوائد من نتاج الاستثمار 47
رابعًا: عملية الرقابة والإشراف 49
الرقابة على الإنفاق 52
خامسًا: المشورة في الأمر 53
1. حد المشورة55
2. الفرق بين الشورى والمشورة 55
3. المشورة في العائلة56
4. من فوائد المشورة 57
5. من عواقب الاستبداد بالرّأي 60
6. اتّخاذ القرار بعد المشورة 60
سادسًا: ضرورة الحزم في اتّخاذ القرار61
1. من لوازم اتّخاذ القرار الصحيح 62
2. أنواع القرارات 64
سابعًا: الأولويّة في الإنفاق 65
1- أقسام الإنفاق 67
2- عملية تدوين النفقات68
ثامنًا: التّخطيط لشؤون العائلة 71
أقسام التّخطيط 72
الفصل الثالث: أكمل طرق التدبير
أكمل طرق التّدبير 76
أوّلًا: الدخل 76
مصادر الدخل 77
أ. تعيين حدّ للدخل 77
التحديد النوعي للدخل 78
أقسام الدخل80
من وسائل رفع مستوى الدخل 81
ثانيًا: الاستهلاك 83
1. أهمّيّة الاستهلاك في مفهوم الِاقْتِصَاد 83
2. قواعد الاستهلاك الأمثل في الإسلام 85
أ. وجوب البعد عن الإسْراف 85
من أسباب حرمة الإسْراف 86
معيار حقيقة الإسْراف87
نسبيّة الإنفاق 89
ب. وجوب البعد عن التَّبْذِير91
من مصاديق الإسْراف والتَّبْذِير93
الفرق بين الإسْراف والتَّبْذِير 95
من عواقب الإسْراف والتَّبْذِير 97
النهي عن اتّباع المسرفين 99
ت. ذمّ البخل والتقتير 101
ضرورة البعد عن الإفراط في التجمُّل103
الآثار السلبية لحياة المترفين المتجملين 104
ث. وجوب مراعاة الاعتدال 107
القَصدُ يذهب بالإسْراف والتَّقتير 109
ج. ساحة القناعة 111
ح. الإنفاق في المعروف ومساعدة الفقراء 113
استفادة الفقراء من الأغنياء 114
3. النزعة الاستهلاكيّة المفرطة 116
أ. من أسباب النزعة الاستهلاكيّة 118
1. حُبّ التنافس119
2. حُب الأثرياء لحياة البذخ 120
3. الآفات الثقافيّة121
4. النظام التعليميّ 122
5. الدعايات ووسائل الإعلام 123
ب. العواقب السيئة لشره الاستهلاك 124
ت. المعيار الأنسب في الاستهلاك 126
ث. استهلاك الثروة وفق مصالح النظام الإسلاميّ 129
ج. ضرورة التصدّي لشره الاستهلاك المُفرِط129
ثالثًا: الادّخار 131
1. أهمّيّة الادّخار132
2. أنواع التوفير والادّخار134
أ. الادّخار والتوفير الممدوح 134
التدبير وخدمة المجتمع 136
ب. الادّخار والاكتناز المذموم138
3. الأسلوب الأمثل في حفظ المال المدّخر 139
الفصل الرابع: نتائج حسن التدبير، وعواقب سوء التدبير
نتائج حُسن التَّدبير، وعواقب سوء التَّدبير 142
أوّلًا: النتائج الحميدة لحُسن التَّدبير 142
(9)
1. التنعُّم بحياةٍ مثاليّةٍ 142
2. العائلة الصغيرة 146
3. نمو الإنتاج وارتفاع مستوى الدخل 146
4. الأمان من النّدم 148
5. ارتفاع مستوى الادّخار والاستثمار148
6- التنميّة الِاقْتِصَاديّة 149
7- الحفاظ على عزة النَّفْس150
ثانيًا: عواقب وخيمة لسوء التَّدْبير152
أ. الفقر والحرمان 152
ب. ابتلاء الإنسان بالتَّبذِيرِ 153
ثالثًا: التبعيّة للغير 155
أ. هدر الطاقات الفرديّة والاجتماعيّة 156
ب. الشعور بالنقص156
ت. مسخ الثقافة الوطنيّة157
ث. العبوديّة157
ج. إهدار المال 158
لائحة المصادر والمراجع161
الحمد للّه ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّدصلىاللهعليهوآله وآله الطاهرين عليهمالسلام ، وبعد...
الحياة الطيِّبة هي الوضعيّة المنشودة لحياة البشر؛ في الأبعاد الإيمانيّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والجهاديّة، والجسميّة، والبيئيّة، والجماليّة، والعلميّة، والإداريّة. ووفقًا لرؤيتنا الإسلاميّة لا مجال لفصل الحياة الطيِّبة بأبعادها ومراتبها كافّة عن الإيمان والعمل الصالح الوارد في عدّة آيات في القرآن الكريم على نحو التلازم، قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل: 97). فالإحياء هنا بمعنى إلقاء الحياة في الشيء وإفاضتها عليه، وفيها دلالة على أنّ الله سبحانه يكرّم المؤمن الذي يعمل صالحًا بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامّة، وما في الآية من طيب الحياة يلازم طيب أثرها وهو القدرة والشعور المتفرّع عليهما الأعمال الصالحة.
إذًا «الحياة الطيِّبة» في هذه الدنيا هي النتاج الطبيعي
(11)للعمل الصالح النابع من الإِيمان، أيْ أنّ المجتمع البشري سيعيش حينها حياةً هادئةً مطمئنةً ملؤها الرفاه والسلم والمحبّة والتعاون، وفي أمان من الآلام الناتجة عن الإِستكبار والظلم والطغيان وعبادة الأهواء والأنانية التي تملأ الدنيا ظلامًا وظلامات.
وتتأكّد أهمية التربية على نمط الحياة الإسلاميّة بسعة التشريعات والقيم الإسلاميّة، لهذا فهي إضافة للتربية على البعد الإيماني التربوي، حيث العمل على تربية شخصيّة الإنسان وبناؤه في الجوانب العقائديّة والإيمانيّة والعباديّة والروحيّة، تبرز الأهميّة للتربية في البعدين السلوكي الفردي والاجتماعي، حيث التربية على الحياة الأسريّة والاجتماعيّة الإسلاميّة، ويتحمّل المسؤوليّة المجتمعيّة في ضوئها. وفي التربية على ثقافة التدبير المعيشي، واتقان العمل، والسعي للكسب الحلال...، وأصول وقيم التعامل مع سائر النعم والمخلوقات. بل والتصرّف في الأرض وخيراتها وفق إرادة الله تعالى، باعتبارها أمانة إلهيّة لخدمة الإنسان ورقيّه ورفاهيّته وتحقيق كماله على ضوء الإرادة الإلهيّة.
ختامًا لا شك بأنّ التزام الإنسان نمط الحياة الإسلاميّة، ومراعاته لقواعد وأصول الحياة الطيِّبة يكفلان له أعلى درجات السعادة والإطمئنان في حياته الدنيويّة، والفوز برضا الله وجزاءه الحسن في حياته الأخروية.
هذا الكتاب «التدبير في المعيشة» يعالج أحد أهم القضايا الثقافيّة ذات البعد التربوي والاجتماعي، وهي قضيّة التَّدبير في المعيشَة، ويقدّمها كعمل استراتيجي مطلوب ليصدق على حياتنا التي نحياها أنّها حياة طيبة، ولذا يفصّل الكلام في «البرامج العامّة التي يجب اتّباعها، لتسخير شتّى الأمور السياسيّة، والِاقْتِصَاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، والعسكريّة...، وغيرها، من أجل تحقيق أهدافٍ معيّنةٍ ترتبط بأهدافنا الفردية والاجتماعيّة في الحياة، وذلك بالاستناد على تراثنا الإسلامي الغني بأصوله وقواعده وتطبيقاته. حتى رُوي أنّ رجلًا قال للإمام الصادق عليهالسلام: بلغني أنّ الِاقْتِصَاد والتَّدْبير في المعيشَة نصف الكَسْب! فقال عليهالسلام: «لا، بَل هُو الكسبُ كلُّهُ، ومِن الدِّينِ التَّدبيرُ في المعيشَةِ».
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة
والحمد للّه ربّ العالمين
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيّدنا ومولانا رسول الله محمّد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد...
قال الله العظيم في كتابه الكريم: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (يونس: 3).
من تدبّر هذه الآية المباركة سيجد أنَّ الباري سبحانه قد وصف ذاته بالمدبّر، وذّكَرَ تعالى اسمه (المُدبر) في كتابه المجيد أربع مرات، حيث جاء بلفظ (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ)، فالتَّدْبير من الأفعال التي نسبها الله إلى ذاته العليّة، وحثّ عباده على التحلّي بصفة التَّدْبير، كونها من الصفات الربانيّة، وجاء في فرقانه الحكيم: ﴿كُونُوا رَبّانِيِّينَ﴾ (آل عمران: 79)، وكل متعاهد للقرآن الكريم بالقراءة والحفظ يعلم كثرة آياته التي شجعت الإنسان على التَّدبّر في عظمة خلق الله تعالى، وطلبت منه أن يكون مسترشدًا بهدي فِطرَته التي فَطَرهُ الله عليها، كي يستلهم من تَّدْبير خالقه الطريقةَ المثلى لتَّدْبير شؤون حياته، وباستقراء قصص الأنبِيّاء الواردة في الذكر الحكيم نجد أنَّه قد صوّر واقع التَّدْبير في حياتهم بأحسن تصوير، ولا سيّما تَّدْبير النَّبِيّ يوسف عليهالسلام الذي جُعل أمينًا على خزائن مصر، فاستطاع تخليص أهلها من المجاعة والفقر
والمشاكل، بحُسن تَّدْبيره، وتخطيطه الصحيح، حينما حلّ بهم الجدب والقحط.
ومعلوم على مرّ العصور أنَّ الحياة الجماعيّة لسائر المجتمعات البشريّة، قد شهدت ما يشوبها من تضارب في المصالح، وخيّمت عليها الحروب، أو سادها السلام وروح التعاون في بعض الفترات. وفي خضمّ هذه الأوضاع، نجد أنّ العقل السليم يحكُم بضرورة التَّدْبير في شؤون الحياة؛ والتفكّر في عواقب الأمور، يوصل إلى التسليم بأنَّ حُسن التَّدْبير ضرورة حياتية ملحّة، ومنهج مبارك على الناس أن تنتهجه، لترشيد أفكارهم وأعمالهم، كي يتسنّى لهم التمتّع بحياةٍ طيّبةٍ، فالتَّدْبير ذا تأثيرٍ مباشرٍ على كافّةً مجالات الحياة، ولا يختصّ بالمأكل والمشرب فقط، لأنّ تأثيره مشهودٌ على ثقافة الإنسان وميادين حياته، الاجتماعيّة، والسياسيّة، والِاقْتِصَاديّة.
وقد أكّد خَاتَم النَّبِيِّين صلىاللهعليهوآله وأئمة العترة الطاهرةعليهمالسلام على وجوب اتّباع منهج التَّدْبير الصّحيح في المعيشَة، فالإسلام وضع برامج شاملةً لجوانب الحياة كافّةً، والصّلة فيهِ بين الدنيا والآخرة وثيقةٌ، لذلك لا يمكن إهمال القضايا التي تعدّ ضروريّةً لاستمرار الحياة في الدنيا، ومقدّمةً للحياة الأخرويّة.
ولو تَّدْبرنا في الأحاديث الشريفة التي رويت عن الأطهار
الذينَ أذْهِبَ اللَّهُ عَنْهمُ الرِّجْسَ سوف لا نجد أيّ تعارضٍ بين انهماك العبد في شؤون حياته، وتوفير سُبُل مَعِيشَتَه من خلال الكَسْب والإنتاج، وبين العبادة والذِّكْر والعَمَل للحياة الآخرة. وهذه الرؤية هي المُتبنَّاة في هذا الكتاب، والآراء المطروحة فيه مستوحاة من النصوص الدينيّة حيث تمّ الرجوع فيه إلى عدةٍ من تفاسيرِ القرآنِ الكريمِ، والمصادرِ الإسلاميّة التي يمكن الاستفادة منها في موضوع حُسن التَّدْبير.
المؤلّف
(16)لا يختلف اثنان في أنّ تَّدْبير شؤون الحياة يُعدّ من الأمور الهامّة لكلّ إنسانٍ، فتنظيم شؤون الحياة حسب تعاليم ديننا الإسلاميّ التي وردتنا عن طريق الوحي المقدّس، من شأنه أن يفتح لنا باب السّعادة على مصراعيه. والمجتمعات البشريّة اليوم كما هي بحاجةٍ للاستعانة بما أنعمَ الله عليها من قوى إدراكيّة، فإنها أيضًا بحاجةٍ ماسّةٍ إلى التّعاليم الدينيّة، والعَمَل بالوصايا المُطَابِقَة للفِطرَة التي فَطَرَ الله النّاسَ عليها.
وممّا لا شكّ فيه أنّ انخفاض مستوى الدّخل العامّ، والغلاء الفاحش، وعدم مراعاة الاعتدال في شؤون المعيشَة، مضافًا إلى التحلّل الخُلُقي للفرد والمجتمع الناشئ من الجهل بفنّ تَّدْبير المعيشَة طبق المعايير الإسلاميّة، وعدم الانسجام بين أعضاء الأسرة الواحدة، كلّها أُمورٌ تقتضي البحث والتدقيق في النصوص الدينيّة المُبيّنة لأُسس التَّدْبير، الكفيلة باستثمار نِعَم الله في هذه الحياة الدنيا خير استثمارٍ في رحاب العَمَل بتعاليم الشّريعة المقدّسة، تمهيدًا لتحقيق هدفنا السامي الذي نطمح إليه، ألا وهو: التوفيق بأن يؤتنا الله في الدُّنيا حَسنةً، وأن ننال نعيم الآخرة الدائم.
وحسب اعتقادنا، فإنّ الشريعة الإسلاميّة تكفّلت بوضع برنامج
(18)شامل ومتكامل يهدي الإنسان إلى السعادة المنشودة في الدّنيا والآخرة، لأنّها تتناول جميع جوانب الحياة المادّيّة والمعنويّة، للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، وقد أولى القرآن الكريم مفهوم التَّدْبير أهمّيّةً بالغةً، حيث زخر بمضامين تؤكّد هذه الأهمّيّة في إطار مفرداتٍ عديدةٍ، مثل (مدبّر) و(تَّدْبير) وما شابههما، والتي توحي لنا المعنى المراد اليوم من كلمة (الإدارة) السائدة بين الناس، وتشمل مفاهيم البرمجة والتّخطيط، والتّنظيم والانسجام، والتّوجيه الصحيح، الكامنة في مبدأ تَّدْبير الأمور. ولا شكّ في أنَّ الإنسان لا يمكنه أن يرجو خيرًا من أفعاله دون تحقّق هذه الأمور.
ومن الطبيعيّ أنَّ الإنسان في بادئ الأمر بحاجةٍ ماسّةٍ إلى معرفة دّين الله، وإدراك مفاهيمه، فالذي لا دين له لا حياة له. ومن هنا، ينبغي على المرء المثابرة، لتنظيم شؤون مَعِيشَتَه، بحُسن التَّقدِير، ثمّ بعد ذلك لا بدّ له من الصبر وتحمّل المصاعب التي تعترض طريقه. وقد أكّدَ إمام المسلمين جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام على هذه الحقيقة، بقوله: «لا يَصلُحُ المؤمنُ إلا على ثَلاثِ خِصالٍ: التَّفقُّهِ في الدِّينِ، وحُسنِ التَّقديرِ في المعيشَةِ، والصَّبرِ على النّائبَةِ».
إذًا، تَّدْبير شؤون الحياة لا بدّ وأن يكون متزامنًا مع أمرين هامّين، هما: تحصيل البصيرة في المعارف الدينية، والصبر على المصيبات الواردة.
كما أنّ هناك أمرين يُعدّان جوهر المعيشَة وأساسها، وهما: الاعتدال، بمعنى: عدم الإسْراف، واجتناب تبديد الجهود، وإهدار الثّروة؛ والتَّدْبير الذي يقوم به الإنسان، يُراد منه: التّفكير في عواقب الأمور، وحُسن التخطيط، والإدارة الصحيحة. وقد روي أنّ رجلًا قال للإمام الصادق عليهالسلام: بلغني أنّ الِاقْتِصَاد والتَّدْبير في المعيشَة نصف الكَسْب! فقال عليهالسلام:: «لا، بَل هُو الكسبُ كلُّهُ، ومِن الدِّينِ التَّدبيرُ في المعيشَةِ».
أكّد الإمام أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام: على وجوب اتّصاف المؤمنين برؤيةٍ مستقبليّةٍ تَّدْبيريّة، حين قال: «المؤمِنُونَ هُم الَّذينَ عَرَفُوا ما أمامَهُمْ».
فلحُسن التَّدْبير تأثيرٌ كبيرٌ على رقيّ شخصيّة الإنسان، من خلال ما يمدّه من نفاذ بصيرة في شؤون الحياة كافّة، ويمكّنه من تحقيق أهمّ متطلّبات حياته في مختلف المجالات، مثل:
استثمار الثروة بطريقةٍ مُثلى.
1- اجتناب الإسْراف في النعمة أو إتلافها.
2- عدم الاضطرار إلى تكرار عملٍ ما.
3- المكانة الرفيعة في المجتمع.
4- الثقة بالنَّفْس.
5- صحّة التعامل الماليّ مع الآخرين.
6- سلامة النَّفْس، والعزّة، وراحة البال.
إنَّ لسوء التَّدْبير عواقب وخيمة على حياة الإنسان، قد تؤدّي إلى هلاكه وسقوطه، منها:
1. عدم الاستقرار والضَّياع.
2. التبعيّة الفكريّة والِاقْتِصَاديّة.
3. الفقر والحرمان.
4. الفساد الخُلُقيّ.
5. الذِلّة والوضاعة الاجتماعيّة.
6. تسلّط الآخرين.
7. التخلّف الفكريّ والرجعيّة.
8. فقدان النعمة.
9. الاختلاف بين أعضاء العائلة الواحدة وتهديد كيانها.
وإذا أمعنّا النظر في النتائج الحميدة لحُسن التَّدْبير، والعواقب القبيحة لسوء التَّدْبير، أدركنا مدى أهمّيّة حُسن التَّدْبير ووجوب اتّخاذه منهجًا في حياتنا. وتتأكّد هذه الأهمّيّة عندما نأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور التي لها تأثيرٌ مباشر على حياة البشر، مثل: الدخل المحدود أو المتدنّي لبعض أبناء المجتمع، وارتفاع مستوى التضخّم المالي، والغلاء الفاحش، والصعوبة في توفير مستلزمات العيش، والإفراط أو التفريط في بعض الأمور، إضافةً إلى وجوب مراعاة الأصول الخُلقيّة، والسلوكيّة، والِاقْتِصَاديّة، والثقافيّة في جوانب الحياة كافّة.
يرتكز موضوع هذا الكتاب على اثنين من المفاهيم الأساسيّة، وهما:
التَّدْبير، والمعيشَة. لذا، فمن الأجدر أن ينال هذين المفهومين قسطًا أكبر من الشرح والتحليل، ولا بدّ من بيان معانيهما العامّة، لغويًّا واصطلاحيًّا، ومداليلهما الخاصَّة في الآيات والروايات. وأحيانًا ينفرج البحث، ليشمل عناوين فرعيّةً أخرى، حيث يتمّ توضيحها بإيجازٍ. وفي ما يلي بيانٌ لهذين المفهومين:
(22)التَّدْبير الذي يقوم به الإنسان، هو: التفكير بعاقبة الأمور، وإمعان النظر، والتحسّب لما سيكون. وأن يُدبِّر الإنسان أمره، هو: أن ينظر إلى ما تَؤول إليه عاقبته وآخرته. والتَّدَبُّر: التفكر في الأمر، وهذا التَّدَبُّر إنما يُثيرُ في الإنسان قلبًا حيًّا يقظًا، وعقلًا منفتحًا مستجيبًا، وإحساسًا دقيقًا مرهفًا. وبهذا الاستعداد يتمكن الإنسان أن يُحسن التَّدَبُّر الدنيويّ والدينيّ.
وبعبارةٍ أخرى: من أحسن التفكر والتَّدَبُّر أحسن التَّدبير، فالتَّدبير هو الإتيان بالشيء عُقيب الشيء، ويُراد به: ترتيب الأشياء المتعدّدة المختلفة، ونظمها، بوضع كلّ شيءٍ في موضعه الخاصّ به، بحيث يلحق بكلٍّ منها ما يُقصَد به من الغرض والفائدة، ولا يختلّ الحال بتلاشي الأصل وتفاسد الأجزاء وتزاحمها.
أشار القرآن الكريم إلى أنَّ التَّدْبير صفةٌ من صفات الله
تعالى وملائكته، والتَّدْبير الإلهيّ للعالم، هو: نَظْم أجزائه نَظْمًا جيّدًا مُتقنًا، بحيث يتوجّه فيه كلّ شيءٍ إلى غايته المقصودة منه، وهي آخر ما يمكن أن يحصل له من الكمال الخاصّ به، ومنتهى ما ينساق إليه من الأجل المسمّى. وتَّدبير الكلّ يعني إجراء النظام العامّ العالميّ، بحيث يتوجّه إلى غايته الكلّيّة، وهي: الرجوع إلى الله سبحانه والقرب منه.
والباري سبحانه متعالٍ عن التَّدْبير الذي هو التفكّر والتقدير، فإنّه لا يتصوّر إلّا في حقّ من جهل شيئًا فأراد أن يستعمل فكرة في تحصيل العلم به، والجهل على الله محال، فالتَّدْبير بمعنى الفكر عليه محال، ويتعالى عن ذلك الخالق القدير المنزه عن خواطر النفس وهواجس الضمير، وإنما ينبأ عن تَّدْبيره الساري في الأكوان قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: 40).
ولك أن تتفكر في عظم قدرة الله تعالى، وسعة حكمته، وكمال عنايته وإتقانه، وحسن تدبيره وتنظيمه، فالكون بما فيه من المخلوقات لأوضح دلالة على هذا كله، وقد ظهر للعقل والحس أنَّ هناك مدبرًا عظيمًا وخالقًا حكيمًا من وراء هذا التدبير والعناية والإتقان.
يشير الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي إلى هذا الموضوع
بقوله: «إنَّ الظاهرات للحواس -أظهر الله لك الخفيات- لأوضح الدلالة على تدبير مُدبر أول .أعني مُدبرًا لكل مُدبر، وفاعلًا لكل فاعل، ومكونًا لكل مكون، وأَوّل لكل أَوَّل».
وأفلاطون مثلًا يبين أنَّ النظام في العالم لا يمكن أن يكون نتيجة للمصادفة، فالعالم من خلق مُدبر رتَّب كل شيء عن قصد، وليس عن المصادفة والاتفاق كما أنَّ فلاسفة العصر الوسيط اعتمدوا دليل الغائية والنظام في إثبات وجود الخالق.
وجملة من الفلاسفة اعتمدوا دليل الغائية والعناية حيث أنَّه من الأدلة القوية في إثبات وجود الخالق عز وجل. فالكون كما لاحظه أصحاب الدليل لم يخلقه الله تعالى مصادفة واتفاقًا، إنَّ الله تعالى أودع الكون سننه التي يسير عليها، وجميع المخلوقات تسير وفق نظام متكامل لا مجال فيه للفوضى أو الاضطراب، ولا مجال فيه للعبث أو الاتفاق، فالإتقان الكامل، والعناية الشاملة لكل الموجودات تشهدان أن لهذا الكون خالقًا ومدبرًا حكيمًا، نَظَّم الكون وربط بين أجزائه المختلفة بحيث يكمل بعضها بعضًا، وقَدَّر الخالق عز وجل كل شيء في هذا الكون تقديرًا، فالله يُدبّر الأمرَ، أي يُقدّر، «ويُنْفِذُه على وجهه، ويرتّبه على مراتبه على أحكام عواقبه»، وهذا التَّدْبير يشمل الهداية التكوينيّة والتشريعيّة للمخلوقات،
وهاتين الهدايتين تتحقّقان عبر بعثة الأنبِيّاء والرسل عليهمالسلام.
أمّا تَّدْبير الملائكة، في قوله تعالى: ﴿فَالمْـُدَبِّراتِ أَمْرًا﴾ (النازعات: 5)، ففيها أقوالٌ -أيضًا-، أحدها: أنَّ الملائكة تُدبّرُ أمرَ العبادِ مِن السَّنَةِ إلى السَّنَة كما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام. وقد أُسند إليهم التَّدْبير كإسناد التقسيم والنزع، والنشط، والزجر، كما في قوله: ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ (الذاريات: 4)، وقوله: ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ (الصافات: 2-3).
وقال تعالى في حق الملائكة: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (الأنبياء: 26)، وقال في شأن الأمين جبريل وغيره من الملائكة ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (مريم: 64)، وأحد وجوه المراد بهذه المحكمات أنَّ تسخير الملائكة، وتَّدْبيرها، وإرسالها هو دليل من أدلة إلهيته تعالى، واستحقاقه لأن يعبد وحده لا شريك له.
وأما بالنسبة للبشر، فالتَّدْبير دائمًا ما يكون متناغمًا مع العلم، والخبرة، والمعرفة، والعقل، فهو بطبيعته بعيدٌ عن العَمَل من دون تفكر وتعقّلٍ. وقد رويَ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قول في التَّدْبير مثّلَهُ كالمصباح المنير، وذلك عندما خاطب صاحبه عبد الله، قائلًا: «يا ابن مسعود، إذا عملتَ عمَلًا فاعملْ بعلمٍ وعقلٍ، وإيّاكَ وأنْ
تعملَ عملًا بغيرِ تدبّرٍ وعلمٍ، فإنّه جلَّ جلالهُ يقولُ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ (النحل» 92).
ويمكن القول: إنّ التَّدْبير والتحسّب لعواقب الأمور، والتخطيط الصحيح، ونظم شؤون الحياة، تعدُّ الأركان الأساسيّة للرقيّ، وبلوغ الكمال، وقد قال حفيد الرسالة الإمام محمد بن علي الباقرعليهالسلام: «الكَمالُ كُلُّ الكَمالِ: التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، وَالصَّبرُ عَلَى النّائبَةِ، وَتَقديرُ المعيشةِ». فمن خلال حُسن التَّدْبير واتّباع التَّقدِير الصحيح في الأمور الِاقْتِصَاديّة، يمكن الوصول إلى الكمال المنشود.
ولا ريب في أنّ تَّدْبير الإنسان، في استثمار ما لديه من إمكانيّاتٍ اقْتِصَاديّةٍ محدودةٍ، واجتناب الإسْراف في تسخيرها، يُعدّ أفضل من حيازته إمكانيّاتٍ ِاقْتِصَاديّةً كبيرةً يُسرف في استثمارها، فينبغي للعبد أن يكون على صوابٍ من التَّقدِير، وحكمةٍ من التَّدْبير، فالتَّدْبير سببٌ في قوّة اقتصاد الحياة ورقيّه، وقد أجاب الإمام جعفر الصادق عليهالسلام على سؤال رجل سأله قائلًا: بلغني
أنَّ الاقْتِصَاد والتَّدْبير في المعيشَة نصف الكَسْب، فقال عليهالسلام: «لا، بَلْ هُو الكَسْبُ كُلُّهُ».
وأكّد الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام على أنَّ التَّدْبير سبيلٌ للنماء والرقيّ الاقْتِصَاديّ، حين قال: «حُسنُ التَّدبيرِ يُنمِي قليلَ المالِ».
من هنا، كان المسؤول اللائق بإدارة شؤون العائلة أو شؤون فئةٍ اجتماعيّةٍ ما، هو الذي يتمكّن من تمهيد الأرضيّة اللازمة، لاستثمار القابليّات والإمكانيّات أفضل استثمارٍ، وذلك عبر تخطيطٍ صحيحٍ، ومنهجيّةٍ مثاليّةٍ، وتنسيقٍ بين كافّة الأعضاء، على مختلف مستوياتهم ومسؤوليّاتهم. كما لا بدّ له من نَظم نشاطاته وفعّاليّاته، ووضع كلّ شيءٍ في موضعه، وتأدية ما عليه من تكاليف في وقتها المناسب، حتى يستحق بذلك صِفة المُدبِّر.
ويُعدّ تَّدْبير شؤون الحياة بطبيعته جزءًا من الدين، لذا، فإنّ حُسن التَّدْبير كان صفة لازمة للمؤمنين بحيث يمتازون بها عن غيرهم، لأنّهم لا يستهلكون أموالهم عبثًا، ولا يبذّرونها، بل يراعون الاعتدال في إنفاقها، ويخشون فيها غضب الله تعالى، في ما لو أفرطوا أو فرّطوا في إنفاقها، بخروجهم عن الحدود التي أجازها الله تعالى لهم في الإنفاق.
في الأطر المعيشيّة المحدودة يجدر بالإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب النوعيّة لمؤونته التي يقتنيها، ومدى كفاية المصادر الإنتاجيّة والخدماتيّة التي يعتمد عليها في معيشته، أي عليه أن يسخّر كلّ مصدرٍ إنتاجيٍّ أو خدماتي بطريقةٍ يمكنه معها بلوغ أقصى درجات الاستثمار، فإننا في زمن من الجيد فيه أن يدرك الإنسان أنه كم أساء إلى نفسه وحياته وسلامته؛ جراء اعتماده نمط الحياة المادية القائمة على الاستهلاك الشره، دون النظر إلى عواقب ذلك، ودون التفكر في أنَّ من واجبه، وحفظًا لبقائه آمنا؛ أن يغيّر طريقة عيشه وسلوكه، وأن يعمل على معالجة كل ما يتسبب بوقوعه في شراك الحاجة، التي قد ينصبها هذا الزمن الصعب. فمن المهم أن يسعى لإصلاح مصادر الكسب، فهذا من الأمور الضرورية في مجال المعيشة. ويتوجب عليه أن يبادر الآن إلى اعتماد مبدأ حسن التدبير، فنحن في ضائقةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ قد زادت مع انتشار هذا الوباء المستجد، وقد تزداد قسوةً في قادم الأيام، فالفرد الذي يفقد حسن التدبير والتخطيط الصحيح في برامجه المعيشيّة سوف يُحرَم من الخير. روي عن الإمام عليٌّ عليهالسلام أنه قال: «لا خَيرَ فِي دُنيا لا تَدبِيرَ فِيها».
البيت وتجميله. وكذلك يُقال: دبَّرَ أمر البيت، أي نظَّمَ أموره، والتصرّفات العائدة إليه، بما يؤدّي إلى صلاح شأنه، وتمتّع أهله بالمطلوب من فوائده.
ولأنَّ الأسرة هي البناء الأقدس، والميدان التأسيسي الأهم والأثمن، فإنَّ المحافظة على أمنها الاقتصادي والاجتماعي ضرورة لا بد منها، واعتماد منهج حُسن التَّدبير في كل ما يخص معيشَتها أجدر وأولى، وبطبيعة الحال فكلما كان الشيء أثمن وأغلى، وأنفع وأعظم وأعلى، كان التَّدْبير لحفظهِ وحمايتهِ أشدُ وأمتنُ وأكثر، وأدقُ وأحكمُ وأوفر.
جهّز الباري سبحانه وتعالى الأرض بكلّ مقوّمات الحياة لتُصبح بيتًا آمنًا للإنسان، وتفي بكلّ متطلّبات المعيشَة، وكلمة (المعيشَة): مشتقّةٌ من مادّة (عَيَشَ)، وهي تعني: الحياة، وتستعمل لذوات الأرواح فقط. وهذه الكلمة أخصّ من كلمة (الحياة)، لأنّ تعبير الحياة يمكن إطلاقه على البارئ عزَّ وَجَلَّ، وعلى الملائكة، بينما تختصّ كلمة العيش بحياة الإنسان والحيوان فحسب.
و(معايش) جمع (معيشة)، وهي: عبارة عن الوسائل
والمستلزمات التي تتطلّبها حياة الإنسان، بحيث يحصل عليها بالسعي تارةً، أو تأتيه بنفسها من دون سعي تارةً أُخرى. ومع أنّ بعض المفسّرين حصر كلمة (معايش) بالزراعة والنبات، أو الأكل والشرب فقط، ولكنّ مفهومها اللغويّ أوسع من أن يُخصّص، ويُطلق ليشمل كلّ ما يرتبط بالحياة من وسائل العيش.
وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ (الحجر: 20)، فـ(المعاش) في هذه الآية: يحتمل أن يكون اسم زمانٍ أو اسم مكانٍ، بمعنى زمان أو مكان الحياة، ويمكن أن يكون مصدرًا ميميًا، فيكون له محذوفٌ، والتَّقدِير: (سببًا لمعاشكم).
ويُذكر أنَّ مشتقّات كلمة (عيش) تكرّرت ثماني مرّاتٍ في القرآن الكريم، كما أنّ الأحاديث والراويات الشريفة تطرّقت إليها بكثرةٍ. وبالطبع، فإنّ رؤية القرآن الكريم والسنّة المباركة لمعنى هذه الكلمة لا تنحصر في كَسْب المال وبذله، بل نجد فيها تحفيزًا لربّ العائلة إلى السعيّ في توفير حياةٍ هنيئةٍ لأفراد أسرته، على جميع المستويات المادّيّة. روى أهل البيت عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنه قال: «مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنْ طَلَبِ الْمَعِيشَةِ خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ، وَرَخَى بَالُهُ، وَنَعِمَ عِيَالُهُ».
لا ريب أنَّ حُسن التَّدبير في المعيشَة يعتبر عمل استراتيجي مطلوب ليصدق على حياتنا التي نحياها أنها حياة طيبة، والاستراتيجيّة بمعناها الشامل، تعني: «البرامج العامّة التي يجب اتّباعها، لتسخير شتى الموارد، من أجل تحقيق أهدافٍ معيّنةٍ ترتبط بتدبير شؤون الحياة على مستوى الأفراد والأسرة والمجتمع.
والاستراتيجيّة في المعيشَة، تعني اتّباع برامج محدّدةٍ، لاستثمار المصادر المُتاحة خير استثمارٍ، بغية التمكّن من تحقيق الأهداف المعيشيّة البعيدة الأمد والقريبة الأمد بشكلٍ أمثل.
أمّا استراتيجيّات تَّدْبير المعيشَة، فهي: عبارةٌ عن البرامج التي من خلالها تتحقّق الطمأنينة، والضمان الِاقْتِصَاديّ، وزوال مشاكل المعيشَة، وهذا لا يحصل إلا في ظلّ إدارةٍ رصينةٍ، ونشير في ما يلي إلى أهمّ هذه الاستراتيجيّات:
إنَّ الإخلال والإنفلات بلاء عظيم حذّر منه الإسلام وأمر
(34)بخلافه، وما أكثر الآيات والروايات التي جاءت في هذا الشأن، وبالنسبة لموضوع كتابنا هذا، فلا شكّ في أنَّ النَظْم والانضباط يُعدَّان من أهمّ استراتيجيّات التَّدْبير في المعيشَة. وهذه الاستراتيجيّة تعني: «ترتيب مناهج الحياة وتنظيمها»، بحيث يُؤدَّى كلُّ عملٍ في الزمان والمكان المناسبين، على أن لا يمنع هذا الأداء عملًا آخر أو يزاحمه.
فالمدير والمدبّر الكفء: هو الذي يراعي النظم والانضباط في عمله، ولا يُوكِل عمل اليوم إلى غدٍ، لأنّ الإنسان المتديّن يؤمن بأنّ كلّ وقتٍ يتطلّب عملًا خاصًا به. وقد أكّد الإمام عليّ عليهالسلام على هذا الأمر بقوله: «فِي كُلِّ وَقْتٍ عَمَلٌ»، فالإنسان -بالتالي- مسؤولٌ عن كلّ لحظةٍ في حياته، وفي هذا الشأن قال رَسُولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله : «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ».
إذًا، يُعتبر -وفق هذه التعاليم الحكيمة- التماهل في أداء عمل اليوم، وإيكاله إلى وقتٍ لاحقٍ، من الأخطاء التي لا يمكن تداركها. وبالطبع، فإنّ رواج هذه الظاهرة في المجتمع، سيؤدّي إلى انحطاطه وانهياره، لأنّ يوم غدٍ لا يأتي إلا في الغد.
ولا شكّ في أنّ نَظمَ المدير وانضباطه يوجبان عليه أن يُدبّر الأمور بطريقةٍ صحيحةٍ يمكنه معها الوفاء بالتزاماته في أوقاتها المحدّدة، من دون أن يخلف وعدًا في أيّ عملٍ من أعماله. وبالتالي فهو سيحظى بمكانةٍ مرموقةٍ، وسيحفظ المؤسّسة التي يديرها، ويبقى عزيزًا بين النّاس ومحترمًا. وكذلك، فإنّ النشاطات التي يمارسها الإنسان لتوفير مَعِيشَتَه، والخدمات التي يقدّمها لمجتمعه، وتوزيع الأعمال بين أفراد الأسرة الواحدة، كلّها أمورٌ تنطوي تحت مبدأي النظم والانضباط، كما كان يفعل أئمّتنا المعصومون عليهمالسلام، وقد قال الإمام الصادق عليهالسلام: «كانَ أميرُ المؤمنينَ عليهالسلام يَحتطِبُ ويَستقِي ويَكنِسُ، وكانتْ فاطمةُعليهاالسلام تَطحَنُ وتَعجِنُ وتَخبُزُ».
فاتّصاف الإنسان بالنّظم والانضباط في تكاليفه المُلقاة على عاتقه، يحفّزه على السعي لأدائها، كما يمكّنه من الوفاء بالتزاماته ووعوده في أوقاتها المحدّدة، فلا يخالف قول الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولًا﴾ (الإسراء: 34).
واجتناب الإفراط والتفريط في أداء الوظائف على المستويين الفرديّ والاجتماعيّ، والتقيّد بمنهجٍ منظّمٍ في الحياة، وإنجاز الأعمال والمشاريع في جميع جوانب الحياة، هي أوامر نابعةٌ من روح تعاليم دِّينِنا الحَنِيف. فهذا مولانا أمير المؤمنين يوصي ولديه السبطين الحسن والحُسين عليهماالسلام قائلًا: «أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ
وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ...»، فدِّينِنا يدعونا إلى نَظْمِ أَمْرِنا، وهذا لا يتم إلا إذا عملنا على تنظيم أوقاتنا، كي نستثمرها خير استثمارٍ، خدمةً لأنفسنا ومجتمعنا، وقد أشار الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهالسلام إلى هذه الحقيقة بقوله: «اجْتَهِدُوا فِي أَنْ يَكُونَ زَمانُكُمْ أَرْبَعَ ساعاتٍ: ساعَةً لِمُناجاةِ اللهِ، وساعَةً لأَمْرِ الْمَعاشِ، وساعَةً لِمُعاشَرَةِ الإِخْوَانِ والثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ ويُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْباطِنِ، وسَاعَةً تَخْلُونَ فِيها لِلَذّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وبِهذِهِ السّاعَة تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلاثِ ساعاتٍ. لا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِفَقرٍ، ولا بِطُولِ عُمُرٍ، فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقرِ بَخِلَ، ومَنْ حَدَّثَهَا بِطُولِ الْعُمُرِ يَحْرِصُ. اجْعَلُوا لأَنفُسِكُمْ حَظًا مِن الدُّنْيا، بِإِعْطائِها ما تَشْتَهِي مِن الْحَلالِ، وما لا يَثْلِمُ الْمُرُوَّةَ وما لا سَرَفَ فِيهِ، واسْتَعِينُوا بذلِكَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ: لَيْسَ مِنّا مَنْ تَرَكَ دُنْياهُ لِدِينهِ، أَو تَرَكَ دِينَهُ لِدُنْياهُ».
لا يختلف اثنان في أنَّ السعي الحثيث يُعد من الاستراتيجيّات الأساسيّة في تَّدْبير المعيشَة. ويُعتبر هذا الأمر -بالنسبة للقوانين الحاكمة على وجود الإنسان- وسيلةً لبناء شخصيّته وترسيخها،
وفي الوقت نفسه هو داعٍ لاكتمال قدراته البدنيّة والفكريّة، ونضوج طاقاته الفِطريّة والذاتيّة، وقد ذكر الله سبحانه العَمَل والسعي في مواطن عديدةٍ من كتابه المجيد، وأكّد على أهمّيّة ذلك في نظام التكوين والتشريع، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنا الإِنْسانَ فِي كَبَدٍ﴾ (البلد: 4).
وقال خَاتَم النَّبِيِّين صلىاللهعليهوآله: «إنكم في ممر الليل والنهار في آجالٍ منقوصةٍ، وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتةً، فمن يزرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة، ومن يزرع شرًا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارعٍ ما زرع».
وفي الحقيقة: إنّ بذل الجهد والسعي الحثيث يصقلان شخصيّة الإنسان في الحياة الدنيا، وحسب قانون الطبيعة، فإنّ الحركة والعَمَل والكبَد (المعاناة) هي أمورٌ ضروريّةٌ في حياة البشر، ولا بدّ لكلّ إنسانٍ من مكابدتها. لذا، يُعدّ الإنسان بذاته ظرفًا للحاجة، وبإمكانه أن يلبّي حاجاته ممّا هو موجودٌ في الطبيعة من ثرواتٍ. وبالتأكيد، فإنّ هذه الثروات ليست مُعدّة على طَبَقٍ من ذهب، بل إنَّ استثمارها بحاجةٍ إلى بذل جهدٍ وعملٍ دؤوبٍ، وهذه الضرورة فرضتها قوانين الطبيعة على الإنسان، من أجل أن يتسنّى له الخلاص من الفقر، والحرمان، وكلّ ما من شأنه الإخلال بنظم حياته الفرديّة والاجتماعيّة.
ولا ريب أنَّ الحياة الطيّبة الكريمة ستكون من نصيب المجتمع الإسلاميّ، متى ما اتّخذ أبناؤه العَمَل منهجًا لهم، لأنّ العَمَل شعارُ المؤمن، وجزءٌ من الإيمان.
ومن هذا المنطلق، فإنّ ترك العَمَل يُعدّ من الأخطاء التي تؤدّي إلى الخمول، وتحول دون نضوج شخصيّة الإنسان وانتعاش المجتمع.
وللعمل فوائد على جسد الإنسان وروحه، لا ينكرها إلا منطمس البصيرة، فالإنسان لا يكون فعّالًا في مجتمعه إلا من خلال عمله وجهده.
ومن الواضح لكل ذي فكر، أنَّ البطالة لها تأثيرٌ سلبيٌّ على معنويّات الإنسان والمجتمع، وقد تطرّق الإمام الصادق عليهالسلام إلى هذا الأمر في حديثٍ مفصل أملاه على المفضّل بن عمر، جاء فيه: «فانظُر كيفَ كُفيَ (إلانسان) الخِلقَةَ التي لم يكُن عندَهُ فيها حِيلةٌ، وتركَ عليه في كلِّ شيءٍ من الأشياءِ موضِعَ عمَلٍ وحرَكةٍ، لما لهُ في ذلكَ مِن الصّلاحِ، لأنّهُ لو كُفيَ هذا كُلَّهُ حَتّى لا يكونَ لهُ في الأشياءِ موضِعَ شُغلٍ وعمَلٍ، لما حملتهُ الأرضُ أشرًا وبطرًا، ولبلغَ بهِ ذلكَ إلى أن يتعاطَى أُمورًا فيها تَلَفُ نفسِهِ. ولَو كُفيَ النّاسُ كُلَّ ما يحتاجونَ إليهِ، لما تهنَّؤوا بالعيشِ، ولا وَجَدوا لهُ لَذَّةً. ألا تَرَى لَو أنّ امرءاً نَزلَ بقومٍ فأقامَ حِينًا، بَلغَ جميعَ
ما يحتاجُ إليهِ من مَطعَمٍ ومَشرَبٍ وخِدمةٍ، لتَبَرَّمَ بالفراغِ، ونازعَتهُ نفسُهُ إلى التّشاغُلِ بشيءٍ! فكيفَ لَو كانَ طولَ عُمرِهِ مَكفِيًا لا يحتاجُ إلى شيءٍ؟! وكانَ من صوابِ التّدبيرِ في هذه الأشياءِ التي خُلِقَتْ للإنسانِ أن جُعلَ لَهُ فيها مَوضعَ شُغلٍ، لِكي لا تُبرِمهُ البطالةُ، ولِتَكُفُّهُ عَن تَعاطي ما لا يَنالُهُ ولا خَيرَ فيهِ إنْ نالَهُ. واعلمْ يا مُفضّلُ أنّ رأس معاشِ الإنسانِ وحياتَهُ: الخبز والماء، فانظُر كيفَ دبّرَ الأمرَ فيهما»، إلى أن قال عليهالسلام: «وهكذا الإنسانُ: لَو خَلا مِن الشّغلِ، لخرَجَ مِن الأشرِ والعبثِ والبطرِ، إلى ما يعظُمُ ضرَرُهُ عَليهِ، وعَلى مَن قَرُبَ مِنهُ، واعتَبرَ ذلكَ بِمَن نَشَأ في الجدَةِ ورَفاهيَةِ العَيشِ والتَرفّهِ والكِفايةِ وما يُخرجُهُ ذلك إليهِ».
فيتوجب علينا أن نتّخذ من مضامين الروايات الشريفة التي تحفّز على العَمَل، منهجًا نسعى لتطبيقه اقتداءً بأنبياء الله تعالى وأوصيائهم الكرام الذين كانت لهم نشاطاتٌ على جميع المستويات، مثل: التجارة، والمضاربة، والزراعة، وتربية الماشية، والسقاية، وما إلى ذلك من أعمالٍ كريمةٍ شجّعوا العباد على مزاولتها.
يُعدّ الاستثمار من الأسباب البارزة والمؤثّرة في تطوّر
الفرد والمجتمع في جميع مجالات الحياة، وما أكثر الدلائل على أن كلّ الموارد يمكن استخدامها بفعاليةٍ أكبر، فاستثمار الأموال على سبيل المثال هو أحد العوامل الأساسيّة في النموّ الِاقْتِصَاديّ. وعلى الرغم من ضرورة هذا الأمر، إلا أنّه لا يزال غير متعارفٍ في النشاطات الِاقْتِصَاديّة الأُسريّة، إذ إنَّ الأُسرة هي المصدر الأساس للاستثمار.
لذا، من الضروريّ السعي في إصلاح برنامج تخصيص الأموال وإنفاقها، بحيث يتمّ اجتناب الإسْراف، والتَّبْذِير، وهدر الثروات، أو خمودها، وذلك لكي يتمّ تسخير الاستثمار والادّخار في خدمة التطوّر الِاقْتِصَاديّ. وهذه الاستراتيجيّة في تَّدْبير المعيشَة تؤدّي إلى القضاء على الفقر والحرمان، وتكون ذخرًا لا ينضب لأبناء المجتمع.
فالمال والثروة -بطبيعة الحال- رصيدٌ للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء. وبعبارةٍ أخرى: إنّ المال قَوّامٌ عليهما، والمُتدبر يعلم أنَّ الخطابات القرآنيّة في هذا المجال جاءت بصيغة الجمع، وذلك للدلالة على أهمّيّة الرصيد المالي وقوّاميّته في المجتمع.
فأصل قوّاميّة المال تبيّن لنا أهمّيّة الاستثمار، حتى وإن كانت الثروة بأيدي الناس، لأنّ الثروة لو سُخّرت لخدمة المجتمع، وتأمين مصالحه، سوف لا تفقد قوّاميّتها، لكنّها لو
ادُّخرت وأصبحت خاملةً، ستفقد هذه القوّاميّة، وقد قال الإمام الصادق عليهالسلام: «إنَّما أعطاكُمْ اللهُ هذهِ الفُضولَ مِن الأموالِ، لتُوجِّهوها حيثُ وَجّهَها اللهُ، ولَم يُعطِكُموها، لتكنِزُوها».
وأكّد الدين الإسلاميّ على خاصّية الاستثمار في جميع المجالات التي تخدم المجتمع، كالزراعة، والصناعة، والتعدين، والخدمات العامّة، وما إلى ذلك. وتطرّقت المصادر الإسلاميّة إلى هذا الأمر وشجّعت الناس عليه، تحت عناوين مختلفةٍ: إمّا بشكلٍ مباشرٍ، مثل: إصلاح المال، والعمران، والإحياء، وإمّا بشكلٍ غير مباشرٍ، مثل: منع ركود الثروة، وحرمة الإسْراف والتَّبْذِير، وحرمة إتلاف المال، وترويج مبدأ القناعة، والِاقْتِصَاد في استهلاك الأموال.
وسنذكر فيما يأتي بعض الآيات الكريمة والأحاديث المباركة التي تشجّع على استثمار الأموال:
صرّح القرآن الكريم بمشروعيّة جمع الثروة، وأهمّيّة تأمين المصادر الِاقْتِصَاديّة واستثمارها في مجال الإنتاج، وأشار إلى أنّ الله تعالى خلق الإنسان من الأرض، وسخّرها له، وأوكل إليه إعمارها، حيث قال: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا﴾ (هود: 61)، وبالطبع، فإنّ عمران الأرض لا يتمّ إلا عن طريق الاستثمار.
- ونستلهم من قصّة النَّبِيّ يوسف صلىاللهعليهوآله أنّه وضع برنامجًا اقتصاديًّا، لإدارة مصر لأكثر من عقدٍ، وتمكّن من القيام باستثماراتٍ ضخمةٍ في هذه البلاد العظيمة، وهذه الاستثمارات قد بُرمِجَت في إطار خطّةٍ طويلة الأمد، وفي ثلاثة محاور، هي:
توفير عناصر الإنتاج، وإنشاء ثروةٍ ماليّةٍ واستثمارها، وبناء مخازن للموادّ الغذائيّة، بغية حفظها لسنوات الجدب، وقد بدأ ذلك حين أشار بمشورةٍ ثمينةٍ وقدم نصيحةً غاليةٍ ساهمت في إنقاذ مصر وما حولها من محنةٍ عظيمةٍ، وكارثةٍ اقْتِصَاديةٍ فادحةٍ: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ (يوسف: 47-49).
- خلق الله تعالى السماء والأرض، وسخّر كلّ ما فيهما، لخدمة الإنسان، وتلبية حوائجه، وأكرمه بالعقل الذي مكّنه من استثمار ما في الطبيعة من خيراتٍ، كصناعة السفن التي تقطع البحار، لكي يتسنّى له كَسْب رزقٍ حلالٍ. وبالطبع، لا بدّ له من أن يشكر الله تعالى على نعمه كلها. ومن المؤكّد أنّ استغلال هذه النعم العظيمة لا يكون ميسّرًا إلا بعد برنامجٍ استثماريٍّ
مناسبٍ، وإن كان محدودًا. فعلى سبيل المثال: إنّ استخراج لحمٍ طريٍّ من البحر: ﴿وَمِنْ كُلٍّ تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا﴾ (فاطر: 12)؛ لا يكون ميسّرًا من دون تسخير بعض الأموال في صناعة السفن والزوارق، أو على أقلّ تقديرٍ توفير وسائل الصيد.
- تحدّث القرآن الكريم عن استثمارٍ ضخمٍ في أحد المشاريع العظيمة إبّان العهود السالفة من خلال تسخير أموالٍ طائلةٍ، واستخدام تقنيةٍ متطوّرةٍ. وهذا المشروع هو: بناء سدٍّ بين جبلين يحول دون عبور الأعداء من تلك الفسحة، حيث تمّ إنشاؤه من قِبَل ذي القرنين، تلبيةً لطلب سكّان تلك المنطقة، وذكر القرآن الكريم نجاح هذا المشروع العظيم، وأنّ ذا القرنين صرح بأنّ هذا النجاح لم يكن ممكنًا لولا رحمة الله تعالى ولطفه، إذ أكرمه تعالى بقدرةٍ مكّنته من صناعة ذلك السدّ. قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (الكهف: 94-97).
- أمر الله تعالى المسلمين بأن يعدّوا أنفسهم لمواجهة الأعداء قدر المستطاع، حتّى لا يطمع أحدٌ بالإغارة على أراضيهم وسلب أموالهم. قال عَزَّتْ آلاَؤُه: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا
اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾ (الأنفال: 60).
فهذه الآية المباركة لا تختصّ بالاستعداد العسكريّ وحسب، بل نستوحي منها ضرورة الاهتمام بسائر القضايا الِاقْتِصَاديّة، والثقافيّة، والسياسيّة، التي تندرج تحت مفهوم (القوّة)، لما لها من تأثيرٍ بالغٍ في مواجهة الأعداء.
- هناك آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم تطرّقت إلى نماذج عديدةٍ من استثمار الأموال في مختلف المشاريع، منها الآيتان 37 و38 من سورة هود، والآية 27 من سورة المؤمنين التي تشير إلى توفير بعض الأمور، من أجل صناعة سفينة نوح عليهالسلام عن طريق الوحي. والآيتان 12 و13 من سورة سبأ تشيران إلى خطّة النَّبِيّ سليمان عليهالسلام الاستثماريّة في صناعة جدران، وتماثيل، وأواني طعام كبيرة، وقدور ثابتة. وكذلك الأمر في الآيتين 10 و11 من سورة سبأ، والآيات 26 إلى 28 من سورة القصص التي تذكر مشروع النَّبِيّ داوودعليهالسلام الاستثماريّ في صناعة الدروع الحربيّة، وفي كتاب الله عَزَّتْ آلاَؤُه عشرات الآيات الدالّة على منافع الاستثمار والمبيّنة لفضله، ومن تدبّر القرآن الحكيم وغاص في بحار أسراره يدرك من خلال مُحكماته عظمة آلاء الله في ملكوته، ونُظُمه المستقيمة الجارية في سمائه وأرضه على مناهجه الحكيمة.
وفي ما يلي نذكر بعض الروايات المباركة التي تناولت قضيّة استثمار الأموال:
- رغّب مولانا رسول الله صلىاللهعليهوآله الناس باستثمار أموالهم، وعدَّ ذلك من المروءة، فقال: «مِن المروءَةِ استصلاحُ المالِ».
وروي أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ يُسمع أهل الإسلام، فسأل ابنه الحسن عليهالسلام عن أشياء من أمر المروءة، فقال: «ما المروءة»: فأجابه السبط الأكبرعليهالسلام : «العفاف وإصلاح المال».
وأكّد الإمام عليّ بن الحسين عليهالسلام على هذا الأمر بقوله: «استثمارُ المالِ تمامُ المروءَةِ».
- روى زرارة عن الإمام الصادق قوله عليهالسلام : «ما يَخلُفُ الرّجُلُ بَعدَهُ شَيئًا أشَدَّ عَلَيهِ مِن المالِ الصّامِتِ». قال زرارة: قلت له كيف يصنع به؟ قال عليهالسلام : «يَجعَلهُ فِي الحائطِ والبُستانِ أو الدّارِ».
- وروى محمّد بن عذافر، عن أبيه، قال: أعطى أبو عبد الله عليهالسلام أبي ألفًا وسبعمائة دينارٍ، فقال له: «اتَّجِر لِي بِها». ثمّ قال عليهالسلام : «أَما إنّهُ لَيسَ لِي رَغبَةٌ في رِبحِها، وإنْ كانَ الرّبحُ مَرغوبًا
فيهِ، ولكِنِّي أحبَبتُ أن يَراني اللهُ عزَّ وجلَّ مُتعرِّضًا لفَوائدِهِ».
قال: فربحت له فيه مائة دينارٍ، ثمّ لقيته، فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينارٍ، ففرح أبو عبد الله عليهالسلام بذلك فرحًا شديدًا، وقال لي: «أَثبِتْها في رَأسِ مالِي».
- أوصى الإمام الصادق عليهالسلام أحد أصحابه أن يشتري مزرعةً أو بستانًا، لأنّ الذي يمتلك رصيدًا مادّيًا يؤمّن حاجاته وحاجات عياله، سوف لا يعاني كثيرًا، ويرتاح باله، لو تعرّض إلى نائبةٍ أو حادثةٍ. فقد روى محمّد بن مرازم، عن أبيه: أنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال لمصادف مولاه: «اتّخِذْ عقدةً أو ضَيعةً، فإنّ الرّجلَ إذا نزَلت بهِ النّازِلةُ أو المصيبةُ، فذَكرَ أنّ وَراءَ ظهرِهِ ما يقيمُ عيالَهُ، كانَ أسخَى لنفسِهِ».
إضافةً إلى ما ذُكر، فإنّ جميع الروايات المباركة التي وردت في العقود التجاريّة، مثل: عقد المزارعة والمساقاة، والمضاربة والشراكة، والإجارة وما شاكلها، تجوّز استثمار الأموال، وتسخيرها خدمةً للفرد والمجتمع.
لا ريب في أنّ الاستثمار ذو فوائد عظيمة للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، ونذكر من هذه الفوائد ما يلي:
أ. الرقيّ الِاقْتِصَاديّ: إنَّ استقطاب رؤوس الأموال، من شأنه أن يمهّد الأرضيّة المناسبة لاستغلال الطاقات البشريّة والِاقْتِصَاديّة بشكلٍ أمثل، وبالتالي سيؤدّي إلى رفع مستوى الإنتاج الوطنيّ الذي يترتّب عليه ارتفاع مستوى الدخل القوميّ، وتوفير فرص العَمَل، وتقليص مستوى التضخّم، والقضاء على البطالة، كما يصون اقْتِصَاد المجتمع من الأزمات التي تطرأ عليه.
ب. التقدّم الاجتماعي: من شأن الاستثمار أن يكون نقطة انطلاقٍ لمنهجٍ تنمويٍّ ينصبُّ في تحسين الأوضاع المعيشيّة للفرد والمجتمع معًا، وكذلك من شأنه أن يصقل القدرات الفرديّة والجماعيّة. كما أنّه سببٌ لبلوغ أقصى درجات الاقتدار السياسيّ والِاقْتِصَاديّ.
ت. الاستقلال السياسي: للاستثمار دورٌ هامٌّ في الاستقلال عن سلطة الأجانب، وبلوغ درجة الاكتفاء الذاتيّ، كما له تأثيرٌ فاعلٌ على مكافحة الفقر، واجتثاث جذوره من المجتمع، وفي الوقت نفسه يعدُّ أساسًا للسياسة الاجتماعيّة والِاقْتِصَاديّة في الإسلام. فالثروة تكون مفيدةً حسب التعاليم الإسلاميّة، حينما تُسخَّر في خدمة مصالح المجتمع الإسلاميّ وتحفظ كرامة أبنائه.
ث. استغلال الطاقات: من الطبيعيّ أنّ إهدار الثروات، واستهلاك الأموال، بأسلوبٍ غير مبرمجٍ، سوف يحول دون التطوّر والإعمار. لذا، فإنّ استثمار الثروة والمال ذو أهمّيّةٍ بالغةٍ في تسخير الطاقات البشريّة والماليّة بشكلٍ صحيحٍ.
ج. الدفع في عجلة التطوّر: يُعدّ الاستثمار من الأسباب البارزة والمؤثّرة في تطوّر الفرد والمجتمع في جميع مجالات الحياة، وهو يؤدّي دورًا هامًا في إصلاح البنية التحتيّة لاقْتِصَاد المجتمع ورقيّه، ولا سيّما في مجالَي الزراعة والصناعة.
إنَّ الإشراف على العَمَل يُعدّ أمرًا هامًّا في شتّى الأمور ومن شأنه ضمان استثمار الفرص بطريقةٍ مُثلى، كما يساهم في رفع كفاءة الإمكانيّات الموجودة، ويُعدّ عاملًا مساعدًا لوليّ أمر المؤسّسة أو العائلة في أداء مهامّه.
لذا، يجب على الإنسان مراقبة نفسه وجميع تصرّفاته، فيصلح ما كان غير لائقٍ منها. من هنا، أكّد الإمام عليّ عليهالسلام على هذا الأمر بقوله: «مَن حاسَبَ نَفسَهُ، وَقَفَ عَلى عُيوبِهِ، وأحاطَ بذُنوبِهِ، واستقالَ الذّنوبَ، وأصلَحَ العُيوبَ».
ولا ريب أنَّ الإشراف الصحيح على الأعمال في مؤسّسةٍ ما، سوف يُصلحها ويؤدّي إلى رفعة رأس المسؤول عنها أمام مَنْ هم أعلا منه رتبةً. وعلى العكس من ذلك، فإنّ فقدان الإشراف الصحيح على الأعمال، سيؤدّي إلى حدوث خللٍ فيها، وبالتالي فسادها، ويعدّ علامةً على ضعف الإدارة وسوء التَّدبير.
ولا بدّ أن تكون الرقابة على الأعمال بالعلن والخفاء في آنٍ واحدٍ، ففي تعاليمنا الدينيّة يوجد أخبارٌ تشير إلى أهمّيّة الرقابة الخفيّة، وتأثيرها الكبير على نجاح الأعمال. أمّا الرقابة الخفيّة التي أشار إليها القرآن الكريم، فهي على مستوىً عالٍ من الدقّة، لدرجة أنّها تدرك أحاسيس الإنسان وأفكاره الباطنيّة، حيث قال تعالى في كتابه المجيد: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنا الإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (ق: 16).
فالرقابة الخفيّة عن طريق الرقابة والتفتيش، لها دورٌ فعّالٌ في تشخيص الطاقات الكامنة، ورفع مستوى العطاء، وكذلك من شأنها كشف الانتهازيّين والمتصيّدين في الماء العكر، والمتملّقين، وتمييز الصَّالِحين والمخلصين في العَمَل عن غيرهم. وما أكثر الذين يرتدون ثياب الصُّلحاء، لكنّهم يكنُّون في أنفسهم المكر والأحقاد، كما أنّهم في الوقت نفسه حمقى ومتحجّرون، حيث ينظرون إلى الحياة من زاويةٍ ضيّقةٍ.
لذلك فإنّ تقويم الأمور، حسب آراء هؤلاء، أمرٌ مخالفٌ
للصواب والمنطق. وللإمام أمير المؤمنين عليهالسلام كلامٌ عظيم في هذا المجال جاء في عهده إلى مالك الأشتر النخعيّ، حينما نصحه بحسن اختيار عمّاله، فقال: «ثُمَّ لا يَكُن اختِيارُكَ إِيّاهُمْ عَلَى فِراسَتِكَ واسْتِنامَتِكَ وحُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ، فَإِنَّ الرِّجالَ يَتَعَرَّفُونَ لِفِراساتِ الوُلاةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وحُسْنِ خِدْمَتِهِمْ، ولَيْسَ وَراءَ ذلِكَ مِن النَّصِيحَةِ والأَمانَةِ شَيءٌ، ولكِنِ اختَبِرهُمْ بِما وُلُّوا لِلصّالِحِينَ قَبلَكَ، فَاعمِدْ لأَحْسَنِهِمْ كانَ فِي العامَّةِ أَثَرًا، وأَعرَفِهِمْ بِالأَمانَةِ وَجْهًا».
وجاء في هذا العهد -أيضًا-: «ثُمَّ انظُرْ فِي أُمُورِ عُمّالِكَ، فَاستَعْمِلهُمُ اختِبارًا، ولا تُوَلِّهِمْ مُحاباةً وأَثَرَةً، فَإِنَّهُما جِماعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ والْخِيانَةِ. وتَوَخَّ مِنهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ والْحَياءِ» إلى أن قال: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمالَهُمْ، وابْعَث الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ والْوَفاءِ عَلَيهِمْ، فَإِنَّ تَعاهُدَكَ فِي السِّرِّ لأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُم عَلَى اسْتِعمالِ الأَمانَةِ والرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ».
وروى الريّان بن الصلت أنَّ الإمام الرضاعليهالسلام قال: «كانَ رَسولُ اللهِ صلىاللهعليهوآله إذا وَجّهَ جَيشًا فَأمَّهُم أميرٌ، بعثَ مَعهُ مِن ثِقاتِهِ مَن يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبرَهُ».
إذًا، الرقابة التي أُشير إليها في هذه الروايات تختصّ عمومًا
بالمؤسّسات والمراكز العامّة، وكذلك فهي من البديهيّ تشمل المكوّن الأصغر في المجتمع، كالأسرة، إذ يمكن تطبيق تلك التعاليم فيها حسب الظروف الزمانيّة والمكانيّة.
إنّ الرقابة على إنفاق الأموال تُعدّ من الأمور الهامّة في مجال تَّدْبير شؤون المعيشَة، وقد تكون أهميّتها توازي الإنتاج أحيانًا. والمقصود من رقابةٍ كهذه هو تحديد صرف الأموال بمستوىً يتناسب مع دخل الفرد أو المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار اجتناب الإسْراف، والتَّبْذِير، وعدم إتلاف المال بأيّ طريقةٍ كانت، بغية إيصال المجتمع نحو التقدّم والرقي.
فالنَّبِيّ يوسف الصديق عليهالسلام عندما تولّى إدارة الشؤون الِاقْتِصَاديّة في مصر، أشرف على الأموال والمحاصيل في السنوات السبع ذات النعمة الوفيرة إشرافًا دقيقًا، فتمكّن من ادّخار أكبر قدرٍ ممكنٍ من المحاصيل الزراعيّة لسنوات الجدب. وحسب ما أشارت إليه بعض الروايات، فإنّه عليهالسلام تجاوز محنة سنوات الجدب، وجنّب الناس القحط والمجاعة، من خلال حسن تَّدْبيره في القضاء على الاستثمار الطبقيّ في المجتمع، وإزالة الفواصل بين أبناءه، فبحسن تَّدْبيره وإدارته الصحيحة قام بمعاوضة المحاصيل الزراعيّة في سنوات القحط مع الدراهم، والدنانير، والمواشي، والغلمان، والجواري، والدور، ثمّ بعد
(52)ذلك أعاد هذه الأموال والممتلكات إلى أهلها بشكلٍ عادلٍ، لأنّ هدفه كان إنقاذ الخلائق من المجاعة والبلاء.
«إنَّ نَّبِيّ الله يوسف عليهالسلام في الواقع لم يكن مجرّد مفسّرٍ للأحلام، بل كان قائدًا يخطّط من زاوية السجن لمستقبل البلاد، حيث قدّم مقترحًا من عدّة موادٍّ لخمسة عشر عامًا على الأقلّ. وكما سنرى، فإنّ هذا التعبير المقرون بالمقترح للمستقبل حرّك الملك وحاشيته، وكان سببًا لإنقاذ أهل مصر من القحط القاتل من جهة، وإخراج الحكومة من أيدي الطغاة من جهة أُخرى».
أمّا في الجانب الفرديّ، فإنّ وفور النعمة يجب أن لا يكون داعيًا للتَّبذير والإسْراف، بل لا بدّ من اتّخاذ منهجٍ صحيحٍ، وإشرافٍ دقيقٍ عند استهلاك النِّعم الإلهيّة، بغية ادّخارها للمستقبل، كي لا يُجبر الإنسان يومًا على أن يمدّ يده للآخرين، طلبًا للعطاء. كما يمكن من خلال هذا الإشراف الصحيح مساعدة الفقراء والمساكين، وأداء التكاليف الشرعيّة والاجتماعيّة بأفضل وجهٍ، وكذلك لا بدّ للإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار حياته الأخرويّة.
إنّ مشورة الآخرين ومعرفة آرائهم تُعدّ من استراتيجيّات التَّدبير في جميع المستويات الفرديّة، والعائليّة، والإداريّة.
ومهما كان الإنسان عبقريًّا وذا حصافةٍ، فإنّه لا يستطيع أن يُدرِك زوايا الحياة كافّةً، وأن يحيط بجميع مشاكل المعيشَة. فالمسؤول الذي لا يستشير أصحاب الاختصاص في إدارة مؤسّسته، يُعدّ فاشلًا في إدارته، ويتعرّض لانتكاساتٍ في عمله.
لقد حظيت مسألة المشورة بأهمّيّةٍ بالغةٍ في التعاليم الإسلاميّة، فالنَّبِيّ صلىاللهعليهوآله رغم امتلاكه قدرةً فكريّةً كبيرةً تؤهّله لتسيير الأُمور وتصريفها من دون حاجةٍ إلى مشاورة أحد، وبغضّ النظر عن الوحي الإلهي، ولكنّه صلىاللهعليهوآله فعل ذلك كي يُشعر المسلمين بأهمّيّة المشاورة وفوائدها، فيتخذوها ركنًا أساسيًا في برامجهم، وحتّى ينمّي فيهم قواهم العقليّة والفكريّة. لذا، نجده يشاور أصحابه في أُمور المسلمين العامّة التي تتعلّق بتنفيذ القوانين والأحكام الإلهية -لا أصل الأحكام والتشريعات التي مدارها الوحي- ويقيم لآراء مشيريه أهمّيّةً خاصّةً، ويعطيها قيمتها اللائقة بها، حتّى أنّه كان أحيانًا ينصرف عن الأخذ برأي نفسه، احترامًا لهم ولآرائهم، كما فعل ذلك في واقعة أُحد. ويمكن القول: إنّ هذا الأمر بالذات كان أحد العوامل المؤثّرة وراء نجاح الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله في تحقيق أهدافه الإسلاميّة العليا.
وحيث إنّه لا شكّ في أهمّيّة المشورة في تَّدْبير أمور المعيشَة، سوف نتطرّق إلى بعض فوائدها وآثارها في ما يلي:
أمر الله تعالى النَّبِيّ صلىاللهعليهوآله أن يشاور المسلمين في الآية الكريمة: ﴿وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159)، وصحيحٌ أنّ كلمة (الأمر) في هذه الآية ذات مفهومٍ واسعٍ يشمل جميع الأُمور، لكن من المسلّم -أيضًا- أنَّ النَّبِيّ صلىاللهعليهوآله لم يشاور الناس في الأحكام الإلهيّة مطلقًا، بل كان في هذا المجال يتّبع الوحي فقط. وعلى هذا الأساس، كانت المشاورة في كيفيّة تطبيق الأحكام الإلهيّة على أرض الواقع. وبعبارةٍ أُخرى:
إنَّ النَّبِيّ صلىاللهعليهوآله لم يشاور أحدًا في التقنين، بل كان يشاور في كيفيّة التطبيق، ويطلب وجهة نظر المسلمين في ذلك، ولهذا عندما كان يقترح أمرًا -أحيانًا-، يبادره المسلمون بهذا السؤال: هل هذا حكمٌ إلهيٌّ لا يجوز إبداء الرأي فيه، أو إنّه يرتبط بكيفيّة التطبيق والتنفيذ؟
فإذا كان من النوع الثاني، أدلى الناس فيه بآرائهم، وأمّا إذا كان من النوع الأوّل، لم يكن منهم تجاهه سوى التسليم والتفويض.
جاءت الشورى من مصدر شاور، أي طلب رأيه، واستخرج ما عنده، والتشاور هو: استطلاع الرأي من ذوي
الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق، فالشورى عبارة عن مشورة متبادلة بين أهل المعرفة والمتخصّصين وأصحاب الخبرة والمفكّرين بشأن موضوعٍ معيّنٍ، لأنّ أفضل طريقٍ للوصول إلى النتيجة هو: البحث والنقاش في ما بينهم، وعبر تلاقح هذه الأفكار، يسطع نورٌ يستنير به الناس، وسبيلٌ يمكنهم سلوكه.
وفي بعض الأحيان، يخلط البعض بين الشورى والمشورة، فالقرار في الشورى يكون جماعيًا، إذ يتشاور المختصّون في قضيّةٍ ما، ويكون القرار مطابقًا لرأي الأغلبيّة.
أمّا القرار في المشورة، فيتّخذه شخصٌ واحدٌ بعد استشارته لشخصٍ أو أشخاصٍ، ويكون هذا القرار حسب ما يراه المستشير مناسبًا، أي أنّ القرار النهائيّ يكون طبق ما يستسيغه هو.
إنَّ المشورة من الأصول التي يجب الاعتماد عليها في إدارة شؤون الأسرة، لذلك، فإنّ أفضل طريقٍ لاجتناب الخلافات التي تَحْدُث في بعض العوائل، في مختلف المجالات المعيشيّة، وفي تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، وفي الأعراف والتقاليد، وفي المسائل المتعلّقة بالضيافة، هو استشارة
الزوجين، واستشارة سائر أعضاء العائلة بعضهم للبعض الآخر، وقبول الرأي الآخر برحابة صدرٍ ومحبّةٍ متبادلةٍ. فعلى جميع أعضاء العائلة التفاهم في ما بينهم، وأن يعيروا أهمّيّةً لجميع الآراء والمقترحات، كما عليهم التخلّي عن الأنانيّة وتحكيم العقل، لأنّ الاستشارة المتبادلة تصقل الأفكار وتشذّبها.
ولا يمكن لعاقل إنكار فوائد المشورة في العائلة، فمن شأنها تقليص الخلافات لأدنى درجةٍ ممكنةٍ، أو القضاء عليها تمامًا، وبالتالي خلق أجواءٍ من الطمأنينة والاستقرار، الأمر الذي يُساعد على حُسن التَّدبير في المعيشَة، كون المشورة تُحقّق قدرًا لا يستهان به من الشعور بالمسؤولية الجماعية التضامنية، وقد يؤدّي ترك مشورة الآخرين إلى الحسرة والندامة، إذ في معظم الأحيان يكون القرار الصادر إثر المشورة صائبًا لا يعقبه ندم.
إنّ استشارة الآخرين ومعرفة آرائهم -حسب ثقافتنا الدينيّة-، تعني مشاركتهم في عقولهم، وتوسعة أُفق اتّخاذ القرار، الأمر الذي أكّد عليه الإمام عليّ عليهالسلام في قوله: «مَن شاوَرَ الرِّجالَ شارَكَها فِي عُقُولِهِا».
لذا، فإنّ القرار الذي يتّخذه المتشاورون لا يكون فرديًّا، إذ يكونون شركاء فيه، ولا يشعرون بأنّه فُرِضَ عليهم فرضًا. أضف
إلى ذلك أنّ الذي يستشير الآخرين في أُموره وأعماله، لو تمكّن من تحقيق نجاحٍ، قَلّ أن يتعرّض للحسد، لأنّ الآخرين يرون أنفسهم شركاء في تحقيق ذلك النجاح، وليس من المتعارف أن يحسد الإنسان نفسه على نجاحٍ حقّقه. وأمّا إذا استشار، ولم يتمكّن من تحقيق نجاحٍ، وتعرّض لنكسةٍ، فسوف لا يلومه الناس، ولا يتعرّض لسهام نقدهم واعتراضهم، لأنّ الإنسان لا يعترض على عمل نفسه، ولا ينقد فعل ذاته، بل سيشاطرونه الألم، ويتعاطفون معه، ويشاركونه في التبعات، كلّ ذلك لأنّهم شاركوه في الرأي، وشاطروه في التخطيط، ولأنّه لم يكن مستبدًا في الرأي، ولا متفرّدًا في العَمَل.
كما أنّ المشورة تعين الإنسان على تشخيص الخطأ، والأمر معها كما قال الإمام عليّ عليهالسلام: «مَن استَقبَلَ وُجُوهَ الآراء عَرَفَ مَواضِعَ الخطَأ».
والرؤية العقلائيّة تشجّع الإنسان على طلب آراء الآخرين، حيث قال أمير المؤمنين عليهالسلام: «العاقِلُ مَن اتَّهَمَ رَأيَهُ، ولَم يَثِق بِما سَوَّلَتهُ لَهُ نَفسُهُ»، وقال عليهالسلام في مناسبةٍ أُخرى: «كَفاكَ مِن عَقْلِكَ ما أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِن رُشْدِكَ».
وهناك فائدةٌ أُخرى للمشورة، تكمن في أنّها خير محكٍّ لمعرفة جواهر الآخرين، والعلم بما يكنّونه للمُستشير، من حبٍّ أو كراهيةٍ، ولا ريب في أنّ هذه المعرفة تمهّد سبيل النجاح. وللمشورة فوائد جمّة في حُسن تَّدْبير المعيشَة، نذكر منها ما يلي، أنّها:
- تحول دون تكرار العَمَل.
- تحول دون وقوع أخطاء لا تُحمد عقباها.
- تجنّب الإنسان الملامة والندم.
- تصون الإنسان من خسائر فادحة.
- تجنّب الإنسان الديون التي لا مسوّغ لها.
- تمنع بعض القرارات الطائشة التي تُتّخذ لأسبابٍ عاطفيّةٍ محضة.
- ترفع من المستوى المعيشيّ للإنسان.
- تمكّن الإنسان من استثمار تجارب الآخرين وأفكارهم في قضايا المعيشَة.
- تحول دون إنفاق أموالٍ طائلةٍ في مختلف المجالات.
- ترفع مستوى الاستثمار الماليّ إلى أعلى درجةٍ.
(59)يُعدُّ الاستبداد بالرأي -حسب تعاليمنا الدينيّة- آفةً عظيمةً تزلُّ قدم الإنسان بها عن طريق الصواب، وتوقعه في المهالك. هذا مضمون ما رويَ عن الإمام أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام حيث قال: «الاستبدادُ بِرأيكَ يزلُّكَ ويهوّرُكَ فِي المهاوِي».
ولا ريب في أنّ الاستبداد في الرأي يقضي على الشخصيّة في الجمهور، ويُوقف حركة الفكر وتقدّمه، ويميت المواهب المستعدّة، بل يأتي عليها، وبهذا الطريق تُهدر أعظم طاقات الأمّة الإنسانيّة.
لذلك، فإنّ عاقبة الاستبداد بالرأي سيّئة، وترك المشورة في شؤون الحياة أمر لا خير فيه، وهو محض جهل بمستلزمات الأعمال لا سيّما ما يتعلّق منها بأمور المعيشَة، فالمُستبدّ برأيه سيكون بعيدًا كلّ البعد عن حُسن التَّدبير، بخلاف العاقل، فإن أمره كما قال الإمام عليّ عليهالسلام: «حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَدِيمَ الِاسْتِرْشَادَ، وَيَتْرُكَ الِاسْتِبْدَادَ».
يقول الله عَزَّتْ آلاَؤُه: ﴿وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ (آل عمران: 109)، حيث أكّدت هذه الآية المباركة على مشورة الجماعة (شاوِرْهُمْ)، ولكنّ القرار النهائيّ أوكلته إلى المُستشير، وقوله تعالى: (فَإِذا عَزَمْتَ) المراد فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله، وهذا الأمر إشارة إلى قضيّةٍ هامّةٍ تكمن في أنّ التطرّق إلى مختلف القضايا الاجتماعيّة، والسياسيّة، والثقافيّة، وغيرها، يجب أن يكون بشكلٍ جماعيٍّ ومشتركٍ، ولكن عند بلوغ مرحلة التطبيق، فمن الضروريّ أن يُتّخذ القرار من جانبٍ واحدٍ، وإلا سوف تعمّ الفوضى.
وهناك مسألةٌ هامّةٌ في هذا المضمار، هي: وجوب التوكّل على الله عند اتّخاذ القرار النهائيّ، وبدء الاستعداد لأداء العَمَل، فإن التوكّل يعطي الإنسان دفعةً معنويّةً تعينه على مواجهة أكبر المصاعب. لذلك، فالمشورة في مسائل الحياة، والمعيشَة، والتَّدبير، يجب أن تتزامن مع التوكّل على الله تعالى، فيتمّ تنفيذ العَمَل بإرادةٍ واحدةٍ، حيث تظهر آثار التوكّل في هذه المرحلة.
إنَّ اتّخاذ القرار هو اختيار أمرٍ من بين عدّة أمورٍ، ويتمّ ذلك عن طريق جمع المعلومات، وتحليل المعطيات بشكلٍ عمليٍّ، الأمر الذي يوسّع الأفق لحلولٍ متنوّعةٍ. وبالطّبع، هناك عدة مسائل لها تأثيرٌ في اتّخاذ القرار في موضوعٍ ما، نذكر منها ما يلي:
(61)- مطالعة المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتحليلها.
- معرفة حقيقة الموضوع.
- تشخيص الموضوع بشكلٍ صحيحٍ.
- سعة أفق التفكير.
- الحصول على حلولٍ مناسبةٍ.
- الاطّلاع على عيوب الموضوع ومحاسنه.
- معرفة أهمّيّة القرار.
ويمكن تشبيه اتّخاذ القرار بقارئ الأقراص المدمجة المصوّرة، حيث يستقبل المعلومات على شكل رموزٍ رقميّة، ثمّ يترجمها إلى صورةٍ وصوتٍ. فعمليّة اتّخاذ القرار تشمل دراسة جوانب الموضوع من كافّة النواحي وتقويمها، وبعد ذلك يتمّ الاختيار.
يوجد مجموعة من الشروط المؤثّرة في صحّة اتّخاذ القرار، حيث تتعلّق بشهامة صاحب القرار، وحزمه، وقدرته على إمضائه، وهذه الشروط نراها جليّةً في سيرة أنبياء الله تعالى عليهمالسلام ، ولا سيّما نبيّنا المصطفى محمّدصلىاللهعليهوآله والأئمّة من أهل بيته الكرام عليهمالسلام ، فهؤلاء العظماء لم يتماهلوا عن أداء واجباتهم
طرفة عينٍ، وكانوا أهلًا للمسؤوليّة، ففي المواقف الصعبة كانوا يتّخذون أصعب القرارات من دون تردّدٍ. ومن خلال حُسن تَّدْبيرهم، كانوا يختارون الطريق الأمثل في الحياة، وفي دعوة خَاتَم النَّبِيِّين صلىاللهعليهوآله التي دامت ثلاث وعشرين سنةً، نجد الكثير من القرارات الحاسمة التي اتّخذها بإرادةٍ حديديّةٍ غيّرت مجريات الأمور، ووجه العالم.
وكذلك هو الحال بالنسبة للإمام أمير المؤمنين علي عليهالسلام، وهو الذي قاتل على التأويل كما قاتل خَاتَم النَّبِيِّين على التنزيل، ففقأ عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيره، ولولاه ما قوتل الناكثون والقاسطون والمارقون.
لذا، فإنّ الخوفَ المُفرِط الذي لا يكون في محلّه، هو علامةٌ على ضعف الشخصيّة، وفقدان الإرادة، الأمر الذي لا يليق بأُولي الأمور، فالمدير أو المسؤول المقتدر والمدبّر في قضايا المعيشَة، هو الذي يتمكّن من اتّخاذ القرارات اللازمة بعزمٍ راسخٍ، متى ما رأى أنَّ المصلحة تقتضي ذلك. وبالتالي، فإنّه قبل أن يتَّخذ أيَّ قرارٍ، عليه القيام بما يلزم من مشورةٍ وتحقيقٍ، قدرَ المستطاع، بغية سلوك الطريق الصحيح، ومعرفة مكامنه، وحينها تكون قراراته صائبةً تُحمد عقباها. ويكون ثمرة ذلك النّجاح.
وأكّد أمير المؤمنين عليهالسلام على هذه الحقيقة، بقوله: «الظَّفَرُ بالْحَزمِ»، فالحزم في مجال المشورة، لتَّدْبير شؤون المعيشَة، لا بدّ أن ييسبقه العَمَل في إطار الليونة والمرونة، ولكن عند اتّخاذ القرار يجب الخروج من هذا الإطار، واتّخاذ جانب القطع والجزم. وهذه الاستراتيجيّة في تَّدْبير المعيشَة تعدّ سببًا لتنفيذ الأعمال في مواعيدها المقرّرة، وتقف حائلًا أمام أطماع الآخرين، كما أنّها تمهّد الأرضيّة اللازمة لنظم شؤون الحياة، وتمنع تدخّل الآخرين في الشؤون الخاصّة.
إنّ القرارات التي يتّخذها الإنسان هي على نوعين، هما:
- قراراتٌ ذات أهداف قصيرة الأمد: تتضمّن قضايا الحياة اليوميّة، وغالبًا ما تتكرّر.
- قراراتٌ استراتيجيّةٌ ذات أهداف بعيدة الأمد: وغالبًا ما تتأثّر بقضايا مجهولةٍ لم يحسب لها حسابٌ.
وعلى الإنسان قبل اتّخاذ أيّ قرارٍ، أن يأخذ بعين الاعتبار العواملَ ذات الصلة بالمعيشَة وسائر العوامل الهامّة، كالأوضاع الِاقْتِصَاديّة، فأحيانًا تكون القرارات مصيريّةً، ومن شأنها أن تقضي على كيانٍ ما بالكامل.
لا ريب في أنَّ الدخل المحدود، والإمكانيّات القليلة، وغلاء الأسعار، أمورٌ تحول دون قدرة الإنسان على تلبية جميع متطلّبات حياته. لذا، فإنّ حُسن التَّدبير في المعيشَة يقتضي تقنين إنفاق الأموال حسب الأولويّات التي تتطلّبها ظروف المعيشَة، أي يجب تسخير الأموال لتوفير المتطلّبات الضروريّة، أمّا الأمور الثانويّة، التي لا ضرورة لها، فتأتي في الدرجة الثانية في سُلّم الترتيب. فلو لم ينتهج الإنسان هذا النهج، ولم يُعِرْ أهمّيّةً لمتطلّبات حياته الضروريّة، ولم يقنّن كيفيّة صرف أمواله، خصوصًا إذا كان دخله محدودًا وثابتًا، فسوف يضطرّ إلى الاقتراض، وبالتالي فإنّ القرض يسبّب ضغوطًا تنهك حياة الفرد والأسرة. ومن هنا، تبرز أهمّيّة إيلاء الأولويّة لبعض الأمور الهامّة في المعيشَة. وقد رويَ عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنَّه قال: «إِنَّ رأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَيءٍ، فَفَرِّغهُ لِلمُهمِّ».
وهناك مسألتان هامّتان يجب التأكيد عليهما في هذا المجال، هما:
أ. ضرورة التصرّف بوعيٍ، وكَسْب معلوماتٍ لازمةٍ، في كيفيّة تسخير الأموال لموردٍ ما، وإنفاقها فيه. فعلى سبيل المثال: يجب العلم بمقدار الموادّ البروتينيّة اللازمة لجسم الإنسان، ومعرفة
مصادر هذه المواد ونوعيّتها، فمن خلال هذه المعلومات يمكن للإنسان أن يشتري ما يحتاج إليه من دون إسرافٍ.
ب. يجب كَسْب معلوماتٍ بخصوص أسعار البضائع والخدمات التي تقدّم في مختلف الأماكن، بغية اتّخاذ القرار المناسب.
وأصحاب الدخل المحدود لو لم يأخذوا هاتين المسألتين بعين الاعتبار، ولم يكن لديهم الاطّلاع الكافي على طريقة الاستهلاك الصحيحة، سوف لا يتسنّى لهم استثمار أموالهم بشكلٍ صحيحٍ، وبالتالي سيواجهون مصاعب في حياتهم.
أمّا الأثرياء، فإنّهم بفقدان هذا التقنين من خلال استهلاكهم المُفْرِط، سوف يتعرّضون لأضرارٍ قد لا يكون لها تأثيرٌ بالغٌ على المدى القريب، ولكن ستظهر آثارها السيّئة على المدى البعيد. فالتَّدْبير الصحيح يقتضي التدرّج في الإنفاق الصحيح، وتعيين الأولويّة في بذل الأموال، ففي بادئ الأمر، يجب الإنفاق في الموارد المهمّة، ثمّ الإنفاق في الموارد الأقلّ أهمّيّةً، وقد وجهنا الرَب تبارك وتعالى قائلًا: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الإسراء: 29).
يمكن تقسيم إنفاق الأموال، وتصنيف ذلك حسب الوقت
الذي يتمّ فيه الإنفاق، وحدّ الأموال التي يجب صرفها على المدى القريب -النّفقات الثّابتة- وعلى المديَين المتوسّط والبعيد،
فالنّفقات الثّابتة، هي التي يتمّ إنفاقها يوميًا، مثل: أجور المأكل، والتنقّل، وإيجار المنزل.
والنّفقات التي تُخصّص للاستهلاك في مدّةٍ طويلةٍ نسبيًا -على المدى المتوسّط- هي التي لا يتمّ إنفاقها يوميًا، مثل: ثمن الثياب، والأحذية، وما شابههم.
أمّا النّفقات التي تُخصّص للاستهلاك على المدى البعيد، فهي التي تؤثّر على اقْتِصَاد الأسرة، مثل: شراء منزلٍ، وسيارةٍ، وسائر الأجهزة المنزليّة.
وبالتأكيد لا يمكن توفير هذه النفقات شهريًا عن طريق الدّخل الشهريّ، لذلك يجب وضع منهجٍ مناسبٍ للنّفقات قريبة الأمد ومتوسّطة الأمد، يمكن من خلاله توفير النفقات بعيدة الأمد.
تُعدّ عمليّة تدوين النّفقات من الأمور الهامّة، لأنّها تُمكّن الإنسان من معرفة مقدار ما يحتاج إليه من أموالٍ في حياته، إذ
يسعى من خلالها إلى رفع مستوى دخله.
ومن هنا، فإنّ رفع مستوى الدَّخل منوطٌ بالعَمَل الجاد والسّعي الحثيث، لذا شجَّع الإسلام على ذلك، بشرط مراعاة الاعتدال والتوازن بين العَمَل والعبادة. ومن جانبٍ آخر، فإنّ الظُّروف المحيطة بالإنسان، والأسعار، ومستوى أجور العَمَل، تُعدّ من الأمور التي تؤثّر على معدّل الدخل، وهي خارجةٌ عن إرادة الإنسان، غير أنّ تغيير مقدار النفقات غالبًا ما يكون منوطًا بإرادة الإنسان.
أمّا تدوين النفقات اليوميّة، والأسبوعيّة، والشهريّة، والسنويّة، فيمكّن الإنسان من معرفة مدى الإنفاق المطلوب، وتحليل معطياته، فيعرف ما يحتاج إليه، لتأمين مؤونته، وكذلك يتمكّن من معرفة أهمّيّة هذه النفقات، ومدى تأثيرها على التوازن الماليّ لعائلته. لذا، فإنّ التدوين يعين الإنسان على وضع برنامجٍ مناسبٍ لنفقات العائلة، من أجل ضمان المستقبل.
إنّ الإنسان يكتسبُ الخبرة اللازمة في تنظيم نفقاته من خلال حُسن التَّدبير، والبرنامج المنظّم لأمور المعيشَة، في الموازنة بين متطلّبات الحياة والإمكانيّات المادّيّة المتوافرة، بعد إنفاق ما يلزم. لذلك، فإنّ تدوين مقدار النفقات وتحليلها، من شأنه أن يخفّف الضغط المادّيّ على العائلة ويوصله إلى أدنى مستوىً له، ويقلّص الشعور بالحرمان من السلع والخدمات
(68)التي يحتاجها.
كما أنّ استخدام الطريقة الصحيحة في تدوين النفقات، من شأنه أن يُقنِعَ أعضاء العائلة المعارضين لبرنامج الإنفاق المُتّبع، وهو بحدّ ذاته يحول دون الإسْراف.
وهناك مرحلة هامّةٌ في موضوع تدوين النفقات، تتأتّى في نهاية كلّ دورةٍ يتمّ تدوينها، حيث، لا بدّ من الاطّلاع على مقدار النفقات، وتقويم مدى صحّة الإنفاق أو عدمه. فإذا كان الدّخل
والإنفاق متوازنين، فهذا يدلّ على أنّ الخطط الِاقْتِصَاديّة صحيحةٌ.
ولكن، إذا كان الدخل والإنفاق غير متوازنين، أي كان الإنفاق أكثر من الدخل، يجب حينها تشخيص أسباب عدم الاتّزان، ومعرفة هل إنّه ناشئٌ من التضخّم والغلاء، أم من البذخ في الضيافة، أم من النّفقات غير الضروريّة، أم من سوء التَّدبير، أم إنّه ناشئ من أسباب وعوامل أخرى؟ وبعد معرفة هذه الأسباب، يجب التخطيط للمرحلة القادمة، واجتناب الأخطاء التي حصلت، لكي يتسنّى لربّ العائلة إيجاد توازنٍ بين مقدار الدخل والإنفاق، وبالتالي، تحقيق تناسقٍ مطلوبٍ بين أمور المعيشَة ومقدار نفقاتها. وهناك فوائد كثيرة لتدوين النفقات، نذكر منها ما يلي:
- تنظيم مستوى الإنفاق، وتحقيق ضبطٍ اقتصاديٍّ.
- معرفة متطلّبات الحياة، وتحديد الأولويّات اللازمة.
- استثمار الطاقات والإمكانيّات المُتَاحة، استثمارًا أفضل.
- الحؤول دون إهدار الطاقات والثروات المادّيّة.
- اجتناب الإسْراف والتَّبْذِير.
- معرفة قيمة النعمة.
- تمهيد الأرضيّة اللازمة للادّخار.
- الرقيّ مادّيًا ومعنويًا.
- تنامي روح القناعة لدى الإنسان.
- حصول توازنٍ بين الدخل والنفقات.
وقد عُبّر عن ما تقدم في الأحاديث الشريفة، بالتَّقدِير والتَّدبير، حيث قال الإمام الصادق عليهالسلام: «التَّقدِيرُ نِصفُ العيشِ»، ورويَ عن جدّه أمير المؤمنين عليهالسلام : «قِوامُ العيشِ حُسنُ التَّقدِيرِ، ومِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ».
إذًا، تدوين النفقات في مجالات الإنفاق العامّة -وكذلك
الخاصّة-، ووضع برنامجٍ صحيحٍ لمداولة الأموال في إطار نظامٍ اقْتِصَاديٍّ فرديٍّ وجماعيٍّ، يُعدّ حلًا ناجعًا للمشاكل الِاقْتِصَاديّة.
يُعدّ التخطيط لمختلف شؤون الحياة الِاقْتِصَاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، من أهمّ استراتيجيّات التَّدبير، وبالنسبة للعائلة، فالتخطيط من شأنه أن يكرس منهج حُسن التَّدبير في المعيشَة، وبالتالي يرسّخ الدعائم الِاقْتِصَاديّة للعائلة، ويكون عاملًا مساعدًا على تحقّق الحسابات الصحيحة في الدخل والإنفاق، وداعيًا لتنظيم أمور العائلة، ونجاح أفرادها في مساعيهم.
إذا لم يحدّد الإنسان مسلكه الصحيح، ولم يضع خطّةً مناسبةً، فإنّه لن يصل إلى هدفه أبدًا. وبعبارةٍ أخرى: عند انعدام التخطيط، أو عند اتّباع خطّةٍ غير صحيحةٍ، فإنّ الإنسان سوف يبتعد عن هدفه وربّما لا يتمكّن من بلوغه أبدًا. وفي بعض الأحيان يكون هذا الأمر سببًا للفقر والتخلّف، كما قال الإمام عليّ عليهالسلام: «سُوءُ التَّدبِيرِ مِفتاحُ الفَقرِ».
فالعائلة أو المؤسّسة التي تفقد حُسن التَّدبير والتخطيط الصحيح في برامجها المعيشيّة، لا شك أنها سوف تُحرَم من الخير الكثير. وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال: «أيُّهَا
النّاسُ، لا خَيرَ فِي دُنيا لا تَدبِيرَ فِيها».
ومن المؤكّد، أنّ التخطيط الصحيح وحُسن التَّدبير، يعدّان وسيلةً لكَسْب المال، والتمكّن من ادّخاره، ولكنّ سوء التَّدبير والتخطيط الخاطئ يحولان دون ذلك، بل قد يؤدّيان إلى اهدار ما في اليد من مالٍ، وتكون عاقبة الأمر كما قال الصادق عليهالسلام: «لا مالَ لِمَن لا تَقدِيرَ لَهُ».
يمكن تعريف التخطيط في العائلة، كما يلي: هو هدايةٌ عقلانيّةٌ وآليّةٌ لاتّخاذ القرار في مختلف شؤون الحياة، على المديَين القريب والبعيد، بغية استثمار الأموال، والإمكانيّات المتاحة بشكلٍ مناسبٍ، لتوفير متطلّبات العائلة. لذا يمكن تقسيم التخطيط في ثلاثة محاور:
1. التّخطيط القصير المدى: هو توجيه الأسرة نحو فعّاليّاتٍ معيّنةٍ وتنفيذها، وعادةً ما تكون نتائجه منطقيّةً خلال مرحلة التطبيق في فترةٍ قصيرةٍ، كما يُطلق عليه اصطلاحًا البرنامج التنفيذيّ، وزمان تنفيذ الخطط وأداء النشاطات في هذا البرنامج، لا يتجاوز سنةً واحدةً.
2. التخطيط متوسّط المدى: هو توجيه الأسرة نحو فعّاليّاتٍ مخطّطٍ لها مُسبقًا، وعادةً ما تكون مُستوحاة من البرامج بعيدة المدى، وبالنسبة لزمان تنفيذ الخطط في هذا البرنامج يكون خلال سنةٍ أو سنتين.
3. التخطيط بعيد المدى: وهو عبارةٌ عن توجيه الأسرة نحو فعّاليّاتٍ تتضمّن أهدافًا بعيدة الأمد، ويطلق عليه -أيضًا- اصطلاح البرنامج الاستراتيجيّ. وزمان تنفيذ الخطط فيه يتراوح بين خمس وعشر سنواتٍ.
وهناك أمورٌ لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للمعيشة، إذ لها تأثيرٌ كبيرٌ على نجاحه، ونذكر منها ما يلي:
- تحديد الأهداف المرجوّة من وراء البرنامج الذي تمّ وضعه بشكلٍ واضحٍ وشاملٍ.
- استشارة أفراد الأسرة، وكلّ من له صلةٌ بهذا البرنامج بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، وكذلك استشارة ذوي الخبرة في هذا الصدد.
- تشخيص القضايا الهامّة، ومعرفة الأولويّات اللازمة في شتّى المجالات.
- تحديد البرنامج حسب الإمكانيّات المتاحة، والقيام بدراسةٍ واقعيّةٍ للمصادر الِاقْتِصَاديّة.
(73)- جمع الحقائق والمعلومات عن آراء الآخرين وتجاربهم، التي لها صلةٌ بالبرنامج الذي تمّ وضعه.
- الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانيّة والاجتماعيّة، ودراسة ما قد يطرأ مستقبلًا.
- الاعتماد على النتائج الجديدة التي تمّ الحصول عليها، إثر التطوّرات الحديثة، وتجارب الآخرين، بغية الرقيّ بمستوى الخطّة الموضوعة، من خلال تشخيص الأخطاء، ومعرفة الطرق الصحيحة لمواجهتها.
(74)إنَّ طريقة التَّدبير في المعيشَة، هي الأسلوب الذي يتمّ من خلاله تنفيذ السياسات الاستراتيجيّة العامّة في أمور المعيشَة وإدخالها في حيّز الإجراء. وهذه الطريقة تشمل ثلاثة محاور أساسيّة ستكون مدار بحثنا في هذا الفصل، وهي: الدخل، والإنفاق، والادّخار.
ويراد به المبالغ اللازمة، لاقتناء المؤونة، وسائر الأموال التي يحظى بها الإنسان، أو مجموعةٌ من الناس، أو أيّ مؤسّسةٍ أو كيانٍ اقْتِصَاديٍّ في زمنٍ معيّنٍ. ومصدر الدخل قد يكون إنتاجيًّا، كأجرة العَمَل، والربح، والإجارة، أو قد يكون هديّةً أو أيّ مبلغٍ مدفوعٍ.
ويُعدّ الدخل من المواضيع الهامّة جدًا في علم الِاقْتِصَاد، وله تأثيرٌ ملحوظ على اختيار أسلوب الاستهلاك الأمثل، كونه عاملًا يحدُّ من كثرة الإنفاق، حيث إنّ الإنسان ذا الدخل المحدود لا يتمكّن من الإنفاق أكثر من وارده الماليّ، لأنّ التَّدبير في المعيشَة يُلزِمُه بتخصيص دخله الثّابت لشراء السّلعِ التي يحتاجها فحسب.
وفي دراستنا لموضوع الدّخل، سيتركَّز محور البحث عمومًا
(76)حول دخل الإنسان المسلم، وبيان ما إذا كان مصدر الدخل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أم لا.
إنّ مصادر الدخل حُدِّدت في حديث مروي عن الإمام عليّ عليهالسلام في خمسة محاور، حيث يقول سلام الله عليه: «إنَّ مَعايشَ الخلقِ خمسَةٌ، الإمارَةُ والعِمارةُ والتِّجارَةُ والإجارَةُ والصَّدَقاتُ».
وسائر الآراء التي يطرحها المتخصّصون في هذا الشأن ذكرت مصادر الدخل بشكلٍ عامٍّ، وبمصاديق متعدّدةٍ، بحيث تندرج جميعها تحت العناوين المذكورة في الحديث المتقدّم.
وبما أنّ الدخل من مواضيع الأحكام الإسلاميّة، فمن الضروريّ للمسلم أن يعلم مصدر تحصيل دخله، وكيف يحصل عليه، وأين ينفقه. والتَّدبير الصحيح في المعيشَة يقتضي دراسة أُطُر الدخل، وبيان أقسامه، ومشروعيّته، وأهمّيّته، لذا سنذكر في ما يلي بعض التفاصيل في هذا الشأن:
إنّ مقدار دخل الإنسان يختلف في كلّ زمانٍ ومكانٍ، والِاقْتِصَاد الإسلاميّ لم يعيّن معدّلًا مُحدّدًا له، لأنّ النشاط
الِاقْتِصَاديّ من ناحية الدخل والإنفاق للمسلم في عصر صدر الإسلام يختلف عمّا هو عليه في عصرنا هذا، حيث لا يمكن المقارنة بينهما. لذا، لا يمكن تعيين حدودٍ ثابتةٍ لمقدار الدخل، تكون متطابقة في مختلف الأزمنة، وإنّما يمكن تعيين نوعيّة الدخل لشتّى المجتمعات وفي جميع العصور
لذلك، فإنّ كلّ نظامٍ اقتصاديٍّ من شأنه تعيين الدخل حسب المعيار النوعيّ والأصول المتبنّاة فيه. ومن هذا المنطلق، فالنظام الِاقْتِصَاديّ في الإسلام حدّد الدخل من الناحية النوعيّة، وهذا التعيين سوف يُيسّر تحديد الكمّيّة أيضًا.
ومن الواضح أنّ قواعد التحديد النوعيّ للدخل تختلف في ما بينها في جوانب مختلفةٍ، ويتجلّى هذا الاختلاف في موارد عديدة. ومن هذه القواعد ما يلي: حرمة المعاملات التجاريّة المحرّمة، وحرمة اقتناء كلّ ما يترتّب على هذه المعاملات، وحرمة الرّبا، وحرمة صناعة الخمور، وحرمة القمار، وحرمة الاحتكار.
لذا، فإنّ تأثير التحديد النوعيّ للدخل لا يقتصر على نوعيّته فقط، بل له تأثيرٌ على كمّيّته -أيضًا-. وبالتالي، فإنّ هذا التأثير لا يعني عدم مزاولة النشاطات الِاقْتِصَاديّة، أو ترك مختلف
(78)المعاملات التجاريّة، والحؤول دون مكافحة الظلم والحرمان في المجتمع.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ قوانين الشريعة الإسلاميّة أقرّت حقّ الإنسان في طلب متاعه، والسعي في كَسْبه، ومنحته الحريّة الكاملة في اختيار طريقة الكَسْب، إلا أنّها منعته من سلوك طريقٍ منحرفٍ يؤدّي إلى فساده وسقوطه الخلقيّ، أو يتسبّب في المساس بمدنيّة البشر وحضارتهم. فالشريعة الإسلاميّة لم تحرّم جميع المنكرات والفواحش فحسب، بل إنّها حرّمت جميع الطرق التي تؤدّي إليها، كإنتاجها، والتوسّط بين الآخرين لتحصيلها، والمعاملة بها، واستخدامها بأيّ شكلٍ كان، وتصدت الروايات الشريفة فنهت بشكلٍ عامٍّ عن سلوك أيّ طريقٍ يؤدّي إلى تحقّق الفساد في المجتمع، ومن هذه الروايات، ما جاء عن الإمام الصادق عليهالسلام: «وأمّا وُجوهُ الْحَرَامِ، مِن البيعِ والشِّراءِ، فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيه الفسادُ مِمّا هو مَنهيٌّ عَنهُ، مِن جِهةِ أكلِهِ، وشُربِهِ، أو كِسبِهِ، أو نِكاحِهِ، أو مُلكِهِ، أو إمساكِهِ، أو هِبَتِهِ، أو عاريَتِهِ، أو شَيءٌ يَكونُ فيهِ وَجهٌ من وُجوهِ الفَسادِ».
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الأحاديث الشريفة أطلقت على اقتناء المال الْحَرَام عنوان (أكل السُّحت) وعدّته من كبائر الذنوب، إذ نهت عنه نهيًا شديدًا. لذا يجب القول: إنّ المراد من
أكل السُّحت لا يعني بالضرورة الأكل والشرب، بل يعني مطلق التصرّفات بالأموال المحرّمة، وعدم إرجاعها إلى أهلها، سواءٌ بتسخيرها للأكل والشرب، أم باقتناء أشياء أخرى بها، كثيابٍ أو منزلٍ، أم مطلق حيازتها وعدم إنفاقها. ففي جميع هذه الحالات يتحقّق موضوع أكل السُّحت، كما هو الحال في حرمة أكل مال اليتيم، والمال المكتسب من المعاملات الربويّة، حيث تحرم جميع أنواع التصرّف فيه.
أضف إلى ذلك أنّ المفهوم من لفظ (السُّحت) هو شموله لجميع أقسام المال الْحَرَام، أي إنّ كلّ مالٍ يكتسبه الإنسان من طريقٍ غير مشروعٍ يُعدّ أكلًا للسُّحت. وعلى سبيل المثال:
الشخص الذي يعمل في مجالٍ ما، ويتقاضى أجرًا مقابل عمله، لكنّه يقصّر في أدائه، هو آكل
للسُّحت. وكذلك الحال بالنسبة لمن ينفق أموال بيت المال في مصالحه الخاصّة.
يمكن تقسيم الدخل من حيث مصادر اكتسابه المختلفة إلى نوعين: دخلٌ مشروعٌ (حلالٌ)، ودخلٌ غير مشروعٍ (حرامٌ):
فالكَسْب الحلال: عبارةٌ عن الأموال التي يكتسبها الإنسان
من طرقٍ أجازها الشرع. فأُطُر المعاملات التجاريّة والنشاطات الِاقْتِصَاديّة وما تختصّ بها من شروط، ذُكِرَت في أحاديث وروايات مستفيضة تتمحور برمّتها حول وجوب الكَسْب الحلال، فيجب على الإنسان أن يُنفق من ماله الذي يمتلكه بشكلٍ لا يتعارض مع أحكام الشرع، فلو أنفق مالًا اكتسبه من طريقٍ محرّمٍ، فعليه إرجاعه إلى أصحابه، وإن أنفقه في معاملة، فإنّ معاملته باطلةٌ.
ومسألة الكَسْب الْحَرَام تُعدّ من المسائل المنهي عنها في حياة الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، لدرجة أنّ أحد أهمّ أبواب علم الفقه اختصّ بعنوان (المكاسب المحرّمة)، حيث تتمّ فيه دراسة طرق الكَسْب غير المشروعة حسب الرؤية الإسلاميّة، والتي تؤدّي إلى أضرار فرديّةٍ واجتماعيّةٍ، وتؤثّر سلبيًا على روح الإنسان وجسمه، وتلوّث أفكاره وأخلاقه، وتزلزل الأركان الِاقْتِصَاديّة لحياة الفرد والمجتمع معًا. ومن خلال هذه الأبحاث يمكننا تمييز الاختلاف بين المدرسة الِاقْتِصَاديّة الإسلاميّة مع سائر المدارس الِاقْتِصَاديّة.
هناك طرق عديدة يتمكّن الإنسان عبرها من زيادة دخله، وزيادة كَسْبه على مستويَين، محدودٍ وواسعٍ، نذكر بعضها في ما يلي:
(81)- كَسْب العلم، والتخصّص المهنيّ.
- استثمار الأموال بطريقةٍ صحيحةٍ من الناحيتين الكمّيّة والنوعيّة.
- وضع منهجٍ يضمن استثمار الحدّ الأقصى من الطاقة الإنتاجيّة.
- تذليل المصاعب التي تعترض طريق الإنتاج.
- إصلاح معدّات الإنتاج وتطويرها.
- التسويق الصحيح للبضائع والمنتجات.
- تحفيز العمّال والمنتجين على زيادة الإنتاج.
- السعي إلى رفع مستوى المهارات، بالاعتماد على المراكز العلميّة المتخصّصة، في وضع مناهج صحيحة، لرفع مستوى الإنتاج، وتحسين نوعيّته، وذلك يتمّ عبر التنسيق الصحيح بين المراكز الأكاديميّة ومراكز الإنتاج.
- إيجاد أجواءٍ آمنةٍ داخل البلاد وفي مناطقها الحدوديّة.
- مكافحة جميع مظاهر الانحراف، كالتّمييز العنصريّ، والظلم الِاقْتِصَاديّ، والاحتكار، والمحسوبيّات، والوقوف بوجه من يُهدِر الثروة العامّة بحزمٍ.
(82)يُعدّ الاستهلاك من الأبحاث الأساسيّة في مجال الِاقْتِصَاد. ويجدر بجميع أبناء المجتمع دون استثناء، ولا سيّما المسؤولون منهم، أن يعيروه أهمّيّةً بالغةً، وهو يعني تسخير المصادر المُتاحة، بغية تحقيق متطلّبات الحياة الراهنة والمستقبليّة، أو أنّه يعني تسخير السلع الِاقْتِصَاديّة في مجال الاستثمار.
فيجب على المسؤول المدبّر أن يتّبع المناهج الصحيحة في الاستهلاك، ليتمكّن من تحقيق متطلّبات الرعيّة على المستويَين الماديّ والمعنويّ، كما يجب عليه اجتناب الإسْراف والتَّبْذِير.
لقد خصّص علماء الِاقْتِصَاد حيّزًا واسعًا من دراساتهم لمسألة الاستهلاك، كونها تتمتّع بأهمّيّةٍ بالغةٍ بين جميع الشعوب والأمَم، بحيث لا تضاهيها أيّ مسألةٍ أخرى بين مختلف المفاهيم الِاقْتِصَاديّة، وكثير منهم يعتقد أنّ الهدف وراء جميع النشاطات الِاقْتِصَاديّة يكمن في الاستهلاك، كالتوفير، والإنتاج، وتوزيع الثروة.
ويُعدّ الاستهلاك هدفًا أساسيًّا في الإنتاج وتوزيع الثروة، إذ له بالغ التأثير في هذا المضمار. من هنا، وضع علماء
الِاقْتِصَاد أصلًا اقتصاديًّا بعنوان (سيادة المستهلك)، وفحواه: أنّ المستهلك هو الذي يعيّن الإطار اللازم للإنتاج، وتخصيص مصادره، ويحدّد طريقة توزيع الثروة. واستنادًا إلى هذه النظريّة، فإنّ الاستهلاك ليس محض تابعٍ للإنتاج والتوزيع، بل إنّ الانتاج والتوزيع تابعان له من جهةٍ ما. وبعبارةٍ أخرى: هناك علاقةٌ متبادلةٌ بين الاستهلاك من جهةٍ، وبين الإنتاج والتوزيع من جهةٍ أخرى: فالاستهلاك يُعدّ آليّةً هامّةً في كيفيّة الإنتاج.
ولا شكّ في أنّ السياسات الاستهلاكيّة الصحيحة -ترشيد الاستهلاك- لها تأثيرٌ بالغٌ على السياسات الِاقْتِصَاديّة، فمن شأنها إيجاد حافزٍ في أسواق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل العامّ.
ولترشيد الاستهلاك فوائد جمّة، فإضافةً إلى كونه منهجًا ضروريًا للادّخار والاستثمار، كذلك يُعدّ سببًا أساسيًّا للرقيّ الِاقْتِصَاديّ.
وهناك مسألةٌ هامّةٌ تجدر الإشارة إليها، وهي: أنَّ حاجات الإنسان المادّيّة تُعدّ المحور الأساس للنظريّات الِاقْتِصَاديّة في النظامين الرأسماليّ والاشتراكيّ، وعند انعدام الحاجات المادّيّة الضروريّة، فإنّ عمليّة الاستهلاك سوف تستمرّ من خلال إيجاد حاجاتٍ مادّيّةٍ كاذبةٍ. لكنّ الاستهلاك في النظريّة الإسلاميّة لا يختصّ بالحاجات المادّيّة فحسب، بل إنّ بعض متطلّبات
(84)الإنسان المعنويّة تعتبر سببًا لإيجاد دافعٍ لدى الإنسان في ذلك، أي أنّ دوافع الاستهلاك في النظام الإسلاميّ أوسع نطاقًا من النظامين الرأسماليّ والاشتراكيّ.
إنّ أُسس الاستهلاك الأمثل في النظريّة الإسلاميّة هي عبارة عن التعاليم التربويّة السامية التي تشكّل منهجًا صحيحًا ومتكاملًا لتَّدْبير المعيشَة، ويمكننا التعرّف عليها من خلال القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وسنشير إلى بعضها في ما يلي:
«السّرف هو تجاوز الحدّ في كلّ فعلٍ يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر». ونستلهم من آيات القرآن الكريم أنّ الإسْراف يقابل التَّقتير، حيث قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقَتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوامًا﴾ (الفرقان: 67).
وتؤكّد تعاليمنا الدينيّة على أنّ الإسْراف من الأعمال الذميمة جدًا، حيث نهى القرآن الكريم عنه نهيًا شديدًا، فالله تعالى عدّه من السُّنَن الفرعونيّة: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى
خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (يونس: 83). وتوعّد المسرفين بعذابٍ أليمٍ: ﴿لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (غافر: 43).
والإسْراف في استهلاك الموارد الطبيعيّة تعدّيًا على حقوق الآخرين، وإهدارًا للثروة العامّة التي هي حقٌّ لجميع البشر والأجيال كافة. وحسب الرؤية الإسلاميّة، فإنّ نتيجة الإسْراف والإنفاق المفرط ليست سوى إهدار الثروة العامّة، وبالتّالي حرمان الشّعب منها. قال الإمام عليّ عليهالسلام في هذا الشأن: «السَّرفُ مَثواةٌ»؛ أي أن السَّرف آلة للتلف والتسبب بالخسارة.
يُعدّ الإسْراف خروجًا عن مستوى التوازن، أي عن حكم العقل والإذعان لأهواء النَّفْس. فهو إهدارٌ للنعمة التي أكرم الله تعالى بها عباده، لإمرار معاشهم. ونتيجة هذا الإهدار هي البعد عن رحمة الله تعالى ورضوانه.
فكما أنّ للمجتمع حقًا في الأموال العامّة، كذلك فإنّ له حقًّا -أيضًا- في أموال الناس الخاصّة، وبما أنّ الإسْراف يُعدّ تعدّيًا على حقوق المجتمع، فالنتيجة أنّ الإسْراف في الأموال الخاصّة غير جائزٍ.
يقول العلامة الشهيد مرتضى المطهّري رحمه الله في هذا الصدد: «إنَّ الإسْراف، والتَّبْذِير، وأيّ استخدامٍ غير مشروعٍ للأموال، ممنوعٌ. والمنع هنا ليس ناشئًا من حرمة هذا العَمَل فحسب، بل لأنّه -أيضًا- يُعدّ تصرّفًا في الثروة العامّة من دون إذنٍ. فهذا المال، وإن كان خاصًا، فهو متعلّقٌ بالمجتمع -أيضًا».
فضلًا عن ذلك، ونظرًا لمحدوديّة المصادر الِاقْتِصَاديّة، فإنّ الإسْراف هو سبب لحرمان بعض الناس من تلك المصادر. وكذلك، فإنّ اعتياد الإنسان على الإسْراف سيجعل منه شخصًا أنانيًا وبعيدًا عن المثل العليا التي أرادها الله تعالى من عباده. والأصل -على أساس النظرة التوحيديّة-، أنّ الله تبارك وتعالى هو المالك الأصليّ، ونحن جميعًا مستخلفون من قبله، وكلّ نوعٍ من التصرّف من دون إذنه ورضاه، فهو قبيحٌ وغير مقبولٍ، ونحن نعلم أنّ الله تعالى لم يأذن بالإسْراف ولا بالبخل.
المراد من الإسْراف تجاوز الحدّ في الإنفاق، أي أنّ الإنسان يتجاوز المستوى المتعارف في إنفاق المال، فينفق أكثر من حاجته، ويسرف في ذلك. فعلى سبيل المثال: شخص لا
يتقاضى في اليوم أكثر من دولارين، لكنّه يشتري لنفسه ولأسرته ثيابًا بمئات الدولارات. وقد تطرّق الإمام الصادق عليهالسلام لهذا الأمر، فقال: «ربّ فقير هو أسرف من الغني، إنّ الغني ينفق ممّا أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي».
وهذه الرواية تشير إلى بعض الموارد النادرة التي لا يتّبع فيها الفقير برنامجًا صحيحًا في مَعِيشَتَه، وذلك حينما ينفق ما يكَسْبه من مالٍ يسيرٍ في مسائل لا تتناسب مع وضعه الماديّ، وبالتالي يُهدرِ دخله، بسبب إسرافه. وبالتأكيد، فإنّ هذا الفعل بالنسبة للأثرياء قد لا يكون إسرافًا، إذ أنَّ إسرافهم يتحقّق عبر إنفاقهم الأموال في أمورٍ أشدّ فداحة ممّا فعله هذا الفقير.
ومن هنا، يتّضح أنّ معيار حقيقة الإسْراف نسبيّ، حيث تكون بعض مصاديق الإنفاق الصادرة من بعض الأفراد مؤدّية إلى الوقوع في الإسْراف، ولكنّها ليست كذلك بالنسبة للبعض الآخر، فبعض موارد الإنفاق التي لا يعدّها العرف تجاوزًا عن حدّ الاعتدال، بينما يعدّها العقل تجاوزًا عن ذلك، لا تُعدّ من أمثلة الإسْراف، ولكنّه نُهي عنها في بعض الأحاديث، منها: قول الإمام الصادق عليهالسلام: «إنَّ القصدَ أمرٌ يُحبُّهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، وإنَّ السَّرفَ أمرٌ يُبغضُهُ اللهُ عزَّ وجلَّ حتّى طرحَكَ النَّواةَ، فإنِّها تَصلحُ لشيءٍ وحتّى صبَّكَ فَضلَ شَرابِكَ»؛ بينما هذه الأفعال لا يعدّها العرف اليوم إسرافًا.
ما يشير إلى أنّ الإسْراف مسألةٌ نسبيّةٌ، هو اختلاف معدّل الإنفاق من مجتمعٍ إلى آخر، لأنّ مستوى رفاهيّة الشعب ورقيّه الِاقْتِصَاديّ أو تدنّي مستواه المعيشيّ مختلف من بلدٍ إلى بلدٍ. فلربّما اقتناء بعض السلع والمؤن أو تقديم بعض الخدمات، يُعدّ تجاوزًا عن الحدّ المتعارف في أحد المجتمعات النامية، لكنّه ليس كذلك في مجتمعٍ متطوّرٍ، لذا يمكن القول: إنَّ الإسْراف مسألةٌ نسبيّةٌ.
والحال كذلك بالنسبة لاختلاف الزمان وتنوّع المسؤوليّات، أي حينما يتمتّع الناس بحياةٍ مرفّهةً في زمانٍ ما، ويشهد مجتمعهم تناميًا اقتصاديًا، فسوف يحظون بحياةٍ أفضل، وبإمكانهم اقتناء سلعٍ أكثر وذات جودةٍ عاليةٍ، وهذا بدوره لا يعدّ إسرافًا، لكن بشرط عدم الإفراط والطغيان. ومن هنا، لو حاول البعض في هذه المجتمعات المرفّهة الإعراض عن نعم الله تعالى، وقيّدوا أنفسهم بحياة الفقر، والعوز، وارتداء الخرق من الثياب، فإنّ زهدهم هذا يحمل على الرياء. فالبعض قد يغفل عن حقيقة الحكمة العَمَليّة في الإسلام، وهؤلاء موجودون في كلّ عصرٍ ومكانٍ، إذ أنّ ضيق إطار أفكارهم يحفّزهم على مؤاخذة الآخرين جهلًا، حتّى أنّهم قد يعترضون على الأئمّة المعصومين عليهمالسلام. فقد رويَ أنّ سفيان الثوري دخل على الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
فرأى عليه ثيابًا بيضاء ناعمة، فقال له: إنّ هذا اللباس ليس من لباسك، فأجابه عليهالسلام: «اسمَعْ مِنِّي وعِ ما أقولُ لَكَ، فإنَّهُ خَيرٌ لَكَ عاجِلًا وآجِلًا إنْ أنتَ مِتَّ عَلَى السُّنَّةِ ولَم تَمُتْ عَلَى بِدعَةٍ، أُخبِرُكَ أنَّ رسولَ اللهِ صلىاللهعليهوآله كانَ فِي زَمانٍ مُقفِرٍ جَدبٍ، فَأمّا إذا أقبَلَتْ الدُّنيا فَأحَقُّ أهلِها بِها أبرارُها لا فُجّارُها، ومؤمِنُوها لا مُنافِقُوها، ومُسلمُوها لا كُفّارُها، فَما أنكرتَ يا ثَوريّ؟! فَوَاللهِ إنِّي لَمَعَ ما تَرِى ما أتَى عَلَيَّ مُذ عَقِلت صباحَ ولا مساءَ وللهِ فِي مالِي حَقٌّ أمرَنِي أنْ أضَعهُ مَوضِعًا، إلا وَضَعتُهُ».
كما روى عليّ بن أسباط أنّ سفيان الثوريّ قال للإمام الصادق عليهالسلام: يُروى أنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يلبس الخشن من الثياب، وأنت تلبس القوهي المَرْوي! فقال له عليهالسلام: «وَيحَكَ، إنَّ عَليًّاعليهالسلام كانَ فِي زَمانِ ضِيقٍ، فَإذا اتَّسَعَ الزَّمانُ، فَأبرارُ الزَّمانِ أولَى بِهِ».
فذوي الفكر المتشدد، يعتبرون ارتداء الإمام المعصوم عليهالسلام الثياب الحسنة تجاوزًا عن الحدّ المتعارف عليه في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام، بينما هذا الأمر الذي لم يكن رائجًا في الأزمنة السالفة، صار متعارفًا عليه في ذلك العهد.
إذًا، لا بدّ أن تكون أفعال الإنسان وطريقة مَعِيشَتَه مُنسجمةً مع مُقتضيات زمانه، فالإسْراف مسألةٌ نسبيّةٌ!
والجدير بالذكر، أنّ بعض موارد الإنفاق تقتضي بذل أموالٍ
كثيرةٍ، ولا يعدّ ذلك إسرافًا، لأنّ إنفاق المال بكثرةٍ -أحيانًا- يكون سببًا لحفظها، وهو بالتالي جزءٌ من حُسن التَّدبير في المعيشَة، كاقتناء ثيابٍ مختلفةٍ لأغراضٍ مختلفةٍ، مثل: الثياب المخصّصة للنوم أو للعمل أو للسفر أو للضيافة، أو ما يُرتدى في مختلف فصول السنة، وهذا الأمر لا يعتبر إسرافًا، حيث إنّه من ضرورات التَّدبير في المعيشَة. رُوي عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الإمام الكاظم عليهالسلام: الرجل يكون له عشرة أقمصةٍ، أَيكون ذلك من السَّرف؟ فقال عليهالسلام: «لا، ولكِنَّ ذلِكَ أبقَى لثِيابِهِ، ولكِنَّ السَّرفَ أنْ تَلبَسَ ثَوبَ صَونِكَ فِي المكانِ القَذِرِ».
لذلك، فإنّ اقتناء ثيابٍ بداعي الحاجة إليها حسب مقتضيات الزمان، لا يُعدّ من الإسْراف بوجهٍ، لأنّها تستخدم عند الحاجة إليها، على العكس من ذلك، الذين يفرطون في امتلاك أنواع الثياب، ويكدّسونها في خزانتهم، بحيث لا يحتاجون إليها كافّة، فهذا هو الإسْراف بعينه.
التَّبْذِير: التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير لكلِّ مُضيِّعٍ لماله، فتَّبْذِير البذر: تضييعٌ في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه.
والتَّبْذِير يخصّ الحالات التي يصرف فيها الإِنسان أمواله
بشكلٍ غير منطقيٍّ وفاسدٍ. وبتعبيرٍ آخر: هو هدر المال في غير موقعه، ولو كان قليلًا، بينما إذا صُرِفَ في محلِّه، فلا يُعدّ تبذيرًا، ولو كان كثيرًا.
لذا، فإنّ إهدار المال وإنفاقه عبثًا يُعدّ من الأفعال المحرّمة دينيًا، سواءٌ أكانت هذه العبثيّة من الناحيّة الكمّيّة أم من الناحية النوعيّة، إذ يجدر بالإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب النوعيّة لمؤونته التي يقتنيها، ومدى كفاية المصادر الإنتاجيّة والخدماتيّة التي يعتمد عليها في مَعِيشَتَه، أي أنَّ عليه تسخّير كلّ مصدرٍ إنتاجيٍّ أو خدماتي، بطريقةٍ يمكنه معها بلوغ أقصى درجات الاستثمار، لكي يستغلّ طاقته الكامنة بشكلٍ أمثل.
والقرآن الكريم بدوره عَدَّ المبذّرين إخوانًا للشياطين: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (الإسراء: 27).
إنَّ الله تعالى أعطى الشيطان قدرةً وقوّةً، وذكاءًا سلبيًّا خارقًا للعادة، ولكنّ الشيطان استفاد من هذه الأُمور في غير محلِّها، أي في طريق إغواء الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم. أمّا كون المبذّرين إخوان الشياطين، فذلك لأنّهم كفروا بنعم الله، حيث وضعوها في غير مواضعها تمامًا، كما فعل الشيطان، ثمّ إنّ استخدام (إخوان) تعني أنّ أعمالهم متطابقةٌ ومتناسقةٌ مع
أعمال الشيطان كالأخَوين اللَّذَين تكون أعمالهما متشابهةً.
لكلمَتي الإسْراف والتَّبْذِير معنىً واسعًا جدًّا يتجلّى في الأفعال اليوميّة للبشر، وقد تطرّقت النصوص الدينيّة إلى ذكرها بشكلٍ مجملٍ أو مفصّلٍ، نشير إلى بعضها في ما يلي:
- المأكل والمشرب: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).
- الإنفاق والعطاء الذي يتجاوز الحدّ المتعارف: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾ (الإسراء: 27).
- طلب المقام والاستكبار في الأرض: ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الدخان: 30-31).
- تجاوز الحدّ في القصاص: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء: 33).
- ارتكاب المعاصي: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر: 53).
- القضاء بين الناس بغير حقٍّ: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (غافر: 28).
ورُوي عن النَّبِيّ صلىاللهعليهوآله أنّه مرَّ بسعد، وهو يتوضّأ، فقال له: «ما هذا السّرفُ يا سَعدُ؟!». قال سعد: أَفي الوضوء سرفٌ؟ فأجابه النَّبِيّ صلىاللهعليهوآله: «نَعَم، وإنْ كُنتَ عَلَى نَهرٍ جارٍ».
وروي عنه صلىاللهعليهوآله: «الخلْقُ عِيالُ اللهِ»، وكذلك هم أُمناؤه على ماله. وعليه، يتوجّب على الإنسان أن يُنفق أمواله في ما فرضه الله بتسخيرها لقضاء حوائجه وتلبية متطلّبات مَعِيشَتَه. لذلك، فإنّ الإنفاق الزائد عن الحاجة، يُعدّ إتلافًا للمال، وسوء تصرّفٍ فيه، بما يؤدّي إلى الإسْراف والتَّبْذِير، وحسب بعض الروايات، فإنّ الإسْراف والتَّبْذِير يتحقّقان حتّى في طرح نواة التمر، وما فَضُل من الماء، أو ارتداء ثيابٍ فاخرةٍ أثناء العَمَل، أو اقتناء سلعٍ لا نفع منها.
فالبناء الذي يمكننا أن نقطنه أو نسخّره لمنافع أخرى، لا يجوز لنا تخريبه لمجرّد عدم مطابقته لموضة العصر، فهذا الخراب هو التَّبْذِير بعينه. وتدمير البستان الذي يمدنا سنويًا بمحاصيل زراعيّةٍ وثمار طريّةٍ، وتشييد أبنيةٍ محلّه، يُعدّ تبذيرًا -أيضًا-، حيث يمكننا أن نُشيّد هذا البناء في الأراضي الفسيحة الموجودة في ضواحي المدينة، والتي هي أقلّ ثمنًا وأكثر مساحةً. كما أنّ عدم صيانة المباني حتّى تندرس، هو في الحقيقة تبذيرٌ أيضًا.
وحسب أحكام الفقه الإسلاميّ، يجب على مَن يمتلك حيوانًا أن يوفّر له الماء والكلأ، وإذا لم يتمكّن من ذلك، عليه أن يُطلقه، ليرعى، وإذا لم يفعل، فإنّ حاكم الشرع يرغمه على ذلك، وإذا لم يستجب لهذا الأمر، فإنّ حاكم الشرع يتولّى ذلك. وبالطبع فإنّ ملكيّة الإنسان لماله تتيح له حرّيّة التصرّف فيه، لكنّ هذا التصرّف محدودٌ، إذ لا يجوز له أن يتلف ماله عامدًا.
إذًا، يتّضح لنا ممّا ذُكِرَ سعة نطاق الإسْراف والتَّبْذِير، ويجدر بالإنسان العاقل أن يراعي الدقّة والاعتدال في إنفاقه، ليصون نفسه من الإثم والزلل في هذا المجال.
تستعمل مفردتا الإسْراف والتَّبْذِير في كثير من الأحيان بمعنىً
واحدٍ، حيث يعطف أحدهما على الآخر، توكيدًا، ونلاحظ ذلك في قول الإمام عليّ عليهالسلام: «ألا وَإنَّ إعطاءَ المالِ فِي غَيرِ حَقِّهِ تَبذِيرٌ وَإسرافٌ، وَهوَ يَرفَعُ صاحبَهُ فِي الدُّنيا، وَيضَعُهُ فِي الآخِرةِ، ويُكرِمُهُ فِي النّاسِ، وَيُهينُهُ عِندَ اللهِ».
في الواقع، لا يوجد هناك بحثٌ واضحٌ عند المفسّرين في التفاوت الموجود بين الإسْراف والتَّبْذِير، ولكن عند التدبر بأصل هاتين الكلمتين في اللغة، يتبيَّن أنّ الإسْراف، هو: الخروج عن حدّ الاعتدال، ولكن دون أن نخسر شيئًا، فمثلًا نلبس ثوبًا ثمينًا، بحيث يعادل ثمنه أضعاف سعر الملبس الذي نحتاجه، أو أنّنا نأكل طعامًا غاليًا بحيث يمكننا إطعام عددٍ كبيرٍ من الفقراء بثمنه. كلّ هذه أمثلةٌ على الإسْراف، وهي تمثّل خروجنا عن حدّ الاعتدال، ولكن من دون أن نخسر شيئًا. أمّا كلمة (تبذير)، فهي تعني: الصرف الكثير، بحيث يؤدّي إلى إتلاف الشيء وتضييعه، فمثلًا نهيّئ طعامًا يكفي لعشرة أشخاصٍ من أجل إطعام شخصين، كما يفعل ذلك بعض الجهلاء، ويعتبرون ذلك فخرًا، حيث يرمون الطعام الزائد في المزابل.
وفي النتيجة إنّ إنفاق كلّ مالٍ في غير طاعة الله تعالى، هو في حقيقته إسرافٌ وتبذيرٌ، كما روي عن الإمام الصادق عليهالسلام:
«مَن أنفَقَ شَيئًا فِي غَيرِ طاعَةِ اللهِ، فَهوَ مُبَذِّرٌ، وَمَن أنفَقَ فِي سَبيلِ اللهِ، فَهوَ مُقتَصِدٌ».
تطرّقنا آنفًا إلى بعض نتائج الإسْراف والتَّبْذِير السيّئة، وهناك نتائج أخرى، مثل: ابتلاء المجتمع بالاختلافات الطبقيّة. فأصحاب الدخل العالي يستولون على مقادير كبيرةٍ من الثروة العامّة، ويهدرونها في لهوهم وعبثهم، بينما هناك كثير من أصحاب الدخل المتدنّي الذين يعيشون حياةً ماديّةً صعبةً، ولا يملكون ما يسدّ رمقهم. والسبب في ذلك يعود إلى الكمّيّة الكبيرة من الأموال التي يمتلكها أولئك الأثرياء وطريقة مَعِيشَتَهم التي يعتمدونها، أي أنّ طبيعة الإسْراف والتَّبْذِير -في الأموال والمؤونة- التي تسود أفعالهم تؤدّي إلى عدم مبالاتهم بالمجتمع، وتبديد ثرواته، وإعراضهم عن تقديم خدماتٍ لأبناء جلدتهم، وعدم توفير متطلّبات مَعِيشَتَهم.
ومن النتائج السيّئة الأخرى للإسْراف والتَّبْذِير، ابتلاء الفرد والمجتمع بالفقر والحرمان. فالمُسرَف الذي لا يُحسن التَّدبير في مَعِيشَتَه، قد يُبتلى بالفقر، بسبب إسرافه، وبالتالي لا يتمكّن من تأمين متطلّبات مَعِيشَتَه. يقول الإمام الصادق عليهالسلام في هذا
الشأن: «إنَّ السّرفَ يُورِثُ الفَقرَ، وَإنَّ القَصدَ يُورِثُ الغِنَى».
وكذلك، فإنّ عددًا من المسرفين قد يؤثّرون سلبيًّا على المجتمع برمّته إثر إسرافهم وإهدارهم الثروة العامّة، ليكون سوء تصرّفهم موجبًا لحرمان المجتمع، ورواج الفقر فيه.
وبتحريم الإسْراف والتَّبْذِير، والمنع من اكتناز الأموال، والتشجيع على الإنفاق، فإنّ ديننا الإسلاميّ يكون كفيلًا بوضع منهج مناسب لاجتثاث الفروقات الطبقيّة من المجتمع، إذ يتمّ ذلك عبر إتاحة الفرصة للطبقة المحرومة، لاستثمار ما كان زائدًا عن حاجة الأثرياء، الأمر الذي يؤدّي إلى تقليص الفارق الطبقيّ، ورفع المستوى المعيشيّ للفقراء. فلو دقّقنا في إسراف بعض المترفين وعبثهم بالأموال، لوجدنا قطعًا أنّ اجتناب هذه التصرّفات من شأنه أن يسدّ رمق الكثير من المحرومين، كذلك فإنّ المباني الشاهقة والقصور الضّخمة التي يشيّدها هؤلاء الأثرياء والتي تحفل بالكثير من الأمتعة والأغراض الفائضة عن الحاجة، يمكن الاستعاضة عنها بما هو أنسب، لاستثمار الفاضل منها، لبناء منازل بسيطةً تؤوي من لا قدرة له على اقتناء منزلٍ، فأصحاب القصور عادةً لا ينتفعون إلا من جزءٍ محدودٍ منها.
والقرآن الكريم بدوره أنّب المسرفين والمبذّرين تأنيبًا شديدًا،
وذمّ تصرّفاتهم في موارد كثيرة، حيث أكّد على أنّهم سيُحرَمون من محبّة الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام: 141). كما قال تعالى في الأمر نفسه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).
وشبّههم في آيةٍ أخرى بالشياطين الذين عاقِبتهم جهنّم وبئس المصير: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (الإسراء: 26-27).
وأشار القرآن إلى سوء عاقبتهم ووجوب عذابهم: ﴿لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (غافر: 43). وإلى أنّ عاقبتهم هي الهلاك: ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنبياء: 9).
نهى القرآن الكريم عن اتّباع المسرفين، وشبّه إسرافهم بالفساد في الأرض وعدم إصلاحها، في قوله تعالى: ﴿وَلا
تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُون﴾ (الشعراء: 151-152)، فـ(الإسْراف) هو التجاوز عن حدّ قانون التكوين وقانون التشريع، ومن الواضح أيضًا أنّ أيّ تجاوزٍ عن الحدّ موجبٌ للفساد والاختلال، وبتعبيرٍ آخر: إنّ مصدر الفساد هو الإسْراف، ونتيجة الإسْراف هي الفساد أيضًا.
وللعلَّامة السيِّد محمّد حسين الطباطبائيّ رحمه الله بيانٌ رائعٌ في هذا المجال، حيث قال: «وذلك أنّ الكون على ما بين أجزائه من التضادّ والتزاحم، مؤلّفٌ تأليفًا خاصًا يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعضٍ في النتائج والآثار، كالأمر في كفّتي الميزان، فإنّهما على اضطرابهما واختلافهما الشديد، بالارتفاع والانخفاض، متوافقتان في تعيين وزن المتاع الموزون، وهو الغاية والعالم الإنسانيّ الذي هو جزءٌ من الكون. كذلك الفرد من الإنسان، بما له من القوى والأدوات المختلفة المتضادّة مفطورٌ على تعديل أفعاله وأعماله، بحيث تنال كلّ قوّةٍ من قواه حظّها المقدّر لها، وقد جُهِزّ بعقلٍ يميّز بين الخير والشرّ، ويعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه. فالكون يسير بالنظام الجاري فيه إلى غاياتٍ صالحةٍ مقصودةٍ، وهو في ما بين أجزائه من الارتباط التامّ يخطّ لكلٍّ من أجزائه سبيلًا خاصًا يسيّر فيها بأعمالٍ خاصّةٍ، من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمينٍ أو يسارٍ، أو ينحرف بإفراطٍ
أو تفريطٍ، فإنّ في الميل والانحراف، إفسادًا للنظام المرسوم، ويتبعه إفساد غايته وغاية الكلّ. ومن الضروريّ أنّ خروج بعض الأجزاء عن خطّها المخطوط لها، وإفساد النظم المفروض لها ولغيرها، يستعقب منازعة بقيّة الأجزاء لها، فإن استطاعت أن تقيمه وتردّه إلى وسط الاعتدال فهو، وإلا أفنته وعفت آثاره، حفظًا لصلاح الكون، واستبقاءاً لقوامه. والإنسان الذي هو أحد أجزاء الكون، غير مستثنىً من هذه الكلّيّة، فإن جرى على ما تهديهِ إليهِ الفِطرَة، فاز بالسعادة المقدّرة له، وإن تعدّى حدود فِطرَته وأفسد في الأرض، أخذه الله سبحانه بالسنين، والمثلات، وأنواع النكال والنقمة، لعلّه يرجع إلى الصلاح والسداد. قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِما كَسِبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: 41).
وإن أقاموا مع ذلك على الفساد، لرسوخه في نفوسهم، أخذهم الله بعذاب الاستئصال، وطهّر الأرض من قذارة فسادهم».
إنّ البخل والتقتير (التفريط في الإنفاق) مفهومان يتضادّان مع الإسْراف والتَّبْذِير (الإفراط في الإنفاق). وهذه الخُلق مذمومةٌ
جملةً وتفصيلًا، لأنّ فيها انحرافًا عن الاعتدال في الإنفاق الذي أكّد عليه الله سبحانه في كتابه المجيد، حيث نهى عن البخل والإسْراف، وأوصى الناس باتّباع الوسطيّة في الإنفاق: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقَترُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوامًا﴾ (الفرقان: 67).
والطريف أنّ البخيل، وإن كان ثريًا، فإنّه لا يحيى حياةً كريمةً، ويحرم نفسه وأهله ممّا يحتاجون إليه رغم استطاعته توفيره، وقد نهى الإمام الصادق عليهالسلام عن طلب العون من هذا الشخص بقوله: «تُدخِل يَدَكَ فِي فَمِ التنِّينَ إلى المِرْفَقِ خَيرٌ لَكَ مِن طَلَبِ الحوائجِ إلى مَن لَم يَكُن لَه فَكانَ»، فهذا الوصف كنايةٌ عن رسوخ البخل والتقتير في نفوس بعض الناس.
كما أنّ التعاليم الإسلاميّة قبّحت هذه الخصلة الرديئة، لأنّ البخيل -في الحقيقة- يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، حيث يمتنع من إنفاق بعض أمواله لقضاء حوائجه، ولا ينتفع منها، ليتمتّع بها الآخرون بعد موته! وقد أشار الإمام عليّ عليهالسلام إلى هذه الحقيقة بقوله: «البَخيلُ يَبخلُ عَلَى نفسِهِ باليَسيرِ مِن دُنياهُ، وَيَسمَحُ لوِرّاثِهِ بِكُلِّها»، وعنه عليهالسلام: «البَخيلُ خازِنٌ لِوَرَثَتِهِ».
والثريّ البخيل يعيش في الدنيا حياة الفقراء، ويعاني كما
يُعانون! بينما يُحشر يوم القيامة في زمرة الأثرياء ويُحاسب حسابهم! قال الإمام عليّ عليهالسلام : «عَجِبتُ للبَخيلِ الّذِي استَعجَلَ الفَقرَ الّذِي مِنهُ هَرَبَ، وفاتَهُ الغِنَى الّذِي إيّاهُ طَلَبَ، يَعيشُ فِي الدُّنيا عَيشَ الفُقَراءِ، ويُحاسَبُ فِي الآخِرةِ حِسابَ الأغنِياءِ!».
وهو أشر الناس حسب وصف الإمام الصادق عليهالسلام : «شِرارُكُم بُخَلاؤكُم»، وبالتالي، فهو محرومٌ من جنان الخلد، الأمر الذي أكّد عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله: «حُرِّمَت الجنَّةُ عَلَى المنّانِ، وَالبَخِيلِ، والقتّاتِ»، وبالطبع، فإنّ عاقبته النار، طبقًا لما رويَ عن النبيّ المُختارصلىاللهعليهوآله حيث قال: «السخيّ قريب من الله تعالى، وقريب من الناس، وقريب من الجنّة بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنّة قريب من النار».
أجازت الشريعة للناس استثمار نِعَم الله تعالى بطريقةٍ معقولةٍ، حسب الضوابط والشروط التي حدّدتها لهم، كمشروعيّة مصادر الدخل، واجتناب الإسْراف والتَّبْذِير، وأداء حقوق الآخرين، والله تعالى ذكر بعض نِعَمه، وحفّز الناس
للانتفاع منها، ودعا إلى شكره عليها، كما جاء في قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (سبأ: 15)، وقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (الضحى: 11).
كما أنّ كثيرًا من الروايات الشريفة قد أكّدت بدورها على ضرورة شكر نِعَم الله، والاعتراف بها، وذمّت إنكارها، والتظاهر بالفقر والحرمان. فلو أنعم الله تعالى على إنسانٍ نعمةً وجَب عليه الاعتراف بها، وعدم التظاهر أمام الناس بأنّه محرومٌ. وقد روي عن الإمام الصادق عليهالسلام: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ الجمالَ وَالتَّجَمُّلَ، وَيُبغِضُ البُؤسَ والتَّباؤسَ، فَإنَّ اللهَ إذا أنعَمَ عَلَى عَبدِهِ بِنعمَةٍ أحَبَّ أنْ يَرَى عَلَيهِ أثَرَها».
وتوصي تعاليمنا الدينيّة باستثمار النعمة، والترفيه عن النَّفْس، والتجمّل وفق القواعد والأصول، فإنّها في الوقت نفسه تنهى عن حياة البذخ، والإفراط في التجمّل، واتّخاذه هدفًا في الحياة، إذ أنّ التجمّل المفرِط ذو عواقب وخيمةٍ على الفرد والمجتمع.
نشير في ما يلي إلى بعض الجوانب السيّئة من حياة الترف والتجمّل المفرط:
- الغفلة عن ذكر الله تعالى: لو انتهج الإنسان أسلوب التجمّل المفرِطَ في حياته، فسوف يقع في شباك المظاهر الدنيويّة البرّاقة، ويغفل عن ذكر الله عَزَّتْ آلاَؤُه، بحيث يطغى ويتمرّد بدلَ أن يستثمر النعمة بعقلٍ وتَّدْبير، ويشكر خالقه عليها. قال سبحانه في كتابه المجيد: ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾ (العلق: 6-7)، وقال تعالى أيضًا: ﴿وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا﴾ (الإسراء: 83).
- ابتلاء الإنسان بالفخر والتكبّر: لا شكّ في أنّ أحد أهمّ أسباب التفاخر على الآخرين والتكبّر عليهم، هو: تَرَف الإنسان، وإفراطه في زينته وتجمّله. والقرآن الكريم بدوره ذمّ هذه الأخلاق السيّئة ذمًا شديدًا، حيث قال تعالى: ﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (الحديد: 23)، وقال -أيضًا-: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا﴾ (الإسراء: 37).
وذمّت الروايات -كذلك- تسخير النِّعَم لأهدافٍ منهيٍّ عنها، كالتكبّر، والتبختر، والفساد، حيث قال الإمام عليّ عليهالسلام في تفسير قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُها لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا فِي الأرْضِ وَلا فَسادًا﴾ (القصص: 83): «إنَّ الرَّجُلَ لَيُعجِبُهُ أنْ يَكونَ شِراكُ نَعلِهِ أجوَدَ مِن شِراكِ نَعلِ صاحِبِهِ، فَيدخُلُ
تَحتَها»، والمقصود تحت عنوان التكبّر والتبختر.
وحذّرت الأحاديث النبويّة الشريفة بدورها من التكبّر على الآخرين، لما يكمن في هذا الأمر من سوءٍ وقبحٍ لا يقبله الشرع، ولا العرف، وإن كان في أبسط الأمور، كشراك النعل مثلًا. فهذا الخلُق الذميم مرفوضٌ بأيّ شكلٍ كان، وفي جميع مجالات الحياة، في الملبس، والمسكن، ووسائل الزينة، وما إلى ذلك. وربّما يكون السبب في دعاء أئمة أهل البيت عليهمالسلام لأنفسهم ولأتباعهم، بأنْ يرزقهم الله ما فيه كفاية لمَعِيشَتهم فحسب، هو حفظ أنفسهم من الغفلة، ومن الوقوع بشباك حبّ الدّنيا، وبالتّالي النّجاة من الابتلاء بالتكبّر. فقد كانوا يحضّون المؤمنين على عدم جمع ثرواتٍ طائلةٍ، والاكتفاء بما يسدّ حاجتهم، ويكفي أهلهم من رزقٍ.
- عدم الاعتناء بالطبقة المحرومة من المجتمع: إنَّ الإفراط في التجمّل يجعل الإنسان غافلًا عن بني جلدته، ولا سيّما الطبقة المحرومة. فحياة البذخ من قِبَل البعض، وعدم اكتراثهم بحقوق الآخرين، من أهمّ أسباب رواج الفقر في المجتمع، الأمر الذي أشار إليه الإمام عليّ عليهالسلام حين قال: «إِنَّ اللهَ سُبحانَهُ فَرَضَ فِي أَموالِ الأَغنِياءِ أَقْواتَ الفُقَراءِ، فَما جاعَ فَقِيرٌ إِلاّ بِما مَنَعَ
غَنِيٌّ، واللهُ تَعالَى جَدُّهُ سائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ».
وتطرّق عليهالسلام إلى هذا الأمر في مناسبةٍ أخرى بتفصيلٍ أكثر، في قوله: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الأَغنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ ما يِكفِي فُقَراءَهُم، وإِن جاعُوا وعَرُوا وجَهدُوا، فَبِمَنعِ الأَغنِياءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحاسِبَهُم يَومَ القِيامَةِ ويُعَذِّبَهُم عَلَيهِ».
فحقوق الفقراء في أموال الأثرياء غير مقصورةٍ في جانبٍ واحدٍ، بل هي ثابتةٌ في عدّة جوانب، كالزكاة، والخمس. ولو امتثل هؤلاء الأثرياء لحكم الشرع، وأدَّوا ما في ذمّتهم من حقوقٍ، لما ساد الفقر في المجتمع، ولعاش الناس حياة الكفاف والغنى. وقد أشار الإمام الصادق عليهالسلام إلى هذه الحقيقة، عندما قال: «إِنَّما وُضِعَتْ الزَّكاةُ، اختِبارًا للأَغنِياءِ، وَمَعُونَةً للفُقَراءِ، وَلَو أَنَّ النّاسَ أَدّوا زَكاةَ أَموالِهُم ما بَقِيَ مُسلِمٌ فَقيرًا مُحتاجًا، وَلاستَغنَى بما فَرَضَ اللهُ لَهُ، وإِنَّ النّاسَ ما افتَقرُوا وَلا احتاجُوا وَلا جاعُوا وَلا عَرُوا، إِلا بِذُنوبِ الأَغنِياءِ».
إنّ الحدّ المعقول من استثمار نِعَم الله تعالى والمقرّر حسب تعاليم ديننا الحنيف، هو ما كان مطابقًا للاعتدال والوسطيّة.
فالإنفاق المعتدل، يعني: خلوّه من الإسْراف والتَّقتير في آنٍ واحدٍ، وقد عبّرت عنه الأحاديث بـ(القصد) أو (الِاقْتِصَاد). والإمام السجّادعليهالسلام يطلب من الله تعالى أن يكرمه بهذه النعمة فيدعوه قائلًا: «وَاحجُبنِي عَن السّرفِ وَالازدِيادِ، وَقَوّمنِي بالبَذلِ وَالاقتِصادِ».
والاعتدال في استهلاك النِعمة هو أسلوبٌ يكون البذل فيه متنوّعًا، ويتمكّن الإنسان من خلاله من تلبية حوائجه، كما أنّه يؤدّي إلى نظم أمور مَعِيشَتَه. رُوِيَ أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام سأله، فقال: إنّا نكون في طريق مكّة فنريد الإحرام، فلا يكون معنا نخالةٌ نتدلّك بها من النورة، فندلّك بالدقيق، فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم. قال عليهالسلام : «مخافة الإسْراف؟». قلت: نعم.
قال عليهالسلام : «لَيسَ فِي ما أصلَحَ البَدَنَ إسرافٌ. أنا رُبَّما أمرتُ بالنّقي فيلت بالزَّيتِ فَأتَدلَّكُ بهِ، إنَّما الإسرافُ في ما أتلَفَ المالَ وأضَرَّ بالبَدنِ».
قلت: فما الإقتار؟ قال عليهالسلام : «أكلُ الخبزِ والملحِ، وأنتَ تَقدِرُ عَلَى غَيرِهِ».
قلت: فالقصد؟ قال عليهالسلام: «الخبزُ، والَّلحمُ، والَّلبَنُ، والزَّيتُ، والسَّمنُ، مَرَّةً ذا، ومَرَّةً ذا».
القَصدُ يذهب بالإسْراف والتَّقتير
كما أنّ هناك حدودًا خاصّةً لكَسْب المال، فإنّ بعض الروايات ذَكَرَت هذه الحدود في تصرّف
الإنسان بأمواله الخاصّة، إذ حسب قواعد الملكيّة الخاصّة، فإنّ الإنسان غير مخوّلٍ بأن يتصرّف بأمواله من دون ضابطةٍ، وكيفما يشاء، بل هناك حدودٌ وشروطٌ في ذلك تقيّده، بالاعتدال، وعدم الإسْراف. لذلك، لا يجوز لمالك المال أن يسرف في إنفاقه، ويتجاوز الحدّ عمّا تتطلّبه مَعِيشَتَه. فالإنفاق من أسمى أنواع التصرّف في الأموال الخاصّة، ولكنّ هذا التصرّف لا بدّ أن يكون محدودًا ومشروطًا، بالاعتدال، والوسطيّة، فلا الإسْراف محمودٌ، ولا التقتير، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: «ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، ... فَذَكَرَ الثَّالِثُ: «الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ».
لذا، فإنّ كيفيّة توفير مصاريف الأسرة يجب أن تكون متوازنةً بين عدم الإسْراف وعدم التقتير في آنٍ واحدٍ، فالمال يكون سببًا، لنظم أمور الفرد والمجتمع، عندما لا يكون مصدرًا للإفراط
والتفريط، لأنّه، إن أُنفِقَ بإفراطٍ أو حُفِظَ بتفريطٍ، يصير آلةً تقضي على الفرد والمجتمع معًا، حيث أكّد الإمام عليّ عليهالسلام على ذلك حينما قال: «لَنْ يَهلِكَ مَن اقتَصَدَ»، وكذلك قال عليهالسلام: «مَن لَم يُحسِن الاقتِصادَ أهلَكَهُ الإسرافُ».
ومن المؤكّد أنّ الأسلوب الصحيح في الإنفاق له فوائد جمّةٌ، منها: رقيّ الفرد والمجتمع اقْتِصَاديًا، ورفاهيّة جميع أبناء المجتمع، وارتفاع كفاءة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى دوام النّعمة. وهناك كثير من الحِكم والأحاديث في هذا المضمار، نذكر منها ما رويَ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله: «الِاقْتِصَادُ يُنْمِي الْيَسِيرَ»، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام: «الِاقْتِصَاد نصف المَؤُنَة»، وقال عليهالسلام أيضًا: «القَصدُ مَثراةٌ».
وروي عن إمامنا الكاظم عليهالسلام: «مَن اقتَصَدَ وَقَنَعَ، بَقِيَت عَلَيهِ النِّعمَةُ، وَمَن بَذَّرَ وَأسرَفَ، زالَت عَنهُ النِّعمَةُ».
في رحاب الإنفاق الصحيح، سيتسنّى لمعظم الناس الاستفادة من الثروات وجميع الإمكانيّات المتاحة لقضاء
حوائجهم، وبالتالي سينجو المجتمع من مهلكة الفقر، قال الإمام الصادق عليهالسلام : «ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ».
«القَناعة بالفتح: الرِّضا بالقِسْمِ». قال ابن فارس: «قنع قناعة: إذا رضي، وسُمّيت قناعة لأنّه يُقبل على الشيء الذي له راضيًا».
و«القناعة ضدّ الحرص، وهي ملكةٌ للنفس تُوجِب الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال، من دون سعي وتعب في طلب الزائد عنه، وهي صفةٌ فاضلةٌ يتوقّف عليها كَسْب سائر الفضائل، وعدمها يؤدّي بالعبد إلى مساوئ الأخلاق والرذائل».
وسُئل الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام عن قول الله سبحانه: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾، فقال: «هي القناعة»، وروى الطبري في تفسيره عنه عليهالسلام : ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾. قال: «القنوع»، وللقناعة نتائج حميدة أشار إليها الأئمة الأطهارعليهمالسلام في أحاديثهم،
نذكر منها ما روي عن الإمام عليّ عليهالسلام: «إذا طَلَبت الغِنَى، فَاطلبهُ بالقَناعةِ».
وقال الإمام الصادق عليهالسلام: «الغِنَى فِي القَناعَةِ، وَهُم يَطلبُونَهُ فِي كَثرَةِ المالِ فَلا يَجِدُونَهُ».
وروي عن الإمام الرضاعليهالسلام أنّه قال: «مَن رَضِيَ عَن اللهِ تَعالى بالقليلِ مِن الرِّزقِ، رَضِيَ اللهُ مِنهُ بالقَليلِ مِن العَملِ».
وقال عليهالسلام أيضًا: «لا يَسلكُ طَريقَ القَناعَةِ إلا رَجُلانِ: إمّا مُتعَبِّدٌ يُريدُ أجرَ الآخِرةِ أو كَريمٌ يَتنَزَّهُ مِن لِئامِ النّاسِ».
إذًا، لا حيلة للإنسان سوى أن يتّخذ القناعة منهجًا في مَعِيشَتَه، وإلا ستلتهمه نيران الحرص وتقضي عليه. وقد شكا رجلٌ إلى الإمام الصادق عليهالسلام أنّه يطلب فيُصيب ولا يقنع، وتُنازعهُ نفسه إلى ما هو أكثر منه، وقال له: علّمني شيئًا أنتفع به، فقال عليهالسلام له: «إنْ كانَ ما يَكفِيكَ يُغنِيكَ، فَأدنَى ما فِيها يُغنيك، وإنْ كانَ ما يَكفِيكَ لا يُغنِيكَ، فَكُلُّ ما فِيها لا يُغنِيكَ».
وسبيل كَسْب القناعة والرضا بالنصيب، أوضحه لنا الإمام الصادق عليهالسلام في قوله: «انظُر إلى مَن هُو دُونكَ فِي المقدِرةِ، ولا
تَنظُر إلى مَن هُو فَوقكَ فِي المقدِرةِ، فإنَّ ذلِكَ أقنَع لَكَ بِما قُسِمَ لَكَ».
من المفروض على كلّ مسلمٍ أن يُبرمج حياته الفرديّة والاجتماعيّة طبق أصول دينه ومبادئه، ويؤدّي أعماله وفق ذلك. كما أنّ الله تعالى منح الإنسانَ الحقَّ ببذل أمواله في ما يحتاج إليه، واستثمار نِعم الطبيعة، ففي الوقت ذاته كلّفه بواجباتٍ في هذا المضمار، وألزمه بأداء حقوق الآخرين، كالخمس، والزكاة، والحقّ المعلوم. والإذعان لهذا التكليف -بالتأكيد- من شأنه تقليص مستوى الفقر في المجتمع، ومعلوم أنَّ للفقراء والمساكين مكانةٌ هامّةٌ في المنهج الصحيح لبذل الأموال حسب التعاليم الإسلاميّة.
وطبق الاصطلاح الدينيّ، فإنّ الفقير هو الذي لا يملك الكفاف في مَعِيشَتَه، والفقراء في المجتمع على قسمين، هما:
- الذين لا يتمكّنون من استيفاء حقّوقهم في المجتمع، مهما بذلوا من جهودٍ، بسبب عجزهم عن العَمَل، كالمعاقين، والطّاعنين في السنّ، والأطفال القُصّر، والمرضى.
- الذين يتمكّنون من العَمَل، لكنّ دخلهم لا يضاهي حاجتهم
المادّيّة، ولا يتمكّنون من بلوغ درجة الكفاف
حيث إنَّ لهاتين الفئتين حقًا في أموال الأثرياء وبيت المال، الأمر الذي أكّد عليه القرآن الكريم وكثير من الأحاديث الشريفة، وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: ﴿وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائلِ وَالمحرُومِ﴾ (الذاريات: 19)، وهذه الآية تبيّن -خاصَةً- «سيرة المتّقين مع الناس، وهي: إيتاء السائل والمحروم، وتخصيص حقّ السائل والمحروم بأنّه في أموالهم -مع أنّه لو ثبت، فإنّما يثبت في كلّ مالٍ- دليلٌ على أنّ المراد أنّهم يرون بصفاء فِطرَتهم أنّ في أموالهم حقًا، فيعملون بما يعملون، نشرًا للرحمة، وإيثارًا للحسنة».
رُوي عن الإمام عليّ عليهالسلام قوله: «إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوالِ الأَغْنِياءِ أَقْواتَ الْفُقَراءِ، فَما جاعَ فَقِيرٌ، إِلاَّ بِما مَنَعَ غَنِيٌّ، واللهُ تَعالَى جَدُّهُ سائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ»، وهذا الحديث من جملة أحاديث وروايات شريفة تثبت أنّ الله عَزَّتْ آلاَؤُه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضةً تسدّ حاجتهم. ويمكن استيفاء حقوق الفقراء من أموال الأغنياء بعدّة طرقٍ، منها:
- الخُمس: قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (الأنفال: 41).
- الزكاة: قال تعالى: ﴿إِنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالمساكِين﴾ (التوبة: 60).
- الحقّ المعلوم: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَموالِهِمْ حَقٌّ مَعلُومٌ * لِلسّائلِ وَالمحرُومِ﴾ (المعارج: 24-25).
وقد سأل رجلٌ الإمام زين العابدين عليهالسلام عن معنى (الحقّ المعلوم) في هذه الآية، فقال عليهالسلام : «الحقُّ المعلومُ. الشَّيءُ يُخرجهُ الرَّجُلُ مِن مالِهِ لَيسَ مِن الزَّكاةِ، وَلا مِن الصَّدَقَةِ المفروضَتَينِ».
فقال الرجل: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة، فما هو؟ فقال الإمام عليهالسلام : «هُو الشَّيءُ يُخرِجُهُ الرَّجُلُ مِن مالِهِ، إنْ شاءَ أَكثَرَ، وإِنْ شاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدرِ ما يَملكُ».
فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال عليهالسلام : «يَصِل بِهِ رَحِمًا، وَيقرِي بِهِ ضَيفًا، وَيِحملُ بِهِ كَلًا، أو يَصِلُ بِهِ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، أو لِنائبَةٍ تَنُوبُهُ». فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته.
فالحقّ المعلوم: هو المال الزائد على الخمس والزكاة، إذ يجب على صاحب المال أن يساعد الفقراء بحسب استطاعته. وختامًا، هناك ملاحظة تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، وهي أنّ حقّ الفقراء في أموال الأغنياء لا يُسوّغ لهم انتزاعه بأنفسهم، لأنّ هذا الأمر يؤدّي إلى اضطراباتٍ وأعمال شغب، لذا فإنّ المسؤول عن تحصيل هذا المال وتقسيمه بين الفقراء، إمّا أصحاب الأموال أنفسهم، أو الوليّ الفقيه الذي يتولّى مقاليد الحكم.
إنّ الهدف الأساس للمذهبين الِاقْتِصَاديّين: الرأسماليّ والاشتراكيّ، محدودٌ في إشباع رغبات الإنسان المادّيّة، وتلبية شهواته، وليست لهما أهدافٌ أخرى تُذكَر. بينما جعل الإسلام هدفه الِاقْتِصَاديّ الأسمى:
استثمارَ النِّعم والخدمات المتاحة، بطريقةٍ مُثلى، لكي ينعم الإنسان بسلامة النَّفْس والجسم معًا، وذلك عبر الامتثال لأوامر الله تعالى. عندها سينعم -أيضًا- برضا ربّه ويتقرّب إليه. وبالطبع، فإنّ الإعراض عن هذا الهدف، وعدم أخذه بعين الاعتبار من قِبَل البعض، ناشئٌ من جهلهم بحقيقة الحياة، وحرصهم الشديد على الدنيا. فهذا الحرص يسلبهم فرصة استثمار ما
(116)هو ميسّرٌ لهم من خدماتٍ وأموالٍ بشكلٍ مطلوبٍ. لذا، ذمّت تعاليمنا الدينيّة استهلاك الإمكانيّات المادّيّة المتاحة، رياءً، وبهدف التباهي والتفاخر على الآخرين، ومنافستهم منافسةً غير مشروعةٍ، وما إلى ذلك من نوايا رذيلةٍ، واعتبرتها دوافع سلبيّةً لا تتناسب وشأن الإنسان الصَّالِح. وتبدو هذه الحقيقة جليّة لنا في قول رسول الله صلىاللهعليهوآله: «مَن لَبسَ ثَوبًا فَاختالَ فِيهِ، خَسَفَ اللهُ بِهِ مِن شَفِيرِ جَهَنَّم، وَكانَ قَرينَ قارونَ».
إنَّ قيمة الإنسان في المجتمع الإسلاميّ لا تُقاس بقدرته الاستهلاكيّة، فليس من الصحيح أن تكون فضيلة الإنسان بين أبناء جلدته منوطةً بمقدار إنفاقه الأموال، أي: إذا زاد استهلاكه المادّيّ، علا مقامه!
لذلك، كلّما ترسّخت القيَم والمبادئ الدينيّة في المجتمع، فإنَّ الرَّغبات الذَّميمة في الاستهلاك بين أبنائه تنحسر شيئًا فشيئًا، وتصل إلى أدنى درجةٍ لها. ويجدر بالمسلمين أن يعيروا هذه المسأله الحسَّاسة أهمّيّةً بالغةً، كي يصونوا أنفسهم من عواقبها الوخيمة.
ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع الهامّ، يجب تقسيمه إلى أربعة أبواب، وفق التالي: أسباب شيوع النزعة الاستهلاكيّة المفرطة، والعواقب الوخيمة للنزعة الاستهلاكيّة
المفرطة، والمعيار الأنسب في الاستهلاك، وكيفيّة التصدّي للنزعة الاستهلاكيّة المفرطة.
لا يختلف اثنان في أنّ الهدف الأساس من الاستهلاك هو توفير الظُّروف الملائمة للإنسان، ومنحه الطاقة اللازمة، كي تستمرّ عجلة حياته بالدوران. فهو يهيّئ جانبًا من متطلّباته عن طريق استهلاك السلع، وتسخير بعض الخدمات، وهذا الأمر بذاته ليس اعتباطيًا، بل إنَّ له ضوابط ومعايير خاصّة لو راعاها كلّ شخصٍ، فسوف ينعكس تأثيرها على المجتمع برمّته. فالمجتمعات التي تبلغ أعلى درجات الرقيّ هي التي يسودها نظامٌ استهلاكيٌّ يطابق القواعد والمعايير التي لا تتعارض مع حكم العقل والمنطق، أي أنّ هناك تناسقًا بين الإمكانيّات المتوافرة فيها ومتطلّبات أبنائها، مثل: تشجيع الإنتاج المحلّي، وتقليص حجم البضائع المستوردة.
فالحياة التي تشوبها النزعة الاستهلاكيّة المُفرِطَة لوسائل التّرفيه وسائر الخدمات، هي حياةٌ مشوبةٌ بالمخاطر، ولا تبشّر بخيرٍ، ولن تعمّها السعادة. فعدم ترشيد الاستهلاك، وإهمال الجانب الإنتاجيّ في المجتمع، لهما أسبابٌ عديدةٌ، منها ما يلي:
(118)بعض أبناء الطبقة المتوسّطة والمحرومة في المجتمع يقعون في فخّ تنافسٍ غير متكافئ مع الطبقة المرفّهة، بسبب انبهارهم بحياة البذخ والترف لهذه الطبقة، إذ أنّهم يتأثّرون بأوهام لا قيمة لها. فهم يعتقدون أنّ الاستهلاك المفرِط شأنٌ اجتماعيٌّ راقٍ، لذلك يسخّرون مواردهم الِاقْتِصَاديّة حسب معايير وهميّة، ويتناسون واقع حياتهم، فيتورّطون في مصاعب لا تُحمد عقباها.
والتنافس في الاستهلاك غير محدودٍ بفئةٍ معيّنةٍ أو موضوعٍ ما، بل له أمثلة عديدة، كالتنافس مع الأقارب، والجيران، والأصدقاء. فعلى سبيل المثال: قد يشتري الإنسان ثوبًا هو في غنىً عنه أو باهظ الثمن بالنسبة له، أو يتناول طعامًا لا يرغب فيه أو لا يتناسب ودخله المحدود. والأمثلة من هذا القبيل كثيرةٌ لا حصر لها، أبرزها -اليوم-: التجمّلات الزائفة في حفلات الزواج وسائر المناسبات العائليّة في الأحزان والمسرّات، إذ تتجلّى فيها مظاهر الإسْراف والتَّبْذِير، والتجمّل، وحياة البذخ الذميمة بوضوحٍ. فهذا البذخ قد يجعل حياة البعض رهن القروض والديون المُنْهِكَة، وأحيانًا يشلّ اقْتِصَاد الأسرة بالكامل. إذ أنّ حمّى التنافس المُفرِط في الاستهلاك، من شأنها أن تغيّر مسار حياة البعض، لدرجة أنّهم يقلّصون من إنفاقهم الضروريّ لمَعِيشَتَهم، ويدّخرونه لمثل مناسباتٍ كهذه!
ومن ناحيةٍ أخرى: إنّ حبّ التنافس في الاستهلاك المُفرِط يتنافى مع مبادئ الأخلاق الحميدة، ويشكّل سببًا لرواج الفساد في المجتمع، ناهيك عن عواقبه الِاقْتِصَاديّة السيّئة. ولذلك، ردعت تعاليمنا الدينيّة عن كلّ هذه الأفعال، وأكّدت على وجوب التصدّي لها بشتّى السبُل.
ويجب التمييز بين التنافس السيّئ وبين التنافس المحمود، الذي يتجلّى في السبق إلى عمل الخير، وكَسْب رضا الإله. وبالتأكيد، فإنّ الروايات الشريفة نهت عن التنافس الذميم، وحذّرت
منه، وجاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا تَكُنْ مِمَّن يُنافِسُ فِيما يَفنَى، وَيُسامِحُ فِيما يَبقَى».
أحد أهمّ أسباب النزعة الاستهلاكيّة المُفرِطَة لدى البشر يكمن في حبّ العيش برفاهيةٍ وبذخٍ من قِبَل أثرياء المجتمع. فهؤلاء يستهلكون إمكانيّاتٍ مادّيّةً ضخمةً أكثر ممّا تتطلّبه مَعِيشَتَهم بأضعافٍ مضاعفة، بسبب أنانيّتهم، وطلبًا لإشباع شهواتهم ورغباتهم المُفرِطَة، إذ أنّ الاستهلاك المُفرِط -باعتقادهم- يُعدّ من القيَم النبيلة! فيتنافسون في ما بينهم، فخرًا، وزهوًا، بغير حقٍّ.
وهؤلاء الأثرياء لا يعيرون أهمّيّةً لأبناء جلدتهم، وهمّهم الوحيد هو المصالح المادّيّة فقط، بينما حوائج الفقراء والمحرومين، من المأكل، والملبس، والعلاج ليست لها أيّ أهمّيّةً لديهم، بل إنّهم يقتنون السلع الفاخرة حتّى لو استوجب الأمر استيرادها من خارج البلاد بأثمانٍ باهظةٍ.
إنّ الانحراف الثقافيّ هو سببٌ آخر في رسوخ النزعة الاستهلاكيّة المُفرِطَة لدى البعض، وهو ناشئٌ من شيوع ثقافة تقليد الغير التي تتنافى مع حكم العقل. فشعوب بعض بلدان العالم الثالث ترجّح اقتناء البضائع المستوردة، وتُعرِض عن البضائع المحليّة، إثر سيطرة الثقافة الغربيّة الذميمة عليها. والأمور التي تساعد على ترويج هذه الثقافة بين الشعوب كثيرةٌ، منها: الدعايات والإعلانات التجاريّة، والسياسة الخاطئة لبعض المنتجين المحليّين، بسبب انحسار هدفهم في الربح، وإنتاج سلعٍ محلّية غير مرغوبٍ فيها، كونها متدنيّة الكفاءة، وإنتاج سلعٍ أجنبيّةٍ مرغوبٍ فيها، كونها عالية الكفاءة.
كما أنّ تدنّي المستوى الثقافيّ في المجتمع ذو تأثيرٍ على المنهج الاستهلاكيّ لدى الفرد والمجتمع. فالضعف الثقافيّ من شأنه أن يرسّخ في النَّفْس نزعةً استهلاكيّةً مفرطةً. والبرامج
التربويّة الخاطئة تُعدّ من الأسباب المساعدة على شيوع هذا التوجّه المنحرف. وللتدنّي الثقافيّ عواقب وخيمة تؤثّر على اقْتِصَاد البلد برمّته، إذ يسوق أبناءَ المجتمع إلى اقتناء سلع أجنبيّةٍ، وإهمال السلع المحلّيّة الصنع، لدرجة أنّ بعض المنتجين المحلّيّين يسوّغون لأنفسهم الغشّ من خلال عرض بضائعهم في السوق بعلاماتٍ تجاريّةٍ أجنبيّةٍ. وللأسف الشديد، فإنّ هذا الانحراف الثقافيّ سيرسّخ في أذهان الناس مبدأ أفضليّة البلدان الصناعيّة من جميع النواحي، وليس من الناحية الِاقْتِصَاديّة فحسب، فيتوهّمون بأفضليّتها في شتّى المجالات، مثل: اللغة، وتربية الأطفال، ونوع المأكل والملبس، وحتّى في الآداب والأعراف. وآثار هذه الثقافة ستظهر على الأجيال القادمة بشكلٍ سلبيٍّ، إذ ستسود بينهم روح الاتّكاليّة على الآخرين، وستتزلزل أركان مجتمعهم أمام أيّ نائبةٍ يتعرّض لها، لأنّهم مستهلِكُون فقط، ولا يفكّرون إلا في تلبية رغباتهم الدنيويّة.
إنّ لكلّ نظامٍ تعليميٍّ تأثيرٌ فعّالٌ على أبناء المجتمع في أسلوب الاستهلاك، سلبيًا أو إيجابيًا. وقد أثبتت التجربة أنّ وصايا المعلّمين وتعاليمهم التي يغذّون أذهان تلامذتهم بها، لها تأثيرٌ ملموسٌ عليهم، في تقبّلهم إيّاها بسهولةٍ. لذا، لو أوصى المعلّم تلامذته بترشيد استهلاك القرطاسيّة، وعدم الإسْراف في
الملبس والمأكل، وسائر الخدمات المعيشيّة، فإنّ ذلك سوف لا ينعكس على تصرّفاتهم وحسب، بل على المجتمع برمّته، فينشأ جيلٌ مقتصدٌ يتّبع مبادئ تربويّةً صحيحةً. لكن، لو كان الأمر بالعكس، وانتهج المعلّم أسلوب البذخ، وشجّع تلامذته على الاستهلاك المفرط، فسوف ينشأ جيلٌ مسرفٌ يُثقل كاهل المجتمع.
إنّ وسائل الإعلام بأنواعها تلعب دورًا هامًا في انتهاج الإنسان سياسةً صحيحةً في الاستهلاك أم سياسةً خاطئةً، مثل: القنوات التلفزيونية، والإذاعات، ووسائل التواصل، بمختلف أنواعها، والكتب، والإعلانات التجاريّة.
فالعديد من الناس يسلكون الطريق الخطأ، بسبب تأثّرهم بالمنهج الخاطئ لبعض وسائل الإعلام ودعاياتها العارية عن الحقيقة، فيقتنون سلعًا فاخرةً وزينةً لا هدف منها سوى التجمّل المُفرِط وإشباع بعض الرغبات، وهناك آخرون ينتهجون المسلك الصحيح في الاستهلاك، متأثّرين بالطريقة الصحيحة التي تتّبعها بعض وسائل الإعلام.
إذًا، نستنتج ممّا ذُكِرَ أنّ أحد أسباب تخلّف بعض المجتمعات عن عجلة التطوّر يعود إلى الأسلوب المُفرِط في الاستهلاك.
وبالطبع، فإنّ البلدان الصناعيّة هي المستفيد الوحيد من هذه الظاهرة المنحرفة. ويُعدّ الإفراط في الاستهلاك مرضًا فتّاكًا يصيب البلدان الفقيرة، لأنّه سببٌ لإهدار ثرواتها، وتزلزل أركان اقتصادها والحؤول دون انتعاش الاستثمار فيها.
إنّ الإنسان بطبعه يسعى وراء المشتهيات ولا يكتفي بما يسدّ حاجته منها، بل يطلب الزيادة منها، فلا يمكن إشباع رغباته مهما زاد من نطاق استهلاكه. وبعد تلبية كلّ رغبةٍ، ستظهر لديه رغبةٌ أخرى، وهذه العجلة ستستمر بالدوران على هذا المنوال. ومن جانبٍ آخر، فإنّ الإمكانيّات الِاقْتِصَاديّة ووسائل تدعيم مصادرها من الأرض محدودةٌ، ولا يمكنها تلبية الرغبات غير المحدودة للبشر. لذا، فإنّ هذه الرغبات المُفرِطة، ستؤدّي إلى تأزّم أوضاع الفرد النَّفْسيّة، وقد تتمخّض عنها وقوع أحداث شغبٍ في المجتمع أو حتّى نزاعات وإراقة دماء.
وطبق التعاليم الإسلاميّة، فكلّ إنفاقٍ غير متعارفٍ ويتجاوز حدّ الكفاف يُعدّ استهلاكًا مفرطًا. ولهذا الإنفاق نتائج سلبيّة وأضرار فادحة كبيرة جدًّا، حيث يتسبّب في: إهدار الثروات والإمكانيّات المتاحة، وعدم استثمار المصادر الِاقْتِصَاديّة
بطريقةٍ مثلى، وتحمّل نفقاتٍ إضافيّةٍ في المعيشَة قد يصحبها أضرارٍ فادحةٍ، وحدوث اضطراباتٍ ومشاكل، وتبعيّة اقْتِصَاديّة، وتهديد سلامة الروح والجسد، وعدم التنعّم بالثروة بشكلٍ أمثل، وحرمان الإنسان من كرامة النَّفْس وصفاء الباطن، وإشاعة التخاذل والتكاسل، وخسارة الأموال المدّخرة، وما إلى ذلك من عواقب وخيمةٍ تُنهِك الإنسان، وتجعل المجتمع هزيلًا غير متماسك.
فالاستهلاك المُفرِط للنعمة، يُعدّ سببًا لتنامي النَّفْس البهيميّة في الإنسان وهيمنتها عليه، ومن ثمّ يؤدّي إلى انحطاطه في المجتمع. ولهذا السبب عدّت التعاليم الدينيّة المُفرطين في الاستهلاك بأنّهم آفاتٌ اجتماعيّةٌ، لأنّهم يخالفون المبادئ السليمة في الحياة، ويخلقون مشاكل جمّةً للمجتمع، بأسلوبهم الخاطئ في المعيشَة، وميلهم المفرط نحو التجمّل.
ويُسلم كل ذي فكر أن من خلال الاستهلاك الأمثل للثروة، سيتسنّى تلبية جميع متطلّبات المجتمع، وتوزيع الثروة بعدلٍ وإنصافٍ، كما يمكن من خلاله تسخير مصادر الإنتاج لخدمة المجتمع، وبالتالي سيُحظى الناس بالسعادة والاستقرار الِاقْتِصَاديّ، لأنّهم سينعمون بحياةٍ لا تنافس فيها ولا إفراط. فالاستهلاك المعقول يتجلّى في الاعتدال والقناعة، الأمر الذي
أكّدت عليه النصوص الدينيّة، وشجّعت الناس على انتهاجه. أمّا المنهج المُفرِط في الاستهلاك، فإنّه يؤدّي إلى بروز حاجاتٍ وهميّةٍ في المجتمع، ويقع حائلًا أمام التوزيع العادل للثروة، ويؤثّر سلبيًّا على إدارة مصادر الإنتاج، وكذلك يتسبّب في التنافس المذموم، وهذه الأمور برمّتها تهدّد مصالح المجتمع، وتعرّضه لمخاطر جمّة.
إنّ الشريعة الإسلاميّة بيّنت لنا المعايير الصحيحة في استثمار النعمة، ووضعت منهجًا قويمًا لاستهلاكها، كمراعاة القيَم الأصيلة واستهلاك الأموال طبق مصالح النظام الإسلاميّ.
والقيَم التي يجب مراعاتها هي الأصول والمعتقدات والسلوكيّات التي تتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلاميّة. وبالطبع، فإنّ القيَم لا تنحصر في أداء الواجبات وترك المحرّمات، بل تشمل كلّ أمرٍ حثّت عليه الشريعة، أي الأعمال المستحبّة. وعلى الرغم من عدم وجوب العَمَل بالمستحبّات،
ولكنّها تُعدّ من القيَم السامية، وتشمل جميع المبادئ الحقوقيّة، والاجتماعيّة، والسلوكيّة. وقد بيّن لنا القرآن الكريم المعيار الصحيح في استثمار النِعمة، وقوامه مراعاة الأسس التالية:
- التقوى: ﴿وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (المائدة: 88).
- العَمَل الصَّالِح: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: 51).
- الشكر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة: 172).
- عدم الطغيان: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ (طه: 81).
- أداء الحقوق واجتناب الإسْراف: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام: 141).
- ترك الذنوب وعدم اتّباع الشيطان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (البقرة: 168).
لقد خاطب الله تعالى خلقه بكلمة (كُلُواْ) إيذانًا منه باستثمار نعمه التي أسبغها عليهم. والمراد
من هذا الاستثمار أو الاستهلاك، مطلق التصرّف في النعمة،
وليس الأكل فقط، فالأكل هو أحد مصاديق التصرّف بالنعمة. وكون مراعاة هذه التعاليم شرطٌ في الاستهلاك، فإنّ ذلك لا يعني الحرمة في تركها. فعلى سبيل المثال، الآية المباركة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة: 172): تحضّ الناس على شكر نِعم الله تعالى، ولكنّ استهلاك النعمة من دون شكر الله تعالى لا يُعدّ حرامًا من الناحية الفقهيّة، بل إنّ العبد يُحرز رضا الله تعالى بشكر النِعمة.
ومراعاة القيَم السامية في استثمار الثروات غير مقيّدةٍ في مرحلةٍ محدّدةٍ، بل تشمل جميع المراحل، ابتداءًا من الإنتاج، ومرورًا بالتوزيع، وانتهاءًا إلى الاستهلاك. فالإنسان مكلّفٌ بمراعاة هذه القيَم الأصيلة، لكي يتسنّى له تطوير واقعه الِاقْتِصَاديّ، والحفاظ على تماسك مجتمعه. ومن هنا، فعليه أن يبذل قصارى جهوده في هذا المضمار، وأن يترك الأنانيّة في برنامجه الاستهلاكيّ، بحيث لا يعير أهمّيّةً لمصالحه الخاصّة، ويهمل المصالح العامّة، لأنّ الشريعة الإسلاميّة منعت الإفراط في استثمار الثروة وإهمال المصالح العامّة. فالإنسان الناجح في حياته هو من يحاول استثمار الثروة والإمكانيّات المتاحة بأسلوبٍ صحيح، حسب القيَم الدينيّة. وكذلك، فإنّ المجتمع المثاليّ في الاستهلاك هو الذي تروج فيه هذه المبادئ الأصيلة.
قد تقتضي المصالح الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع الإسلاميّ -أحيانًا- تحريم استهلاك السلع المستوردة من البلدان غير الإسلاميّة، وذلك عندما تكون العلاقات السياسيّة والاجتماعيّة بين الدولة الإسلاميّة وتلك البلدان سببًا لبسط سيطرة هذه البلدان، واتّساع رقعة نفوذهم، أو في التبعيّة السياسيّة أو الِاقْتِصَاديّة لهم، أو في الحطّ من شأن المسلمين وإضعافهم. وبالطبع، فإنّ جميع المسلمين مكلّفون بالدفاع عن كيانهم السياسيّ والِاقْتِصَاديّ، وحفظ استقلالهم، وهذا الدفاع يمكن أن يكون عن طريق مقاطعة استهلاك السلع المنتجة في تلك البلدان، أو من خلال عدم بيعهم منتجات السوق الإسلاميّ.
وفي أوضاعٍ كهذه، يجب على وليّ أمر المسلمين الحكم بحرمة المتاجرة ببضائع كهذه، كما يجب على أبناء المجتمع الإسلاميّ الانصياع لهذا الحكم، ومقاطعة تلك البضائع، كما حدث في قضيّة تحريم التنباك (التبغ) بعد فتوى الميرزا الشيرازيّ في عهد ناصر الدين شاه القاجاريّ.
إنَّ كلّ متبحّرٍ في المسائل الِاقْتِصَاديّة يُدرك أنَّ إمكانيّة ادّخار
ثروةٍ في بلدٍ ما، بغية تطويره، لها صلةٌ وثيقةٌ بالثقافة الاستهلاكيّة للشعب، ومدى توفير الأموال من دخلهم. فحينما تشوب النزعةُ الاستهلاكيّة ثقافةَ الناس، ويصبح إنفاقهم بمستوى دخلهم أو أعلى منه، فيسدّون الحاجة الزائدة عن الدخل عبر القروض، فلا يتسنّى لهم توفير المال مطلقًا. لكن، حينما تكون ثقافتهم مقتصدةً، ويدّخرون ما زاد عن حاجتهم، فسوف تدور عجلة التطوّر في المجتمع، ويتّسع نطاق الاستثمار فيه، وفي الوقت نفسه سوف ينحسر نطاق الإسْراف والتَّبْذِير.
لذا، فالمجتمعات الإسلاميّة بحاجةٍ ماسّةٍ إلى أنموذجٍ أمثلٍ في الاستهلاك، ومن الواضح أنّ ترويج الثقافة الصحيحة في الاستهلاك بحاجةٍ إلى تعليمٍ مستمرٍّ، لكي يترسّخ مبدأ القناعة بين الناس بصفته أصلًا دينيًا، وفي الوقت نفسه يُستأصل مبدأ الإفراط في الاستهلاك. ونتيجةً لذلك، سوف تنصبّ جُلّ جهود أبناء المجتمع في توسيع نطاق الإنتاج، وسيسخّرون طاقاتهم لمصلحة مجتمعهم من خلال الانصياع لتعاليم دينهم.
ولو دقّقنا في أوضاع البلدان المتطوّرة، سنلاحظ أنّه رغم امتلاكها ثرواتٍ طائلةً وقدرةً عظيمةً، فإنّها تحارب الإسْراف في مجتمعاتها على كافّة الأصعدة، مثل: الكهرباء، والماء، والغذاء، والوقود، كما تشوّق شعوبها لأن يكونوا مقتصدين وقانعين، لدرجة أنّهم يعتبرون إسراف الوافدين إلى بلدانهم إهانةً لهم، ولولا
(130)هذه الخصال المنافية للإسراف، لما تمكّنوا من تطوير بلدانهم، والتربّع على سلَّم الرقيّ الِاقْتِصَاديّ في العالم. وبفضل مراعاة الثقافة الاستهلاكيّة الصحيحة تمكّنوا من بلوغ هذه المكانة.
ومن البديهيّ أن يكون ترويج فكرةٍ ما أو نشر ثقافةٍ معيّنةٍ في أيّ مجتمعٍ عملٌ يقع على عاتق المسؤولين في البلاد. وأما الحكومة، فيجدر بها أن تتّخذ إجراءاتٍ وتدابير منسجمةً مع المعايير الدينيّة، بغية تربية الأجيال الجديدة في مدارسهم، وفي أحضان أسرهم تربيةً صالحةً، لتترسّخ في أذهانهم ثقافةً استهلاكيّةً صحيحةً يميّزوا من خلالها أضرار الاستهلاك المفرط وفوائد الاستهلاك المقتصد، وذلك من خلال الحدّ من رغباتهم، والتقليل من طلباتهم. وبالتالي، سوف يلعبون دورًا هامًا في تحسين أوضاعهم المعيشيّة وأوضاع مجتمعهم مستقبلًا.
لا يختلف اثنان في تأثير ادّخار الأموال على تماسك الأسرة والمجتمع ورقيّهما، وهذا الأمر -طبعًا- من أهمّ سياسات حُسن التَّدبير في المعيشَة، فلو تصفّحنا تاريخ الأنظمة الحاكمة المستقرّة، والمجتمعات البشريّة المتطوّرة والأسر الناجحة، للمسنا أهمّيّة التوفير والادخار، ومدى تأثيره الإيجابيّ عليها.
أمّا النصوص الإسلامية فهي بدورها تطرّقت إلى بيان أهمّيّة هذا الأمر، وسنشير إلى بعضها في الأبحاث التالية:
إنّ روح الانسجام والتعاون بين أفراد الأسرة والمجتمع من أهمّ العوامل التي تساعد على تنامي الرغبة في التوفير لديهم. فعندما تسود هذه الروحيّة بينهم، ويتولّى زمام أمورهم وليّ أمرٍ مدبّرٍ، فسوف يتسنّى لهم الادّخار، ولكن لو فُقد الانسجام والتعاون بينهم وبين إدارتهم، أو أنّهم تمرّدوا على أوامر ولي أمرهم، فسوف لا يتمكّنون من ادّخار أموالهم، وسيواجهون مصاعب في إدارة أمورهم.
إذًا، لو سلك أعضاء الأسرة أو المجتمع نهج الإسْراف والتَّبْذِير، فإنهم لن يتمكنوا من ادّخار ما يلبّي متطلّباتهم عند الحاجة، حتّى وإن كان وليّ أمرهم مدبّرًا وقانعًا. فإذا تمكّن الناس من ادّخار أموالهم وتسخيرها في النشاطات الإنتاجيّة، فسوف تتهيّأ الأرضيّة اللازمة للرقيّ الِاقْتِصَاديّ، وتتوافر فُرص العَمَل، ويرتفع المستوى المعيشيّ للناس. كما أنَّ الادّخار بذاته يُعدّ سببًا للحيلولة دون الإسْراف والتَّبْذِير. وكلّما زادت قدرة الناس على الادّخار، فسوف يبتعدون عن طبيعة الاستهلاك المُفرِط إلى حدٍّ كبيرٍ.
ومصادرنا الدينيّة حافلةٌ بنصوصٍ تؤكّد على أهمّيّة الادّخار، منها: ما قاله الإمام الرضاعليهالسلام: «إنَّ الإنسانَ إذا أدخل (ادّخر) طَعامَ سَنَةٍ، خَفَّ ظَهرُهُ وَاستَراحَ. وَكانَ أبو جَعفر وَأبو عَبدِ اللهِ عليهماالسلام لا يَشتَريانِ عُقدَةً، حَتَّى يُحرِزا طَعامَ سَنَتِهِما».
لو انتهج الإنسان هذا الأسلوب في المعيشَة، لا شك أنّه سينعم براحة البال، ويستقرّ نفسيًّا. وبالطبع، فإنّ راحة بال أيّ إنسان لها تأثيرٌ كبيرٌ على نشاطاته، فهي تعتبر أساسًا لتطوّره الفكريّ، وداعيًا لعطائه العَمَليّ، كما أنّها من أسباب تكامل شخصيّة الإنسان وسموّ المجتمع، وقد قال سلمان المُحَمَّدِيّ رضي الله عنه: «إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ».
ولا ريب في أنَّ التوفير والادخار يزرعان روح الطمأنينة بين جميع أعضاء الأسرة والمجتمع، ولا يُبقي مجالًا للقلق والاضطراب بشأن المستقبل في أذهانهم. فوليّ أمر كهذه أسرةٍ أو مجتمعٍ كهذا، سيكون محترمًا ومستّقلًا، حيث لا يضطرّ لأن يمدّ يده إلى الآخرين، طلبًا للمعونة.
لذا، فإنّ تأكيد الإمام الرضاعليهالسلام على ضرورة توفير متطلّبات الحياة لمدّة عامٍ، هو مثالٌ على الادّخار الممدوح الذي سنتطرّق
إلى ذكره لاحقًا، وهو في الحقيقة تأكيدٌ على أهمّيّة الادّخار بشكلٍ عامٍّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الادّخار ليس دائمًا، بمعنى: توفير الأموال في الحياة الدنيويّة، فهناكٌ ادّخارٌ معنويٌّ -أيضًا- أكّدت عليه النصوص الدينيّة، وفيه بركاتٌ عظيمةٌ لا تفنى، وتفوق بركات الادّخار المادّيّ. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ وهو في قبره وبعد موته: من علّم علمًا أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته».
يمكن تقسيم التوفير حسب أهدافه العقلائيّة والشرعيّة إلى قسمين، ممدوحٌ (ادّخارٌ مطلوبٌ)، ومذمومٌ (اكتناز منهيٌّ عنه):
إنّ الادّخار الممدوح أو التوفير الأمثل الذي يجب على المؤمن انتهاجه هو ما تتحقّق به أهدافٌ لا تتنافى مع العقل
والشرع، بل يتمّ من خلاله حفظ كرامة المؤمن، وعزّته، وصيانته وعياله من الفقر والحرمان، كما يعينه على القيام بواجباته على أكمل وجهٍ. ويتجلّى هذا النوع من التوفير في أمورٍ كثيرة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع معًا، منها: الوقف، والإنفاق في سبيل الله، ومساعدة الفقراء، وبناء مدارس، وبناء مستشفيات، وما إلى ذلك من أعمالٍ ممدوحةٍ.
وقصّة النَّبِيّ يوسف عليهالسلام في القرآن الكريم خير دليلٍ على أهمّيّة الادّخار، وذلك عندما فسّر رؤيا ملك مصر في البقرات السبع العجاف بسنوات الجفاف، والجدب، ومن ثمّ اقترح عليه توفير القمح وادخاره، لتجاوز هذه المحنة: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ (يوسف: 47-49).
ونستلهم من هذه الآيات المباركة أنّ الهدف من الادّخار يكون حميدًا، لو كان المراد منه حماية اقْتِصَاد المجتمع، والحفاظ على تماسكه، لدرجة أنّ نبيًا من أنبياء الله تعالى تولّى هذه المهمّة بنفسه، والنصوص الحديثيّة -أيضًا- أكّدت على هذا المبدأ في تَّدْبير المعيشَة، أي ضرورة ادّخار مؤونة سنةٍ، كما جاء في حديث الإمام جعفر الصادق عليهالسلام: «فَإنَّ النّاسَ إنَّما يُعطَونَ
ِن السَّنةِ إلى السَّنةِ، فَللرِّجُلِ أنْ يَأخُذَ ما يَكفِيهِ وَيَكفِي عِيالَهُ مِن السَّنَةِ إلَى السَّنَةِ».
وأجاب الإمام الرضاعليهالسلام على سؤال معمّر بن خلاّد عن توفير طعام سنةٍ، قائلًا: «أنا أفعَلُهُ»،
ويعني بذلك إحراز القوت.
إنّ توفير الخدمات العامّة للمجتمع من شأنه المساعدة على ادّخار النعمة، وفي الوقت نفسه يُعدّ ذخرًا معنويًا للعبد في آخرته، كحفر بئرٍ، أو شقّ قناةٍ، لتأمين مياه الشرب والسَّقي للناس. ولهذا التوفير آثاره المعنويّة التي لا ينكرها أحدٌ. قال الإمام الصادق عليهالسلام: «سِتُّ خِصالٍ يَنتَفِعُ بِها المؤمِنُ بَعدَ مَوتِهِ: وَلَدٌ صالِحٌ يَستَغفِرُ لَهُ، وَمُصحَفٌ يُقرَأ فِيهِ، وَقُلَيبٌ يَحفِرُهُ، وَغَرسٍ يَغرِسُهُ، وَصَدَقَةُ ماءٍ يجرِيهِ، وَسُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُؤخَذُ بِها بَعدَهُ».
وما أكثر الأعمال التي قام بها أمير المؤمنين عليهالسلام في هذا المضمار، وقد نقل خبر بعضها المؤرّخون كقيامه بحفر آبار «ينبُع»، وإنشاء قنواتٍ عديدةٍ، وتفجير عيون كثيرة كعين
«البغيبغة»، و«أبي نيزر»، وذكروا كيف جعلها وقفًا في سبيل الله تعالى. ولا زالت آثار بعضها باقيةً حتّى يومنا هذا في عدة مناطق كالمنطقة التي تُعرف باسم آبار عليٍّ.
فرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته الكرام كانوا مثالًا يُحتذى به في السبق إلى الخيرات، لأجل حفظ المصالح العامّة، وتوفير الخدمات لأبناء جلدتهم، ودائمًا ما كانوا يوصون الناس بذلك. فقد روى معتب: قال لي الإمام الصادق عليهالسلام : «قَدْ يَزِيدُ السِّعرُ بالمدِينةِ،كَمْ عِندَنا مِن طَعامٍ؟». قلت: عندنا ما يكفينا أشهرًا كثيرةً.
قال عليهالسلام : «أخرِجْهُ وَبِعْهُ». قلت: وليس بالمدينة طعامٌ؟!
قال عليهالسلام : «بِعْهُ». فلمّا بعته، قال عليهالسلام : «اشتَرِ مَعَ النّاسِ يَومًا بِيَومٍ»، ثمّ قال عليهالسلام: «يا معتبُ، اجعَلْ قُوتَ عِيالِي نِصفًا شَعِيرًا، وَنِصفًا حِنطَةً، فإنَّ اللهَ يَعلَمُ أنِّي واجدٌ أنْ أُطعِمَهُم الحِنطَةَ عَلَى وَجهِها، وَلكِنِّي أُحِبُّ أنْ يَرانِي اللهُ عزَّ وَجَلَّ قَد أحسَنتُ تَقديرَ المعِيشةَ».
وتأكيد تعاليمنا الدينيّة على أهمّيّة الادّخار المحمود وحثّنا
على انتهاجه، دليلٌ على فائدته ومكانته. فالشعب الذي يروم تحقيق الأهداف المنشودة في بلوغ درجات الرقيّ الِاقْتِصَاديّ، وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ، لا بدّ له من تسخير الأموال والجهود في هذا المضمار، وتحمّل بعض المصاعب، وغضّ النظر عن بعض ملذّات الحياة، وإن كانت مشروعةً.
إنّ جواز إدخار الأموال وتوفيرها لوقت الحاجة أو عدمه منوطٌ بالأهداف المتوخّاة منه، فإن كانت الأهداف تتّفق مع حكم العقل والشرع، يكون الادّخار مطلوبًا، ولا بدّ منه. وأمّا إن كانت هذه الأهداف لا تنسجم مع حكم العقل والشرع، فسيكون الادّخار حينها مذمومًا ومنهيًا عنه، لأنّه يؤدّي إلى تسخير الثروة في غير رضا الربّ، ويحرم المجتمع والفقراء من منافعه. إذ أنَّ أصحاب هذا المال المكتنز سيتنصّلون من أداء واجباتهم الماليّة تجاه أبناء مجتمعاتهم، فجمع المال من قِبَل الأثرياء، بهدف جني ثروةٍ طائلةٍ، أو احتكار بضاعةٍ يحتاجها الناس، سيؤدّي إلى حرمان الناس من حقوقهم المشروعة.
وهذا العَمَل بذاته يُعدّ من أكثر الأفعال قبحًا، وقد أنّب الله تعالى هؤلاء في كتابه المجيد تأنيبًا شديدًا، وهدّدهم بالعذاب الأليم فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
(138)لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: 34).
كما ذمّ عزَّ وَجَلَّ البخلاء، والذين يكنزون الأموال ولا ينفقوها، بقوله: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (النساء: 37).
ففعل البخيل مذمومٌ، لأنّه لا يُرجّح تلبية حاجات مجتمعه ودينه على ما يظنّه من حاجاتٍ قد تطرأ عليه وعلى أسرته، والبخيل لا يتقيّد بحدٍّ معيّنٍ لادّخار المال، بل يجمعه بشرَهٍ، ويحاول جني ثروةٍ دون رويّةٍ، إذ تطغى عليه الأنانيّة، ولا يعير أيّ أهمّيّةٍ لحوائج الآخرين، حتّى لو كان ذوي الحاجات مؤمنين، لأنّ مصلحة المجتمع الإسلاميّ لا تمتّ إليه بصلةٍ، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ، وهمّه الوحيد جمع أكبر قدرٍ ممكنٍ من المال.
إنَّ إدارة شؤون الحياة بأسلوبٍ مناسبٍ يتطلّب حُسن تدبيرٍ وتخطيطٍ صحيحٍ، ومَن يأخذ المستقبل بعين الاعتبار ولا يغفل عن عواقب أفعاله، سيضمن عيشًا رغيدًا لنفسه ولأهله.
والتخطيط للمدى البعيد على المستوى الِاقْتِصَاديّ يُعدّ من
المسائل الهامّة في ديننا الحنيف، إذ أعاره عظماء ديننا أهمّيّةً بالغةً. قال الإمام عليّ عليهالسلام : «فَدَعْ الإسرافَ مُقتَصِدًا، وَاذكُرْ فِي اليَومِ غَدًا، وَأمسِكْ مِن المالِ بِقَدَرِ ضَرورَتِكَ، وَقَدِّمْ الفَضلَ لِيَومِ حاجَتِكَ».
وذكر لنا الإمام الكاظم عليهالسلام عن والده الإمام الصادق عليهالسلام طريقة لحفظ المال وادّخاره، فقال: إنَّ رجلًا أتى الإمام الصادق عليهالسلام شبيهًا بالمستنصح فقال له: يا أبا عبد الله كيف صِرتَ تتّخذ الأموال، قطعًا متفرّقة، ولو كانت في موضعٍ واحدٍ كان أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «اتَّخذتُها مُتفَرِّقَةً، فإنْ أصابَ هذا المالَ شيءٌ، سَلِمَ هذا، وَالصّرَةُ تَجمعُ هذا كُلَّهُ».
فالإمام الصادق عليهالسلام يعلّمنا الأسلوب الصحيح في توفير المال، وذلك بادّخاره في عدّة أماكن، كاستثماره في عدّة مشاريع، فذلك أنسب وأحفظ له. فلو وقعت حادثةٌ، فإنّ المال لا يتلف كلّه، ويبقى منه شيءٌ، وهذا كفيل للإنسان بأن لا يحتاج إلى الآخرين حينها.
سنتجري في هذا الفصل من الكتاب مقارنة بين موضوعين أساسيّين، هما: حُسن التَّدبير، وسوء التَّدبير، بهدف بيان الآثار المترتّبة على كل منهما بلحاظ ما أوردناه في الفصول السابقة من الكتاب. وبالطبع، فإنّ نطاق التَّدبير واسعٌ جدًا، لذا، سنكتفي بذكر بعض جوانبه.
لا شكّ في أنّ حُسن التَّدبير والتخطيط الصحيح للمعيشة، يمكّن الإنسان من التنعّم بحياةٍ مثاليّةٍ. والحياة المثاليّة حسب التعاليم الإسلاميّة، هي حياة الكفاف التي يتمكّن المسلم فيها من تأمين سلامته النَّفْسيّة والبدنيّة، من خلال سعيه الحثيث، كما يتسنّى له فيها اجتناب الإفراط والتفريط في المعاش، لذلك، فإنّ نبيّنا الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام حفّزوا الناس على القناعة والكفاف في المعيشَة. فالإنسان في معيشةٍ كهذه، سيتمكّن من توفير نفقات معيشَته، والمتطلّبات المشروعة لأسرته ومجتمعه.
ونفقات المعيشَة على المستوى الشخصيّ تشمل: جميع النفقات التي يحتاجها الإنسان في تأمين حياةٍ مثاليّةٍ ونزيهةٍ، حيث تشمل أجور الطعام، والثياب، والسكن، وأجور النقل،
وما شاكل ذلك. كما يُفترض بالإنسان أن يسخّر الفاضل من دخله لبعض الموارد المعيشيّة، كاقتناء العطور، ووسائل النظافة، والصحّة، والتزيين المعتدل، والاهتمام باللباس، وإذا اقتضت الضرورة، يمكنه أن يشتري ما يحتاج إليه من وسائل تعينه في حياته، أو يقوم بإصلاح ما لديه من وسائل تالفة أو تعميرها.
أمّا نفقات الأسرة، فتشمل كلّ ما يحتاج إليه ممَّن تجب نفقتهم من أفرادها، إذ يجب على ربّ الأسرة أن يوفّر جميع متطلّبات والديه وزوجته وأبنائه، من مأكلٍ متنوّعٍ، وملبسٍ مناسبٍ. كما يجدر به أن يكون قادرًا على ضيافة الأصدقاء والأقارب وإطعامهم، ويسعى لتحسين نوع الغذاء الذي يقتنيه في الأعياد وسائر المناسبات، ويحاول تأمين مؤونة عامٍ كاملٍ، واعتبر الإمام محمد الباقر عليهالسلام أنَّ طلب الرزق في الدنيا، بهدف التعفّف، وتلبيةً لمتطلّبات الأسرة، وإعانةً للجار، أمرٌ ممدوحٌ، وثوابه الأخرويّ عظيمٌ جدًا. حيث قال عليهالسلام : «مَن طَلَبَ الرِّزقَ فِي الدُّنيا، استعفافًا عَن النّاسِ، وَتَوسِيعًا عَلى أهلِهِ، وتَعَطُّفًا عَلَى جارِهِ، لَقِيَ اللهَ عزَّ وَجلَّ يَومَ القِيامَةِ وَوَجهُهُ مِثلُ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ».
وأمّا النفقات الاجتماعيّة، فهي الأموال التي ينفقها الإنسان، لتحسين وضع المجتمع، ونظم أموره. فالحقوق الماليّة على
قسمين: واجبةٌ ومستحبّةٌ، منها القرض والعارية. وبالطبع، فإنّ الإنسان مكلَّفٌ بأداء نشاطاتٍ إيجابيّةٍ في مجتمعه عبر بذل الأموال حسب استطاعته، مثل: إعانة ذوي الحاجة لتيسير زواجهم. كما يجب عليه المشاركة في العبادات الجماعيّة، كالحجّ الذي تُشرط فيه الاستطاعة الماليّة.
إذًا، نستنتج ممّا ذُكِرَ أنّ الحياة المثاليّة تتحقّق عندما ينعم الإنسان بحياةٍ مناسبةٍ مادّيًا في المجالين الكمّيّ والنوعيّ، وهذه هي الحياة التي تنطبق مع تعاليم الشريعة الإسلاميّة، لما تتمتّع به من كفايةٍ وطمأنينةٍ. وبالتأكيد، فإنّ الرفاهيّة الشخصيّة مقدمة لتحقّق الرفاه الاجتماعيّ -أيضًا- وفائدة الرفاهيّة تكمن في قابليّة استثمار جميع أعضاء الأسرة أو المجتمع إمكانيّاتهم إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ، وقدرتهم على مزاولة مهامّهم العائليّة، والأخلاقيّة، والاجتماعيّة، والِاقْتِصَاديّة، بدقّةٍ واهتمامٍ كبيرين.
وهناك أمورٌ تتعلّق بموضوع الرفاهيّة في المعيشَة، لا بدّ لنا من ذكرها هنا، وهي:
أ. إنّ الله تعالى يريد لعباده أن يعيشوا حياةً مرفّهةً، حيث أكرمهم بنَعمٍ لا حصر لها، كما قال في كتابه المجيد: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 32). ويسّر تعالى لهم استثمار هذه النِّعم
دون عناءٍ ومشقّةٍ، ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (النحل: 7).
ب. إنّ توفير وسائل الراحة والرفاهيّة، من شأنه إعانة الإنسان لبلوغ درجة القرب الإلهيّ، لأنّ التنعّم بعطاء الله تعالى لا بدّ وأن يكون داعيًا لزيادة شكر العبد، وتهذيب نفسه، فيتقرّب بذلك من ربّه. لذا، عليه أن لا يُعاند ولا يغفل عن ذلك. فالكثير من الناس عندما يُنعِم الله تعالى عليهم يغفلون عن ذكره وشكره، وقد تؤول بهم الأوضاع إلى الطغيان والتمرُّد على أوامره.
ت. يختلف معنى الرفاهيّة في التعاليم الإسلاميّة عن معناها في الأفكار والنظريّات الأخرى، إذ توصي تعاليمنا الدينيّة بوجوب تحقّقها بطرقٍ مشروعةٍ، وعدم ابتنائها على أساسٍ مُحرّمٍ، أو جعلها تؤدي إلى التعدّي على حقوق الآخرين، أو الوقوع في الإسْراف والتَّبْذِير.
ث. إنّ المثل العليا للحياة المرفّهة في المجتمع الإسلاميّ تتطلّب تغييراتٍ جذريّةً في الرُّؤى والمبادئ، وهذه التغييرات لا تتحقّق إلا في ظلّ حكومة الإمام المهديّ عليهالسلام إذ بعد ظهوره الميمون، سوف تُخرِج الأرض بركاتها، وينعم الناس بخيراتٍ لا نظير لها على مرّ العصور. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «تَتَنعَّمُ أُمَّتِي فِي زَمنِ المهديِّ عليهالسلام نِعمَةً لَم يَتَنعَّمُوا مِثلها قَطُّ، يُرسِلُ السَّماءَ عَلَيهِم
(145)مِدرارًا، وَلا تَدَعْ الأرضُ شَيئًا مِن نَباتِها إلا أخرَجَتهُ».
إنَّ حُسن التَّدبير يقتضي العَمَل على تنظيم معدّل التكاثر في المجتمع، وبعض النصوص الدينيّة تحذّر الناس من التكاثر غير المحدود. قال الإمام الصادق عليهالسلام : «هَلَكَ صاحِبُ العِيالِ»، والتَّدبير الصحيح في هذا المجال، من شأنه أن يُعين الحكومة في السّيطرة على معدّل الارتفاع السكّانيّ، ووضعٍ برنامجٍ منظّمٍ له. فالكثافة السكّانيّة المنسجمة مع الإمكانيّات الِاقْتِصَاديّة، تُعدّ من دعائم الرفاه الِاقْتِصَاديّ في المجتمع، الأمر الذي أكّد عليه الإمام عليّ عليهالسلام ، بقوله: «قِلَّةُ العِيالِ أحَدُ اليَسارَينِ».
إنَّ استقرار الفرد والمجتمع منوطٌ بكيفيّة استثمار الثروات المختلفة. وقد أكّدت الشريعة المقدّسة على ضرورة اتّخاذ أنسب السبُل في استثمار الأموال، كإيداعها في أيدٍ أمينةٍ ذات أفقٍ فكريٍّ اقْتِصَاديٍّ ناضجٍ، وعدم تمكين السُّفهاء منها، حيث قال تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).
كما ذمّت ركود الثّروة، وأنّبت الذين يكتنزون الأموال والذين يهدرونها عبثًا على حدٍّ سواء، لأنّ هذه التصرّفات تزلزل أركان المجتمع اقْتِصَاديًا، وتحول دون تطوّره.
فالإنسان يكون قادرًا على التنعّم بحياته من خلال جهوده المثمرة، وحسن تَّدْبيره في استثمار ما بحوزته من مصادر اقْتِصَاديّةٍ، إذ من المؤكّد أنَّ الاستثمار العشوائيّ للثروة، والإسْراف، والهدر والتكاسل، كلّها أمورٌ تسوق الإنسان نحو الفقر، والتخلّف، والتبعيّة للآخرين، والاستثمار السيّئ للثروات أمرٌ يُبغِضُهُ الله تعالى، حتّى إهدار قليلٍ من الماء، حيث قال الإمام الصادق عليهالسلام : «إنَّ السَّرفَ أمرٌ يُبغِضُهُ اللهُ عزَّ وَجلَّ... حَتَّى صَبُّكَ فَضلَ شَرابِكَ».
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر إهمال الأرض الخصبة ذات المياه الوفيرة، وعدم قدرة الناس على استثمارها، وهذا يُعدّ أمرًا غير منطقيٍّ، ولا ينسجم مع العقل وأصول التَّدبير الصحيح، بل سيؤدّي إلى حرمان الناس من رحمة الله تعالى، وقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول: «مَن وَجَدَ ماءً وَتُرابًا ثُمَّ افتَقَرَ، فَأبعَدَهُ اللهُ»، أي: أبعده الله عن رحمته؛ نعوذ بالله من ذلك، وفي هذا غاية التغليظ والتشنيع على من وَجَدَ ماءً وَتُرابًا ثُمَّ افتَقَرَ.
إنَّ المسؤول الناجح هو المدبّر الذي يتمكّن من وضع مناهج اقتصاديّةٍ مناسبةٍ في كل نشاطاته الإداريّة، ويرجّح أداء الأهمّ على المهمّ، حسب الأولويّات المطروحة في عمله والنتائج المتوخّاة، أي أنّه قبل اتّخاذ أيّ قرارٍ لا بدّ له من القيام بدراسته على كافّة المستويات، وعليه بذل قصارى جهده لسلوك الطريق الصحيح في إدارة الأمور. فوليّ الأمر الذي يتعقّل في أفعاله ويتّخذ التَّدبير منهجًا له، سوف لا يندم على تصرّفاته، لأنّ البرنامج الصحيح والمنسّق قبل العَمَل يحول دون الانحراف والزلل. وقد اختصر سيّد البلغاء الإمام عليّ عليهالسلام هذه الأمور بجملةٍ قصيرةٍ، فقال: «التَّدبِيرُ قَبلَ العَمَلِ يُؤمِنُكَ مِن النَّدَمِ».
إذا كان الادّخار: هو حفظ الأموال التي يُحصل عليها الإنسان من دخله الحاليّ، من أجل إنفاقها في المستقبل، وهو شرط مسبق لعملية الاستثمار، فإنَّ الاستثمار، هو تسخير هذه الأموال في عجلة الإنتاج، وكَسْب دخلٍ جديدٍ.
والبرنامج الناجح في الادّخار والاستثمار ذو صلةٍ وثيقةٍ بالتَّدبير في أمور المعيشَة وتخصيص الدخل الفرديّ، لأنّ
الاستهلاك المُفرِط للأموال أو ركودها لا يؤدّي إلى تحقيق أيّ عائدٍ منها، كما هو الحال في التقاعس عن أداء الواجبات الذي لا يتحقّق من ورائه أي ادّخار.
والأراضي الزراعيّة ذات المحاصيل الوفيرة التي أوقفها أهل الإيمان في عهد الأئمّة المعصومين عليهمالسلام، ولا سيّما عهد الإمام عليّ عليهالسلام ، حظِيَت باهتمامهم عليهمالسلام، وبذلوا قصارى جهودهم في حفظها واستثمارها قدر المستطاع. وهذا الأمر بذاته شاهدٌ على حسن تَّدْبيرهم، وأهمّيّة الادّخار والاستثمار عندهم عليهمالسلام. وبالطبع، فإنّ إدارة مشاريع ضخمةٍ كهذه من دون تَّدْبيرٍ صحيحٍ ومنهجٍ دقيقٍ، سوف تكون فاشلةً، لذلك يجب على الإنسان أن يقتدي بهم عليهمالسلام في كل شؤون مَعِيشَتَه.
لو تمّ تحديد أهدافٍ صحيحةٍ في برامج المعيشَة، فسوف يلوح أُفقٌ جديدٌ للمستقبل الزاهر. لذا، يجب على الإنسان تعيين زمنٍ مناسبٍ لأداء أيّ عملٍ برؤيةٍ دقيقةٍ، وكذلك عليه دراسة مدى الإمكانيّات المتاحة، لكي يتسنّى له وضع برنامجٍ منظّمٍ من جميع الجهات. وبالطبع، فإنّ ثمرة برنامجٍ كهذا تتجلّى في نظم الأوضاع المعيشيّة والِاقْتِصَاديّة للفرد والمجتمع. والحصيلة النهائيّة ستكون نموًا اقتصاديًا ورخاءاً للجميع. فقد رويَ عن
الإمام عليّ عليهالسلام أنّه قال: «حُسن التَّدبيرِ ينمي قَليلَ المالِ».
إنّ العزّة والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها خَاتَم النَّبِيِّين صلىاللهعليهوآلهوسلم، وغرسها في نفوس أتباعه، وتعهَّد نماءها بما سنّه من أحكام، ووجَّه به من آداب، وقال حفيده الإمام الصادق عليهالسلام : «إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن أموره كلّها، ولم يُفوّض إليه أن يذلّ نفسه ألم ترَ قول الله سبحانه وتعالى هاهنا: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾».
ولا شكّ في أنّ الإنسان الذي يُحسن التَّدْبير في مَعِيشَتَه، سيحفظ كرامته وعزّته في المجتمع. وسنتتعرض إلى ذكر بعض المسائل التي وردت في هذا الشأن العظيم، كي تتّضح مدى أهمّيّته.
فالعزّة: «حالةٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُغلَب، والقرآن الكريم بدوره أكّد على سموّ هذه الصفة في آياتٍ عديدةٍ، نذكر منها ما يلي:
أنَّ العزّة الحقيقيّة لله تعالى: ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم﴾ (يونس: 65).
كما أنّ العزّة لله تعالى، فكذلك لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وللمؤمنين: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون: 8).
وطريق كَسْب العزّة، يكون بالتقرّب إلى الله عزَّ وَجَلَّ وطلبها منه: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ (فاطر: 10).
وقد عقّب السيد الطباطبائيّ على هذه الآية، قائلًا: «هذا القول ليس بمسوقٍ لبيان اختصاص العزّة بالله، بحيث لا ينالها غيره، وأنّ من أرادها فقد طلب محالًا وأراد ما لا يكون، بل المعنى: من كان يريد العزّة، فليطلبها منه تعالى، لأنّ العزّة له جميعًا لا توجد عند غيره بالذات. فوضع قوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ في جزاء الشرط، من قبيل: وضع السبب موضع المسبّب، وهو طلبها من عنده، أي اكتسابها منه بالعبوديّة التي لا تحصل إلا بالإيمان والعَمَل الصَّالِح».
ومعلوم لدى كل عزيز أنَّ عزّة النَّفْس تقوّي روح التحرّر وحبّ الاستقلال لدى جميع أعضاء المجتمع، لأنّ إحساس الإنسان بالاستغناء عن الآخرين يرسّخ دعائم التحرّر والاستقلال
في نفسه، ولعزّة النَّفْس فوائد في الجانب الِاقْتِصَاديّ -أيضًا-، منها أنّها:
- تساعد على رفع مستوى الإنتاج، وتقليص الاستهلاك، وزيادة الادّخار.
- تحفّز الإنسان على استثمار الفائض عن الحاجة من الدخل في مساعدة الفقراء، ووقف أشياءٍ يحتاجها المجتمع.
- تكون وازعًا لعدم إنفاقِ المال في التجمُّل المُفرِط، وسببًا لاجتناب الإسْراف وتبذير الأموال الخاصّة والعامّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مراعاة الاستراتيجيّات الصحيحة في تَّدْبير المعيشَة، كالبرنامج المنظّم، والنظم والانضباط، والرؤية المستقبليّة، واتّباع الإنسان هذه الاستراتيجيّات، يؤدّي به إلى أن ينعم بحياةٍ مرفّهةٍ، ويحقّق طموحاته.
يحصل -أحيانًا- الفقر نتيجةً لسوء التَّدْبير في المعيشَة، بحيث تُبتَلى به بعض العوائل، وربّما مجتمعات بأسرها. ويمكن تقسيم الفقر إلى نوعين، هما: فقرٌ مطلقٌ، وفقرٌ نسبيٌّ.
فالفقر المطلق: هو عدم قدرة الإنسان على تلبية الحاجات
(152)الضروريَّة في حياته، كالمأكل، والملبس، والمسكن، والعلاج.
أمّا الفقر النسبيّ: فهو عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة الطبيعيّة، أي أنّ الإنسان يحيى حياةً تتوافر فيها المستلزمات الضروريّة للعيش، ولكنّه يفتقر إلى بعض إمكانيات الرّفاهية، التي توفّر له سبُل الراحة بشكلٍ أكبر، وتساعده على رفع مستواه المادّيّ.
من النتائج الأخرى لسوء التَّدْبير، وفقدان البرنامج الصحيح في المعيشَة، ابتلاء الإنسان بالإسْراف والتَّبْذِير، حيث تطرّقنا إليهما آنفًا. فحياة البذخ حسب التعاليم الإسلاميّة تُعدّ كفرانًا للنّعمة، ومن الذنوب التي تُوجب العقاب الإلهيّ في الحياة الآخرة قال تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (غافر: 43)، والعقلاء بدورهم ـ أيضًا ـ يذمّون حياةٍ كهذه ولا يستسيغونها، لذا يجب على الإنسان أن يراعي حُسن التَّدْبير في مَعِيشَتَه، ويجتنب الإسْراف والتَّبْذِير. فقد رويَ عن الإمام عليّ عليهالسلام في هذا الشأن: «مِن العَقلِ مُجانَبَةِ التَّبذِيرِ وَحُسنُ التَّدبِيرِ».
وتُعدّ حُرمة الإسْراف والتَّبْذِير من الأحكام الأساسيّة في النظام
الِاقْتِصَاديّ الإسلامي، حيث يقضي هذا الإنفاق للأموال على روح العبوديّة لدى الإنسان، ويسلب منه الشعور بالمسؤوليّة، ويجعله أنانيًا يعارض أيّ إصلاحٍ اجتماعيٍّ. وكل ذي فكر بناء يعلم أنَّ حياة الإسْراف تمسخ شخصيّة الإنسان، وتفرغ فكره من القيَم المعنويّة، كما أنّها تمهّد الأرضية اللازمة لانتشار الفساد، ورواج المبادئ المنحرفة في المجتمع، ونذكر في ما يلي بعض العواقب الوخيمة للإسراف:
- الحرمان من محبّة الله تعالى: وقد قال في كتابه المجيد: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام: 141).
- زوال النعمة والحرمان من البركة: قال الإمام الكاظم عليهالسلام : «وَمَن بَذَّرَ وَأسرَفَ زالَتْ عَنهُ النِّعمَةُ»، وقال الإمام الصادق عليهالسلام : «إِنَّ مَعَ الإسرافِ قِلَّةُ البَرَكَةِ».
- عدم استجابة الدعاء: قال الإمام الصادق عليهالسلام : «أربَعةٌ لا يُستَجابُ لَهُم دعاءٌ: رَجُلٌ جالِسٌ فِي بَيتِهِ يَقولُ يا رَبِّ ارزُقنِي،
فيقولُ لَهُ: أَلَم آمُرُكَ بالطَّلَبِ؟! وَرَجُلٌ كانَتْ لَهُ امرَأةٌ فَدَعا عَلَيها، فيقولُ لَهُ: أَلَم أَجعَل أمرَها بيدِكَ؟! وَرَجُلٌ كانَ لَهُ مالٌ فَأفسَدَهُ، فَيقُولُ يا رَبِّ ارزُقنِي، فيقولُ لَهُ: أَلَم آمُرُكَ بالاقتَصادِ أَلَم آمُرُكَ بالإصلاحِ؟!».
- استجلاب الفقر: قال الإمام عليّ عليهالسلام : «سَبَبُ الفَقرِ الإسرافُ».
والجدير بالذكر: أنّ اعتقاد الإنسان بالمعاد والحساب في الحياة الآخرة يؤثّر على سلوكه، ويجعله دقيقًا في حساباته الِاقْتِصَاديّة وإنفاقه، لذلك أمرت الشريعة الإسلاميّة العباد بوجوب اجتناب النشاطات الِاقْتِصَاديّة التي تتنافى مع الأصول الدينيّة وتتعارض مع مصلحة المجتمع. وكذلك ألزمتهُ بترك التفريط في الأموال العامّة، كالماء، والكهرباء، ...، وترك الإفراط في النوم، والطعام، والثياب، والضيافة، والحفلات، والمناسبات العائليّة، ... وما شاكل ذلك.
لو لم يتّبع الإنسان أو المجتمع منهجًا اقتصاديًا صحيحًا مبني على خططٍ بعيدة الأمد لتَّدْبير المعيشَة، فلا محالة سيُبتلى
بالتبعيّة للآخرين من الناحية الِاقْتِصَاديّة، أي أنّ زمام أموره المادّيّة ستكون بأيدي الآخرين. وهذا الوضع لا تُحمد عُقباه، وله مساوئ كثيرة، منها:
إنّ المجتمعات المرفّهة اقتصاديًا والتي تتمتّع باكتفاءٍ ذاتيٍّ، تؤمِّن بعض متطلّبات المجتمعات الأخرى المحرومة، مما يجعلها متحكِّمة بتلك المجتمعات. وجعلها تابعة لها اقتصاديًا، ومن الملاحظ أنَّ جُل أبناء المجتمعات التابعة ليس لهم فكرٌ إبداعيٌّ يمكّنهم من توفير متطلّباتهم، بسبب توفّر سبُل العيش من مصدرٍ آخر، وبالتالي سوف تبقى قابليّاتهم كامنةً، ولن يتمكّنوا من استثمارها. وقد تقوم المجتمعات المُنتجة باستغلال قابليّات أبناء المجتمعات التابعة لها، وتسخّرها لمصالحها الخاصّة.
إنَّ أبناء المجتمعات التابعة اقتصاديًّا لغيرها لا يجدون في أنفسهم قابليّة توفير متطلّباتهم المعيشيّة، لذلك، فهم يشعرون بالنقص، وفي الوقت نفسه ينظرون إلى أبناء المجتمعات المتطوّرة اقتصاديًا نظرة علوٍّ واحترام، لأنّهم تمكّنوا من بلوغ أهدافهم.
(156)إنّ المجتمعات النافذة من خلال تصدير بضائعها وخبرائها إلى المجتمعات الضعيفة اقتصاديًا، تقوم في الوقت نفسه بتصدير ثقافتها، ونشر أفكارها في تلك المجتمعات. ومن جانبٍ آخر، فإنّ أبناء المجتمعات الفقيرة، من منطلق إحساسهم بالعجز، وانبهارهم بقدرة المجتمعات النافذة، يحاولون تقليدهم في شتّى المجالات، مثل: نوعيّة الثياب، ووسائل الزينة، والسلع الاستهلاكيّة والآلية، وما شاكل ذلك، بل إنّهم يتأثّرون بخلُقهم وطباعهم النَّفْسيّة، وهذا الأمر سيؤدّي إلى التبعيّة الثقافيّة، ومسخ الثقافة الأصيلة.
من المؤكّد أنّ الفرد أو المجتمع لو كان ذليلًا أمام الآخرين، ولم يتمكّن من توفير متطلّبات حياته، سيكون عبدًا لهم، وقد قال إمام العارفين عليّ عليهالسلام : «لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا».
إنّ مفهوم إهدار المال يشمل كلّ عملٍ يُتلِف المال ويتسبَّب
في ضياعه، مثل: الإسْراف، والاستهلاك المُفرِط، والجهل بأُسس الإنفاق، واستغلال الثروة، والتقصير، واللامبالاة في إنفاق المال، وفقدان الإشراف الصحيح على إنفاقه، وسوء التَّدْبير في تسخيره بشكلٍ عامٍّ.
ومهما كان السبب في إهدار الأموال، فإنّ نتيجته واحدة، ألا وهي: إتلاف الثّروة. وبالتالي عدم القدرة على أداء الواجبات العائليّة والاجتماعيّة. وقد يؤدّي كذلك إلى تلكّؤ مسيرة الرقيّ المعنوي للإنسان، لأنّ المسيرة المعنويّة للعبد في الدنيا مرهونةٌ بتوافر السبُل المادّيّة، والظروف المعيشيّة المناسبة، التي تعطيه النشاط الضروريّ للعبادة. وبالطبع، فإنّ هذه الأمور يمكن تحقيقها من خلال المال. ولذلك اعتبر القرآن الكريم المالَ بأنّه سببٌ لتقويم حياة البشر، حيث قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (النساء: 5).
كما أنَّ الأحاديث الشريفة -بدورها- تؤكّد أنّ توفير سبُل المعيشَة ضرورة من ضرورات الحياة، وعدّت إهدار الأموال أمرًا بغيضًا. فعن الإمام الرضاعليهالسلام : «إِنَّ اللهَ يُبغِضُ القِيلَ
وَالقالَ، وَإِضاعَةَ المالِ، وَكَثرَةَ السُّؤالِ»، وهذه أمور نهى عنها النَّبِيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم، وروي عنه أَنَّهُ قال: «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ عَنْ قِيلٍ وقَال، وإِضَاعَةِ الْمَالِ، وكَثْرَةِ السُّؤَالِ، فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِنًا كَسَبَ طَيِّبًا وأَنْفَقَ قَصْدًا، وقَدَّمَ خَيْرًا».
بالمحصلة، إذا لم يكن هناك برنامجٌ معيشيٌّ صحيحٌ، وحُسن تَّدْبيرٍ في الأمور الِاقْتِصَاديّة، فسوف تتزلزل المعاملات الماليّة، وقد يتعرّض البعض إلى الغبن، وربّما يكون ذلك سببًا لإتلاف المال، وإهدار ثروات الأفراد والعوائل والمجتمع، وأما إذا صار حُسن التَّدْبير للإنسان خُلقًا يتحلّى به، فإنه سيعصم صاحبه من السوء ويقرنه بالخير.
وللعلم والبيان إنَّ جميع المفاهيم التي وردت في هذا الكتاب جمعها وارث أصحاب الكِساء الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهالسلام في فقرة واحدة من دعاء كان يناجي فيه ربه سبحانه وتعالى، قائلًا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاحْجُبْنِي عَنِ السَّرَفِ وَالِازْدِيَادِ، وَقَوِّمْنِي بِالْبَذْلِ وَالِاقْتِصَادِ، وَعَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ، وَاقْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ، وَأَجْرِ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلَالِ
أَرْزَاقِي، وَوَجِّهْ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ إِنْفَاقِي، وَازْوِ عَنِّي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْدِثُ لِي مَخِيلَةً أَوْ تَأَدِّيًا إِلَى بَغْيٍ أَوْ مَا أَتَعَقَّبُ مِنْهُ طُغْيَانًا».
جعلنا الله وإياكم من المهتدين بهديّ النَّبِيّ المصطفى والأئمة الأطهار من أهل بيته، ومن المقتفين آثارهم السالكين منهاجهم الآخذين بحجزتهم والماكثين في ظلّهم، وممن عناهم سبحانه بقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: 18)، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الأطياب.
ترجمة: السيّد عليّ محمّد الرفيعي، ط1، المؤسّسة العالميّة للفكر الإسلاميّ، طهران.
الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين.
الوفاء، بيروت.