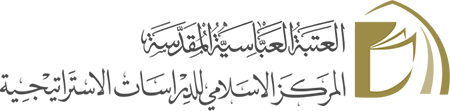
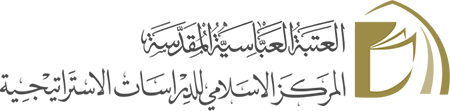
الفصل الأوّل: الحركة الاستشراقيّة: مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآليّاتها: | 13
1- تعريف الاستشراق والمستشرق | 15
2- نبذة تاريخية مختصرة عن مراحل الحركة الاستشراقية | 25
3- علاقة الاستشراق بالتبشير(التنصير) والاستعمار | 41
4- أهداف الحركة الاستشراقية ودوافعها | 49
5- آليات الحركة الاستشراقية ووسائلها | 63
الفصل الثاني: الحركة الاستشراقيّة: مدارسها، مجالاتها، وخصائصها،ودوافعها لدراسة القرآن: | 75
1- أبرز المدارس الاستشراقيّة وأهم المستشرقين | 77
2- الدراسات الاستشراقية، المجالات والخصائص | 137
3- دوافع المستشرقين لدراسة القرآن الكريم | 165
الفصل الثالث: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة والقرآنيّة: | 177
1- المناهج العامّة للمستشرقين | 181
2- مناهج المستشرقين في دراستهم للقرآن | 201
الفصل الرابع: القرآن: مصدره، وتاريخه، وترجمته عند المستشرقين: | 233
1- حقيقة القرآن ونظريّات الوحي عند المستشرقين | 237
2- القرآن في دوائر المعارف والمعاجم القرآنية الاستشراقية | 275
3- آراء المستشرقين في مصادر القرآن الكريم وموثوقيّة النصّ القرآنيّ | 295
4- ترجمة القرآن الكريم (دراسة نقدية) | 335
الفصل الخامس: مباحث علوم القرآن في دراسات المستشرقين: | 367
3- آراء المستشرقين في نسخ القرآن الكريم | 405
5- آراء المستشرقين في القراءات القرآنية | 433
مقدِّمة المركز7
مقدِّمة المؤلِّف 9
الفصل الأوّل: الحركة الاستشراقيّة: مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآليّاتها:
1- تعريف الاستشراق والمستشرق15
2- نبذة تاريخية مختصرة عن مراحل الحركة الاستشراقية 25
3- علاقة الاستشراق بالتبشير(التنصير) والاستعمار41
4- أهداف الحركة الاستشراقية ودوافعها49
5- آليات الحركة الاستشراقية ووسائلها63
الفصل الثاني: الحركة الاستشراقيّة: مدارسها، مجالاتها، وخصائصها و
دوافعها لدراسة القرآن:
1- أبرز المدارس الاستشراقيّة والمستشرقين77
2- مجالات الدراسات الاستشراقية137
3- دوافع المستشرقين لدراسة القرآن الكريم165
الفصل الثالث: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة والقرآنيّة:
1- المناهج العامّة للمستشرقين181
2- مناهج المستشرقين في دراستهم للقرآن201
(5)الفصل الرابع: القرآن: مصدره، وتاريخه، وترجمته عند المستشرقين:
1- حقيقة القرآن ونظريّات الوحي عند المستشرقين237
2- آراء المستشرقين في مصادر القرآن الكريم وموثوقيّة
النصّ القرآنيّ 275
3- القرآن في دوائر المعارف والمعاجم الاستشراقية295
4- الترجمات الاستشراقية للقرآن الكريم335
الفصل الخامس: آراء المستشرقين في المباحث الأساسيّة لعلوم القرآن:
1- جمع القرآن الكريم369
2- المكّي والمدني389
3- النسخ في القرآن405
4- إعجاز القرآن423
5- القراءات القرآنية433
6- شبهات المستشرقين عن ادّعاء الأخطاء اللغويّة في القرآن453
الخاتمة466
فهرس المصادر والمراجع 473
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزّ المرسلين سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآله، وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
أَوْلى المستشرقون الغربيّون اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم نشأ في كثير من الأحيان من المخاوف التي استحوذت على عقليّة الإنسان الغربيّ ونظرته إلى الإسلام نظرة المنافس المهدِّد له باستلاب حضارته وثقافته، فظهر الجدل ضدّ القرآن الكريم مبكِّرًا، منذ القرون الوسطى في الغرب، في الخطاب الدينييّ اليهوديّ والمسيحيّ على لسان يوحنا الدمشقيّ (ت: 749م)، وموسى بن ميمون (ت: 1204م)، وتوما الأكويني (ت: 1274م)، ورئيس دير كلوني بطرس المبجَّل (ت: 1156م) الذي كان أوّل من شجّع على مشروع ترجمة القرآن الكريم إلى لغة غربيّة ودعمه، فظهرت أوّل ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينيّة على يد البريطاني روبرت كيتون (Robert of Ketton) في الفترة الممتدة بين (1136-1157م)، ثمّ تتابعت من بعدها الترجمات إلى اللغات الأوروبيّة المختلفة؛ كالإنكليزيّة، والفرنسيّة، والألمانيّة، والإيطاليّة، والهولنديّة، والإسبانيّة، والروسيّة، ... ولم يقتصر عمل المستشرقين على هذا المجال بالنسبة للقرآن الكريم، بل اتّسعت جهودهم إلى مجالات أخرى تتعلّق بالقرآن الكريم؛ كعلوم القرآن والتفسير والدراسات القرآنيّة، فبرزت في هذا الصدد شخصيّات استشراقيّة عدّة تنتمي إلى مدارس استشراقيّة أوروبيّة؛ ألمانيّة، وبريطانيّة، وفرنسيّة، ومجريّة...؛ من قبيل: الألمانيّ تيودور نولدكه (Theodor Noldke) (ت: 1930م)، ومواطنه رودي باريت (Rudi
Paret) (ت: 1983م)، والمجريّ إجنتس جولدتسيهر (Ignaz Goldziher) (ت: 1921م)، والبريطانيّ ريتشارد بيل (Richard Bell) (ت: 1952م)، والفرنسيّ ريجيس بلاشير (Regis Blachere) (ت: 1973م)، والأستراليّ آرثر جفري (Arthur Jeffery) (ت: 1959م)، ... ووصلت هذه الجهود الاستشراقيّة في مجال دراسة القرآن إلى مرحلة إصدار موسوعات خاصّة؛ كـ«موسوعة القرآن» التي صدرت ما بين
(2000-2006م) عن دار بريل الهولنديّة ضمن ستّ أجزاء، والعمل على مشاريع بحثيّة أخرى؛ كمشروع الموسوعة القرآنيَّة الألمانيَّة (Corpus Coranicum)، الذي بدأ تنفيذه عام 2007م، وتستمرُّ فعاليَّاته حتَّى العام 2025م، والمشروع الداعم له (Coranica)؛ وهو مشروع ألماني- فرنسيّ.
وقد أدّت هذه الجهود الاستشراقيّة في أغلب ما نتج عنها -عن تعمّد أو عن قلّة إطلاع وعلم ودراية- إلى الوقوع في أخطاء خطيرة وجسيمة لا تليق بالقرآن الكريم؛ وهو منزّه عنها؛ ما استدعى ذلك ردودًا من قِبَل العلماء والباحثين المسلمين على مدار العقود المنصرمة.
ويأتي هذا الكتاب بوصفه أحد الجهود العلميّة والتحقيقيّة المبذولة في التعرّف على جهود المستشرقين القدامى في ترجمة القرآن الكريم ودراسة دوافعهم لدراسة القرآن، ومناهجهم في فهم القرآن، إذافة إلى بيان الرأي الحق في الوحي وجمع القرآن وإعجازه، وغيرها من الموضوعات القرآنية الرئيسة، التي سعى المستشرقون لحرفها عن الحقيقة والواقع، ونقد مقولاتهم وتصحيح أخطائهم ودرء شبهاتهم في هذا الصدد.
نرجو أن يقدِّم هذا الكتاب إضافة علميّة وبحثيّة مرجعيّة للباحثين وللطلاب في تعرّفهم على جهود الحركة الاستشراقيّة في مجال الدراسات القرآنيّة ومدارسها وأقطابها ومدارسها ومقولاتها ونقد هذه المقولات.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الدراسة جهد علميّ، وبحثيّ متواضع في عرض دراسات المستشرقين عن القرآن الكريم ونقدها، وأبرز أعمالهم الفكريّة والعلميّة في هذا المجال.
وقد حاولنا قدر الإمكان أن تتسم دراستنا بالعلميّة، والموضوعيّة، خصوصًا إزاء تلك الدراسات التي طغى عليها الهوى والتعصّب حينًا، وملامح التبشير تارة أخرى.
وقد دفعنا لكتابة هذا الكتاب دوافع كثيرة على رأسها الحبّ والعشق للقرآن الكريم، وهذا أمر طبيعي تفرضه طبيعة اعتقادنا بقداسة هذا الكتاب وألوهيّته وكونه المنجي للبشريّة من مستنقع الظلم والضلال، بالإضافة لما يتمتّع به من جاذبيّة خاصّة، جذبت قلوب الملايين من غير المسلمين فكيف بنا وقد تربيّنا على تلاوته، وحفظه، وفهمه، منذ نعومة أظفارنا.
بالإضافة إلى ما تعرّض ويتعرّض له هذا الكتاب المقدّس من تشويه متعمّد، وتضليل الناس عن سماعه والاهتداء بهديه، وهو منهج قديم قد حدّثنا عنه القرآن نفسه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾، وما مارسه الاستشراق القديم، ويمارسه الاستشراق المعاصر، ما هو إلا لغو في الكتاب، ولكن بشكل مختلف،
(9)ظاهره علمي، وحقيقته وجوهره لا تختلف عمّا كان في السابق، فأصبح اللغو له طرق علميّة من خلال إصدار عشرات المجلاّت، وآلاف الكتب، وعقد مئات الندوات والمؤتمرات، وإنشاء عشرات المعاهد التعليميّة، والفروع التخصّصيّة الجامعيّة، وغير ذلك من طرق ووسائل، كلّ ذلك من أجل صرف الناس عن القرآن، وتصغيره في أعينهم، وإبعاده عن نمط حياتهم، وصناعة مستقبلهم، وجعله كتاب تاريخ لا كتاب حياة تصنع من خلاله الحضارة الإنسانيّة.
وقد كان القرآن الكريم وما زال محطّ أنظار المستشرقين؛ لأنّه مصدر القوّة في حياة المسلمين، ومنبع الرؤية في حضارتهم، والموجّه لحركتهم، ولمناحي التفكير لديهم. وكما كذّب مشركو قريش بالقرآن في السابق، واعتبروه شعرًا مرّة، وسحرًا أخرى، وكهانة مرّة، وأساطير الأوّلين مرّات، وكما رموا صاحب الرسالة بالافتراء والكذب تارة، وبالجنون تارة أخرى، وبحثوا له عن مصدر في الأرض؛ كانت أغلب جهود الاستشراق لا تخرج عن هذه التوجّهات والتوجيهات.
وباختصار ما زالت ملاحقة المتّهم في زعمهم وهو نبيّ الإسلام قائمة، والمحكمة منعقدة، والقضاة أبرموا حكمهم، وأنزلوا أشدّ العقوبة على المتّهم ورسالته، من دون سماع لصاحب الرسالة وأدلّته، ومعرفة بكتاب الله وعظمته، بل افترضوا رسالة ما، ومرسلًا ما، ووجّهوا لهما سهام النّقد، وعند التدقيق في كلامهم نراهم قد أخطؤوا الإصابة، فلا من أصابوه بمقتل -حسب زعمهم- هو القرآن الكريم، ولا من تحدّثوا عنه، وعن نهجه، وسيرته وفكره، هو الرسول الأمين محمد صلىاللهعليهوآله.
وإن كانت هذه الدراسة لا تنفي وجود بعض الدراسات المنصفة والجادّة في مجال الدراسات القرآنيّة والإسلاميّة بشكل عامّ، والتي يمكن البناء على بعضها، ولكن ساحتنا لا تزال عطشى لمثل هذه الدراسات.
ولتحقيق غاية هذا الكتاب المتمثّلة في بيان عناصر الضعف العلمي والبحثيّ في دراسات المستشرقين للقرىن الكريم، إضافة إلى النقد المنهجيّ، وتصويب العديد من الشبهات التي سعى المستشرقون إلى تكريسها حول القرآن، والوحي، ونبي
(10)الإسلام...، بحسب ما يحملون من أهداف وخلفيات تجاه الدين الإسلامي.
وقد تضمّن هذا الكتاب الفصول الآتية.
الفصل الأوّل: الحركة الاستشراقيّة: مفهومها، مراحلها، أهدافها، وآليّاتها.
الفصل الثاني: الحركة الاستشراقيّة: مدارسها، مجالاتها، وخصائصها، ودوافعها لدراسة القرآن.
الفصل الثالث: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة والقرآنيّة.
الفصل الرابع: القرآن: مصدره، وتاريخه، وترجمته عند المستشرقين.
الفصل الخامس: آراء المستشرقين في المباحث الأساسيّة لعلوم القرآن.
الخاتمة: وتضمّنت استخلاصات الدراسة، ونتائجها، وتوصياتها.
(11)
(13)
إنّ كلمة (استشراق) على وزن استفعال، مصدر للفعل (استشرَق)، وأصله فعل ثلاثي (شَرَقم)زيد بثلاثة أحرف: الألف والسين والتاء، كما في استغفر، طلب الغفران، واستفهم، طلب الفهم، والمعنى طلب الشرق، وليس هناك معنى محصّل لطلب الشرق إلا طلب علوم الشرق وآدابه ولغاته وأديانه وما شاكل ذلك، وتشير لفظة(شرق) حسب المعجم الوسيط من: شَرَقَت الشمسُ تشرُق شُروقًا وشَرُقًا، أي طلعت وأضاءَت على الأرضِ، واسم الموضع المَشْرِق، و(الشَّرْق) جهة شروق الشمس، و(شرَّق) أخذَ في ناحية المشرق.
وفي معجم مقاييس اللغة: شرق: أصل واحد يدلّ على إضاءة وفتح. من ذلك شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت، والشروق: طلوعها، ومن خلال تتبع استعمال هذه الكلمة في المعاجم اللغوية نخرج بهذه النتيجة: إنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الطلوع مع الإضاءة. وعلى هذا لا يصحّ أن يقال: شرق الرجل. ويدلّ على هذا المعنى استعمالها في مقابل الغروب بمعنى البعد والغيبة، والعشاء بمعنى الظلام، كما في: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾، ﴿لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ .
ولذا يرى بعض الباحثين أن كلمة استشراق لا ترتبط فقط بالمشرق الجغرافي وإنما تعني أن الشرق هو مشرق الشمس ولهذا دلالة معنوية؛ بمعنى الشروق والضياء والنور بعكس الغروب؛ بمعنى الأفول والانتهاء.
وإذا رجعنا إلى اللغات الأوروبيّة فثمة تعريف للشرق، ليس المراد منه الشرق الجغرافي، وإنما الشرق المقترن بمعنى الشروق والضياء والنور والهداية، وهو قريب من المدلول اللغوي لهذه الكلمة.
فلفظ ORIENT في الدراسات الأوروبية يشير إلى منطقة الشرق المقصودة بالدراسات الشرقيّة بكلمة تتميز بطابع معنوي وهو: Morgenland وتعني بلاد الصباح، ومعروف أنّ الصباح تشرق فيه الشمس، وتدل هذه الكلمة على تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى التركيز على معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور واليقظة، وفي مقابل ذلك نستخدم في اللغة كلمة Abendland وتعني بلاد المساء لتدل على الظلام والراحة.
وفي اللاتينية تعني كلمة Orient: يتعلَّم أو يبحث عن شيء ما، وبالفرنسية تعني كلمة Orienter وجّه أو هدى أو أرشد، وبالإنجليزية Orientation،
وorientate تعني «توجيه الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو الفكر أو الأدب نحو اهتمامات شخصية في المجال الفكري أو الروحي».
على اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻠﻤﺘﻲ «east» و«orient» ﻣﱰادﻓﺘﺎن ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ على ﻣﻌﻨﻰ «الشرق» إلا أن الكلمة «east» تأتي ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ على الجهة الشرقيّة والجانب الشرقي من كلّ شيء، ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ على اﻟﻨﺼﻒ الشرقي ﻣﻦ الكرة الأرضية، بينما ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ «orient» ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ على اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ في الشرق من اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮسـﻂ وأوروﺑﺎ. وربما ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻔﺮدة «الاستشراق» و«المستشرق» ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وشاع مصطلح «Orientalism» و«Orientalist». وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ الحال ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ ترجمة ﻛﻠﻤﺔ «Orientalism» إﱃ الاستشراق؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻼﺣﻘﺔ «al» ﺗﺪلّ على ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﻴﺎء «اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بالشرق» وليس «الناحية الشرقيّة من الأرض»
إلا إذا اعتبرنا مفهوم «الشرق» يطلق على ما هو أعم من الأراضي الشرقيّة وجميع ما يرتبط بها.
وبذلك يتبيّن أن مصطلح الاستشراق ليس مستمدًا من المدلول اللغوي، بل من المدلول المعنوي لشروق الشمس التي هي مصدر العلم.
وفي الثقافة الإسلاميّة، يطلق على أحد أبرز المدارس الفلسفية اسم المَدرسة الاشراقيَّة المأخوذ من لفظ أشرقَ: وهي المدرسة التي ترى أن المعرفة تتمّ عن طريق ظهور الأنوار العقليّة ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على النُّفوس عند تحرّرها، ويطلق اسم الاشراقيين بالأخصّ على شهاب الدين السّهرورديّ وأتباعه.
وما يؤكّد هذا المعنى أنّنا نلحظ حصول تطوّر في معنى كلمة الاستشراق شملت مصر وبلاد شمال أفريقيا، وشمال غرب أفريقيا المسمى بالمغرب، وإن كان الاستشراق مدلولًا لفظيًّا مختصًا بالبلدان الشرقيّة دون غيرها وهذا يدلّل على أن مدلول كلمة الاستشراق ليست محصورة بالجهة المكانية، بل له علاقة بالجنبة المعنوية للكلمة.
ويمكن القول نتيجةً لما تقدّم أنّ مدلول كلمة الاستشراق وربطه بالشرق يعني في المقام الأول المنطقة التي أشرقت فيها شمس المعرفة، وليست الشمس بمعناها الحسّي.
إنّ المفهوم المقابل للاستشراق هو مفهوم الاستغراب. والأوّل لغة كما تقدّم مأخوذ من الشرق بالمعنى المعنوي لا الحسي فقط، أو طلب الشرق بمعنى طلب علوم الشرق، والثاني مأخوذ من الغرب جهةً أو بمعنى طلب الغرب، والاستغراب اصطلاحًا هو علم يُعنى بدراسة الغرب، على غرار الاستشراق، الذي أطلق على دراسة المجتمعات والثقافات الشرقيّة.
ولم ترد كلمة «الاستشراق» orientalism، المشتقة من مادة «ش ر ق» في أي من المعاجم العربيّة القديمة، وربما كان المعجم العربي الحديث الوحيد الذي يشير إلى واحد من مشتقاتها هو معجم «متن اللغة» للشيخ أحمد رضا، وأغلب المعاجم الحديثة تعرّضت للفظ استشرق بإيراد فعلها «استشرق» وإتباعه بشرحه له؛ وهو «طلبَ علوم الشرق ولغاتهم»، مع وصف الكلمة بأنها «مولدة عصرية» تطلق على من «يعنى بذلك من علماء الفرنجة». وفعل «استشرق» العربي مشتق من كلمة «الاستشراق» المترجمة لكلمة «orientalism» الإنجليزية و«orientalisme» الفرنسية، حديثتَي العهد، واستخدمت كلمة «مستشرق» ترجمة لكلمة «orientalist» لتصف المشتغل بهذا الحقل المعرفي.
وإذا قمنا بعملية رصد لتعريفات الاستشراق الواردة في الكتب والأبحاث والرسائل الجامعية فنجد بعضًا منها عامًا، وبعضها خاصًا، قد ركز على نقطة ما تتناسب مع جهة بحثه، وبعضها يجرّم الاستشراق بكل أشكاله، وبعضها يعتبر الاستشراق علمًا، وبعضها يراه أقرب إلى الحركة من العلم، وهكذا... وفي الآتي نعرض بعضًا من هذه التعاريف:
(20)1- الاستشراق orientalism يعني: «علم الشرق أو علم العالم الشرقي» وكما يقول مكسیم رودنسون الذي أشار إلى أن مصطلح الاستشراق إنما ظهر للحاجة إلى «إیجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق».
هو: «ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلاميّ، والتي شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته».
وأحيانًا يراد به: «ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الشرقيّة بالدراسة والتحليل من قبل علماء الغرب».
وبعض التعاريف حاولت أن تعطي أبعادًا ومحاورًا للاستشراق، معتبرة أنّه عبارة عن مجموع من المحاور، فالاستشراق لا يمكن اختزاله في بعده التاريخي أو الجغرافي فقط، أو في بعده الإنساني أو الثقافي فحسب، وإنما هو مجموع ذلك كله:
1- المكان.
2- الزمان.
3- الإنسان.
4- الثقافة.
فالحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطًا عضويًا وتكامليًا مع هذه العناصر الأربعة الأساسيّة، إذ لا بدّ له من مسافة زمنية ومساحة مكانية ونوع إنساني وإنتاج ثقافي وفكري، ويرى أن الشرق الذي اهتمّ الغرب بدراسته والتخصّص في
ثقافته وتراثه، ليس هو الشرق الجغرافي الطبيعي، وإنما هو «الشرق الهوية» وهو محور ما استهدفه علم الاستشراق ومصدر العناية والاهتمام، فهدف الاستشراق هو معرفة «الشرق الهوية والتاريخ» المتمثّل في الإسلام والمسلمين.
وبعض الباحثين المعاصرين اعتبر أن الاستشراق هو إسقاط من الغرب على الشرق بهدف السيطرة عليه، وسنتعرض لذلك في بحث منهج الإسقاط وهو أحد مناهج المستشرقين.
وما تقدّم من التعريفات التي ذكرت لمفهوم الاستشراق نجد بعض هذه التعريفات عرّفته بلحاظ الرقعة الجغرافيّة سعة وضيقًا، وبعضها بلحاظ البعد المعرفي، فلقد ﻧﻈﺮ المستشرقون إلى الاستشراق ﻣﻦ زواﻳﺎ وخلفيّات ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺒﺤﺚ في ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت الشرق فمنهم من تحدّث عن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت الشرق اﳉﻐﺮاﻓﻴّﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴّﺔ، وآخرون عن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻦ واﻷدب وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻠﺪان الشرقيّة، وفريق آخر تحدّث عن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﻔﻨﻮن واﳊﻀﺎرة الشرقيّة، والقسّم الأكبر من الدراسات الاستشراقيّة تمحور حول الاستشراق الديني وبالتحديد الدين الإسلاميّ، ﻗﺪ رﻛّﺰوا أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ودراساتهم على ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹسـﻼم ودراسـﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮان، واﻟﺴﻨّﺔ، وسـﲑة اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻛﺮم صلىاللهعليهوآله واﳋﻠﻔﺎء واﻷﺋﻤﺔ، ورؤسـﺎء اﳌﺬاﻫﺐ اﻹسـﻼﻣﻴﺔ، وﻣﺸﺎﻫﲑ العلماء ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹسـﻼم، واﳊﺮﻛﺎت اﻹسـﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺘﺠﻤّﻌﺎت اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ، وﻣﻮاﻃﻦ سـﻜﻨﺎﻫﻢ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﱂ، وﻧﻘﺎط ﻗﻮّة وﺿﻌﻒ اﳌﻌﺎرف اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ اﻷﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻔﻘﻪ واﻷﺧﻼق واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن، واﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﺑﺆرة تهديد أو ﺧﻄﺮ ﰲ اﳌﻌﺎرف اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ، وﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻹسـﻼﻣﻲّ واﻷﻣﺔ اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ أن أهم ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﲑ علماء اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺼﻠﺤﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺬاﺑّﲔ عن الثقافة الإسلاميّة هو هذا النوع من الاستشراق الخاص ونقده، بمعنى «دراسة الغربيّين للإسلام».
وما نريده في هذه الدراسة هو معنى أخص -إذا صحّ التعبير- للدراسات
الاستشراقيّة وهو دراسة القرآن الكريم بأبعاده المختلفة.
ويمكن القول في النتيجة: إنّ الاستشراق هو «أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي (أنطولوجي)، ومعرفي (إبستمولوجي) بين الشرق والغرب، ويستخدم دراسات أكاديميّة يقوم بها علماء غربيين للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخ ونظم وثروات وإمكانات، سواء أكانت هذه الشعوب تقطن شرق البحر الأبيض أم الجانب الجنوبي منه، وسواء أكانت لغة هذه الشعوب العربيّة أم غير العربيّة «كالتركية والفارسية والأوردية» وغيرها من اللغات، لأهداف متنوّعة ومقاصد مختلفة».
من هو المستشرق وما هي خصائصه وهويته؟
1- المستشرق: هو «عالم متمكِّن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه». وفي تعریف أكسفورد ورد أن المستشرق هو «من تبحَّر في لغات الشرق وآدابها ».
2- هو «ذلك الباحث الذي يحاول دراسة الشرق وتفهمّه، ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار ما لم يتقن لغات الشرق».
3- «إنّنا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيّين الذين يكتبون عن الفكر الإسلاميّ وعن الحضارة الإسلاميّة».
فالمستشرق مصطلحًا -بناءً على هذه التعاريف- ينبغي أن تقتصر على من ليس شرقيًا، لأنّها تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في البيئة التي نشأ فيها الطالب وهو معنى الاستشراق أي طلب علوم الشرق كما تقدّم.
هذا هو التحديد الغالب لهوية المستشرق وهو من يحمل ﻫﻮﻳﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ أو أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، أي غربي يقوم بدراسة الشرق، وبعض الباحثين ونظرًا لوجود دراسات للإسلام من البلدان التي لا تنتمي جعرافيًا للغرب وإن كانت دراساتهم تحقق نَفَس الاستشراق الغربي نفسُه؛ كالصين، والهند، واليابان، فيطلق بعض الباحثين كلمة مستشرق على ﻛﻞ دارس ﻟﻺسـﻼم ﻣﻦ غير المسلمين سواء أﻛﺎن ﻏﺮﺑﻴًّﺎ أم شرقيًّا.
ولذا عرّف بعضهم الاستشراق أنّه: «اﺷﺘﻐﺎل ﻏﲑ اﳌﺴﻠمين ﺑﻌﻠﻮم اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ اﳌﺸﺘﻐﻞ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وانتماءاﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻟﻮ لم ﻳﻜﻮﻧﻮا غربيين».
ﻻ ﺷﻚّ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪراسـﺎت الاستشراقيّة؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ بالشرق اﻹسـﻼﻣﻲ وﺣﻀﺎرﺗﻪ ﻗﺪﻳﻢ، ﻏﲑ أن آراء العلماء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺸﺄن تحديد اﻟﺒﺪاﻳﺎت التاريخية ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪراسـﺎت، وﺗﺘﺠﻪ أﻛﺜﺮ اﻵراء إﱃ تحديد ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ وﻟﻴﺲ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ سـﻨﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺒﺪاﻳﺔ الاستشراق. وﻻ ﻳُﻌﺮَف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣَﻦ ﻫﻮ أول ﻏَﺮْﰊّ ﻋُﻨِﻲ ﺑﺎﻟﺪراسـﺎت الشرقيّة، وﻻ ﰲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻫﺒﺎن قصدوا اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﰲ إﺑﺎن ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ وﳎﺪﻫﺎ، وﺗﺜﻘﻔﻮا ﰲ ﻣﺪارسـﻬﺎ، وﺗﺮﲨﻮا القرآن واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ لغاتهم، وﺗﺘﻠﻤﺬوا على علماء المسلمين ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻄﺐ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.
وقبل الدخول في عرض المراحل التاريخية للاستشراق لا بد أن نلفت النظر إلى الأمور الآتية:
أولًا: هناك فرق بين التأريخ لحركة الاستشراق، وبين ظهور مصطلح الاستشراق نفسه الذي تأخر ظهوره عن الحركة الاستشراقيّة بقرون عديدة.
ثانيًا: أن أحد أسباب تعدد آراء الباحثين في تحديد بداية الاستشراق، جاء نتيجةً لاختلافهم في تعريف الاستشراق نفسه. فمن نظر إلى أن الاستشراق يطلق على أي دراسة من غير المسلمين للإسلام؛
1. قال إنه بدأ من بعثة النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله واهتمام المشركين من داخل الجزيرة أو خارجها.
2. أو إنّه بدأ بعد الهجرة واحتكاك النبيّ بيهود المدينة ونصارى نجران والجزيرة وبداية مراسلة النبيّ للملوك والقياصرة.
3. وبعضهم أرجع الاستشراق إلى القرن الثامن الميلادي وحدّده من بداية
الرهبان والملوك إرسال أبناءهم إلى الأندلس لدراسة اللغة العربيّة والإسلام.
وأمّا من نظر إلى الاستشراق أنّه دراسات أكاديميّة، طبعًا هذا لا يعني أنّ هذه الدراسات لا توجد فيها أهداف أخرى كتشويه الصورة الإسلاميّة وتضعيف المصادر الإسلاميّة؛ كالقرآن والحديث وغير ذلك، ولكن المقصود بها أول دراسات وأبحاث صدرت من المستشرقين؛
4. فقد حدّد بداياته في القرن الثاني عشر الميلادي (1343م) وذلك بظهور أول ترجمه لمعاني للقران الكريم إلى اللاتينية؛ أصل اللغات الأوروبية.
5. أو أرجعه إلى عام 1312م في القرن الرابع عشر الميلادي بعد قرار مجمع فيّنا الكنسي القاضي بتأسيس كراسـي الجامعات الأورُوبية لدراسة الإسلام واللغة العربيّة.
6. وأرجعه آخرون إلى أنّه بدأ في القرن السادس عشر الميلادي عام 1539م حيث أنشئت أول كراسي للغة العربيّة في الجامعات.
إذا دقّقنا في هذه الأقوال نجد أن المسار التاريخي للاستشراق يستوعب تلك الآراء جميعًا وذلك بتقسيم هذه الأقوال إلى: بدايات رسمية، وبدايات غير رسمية، فيكون الأول والثاني والثالث يمثلان البداية غير الرسمية ضمن الجهود الفردية. ويكون الرابع والخامس والسادس ممثلًا للبداية الرسمية. وفي ما يأتي نذكر أهم الآراء والمراحل التاريخية للاستشراق مع مراعاة التسلسل الزمني لبيان نشوء الاستشراق في هذا المجال.
هناك عدّة مراحل للحركة الاستشراقيّة قد أوصلها بعضهم إلى ما يقارب عشرة مراحل، طبعًا بغضّ النظر عن كون هذه المرحلة أو تلك ينطبق عليها مصطلح الاستشراق المقصود بهذه الدراسة أو لا، فمما لا شك فيه أن الاطلاع على هذه المراحل، ومعرفة الجهود التي قام بها هؤلاء في كل مرحلة مسألة مهمة جدًّا لا
من باب التاريخ فحسب، بل لأنّ هذه المراحل أشبه بحلقات متكاملة ومن خلال دراستها بشكل كامل تتّضح عندنا الصورة الكاملة للحركة الاستشراقيّة.
ومن الواضح أنّ كل هذه المراحل التي تحدّد نشوء ما يمكن أن يسمّى حركة استشراق تجمعها فكرة واحدة وهي «التعرّف إلى الشرق»؛ فأي تعرّف على هذا الشرق نطلق عليه اسم استشراق سواء كان التعرّف عليه تجاريًا أو عسكريًا أو ثقافيًا أو دينيًا، أو غير ذلك، وسواء كان ذلك قبل ظهور الإسلام أو بعده.
ومن الواضح أيضًا أن بعض هذه المراحل حتى ولو أطلق عليها بعض الباحثين مصطلح الاستشراق فليست مقصودة في هذه الدراسة. ولتتضّح هذه المسألة نذكر هذه المراحل على الشكل الآتي:
ذﻛﺮ بعض الباحثين أن الاستشراق ﺑﺪأ في اﻟﻐﺮب ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻜﻨﻌﺎنيين ﺣﻴﺚ أﻗﺎم اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻋﻼﻗﺎت تجارية في ما ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺛﻢ أﺧﺬوا ﻳﺘﻮسـّﻌﻮن ﰲ هذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أيضًا.
فالارتباط التاريخي بين الشرق والغرب يعود إلى ظهور التبادل التجاري أياّم الكنعانيين والصراع الذي احتدم إثر ذلك في القرن السادس قبل الميلاد بين إيران واليونان، فبدأ الإغريقيون منذ ذلك الحين بـ «التعرّف إلى الشرق» من أجل تحسين أدائهم في عملية الدفاع والهجوم.
وكان أوّل مستشرق في تلك المرحلة هو المؤرّخ اليوناني الشهير هيرودوتس الذي
قام بتسجيل مشاهداته وملاحظاته حول الري وبلاد ما بين النهرين والرافدين «العراق»، ومصر والشام وشبه الجزيرة العربية، وكذلك معرفة السكان القاطنين فيها وعاداتهم، وتجاراتهم والبضائع التي يتاجرون بها في تاريخه المعروف.
أما الارتباط الثاني فيعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد حيث هاجم الاسكندر المقدوني الملك الإغريقي الشاب الأراضي الإيرانية وكافة الأقطار الشرقيّة، واحتل كافة المناطق الآسيوية.
وهذه النظرية كما هو واضح ترى أن الاستشراق كان قبل نشوء الإسلام وظهوره، بل بدء هذه الحركة كان قبل الديانة المسيحيّة أيضًا. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المرحلة مع أهميتها التاريخية ليست مستهدفة في هذه الدراسة.
كما ذﻫﺐ آﺧﺮون إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄنّ ﳎﺮد ﻇﻬﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻹسـﻼﻣﻲ ودﻋﻮة خاتم اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺨﺖ ﻣﺎ سـﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن، أﺛﺎر اﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻐﺮب وﺣﻔّﺰﻫﻢ إﱃ اﻟﺘﻌﺮّف على اﻹسـﻼم ونقده واﳋﻠﻔﻴّﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ .
فقد شكّلت الكتب التي بعث بها النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله إلى ملوك البلدان الغربيّة والشرقيّة وزعمائها حافزًا آخر للتعرّف على الإسلام، فكان هناك من رحّب بهذه الكتب وتعامل معها بإيجابيّة وحصل على بعض المعارف الإسلاميّة التي رآها صحيحة، وكان هناك من عمد إلى دراسة الإسلام بدوافع عدائيّة، فاحتدمت إثر ذلك بعض المعارك والصراعات.
وقد شهد أيضًا القرن الثامن للميلاد «القرن الهجري الثاني» ظهور عالم نصراني اسمه يوحنا الدمشقي، حيث عاش في كنف الأمويّين وخدم في بلاطهم، فكان أوّل
مسيحيّ يعمد رسميًا إلى دراسة الإسلام ونقده، وألّف كتبًا في الرد عليه، ومنها: «محاورة مع مسلم»، و«إرشادات النصارى في جدل المسلمين». واعتبر يوحنا أن الإسلام منشقّ عن الديانة الصحيحة فما هو إلا هرطقة مسيحيّة.
أما المستشرق التبشيريّ الثاني وهو ثيوفانس البيزنطي «المتوفى عام 202 هـ ـ 817 م». فقد ذكر في كتابه «حياة محمد»: أنّ نبيّ الإسلام لم يكن نبيًا، بل أخذ تعاليم الإسلام من علماء النصارى واليهود في الشام، وكان أتباعه يرون فيه المسيح الموعود، وبعبارة أخرى أن النبيّ لم يكن نبيًا مرسلًا بل كان مبتدعًا.
وذهب بعض الباحثين إﱃ اﻟﻘﻮل: إنّ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﰲ اﳌﺪة اﳌﻤﺘﺪّة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ إﱃ العاشر ﻟﻠﻤﻴﻼد أﺛﺎرت ﻓﺰع اﻟﻐﺮب واﻟﻨﺼﺎرى؛ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء على دراسـﺔ الشرق واﻹسـﻼم، ﻟﻠﻌﺜﻮر على أسلوب يخرﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ بعضهم إﱃ اﻟﻘﻮل إنّ ﻋﻤﺮ الاستشراق ﻳﻤﺘﺪ ﻷﻟﻒ سـﻨﺔ .
إنّ دعوة الإسلام في القرون الخمسة الأولى لقيت ترحيبًا من مختلف شعوب الشرق والغرب وشبه الجزيرة العربية. وإنّ تغلغل الإسلام داخل العمق الأوروبي والأندلس والثغور الفرنسيّة قد أثار فزع الكنيسة والمنظومة البابويّة التي كانت حتى ذلك الحين هي الحاكم المطلق في أوروبا. وعلى هذا الأساس فقد عمد القساوسة والبابوات من أمثال الراهب الفرنسي جربرت في القرن العاشر، وبطرس المبجّل في القرن الحادي عشر للميلاد، وغيرهما، إلى مباشرة العمل وخوض المعترك بأنفسهم. فخاضوا في حقل معرفة الإسلام والشرق، وتعلم اللغة العربية، وترجمة القرآن الكريم، وتدوين الإشكالات والنقد عليه.
وكان بطرس المبجّل أول قسّ قام بترجمة القرآن الكريم، وكان الغرض الذي هدف إلى تحقيقه من وراء ترجمته اللاتينيّة هو هداية المسلمين -طبعًا حسب اعتقاده- إلى محاسن الديانة المسيحيّة. وسيأتي الكلام عن ترجمة بطرس للقرآن وتقويمها في الأبحاث القادمة.
لكنّ إخفاق المؤسسة البابويّة في هذا الاتجاه بسبب ضعفها العلمي الشديد أدّى بالكنسيين إلى اختيار سبيل العنف والمواجهة العسكرية. وقد عرفت هذه المواجهات التي امتدت قرابة القرنين من الزمن بـ«الحروب الصليبية»، وكان يراد من تلك المواجهات صدّ زحف الثقافة الإسلاميّة إلى عمق الغرب من خلال إسقاط قلاع الحضارة الإسلاميّة في الأندلس.
وﻗﺪ ذﻫﺐ أﻣﺜﺎل: «رودي ﺑﺎرﻳﺖ» و«ﺟﻮسـﺘﺎف دوﺟﺎ»، إﱃ اﻟﻘﻮل: إنّ اﻟﻐﺮب ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن الثاني عشر ﻟﻠﻤﻴﻼد ازدﻫﺎر اﳊﻀﺎرة اﻹسـﻼﻣﻴﺔ في اﻷﻧﺪﻟﺲ، واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻷﻣّﺔ اﻹسـﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻌﻤﺪ إﱃ ترجمة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹسـﻼﻣﻴﺔ والشرقيّة، ﻛﻲ ﺗﺘﻢ اﻻسـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هذه اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳍﺎئلة، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﻮن «ﺟﻮسـﺘﺎف دوﺟﺎ» ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻃﺒﻌﻪ ﻋﺎم ١٩٦٠م: «ﺗﺎرﻳﺦ المسشرقين ﰲ أوروﺑﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن الثاني عشر إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎسـﻊ عشر» .
وذﻫﺐ بعض الباحثين إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄنّ ﺑﺪاﻳﺔ الاستشراق اﻟﻔﺮدي إنما كانت ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي عشر ﻟﻠﻤﻴﻼد، إذ ﺑﺪأ ﺑﺠﻬﻮد (بيتروس فينيرا بيليس) الملقب بـ (ﺑﻄﺮس اﳌﺒﺠﻞ) «1156 ـ 1092 » ﻓﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻓﺮاد ﻗﻼﺋﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺮن ﻳﺰاوﻟﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط، وﻗﺪ ذﻛﺮ أسماء ﻫﺆﻻء ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
أما ﺑﺪاﻳﺔ الاستشراق الجماعي ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس عشر ﻟﻠﻤﻴﻼد، حيث أﺧﺬت ﲨﻮع المحققين والعلماء الغربيين ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ الاستشراق
والإﻗﺒﺎل على اﻟﺪراسـﺎت اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ. وﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﱃ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺘﺎﺑﻪ «ﻃﺒﻘﺎت المستشرقين» ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ بالمستشرقين ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس عشر للميلاد. واﺷﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ على اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﲑة ﻣﺎ ﻳﻨﻴﻒ على مئتي مستشرق.
عقد الغربيّون -وخاصة البابوات والمؤسسات الكنسيّة والدول الغربيّة ومستشرقوها- منذ ذلك الحين العزم على استيعاب العلوم والحضارة الإسلاميّة والتقدّم العلميّ، تمهيدًا إلى إعداد المقدّمات العلميّة لنهضة ثقافيّة وحضارة جديدة:
كان ريموندوس لولوس (Raymon Lull) مؤسّسًا لأول مركز لتعليم المستشرقين اللغة العربيّة والعلوم الإسلاميّة.
وإثر مشاهدته إخفاق نشاط التبشير المسيحيّ في الحروب توصل إلى نتيجة مفادها ضرورة تعزيز النشاط الثقافي للتبشير المسيحيّ ضد الكفر والإلحاد «الإسلام». وقد ذهب إلى ضرورة تأسيس «مركز لتعليم اللغة العربيّة وتعزيز ثقافة المبشرين ضد الإسلام» للاضطلاع بهذه المهمة.
وبعد أن ارتقى القسّ ريميدوس لولوس إلى مقام الأسقفيّة، ثم البابويّة. باشر تطبيق آماله وطموحاته من موضع سلطته الفعلية، فعمد إلى إرسال البعثات التبشيرية إلى مختلف أنحاء العالم بغية الترويج للكاثوليكيّة وتعلم اللغات المختلفة. كما أمر الذين يتحولون إلى المسيحيّة من الأديان الأخرى تعليم لغاتهم الأم للمبشّرين.
لقد عمد البابا لولوس في نهاية عمره إلى إقرار قانون في مؤتمر فيينا يقضي على الجامعات الغربيّة الخمس، وهي: «باريس، وأكسفورد، وبولوينا، وسلمنكا، وجامعة الإدارة المركزية للبابا» بأن يضطلع الأساتذة فيها بمهمّة تعليم الطلاب اللغات الشرقيّة؛ من قبيل: العربيّة، والعبريّة، واليونانية، والكلدانية، وما إلى ذلك.
بعد أن تمكّنت جيوش الغرب من احتلال بلاد الأندلس الإسلاميّة في حروبها الصليبيّة، واستولت على مركز حضارة العلوم الإسلاميّة وثقافتها، دخلت مكتبة الأندلس العظمى التي قال بعض المؤرّخين إنها كانت تحتوي على أربعة آلاف كتاب.
وقد أرسل الزعماء الصليبيّون العلماء والمحقّقين الغربيّين إلى هذه المكتبة ليصادروا ما يرونه مفيدًا لبناء الحضارة الغربيّة الجديدة والنهضة العلميّة الحديثة في الغرب، وأما الذي لم يفهموه منها فقد عمدوا إلى إحراقه.
وهناك من قال: إنّ اﻟﻐﺮب أﺧﺬ ﻳﻔﻜّﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ عشر ﻟﻠﻤﻴﻼد، وبعد اﳊﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴّﺔ، بضرورة التخلّيﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﳊﺮب واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﻌﺮّف على ﺛﻘﺎﻓﺔ الشرق ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺜﻮر على أسـﺎﻟﻴﺐ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴّﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ الشرق انطﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪراسـﺎت الشرقيّة وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.
وذهب المستشرق «آربري» «Arberry»إلى أنّ المدلول الأصلي لكلمة -مستشرق- أو ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻢ الاستشراق ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﰲ أوروﺑﺎ منذ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس عشر ﻟﻠﻤﻴﻼد؛ لأنّ
أوّل استعمال لكلمة «مستشرق» في اللغات الأوروبيّة يعود إلى عام 1638م عندما أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقيّة أو اليونانية...
في سنة 1691م وصف انتوني وود «Wood Anthon» صمويل كلارك «Samuel Clarke» بأنّه (استشراقي نابه) يعني ذلك أنّه يعرف بعض اللغات الشرقيّة.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﻮل: إنّ ﻋﻠﻢ الاستشراق إنّما ﻇﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ رسـﻤﻲّ ﰲ القرن الثامن عشر ﻟﻠﻤﻴﻼد؛ وذﻟﻚ ﻷنّ ﻣﺼﻄﻠﺢ «Orientalism» ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ إﻻّ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ الثاني ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ عشر.
ويعتبر مكسيم رودنسون أنّ مصطلح المستشرق ظهر أوّلًا في إنجلترا 1779 م أو1780م، ثمّ في فرنسا عام 1799م. في حين لم تدخل كلمة «الاستشراق» معجم الأكاديمية الفرنسية Dictionnaire de l’Académie Française إلا عام 1838م، وإن كان هذا المصطلح قد انتقل إلى اللغة الفرنسيّة عام 1799م. لقد استعمل مصطلح «Orientalist» المستشرق للمرة الأولى في مستهلّ عام 1766م، حيث ورد في موسوعة لاتينية للتعريف بالأب بولينوس.
هناك مصطلح يتداول بين الباحثين في مجال الدراسات الاستشراقيّة؛ وهو وصف الاستشراق بالقديم أو الجديد. فما الفرق بين هذين المصطلحين؟ وما هو الحدّ الزمني الفاصل بينهما؟
انتهى مصطلح الاستشراق، رسميًا، في مؤتمر باريس للاستشراق عام 1973م بمناسبة مرور قرن على بداية عقد المستشرقين لمؤتمراتهم العالميّة التي كانت تعقد كل (3- 5) سنوات. وحين صوّت المشاركون في المؤتمر على مدى الرغبة في استمرار استخدام مصطلح (استشراق ومستشرق) كانت نتيجة التصويت لصالح إلغاء التسمية مع استمرار المؤتمر بنفس وتيرته ولكن بعنوان (المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية عن آسيا وشمال أفريقيا) ثم استبدل بعد مؤتمرين إلى (المؤتمر العالمي للدراسات الآسيوية والشمال أفريقية).
وبعد تنظيم تسعة وعشرين مؤتمرًا خلال قرن من الزمن، ستكون باريس التي احتضنت ميلاد هذه المؤتمرات قبرًا لمؤتمرات هذا الاتحاد الدولي، فخلال مؤتمر المستشرقين الذي افتتح في هذه العاصمة بتاريخ (١٤ يوليو ١٩٧٣م) الموافق (١٣٩٣هـ) دعا عدد من كبار المشاركين من أمثال برنارد لويس «Lewis Bernard» وبشم «Basham» «وكلودكاهن» «Cahen Claud» إلى حل مؤتمر المستشرقين على أن يُستبدل بمؤتمرات خاصة، ُأطلق على المتعلّق منها بالدراسات الإسلاميّة «مؤتمر العلوم الإنسانية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا».
ومع مستهل القرن الخامس عشر الهجري لم يعد للمستشرقين مؤتمر واحد يجمعهم، بل حتى الإطار الوليد الذي ابتدعوه «مؤتمر العلوم الإنسانية» اختلف
أنصاره في تسميته قبل أن يتوافقوا -لأجل رفع الالتباس والغموض- على اسم «المؤتمر الدولي للدراسات الآسيوية والشمال إفريقيّة»، لكنّ هذا المؤتمر الذي لا زال يُعقد حتى الآن لم تعد له أبدًا تلك الأهميّة السابقة.
أما المستشرقون الساخطون على إلغاء مؤتمرهم الدولي، فأكثرهم من ألمانيا، وقد اتّجهوا إلى تنظيم مؤتمرات خاصة بهم وانضمّ إليهم خلال العقود الثلاثة الأخيرة عدد من نظرائهم ولا سيّما من فرنسا، وظلوا حتى الآن محافظين على الاهتمامات القديمة نفسها التي تتمحور حول أغراض أربعة؛ هي:
1- جمع المخطوطات العربيّة والنصوص القديمة ونشرها وفهرستها
2- التدريس الجامعي
3- إنشاء المعاهد والمراكز العلميّة
4- تنظيم ملتقيات أكاديميّة
ويمكن القول: لقد بدأ الاستشراق الجديد من نهاية الاستشراق القديم عام 1973م، ومن مكانه الجديد في أميركا، وكان لا بدّ من أن يجد له جذورًا جديدة بالإضافة إلى جذره الاستشراقي القديم فوجدها في أربعة مشارب مغطاة وهي: (دراسات المناطق، مستودعات الأفكار، ما بعد الاستشراق، استشراق ما بعد الحداثة)، ولم يكن الغرض من نشوء هذه البداية واضحًا.
ومع بداية التسعينيات من القرن العشرين وتفكّك العالم الاشتراكي وسقوط الاتحاد السوفيتي وتصدّع العالم الثالث، ظهرت الحاجة، أميركيًا، للاستشراق الجديد ليشكل ظهيرًا ثقافيًا وأيديولوجيًا لإعادة ترتيب العالم من منطلق أميركي جديد تحديدًا؛ ولذلك ظهر أوّل المستشرقين الجدد من أميركا وهم: المستشرق
البريطاني-الأمريكي برنارد لويس، وفوكوياما والباحث الأميركي في العلوم السياسية صمويل هنتنغتون (صاحب نظرية صدام الحضارات).
وإذا راجعنا صورة الإسلام في الدراسات الحديثة وهي ما يُطلق عليه الاستشراق الجديد فإنّ صورة الإسلام في كتاباتهم هي جزء من مسعى استراتيجي لبناء عدو جديد للغرب. وهي -بحسب بعض الباحثين- صورة نمطية نتجت من الرؤى الاستشراقيّة القديمة نفسها عن الشرق المتخلّف، غير العقلاني، العنيف، المستبدّ الذي يَعُمّه الطغيان، الأدنى منزلةً من الغرب العقلاني، المتحضر، الديمقراطي، المتمسك بحقوق الإنسان.
يمكن القول: إنّ «الاستشراق الجديد» يتقاطع مع «الاستشراق القديم» بتركيزه على بناء تصورات أيديولوجيّة حول الإسلام والمسلمين، من دون أن يسعى إلى تقديم معرفة نظريّة وتطبيقية حقيقيّة؛ ذلك أن جوهر ما يفعله هذا الفرع الجديد من الاستشراق المتحوّل في ثنايا دراسات الاهتمامات الإستراتيجيّة لـ«الامبريالية الأميركيّة العولميّة المتوحّشة»، هو إعادة تمثيل الإسلام والمسلمين بصورة تخدم الغايات الإمبراطوريّة للقوة الأميركيّة التي تسعى إلى الإبقاء على سيطرتها بوصفها قطبًا عالميًا وحيدًا وأوحد. وهذا ما يمكن أن يفسّر دور كل من برنارد لويس وصمويل هنتنغتون في صناعة السياسة الأميركيّة خلال ربع القرن الأخير.
والأبحاث التي سنتعرض لها في هذا الكتاب تشمل أهم الدراسات الاستشراقيّة القديمة من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن العشرين تقريبًا، بمعنى أن العقود الخمسة الأخيرة مستثناة من الدراسة وذلك لاختلافها في المجالات البحثيّة وطرائق البحث كما أشرنا إليه وتحتاج إلى دراسة خاصة ومستقلّة وإن كان يمكن تسمية هذه العقود الأخيرة بمرحلة ما بعد الاستشراق. وعلى سبيل المثال ستستثني
الدراسة أشهر المستشرقين المعاصرين المهتمين بالدراسات القرآنيّة خلال الربع الأول من القرن الخامس عشر وهم:
أنجليكا نويورث «Neuwrith Angélika»
كلود جليوت «Gilliot Claude»
أندريه ريبان «Andrew Rippin»
سيرجيو نوصيدا «Noseda Sergio»
التزامًا بمجال البحث وحدوده؛ وهي الدراسات الاستشراقيّة القديّمة.
(41)
إنّ علاقة الاستشراق بالتنصير والاستعمار هي من الأمور الواضحة لكل من راجع نشأة الحركة الاستشراقيّة وأهدافها وآليّات عملها وغير ذلك، طبعًا لا نريد القول: إنّ كلّ منصّر -أي من قام بدعوة الآخر إلى المسيحيّة- هو مستشرق، وإنّ كلّ مستشرق هو منصّر، لأنّه بكل بساطة قد يكون المستشرق يهوديًا كما هو الحال في الاستشراق الإسرائيليّ أو لا يتديّن بديانة معيّنة أو لا يتديّن بديانة أصلًا؛ كبعض الملحدين، ولكن ما نريد قوله: إن هناك علاقة وطيدة ومتينة بين الاستشراق والتنصير من جهة، وبين الاستشراق والاستعمار من جهة أخرى، فهناك علاقة بين هذه الحركات الثلاث: الاستشراق، والتنصير، والاستعمار.
قد تقدّم تعريف الاستشراق، أما التنصير فيشير إلى عمليّة تحويل الأفراد أو تحويل شعوب بأكملها في وقت واحد إلى الديانة المسيحيّة. وقد يشير المصطلح أيضًا إلى الفرض القسّري والتحويل الثقافيّ والحضاريّ لغير المسيحيّين بحيث يتبنّون الثقافة المسيحيّة؛ بدلًا من ثقافتهم الأصليّة.
والتنصير حسب ما ورد في الموسوعة العربيّة العالمية: «مصطلح يقصد به قيام مجموعة من النصارى بنشر النصرانية بين الناس في جميع أنحاء العالم بطريقة تنظيميّة حتى يعتنقها الكثيرون ويرغبون عن دينهم الأصلي». وطبعًا لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هناك تنصير فرديّ أو عفويّ وهو خطير على معتقدات الناس، وإن كان الأخطر على أفكار وعقائد الناس هو التنصير المؤسسيّ وهو المرتبط بشكل واضح بحركة الاستشراق أو الموّلد لها.
ومصطلح التنصير يطلقه الباحثون المسلمون على الحركة التي يقوم بها النصارى تجاه الآخرين وبالأخصّ المسلمين، بينما هم أنفسهم يُسمّونه «التَّبشِير»، والتَّبشِير مأخوذ من البشارة؛ أي: «الإنجيل».
وما تقدّم يتبيّن أنّ الاستشراق لم يقم على أهداف نبيلة ونوايا حسنة منذ نشأته، إذ كانت دراسة المستشرقيـن للإسلام في معظمها، تهدف لأخذ المعلومات عنه لاستخدامها في القضاء عليه مـن جهة، ومـن جهة أخرى لحماية النصارى وحجب حقائق الإسلام عنهم، في الوقت الذي يقومـون فيـه باستغلال كل وسيلة للتنصير بين المسلمين، ومع ذلك فقد انتشرت المفاهيم الصحيحة عن الإسلام في المجتمعات الأوروبية، فلجأ المنصّرون إلى تكثيف الهجمة الاستشراقيّة، حيث تركزت على تشويه أحكام الإسلام، والافتراء عليه للحدّ مـن انتشاره في أوروبا، وإضعاف قيمته، وتصويره للرأي الأوروبيّ والأميركيّ بصورة مشوّهة بعيدة عن المستوى الحضاريّ، كما ركزت تلك الدراسات على ضرورة إحلال مفاهيم الصداقة بيـن الدول الغالبـة، والمغلوبـة، تحت اسم الحضارة، والإخاء الإنساني، ونحو ذلك من مسمّيات، لتفكيك عرى الوحدة الإسلاميّة .
وكتب القسّيس السابق والذي هداه الله للإسلام (إبراهيم خليل أحمد) في كتابه (المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلاميّم)بيّنًا العلاقة بين التنصير والاستشراق على الشكل الآتي:
1- إنّ التبشير والاستشراق دعامتان من دعائم قيام الاستعمار في البلاد التي يغزونها ويمهّدونها لاستقبال المستعمرين.
2- الاستشراق والتبشير والاستعمار كلّهم يسيرون حسب خطّة مرسومة، الاستشراق مهمته اجتذاب الناس عن طريق العلم والتعليم، والتبشير مهمته
اجتذاب الناس عن طريق الدعوة المباشرة، وتحبيب النصرانية إلى القلوب بكل وسيلة يستطيعونها.
3- استطاع المبشّرون الأمريكيّون بحكم امتيازاتهم أن يتغلغلوا إلى كل مكان يريدونه في آسيا وأفريقيا.
4- استخدم المبشّرون عملاءهم في كل دولة؛ للقيام بمهمّتهم دون أن يثيروا أي مشكلة بحكم الانتماء الوطني لأولئك العملاء.
5- استعان التبشير بالقوى العسكريّة الاستعماريّة لحمايته؛ كي يعملوا بهدوء واستقرار.
وفي ما يلي نحاول أن نبيّن العلاقة بين هاتين الظاهرتين (التنصير والاستشراق) أما العلاقة بين الاستشراق والاستعمار سنشرحها عندما نتكلّم عن الدافع الاستعماري للاستشراق:
طَلائِع المُستَشرِقين الأولى من النَّصارَى خرجَتْ من الكنائس والأديِرَة، بمناصب دينية، والبداية (الرسمية) للاستشراق من «مجمع فيينا الكنسي» سنة 712هـ - 1312م، الذي أَوصَى بإنشاء عِدَّة كراسيِّ لِلُّغات، ومنها اللغة العربيّة.
وقـد قامت الكنيسة بدعم الاستشراق في أوّل نشأته، حيث كان رجال الكنيسة يشكّلون غالبيّة الطبقة المتعلّمة في أوروبا، التي تهتمّ بالجامعات، ومراكز العلم، ويؤكّد ذلك أن عشرين من أصل تسعة وعشرين من أوائل المستشرقين، كانوا من رجال الكنيسة. كما قام البابا ومن معه من رجال الدين النصراني بمساعدة المستشرقين، فعمل علـى إنشاء مطابـع عربيـّة، وتوفيـر مجموعـة لا بأس بها من الكتب الإسلاميّة العربيّة المتنوّعة.
إنّ جميع الباحثين يتّفقون أن بداية الاستشراق كانت من الكنيسة. فروّاد حركة الاستشراق كانوا رهبانًا وقساوسة ولم تكن أعمالهم العلميّة أبدًا بمعزل عن دورهم الكنسي، ومن هؤلاء مثلًا:
1- سلفستر الثاني الذي توفي سنة 1003م.
2- وبطرس، المحترم الذي توفي سنة 1156 م.
3- وبسكوال المتوفي 1300م.
4- ويوحنا الأشقوبي المتوفي 1456 م.
5- وأدوارد بوكوك المتوفى 1691م. وغيرهم.
ويفرد نجيب العقيقي فصلًا كاملًا عن المستشرقين الرهبان؛ وهم على النحو الآتي:
-الرهبان البندكتيون. -الرهبان الكرمليون. -الرهبان اليسوعيون. -الرهبان الفرنسيسكان.
-الرهبان الدمنيكيون. -الرهبان الكيوشيون. -الرهبان البيض.
وقد أوصل عدد المستشرقين الرهبان إلى مائة واثنين وثلاثين (132م)ستشرقًا راهبًا. أما الفصل الخامس عشر من الجزء الأول من الكتاب فقد خصّصه العقيقي للمستشرقين اللبنانيين، وركّز فيه على المذهب الماروني، وأوصل عدد مستشرقيها إلى ثمانية وثلاثين مستشرقًا مارونيًّا وعدّ نفسه آخرهم.
والناظر إلى أهداف التنصير والاستشراق، يجدها واحدة مع اختلاف الأساليب:
أ. المبشّرون والمنصّرون، يخاطبون عوامّ الناس، ويجذبوهم إلى العقائد المسيحيّة من خلال تقديم المساعدات الإنسانيّـة للفقـراء، والخدمات العلاجيّة للمرضى، كما أن
للحركات التبشيريّة مؤسّسات تعليميّة بدءًا بدور الحضانة، ورياض الأطفال، مرورًا بالمراحل الابتدائية، والثانويّة، ووصولًا إلى الجامعة. أما المستشرقون فيخاطبون طبقة خاصّة من المجتمع وهي الطبقة المثقّفة، وذلك من خلال استخدام الكتاب والمقال في المجالات العلميّة، والبحثيّة، والأكاديميّة الجامعيّة، وغير ذلك.
ب. المبشرّون أو المنصّرون يمارسون الدعوى للأفكارهم بشكل مباشر وبين الناس أي من خلال الاحتكاك المباشر مع الشريحة المستهدفة. أمـا المستشرقون فعلاقتهم بالمكتبات والكتب فهم يبحـثون وينقّبون في بطونها عن تراث المسلمين لدراسة مفاهيمهم وقيمهم، ويكتبون ما يتوصّلون إليه من نتائج بحثيّة في كتب وبحوث ومقالات ومحاضرات، ويُنشر إنتاجهم من دون أن يكون لهم علاقة واحتكاك مباشر بمن كتبوا لهم.
ج. المنصّر يخفي دعوته إلى التنصير ويعمل بطريقة خفيّة وذكيّة، هو لا يخفي هويّته الدينيّة ولكنّه يخفي دعوته لكي لا يؤدّي ذلك إلى تنفير الناس من جهة، وانكشاف دعوته الحقيقيّة من جهة أخرى. بخلاف المستشرق فهـو ينشر كتبه ودراساته ويبثّ أفكاره من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات، ويتظاهر باتبـاع المنهـج العلميّ الموضوعيّ المتجرّد، للوصول إلى أهدافه الحقيقيّة.
فالعلاقة بين التنصير والاستشراق قويّة، والارتباط بينهما وثيق، وما يؤكّد ذلك:
• الأعمال التـي يقوم بها المنصّرون في المناطق المستهدفة، مبنية على دراسات استشراقيّة خاصة بتلك المنطقـة، تظهـر ما خفي من أسرارها، وهكذا فإنّ قوّة التنصير مستمدّة من أعمال المستشرقين ودراساتهم.
• يزوّد كلّ منصّر بما يحتاج إليه من مؤلّفات المستشرقين، عندما يعمل في الدول الإسلاميّة، كمـا يشترط عليـه إتمـام دراسة ما كتبـه أشدّ المستشرقين حقدًا على الإسلام والمسلمين.
• الكثير مـن البارزين في عالم الاستشراق، بدؤوا حياتهم العلميّة بدراسة علم اللاهوت النصراني، قبل التوجّه للدراسات الاستشراقيّة، والتفرّغ لها.
• المؤسّسات الثقافيّة الاستشراقيّةكانت في معظمها مؤسّسات كنسيّة ومن ذلك مثلًا:
أ. معهد تعليم اللغات الشرقيّة في فرنسا أنشأه البابا هونوريوس الرابع سنة 1285 م.
ب. السوربون بدأت بهبة من الأب روبردي سوربون كاهن القديس لويى، ثم جدّد الكردينال رشيليو بناءها 1626م. مراكز اللغات الشرقيّة في روما نشأت بتكليف من مجمع نشر الإيمان الرهبنات.
• معظم إنتاج المستشرقين تركّز حول أساسيّات العقيدة الإسلاميّة، القرآن، والرسول، الفقه، وغير ذلك.
• الارتباط الواضح والمستمرّ بين الهيئات الاستشراقيّة والإرساليات التنصيريّة التي استفادت كثيرًا من الاستشراق الذي يعدّ الهيئة الاستشاريّة للتنصير، ومن أمثال هؤلاء المستشرقين الذين عملوا مع الدوائر التنصيريّة نذكر جيوم وكتابه (الإسلام) وسميث وكتابه (الإسلام في التاريخ الحديث)، وأندرسون وكتابه (تاريخ الأديان)، ولامانس ودراساته: (الحكام الثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة) و(محمد) وغير ذلك من المؤلّفات.
وبالنتيجة: إنّ تاريخ التنصير مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الاستشراق وهما لا ينفصلان عن تاريخ الاستعمار السياسي والفكريّ والأخلاقيّ، وأنّ كلّ ذلك نتيجة طبيعيّة لتعاليم الكنيسة الغربيّة بأنّ ما لديها هو أسمى وأصدق وأوثق ممّا لدى الكنيسة الشرقيّة الأرثوذكسيّة وغيرها .
(49)
لا شكّ أن الغرب لم يتحرّك لدراسة الإسلام والشرق بشكل عام من دون فلسفة تحكم هذا التحرك، وأهداف محدّدة، وإنْ كان هذا لا يلغي الجهود الفرديّة لبعض المستشرقين، وهذا يحتّم علينا أن نتعرّف على المبادئ والفلسفات التي تحكم العقليّة الغربيّة، والتعرّف على أهدافهم، ودوافعهم.
وبعض الباحثين يُفرط في الثناء على المستشرقين ويعتبر أن الدافع الأساس وراء البحث والدراسة عند هؤلاء هو العلم والمعرفة، ولا توجد أهداف أو دوافع أخرى وإن وجدت فهي فرديّة أو قليلة قياسًا للهدف العلميّ، وبعض الباحثين يذمّ وينتقد كل ما يمّت إلى الدراسات الاستشراقيّة بصلة ويجرّم كل أعمال المستشرقين، وفي الحقيقة البحث العلمي يقتضي عدم النظرة التفريطيّة أو الإفراطيّة للدراسات الاستشراقيّة، ونحن إذ نؤمن بهذه المنهجيّة العلميّة، وبعدم التحامُل المُسبق على أيّ دراسة.
ولكن من خلال قراءة أعمال أهم المستشرقين ودراستها فإنّنا نجد أن الدافع العلمي أو الهدف النبيّل يبدو ضئيلًا جدًا، بل نجد عكس ذلك تمامًا، كما سيتضح هذا من خلال القراءة النقديّة والتقويميّة لإنتاج المستشرقين وأعمالهم المختلفة، وهذا ما سيتبيّن معنا في طيات هذه الأبحاث المتعلّقة بالقرآن الكريم وعلومه. ونذكر هنا أهمّ هذه الدوافع والأهداف لتتجلّى لنا بشكل واضح معالم الحركة الاستشراقيّة، وهي الآتية:
لا نحتاج إلى استنتاج وجُهدٍ في البحث لنتعرَّف إلى الدافع الأول للاستشراق عند الغربيّين وهو الدافع الديني، فقد بدأ بالرّهبان، ومن أشهر الرُّهبان الذين اهتموا بالدراسات العربيّة والإسلاميّة الراهب أدلارد أوف باث (1070 - 1135)، وكذلك الراهب الشهير بطرس المبجل. وهذان الراهبان وغيرهما قاموا بتشويه الإسلام، وسيأتي بيان ذلك عند تقويم أعمالهم ومن أهمّها ترجمة هؤلاء للقرآن الكريم.
وذهَب رودي بارت Rudi Paret إلى أن ّالهدف الرئيس من أعمال المستشرقين
وجهودهم في بدايات الاستشراق في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التي تلت ذلك: هو التبشير heraldin، وعرَّفه بأنّه: «إقناع المسلمين بلغتهم ببُطلان الإسلام، واجتذابهم إلى الدين المسيحيّ، ...».
وقد أطلق محمد حسين الصغير على الدافع الديني اسم الدوافع التبشيرّية وهذا يدلل على حجم التبشير في الحركة الاستشراقيّة وأنّ هذه الحركة تتّفق في أغلبها على تقديم صورة مشوّهة عن الإسلام والقرآن الكريم.
ويمكن إبراز هذا الدافع الديني في أمور ثلاثة وهي:
وقد أوضح المستشرق «رودي بارت» هذا الأمر بشكل واضح إذ قال: «حقيقة أن العلماء ورجال اللاهوت في العصر الوسيط كانوا يتّصلون بالمصادر الأولى في تعرّفهم على الإسلام، وكانوا يتّصلون بها على نطاق واسع، ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصادر على نحو موضوعي نوعًا ما كانت تصطدم بحكم سابق؛ يتمثّل في أن هذا الدين المعادي للنصرانية لا يمكن أن يكون فيه خير، هكذا كان الناس لا يولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التي تتّفق مع هذا الرأي المتّخذ من قبل، وكانوا يتلقون بنهَمٍ كل الأخبار التي تلوح لهم مسيئة إلى النبيّ العربيّ وإلى دين الإسلام».
أثّرت «حركة الإصلاح الديني المسيحيّ» المعروفة بالحركة «اللوثرية» التي ولدّت المذهب البروتستانتي، بشكل واضح على مسار الدافع الديني للاستشراق.
وقد كان لهذه الحركة أثر في دراسة الإسلام في جانبين:
الجانب الأوّل: دراسة اللغة العربيّة؛ بوصفها جسر عبور للغة العبريّة:
ذلك أنّه «عندما قامت حركة «لوثر» (1483 - 1546م) بالثورة على الفاتيكان، بدأ بالدعوة إلى دراسة التوراة في لغتها الأولى، وهي العبريّة، ولما كانت العلاقة بين العبريّة وبين العربيّة وثيقة، وكانت العبريّة تائهة المعالم، وغير مضبوطة، فإنّ الاعتماد على اللغة العربيّة في التعرّف على الكلمات العبريّةكان أمرًا ضروريًا».
«ومن هنا اتجهوا إلى دراسة العبرانية، وهذه أدّت بهم إلى دراسة العربيّة فالإسلاميّة، لأنّ الأخيرة كانت ضروريّة لفهم الأولى، خاصة ما كان منها متعلّقًا بالجانب اللغوي، وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقيّة حتى شملت أديانًا ولغاتٍ وثقافات غير إسلاميّة وغير عربيّة».
من مَقاصِد الاستشراق الرَّئِيسَة التعرُّف على مَصادِر النصرانية من اللغة العبريّة، خاصَّةً بعد انتِشار حركة الإصلاح الكلونية في الكنائس، وقد ساقَتْهم دراسة اللغة العبريّة إلى تعلُّم اللغة العربيّة، وتعلُّم اللغة العربيّة قادَ إلى الاستشراق، فاللغة العربيّة هي لغة دين وثقافة وفكر جاء ليَحِلَّ محلَّ الدين النصراني والثقافة والفكر المُنبَثِقَيْن عن الدين النصراني، فأَوجَد هذا نزعة التعصُّب والعداء التي قادَتْ إلى استِخدام اللغة العربيّة والعبريّة في هذا المنحى «الاستشراقي الذي اتَّجه إلى الإسلام والعربيّة، وقد قيل: إنّك لا تَكاد تجد مُستَشرِقًا إلا أجاد اللغة العبريّة والعربيّة معًا».
الجانب الثاني: دراسة الإسلام بقصد عرض نقائصه «المزعومة» لإشغال جموع النصارى بها عن الإصغاء لزعماء حركات الإصلاح في نقد رجال الكنيسة وكشف مشاكلهم الفكريّة والعقديّة والروحيّة وغير ذلك. وسيأتي في طيّات الأبحاث القرآنية ما يؤكّد هذا التوجّه عند هؤلاء المستشرقين.
يتمثّل هذا الدافع الديني بمجموعة من العوامل ساهمت في ظهور حركة الاستشراق وتطوّرها ومن تحليل هذه العوامل نستطيع أن نفهم من خلالها أن أهمّ دافع لدراسة الإسلام هو تنصير المسلمين، أو لا أقلّ تشكيكهم بدينهم، كما تقدّم.
ومن هنا يعتبر أهمّ أهداف الدراسات الاستشراقيّة كانت في المرتبة الأولى التشكيك بالإسلام، ما يمهّد لدخول المسلمين إلى المسيحيّة؛ وهو ما نقصده «بتنصير المسلمين». ولتحقيق هذا الهدف قام المستشرقون بالخطوات الآتية:
1. التشكيك في رسالة النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله.
2. التشكيك في مصدر القرآن الكريم وصحته.
3. التشكيك في الدين الإسلاميّ نفسه: فهم يقولون: إن الدين الإسلاميّ ليس دينًا منزلًا من عند الله، بل هو دين مستمد من الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة.
4. التشكيك في صحّة الحديث النبويّ والذي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع. ويبرز هذا الأمر من خلال تركيزهم على بعض الأحاديث الموضوعة والمحرّفة التي دخلث إلى تراثنا الحديثي، متجاهلين جهود العلماء المسلمين في تنقية الحديث الصحيح وتمييزه من غيره، واعتمادهم على قواعد ومناهج دقيقة لهذا العرض عرفت باسم الجرح والتعديل أو علم الرجال بالإضافة إلى باقي علوم الحديث.
5. التشكيك في معظم جوانب التراث الإسلاميّ العلمي والحضاري، فهم يزعمون أن الفقه الإسلاميّ قد استمدّ من الفقه الروماني، وغير ذلك من ترّهات حاولوا إلصاقها بالإسلام.
وهناك وثائق كثيرة تؤكد أنّ هذا الهدف كان من أهمّ أهداف الدراسات الاستشراقيّة نكتفي بذكر واحدة؛ منها:
(54)«جاء في تقرير المراجع الأكاديميّة المسؤولة في جامعة كمبردج بالنسبة لإنشاء كرسيّ اللغة العربيّة فيها، في خطاب مؤرّخ في 9 من مايو 1636م إلى مؤسّسي هذا الكرسي:
ونحن ندرك أنّنا لا نهدف من هذا العمل إلا الاقتراب من الأدب الجيّد بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلًا من احتباسه في نطاق هذه اللغة التي نسعى لتعلّمها، ولكنّنا نهدف أيضًا إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقيّة، وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة، والدعوة إلى الديانة المسيحيّة بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلمات».
الهدف العلميّ للاستشراق، هو أحد الدوافع التي دفعت بعض المستشرقين إلى دراسة علوم الشرق. ولكن للأسف هذا الصنف عدده قليل جدًا إذا قيس بأعداد المستشرقين الآخرين، وهذا النوع من المستشرقين يتميّز بالروح العلميّة النزيهة، غير أن هناك أمور يشترك فيه جميع المستشرقين بما فيهم هذا النمط الأخير، فهم جميعًا قد يقعون في أخطاء علميّة بسبب جهلهم بأساليب اللغة العربيّة وطرائق التعبير فيها، ويرتّبون على فههم الخاطئ نتائج وأحكامًا خاطئة تبتعد بهم كثيرًا عن منطق الصواب والإنصاف، وقد يكون الفارق بين هذا النمط الأخير وغيرهم هو توفّر حسن النية عند النمط الأخير الذي تميز بالإنصاف والنزاهة وتوفّر سوء القصد وعدم النزاهة عند غيرهم.
فأصحاب الهدف العلمي منهم أقبلوا على الاستشراق بدافع من حبّ الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتها، وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خطأً في فهم الإسلام وتراثه؛ لأنّهم لم يكونوا يتعمَّدون الدَسَّ والتحريف، فجاءت
أبحاثهم أقرب إلى الحقّ وإلى المنهج العملي السليم من أبحاث الجمهرة الغالبة من المُسْتَشْرِقِينَ. ومن خلال معرفتنا لهذا الدافع نستطيع معرفة الهدف الغائي المرتبط به؛ فهدف هذا الدافع: إشباع نهم علميّ متجرّد، وتحصيل معرفة صحيحة تتّصل بأمّة ذات علم، وحضارة أصيلة.
إنّ الدراسات الاستشراقيّة كثيرة جدًا فلقد بلغ ما ألّفوه عن الشرق في قرن ونصف قرن (منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين) ستين ألف كتاب. وبعض هذه الكتب والدراسات ألّفت بداعي البحث مع قلّتها نذكر منها الآتي:
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان ت 1956م.
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف لفنسنك، مرتّبًا على الحروف الأبجدية (ليدن 1927م)، والذي يشمل الكتب الستة المشهورة بالإضافة إلى مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وقد وضع في سبعة مجلدات نشرت ابتداءً من عام 1936م.
مفتاح كنوز السنة لفنسنك، وقد قام بنشره بالعربيّة محمد فؤاد عبد الباقي.
بالإضافة إلى الكتب التي كتبت حول معاجم القرآن الكريم وغير ذلك.
كما كانت لهم جهود في كشف المخطوطات وحفظها، وفهرستها، والعناية بها، ويوجد في مكتبات أوروبا عشرات الآلاف من المخطوطات الإسلاميّة. وفي مكتبة
باريس الوطنية وحدها سبعة آلاف مخطوطة عربيّة بينها نفائس علمية وأدبية وتاريخية ونوادر قلما توجد في غيرها.
عندما ندرس بدايات حركة الاستشراق لا نرى أيّ ترابط واضح بين الاستشراق والحركة الاستعماريّة، بل بداية حركة الاستشراق ودوافعه كما تقدّم كانت دينية وعلميّة، بغضّ النظر عن عدم الموضوعيّة في كثير من هذه الدراسات الاستشراقيّة.
ولكن بعد أن اجتاح الفكر الاستعماريّ الأوروبيّ العالم الشرقيّ واستعمرت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرهم من الدول الغربيّة العالم الشرقي والإسلاميّ، احتاجت هذه الدول الغربيّة دراسة واقع الدول الشرقيّة التي استعمرتها فوجدت في الحركة الاستشراقيّة ضالتها المنشودة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستعمارية، فاستعانت بهم في هذا المجال، والمستشرقون قدّموا دراساتهم في هذا المجال، ومن هنا تحقّق التلاقي بين الاستعمار والاستشراق، ودخلت الحركة الاستشراقيّة في مرحلة جديدة وهي المرحلة الاستعماريّة.
يقول نجيب العقيقي: «فلما أرادت معظم دول الغرب عقد الصلات السياسيّة بدول الشرق والاغتراف من تراثه، والانتفاع بثرائه، والتزاحم على استعماره، أحسنت كل دولة إلى مستشرقيها فضمّهم ملوكها إلى حاشياتهم أمناء أسرار وتراجمة، وانتدبوهم للعمل في سلكي الجيش والدبلوماسيّة إلى بلدان الشرق، وولّوهم كراسيّ اللغات الشرقيّة في كبرى الجامعات والمدارس الخاصة، والمكتبات العامة، والمطابع الوطنية، وأجزلوا عطاءهم في الحلّ والترحال، ومنحوهم ألقاب الشرف وعضويّة المجامع العلميّة».
هكذا اشتغل فريقٌ من المفكّرين بمجال الاستشراق مدفوعين من قبل حكوماتهم
التي دعتهم إلى مساعدتها على استعمار الشرق، فكانوا عونًا لها مخلصين في تقديم المعلومات التي احتاجت إليها وهي في طريقها إلى اجتياح الشرق، معلنةً الهيمنة عليه لفترةٍ من الزمن تعين على امتصاص خيراته، وعلى إيجاد البديل عند الخروج، وعلى إضعاف مكامن الخطر بالنسبة لهم.
فالمستشرقون كان دورهم نقل وتوصيل المعلومات عن العالم الإسلاميّ؛ مثل: جغرافيّته ومكامن قوّته ونقاط ضعفه وعن شعوبه، وأديانه، ولغاته،...
ولقد انبثق الدافع الاستعماري للاستشراق من رحم الحروب الصليبية، فعندما انتهت الحروب الصليبيّة بهزيمة الصليبيين وفشلهم، -وهي في الحقيقة حروب استعمارية دينية- لم ييأس الغربيون من العودة إلى احتلال بلاد الإسلام والعرب. فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد، وجندوا لها علماء بارزين يبحثون عن كل شؤون من عقيدة وتقاليد وعادات وأخلاق وثروات وغيرها، ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها، وإلى مواطن الضعف فيستغلوها.
أما الدافع السياسيّ فمن الواضح أن الاستعمار المباشر للبلدان -طبعًا باستثناء فلسطين المحتلّة- قد انتهى. وأمّا الدافع السياسي فما زال قائمًا. فنرى الآن في كل سفارة من سفارات الدول الغربيّة في بلادنا العربيّة والإسلاميّة ملحقًا ثقافيًا يحسن اللغة العربيّة ليتمكن من الاتصال برجال الفكر والصحافة والسياسة، فيتعرّف أفكارهم، ويبثّ فيهم من الاتجاهات السياسيّة ما تريده دولته.
وهذا الدافع برز مع بداية استقلال البلدان الإسلاميّة عن الاستعمار الغربي، «فاقتضى التفكير الاستعماري أن يكون في قنصليّات الدول الغربيّة وسفاراتها رجال لهم باع طويل في ميدان الدارسات الاستشراقيّة لكي يتحمّل هؤلاء مهمّة الاتصال برجال الفكر والثقافة للامتزاج بهم وبثّ الاتجاهات السياسيّة المختلفة بينهم، حتى يكونوا أداة منفّذة لكل مخطّطات الاستعمار وأساليبه»، فكان لهذا الاتصال
أثر خطير جدًّا ومن خلال السفراء الغربيّين ليبثّوا الدسائس والتفرقة بين الدول العربيّة الإسلاميّة بحجّة النصائح والمعونة والمساعدة، فهم لا يزالون يسعون إلى إضعاف تماسك المسلمين.
ويمكن تلخيص هذه المهمّات السياسيّة التي كانت تقوم بها ما يسمّى بالبعثات الدبلومسيّة والسفارات الأجنبيّة بالآتي:
1- الاتصال بالسياسيين والتفاوض معهم لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم.
2- الاتصال برجال الفكر والصحافة للتعرّف على أفكارهم وواقع بلادهم.
4- بثّ الاتجاهات السياسية التي تريدها دولهم، فيمن يريدون بثّها فيهم، وإقناعهم بها.
5- الاتصال بعملائهم وأجرائهم الذين يخدمون أغراضهم السياسيّة داخل شعوب الأمّة الإسلاميّة، إلى غير ذلك من الأعمال.
ويمكن أن نلحق بالدوافع السياسية، الدافع الاقتصادي، فالاقتصاد، والمصالح التجارية والنزوع نحو استغلال الشعوب الضعيفة، لا تنسلخ عن السياسة والخطط السياسية.
من بين دوافع الاستشراق كان هناك الدافع الاقتصاديّ، حيث رغبت الدول الأوروبيّة في تنشيط تجارتها مع دول الشرق الإسلاميّ، وتسويق منتجاتها، والبحث عن مواد خام لصناعاتها، فلزم الأمر القيام بالتعرّف على الشرق وطبيعته وجغرافيّة بلاده، وعادات شعوبه ومعتقداتهم، وتوظيف هذه المعرفة بالشرق في ما يخدم الهدف الاقتصادي.
وقد سبقت الإشارة إلى ما جاء في تقرير المراجع الأكاديميّة المسؤولة في جامعة كمبردج بشأن كرسيّ اللغة العربيّة فيها،
إنّ البعد الاقتصادي يكمن في «تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقيّة».
ومن خلال ما تقدّم تبين أن هناك دوافع دينية، وسياسيّة، واقتصادية، وغير ذلك، دفعت المستشرقين لدراسة الشرق وبالأخص الديانة الإسلاميّة، وفي كل هذه الأعمال والدراسات قد نلحظ هدفًا عامًا ركّزت عليه هذه الدراسات سواء بطريقة مباشرة أم لا؛ وهو «تغريب الفكر الإسلاميّ» وبالأحرى تغريب الإسلام. فما المراد بالتغريب؟
يعتبر «تغريب الفكر الإسلاميّ» من الأهداف الرئيسة لأغلب الدراسات الاستشراقيّة، يُطلق «التغريب»، في الاصطلاح الثقافي والفكري المعاصر، غالبًا على «حالات التعلّق والانبهار والإعجاب والتقليد والمحاكاة للثقافة الغربيّة والأخْذ بالقيم والنُّظم وأساليب الحياة الغربيّة؛ بحيث يصبح الفرد أو الجماعة أو المجتمع المسلم الذي له هذا الموقفُ أو الاتجاه غريبًا في مُيوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العام وتوجهاته في الحياة، يَنظر إلى الثقافة الغربيّة وما تشتمل عليه من قِيم ونُظم ونظريات وأساليب حياة نظرةَ إعجابٍ وإكبار، ويرى في الأخذ بها الطريقة المُثلى لتقدُّم جماعته أو أمّته الإسلاميّة.
وهذا المعنى قريبٌ من دلالة الفعل «غَرَّب» (To Westernize) في الإنجليزية؛ إذ يعرِّف معجم «أوكسفـورد» هذا الفعل على النحو الآتي: «To Make an eastern country, person, etc more like one in the west, esp in ways of living
and thinking,.institutions, etc» ؛ أي جعْل الشرق تابعًا للغرب في الثقافة وأساليب العيش وطرق التفكير… وفي الفرنسية، يعني التغريب الشيء نفسَه.
ويتّخذ التغريب أشكالًا مختلفة، لعلّ أخْطرها «التغـريب الثقافي»؛ لأنّه إبْدال ثقافي يتغيّى إحْلال ثقافة أجنبيّة محلَّ الثقافة المحليّة الأصليّة، مع ما يرافق ذلك من مظاهر التبدُّل والتغيـير.
وعندما يتحدّث الباحثون والمفكّرون المسلمون عن التغريب؛ فإنّهم يشيرون إلى واقع يومي مَعيش مشاهَد في الحياة المادية والاجتماعية والنفسية والثقافية والحضارية؛ واقعٍ صنَعَته ظروفٌ تاريخية عصيبة، وتضافرت على نسْج خُيوطه عواملُ كثيرة. وبالنظر إلى عُمق ظاهرة التغريب في حياتنا الثقافية المعاصرة، فإننا نرى هؤلاء الباحثين يستعملون عددًا من المصطلحات للدلالة عليه؛ نحو الاغتراب الثقافي، والإلحاق الثقافي، والاسْـتِلاب الثقافي، والمسْـخ، … ومن المؤكَّد أن مصطلح «التغريب»، بدلالته المعاصرة المعروفة، من نتاج الفكر الغربي، ويرتبط بالحركة الإمبريالية الأوروبية التي انطلقت في القرن التاسع عشر. يقول محمد مصطفى هدارة: أن «اصطلاح «التغـريب» ليس من ابتكارنا في الشرق، ولكنه ظهر في المعجم السياسي الغربي باسم «Westernyation»، وكانوا يعنُون به نشْر الحضارة الغربيّة في البلاد الآسيوية والإفريقية الواقعة تحت سيطرتهم عن طريق إزالة القُوى المضادَّة التي تحفظ لهذه البلاد كِيانها وشخصيتها وعاداتها وتقاليدها، وأهمّها الدين واللغة، وفي زوال هذه القوى ضمان لاستمرار السيطرة الغربيّة السياسيّة والاقتصاديّة حتى بعد إعلان استقلال هذه البلاد وتحرُّرها من نير الاستعمار الغربي ظاهـريًا.
(63)
«لم يترك المستشرقون مجالًا من مجالات الأنشطة المعرفيّة والتوجيهيّة العليا إلا تخصّصوا فيها، ومنها التعليم الجامعي، وإنشاء المؤسّسات العالميّة لتوجيه التعليم والتثقيف، وعقد المؤتمرات والندوات ولقاءات التحاور، وإصدار المجلات ونشر المقالات وجمع المخطوطات العربيّة، والتحقيق والنشر وتأليف الكتب، ودس السموم الفكريّة فيها بصورة خفيّة ومتدرّجة، وإنشاء الموسوعات العلميّة الإسلاميّة، والعناية العظمى لإفساد المرأة المسلمة وتزيين الكتابة باللغة العاميّة...». ونحاول أن نذكر أهمّ هذه الآليّات والوسائل؛ وهي الآتية:
اﻫــﺘﻢّ المستشرقون بتأليف الكتب ونشرها، وإﺻﺪار اﳌﻮسـﻮﻋﺎت واﳌﻌﺎﺟﻢ، وبشتى اللغات الأجنبيّة، ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﳍـﻢ إﻧﺘـﺎج ﺿـﺨﻢ، وسيل متدفّق من الكتب يحمل أهمّ أفكارهم وآرائهم المختلفة، وكثيرٌ من هذه الكتب تُرجمت إلى اللغة العربيّة. وعلى مستوى المضمون لهذه الكتب اشتملت اﳊﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﺟﻮاﻧـﺐ اﻹسـﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻧﻮاﺣﻴـﻪ اﳌﺘـﺸﻌّﺒﺔ، ﻓﺘﻨﺎوﻟـﺖ العقيدة والشريعة، واﻟﺴﻨّﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ، والسيرة واﻟﻔﻘـﻪ، واﻟـﺪﻋﻮة اﻹسـﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻠﻐـﺔ وغيرها ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻌﺎرف الإسلاميّة واشتملت هذه الكتب في أغلبها على تزوير للحقائق الثابتة في
الإسلام وعلى افتراءات على الإسلام والقرآن الكريم وهجوم مركز على شخصية نبي الإسلام صلىاللهعليهوآله وبعض هذه الكتبات والمؤلفات اتّسمت بنوع من الخفاء والدهاء التي قد تجعل بعض السذج يقع في فخ هذه الدراسات وهي أشبه بدس السمّ بالعسل.
وقد تميّزت كتابات المستشرقين في العصور الوسطى أو بدايات الاستشراق بالتعصّب والحقد الشديد والكراهيّة للإسلام وإظهار هذه العواطف والاتجاهات بصراحة متناهية حتى ظهر منهم من كتب منتقدًا هذا الأسلوب ومن هؤلاء ما كتبه نورمان دانيال في كتابه (الإسلام والغرب) وما كتبه ريشتارد سوذرن في كتابه (صورة الإسلام والمسلمين في كتابات العصور الوسطى).
وظهرت في القرن العشرين كتابات عن الإسلام تظاهرت بأنّها تجاوزت التعصّب والحقد القديم ومنها ما كتبه توماس آرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) وقد يكون هذا الكتاب قدم بعض العبارات والجمل المادحة للإسلام والمسلمين كما ظهرت كتابات مونتغمري وات حول الرسول صلىاللهعليهوآله (محمد في مكة) و(محمد في
المدينة) و(محمد رجل الدولة والسياسة) وغيرها من الكتب.
وقد أورد الأستاذ محمد البهيّ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘـﺐ الاستشراقيّة المتطرفة والمشوِّهة منها:
- ﺣﻴﺎة محمد: ﺗﺄﻟﻴﻒ سير وﻟﻴﺎم ﻣﻮﻳﺮ.
- اﻹسـﻼم: ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻟﻔﺮد ﺟﻴﻮم.
- اﻹسـﻼم: ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﻨﺮي ﻻﻣﻨﺲ.
- ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹسـﻼﻣﻲ: ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻷﳌﺎﻧﻴـﺔ، وﺗـُﺮﺟﻢ إﱃ العربيّة ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻮﻟﺪزيهر.
- ﻣﺼﺎدر ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮآن: ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺗﺄﻟﻴﻒ آرﺛﺮ ﺟﻴﻔﺮي ـ
- اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺒﻜّﺮة ﰲ اﻹسـﻼم: ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺗﺄﻟﻴﻒ د.س ﻣﺮﺟﻠﻴﻮث.
- الحلاج اﻟﺼﻮﰲ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﰲ اﻹسـﻼم: ﺑﺎﻟﻔﺮﻧـﺴﻴّﺔ، ﻣـﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟـﻮي ﻣﺎسـﻨﻴﻮن.
- اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ اﻹسـﻼم: ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ إﺑﺮاﻫﺎم ﻛﺎسـﻦ.
- ﻣﻘﺪّﻣﺔ اﻟﻘﺮآن: ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻴﻨﻴﺚ ﻛﺮاج.
- دراسـﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻹسـﻼﻣﻴّﺔ: ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﻮن ﺟﺮوﻧﻴﺒﺎوم.
(67)
ومن المؤلفات الخطيرة:
كتاب ميزان الحق الدكتور فاندر المستشرق الأمريكي، والدكتور سنكلير تسدل.
كتاب الهداية، ويقع في أربعة أجزاء، وهو هجوم مريع على الإسلام ونبي الإسلام.
كتاب: مقالة في الإسلام، للدكتور المستشرق سال.
كتاب: مصادر الإسلام، للدكتور سنكلير تسدل.
وهذه الكتب الأربعة الاستشراقيّة والتبشيرية، تعتبر من أخطر الكتب في حق الإسلام والقرآن ونبي الإسلام.
ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار «دائرة المعارف الإسلاميّة» بلغات عدّة.
قد زاد عدد اﳌﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت الشرقيّة ﻟﺪى المستشرقين على ثلاثمائة مجلّة ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ بالاستشراق، ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺌﺎت ﺗﺘﻌﺮّض ﻟـﻪ ﰲ موضوعاتها اﻟﻌﺎﻣـﺔ؛ ﻛﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺎرن وﳏﻔﻮﻇﺎت اﻟﺘـﺎرﻳﺦ، وﻣﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴّـﺔ، وغير ذلك.
وﻣﻦ هذه اﻟﺪورﻳﺎت:
«مجلة العالم الإسلامي» وهي مجلة تبشيريّة ﺗـﺼﺪر ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳـﺔ ﰲ ﻫـﺎر ﺗـﺴﻮرد - ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ، وﺗﻮزع ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ.
«مجلة العالم الإسلامي» وهي مجلة تبشيريّة ﺗـﺼﺪر ﰲ ﻓﺮﻧـﺴﺎ، وﺗﻮزع ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ.
«مجلة جمعية اﻟﺪراسـﺎت الشرقيّة» -أﻧــﺸأﻫﺎ المستشرقون اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﻮن ﰲ ﺟﺎﻣﺒﲑ ﺑﻮﻻﻳﺔ أوﻫﺎﻳﻮ، وﻛﺎن ﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﺮوع ﰲ أوروﺑﺎ وﻛﻨﺪا.
«مجلة ﺷؤون الشرق اﻷوسـﻂ» ﺗـﺼﺪر ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳـﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜـﺎ، وﳛﺮرﻫـﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ المستشرقين اﳌﻌﺎدﻳﻦ ﻟﻠﻌﺮب والمسلمين، واهتماهها ﻣﻮﺟـﻪ ﰲ اﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎسـﻴﺔ. وغير ذلك من المجلات والدوريات.
هناك دور نشر كثيرة في الغرب تعنى بإعداد الكتب الاستشراقيّة والترويج لها وتوزيعها في الأماكن المختلفة من العالم، ومن أشهر دورُ النشر نذكر الآتي:
في باريس:
دار إرﻧﺴﺖ ﻟﺮو: ﻣﻌﺮوﻓﺔ بنشر اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت الاستشراقيّة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﳎـﻼت ونشرات، وﺑﺈﺻﺪار ﻓﻬﺮس ﻣﻔﺼﻞ دﻗﻴﻖ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﻌﻨﻮان: مسرد ﻋﺎم.
دار ﻫﻨﺮي ﻓﻠﱰ: وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والفارسية والتركية النفيسة.
دار ﻣﺰوﻧﻴﻒ: ﻣﻦ أﻛﱪ دور النشر الاستشراقيّةﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأوروﺑﺎ.
في إنجلترا:
دار ﺑﺮوﺑﺴﺘﺎﻳﻦ وشركاه ﰲ ﻟﻨﺪن، وتنشر ﻓﻬﺮسـًﺎ دورﻳًّﺎ ﺑﺎسـﻤﻪ.
دار ﻫﻴﻔﺮ وأوﻻده ﰲ ﻛﻤﱪﻳﺪج، وتنشر ﺑﻌﻨـﻮان اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻵسـﻴﻮﻳﺔ ﻓﻬـﺎرس دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت الشرقيّة على اﺧﺘﻼف موضوعاتها.
دار ﺑﺮﻧـﺎرد ﻛــﻮارﻳﺘﺶ ﰲ ﻟﻨــﺪن، وتنشر ﻓﻬﺮسـًــﺎ دﻗﻴﻘًــﺎ ﻣــﺸﻬﻮرًا بعنوان: ﻓﻬﺮس اﳌﺆﻟﻔﺎت الشرقيّة.
في إسبانيا:
دار ﻣﺎﻳﺴﱰي ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ.
في ألمانيا:
دار ﻫﺎراﺷﻮﻓﺘﺶ ﰲ ﻓﻴـﺴﺒﺎدن، وﳍـﺎ نشرة ﺷـﻬﺮﻳﺔ ﻟﻮﺻـﻒ ﻣـﺎ ﻳـﺼﺪر ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ مصر وﻟﺒﻨﺎن وسـﻮرﻳﺎ واﳍﻨﺪ واﳌﻐﺮب الأقصى.
في هولندا:
دار ﺑﺮﻳﻞ ﰲ ليدن
اسـﺘﺨﺪم المستشرقون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ الجامعة لنشر أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﺗﻮسـﻠﻮا ﺑـﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿـﻬﻢ وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﻧـﺸﺎء أﻗـﺴﺎم ﻟﻠﺪراسـﺎت اﻹسـﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ بالجامعات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻻ ﺗﻜﺎد ﲣﻠﻮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻐﺮب اﻵن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌـﺔ بها ﲣـﺼﺺ أو ﻗﺴﻢ ﺧﺎص للاستشراق.
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪد هذه اﻷﻗـﺴﺎم [اﻹسـﻼﻣﻴﺔ] ﰲ الجامعات اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ سـﺘﲔ قسمًا ﰲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ستين ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﰲ اﻟﻐـﺮب، على رأس اﻷﻗـﺴﺎم أسـﺎﺗﺬة يهود، ومحاورهم اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﺗـﺪور ـ ﰲ ﻛﻴﺎسـﺔ ـ ﺣـﻮل اﻟﺘـﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻟـﻮﺣﻲ، وﰲ السنة، وغير ذلك من الأسس والمعتقدات الإسلاميّة المسلمة بين المسلمين.
وﻫﻨﺎك دﻻﺋﻞ على أن المستشرقين ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻣﺎ وسِعهم الحِرصُ، على أن لا يُمكنَّوا
(70)باحثًا إسلاميًا منصفًا ومتمكنًا من العلوم الإسلاميّة فلا يسمحون لطلاب كهؤلاء من قصد معاهدهم لانصاف الإسلام وبعبارة أخرى تقديم الإسلام كما هو في الواقع، لا كما يريد هؤلاء المستشرقون في معاهدهم وجامعاتهم وعلى ذلك شواهد كثيرة.
لا يكتفي هؤلاء بتدريس الإسلام في دولهم الغربيّة، بل يأتون إلى بلادنا وعواصمنا ويدرسون الإسلام في جامعتنا، وخاصة الجامعات غير الحكومية لبلادهم كالجامعة الأمريكية في القاهرة، وفي بيروت.
وكنموذج على ذلك نذكر أنه في 1997-1998م أسندت الجامعة الأمريكية في القاهرة إلى أحد المستشرقين وهو الفرنسي دودييه تدريس مادة «تاريخ المجتمع العربي» وما كان من الأخير إلى أن أضاف إلى المقرر الدراسي كتاب «محمد» للمستشرق ماكسيم رودنسون، والكتاب يطفح بعبارات السوء والبهتان في حق نبي الإسلام صلىاللهعليهوآله.
وﻗــﺪ ﻋﻘــﺪ المستشرقون ﻣﻨــﺬ ﻋﺎم 1873م إﱃ ﻋﺎم 1976م ثلاثين ﻣــﺆﲤﺮ دوﻟﻴًـﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﲤﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ مثل مؤتمر المستشرقين اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺖ (ﻟﻴﻨﻨﺠﺮاد 1935-1937م) وﺣﻠﻘﺔ المستشرقين ﰲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، حيث نُشرت أﺑﺤﺎﺛﻬــﺎ ﰲ ﻛﺘـﺎب ﺑﻌﻨﻮان: ﺗﻄــﻮر اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻹسـﻼﻣﻴﺔ (باريس 1962م).
وﻳﻀﻢ المؤتمر ﻣﺌـﺎت العلماء ﻣـﻦ أﻋـﻼم المستشرقين وأﻗﻄـﺎب الوطنيين ﰲ اﻟﻐﺮب والشرق، ﻓﻘﺪ اﺷﱰك ﰲ مؤتمر أﻛﺴﻔﻮرد 900 عالم ﻋﻦ 25 دوﻟـﺔ، 85 ﺟﺎﻣﻌﺔ 69 جمعية ﻋﻠﻤﻴﺔ.
وﻳﻨﻘﺴﻤﻮن إﱃ أرﺑﻊ عشرة جماعة، ﺗﻨﻔﺮد ﻛﻞﱞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺟـﺪول الأعمال وﻫﻲ:
اﻟﺪراسـﺎت المصرية اﻟﻘﺪﻳﻤـﺔ، واﻟﺪراسـﺎت اﻵسيـﻮﻳّﺔ اﻟﺒﺎﺑﻠﻴـﺔ، وآﺛـﺎر الشرق اﻷدﻧﻰ، واﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وآﺛﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘـﺪس، والشرق اﳌـﺴﻴﺤﻲ، وﺑﻴﺰﻧﻄـﺔ، واﻟﺪراسـﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، واﻟﺪراسـﺎت اﻹسـﻼﻣﻴﺔ (اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب)، واﻟﺪراسـﺎت اﻹسـﻼﻣﻴﺔ (اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻨـﻲ)، واﻟﺪراسـﺎت اﻟﱰﻛﻴـﺔ، واﻟﺪراسـﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﺮان واﻟﻘﻮﻗﺎز وﻣـﺎ جاورهما، واﻟﺪراسـﺎت الهندية، ودراسـﺎت آسـﻴﺎ اﻟﻮسـﻄﻰ، ودراسـﺎت آسـﻴﺎ الشرقيّة، ودراسـﺎت آسـﻴﺎ الشرقيّة الجنوبية، واﻟﺪراسـﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
وﻗﺪ أحصى اﻟﻌﻘﻴﻘﻲ ﻣﺆﲤﺮات المستشرقين اﻟﺜﻼﺛــﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ من سنة 1873-1976م، ﻓﺬﻛﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎده، وحجم أعماله، ﻛﺄن ﺗﻜــﻮن مجلدين أو ﺛﻼﺛﺔ أو خمسة، وﻫﻜﺬا...كما أورد نماذج ﳑــﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪراسـﺔ على ﺟﺪاول أعمالها.
اسـﺘﻄﺎع المستشرقون أن ﻳﺘــﺴﻠﻠﻮا إﱃ ﺑﻌــﺾ اﳌﺠــﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﺮسـﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹسـﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜـﻞ مصر ودﻣـﺸﻖ وﺑﻐـﺪاد، وعملوا ﺟﺎﻫـﺪﻳﻦ على تحويل في أهداف هذه المجافل العلميّة من خلال ﻗﻴـﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟـﺪﻋﻮة إﱃ إﺣﻴـﺎء اﻟﻌﺎﻣﻴـﺎت، أو اﻟـﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻟﻨﺤـﻮ اﻟﻌـﺮﰊ، أو اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻮسـﻄﻰ أو اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ المعاصرة، وﻛﻠﻬـﺎ ﳏـﺎوﻻت ﺗﺮﻣـﻲ إﱃ إﳚـﺎد ﻓﺠﻮة بين ﻟﻐﺔ القرآن وﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وﻣﻦ المستشرقين اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﰲ اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﻮي بمصر؛ «ﺟـﺐ» و«ﻣﺮﺟﻠﻴﻮث» و«ﻧﻴﻜﻠﺴﻮن» وﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﻣﻦ إنجلترا و«ﻟـﻮي ﻣﺎسـﻨﻴﻮن» الفرنسي. وﻣﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ: «أ.ج.ﻓﻴﻨﺴﻴﻨﻚ».
وﻣﻦ المستشرقين اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﰲ اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ: «ﺟﺮﻳﻔﻨـﻲ»
اﻹﻳﻄﺎﱄ، و«جوتهيل» اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ، و«ﺟﻮﻳﺪي» اﻹﻳﻄﺎﱄ، و«ﺟﻲ سـﻮ» الفرنسي و«ﻧﺎﻟﻴﻨﻮ» اﻹﻳﻄﺎﱄ، و«ﻫﺎرﲤﺎن» ألماني اﻷﺻـﻞ، و«م. هوتمان الهولندي»، وكذلك «مرجيلوث» و«ماسنيون».
ولا بد من الالتفات أنّ ﻫﺆﻻء المستشرقين ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻠﻮا إﱃ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وﻓﻘﻪ اﻟﺒﻴـﺎن اﻟﻌﺮﰊ، وإدراك أسرار اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ ﺗــﺆﻫﻠﻬﻢ لأن يكونوا في مصافِّ علماء اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺘـﺪرﻳﻦ، بل هناك آراء طرحها هؤلاء تشير إلى جهلهم باللغة العربية.
أن ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻮسـﺎﺋﻞ وأﺧﺒﺜﻬﺎ ﰲ نشر وإذاﻋﺔ اﻟﻔﻜـﺮ الاستشراقي اﳌﻌـﺎديِّ ﻟﻺسـﻼم؛ اسـﺘﺨﺪام ﺑﻌــﺾ أﺑﻨـﺎء اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣــﻦ ﺗﻼﻣﻴــﺬ المستشرقين والمبشرين ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا بهذه الوظيفة (نشر الفكر الاستشراقي) ﻧﻴﺎﺑـﺔ عن أساتذتهم، واﻟﱰوﻳﺞ ﻵراء المستشرقين والمبشرين ﻣـﻦ غير ﻧـﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟـﻴﻬﻢ، بل على أنها ﻣــﻦ ﻧﺘــﺎج ﻗــﺮاﺋﺢ أوﻟﺌــﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ، وﺛﻤــﺮة اﺟﺘﻬــﺎدﻫﻢ وتفكيرهم، بينما ﻫـﻲ ﰲ واﻗـﻊ اﻷﻣـﺮ ﻻ ﺗﻌـﺪو أن ﺗﻜـﻮن ﺻـﺪى ﻵراء وسـﻤﻮم ﺧﺼﻮم اﻹسـﻼم. وبعبارة أخرى حرص هؤلاء على صناعة المفكِّر المستغرب من أبناء البلاد الإسلاميّة والعربية.
(73)
اختصَّت كلّ مدرسة من مدارس الاستشراق الغربيّ بخصوصيَّاتها ومناهجها، وأخذت تتنافس في ميدان البحث والتحقيق. وهناك تقسيمات مختلفة لمدارس الاستشراق نشير إلى أهمّها، وهي:
هناك تقسيمات عدَّة لمدارس الاستشراق؛ فبعضها انصبّ على طبيعة المجال البحثيّ للمستشرقين، أيْ من حيث نوعيّة الموضوعات التي اشتغلوا عليها، فقسَّم الدكتور حسين الهراوي -بناءً على ذلك- المدارس إلى أقسام ثلاثة:
1- مدرسة تختصّ بمباحث القرآن الكريم.
2- مدرسة تتعلَّق بالنبيّ محمَّد صلىاللهعليهوآله، أي المختصَّة بحياته وما جرى معه في سيرته، وأعماله، وحروبه وسياسته و….
3- مدرسة تختصّ بالتاريخ العربيّ والإسلامي،ّ أيْ المدرسة التي تُعنَى بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده، وباللغة العربيَّة، وبتاريخ الإسلام في عصر الصحابة، والعصر الأمويّ والعبَّاسيّ إلى يومنا هذا..
ومن الواضح أنّ َهذا التقسيم غير شامل؛ لأنَّ الاستشراق لا يهتمّ فقط بما يتعلّق بالإسلام ومصادره ونبيّه والتاريخ فقط. بل هناك مجالات أخرى، بحثها بعمق علماء الاستشراق؛ كالفلسفة، واللغة، والأدب، والجغرافيا، والاقتصاد، وغيرها.
وقسَّم نجيب العقيقي الاستشراق إلى مدرستين، هما:
1. المدرسة السياسيَّة التي تبحث في الأدب بمفهومه العامّ.
والأدب بهذا المفهوم يطال كلّ أنواع الفكر الإنسانيّ. وفي هذه المدرسة تندرج دراسات المستشرقين حول الدين، والتاريخ، واللغة، والعادات، والتقاليد للمجتمعات الإسلاميَّة، والشعوب المختلفة، و...
2. المدرسة الأثريَّة التي تهتمّ بالآثار.
ومن الواضح أنَّ هذا التقسيم واسع جدًا، ولا يمكنُّنا من تمييز المدارس وتصنيفها بشكلٍ دقيق.
يعتمد هذا التقسيم على دراسة أهداف المستشرقين، ودوافعهم، وغاياتهم. وفي هذا السياق يمكن تقسيم مدارس الاستشراق على الشكل الآتي:
الاستشراق الدينيّ الأيديولوجيّ: وهو الاستشراق الذي كانت دوافعه دينيَّة، وهو ذاك الاستشراق الذي قادته المؤسَّسات الدينيَّة المسيحيَّة. وقد بيَّنَّا ذلك عند بحث العلاقة بين الاستشراق والتنصير.
الاستشراق الاستعماريّ: وهو الاستشراق الذي كان ينطلق من دافعٍ سياسيّ-عسكريّ-توسُّعيّ. وقد تقدَّم بيانه في الأبحاث السابقة.
الاستشراق العلميّ: وهو الاستشراق الذي لم يرَ في دراسة الشرق سوى مادَّة علميَّة، وقد بدأ شياع هذا النوع من الاستشراق، وهذا الجيل من المستشرقين بالأخصّ بعد الحرب العالميَّة الثانية وانهيار كلّ من الاستعمار الأجنبيّ المباشر وسلطة الكنيسة المطلقة.
المنهج الجغرافيّ في تقسيم مدارس الاستشراق، وهو التقسيم الذي يعتمد على بلد المستشرق، فيقسِّم الاستشراق وفق الجغرافيا، إلى الاستشراق الفرنسيّ، والإنكليزيّ، والإيطاليّ، والألمانيّ، والروسيّ، وغيرهم.
ومن الواضح صعوبة تصنيف مدارس الاستشراق بالدقَّة؛ لأنَّنا نتكلَّم عن آلاف من المستشرقين، و«من المستحيل تصنيف هذا العدد الهائل من المستشرقين في مدارس ذات خصائص محدَّدة؛ حيث إنَّهم يمثِّلون جنسيَّاتٍ مختلفة، ويتكلَّمون لغاتٍ متعدِّدة، ويسيرون في اتِّجاهاتٍ متنوِّعة، وينطلقون من أهدافٍ متقاربة. ولا بدَّ لكلِّ من أراد الخوض في هذا الموضوع خاصَّة، وميدان الاستشراق عامَّة أن يلمّ بأطراف كلّ هذه الاختلافات، وهذا ما يبدو أمرًا مستحيلًا، ولكن مع استحالته هذه، فإنَّه من الممكن الالتجاء إلى التوزيع الجغرافيّ أساسًا للتصنيف، انطلاقًا من أنَّ البيئة بما لها من خصائص -إيجابيَّة كانت أو سلبيَّة- ذات أثرٍ كبيرٍ في تكوين شخصيَّة الكاتب وتوجيه أفكاره».
سنعتمد التقسيم الجغرافيّ للمدارس الاستشراقيَّة، لا من باب أنَّه الأفضل من الناحية المنهجيَّة، بل هو الأسهل في اعتماده معيارًا للتقسيم؛ لأنَّه يجنِّبنا التداخل في الأقسام أو خروج بعض الأقسام، بخلاف ما لو اعتمدنا معايير أخرى في هذا المجال.
وأهمّ مدارس الاستشراق هي:
1- الاستشراق الإيطاليّ
2- الاستشراق الفرنسيّ
3- الاستشراق البريطانيّ
4- الاستشراق الألمانيّ
5- الاستشراق الإسبانيّ
6- الاستشراق الهولنديّ
7- الاستشراق الأمريكيّ
8- الاستشراق الروسيّ
وسنتعرَّض لكلِّ مدرسة من هذه المدارس بشكلٍ مختصر، مع الإشارة إلى أبرز أعلام هذه المدرسة.
إنَّ لتصدير البحث بالمدرسة الاستشراقيَّة الإيطاليَّة أسبابًا عدَّة، منها:
ـ إنّ إيطاليا مهد الدراسات العربيَّة والإسلاميَّة في أوروبا؛ فقد كان البابوات هم الذين وجّهوا إلى دراسة اللغة العربيّة، ومن هنا صدر القرار البابويّ بإنشاء كراسٍ ستَّة لتعليم اللغة العربيَّة في باريس ونابولي وسالونيكا وغيرها كما تقدَّم، وقد تعاون مجموعة من نصارى الشام مع الكنيسة الكاثوليكيَّة لنشر الديانة الكاثوليكيّة في المشرق، وقد بدأ هذا التعاون باتِّحاد الكنيستَيْن المارونيَّة والكاثوليكيَّة عام 1575م، وقام المارونيُّون بترجمة العديد من كتب اللاهوت إلى اللغة العربيَّة.
ـ وبدأتِ الجامعات الإيطاليَّة تهتمُّ بالدراسات الإسلاميّة؛ فقامتْ جامعة بولونيا سنة 1076م بالاهتمام بالعلوم العربيَّة، وتلتْها جامعة نابولي عام 1224م، ثمَّ جامعات: مسينا، وروما، وفلورنسا، وبادوا، ثمَّ أخيرًا الجامعة الجريجوريَّة التي
اعتنتْ بصورة خاصَّة بالدراسات الإسلاميَّة، ويبدو أنَّ أوَّل إيطاليّ تعلَّم اللغة العربيّة واعتنى بدراستها هو «جيراردودا كريمونا» (Gerardo da Cremona) (1114-1187م)، ومن الإيطاليِّين نجد -أيضًا- توما الإكويني (1225-1274م) الذي اهتمّ بالدراسات الفلسفيَّة، وخاصة الفلسفة العربيَّة؛ إذ قضى جلَّ حياته باحثًا فيها، وساهم في نشر الفلسفة الرشديَّة على الرغم من محاربته إيَّاها.
ـ إنَّ العلاقة بين إيطاليا والشرق قديمة جدًّا؛ وذلك نظرًا إلى قرب إيطاليا جغرافيًّا من بعض البلاد العربيَّة وإفريقيا، وعندما فتح العرب صقلية توطَّدت هذه الصلة بين إيطاليا والعالم الإسلاميّ ثقافيًّا، وخاصَّةً في عهد الملك «روجار الأوَّل» وحفيده «فريدريك الثاني»، حيث كان بلاطهما كعبةً للعلماء والمثقَّفين من البلاد الشرقيَّة كلّها، وكان لوجود الفاتيكان في إيطاليا أثرٌ كبيرٌ في توطيد الصلة بينها وبين البلاد الشرقيَّة؛ نظرًا إلى ما يوليه الفاتيكان من أهمِّيَّة كبيرة جدًّا في التبشير بالدين المسيحيّ، ومحاولة تنصير الشرقيين في كل مكان.
ـ إنَّ أوَّل كتب عربيَّة جرى طبعها في إيطاليا، وبرز أوَّل كتاب عربيّ مطبوع في إيطاليا سنة 1514م، ذلك في فانو (مدينة صغيرة تقع جنوب البندقيَّة)، ويحمل الكتاب اسم «كتاب صلاة السواعي»، والكتاب العربي الثاني نُشر في جنوة سنة 1516م وعنوانه «مزامير عبرانيّ يونانيّ عربيّ قصدانيّ بترجمة لاتينيّ وتفسيرهم». أمَّا القرآن الكريم، فقد طبع لأوَّل مرَّة في البندقيَّة سنة 1518م من طرف بافاناني، وهو مطبعي من مدينة براسيا. ونشرت تسعة كتب ما بين سنتي 1590 و1610م، كانت ذات مواضيع متنوِّعة، منها: «الإنجيل المقدَّس» (كتابان) وكتاب «الأجروميَّة» لابن آجروم، وكتاب «الكافية» لابن الحاجب، وكتاب «القانون الثاني في الطبّ» لابن سينا، وهو من أبرز معالم الطباعة العربيَّة في أوروبا من حيث إخراجه وتقديمه، وكتاب «نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والآفاق» للإدريسيّ، وكتاب في الهندسة «كتاب تحرير أصول
الأوقليدس» ترجمة نصير الدين الطوسيّ. ومن أهمّ المطبوعات التي أشرف عليها المعهد المارونيّ في روما أربعة كتب نحويَّة وكتاب في الفلسفة، نذكر منها: «مبادئ اللغة العربيَّة» سنة 1622م من تأليف المارونيّ نصر الله شالاق، وآخر للمؤلِّف نفسه فيه تقديم للحروف الهجائيَّة العربيَّة، ثمَّ كتابٌ ثالثٌ من عمل تلميذٍ مارونيٍّ هو بطرس المطوشي عام 1624م. أمَّا كتاب الفلسفة، فعنوانه: «مدخل لعلم المنطق» سنة 1625م. وأظهر العالم الإيطاليّ «انطونيو جيجاني» اهتمامًا بتأليف المعجمات، فقد نشر سنة 1632م في مدينة ميلانو معجمًا باللغة العربيَّة واللاتينيَّة في أربعة أجزاءٍ ضخمة، واعتمد فيه على القاموس المحيط للفيروز آبادي اعتمادًا كبيرًا، وبذلك كان له السبق في تعريف الغرب بالمعجمات العربيَّة والاهتمام بها؛ ولذا أطلق المستشرق الإيطاليّ «فرانشيسكو غابريلي» على الاستشراق الإيطاليّ تسمية «الاستعراب»؛ لأنَّه وجه لدراسة اللغة العربيَّة وآدابها وحضارة المسلمين وعلومهم.
قامت نهضة الاستشراق الإيطاليّ الحديث على أعمدةٍ ثلاثة، وذلك في منتصف القرن التاسع عشر وإلى غاية الربع الأوَّل من القرن العشرين حسب «دي غوبرناتي وبريداري» المهتمَّيْن بتاريخ الاستشراق الإيطاليّ، وهذه الشخصيَّات هي:
إغناطيوس (والإيطاليُّون يلفظونها: إينياتسيو جويدي Ignazio Guidi): هو مستشرقٌّ إيطاليّ،ٌ عالمٌ بالعربيّة والحبشيَّة والسريانيَّة. كان «جويدي» يتقن اللغة العربيَّة إتقانًا تامًّا، كما كان على علم بالعامِّيَّة، خصوصًا اللهجة اللبنانيَّة. وهو من
أعضاء المجمع العلميّ العربيّ، وكان شيخ المستشرقين في عصره. ولد في روما، وعهد إليه بتعليم العربيَّة في جامعتها سنة 1885م. ثمَّ كان أستاذًا في الجامعة المصريَّة سنة 1908م يلقي محاضراته بالعربيَّة، واستمرّ بضع سنين. من كتبه العربيَّة: «محاضرات أدبيَّات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب باعتبار علاقتها بأوروبا خصوصًا بإيطاليا» وهي سلسلة من أربعين محاضرة ألقاها في الجامعة المصريَّة، و«جداول كتاب الأغاني» يحتوي على فهارس الشعراء والقوافي والأعلام والأمكنة، وكتاب «المختصر» رسالة في علم اللغة العربيَّة الجنوبيَّة القديمة، ونشر كذلك كتابا «الاستدراك على سيبويه» للزبيدي، و«الأفعال وتصاريفها» لابن القوطيَّة.
الأمير ليونه كايتاني (Leone Caetaniم)ن أبزر المستشرقين الإيطاليِّين، فقد كان يحسن سبع لغات، منها: العربيَّة والفارسيَّة. عمل سفيرًا لبلاده في الولايات المتَّحدة، وزار الكثير من البلدان الشرقيَّة، منها: الهند إيران، مصر، سوريا، ولبنان. من أبرز مؤلَّفاته: كتاب «Islam Annalli dell» وطبع منه خلال (1905-1908م) ثمانية مجلَّدات ضخمة محلَّاة بالرسوم والخرائط المفصَّلة، انتهى فيها إلى سنة 40 للهجرة، ويعدّ كتابه «الحوليَّات» مرجعًا مهمًا لكثيرٍ من المستشرقين. وفي المواقف السياسيَّة، عندما احتلَّت إيطاليا ليبيا سنة 1912م كان من بين المعارضين القلائل في البرلمان الإيطاليّ لهذا الاحتلال.
كارلو ألفونسو نـَلـّينو (Carlo Alfonso Nallino). مستشرق إيطاليّ ولد في تورين في 16 شباط، ونشأ وتلقَّى دروسه الأوَّليَّة ومبادئ العربيَّة والعبريَّة والسريانيَّة في مدينة أوديني، واستكمل دراسته في جامع تورين وفي المعهد الشرقي بنابولي، ثمَّ في بالرماوروما، ودرس في الجامعة المصريَّة القديمة، وانتخب عضوًا في
المجمع العلميّ الإيطاليّ، والمجمع اللغويّ في مصر، والمجمع العلميّ العربيّ في دمشق، وعُيِّن مديًرا لتنظيم المحفوظات العثمانيَّة في وزارة المستعمرات في روما، وتولَّى الإشراف على مجلَّة الدراسات الشرقيَّة، ثمَّ مجلَّة الشرق الحديث، وكلتاهما بالإيطاليَّة. من آثاره: «علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى»، و«تاريخ الآداب العربيَّة من الجاهليَّة حتَّى عصر بني أميَّة».
وقد شملت مؤلَّفاته مختلف فروع الحضارة الإسلاميّة، منذ ما قبل الإسلام وحتّى العصر الحديث، كما اهتمَّ بدراسة العلاقة بين الشرع الإسلاميّ والقانون الرومانيّ، والعلاقة بين القانون الشرقيّ القديم والقانون الشرقيّ المسيحيّ، مضافًا إلى ترجمته شعر ابن الفارض إلى الإيطاليَّة. وقد تُرجم العديد من مؤلَّفاته إلى الفرنسيَّة والإنكليزيَّة.
كان واسع الاهتمام باليمن، وقد وضع دراساتٍ تتعلَّق به، منها ما يتناول الحضارات القديمة المتعاقبة في اليمن، ومنها ما يتعلق باللَّهجاتِ والخطوط العربيَّة فيه، ورُشِّحَ لتدريس تاريخ اليمن في كلِّيَّة الآداب في مصر، ودرَّسَه أربعَ سنواتٍ منذ عام 1927م حتَّى عام 1931م.
وهناك أعلام آخرون في هذه المدرسة، منهم:
- «داڤيد سانتيلانا» (David Santillana) (1855-1931م)
- «بييترو ساڤورنيان دي برازا» (Pietro Paolo Savorgnan di Brazzà)(1852-1905م)
- «فرانشيسكو غابرييلي» (1904-1996م)
- «لورافيشيا فاغليري»، ولهذه المستشرقة مؤلَّفات اتَّسمت بالموضوعية عن الإسلام والنبيّ، منها: دراسة موضوعيَّة عن الإسلام صدرت بالإيطاليَّة، بعنوان:
«دفاع عن الإسلام»، ترجمه إلى العربيَّة «منير البعلبكيّ» صدرت الطبعة الأولى منه عام 1960م، ويضمّ فصولًا سبعة، هي:
1- سرعة انتشار الإسلام
2- بساطة العقيدة الإسلاميَّة
3- معنى الشعائر الإسلاميَّة
4- الأخلاق الإسلاميَّة
5- الحكم الإسلاميّ والحضارة
6- معنى التصوُّف في الإسلام
7- الإسلام وصلته بالعلم
ويمكن إيجاز أهم خصائص هذه المدرسة في الآتي:
بدأتْ لتحقيق أغراض دينيَّة، ثمَّ تطوَّرت لتحقيق أغراض تجاريَّة وسياسيَّة واستعماريَّة.
التركيز على الدراسات العربيَّة والإسلاميَّة.
الاهتمام بجمع المخطوطات العربيَّة النادرة.
تُعدّ المدرسة الاستشراقيَّة الفرنسيَّة من أبرز المدارس الاستشراقيَّة، وأغناها فكرًا، وأخصبها إنتاجًا، وأكثرها وضوحًا؛ ويعود سبب ذلك إلى العلاقات الثنائيَّة التي تربط فرنسا بالعالم العربيّ والإسلاميّ قديمًا وحديثًا، وكانت فرنسا موجودة في معظم علاقات العرب بأوروبا في حالات السلم والحرب، فالعرب وصلوا إلى حدود فرنسا وأخافوها، وكانت فرنسا على علاقةٍ وثيقةٍ بدولة الخلافة العبَّاسيَّة في أيَّام شارلمان والرشيد، وشاركت في الحروب الصليبيَّة، وتطلَّعت إلى احتلال أجزاء من الوطن العربيّ، وغزا نابليون مصر، وأقام علاقاتٍ سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ معها، واحتلَّت فرنسا المغرب العربيّ وسوريا ولبنان.
وقد برزت المدرسة الفرنسيّة بين مدارس الاستشراق، بخاصَّة منذ إنشاء مدرسة اللغات الشرقيَّة الحيَّة عام 1795م التي رأسها المستشرق المشهور «سلفستر دي ساسي»، وكان هذا المستشرق يعدّ عميد الاستشراق الأوروبيّ في النصف الأوَّل من القرن التاسع عشر دون منافس.
ويقول السامرائيّ عن كتاب «ساسي» في قواعد اللغة العربيَّة أنَّه «قد لوَّن الاستشراق الأوروبيّ بصبغةٍ فرنسيَّةٍ»، أمَّا اهتمامات «دي ساسي» فقد تنوَّعت، حيث شملت اللغة العربيَّة وآدابها، والتاريخ، والفرق والجغرافيا، وهي فترة -كما يقول السامرائيّ- افتقدت إلى التخصّص؛ إذ كان المستشرق بمجرَّد دخوله هذا المجال يظنُّ أنَّه يستطيع أن يكتب في كلّ ما يخصّ الإسلام والمسلمين، ولكن هذا النمط استمرَّ كثيرًا بعد هذه الفترة حتَّى يومنا هذا .
أنطوان إسحاق سِلفستر دي ساسي (Antoine Isaac Silvestre de Sacy): لقَّبه البدوي بشيخ المستشرقين الفرنسيِّين، ولد في باريس عام 1758م، وتعلَّم اللاتينيَّة واليونانيَّة، ثمَّ درس على بعض القساوسة، منهم: القسّ مور، والأب بارتارو، ثمَّ درس العربيَّة والفارسيَّة والتركيَّة. عمل في نشر المخطوطات الشرقيَّة في مكتبة باريس الوطنيَّة، وكتب العديد من البحوث حول العرب وآدابهم وحقَّق عددًا من المخطوطات.
عُيِّن أستاذًا للُّغة العربيّة في مدرسة اللغات الشرقيّة الحيَّة عام 1795م، وأعدَّ كتابًا في النحو تُرجم إلى الإنكليزيَّة والألمانيَّة والدنماركيَّة، وأصبح مديرًا لهذه المدرسة عام 1833م، وعندما تأسَّست الجمعيَّة الآسيويَّة انتُخب رئيسًا لها عام 1822م. ومن أبرز اهتماماته «الدروز»، حيث ألَّف كتابًا حولهم في جزأين، أصبحت فرنسا في عهده قبلة المستشرقين من جميع أنحاء القارَّة الأوروبيَّة، ويقول أحد الباحثين -في هذا الصدد- إنَّ الاستشراق اصطبغ بالصبغة الفرنسيَّة في عصره. عمل «دي ساسي» مع الحكومة الفرنسيَّة، وهو الذي ترجم البيانات التي نُشرت عند احتلال الجزائر، وكذلك عند احتلال مصر من قبل حملة نابليون عام 1797م.
1- تحقيق «مقامات الحريري»، وقد طبعها أوَّل مرَّة على حسابه الخاصّ في المطبعة الإمبراطوريَّة عام (1812م)، وزوَّدها بشرحٍ باللغة العربيَّة
2- ترجم إلى اللغة الفرنسيَّة كتاب «الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثار» لموفَّق الدين عبد اللطيف البغداديّ
3- تحقيق «كليلة ودمنة» عام (1816م)
4- تحقيق «بند نامه» وترجمته إلى اللغة الفرنسيَّة، عام (1819م)
5- ترجمة فصول من كتاب «روضة الصفاء»، تأليف «ميرخاوند بن برهان الدين خاوند شاه»
6- «قانون الملكيَّة في مصر منذ الغزو العربيّ 1805-1818م»
7- «أنطولوجيا النحو» (1829م)
8- «عقيدة الدروز» (جزءان) (1838م)
9- «مختارات أدبيَّة عربيَّة» (1806م)
10- «مذكَّرات حول تاريخ العرب قبل محمَّد» (1785م)
11- «تاريخ الآثار القديمة في بلاد فارس» (1793م)
12- «مبادئ اللغة العربيَّة» (1799م)
13- «النحو العربيّ في مدرسة اللغات الشرقيَّة الحيَّة» (1810م)
14- «مذكَّرات عن جبال كرمنشاه» (1815م)
15- «مذكَّرات حول تاريخ الأدب الشرقيّ» (1818م)
ولد في مقاطعة (بريتاني) في فرنسا، ووهب جلَّ اهتمامه للبحث العلميّ العقليّ الذي تركه أتباع محمَّد. لقد وضع «أرنست رينان» كتابًا عن العملاق «ابن رشد»، وكيف أثَّرت فيه فلسفته، حتى لُقِّب هو وأتباعه بأبناءِ المدرسة الرشديَّة، وهذه المدرسة هي حقيقة واقعة، وقد انقسمت إلى قسمين، القسم الأوَّل: المدرسة
الرشديَّة اللاتينيَّة، وحمل القسم الثاني لقب المدرسة الرشديَّة العبريَّة، بينما بقي «ابن رشد» أستاذًا للجميع على مختلف مللِهم ونِحَلهم ومختلف عقائدهم.
اشتهر بترجمته ليسوع التي دعا فيها إلى نقد المصادر الدينيّة نقدًا تاريخيًّا علميًّا، وإلى التمييز بين العناصر التاريخيَّة والعناصر الأسطوريَّة الموجودة في الكتاب المقدَّس. الأمر الذي أثار كاثوليكيَّة ضده.
وعرف عن رينان نطرته القوميَّة والعرقيَّة والتراتبيَّة في الأعراق؛ فهو القائل: «خَلَقت الطبيعة عرقًا من العمَّال. هو العرق الصينيّ المتَّصف بشطارة يده العجيبة، وبخلوه من عزّ النفس. احكموه بالعدل آخذين منها مقابل نعمة هذه السياسة أجرًا كبيرًا لصالح العرق المظفر يرضَ. ثم عرقًا من الفلاحين: الزنج. عاملوه بالمعروف والإنسانيَّة يستتبُّ النظام. ثمَّ عرقًا من الأسياد والجنود: الأوروبيِّين. ليعمل كلّ واحد ما خُلق من أجله يستقِمِ الأمر».
أمَّا نظرته عن الدين الإسلاميّ فتتَّصف بالعصبيَّة واللاموضوعيَّة، فيعبِّر في طيَّات ترجمته ليسوع وأعماله الأخرى عن احتقاره للإسلام، فيقول: «الإسلام هو تعصُّب لم تكد تعرف مثيله إسبانيا في زمان فيليلبي الثاني، أو إيطاليا في زمان بي الخامس. الإسلام هو الاستخفاف بالعلم، هو إزالة المجتمع المدنّي. هو بساطة العقل الساميّ الفظيعة التي تقلِّص دماغ الانسان وتغلقه دون أيَّة فكرة لطيفة ودون كلِّ إحساسٍ رقيقٍ، ثمَّ دون كلّ بحثٍ عقلانيّ ليواجهه بالتحصيل الحاصل الأزلي: الإله هو الإله».
أتقن رينان اللغة العبريَّة، أمَّا العربيَّة فلم يتقنها. ويعزو هو السبب في ذلك إلى كون أستاذه في اللغات الساميَّة في معهد سان سلپيس لم يكن ضليعًا في العربيَّة.
لم تقلِّل قلَّة بضاعته في اللغة العربيَّة من اهتمامه بالثقافة العربيَّة والموضوعات الإسلاميّة، بل حرص على متابعة ما يصدر من كتبٍ ودراساتٍ في هذا الميدان، وراح
(91)يكتب مرارًا عن هذه الكتب في مقالات إضافيَّة. ونورد فما يأتي ثبتًا بهذه المقالات:
1- «مقامات الحريري»، سنة 1853م (مجموع مؤلَّفاته ج 2 ص 199 ـ 208) ـ وهي دراسة كتبها بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتاب «مقامات الحريري»، وكانت الطبعة الأولى قد أصدرها «دي ساسي» في سنة 1822م، وتشمل النصّ العربيّ وشرحًا عليه، فأشرف على هذه الطبعة الثانية وزوَّدها بتعليقاتٍ بالفرنسيَّة «رينو» (Renaud) و«دارنبور» (Derenbourg) سنة 1853م، ونُشرت هذه الدراسة في (Journal des Dèbats) بتاريخ 8 يونيو من عام 1853م.
2- «إسبانيا الإسلاميَّة»، سنة 1853 (مجموع مؤلَّفاته ج 2 ص 520 ـ 529) وهي دراسة عن كتاب دوزي: «أبحاث في التاريخ السياسيّ والأدبيّ لإسبانيا خلال العصور الوسطى، (ط1، ليدن سنة 1849م). وقد نَشَرَ هذه الدراسة في (Journal des Debates) بتاريخ 31 أغسطس من عام 1853م.
3- «ابن بطوطة»، سنة 1853م (مجموع مؤلَّفاته ج 2 ص530 ـ 539)، وهي دراسة كتبها بمناسبة صدور الجزء الأوَّل من تحقيق النصّ العربيّ مع الترجمة الفرنسيَّة لرحلة ابن بطوطة على يد (C.Defrèmery) والطبيب (B-R. San guinetti، سنة 1853م. وقد نشر هذه الدراسة في
(Journal des Dèbates) بتاريخ 14 ديسمبر من عام 1853م.
4- «مروج الذهب للمسعودي»، سنة 1873م (مجموع مؤلَّفاته، ج 2 ص 502 ـ 519)، وهي دراسة بمناسبة ظهور الجزء الرابع من تحقيق «باربييه دي مينار» وترجمته لكتاب «مروج الذهب» للمسعوديّ. وقد نشر هذه الدراسة في (Journal des Dèbats) بتاريخ 1، 2 أكتوبر من عام 1873م.
ترجع شهرة رينان في البلاد العربيَّة منذ سنة 1883م حتَّى اليوم إلى محاضرةٍ ألقاها في السوربون بتاريخ 29 مارس سنة 1883م، عنوانها: «الإسلام والعلم»،
ونشرت في (Journal des Dèbats) بتاريخ 30 مارس 1883م. وقد ردَّ عليها السيِّد جمال الدين الأفغانيّ -وكان آنذاك في باريس، بينما كان الشيخ محمَّد عبده في بيروت- بمقالٍ نُشر في عدد 18 مايو سنة 1883م في الجريدة نفسها. وفي اليوم التالي أجاب «رينان» على هذا الردّ في الجريدة نفسها -أيضًا- بتاريخ 19 مايو.
ونبدأ بذكر الآراء الرئيسة في محاضرة «رينان»، خصوصًا المثيرة للجدل:
أ. ما يسمَّى بالعلم عند العرب ليس فيه من العروبة إلَّا الاسم
ب. الإسلام اضطهد دائمًا «العلم والفلسفة»
جـ. «الأحرار الذين يدافعون عن الإسلام لا يعرفون الإسلام. إنَّ الإسلام هو التوحيد غير المميّز بين ما هو روحيّ وما هو دنيويّ، إنَّه سيطرة عقيدة، وهو أثقل قيد حملته الإنسانيَّة. وفي النصف الأوَّل من العصور الوسطى احتمل الإسلام الفلسفة؛ لأنَّه لم يستطع منعها؛ وهو لم يستطع منعها، لأنَّه كان غير متماسك، ولم تكن لديه الأداة الكافية للإرهاب. فالشرطة كما قلت كانت في أيدي النصارى، وكانت مهمّتها الرئيسة هي مطاردة محاولات شيعة علي».
إنَّ المفاخرة بالإسلام بسبب ابن سينا، وابن زهر، وابن رشد هي مثلما نفاخر بالكاثوليكيَّة بسبب جالليو ـ يعني أنَّه لا فضل للإسلام على ابن سينا وابن زهر وابن رشد، كما لا فضل للكاثوليكيَّة على جالليو.
إنَّ ما يأخذه «رينان» على الإسلام هو أنَّه «اضطهد الفكر الحرّ؛ ولا أقول إنَّه فعل ذلك على نحوٍ أشدّ وطأة من سائر المذاهب الدينيَّة، وإنَّما لأنَّ ذلك كان على نحوٍ أكثر فعاليَّة. لقد جعل من البلاد التي فتحها ميدانًا مغلقًا دون الثقافة الفعليَّة للروح».
وآخر بحثٍ كتبه «رينان» في ميدان الدراسات الإسلاميّة هو مقال كتبه بمناسبة بحث كتبه ألسندرو دانكونا (Alessandro d’Ancona)، بعنوان: «أسطورة محمَّد في الغرب» ونشر في (Giora – ale storico della letteratura italiana).
وفي أثناء عرض «رينان» لمحتويات البحث أبدى آراءه الخاصَّة في سيرة النبيّ محمَّد، وشخصيَّة الراهب بحيرا، والعناصر التي أثّرت في تكوين «أسطورة» عن النبيّ محمَّد صلىاللهعليهوآله في أوروبا في العصور الوسطى وما تلاها.
ولد في باريس وحصل على دبلوم الدراسات العليا في بحثٍ عن المغرب، كما حصل على دبلوم اللغة العربيَّة من مدرسة اللغات الشرقيّة الحيَّة (فصحى وعامِّيَّة)، زار كلًّا من الجزائر والمغرب، وفي الجزائر انعقدت الصلة بينه وبين بعض كبار المستشرقين، مثل: جولدزيهر، وآسين، بلاثيوس، وسنوك هورخرونيه، ولي شاتيليه.
التحق بالمعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة في القاهرة أعوامًا عدَّة (1907م-1908م) وفي عام 1909م عاد إلى مصر وهناك حضر بعض دروس الأزهر وكان مرتديًا الزي الأزهريّ، زار العديد من البلاد الإسلاميَّة، منها: الحجاز، والقاهرة، والقدس، ولبنان، وتركيا. عمل معيدًا في كرسي الاجتماع الإسلاميّ في معهد فرنسا (1919م-1924م) وأصبح أستاذًا لهذا الكرسي (1926م-1954م) ومديرًا للدراسات في المدرسة العلميّة العليا حتَّى تقاعده عام 1954م.
لقد اشتهر «ماسنيون» باهتمامه بالتصوُّف الإسلاميّ، وبخاصة بالحلَّاج؛ حيث حقّق ديوان الحلاج (الطواسين) وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان (آلام الحلَّاج شهيد التصوُّف) في جزأين، وقد نشرت في كتاب تزيد صفحاته على ألف صفحة، وقد تُرجم الكتاب إلى اللغة الانكليزيَّة، وله اهتمامٌ -أيضًا- بالشيعة والتشيُّع، وعُرف عن «لويس» صلته بالحكومة الفرنسيَّة وتقديمه المشورة لها.
بلغت مؤلَّفات «ماسينيون» أكثر من مئتي كتاب ومقالة، يُذكر منها: «عالم الإسلام» (1912-1913م) و«الكنيسة الكاثوليكيَّة والإسلام» (1915م)، و«الإسلام والاتِّحاد السوڤييتيّ» (1917- 1927م)، ومن مقالاته: «تاريخ العقائد الفلسفيَّة
العربيَّة في جامعة القاهرة» (1912-1921م)، و«الدراسات الإسلاميَّة في إسبانيا» (1918-1936م)، و«أصول عقيدة الوهابيَّة وفهرس بمصنَّفات مؤسِّسها» (1918- 1936م)، و«أساليب تطبيق الفنون لدى شعوب الإسلام» (1921م) صدرت كلّها في مجلَّة «العالم الإسلاميّ». كما كتب «حال الإسلام اليوم» مجلَّة «باريس» (1929م)، و«أثر الإسلام في تأسيس المصارف اليهوديَّة وحركتها في العصر الوسيط» في مجلَّة «الدراسات الشرقيّة» (1931م). وفي مجلَّة «تاريخ علم الأخلاق» كتب «أسباب وأساليب الدعوة الإسلاميَّة بين شعوب إفـريقيا الوثنيَّة» (1938م)، و«التصوُّف الإسلاميّ والتصوُّف المسيحيّ في العصر الوسيط» (1956م). وتحدَّث عن مكانة الثقافة العربيَّة في الحضارة العالميَّة في مؤتمر الأونيسكو - بيروت (1948م)، ونشر له المعهد الفرنسيّ في القاهرة عام (1952م) «فلسفة ابن سينا وألفباؤه الفلسفيَّة».
وقد تخرَّجت على يديه أجيال من المستشرقين والمفكِّرين العرب -أيضًا-، أمثال: عبد الرحمن بدوي، والشيخ عبد الحليم محمود الذي أصبح في ما بعد شيخ الأزهر، والمستشرق الكبير ذي الأصل اللبنانيّ جورج مقدسي.
ولد في باريس وتلقَّى التعليم الثانوي في الدار البيضاء، وتخرَّج باللغة العربيَّة من كلِّيَّة الآداب بالجزائر، تولَّى العديد من المناصب العلميَّة، منها: أستاذ اللغة العربيَّة في معهد مولاي يوسف بالرباط، ومدير معهد الدراسات المغربيَّة العليا (1924م-1935م)، وأستاذ كرسي الأدب العربيّ في مدرسة اللغات الشرقيّة الحيَّة في باريس وأستاذًا محاضرًا في السوريون، ثمَّ مدير مدرسة الدراسات العليا والعلميّة، ثم أستاذ اللغة العربيّة وحضارتها في باريس.
اهتمّ «ريجيس بلاشير» بمسائل عدّة في الثقافة العربيَّة الإسلاميَّة وكتب فيها، ولعلّ أهمّها الأدب العربيّ قديمه وحديثه، وخاصَّة تراث أبي الطيِّب المتنبّي الذي حظي بنصيبٍ وافرٍ من كتاباته وأبحاثه، وكذلك تاريخ العلوم عند العرب، وله -أيضًا- عددٌ من الدراسات الدينيَّة لعلَّ أهمَّها ترجمته للقرآن وفق نزول السور والآيات في مرحلةٍ أولى، ثمَّ وفق
الترتيب الشائع للمصحف مع محاولاتٍ بسيطة في التفسير. هذا مضافًا إلى مؤلَّفه «معضلة محمَّد» الذي جمع فيه بإيجاز مجمل أبحاث المستشرقين في السيرة النبويَّة.
لم يسعفه الأجل في استكمال مشروعٍ ضخمٍ باشر التأليف فيه، يتعلَّق بـ«تاريخ الأدب العربيّ» فلم ينجز منه إلَّا ثلاثة أجزاء توقَّفت عند حدود سنة 125هـ، وكان المؤمّل إنجاز مسحٍ يبلغ القرن التاسع للهجرة.
وقد كان ضليعًا في اللغة والآداب العربيَّة من جهة وفي الدراسات القرآنيَّة والإسلاميَّة من جهةٍ أخرى. وقد تخرَّجت على يديه -أيضًا- كوكبةٌ من الباحثين المسلمين والأجانب ليس أقلّهم «أندريه ميكل» و«محمَّد أركون». ومعلوم أنَّه ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيَّة، وقدَّم عنه عدَّة دراسات تاريخيَّة مهمَّة.
ومن أبرز إنتاجه ترجمته لمعاني القرآن الكريم، وكذلك كتابه «تاريخ الأدب العربيّ» في جزأين، وترجمه إلى العربيَّة: إبراهيم الكيلاني، وله -أيضًا- كتاب، بعنوان: «أبو الطيِّب المتنبِّي: دراسة في التاريخ الأدبيّ.»
ولد في باريس في 26 يناير 1915م، وحصل على الدكتوراه في الآداب، ثمَّ على شهادةٍ من المدرسة الوطنيَّة للُّغات الشرقيّة الحيَّة والمدرسة العلميَّة العليا، تولَّى العديد من المناصب العلميَّة في كلٍّ من سوريا ولبنان في المعاهد التابعة للحكومة الفرنسيَّة هناك، تولَّى منصب مدير الدراسات في المدرسة العلميَّة للدراسات العليا قسم العلوم التاريخيَّة واللغويَّة، ثمَّ محاضرًا في قسم العلوم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، نال العديد من الأوسمة والجوائز من الجهات العلميَّة الفرنسيَّة والأوروبيَّة.
مع أنَّ «رودنسون» من أصولٍ يهوديَّة دينيَّة، ولكنَّه أصبح معروفًا في فرنسا عندما أظهر معارضةً حادَّة، تتناول إسرائيل، وقد عارض على وجه الخصوص سياسة الاستيطان
للدولة اليهوديَّة. وفي الوقت نفسه اتَّهمه البعض بالارتباط «بالفاشيَّة الإسلاميَّة» (le fascisme islamique) في 1979م، التى اعتاد أن يصفها بالثورة الإيرانيَّة.
له العديد من المؤلَّفات، منها: كتابه الذي ترجم إلى العديد من لغات العالم عن النبيّ العربيّ «محمد»، الذي صدر عام 1961م… ثمَّ في أواخر الستينات، كتاب «الإسلام والرأسماليَّة» وكتاب «إسرائيل والرفض العربيّ: 75 عامًا من التاريخ»، ثمَّ كتاب «الماركسية والعالم الإسلاميّ» في العام 1972م، وكتاب «العرب» في إحدى موسوعات دور النشر الفرنسيَّة في العام 1979م… وبعد الثورة الإيرانيَّة كتاب «جاذبيَّة الإسلام» عام 1980م، وكتاب «شعب يهوديّ أم مسألة يهوديَّة؟» في العام 1981م، و«الإسلام: سياسة وعقيدة» عام 1993م، و«من پيثاغورس إلى لينين» في العام ذاته، وكتب ومقالات عديدة أخرى أصدرها أو كانت نتاج حوارٍ طويلٍ معه، ككتاب «بين الإسلام والغرب» عام 1998م.
ويتميَّز «رودنسون» عن غيره بتطبيق المنهجيَّة السوسيولوجيَّة على تاريخ الإسلام والمجتمعات الإسلاميَّة. فهو لا يكتفي بالمنهجيَّة التاريخيَّة الفللوجيَّة أو اللغويَّة كما يفعل الاستشراق الكلاسيكيّ منذ القرن التاسع عشر. وإنَّما يضيف إليها منهجيَّات علم الاجتماع وتاريخ الأديان المقارن، بل وحتَّى التحليل النفسيّ.
وهناك العديد من المستشرقين الفرنسيِّين البارزين، مثل: «هنري لاؤوست»، و«كلود كاهن»، و«شارل بيلا»، والأب البلجيكيّ الأصل الفرنسيّ الجنسيَّة
الأب «لامانس»، و«أندريه ريموند»، و«روبير مانتران»، وغيرهم.
1. تتركَّز دراساته حول محاور ثلاثة، هي:
أ. المحور الدينيّ
ب. المحور السياسيّ
ت. المحور الاستعماريّ
2. يعتبر معهد اللغات الشرقيَّة الذي أسّس سنة 1195م أهم مكان ترعرع فيه الاستشراق الفرنسيّ.
3. أسَّس كثيرًا من المعاهد والمدارس الثقافيَّة في بلاد الشرق التي كان لها تأثير كبير في فرنسة عددٍ من هذه البلاد، خاصَّة التي استعمرت من قبل فرنسا.
4. يمتاز الاستشراق بالتخصُّص، أي إنَّ معظم أفراده تخصَّص كلٌّ منهم في جانبٍ معيَّن من جوانب البحث والدراسة.
قد يكون من الأفضل تسمية هذه المدرسة بالاستشراق الإنكليزيّ؛ لأنَّ الاستشراق البريطانيّ يتداخل مع: الاستشراق الإنكليزيّ، واستشراق المملكة المتَّحدة، واستشراق الدول الناطقة باللغة الإنكليزيَّة، وربَّما الكمنولث. وعلى أيّ حال، فقد اهتمَّ الاستشراق البريطانيّ بدراسةِ العقائد الإسلاميَّة والدين الإسلاميّ.
وللاستشراق الإنكليزيّ بعض الخصائص التي تختلف في طبيعتها ووظيفتها عن باقي المدارس الاستشراقيَّة كالفرنسيَّة، وقد تقدَّم في الأبحاث السابقة بيان العلاقة بين الاستعمار والاستشراق، فالإمبراطوريَّة البريطانيَّة الاستعماريَّة تختلف في التعامل مع ثقافات المستعمرات عن الاستعمار الفرنسيّ مثلًا، فالاستعمار الفرنسيّ الاستيطانيّ يقوم على اقتلاع أشجار الثقافة في المستعمرات، أمَّا الاستعمار الإنكليزيّ فيُفضِّل تعطيش تلك الأشجار أو تسميمها، والمقارنةُ ظاهرةٌ بين ما حدث في الجزائر أيْ الاستعمار الفرنسيّ مثلًا، وما حدث في الهند من الاستعمار الإنكليزيّ.
الطابع الإمبراطوريّ والانتشار الواسع، مضافًا إلى الاستفادة من التطوُّر العلميّ المادِّيّ والفكريّ، سمح كلّ ذلك للمستشرقين البريطانيِّين من الوصول إلى مناطق نائيةٍ ومتنوِّعةٍ كثيرة ساهمت في صبغ المدرسة الاستشراقيَّة البريطانيَّة بالتوسُّع والتنوُّع الأفقيّ بالانتشار الجغرافيّ والعموديّ في تنوّع الموضوعات.
الطابع المؤسَّساتي للاستشراق البريطانيّ وارتباطه بمصالح الدولة السياسيَّة والاقتصاديَّة خاصيَّة واضحة في مراحل تاريخ الاستشراق البريطانيّ؛ فبعض الدراسات تُرجع احتكاك بريطانيا بالتراث الشرقيّ إلى William BEDWELL (1561-1632م)، وهو خرِّيج جامعة كامبريدج، ومهتمّ باللغة العربيَّة طالًبا وأستاذًا، كما
أسهم السير (Thomas ADAMS) في تأسيس كرسي الدراسات العربيَّة في جامعة كمبريدج.
الطابع الإمبراطوريّ -أيضًا- ساهم في الرحلات المحميَّة إلى مختلف المناطق الغنيَّة بتاريخها الحافل، ولكن -أيضًا- بهجرة أبناء المستعمرات إلى مركز المتربول، فاستفادت المراكز البحثيَّة منهم باعتبارهم باحثين مجتهدين كما كُلِّفوا من المراكز نفسها بدراسة مناطقهم وفق المناهج العلميَّة وضمن سياسة تراكميَّة للبحوث تلتزم بها الهيئات العلميَّة الرصينة.
وكان التركيز على المناطق الآتية: مصر، الجزيرة العربيَّة، بلاد الشام، العراق، تركيا، إيران، وشبه القارَّة الهنديَّة. وكلّ هذه المناطق كانت لها حضارات مشهودة قبل الإسلام وبعده، وهذا ما يفتح شهيَّة المستشرقين للدراسات المقارنة والتأصيليَّة وفق نظرتهم لتعدُّديَّة المصادر الدينيَّة والثقافيَّة.
مستشرق إنكليزيّ، ينعته الإنكليز بأبي الدراسات العربيَّة، ويعدّه الأوروبيُّون من «المستعربين». كان يقول عن العربية «إنَّها لغة الدين الفريدة، إنَّها أعظم لغة للسياسة، من الجزائر السعيدة إلى بحر الصين». وهو أوَّل من نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيَّة. له «معجم عربيّ» في مجلَّدات سبعة، قال الدكتور «برنارد لويس» عنه: «لم يُنشر لسوء الحظّ». وبين مؤلَّفاته المطبوعة في إنكلترا: «نصوص عربيّة»، و«معجم للمفردات العربيَّة المستعملة في اللغات الغربيَّة من العصر البيزنطيّ إلى أيَّامه».
مستشرق إنكليزيّ، كان يحترف المحاماة. تعلَّم العربيَّة، وحصل على مجموعةٍ
وافرة من مخطوطاتها، وعُني بتاريخ الإسلام حتَّى ُوصف بأنَّه نصف مسلم! له بالإنكليزيَّة (ترجمة القرآن) وهو أوَّل من حاول ترجمته إلى هذه اللغة كاملًا.
ولد في لندن، التحق في البداية بالتعليم اللاهوتيّ، تعلَّم العربيَّة على يد معلِّمٍ من سوريا، وكان يتقن اللغة العبريَّة أيضًا، من أبرز أعماله ترجمته لمعاني القرآن الكريم التي قدَّم لها بمقدَّمةٍ احتوت على كثيرٍ من الافتراءات والشبهات، يقول عنها عبد الرحمن بدوي: «ترجمة سيل واضحة ومحكمة معًا، ولهذا راجت رواجًا عظيمًا طوال القرن الثامن عشر؛ إذ عنها تُرجم القرآن إلى الألمانيَّة عام 1746م»، ويقول في موضعٍ آخر: «وكان سيل منصفًا للإسلام بريئًا -رغم تديُّنه المسيحيّ- من تعصُّب المبشِّرين المسيحيِّين وأحكامهم السابقة الزائفة».
وهناك ملاحظات كثيرة على ترجمته للقرآن، ما يجعل الباحث يطمئنُّ بوجود تعمُّدٍ لتحريف الترجمة، وهناك شواهد عدَّة على ذلك، سنأتي على ذكرها في مبحث ترجمة القرآن الكريم.
إنكليزيّ يهوديّ، من كبار المستشرقين، متعصِّب ضدَّ الإسلام، عُيِّن أستاذًا للعربيَّة في جامعة أكسفورد.
بدأ حياته العلميَّة بدراسة اليونانيَّة واللاتينيَّة، ثمَّ اهتمَّ بدراسة اللغات الساميَّة، فتعلَّم العربيَّة، ومن أشهر مؤلَّفاته ما كتبه في السيرة النبويَّة، وكتابه عن الإسلام، وكتابه عن العلاقات بين العرب واليهود، منها: «التطوُّرات المبكرة في الإسلام»، و«محمَّد ومطلع الإسلام»، و«الجامعة الإسلاميَّة» وغير ذلك.
ولكنَّ هذه الكتابات اتَّسمت بالتعصُّب والتحيُّز والبعد الشديد عن الموضوعيَّة كما وصفها عبد الرحمن بدوي، ولكن يُحسب له اهتمامه بالتراث العربيّ كنشره
لكتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي، ورسائل أبي العلاء المعرّي، وغير ذلك من الأبحاث .وقد أهداه أحمد شوقي قصيدة النيل.
ولد في Devenport (إنكلترا) في 19 أبريل عام 1864م. تعلَّم أوَّلًا في مدرسة بلايموث Plymouth الثانويَّة، ومن ثمَّ انتقل في سنة 1880م للدراسة في مدرسة مدينة لندن City of London School ، ثمَّ التحق بكلِّيَّة المجدليَّة في جامعة كمبردج في سنة 1882م، حيث اجتذبته الدراسات الشرقيَّة تحت تأثير «إدوارد بيلس كورل» (Ed. Byles Courell) و«وليم روبرتسون اسمث» (William Robertson Smith)، وبعد أن أنجز بنجاحٍ دراسته في الكلاسيكيَّات أمضى السنة الرابعة في كمبردج -أيضًا- متوفرًا على دراسة تاريخ الإسلام.
ونظرًا إلى اهتمامه بالدراسات الإسلاميَّة، فقد اختير لتدريس الفلسفة في كلِّيَّة عليكَره الإسلاميَّة في المقاطعات المتَّحدة بشمالي الهند. وأمضى في كلِّيَّة عليكَره عشر سنوات (1888-1898م)، وهي فترة كانت ذات تأثيرٍ بالغٍ في تشكيل نظرات «توماس آرنولد» للإسلام.
ألَّف أوَّل كتبه المهمَّة، وهو كتاب: «الدعوة الإسلاميَّة (The Preaching of Islam)» (سنة 1896م).
كان لانشغال «آرنولد» بالأعمال الإداريَّة أثرٌ في قلَّة إنتاجه العلميّ، حتى أنَّ كتابه «الدعوة الإسلاميّة» ظلَّ حتَّى سنة 1920م -أيْ وهو في السادسة والخمسين من عمره- الإنتاج العلميّ الوحيد ذا القيمة. وقد أعيد طبعه في سنة 1913م في طبعة موسَّعة ومنقَّحة، وتُرجم إلى اللغتين الأورديَّة والتركيَّة، كما تُرجم في الأربعينات إلى اللغة العربيَّة.
وألَّف -وهو لا يزال في الهند- كُتيِّبًا صغيرًا عن «المعتزلة» (The Mu’tazilah) (سنة 1902م) ليس بذي قيمةٍ علميَّةٍ تذكر.
وبمناسبة زوال الخلافة في سنة 1924م، ألَّف توماس آرنولد كتابًا بعنوان: «الخلافة» (The Caliphate) تتبَّع فيه تاريخ منصب الخلافة في الإسلام منذ الخلفاء الراشدين حتَّى إلغاء الخلافة سنة 1924م على يد كمال أتاتورك. وعقَّب ذلك بتلخيصٍ لهذا الكتاب في كُتيِّب صغير جدًّا، بعنوان: «الدين الإسلاميّ» (The Islamic Faith) (سنة 1928م) قصد به إلى الجمهور.
وكتب مادَّتَي: «الاضطهاد» و«التَّسامح» في الإسلام، وذلك في «موسوعة الدين والأخلاق». وأدَّى به ذلك إلى التفكير في كتابة كتاب موسَّع عن التسامح في الإسلام؛ لكنَّه لم يُنجز هذا المشروع.
وكتب مقالاتٍ عدَّة تتعلَّق خصوصًا بالهند الإسلاميَّة في «دائرة المعارف الإسلاميَّة» التي صار هو من هيئة مصدِّري الطبعة الإنكليزيَّة لها ابتداءً من سنة 1910م.
ولد «هاملتون جيب» في الإسكندريَّة في 2 يناير 1895م، انتقل إلى إسكتلندا وهو في الخامسة من عمره للدراسة هناك؛ ولكنَّه كان يمضي الصيف مع والدته في الإسكندريَّة. التحق بجامعة أدنبرة لدراسة اللغات الساميَّة، عمل محاضرًا في مدرسة الدراسات الشرقيّة والإفريقيَّة في جامعة لندن عام 1921م، وتدرَّج في المناصب الأكاديميَّة حتَّى أصبح أستاذًا للُّغة العربيَّة عام 1937م، وانتُخب لشغل منصب كرسيّ اللغة العربيَّة في جامعة أكسفورد. انتقل إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة؛ ليعمل مديرًا لمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد بعد أن عمل أستاذًا للُّغة العربيَّة في الجامعة.
مضافًا إلى اهتمامه اللغويّ، فقد أضاف إلى ذلك الاهتمام بتاريخ الإسلام وانتشاره، وقد تأثَّر بمستشرقين كبار من أمثال «توماس آرنولد» وغيره.
من أبزر إنتاج «جيب» كتاب «الفتوحات الإسلاميّة في آسيا الوسطى» (1933م)، ودراسات في الأدب العربيّ المعاصر، وكتاب «الاتِّجاهات الحديثة في الإسلام». كما وشارك في تأليف «إلى أين يتَّجه الإسلام»، وقد انتقل «جيب» من دراسة اللغة والآداب والتاريخ إلى دراسة العالم الإسلاميّ المعاصر، وهو ما التفت إليه الاستشراق الأمريكيّ حينما أنشأ الدراسات الإقليميَّة أو دراسات المناطق، وله كتاب بعنوان: «المحمَّديَّة»، وقد أعاد نشره بعنوان: «الإسلام»، وله كتابٌ عن الرسول صلىاللهعليهوآله.
ـ إنَّ الأسلوب الذي اتَّبعه في كتبه يعتمد على إثارة الأسئلة أكثر من اعتماده على عرض الموضوعات،كما في كتابه «الإسلام إلى أين؟» على سبيل المثال.
ـ تميَّز «هاملتون جيب» باطِّلاعه العميق على أوضاع العالم العربيّ، بفضل إتقانه اللغة العربيَّة ومعرفته بالثقافة الإسلاميَّة، قد عبّر عن مخاوفه منذ ثلاثينيَّات القرن الماضي من موجة التغريب التي تهدِّد المجتمعات الإسلاميَّة.
ـ يرى في كتابه «دعوة تجديد الإسلام» أنَّ إغلاق باب الاجتهاد أدَّى إلى وضع حدٍّ فعالٍ للفعاليَّة والحركيَّة في الإسلام.
لا يرى السير «هاملتون» صحَّة فصل الإسلام عن قضايا المجتمع والسياسة والاقتصاد؛ لأنَّ الإسلام في نظره دينٌ متكاملٌ في رؤيته للحياة.
طبعًا، هناك ملاحظات كثيرة على آراء «هاملتون»؛ فالمقارنات التي طرحها تستهدف شيئًا رئيسًا، وهو تصوير الرسول على أنَّه مصلحٌ اجتماعيٌّ عكس ضرورات البيئة العربيَّة في مكَّة. ويقول جيب: «إنَّه نجح لكونه أحد المكِّيّين» بمعنى أنَّه عبَّر عن الحاجيَّات المحلِّيَّة، وقد ذهب في كتابه: «المذهب المحمَّديّ» إلى أنَّ محمَّدًا
صنعته بيئته الخاصَّة بمركزها الثقافيّ والدينيّ والتجاريّ، وبحكم مركزها من العالم وصلتها بأرقى شعوبه. وقد وصف النبيّ بأنَّه شخصيَّة مبدعة، قد تأثَّرت بضرورات الظروف الخارجيَّة المحيطة بها.
ولد في كريس فايف في 14مارس 1909م، والده القسِّيس «اندرووات»، درس في كلٍّ من أكاديميَّة لارخ (1914-1919م)، وفي كلِّيَّة جورج واتسون في أدنبرة، وجامعة أدنبرة (1927م-1930م)، وكلِّيَّة باليول في أكسفورد (1930م-1933م)، وجامعة جينا في ألمانيا (1933م)، وجامعة أكسفورد، وجامعة أدنبرة في الفترة من (1938م إلى1939م) ومن (1940م إلى 1943م) على التوالي، عمل راعيًا لكنائس عدَّة في لندن وفي أدنبرة. تخصَّص في الإسلام لدى القسّ الإنجليكانيّ في القدس، وبعد تقاعده عاد إلى العمل في المناصب الدينيّة.
عمل رئيسًا لقسم اللغة العربيَّة والدراسات الإسلاميَّة في جامعة أدنبرة في الفترة (1947-1979م). نال درجة الأستاذيَّة عام 1964م. دُعي للعمل أستاذًا زائرًا في كلٍّ من الجامعات الآتية: جامعة تورنتو (1963و1978م)، وكلِّيَّة فرنسا في باريس (عام 1970م)، وجامعة جورجتاون في واشنطن (عام 1978-1979م).
أصدر العديد من المؤلَّفات، من أشهرها: «محمَّد في مكَّة»، «محمَّد في المدينة»، «محمَّد نبيّ ورجل دولة»، «الفلسفة الإسلاميَّة والعقيدة»، «الفكر السياسيّ الإسلاميّ»، «تأثير الإسلام في أوروبا القرون الوسطى»، «الأصوليَّة الإسلاميَّة والتحديث»، و«العلاقات الإسلاميَّة النصرانيَّة». ومن آخر كتبه: «حقيقة الدين في عصرنا» (سنة 1996م)، وكتاب «الفترة التكوينيَّة للفكر الإسلاميّ» (سنة 1998م)، و«موجز تاريخ الإسلام» (سنة 1995م)، وغيرها كثير.
ولد في 12مايو 1905م في مدينة بورتسموث جنوب بريطانيا، التحق بجامعة كامبريدج لدراسة اللغات الكلاسيكيَّة اللاتينيَّة واليونانيَّة، شجَّعه أحد أساتذته على دراسة العربيَّة والفارسيَّة، ارتحل إلى مصر لمواصلة دراسته للُّغة العربيَّة، عاد إلى مصر ليعمل في كلِّيَّة الآداب رئيسًا لقسم الدراسات القديمة (اليونانيَّة واللاتينيَّة) وزار فلسطين وسوريا ولبنان.
اهتمَّ بالأدب العربيّ، فترجم «مسرحيَّة مجنون ليلى» لأحمد شوقي، كما حقَّق كتاب «التعرُّف إلى أهل التصوُّف»، وواصل اهتمامه بالتصوُّف؛ وذلك بنشره كتاب «المواقف والمخاطبات» للنفري وترجمه إلى الإنكليزيَّة.
عمل آربري مع وزارة الحرب البريطانيَّة أثناء الحرب العالميَّة الثانية مهتمًّا بشؤون الإعلام والرقابة البريديَّة، وأصدر كتابه «المستشرقون البريطانيُّون». في سنة 1943م تولَّى منصب أستاذ كرسي اللغة العربيَّة في مدرسة الدراسات الشرقيَّة والإفريقيَّة، ثمَّ انتقل إلى جامعة كامبريدج؛ وحاز فيها على منصب أستاذ كرسي اللغة العربيَّة.
ولعلَّ من أبرز جهود آربري ترجمته لمعاني القرآن الكريم، حيث أصدر أوَّلًا مختارات من بعض آيات القرآن الكريم مع مقدِّمة طويلة ثمَّ أكمل الترجمة وأصدرها عام 1955م.
ولد لويس في 31 مايو 1916م، وتلقَّى تعليمه الأوَّل في كلِّيَّة ولسون والمدرسة المهنيَّة، حيث أكمل دراسته الثانويَّة. لا تذكر المراجع أيَّ معلومات عن تلقِّيه تعليمًا دينيًّا يهوديًّا خاصًّا. التحق بجامعة لندن لدراسة التاريخ، ثم انتقل إلى فرنسا للحصول على دبلوم الدراسات الساميَّة سنة 1937م متتلمذًا على المستشرق الفرنسيّ «ماسنيون» وغيره، ثمَّ عاد إلى جامعة لندن، مدرسة الدراسات الشرقيّة والإفريقيَّة، وحصل على الدكتوراه عام 1939م عن رسالته القصيرة حول أصول الإسماعيليَّة.
استُدعي أثناء الحرب العالمية الثانية لأداء الخدمة العسكريَّة، وأعيرت خدماته لوزارة الخارجيَّة من سنة 1941م حتَّى 1945م، عاد بعد الحرب إلى مدرسة الدراسات الشرقيَّة والإفريقيَّة؛ لتدريس التاريخ الإسلاميّ، وأصبح أستاذ كرسي التاريخ الإسلاميّ عام 1949م، ثم أصبح رئيسًا لقسم التاريخ عام 1957م، وظلَّ رئيسًا له حتَّى انتقل إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة عام 1974م.
دُعِي للعمل أستاذً زائرًا في العديد من الجامعات الأمريكيَّة والأوروبيَّة، منها: جامعة كولمبيا، وجامعة إنديانا، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجامعة أكلاهوما، وجامعة برنستون التي انتقل إليها وعمل فيها من 1974م حتَّى تقاعده عام 1986م. وهنا عُيِّن مديرًا مشاركًا لمعهد أنانبرج اليهوديّ للدراسات اليهوديَّة والشرق أوسطيَّة في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا.
يعدُّ لويس من أغزر المستشرقين إنتاجًا -وإن كانت له قدرة على إعادة نشر بعض ما سبق نشره بصورٍ أخرى- وقد تنوعت اهتماماته من التاريخ الإسلاميّ
ـ حيث كتب عن: الإسماعيليَّة، وعن الحشَّاشين، وعن الطوائف المختلفة في المجتمع الإسلاميّ ـ إلى الحديث عن المجتمع الإسلاميّ؛ ولكنَّه في السنوات الأخيرة قبل تقاعده بقليل بدأ الاهتمام بقضايا العالم العربيّ والإسلاميّ المعاصرة، فكتب عن الحركات الإسلاميّة (الأصوليَّة) وعن الإسلام والديمقراطيَّة.
قدَّم خدماته واستشاراته لكلٍّ من الحكومة البريطانيَّة التي كلَّفته القيام برحلةٍ إلى العديد من الجامعات الأمريكيَّة وإلقاء الأحاديث الإذاعيَّة والتلفازيَّة عام 1954م، كما قدَّم استشارته للكونغرس الأمريكيّ أكثر من مرَّة. وفي إحدى المرَّات (8 مارس 1974م) ألقى محاضرةً في أعضاء لجنة الشؤون الخارجيَّة بالكونغرس الأمريكيّ حول قضيَّة الشرق الأوسط، ولأهمِّيَّة هذه المحاضرة نشرتها وزارة الخارجيَّة الإسرائيليَّة بعد أسبوعين من إلقائها .
ويمكن لنا إيجاز أهم خصائص هذه المدرسة في الآتي:
يمتاز الاستشراق البريطاني بارتباطه بالحركة الاستعمارية، ومحاولة ترسيخ السياسات الاستعمارية الإنجليزية في الشرق.
الاهتمام باللغة العربية؛ نظرًا لمصالح بريطانيا الاقتصادية والسياسية التي تربطها بالعالم العربي.
تتميز هذه المدرسة بالتعدُّد والشمول في سائر الدراسات الشرقيّة «آداب -تاريخ - فلسفة- علوم- فنون وعمارة وآثار».
تتميَّز هذه المدرسة -أيضًا- بالتخصصية الدقيقة، فكلُّ مستشرقٍ له تخصُّصه الدقيق في أحد مجالات المعرفة الشرقيّة.
الاهتمام بدراسة المعارف الخاصة بالمنطقة الجغرافية التي تقع تحت قبضتها الاستعمارية «مصر وإفريقيا السوداء»، مع الإهمال الواضح لشمال إفريقيا؛ نظرًا لوقوعه تحت قبضة الاستعمار الفرنسي.
ساهم المستشرقون الألمان أكثرَ من غيرهم من المستشرقين بجمع المخطوطات العربية ونشرها وفهرستها، وخصوصًا كتب المراجع والأصول المهمة، ونشر المخطوطات، فان أهمَّ ما قام به المستشرقون الألمان وضعُ المعاجم العربية؛ فقد وضع فرايتاج (1788 – 1861) المعجمَ العربي اللاتيني في أربعة أجزاء، ثم وضع فيشر (1865 – 1949مم)عجمًا للغة العربيّة الفصحى، وقاموس هانزفير (1909 – 1981م) العربي –الألماني للغة العربيّة المعاصرة، وقاموس شراكل (1923م) الألماني– العربي، الذي صدر سنة 1974، والقاموس الضخم للغة العربيّة الفصحى الذي عمل عليه أولمان (1931) في جامعة توبنجن، وفي سنة 1980م كان قد وصل إلى حرف الكاف (ك)، وفي سنة 2000 انتقل العمل على هذا القاموس إلى جامعة ميونيخ، ووصل إلى حرف الميم (م).
وإنّ أكبر الإفادات من بحوث الألمان في التاريخ العربي القديم، تمت على يد الدكتور جواد علي صاحب الكتاب القيّم «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام»، في عشر مجلدات؛ فقد رجع الرجل إلى ستة وعشرين كتابا ألمانيًّا، وحوالي الأربعمائة مقالة للباحثين الألمان... وما يزال الذين يؤلفون الكتب المدرسية للجامعات عن تاريخ العرب القديم يرجعون الى دراسات هؤلاء العلماء عبر كتاب جواد علي دونما ذكر له في كثير من الأحيان.
على أنّ أكبر تأثير للاستشراق الألماني في مجال التاريخ والكتابة التاريخية جاء من خلال كتاب يوليوس فلهاوزن المشهور: الدولة العربيّة وسقوطها، وقد صدر الكتاب عام 1901م، وتُرجم إلى الإنجليزية، وبدأ الدارسون العرب يعرفونه من خلال تلك الترجمة. ثم ترجم إلى العربيّة مرتين في مصر والشام، على يد عبد الرحمن بدوي ويوسف العش، وقد أثر في الكتابة التاريخية العربيّة تأثيرًا كبيرًا.
وسيأتي الحديث عن الآثار التي تركتها دراسات تيودور نولدكه (1836- 1930م)، الذي اهتم بالأبحاث القرآنيّة.
يعدُّ رايسكه مؤسس الدراسات العربيّة في ألمانيا، حيث بدأ تعلّم العربية، ثم درس في جامعة ليبزيج Leipzig، وانتقل إلى جامعة ليدن لدراسة المخطوطات العربيّة فيها، كما اهتمَّ بدراسة اللغة العربيّة والحضارة الإسلاميّة، وإنْ كان له فضل في هذا المجال فهو الابتعاد بالدراسات العربيّة الإسلاميّة عن الارتباط بالدراسات اللاهوتية التي كانت تميز هذه الدراسات في القرون الوسطى (الأوروبية).
وقدم رايسكه في كتاباته رؤية منصفة للإسلام ونبيه ودفع ثمن هذا الانصاف، إذ تعرض لمضايقات من رجال اللاهوت الذين اتهموه بالزندقة.
وقد رفض في كتابٍ له باللاتينية وصف النبيّ صلىاللهعليهوآله بالكذب أو التضليل أو وصف دينه بأنّه خرافات مضحكة -كما كان سائدًا حينذاك- ورفض تقسيم تاريخ العالم إلى تاريخ مقدس وتاريخ غير مقدس، بل وضع العالم الإسلاميّ في قلب التاريخ العالمي وعبر عن آرائه بأعظم قدر من الصراحة، غير مكترث بكل العواقب المترتبة على ذلك وهو ما جرّ عليه ويلات كثيرة جعلته يعيش معظم أيام حياته في ضائقة مالية.
بدأ دراسة اللغة العربيّة في ألمانيا ثم التحق بمدرسة الدراسات الشرقيّة الحية في باريس على يدي المستشرق الفرنسي المشهور سيلفستر دي ساسي. عيِّن أستاذًا للغات الشرقيّة بجامعة بون، ومن أهم انتاجه القاموس العربي اللاتيني في أربعة أجزاء. كما اهتمَّ بالشعر العربي وبخاصة المعلقات، وحقَّق
ونشر بعض الشعر الإسلاميّ. شارك في نشر كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي.
تعلَّم اللغة العربيّة في جامعة ليبزيج وفي جامعة فيينا، ثم التحق بمدرسة اللغات الشرقيّة الحية في باريس على يدي دي ساسي. ومن أهم أعمال فلوجل وضع (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) كما اهتمَّ بالتراث الإسلاميّ في مجال الفلسفة، والنحو العربي.
تخصَّص في دراسة التاريخ الإسلاميّ والفرق الإسلاميّة، من أبرز مؤلّفاته: تحقيق تاريخ الطبري. وألَّف كتابًا بعنوان (الإمبراطورية العربيّة وسقوطها) ومن اهتماماته بالفرق الإسلاميّة تأليف كتابيه (الأحزاب المعارضة في الإسلام) وكتابه (الخوارج والشيعة) وكتب عن الرسول صلىاللهعليهوآله في كتابه (تنظيم محمد للجماعة في المدينة) وكتابه (محمد والسفارات التي وجهت إليه).
ولد في هامبرج في (2مارس 1836)م، ودرس فيها اللغة العربية، ودرس في جامعة ليبزيج وفينا وليدن وبرلين. عيِّن أستاذًا للغات الإسلاميّة والتاريخ الإسلاميّ في جامعة توبنجن، وعمل أيضًا في جامعة ستراستبرج. اهتمَّ بالشعر الجاهلي وبقواعد اللغة العربية، وأصدر كتابًا بعنوان (مختارات من الشعر العربيم)ن أهمِّ مؤلفاته كتابه (تاريخ القرآن) نشره عام (1860م)، وهو رسالته للدكتوراه، وفيه تناول ترتيب سور القرآن الكريم، وحاول أن يجعل لها ترتيبًا ابتدعه.
ولد في (17سبتمبر 1868م)، في مدينة روستوك، بدأ دراسة اللغة العربية، وهو في المرحلة الثانوية، ودرس في الجامعة اللغات الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية)؛
بالإضافة إلى اللغات الشرقيّة، ودرس على يدي المستشرق نولدكه. اهتمَّ بدراسة التاريخ الإسلاميّ، وله في هذا المجال كتاب مشهور (تاريخ الشعوب الإسلاميّة)، ولكنه مليء بالمغالطات والافتراءات على الإسلام.
ومن أشهر مؤلفاته كتاب (تاريخ الأدب العربي) الذي تُرجم في ستة مجلدات، وفيه رصد لما كُتب في اللغة العربيّة في العلوم المختلفة من مخطوطات، ووصفها ومكان وجودها.
ولد في (2 أبريل 1876م)، ودرس في جامعة لوزان وفي جامعة هيدلبيرج وجامعة برلين. كان له اهتمام كبير بدراسة الأديان، وهي التي قادته إلى الاهتمام بدراسة الدين الإسلاميّ. ويعدُّ من أشهر المستشرقين الذين كتبوا في التاريخ الإسلاميّ وبخاصة في جوانب تأثير العوامل الاقتصادية وتأثير العناصر الإغريقية والمسيحيّة في الحضارة الإسلاميّة. واهتمَّ كذلك بدراسة التاريخ الاقتصادي والإداري في صدر الإسلام. قام برحلات علمية كثيرة في أنحاء أوروبا حيث عمل فترة في مكتبة الأسكوريال في مدريد (إسبانيا)، واطلع على المخطوطات العربيّة فيها. زار مصر وتعمَّق هناك في دراسة اللغة العربية. تولَّى منصب أستاذ في معهد هامبورج الاستعماري الذي أنشأته الحكومة الألمانية لمساعدتها في التعامل مع الشعوب العربيّة والإفريقية. أسهم في إنشاء مجلة (الإسلام) Der Islam عام (1910م)، وتولَّى منصب وزير الثقافة في بروسيا (إحدى الولايات الألمانية).
ولد في (15مارس 1902م)، درس اللغات الشرقيّة في جامعة برسلاووليبتسك، انتدب للعمل في الجامعة المصرية عام (1934م)، لتدريس مادة فقه اللغة العربيّة واللغة السريانية. شارك في هيئة تحرير دائرة المعارف الإسلاميّة في طبعتها الثانية. عُرف شاخت باهتمامه بالفقه الإسلاميّ، ولكنه صاحب إنتاج في مجال المخطوطات وفي علم الكلام وفي تاريخ العلوم والفلسفة.
ولد في (27فبراير 1892م)، درس على المستشرق الألماني هينريتش بيكر، عمل في الجيش الألماني، عاش في إسطنبول في تركيا في الفترة من (1927- 1949م)؛ ما أتاح له الفرصة للاطلاع على ما في مكتبات تركيا من كنوز المخطوطات الإسلاميّة. وله تحقيقات مهمة من أبرزها الآتي:
- مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري.
- الوافي بالوفيات.
- فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي.
- أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني.
أسّس المكتبة الإسلاميّة في ألمانيا عام (1918م)، للعناية بحفظ المخطوطات الإسلاميّة ونشرها، كما أسّس مجلة أويانس عام (1948م)(Oriens).
ولد عام (1901م)، درس في جامعة توبنجن اللغات السامية والتركية والفارسية في الفترة من (1920حتى 1924م)، وتخرَّج على يد المستشرق الألماني ليتمان. أمضى سنتين في القاهرة (1925-1926م)، كان اهتمامه في البداية بالأدب الشعبي، ولكنه تحوَّل إلى الاهتمام باللغة العربيّة والدراسات الإسلاميّة، وبخاصة القرآن الكريم.
تولَّى العديد من المناصب العلميّة؛ منها: مدرِّس في جامعة توبنجن وأستاذًا في جامعة هايدلبرج، ثم عاد إلى توبنجن أستاذًا للغة العربيّة والإسلاميّات من عام (1951- 1968م). ومن أهمِّ مؤلفاته (محمد والقرآن) وترجم معاني القرآن الكريم إلى الألمانية، وله كتاب عن القرآن بعنوان (القرآن تعليق وفهرست).
هي واحدة من أشهر المستشرقين الألمان على المستوى الدولي، بدأت دراسة اللغة العربيّة في سن الخامسة عشرة، وتتقن العديد من لغات المسلمين، وهي التركية والفارسية والأوردو. درَّست في العديد من الجامعات في ألمانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أنقرة. اهتمت بدراسة الإسلام، وحاولت تقديم هذه المعرفة بأسلوب علمي موضوعي لبني قومها، حتى نالت أسمى جائزة ينالها كاتب في ألمانيا تسمَّى جائزة السلام. ولكن بعض الجهات المعادية للإسلام لم يرقها أن تنال هذه الباحثة المدافعة عن الإسلام هذه الجائزة في وجه الهجمات الغربيّة عليه، فحاولوا أن يمنعوا حصولها عليها...
امتازت مدرسة الاستشراق الألماني منذ القرن الثامن عشر في ظل رائدها يوهان جاكوب رايسكه (1716- 1774)، بخصائص منها:
• إنّها لم تكن نتيجة لأهداف سياسية واستعمارية. ولم تكن وثيقة الصلة بالأهداف الدينيّة التبشيرية؛ لبعض الدول الأخرى؛ كفرنسا وإنكلترا وإيطاليا، بل على العكس كان الألمان على علاقة طيبة بالدولة العثمانية، فقد تحالفوا معها في الحرب العالمية الأولى .
• غلبة الروح العلميّة وتقصي الحقائق على الدراسات الشرقيّة في ألمانيا، فهي تمتاز بالعمق والشمولية.
• ما يبرزها عن غيرها من المدارس الاستشراقيّة الأخرى هو الاهتمام بالقديم والتركيز على دراسة التراث العربي وخدمة التراث. بدأ الاهتمام باللغات الشرقيّة مرتبطًا بعلم اللاهوت. وكانت اللغة العبريّة هي أساس هذه
الدراسات، ثم ما لبثت اللغة العربيّة والإسلام أن لقيا الاهتمام في أعقاب القرون الوسطى والدخول في عصور النهضة. ولعل أبرز ما قام به المستشرقون الألمان في مجال اللغة والتاريخ العربيّين والدراسات الإسلاميّة هو أنهم جمعوا المخطوطات العربيّة والنصوص القديمة ونشروها وفهرسوها.
نشأ الاستشراق الإسباني في أحضان حركة عدائية لكل ما هو عربي ومسلم، وكان هدفها التحقير والانتقام والتشويه، وقد وصف المستعرب الإسباني خوان غويتسولو في كتابه (في الاستشراق الإسباني) نماذجًا من هذا النوع حين يكتبون عن الإسلام والمسلمين بقوله إنّهم «إنّما يكتبون ويتصرفون وينطقون باسم المسيحيّة في مواجهة حضارة متدنية، وفي أفضل الأحوال، فإنّ استحضار الماضي المجيد الذي عرفه العالم الإسلاميّ يدفعهم إلى التفجع على نحو متحذلق على الانحطاط الحالي (انحطاطًا كان في رأيهم محتّمًا ولا مناص منه) وعلى عجزه الطبيعي عن هضم التقدم الأوروبي. «ووصف غويتسولو دراسات المستشرقين الأسبان للغات الإسلاميّة بأنّهم يدرسونها كما لو كانت «لغات حضارات منقرضة، ومقطوعة عن اللغات الحالية التي هي وريثها الشرعي، حاكمين عليها بذلك بأنْ تشكّل عدمًا أو ما هو أقل من العدم».
واختلط الدافع الديني الحاقد بدافع استعماري سياسي حينما بدأت حركات الاحتلال الأوروبي للعالم الإسلاميّ وطمعت إسبانيا في المناطق المجاورة لها فجندت
مستشرقيها لإعداد الدراسات لمعرفة مواصفات السكان وطبائعهم وتجارتهم وزراعتهم، وكذلك معرفة اللغات واللهجات المحلية، وقد أنشأت الحكومة الأسبانية العديد من المراكز لتعليم العربيّة العاميّة والمغربيّة، فتجاوزت خمسين مدرسة.
وما تزال إسبانيا تحتفظ بالكثير من المخطوطات العربيّة في مكتباتها الكبرى كمكتبة الاسكوريال ومكتبة مدريد الوطنيّة، ومكتبة جمعية الأبحاث الوطنيّة.
و«الإسبان الذين يهتمّون بالدراسات العربيّة الإسلاميّة يفضلون تسميتهم بالمستعربين (الاستعراب Arabists)؛ عوض المستشرقين، وذلك نظير ما قاموا به خدمةٍ لدراسة اللغة العربيّة وآدابها، وحضارة المسلمين وعلومهم في شبه الجزيرة الإيبيرية بصفةٍ خاصةٍ، دون أن يهتموا بلغاتٍ شرقيةٍ أخرى؛ كالفارسية والتركية والأردية وغيرها».
ويشير بعض الباحثين إلى أنّ مفهوم الاستعراب «ربما يكون قد أخذ منحى آخر في الأندلس حيث أطلق على العناصر المسيحيّة التي استعربت لغتها وعاداتها ولكنها بقيت على دينها محتفظة ببعض تراثها اللغوي والحضاري خاصة وأنّ الدولة الإسلاميّة كفلت لهم حرية العقيدة، فأبقت لهم كنائسهم وأديرتهم وطقوسهم الدينيّة التي كانت تقام باللغة اللاتينية».
وجدير بالذِكْر أنّ أيّ دارس للاستشراق الإسباني وتاريخه لا يمكن له الإحاطة به بشكل سليم إلا بالرجوع لخلفياته الثقافية والتاريخية ولا يمكن إلا برده لأصوله التاريخية والمعرفية؛ أي بالغور في جذور الفكر الإسباني وبالذات الاستشراقي للوصول إلى هويّته العربيّة الإسلاميّة؛ باعتباره حقبة زاهرة في تاريخ أوروبا، ولذلك نجد من رواد هذا الفكر أسماء تعتبر من أقطاب الفكر العربي الإسلاميّ؛ كابن رشد وابن طفيل وابن باجه وابن حزم.
ولد في 5 يوليو1871م في مدينة سرقسطة والتحق بكلية الآداب في جامعة سرقسطة بالإضافة إلى دراسته في المعهد المجمعي، فتخرج فيه قسيسًا.
من مؤلفاته كتاب «علم الأخرويات الإسلاميّ في الكوميديا الإلهية» (1919، بالإسبانية: La Escatología musulmana en la Divina Comedia)، الذي ألقى فيه الضوء على المصادر الإسلاميّة للأفكار والدوال الموجودة في الكوميديا الإلهية لدانتي كتب بلاثيوس الكثير من المؤلفات عن الإسلام في العصور الوسطى، وقد عَنِي بلاثيوس بمحيي الدين بن عربي عناية شديدة، فنشر عنه سلسلة دراسات منوعة.
ولد في غرناطة ودرس الفلسفة في كلية الآداب في جامعة غرناطة، عمل مستشارًا للثقافة والتعليم في الإقامة الإسبانية في المغرب، عيّن أستاذًا للغة العربيّة في جامعة غرناطة عام 1942م، وثمّ عيّن مديرًا لمعهد الدراسات العربيّة في غرناطة، وعمل رئيسًا لقسم الدراسات العربيّة في معهد الدراسات الإفريقية في مدريد، انتخب عضوًا في مجمع الفنون الجميلة، له إنتاج غزير في مجال تحقيق المخطوطات وفي البحوث عن الشريعة الإسلاميّة، وكذلك عن التاريخ الإسلاميّ والآثار الإسلاميّة.
ولد في مدريد ودرس في جامعتها، عمل أستاذًا في جامعة غرناطة وفي جامعة مدريد. تولى إدارة المعهد الثقافي الإسباني، زار سوريا ولبنان، انتخب عضوًا في المجمع
العلمي العربي في دمشق عام 1948م، عمل سفيرًا لبلاده في بغداد وفي لبنان، له دراسات عديدة في الأدب العربي وترجمات لبعض الشعر العربي إلى الإسبانية.
ومن أقوال غارسيا «لو لم يكن الحضور العربي في الأندلس وما أفرزته من حضارة مشرقة طوال ثمانية قرون، لما وصل الغرب إلى ما وصل إليه الآن، بل كان عليه أن يبدأ من حيث انتهى الرومان والإغريق «اميليوغارسيا غومز لمجلة الأندلس، العدد 47، مدريد 1995».
ولد في فيجراس عام 1922م، درس في جامعة برشلونه فقه اللغات السامية وحصل على الدكتوراه من جامعة مدريد بعنوان (الإقطاع، مملكة الطوائف على عهد بنورزين) عمل في تدريس اللغة العربيّة في كل من جامعتي برشلونة وجامعة سرقسطة، تولى منصب أستاذ مساعد للتاريخ والنظم الإسلاميّة في جامعة مدريد وعمل أمين مكتبة معهد الدراسات العربيّة في مدريد، ودرّس التاريخ والنظم الإسلاميّة في جامعة غرناطة.
تولى رئاسة الجمعية الإسبانية للمستشرقين، وهو عضو جمعية شمال أمريكا لدراسات الشرق الأوسط، تركزت بحوثه في مجال الدراسات الإسلاميّة والجغرافيا والتاريخ كما اهتم بقضايا العالم العربي المعاصرة.
1- دراسات عن الأصل التاريخي لكتاب الروض المعطار (سرقسطة 1950)
2- والوثائق العربيّة والعبريّة في أراغون ونبره (سرقسطة 1953)
3- وأثر العرب في ثقافة الثغر الأعلى (مدريد 1954)
4- وتاريخ المغرب، جـ 5، الموحدون (تطوان 1957)
5- ومملكة بني رزين (مدريد 1959)
6- ومباحث عن الكتابات العبريّة والعربيّة (تكريم مياس فاليكروسا 1954)
7- وحول بعثة نصرانية إلى بلاط المقتدر ابن هود (تمودا 1954)
8- والدنانير الأسبانية (تمودا 1954).
ولد في غرناطة في 14/11/1940م درس اللغات الشرقيّة في جامعة مدريد، حصل على الدكتوراه في علم اللغة، عمل مديرًا للمركز الثقافي في القاهرة 1962م-1965م، تولى منصب أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الألسن العليا في جامعة عين شمس في الفترة نفسها، وترأس قسم اللغة الإسبانية في جامعة محمد الخامس في الرباط عام 1965م-1968م، عمل في جامعة فيلاديلفيا أستاذًا للغات الشرقيّة والعربية، وأستاذًا لكرسي اللغة العربيّة في جامعة سرقسطة منذ عام 1976م.
ألّف أعمالًا هامّة توطّد التلاقح اللغوي والثقافي العربي الإسباني؛ مثل: القاموس العربي الإسباني، والقاموس الإسباني العربي، وقاموس المفردات الإسبانية ذات الأصول العربيّة، وغيرها من أعمال الترجمة عن الأدب العربي القديم، وعن أدب القرون الوسطى والأدب العربي المعاصر، فضلًا عن بعض الدراسات المتعلّقة بعلم اللهجات؛ كاهتمامه بلغة الأندلس وعلاقتها بلغات شبه الجزيرة الإيبيرية. حاز على جوائز عالميّة عدّة عن أعماله التي وصلت إلى أربعين كتابًا وخمس وخمسين مقالةً؛ بالإسبانية والإنجليزية والعربيّة والفرنسية والبرتغالية والروسية.
أهم ما يميز الاستشراق الإسباني ما يأتي:
1- يعتبر الدافع العلمي المحرك الأول للاستشراق الإسباني، فالرغبة في تعلم اللغة العربيّة من أجل دراسة الكتب العربيّة وترجمتها كانت السبب الرئيس في إقبال الإسبان على حقل الاستشراق.
2- يكاد الاستشراق الإسباني أن يكون مشابهًا للاستشراق الألماني في التركيز على التراث العلمي العربي، والاهتمام به؛ حفظًا وفهرسةً وتحقيقًا ونشرًا، ولعلّه امتاز عنه بامتلاك جزءٍ كبيرٍ من هذا التراث في المكتبات الإسبانية.
3- على الرغم من أن القرن العشرين شهد انخفاضًا واضحًا في العمل الاستشراقي من حيث المستوى الكمّيّ، إلا أنّنا نجد شذوذًا في الاستشراق الإسباني يمثله عدد من المستشرقين الإسبان وفي طليعتهم آسين بلاسيوس الذي خلف ما يقرب عن مائتين وخمسين كتابًا وبحثًا بعضها في عدةِ مجلداتٍ، وكذلك غونزاليث بلانسيا الذي خلف ما يقرب عن ثلاثمائة وعشرين كتابًا وبحثًا، وهو عددٌ يذكّرنا بما تميز به الألمان في مراحل الاستشراق الأولى من تفرغ للبحث والإنتاج العلمي.
4- كان للقساوسة والرهبان أثرٌ واضحٌ في تنشيط الاستشراق الإسباني، وذلك بانخراطهم الشخصي في هذا الميدان، أو بدفعهم الباحثين الآخرين إليه، ومن أشهر هؤلاء يوحنا الأشقوبي، وبدرو القلعاوي، وريموندو مارتيني، وكانيس.
5- فهرسة المخطوطات العربيّة أحد المجالات التي اهتم بها المستشرقون الإسبان، وكان لهم فيها دورٌ واضحٌ، ومن الأسماء اللامعة في الفهرسة: غينغوس، وسلفادور غوميث، وألاركون.
ولكن لا يمكن إنكار الدوافع الدينية الكامنة والظاهرة في هذا الاستشراق،
وما شابه من نزعة تعصب ديني نتيجة الصراع بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس وطرد المسلمين من تلك البلاد.
اهتمّ المستشرقون الهولنديون باللغة العربيّة ومعاجمها، كما اهتموا بتحقيق النصوص العربية، وما يميز الاستشراق الهولندي اتساع نشاطات الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد الهولندية في مجال الدراسات العربيّة والإسلاميّة، وبخاصة جامعة ليدن التي يوجد فيها كليَتَي الآداب واللغات والثقافة، وكلية اللاهوت التي تضم معهد ليدن لدراسة الأديان. ولو أضفنا إلى هذه الجامعات ما تقوم به دار بريل للنشر من الإشراف على طباعة دائرة المعارف الإسلاميّة وسلسلة من الكتب المختارة بعناية عن الإسلام والمسلمين لتأكّد لنا أهمية هذا الاستشراق.
والمتابع للنشاطات الاستشراقيّة الأوروبية يلفت نظره سعة الاستشراق الهولنديّ ونشاطاته الواسعة والدعم الحكومي الكبير ودعم المؤسسات التجارية والخيرية الهولندية لهذا المجال حتى تكاد تكون هولندا هي رائدة الاستشراق الأوروبي المعاصر.
إنّ جامعة ليدن تعدّ أم الجامعات الهولندية في مجال الدراسات العربيّة والإسلاميّة، وقد تأسّست هذه الجامعة عام 1575م وبدأت الدراسات الاستشراقيّة فيها عام 1591 عندما استقدمت الجامعة العالم الأوروبي المشهور جوزيف سكاليجر (1540-1609مم)ن فرنسا. ومنذ ذلك الحين والدراسات العربيّة الإسلاميّة في تطور مستمر وقد ازدادت تطورًا خلال الأعوام العشر الماضية لتصبح بؤرة لاهتمام المستشرقين الغربيّين عمومًا وبخاصة أن مدينة ليدن تضم مؤسسة بريل التي تقوم بطباعة دائرة المعارف الإسلاميّة ونشرها.
ولد في 21 فبراير 1920 في مدينة ليدن، بدأ دراسة العربيّة في المرحلة الثانوية وواصل هذه الدراسة في الجامعة، حصل على الدكتوراه عام 1881م عن بحثه (أخبار بني عيّاد عن الكتّاب العرب) اهتم بالمخطوطات العربيّة وبخاصة كتاب الذخيرة لابن بسّام وغيره من الكتب، اهتم بتاريخ المسلمين في الأندلس وأبرز كتبه «تاريخ المسلمين في إسبانيا» المكون من عدة مجلدات، أشهر هذه الكتب: تكملة المعاجم العربية.
ولد في 9 أغسطس 1836، تخصص في جامعة ليدن بالدراسات الشرقيّة ومن أساتذته المستشرق دوزي وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان (أنموذج من الكتابات الشرقيّة في وصف المغرب مأخوذ من كتاب البلدان لليعقوبي)، عمل في التدريس في جامعة ليدن، وكان أبرز اهتماماته الجغرافيا، وكذلك التاريخ الإسلاميّ، ومن إنتاجاته: تحقيق كتاب فتوح البلدان للبلاذري، كما شارك وأشرف على تحقيق تاريخ الطبري، وهو غزير الإنتاج.
يعتبر أرسخ المستشرقين قدمًا في الدراسات العربيّة. تعلم في جامعتي ليدن وأكسفورد، ودرس في الأولى. وكان من أعضاء المجمع الشرقي في ليدن ومجامع أخرى. ونشر نفائس من الكتب العربية.
انصبّ اهتمام دي خويه على كتب الجغرافيا العربيّة، وصدرت باهتمامه سلسلة المكتبة الجغرافية العربيّة في عشرة أجزاء، ما بين عامي (1870- 1894م)عتمدًا فيها على مخطوطات مكتبة ليدن الشهيرة. وتضمنت الكتب الأمهات الجغرافية والتاريخية ومنها:
كتاب البلدان لليعقوبي (توفي 284هـ/ 897م) يُعني هذا الكتاب بالجغرافية الاقتصادية وإحصاءات الجباية.
- فتوح البلدان الصغير للبلاذري.
- مسالك الممالك للإصطخري.
- صورة الأرض لابن حوقل.
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي.
- التنبيه والإشراف للمسعودي.
مختارات من كتاب الخراج لأبي فرج قدامة بن جعفر يعرض لنظام البريد والجباية والإدارة. وغيرها من الكتب.
ولد في أستر هوت، وتعلم بليدن وستراسبورج. وأقام في «جدة «في الحجاز (سنة 1884) سبعة أشهر، ويقول إنّه دخل مكة متسمّيًا بعبد الغفّار، ومكث فيها، في «سوق الليل» خمسة أشهر، واضطر إلى مغادرتها فجأة قبل حلول موسم الحج، لانكشاف أمره بكلمات فاه بها وكيل قنصل فرنسة في جدة في بعض المجالس. ورحل إلى بلاد الجاوي، فأقام 17 سنة. وعيّن (سنة 1906) أستاذًا للعربيّة في جامعة ليدن، خلفًا لدي خويه.
ثمّ كان مستشارًا في الأمور الإسلاميّة والعربيّة، في وزارة المستعمرات الهولندية.
له كتب عدّة، بالألمانية، عن الإسلام والمسلمين، أشهرها كتابه عن «مكة في القرن التاسع عشر»، في مجلّدين، نشره سنة 1889م، وهي مجموعة في ستة مجلدات، طبعها سنة 1923 - 1927 في «الإسلام وتاريخه» و«الشريعة الإسلاميّة» و«بلاد العرب وتركيا» و«الإسلام في المهاجر الهولندية» و«اللغة
والأدب» و«ملاحظات في الكتب» ذكر فيه بعض المخطوطات وتواريخ كتابتها، و«فهارس الأجزاء المتقدّمة».
وأبرز من أثّر على سنوك هرخرونيه في مرحلة دراسته؛ هما:
• ثيودور نولدكه.
• دي خويه.
يعد سنوك أنموذجًا للمستشرق الذي خدم الاستعمار خدمات كبيرة وسخّر علمه لهذا الغرض.
كان أستاذ اللغة العربيّة في جامعة ليدن من سنة 1972 إلى وفاته. وقام برحلات إلى مصر وسورية وغيرهما من بلاد العرب. وانصرف إلى العناية بالحديث النبوي، فوضع بالإنجليزية معجمًا للألفاظ الواردة في أربعة عشر كتابًا من كتب السنن والسيرة، نقله إلى العربيّة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي وسمّاه (مفتاح كنوز السنة) وتولّى فنسنك تحرير (دائرة المعارف الإسلاميّة سنة 1925 م، بلغاتها الثلاث، فأتم منها أربعة مجلدات وخمس ملازم. وكتب مقالات كثيرة في مجلات مختلفة. وله كتب بالإنجليزية عن الإسلام والمسلمين. وبدأ بنشر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) بالعربيّة، وتوفي قبل إتمامه.
له إنتاج غزير في مجال الدراسات الإسلاميّة؛ منها: (الإسلام في مرآة الغرب) و(واقع الجامعات العربيّة–مجلدان) والطرق الكلاسيكية لدراسة الدين، شارك في الكتابة في دائرة المعارف الإسلاميّة (الطبعة الثانية) وقد كتب مادة (مستشرقون).
نشأت حركة الاستشراق في أوائل القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد غلب عليها الطابع الديني، ولكن مع عدم إغفال الأطماع السياسية، فكيف يكون لبريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولا يكون لأمريكا اهتمامات إمبريالية، وقد اشترك الهدفان، فتأسّست الجمعية الشرقيّة عام 1840م وأرسلت باحثيها إلى العالمين العربي الإسلاميّ، وحرصت بعض الجامعات الأمريكية على أن تنال نصيبها من المخطوطات الإسلاميّة، فاشترت جامعة برنستون Princeton كمية من المخطوطات حتى أصبحت تضم ثاني أكبر مجموعة مخطوطات إسلامية.
ولكنّ الاستشراق الأمريكي بدأ عمليًا بعد الحرب العالمية الثانية، وشَهِد نهضةً شاملة حينما أَخْلَتْ بريطانيا مواقعَها للنفوذ الأمريكي؛ كما ذكر ذلك «مايلز كوبلاند» ضابط المخابرات الأمريكي في كتابه: (لعبة الأمم)، ووجد الأمريكيون أنّهم بحاجةٍ إلى عددٍ كبير من المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، فأصدرتِ الحكومة الأمريكية مرسومًا عام 1952م خصصتْ بموجبِه مبالغَ كبيرة لتشجيعِ الجامعات على افتتاحِ أقسام الدراسات العربيّة الإسلاميّة، واستقدم لذلك خبراء في هذا المجال من الجامعات الأوروبية، وحضر من بريطانيا كلٌّ من: «جوستاف فون جرونباوم»، و«هاملتون جب»، و«برنارد لويس»، وغيرهم، فأسّس هاملتون جب مركزَ دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، و«جرونباوم» أسّس مركزًا في جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس»، وبعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية منتصرة، وأصبحت قوة عظمى، وتغيرت موازين القوى في العالم كان لا بد لها أن تتعلم من الأوروبيين الذين كانوا يسيطرون على معظم أرجاء العالم الإسلاميّ كيف كانوا يُحكِمون سيطرتهم عليه، فماذا هم متعلمون؟
«بدأت وزارة الدفاع الأمريكية باستصدار قانون يخولها الإنفاق بسخاء على برامج الدراسات العربيّة والإسلاميّة وبرامج دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية، وفي مراكز البحوث والمؤسسات العلميّة المختلفة، واستعانت في هذا الأمر بمجموعة من المستشرقين الأوروبيين الذين تركوا بلادهم إلى العالم الجديد؛ لأنّهم أدركوا اهتمام أمريكا بخبراتهم.
وانتشرت مراكز الدراسات العربيّة الإسلاميّة وأقسام الشرق الأوسط في الجامعات والمعاهد العلميّة الأمريكية حتى تجاوز عددها المئات، وبدأت نشاطًا محمومًا في دراسة العالم الإسلاميّ. وبعد مضي فترة من الزمن لم تطل كثيرًا أصبحت هذه المراكز عصب السياسة الأمريكية تمد السياسيين بالمعلومات والمقترحات والآراء والخطط، وحدث تبادل في المراكز فكم من مستشرق أو متخصص في الدراسات العربيّة الإسلاميّة انتقل إلى العمل السياسي، وكم من سياسي ترك السياسة إلى العمل الجامعي والبحث والدراسة.
ولعل من أبرز اهتمامات السياسة الأمريكية دراسة الحركة الإسلاميّة وسبل مواجهتها والقضاء عليها، ومن ذلك أن مجموعة من المستشرقين والسياسيين الذين عملوا في العالم الإسلاميّ قدموا ثمرة خبراتهم وبحوثهم إلى الكونجرس الأمريكي في جلسات خاصة في صيف وخريف عام 1985م، وقد نشرت محاضر الجلسات في كتاب بلغت صفحات اثنتين وأربعين وأربعمائة صفحة ووزع توزيعًا محدودًا حتى يتسنى للمختصين مواصلة البحث والدراسة» .
مستشرق وطبيب أمريكي، هولندي الأصل ومن أقدم أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت عمل في مستشفى مار يوحنا في بيروت. أما في الطب فله مؤلّفات عدّة؛
منها: كتاب الباثولوجيا التشخيص الطبيعي للفحص الطبي، ورسالة في الجدري والحصبة للرازي، وغير ذلك.
ولد في قرية من أعمال نيويورك، وتعلم الطب الصيدلية في مدرسة جفرسن (في فيلادلفيا) وأرسله مجمع المرسلين الأميركيين، للتبشير الديني في سورية، وهو في الحادية والعشرين من عمره، فقدم بيروت سنة 1840 وحذق العربيّة كل الحذق، وحفظ كثيرًا من أشعارها وأمثالها ومفرداتها وتاريخها. وأنشأ مع بطرس البستاني مدرسة في عبية (في لبنان) وتنقّل في الإقامة بين القدس ولبنان وصيدا.
له نحو خمسة وعشرين مصنّفًا عربيًّا، أشهرها: «المرآة الوضية في الكرة الأرضية» و«النقش في الحجر» ثمانية أجزاء، و«أصول علم الهيئة» و«التشخيص الطبيعي» و«الروضة الزهرية في الأصول الجبرية» و«الأصول الهندسية» و«أصول الكيمياء» و«طب العين.» ونُشرت له أبحاثًا من كتابه «تاريخ الأطباء»، في المقتطف.
بلجيكي الأصل متخصص في العلوم الطبيعية والرياضية درس العربيّة في الجامعة الأمريكية في بيروت 1931-1932، ألقى محاضرات عن فضل العرب على الفكر الإنساني، أشرف مع ماكدونالد على مجلة إيزيس 1913-1946 وأبرز إنتاجه (المدخل إلى تاريخ العلم).
وجورج سارتون من أعضاء المجمع العلمي العربي. قالت مجلة المجمع في وصفه: (أخلص الحب للعرب ولغتهم، وجلا فضل علمائهم على العالم القديم، في تجرّد وانصاف) هاجر من بلاده إلى أميركا (سنة 1916م) فكان مدرس (تاريخ العلوم) في جامعة هارفرد (1917 - 49) وزار مصر وبلاد الشام وإفريقية الشمالية سنة 31 – 32 وألقى محاضرات حول بيان (فضل العرب على التفكير الإنساني)
وانشأ مجلتين إنكليزيتين علميتين؛ هما: (إيزيس) و(أوزيريس) فأصدر منها 43 مجلّدًا، وتخلّى عن الإشراف عليهما بعد ذلك لبعض العلماء. وكان من أعضاء عشرة مجامع علمية دولية، ومنح ست شهادات (دكتوراه) فخرية وظل مدة طويلة رئيسًا للاتحاد الدولي لتاريخ العلوم، في باريس. وكتب وألّف كثيرًا. أجلّ كتبه (المدخل إلى تاريخ العلوم) بالإنجليزية، في خمسة مجلدات، خص تاريخ العلوم عند العرب بجزء وافر منه. وله (حضانة الشرق الأوسط للثقافة الغربيّةم)حاضرة ترجمها إلى العربيّة عمر فروخ، و(تاريخ العلم) الأول والثاني، ترجمتهما إلى العربيّة لجنة نشر مؤسسة فرانكلن».
ولد في فيينا في 1/9/1909م، درس في جامعة فيينا وفي جامعة برلين، هاجر إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة نيويورك عام 1938م، ثم جامعة شيكاغو، ثم استقر به المقام في جامعة كاليفورنيا حيث أسهم في تأسيس مركز دراسات الشرق الأوسط الذي أطلق عليه اسمه في ما بعد، من أهم كتبه الإسلام في العصر الوسيط، كما اهتم بدراسة الأدب العربي وله إنتاج غزير في هذا المجال.
هو باحث ومستعرب ورائد من روّاد شركة الزيت العربيّة الأمريكية (أرامكو) حيث عمل فيها من عام 1946 حتى 1963، وهو مؤسس قسم الأبحاث والترجمة في إدارة العلاقات الحكومية في أرامكو.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عينت أرامكو جورج رينتز مترجمًا في قسم الأبحاث والترجمة بشكل مؤقت ولكن فترة عمله طالت وامتدت حتى انتهى به
المطاف إلى أن عمل مع أرامكو لمدة 17 عامًا، فقد عُين رينتز في عام 1946 مديرًا لقسم الأبحاث والترجمة في إدارة العلاقات الحكومية، وأصبح له تأثيرًا كبيرًا على سياسات أرامكو التي تحكم علاقتها بموظفيها السعوديين وبموظفي الحكومة السعودية الذين تتعامل معهم، وذلك في ما يتعلق بأمور الدين والثقافة والأعراف.
في فترة عمله مع أرامكو قام رينتز بتوثيق التاريخ الشفوي للقبائل البدوية ونشر سلسلة من كتيبات أرامكوAramco Handbooks وهي المطبوعات التي تصدرها أرامكو أدلةً لموظفيها الغربيّين عن ديانة المملكة العربيّة السعودية وثقافتها وأعرافها، ونشرت في ما بعد للتوزيع العام مثل كتيّب جزيرة ابن سعود The Arabia of Ibn Sa’ud. في عام 1948م. أنهى رينتز أطروحته عن الحركة الوهابية في المملكة العربيّة السعودية وهي أطروحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة كاليفورنيا، بركلي. وفي الخمسينات أنجز رينتز مع زميله وليام موليجان بعض من أهم الدراسات التي خرجت من قسم الأبحاث والترجمة في أرامكو:
• الروافد الشرقيّة لمنطقة الإحساء
The Eastern Reaches of al-Hasa Province
• عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي
Oman and the Southern Shore of the Persian Gulf.
وهو كَندي، أستاذ في مقارنة الأديان، كان يعمل مدير مركز جامعة هارڤرد (1964-1973) لدراسة الديانات في العالم. ويعتبر من أكثر الشخصيات تأثيرًا في هذا المجال في القرن الماضي. أثار عمله (المعنى ونهاية الدين) في عام 1962م جدلًا واسعًا لتشكيكه في صحّة مفهوم الدين.
درس اللغات الشرقيّة في جامعة تورنتو، حصل على الماجستير والدكتوراه في مجال دراسات الشرق الأدنى من جامعة برنستون، متخصص في دراسة الإسلام وأوضاع العالم الإسلاميّ المعاصرة وأشهر كتبه في هذا المجال (الإسلام في العصر الحديث) عمل أستاذًا في جامعة هارفرد وفي معهد الدراسات الإسلاميّة في جامعة مكگيل في كندا، قام بتدريس الدين الإسلاميّ في كلية نورمان المسيحيّة في مدينة لاهور في باكستان 1941م - 1945م، دعي للعمل أستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات، صدر له كتب عدّة؛ منها: (نماذج الإيمان حول العالم)، و(الإيمان نظرة تاريخية)، و(الإيمان والاعتقاد والفرق بينهما).
ولدت في ألمانيا حيث تلقت تعليمها الأولي ثم حصلت على الشهادة الجامعية من جامعة أنقرة في دراسة اللغة التركية العثمانية والحديثة واللغة الفارسية والعربيّة والتصوف، حصلت على الماجستير من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في تاريخ الشرق الأوسط وحضارته، حصلت على الدكتوراه من جامعة مونستر Munster في ألمانيا في الدراسات الإسلاميّة.
تولت العديد من المناصب منها أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربيّة في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة. ثم عينت مديرة لمركز الدراسات العربيّة المعاصرة بالجامعة نفسها في الفترة من 1993 حتى الآن، لها العديد من المؤلّفات منها: (النساء في القرآن وفي الحديث وفي التفسير)، و(التطور الديني والسياسي، بعض الأفكار حول ابن خلدون وميكيافيللي)، وعدد كبير من البحوث عن الدراسات الإسلاميّة؛ وبخاصة في ما يتعلق بالمرأة في الإسلام؛ قديمًا وحديثًا.
وهي عضو مؤسس في المجلس الأمريكي لجمعيات الدراسات الإسلاميّة، وعضو في الجمعية الاستشراقيّة الأمريكية، وعضو الرابطة الأمريكية لمعلمي اللغة العربية.
قوي الاهتمام بالاستشراق في روسيا في بداية القرن التاسع عشر حينما أنشأت بعض الجامعات الروسية كراسٍ باللغة العربيّة عن الإسلام، ومن هذه الجامعات: جامعة قازان، وجامعة موسكو، وجامعة بطرس برغ، وكلية لازاريف، وغيرها، حيث شجّعت الحكومات الروسية في العهود المختلفة دراسة التراث العربي الإسلاميّ، وخاصة ذلك الذي يتعلّق بالأقاليم الإسلاميّة الواقعة تحت سيطرة روسيا لتوسيع المعرفة بالشعوب الإسلاميّة.
إنّ بدء العمل الرسمي والمنظّم في الدراسات الاستشراقيّة العربيّة الإسلاميّة، كان مع عهد القيصر بطرس الأكبر، عندما أُنجِزَت أوّل ترجمة للقران الكريم عام 1716م إلى اللغة الروسية، وقد قام بها الدكتور (بيتر بوستينكوف) عن الترجمة الفرنسية للمستشرق الفرنسي (ديوري) عام 1643م، تلا ذلك ترجمة أخرى عام 1776م، ولكن أول ترجمة للقرآن من اللغة العربيّة مباشرة إلى اللغة الروسية كانت في عام 1878م، قام بها المستعرب (سابلوكوف) 1854م -1880م، الذي كان يتقن العربيّة إتقانًا جيدًا، وقد تكررت طباعة هذه الترجمة في أعوام 1879م-1898م. وقام المستعرب (موخلينسكي) 1808م - 1877م بترجمة وتفسير القرآن إلى اللغة البيلاروسية والبولندية من أجل التتار المسلمين الذين كانوا على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا.
وقد تواصل هذا الاهتمام ولا سيّما خلال الربع الأخير من القرن نفسه، ففي عهد القيصرة كاتيرينا الثانية، أُرسل عدد من الطلاّب في بعثات لعدد من الدول الأوروبيّة، للتوسّع في تعلّم لغات الشعوب الإسلاميّة في الأقاليم الإسلاميّة، كما تمّ التوسع في الطباعة العربية، ولقد كان لمطابع سان بطرسبرج وقازان شهرة عالميّة في هذا المجال، حيث طُبع العديد من المؤلّفات والكتب الإسلاميّة، ويأتي على رأس تلك المطبوعات، طباعة المصحف الشريف، الذي طبع سنة 1778م، ثم تكرّر طبعه في سنوات لاحقة .
وُلد فاسيلي فلاديمر بارتولد في مدينة سان بطرسبرج في أقصى الغرب الروسي سنة 1869م لأسرة تعود أصولها إلى الألمان الذين استوطنوا روسيا، وكانت أسرته على درجة كبيرة من الغنى والثراء ساعدته في دراساته وأسفاره، وقد استهوته دراسة اللغات وتاريخ الشعوب الشرقيّة، فتخرج في كلية اللغات الشرقيّة في جامعة بطرسبرج سنة 1891م، ثم قرر بعد التخرج السفر ليسمع على كبار المستشرقين في عصره، فاتجه صوب ألمانيا، وتمكّن من سماع محاضرات أساطين هذا اللون من الدراسات مثل أُوجست مولر ونولدكه وغيرهم، ثم قرر السفر إلى بعض بلدان وسط آسيا مثل تركستان ليقف بنفسه على تاريخ هذه الشعوب فيراها رأي العين.
درس التاريخ الإسلاميّ في جامعة بطرسبرج وعمل فيها أستاذًا لتاريخ الشرق الإسلاميّ، اهتم بمصادر التاريخ الإسلاميّ العربية، كما اهتم بدراسة ابن خلدون ونظريته في الحكم.
انتخب عضوًا في مجمع العلوم الروسي ورئيسًا للجنة المستشرقين، له كتابات كثيرة في مجال التاريخ الإسلاميّ.
وله مؤلفات متعددة منها:
«تاريخ تركستان» وهو رسالة ماجستير... وانخرط في السلك الأكاديمي في جامعة بطرسبرج ومنها إلى أعلى المراتب؛ عضوا في المجمع الأكاديمي السوفييتي ليكون له الدور الأكبر في إصدار مجلة علمية مختصة بدراسة الإسلام وهي مجلة «عالم الإسلام» التي صار رئيس تحريرها. في عام 1894م بدأ بارتولد بنشر مقالاته عن الإسلام، مثل «الإسلام المعاصر ومهماته»، و«العلم الإسلاميّ في مكة» التي نشرها في العام التالي، وبعد ذلك بست سنوات كاملة، نشر بارتولد دراسته «الأفكار الثيوقراطية والسلطة المدينية في الدولة الإسلاميّة».
وبعد عام 1916م انصرف بارتولد لتأليف كُتيّبات مبسطة بمنهجية علمية سليمة عن الإسلام والحضارة العربية، فأصدر كتيّبه الأول «الإسلام» الذي يقع في 60 صفحة، وتلاه كتابه «الحضارة الإسلاميّة» ثم كتاب «عالم الإسلام»، وهي الكتب التي لا تزال من أهم شواهد الانصاف في حقل الدراسات الاستشراقيّة للإسلام وشعوبه وثقافته، وإنْ شابها بعض القصور أو الخطأ.
مستشرق روسي. ولد بفيلنل في 4 آذار وتعلم بها، ثم في معهد اللغات الشرقيّة في جامعة بطرسبرج، حيث عكف على دراسة اللغات العربيّة والفارسية والتركية والتتارية والعبريّة والحبشية القديمة، وأرسل في بعثة علمية إلى الشرق العربي، فأقام عامين (1908 -1910م) في سورية ولبنان وفلسطين ومصر ولما عاد إلى بلاده عُيّن مديًرا لمكتبة فرع اللغات الشرقيّة في كلية لينيغراد، فمدرّسًا للعربيّة فيها، وجعل من أعضاء أكاديمية العلوم الروسية في قسم التاريخ واللغات سنة 1921
م وانتخبه المجمع العلمي العربي في دمشق عضوًا مراسلًا سنة 1923 م، وتوفّي في لينينغراد.
من آثاره الرسائل الآتية: ترجمة الشاعر أبي دحبل الجمحي، التعاويذ عند عرب الجنوب الرواية التاريخية وكتبة العرب، حماسة البحتري وأول من اكتشفها في أوروبا، ونظرة في وصف مخطوطات ابن طيفور والأوراق للصولي.
ويمكن أن نقسّم إنتاج كرتشكوفسكي إلى الأبواب التالية:
أ. نشر النصوص العربيّة القديمة.
ب. ترجمات لنصوص عربيّة قديمة.
جـ . دراسات وترجمات للأدب العربيّ المعاصر.
د. دراسات للأحوال الخاصة للعالم العربي:
1. مقال بعنوان: «مصطفى كامل وجولييت آدم، بحث في تاريخ الحركة الوطنية في مصر».
2 . «الشيخ أبو نَضًارة، مؤسس الصحافة الساخرة العربيّة في مصر».
3 . «في الصحافة العربيّة في مصر».
4. «المسألة العربيّة والتعاطف الروسي».
5. «الكُتّاب الروس في الأدب العربي».
وإلى جانب هذه الدراسات والنشرات ألّف كرتشكوفسكي كتابين نال أولهما شهرة واسعة حتى ترجم إلى لغات عدّة، وهما:
1. «بين المخطوطات العربية».
2. «تاريخ التأليف في الجغرافيا عند العرب».
مستشرق روسي ورائد متقدم، بل ومُؤسس، في الدراسات النزارية الإسماعيلية الحديثة. وُلد في سانت بطرسبورج، ودرس التاريخ العربي والفارسي، إضافة إلى التاريخ الإسلاميّ وتاريخ آسيا الوسطى، في كلية اللغات الشرقيّة في جامعة سانت بطرسبورج، حيث تخرج في العام 1911. قام إيفانوف ببحث ميداني عن اللهجات الفارسية والشعر الشعبي في إيران استغرق سنوات عدّة. وبعد ثورة 1917م الروسية استقر إيفانوف في الهند، في كلكتا أولًا حيث قام بفهرسة مجموعات المخطوطات الفارسية الضخمة العائدة للجمعية الآسيوية في البنغال.
وفي العام 1931م قام الآغا خان الثالث بتوظيف إيفانوف عنده للقيام في أبحاث عن التاريخ والأدب الإسماعيليين. تمكن خلالها من التعرف على أعداد ضخمة من نصوص الأدب الإسماعيلي، التي صنفها في كتابه «المرشد إلى الأدب الإسماعيلي»، فكان هذا العمل أول فهرس بالمصادر الإسماعيلية في الأزمنة الحديثة.
كما لعب إيفانوف دورًا فعالًا في تأسيس الجمعية الإسماعيلية في بومباي سنة 1946م برعاية الآغا خان الثالث، وأصبحت جلّ دراساته الإسماعيلية الكثيرة وتحقيقاته للنصوص الإسماعيلية وترجمتها، لا سيما تلك المتعلّقة بالمصادر النزارية، تصدر عبر سلسلة منشورات الجمعية الإسماعيلية. أمضى إيفانوف العقد الأخير من حياته في طهران، حيث توفي فيها ودفُن سنة 1970م.
«فهو متخصص بالدراسات (النزارية)، زار آلموت [قلعة آلموت (|Alamūt|)] مرّتين لدراستها على الطبيعة والتأكد من بعض ما ورد عنهم وعنها». ومن آثاره المخطوطات الإسلاميّة في المتحف الأسيوي، وثائق جديدة لدراسة الحِجاج وعقيدة الفاطميين.
(عاش1871- 1942م) اهتم بدراسة التاريخ العربي والإسلاميّ وكذلك اللغات السامية وتاريخ الشعوب الناطقة بالتركية ولا سيما تتار القرم الذين ينتمي إليهم عن طريق والده.
درس في جامعة موسكو في الفترة من 1892م إلى 1896م اللغات السلافية والعربيّة والفارسية. عاش في سوريا في الفترة من 1896م إلى 1898م، عمل أستاذًا للعربيّة وآدابها في كلية لازاريف، وأستاذًا للعربيّة في قازان من 1898م إلى 1918م. تولى منصب سكرتير مجمع العلوم الأكراني. وترأس قسم الدراسات العليا في خاكوف بعد الثورة البلشفية 1917م.
أصدر كريمسكي العديد من البحوث العلميّة؛ منها:
«دراسة تطور الصوفية حتى نهاية القرن الثالث الهجري» (1895)
«محاضرات حول القرآن الكريم» (1902)
«تأريخ الإسلام» في ثلاثة مجلدات (1903-1904)
«تأريخ تركيا وآدابها» في مجلدين (1910-1916)
«تأريخ العرب والأدب العربي» في ثلاثة مجلدات (1911-1913)
«تأريخ فارس وآدابها وحكمة الدروشة الصوفية» في ثلاثة مجلدات (1909–1917)
«تاريخ الأدب العربي الحديث» (1971)
«نظامي ومعاصروه» (1981) وغيرهم.
تلقى تعليمه على يد المستشرقين روزين وجولدزيهر، تخصص في دراسة اللغة العربيّة والتاريخ الإسلاميّ، عمل أستاذًا في جامعة بطرسبرج مدة عشرين سنة، ثم انتقل إلى طشقند عام 1920م ليؤسس جامعة فيها وكان أول رئيس لها، من آثاره: (تاريخ الإسلام)، و(النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله)، و(محاولة التقريب بين السنة والشيعة)، و(فهرس المخطوطات العربيّة في طشقند).
(137)
كتب المستشرقون كتب كثيرة عن الإسلام والمسلمين؛ بناءً على معتقدات خاطئة ومزاعم مفتراة، هدفها تشويه صورة الإسلام والمسلمين في المجتمع الغربي، وإنْ كان هذا لا يمنع من بروز بعض المؤلّفات المنصفة للإسلام والمسلمين، ومن تلك الكتب المتطرّفة نذكر: تاريخ القرآن لتيودور نولدكه، حياة محمد لسير وليام موير، تاريخ مذاهب التفسير الإسلاميّ لجولدزيهر، مصادر تاريخ القرآن لآرثر جفري، دراسات في تاريخ الثقافة الإسلاميّة لفون جرونيباوم، الإسلام لألفرد جيوم، مقالة في الإسلام لجرجس سال، كتاب مصادر الإسلام لسنكلير تسدل.
وإنّ هذه الأعمال الاستشراقيّة التي كتبت عن الإسلام من كثرتها ألّفت عنها دراسات ببلوغرافية تحصي الدراسات والمقالات، نذكر على سبيل المثال: كتاب (كتابشناسي خاورشناسان) الذي دوّنته مجموعة من الباحثين والمترجمين، وصدر عن (انتشارات بين المللي الهدى) في طهران عام 1993م، وكتاب (طبقات المستشرقين) للدكتور عبد الحميد صالح حمدان، وكتاب (المستشرقون) لنجيب العقيقي، و(موسوعة المستشرقين) لعبد الرحمن بدوي.
وسنتعرض لنماذج من مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة وغيرها، طبعًا ما عدا القرآن الكريم وعلومه؛ لأنّه سيأتي الحديث عنه في الفصول القادمة.
حظيت السنّة النبويّة الشريفة، والسيرة النبويّة كذلك باهتمام منقطع النظير من قبل الباحثين المستشرقين ومن المدارس المختلفة، وإنْ اختلفت الدراسات والأبحاث؛ كمًّا ونوعًا، فالاستشراق الألماني، والبريطاني اهتمًا بشكل واضح بالسيرة النبويّة، والسنّة الشريفة، فتُرجمت السير والمغازي والملاحم، ووُضعت المصنّفات المرتبطة بشخص الرسول وسيرته المباركة، بينما نجد الاستشراق الهولندي مع أنّه
يعتبر من أهمّ المدارس الاستشراقيّة الأوروبيّة ولكنّه انصبّ جهده على الأدب واللغة العربيّة واللغات بشكل عام أكثر من اهتماهه بالسيرة والسنّة.
وقد تعدّدت الكتابات الحديثة في بيان موقف المستشرقين من الحديث الشريف أو السنة النبويّة المطهّرة، ومناقشة شبهاتهم حولها، مثل شبهة تأخّر تدوين السنّة، وشبهة تطوّر الإسناد، وشبهة اهتمام المحدّثين بنقد سند الحديث وإهمال نقد المتن، وغير ذلك من الشبه. كما تناولت بعض الدراسات نقد مناهج المستشرقين في دراستهم لعلم الحديث والسيرة النبوية.
وهناك إشكالات متعدّدة وشبهات نسجتها الدراسات الاستشراقيّة على السنة النبوية وهناك شبهات يمكن اعتبارها مشتركة بين كل الدراسات الاستشراقيّة، نذكرها على الشكل الآتي:
1- مفهوم السنة النبوية عند المستشرقين.
2- الطعن في رسالة النبيّ.
3- الطعن في شخصية النبيّ ومنها:
• زعمهم انشعالة بالنساء.
• زعمهم اهتمام الرسول بالغنائم والسلب.
الطعن في الأحاديث النبوية سندًا ومتنًا.
هو مستشرق نمساوي. اشتغل في مدرسة دهلي ومطبعة كالكوتا في الهند عام 1842. تجنس بالجنسية الإنجليزية، واشتهر بكتابه عن حياة النبيّ محمد . وهو أول من نشر كتاب الإتقان للسيوطي، والإصابة لابن حجر، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، كما كتب عددًا من المقالات في السنَّة النبويَّة.
مستشرق أسكتلنديّ. يعدّ من مشاهير المستشرقين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر، صنَّف العديد من المؤلفات، بحث فيها التاريخ الإسلاميّ منذ البعثة النبويَّة الشريفة حتى سقوط المماليك الشراكسة وزوال الخلافة العباسية في مصر على أيدي العثمانيين.
ومن مؤلفاته نذكر: حوليات الخلافة، أصدره عام 1853م؛ وهو كتاب تناول فيه الخلفاء الراشدين حتى نهاية الدولة الأموية، والقرآن: تأليفه وتعاليمه، وتاريخ
دولة المماليك في مصر، والتي وصفت من قبل بعض الباحثين بأنّها مراجع علمية في الجامعات الإنجليزية والهندية، لكن عبد الرحمن بدوي أكد أنّ مؤلفات موير جميعًا تسودها نزعة تبشيرية شديدة التعصّب.
وكتاب حياة محمد وتاريخ الإسلام أصدره بين عامي (1856-1861م)، وقال عبد الرحمن بدوي عن محتوى هذا الكتاب، إنّه عبارة عن مقالات كتبها المستشرق عن تاريخ العرب قبل الإسلام ومصادر السيرة النبوية وحياة الرسول الكريم حتى الهجرة، ثم جمعها وأضاف إليها مقدمة طويلة عن المصادر وأصدرها في كتاب ضخم من أربعة أجزاء. وذُكِرَ له بحث آخر بعنوان (سيرة النبيّ والتاريخ الإسلاميّ) عدَّه البعض مرجعًا معتمدًا في الجامعات الإنجليزية والهندية لما يحتويه من شمول الشرح ودقَّة المعلومات المسندة إلى المصادر الإسلاميّة.
هو مستشرق يهودي مجري عُرف بنقده للإسلام وبجدّيّة كتاباته، ومن محرّري دائرة المعارف الإسلاميّة، ولقد اشتهر بغزارة إنتاجه عن الإسلام حتى عد من أهم المستشرقين لكثرة إسهامه وتحقيقاته عن الإسلام ورجاله، متأثرًا في كل ذلك ربما بيهوديته. وهو أبرز من قام بمحاولة واسعة وشاملة لنسف السيرة النبوية.
من أهم كتبه: (العقيدة والشريعة في الإسلام) نقله إلى العربيّة الدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور محمد يوسف موسى، والأستاذ عبد العزيز عبد الحق، كما توجد له كتب أخرى، كالحديث في الإسلام، صدر عام 1909م، وكتاب مذاهب التفسير الإسلاميّ، وأخوان الصفا 1910م، والمعتزلة والمترادفات العربيّة عام 1918م، والمجلية الآسيوية البريطانية 1912م، ودراسات عن النبيّ، صلىاللهعليهوآله، وقد علق الشيخ محمد الغزالي على كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام بقوله: والحق أن الكتاب من شر ما ألف عن الإسلام، وأسوء ما وجه إليه من طعنات.
قد تقدمت ترجمته.
بدأ في عمل معجم مفهرس لألفاظ الحديث الشريف مستعينًا بعدد كبير من الباحثين وتمويل من أكاديمية العلوم في أمستردام ومؤسسات هولندية وأوروبية أخرى. وأصدر كتابًا في فهرسة الحديث ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي بعنوان (مفتاح كنوز السنة).
تقدَّمت ترجمته، هو متخصص في الفقه الإسلاميّ وأحاديث الأحكام، ويعد خليفة جولدتسيهر في مجال الدراسات الإسلاميّة. وقد كان لآرائه أثر كبير في كتابات من جاء بعده من المستشرقين.
الميدان الحقيقي الذي برّز فيه شاخت هو تاريخ الفقه الإسلاميّ. وأهم ما له في هذا الباب كتابه الرئيس: «بداية الفقه الإسلاميّ» أكسفورد 1950، ويقع في 350 صفحة، وأعيد طبعه The Origins of Muhammadan Jurisprudence وقد درس فيه خصوصًا مذهب الإمام الشافعي، استنادًا إلى «الرسالة» للإمام الشافعي. ويتلوه في الأهمية كتيّب صغير بعنوان: «مخطط تاريخ الفقه الإسلاميّ»، وقد ترجمه إلى الفرنسية Arin، ونشر في باريس 1953 في 91 Esquisse d’une Histoire du droit Musulman .
تخرّج في اللغات الشرقيّة من جامعة جلاسجو. وعين مساعد أستاذ اللغة العبريّة فيها (1915ـ 16) وتنقلّ بين العراق والهند (1916 ـ 18) واختير معيدًا للإنجليزية في لاهور (1918 ـ 19) ثم قصد عدن (1919ـ 26) وعين وزيرًا في شاندون
(1926 ـ 28) ومعيدًا للعربيّة في جلاسجو(1928 ـ 1948) ثم محاضرًا (1949) وأستاذًا للعربيّة في جامعة مانشستر (1949).
من كتبه: المسيح في الإسلام (1928)، وآلات الطرب العربيّة القديمة (1938)، وذم الملاهي لابن أبي الدنيا (مقالات في سماع الموسيقى. لندن 1938 ثم ترجمه إلى
الإنجليزية) والملاهي لأبي طالب المفضل بن سلمة النحوي اللغوي عن مخطوط في الآستانة بجميع صوره (جلاسجو 1938، ثم ترجمه إلى الإنجليزية)، وفهرس المخطوطات الشرقيّة في مكتبة جامعة جلاسجو، وقد نشره مولر وير (الدراسات السامية الشرقيّة، جلاسجو 1945)، والمدخل إلى علم الحديث (1953). وغير ذلك .
إن ّفريقًا من المستشرقين يعتقد أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله مخلصٌ قولًا وعملًا، ولكنه يخبر بما خيل إليه أنّه رآه أو سمعه وهو في حالة غيبوبة.
وفريق يقف من محمد موقف المرتاب أو الجاحد المنكر. وفريق يزعم أنّ محمدًا استمد القرآن من مصادر يهودية، وبالأخص العهد القديم، وكذلك من مصادر نصرانية.
والسنة التي هي قول النبيّ وفعله وتقريره، يرى الدكتور الدسوقي أنّ المستشرقين يكادون يجمعون على أن السنة لم تعرف التدوين إلا في القرن الثاني، وهذا يعني أنّه لم يكن هناك تدوين في القرن الأول لا في حياة النبيّ ولا في حياة الصحابة من بعده، ثم تعد الكتب المعول من السنة لدى المسلمين ليست صحيحة كلها وأنّ كتابًا كالبخاري على حد تعبير بعض المستشرقين يشتمل على أمور كثيرة يود المؤمن الصادق أنّه لم ترد فيه.
ومنهجهم في دراسة السنّة أي كتب الأحاديث يعتمد تكذيب الأحاديث المروية في الصحاح، يقول «هربلو» أن جملة الأحاديث التي في الكتب الستة والموطأ والدارمي والدارقطني والبيهقي والسيوطي مأخوذة إلى حد كبير من التلمود.
وهم ينتقدون طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الأحاديث لاحتمال الدسّ في سلسلة الرواة، ويقرّون بأنّ الأسانيد أضيفت إلى المتون بتأثير خارجي، لأنّ العرب لا يعرفون الإسناد.
ويرى «موريس بوكاي» أنّ الأحاديث في صحيح البخاري مشكوك فيها.
ويمكن تلخيص رؤية علماء الاستشراق للسنة النبوية بالأفكار الرئيسة الآتية:
يركّز عدد من المستشرقين وعلى رأسهم جولدتسيهر وشاخت على أنّ الحديث والسنّة وضعت نتيجة التطوّر والتحوّل في الحركة الاجتماعيّة للمسلمين. ففي هذه النظرية لا حاجة للحديث عن الأحاديث الضعيفة والصحيحة أو حتى الموضوعة؛ لأنّ الحديث ظاهرة لم تكن في زمن النبيّ أصلًا؛ إنّما استحدثت بعده نظرًا لحركة التطور والتحول في البيئة العربيّة والإسلاميّة.
وملخّص الفكرة:
• واجه المسلمون وضعًا جديدًا نتيجة الفتوحات
• انتج هذا الوضع مجموعة من الأسئلة وفي مختلف المجالات: الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، و...
• لا يمكن إهمال هذه الأسئلة بل لا بد من أجوبة عن كل شيءٍ مستجدّ
• لا بد أن تمتلك هذه الأجوبة حظًّا من المشروعية والقدسية
• الإجابات القرآنيّة محدودة ولا تسع كل الأسئلة
• فكانت السنّة هي الملجأ لذلك، وتم وضع السنة على الشكل الآتي:
ـ تحويل الأفكار إلى نصوص.
ـ نسبة هذه النصوص إلى النبيّ لتملك نفوذًا وسلطانًا.
الفكرة الأساس التي ينطلق منها جملة من المستشرقين هي أنّ إسناد الحديث لم يعهده المسلمون في القرن الهجري الأول، بل عندما كانوا يتحدّثون عن النبيّ وأقواله وأفعاله لم يكونوا يذكرون السند، بل كانوا ينسبون ذلك مباشرةً إلى النبيّ، وفي القرن الثاني الهجري وبعدما تطوّرت الأمور وظهرت الحاجة للإجابة عن كثير من التساؤلات، ظهرت فكرة الإسناد، كي يؤكّد الجميع أن ما عندهم معلوم النسبة للنبي وليس مختلق.
ويشير جولدتسيهر إلى فكرة تتعلّق ببُنية الحديث، حيث يرى أنّ الأحاديث الصحيحة لا تختلف عن غيرها في مكوّناتها الدلالية والأدبية، أي ما نطلق عليها المتن فهو يريد أن يقول لا فرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف متنًا وإن اختلف الإسناد، فالإسناد لا يغيّر شيئًا، وهو يريد أن يصل إلى فكرة مفادها أنّه لو كان هناك حديث صحيح واقعًا لظهر اختلاف في تركيبة الأحاديث الصحيحة وغيرها، وهو أمر لا نجد أنّ علم السند يوفّره لنا.
وتعتمد حجج المستشرقين ونتاﺋﺠﻬﻢ على نظرتهم إﱃ الحديث اﻟﻨﺒــــﻮي وفق النتاﺋﺞ اﻟـﱵ وﺿـﻌﻬﺎ اﳌﺴتشـﺮق إﺟﻨـﺎﺗﺲ ﺟﻮﻟﺪﺗﺴـﻴﻬﺮ في كتابه Muhammedanisch Studien: دراسـﺎت محمّدية وﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﻌــﺪ ﺟﻮﻟﺪﺗﺴـﻴﻬﺮ اعتمد ﻋﻠــﻰ آراﺋــﻪ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻫــﺎ ويرى «أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ بمكان أن ﻧﻨﺨـﻞ أو نميز وﺑﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻛﻤﻴـــﺔ الحديث الكبيرة اﻟﻮاسـﻌﺔ ﻗﺴـﻤًﺎ ﺻـﺤﻴﺤًﺎ يمكننا نسبته إﱃ النبي أو إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻪ» وﺗﻮﺻﻞ ﺟﻮﻟﺪﺗﺴـﻴﻬﺮ إﱃ النتيجة الآتية: «أنّ الحديث اﻟﻨﺒـﻮي وﺟــــﺪ نتيجة للتطور الديني والتاريخي والاجتماعي اﻹسـﻼﻣﻲ ﺧﻼل القرنين الأولين ﻟﻠﻬﺠـﺮة».
تبنى «شاخت» نظرية «إﺟﻨـﺎﺗﺲ ﺟﻮﻟﺪﺗﺴـﻴﻬﺮ» حول السنّة إلا أنّه أضاف فكرة أخرى؛ وهي: أﻧّﻪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋـﺎدة الجيلين ﻣـــﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ سبقوا اﻟﺸـافعي أن ﻳﻨﺴـﺒﻮا اﻷﺣﺎدﻳـﺚ إﱃ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ والتابعين، وﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أنّهم ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺴﺒﻮنها إﱃ النبي صلىاللهعليهوآله. ووﺻـﻞ إﱃ نتيجة مفادها: أنّ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﺴـﻮﺑﺔ ﻟﻠﺼـﺤﺎﺑﺔ والتابعين سـﺒﻘﺖ ﰲ وﺟﻮدﻫـﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﺴـﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨـﱯ وﻫـﻮ ﺑـﺬﻟﻚ يودّ أن ﻳﻘﻠـﻊ ﺟـﺬور اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹسـﻼﻣﻴﺔ، ويقضي على تاريخ التشريع اﻹسـﻼﻣﻲ ﻗﻀﺎءً ﺗﺎﻣًّﺎ، ولهذا فقد وصف اﻟﻌﻠﻤﺎء المسلمين ﺧﻼل اﻟﻘــﺮون اﻷوﱃ بأنّهم ﻛﺎﻧﻮا كذّابين وملفّقين وغير أمناء.
ومعنى هذا الكلام أنّه لا يوجد علاقة بين كثير من العلوم الإسلاميّة؛ كالحديث والتفسير، والحديث والفقه، فالفقه لم يخرج من رحم الحديث؛ وإنّما من رحم الأفكار والعادات والأعراف والتوجّهات التي عرفتها الأجيال بعد النبيّ، ففي البداية كان الفقه وليد الأوضاع الجديدة ونتيجةً للمجهود البشري، ثم نسب إلى الصحابة والتابعين، ثم في القرن الثاني الهجري بدأ ينسب إلى الرسول، وهذا يعني أنّ النسبة للنبي وتكوّن الإسناد وتطوّره قد مرّا بمراحل تدريجية، ويرجع شاخت ولادة اختلاق الأحاديث إلى بداية القرن الهجري الثاني أو على أبعد تقدير القرن الأول.
ويقول المستشرق البريطاني نورمان كولدر: «إنّ شاخت ﻛﺴﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ التاريخية ﺑﲔ الحديث واﻟﻔﻘﻪ. واﻟﺬي ﺑﻴّﻨـﻪ ﻟﻨـﺎ هو أنّ اﻟﻔﻘـﻪ ﻛـﺎن ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻇﻬــﻮرﻩ منفصلًا عن الحديث، وأنّ أصول الفقه الإسلاميّ الحقيقية عنده ترجع إلى العادات الحية السائدة للمدارس الفقهية المحلية».
والنتيجة عند شاخت ومن تبعه هي: إنّ ﻛﻞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ لم يكن لها وجود أصلًا، بل اخْتُرِعَتْ ووُضِعَتْ خلال منتصف القرن الثاني الهجري، فالأسانيد التي نراها مع الأحاديث إنّما هي كلّها موضوعة.
(147)إنّ أشهر من صنَّف في السيرة النبويّة: جولدتسيهر، ومونتغمري وات، وجوستاف لوبون، وستانلي بول، وغيرهم، ومن بين هؤلاء المؤلّفين نجد من أنصف شخص الرسول وسيرته المباركة، ولكن بشكل عام نجد في كتب السيرة الاستشراقيّة نوعًا من التشويه المتعمّد أو غير المتعمّد للرسول وسيرته، وهناك من المستشرقين من وضع منهجية لكتابة السيرة، وسار عليها أغلب الباحثين بعده في هذا المجال وأدّى ذلك إلى تحريف صورة النبيّ وسيرته.
يعدّ المستشرق البريطانيّ ستانلي بول أحد المستشرقين المرموقين في القرن العشرين، وله تآليف عديدة حول العرب والإسلام، وقد تناول سيرة النبيّ محمّد بالتحليل في دراسة أعدّها ونشرتها مجلة Islamic Review عام 1956 أي عقب وفاته بأكثر من عقدين.
وفي هذه الدراسة يغاير بول منهج المستشرقين الأوائل الذين درسوا سيرة النبيّ محمد مثل إيجانس جولدتسيهر والذين عمدوا إلى تشويه صورة النبيّ وتصويره على أنّه إنسان يعاني نوبات صرعيّة وشهوات جسمانيّة تدفعه إلى الإفراط في الزواج، أما ستانلي فيبدو أكثر اعتدالًا وحياديّة:
أ. يفتتح دراسته بالقول: إنّه لا يسع المرء إلّا أن يشير إلى كون النبيّ إنسانًا متسامحًا مع أعدائه ويعرض جملة من المشاهد الدالّة على ذلك، مستخلصًا من ذلك كلّه إلى أنّ القوّة لم تكن جزءًا من طبيعته وتكوينه.
ب. يخفّف ستانلي بول من حدّة الصورة النمطيّة للنبيّ الأكرم في الكتابات الاستشراقية، فيناقش المسائل الشائكة المتعلّقة بشهوانية النبيّ، فمن يشاهد-حسب ستانلي- تقشفه في طعامه وحصيره القاسي الذي ينام عليه وتعبده بالليل شواهد تجعله أقرب للراهب، وأما زيجاته فقد كانت مدفوعة إمّا بعوامل إنسانية بعد سقوط بعض الأزواج في معارك وتركهم زوجاتهنّ دون حماية، أو بعوامل سياسية للتأليف بين الأحزاب، وهكذا في مسألة انتشار الإسلام بالسيف، وغير ذلك، فهو وإن كان لم ينسف هذه المقولات الاستشراقيّة؛ وإنّما خفف فقط من غلوائها.
ج. يصف النبيّ بقوله: «كان محمد صلىاللهعليهوآله رؤوفًا شفيقًا؛ يعود المريض، ويزور الفقير، ويُجِيب دعواتِ العبيد الأرقاء، وقد كان يُصلِح ثيابَه بيدِه؛ فهو إذًا -لا شكَّ- نَبِي مقدَّس، نشأ يتيمًا مُعْوِزًا، حتى صار فاتحًا عظيمًا».
د. أمّا في قضية النبوة فهو لا يخالف فيها رأي المستشرقين السالفين حيث يعتقد أنّ محمدًا قد آمن في نفسه إيمانًا راسخًا بأنّه رسول موحى إليه، وأنّ تصوره عن الألوهية ليس وحيًا؛ وإنّما هو تصوّر خاص لم يخرج عمّا فهمه عقل الساميين دائمًا من كون الإله قادر على فعل كل شيء، وعليم بكل أمر، ولا يظلم الناس شيئًا، وأمّا القوة فهي من أهم صفاته العليّة لكنها مقرونة دومًا بالرحمة والغفران. وبهذا الفهم استطاع محمد «إيجاد الشكل الوحيد من التوحيد الذي يلائم كل الطوائف الكبيرة في العالم الشرقي»، حيث لم تستطع المسيحيّة قط أن تهيمن على الشرق بفعل رؤيتها التثليثية للإله.
(149)
وقبل عرض منهج «مونتغمري وات» نشير إلى أنّ (وات، وبركلمان، وفلهاوزن) اتبعوا مناهج عديدة في دراسة السنّة؛ وهي:
• منهج الأثر والتأثر.
• المنهج العلماني.
• المنهج المادي.
• المنهج الإسقاطي.
• منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ.
• منهج البناء والهدم.
سنشير إلى بعض من هذه المناهج، لأنّ التفصيل في كل المناهج يحتاج إلى دراسة مستقلّة لمناهج المستشرقين لدراسة السنّة.
إنّ دراسة المستشرق البريطاني «مونتغمري وات» -والذي تقدّمت ترجمته- للسيرة النبوية في كتابيه «محمد في مكة» و«محمد في المدينة» وقدم خلالهما رؤية وصفت بأنّها شاملة ولاقت تقديرًا كبيرًا ليس في الغرب وحده؛ وإنّما في الشرق حيث ترجم كتابَيه مرّات عدّة إلى اللغة العربية، ونستطيع القول وللأسف إنّ أغلب الدراسات الاستشراقيّة القديمة والحديثة تعكس هذه العقلية والمنهجية المتعصّبة وغير المنصفة في دراسة شخصيّة النبيّ وسيرته المباركة.
أشار مونتغمري وات في مقدمة كتابه محمد في مكة إلى منهجه أو ما أسماه (standpoint) في كتابة السيرة، موضحًا أنّ دراسته موجَّهة إلى المؤرّخين بالأساس، وأنّه سيلتزم بالحياد في القضايا المختلف بشأنها بين الإسلام والمسيحيّة، وبما تمليه
عليه قواعد البحث التاريخي التي تقتضيه ألا يرد أو يدحض أيًّا من مبادئ الإسلام الرئيسة. غير أنّ هذه لم تكن جميعها معالم المنهج لديه فقد استنبط عبد الله النعيمي في كتابه الاستشراق في السيرة النبوية بعضًا من معالم منهجه؛ ومنها:
أ. منهج التأثير والتأثّر، ويعني به تأثر الإسلام بالديانات السماوية في الجزيرة العربية، وقد حدث ذلك عبر ورقة ابن نوفل وبحيرا الراهب اليهودي، وهذا التأثر يبدو جليًّا في توجّه المسلمين في صلاتهم نحو القدس، وصيام عاشوراء، وصلاة الجمعة، وتحليل طعام أهل الكتاب، وهذا التأثّر يحمل على الاعتقاد أنّ الإسلام ليس إلا مزيج ملفّق من الديانتين اليهودية والمسيحيّة، وأنّ «الرسول قد صاغه على شاكلة الدين الأقدم».
ب. التأويل المادي للنبوة والمعجزات النبوية، وهي معلم آخر من معالم المنهج لدى مونتغمري وات ويشاركه فيه عدد لا بأس فيه من المستشرقين، فهو يعلّق على واقعة شقّ الصدر بالقول «إنّ هناك العديد من القصص ذات الطابع الديني يكاد يكون من المتيقن بأنّها ليست حقيقة من وجهة نظر المؤرّخ العلماني».
أما نبوّته فهي ليست حقيقة واقعيّة؛ وإنما هي محض تخيل من الرسول، إذ هناك ما يؤكد من الناحية التاريخية نزول جبريل بالوحي عليه، وهذا الإنكار للنبوة والوحي يؤكّده بقوله «إنّ القول إنّ محمدًا كان صادقًا -في ادعائه النبوة- لا يعني أنّ القرآن وحي وأنّه من صنع الله، إذ يمكن أن نعتقد بدون تناقض أن
محمدًا كان يعتقد أنّ القرآن ينزل عليه من الله، وأنْ نؤمن في ذات الوقت أنّه كان مخطئًا»، وهو يرجع مصدر الوحي المحمدي إلى «اللاوعي الجماعي» الذي هو مصدر كل وحي ديني سواء كان الإسلام أم المسيحيّة أم اليهودية، ويختم رأيه في مسألة النبوة بالقول: إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله «رجل تجسّد فيه التخيّل الخلّاق حتى الأعماق فاستطاع أن ينتج أفكارًا وثيقة الصلة بقضية الوجود الإنساني».
ج. التفسير الاقتصادي للغزوات والفتوحات، فيذكر مونتغمري أن مؤرخ القرن العشرين ينبغي أن يسأل أسئلة كثيرة عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التي بدأها محمد صلىاللهعليهوآله من غير أن يتجاهل جوانبها الأيديولوجية، وهو يفسّر حركة الفتوح الإسلاميّة انطلاقًا من العامل الاقتصادي، ويذهب إلى أنّها جاءت ردّ فعل على المشكل الاقتصاديّ الذي ظهر في عهد النبوة والمتمثل في زيادة السكان بفعل توقف الحروب القبلية، فكان هناك ضرورة للبحث عن متنفّس للطاقة يستطيع في ذات الوقت أنْ يحقق موارد مالية، وبفعل هذا اندفع المسلمون منذ العهد النبوي في حركة فتوح خارجية لتأمين الرفاهية الاقتصادية.
يمكن القول إنّ المنهج الاستشراقي في التعامل مع السيرة النبويّة قد تميّز بعدد من الخصائص المميّزة؛ منها:
نفي النبوة عن النبيّ محمد وإنكار ظاهرة الوحي.
والتأكيد على أهميّة التأثيرات اليهوديّة والمسيحيّة ونفي الخصوصيّة عن دين الإسلام.
والتركيز على الجانب الماديّ السياسيّ والاقتصاديّ في السيرة النبويّة وتهميش الإصلاحات الاجتماعيّة والتربويّة والفكريّة الأخرى.
(152)نالت العقيدة الإسلاميّة والفِرق في التاريخ الإسلاميّ اهتمامًا خاصًا، فنجد في مواد «الموسوعة الإسلاميّة» مواد كثيرة تتعلّق بالعقيدة. وهناك كتب وأبحاث متعدّدة؛ منها: ما كتبه فون كريمر «تاريخ الفِرق في الإسلام»، وهوتسما «العقيدة الإسلاميّة والأشعري»، كما قام شبرنجر بإعداد «فهرست كتب الشيعة». ومنها ما كتبه مونتغمري وات بعنوان: «الجبر والاختيار في الإسلام المبكر». وقد كان هذا البحث عنوان رسالته لنيل درجة الدكتوراه. كما اهتم عدد من المستشرقين بالفرق في التاريخ الإسلاميّ، ومن هؤلاء لويس ماسنيون Louis Massingion والمستشرق برنارد لويس. فقد اهتم الأول بالحلاج المتصوف الذي أطلق عليه (شهيد الإسلام) وأنفق حياته في تحقيق كتاباته ونشرها. أما الثاني فقد كتب حول الإسماعيلية والحشاشين وغيرهم من الفرق.
ومن المستشرقين الذين اهتمُّوا بالتصوّف: المستشرق الإنجليزي آربري؛ حيث كان ينصح طلابه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بدراسة قضايا تتعلق بالتصوّف.
توافر عددٌ من المستشرقين على دراسة العقيدة الإسلاميّة من خلال دراسة القرآن الكريم والسنّة النبوية والسيرة والتاريخ الإسلاميّ، وزعموا: «عدم أصالة الإسلام واعتماده على الأديان السابقة»، وأصبحت هذه النتيجة كما قال أحد المستشرقين: «(موضة) بين عموم المستشرقين»، ولكي يصلوا إلى هذه النتيجة قاموا بتجزئة أمور العقيدة الإسلاميّة إلى أجزاء متناثرة، وحاولوا إرجاعها إلى مصادر أخرى في الأديان السابقة، ولا شكّ أنّ هذا المسلك محاولة لنفي تميُّز الأُمَّة الإسلاميّة، وذلك بزعم نسبة عقيدتها إلى أخلاطٍ من اليهودية والنصرانية والوثنية.
وحاول جملة من المستشرقين تشويه المعتقدات الأساس في الإسلام فزعم «جولدتسيهر» أنّه من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه في العقيدة موقفًا متجانسًا خاليًا من التناقضات فالتوحيد مذهب مبني على النقائض العسيرة على الفهم، أما التثليث فمذهب واضح في فهم الألوهية. وربما كان بهذه التهمة يستهدف أن يسوّي بين الإسلام والمسيحيّة في تطور العقيدة وتدرج الإيمان.
والقسّ «زويمر»: يرى أن المسلمين وإنْ كانوا موحّدين، فإنّ إلههم ليس إله قداسة ومحبة.
ولبيان نظرة المستشرقين للعقيدة الإسلاميّة سنقسم العناوين على الشكل الآتي:
• زعم (يوحنا الدمشقي): «أنّ الإسلام زندقة مسيحيَّة نسطورية الأصل والمضمون، وأنّ محمدًا لم يكن نبيًا مرسلًا، بل صاحب نبوة منتحلة مبتدعة: Pseudo-Prophentes جاء العرب من قومه بكتاب مُخْتَلَقٍ، جمع أشتات مادته من راهب من أتباع آريوس المنشق عن الكنيسة، وأنّه إنّما ملك قلوب أتباعه بما كان يصطنع من ورع وتقوى كاذبة».
• ألَّفَ (ثيوفانس): المؤرّخ البيزنطي الشهير كتابًا عن حياة محمد؛ عُدَّ من بعده مرجعًا معتمدًا وموثقًا يستمد اللاحقون منه مادتهم عن الإسلام، جاء فيه: «... توفي عام 632 للميلاد حاكم العرب ونبيهم الكذّاب (ماومود - Mouamed) الذي أضلَّ بمكره وسحره في أول أمره جمعًا من اليهود الذين اعتقدوه باطلًا بأنّه المسيح المخلص الذي ينتظرونه، فآمن به عدد من أحبار اليهود، ودخلوا في عقيدته، وارتدوا عن دين موسى الذي كانوا عليه».
• صُوِّر الرسول صلىاللهعليهوآله على أنّه: الصنم المعبود عند أتباعه، وصُوِّر كذلك المسلمون على أنّهم: «وثنيين يعبدون مجمعًا من الأوثان المعبودة مشخصة في صور تماثيل مصنوعة من الذهب والفضة يتقرب إليها وتعبد وفق تقاليد وطقوس معينة، ويستثار رضاها ويلتمس عونها في الحروب والقتال ضد النصارى، حتى إذا فشل العرب في القتال، وغالب أمرهم أن يفشلوا، لعنت الآلهة وشتمت ودست في التراب».
هذه نبذة مختصرة عن صورة العقيدة الإسلاميّة لدى الغرب في عصورهم الوسطى، وإن كانت هذه الصورة أصبحت مرفوضة في أعراف المستشرقين في العصر الحديث، وقد وجهوا لها انتقادات حادَّة ووصفوها بالتعصب والجهل والحماقة، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل جاءت الدراسات الاستشراقيّة في ما بعد أقرب إلى الانصاف والبحث العلمي المجرد عن الأحقاد التاريخيَّة الموروثة، والتعصّب الديني المقيت؟
ولكنْ للأسف الذي يراجع الدراسات الاستشراقيّة التي جاءت بعد العصور الوسطى يجد أن صورة النبيّ والإسلام والعقيدة الإسلاميّة ما زالت على حالها أن لم نقل ازدادت سوءًا.
يقول (ستوبرت) في ذلك: «لقد تأثر محمد صلىاللهعليهوآله بمعتنقي ديانتي التوحيد: اليهودية والمسيحيّة، إذ لم يبخل عليه الأحبار والرهبان بالمعلومات التي تتعلق بهاتين الديانتين، وتشهد بذلك كتب السيرة عند المسلمين أنفسهم».
وقد عقد إميل در منغم في كتابه (حياة محمد) فصلًا بعنوان: (النصرانية والإسلام)، تطرَّق فيه إلى هذا الادّعاء.
ولكارل بروكلمان أقوال متناثرة في كتابيه: (تاريخ الأدب العربي وتاريخ الشعوب الإسلاميّة) تشير إلى الفكرة نفسه.
و(لجولدتسيهر) في كتابيه: العقيدة والشريعة، ومذاهب التفسير الإسلاميّ أقوال تشكك في العقيدة الإسلاميّة ففي كتابه الأول تركزت تلك الأقوال على أربع مزاعم، هي:
• أنّ القرآن من صنع محمد.
• أنّ الحديث النبوي من صناعة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية.
• التشريع الإسلاميّ مستمد من القانون الروماني.
• أنّ الجيوش الإسلاميّة لم يكن باعثها الإيمان، وإنما الذي أخرجها من الجزيرة العربيّة القحط والجوع».
وممّا يخصّ مجال العقيدة: زعم بأنّ الإسلام: «ليس إلا مزيجًا منتخبًا من معارف وآراء دينية عرفها (محمد) بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحيّة». وأنّه لم يأتِ بجديد.
يكاد هذا الموقف من العقيدة الإسلاميّة أن يكون متأصلًا في دراساتهم الاستشراقيّة والذي يؤكّد ذلك ما وردت في الموسوعات ودوائر المعارف التي كتبها هؤلاء ونعرض بعضًا منها نماذجًا على ذلك:
• تقول دائرة المعارف الإسلاميّة تحت مادة (السامرة):
«وما من أحد يشك في تعدد مصدر الأصول التي استقى محمد منها معارفه، وكثيرًا ما جرى القول بتأثير اليهودية والنصرانية فيه...».
• جاء في دائرة المعارف البريطانية: «إنّ صورة اللَّه التي تتداخل فيها صفات القوة والعدل والرحمة ذات صلة بالتراث اليهودي المسيحيّ، حيث استمدت منه بعد أن طرأ عليها بعض التعديلات، وكذلك تتصل بالوثنية التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية» .
• وجاء في موسوعة الحضارة التي أصدرتها هيئة اليونسكو: «الإسلام تركيب ملفَّق من اليهودية والنصرانية ورواسب الوثنية».
بحث المستشرقون المنظومة العقدية كلّها عند المسلمين من التوحيد إلى المعاد، ولا نتمكن في هذا البحث من عرضها بشكل كامل، ولكن سنأخذ منها بعض النماذج التي تدلل على المنهجية التي اعتمدها أغلب علماء الاستشراق في مقاربة الفكر العقدي عند المسلمين وإن كانت أكثر الأبحاث انصبّت على الفكر السنّيّ، وقلّما نرى أبحاثًا عقديّةً مرتبطة بالفكر الشيعي بشكل عام وبالإمامي بشكل خاص. ونذكر بعض النماذج التي تبيّن نظرة هؤلاء إلى العقيدة الإسلاميّة.
إدعاء «سورديل» أنّ الرسول أخذ مفهوم الملائكة وما لهم من أعمال من التقاليد الخيالية التي كانت سائدة في عصره آنذاك.
ثمّ ذهب «هنري ماسيه» إلى أبعد من ذلك فزعم أنّ عقيدة الملائكة المقربين (في الإسلام) قد أخذها محمد من اليهودية.
شكّك المستشرقون في هذه العقيدة المهمة جدًا عند المسلمين فجاء على لسان المستشرق «جيته»:
إنّ هذه العقيدة فكرة إسلاميّة خاصة وإنّ المحمدين يقومون بتعليمها إلى شبابهم على أنّهم لا يصيبهم إلا ما قدّر الله ودبّر بإرادته، هذا أساس دينهم منذ الأزل.
ثم زعموا أنّ الإسلام بهذه العقيدة كان سببًا في تخلف المسلمين عن ركب الحضارة، وكانت دعوة إلى التواكل والخمول والكسل وعدم السعي للعمل اعتمادًا على أن الله قدّر عليهم كل شيء وأنّه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، فهم نتيجة لهذا المعتقد مستسلمون.
من أبرز المستشرقين الذين كتبوا في الفقه- المستشرق: «جوزيف شاخت» 1902 - 1970-كما تقدم-، ومن المعروف بأنّه حاول أن يأتِي بنظرية جديدة في أسس الفقه الإسلاميّ، ونشر لبيانها كتب ومقالات عدّة؛ بالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ووضع كتاب (المدخل إلى الفقه الإسلاميّ) لهذا الغرض، وإن كان كتابُه: (أصول الشريعة المحمدية) يعدُّ من أشهر مؤلفاته على الإطلاق، كما عبَّر عنه المستشرق «جب» بأنّه (سيصبح أساسًا في المستقبل لكل دراسةٍ عن حضارة الإسلام وشريعته، على الأقل في العالم الغربي)، وقد أثَّرت نظريات (شاخت) تأثيرًا بالغًا على جميع المستشرقين تقريبًا؛ مثل: (أندرسون)، و(روبسون)، و(فيتزجرالد)، و(كولسون)، و(بوزورث)؛ كما أن لهذه النظريات تأثيرًا عميقًا على مَن تثقفوا بالثقافات الغربيّة من المسلمين.
«فكتاب شاخت يحاول أن يقلع جذور الشريعة الإسلاميّة، ويقضي على تاريخ التشريع الإسلاميّ قضاءً تامًا... فهو يزعم أنّه «في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلاميّ -في معناه الاصطلاحي- وجودٌ كما كان في عهد النبيّ، والقانون -أي الشريعة- من حيث هي هكذا كانت تقعُ خارجةً عن نطاق الدين، وما لم يكن هناك اعتراض ديني أو معنوي روحي على تعامل خاصٍّ في السلوك؛ فقد كانت مسألة القانون تمثِّل عملية لامبالاة بالنسبة للمسلمين؛ حيث صرَّح «شاخت» بأنّه «من الصعوبة اعتبار حديثٍ ما من الأحاديث الفقهية صحيحًا بالنسبة إلى النبيّ».
وبالإضافة لذلك يحاول جمهور المستشرقين نفي أي قيمة علمية للفقه والفقهاء المسلمين، بل يتهمون الفقه الإسلاميّ بأنّه قد استعان بالفقه الروماني وتأثّر به تأثّرًا
كبيرًا، وقد أشار «ﺟﻮﻟﺪﺗﺴـﻴﻬﺮ» في عديد من أبحاثه إلى التشابه الكبير بين الفقه الإسلاميّ والقانون الروماني، وتأثره كذلك بالتلمود اليهودي.
ويقول «يوسف شاخت» عن مكانة الشريعة في الإسلام: «إنّ القانون (الشريعة) تقع إلى حدٍ كبير خارج نطاق الدين».
والفكرة الأساس التي يريدها «شاخت» هي إبعاد النظرة التأصيلية للفقه واعتبار ما يسمى فقه أو شريعة هي أمور وجدت بعد النبيّ لدواعٍ كثيرة؛ منها: التمدّد الإسلاميّ؛ ما استدعى وجود قوانين صُبغت بالصبغة الإسلاميّة واضطر العلماء أن يضعوا لها أحاديث نسبوها إلى النبيّ وهذا يعني الشطب الكلي للتراث الفقهي للمسلمين.
هناك لائحة كبيرة من أسماء المستشرقين الذين تخصّصوا في اللغة العربيّة وآدابها، أمثال «هاملتون جب»، وكذلك «ماسينيون»، «سلفستر دي ساسي»، الذي أسّس «مدرسة اللغات الشرقيّة الحية» في باريس، وكانت «قِبلة» المستشرقين في ذلك الزمن، ومن خلال اهتمام المستشرقين باللغة العربيّة وآدابها نادى بعضهم بالاهتمام باللهجات المحلية، بل إنّ بعض المستشرقين كـ لويس ماسينيون وغيره نادوا بكتابة اللغة العربيّة بالأحرف اللاتينية.
وهناك دوريات مثيرة تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، تتخصص في الأدب العربي أو الدراسات العربية؛ فهناك مثلًا: (المجلة الدورية للدراسات العربيّة Arab Studies Quarterly، ومجلة المختار في دراسات الشرق الأوسط Digest of Middle East Studies التي بدأتْ في الصدور منذ ست سنوات، ومجلة آداب الشرق الأوسط أدبيات) (Middle East Literature) (Literary Articles)، التي تتعاون في إصدارها جامعة «أكسفورد» البريطانية، وجامعة «داكوتا» الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت في الصدور منذ عام 1996م.
ولمعرفة حجم الدراسات التي قام بها علماء الاستشراق في مختلف مدارسهم في مجال اللغة العربيّة، لا بد أن نلحظ هذه المحطات الرئيسة لدراسة اللغة العربية.
• لقد بدأت الدراسات الشرقيّة الإسلاميّة بتعلم العربيّة ولغات شرقية أخرى لأغراض تبشيرية، بهدف تنصير المسلمين ذوى اللسان العربي، وتأليف أدبيات ناقدة للقرآن.
• فى عام 1143 م أعد روبرت آينيت Kennet Robert بمساعدة آخرين ترجمة لاتينية للقرآن كي ما يفندها نقدًا بيير رئيس دير كلوني الفرنسي. Peter di Cluny
• فى إسبانيا – تحديدًا في طليطلة Toledo كان الإيطالي جيراردو دي آريمونا di Gerardo Cremona (1114-1187) بارعًا في دراسة العربية.
• وفي فرنسا اقترح بيير دوبوا Pierre DuBois) 1250-1312) تأسيس مستعمرات أوروبية في فلسطين لأغراض التبشير بين العرب.
• أمّا في بريطانيا القرن الثالث عشر الميلادي؛ فقد شجّع الفرنسيسكاني روجر بيكون Bacon Roger على تعلّم اللغات الشرقيّة -واللغة العربيّة بالأخص- لأسباب غير تبشيرية. وأول مبرراته لتعلم اليونانية والعبريّة والعربيّة يكمن في أنّها «دراسات تبلغ الكمال في الحكمة».
• أمّا في فرنسا القرن السادس عشر فقد ظهر المستعرب والمستشرق جيولوم بوستل Giullaume Postel الذي كان قد درس في باريس وتعلّم العربيّة والعثمانية في بلاد المشرق. وفي عام 1539 أخرج إلى النور مؤلفه الهام في «أجرومية اللغة العربية».
• في القرن السادس عشر كانت هولندا تستعدّ لتصبح أهم مركز لدراسة اللغة العربيّة على يد نيكولاس آلينداروس Nicolas Clendarus 1495-1542. الذي حوّل اهتمامه من اللاهوت إلى تعلّم اللغات.
إنّ معرفة اللغة العربيّة في أوروبا العصور الوسطى كانت تمثّل نقطة انطلاق نحو التنافس العقديّ مع الإسلام. أي أنّ بداية الدراسات الشرقيّة كانت مبنيّة على صراع مع الإسلام، وتنافس سياسي، ولا يزال كلاهما يلقى دعمًا من بعض المستشرقين إلى يومنا هذا.
هناك أهداف متعدّدة ودوافع لدراسة اللغة قد تكون كل أهداف الحركة الاستشراقيّة الاقتصادية، السياسية، الدينية، وغير ذلك تكاد تجتمع في دراسة هذه اللغة. وأحاول الإشارة إلى بعض هذه الأهداف وباختصار.
وأمّا الأهداف الاقتصادية والسياسية، ففي ذلك يقول وليام بدويل (1561 ـ 1632) في سياق ترغيبه في تعلم العربية: «إنّها هي لغة الدين الوحيدة وأهم لغة للسياسة والعمل من الجزائر السعيدة إلى بلاد الصين».
وأما التنصير فهو ذو علاقة وثيقة بالاستشراق، بل إنّهما توأمان يصعب التفريق بينهما كثيرًا وبخاصة في بداية نشأتهما، فقد كان علماء الكنيسة المسيحيّة هم أول من اعتنى بدراسة اللغة العربيّة وتعلّمها.
فأول مؤسس لكرسي الاستشراق في جامعة أكسفورد هو رئيس الأساقفة واسمه «لود»، كان ذلك في سنة (1636). وكان من أهداف أول جالس على كرسي اللغة العربيّة في كمبردج في السنة نفسها أن يعد مشروعًا لتفنيد القرآن، كما كان من أهداف هذا الكرسي أيضًا تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة، والدعوة إلى الديانة المسيحيّة بين هؤلاء الذين يعيشون في الظلمات !
ويقول جيوم بوستل (ت 1581 م) أول من شغل كرسي اللغة العربيّة في «الكوليج دي فرانس» في باريس عن اللغة العربيّة «إنّها تفيد بوصفها لغة عالمية في التعامل مع المغاربة والمصريين والفرس والأتراك والتتار والهنود، وتحتوي على أدب ثري، ومن يجيدها يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية بسيف الكتاب المقدس».
وأما الأهداف اللاهوتية فخلاصتها أنّ للغة العربيّة أهمّيّة كبيرة من هذه الناحية تتمثل في أنّها -ببقائها حيّة وبأصلها السامي- تساعد على فكّ طلاسم نصوص العهدين القديم والجديد وفهمها يقول يوهان فوك عن المستشرقين الذين معظمهم من اللاهوتيين: «لم يدرسوا اللغة العربيّة لقيمتها الأدبية أو للتعمّق في تاريخ الإسلام أو لدرس تطوّر الأدب عند المسلمين، بل لاستعمالها وسيلة لدرس العهد القديم واللغة العبرانية».
ولم يخلُ الاستشراق والاهتمام باللغة العربيّة من أهداف علمية وثقافية خالصة؛ لأنّ المسلمين ظلّوا متقدّمين وأساتذة العالم من القرن التاسع الميلادي إلى القرن الرابع عشر، فقد كان من يرغب من الغربيّين في العلم أو الفنّ أو الأدب أو الفلسفة ييمّم شطر الشرق وهناك شواهد كثيرة على ذلك.
قد كان للقرآن الكريم مركزًا جوهريًا في الدراسات الاستشراقيّة التي بدأت بترجمته لأهدافٍ دينية معادية؛ مثل ترجمته الأولى إلى اللغة اللاتينية التي أشرف عليه (بيتروس فينيرا بيليس) الملقّب بـ (بطرس المبجل) رئيس دير (كلوني) وسيأتي الكلام عن هذه الترجمة وغيرها.
والذي يطالع حجم الدراسات الاستشراقيّة عن القرآن الكريم، وتنوع هذه الدراسات التي اشتملت في بعض الأحيان على بعض الأبحاث التي لم يتعرّض لها المسلمون أنفسهم، يعرف مدى اهتمام هؤلاء بالقرآن الكريم وجعله على رأس الأولويات التي شغلت بالهم وتفكيرهم، ولعل المستشرقين قد أدركوا أهمية القرآن بل خطورته على أفكارهم ومعتقداتهم اللاهوتية، بعد ترجمتهم له؛ ما دفعهم لدراسته ونقده.
«ومن خلال استقراء متنوع الجهود الاستشراقيّة في الدراسات القرآنيّة؛ فإنّ أهمّ أعمالهم تدور حول الموضوعات التالية بحسب أهميتها عندهم، أو بحسب ما أنتجوه فيها:
1- تأريخ القرآن الكريم، وكل ما يتعلق بأسباب نزوله، وتأريخ سوره، ومكيّه ومدنيه، وقراءاته ولهجاته، وكتابته وتدوينه، وما دار في هذا الفلك من رأي، أو فكرة أو نظرية.
2- ترجمة القرآن إلى مختلف اللغات العالمية والألسن الحيّة، ترجمة حرفية أو تفسيرية أو لغوية، جزئية وكلية.
3- نشر ما كتب عن القرآن وما ألّف فيه، وتحقيق النصوص القديمة في آثاره، والتدوين والفهرسة بمختلف الأصناف».
فلماذا اهتّمّ المستشرقون بدراسة القرآن الكريم؟ وبعبارة أخرى ما هي الدوافع الرئيسة وراء هذا الاهتمام البالغ واللافت في دراسة القرآن.
إنّ معرفة الأسباب والدوافع وراء دراستهم تكشف لنا عن أسباب اختيارهم لبعض المناهج التي استخدموها في دراسة القرآن الكريم.
فهناك دوافع عدّة للبحث الاستشراقي في القرآن نذكر منها:
بعد أن ترجم رجال الكنيسة القرآن واطلعوا على ما فيه من أفكار ومعتقدات، وجدوا أنّ ما جاء في هذا الكتاب فيه إبطال واضح وصريح لأسس الاعتقاد الذي يقوم عليه الإيمان المسيحيّ أي: (التثليث، الصلب، الفداء)، قال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .
وقال -تعالى- ردًا على فكرة صلب السيد المسيح: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) .
فالقرآن أبطل بشكل واضح عقيدة التثليث، والصلب للسيد المسيح عليهالسلام وغير ذلك من اعتقادات، وهذا دفع المستشرقين وبالأخص رجال اللاهوت المسيحيّ لدراسة القرآن الكريم، أولًا: لحماية العقائد المسيحيّة لكي لا يتأثر أتباع الديانة المسيحيّة أنفسهم بأفكار القرآن، ثانيًا: إقناع المسلمين ببطلان أفكارهم وعقائدهم من خلال إضعاف المصدر الأول لعقيدتهم وهو القرآن وإبطال وحيانية القرآن والقول إنّه من صنع محمد صلىاللهعليهوآله، وعند ذلك يتمكّن علماء اللاهوت من التبشير بالدين المسيحيّ وإقناع المسلمين به، ولذا استخدموا من أجل ذلك وسائل وأساليب ومناهج للوصول إلى هذه الغاية المحددة، من قبيل تطبيق نظرية «النقد الأعلى»
على القرآن وهي النظرية التي طبقها علماء اللاهوت في أمريكا على الإنجيل والتوراة.
فالدافع الديني يعتبر من أهم الدوافع لدراسة القرآن الكريم وعلومه ولذا يُعتبر القرآن المجال الخصب لهؤلاء المستشرقين وبالأخص لعلماء اللاهوت المسيحيّ في الدرجة الأولى؛ لأنّهم يريدون من خلال دراساتهم المختلفة تحطيم المسلّمات التي يؤمن بها المسلمون أو تشويهها، وفي الوقت ذاته الحيلولة دون تأثّر الغرب المسيحيّ واقتناعه بالقرآن الكريم.
وهذا الدافع الديني جعل الكنيسة تشن حملة واسعة ضد القرآن الكريم بشكل خاص، وشخص النبيّ والإسلام بشكل عام، وكان لهذه الحملة أشكال متعدّدة من الافتراءات على القرآن الكريم وعلى الرسول الأعظم؛ منها:
• إنّ حقيقة الوحي الإلهي ما هي إلا نوبات من الصرع، أو مجموعة من الأوهام والخيالات الخاصة بالرسول.
• الترويج لفكرة أنّ النبيّ استقى تعاليم القرآن من كتب اليهود والنصارى. يقول بعض الباحثين «إنّ السبب الأوّل لحقد المستشرقين على القرآن وإصرارهم على أنّه من كلام محمد وليس من عند الله وكلامه هو أنّ القرآن اتّهم أتباع التوراة والإنجيل بتحريفهما، ولذلك زعموا أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله استمدّ معارفه في إنشاء القرآن من هذين الكتابين؛ قصصًا وأخبارًا وأحكامًا؛ كما أنّ القرآن من ناحية أخرى ينكر الأسس الثلاثة التي تقوم عليها مسيحيّتهم؛ وهي «التثليث والصلب والفداء».
• تكذيب الأفكار والمعتقدات الإسلاميّة بمجرد مخالفتها للمسيحية يوضح (مونتغمري وات) الموقف الكنسي من القرآن والإسلام قائلًا «لقد سيطرت مفاهيم الكتاب المقدس خلال القرون الوسطى على نظرة الأوروبيين عن
الطبيعة، والله، والإنسان، بحيث لم تمكنهم من أن يتصوّروا أنّ هناك طريقًا بديلة للتعبير عن هذه العلاقة، وكانت النتيجة أن حُكم على تعاليم الإسلام بالكذب حين اختلفت مع المسيحيّة».
ا لقول إنّ الإسلام لم يكن سوى هرطقة مسيحيّة وإنّ الإسلام كان أسوأ من ذلك، وبالإمكان اعتبار المسلمين وثنيين، ولقد جاءت نواة الاعتقاد المسيحيّ في هذا الصدد من أنّه ما دام محمد لم يكن رسولًا، وما دام قد أقام دينًا، فلا بدّ إذن من أنّه شجع الشر، وبذلك فإنّه يجب أن يكون أداة للشيطان؛ وبهذه الطريقة وضع الإسلام على طرفي نقيض مع المسيحيّة».
لا تخفى الصلة بين الاستشراق والاستعمار، فالتراث الاستشراقي بمثابة دليل للاستعمار من أجل فرض السيطرة الاستعمارية على الشرق وإخضاع شعوبه وإذلالها والهيمنة عليها.
ولكي يصل الاستعمار إلى أهدافه التوسعية لا بدّ أن يضعف عقيدة الشعوب، لأنّ قوة الشعوب بسبب معتقداتها، والقرآن الكريم يشكل المصدر الأساس لعقيدة المسلمين، فلذا كان لا بدّ من المرور عبره والتشكيك في منظومته الفكرية، وأصوله الاعتقادية، ومبانيه الأخلاقية، ولا أقل التقليل من قيمتها.
ومن هنا تناول المستشرقون العديد من المفاهيم والموضوعات القرآنيّة الرئيسة؛
وبالأخص التي تواجه حركتهم الاستعمارية، وكان أوّل ما تناوله المستشرقون -بوابة المستعمر الكبرى- «مفهوم الجهاد» في القرآن الكريم هذا الجهاد الذي أكّده القرآن في تضاعيف آياته فبلغت آيات الجهاد والنفير والقتال في القرآن الكريم (70 آية)، وحاول هؤلاء تشويه هذا الجهاد المقدس وقاموا بتصويره تصويرًا سيئًا، وكان هدفهم واضحًا وهو: إضعاف روح المقاومة والدفاع عن الدين والنفس والأرض... فاعتبروا الإسلام عقيدة سيف، وكان جون هيجل يقول: «كان الإسلام دائمًا، وسيبقى دائمًا، دين السيف، لأنّه لا يمكن العثور على أيّ فكرة للحب في القرآن».
وهناك دراسات كتبها المستشرقون عن نقد موضوع الجهاد في الإسلام، نذكر منها:
ـ «الحرب المقدّسة: الحملات الصليبيّة وأثرها على العالم اليوم» للمستشرقة البريطانية كارين آرمسترونغ Karen Armstrong الطبعة العربيّة للكتاب: ترجمة: سامي الكعكي، (بيروت، دار الكتاب العربي، 2005م).
ـ «الجهاد من أجل القيصر» للمستشرق النمساوي شتيفان كرويتسر.
ـ المستشرق البريطاني ويليام مونتغمري وات William Montgomery Watt (1909-2006) المعنون بـ: «مُحمَّد في المدينة» Muhammad at Medina.. والذي تعرض في كتابه إلى دراسة نقدية تحليلية لغزوات وسرايا الرسول صلىاللهعليهوآله.
والدافع إلى هذا التشكيك خصوصًا في موضوع الجهاد:
• الخوف من سيطرة الإسلام على عالم الغرب المسيحيّ.
• الرغبة الجامحة والحلم القديم الجديد في السيطرة على الشرق، ونهب ثرواته.
يقول الوزير البريطاني السابق «جلادستون» في سياق كلامه عن أسباب الحملة التي شُنت على القرآن الكريم ولا تزال تُشن وبأساليب مختلفة: «ما دام هذا القرآن موجودًا، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان».
وقد رد بديع الزمان النورسي على مقالة «جلادستون» بقوله: «أقسم بالله إنّني سأكرّس نفسي للقرآن باذلًا حياتي مهما كانت مكائد الوزير البريطاني القذرة»، ويقصد به وزير المستعمرات البريطاني غلادستون الذي قال آنذاك: «طالما أنّ القرآن مع المسلمين فسيبقون في طريقنا ولذلك يجب علينا أن نبعده عن حياتهم».
وقال أيضًا: «لأبرهننّ للعالم بأنّ القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاؤها»، فجعل القرآن محور حياته والنهضة بالمسلمين وجهته، وكان من آثار ذلك أنّه توجّه إلى إسطنبول وعرض على السلطان عبد الحميد إنشاء جامعة في شرق الأناضول باسم مدرسة الزهراء تكون ميدانًا لتدريس العلوم الدينيّة والشرعية
معًا ليقدم النموذج الذي ينهض به المسلمون ممّا كانوا فيه من حال تخلّف.
وكتب النورسي «رسائل النور» وتبلغ رسائله مئة وثلاثين رسالة وتقع في تسعة مجلدات هي: الكلمات والمكتوبات واللمعات والشعاعات وإشارات الإعجاز والمثنوي العربي النوري والملاحق وصيقل الإسلام وسيرة ذاتية ووُضع للرسائل جزء عاشر بمثابة فهرس تحليلي عام.
وقد عرّف الأستاذ النورسي رسائل النور فبيّن أنّها «برهان باهر للقرآن الكريم وتفسير قيّم له وهي لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البحر وشعاع من تلك الشمس وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته».
إنّ ما تقدم من دوافع لا يمنع من ظهور الدافع العلمي، هذا الدافع الذي سعت إليه قلة قليلة من المستشرقين إذا ما قيسوا بالجمهور منهم، فكانت الأخطاء التي وقعوا فيها أثناء البحث في القرآن الكريم ودراسته أخطاء طبيعية.
ولكن بشكل عام تهدف الدراسات الاستشراقيّة للقرآن الكريم وعلومه بالدرجة الأولى إلى زعزعة عقيدة المسلم، وتشكيكه في أمهات الكتب الإسلاميّة، من خلال مناهجهم -المزعومة- التي لا تحتكم إلى المنهج العلمي الرصين.
ولكي تتضح -ولو بصورة إجمالية- آراء هؤلاء تجاه القرآن نعرض بعض الأمثلة على ذلك، على أنّه سيأتي البحث بشكل موسّع عن بعض الافتراءات والأكاذيب التي كتبها هؤلاء تجاه القرآن الكريم.
يرى المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون أنّ التصرفات التي كانت تعتري الرسول إبان نزول الوحي عليه ما هي إلا بسب إصابته بالهوس. ويرى مونتغمري وات أن الوحي من نتاج الخيال الخلاّق للرسول. ويرى جولدتسيهر أن النبوة مسألة نفسية من تشبّع الإنسان بحالة خاصّة.
حاول المستشرق (كازانوفا) أن يثبت من خلال بحثه أنّ القرآن قد أضيفت إليه أمور كثيرة بعد وفاة النبيّ. ويقرّر (جولدتسيهر) أنّه لا يوجد نصّ موحّد للقرآن، بل قد حذفت منه آيات كثيرة، وهذا ما أكده (نولدكه) و(موير) أيضًا.
زعموا أنّ الرسول استمد تعليمات القرآن الكريم من الديانات الأخرى، فشرائع الإسلام تأسّست من الشرائع المعاصرة له والمنتشرة وقتئذٍ في الشرق، ألا وهي: اليهودية، المسيحيّة، الهندية، الصابئة، الزرادشتية، الجاهلية. وهذا ما يراه المستشرق (جب) في كتابه (المذهب المحمدي) والمستشرق (سنكريل تسدل) في كتابه (مصادر الإسلام) وغيرهما.
وهناك أمثلة كثيرة في هذا المجال توضح مدى افتراء هؤلاء على الرسول والرسالة ويمكن اختصار موقفهم في النقاط الآتية:
القرآن من تأليف محمد.
وهو ليس وحيًا على الإطلاق.
وليس بمعجزةٍ أصلًا.
فيه كثيرٌ من التناقضات.
وهو خليطٌ من الديانات والعادات.
(175)
لا شكَّ في ضرورة اتِّباع منهجٍ ما، في أيِّ دراسةٍ من الدراسات؛ لأنَّ المنهج هو الطريق المؤدِّي إلى التعرُّف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفةٍ من القواعد العامَّة التي تهيمن على سير العقل، وتحدِّد عمليَّاته حتَّى يصل إلى نتيجةٍ معلومة. وبعبارة أوجز: هو القانون، أو القاعدة التي تحكُّم أي محاولة للدراسة العلميَّة، وفي أيِّ مجال.
ثمَّ إنَّ المناهج تختلف باختلاف العلوم التي تبحث فيها؛ فلكلِّ علمٍ منهجٌ يناسبه، مع وجود حدٍّ مشترك بين المناهج المختلفة، وقد تتعاون -وهو الغالب- مجموعةٌ من المناهج لخدمة فنٍّ واحدٍ ومعالجته.
ولكن لكلِّ منهجٍ حدودًا معيَّنة، ومن هنا فمن الخطورة بمكان أن نعتقد أنَّ منهجًا بعينه يصلح لدراسة الظواهر المختلفة، فقد يفيد المنهج الفلانيّ في دراسة ظاهرةٍ محدَّدةٍ أو موضوعٍ معيَّنٍ في بيئةٍ معيَّنةٍ، بينما قد يأتي استخدام المنهج نفسه بنتائج خاطئة بل كارثيَّة في بعض الأحيان، إذا ما طُبِّق على موضوعٍ آخر مشابهٍ في بيئةٍ أخرى وظروفٍ مختلفة.
هناك مناهج علميَّة أو مكتبيَّة (Méthodes Library) اعتمدها المستشرقون، من قبيل: المنهج التاريخيّ، المنهج الوصفيّ، وغيرهما. والمقصود بالعلميَّة طريقة استعمال المصادر، والدراسات العلميَّة التي لها صلة مباشرة، أو غير مباشرة بموضوع الدراسة، والتي تحصل وتتمّ من على المكتب دون الحاجة للنزول إلى الميدان. وهناك مناهج عمليَّة تتطلَّب الحضور الميدانيّ، من قبيل: المنهج الأنثروبولوجيّ في دراسة التراث.
(181)
الاتِّجاه التاريخيّ هو من الاتِّجاهات اللاهوتيَّة، ويبدو أنَّه نابعٌ من محاولة بعض المستشرقين تطبيق مناهج النقد التاريخيَّة عنْوةً على النصِّ القرآنيّ، وهي المناهج التي طُبِّقت على الكتاب المقدَّس، وطوَّرت في ما بعد علم اليهوديَّة، ومن ثمَّ علم نقد أسفار العهد القديم في الغرب، وخرجَت هذه المناهج بنتائج تفيد بأنَّ هذه النصوص كُتبت في مراحل تاريخيَّة مختلفة، وتنتمي لأكثر من مؤلِّف لا لمؤلِّفٍ واحد، ومن أشهر الكتابات الاستشراقيَّة في هذا الصدد كتاب المستشرق الألمانيّ تيودور نولدكه: «تاريخ القرآن» عام 1860م، الذي تأثَّرت به -على أغلب الظنّ- كثيرٌ من الكتابات الاستشراقيَّة التي نهجَت هذا النهج؛ إِذْ حاولَت وضع النصّ القرآنيّ في إطارٍ تاريخيّ، مقسِّمةً سور القرآن إلى مجموعات، وفقًا لمراحل وحقب تاريخيَّة مختلفة ارتأَتْ أن َّكلًّا منها كان لها تأثيرٌ على مضامين آيِ القرآن.
ويقصد بالمنهج التاريخيّ القوانين العامَّة للوصول إلى الأحداث الماضية من خلال التحليل المفصَّل الذي يقود من المشاهدة المادِّيَّة للوثائق إلى معرفة الوقائع، وقد قام بتوضيح معالم هذا المنهج العالمان الفرنسيّان لانجلو وسينوبوس في كتابٍ لهما، بعنوان: «المدخل إلى الدراسات التاريخيَّة»، وعالجا فيه شروط المعرفة في التاريخ، وعلاماتها وخصائصها، وكيفيَّة التعامل مع وثيقةٍ تاريخيَّة، وقد تَرجَمَ هذا الكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي.
ويُعرِّفه بعض الباحثين بأنَّه: «عبارة عن ترتيب وقائع تاريخيَّة أو اجتماعيَّة، وتبويبها وترتيبها، ثمَّ الإخبار عنها، والتعريف بها باعتبارها الظاهرة الفكريَّة ذاتها. وقد خلطوه بالمنهج الذاتيّ، فجاءت دراستهم ذاتيَّة أكثر منها تاريخيَّة.
والمنهج التاريخيّ قد يكون عامًّا يشمل دراسة كلّ الظواهر السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والقانونيَّة للمجتمع، وقد يكون خاصًّا بجزءٍ معيَّنٍ مقتصرًا عليه. والمستشرقون حين طبقوا هذا المنهج على الحضارة الإسلاميَّة، فإنَّهم صنَّفوا التاريخ الإسلاميّ ومفكِّريه على نمط العقليَّة الغربيّة؛ فهم إذا تحدَّثوا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قالوا: إنَّه كان تاجرًا ميسورًا، وعندما يتناولون دعوته يقولون: إنَّها جاءت للانقضاض على الأرستقراطيَّة القرشيَّة، وعندما يتحدَّثون عن نضاله وجهاده يقولون: إنَّ لديه أغراضًا سياسيَّة يرمي إلى تحقيقها بالقوَّة المسلَّحة للوصول إلى السلطة والهيمنة على الجزيزة، وعندما يتحدَّثون عن مفكِّري الإسلام كابن رشد والغزالي فإنَّهم يصنِّفونهم على أنَّهم أصحاب مدارس كالغربيّين، وهذا غير صحيح بل بعيدٌ كلَّ البعد عن التاريخ الإسلاميّ. ونتائج تطبيق هذا المنهج ليست صحيحةً غالبًا كما أنَّه يؤدِّي إلى إنكار نبوَّة محمَّد صلىاللهعليهوآله، وعدم صدق الوحي؛ حيث يفسِّر كلّ شيءٍ على أنَّه ظاهرةٌ تاريخيَّةٌ ذات أصولٍ مادِّيَّة، وهو بذلك يقوم على فكرةٍ مسبقةٍ وتمييزٍ حضاريٍّ وتعصُّبٍ دينيّ».
البحث التاريخيّ يمرّ بمرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة جمع الأصول المرتبطة بواقعةٍ تاريخيَّة وتمحيصها؛ لإثبات صحَّتها، وتعيين درجة الاعتماد عليها.
المرحلة الثانية: مرحلة إعادة بناء تصوُّر الواقع التاريخيّ بعد تجزئة المعلومات عنها وتصنيفها وترتيبها على أساس التسلسل المنطقيّ للحوادث.
• حاز النقد التاريخيّ في الغرب مكانةً عليا في الدراسات التاريخيَّة، وأصبح هذا المنهج مهيمنًا على مجال البحث العلميّ-التاريخيّ، كما شاع استعماله في البحث الأكاديميّ للكتاب المقدّس.
• قد تناولت الدراسات الإسلاميَّة عند المستشرقين عددًا من الموضوعات المرتبطة بالقرآن الكريم، والسنَّة، والسيرة النبويَّة، والتاريخ الإسلاميّ، على أسسٍ منهجيَّةٍ نقديَّةٍ متأثِّرين بهذا المنهج.
• الهدف من استخدام النقد التاريخيّ في دراسة الأديان وكتبها المقدَّسة هو الكشف عن نشأتها وطبيعتها.
• الفكرة الرئيسة في هذا المنهج هي أنَّ الأديان تمرّ بمراحل نشأةٍ وتطوُّر في التاريخ، وأنَّها خاضعة لقانون التأثُّر والتأثير، فهي أديان متطوِّرة في التاريخ.
هناك ملاحظات عدَّة على المنهج التاريخيّ، نذكر أهمّها:
إنَّ من مسلَّمات المنهج العلميّ أن يكون صالحًا لموضوع البحث، فالتزام المنهج المناسب لمجال البحث يكون ضمانًا لتوليد معرفةٍ صحيحةٍ، وعدم مراعاة التناسب بين المنهج والموضوع سيؤدِّي إلى معرفةٍ فاسدة ونتائجَ خاطئة؛ ولذلك تُشترط في المنهج العلميّ شروطٌ ثلاثة:
الشرط الأوَّل: أن يكون منهجًا محدَّدًا
الشرط الثاني: أن يكون ملائمًا لموضوع البحث
الشرط الثالث: أن يكون متناسبًا مع طاقة العقل، وفي حدود قدراته.
«والخطأ الأوَّل هو خطأ التعميم الذي وقع فيه المستشرقون. وهذا الخطأ المنهجيّ الاستشراقيّ ينبع من الاعتقاد في أنّ ما ينطبق على اليهوديَّة والنصرانيَّة ينطبق بالضرورة على الإسلام، وأنَّ ما ينطبق على النصوص الدينيَّة المقدَّسة في اليهوديَّة والنصرانيَّة صالحٌ للتطبيق على الإسلام». وهذا خطأٌ منهجيٌّ في المقايسة، ولكي يتَّضح هذا الخلل لا بد أن نلتفت إلى النقطة الآتية:
هناك فارق كبير بين القرآن الكريم بوصفه كتابًا ووحيًا سماويًّا وبين الكتب السماويَّة الأخرى كالإنجيل والتوارة؛ فالقرآن الكريم نزل خلال 23 عامًا، وقد كُتب أمام النبيّ صلىاللهعليهوآله مع تمام نزول الوحي، أيْ لم ينزل القرآن ثم بعد رحيل النبيّ بسنواتٍ أو عقودٍ أو قرونٍ كُتِبَ القرآن؛ ولذا بالنسبة إلى النصّ الأوَّل في الإسلام، وهو القرآن الكريم، ليس هناك فترةٌ يمكن أن تُسمَّى تاريخًا، أي وجود زمنٍ فاصلٍ بين نزول الوحي القرآنيّ وتدوين النصّ القرآنيّ.
أمَّا النصوص الدينيَّة المقدَّسة في اليهوديَّة، فلها تاريخٌ طويلٌ يقترب من ثمانمئة عامٍ بين زمن نزول الوحي وتدوينه، أيْ بين زمن نزول الوحي على النبيّ موسى عليهالسلام، أي القرن الثالث عشر قبل الميلاد وزمن إخضاع هذا الوحي للكتابة والتدوين على يد عزرا الكاتب أيْ منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وهي فترة طويلة جدًّا، فنحن أمامَ نصٍّ له تاريخٌ تغيَّر فيه شكله من النصّ الشفويّ إلى النص الكتبّي على يد «عزرا الكاتب»، وهذه الفترة سمحت بأنواع التحريف والتبديل كلِّها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العهد الجدي، فلكلِّ إنجيلٍ من الأناجيل الأربعة تاريخ.
الصحيح أنَّ اليهوديَّة والنصرانيَّة ديانتان تاريخيَّتان، وكلُّ ديانةٍ منهما لها تاريخ ينقسم إلى عصور. بالنسبة إلى الديانة اليهوديَّة، وحسب التقسيمات اليهوديَّة لتاريخها، هناك ما يُعرف بيهوديَّة التوراة، ويهوديَّة الأنبياء، ويهوديَّة العهد القديم ككلّ، ويهوديَّة التلمود بعد انتهاء عصر العهد القديم، وهكذا... وبالنسبة إلى الديانة النصرانيَّة، فقد أدَّى تاريخ النصّ إلى تطوُّر نصرانياتٍ عدَّة، من بينها: ديانة عيسى عليهالسلام، والنصرانيَّة اليهوديَّة (Jewish Christianity)، ونصرانيَّة الأناجيل المختلفة، ونصرانيَّة بولس، ونصرانيَّات المذاهب الأرثوذكسيَّة، والكاثوليكيَّة، والبروتستانتيَّة. وفي مقابل هذا التطوُّر العقديّ الناتج عن تاريخ النصّ والمؤدِّي إلى تطوُّر تاريخٍ لليهوديَّة وتاريخٍ للنصرانيَّة، لا يوجد تاريخٌ للإسلام بالمعنى المتقدِّم، فهناك توافقٌ تامٌّ بين القرآن بوصفه نصًّا والإسلام بوصفه دينًا، ولا يوجد إسلام خارج حدود النصّ القرآنيّ، وبالتالي لا يوجد تطوُّر عقديّ أو عصور للإسلام. وهنا يجب عدم الخلط بين الإسلام، وتاريخ المسلمين؛ فالتاريخ الموجود هو تاريخ المسلمين، وليس تاريخ الإسلام.
في عام 1837م صدر كتاب «أبراهام جايجر»، بعنوان: «ماذا أخذ القرآن عن اليهودية»؟ وهدفه ممَّا طرحه في هذا الكتاب إرجاع العناصر الرئيسة في الإسلام إلى الديانة اليهوديّة، وبالتالي إفقاد الإسلام الأصالة الدينيَّة، واعتباره ديانة التقاطيَّة وتلفيقيَّة. فَوِفقًا لكتابه الذي هو في الأصل أطروحة دكتوراه باللغة الألمانيَّة، بعنوان: «ماذا أخذ محمَّدٌ عن اليهوديَّة؟» (Was hat Mohammed aus dem judenthume aufgenommen)، فإنَّ النصَّ القرآنيَّ في مجمله اقتباساتٌ عن الديانة اليهوديَّة.
فـ «مهمَّتنا -على ما يقول غايغر- هي أن نثبت أنَّه كم كانت مرتبطة روح محمّد، نضاله وأهدافه، مع عقل زمانه ودستور محيطه، ومن ثمَّ إثبات حقيقة أنَّه حتَّى إذا كنَّا حُرِمنا من جميع البراهين التي تظهر على نحوٍ لا يمكن إنكاره أنَّ اليهوديَّة مصدرٌ للقران، فإنَّ التخمين بأنَّه استعارةٌ من اليهوديَّة كانت قد حدثت لا تزال تمتلك احتماليَّةً عظيمة».
ومن النماذج –أيضًا- لمنهج التأثير والتأثُّر كتاب «مصادر يهوديَّة للقرآن» باللغة العبريّة، لمؤلِّفه الحاخام والمستشرق الإسرائيليّ أندريه شالوم زاوي، الصادر في القدس عن دار نشر (دافير) الإسرائيليَّة عام 1983م، والذي يعدُّ من المؤلَّفات النادرة التي تركِّز بالتحليل والنقد على الآيات القرآنيَّة؛ إِذْ شمل جميع سور القرآن الكريم، رادًّا عددًا كبيرًا من آياته إلى مصادر دينيَّة يهوديَّة قديمة ومتأخِّرة، وإلى مصادر أخرى غير أصيلة، علاوة على اعتبار عددٍ من ألفاظه ذات أصول عبريَّة وأخرى أجنبيَّة.
ويمكن الردّ على هذا المنهج في ما يتعلَّق بالإسلام والنصِّ القرآنيّ تحديدًا، بأنَّ الذي يحلّ محلّ ظاهرة التأثير والتأثُّر هو الرؤية القرآنيَّة والإسلاميَّة عن الوحدة
الإلهيَّة للأديان في علاقاتها باليهوديَّة والنصرانيَّة وكتبهما المقدَّسة، فمن الطبيعيّ أن تكون المتشابهات موجودة بين نصوص هذه الأديان طالما أنَّ المصدر واحد؛ وهو ما يتَّضح أكثر من خلال مفهوم «الهيمنة» القرآنّي، وهو من المفاهيم الـمُهمَلة في الدراسات الاستشراقيَّة عن الإسلام.
وباختصار، فإنَّ المقصد من منهج التأثير والتأثُّر هو ردُّ كلّ عناصر منظومة الإسلام بعد تجزئتها إلى اليهوديَّة والنصرانيَّة أو إليهما معًا، أو إلى ما هو خارج اليهوديَّة والنصرانيَّة؛ كالهنديَّة، والفارسيَّة، واليونانيَّة، وغير ذلك. والهدف من تطبيق هذا المنهج هو الاستدلال على عدم أصالة الدين الإسلاميّ بأصوله وفروعه. فالتوحيد بناءً على هذا التصوُّر تكون أصوله يهوديَّة، والتصوُّف أسسه هنديَّة وفارسيَّة، والفلسفة يونانيَّة، وهكذا غدا الفقه الإسلاميّ عندهم نسخة من القانون الرومانيّ، والحضارة الإسلاميَّة -في أحسن أحوالها- ليست إلا شكلًا من أشكال «الهللينيَّة»، بل إنَّ الإسلام ذاته هو لون جديد يجمع بين اليهوديَّة والمسيحيَّة. والصحيح -بناءً على قواعد المنهج العلميّ الرصين- عدم صحَّة تطبيق هذه القاعدة بمجرَّد التشابه؛ لأنَّ القرآن عندما تحدَّث عن الأديان الأخرى تحدَّث عنها ضمن فكرة وحدة المصدر الإلهيّ للأديان، ولكن علماء الاستشراق تعاملوا مع الأديان على أنَّها منفصلة عن بعضها لا يجمع بينها رابط، وعندما أرادوا إجراء مقارنة بين الأديان سمحوا لمخيِّلتهم الإجابة عن أسئلة افتراضيَّة ومبنيَّة على رؤية غير منهجيَّة، من قبيل: من تأثر بمن؟ وما هي أدلّة التأثير؟ وهكذا بدل أن تكون حالات التشابه بين
الأديان عاملًا يوحِّدها ويرجعها إلى منبعها الأصليّ، تحولت بيد علماء الاستشراق إلى أداة سطوٍ فكريّ، يجري بواسطتها «إفراغ الإسلام من مضمونه؛ وذلك بإرجاعه إلى مصادر خارجيَّة كالنصرانيَّة، واليهوديَّة، والمجوسيَّة، والبوذيَّة، والبابليَّة». وقد اعتبر بعض الباحثين أنَّ كلّ الدراسات والموسوعات التي كتبها المستشرقون عن الإسلام تسير على منهج (التأثير والتأثُّر) ولا تعدوه.
وهذا المنهج الذي يقوم أصلًا -كما أشرنا- على محاولة تفريغ الظاهرة الفكريَّة من مضمونها، محاولًا ردّها إلى عناصر خارجية في بيئات ثقافيَّة أخرى، دون وضع أيِّ منطقٍ سابقٍ لمفهوم التأثير والتأثُّر، بل بإصدار هذا الحكم دائمًا لمجرَّد وجود اتِّصالٍ بين بيئتين أو ثقافتين، وظهور تشابهٍ بينهما، مع أنَّ هذا التشابه قد يكون كاذبًا وقد يكون حقيقيًّا، وقد يكون لفظيًّا وقد يكون معنويًّا.
لا بد من الإشارة إلى أنّ هذا المنهج غير المنهج التاريخيّ المتقدِّم، وإن كان كلاهما من المناهج المتَّبعة في دراسة الكتاب المقدَّس.
ولا بد من الإشارة -أيضًا- إلى أنَّ المنهج الفيلولوجيّ قد يجمع منهجيَّات عدَّة، يمكن الكلام عنها وبحثها بشكلٍ مستقلّ، من قبيل: النقد النصِّيّ، أو نقد المصادر، أو تحقيق النصوص، فكلّ هذه الأمور تدخل في المنهج الفيلولوجيّ.
يمكن -وبشكلٍ مختصر- تعريف الفيلولوجيا بأنَّها: دراسة النصوص بشكلٍ يؤهِّل لفهم الحضارة القديمة، مع مراعاة التطوُّر الإنسانيّ فيها سياسيًّا، واقتصاديًّا،
واجتماعيًّا، وأدبيًّا؛ من خلال استيعاب عقليَّة الشعوب، وتطوُّرها الثقافيّ، وتمظهراتها اللغويَّة.
ويهتمّ علم الفيلولوجيا بنقاط رئيسة ثلاث، هي:
1- إعداد النصوص وطبعها
2- نقد صحّة النصوص
3- البحث عن مصادر النصوص.
فعلم الفيلولوجيا يعتني بدراسة التغيُّرات اللغويَّة عبر التاريخ، واصطلاح الفيلولوجيا في منشئه يدور بين معنيين: معنى قديم (دراسة النصوص القديمة)، ومعنى حديث (علم اللغة)، ويرى صبحي الصالح أنَّ «اسم فقه اللغة عندهم [أي الغربيِّين] (philology): كلمة مركَّبة من لفظين إغريقيَّين: أحدهما (philos) بمعنى الصديق، والثاني (Logos) بمعنى الخطبة أو الكلام، فكأنَّ واضع التسمية لاحظ أنَّ فقه اللغة يقوم على حبّ الكلام، للتعمق في دراسته من حيث قواعده وأصوله وتاريخه، وعلى هذا النحو كان العلماء في عصر إحياء العلوم يفهمون «فقه اللغة»، بل كان هذا الاسم إذا أطلقوه لا ينصرف إلَّا إلى دراسة اللغتين الإغريقيَّة واللاتينيَّة؛ من حيث قواعدهما، وتاريخ أدبها، ونقد نصوصها». وبذلك يدلّ اصطلاح الفيلولوجيا في الغرب قديمًا على الاعتناء بالنصوص القديمة دراسة ونقدًا وتحقيقًا وضبطًا… ابتداءً بالنصوص اليونانيَّة واللاتينيَّة فالشرقيّة (العبريَّة والفارسيَّة…) ثمَّ العربيَّة.
ويمكن القول إنَّه حصل توسُّع في الفيلولوجيا، ليتعدى دراسة اللغة اليونانيَّة فقط، ويشمل دراسة أيّ لغة من اللغات ذات بعد حضاريّ.
«وهذا المصطلح له معان مختلفة في اللغات الأوروبيّة، ففي اللغة الإنكليزيّة يعني (الدراسات التاريخيَّة المقارنة)، وأمَّا في الألمانيَّة، فإنَّه يستعمل عنوانًا للدّاسة العلميَّة المتعلِّقة بالنصوص الأدبيَّة، ولا سيَّما تلك المتعلِّقة بالعالم الإغريقيّ الرومانيّ
القديم، ويستعمل فيها -أيضًا- على نحوٍ أكثر عموميَّة لدراسة الثقافة والحضارة من خلال الوثائق الأدبيَّة. وهو يعمد في فرنسا إلى دراسة النصوص الأدبيَّة المكتوبة، ونقدها، وإعدادها للنشر. ومعنى ذلك أنّ ما يعنيه مصطلح (الفيلولوجيا) في اللغة الإنكليزيَّة هو مرحلة متقدِّمة من مراحل علم اللغة الذي كان من أهمّ بشائره تطبيق منهج البحث التاريخيّ ومنهج البحث المقارن في دراسة اللغة».
وهناك دراسات استشراقيَّة فيلولوجيَّة كثيرة حول القرآن الكريم، نذكر أبرزها -على أن يأتي الردّ على بعضها في طيَّات أبحاث الكتاب- ومن هذه الدراسات:
ـ الدراسة الفيلولوجيَّة حول النصوص القرآنيَّة للمستشرق نولدكه في كتابه «تاريخ القرآن» في الجزء الأوَّل منه والذي حمل عنوان: «في أصل القرآن»
ـ دراسة المستشرق الإنكليزيّ وليام موير، وذلك في كتابين له: أحدهما في السيرة وهو كتاب «حياة محمَّد»، والآخر في القرآن، بعنوان: «القرآن: نظمه وتعاليمه وشهادته للكتب المقدَّسة»
ـ دراسة المستشرق المجريّ جولدتسيهر في كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام» في موضوع «محمَّد والإسلام»
ـ دراسة المستشرق الفرنسيّ ريجيس بلاشير في كتابيه «القرآن -نزوله، تدوينه، ترجمته، وتأثيره-» و«تاريخ الأدب العربيّ»، فهو أحد الذين صرَّحوا أنَّ الفيلُولُوجيا هي مما يُعين على اكتشاف معالم القرآن الذي يُمثِّل انعكاسًا لسيرة النبيّ محمَّد صلىاللهعليهوآله
والعبارات التي يستخدمها أصحاب هذا المنهج هي من قبيل: «إعادة قراءة القرآن» وهو عنوان كتاب لجاك بيرك، أو تعبير بلاشير في كتابه «تاريخ الأدب العربيّ» بعنوان «تكوين النصّ القرآنيّ»، أو ما كتبه كريستوف لكسنبرغ بعنوان «قراءة سريانيَّة آراميَّة للقرآن -مساهمة في تحليل اللغة القرآنيَّة-».
استخدم المستشرقون هذا المنهج في دراستهم للنصوص الإسلاميَّة، وبرعوا من هذه الناحية وأجادوا، وكان لهم في ذلك جهدٌ كبيرٌ وفضلٌ في استخراج العديد من المخطوطات، وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم للعديد من اللغات واطِّلاعهم على المخطوطات ووصولهم إلى أماكنها، واكتشافهم للعديد من النقوش والآثار، وقد برعوا في جمع هذه المخطوطات ومقابلتها والتوفيق بينها، كما برعوا في الدقَّة في الترجمة وتحقيق النصوص وإرجاعها إلى مصادرها الأصليَّة. ولكنَّ هذه الطريقة لم تسلم من الخطأ؛ فإنَّ أغلب المستشرقين قد رسخت في أذهانهم فرضيَّات علميَّة وأحكام مسبقة، وهم يحاولون إثباتها دائمًا وتطويع النصوص للبرهنة على صحَّتها.
يعتمد المنهج الفيلولوجي في بناء الموضوع على النصوص التي يجتهد في جمعها الباحث من المصادر المتاحة، ويركِّز على جزئيات الموضوع إذا وجدها جاهزةً أو يعمل على تجزئة الموضوع إن كان فيه تركيب، ثمَّ يبحث لكلِّ جزءٍ عن أصلٍ في التراث الإسلاميّ أو في التراث السابق عليه؛ ثم إذا حان وقت استخلاص النتيجة يتوقَّف صاحبه أو يتردد خوفًا من أن تكون هناك نصوص لم تكتشف بعد قد لا تؤيِّد الحكم الذي قرَّره، فهو -إذًا- لا يصل إلى نتيجة نهائيَّة، بل يترك الباب مفتوحًا أحيانًا. وحسب الظاهر، فإنَّ هذا المنهج إيجابيٌّ لشدَّة احتياطه وعدم استسلامه للتخمينات والفرضيَّات، لكن هذه المزايا لا تلبث أن تتوارى أمام المساوئ الناتجة عنها؛ ذلك أنَّ لهذا المنهج عند المستشرقين خلفيَّة أيديولوجيَّة خاصَّة، فتمارِس النظرة التجزيئيَّة التي يعتمدها هذا المنهج -عندئذٍ- عدوانًا خطيرًا على النصِّ وصاحبه، فتفتِّته وتقتل الحياة في سياقه، وتنتزع منه ما تريد وتلقي بالباقي وراء ظهرها. وأخيرًا، فإنَّ حرصَ هذا المنهج على ردِّ كلِّ فكرةٍ إلى أصلٍ سابقٍ عليها يصدر
عن تصوُّرٍ مسبقٍ مفاده أنَّ حضارةً ما عقيمة؛ وبالتالي فإنَّ مفكِّريها عاجزون عن الإبداع والتجديد.
وعليه، يمكن اختصار المعالم الرئيسة لهذا المنهج في أمرين:
1- تفكيك القضيَّة الكلِّيّة إلى جزئيَّات عدَّة
2- عزل تلك الجزئيَّات عن ذلك المفهوم الكلّيّ.
ومثال على ذلك أنَّهم حكموا -مثلًا- على وضع المرأة المسلمة من خلال عناصر معزولة عن الرؤية الكلِّيَّة للإسلام كالحجاب، وتعدُّد الزوجات، وعدم الاختلاط، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تبدو سلبيَّة في إطار النظرة الجزئيَّة السريعة المفصولة عن الرؤية الكلِّيَّة لوضع المرأة في الإسلام، وبالمقابل تأتي النظرة الاستشراقيَّة للمرأة الغربيَّة في ضوء عناصر جزئيَّة تبدو إيجابيَّة في شكلها المفصول عن الإطار العامّ، كعلاقاتها المفتوحة مع الرجال، وحرّيَّتها غير المنضبطة. والنظرتان مخطئتان؛ لقيامهما على وقائع جزئيَّة لا تقدِّم تصوُّرًا صحيحًا عن حال المرأة عند الجانبين وفي الرؤيتين الإسلاميَّة والغربيَّة.
لعلَّ أبرز وأهمّ نقدٍ للمنهج الفيلولوجيّ، خصوصًا في ما يتعلَّق بالدراسات القرآنيَّة الاستشراقيَّة، هو أنَّ هذا المنهج قام بإسقاط النتائج التي خرج بها من نقد (الكتاب المقدس) على القرآن الكريم. ولا يهمّنا في هذه الدراسة توجيه النقد إلى أصل المنهج الفيلولوجيّ، بل يكفي بيان سلبيَّات تطبيقه على النصوص القرآنيَّة.
والهدف الأساس من الإسقاط «إثبات أنَّ القرآن يخضع لأثر البيئة ويتطوَّر بتطوُّرها، وتنعكس فيه المصالح الاجتماعيَّة والسياسيَّة».
في الواقع منهج الإسقاط هو عبارة عن توصيفٍ للدراسات الاستشراقيَّة، لا أنَّه منهج يعتمده المستشرقون كما هو حال المنهج التاريخيّ أو المنهج الفيلولوجيّ، أو غير ذلك من المنهاج؛ ولذا عدَّ بعض المهتمِّين بالدراسات الاستشراقيَّة عمليَّة الإسقاط منهجًا معتمدًا لدى بعض الدارسين الغربيّين للعلوم الإسلاميّة. والحقيقة أنَّ هذا المنهج منهجٌ نفسيٌّ لا يمكن التحرُّر منه إلَّا بالتقيُّد الجازم بالمنهج العلميّ السليم والأمانة العلميَّة الحقَّة، ولهذا السبب فهو منهجٌ مذمومٌ من جهة، ولا يُحبّذ الوقوع فيه -بقصدٍ أم بغير قصد- والإعلان عن استعماله من جهةٍ أخرى، كما أنَّه ليس منسوبًا في بدايته إلى أحدٍ بعَينه. نعم، يمكن اعتبار أيّ عمليّة إسقاط هي غير علميَّة سواء صدرت من المستشرقين أو من غيرهم، ولكن لكثرة وقوع هؤلاء في الإسقاطات اعتبر هذا الإسقاط منهجًا؛ لأنَّه من غير المنطقيّ الوقوع بهذا الحجم الكبير والخطير دون قصد.
وعلماء النفس اعتبروا الإسقاط عمليةَّ لا شعوريَّة يقوم بها المسقط على أفكار الآخرين؛ لأنَّهم كما قالوا: «الإسقاط حيلة نفسيَّة، يلجأ إليها الشخص وسيلةً للدفاع عن نفسه ضدّ مشاعر غير سارّة في داخله، مثل الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص، فيعمد -على غير وعيٍ منه- إلى أن ينسب للآخرين أفكارًا ومشاعر وأفعالًا حياله، ثمَّ يقوم من خلالها بتبرير نفسه أمام ناظريه».
ويبدو أنَّ تفسير كلّ عمليَّات الإسقاط على أنَّها عمليَّات لا شعوريَّة غير صحيح؛ لأنَّ هناك عمليَّات إسقاطٍ مقصودة، نلحظها خصوصًا في الدراسات الاستشراقيّة والغربيّة للإسلام والقرآن الكريم.
فعند مراجعة بعض دراساتهم للقرآن الكريم وعلومه -كما سيأتي- نرى أنَّ هؤلاء قد مارسوا عمليَّة الإسقاط متأثِّرين بخلفيَّاتهم العقديَّة وموروثاتهم الفكريَّة، ومندفعين بدافعٍ نفسيٍّ يهدف إلى رَمي القرآن الكريم بما ثبت في حقِّ كتبهم المقدَّسة، والانتقاص من هذا الكتاب العظيم.
وسنحاول الإضاءة المختصرة على هذا المنهج من دون الدخول في النماذج الإسقاطيَّة في الدراسات الاستشراقيَّة، من قبيل: إسقاط المفاهيم الاستشراقيَّة على التعريف بالقرآن الكريم، أو إسقاط المفاهيم الاستشراقيَّة على تاريخ القرآن الكريم، والإسقاطات ذات المنطلقات الدينيَّة أو الفكريَّة، وغير ذلك؛ لأنَّنا سنبيِّن بعضًا من ذلك في الأبحاث القادمة.
هو إسقاط الواقع المعيش على الحوادث والوقائع التاريخيَّة، إنَّه تصوُّر الذات في الحدث أو الواقعة التاريخيَّة. فالمنهج الإسقاطيّ هو المنهج الذي يُسقط فيه المستشرق من ذاته على الموضوع، أي ممَّا في ذهنه من أحكامٍ مسبقةٍ من ثقافته ودينه وتحيُّزاته الخاصَّة، فتغطِّي الموضوع وتكون بديلًا عنه، وقد يصل الأمر إلى حدِّ التعصب لهذه الأحكام الإسقاطيَّة الخاصَّة.
فيسمَّى الإسلام -مثلًا- «المحمَّديَّة» كما فعل «جِبْ» قياسًا على المسيحيَّة نسبةً إلى المسيح، أو البوذيَّة نسبة إلى بوذا، أو الكونفوشوسيَّة نسبة إلى كونفوشيوس، أو التاويَّة نسبة إلى تاو.. مع أنَّ الإسلام غير مشتقّ من اسم الرسول محمَّد صلىاللهعليهوآله، بل من لفظ «سلم».
ويتمثَّل هذا المنهج في خضوع الباحث إلى هواه، وعدم استطاعته التخلّص من الانطباعات التي تركتها عليه بيئته الثقافيَّة المعيَّنة، وعدم تحرُّره من الأحكام المسبقة التي يكوِّنها عن موضوع بحثه، ويعني ذلك تفسير التاريخ بإسقاط الواقع
المعاصر المعاش على الوقائع التاريخيَّة الضاربة في أعماق التاريخ، فيفسِّرونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاصَّة وما يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم، وهم بذلك يحاولون إثبات الصور المرسومة في أذهانهم حتَّى وإن استحال وقوعها وينفون الحقائق الواقعة التي لا تتصوَّرها أذهانهم.
من الملاحظات المنهجيَّة على هذا المنهج:
ـ هذه المنهجيَّة خاضعة للهوى، وبالتالي لا يرجى منها إعطاء نتائج صائبة حول الإسلام وحضارته وعلومه
ـ ما في ذهن المستشرق هو أحكام مسبقة من ثقافته ودينه وتحيُّزاته الخاصَّة، يُسقطها على الموضوع، فتغطّيه وتكون بديلًا عنه. وقد يصل الأمر إلى حدِّ التعصب لهذه الأحكام الإسقاطيَّة الخاصَّة.
المنهج التحليليّ: هو منهج يقضي بتحليل الظاهرة المركَّبة إلى عناصرها الأوَّليَّة التي تكوَّنت منها لمعرفة الأجزاء بوضوحٍ وإصدار الأحكام على كلٍّ منها. وهو أفضل من ترك الظاهرة الكلِّيَّة والحكم عليها دون رؤية الأجزاء من قبل. الكلّ مركَّبُ من أجزاء، ولا يمكن إصدار الحكم على الكلّ دون معرفة الأجزاء التي يتكوَّن منها. الفكر مثل الجسم، كلٌّ منهما مركَّب من أجزاء. والحضارة الإسلاميّة علوم، وكلُّ علمٍ مكوَّنٌ من موضوعات، وكلٌّ موضوعٍ من موضوعات أصغر، وبتفكيكها تضيع الرؤية الكلِّيَّة. والحضارة قصدٌ كلِّيّ، لا يمكن تقطيعه إلى أجزاء مثل التوحيد في علم أصول الدين، والمصلحة العامَّة في علم أصول الفقه، والحكمة في الفلسفة، والكمال
في التصوُّف. ويعتزُّ الغرب بأنَّه وضع المنهج التحليليّ منذ ديكارت عندما جعل التحليل القاعدة الثانية في المنهج العقليّ بعد الحدس وقبل التركيب والمراجعة. وصحيحٌ أنَّ الغرب تفادى عيوب التحليل بالتركيب في المنهج التكامليّ في علم النفس والمنهج الجدليّ لاكتشاف قوانين التاريخ... لكنّ قوَّة الحضارة الإسلاميّة في مقاصدها الكلِّيَّة، وتفتيتها يضعفها ويضيع رؤيتها للعالم ويحوّلها إلى شذراتٍ تاريخيَّة صِرف. كان الهدف من المنهج التحليليّ في الغرب التحقُّق من صدق الكلِّيَّات، سواء في تحليل الظواهر أم في تحليل النفس أم في تحليل اللغة. وهو ما سمَّاه الأصوليُّون السبر والتقسيم في البحث عن العلَّة الفاعلة، أو العلَّة المؤثِّرة، أو العلَّة المناسبة، أو العلَّة الملائمة، بعد رصد العلل الممكنة، ثمَّ اختبار كلّ واحدة منها، وهو ما سمَّاه اللغويُّون القسمة للألفاظ وأنواعها. والتحليل عند القدماء وسيلةٌ لا غاية. في حين أنَّ استخدام المستشرقين للتحليل هو لضياع النظرة الكلِّيَّة، وتحويل الحضارة الإسلاميَّة الحيَّة إلى أجزاء متناثرة مثل أجزاء محرِّك مفكَّك ولا يعمل.
يُستعمل المنهج التحليليّ عمدًا للقضاء على الطابع الكلِّيّ الشامل. وهو أهمّ ما يميِّز الحضارة الإسلاميّة التي قامت -أيضًا- على وحيٍ كلِّيٍّ شامل، فبتفتيت الكلّ لا يرى أحد الأجزاء المتناثرة، ومن ثمَّ لا تختلف الحضارة الإسلاميَّة عن الغربيَّة في شيء، فكلٌّ منهما ستبدو في هذه الحالة وكأنَّها مجموعةٌ متناثرةٌ من الأجزاء. وقد يُستعمل التحليل بطريق لا شعوريّ تعبيرًا عن رغبةٍ دفينةٍ في الهدم المنهجيّ، وقضاءً على الموضوع، فالتحليل تفتيت وسحق، وقد يحقِّق الباحث، من خلاله وتحت دعاوى منهجيَّة، ما يريد من القضاء على الظاهرة إن أراد، أو تقديمها بطريقةٍ غير موضوعيَّة وغير سليمة. وقد يُستعمل التحليل حتى يمكن ردّ كلّ جزءٍ إلى أجزاء شبيهة في حضارات معاصرة، ومن ثمَّ يكون التحليل مقدِّمة لإثبات الأثر الخارجيّ، وتفريغ الحضارة من مضمونها الأصيل، والادِّعاء بأنَّ كلَّ اكتشافاتها ومنجزاتها المعرفيَّة -مثلًا- مأخوذة أصلًا من ثقافاتٍ وحضاراتٍ أخرى، وفي هذا تقليلٌ من شأن جهدها وموروثها.
منهج البناء والهدم، حيث الإطراء والمديح ثمَّ الطعن. ففي مرحلة البناء، يقوم المستشرق بالإطراء على الظاهرة التي يدرسها، أو على جوانب ثانويَّة منها، ثم يأتي دور الهدم، حيث يجرِّد تلك الظاهرة من أهمّ مقوّماتها وأركانها على نحوٍ يؤدِّي إلى سقوطها، وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون المعاصرون أمثال وات، غوستاف فون غرونبوم.
فعلى سبيل المثال المستشرق الفرنسيّ «غوستاف لوبون» (Lebon) (ت1931م) يستخدم هذا المنهج في كتابه «حضارة العرب» فيذكر -على سبيل المثال- أفكارًا صحيحةً ومعتدلةً عن الإسلام، ويشيد بالإسلام ونبيِّه، وبعد جملةٍ وافرة من المديح والإطراء، يبدأ بعمليَّة الهدم، فيصنِّف النبيّ ضمن فصيلة المتهوّسين وأصحاب الصرع، إلى غيرها من المناهج الخطيرة على فهم الإسلام والقرآن ونبيِّ الإسلام. وسيأتي تفصيلٌ آخر للمناهج في مبحث مناهج دراسة القرآن الكريم.
نُسجِّل -هنا- ملاحظات عدَّة على منطلقات البحث في المناهج الاستشراقيَّة، تتمثَّل في عاملين:
ـ جهلُ كثيرٍ من المستشرقين بحقائق الإسلام… وهذا الجهل قد أدَّى بهم إلى كثيرٍ من الأخطاء في استنتاجاتهم العلميَّة
ـ الحكم المسبق على الإسلام، وإنكار كثيرٍ من المسلَّمات التي يرتكز عليها الفكر
الإسلاميّ، وبخاصَّة في ما يتعلَّق بالوحي والقرآن والسنَّة والعقيدة. و«يعتمد جمهرة المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن الشريعة الإسلاميّة على ميزانٍ غريبٍ بالغ الغرابة في ميدان البحث العلميّ، فمن المعروف أنَّ العالِـمَ الـمُخْلِصَ يتجرَّد عن كلِّ هوىً وميلٍ شخصيٍّ في ما يريد البحث عنه، ويتابع النصوص والمراجع الموثوق بها، فما أدَّت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو النتيجة المحتّمة التي ينبغي عليه اعتقادها. ولكنَّ أغلب هؤلاء المستشرقين يضعون في أذهانهم فكرةً معيَّنةً يريدون تصيُّد الأدلَّة لإثباتها، وحين يبحثون عن هذه الأدلَّة لا تهمُّهم صحَّتها بمقدار ما يهمّهم إمكان الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصيَّة».
ـ إنَّ مناهج البحث الاستشراقيَّة بخصائصها المتميِّزة لا يمكنها بحال أن تقدِّم تفسيرًا معقولًا شاملًا متماسكًا لتاريخنا الإسلاميّ؛ لأنَّ التفكير الذي يحكم عقليَّة المستشرق هي الدوافع المادِّيَّة، ولذا تسعى مناهحهم دائمًا إلى ترجيح الدافع المادِّيّ، وتقليص مساحة الدوافع الروحيَّة في حركة التاريخ، وربَّما طمسها وإنكارها أساسًا. فهي لا تقوم على أساسٍ متوازنٍ ينظر إلى القيم الروحيَّة والماديَّة على أنَّها عوامل فعَّالة مشتركة في صنع التاريخ.
ـ من المشاكل التي تحكم المناهج الاستشراقيّة هي مركزيَّة الغرب في عمليَّة أيّ تقييم لأيّ نموذجٍ آخر؛ فالثقافة والحضارة الغربيّة هي الأعلى والأسمى والأنقى، وبالتالي إنَّ طريقة الحياة الغربيّة هي النموذج الصحيح الوحيد الذي يمكن أن يُتَّخذ مقياسًا للحكم على سائر طرائق الحياة؛ لأنَّ كلَّ مفهومٍ ثقافيٍّ أو مؤسَّسة اجتماعيَّة أو تقييمٍ أدبيٍّ يتعارض مع النموذج الغربيّ، إنَّما ينتمي -حتمًا- إلى درجةٍ من الوجود أدنى وأحطّ.
(201)
تقدم في المبحث السابق إطلالةٌ عامةٌ على معنى المنهج، وعرضنا بعضًا من المناهج التي اعتمدها المستشرقون في دراستهم للشرق وبالأخص العلوم والمعارف الإسلاميّة ومن هذه المناهج: المنهج التاريخي، والمنهج الفيلولوجي، والمنهج الإسقاطي، وغير ذلك مما تقدّم، وما نريد طرحه في هذا المبحث هو خصوص مناهج دراسة القرآن الكريم التي تتقاطع مع المناهج العامّة، وفيها بعض الخصوصيات الأخرى.
وقبل الدخول في مناهج المستشرقين في دراستهم للقرآن، لا بدّ من الإشارة إلى بعض النقاط المنهجية المهمّة في هذا الصدد:
عندما بدأت دراسات المستشرقين للإسلام لم تكن كتابات علمية ومنهجية ولا بحوثًا تتوخى حقائق التاريخ، وإنما كانت أسلحة من أسلحة الدعاية الحربية، وأسلوبًا انتقاديًا ضد الإسلام وأهله؛ وذلك ردّة فعل لما لاقوا من هزائم على أيدي المسلمين.
ومن أشد هذه الكتابات على الإسلام كانت الكتب التي صدرت في العصور الوسطى، أما كتب القرنين الحادي عشر والثاني عشر فقد تميزت بكثير من التهور والاندفاع في حرب الإسلام وأهله.
وهذا يعني أننا لا نستطيع اكتشاف المناهج الاستشراقيّة من هذه الكتابات، بل لا بدّ من تتبع الدراسات الأخرى التي كتبت في ما بعد ذلك خصوصًا من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين.
«إنّ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ الخاصة بالمستشرقين في بحث الدراسات والقضايا القرآنيّة، تتغيّر وتتبدّل من بحث لآخر، تبعًا لخلفيات الباحث ومنطلقاته الفكرية في توظيف المنهج على الدراسة بعينها».
ومن خلال استقراء مناهج المستشرقين في دراسة القرآن الكريم وعلومه، يلحظ الباحث صعوبة استبانة طرق المعالجة، وآليات المنهج الموظف، نظرًا لتباين الخلفيات الفكرية التي ينطلق منها هؤلاء في دارستهم للقرآن.
طبعًا هذا لا يمنع من وجود مناهج عامة حكمت أغلب الدراسات الاستشراقيّة للقرآن، ولكن من الصعوبة بمكان الالتزام بمنهج أو أكثر وتعميمه على كل الدراسات الاستشراقيّة من دون ملاحظة المناهج البحثية للباحث نفسه، التي قد تختلف من مستشرق لآخر؛ بمعنى أنّه قد يستخدم منهجًا ما أو أكثر من منهج، ولكنه في الوقت نفسه يستخدم منهجًا خاصًّا به، غير ما استخدمه مستشرق آخر، اتفق معه في المنهج العام، ولا بد من الالتفات أيضًا إلى أنّ منهج المستشرق الخاص قد يؤثر حتى على منهجه العام. ولذا اعتقد أنّه من الأدق من الناحية العلميّة اعتماد المناهج المنوطة بالدراسة نفسها وتحليلها.
على الرغم من الملاحظة المتقدمة، من الممكن الإشارة إلى بعض المناهج العامة التي لوحظ وجودها في كثير من الدراسات الاستشراقية، ولكن السؤال هو هل يمكن حصر هذه المناهج بعدد معين؟
يعتبر بعض الباحثين أنّه قد غلب على الموضوعات القرآنيّة المتعددة عند المستشرقين اتّجاهات عدّة؛ من أهمّها:
• اتجاه دراسة القرآن الكريم في ضوء علم نقد الكتاب المقدس Biblical Criticim.
• اتجاه دراسة القرآن الكريم في ضوء المنهج التنصيري.
• اتجاه دراسة القرآن الكريم في ضوء المنهج المقارن.
• الاتجاه المرتبط بترجمات معاني القرآن الكريم.
وبعض الباحثين عمموا المناهج ولكنهم اختلفوا في عددها وتسمياتها، فبعضهم اعتبر أن المناهج المختلفة عند المستشرقين لا تتعدى منهجًا واحدًا وهو منهج الإسقاط وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المنهج في الأبحاث السابقة، فقد «مارس المستشرقون عملية الإسقاط متأثرين بخلفياتهم العقدية وموروثاتهم الفكرية ومندفعين بدافع نفسي يهدف إلى رَمي القرآن الكريم بما ثبت في حق كتبهم المقدّسة ودياناتهم المحرّفة، محاولين بذلك الانتقاص من قدر هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي -لا محالة- يشهد له في كل عصر شهودٌ جُددٌ بالإعجاز والعظمة.
ومنهم من عدها أربعة مناهج وقال إنّه يمكن إجمال هذه المناهج التي يشترك فيها عدد من المستشرقين قديمًا وحديثًا وهي النزعة التأثيرية، الانشطارية، الشك والتزوير، وسنعرض هذه المناهج ضمن عنوان: «المناهج الاستشراقيّة لدراسة القرآن الكريم». ونعتقد أنّ هناك مناهج أخرى غير هذه الثلاثة المتقدمة فلا حاجة لحصر المناهج الاستشراقيّة القرآنيّة بعدد معيّن.
بغضّ النظر عن صحة المناهج الاستشراقيّة التي سنتعرض لها فإنّها لا يمكنها أن
تعالج الظواهر الغيبية كالقرآن الكريم، لأنّها بالأصل تعالج هذه الحقائق الغيبية وفق المنهج المادي والعقلي المحض، ومن هنا كانت نتائجها غير صحيحة، ولا تزيد الباحث إلا بُعدًا عن القرآن وتعاليمه، هذا في حال افترضنا حُسن النية عند هؤلاء في استخدام هذه المناهج.
يقول رودي باريت: «ونحن في هذا نطبّق على الإسلام وتاريخه، وعلى المؤلفات العربيّة التي نشتغل بها المعيار النقدي نفسه الذي نطبّقه على تاريخ الفكر عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن».
ينطلق أغلب هؤلاء من نظرية التفوق العنصري، والكراهية والحقد على الإسلام، وهذا ليس مجرد إدعاء في حقهم بل تشهد على ذلك عشرات بل مئات الدراسات التي سطّروها عن الإسلام؛ وبالأخص عن القرآن الكريم.
اعتمد المستشرقون بشكل عام على فكرة تغريب الحضارة والفكر الإسلاميّ، في أغلب دراساتهم والهدف من ذلك تضعيف الحضارة الإسلاميّة، فقد حاول هؤلاء بكل الأساليب والطرق الممكنة تغريب الفكر الإسلاميّ، والمقصود بالتغريب إظهار تفوق الفكر الغربي على الفكر الإسلاميّ، يقول بعض الباحثين: إنّ «اصطلاح «التغـريب» ليس من ابتكارنا في الشرق، ولكنه ظهر في المعجم السياسي الغربي باسم «Westernyation»، وكانوا يعنُون به نشْر الحضارة الغربيّة في البلاد الآسيوية والإفريقية الواقعة تحت سيطرتهم عن طريق إزالة القُوى المضادَّة التي تحفظ لهذه البلاد كِيانها وشخصيتها وعاداتها وتقاليدها، وأهمّها الدين واللغة، وفي زوال هذه القوى ضمان لاستمرار السيطرة الغربيّة السياسية والاقتصادية حتى بعد إعلان استقلال هذه البلاد وتحرُّرها من نير الاستعمار الغربي ظاهـريًا ويكاد
التغريب يرافق كل مراحل الحركة الاستشراقيّة وكل التيارات المختلفة، قد بيّن المستشرق هاملتون جب في كتاب «وجهة الإسلام» الذي ألفه مع مجموعة من المستشرقين، وصدر سنة 1947م. وأشار إلى أنّ الهدف من هذا البحث هو معرفة إلى أي حد وصلت إليه حركة تغريب الفكر الإسلاميّ، وما هي العوامل التي تحول دون هذا التغريب.
ويمكن من خلال مطالعة الكتاب المذكور أن يكتشف القارئ أبرز مناهج التغريب التي يسقطها المستشرقون على الفكر الإسلاميّ.
ويستخدم الآن في الدراسات المعاصرة مصطلحا (علم الاستغراب) occidentalism أو (فقه الاستغراب) وهما في مواجهة (التغريب) westernization الذي امتد أثره إلى الحياة الثقافية للعالم، وهدد استقلالنا الحضاري وامتد إلى أساليب الحياة وأنماطها.
فالاستغراب علم أو حركة تقابل علم أو حركة الاستشراق ويعنى بدراسات علمية وثقافية للغرب، أما التغريب فهو تقمص الفكر الغربي على حساب الفكر الإسلاميّ والثقافة الإسلاميّة.
وهذا المنهج هو ما يطلق عليه مصطلح «التأثر والتأثير»، -وسنشير إلى تطبيقاته في الأبحاث الآتية-، وهو نزعة دراسية يأخذ بها من اعتادوا رد كل عناصر الإسلام وعلى رأسها القرآن إلى عناصر أخرى؛ كاليهودية أو النصرانية أو إليهما معًا، وللأسف
أصر جملة من المستشرقين كماركس هورتن الألماني، ورينان الفرنسي أن الجنس العربي ليس من صفاته التعمق في التفكير ولا الابتكار، بل عنده قصور في هذا المجال فالعربي ليس من طبيعته التفلسف. وهؤلاء من شدة عنصريتهم وتعصبهم لا يُرجعون المصادر الإسلاميّة فقط إلى مصادر يهودية ومسيحية، بل يصفون العرب بالقصور الذاتي في التفكير، وأنّ العربي لا يتمكن من الناحية التكوينية من التفكير المعمّق والتفلسف، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مدى الانحطاط الفكري عند هذه العيّنة من المستشرقين.
وهذه النزعة التأثيرية تشكل خطورة كبيرة على أصالة الفكر الإسلاميّ، لا لأنّنا لا نعترف بوجود تشابه في بعض الأمور والأفكار بين الفكر الإسلاميّ وغيره، بل لأنّ محض التشابه لا يؤدي إلى تهجين الفكر الإسلاميّ وعدم أصالته والحكم عليه بأنّه فكر تلفيقيٌ من أفكار يهودية، ومسيحية، وفارسية، وغير ذلك.
والفكرة الحاضرة عند المستشرقين هي: كلما وجد تشابهٌ بين الأفكار الإسلاميّة وغيرها من الأفكار الأجنبية، فهذا يعني أن الفكرة غير إسلامية، فعندما نراجع دراسات المستشرقين للتصوف الإسلاميّ نجدهم يرجعونه إلى أصول خارجية كالعنصر الفارسي أو الهندي، لا لشيء إلا لوجود عناصر متشابهة بين التصوف الإسلاميّ والتصوف الفارسي.
ثم حاولوا تطبيق ذلك على القرآن من خلال ردّ قصصه، وأحكامه، وعقائده،... إلى التوارة، والتلمود، والإنجيل، ...
الانشطاريّة تعني الفصل بين القيم المتكاملة في الفكر الإسلاميّ، والقول بعجزها عن التفاعل والترابط، وعدم قدرتها على الاستيعاب والتكامل.
والمستشرقون الغربيّون يعون جيّدًا مدى تكامل المعرفة الإسلاميّة والفكر
الإسلاميّ المبني أساسًا على التكامل بين قيمه ومُثُله، والترابط بين مختلف جوانبه، ولكنهم عندما يحاولون دراسة بعض مباحث الفكر الإسلاميّ؛ فإنّهم يسعَون جاهدين إلى تجزئتها وعزل بعضها عن بعض؛ بقصد التأكيد على استحالة التقاء عناصر القوة والتكامل في آن واحد.
ولعل أبرز ما وصلت إليه الانشطارية في الفكر الغربي وحاول المستشرقون تطبيقه على الفكر الإسلاميّ هو الدعوة إلى الانفصال بين الحاضر والماضي؛ فإنكار الماضي كلّيّةً مع الدعوة إلى الانفصال عنه يعتبر من خصائص الفكر الغربي، وهو ما يحاول بعض المستشرقين نقله إلى الفكر الإسلاميّ؛ حيث نجد ثُلَّة منهم يرمون التراث الإسلاميّ بكل مهانة وانتقاص، بل إنّهم ينكرون على زملائهم من التقليديين إضاعةَ الوقت في تكريس الاتجاهات المطلوبة؛ ولذلك فإنّ معظم المستشرقين لا يسلكون مسلكَ المسلمين في التدليل على قيمة الإسلام وتراثه الخالد في صلته بالحياة.
من المناهج التي نراها في كثير من الدراسات الاستشراقيّة وبالأخص الدراسات القرآنيّة، وسيتّضح هذا الأمر في طيات هذه الأبحاث.
لا بدّ من التنويه أنّ منهجي الشك والتزوير استخدمهما علماء الاستشراق بشكل عام ولكن تم توظيفهما بشكل مكثّف وواضح في مجال القرآن بهدف التشكيك بمصدر القرآن والوثوق بنقله، وجمعه، وترتيبه، والنسخ، والمكي والمدني، بالإضافة إلى تزوير بعض الحقائق القرآنيّة المسلَّمة، وهذا المنهج قديم وقد استخدمه المشركون في بداية الدعوى الإسلاميّة فوصفوا النبيّ بأنّه مفتري، وأنّه تعلّم القرآن من بشر وغير ذلك من الافتراءات التي سيأتي الحديث عنها.
واستخدم المستشرقون المنهج الشكّي الديكارتي في تفسير المبادئ الإسلاميّة
وظاهرة الوحي والنبوة، وتفسير بعض المعجزات التي حصلت للأنبياء السابقين، لذلك كانت نتائجهم مخالفة لاعتقاد المسلمين.
ولقد انساق المستشرقون المعاصرون مع أسلافهم في اتباع منهج الشكّ والمبالغة في إثارة الشكوك على الوقائع التاريخيّة الثابتة، والروايات الصحيحة المرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه، واعتمدوا في ذلك على عمليّة الانتقاء بطريقة مغرضة وهادفة إلى ما يصبون إليه من نتائج عكسية، والذي عزز بعض النتائج عند هؤلاء الأمور الآتية:
ـ عدم ثقتهم في صحة النص القرآني دفعهم إلى الشك في أمانة نقله وسلامة تبليغه.
ـ الشك في جمعه وترتيبه، كما يدعي كثير من المستشرقين أنّ النص القرآني الذي جاء به محمد قد نالته تعديلات بالزيادة والنقصان خاصة في صورته المكتوبة، ووجدوا في موضوع اختلاف المصاحف الخاصة التي كانت بأيدي بعض الصحابة ميدانًا لزلزلة العقيدة وفتح أبواب الشكوك والارتياب بصحة النص القرآني.
وقد جمع المستشرق الإنجليزي آرثر جفري الاختلافات المنسوبة إلى المصاحف الفردية لبعض الصحابة أمثال ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وحفصة، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وغيرهم - رضي الله عنهم - كما جمع الاختلافات المنسوبة إلى بعض مصاحف التابعين، وقد جمع ذلك من مختلف المصادر القديمة التي احتفظت بالروايات الآحاد والشاذة المنسوبة إليهـم، وبخاصة تفسير الطبري الذي استقصى الشيء الكثير من ذلك.
ومع أنّ بعضهم لا يجدون مناصًا من الاعتراف بأنّ بعض الاختلافات تبدو مستحيلة من الناحية اللغوية، وبعضها الآخر يشعر أنّها ممّا اخترعه بعض اللغويين
الذين نسبوها لهؤلاء الصحابة والتابعين، فإنّهم يصفون مصحف عثمان بأنّه أقرب المصاحف إلى الأصل، ولا يقولون إنّه الأصل الموثوق به نفسه، فهم يتحاشون الاعتراف بأنّ القرآن الكريم قد جُمع وفق منهج علمي رصين قوامه التوثيق والدقة والتثبت.
ـ وجد (ولش) في موضوع خلوّ مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود من المعوذتين (الفلق، والناس)، مجالًا للتشكيك في تواتر السورتين، وبالتالي التشكيك في موثوقية النص القرآنيّ.
وهناك شواهد كثيرة على أنّ المستشرقين مارسوا هذا المنهج في التعامل مع القرآن، على سبيل المثال، نذكر بعض النماذج، وسيأتي الرّد على بعض هذه الأفكار في المباحث الآتية:
1- كان علماء اللاهوت المسيحيّ قبل القرن السابع عشر الميلادي لا يرون أنّ القرآن جدير بالدراسة، ولقد أطلقوا عليه جميع الأوصاف والنعوت الشائنة، وحاولوا النيل من جوهره وتاريخه.
2- سجّل المستشرق الفرنسي(بلاشير) في كتابه (القرآن نزوله تدوينه...) العديد من الافتراءات والطعون، منها: أنّ القرآن منقول عن راهب من رهبان الكنيسة وأما ما فيه من قصص فهو أساطير معروفة في الجزيرة العربيّة، وغير ذلك من الافتراءات على القرآن الكريم.
أمّا المستشرق المجري(جولدتسيهر) فلقد حاول في كتابه (مذاهب التفسير الإسلاميّ) التشكيك في النص القرآني، حيث اعتبره مضطربًا وغير ثابت، وعباراته واضحة التحيّز والتعصّب.
ويقول (جورج سيل): «أمّا أنّ محمدًا كان في الحقيقة مؤلّف القرآن، والمخترع الرئيس له؛ فأمر لا يقبل الجدل...».
ويذهب المستشرق (لوت) إلى «أنّ النبيّ مدين بفكرة فواتح السور من مثل حم وطسم وألم إلى آخره لتأثير أجنبي، ويرجح أنّه تأثير يهودي؛ ظنًّا منه أن السور التي بدئت بهذه الفواتح مدنية، خضع فيها النبيّ لتأثير اليهود، ولو دقّق في الأمر لعلم أن سبعًا وعشرين من تلك السور التسع والعشرين مكية، وأنّ اثنين فقط من هذه السور مدنية، وهما سورتا البقرة وآل عمران.
والمقصود بالانتقاء: تفضيل الشيء على غيره، أو الإتيان بالتصرّف على الوجه الذي يريد، أو ترجيح تصرف على غيره وهذا المعنى من الانتقائية هو المعنى اللغوي. والمنهج الانتقائي عند المستشرقين قريب من معناه اللغوي أو العامّ وهو الانتقاء من دون الخضوع للضوابط العلميّة والمنهجية، فعلى سبيل المثال نجد في كتاباتهم عن القرآن الكريم، والسيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلاميّ أنّهم ينتقون بعض الروايات والأحداث والقضايا ويكتبون عنها ويهملون غيرها وهكذا الأمر في كتب الحديث فهم يذهبون إلى الكتب التي تجمع الأحاديث وبخاصة مثل كنز العمال وغيرها من الكتب التي لا يرد فيها تصحيح أو تخريج للأحاديث.
وهناك عدد من المستشرقين استخدموا هذا المنهج من قبيل (لامنس) و(بلاشير) وغيرهم. ومن أخطر أشكال الانتقائية الانتقاء في المصادر.
لا شك أنّ فعالية المنهج المتبع في أيّ دراسة، تتوقف على قيمة المصادر والروافد المعتمدة؛ إذ هي القاعدة المغذية والمادة الخام التي ترتكز عليها الدراسة، فكلما كانت المصادر رئيسة وأصيلة وذات علاقة مباشرة بالموضوع، كانت الدراسة أقرب إلى حصول المراد المنشود والمبتغى المقصود للباحث.
وفي إطار البحث الاستشراقي يتبين أن المنهج المتبع في انتقاء المصادر المعينة على بحث الموضوعات المرتبطة بالقرآنيات يتنوع ويختلف تبعًا لطبيعة الموضوعات المستهدفة من جهة، وموضوعية المستشرق وأمانته العلميّة أو حياده على الأقل في توظيف تلك المصادر والنقل عنها من جهة ثانية.
ومثالًا على هذا النوع من الانتقائية يذكر أحد الباحثين في دراسة أجراها أنّه بتتبّع عدد المراجع التي ذكرها (بلاشـير) فـي مقدمة كتابه مدخل إلى القرآن وجد أنّه اعتمد على مائة وثمانية وسبعين كتابًا ليس منها سوى سبعة وأربعين كتابًا عربيًّا، وكثير منها في الأدب والتاريخ؛ مثل اليعقـوبي ومـروج الذهب للمسعودي وأسد الغابة لابن الأثير ومقدمة ابن خلدون والفهرست لابـن النـديم.
ولعل من أبرز مواطن الخلل -في مجال انتقاء المصادر المتعلّقة بالقرآن وعلومه-التي يمكن الإشارة إليها- نذكر الآتي:
وهذا أمر يمكن أن يلاحظه كل من تتبع بدقة بعض دراسات المستشرقين في القرآنيّات، فعدد المصنفات العربيّة المتعلّقة بعلوم القرآن المعتمدة من طرف المستشرقين محدودة جدًّا، وهي في معظمها كتب جامعة لم تتحرَّ الصحة والنقد والرواية السليمة، وهكذا نجد أن نولدكه، وبيل، وبلاشير، وبورتون في جمع القرآن الكريم لا يتجاوزون كتب المصاحف لابن أبي داود، والإتقان للسيوطي، والفهرست
(213)لابن النديم، في حين لا نجد عندهم اعتمادًا يذكر على الروايات الصحيحة الواردة في كتب الصحاح والسنن أو في مقدمات المفسرين عند السنة؛ فضلًا عن الكتب الروائية والقرآنيّة عند علماء الإمامية. فاقتصروا على دراسة تفاسير محددة (الطبري -الزمخشري- ابن عربي...) ولم يستقصوا بيان مذاهب التفسير كلّها وقد يكون من حق الباحث أن يسلك هذا الطريق طوال بحثه، وألا يؤمن ببعض المناهج ويكفر بالبعض الآخر، ولو فعل المستشرق ذلك واستقصى جوانب التفسير المذهبي كلها من تشريعية فقهية، إلى لغوية نحوية، أو أثرية موسوعية من خلال جميع كتب التفسير التي كانت -على الأقل- في وقته لتكشَّفت له حقيقة مغايرة، وهي أن ّالنص القرآنيّ خصيب متجدّد وثريّ. فليس سهوًا إذن أن يغفل جولدتسيهر عن آثار أخرى في التفسير، وإنما هو التجاهل المتعمّد ليبدو محصول المسلمين من التفسير في النهاية رذاذًا متناثرًا فرّقته الأهواء الحزبيّة والفكريّة.
يكاد يتّفق منهج المستشرقين العام في الدراسات القرآنية على تعمّد اختيار الأخبار الضعيفة والروايات الشاذة في بطون الكتب وذلك لمقاصد وأغراض معينة. ولقد وجد المستشرقون في كتب معينة من كتب الأدب والتاريخ ضالتهم في هذا المحال فقاموا بتصيّد جملة من النصوص والشواهد وجعلوها أسسًا بنوا عليها أحكامهم القرآنية وغيرها.
لقد أخذ المستشرقون بالخبر الضعيف في بعض الأحيان وحكموا بموجبه، يقول جواد علي: «واستعانوا بالشاذ ولو كان متأخرًا، أو كان من النوع الذي استغربه النّقدة (النقًاد)، وأشاروا إلى نشوزه، تعمدوا ذلك لأنّ هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك».
يختلف البحث الاستشراقي في حقّ القرآنيات عن المنهج الإسلاميّ المؤسس على ضرورة اعتماد الموثوق من المصادر والمشهود له بالأولية والتميز، فالمصادر القرآنيّة
الموثوقة ليس فيها ما يسعفهم في تسويغ ما يَصْبون إلى تأكيده من أحكام مغرضة، واستنتاجات مغلوطة وخاطئة أريد لها أن تكون كذلك، ولهذا يلجئون إلى مصادر أخرى بحثًا عما يعينهم على بلوغ مأمولهم فيجدون بغيتهم في كتب الأدب والتاريخ وغيرها دون أدنى اكتراث بما يشكله اعتماد تلك المصادر في قضايا جوهرية ترتبط بالدراسات القرآنيّة، والواقع أن كثيرًا من المستشرقين ودعاة التغريب قد أصروا على اعتماد مثل هذه الكتب، وأولوها الاهتمام البالغ وأعادوا طبعها وروّجوها، وحرضوا الباحثين من التغريبيين على اعتمادها مصادر ومراجع ؛ وذلك لأنّها تفسد الحقائق وترسم صورًا غير صحيحة ولا موثوقة عن واقع الأمور.
يبدو أنّ من أخطاء منهج المستشرقين في اعتماد مصادر ومراجع معيّنة تعمُّد عدم الاكتراث بموثوقيّتها وأولويّة بعضها؛ لهذا نجد أنّ المستشرق الذي يسعى إلى فرض فكرة معيّنة وتكريسها لا يلقي اهتمامًا إلا إلى المصادر التي ترمي مضامينها إلى ما يذهب إليه، وهو يعمد في الغالب إلى تقديم كتب ثانوية وغير موثوقة على ما هو معروف من كتب موثوقة، وهذا المنهج الخاطئ كفيل بأنْ يؤدّي إلى نتائج مغلوطة وخاطئة. ويبدو أنّ من أعظم أخطاء هذا المنهج المتمثّل في عدم ترتيب المصادر حسب موثوقيّتها وقيمتها هو تقديم كتب المستشرقين على غيرها من كتب العلماء المسلمين الأوائل في نقل الروايات، والنصوص القديمة.
بالإضافة إلى الانتقائيّة في المصادر كما تقدّم، والاعتماد على المصادر باللغة الأجنبيّة وقلّة الاعتماد على مصادر باللغة العربيّة، سواء كانت أصيلة أم غير أصلية، فإنّ إطلالة سريعة على «دائرة المعارف الإسلاميّة» و«الموسوعة البريطانية» و«وغيرهما يؤكّد صحّة هذا الكلام وسيأتي التعريف بهاتين الموسوعتين.
ونجد أيضًا أنّ هناك انتقائيّة مذهبيّة فنجد تغييبًا متعمّدًا لنصوص علماء الإماميّة وآرائهم؛ كما أشرنا، وهذا واضح جدًّا خاصّة في الدراسات القرآنيّة، ويقع
التركيز فقط على علماء السنّة، بل للأسف على الضعيف أو الشاذّ من أقوال علماء السنّة والاعتماد على الكتب الضعيفة عندهم؛ سواء في مجال التفسير وعلوم القرآن، أو الكتب الحديثية.
ويقوم هذا المنهج على أنْ يضع الباحث فرضًا ليصل به إلى حلّ مسألة مُعيَّنة، و(الفرضيةم)قولة تُقبل على علَّتها دون إثبات.
و«إذا كان المستشرقون في منهجهم التشكيكي يشكّكون في الوقائع القطعيّة ففي المنهج الافتراضي يفترضون أفكارًا مسبقة ومحددة، ثم يأخذون النتائج بناء على الافتراضات التي افترضوها، وليس المراد بالافتراض هنا الفرضيّة البحثيّة أي أنّني أفترض مجموعة احتمالات للبحث قد أصل إلى صحتها وقد أصل إلى بطلانها، بل المقصود هو الانطلاق من افتراض معيّن وجعله هو الحاكم على البحث.
ولعلّ أبرز حقل قرآني مارس فيه المستشرقون هذا المنهج هو ترتيب الآيات والسور في القرآن، إذ نجد معظم المستشرقين قد أبدوا في مسألة ترتيب الآيات،...وانطلاقًا من منهجهم التاريخي الذي يفترض ترتيبًا منطقيًا يقبله العقل البشري، حاولوا افتراض ترتيبات جديدة يحكمها الهوى المجرد، وهذا الترتيب المفترض سببه اعتمادهم على المنهج التاريخي والذي أوصلهم إلى نتائج غير صحيحة علميًا في حقل القرآنيات».
مع أنّ هناك توجه واضح لدي علماء التفسير هو أنّ ترتيب الآيات مسألة توقيفية لا اجتهادية، وأقاموا على ذلك أدلة متعددة نذكر منها:
ـ أنّ العقل والاعتبار لا يريان للاجتهاد في القرآن مجالًا؛ الأمر الذي يؤثّر في إعجازه الخالد، إذ لو جاز إعمال الرأي والقياس في ترتيب آياته لأمكن حدوث
الخطأ أحيانًا في الترتيب، وهذا يوجب اختلالًا في الأسلوب القرآني المعجز. ومن المعروف أنّ من أهمّ أنواع الإعجاز القرآنيّ هو الإعجاز النظمي للقرآن، وهو مرتبط بنظم كلمات الآية، ونظم الآيات في السورة.
أضف إلى ذلك، أنّ ترتيب القرآن الموجود ليس له ملاك واحد، يكون أساسًا مطّردًا في تقديم هذا وتأخير ذاك، ومثالًا على ذلك تأمّل في الآيتين من سورة الشمس: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا) فترى ذكر النهار فيها مقدّمًا على ذكر الليل، بخلاف الآيتين في سورة الليل: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ) فالليل فيها مقدم على النهار، الأمر الذي يقوّي الظنّ بأنّ الترتيب لم يكن بالاجتهاد والاستحسان، وإلا لقدّم أحدهما في جميع المواضع.
ـ الأحاديث المنقولة عن النبيّ الأعظم صلىاللهعليهوآله بأنّ بعض الآيات بأنّها آخر السورة الفلانية أو أوّلها، ما يكشف عن أنّ أول السورة وآخرها قد كان مشخصًا في زمنه صلىاللهعليهوآله.
ـ ما دلّ على أنّ وضع الآيات في أماكنها كان يحصل بأمره صلىاللهعليهوآله وأنّه كان يقول: ضعوا هذه الآيات في مكان كذا وتلك في مكان كذا، ....
من نماذج المنهج الافتراضي في مسألة ترتيب الآيات ما ذكره المستشرق الإنجليزي آرثر جيفري عن سورة الجن، فيقول: «إنّ الآيات الخاتمة للسورة تختلف كثيرًا في الشكل والأسلوب، وتظهر وكأنّها قطعة غريبة وضعها جامعو القرآن أو كتبته».
فجفري يريد أن يؤكّد للقارئ وجود اختلاف وعدم تناسب وتناسق بين الآيات الخاتمة (يرمي بدون شك إلى الآيات 19 فما بعدها من السورة) والتي قبلها من خلال التلميح -بشكل عرضي وكأنّه أمر طبيعي- إلى أنّ كتبة الوحي هم الذين
أضافوا المقطع الذي لا يتناسب -حسب زعم جفري- مع الآيات السابقة، وهذه طريقة معروفة لدى المستشرقين في مخاطبة قرائهم. ولو رجع جفري إلى كتب التفسير، وكتب علم التناسب القرآنيّ؛ لتبيّن له أن لا اضطراب ولا اختلاف بين طرفي السورة .
يقول برهان الدين البقاعي (ت885ه): «لقد ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺃﻭل السورة وآخرها؛ فدل آخرها ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل المجمل، وﺃﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ الآخر المفصل، ﻭذلك ﺃﻥ ﺃﻭل السورة بين عظمة الوحي بسبب الجن، ثم بين في أثنائها حفظه من مسترقي السمع، وختم بتأكيد حفظه وحفظ جميع كلماته...».
ويُعد (تيودور نولدكه) أول من رسم لنفسه هذه المنهجية في كتابه «ملحوظات نقدية حول التركيب والأسلوب في القرآن» وتأثر به كل من أتى من بعده، فأصبح موضوع الترتيب الشغل الشاغل لأذهان المستشرقين. وتعتبر المستشرقة المعاصرة أنجليكا نويورث ممّن اتبع هذا المنهج فكثيرًا ما نجدها تختار سورة محدّدة مثل سورة يوسف، أو سورة الفاتحة، أو سورة الرحمن، أو سورة الحجر، وتكتب عنها، على شاكلة ما دعا إليه نولدكه.
ولقد زعم بلاشير أن فواتح السور بالأحرف المقطعة ليست من القرآن الكريم، فمثلًا حرف الميم كان رمزًا لمصحف المغيرة، والهاء لمصحف إبراهيم، والصاد لسعد بن أبي وقاص، والنون لمصحف عثمان بن عفان».
ويفترض (بلاشير) أيضًا في ما يتعلق بنزول القرآن افتراضات عجيبة فقد نفى أن يكون ما نزل من القرآن في مكة، قد دوّن في عهد الرسول، وأنّ بدء التدوين كان بعد الهجرة، ومع ذلك لم يكن هذا التدوين صحيحًا ودقيقًا، فسقطت آيات كثيرة منه، فضلًا أن بعض ما كان مكتوبًا عليه من رقاع قد ضاع. وهناك كثير من هذه الافتراضات عند المستشرقين نكتفي بما أوردناه.
وما لا شك فيه أنّ للمستشرقين في كل موضوع من موضوعات القرآن التي يناقشونها ويدرسونها هدفًا وغاية يدور فلكها حول الهدف الأكبر الذي هو إثبات بشرية القرآن بكل الوسائل. وإزاء موضوع ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، يتّضح أنّ هدفهم من افتراض ترتيبات جديدة ومحاولات مبتكرة على بساط البحث والدرس يرمي إلى إظهار التناقض المزعوم في القرآن سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأسلوب.
إذن منهجية المستشرقين، ومن سلك مسلكهم تنمّ عن تعسف في إطلاق الأحكام، واتباع الهوى، وحب الافتراض والتخمين، وفي ذلك تجاهل لقيمة الرواية الصحيحة التي تعدّ الطريقة الوحيدة في ترتيب الآيات ترتيبًا دقيقًا حكيمًا.
تقدّم في مبحث المناهج العامّة للحركة الاستشراقية، الكلام عن المنهج الإسقاطي إجمالًا، وفي هذا الموضع سنبيّن أنواع الإسقاطات التي قام بها المستشرقون على القرآن الكريم، بالإضافة لذكر بعض النماذج على ذلك.
وبعض الباحثين يعتبر أنّ المستشرقين يكذّبون لا يخطئون فقط في عمليات الإسقاط فيقول هم «ﻻ يخطئون فقط في كلّ جملة يقولونها، بل يكذّبون؛ أي إنّهم لم يعودوا أحرارًا في أن يكذبوا ببراءة وبسبب الجهل» .
وهذه العمليّات الإسقاطية على القرآن الكريم وعلومه يمكن النظر إليها من زاويتين:
الزاوية الأولى: بالنظر إلى هذه العمليات الإسقاطية من حيث موضوعاتها، ويمكن تصنيفها إلى موضوعات متعدّدة منها:
1- إسقاط المفاهيم الاستشراقيّة على التعريف بالقرآن الكريم.
2- إسقاط المفاهيم الاستشراقيّة على تاريخ القرآن الكريم.
3- إسقاط المفاهيم الاستشراقيّة على العقائد القرآنية.
الزاوية الثانية: وبالنظر الى منطلقاتها المذهبية، يمكن تصنيفها إلى المنطلقات الآتية:
1- المنطلقات الدينية: وتشمل المفاهيم اليهودية والمفاهيم النصرانية.
2- المنطلقات الفكرية: وتشمل المفاهيم المادية والمفاهيم الصوفية.
صدّر اﳌﺴﺘﺸﺮق ﺟﻮﻟﺪتسيهر ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹسـﻼﻣﻲ) الذي يقول ﻓﻴﻪ: «ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ -اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ اﻋﱰافًا عقديًا ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻧﺺّ ﻣﻨـﺰل أو ﻣﻮﺣﻰ ﺑﻪ-...[فيه] من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في القرآن».
وﰲ ﻛﺘﺎبه (اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻹسـﻼم) يعرّف ﺟﻮﻟﺪزﻳﻬﺮ اﻟﻘﺮآن بقوله: «القرآن هو الأساس الأول للديّن الإسلاميّ، وهو كتابه المقدّس، ودستوره الموحى به، وهو في مجموعه مزيجًا من الطوابع المختلفة اختلافًا جوهريًا، والتي طَبَعت كلا العصرَين الأولين من عهد طفولة الإسلام».
وﻳﻘﻮل ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﻳﺲ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ للقرآن: «ويرى ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆرﺧﲔ أﻧّﻪ سـﺠﻞ أﺻﻴﻞ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﳏﻤﺪ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ».
إذا لاحظنا التعاريف السابقة للقرآن فإنّنا نجد تأثّر هؤلاء بما يحملونه من
أفكار يهودية فجولدزيهر اعتبر أنّ القرآن الكريم فيه اضطراب وعدم ثبات وأنّه مزيج مختلط من الثقافات المتعددة وليس من عند الله. وهو بذلك ﱂ يستطع الخروج من تأثيرات العقيدة اليهودية، وبتعريفه ذاك ﺃﺭﺍﺩ أن يضفي على القرآن ما أضفاه أصحاب الديانات الأخرى من التغيير والتبديل، لأنّه على علم بما احتوته الكتب المقدّسة عند اليهود سواء العهد القديم أم التلمود من فروق واختلافات بين النُسَخ وتناقضات في الأخبار واضطراب في الألفاظ والأساليب البيانية.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﻳﺲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، فهو يعتبر أنّ القرآن هو سجل لنشاطات محمد فهو في نفس الاتجاه والاسقاطات؛ لأنّ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻬﺪ القديم ﻫﻮ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي أسـﻘﻄﻪ اﳌﺴﺘﺸﺮق ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺮآن واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻏﲑﻫﻢ.
بينما لا تمثل الآيات المعنية بسيرة النبيّ صلىاللهعليهوآله إلا جزءًا يسيرًا من القرآن، في حين أنّ الآيات المتعلّقة بقصة النبيّ موسى هي أكبر بكثير من قصة النبيّ محمد بل هي أكبر قصة في القرآن الكريم. فقد ذكر اسم موسى عليهالسلام في القرآن 136 مرة في سور متفرقة في كتاب الله عز وجل. بينما ذكر اسم النبيّ محمد 4 مرات في القرآن.
تقدم في الأبحاث السابقة أن هناك فارق كبير بين القرآن الكريم؛ بوصفه كتابًا ووحيًا سماويًّا وبين الكتب السماوية الأخرى؛ كالإنجيل، والتوارة، وأشرنا أنّه لا يوجد فترة يمكن أن تسمّى تاريخًا بالنسبة للقرآن؛ أي وجود فاصل زمني بين نزول الوحي القرآني وتدوين النص القرآنيّ.
أمّا النصوص الدينيّة المقدسة في اليهودية لها تاريخ طويل يقترب من ثمانمئة عام بين زمن نزول الوحي وتدوينه أي بين زمن نزول الوحي على النبيّ موسى عليهالسلام أي القرن الثالث عشر قبل الميلاد وزمن إخضاع هذا الوحي للكتابة والتدوين على يد عزرا الكاتب أي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وهي فترة طويلة جدًا
فنحن أمام نص له تاريخ تغير فيه شكله من النص الشفوي إلى النص الكتابي على يد «عزرا الكاتب» وهذه الفترة سمحت بكل أنواع التحريف والتبديل. وكذلك بالنسبة للعهد الجديد فلكل إنجيل من الأناجيل الأربعة تاريخ.
لم يُكتب للتوراة ولا الإنجيل أن يلقيا الحرص والاهتمام المبكّرَين من أجل حفظ نصوصهما، فعلى حدّ الروايات اليهودية قد حفظ موسى عليهالسلام نسخة التوراة في تابوت وعهد إلى أبناء هارون عليهالسلام بحفظها وتعليمها بني إسرائيل، فتساهل الأحبار من آل هارون في مسألة الرجوع إلى الأصول التوراتية المحفوظة في التابوت في فتاواهم الشرعية؛ ما عرّض أحكامها للضياع والتبديل، وبعد وفاة موسى عليهالسلام بجيلَين أو ثلاث؛ نَهب الفلسطينيون الإسرائيليين واستولوا على تابوت التوراة، ومن ذلك الوقت لم تظهر التوراة حتى عودة أجزاء منها على يد الملك طالوت الذي أرسله الله لمقاتلة الفلسطينيين الوثنيين عام 1020ق.م.
وأما الإنجيل فإنّ النصارى يزعمون أنّه لم يكن سوى تعاليم ووصايا ألقاها المسيح عليهالسلام شفويًا على حواريّيه، ولم يكن على نحو كتاب تشريعي، ويضيفون بأنّ الأناجيل الموجودة اليوم ما هي إلاّ من تأليفات الحواريين بعد وفاة المسيح عليهالسلام.
وهذه الأفكار والمعلومات لم تكن غائبة عن المستشرقين الذين خاضوا في مجال الدراسات القرآنيّة، لأنّهم هم أهل الاختصاص في مجال الدراسات الدينيّة وبالأخص اليهودية والنصرانية، وهم من خلال ذلك قاموا بعملية إسقاط لهذه المعارف والمفاهيم على القرآن الكريم ونظروا له نظرة تاريخية؛ مثل كتبهم المقدسة فاتهموه بالنقائص نفسها التي اعترت تاريخ كتبهم المقدّسة من قِبَل علماء الدين وورثة الأنبياء. وسنبين إسقاطات هؤلاء على تاريخ القرآن في الأبحاث القادمة.
يؤمن اليهود بإله واحد هو الله، ويعتقدون في أن الله خالق كل شيء بلا شريك، وأنّه لا شبيه له، ولا يمكن رؤيته وهو محجوب عن الخلق، وفي سفر التثنية تجد دليلًا توراتيًّا على التوحيد في الآية: «اسمع يا إسرائيل، الربّ إلهنا رب واحد» (التثنية 6: 4).
ولكن للأسف تعرضت هذه العقيدة للتحريف بعد ما تعرضت التوراة إلى التحريف من قبل أحبار اليهود أصبحت تجد في سطور هذا الكتاب كلمات تتنافى مع قدسية الله، فتارة تقرأ أن الله يغضب وتارة تجد أن الناس فعلوا الشر في أعين الرب. وأصبح الرب في التوراة لا يتورع عن مصارعة أحد أفراد البشر، ويغضب ويغار ويعتب ويحنق وغير ذلك من الصفات التي نسبوها إلى الله تعالى.
وهذا الأمر يعكس بشكل كبير تأثر أحبار اليهود وكتاب العهد القديم بالعقائد التي سبقت ظهور أنبياء بني إسرائيل، الأمر الذي جعلهم يشبهون الله بذاك الإله البدائي القبلي القديم الذي كان على شاكلة البشر يحب ويكره ويحزن ويغار ويصارع باليد ويطالب بنصيبه من اللحم والشحم والمسكن ككل الناس كما تذكّرنا بها مرارًا نصوص التوراة..!
ويعكس اسم الرب في اليهودية أيضًا تخبّطًا شديدًا هم يطلقون عليه «إلوهيم» وهذه صيغة جمع تعني «الآلهة» وليس إلهًا واحدًا، وهم يفعلون هذا على الرغم من أنّهم أقرّوا في هذه الفترة بالتوحيد لله، لكنّ ثقافتهم ظلّت عاجزة عن تفادي آثار التعددية التي سيطرت على عقائدهم قبل ظهور الأنبياء.
وفي مرحلة أخرى يتغاضى بنو إسرائيل عن نطق اسم الرب، فيكتبونه «يهوه» وينطقونه «أدوناي» أي السيد. أو ينطقونه «هَشِمْ» أي الاسم، وهم يفعلون ذلك تطهيرًا لاسم الرب من أن ينطق على لسانهم.
والخلاصة: أنّ بني إسرائيل على الرغم ممّا هم فيه من ضلال، وكذلك بعدهم عن ما أنزل عليهم في التوراة، لكنّهم يعبدون إلهًا واحدًا لا يشركون به شيئًا.
وكان للمستشرق جولدزيهر قصب السبق في تحريف مدلولات القرآن الكريم عن الله تعالى بإسقاط المفاهيم اليهودية والنصرانية على هذه المدلولات التي لا تتفق والعقيدة الإسلاميّة، ومن ذلك إسقاطه لمفهوم التجسّد الإلهي عند
اليهود والنصارى على التمثيل القرآني لنور الله سبحانه وتعالى بنور المصباح في مشكاة وهي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، وهذا الإسقاط نابع من جهل المستشرق بالأساليب البلاغية في اللغة العربيّة التي منها التشبيه، وهو نابع كذلك من تأثره بمسلك العقائد اليهودية.
وقد خضع المستشرق جاك بيرك Jacques Berqueأيضًا لعقيدة التجسيد وأسقط مفهومها على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ مفسِّرًا إياها بـ: «فالله هو الذي تاب بدلًا منكم لأنّه يميل إلى التوبة».
كما قام المستشرق كراتشكوفسكي Kratchkovski بنهج المنهج نفسه في ترجمة سورة الناس: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ إذ ترجمها بـ: «أعوذ بإله الناس الذي يختبئ من شرّ الوسواس الذي يوسوس صدورَ الناس». إلى غيرها من النماذج التي ذكرها هؤلاء وجسدت إسقاطات للعقيدة التي يحملونها عن الله على القرآن الكريم.
فمن ذلك إقدام عدد من المستشرقين الذين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات أوروبية على ترجمة كلمة (الأُمِّيّ) -التي وصف الله تعالى بها نبيّه محمدًا- بـ (نبي الوثنية) أو (نبي الكفرة)، ومن أبرز هؤلاء المستشرقين كلٌ من: هيننج Henning (في ترجمته المنشورة عام 1901)، ورودي بارت Rudi Paret (في ترجمته المنشورة عام 1966) وبلاشير Blachere (في ترجمته المنشورة في باريس عام 1966(وماسون Masson) في الطبعة الأولى لترجمتها المنشورة عام 1976 .
ومن المعلوم أن كلمة (الأُمِّيّ) تعني الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا المعنى لم يكن خافيًا على المستشرقين فإنّ الذي يعنينا في هذا المقام هو أنّ هؤلاء المستشرقين أسقطوا من خلال هذه الترجمة مفهومًا عقديًا يهوديًا أو نصرانيًا على كلمة (الأُمِّيّ)، حيث إنّ اليهود دأبوا على إطلاق كلمة (غويم) goim على غير اليهود من الأمم الأخرى، وهذه الكلمة هي التي كانوا يعبّرون عنها في الجزيرة العربيّة بكلمة (الأُمِّيين) وهي التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، وكان اليهود يقصدون بكلمة (غويم) الفاسدين أو المرتدين والوثنيين؛ لأنّ الكلمة في
صيغة الجمع، ومفردها (غَوِيّ) وهي على معناها نفسه في اللغة العربية.
يعتقد المسلمون أنّ جبريل عليهالسلام من الملائكة المقرَّبين عند الله تعالى، وهو الذي نزل بالوحي الإلهي إلى أنبيائه وبالتحديث على الصالحين من عباده، وهو الذي بشَّر مريم بنت عمران بعيسى عليهما السلام، وقد وصفه الله تعالى بلفظ (رُوح القُدس) وقد ذكر مؤيدًا للمسيح عيسى بن مريم، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، وهو الذي بشّر مريم بولادة المسيح، فقد ورد في القرآن﴿ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ وفي آية أخرى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾. وجبريل في الإسلام هو الروح الأمين وروح من أمر الله، وهو الملاك الذي نزل بالرسالات على الرسل. ووصف بأوصاف عديدة في القرآن، منها وصفه الله بالقوة، وذكر في القرآن الكريم باسمه صراحة في سورتي البقرة والتحريم.
أما الروح القدس في المسيحيّة هو من أقانيم الله الواحد، مع أقنوم الله الأب
وأقنوم الله الابن. وهذه العقيدة هي عقيدة الثالوث. حيث يؤمن المسيحيّون أنّ الروح القدس هو روح الله الذي يرشد البشر ويكون دليلًا لهم.
ذكر الروح القدس مرات عدة في الإنجيل منها؛ مثلًا: «ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضًا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء * ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلًا أنت هو ابني الحبيب الذي به سررت»، «ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معًا بنفس واحدة * وصارت بغتة من السماء كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين * وظهرت لهم السنة منقسمة كأنّها من نار واستقرت على كل واحد فيهم * وامتلأ الجميع من الروح القدس.....». فالروح القدس هو الذي يساعد المؤمن في صلاته، والمؤمن عندما يكون مع الله يكون مملوءًا من الروح القدس وهو الذي يوجّهه ويساعده.
فعقيدتهم تتمثل في كونه واحدًا من الأقانيم الثلاثة للألوهية، وهم يطلقون عليه مسمّى (الرُّوح القدس) – بإضافة (ال) إلى كلمة (روح)، ويقصدون بالروح المعرَّفة: حياة الله تعالى ولهذا يضيفونها إلى القدس.
وعندما قام المستشرق آربري Arberryبترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية؛ ترجم لفظ (روح القدس) بـ The Holy Spirit أي: الروح القدس، فجعل (القدس) صفةً بعد ما كانت في القرآن مضافًا إليه، ولم يكن ذلك من آربري Arberry إلاّ لإسقاطه مفهومه العقدي المسيحيّ على جبريل عليهالسلام؛ على الرغم من اختلاف عقيدة القرآن واختلاف موقع كلمة (القدس) النحوي.
لمعرفة كيفية إسقاط المفاهيم بل في بعض الأحيان نفس الألفاظ الواردة في الكتاب المقدّس على القرآن، فلنقرأ الجدول الآتي:
|
كلام جولدزيهر عن اليوم الآخر في القرآن |
يوم القيامة في الإنجيل |
........... ........................... المقارنة وعملية الإسقاط |
|
يقول جولدزيهر عند حديثه عن اليوم الآخر في القرآن الكريم: «فمحمد منذرٌ بنهاية العالَم وبيوم الغضب والحساب، ولهذا نراه في نظريته الخاصة بالدار الآخرة يميل إلى جانب التشاؤم، أما التفاؤل فهو من نصيب المصطفين للجنة دون غيرهم..» |
يقول الرسول بولس مخاطبًا الذين قست قلوبهم ورفضوا التوبة مستهينين بلطف الله وإمهاله قائلًا: «وَلكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ التًائِبِ، تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ الْغَضَبِ وَاسْتِعْلان دَيْنُونَةِ اللهِ الْعَادِلَةِ»، وفي سفر الرؤيا يقدّم لنا يوحنا الرائي مشهدًا موجزًا عن الدينونة فيقول: «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام الله.... وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني (أي الانفصال الأبدي عن الله)، وكل من لم يوجد مكتوبًا في سفر الحياة طُرح في بحيرة النار» |
وإذا ما قارنّا رؤية جولدزيهر عن ذِكر الآخرة في القرآن الكريم بما جاء على لسان بعض رسل النصرانية؛ نجد اتفاق التصورَين اتفاقًا كليًا. لعلّنا نلاحِظ وصف القيامة بـ (يوم الغضب)، والنظرة التشاؤمية التامّة للعصاة بحيث لا وزن للأعمال، بل العبرة كل العبرة بما هو مكتوب في سِفر الحياة، وهذا ما عبّر عنه المستشرق بقوله ((المصطفين للجنة))، نلاحِظ هذا التطابق عند المستشرق وعند رسل النصرانية، أما القرآن الكريم فهو لم يسمِّ يوم القيامة بيوم الغضب أبدًا، ولم تأت هذه التسمية في أي حديث صحيح من الأحاديث النبوية الشريفة، وبالنسبة لمصير الكافرين؛ فهوحقًا مصير مشؤوم في نظر القرآن، لكنّ العبرة يوم القيامة بالأعمال وليس بما هو مكتوب في الكتاب. إذن فليس تصوّر المستشرق إلاّ ضربًا من إسقاط المفاهيم الدينيّة لأهل الكتاب على العقائد القرآنيّة. |
|
ترجمة كلمة «الفرقان» |
معنى الفرقان في القرآن |
الإسقاط |
|
ترجم المستشرق آربري كلمة (الفرقان) حيثما وردت في القرآن الكريم بكلمة salvation وتعني: (النجاة أو الخلاص). |
والفرقان في اللغة العربيّة تعني: كلّ ما فُرّق به بين الحق والباطل أو بين شيئين، وهو أيضًا اسم للقرآن ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَان عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾. |
أما كلمة (الخلاص) فهي ذات مدلولات عقدية نصرانية، وقد تطلق على الإنجيل؛ لان فيها الدعوة إلى الإيمان بالخلاص، وقد أسقط آربري هذا المفهوم العقدي النصراني على كلمة (الفرقان) الواردة في القرآن الكريم. |
|
ترجم المستشرق جاك بيرك كلمة (المسجد) حيثما وردت في القرآن الكريم بكلمتي (Sanctuaire) و(Oratoire)، وتعني الكلمة الأولى: المعبد الكنسي، وأما الثانية فتعني: المصلى في كنيسة صغيرة |
ومن الواضح الفرق بين كلمة مسجد والمعبد أو المصلى في الكنيسة، ويختلفان من عدة وجوه معلومة، والأمر الذي يزيدنا يقينًا من معرفة المستشرق للفروق بين المسجد والكنيسة هوانه عندما يأتي لقوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾، فإنّه يترجم كلمة (المساجد) بـ (Mosques) وهي الكلمة المعروفة لدى الفرنسيين عن المسجد، وكان ينبغي استعمالها في كل مكان، ولكن المستشرق لم يستعملها إلاّ في هذا الموضع عندما خشي التباس المساجد بالصوامع والبيع. |
إسقاط لمفهوم نصراني لمكان العبادة على مفهوم إسلامي عن كلمة (المسجد). |
إسقاط المفاهيم المادية على مفهوم (الله) تعالى في القرآن الكريم:
من المعلوم أن المذهب المادي الإلحادي المنكر للديانات والروحانيات كان سائدًا في الاتحاد السوفييتي السابق مدة سبعين سنة تقريبًا، ولذلك فإنّ عددًا من المستشرقين الروس قد تأثروا بهذا المذهب الفكري عند قيامهم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الروسية، ومن هؤلاء المستشرقين مَن أسقطوا مفاهيمهم المادية على كلمة (ربّنا) في القرآن الكريم حيثما وردت وترجموها بكلمة (سلطاننا)
إسقاط المفاهيم المادية على ذِكر الملائكة واليوم الآخر في القرآن الكريم:
لقد أسقطت المستشرقة الروسية بروخوفا ذلك المفهوم المادي السائد في بلادها على مفهوم (الملائكة) في بعض المواطن في القرآن الكريم، حيث نجدها تقول عند تفسيرها لقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ : «هم الملائكة الذين يمثّلون الحواس التي بواسطتها يشعر الإنسان بالعالم».
كما نجد المستشرقة نفسها تفسّر قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ «تسمية هاروت وماروت بالملكَين من المجاز، وفي الحقيقة فإنّهما كانا من أناس عاديين في بابل، وقد تفوّقا في علوم حضارتهم المختلفة».
إلى غيرها من الإسقاطات التي نلاحظها بكثرة في ترجمات القرآن الكريم للغات
المختلفة. وسيأتي تقويم هذه الترجمات في الأبحاث القادمة.
هذه أهم مناهج المستشرقين في دراسة القضايا القرآنية، بيد أنّ هذه المناهج قد تزيد وقد تنقص لدى بعض الباحثين، فبعضهم أضاف منهجًا أو أكثر لما تقدّم، وإنْ كان عند التدقيق نجد أنّ بعض ما ذكر يرجع إلى المناهج السابقة؛ مثل: منهج النفي، الذي يهدف إلى نفي الحقائق القرآنيّة والوقائع التاريخية المرتبطة بنُزول القرآن وجمعه وغير ذلك، ويتحقّق ذلك من خلال إثارة الشكوك والمبالغة في النقد إلى حد الإلغاء والنفي الكيفي لكل ما يتعارض مع وجهات النظر الاستشراقيّة. وهذا المنهج يدخل في منهج الشك.
(231)
اهتم المستشرقون بدراسة علوم القرآن والتفسير اهتمامًا بالغًا؛ طبعًا ضمن أغراضهم وأهدافهم الخاصّة، التي أشرنا في الأبحاث السابقة إلى أهمّها وهو «إثبات بشريّة القرآن»، ولذا قاموا بالدراسة والنقد والتحليل للقرآن الكريم، وكل ما يتصل به من علوم؛ وهي ما يطلق عليه في الدراسات الإسلاميّة اسم «علوم القرآن»، وقد لاحظنا في العقود الثلاثة الأخيرة، جهدًا ملحوظًا في الرد على الدراسات الاستشراقيّة من قبل الباحثين المسلمين وتقديم دراسات نقدية وازنة لتفنيد أفكارهم الرئيسة وتثبيت الثوابت الإسلاميّة والقرآنيّة.
وفي هذا الفصل، والفصل اللاحق سنقدم نماذج من الأبحاث الاستشراقيّة للدراسات القرآنيّة، مع نقد لأهمّ أفكارهم ومناهجهم في هذا المجال، وسنكتفي ببعض المباحث المهمة في علوم القرآن، ولن نتعرّض للتفسير الاستشراقي للقرآن مع أهميته القصوى، لأنّ ذلك يحتاج إلى دراسة تفصيلية للمدارس التفسيريّة الاستشراقية ومناهجها، وكتب المستشرقين في التفسير، ونقد كل ذلك، وهذا يتجاوز الأهداف المتوخّاة لهذا الكتاب.
وفي هذا الفصل سنعالج الإطار النظري الأساس لموضوعات علوم القرآن والمتمثلة في نظرة المستشرقين للقرآن وفهمهم لحقيقة الوحي، ثم تصوراتهم عن مصادر القرآن الكريم، وكيف عرّفوه في موسوعاتهم وقاربوه في معاجمهم، وأخيرًا كيف تعاملوا مع ترجمته إلى لغات أخرى ونخصص الفصل الخامس والأخير لبحوث هامة في علوم القرآن من منظار استشراقي: عرضًا، ونقدًا.
(235)
حاز القرآن الكريم مكانة معنوية كبيرة في نفوس المسلمين، فهو المصدر الأساس لتنظيم حياتهم الفردية والاجتماعية، وأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم.
والقرآن الكريم الذي يعتقد به المسلمون له الخصائص الآتية مجتمعة؛ وهي:
1- هو الكتاب السماويّ المقدّس لدى المسلمين.
2- وهو المصدر الأول للتشريع.
3- أُوحيَ للنّبيّ محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآله خلال فترة نُبُوَّته التي دامت (23) سنة.
4- بواسطة الملك جبرائيل عليهالسلام.
5- القرآن بألفاظه هو كلام الله، ومعجزة النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله.
6- هو الكتاب السماوي الأخير.
7- هو من المعاجز الأساس التي أتى بها الرسول الأكرم محمد صلىاللهعليهوآله، بحيث لا يمكن لأحدٍ من الخلق أن يأتي بمثله.
8- له أوجه إعجاز متعدّدة؛ من أهمها: الإعجاز اللغوي والبلاغي، وما جاء به من أخبار القرون والأمم البائدة، والإعجاز على المستوى العلمي (الإخبار عن القوانين الكونية) والتشريعي (الجامعية في التشريع) وغير ذلك.
9- يرى جميع المسلمين اليوم أنّ القرآن لم يحرّف، والقرآن الموجود بين الدّفتين حاليًا هو بعينه ما نزل على النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ويمكن تعريف القرآن الكريم -حسب المشهور بين العلماء- بأنّه: كلام الله ـ عز وجل- المعجز، المتعبّد بتلاوته، المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلىاللهعليهوآله بلفظه ومعناه،
المنقول عنه بالتواتر المفيد للقطع والتعيين، المكتوب بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس.
هناك تعاريف متعدّدة ذكرها المستشرقون للقرآن الكريم ومنها ما ورد في دائرة المعارف الإسلاميّة فهو يكشف بعضًا من اتجاه هؤلاء في تعريفهم للقرآن طبعًا بناء على خلفيات مسبقة في هذا المجال.
وقبل عرض التعريف المطروح في دائرة لمعارف من المناسب إجراء إطلالة عامّة على الأجواء والخلفيات التي كانت تحكم الدراسات الاستشراقيّة القديمة تجاه القرآن الكريم.
فالدراسات الاستشراقيّة كانت في عمومها قائمة على اعتبار القرآن الكريم نتاجًا بشريًا، فهم لا يؤمنون بأنّ القرآن وحي إلهي. وتميل هذه الدراسات إلى النزعة التشويهية للقرآن الكريم؛ سواء كانت عن قصد أم عن غير قصد، وسواء كان عن مصدره أم تاريخه أم بنيته وغير ذلك. والهدف الذي يصرّح به بعضهم هو ضرورة مكافحة القرآن الكريم ومواجهته، فقد كتب القسّيس الألماني «إبراهام هنكلمان» الذي قام بنشر القرآن الكريم باللغة العربيّة في القرن السابع عشر، في مقدمته قوله: «من الضروري أن نعرف القرآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته، وتمهيد السبيل لانتشار المسيحيّة في الشرق»، ويقول الراهب الإيطالي «ماراتشي»: «أنّه قضى أربعين سنة في دراسة القرآن وكتب التفسير العربية؛ كي يستطيع محاربة الإسلام بأسلحته نفسها».
وتتجه أكثر هذه الدراسات إلى توجيه الدراسة للجهات الخارجيّة للقرآن الكريم أي الدراسات المرتبطة بالنص القرآني من تاريخه، وأسباب نزوله، وتفسيره، والدراسات الإحصائية لسوره وآياته وكلماته وغير ذلك، دون الدراسات المعمقة للنص القرآني نفسه؛ إلا ما ندر، أي دراسة مداليل الآيات والسور في المجالات الحياتية، والتشريعية، والاجتماعية، والأخلاقية، وغير ذلك. وهذا التوجه بالإضافة
إلى النزعة التشويهية انسحب على أكثر الدراسات الاستشراقيّة القديمة، وأثّر بشكل واضح على تعريف القرآن والمواد التي ذكروها للتعريف بالقرآن الكريم؛ كما سنبيّن.
وقد غلب على أكثر المناهج الاستشراقيّة في دراسة القرآن المناهج التي اعتمدها هؤلاء في دراسة التوراة والإنجيل؛ ومنها: «منهج النقد الأعلى والأدنى للكتاب المقدس»، ومن المستشرقين الذين عبّروا عن هذا المنهج المستشرق «آرثر جيفري» في المقدمة التي وضعها لكتاب المصاحف لابن أبي داود، بل إن بعض المستشرقين كان له التأثير المنهجي الواضح على الأبحاث الاستشراقيّة؛ أمثال: المستشرق «جولدتسيهر» فقد قال عنه المستشرق «بيكر» في حفل رثاء «جولدتسيهر» «مهما تكن التطورات والتعديلات التي تطرأ على بحث الإسلام في المستقبل فما لا شك فيه أن هذا البحث سيقوم دائمًا على الأسس والمناهج التي وضعها جولدزيهر». وهذه الأسس والمناهج في فهم الحديث والقرآن أثرت على مجمل الدراسات الاستشراقية. وبشكل عام كان للمستشرقين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الأثر الأكبر على الدراسات الاستشراقيّة عن الإسلام والقرآن الكريم. يقول المستشرق «هاملتون جب»: «لقد قامت في صفوفهم في السنوات الأخيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق وإخلاص إلى أعماق الفكر الديني للمسلمين بدل السطحية الفاضحة التي صبغت دراساتهم السابقة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ التأثر بالأحكام التي صدرت مسبقًا على الإسلام، والتي اتخذت صورة تقليد منهجي في الغرب، لا زال قويًّا في بحوثهم، ولا يمكن الإغفال عنها في أية دراسة لهم عن الإسلام».
المادة التعريفية كتبها المستشرق «ف.بول». وقد عرض هذه المادة في ثلاث
عشرة صفحة ذكر في أولها أنّ القرآن هو كتاب المحمديين المقدس، ثم قسم حديثه عن القرآن إلى أقسام عدّة جعلها على شكل فقرات مرقّمة بلغت اثنتين وعشرين فقرة. وتختصر هذه المادة التعريفية أغلب الآراء حول القرآن الكريم التي كانت سائدة في الدراسات الاستشراقيّة القديمة؛ لأنّ هذه المادة التعريفية للقرآن الكريم تناولته من أبعاد مختلفة؛ كما سنبيّن.
القرآن هو: كتاب المحمّديين المقدس وضعه النبيّ من عند نفسه، اتّهم فيه اليهود بأنّهم حرَّفوا التوراة، وأنّهم يكتمون ما أنزل الله به من البينات والهدى، واتّهم فيه النصارى بأنّهم حرَّفوا الإنجيل، وأنّهم حرَّفوا الآيات الشاهدة على صدقه، وقد جمعه من القصص السريانية، والأساطير اليهودية، والتوراة، والزبور والتلمود، والهاجاداة، ومشناه سنهدرين، وسفر التكوين، ومصادر يهودية
متأثرة بالإيرانية، وسفر إستير، وسفري الملوك وسفر الخروج، وسفر التكوين، والإنجيل، وإنجيل صُبُوَّة المسيح، وإنجيل لوقا، وأعمال الرسل، وقصة الإسكندر، وملحمة جلجامش.
القرآن كان في الحقيقة كتابًا محجوبًا، وإنّ النبيّ سمع صوت الله ولم يقرأ شيئًا، وإنّه يجب علينا أن نتخيل أنّ الله قد قرأ حقيقة على النبيّ من الكتاب السماوي.
وقد وقع فيه اختلاف بين نسخه من ناحية ترتيب آياته وسوره، وتمكّن الشيطان من تخليطه، ونسي الرسول من آياته عددًا، وجاء فيه بأخبار متناقضة سعى المفسّرون للتخلّص منها، ويحتوي على عدد من الإضافات التفصيلية وانتقال الجمل والتحريفات غير الضارّة، وأعيدت صياغته، فانتهى إلى صورته الحالية بعد أن فقد كمية كبيرة من الوحي المبكر.
فالقرآن حسب دائرة المعارف الإسلاميّة هو عبارة عن:
1- كتاب بشري من صنع النبيّ محمد.
2- ملفّق من مصادر متعدّدة.
3- محرّف فقد فُقدت منه آيات ثم أعاد المسلمون صياغته.
طرحت هذه الموسوعة عناوين عدّة عن القرآن: تعريف القرآن، شكل القرآن ومضمونه، محتوياته، مصير الإنسان، أصول القرآن طبقًا للمسلمين، أصوله طبقًا للمستشرقين، التفسير والتراجم. وسنركّز البحث على العنوان الأول وهو تعريف القرآن الكريم.
جاء تعريف القرآن في دائرة المعارف البريطانية: القرآن هو كتاب المسلمين المقدس، ويعده المؤمنون كلمة الحق من ربهم، وأنّه كتاب أوحي به إلى النبيّ وجمع في كتاب بعد مماته ويعتقدون أنّه كتاب أزلي وأنّه أوجد في اللوح المحفوظ ومن المحتمل أنّ كلمة قرآن مشتقة من كلمة قرأ وهي كلمة سريانية في أصلها وفي القراءة كانت تستعمل في الكنيسة السريانية. والقرآن ينظر إليه المسلمون بوصفه مرجعًا أساسًا للفصل في المسائل التي تتعلّق بالأمور التشريعية والأمور الدينية، ولا يقبل بأيّ حال من الأحوال الطعن في ما يقول. كما أنّ اللغة العربيّة التي صيغ بها تعد بأنّها لا يمكن التفوق عليها في نقائها وجمالها وأسلوبها الرائع، وأنّه لا مجال لتقليده، حيث إنّ هذا هو الجنون بعينه.
في هذا التعريف يوجد نقاط عدّة نشير إليها على أنّ بعضها سيأتي بحثها بشكل مفصّل. وهذه النقاط هي:
1- ما يتعلّق بجمع القرآن الكريم.
2- ما يتعلّق بمحاكاة القرآن والإتيان بمثله.
3- ما يتعلّق بأصل كلمة القرآن الكريم ومادتها.
ورد في الموسوعة: «وجمع في كتاب بعد مماته».
من المعلوم أنّ الآيات القرآنيّة كانت تنزل على قلب النبيّ وكان صلىاللهعليهوآله يقرؤها على أصحابه، وأصحابه ولشدّة شغفهم وتعلّقهم بالقرآن يتلقّونها بالحفظ، ومن المعروف بين الباحثين أنّ هناك ظاهرة على زمن الرسول أُطلق عليها اسم «كُتّاب الوحي» وأنّ القرآن الكريم كتب في زمنه صلىاللهعليهوآله وأنّ قضية الجمع للمصحف ليست بمعنى الكتابة كما سيأتي.
وفي آخر التعريف: «وأنّه لا مجال لتقليده، حيث إنّ هذا هو الجنون بعينه».
القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخالدة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ، ولكل مرحلة من مراحل التحدي طبيعتها وظروفها، وآخر مرحلة طرحها القرآن هي الإتيان بسورة واحدة من مثله من دون تحديد نوع السورة وحجمها، وعلى كل حال لم يأتوا بشيء من مثله وإلى الآن لا العرب القدماء ولا غيرهم قدروا على ذلك، فلم يتمكن أحد إلى هذه اللحظة من محاكاة القرآن، وعلى قاعدة لو كان لبان، فإنّ عدم الإتيان بمثله سببه عجزهم عن ذلك، وسيأتي الكلام بحث إعجاز القرآن عند المستشرقين.
ورد في التعريف: «كلمة قرآن مشتقة من كلمة قرأ وهي كلمة سريانية في أصلها وفي القراءة كانت تستعمل في الكنيسة السريانية».
الصحيح أنّه لا يوجد في القرآن كلمة غير عربية، فلو كان ثمّة كلمات غير عربيّة في القرآن لاتهموا القرآن الكريم بالكذب، ولقالوا: كيف يصف نفسه بأنّه قرآن عربي مبين، وفيه كلمات أعجمية، مع العلم أن الله عز وجل في ما يربو عن عشرة آيات يشدد ويؤكّد على أنّه قرآن عربي مبين، بل نراه يصرح وينفي كونه أعجميًا بالمجموع، وينفي أن يكون بعض آياته عربيًا والبعض الآخر أعجميًا، وهذا ما نجده واضحًا وصريحًا في سورة فصلت في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ . فهل يعقل أن العرب الفصحاء لم تمر على مسامعهم كلمات في القرآن غير عربيّة ولم يلتفتوا إليها ولم يحتجوا بها في مقام الرد، والصحيح أنّهم لو وجدوا كلمة واحدة غير عربيّة لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولوصلت إلينا هذه الردود والتشكيكات.
إنّ هنالك عند العرب كلمات معربة، أي إنّها جاءت إلى العرب من لغات أخرى، ولم يتلفظوا بها كما هي، وإنما عرّبوها ونطقوا بها، أي لم يستعملوها كما وردتهم، وسبب ذلك أنّهم عرب لهم لغتهم الخاصة ويتفاخرون بها، ولا يرضون بأي دخيل وغريب يدخل فيها، ومن هذه الكلمات هي كلمة (قريان) وغيرها، فلم نجد ولم ينقل أن العرب استعملت هذه الكلمة وغيرها بحسب أصلها، وإنما عرّبوها إلى (قرآن)، وظاهرة التعريب في كلام العرب ظاهرة مقررة عند أهل العربية؛ والتعريب ليس أخذًا للكلمة من اللغات الأخرى كما هي ووضعها في اللغة العربية، بل التعريب هو: أن تصاغ اللفظة الأعجمية بالوزن العربي، فتصبح عربيّة بعد
(246)وضعها على وزان الألفاظ العربية، فيتدخلون في بنية الكلمة بزيادة أو نقيصة حتى تكون على طبق الوزن العربي الفصيح. وسيأتي الرد على سريانية القرآن الكريم أو آراميّته.
ملخّص ما جاء في الموسوعة:
1. القرآن يتألّف كما يتألف الكتاب المقدس كتاب اليهود والمسيحيّين من أجزاء جمع بعضها إلى بعض.
2. القرآن يختلف عن التوارة في أنّه كله نطق به رجل واحد.
3. القرآن لم يجمع في كتاب واحد في حياة النبيّ وأنّه كان مكتوبًا في أشياء مختلفة ومتفاوتة ولم يكن مرتبًا ترتيبًا زمنيًا أو منطقيًا...
4. لمّا كانت ألفاظ القرآن خالية من الحركات فقد اختلف بعض القرّاء في تفسير بعضها واختلفت نصوصها.
5. من شأن الظروف التي أحاطت بالقرآن أنْ تعرّضه للتكرار وعدم الانسجام فكل فقرة تؤدي إلى غرض واضح مفهوم ولكننا لسنا واثقين من أنّ محمدًا كان يريد جمع هذه الأجزاء كلها في كتاب واحد، فقد كان كثير منها حديثًا لرجل واحد بعينه في وقت بعينه ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد أهله.
6. عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وهي مرتبة حسب طولها، لا بحسب نزولها.
7. إذا كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدًا من طوالها؛ فإنّ للقرآن تاريخ مقلوب. فالسور المدنية وهي التي يبدأ بها الكتاب، وهي عملية في أغراضها،
عادية في أسلوبها. أما السور المكية فهي شعرية روحية وبها ينتهي الكتاب. وخليق بنا أن نبدأ بقرائته من نهايته.
8. جميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو جبريل إلى النبيّ أو أتباعه أو أعدائه، وتلك هي الطريقة التي سار عليها أنبياء بني إسرائيل، وهي التي نراها في كثير من فقرات أسفار موسى الخمسة. وكان محمد يعتقد أنّه ما من قانون أخلاقي يمكن أن يقع في النفوس، وأن يطاع طاعة تكفل للمجتمع النظام والقوة؛ إلا إذا آمن الناس أنّه منزل من عند الله، وهذه الطريقة تتفق مع الأسلوب الحماسي الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان في بعض الأحيان عن أقوال النبيّ أشعيا. وهو غني بالتشبيهات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات الخلابة التي لا توائم ذوق الغربيين.
وسيأتي الرد على أهم هذه الأمور؛ كجمع القرآن والقراءات القرآنيّة...
الوحي ظاهرة تحدث للأنبياء عليهمالسلام وهي عبارة عن علاقة لا مرئية ومعنوية بین نبي من الأنبياء وعالم الغيب، ويتحقّق من خلالها تبيان الرسالة الإلهية، والوحي بهذا المعنى مختص بالأنبياء عليهمالسلام. ويحتاج الوحي إلى واسطة في بعض الأحيان (مثل واسطة الملائكة كالمَلكِ جبرائيل)، ويستغني عن الواسطة في أحيان أخرى وهو ما يطلق عليه العلماء اسم (الوحي المباشر) ويختلف المعنى الاصطلاحي للوحي عن معنيي الإلهام والتحديث.
عرّف شيخ الطائفة الطوسي الوحي بأنّه: «البيان الذي ليس بإيضاح، نحو الإشارة
والدلالة، لأنّ كلام المَلَك كان للرسول صلىاللهعليهوآله على هذا الوجه». وفي موضع آخر قال إنّ: «الإيحاء إلقاء المعنى في النفس على وجه يخفى، وهو ما يجيء به من دون أن يرى ذلك غيره من الخلق».
ويتّضح من خلال التحديدين السابقين أنّهما ناظران إلى أكثر أنحاء الوحي ورودًا في القرآن الكريم، وهو طريق وحي القرآن الكريم نفسه، عبر إرسال مَلَك، وهو جبرائيل عليهالسلام إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾.
وحدّد العلامة الطباطبائي الوحي بأنّه: «إلقاء المعنى بنحو يخفى على غير من قُصِدَ إفهامه»، ويشمل هذا التحديد كلّ أنحاء الوحي، فيدخل فيه الوحي المباشر(بلا واسطة) والوحي غير المباشر(كالوحي بواسطة مَلَك).
ورد في (موجز دائرة المعارف الإسلاميّة):
بعنوان: محمد صلىاللهعليهوآله والقرآن:
1- لا توجد إشارة قط إلى مصدر الوحي أو صيغة المتكلم في السور والآيات التي يظهر أنّها أقدم ما نزل من القرآن.
2- يبدو من بعض الآيات أنّ محمدًا هو المتحدّث.
3- من غير المستبعد أن يكون محمد في بعض الأحيان يكتب بنفسه ما يوحى إليه.
وهناك آراء متعددة عن الوحي المحمدي أوصلها بعض الباحثين إلى ثلاثين رأيًا ولكن يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:
اتّهام الصادق الأمين بالكذب:
الاتّهام المباشر للرسول صلىاللهعليهوآله -والعياذ بالله- بالكذب وأنّه افترى القرآن من عند نفسه، ونسبه إلى الله تعالى.
عرض المستشرقون جملة من الشبهات على الوحي وعند مراجعة كلامهم فإنّ أكثرهم يؤكّدون فكرة واحدة؛ وهي أنّ «القرآن من صنع النبيّ محمد»، ومن هذه الأقوال نذكر:
يقول مونتغري وات: «أنّ محمّدًا لم يكن يؤمن بما كان يوحى إليه وأنّه لم يتلقَّ الوحي من مصدر خارجي عنه، بل إنّه ألّف الآيات عن قصد ثم أعلنها للناس بصورة خدعهم بها وجعلهم يتبعونه فضمن لنفسه بذلك من يرضي طموحه...».
يقول ماكدونالد: «القرآن ليس من عند الله»، وقريب منه قول ويلز: «محمد هو الذي صنع القرآن» وغيرها من الأقوال التي تؤكّد الفكرة نفسها.
وقد عبّروا عن هذه المقولة الباطلة بتعبيرات شتّى:
• الوحي حالة نفسية (الوحي النفسي).
• الوحي انفعال عاطفي (نوبات انفعالية).
• الوحي تنويم ذاتي.
• الوحي تجربة ذهنية.
• الوحي حالة مرضية؛ كالصرع الهستيري.
• الوحي نوع من الهوس المَرَضي.
يقول جولدتسيهر عن النبي محمد صلىاللهعليهوآله أنّه «خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال بأوساط استقى منها أفكارًا أخذ يجترها في قرارة نفسه وهو منطوٍ في تأملاته أثناء عزلته، ولميل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة التي يلمح فيها أثر حالته المرضية، نراه ينساق ضد العقلية الدينيّة والأخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين».
• عبقرية محمد، هي التي مكنته من وضع القرآن على هذه الهيئة.
• إنّ محمدًا ليس رسولًا من عند الله، وإنّما هو رجل ذكي أتى بنوادر الأعمال الإنسانية، ثم انتحل صفة الرسالة والرسول.
• مناجاة روح الخداع والحماسة التي لا تقطن السماء، وإنّما تسكن عقلَ النبيّ.
• نبوة الرسول ليست وحيًا، وإنّما هي فكرة بشرية تتطور في نفس صاحبها.
• من إملاءات الكهنة والمنجمين.
• جمعه من البيئة المكية.
• من الديانة اليهودية والنصرانية والبيئة الجاهلية.
ويذهب بروكلمان إلى أنّ القرآن ناتج عن أمرين؛ الأول: الأفكار التي كوّنها النبيّ، والثاني: ما استقاه من الديانتين اليهودية والنصرانية. فيقول في هذا المجال: «لم يكن عالمه الفكري من إبداعه الخاص إلا جزءًا صغيرًا فقد انبثق في الدرجة الأولى عن اليهودية والنصرانية».
ويقول: جرجس سال: «اجتمع في جزيرة العرب عدد وافر من الفرق المختلفة الأسماء لجأوا إليها هربًا من اضطهاد القياصرة فأدخل محمد كثيرًا من عقائدهم في دينه، أمّا اليهود الذين كانوا أذلّاء لا يعتد بهم فقد قويت شوكتهم في بلاد العرب حيث لجأ كثير منهم على أثر خراب بيت المقدس وهوّدوا كثيرًا من ملوك العرب، ولذا كان محمد في بادئ أمره يداريهم حتى أنّه أخذ عنهم كثيرًا من مقالاتهم ورسومهم تألّفًا لهم لعلهم يشايعونه».
• أخذه من غيره، وهذا الغير مختلف فيه بين أفراد -كما سيأتي- وجماعات؛ كاليهود والنصارى أو بعض المؤمنين من أهل الكتاب.
ينقل المستشرق الروسي أليكس -مشكّكًا- قصة أنّ النبيّ أخذ من الراهب بحيرا أثناء سفره إلى الشام «أنّ محمدًا كان في البداية تلميذًا للراهب النسطوري سرجيوس بحيرا، زاعمين أنّه تلقّى منه بعض المعلومات الأساسيّة من التوراة والإنجيل».
وبعضهم ذهب إلى أنّه النبي قد تعلّم من ورقة بن نوفل. يقول مونتغري وات: «كانت خديجة ابنة عم رجل يدعى ورقة بن نوفل بن أسد وهو رجل متدين اعتنق أخيرًا المسيحيّة، ولا شك أن خديجة قد وقعت تحت تأثيره ويمكن أن يكون محمد قد أخذ شيئًا من حماسه وآرائه».
• كلام عربي نَظَمه محمد شعرًا.
• القرآن ما هو إلا سحر من كلامه.
يقول مونتيه: «إنّ أسلوب القرآن أسلوب شعري مقفى، غير أنّ هذا الأسلوب الشعري ينحصر في السور المكية، خصوصًا القديمة جدًّا منها، دون السور المدينة... إلى أن يقول: المقطع الشعري يتبعه تقسيم منظم، فهو مجموعة أبيات في نظام محدد، تحدث بروابطها ورجوعها انطباعًا لطيفًا في الأذن».
ويري «ريجس بلاشير» أنّ لغة القرآن تشبه لغة الشعر العربي الأصيل في إيقاعه وحركاته وسجعه وقافيته... ويقول: المستشرق البلجيكي «هنري لامانس»: «إنّ كل آية تنتهي بسجع يقوم مقام القافية، هذه القافية من جنس خاص تسمى السجع، كانت سابقًا مستعملة عند الكهّان الوثنيين العرب، وكانت مستعملة بحرّيّة أكثر وبتسامح في البحور العروضية».
القرآن صياغة عربيّة جديدة لما ورد في التوراة والإنجيل، وليس وحيًا من عند الله تعالى.
يقول «مكسيم رودنسون» في كتابه محمّد: «إنّ قصص القرآن ما هي إلا ترديد لما تعلّمه محمد وسرقه من الأديان السابقة، ومن الكتب اليهودية».
ويرى «ريتشارد بل» مؤلّف كتاب (مقدمة القرآن): «إنّ النبيّ قد اعتمد في كتابه القرآن على الكتاب المقدّس، وخاصة على العهد القديم في قسم القصص...».
يمكن تصنيف هذه الشبهات إلى أربعة أصناف:
ولو سألت هؤلاء كيف تمكّن محمدٌ صلىاللهعليهوآله من صنع القرآن، مع اعترافكم بأنّ أسلوب القرآن في أعلى درجات البلاغة، والفصاحة وقوة التعبير، بالإضافة إلى تناوله الكثير من قضايا العلوم والمعارف الكونية وغيرها التي لم يكن لها وجود في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله؟
لرأيتهم يصتنعون جملة من الأجوبة في هذا المجال؛ منها: أن محمدًا صلىاللهعليهوآله كان عنده عبقرية خارقة، أو كان ساحرًا، أو كان شاعرًا، أو جمعه من البيئة المكية، وغير ذلك من الأجوبة المتقدمة.
وهذه الشبهة قد ردّ عليها جملة من المستشرقين المنصفين. قال إدوارد مونتيه: «كان محمد نبيًا بالمعنى الذي يعرفه العبرانيون القدماء، ولقد كان يدافع عن عقيدة خالصة لا صلة لها بالوثنية».
كما تصدّت المستشرقة الإيطالية لورا للأقلام المغرضة ودافعت عن الرسول صلىاللهعليهوآله بتفنيد الأكاذيب التي كانت تشاع عنه في القرون الوسطى.
والموقف نفسه نجده عند المستشرق السويسري حنّا الذي قال: «بقدر ما نرى صفة محمد الحقيقيّة بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة... وقد جاء بشرع لا يسعنا أن نتهمه فيه».
يقول المستشرق كارل: «لقد أخطأ من قال إنّ نبي العرب دجّال أو ساحر؛ لأنّه لم يفهم مبدأه السامي، أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله جدير بالتقدير، ومبدأَه حري بالاتباع، ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، وأنّ محمدًا خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال، كما أنّنا لا نرى أنّ الديانة الإسلاميّة بعيدة عن الديانة المسيحيّة».
وممّن دحض هذه المزاعم: المستشرق الروسي جان ميكائيليس (1717م-1791م)، وكذلك المستشرق الفرنسي دينيه، كما اعترف بصدق رسالته وتأكيد نزول الوحي إليه كل من: توماس كارليل، ولامارتين ماري لوي دي، والكونت كاستري، والباحث الأوروبي سنكس، والفيلسوف الروسي تولستوي، والبروفيسور ليك، والإنجليزي توماس آرنولد.
هؤلاء وغيرهم من المستشرقين المنصفين كانت لهم اعترافات بنُزول الوحي على النبيّ صلىاللهعليهوآله، وصرحوا بصدقه صلىاللهعليهوآله بعد دراسة عميقة، بعدل وإنصاف.
ومن الملاحظات التي يمكن إيرادها في هذا المجال نذكر الآتي:
• لو كان القرآن من صنعه صلىاللهعليهوآله لماذا كان ذلك بعد (40) سنة من عمره؟ ولماذا حصلت الدعوة بهذه الطريقة، ولماذا سكت كل هذه المدة؟
• لو كان القرآن عملًا أدبيًا للنبي لماذا لا نجد اشتراكًا بينه وبين الأدب
الجاهلي، اللهم إلا في اللغة العربية، فلا الأفكار هي نفسها، ولا الأسلوب، ولا المنهج، ولا أي شيء آخر.
• لو كان القرآن صنع النبيّ لماذا تختلف أحاديث النبيّ -وبشكل واضح- من ناحية الأسلوب والروح والألفاظ والتراكيب عن القرآن الكريم؟
• لو كان الوحي القرآني من عندياته ومن إبداعاته لجعله يوافق هواه، ولو كان من إنشائه، فلماذا لم يضمنه أحاديثه؟ ولماذا لم يسرد فيه قصة حياته؟ و...
• القرآن نفسه ينفي أن يكون من صنع البشر وتأليفهم، وإنّما هو كلام الله المنـزل على رسوله وذلك لأسباب عدّة:
ـ من ناحية أسلوبه البليغ المعجز المغاير لأسلوب الرسول.
ـ من ناحية ما تضمنه القرآن من إشارات علمية دقيقة، ونبوءات غيبية، وأخبار القرون الماضية، وأمور التشريع، وغير ذلك من العلوم والمعارف...
ـ القرآن لا يعكس شخصية الرسول في أفراحه وأحزانه، فقد توفي عمه وزوجه في عام واحد فحزن عليهما حزنًا شديدًا، ومع ذلك لم نر في القرآن أي إشارة إلى ذلك.
أشرنا في ما سبق إلى أنّ هذه الشبهات التي أثارها المستشرقون ما هي إلا ترديد للشبهات القديمة التي أثارها المجتمع الجاهلي آنذاك في نفي الوحي وإنكار النبوة، والرد عليهم هو نفسه الرد على آراء المستشرقين، باعتبار أنّ هذه الآراء ما هي إلا صدى لتلك الشبهات.
قالوا: إنّ القرآن سحر ومحمد ساحر، فحكى الله ذلك عنهم بقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً
سْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ، وبقوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾.
وقالوا: إنّ القرآن شعر ومحمد شاعر، قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾.
وقالوا عنه: إنّه مجنون، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) ، فرد الله عليهم بقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ .
يتفق أصحاب هذه الشبهة على أنّ القرآن الكريم هو من صُنع الآخر، فمحمد تلقّاه من الآخرين، طبعًا اختلفوا في مرجع هذا التلقّي، فقالوا إنّه الأديان السابقة، أو المجتمع الوثني، وغير ذلك وقد تقدّمت الإشارة إلى هذه الأمور، ومن بين التُهم قالوا إنّ محمدًا كان يعلّمه بشر، وهم في ذلك أنكروا الوحي وأرجعوا القرآن إلى بشر آخرين غير شخص النبيّ، ومن الأسماء التي طرحوها في المجال نذكر الآتي:
ـ الحداد الرومي.
ـ بحيرا النصراني.
ـ ورقة بن نوفل القرشي.
وفي تفسير قوله تعالى من سورة الفرقان: ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾. ذكر المفسرون جملة من الأسماء في هذا المجال.
قال العلامة الطباطبائي: «وقد ورد في بعض الآثار أن القوم الآخرين هم عداس مولى حويطب بن عبد العزى، ويسار مولى العلاء بن الحضرمي، وجبر مولى عامر، كانوا من أهل الكتاب يقرءون التوراة أسلموا وكان النبيّ صلىاللهعليهوآله يتعهدهم فقيل ما قيل».
والمستشرقون لم يأتوا بشيء جديد وما يقولونه إنّما هو صدى لما كان يردّده أسلافهم من المشركين وأهل الكتاب أثناء نزول الوحي. ولكن هؤلاء لكي يعطوا هذا الكلام نوعًا من المصداقية، قالوا إنّ محمدًا قد تعلّمه من بشر، ولكنهم حدّدوا صنفين:
الأول: أن يكون من سكان مكة، وذلك ليتمكّنوا من ادّعاء الملاقاة بينه وبين النبيّ صلىاللهعليهوآله.
الثاني: أن لا يكون من أبناء جلدتهم فقالوا إنّه تعلّم القرآن من حداد رومي. قيل: بلعام، وقيل: يعيش، وقيل: جبر، وقيل: يسار، وغير ذلك المهم أنّ النبيّ حسب ادعاءهم تعلّم القرآن منه.
والقرآن الكريم ردّ على هذه الفرية بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾.
لا بد من الالتفات أولًا إلى أنّ تمام الجواب عن الشبهة ليس فقط في هذه الآية
بل إلى تمام الآيتين التي بعدها أي الآية 104 و105؛ لأنّه قد يقال حتى لو افترضنا أنّ من علّمه القرآن هو أعجمي فمن المحتمل أن يعلّمه المعاني والنبيّ يصوغها ويسبكها بعباراته وألفاظه العربية.
ولذا تمام الجواب مأخوذ من الآيات الثلاث من سورة النحل، أي الآية 103 المتقدمة وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾.
فالجواب على الشكل الآتي:
أنّ اتّهام النبيّ بأنّ هناك بشر يعلّمه القرآن الكريم لا يخلو من احتمالين:
الاحتمال الأوّل: أنّه يعلّمه القرآن بلفظه، فالقرآن كلام الرومي لا كلام الله.
وجوابه: أنّ هذا الرجل لسانه أعجمي، وهذا القرآن عربي مبين. وهذا ما أفادته الآية 103من سورة النحل.
الاحتمال الثاني: كان يعلّمه معاني القرآن واللفظ من النبيّ، ثمّ النبيّ ينسبه إلى الله افتراء عليه.
والجواب عنه:
أولًا: أنّ الذي يتضمّنه القرآن معارف حقّة لا يرتاب ذو لبّ فيها وتضطر العقول إلى قبولها قد هدى الله النبيّ إليها فهو مؤمن بآيات الله إذ لو لم يكن مؤمنًا لم يهده الله، والله لا يهدى من لا يؤمن بآياته. وهذا ما أفادته الآية 104 من سورة النحل.
ثانيًا: وإذ كان مؤمنًا بآيات الله فهو لا يفتري على الله الكذب؛ فإنّه لا يفتري عليه إلا من لا يؤمن بآياته، فليس هذا القرآن بمفترى، ولا مأخوذًا من بشر، ولا منسوبًا إلى الله سبحانه كذبًا. وهذا ما أفادته الآية 105 من سورة النحل.
والمعنى إنّ الذين لا يؤمنون بآيات الله ويكفرون بها لا يهديهم الله إليه وإلى معارفه الحقّة الظاهرة ولهم عذاب أليم والنبيّ صلىاللهعليهوآله مؤمن بآيات الله لأنّه مهدي بهداية الله؛ وإنّما يفتري الكذب وينسبه إلى الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون المستمرون على الكذب. وأمّا مثل النبيّ صلىاللهعليهوآله المؤمن بآيات الله فإنّه لا يفتري الكذب ولا يكذب، فالآيتان كنايتان عن أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله مهدي بهداية الله مؤمن بآياته ومثله لا يفتري ولا يكذب.
«فإذا كان قوم من الذين كانوا أحرص الناس على خصومته، وأدراهم بأسفاره، وأحصاهم لأحواله، عجزوا أن يقدموا أي صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره، فما بال المستشرقين وأذنابهم من الملحدين يبحثون عن تلك الصلة بعد مضي أربعة عشر قرنًا وربع من الزمان؟ فلو وُجِدت لأثبتها سلفهم، وكَفَوهم عناء البحث، فليريحوا أنفسهم وليشتغلوا بغير هذه الشبهات».
يقول توماس كاريل: «ثمّ علينا أن لا ننسى شيئًا وهو أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله لم يتلقّ درسًا عن أستاذ أبدًا، ويظهر لي أنّ الحقيقة هي أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله لم يكن يعرف الخطّ والقراءة، وكل ما تعلّمه هو عيشة الصحراء وأحوالها. وعجيب والله أميّة محمد صلىاللهعليهوآله، نعم إنّه لم يعرف من العالم ولا من علومه إلا ما تيسّر له أو يبصره بنفسه أو يصل إلى سمعه». ويقول هنري كاستري: «ثبت إذن أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله لم يقرأ كتابًا مقدّسًا، ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدّم عليه».
لقد حاول المستشرقون إثبات عدم أميّة النبيّ لإثبات تعلّمه الكتاب المقدّس من الآخرين.
والمعروف أنّ النبيّ أمّيّ؛ بمعنى لا يقرأ ولا يكتب. وهذا هو الرأي المعروف عند علماء أهل السنّة وعند جملة من علماء الإمامية. وهناك رأي آخر عند بعض العلماء وهو أنّ النبيّ كان يقرأ ويكتب ولكنه لم يمارس القراءة والكتابة أصلًا، طبعًا وهناك أدلّة متعددة على ذلك. وعلى كلا الأمرين فهذا لا يثبت ما ادّعاه المستشرقون.
لأنّه حتى لو ثبتت قدرة النبيّ صلىاللهعليهوآله على القراءة والكتابة؛ فإنّ ذلك لا يقلّل من إعجاز القرآن؛ لأنّه لا يتطرّق الاحتمال إلى أنّ ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله من نظم عجيب وكلام بليغ هو من عند الأقوام السابقة أو من الأديان السالفة، بل الكلّ أدرك أنّ ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله هو شيء جديد يختلف عمّا سمعوه سابقًا من كلام السابقين والذي يؤكِّد هذا المعنى أنّ القرآن تحدى الجميع بأنّ يأتوا بمثله، وكان بإمكانهم وبكلّ سهولة أن يقولوا إنّ ما نسمعه من كلام محمد صلىاللهعليهوآله هو نفس الموجود في الكتب السماوية السابقة، وهذا سيؤدي إلى انهيار دعوى النبيّ، ويؤكِّد عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. ومن هذه الجهة لا موضوعيّة لكون النبيّ يقرأ ويكتب أو لا، فعجزهم عن ذلك يكفي لأن يكون القرآن الكريم هو كلام يفوق كلّ كلام سابق أو لاحق.
فقولهم: إنّ محمدًا اتصل بـ (بحيرا) فأملى عليه معلومات، ثم لما رجع إلى مكة تبنًاها وزعم أنّها من عند الله.
فردّه واضح لأنّ إلقاءه ذلك كان محدودًا وبحضور زعماء قريش، وكان عمر النبيّ اثني عشر عامًا، فطبيعة اللّقاء تنفي أن يكون قد حصل تعلّم لمحمد صلىاللهعليهوآله من بحيرا؛ لأنّه لقاء قصير عابر لا يكفي للدرس والتحصيل، وسنّ النبيّ إذ ذاك صغيرة لا تؤهِّله للتلقّي، ولا توجد رواية تذكر ذلك التعليم، ثم إنّ اللقاء حضره عدد من رجال القافلة، فلم يذكروا شيئًا من ذلك، وقد كانوا أحرص الناس على إحباطها بعد إعلانها.
أمّا دعوى تعلّمه من ورقة بن نوفل فإنّه لم يثبت تاريخيًا أنّ ورقة كان يدعو إلى النصرانية، وإنّ جميع الروايات الصحيحة أكّدت عدم اتصال الرسول بورقة إلا بعد مجيء الوحي إليه، وعدم وجود أي صلة سابقة بين محمد صلىاللهعليهوآله وورقة.
ثم إنّ موقف ورقة من ذلك اللّقاء كان موقف المستفسر لما حصل مع الرسوّل في غار حراء، فلمًا سمع ما وقع للنبي صلىاللهعليهوآله آمن به وشهد على صدقه، ووعده أنّه سينصره نصرًا مؤزرًا، بعد أن أخبره أن قومه سيؤذونه ويخرجونه، ثم لم يلبث ورقة أن توفى وفتر الوحي.
فلو سلّمنا أنّ هناك لقاء بين النبيّ وورقة، لكن ذلك لا يكفي للتعليم؛ أي ليأخذ النبيّ منه القرآن والتعاليم الإسلاميّة، والمشكلة الحقيقية هي في أصل قصة ورقة بن نوفل!
فمن راجع هذه القصّة في المجاميع الروائية؛ كالبخاري، ومسلم، وغيرهما وكتب التفسير كابن كثير، والطبري، و.. يجد أنّ بعض علماء أهل السنّة يقبلون قصة ورقة بن نوفل في بداية الوحي، بل بعضهم يدافع عن ذلك بحجّة أنّ الرواية أخرجها الشيخان، ويطرحون تصوّرات خطيرة جدًا لا يمكن القبول بها على الإطلاق، تمس شخص النبيّ، بل أصل الوحي، منها تصور خوف النبيّ ورعبه من الوحي أو تحديدًا من الملاك جبرائيل، ثم بعد ذلك لجأ إلى ورقة بن نوفل باقتراح من السيدة خديجة عليهاالسلام ليهدّئ له من روعه وشدة خوفه! ولندقّق ونتأمّل بعض المقاطع الخطيرة:
روى عروة بن الزبير، عن السيدة عائشة: «إنّه نزل جبرئيل بغار حراء على رسول الله صلىاللهعليهوآله، وكان حينها يتعبَّد في ذلك الموقع، فنزل عليه جبرئيل وقال له: يا محمد، اقرأ. قال: ما أنا بقارىء. فأخذه، وغطَّه، حتى بلغ منه الجهد، وفي رواية: حتى كاد أن يموت، فلما أشرف على الموت أطلقه. ثم قال له: يا محمد، اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فأخذه، وغطَّه، وضمَّه ضمًا شديدًا، حتى بلغ منه الجهد، وحتى كادت روحه أن تزهق، ثم أطلقه. ثم قال له: يا محمد، اقرأ، اقرأ باسم ربِّك الذي خلق -فتلا عليه الآيات-...
• فنزل محمد صلىاللهعليهوآله من الجبل، وذهب إلى بيت السيدة خديجة مرهوبًا، مرعوبًا، مضطربًا، خائفًا، وقال: زمِّلوني زمِّلوني.
• وبعد أن هدَأ عنه الرَّوع والخوف، أخبر خديجة بالأمر، وقال: أخشى أنّه قد اعتراني مسٌّ من الشيطان... فهدّأتْ خديجةُ من رَوعه....
• ثم قال: لأطرحـنَّ نفسي منه، فلأقتلـنَّها، ولأستريحـن. وفي رواية، أو روايات عديدة: ولألقيـنَّ نفسي من أعالي الجبال، وأقتلها.
• لم تكتفِ خديجة بما فعلت بل أخذته إلى ورقة بن نوفل!! فهدّأ ورقةُ من روعه، وقال: إنّ الذي يأتيك هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي النبيّ موسى.
• فاطمئنَ قليلًا، لكنّه لا يكاد يطمئن إلا ويعاوده التردُّد، والشكّ، والرهبة، والرعب، والخوف! وتُؤكد الروايات الواردة من طرقهم أنّه لم يطمئن بذلك في أول الأمر، بل بادر إلى قتل نفسه، فذهب إلى الجبال؛ يريد أن يلقي بنفسه من أعاليها -كما تؤكِّد رواياتهم-، وكان كلَّما أراد أن يُلقي بنفسه تجلَّى له جبرئيل، وقال له: إنّك لرسول. فيهدأ، ثم يُعاوده الشك، وهكذا مرارًا.
• ومن الوسائل التي اعتمدتْها السيدة خديجة -كما يروون- بطلبٍ من ورقة بن نوفل، حيث قال لها: إذا جاءه الذي يأتيه، فليجلس على شقِّك الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم في حجرك. ففعلت ذلك، فلما جاءه الملَك، جلس عند جانبها الأيمن، فلم يذهب الملَك.. ثم قام وجلس عند قدمها اليسرى، فلم يذهب الملَك.. ثم أدخل رأسه من تحت جيبها، وألصق جلده بجلدها، وكشفت هي عن خمارها وشعرها، فرحل الملَك. فقالت ما هذا بشيطان وأنّه الملَك؛ إذ لو لم يكن هو الملَك، لما رحل عندما كشفتُ خماري....
إلى هنا نبينا الأعظم محمد -والعياذ بالله-: كان مضطربًا، مرعوبًا، لا يعرف ما الذي يحصل معه إلى أن هدأت خديجة من روعه، ولم تكتف خديجة بذلك بل أخذته إلى ورقة بن نوفل النصراني، ثم فكّر محمد بالانتحار، ثم طرح ورقة بن نوفل تلك الطريقة المخجلة والمؤسفة التي نراها في كتب المسلمين لمعرفة الوحي...
في الحقيقة هذه الروايات وأمثالها هي أسوأ ممّا ذهب إليه المستشرقون، بل بعض هذه الروايات تمسّك بها هؤلاء لتأيد أوهامهم في شأن الوحي.
وينبغي على الباحثين من الفريقين أن يرفضوا هكذا نوع من الروايات سواء وجدت في كتب أهل السنّة أم الشيعة، لأنّ لها لوازم خطيرة على المعتقد الإسلاميّ، وعلى شخص الرسول الكريم، ولذا المعروف بين علماء المسلمين أن كل رواية فيها إساءة إلى شخص النبيّ أو تنافي المعتقدات المسلَّم بها والمجمَع عليها تُرفض ولا يعمل بها.
ولذا إذا رجعنا إلى هدي الإمام المعصوم عليهالسلام فهو يرفض هذه الفكرة الخطيرة ويعطينا قاعدة في هذا المجال؛ وهي: أنّ الله تعالى لا يبعث نبي من الأنبياء حتى ينزل عليه السكينة والوقار.
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَيْفَ لَمْ يَخَفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ أن يَكُونَ ذَلِكَ مِمًا يَنْزِغُ بِهِ اَلشَّيْطَان قَالَ: فَقَالَ: «إنّ اَللَّهَ إِذَا اِتَّخَذَ عَبْدًا رَسُولًا أنزَلَ عَلَيْهِ اَلسَّكِينَةَ وَاَلْوَقَارَ، فَكَان [اَلَّذِي] يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ مِثْلُ اَلَّذِي يَرَاهُ بِعَيْنِهِ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، فَقَالَ: قَالَ أَثْنُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا لَهُ. فَقُلْتُ كَيْفَ عَلِمَتِ اَلرُّسُلُ أنّهَا رُسُلٌ. قَالَ: كُشِفَ عَنْهَا اَلْغِطَاءُ.
يعني هذا الصنف من تفسير الوحي بـ (الوحي النفسيم)ع الاضطراب في تحديده ويعنون بـ: «أنّ القرآن فيض من خاطر محمد أو انطباع لإلهامه، أي أنه ناتج عن تأملاته الشخصية، وخواطره الفكرية وسبحاته الروحية».
يقول بروكلمان: «تحقّقت عنده أنّ عقيدة مواطنيه الوثنيين فارغة فكان يعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم ما دام هو قد تجلى آخر الأمم للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنّه مدعوّ إلى أداء رسالة النبوة».
وقد اضطربوا في تحديد حالة النبيّ النفسية التي صدر عنها القرآن، فاختلفوا في ذلك إلى أقوال متباينة وقد تقدم بيان هذه الأقوال.
يرى جوستاف لوبون أنّ التصرفات التي تعتري الرسول إبان نزول الوحي الإلهي
عليه ما هي إلا إصابته بالصرع الذي ينتابه في هـذه اللحظات، فيعتريه احتقان فغطيط، فغثيان. ويرى أنّه يجب اعتبار محمد من فصيلة المتهوسين ويقول في هذا الصدد: ولا أهمية لذلك فلم يكن ذو المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشئون الديانات، ويقودون الناس، وإنما أولو الهوس هم الذين مثلوا هذا الدور، وهم الذين أقاموا الأديان، وهدموا الدول، وأثار الجموع وقادوا البشر، ولو كان العقل لا الهوس هو الذي يسود العالم لكان للتاريخ مجرى آخر.
وخلاصة الشبهة: أنّ الوحي عبارة عن فيض وجدان النبيّ الباطني الناتج عن تفكيره بخلاص قومه من الشرك والظلم.
• أدرك بطلان ما عليه قومه.
• ابتعد عن ممارسة الظلم وارتكاب الفواحش.
• فكرّ بإصلاحهم.
• استقى معلوماته من أهل الكتاب.
• اعتقد أنّه النبيّ المبشَّر به.
• أوحت له نفسه.
إنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله قد أدرك بقوّة عقله الذاتية، وما يتمتّع به من نقاءٍ وصفاءٍ روحيّ ونفسيّ، بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام، وفطرته الزكيّة؛ إضافةً إلى بعض الظروف الموضوعيّة التي حالت دون أن يمارس أساليب الظلم الاجتماعي، ثم طال تفكيره من أجل إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح، وتطهيرهم من تلك الفواحش والمنكرات.
وقد استفاد من النصارى في المعلومات وإن كان لم يقبل جميع ما وصل إليه منهم؛ كألوهيّة المسيح وأُمّه، وغير ذلك.
وكان قد سمع أنّ الله سيبعث نبيًا، وتولّد في نفسه أملٌ ورجاء في أن يكون هو ذلك النبيّ الذي آن أوانه، وأخذ يتوسّل إلى تحقيق هذا الأمل بالانقطاع لعبادة الله تعالى في خلوته في غار حراء.
وهنالك قَوِيَ إيمانه وسما وجدانه، وبعد فترة من التأمل أصبح أهلًا لهداية الناس، ثم ما زال يفكّر ويتأمّل ويتقلّب بين الآلام والآمال، حتّى أيقن أنّه هو النبيّ المنتظَر الذي يبعثه الله لهداية البشرية، وتجلّى له هذا الاعتقاد في الرؤى المناميّة، ثم قَوِيَ حتّى صار يتمثّل له الملك يلقّنه الوحي في اليقظة.
وأمّا المعلومات التي جاءته من هذا الوحي، فهي مستمدة في الأصل من تلك المعلومات، التي حصل عليها من اليهود والنصارى، وممّا هداه إليه عقله وتفكيره في التمييز بين ما يصحّ منها وما لا يصح، ولكنّها كانت تتجلّى وكأنّها وحي السماء، وخطاب الخالق عزّ وجلّ، كما كان يأتي الأنبياء؛ كموسى وعيسى عليهمالسلام.
وإذا أردنا أن ندرس هذه النظرية (نظرية الوحي النفسي)، لا نجدها تصمد أمام النقد والمناقشة العلميّتين، إذ يمكن أن يُلاحظ عليها من خلال أبعاد ثلاثة:
(267)الأوّل: أنّ الدلائل التأريخية القطعية وطبيعة الظروف التي مرّ بها النبيّ صلىاللهعليهوآله تأبى التصديق بهذه النظرية وقبولها.
الثاني: أنّ المحتوى الداخلي للقرآن الكريم -بما يضمّ من تشريع وأخلاق وعقائد وتأريخ- لا يتّفق مع هذه النظرية في تفسير الوحي القرآني.
الثالث : أنّ موقف النبيّ صلىاللهعليهوآله من الظاهرة القرآنيّة، يشهد بوضوحٍ على رفض تفسير الظاهرة القرآنيّة بنظريّة الوحي النفسي.
قد أجاب الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب الوحي المحمدي بالتفصيل عن هذه الشبهة، فعرض أولًا المقدمات العشرة التي رتبها (درمنغام)، ثم أبطل كل هذه المقدمات لأنّ أكثر المقدمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آراء متخيّلة، أو دعاوى باطلة، لا قضايا تاريخية ثابتة، وإذا بطلت المقدمات بطل لزوم النتيجة لها.
• ما يذكرونه من تفاصيل ليس لها مصدر تأريخي معتمد من قبيل:
مسألة لقاء الراهب بحيرا مع محمد صلىاللهعليهوآله وهو بصحبة عمّه أبي طالب، الأمر الذي يدعوهم إلى الاستنتاج وافتراض محادثات دينية وفلسفية معقدة جرت بينهما.
تعليل اطلاعه على أخبار عاد وثمود، من أنّه كان نتيجة مروره بأرض الأحقاف، بالرغم من أنّ هذه الأرض لا تقع على الطريق الاعتيادي لمرور القوافل التجارية، كما أنّ التأريخ لم يذكر لنا مرور النبيّ بها إلى غير ذلك من الأحداث والقضايا.
• افتراض تعلم النبيّ صلىاللهعليهوآله من نصارى الشام وغيرهم لا يتفق مع واقع الحيرة والتردد في موقف المشركين من دعوة رسول الله ونسبته الرسالة إلى الوحي
الإلهي، لأنّ مثل هذه العلاقة -لو كانت موجودة- لا يمكن التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم، الذين عاصروه وعايشوه في مجتمع ضيق وعرفوا أخباره وخبروا حياته العامة بما فيها من سفرات ورحلات.
«ولو فرض محالًا ذلك [تعلمه من أهل الكتاب] فما هذه المعارف والعلوم؟ ومن أين هذه الحكم والحقائق؟ وممّن هذه البلاغة في البيان الذي خضعت له الرقاب وكلّت دونه الألسن الفصاح؟».
• إنّه لم يعرف عن الرسول محمد صلىاللهعليهوآله أنّه كان ينتظر أن يفاجأ بالوحي، أو يأمل أن يكون هو الرسول المنتظر، لينمو ويتطور هذا الأمل في نفسه، فيصبح واقعًا نفسيًّا، بالرغم من تدوين كتب السيرة النبوية لأدق الأحداث والتفصيلات عن حياة الرسول الشخصية.
ولعلّ من القرائن التأريخية التي تشهد بكذب هذا الافتراض: هو ما ذكرته كتب السيرة من اضطراب النبيّ -في البداية- وخوفه حين فاجأه الوحي في غار حراء.
• إنّ هذه النظرية تفرض أن يكون إعلان النبوة في اللحظة الأولى من الدعوى وأن يطرح مفاهيمه وأفكاره ومناهجه عن الكون والحياة والمجتمع بجوانبه المتعددة ودفعة واحدة، لأنّ المفروض أنّ الصورة كانت متكاملة عنده نتيجة التفكير الطويل ودراسة الكتب وأعمال الانبياء السابقين، مع أنّ التأريخ يؤكد أنّ أسلوب الدعوة وطريقتها كانا يختلفان عن ذلك تمامًا.
إنّ للمحتوى الداخلي للظاهرة القرآنيّة وما تتصف به من مواصفات، ولسعة النظرية القرآنيّة وآفاقها المتعددة ومجالاتها المتشعبة، أهمية كبرى في رفض نظرية الوحي النفسي، إذ إنّ هذه المواصفات وهذا الاتساع والشمول لا يتفق مع طبيعة المصادر التي تفرضها النظرية، ويتضح ذلك عندما نلاحظ الأمور التالية:
• أنّ الموقف العام للقرآن الكريم تجاه الديانتين اليهودية والمسيحيّة هو موقف المصدّق لهما والمهيمن عليهما، فقد صدّق القرآن الكريم الأصل الإلهي لهاتين الديانتين وارتباطهما بالمبدأ الأعلى، ولكنّه في الوقت نفسه جاء مهيمنًا ورقيبًا وحاكمًا على ما فيهما، ومبيّنًا لواقع ما ورد عليهما من تحريفات وبدع وضلالات.
وجاءت هذه الرقابة دقيقة شاملة، فلم تترك مفهومًا أو حكمًا أو حادثةً إلا ووضعت المقياس الصحيح له. ولا يمكن أن نتصوّر محمدًا صلىاللهعليهوآله وهو يأخذ عن أهل الكتاب ويراهم قد أخذوا عن الوحي الإلهي، ومع ذلك يتمكن من أن يصفهم بالجهل والتحريف والتبديل بمثل هذا اليقين والثبات، ثم يوضح الموقف الصحيح في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها أو خالفوا الواقع الصحيح للديانة، ثم تأتي نظريته بعد ذلك كاملة شاملة ودقيقة ليس فيها تناقض ولا اختلاف!
ولكنّ الحقيقة هي أنّ محمدًا لم يكن قد أخذ منهم شيئًا، وإنّما تلقّى كلّ ذلك عن الوحي الإلهي الذي جاء مصدّقًا لما سبقه من الوحي ومهيمنًا عليه، ومبيّنًا للانحراف والتحريف الذي أصاب الرسالات السابقة عليه.
• ونجد القرآن أيضًا يخالف التوراة والإنجيل في بعض الأحداث التأريخية، فيذكرها بدقة متناهية ويتمسّك بها بإصرار، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل بعضها على الأقل، تفاديًا للاصطدام بالتوراة والإنجيل.
• سعة التشريع الإسلاميّ وعمقه وشموله للمجالات المختلفة من الحياة، مع دقّة التفاصيل التي تناولها، والانسجام الكبير بين هذه التفصيلات.
إنّ موقف النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله من الظاهرة القرآنيّة هو من أفضل الشواهد على بطلان نظرية الوحي النفسي، فقد كان النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله يدرك بشكل واضح الانفصال التام بين ذاته المتلقية والذات الإلهية الملقية من أعلى.
وكان له مظاهر عديدة نذكر منها الأشكال الثلاثة التالية:
الصورة التي يبدو فيها النبيّ من خلال الظاهرة القرآنيّة عبدًا ضعيفًا لله سبحانه، يقف بين يدي مولاه يستمد منه العون ويطلب منه المغفرة ويمتثل أوامره، ونواهيه، والأمثلة القرآنيّة على ذلك كثيرة:
1. فالقرآن يصور محمدًا صلىاللهعليهوآله في صورة الإنسان المطيع الذي لا يملك لنفسه شيئًا، ويخاف ربّه إن عصاه، فيلتزم الحدود التي وضعها له ويرجو رحمته وليس من شيء يأتيه إلّا من قبل ربّه، فهو يعترف بالعجز المطلق تجاه إرادة الله أو تبديل حرف من القرآن.
2. ثم يزداد هذا الفرق وضوحًا بين ذات الله المتكلم منزل الوحي وصفاته، وبين ذات رسوله المخاطب متلقي الوحي وصفاته في الآيات التي يعتب الله فيها على نبيّه، أو يُعلِمه فيها بعفوه عنه وغفرانه.
3. ويبدو لنا أيضًا: كامل الوعي للفرق بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة،
وبوعيه الكامل هذا كان صلىاللهعليهوآله يفرق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر عنها بإلهام من الله.
يبدو النبيّ في القرآن الكريم بمظهر الخائف من ضياع بعض الآيات القرآنيّة ونسيانها، الأمر الذي كان يدعوه إلى أن يعجل بقراءة القرآن، قبل أن يقضى إليه وحيه ويأخذ بترديده ويجهد نفسه وفكره من أجل أن لا يفوته شيء من ذلك.
يبدو النبيّ من خلال تأريخ نزول القرآن أنّه كان مقتنعًا بأنّ التّنزيل القرآني مصحوب بانمحاء إرادته الشخصية، وأنّه منسلخ عن الطبيعة البشرية حتى ما بقي له اختيار في ما ينزل إليه أو ينقطع عنه، فقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر أنّه يكثر عليه، وقد يفتر عنه بل وينقطع وهو يشعر أنّه أحوج ما يكون إليه.
وبالنتيجة: حين نلتفت إلى هذه الأشكال الثلاثة بصورها المختلفة، ونضيف إليها البعدين الآخرين السالفين، لا يبقى لدينا مجال لأي تردّد في شأن حقيقة الظاهرة القرآنيّة، وانفصالها عن الذات المحمّدية، وبطلان الوحي النفسي وما إليه من شبهات قد تثار.
تصوّر أصحاب التيار المادي أنّ الأنبياء (بعثوا) ولم (يبعثوا) بتأثير وضغط الحاجة الفكرية والنفسية والاقتصادية التي عانى منها أفراد مجتمعاتهم، وقد كان أولئك الأنبياء مرهفي الإحساس، شديدي الذكاء، قادرين على استغلال تلك الحاجة في النفوس بتحريك أصحابها وقيادتهم. ويرون أنّ دعوة الأنبياء جاءت نتيجة عاطفتهم الإنسانية أو ميلهم نحو الإصلاح.
يقول توماس كارليل أثناء مدحه للنبي محمد صلىاللهعليهوآله: «القرآن لو تبصرون ما هو إلا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس رجل كبير السن بعد أن أوقدتها الأفكار الطوال في الخلوات الصامتات، وكانت الخواطر تتراكم عليه بأسرع من لمح البصر وتتزاحم في صدره» إلى أن يقول: «وقد أتخيل روح محمد الحادّة الناريّة، وهي تتململ طول الليل الساهر يطفوبها الوجد ويرسب، وتدور بها دوّامات الفكر، حتى إذا أسفرت لها بارقة رأي حسبته نورًا هبط عليها من السماء وكل عزم مقدّس يهم به يخاله جبريل ووحيه».
ولا شكّ أن هناك فروقًا واضحة بين الأنبياء والمصلحين: فالنبيّ: إنسان حرّ من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، فهم جاؤوا بأفكار جديدة تخالف ما كان عليه ثقافة أقوامهم، وأتوا بقيم أخلاقية واجتماعية غير متأثرة بما كانت عليه أممهم؛ ما يدّل على ربانية ما جاؤوا به من علم أو كتاب.
ولقد ظهر لكل منصف أنّ ما دعا إليه الرسول من الشعائر العبادية والقيم الأخلاقية، وقواعد السلوك لم يكن نابعًا من بيئته، بل كان غريبًا عن ثقافتهم مباينًا لأعرافهم، كما قرّره جعفر بن أبي طالب، أمام ملك الحبشة، مظهرًا المفارقة بين مظاهر الواقع، ومعطيات الوحي، قال: «أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ و... حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَان وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانا عَنْ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ...».
فوصف لنا الحالة التي كانوا يعيشونها، ثم بَيَّنَ صفات النبيّ الموحى إليه، ثم بين ما أمرهم به مما يخالف ما كانوا عليه، وما نهاهم عنه من الأوزار، ثم عدد أمور الإسلام الأخرى.
فدّل هذا على أن الوحي يأتي إلى الرسول من قِبَلِ الله؛ لإعادة الناس إلى فطرهم الأصلية التي انصرفوا عنها بفعل عوامل كثيرة اقترفوها مع عامل الزمن.
(274)
(275)
صنّفت موسوعات متعددة، ومعاجم مختلفة في الغرب وباهتمام مجموعة من كبار علماءهم، عنيت بالتعريف بالإسلام، والقرآن الكريم، ومضامينه، وسنكتفي في هذه الدراسة بذكر أنموذجٍ واحدٍ لموسوعة قرآنية، وبعض النماذج للمعاجم القرآنية، حتى نستكمل الإحاطة بالنظرة الاستشراقية للقرآن الكريم.
الموسوعة المختارة هي دائرة المعارف الإسلاميّة، وسبق أن تحدّثنا عن تعريف القرآن في هذه الموسوعة في المبحث السابق.
وهذه الموسوعة، كما لاحظنا في التعريف المقتبس منها لم تبتعد عن السياقات والارتكازات الاستشراقية التي عجّت بها كتب المستشرقين وبحوثهم، ومن هذه الكتب:
1- ضد قرآن محمد: كتبه ريكولدوبنيني راهب دومينكي.
2- في الرد على القرآن: كتبه لودوفيقوماراتشي راهب إيطالي.
3- التوراة في القرآن: كتبه المستشرق الألماني حوستاف قابل.
4- الراهب بحيرا والقرآن: كتبه المستشرق الفرنسي كارا دينو.
5- القرآن: الإنجيل المحمدي: كتبه المستشرق السويدي سرجستين.
6- تاريخ القرآن: وهو من أبرز الكتب التي ألفها المستشرقون للمستشرق الألماني نولدكه.
لم يتوقف اهتمام علماء الغرب بالإنتاج الموسوعي لمعارفهم فقط، بل اهتموا
بإنتاج الأعمال الموسوعية للأديان والحضارات الأخرى، ومن بينها الإسلام الذي لقي عناية خاصّة في إصدارهم في هذا المجال. وظهر ذلك جليًّا «دائرة المعارف الإسلاميّة» التي تعدّ من أكبر الدراسات الاستشراقيّة للإسلام، وأعظمها خطورة خلال القرن العشرين، فقد تضمنت خلاصة جهود المستشرقين في الدراسات الإسلاميّة.
ويمكن التعريف بـ«دائرة المعارف الإسلاميّة» بأنّها: مجموعة من المقالات والبحوث المتعلقة بالإسلام والمسلمين بأقلام كبار المستشرقين ولكل منهم أهدافًا من وراء الكتابة فيها بدأت فكرتها عندما شعروا في مؤتمراتهم الدولية بالحاجة إلى دائرة معارف لأعلام العرب والإسلام لكي تجمع شتات دراساتهم عنهم باللغات الثلاث: (الألمانية والفرنسية والانجليزية). فبدأ تأليفها سنة 1906م وقد صدر المجلد الأول واستمر في أربعة مجلدات كبيرة وملحق عام 1938م.
وإذا رجعنا إلى مصادر هؤلاء في هذه الدائرة فنجد أنّهم انتقائيون في مصادرهم وذلك لتحقيق أغراضهم الخاصة، وهي على الشكل الآتي: كثيرًا ما يترك المستشرقون الاستدلال بالكتاب والسنة في بيان اعتقاد المسلمين، بل يأخذون من كتب أهل البدع والقصص والعجائب، ويلاحظ مخالفتهم للمنهج العلمي في الأخذ من المصادر؛ مثل أن ينسب بعضهم إلى المصدر ما يستنتجه، مع أن استنتاجه قد لا يكون صحيحًا، ومثل الاستدلال بالكتاب التركي المليء بالخرافات على عقيدة اليوم الآخر، والاستشهاد بكتب القصص لبيان تطبيق المسلمين للأحكام الشرعية (مثل الإحالة على ألف ليلة وليلة)، ويركّزوا على الكتب التي تجمع الروايات المختلفة، والانتقاء منها كالطبري في تفسيره وتاريخه.
أما طريقة الدائرة في بث المطاعن: فهي البحث عن مواطن الضعف، ومن ثم إبرازها وجمع المعلومات ومن ثم تقديمها بكل جرأه ويبنون عليها نظرية لا وجود لها إلا في أنفسهم وأذهانهم فدراساتهم تبين أنهم يريدون النيل من الإسلام عن طريقة النقد.
ويصف بعض الباحثين هذه الموسوعة بقوله: «عندما وصل الاستشراق إلى
ذروة نفوذه وغاية تأثيره جمع كل شبهاته وتأثيراته وسمومه في موسوعة جامعة أُطْلِقَ عليها اسم (دائرة المعارف الإسلاميّة)، جمعت خلاصة فكر المستشرقين الكبار جميعًا، كلٌ في المجال الذي تخصص فيه، وقدمت هذه الموسوعة أساسًا لتشكيك الباحثين في الغرب في حقائق الإسلام، وعظمة تاريخه، وسماحة أبطاله وأعلامه، ثم ترجمت إلى اللغة العربية؛ لتكون مرجعًا في الجامعات والمعاهد والمدارس، في مختلف أنحاء العالم الإسلاميّ».
ويؤكّد باحث آخر خطورتها بقوله: «ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار (دائرة المعارف الإسلاميّة) بلغات عدّة، وكذلك إصدار موجز لها باللغات الحيّة نفسها التي صدرت بها الدائرة، وقد بدأوا في الوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة تظهر في أجزاء، ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أنّ المستشرقين عبّأوا كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة، وهي مرجع لكثير من المسلمين في دراستهم على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين».
وباختصار فهي موسوعة تعنى بكل ما يتّصل بالحضارة الإسلاميّة، سواء من الناحية الدينيّة أو الثقافية أو العلميّة أو الأدبية أو السياسية أو الجغرافية على امتداد العصور، بما في ذلك العصر السابق للإسلام.
وقد تم إصدارها على طبعتين، الأولى بين 1913 و1938م، والثانية ما بين 1954 و2005، ويتم إصدارها من قبل شركة بريل الهولندية.
وظهرت هذه الموسوعة بأكثر من لغة، أما بالنسبة للعربيّة فقد تم تعريب بعض أجزائها وتنقيحها وصدرت في مصر في الستينات وأعيد طبعها بالشارقة عام 1998م.
وهناك نقاط خطيرة وغير صحيحة في هذه الدائرة سواء ما يتعلق بالسنة والنبيّ وما يهمنا ما يتعلق بالقرآن الكريم ومنها.
و«الادّعاء بأنّ القرآن من حيث المصدر يرجع إلى أصول يهودية ونصرانية والادّعاء بالأخذ عن غير المسلمين».
وعندما نراجع كبار المستشرقين الذين كتبوا هذه الموسوعة وقد كان لبعضهم الدور الأبرز في تحرير موادّها، ومن ثم نعرف ميولهم الفكرية تجاه الإسلام والقرآن الكريم نعرف خطورة هذا العمل وعدم حياديته بل عدم موضوعيته أصلًا.
وقد بلغ عدد كتاب دائرة المعارف الإسلاميّة في كلتا الطبعتين 486 كاتبًا، حرّروا 3930 مادة وجعلت كل مادة رمزًا مستقلًا؛ نظرًا لاختلاف المواد والكتاب في دائرة المعارف، ومن أشهر كتاب الدائرة:
ـ لويس ماسينيون (1883-1962م) أكبر مستشرقي فرنسا المتأخرين.
ـ جوزيف شاخت (1902-1970مم)ستشرق هولندي من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق.
ـ دافيد صموئيل مرجليوث (1858-1940مم)ن كبار المستشرقين، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق.
ـ دانكن بلاك ماكدونلد (1863-1943م-م)ستشرق أميركي.
ـ إجناس كولد ذهير (1850-1921م)ستشرق مجري موسوعي، عرف بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه.
ـ كارل بروكلمان (1868-1956م)ستشرق ألماني يعتبر أحد أبرز المستشرقين في العصر الحديث.
وأشرف على الطبعة الأولى المستشرق الهولندي أرند جان فنسنك
A. J. Wensinck وقد كان عضوًا في مجمع اللغة العربيّة في القاهرة وفُصل منه نتيجة مؤلفاته التي هاجمت الإسلام والقرآن والرسول.
وشارك -أيضًا- في إعداد هذه الموسوعة المنصِّر والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون Louis Massignon وهو يعتبر رائد الحركة التبشيرية في مصر. وفي مدينة دمياط تعهد مع معاونيه على بذل حياتهم لتنصير المسلمين قائلًا: الهدف ليس فقط تنصيرهم، ولكن جعل إرادة الربّ تعمل بهم ومن خلالهم قد اشتهر بالعمل على تنصير الأمّيّين عبر خداعهم بتحوير آيات القرآن الكريم لإيهامهم بموافقتها للنصرانية.
كما اشترك -أيضًا- في تحرير الموسوعة كثير من اليهود؛ مثل: جوزيف شاخت Joseph Schacht المستشرق الهولندي وإجناس جولذيهر Ignaz Goldziher المستشرق المجري وجورجيوليفي دلا فيدا Giorgio Levi Della Vida المستشرق الإيطالي وبرنارد لويس بالإنجليزية: Bernard Lewis المستشرق البريطاني. وبرنارد لويس من أشد المناصرين لإسرائيل وهو صاحب مصطلح «صراع الحضارات» الذي أعلنه عام 1990 وقصد به الصراع بين الغرب والإسلام؛ بوصفه عدوًا قادمًا بعد انهيار الاتّحاد السوفيتي. وكلّ كتبه عن الإسلام تدعو إلى محاربته بشتى الطرق. وهو أيضًا من المشاركين في صنع القرار في الولايات المتحدة في ما يخصّ الشرق الأوسط.
واشترك في كتابتها -أيضًا- قساوسة وعلماء لاهوت ومنصِّرون؛ مثل: القسّ دافيد صموئيل مرجليوث David Samuel Margoliouth وكان قسًّا بالكنيسة الإنجليزية وعرف عنه التعصّب ضدّ الإسلام. وكذلك عالم اللاهوت والمستشرق هنري لامن-س Henry Lammans وقد عمل بالتنصير في بيروت وعرف عنه الحقد الشديد على الإسلام.
وكذلك المستشرق ج. كريمرز J. H. Kramers وكتاباته تركز على التنصير. أمّا دانكن بلاك ماكدونلد Duncan Black Macdonald فهو منصِّر أمريكي تتركز مؤلفاته حول تنصير المسلمين وكان قد أنشأ معهدًا متخصصًا لهذا الغرض. وأيضًا أدوين كالڤرلي Edwin Calverley المنصِّر الأمريكي الذي رأس تحرير مجلة العالم الإسلاميّ التنصيريّة التي تهتم بتنصير المسلمين.
تضمّنت دائرة المعارف الإسلاميّة في موادها التعريفية مادة (القرآن)، كتبها المستشرق الدانماركي «ف.بول».
وعرض الكاتب هذه المادَّة في ثلاث عشرة صفحة، ذكر في أولها أنَّ القرآن كتاب المحمَّديين المقدَّس، ثم قسَّم حديثه عن القرآن إلى أقسام عدَّة، جعلها على شكل فقرات مرقَّمة بلغت اثنتين وعشرين فقرة. ولنتوقَّف عند أهمّ الفقرات ومدلولاتها:
في هذه الفقرة تحدث الكاتب عن مصدر القرآن، وعن بعض موضوعاته، وكيفيَّة نزول الوحي على النبيّ، وذكر على نحو مختصر قصة الغرانيق. وفي آخر الفقرة شكَّك الكاتب في حقيقة قصار السور؛ إذ ذكر أنَّها قد أخذت نصَّها الحاليّ بعد إعادة الصياغة.
قال: إنّ تقسيم نزول القرآن إلى أجزاء قصيرة كان مرتبطًا بهجوم معارضيه في مكَّة، وبالعوامل السياسيَّة وغيرها في المدينة؛ ولذلك كانت لظروفه صلىاللهعليهوآله أثرها على محتويات القرآن وهيئته.
ويقول: ولا نجد في أيّ مكان معالجةً شاملةً لأساسيَّات العقيدة أو للقوانين، ولكن النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يتحوّل بسرعة من موضوع إلى آخر حسب الرغبات.
ذكر أن النبيّ قد استفاد من الأفكار الدينيّة الموجودة في جزيرة العرب، والتي كانت تمثِّل فروعًا لبعض الطوائف التي تتَّصل باليهود والنصارى. وقال أيضًا: إنَّ
النبيّ كان يعرض القرآن ليس طبقًا لنماذج الكتاب المقدَّس، وإنَّما كان يعرضه بأسلوب الكهَّان من العرب الوثنيِّين.
ادَّعى أنَّ أجزاء القرآن الأولى تختلف عن أجزائه المتأخِّرة، وكان يؤكد أنَّ تلك الأجزاء المبكرة والمتأخِّرة هي من إنتاج الفرد نفسه، واستمرّ الكاتب في تأكيد أنّ القرآن من وضع النبيّ.
وجاء في المقالة مع وفاة النبيّ تغيّر الوضع تدريجيًا، ولم يَرِثْ أحد موهبة محمد التنبّؤية...، وقد استدعى الواجب جمع تراثه القيّم في صورة كاملة وصحيحة قدر الإمكان، وحفظه من الضياع، وهذا الأمر هو ما أكَّدته الروايات؛ ولكن لسوء الحظّ بطريقة تترك الكثير غامضًا... إلى آخر النقاط التي عرضتها دائرة المعارف الإسلاميّة.
وقد كتب بعض الباحثين ردودًا تفصيلية على ما ورد في دائرة المعارف الإسلاميّة، منها:
يقول بعض الباحثين عن الموسوعة –وهو من الذين كتبوا ردودًا تفصيليَّة ومهمَّة على الموسوعة –: «وقد عكفت على هذا الكتاب أتمعّن فيه فهالني ما يسوده من انحرافٍ عن المنهج العلمي، وعداوة بارزة للإسلام ورسوله وكتابه وعقائده وشرائعه، ورغبة جارفة في تلطيخ كلّ شيء فيه. ولم أجد مرة أحدًا من كتّاب الموسوعة قد تحدث عن ديننا ورسولنا وقرآننا بشيء من رحابة الصدر وسعة الأفق، بل دائمًا ما تُقدّم أسوأ التفسيرات،... إلى أن قال: وقد دفعني هذا كلّه إلى الكتابة عن هذه الموسوعة، وتبيين ما فيها من انحراف عن منهج البحث العلمي، وإلقاء الضوء على الأخطاء الرهيبة والتناقضات الخطيرة التي تطفح بها...».
ثمَّة أخطاء كثيرة وجسيمة في هذه الموسوعة، ويجدر بنا الوقوف عند نماذج من هذه الشبهات الواهية، خاصَّة تلك التي وردت في مادَّة «قرآن»:
إنَّ المستشرقين قبلوا النظرية التي قال بها «شفالي» في كتابه «تاريخ القرآن» من أنَّ كلمة (قرآن) قد اشتقّت من كلمة (قرياءنا) السريانيَّة، ومعناها: القراءة المقدَّسة، والدرس.
وبعد ذلك يعرض لكلمة (سورة)، فينقل عن «شفالي» قوله: «إنَّها تبدو مشتقَّة من (صورطا) أو (سورثا) السريانيَّة، ومعناها: الكتاب المقدَّس».
كما يعرض للفظ (مثاني)، فينقل ما قاله بعض المستشرقين من أنَّها مشتقَّة من (مشنا) العبريَّة، وبعضهم الآخر اعتبرها مشتقَّة من «ماثنيتكا» السريانيَّة أو الآراميَّة.
ويعرض الكاتب كلمات أخرى، ويحاول إرجاعها إلى أصول غير عربيّة، ولا شك أنّ الهدف من وراء هذا التشكيك في أصالة المصطلحات الرئيسة في القرآن وردِّها إلى أصول عبريَّة أوساميَّة أو آراميَّة، إنَّما هو استدراج للقارئ وتمهيد لإقناعه بأن القرآن هو من اختراع محمَّد وتأليفه، وأنَّه قد تعلّم هذه الألفاظ من اليهود والنصارى.
وهذا الكلام يفترض الآتي:
1- أنَّ محمدًا كان يعرف العبريّة والسريانيَّة واليونانيَّة، ولا بدَّ أنَّه كانت لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كلّ الأدب التلموديّ والأناجيل المسيحيّة و...
وهل يمكن أن يعقل هذا الكلام الشاذّ لهؤلاء الكتَّاب، وهو كلام لا برهان عليه.
2- يمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربيّة قبل زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله بوقتٍ طويل، واستقرّت في اللغة العربيّة حتى أصبحت جزءًا منها وصارت من مفرداتها التي يروج استخدامها بين العرب. كما أنَّه من المستحيل الآن -بسبب غموض تاريخ اللغات الساميَّة- أن نحدّد من اقتبس هذه الألفاظ المشتركة من الآخر: العربيّة أم العبريَّة.
الفكرة الأساس أنّ كتاب الإسلام المقدس وتجربة محمَّد النبوية ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحيث لا يمكن فهم أيّهما فهمًا كاملًا دون الآخر. ثمَّ يشير إلى ما استقرّ عليه الرأي من أنَّ الله في القرآن هو المتكلِّم دائمًا، وأن محمَّدًا هو المتلقّي، وأن جبريل هو وسيط الوحي، ويضيف: ولكنّ تحليل النصّ يبيّن أنّ الموقف أشدّ تعقيدًا من هذا. ويبدأ الكاتب في عرض نصوص من القرآن الكريم لبيان العلاقة التي تربط بين أطراف القضيَّة الثلاثة: المتكلِّم، والوسيط، والمتلقِّي؛ استنادًا إلى منهج «النقد الأعلى والأدنى» الذي يعمد إلى تحليل هذه النصوص وربط بعضها ببعضٍ ربطًا تاريخيًّا.
وتفصيل هذه المسألة في المبحث الآتي عن مصادر القرآن وموثوقيّته.
ويشير الكاتب في زعمه بإغواء الشيطان للنبيّ إلى قصَّة الغرانيق التي أقحمها بعض المفسّرين والمحدِّثين في مؤلَّفاتهم.
ولكن ليس من الموضوعيَّة أصلًا الاعتماد على فكرة أو حادثة بمجرد وجودها في
كتب التفسير أو الحديث فقط لأنَّها تتناسب مع معتقداتنا، بل لا بدّ من معرفة آراء علماء المسلمين في هذا المجال.
بالنسبة إلى حادثة الغرانيق المرويَّة في كتب العامَّة، فقد رفضها علماء العامَّة قبل الخاصَّة، وهناك شبه اتّفاق بين العلماء على رفض هذه الحادثة التي لا مجال لذكر تفاصيلها هنا، ولكن نشير إشارة إجماليَّة لهذا الموضوع:
ـ ملخّص الحادثة أنّ الرسول قرأ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنّ لترتجى، ففرح المشركون بأنّ النبيّ ذكر آلهتهم بخير، فنزل جبرائيل وطلب من النبيّ أن يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى، وأنَّ هذا الذي قاله من الشيطان، فقرأ كما هو مثبت في المصحف الشريف إلى آخر القصَّة المخترعة.
ـ أقوال بعض علماء العامة في هذه الحادثة: إنَّ علماء العامَّة أنكروا هذه الحادثة ونفوا حصولها؛ قال ابن حزم الأندلسيّ: «وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحت موضوع؛ لأنه لم يصحّ قط من طريق النقل، فلا معنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد». وقال أبو حيّان: «إنّ رواته مطعون عليهم، وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثيّة شيء ممّا ذكروه، فوجب إطراحه، ولذلك نزّهت كتابي عن ذكره فيه، والعجب من نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ، ثم إنَّ هذه القصة تناقض أصول الإسلام، وقواعد الدين، وصريح الآيات، وصحيح المرويا، وليس لها إسناد صحيح، ومتونها مضطربة متناقضة-حيث رُويت في سبعة عشر لفظًا ـ وألفاظها ينادي بعضها على بعض بالنكران».
احتوى الكلام في الفقرة الأخيرة من التعريف على جملة من الافتراءات والادعاءات غير الصحيحة وإن كانت كلها تصبّ في فكرة واحدة، وهي تحريف القرآن؛ فقد ادّعى أنّ القرآن:
1- يحتوي على عددٍ من الإضافات، وقد انتقلت إليه بعض الجمل والتحريفات غير الضارّة.
2- القرآن قد أعيدت صياغته، فانتهى إلى صورته الحاليّة.
3- فقد كمية كبيرة من الوحي المبكر.
كان للمستشرقين نشاط واضح في مجال صناعة المعاجم، فقد أسهموا في صناعة المعجم العربيّ وغيره من المعاجم، من قبيل: معاجم السنة النبويّة، ومعاجم القرآن الكريم. فصدرت مجموعة من هذه المعاجم مع اختلافٍ بينها في مناهجها وأغراضها وأسسها، ولم تكن كلّها في مستوى واحد من الجودة والإتقان، وما يهمّنا في هذه الدراسة هو الإطلالة المختصرة على المعاجم القرآنيّة، نذكر منها:
وضع المستشرق الألمانيّ «جوستاف فلوجل» (1802 - 1870م) فهرسًا أبجديًا لكلمات القرآن الكريم، مع ذكر رقم السورة ورقم الآية التي ترد فيها، وأسماه: «نجوم الفرقان في أطراف القرآن»، وطبع في ليبتسك عام 1842م، وأعيد طبعُه فيها عام 1898م، وهذا الكتاب هو الذي اعتمده محمّد فؤاد عبد الباقي وجعله أساس معجمه: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن»؛ كما أخبر هو بذلك في قوله: «وإذ كان خير ما أُلف وأكثره استيعابًا في هذا الفن -دون منازع ولا معارض- هو كتاب «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» لمؤلّفه المستشرق «فلوجل» الألمانيّ،
الذي طبع لأول مرة عام 1842م ميلادية، فقد اعتضدتُ به وجعلته أساسًا لمعجمي، ولـمَّا أجمعت العزم على ذلك راجعت معجم «فلوجل» مادَّة مادَّة على معاجم اللغة وتفاسير الأئمَّة اللغويين، وناقشت موادّه، حتى رجعت كل مادة إلى بابها...».
وبحسب المشهور والمتدوال بين الباحثين أوّل من قام بالعمل المُعجمي أو ما يسمّى التكشيف الموضوعيّ للقرآن هم المستشرقون، وعلى رأسهم فلوجل؛ ولذا يعتبر هذا المعجم هو أول عمل معجمي لألفاظ القرآن الكريم، وقد اختار فلوجل لمعجمه عنوانًا عربيًا، وهو ما تقدم، وهذا العمل هو الأساس الذي سارت عليه كل المعاجم في البلاد العربيّة والإسلاميّة، ولم يصل إلى درجته من الدقة والاستيعاب أيّ عمل مماثل».
ولكن الواقع خلاف ذلك فقد قام العالم التركي محمود الورداري، بكتابة كتابه «ترتيب زيبا»، وبذلك يكون قد سبق «فلوجل» إلى ذلك بما يقارب قرنين من الزمن.
ويقول بعض الباحثين في هذا المجال: «ولقد أحسّ بهذه الحاجة الملحّة بعض علماء الإسلام خصوصًا عندما قّل عدد حفَّاظ كتاب الله الكريم، وصعب معه تحديد أماكن آيات القرآن. ومع هذه الحاجة بدأت تظهر كشّافات آيات القرآن الكريم، وكان ذلك في منتصف القرن الحادي عشر الهجري على يد العالم التركي محمود الورداري (كان حيًّا حتّى عام 1054هـ) في كتابه المعروف «ترتيب زيبا». وهذا لا يعني أنَّه لم تكن هناك أدوات ترشد لبعض ألفاظ القرآن الكريم، فكتب غريب القرآن وكتب الوجوه والنظائر شواهد على ذلك، وهي إرهاصات لظهور كشَّافات القرآن الكريم فيما بعد. وبعد ترتيب «زيبا» بدأت تظهر كشّافات القرآن تباعًا، واختلفت المناهج وطرق الترتيب لهذه الكشّافات.
ووضع سعيد الأفغان -أيضًا- كشَّافًا يُعرف باسم «نجوم الفرقان» ويُعرف -أيضًا- بـ«كشاف كلكتا» سبق به فلوجل في كشّافه «نجوم الفرقان في أطرف القرآن». ويمكن القول: إنَّ كشاف «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» أوَّل كشَّاف لألفاظ القرآن الكريم وضعه مستشرق أوروبيّ، وليس أوّل كشاف ألفاظ للقرآن ظهر في هذا المضمار على الإطلاق».
وضعه بالفرنسيّة المستشرق «جول لابوم» ويليه المستدرك، وهو فهرس مواد القرآن الكريم، وضعه «إدوار مونتيه» تضمّن 158 بابًا آخر، ونقلهما إلى العربيّة الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي، رتب واضعه موضوعات القرآن الكريم في ثمانية عشر بابًا، ثم حاول توزيع آيات القرآن على هذه الأبواب، وجعل تحت كلّ باب فروعًا، بلغت هذه الفروع حوالي 350 فرعًا، ويذكر بجوار كل آية رقمها ورقم السورة في المصحف. ومع ذلك فقد غابت مقاصد كثيرة عن فهم هؤلاء الدارسين.
أمَّا الأبواب الرئيسة، فهي: 1- التاريخ، 2- محمَّد صلىاللهعليهوآله، 3- التبليغ، 4- بنو إسرائيل، 5- التوراة، 6- النصارى. 7- ما وراء الطبيعة، 8- التوحيد، 9- القرآن، 10- الدين، 11- العقائد، 12- العبادات، 13- الشريعة، 14- النظام الاجتماعي، 15- العلوم والفنون، 16- التجارة، 17- علم تهذيب الأخلاق، 18- النجاح.
طبعًا، لم يخلُ هذا الكتاب -مع أهمّيّته في مجاله- من بعض الأخطاء والعيوب، نذكر منها:
يقول عبد الله دراز وهو يتحدَّث عن عيوب أعمال المستشرقين: «وترجع عيوب المضمون إمَّا إلى ترجمات غير صحيحة، وإمَّا إلى تلخيص سيِّئ، وإمَّا إلى الأمرين معًا، وهو ما نجده واضحًا لدى المستشرق «جول لابوم» في كتابه «تحليل آيات القرآن»،
وهو مع ذلك أقلّ الأعمال التحليلية في هذا المجال بعدًا عن التمام».
ويمكن تقسيم الملاحظات على هذا العمل إلى قسمين:
نذكر في هذا المجال النقاط الآتية:
ـ وضع الآيات في غير موضعها الصحيح بسبب الفهم الخاطىء للمراد بها:
ندكر بعض الأمثلة على ذلك:
في الباب التاسع وتحت فرع القرآن، افتتحه بقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾؛ ظنًّا منه أنّ معنى «الكتاب» المراد في الآية هو «القرآن الكريم».
في الباب الحادي عشر فرع الأعراف، ذكر قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.
مع أنَّ الآية -كما هو واضح- لا علاقة لها بالأعراف بل جاءت في سياق الإنكار على اليهود والنصاري الذين إذا دُعوا إلى التحاكم إلى كتبهم، وما فيها من تصديق النبيّ تولوا وأعرضوا.
الإيهام بوضع آيات تحت عناوين تحمل معانٍ مغايرة:
من الأمثلة على ذلك:
تحت باب العبادات، فرع السبت، ذكر آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
وهذا فيه إيهام وخلط بين يومين: اليوم الخاصّ باليهود وهو السبت، واليوم الخاصّ بالمسلمين وهو الجمعة.
ـ أن يضع الآية تحت أحد الفروع حسب الأقوال التفسيريَّة الضعيفة لها:
في باب: علم تهذيب الأخلاق ذكر في اللواطة قوله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾.
ـ أن يذكر آيات معينة فيحصرها بنوع واحد:
في الباب الرابع عشر، النظام الاجتماعيّ، فرع الرجل، ذكر آيات عدّة هي عامة في الرجل والمرأة وليست محصورة في الرجل وحده كما هو واضح، منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾. وغير ذلك من الآيات التي ذكرها وهي عامّة، ولكن ذكرها في نوع واحد.
ـ أن يذكر آيات لا صلة لها بموضوعها:
فمثلًا في باب العبادات، فرع الصلاة، ذكر آيات بل وسور لا علاقة لها بالموضوع
أصلًا، فقد ذكر في ذلك آية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، والآيات التي اشتملت على الدعاء، وذكر سورة الفلق وسورة الناس بل ذكر سورة يس كاملة في هذا الفرع.
من الواضح أنّ المقصود الأساس من المعاجم والكشّافات هو دقة العبارة وصحّتها للدلالة على موضوعها؛ ولذا فحينما يكون الموضوع الذي تذكر تحته الفروع خطأً أوموهِمًا، فإن المعجم سيفتقد المهمّة الرئيسة التي وضع لأجلها.
ويمكن إجمال أخطاء المؤلِّف في هذا الباب من خلال النقاط الآتية:
ـ الخلط بين المصطلحات المتقاربة:
في الباب العاشر: الدين، فرع الإيمان، ذكر قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ومن الواضح الفرق بين مصطلحي الأمانة والإيمان.
التبويب على خلاف ما دلَّت عليه الآية:
في الباب الخامس: التوراة، فرع التثليث، أورد قوله تعالى: ﴿بِاللَّهِ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. والأولى أن يكون عنوان الفرع هو نفي التثليث.
ـ التبويب بعناوين مخالفة تمامًا لمضمون الآية:
في باب الدين، ذكر فرعًا بعنوان التعصُّب، وذكر فيه آية (وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلًا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ...٧٣) . وهناك ملاحظات كثيرة يمكن إيرادها على هذا المعجم.
ألَّف المستشرق إدوارد ماير (1857-1945م) كتابًا جمع فيه مفردات القرآن الكريم وأفعاله وحروف الجر والعطف وأسماه (دليل القرآن)، وقدَّم برجشتراسر دراسةً عن «حروف النفي في القرآن» (لايبتسيش 1911م) واهتمّ فيها بصفة خاصة بالقراءات؛ فقدَّم دراسة متنوعة في هذا المجال منها «معجم قرّاء القرآن وتراجمهم» (1912م).
عند مراجعة الأبحاث والدراسات التي كتبها المستشرقون عن ﻣﺼﺪر اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ نجد أنّ موقفهم متّفق في الأغلب على مسألة واحدة، وهي: نفي أي علاقة بين هذا الكتاب والسماء، أيْ التعامل مع القرآن على أنَّه نتاج بشريّ وليس كتابًا سماويًّا. تهدف هذه الدراسة في النتيجة إلى التشكيك بحجّيّة القرآن. والمستشرقون في هذا الاتجاه يسلكون مسارين متكاملين:
-إرجاع القرآن إلى مصادر شتى من خارج منظومة الوحي الإلهيّ.
-التشكيك في صحة النص القرآني وموثوقيته ورميه بالتحريف.
وعن هذا الموضوع أُلّفت العديد من الكتب والبحوث، منها:
1. «المدخل إلى القرآن»، لـ«بلاشير الفرنسيّ»، ونشر في باريس 1947م.
2. «المدخل إلى القرآن»، لـ«د. بل»، ونشر في إدنبرة عام 1954م.
3. «المصادر الأصلية للقرآن»، للمنصر البورتستانتي «سانت كلير تِسدَل».
4. «مصـادر القصص الأصلية في القرآن وقصص الأنبياء»، لـ«سـايدر سكاي»، باريس 1932م.
5. «مصادر تاريخ القرآن»، لـ«آرثر جفري».
6. «تاريخ القرآن»، لـ«بوتيه»، طبع في باريس 1904م.
7. «التطور التاريخي للقرآن»، لـ«إدوارد سيل»، مدراس الهند 1898م.
8. تاريخ النصّ القرآنيّ، لـ«إجناس جولدتسهر»، جوتنجن 1860م.
9. «تاريخ النصّ القرآنيّ»، لـ«تيودور نولدكه».
قبل عرض آراء المستشرقين في مصدر القرآن وتفنيدها، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ القرآن الكريم يقرّر حقّانيّة رسالة النبيّ صلىاللهعليهوآله، وأنّ أوَّل دلائل النبوة وأعظمها وأظهرها هو القرآن الكريم المنزل على قلب الرسول الأمين صلىاللهعليهوآله بلسان عربيّ مبين تحدّى الله به الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة من مثل سوره، فعجزوا وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ . فالله تعالى أنزل القرآن على النبيّ ليكون دالًّا على ﺻﺪق اﻟﺮﺳﻮل ﰲ دﻋﻮة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وبمقتضى هذا أنزله يحمل في أسلوبه ومعانيه، وﺗﺸﺮﻳﻌﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻋﺠﺎز، وﻗﺪ أﻣﺮ الله رﺳﻮﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﺪّى ﺑﻪ اﻟﻘﻮم، ﻓﺘﺤﺪَّاﻫﻢ وأﻇﻬﺮ ﻋﺠﺰﻫﻢ، فتمّت بذلك اﳊﺠّﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
إذا تأملنا في بعض آيات القرآن نجد أنّ هذه الدعوى كانت في عصر النبوة؛ فقد حكى القرآن عن موقف الكفار منه (أي من القرآن الكريم نفسه) بقوله: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، وبقولهم الذي حكاه -أيضًا- عنهم من أنّ هذا الكتاب
أعانه عليه الآخرون، وأنَّه أساطير الأولين: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾.
كما حكى القرآن موقفهم وتخبّطهم في هذا المجال، فتارة قالوا هو أضغاث أحلام وافتراه شاعر، وتارة شكَّكوا بأنّ من نُزِّل عليه القرآن ليس أهلًا لذلك، وتارة أقرّوا بصدق المنَزَّل وأهلية المنَزّل عليه؛ ولكنَّهم أنكروا كيفيّة إنزاله، وتارة طلبوا قرآنًا غير هذا القرآن، إلى غير ذلك من مواقفهم المختلفة والمضطربة والتي تدل على انعدام المنطق عندهم.
أمَّا موقف أهل الكتاب، فهو يختلف عن موقف الكفار؛ فهؤلاء -حسب ما يحكي القرآن عنهم- عرفوا الحق؛ ولكنهم أنكروه أو أخفوه كما قال -تعالى-: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.
من الواضح أنّ هؤلاء قد وجّهوا سهام نقدهم للقرآن؛ لأنَّه المعجزة الخالدة للدين الإسلاميّ، وبتضعيفهم لهذا الكتاب يكونون قد قضوا -حسب زعهمهم- على الدين الإسلاميّ؛ لذا ركّز المستشرقون جهودهم في بعض البحوث القرآنيّة، خاصة بحث «مصدر القرآن الكريم»؛ لأنَّه من خلال التشكيك بوحيانيّة القرآن والقول بأنَّه من صُنع البشر، يتوصَّل هؤلاء -حسب زعمهم- إلى إبطال أصل الدين الإسلاميّ.
تقدَّمت الإشارة في المبحث السابق (القرآن في دوائر المعارف والمعاجم الاستشراقية) إلى شبهة العلاقة بين القرآن ومحمد صلىاللهعليهوآله التي وردت في بعض فقرات دائرة المعارف الإسلاميّة، والهدف من هذا البحث عند المستشرقين -سواء في دائرة المعارف أم في غيرها- هو نفي الصبغة الإلهيّة عن القرآن الكريم، والتشكيك في كونه وحيًا إلهيًا.
يقول محرِّر مادة (القرآن) في دائرة المعارف الإسلاميّة: «ارﺗﺒﻂ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻨﺒﻮة محمد صلىاللهعليهوآله، بحيث لا يمكننا فهم أيٍّ منهما دون فهم الآخر. ونظرة المسلمين السنّة لا تعدو أن يكون الله هو المتحدِّث، وأنَّ محمدًا هو المتلقّي، وأنَّ جبريل هو الوسيط الموكل توصيل كلام الله إلى محمد.... ولكن تحليل النص القرآني يُظهر -لنا- أنّ المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك؛ إذ لا توجد إشارة قطّ إلى مصدر الوحي أو صيغة المتكلم في السور والآيات التي يظهر أنَّها أقدم ما نزل من القرآن الكريم؛ ففي بعض الآيات ليست هناك أدنى إشارة إلى أنّ هناك رسالة من الله -سبحانه وتعالى- وفي بعض الآيات الأخرى يبدو وكأنَّ محمدًا هو المتحدِّث، وﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺮة ﳒﺪ ما يشير إلى أنَّ جبرائيل هو الموكل إليه الوحي».
وكذلك ما ورد في الدائرة في مادة أصول: «وكان همّ المفسّرين المتأخّرين التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن، والتي تصور لنا تدرج محمد في نبوته، إمّا بما عمدوا إليه من التوفيق فيما بينهما، وإمَّا بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلها وذلك في الحالات التي يشتدّ فيها التناقض بين تلك الآيات».
وعند تحليل كلام الكاتب في مادة (القرآن) يتبين أنّ فيه مغالطات عدَّة:
ـ التشكيك في كلامه يبدأ من قوله: «ولكن تحليل النص القرآني...»، فهو يظهر أنّ القرآن الكريم نفسه لا يحسم فكرة مصدر الوحي.
ـ استند حسب زعمه إلى أنّ هناك مجموعة من الآيات في سور متعددة، وهي أقدم ما نزل من القرآن، لا تشير إلى مصدر الوحي، أيْ أنَّه من الله -تعالى- وهي على الشكل الآتي:
• مجموعة من الآيات لا تشير إلى أنّ هناك رسالة من الله تعالى
• هناك آيات تشير أنّ محمّدًا هو المتحدّث
• وآيات أنّ الموكل إليه الوحي هو جبريل.
قوله: «لا توجد إشارة قط إلى مصدر الوحي أو صيغة المتكلم في السور والآيات...».
• ترك الكاتب آيات في القرآن الكريم تصرّح بمصدر الوحي وبمنزّل القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾. والسورة الكريمة هي أقدم من السور التي ذكرها.
• ما استند إليه من أنّ بعض السور تفيد بأنّ المصدر تارة هو جبريل، وأخرى نفس النبيّ، هو غير صحيح؛ لأنَّ اﻟﻘﺮان ﻛﻠّﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ، وﻟﻘﺪ ﺻﺮﺣﺖ آﻳﺎت اﻟﻘﺮان ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﺑﺄنّ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻧﺬﻛﺮ من هذه الآيات الآتي:
﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴾ .
﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾.
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.
وهذه الآيات تكفي لإثبات أنّ القرآن كلّه من عند الله تعالى، أي المصدر، أمَّا أنّ الواسطة تارة هي جبريل، أو عبر الرؤيا بالمنام، أو عبر الوحي المباشر، فهذه كلها تفاصيل مرتبطة بكيفيّة الوحي وأساليبه، لا في تنوّع مصدر الوحي الذي هو الله تعالى.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الشبهة، أيْ نسبة القرآن إلى النبيّ من أقدم الشبهات التي أثارها العرب في عهد النبوة، كما أشار لذلك القرآن الكريم في قوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾أي إنّك متقوِّل على الله تعالى. وكما قال أيضًا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾، إلى غيرها من الآيات.
فما ذهب إليه بعض المستشرقين من أنّ مصدر القرآن الكريم هو محمّد صلىاللهعليهوآله ليس بجديد، وأنَّه قد ألّفه بلغته الخاصة، ولذلك كان يغيّر في القرآن ويبدّل فيه حسب هواه، وهذا يدلّ على أن «القرآن ليس من عند الله تعالى»، كما قال
المستشرق ه.ج ويلز: «محمد هو الذي صنع القرآن»، وكما قال يوليوس فلهاوزن: «القرآن من عند محمد ومن تأليفه».
وﻗﺎل اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻹنكليزيّ «جورج ﺳﻴﻞ»: «وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﺛﻨﺎن أنّ ﳏﻤّﺪًا هو في اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﻨﻒ اﻟﻘﺮآن وأوّل واﺿﻌﻴﻪ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺒﻌﺪ أن ﻏﲑﻩ أﻋﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ اتهمته العرب، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﺸﺪّة اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ زﻋﻤﻮا انهم ﻛﺎﻧﻮا يعينونه وَهَت حجّتهم، وﻋﺠﺰوا ﻋﻦ إﺛﺒﺎت دﻋﻮاﻫﻢ، ولعلّ ذلك لأنّ محمدًا كان أشدّ احتياطًا من أن يترك سبيلًا لكشف الأمر».
على كل حال «اﳌﺘﺘﺒّﻊ ﳌﻮﻗﻒ ﲨﻮع اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﳚﺪ أن ﳏﺼﻠّﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﰲ نهاية اﻷﻣﺮ ﲡﺰم ﺑﺄن اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻛﻼم ﳏﻤﺪ وأنه ﳝﺜّﻞ ﲦﺮة ﻣﻌﺎﻧﺎة ﳏﻤﺪ النفسيّة، وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻄﻮّر اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻪ».
الردّ على المصدر الأوّل:
• إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نفسه نجده ينفي وبشكل قاطع أن يتمكّن النبيّ صلىاللهعليهوآله من تغيير ولو حرفٍ واحد من القرآن، قال -تعالى-: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، وقال -تعالى-: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾.
• لو كان القرآن من عند النبيّ، كما زعم المجتمع الجاهلي قبل زعم هؤلاء،
لكان العرب استجابوا لدعوى التحدي، بل لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله، مع حرصهم الشديد على معارضته، ولما حار العرب بأمره وتخبّطت آراؤهم فيه، وذلك باعتبار أن القرآن من صُنع محمّد صلىاللهعليهوآله فمن الممكن الإتيان بمثله، ولكن القرآن تحدَّاهم بذلك، قال -تعالى-: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ .
• لو كان القرآن الكريم من كلام محمد للزم أن يكون النبيّ قارئًا وكاتبًا وعالمًا بتفاصيل المنهج القرآني في العقيدة، والأخلاق، والتشريع، و.. وأن يكون على معرفة دقيقة بأخبار السابقين وقصصهم؛ من أنبياء وغيرهم، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾.
• ما يكتبه البشر يحمل الطابع البشري وينعكس بشكل واضح على الأسلوب والمضمون، وهذا ما لا نجده لا في أسلوب القرآن ولا في مضمونه، فبالمقارنة بين القرآن والسنة النبوية يتضح الفرق بين الأسلوب الإلهي والأسلوب البشري، فلو كان القرآن من عند محمدصلىاللهعليهوآله كما زعموا لوجدنا تشابهًا بين القرآن وبين كلام محمد صلىاللهعليهوآله، وبما أنّه لا يوجد تشابه بينهما، فيثبت أنّ القرآن ليس من عند محمد صلىاللهعليهوآله بل هو من عند الله تعالى.
وتقرير الشبهة: أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله استقى معلوماته التي وضعها في القرآن من البيئة التي عاش فيها، وذلك بدليل التشابه. والمقصود من التشابه، هو التشابه المزعوم بين مقاطع من الشعر الجاهلي وبعض الآيات القرآنيّة، بالإضافة إلى
التشابه بين القوانين والتشريعات والطقوس القرآنيّة وما كان سائدًا في المجتمع الوثني العربي حيث زعموا أن محمدًا صلىاللهعليهوآله استقى هذه الأمور من وسطه الوثني ووضعها في القرآن.
ويذهب شاخت إلى أنّ الشريعة الإسلاميّة: تشتمل على عناصر من شرائع العرب في الجاهلية، وعناصر عديدة مأخوذة من شعوب البلاد التي فتحها المسلمون.
ويقول أيضًا: إنّ ما نسمّيه قانون العقوبات ينتمي إلى باب رد المظالم، وهو باب ليجمع بين القانون المدني وقانون العقوبات، وقد احتفظ به التشريع الإسلاميّ من القانون الذي كان سائدًا أيام الجاهلي.
يقول «فنسنك Wensinck» تحت مادة «أصل الحج في الإسلام»: «لم تكن نظرة النبيّ إلى الحج واحدة على الدوام، فلا بد أنّه اشترك كثيرًا في مناسكه وهو حدث، أمّا بعد دعوته فقد كانت عنايته قليلة أول الأمر بالحج. فلم يرد ذكر الحج في السور القديمة. ولا يبدو من المصادر الأخرى أن النبيّ اتّخذ خطّةّ محدّدة حيال هذه العادة وثنية الأصل».
الردّ على المصدر الثاني:
وللردّ على هذه الشبهة الأفضل أن نفصّل العناوين التي تعرضوا لها في هذا المجال:
إنّ الباحث عندما يقارن دعوى الإسلام التوحيدية مع ما كانت عليه شبه الجزيرة العربيّة آنذاك من شرك ووثنية، وبالإضافة إلى ما قام به النبيّ صلىاللهعليهوآله عندما أمر الإمام علي عليهالسلام بتحطيم الأصنام عند فتح مكة، وبالإضافة إلى الآيات الكثيرة في القرآن الداعية إلى التوحيد والنابذة للشرك وعبادة الأصنام، يقطع أنّ دعوى النبيّ للوحدانية لم يكن بتأثير الوسط الوثني كما زعم المستشرقون بل هي صدى للدعوة الأولى دعوة إبراهيم عليهالسلام، لأنّ أصلهما واحد. والتاريخ يشهد بذلك.
والقرآن الكريم -كما قلنا- مليء بالآيات القرآنيّة الداعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، منها: قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾.
وكذلك وضّح القرآن هذه القضية في دعوة إبراهيم عليهالسلام كما أنّه كان داعية إلى هذا التوحيد. قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .
ادّعى المستشرقون أنّ هناك تشابهًا بين الشعائر الإسلاميّة والوسط الجاهلي كالحج مثلًا، فالسعي، والطواف، وتقبيل الحجر الأسود، وغير ذلك هي عادات وطقوس جاهلية.
والصحيح أنّ الجزيرة العربيّة نبتت فيها دعوة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهالسلام ولكن العرب هم الذين غيروها بالشركيات والوثنيات ومع هذا فإنّه بقي في هذا الوسط الوثني شيء من تلك الديانة الحنيفية.
كما أن الشرائع الإلهية التي نزلت على إبراهيم وإسماعيل ومحمد ـ عليهم
السلام ـ أصلها واحد وهي منزلة من عند الله عزّ وجلّ؛ لأنّهم جميعًا رسله لأقوامهم فالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات ممّا شرعه الله عزّ وجلّ في كل الديانات؛ سواء ديانة إبراهيم أو ديانة محمد أو غيرهما من أنبياء الله عليهمالسلام.
فالمسلمون يقفون في حجهم على جبل عرفات، واليهود يقفون في حجهم على جبل سيناء، والنصارى يحجون إلى بيت المقدس في فلسطين، فهل يعني هذا أن الديانات الثلاث أخذت شعيرة الحج من الوسط الجاهلي الوثني! والمستشرقون يعرفون أن اليهودية والنصرانية سابقة للوثنية في الجزيرة العربيّة فلا يبقى إلا أن يكون المصدر لكل ذلك هو الله عزّ وجلّ.
وزعم بعض المستشرقين أمثال «تسدال» و«شيخو» و«شبرنجر» أن من مصادر القرآن الكريم: الشعر الجاهلي. فقد توافقت بعض الآيات القرآنيّة مع مقاطع من شعر أمية بن أبي الصلت وامرئ القيس؛ ما يدلّ في زعمهم على أنّ القرآن الكريم قد اقتبس من قصائد الشعراء الجاهليين؛ كالمعلقات.
فادّعوا أن هناك تشابه واضح بين شعر أمية بن أبي الصلت وبين آيات من سورة القمر وسورة الملك، وهناك تشابه أيضًا بين أبيات امرئ القيس مع سورة القمر.
وأبيات أمية المقصودة بالتوافق:
ويوم موعدهم أن يحشروا زمرًا يوم التغابن إذ لا ينفع الحذر
مستوسقين مع الداعي كأنّهم رجل الجراد زفته الريح منتشر
وأبرزوا بصعيد مستوجرز وأنزل والميزان والزبر
إلى آخر ما نُسب إليه من أبيات.
وأمّا أبيات امرئ القيس التي ذكرها «تسدال» متوافقة مع آيات من سورة القمر فمطلعها:
دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر
أحور قد حرت في أوصافه ناعس الطرف بعينه حور
ويمكن تسجيل ملاحظات عدّة على زعمهم؛ وهي:
1- قضية التلفيق في الشعر ونسبتها للقدماء من الشعراء أمر لا يستطيع أحد إنكاره وقد فعل هذا حمّاد الراوية وخلف الأحمر فما الذي يمنع أن يكون هذا الشعر ملفّقًا على العصر الجاهلي وعلى شعرائه؟!
2- أمية بن أبي الصلت توفي سنة 9 ه أي أنّه كان معاصرًا للنبي، واستمر في قرض الشعر طوال ما يقرب من ثماني سنوات بعد هجرة النبيّ ومن ثمّ يمكن القول إن أميّة أخذ من القرآن لا أنّ النبيّ اقتبس من أميّة، لذا يكون من التعسّف الادّعاء بأنّ هذا الشعر كان سابقًا للقرآن من الناحية التاريخية.
3- أمّا أبيات امرئ القيس فلم تثبت عند أحد من الناحية التاريخية إلا عند المستشرقين والأبيات المزعومة تتحدّث عن وصف الحبيبة الموعودة باللقاء وفيها يتغزّل الشاعر بمحبوبته فقصده من (الساعة) ساعة موعد اللقاء، ويقصد (بانشقاق القمر) ظهور وجه محبوبته من وسط سواد شعرها أو ظلام الليل. فلو سلّمنا صحّة نسبة هذه الأبيات إلى امرئ القيس فوجود هذه الألفاظ المستعملة في غير ما استعملت له في القرآن الكريم لا يقتضي الأخذ والاقتباس. فالقرآن الكريم قد نزل بلغات العرب وأساليبهم والقرآن عربي وأسلوبه عربي وقد استعملت هذه الألفاظ قبل نزول القرآن وبعده
ولم يدّع أحد من معاصريه أنّ القرآن مقتبس من شعر الشعراء أو خطب الخطباء أو كلام الكهّان مع معرفتهم بكل ذلك. ولو ثبت شيء من ذلك لرفعت قريش عقيرتها بإبطال دعوى محمد صلىاللهعليهوآله.
ذهب بعض المستشرقين ومنهم تسدال ومستر كانون (سل) وغيرهما إلى أن الحنفية ورجالها قبل البعثة المحمدية هم أحد مصادر القرآن بدليل وجود توافق وتشابه بين أحكام القرآن وهداياته وبين ما كان يدعو إليه الحنفاء؛ مثل:
1- الدعوة لإفراد الله بوحدانيته سبحانه وتعالى.
2- رفض عبادة الأصنام.
3- الوعد بالجنان.
4- الوعيد بالعقاب في جهنم.
5- اختصاص المولى بأسماء: الرحمن، الرب، الغفور.
6- منع وأد البنات، والإقرار بالبعث والنشور والحساب.
الردّ على المصدر الثالث:
ما المراد بالحنفاء؟
كلمة (حنيف) عربيّة الأصل وهي بمعنى الميل والحنف اعوجاج في الرجل إلى الداخل والحنيف: المائل إلى الدين المستقيم قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.
أﻣﺎ اﳊﻨﻔﺎء إذا ذﻛﺮوا ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻓﻬﻢ أﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺮّﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎﻟﻮا ﻋﻦ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ وﻋﺒﺎدة اﻷﺻﻨﺎم إﱃ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ولم يكونوا تحت شريعة واحدة ﺑﻞ ﻛﺎن ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﲟﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﱵ ﲪﻠﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ. وظهروا في الجزيرة العربيّة امتدادًا لدعوة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، فبقوا محافظين على شيء من تراث إبراهيم عليهالسلام من دعوة للوحدانية، ونبذ لعبادة الأصنام، والإقرار بالبعث والنشور، والحشر وتبشير المؤمنين بالجنة، وتخويف الكافرين من النار، والابتعاد عن الخمر، ووأد البنات، وسيّئ الأخلاق.
أما الرد فهو باختصار: أنّ الناظر بأدنى تأمل في القرآن الكريم وما أتى به هؤلاء الحنفاء يرى البون الشاسع بينهما، حيث يرى بساطة ما دعوا إليه، ويرى مقابله قرآنًا معجزًا في لغته وأسلوبه قد عجز العرب جميعًا عن مضاهاته مع فصاحتهم وطلاقة ألسنتهم. ثمّ إنّ هؤلاء الحنفاء كانوا هم أنفسهم يخبرون الناس بقرب بعثة الرسول صلىاللهعليهوآله.
يقول محمد رشيد رضا: ومن هنا يتبيّن الفرق بين نبوة كاملة تامة، وشرع متكامل، وقرآن معجز عظيم وبين بقايا دين طمس نوره بين حطام الجاهلية وأوحال الشرك والوثنية، فالقرآن بما حواه من لغة رفيعة المستوى، وأسلوب محكم بديع وبما فيه من فصاحة وبلاغة خارقة، وحكم بالغة، وأمثال محكمة، وذكر لأحوال الماضين من أنبياء وأمم وأنباء المستقبل، وعلاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بغيره، والتشريع العظيم الشأن الذي صار موضوع بحث الأئمّة المجتهدين، والعلماء الأعلام لا يكون مصدره اجتماع «زيد بن عمرو» برسول الله صلىاللهعليهوآله مصادفة في حراء أو في الطريق ولكنها الرسالة التي بعث بها أكرم رسول وهو محمد من عند الله عز وجل. فوافق نوره بقايا النور الإلهي الضارب في أعماق التاريخ لإبراهيم عليهالسلام.
اعتبر المستشرقون الصابئة مصدرًا من مصادر القرآن الكريم وذلك للتشابه بينهما وبين ما جاء في القرآن من عقائد وعبادات ونسك؛ منها:
1- التشابه بين الصابئة والإسلام في الصلاة.
2- التشابه في الصوم وارتقاب انتهائه وارتقاب الأعياد ببعض الكواكب.
3- التشابه في الحج والتلبية وتقديم القرابين.
ويمكن الرد على هذه الشبهة على الشكل الآتي:
1- الحقيقة أنّ الصابئة من أكثر الفرق صعوبة في الحكم عليها حيث إنها تلتقي مع كثير من الديانات السماوية وغير السماوية سواء في العقائد أو في العبادات أو غير ذلك من أجل هذا اختلفت أحكام الناس عليهم منذ القِدَم. فعندما نراجع آراء الباحثين عن الصابئة نجدها لا تتفق على تحديد هوية لهؤلاء فمن قائل: إنهم قوم لا دين لهم، ومن قائل: هم أهل دين من الأديان كانوا في جزيرة العرب، ومن قائل: هم عبدة الملائكة، ومن قائل: هم فرقة من أهم الكتاب، ومن قائل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى؛ لكنّ قبلتهم نحو الجنوب، ومن قال: إنّهم وثنيون فذلك لعبادتهم الأصنام والكواكب والملائكة وتقديمهم القرابين لها، ومن قال: هم من اليهود فذلك لموافقتهم اليهود في طريقة الذبح وحرق القرابين، ومن قال: هم فرقة من النصارى... إلى غير ذلك من الأقوال. فأي صابئة نقصد؟ حتى نزعم أنّ تعاليمها تشبه تعاليم الإسلام والقرآن.
2- عند دراسة التشابه المدّعى بين طقوس الصابئة وبين العبادات والشعائر الإسلاميّة نجد اختلافًا واضحًا في هذا المجال ومجرد التشابه في بعض الصلوات
لا يعني أنّ القرآن أحد مصادره الصابئة. فقد ذكر أن صلواتهم سبعة وبعض الباحثين قالوا ثلاثة، وكيفية صلاتهم تختلف عن صلاة المسلمين.
3- أمّا صومهم فهو لا يشبه صوم المسلمين فالصوم من العبادات التي عرفتها الصابئّة الحرانيون وهي عندهم ثلاثين ليلة من الليل إلى شروق الشمس، أما الصابئة المندائيّون الحاليّون يحرمّون الصيام في طقوسهم الدينية. وهم يمتنعون عن أكل اللحوم المباحة لهم (٣٦) يومًا، متفرقة على طول السنة، على نحو امتناع النصارى عنها.
4- أعيادهم تكون بمراقبة خمسة نجوم في السماء وهي: (الجدي، الزهرة، زحل، القمر، والشمس). بينما الأعياد الإسلاميّة تثبت بمراقبة القمر فقط.
على كل حال هناك أقوال متعددة في طبيعة الصابئة وهناك اختلافات واضحة وجلية بين طقوس الصابئة وطقوس المسلمين فلا يصح على الإطلاق اعتبار الصابئة أحد مصادر القرآن الكريم؛ لأنّ هناك فرقًا كبيرًا بين الإسلام وبين الصابئة في الاعتقادات والعبادات والأحكام والسلوك.
قالوا إنّ خمسة وسبعين في المائة من آيات القرآن مقتبسة من الكتاب المقدس للنصارى (العهد الجديد) وفي هذا يقول القسّ أنيس شروش: «إنّ هناك نصوصًا عديدة من مقاطع العهد الجديد قد استعارها القرآن واقتبسها من الكتاب المقدس؛ فهناك مثلًا حوالي (130م)قطعًا في القرآن مستوحاة من سفر المزامير».
واستدلوا أيضًا بأنّ الرسول كان قد استعان ببحيرا الراهب، ونسطور في كتابة بعض آيات القرآن!!
وزعم تسدال أنّ النصرانية كانت أحد المصادر التي أخذ منها محمد وأدخلها في قرآنه، واستشهد تسدال على ذلك ببعض القصص وبعض القضايا الأخرى؛ منها:
1- قصة أصحاب الكهف.
2- قصة مريم عليها السلام.
3- قصة طفولة المسيح.
• ما معنى الاقتباس:
الفكرة التي يروّجها هؤلاء هي أنّ القرآن اقتبس معلوماته ومعارفه أو نسخهما عن اليهود والنصارى، أي عن الكتاب المقدّس؛ لأنّه هو مصدر الديانة اليهوديّة والنصرانيّة.
وحقيقة (الاقتباس) التامّ هي: نقل فكرة ما، إمّا نقلًا كليًا أو نقلًا جزئيًا، بحيث لا يزيد الناقل المقتبس شيئًا؛ أمّا إذا زاد الناقل وأضاف وعدّل بعض الأفكار وصحّحها، فإنّ هذا لا يسمّى اقتباسًا.
• مجرّد الاتفاق لا يؤدّي إلى الاقتباس:
من حقّنا أن نسأل: هل يعتبر مجرّد الاتفاق على وقوع قصة ما، كقصّة النبيّ آدم والسيدة حواء، أو قصة النبيّ موسى أو أي قصة أخرى، ونقل أحداثها ومجرياتها، اقتباسًا ونقلًا؟ وهذا لا يمنع من التشابه بين بعض نصوص الإنجيل أو التوراة والقرآن الكريم.
ويمكن ادّعاء ذلك لو فرضنا أنّ القرآن الكريم لم يأتِ بجديد؛ وكان بعض ما فيه أو أكثره نسخة عن الكتاب المقدس، ولكن من الواضح أنّ القرآن قد أضاف وعدَّل وصحَّح كثيرًا من الأحكام والوقائع، فكيف يصحّ والحال كذلك أن يسمى هذا اقتباسًا؟ ولبيان ذلك نعرض أنموذجًا ممّا ذكر في الإنجيل والقرآن؛ وهو
بشارة زكريا بـيحيى عليهما السلام ليتبيّن معنا مدى الاختلاف بينهما، وهناك عشرات النماذج تشبه هذا الأنموذج لا يسع المقام لذكرها.
في النصّ الإنجيلي وردت البشارة على الشكل الآتي:
«لم يكن لهما يعنى زكريا وامرأته ولد. إذ كانت اليصابات يعني امرأة زكريا عاقرًا. وكان كلاهما متقدمين في أيامهما، فبينما هو يكهن في نوبة غرفته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلّي خارجًا وقت البخور. فظهر له ملاك الرب واقفًا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا؛ لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ولدًا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج. وكثيرون سيفخرون بولادته؛ لأنّه يكون عظيمًا أمام الرب. وخمرًا ومسكرًا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ بروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء. والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيء للرب شعبًا مستعدًا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا وأنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها؟! فأجاب الملاك وقال: أنا جبرائيل الواقف قدام الله. وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامتًا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا؛ لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل. فكان يومئ إليهم، وبقي صامتًا...».
أمّا بشارة زكريا بيحيى بحسب النصّ القرآن؛ فهي:
قال تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ .
وقال تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ .
إنّ المقارنة بين نصّ الإنجيل لهذه الواقعة وبين النصّ القرآنيّ، تظهر الفوارق الآتية:
1- في سورة «آل عمران» تقدم على قصة بشارة زكريا بيحيى، قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها خالصًا لله، في حين أنّه لم يرد ذكر لهذا في النصّ الإنجيلي.
2- النص القرآني أخبر أن امرأة عمران ولدت أنثى؛ وكانت ترجو أن يكون المولود ذكرًا، وهذا أيضًا لم يأتِ له ذكر في النص الإنجيلي.
3- ذَكَر النص القرآنيّ كفالة زكريا للمولودة «مريم» وأخبر عن وجود رزقها عندها، وبيَّن أن مصدر هذا الرزق هو الله. وهذا بدوره لم يرد ذكره في النص الإنجيلي.
4- ربط النص القرآني بين قصة الدعاء بمولود لزكريا، وبين قصة مولودة امرأة عمران. وهذا لا وجود له في النص الإنجيلي.
5- ذَكَر النص القرآني دعاء زكريا، في حين أنّنا لا نجد ذكرًا لذلك في النص الإنجيلي.
6- تناول النصّ القرآني ما رتّبه زكريا على هبة الله له وليًا، وهو أن يرثه ويرث من آل يعقوب. بينما لم يرد ذكر لهذا في النص الإنجيلي.
7- بيَّن النصّ القرآنيّ أن السبب الذي حمل زكريا على دعاء ربه، هو خوفه الموالي من ورائه. والنص الإنجيلي خالٍ من هذا تمامًا.
8- صرَّح النص القرآني بأنّ زكريا أوحى لقومه، بأنْ يسبحوًا بكرة وعشيًا. ولا وجود لهذا في النص الإنجيلي.
9- ذَكَر النص القرآني الثناء على المولود «يحيى» وبيَّن أنّه بارّ بوالديه، يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه حيًا. ولا مقابل لهذا الثناء في النص الإنجيلي.
وأيضًا القرآن قام بمهمّة تصحيح الأخطاء التي وردت في النص الإنجيلي، وبيان هذا وِفْقَ الآتي:
ـ أنّ النص الإنجيلي جعل الصمت الذي قام به زكريا عقوبة له من الملاك. بينما الصمت -بحسب النص القرآنيّ- كان تكريمًا لزكريا من الله، وهذا ممّا يتناسب مع خصائص الأنبياء والرسل.
ـ النص الإنجيلي يحدّد مدّة الصمت بخروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن ولد يحيى. في حين أنّ النص القرآن يصحح هذا الخطأ، ويذكر أن مدته كانت ثلاثة أيام بلياليهن، بعد الخروج من المحراب.
ـ النص الإنجيلي يجعل البشارة على لسان ملاك واحد، بينما النص القرآن يجعل البشارة على لسان جمع من الملائكة.
ـ النص الإنجيلي جعل التسمية بـ«يحيى» -«يوحنا» بحسب النص الإنجيلي-
من اختيار زكريا، غير أنّ الملاك قد تنبأ بها. في حين أنّ النص القرآنيّ صحح هذا الخطأ، وبيَّن أن التسمية كانت من وحي الله إلى زكريا.
وعلى ضوء هذه المقارنة، يتضح لنا، أنّ القرآن قد أدى في تعقّبه للنص الإنجيلي، مهمتين أساسيّتين؛ هما:
الأولى: تصوير الواقعة تصويرًا أدقّ تفصيلًا، وأجدر تصديقًا.
الثانية: تصحيح الأخطاء الواردة في النص الإنجيلي المقارن.
لقد أوضحت هذه المقارنة أنّ القرآن لم يقتبس جزءًا من الواقعة، فضلًا عن أن يقتبس الواقعة كلها؛ وإنّما صور الواقعة تصويرًا دقيقًا، فسجل كل حقائقها، وبيَّن كل دقائقها. وعرضها عرضًا جديدًا، وربط بينها وبين وقائع محددة، كانت كالسبب الموحد لها، والناظم لعقدها.
زعم تسدال، وأندريه، ولامنز، وجولدتسيهر، وغيرهم أنّ اليهودية مصدر من مصادر الإسلام والقرآن واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- تشابه القرآن واليهودية في القصص؛ مثل قصة ابني آدم وقصة إبراهيم.
2- التشابه في بعض القضايا العقدية والتشريعية والحث على مكارم الأخلاق.
ولعل من أبرز الكتب -كما تقدم- التي أكدت هذه الفكرة هو كتاب «أبراهام جايجر»، بعنوان: «ماذا أخذ القرآن عن اليهودية»؟ ومن الاستشراق المعاصر (مصادر يهودية في القرآن) لمؤلِّفه شالوم زاوي الذي يعد من مؤلفات الاستشراق الإسرائيلي المهمّة في هذا المجال.
وبالطريقة نفسها التي حاول بها بعض المستشرقين إثبات أنّ بعض المعارف القرآنيّة ترجع إلى أصول نصرانية وأنّ محمدًا اقتبس نصوص القرآن الكريم من الإنجيل، نجدهم يحاولون إثبات أنّ بعض المعارف القرآنيّة ترجع إلى أصول يهودية
أي إلى التوراة. ولعل منهجية الإجابة على هذه الشبهة هي منهجيّة الشبهة السابقة نفسها؛ أي من خلال المقارنة بين نصوص التوراة ونصوص القرآن الكريم.
فعلى سبيل المثال، إنّ فرضيات كتاب (مصادر يهودية في القرآن) انحصرت في ردّه القرآن لمصادر يهودية، وذلك على مستويين أساسيين، وهما: 1- قصص القرآن. 2- لغة القرآن. وقد تعرضنا لهذا الموضوع في الأبحاث السابقة.
من لوازم تشكيك المستشرقين في المصدر الإلهي، الطعن في موثوقية النص القرآني ورمي القرآن بأنّه نص محرف نقيصة أو زيادة على الرغم من الاتّفاق بين الشيعة والسنّة على أنّ القرآن الكريم المُنزَل على الرسول الخاتم صلىاللهعليهوآله قد وَصل إلينا دون أيِّ نقصٍ أو تحريف.
وقد حَشد الأعلام عدَدًا من الأدلَّة التي تدلّ على عدم وقوع التحريف، كآية الحفظ وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾وآية نفي الباطل وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ ورواية الثقلين وهي قوله صلىاللهعليهوآله: «...إني تَارِك فِيكمْ أَمْرَينِ أن أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا- كتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأَهْلَ بَيتِي عِتْرَتِي أَيهَا النَاسُ اسْمَعُوا وقَدْ بَلَّغْتُ انكمْ سَتَرِدُونَ عَلَيّ الْحَوْضَ فَأَسْأَلُكمْ عَمَا فَعَلْتُمْ فِي الثَّقَلَينِ، وَالثَّقَلان كتَابُ اللَّهِ جَلَّ ذِكرُهُ وَأَهْلُ بَيتِي... «، وما دلَّ على جواز قراءة أيّ سورةٍ في الصلاة، وأخبار عرض الروايات على القرآن كقوله: «كلُّ حديثٍ لا يُوافق كتاب الله فهو زخرف»، وحجيَّة ظواهر القرآن وغير ذلك.
وقد أثار هذه الشبهة أي (موثوقية النص القرآني) أصحاب دائرة المعارف الإسلاميّة؛ كما مرّ بنا في التعريف بالموسوعة في المبحث السابق، و«تيودور نولدكه».
ويعتبر نولدكه من أوائل الذين فتحوا باب التشكيك في موثقية النص القرآني، ففي كتابه تاريخ القرآن يعقد فصلًا بعنوان: (الوحي الذي نزل على محمد ولم يحفظ في القرآن) والذي يبدو فيه قائلًا بالتحريف تلميحًا، ونجد تصريحًا بذلك في مادة قرآن في دائرة المعارف الإسلاميّة: «إنّه ممّا لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن ضاعت... وأن القرآن غير كامل الأجزاء». كما حاول «اجنتس جولدتسيهر» و«ريجي بلاشير» و«ريتشارد بل» أن يشككوا في صحة القرآن من خلال نسبة التحريف إليه كما فعل «ريتشارد بل» حيث قال: «لو أنّ شخصًا سأل ما الضّمان القائم على أنّ القرآن الذي تمّ جمعه في عهد عثمان تسجيل صحيح للتنزيلات كما تمّ تلقّيها وإعلانها بواسطة محمد..». وبعضهم صرّح بذلك كـ«جولدتسيهر» في مقدّمة كتابه مذاهب التفسير الإسلاميّ حيث قال: «فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافًا عقديًا على أنّه نص منزل أو موحى به، يقدّم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثباتّ، كما نجد في نص القرآن».
وقد ردّ هّؤلاء أسباب هذا الاختلاف والاضطراب لأمور عدّة؛ منها:
1- الاعتماد في حفظ القرآن على صدور الصحابة.
2- الكتابة بوسائل بدائية يصعب المحافظة عليها.
3- نسيان شيء من القرآن استنادًا للنصوص العامّة من القرآن والسنّة التي ذكرت هذا الأمر.
4- وجود منسوخ التلاوة.
5- اختلاف مصاحف الصحابة في عدد السوّر والآيات ووجوه القراءات والاختلاف في الرسّم.
6- النقصان والزيادة في القرآن الكريم للمصلحة.
ومن جملة الموارد التي وقعت تحت أيدي هؤلاء المستشرقين واستندوا إليها للدلالة على وقوع تحريف في القرآن الكريم هو حذف سورتي الخلع والحفد، وآيات الرجم، وبعض الآيات من سورة الأحزاب، وسورة النور، وضياع جملة من الآيات القرآنيّة في معركة اليمامة وغير ذلك. وسنكتفي بمعالجة بعض هذه الشبهات.
ولكنّ السؤال المهم هو: أنّه مع وجود هذا الإجماع بين المسلمين؛ ما هي أسباب ومناشئ القول بتحريف القرآن الكريم عند المستشرقين؟
حين يتكلّم المستشرقون عن تاريخ القرآن يقصدون بذلك إظهار أنّ القرآن مثل كتب أهل الكتاب له تاريخ من التغيير والتبديل، وأنّ يد التحريف والتبديل دخلت إليه، حتى أن هناك بونًا بين ما ينسب إلى الكتاب وما بين أيدينا من نسخته.
ولعلَّ من مناشئ القول بتحريف القرآن اعتقاد علماء سائر الأديان بتحريف الكتب المقدّسة لسائر الأديان، فقد قامت عقيدتهم على أنّ الأناجيل الأربعة دوِّنَت من قِبل الحواريّين الأربعة، فبَعد الذي جرى على المسيح من أحداث، قام هؤلاء بتدوين رحلات المسيح وحياته ونصائحه. إلى حدّ أننا نجد بين الأناجيل الأربعة تناقضًا وتهافتًا.
كما نَجد ذلك أيضًا في الدِّيانة اليهوديّة، فليس لدى اليهود كتابًا خاصًا معروفًا بأنّه الكتاب المُنزَل على موسى، بل ما لديهم اليوم هو ما قام بعضٌ بتدوينه طبقًا لميوله الخاصّة في وصف الظروف المحيطة.
تقدّم في الفصل الأوّل من الكتاب بيان أهداف الحركة الاستشراقيّة ودوافعها ولعل أبرزها شيوعًا الأهداف التبشيرية والأهداف السياسية.
فبعض المستشرقين كان دافعه لدراسة الشرق أن يَدفع المسلمين إلى إساءة الظنِّ بدينهم وبعقيدتهم. فقد سعى هؤلاء ومن خلال اختلاق بعض الشُّبهات حول الإسلام والقرآن، لإضعاف إيمان المسلمين بدينهم بهدف توفير الظروف الملائمة للقبول بالدِّيانة المسيحيّة دينًا بديلًا عن الإسلام.
وتقدم أيضًا أنّ خوف الاستعمار والدول الغربيّة من قوة المسلمين جعلتهم يشنون حروبًا طابعها ثقافي وعلمي حسب الظاهر، وهدفها الواقعي ضرب القوة الإسلاميّة وأفضل طريقة لذلك هي تضعيف المصادر الإسلاميّة وعلى رأسها القرآن الكريم، وأفضل طريقة لتضعيف القرآن هي القول بتحريفه.
ولذا سعَت الدول المستعمِرة والقوى العالميّة الكبرى، حيث رأت في التعاليم القرآنيّة سدًا منيعًا أمام وصولها إلى أهدافها ومصالحها، إلى تربية فكرة تحريف القرآن في أذهان المسلمين، وبهذا انصبَّ جهدهم على هدم أساس الإسلام المتمثِّل بالقرآن الكريم.
المنشأ الثالث للقول بتحريف القرآن وجود بعض الروايات التي تدلّ على تحريف القرآن، وقد نُقلت هذه الروايات في كتب الفريقين، ولكن لم يقبلها أكابر علماء السنة والشيعة.
يقسّم الإمام الخميني روايات جمع القرآن إلى طوائف ثلاث:
-الروايات الضعيفة التي لا يُمكن الاستدلال بها.
(320)- الروايات الموضوعة التي قامت القرائن والشواهد على الوضع فيها.
- الروايات الصحيحة التي نصل من خلال التأمّل فيها إلى أن المقصود من التحريف فيها هو التحريف في معاني الآيات لا التغيير في ألفاظها.
ولكن على الرغم من الإجماع بين علماء المسلمين على عدم تحريف القرآن ورفضهم للروايات الموجودة في كتب الأحاديث أو حملها على التحريف المعنوي وغير ذلك من ردود تفصيلية ومطولة في كتبهم المختلفة، نجد بعض المستشرقين؛ أمثال (جولدتسيهر) يعتمدون على الروايات الضعيفة والموضوعة ويرون أنّ الشيعة يَعتقدون بأنّ في المصحف العثماني زيادات وإضافات وتغييرات على أصل القرآن المنزل على النبيّ صلىاللهعليهوآله. ويذكرون بأنّ لدى الشيعة من الروايات ما يدلّ على أنّ القرآن المنزَل على الرسول الأكرم عليهالسلام أطول وأكثر تفصيلًا من القرآن الحاليّ، كسورة الأحزاب والتي تحوي الآن ثلاث وسبعون آية، ولكنَّها على أساس النصِّ السابق تُعادل سورة البقرة، وكسورة النور التي تحتوي في النصِّ الحاليّ على أربع وستون آية، ولكنَّها كانت سابقًا تزيد على مائة آية، وكسورة الحجر التي تحتوي على تسعٍ وتسعونَ آية، ولكنَّها كانت سابقًا تزيد على مائة وتسعين آية!.
يمكن تقسيم شبهات المستشرقين في ادّعاءهم تحريف القرآن الكريم إلى أقسام عدّة، على الشكل الآتي:
ويقصدون من الزيادة في القرآن أنّ بعض القرآن؛ كبعض السور أو بعض الآيات
ليست من القرآن بل هي من الزيادات التي زادها بعض الصحابة أو غيرهم على القرآن الكريم. ومن الأمور التي تمسّكوا بها نذكر الآتي:
1- قالوا: إنّ القرآن الكريم قد زيد فيه ما ليس منه بدليل ما ورد أن عبد الله ابن مسعود كان لا يكتب الفاتحة والمعوذتين في مصحفه. يقول: (مونتغمري وات) أن (عبد الله بن مسعود) لم يدوّن المعوذتين في مصحفه، وكان يرى أنّهما ليستا من القرآن.
2- وينقل (روجيه بلاشير) أن من بين متكلمي المعتزلة من استنكف ونظرًا لإيمانه بمفهوم الإله الواحد العادل والرحيم، عن قبول بعض اللعن والتجريح الموجود في القرآن بالنسبة لبعض الأعداء الشخصيّين للنبيّ صلىاللهعليهوآله، وذلك لأنّهم كانوا يرون ذلك منافيًا لعظمة الوحي. وبعض الخوارج وهم أتباع عبد الكريم بن عجرد ينكرون كون سورة يوسف من القرآن لأنّه لا يُمكن القول بصحّة وجود قصّة عشقٍ كجزءٍ من القرآن. ويستنتج (بلاشيرم)ن ذلك أن القرآن الكريم قد تعرض لإضافات محض بشرية في هذا المجال.
3- وذهب بعض المستشرقين أمثال (كازانوفا) إلى أن الآية 144 من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ هي من كلام أبي بكر، وأن الآية 125 من سورة البقرة، ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ هي من كلام عمر بن الخطاب.
فهذه النماذج وغيرها تدل على وجود الزيادة في القرآن الكريم.
أ. في إبطال أصل فكرة الزيادة في القرآن: يقول السيد الخوئي: «التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل. والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة».
قال النووي: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأنّ من جحد شيئًا منه كفر. وما نُقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيحٍ عنه».
ب. في ما يتعلق بخلوّ مصحف ابن مسعود من الفاتحة أو المعوذتين يقول ابن قتيبة:» وأمّا إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لجهله بأنّها من القرآن، كيف وهو أشدّ الصحابة عناية بالقرآن، ولم يزل يسمع رسول الله صلىاللهعليهوآله يؤمّ بها، ويقول: لا صلاة إلاّ بسورة الحمد، وهي السبع المثاني وأم الكتاب. لكنّه ذهب في ما يظنّ أهل النظر (المحقّقون) إلى أنّ القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين (الدفّتينم)خافة الشكّ والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون على سورة الحمد، فلمّا أمن عليها العلّة التي من أجلها كتب المصحف، ترك كتابتها، وهو يعلم أنّها من القرآن». فإسقاطه سورة الفاتحة، لا اعتقادًا أنّها ليست من القرآن، بل لأنّ الثبت في المصحف كان قيدًا للسور دون الضياع.
ونُقل في الروايات أن ابن مسعود كان يحكّ المعوذتين من المصاحف، ويقول: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنّهما ليستا من كتاب الله، إنما أمر النبيّ ويقول: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنّهما ليستا من كتاب الله، إنّما أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يتعوّذ بهما.. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما في صلاته.
هذا.. وقد أنكر بعضهم صحّة هذه النسبة إلى ابن مسعود، كالرازي وابن حزم- في ما نقل عنهما ابن حجر- وردّ عليهما بصحّة إسناد الرواية قال: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل. بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل.
ج. في ما يتعلق من دعوى أنّ في القرآن الكريم آيات هي من أقوال الصحابة؛ كما تقدم:
• هذه الدعوى لا يقبلها العلماء من الطرفين وحملوا بعض الإضافات التي نقلت عن الصحابي ابن مسعود على أنها إضافات تفسيرية وهو منهج ابن مسعود في تعليم القرآن؛ فقد كان من عادة بعض الصحابة – لا سيما عبد الله بن مسعود – أنّهم يكتبون في مصاحفهم تفسيرًا لبعض الآيات، ولا يميزونها عن الآيات، اعتمادًا منهم على أنّ لفظ الآية معروف ومحفوظ. ونجد أيضًا في روايات أهل البيت عليهمالسلام بعض الإضافات التي حُملت على التفسير أيضًا أو أنّها من باب بيان المصداق الأبرز للآية، لا أن الآية نزلت باللفظ الفلاني المخالف للنص المتواتر الموجود بين أيدي المسلمين. فقد جاء في تفسير القمي بسند صحيح: «أنّ ابن سنان قرأ على الإمام الصادق عليهالسلام: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾. فقال عليهالسلام: خير أمة، تقتلون أمير المؤمنين، والحسن، والحسين بن علي عليهم السلام؟! فقال القاري: جعلت فداك، كيف نزلت؟ قال: نزلت: كنتم خير أئمة أخرجت للناس، ألا ترى مدح الله لهم: ﴿...تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ...﴾.
والمراد بنزولها كذلك: أنّ هذا التفسير لكلمة: «الأمّة»، بكلمة «الأئمة»، قد نزل من عند الله سبحانه. حتى ليصح أن نضع هذه بدل تلك، على سبيل التفسير، لا لتصبح هذه هي القرآن المنزَل!... أو فقل: إنّ كلمة «الأمّة» هكذا نزلت، مرادًا بها هذا المعنى، وهو «الأئمة»، دون سواه....
• أما في ما يتعلق بشبهة تأليف آية من كلام أبي بكر فقد زعموا أن قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ... ﴾ هي من كلام أبي بكر ردّ بها على عمر عندما أنكر وفاة الرسول صلىاللهعليهوآله.
إنّ مجرد تلاوة أبي بكر لهذه الآية في رده على عمر، وتهدئة الناس لا يعني مطلقًا، أنها من كلام أبي بكر وقد تفوه بها، أو قالها، وذلك من جهتين:
الأولى: أن جميع الصحابة، ومنهم أبو بكر يحفظونها، ويعلمون أنّها من القرآن، وأنها كلام الله تعالى، وترتيبها في سورة آل عمران، ونزلت قبل وفاة الرسول صلىاللهعليهوآله ببضع سنين.
الثانية: أنّ الكثير الكثير من الصحابة يعلمون سبب نزولها، ومكان، وتاريخ نزولها. وقد ورد في الروايات أن الآية: قد نزلت في غزوة أحد، عتابًا من الله تعالى على الصحابة، لفرارهم من القتال. حيث إنّه عندما أصيب المسلمون في غزوة أُحُد، وكسرت رباعية الرسول صلىاللهعليهوآله وشجّ وجهه، وشاع بين المقاتلين أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد قُتل.
أمّا بالنسبة للآية المنسوبة إلى عمر فقد حملها علماء العامة على أنّها من باب الاقتراح على رسول الله حيث قال عمر للنبي صلىاللهعليهوآله: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تعالى: ﴿وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فالآية وافقت اقتراح عمر لا أنّ الآية من كلامه وقد
ورد في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، في النوع العاشر: في ما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة. قال السيوطي فيه: «هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل في موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة». وممن أفردوا لذلك السيوطي نفسه في كتابه «قطف الثمر في موافقات عمر» وذكر الفرق بين سبب النزول والموافقة أنّ الموافقة ما نزل من القرآن لقول الصحابي بينما سبب النزول بيان لما قال أو فعل أو سأل الصحابي.
ذهب بعض المستشرقين واستنادًا منهم إلى بعض الشواهد التاريخيّة واعتمادًا على بعض الروايات الضعيفة والموضوعة إلى القول بوجود نقصٍ في القرآن الحالي. وقد تمسَّكوا لإثبات هذا النوع من التحريف بمجموعة من الشُبهات نذكر منها:
زعموا أنّ القرآن نقص منه بعض السور مستدلين على ذلك بكتابة بعض الصحابة كأبي بن كعب بعض السور ولم تكتب في القرآن الحالي ويقصدون بذلك سورتي الخلع والحفد.
وهذا نص سورة الخلع المزعومة: «اَللّهُمّ انا نَسْتَعِيْنُك وَنَسْتَغْفِرُكَ ونُثْني عَلَيْكَ اَلْخَيْرَ ولا نَكْفُرُك ونَخْلَعُ ونـَــتـْرُكُ مَنْ يَفْجُرُك».
وهذا نص سورة الحفد المزعومة: «اَللّهُمّ إيًاكَ نَعْبُدُ ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكْ ونَخْشَى عَذَابَكَ اَلْجَد أن عَذَاْبَكَ بِالكُفًارِ مُلْحِقٌ».
لم يقبل علماء العامة هذه الدعوى واعتبر بعضهم أن ما نُسب إلى بعض الصحابة لم يُنسب بعنوان أنهما من القرآن، بل قد يكونا من القنوت في الصلاة، وعلماء الإمامية أيضًا رفضوا ذلك أيضًا فكون سورتي الخلع والحفد من القرآن أمر مرفوض بالإجماع.
ومن أسباب ذلك الرفض:
1- عدم ملائمة مضمون هاتين السورتين وانسجامه مع ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، فالركاكة واضحة عليهما ولا يصح نسبتهما إلى أدباء العرب وشعرائهم، فكيف بالقرآن الكريم المعجز في بلاغته وفصاحته.
2- إنّ في بعض الروايات التي روت هاتين السورتين المزعومتين، قد يفهم منها أنهما من أدعية الصلاة؛ أي من القنوت.
ومن أسباب عد ملائمة السورتين المزعومتين لأسلوب القرآن الكريم نذكر الآتي:
ـ الملاحظات المتعلقة بكلمة «اللهم» التي أفتتحت بها سورتي «الحفد والخلع»:
• وردت كلمة «اللهم» في القرآن خمس مرات لم تأتِ أي منها في بداية أيّ سورة بتاتًا.
• لا تفتتح السور القرآنيّة بمناداة الله تعالى، بل بمناداة البشر: «يا أيها الناس»، «يا أيها الذين آمنوا»، «يا أيها المـُزَّمِّل».
• لم تأتِ كلمة «اللهم» في أيّ سورة إلا وسبقتها كلمة تدلّ على «القول» لفظًا أو معنىً.
• لم يرِد بعد النداء بكلمة «اللهم» في القرآن أي ضمير، أو «أن» الناسخة.
ـ بعض الكلمات والصيغ المستعملة لم ترد ولو مرّة واحدة في القرآن الكريم:
• لا يوجد في القرآن كله الفعل: «نُصَلِّي».
• لا وجود لفعل «يحفد» في القرآن في أي زمن من الأزمان أو أيّ صيغة من الصيغ. الموجود كلمة «حَفَدَة» وهم أبناء الأبناء، وهذا شيء مختلف عما نحن فيه.
• ليس في القرآن كلّه كلمة «خَلْع» التي تدور عليها السورة المدَّعاة وعُنْوِنَتْ بها، بل ليس فيه من ذات المادة إلا فعل الأمر: «اخلع»: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) .
• لا يتقدَّم حرف الجر على الفعل الدال على الصلاة: «ولَكَ نُصَلِّي»، بل المشاهد أنّه إذا كان هناك حرف جر فإنّه يأتى بعد الفعل، أو تُذْكَر الصلاة مطلقة دون حرف جر أصلًا.
• كلمة «عذاب» قد تكررت في القرآن المجيد بضع مئات من المرات: نكرةً ومعرَّفةً بـ«أل» ومضافةً، فلم يتصادف أن جاءت مضافة إلى «كاف الخطاب» قط كما هو وَضْعها هنا. ولم يتفق أيضًا أن اقترنت الاستعانة بالاستغفار في القرآن قط كما هو الأمر في الجملة التي نحن أمامها: «نستعينك ونستغفرك».. وهناك ملاحظات أخرى أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.
أشار نولدكه إلى وجود هاتين السورتين عند الشيعة في كتاب تاريخ القرآن نقلًا عن كتاب «دبستان مذاهب».
غولدتسيهر ذكر هذا الأمر بشيء من التفصيل يقول: «وهم في الحق لا يأتون بالأجزاء الناقصة من النص، وبدلًا من ذلك جاءوا بسور ناقصة بالكلية من القرآن
العثماني، أخفتها الجماعة التي كلّفها عثمان بكتابته، عن سوء نية، في زعمهم، إذ هي تشتمل على تمجيد لعليّ، وقد نشر جارسان دي تاسي Garcin de Tassy ومرزا كاظم بك، لأول مرّة، في المجلة الآسيوية (Journal Asiatique) (1842)، صورة من هذه السور المتداولة في دوائر الشيعة.
وحديثًا وجدت في مكتبة بانكيبور (بالهند) نسخة من القرآن تشتمل، فضلًا عن هذه السورة، على سورة «النورين» (41 آية)، وسورة أخرى شيعية أيضًا (ذات سبع آيات)، وهي سورة الولاية، أي الموالاة لعليّ والأئمّة، كما تشتمل على تفسيرات مذهبية كثيرة في بقية السور المشتركة”.
وكل هذه الزيادات الشيعية نشرها كلير تسدال W. st. Clair Tisdall باللغة الإنجليزية.
وذلك يدل على استمرار افتراض الشيعة حصول نقص غير قليل في نصّ القرآن العثماني بالنسبة إلى المصحف الأصلي الصحيح.
ومما جاء في سورة النورين: بسم الله الرحمن الرحيم * يا أيها الذين آمَنوا آمِنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم.* نوران بعضهما من بعض وأنا لسميع عليم.* إن الذين يعرفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات نعيم* والذين كفروا من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفونه في الجحيم... إلى أخر السورة المزعومة. وادّعوا أنّ عدد آيات هذه السورة 42 أو43 آية.
ومما جاء في سورة الولاية: بسم الله الرحمن الرحيم * يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبيّ والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم * نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير * إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم * والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين *...
لا يعتقد أيّ من الشيعة أن هذه السور مشمولة في القرآن، ولكنْ ادُّعِيَ أنّها بالفعل جزء أصيل من القرآن وأدرجوها في نسختهم من القرآن (في ما أطلق عليه اسم القرآن الشيعي). ومع ذلك، فإنّ الشيعة يرفضون ذلك باعتباره اتهامات لا أساس لها تهدف إلى اتهام الشيعة بالاعتقاد بفساد القرآن، ولا يوجد شيء اسمه القرآن الشيعي!
ولا تحتوي أيّ نسخة من القرآن الكريم على هاتين السورتين وليس هناك ذكر لهما في أي من المخطوطات القديمة من القرآن والحديث. ويقال إنّ مؤلّف النص كان فارسيًا وفقًا لبعض الأكاديميين.
ويعتقد الأكاديميون الغربيون، مثل فون جرونيبوم، أنّ النص هو تزوير واضح، على الرغم من أن الكثير منهم اعتبروا أن إدخال النصين هم من عمل الزرادشتيين وليس الشيعة.
ولا يوجد أي ذكر لهاتين السورتين المزعوتين في أي من مصادر الإمامية؛ كالكتب الأربعة، أو الكتب القديمة؛ ككتاب سُليم بن قيس، أو غيرها من المصادر.
وإن مصدر المستشرقين ومرجعهم، وكذلك الآخرين حول سورتي النورين والولاية، ليس سوى كتاب «دبستان مذاهب»، ونسخة من القرآن يقال إنّها مكتوبة في القرن السابع عشر الميلادي، ولم يقدّم أحد أي مصدر ومستند آخر لهما. وقد يضاف أيضًا فصل الخطاب للمحدّث النوري، وتذكرة الأئمة لمحمد باقر اللاهيجي.
والظاهر أنّ المصدر الأساس لسورة النورين أو سورة الولاية ليس سوى كتاب «دبستان مذاهب» والذي يعود إلى القرن الحادي عشر الهجري، وتذكرة الأئمة الذي جاء بعد حوالي القرن منه استقى منه هذه الفكرة، أمّا النسخة المجهولة التي
عثر عليها في بلاد الهند في القرن السابع عشر الميلادي، وادعى كلير تسدال بأنّ هذه السورة موجودة فيها، فثمة احتمال قوي عندما نلاحظ تاريخ كتابة هذه النسخة أن تكون مأخوذة من كتاب «دبستان مذاهب» نفسه أيضًا، وبالتالي فقبل هذا الكتاب ليس ثمة مصدر أو مستند يرجع إليه في ما يخصّ سورة النورين. أمّا سورة الولاية، فلم يعثر عليها إلاّ في تلك النسخة المجهولة من القرآن في القرن السابع عشر الميلادي. وعليه، فلا يوجد أي أثر عن هاتين السورتين في أي مصدر من مصادر الشيعة على الإطلاق كما أشرنا.
أما كتاب دبستان المذاهب الذي هو المصدر الأساس لسورة النورين المزعومة فهو» كتاب فارسي في المذاهب والملل المختلفة، وهو مجهول المؤلف. الكتاب عرض للمذاهب الدينيّة المنتشرة في الهند في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي وفي ختامه درس عن الفلاسفة المشائين وأتباع الأفلاطونية المحدثة. اكتشفه وليم جونز – حسب قول بدوي- سنة 1787م.
أما كتاب تذكرة الأئمة فقد عده بعض الباحثين اشتباهًا من كتب العلامة المجلسي وذلك لوجود تشابه بين اسم كتاب للمجلسي وهو «تذكرة الأئمة» والكتاب المذكور، وكون المؤلف معاصر للعلامة المجلسي. ولكن الصحيح أن الكتاب هو لمحمد باقر اللاهيجي. وقال الشيخ آغا بزرگ الطهراني عن كتاب «تذكرة الأئمة»: «(تذكرة الأئمة) في تواريخ الأئمة المعصومين عليهم السلام من ولادتهم ووفياتهم وبيان سائر حالاتهم وما يتعلق بذلك، للمولى محمّد باقر بن محمّد تقي اللاهيجي، فارسي... فرغ من تأليفه في (1085) حكى شيخنا في الفيض القدسي، تصريح صاحب الرياض بأنّ مؤلفه كان معاصرًا للعلاّمة المجلسي مشاركًا معه في الاسم واسم الأب وكان مائلًا إلى التصوف، ومع هذا التصريح من صاحب الرياض وهو تلميذ العلاّمة
المجلسي وخرّيت الصناعة فتكون نسبة الكتاب إلى المجلسي توهم منشؤه الاشتراك الإسمي...».
وبالنتيجة: السورة فكرة وهمية اخترعها بعض المستشرقين أو غيرهم ونسبوها إلى الشيعة أو إلى ما يسمونه «القرآن الشيعي السري»، مع أنّه حتى «المحدّث النوري» في كتابه «فصل الخطاب» قال عن السورة المزعومة: «لم أجد لها أثرًا في كتب الشيعة».
ينقل (جولدتسيهر) في كتابه (مذاهب التفسير الإسلاميّ) بعض الروايات التي تدلُّ على أنّ لدى العلويِّين قرآنًا مدوّنًا بحسب ترتيب نزوله، وأنّ هذا القرآن قد كتَبه علي عليهالسلام بعد وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآله مراعيًا فيه ترتيب النزول، وهذا الترتيب مخالفٌ للترتيب العثماني. وهذا القرآن يشتمل على سبعة أجزاء.
واعتبر نولدكه أنّ الإمامية يؤمنون بالمصحف الحالي أي «المصحف الذي جمعه عثمان» بشكل مؤقت وأنّ المصحف الحقيقي يظهر عند ظهور الإمام المهدي عليهالسلام.
لا بد من الإشارة إلى أنّ كلام نولدكه متداخل مع كلام جولدتسيهر عن مصحف علي عليهالسلام مع باقي مصاحف الصحابة.
ولكن الصحيح أن أوجه الاختلاف بين مصحف أمير المؤمنين ومصاحف الصحابه؛ كمصحف أبي بن كعب، ومصحف ابن مسعود، وغيرهما، قد تكون في أمور أخرى لا تؤدّي إلى تحريف القرآن الكريم بالزيادة والنقيصة:
1- الاختلاف في الترتيب والتأليف، وذهب إليه جماعة، يقول العلامة
الطباطبائي: «إنّ جمعه عليهالسلام القرآن وحمله إليهم وعرضه عليهم لا يدلّ على مخالفة ما جمعه لما جمعوه في شيء من الحقائق الدينيّة الأصليّة أوالفرعية، إلاّ أن يكون في شيء من ترتيب السور أو الآيات من السور التي نزل نجومًا، بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينية. ولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجرد إعراضهم عمّا جمعه واستغنائهم عنه، كما روي عنه عليهالسلام في موارد شتَّى، ولم ينقل عنه عليهالسلام في ما روي من احتجاجاته أنّه قرأ في أمر ولايته ولا غيرها آية أو سورة تدلّ على ذلك، وجّبهم على إسقاطها أو تحريفها ».
الاختلاف بالزيادة والنقصان من جهة الأحاديث القدسيّة، بأن يكون مصحف الإمام عليهالسلام مشتملًا عليها، ومصحفهم خاليًا عنها، كما ذهب إليه شيخ المحدّثين الصدوق.
الاختلاف بالزيادة والنقصان من جهة التأويل والتفسير، بأن يكون مصحفه عليهالسلام مشتملًا على تأويل الآيات وتفسيرها، والمصحف الموجود خال عن ذلك، كما ذهب إلى ذلك جماعة.
(335)
من أبرز جهود المستشرقين في مجال الدراسات القرآنية عنايتهم الخاصة بترجمة القرآن الكريم إلى أمهات اللغات العالمية، وقد جاءت على نحوين:
• ففي أوروبا تمت أول ترجمة للقرآن بين عامي (1141م ـ 1143م)، إلى اللغة اللاتينية بتوجيه وبطلب من الأب: (بيتروس فينيرا بيليس) (بطرس المبجل).
• ونشر المستشرق الإيطالي (أريفاين) أول ترجمة من القرآن إلى الإيطالية.
• ثم ترجم القرآن إلى اللغة الألمانية من قبل (شنيجر النور مبرجي) (عام 1616م)، وأعقبت ذلك ترجمة إلى الفرنسية بقلم (سيور دوريز) (باريس 1647م).
• وفي إيطاليا يبدو أنّ الأب (دومينيك جرمانوس) (1588م ـ 1670م) قام بأول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية.
• وقد قام جورج سيل (1697م ـ 1736م) بترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية.
• وصدرت الترجمة الروسية للقرآن في عام (1776م) بـ (سنت بطرسبرج) (لينينجراد) بينما نجد أن أول ترجمة علمية إلى الروسية قام بها (سابلوكوف) (1804م ـ 1880 م) (عام 1878م)، ثم توالت ترجمة القرآن ترجمة كلية إلى لغات عدّة.
• ترجم القرآن جزئيًا كازيميرسكي البولوني (1808م ـ 1887م) إلى الفرنسية،
• وترجم فصول عدّة من القرآن إلى الإسبانية المستشرق السويدي سترستين،
• ونقل المستشرق الدانماركي (بول ـ Bull) أجزاء عدّة من القرآن إلى الدانماركية.
التَّرْجَمَة أو النَّقْل هي عملية تحويل نص أصلي مكتوب (ويسمى النص المصدرم)ن اللغة المصدر إلى نص مكتوب (النص الهدف) في اللغة الأخرى. فتعدّ الترجمة نقل للحضارة والثقافة والفكر.
وهي بعبارة أوضح نقل الكلام أو النص من لغته الأصلية التي كُتب بها إلى لغة أخرى مع الإلتزام بنقل الكلمات بطريقة صحيحة لتتشابه مع معانيها الأصلية حتى لا يؤدي إلى تغيير في معنى النص الأصلي.
والترجمة في الأساس ليست مجرد نقل كل كلمة بما يقابلها في اللغة الهدف ولكن نقل لقواعد اللغة التي توصل المعلومة ونقل للمعلومة ذاتها ونقل لفكر الكاتب وثقافته وأسلوبه أيضًا.
إنّ البحث في ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى تارة يكون عن إمكانية الترجمة؛ أي هل ترجمة القرآن ممكنة أصلًا؟ وهذا مرتبط بتحرير معنى الترجمة المراد في هذه الأبحاث، وأخرى يكون البحث عن المشروعية والجواز أي هل تجوز(شرعًا) ترجمة القرآن الكريم؟ وهذا السؤال يُسأل عادة بعد حسم إمكانية الترجمة، ونعتقد أنّه لا حاجة للخوض في بحث إمكانية الترجمة لأنّ ترجمة القرآن كما سيظهر هي مرتبة من مراتب تفسير القرآن، وتفسير القرآن مع إحراز الشروط العلميّة، والمنهجية جائز بل مطلوب أيضًا.
وفي البداية نعرض أقسام الترجمة، ثم نبين بعد ذلك مشروعية ترجمة القرآن الكريم.
ولكي تتضح الإجابة سواء عن إمكانية الترجمة أم مشروعيتها لا بد من الالتفات إلى أقسام الترجمة، فالترجمة على ما هو المعروف تقسم إلى قسمين:
وهي نقل ألفاظ من لغة إلى لغة أخرى بحيث تقابل اللفظة بمثلها من غير إخلال بترتيب الكلام المترجم.
وقد عرفها بعض الباحثين بأنّها: «نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغات الأخرى بحيث يكون النظم موافقًا للنظم، والترتيب موافقًا للترتيب». فالترجمة الحرفية هي عملية محاكاة للأصل وهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه أو ذكر المقابل للفظ من اللغة الأخرى، وهذا غير ممكن في اللغة العربيّة لعدم وجود لغة مشابه لها في سعتها وأساليبها البلاغية فكل هذه الأمور تختص بها اللغة العربيّة دون غيرها ويقل نظيرها في اللغات الأخرى، فإذا ترُجم القرآن ترجمة حرفية فيلزم منه تغيير المعنى.
(339)وهي أن ينقل مضمون الكلام إلى لغة أخرى من غير التزام بنظم الألفاظ وترتيبها أو عدد الكلمات المترجم إليها. ففي الترجمة التفسيرية لا نراعي المحاكاة بين الأصل واللغة المنقولة لها، بل يعمد المترجم إلى المعنى الذي يدل عليه تركيب الأصل فيفهمه بالدقة في المرحلة الأولى، ثم يصبه بقالب آخر باللغة الأخرى يؤدي المعنى الموجود في الأصل، ولا يتوقف عند كل مفردة ويستبدلها بلفظ مساوي لها وهذا هو الفرق الأساس بينها وبين الترجمة الحرفية.
ويمكن تعريفها بأنّها: بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقيد بترتيب الأصل أو مراعاة لنظمه.
الترجمة تفسيرية سميت بذلك لأنّ حسن تصوير المعاني والأغراض فيها جعلها تشبه التفسير وما هي بتفسير، فما هو الفرق بين الأمرين؟
فالتفسير لغة: تفعيل مشتق من جذر(فسْر) التي تعني الإبانة، والفصل، والإيضاح، وكشف المغطّى، وإظهار المعنى المعقول، وقد ورد لفظ التفسير مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلًا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾، أي: بيانًا وكشفًا. أمّا التفسير اصطلاحًا فله تعاريف متعددة منها: «هو بيان معاني الآيات القرآنيّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها».
والترجمة تختلف عن التفسير في النقاط الآتية:
• الاهتمام بالكلية والأداة التعبيرية في الترجمة دون التفسير.
• الترجمة لا تكون إلا نقلًا لمعنى الألفاظ من لغة إلى أخرى في حين أن التفسير يكون كذلك ويكون تعبيرًا عن المعنى بألفاظ أخرى في نفس اللغة.
• إنّ صيغة الترجمة استقلالية يراعى فيها الاستغناء بها عن أصلها وحلولها محله، بينما التفسير قائم أبدًا على الارتباط بأصله، فبالتفسير لا يمكن قطع التراكيب بعضها عن بعض.
• الترجمة لا يجوز فيها الاستطراد أما التفسير فيجوز بل قد يجب فيه الاستطراد.
• الترجمة تتضمن عرفًا دعوى الوفاء بجميع معاني الأصل ومقاصده، بينما التفسير قائم على كمال الإيضاح سواء أكان بطريق إجمالي أو تفصيلي متناولًا كافة المعاني والمقاصد أو مقتصرًا على بعضها دون الآخر. وهناك فوارق أخرى للتفسير والترجمة وما ذكر يكفي لبيان الفرق بينهما.
قبل بيان الحكم الشرعي للترجمة، نعطي مثالًا للفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية، فلو أراد المترجم أن يترجم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) .
فالمترجم ترجمة حرفية يأتي بكلام من لغة الترجمة يدل على النهي عن ربط اليد في العنق وعن مدها غاية المد مع مراعاة ترتيب الأصل ونظامه ولكن هذا التعبير الجديد يخرج في أسلوب ما يرمي إليه الأصل من النهي عن التقتير والتبذير بل قد يستنكر المترجم لهم ويقول: ما باله ينهى عن ربط اليد بالعنق وعن مدها غاية المد.
أما إذا أردت ترجمة تفسيرية فإنك بعد أن تفهم المراد وهو النهي عن التقتير
والتبذير في أبشع صورة منفردة تعمد إلى هذه الترجمة فتأتي بعبارة تدل على هذا النهي المراد في نفوس المترجَم لهم أكبر الأثر وأوفاه في استبشاع التقتير والتبذير بدون رعاية في نظمه وترتيبه اللفظي.
لا بد من الالتفات إلى نقطة جوهرية عقدية مهمة في مبحث الترجمة الحرفية للقرآن وهي أننا نعتقد بوصفنا مسلمين أنّ القرآن وحي إلهي فهو ليس كأيّ نص آخر ولا يشبه أي كتاب آخر، فالقرآن بلفظه ومعناه نزل على قلب النبيّ صلىاللهعليهوآله، والقرآن:-حسب تعريفه المشهور بين الباحثين في علوم القرآن- هو الوحي الإلهي المنزل على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآله لفظًا ومعنًى وأسلوبًا والمكتوب في المصاحف والمنقول عنه بالتواتر. وبناء على هذا التعريف فإنّ أي ترجمة للقرآن هي نقل لمضمون القرآن وبيانه وتوضيحه بلغة أخرى، لأنّ القرآن بلفظه ومعناه معجز.
فـ«لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسوله المعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوته، ولا يقول أحد أن الكلمة المترجمة هي نفسها كلام الله. فإنّ الله لم يتكلم إلا بما نتلوه بالعربيّة ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة لأنّ الإعجاز خاص باللغة العربيّة».
ويمكن صياغة دليل على استحالة الترجمة الحرفية على الشكل الآتي:
ترجمة القرآن بهذا المعنى تستلزم المحال وكل ما يستلزم المحال محال.
الترجمة بهذا المعنى تقتضي نقل كل الأساليب البلاغية (وهي وجه إعجاز القرآن).
وكل نقل بهذا المعنى (أي نقل كلّ الأساليب البلاغية) يقتضي الإتيان بمثل للقرآن، والإتيان بمثل القرآن ممتنع.
فالترجمة الحرفية للقرآن ممتنعة (أي مستحيلة).
وجه الاستحالة مرتبطة بعوامل كثيرة منها: ترتيب الجملة في اللغة العربيّة، الخصائص التعبيرية للغة، ففي العربيّة هناك الحقيقة والمجاز، والتشبيه والاستعارة والكنايات، واللغة العربيّة من أوسع اللغات استعمالًا للأساليب البيانية وعلم البديع، ولا يقابلها شيء في اللغات الأخرى.
أما الترجمة التفسيرية أو المعنوية: فهي ممكنة لأنها لون من تفسير القرآن الكريم، فكما يفسر القرآن باللغة العربيّة لبيان معانيه، وشرح الغامض، وتفصيل المجمل، فكذلك تفسيره بأي لغة أخرى ممكن؛ لنقل المعاني وتوضيحها بلغة أخرى، فان المترجَم عندئذ هو فهم المترجم للمراد بالآية حسب طاقته البشرية.
ولكي يتضح حكم الترجمة التفسيرية للقرآن لا بد من التمييز بين المعاني الأصلية للقرآن والمعاني الثانوية، فللقرآن نوعان من المعاني: معان أصلية ومعان ثانوية.
المعاني الأصلية: هي التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية.
المعاني الثانوية: هي خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام وبها كان القرآن معجزًا.
إنّ ترجمة المعاني الثانوية أمر غير ميسور أصلًا لأنها مرتبطة بالإعجاز البياني للقرآن، والمعاني الأصلية فقط هي التي يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى.
يقول الشاطبي: «إنّ ترجمة القرآن على الوجه الأول ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس لهم فهمٌ يقوى على تحصيل معانيه ومع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد فإن اللفظ الواحد قد يكون
له معنيان أو أكثر فيضع المترجم لفظًا يدل على معنى واحد حيث لا يجد لفظًا يشاكل اللفظ العربي في ضمان تلك المعاني. وقد يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي ولهذا وقعت أخطاء في ترجمة معاني القرآن».
والترجمة التفسيرية للمعاني الأصلية للقرآن الكريم جائزة بشروط نذكر منها:
1- معرفة المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل ولغة الترجمة.
2- معرفته لأساليبهما وخصائصهما.
3- وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن.
4- أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل بحيث يمكن أن يستغنى بها عنه بأن تحل محله كأنّ لا أصل هناك ولا فرع.
يقول السيد الخوئي قدسسره : لقد بعث الله نبيه لهداية الناس فعزّزه بالقرآن، وفيه كل ما يسعدهم ويرقى بهم إلى مراتب الكمال، وهذا لطف من الله لا يختص بقوم دون آخر بل يعمّ البشر عامة، وقد شاءت حكمته البالغة أن ينزل قرآنه العظيم على نبيه بلسان قومه، مع أن تعاليمه عامة، وهدايته شاملة، ولذلك فمن الواجب أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدي به.
ولا شكّ أن ترجمته ممّا يعين على ذلك، ولكنه لا بد وأن تتوفر في الترجمة براعة وإحاطة كاملة باللغة التي ينقل منها القرآن إلى غيرها، لأن الترجمة مهما كانت متقنة لا تفي بمزايا البلاغة التي امتاز بها القرآن، بل ويجري ذلك في كل كلام إذ لا يؤمن أن تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل.
ولا بد -إذن- في ترجمة القرآن من فهمه، وينحصر فهمه في أمور ثلاثة:
1- الظهور اللفظي الذي تفهمه العرب الفصحى.
2- حكم العقل الفطري السليم.
3- ما جاء من المعصوم في تفسيره.
وعلى هذا تتطلب إحاطة المترجم بكل ذلك لينقل منها معنى القرآن إلى لغة أخرى.
وأما الآراء الشخصية التي يطلقها بعض المفسرين في تفاسيرهم، لم تكن على ضوء تلك الموازين فهي من التفسير بالرأي، وساقطة عن الاعتبار، وليس للمترجم أن يتكل عليها في ترجمته.
وإذا روعي في الترجمة كل ذلك فمن الراجح أن تنقل حقائق القرآن ومفاهيمه إلى كل قوم بلغتهم، لأنها نزلت للناس كافة، ولا ينبغي أن تحجب ذلك عنهم لغة القرآن ما دامت تعاليمه وحقائقه لهم جميعًا.
ومع مراعاة الضوابط السابقة يجوز لنا ترجمة معاني القرآن إلى لغة أخرى أما الألفاظ بدقتها مع الأسلوب الإعجازي للقرآن فترجمة هذه الأمور غير ممكنة أصلًا كما تقدم، ولذا فقهاء الإمامية يعتبرون ترجمة القرآن ليست القرآن الكريم نفسه، فلا يمكن الاحتجاج بترجمة القرآن بنحو الإعجاز لناقلها لأن إعجاز القرآن النظمي والبلاغي بلغته الأم لا بغيره من اللغات بل حتى بترجمته إلى المعنى العربي الدارج لا يكون معجزًا إلا بألفاظه التي نزل بها حصرًا.
يقول الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره: «لأن ترجمة القرآن لا يصدق عليه القرآن، ولا يجعل منه المقصود الأصلي من القرآن وهو نظمه المعجز، بخلاف ترجمة الذكر؛ الذي لو لم يصدق عليه خصوص الذكر المأثور، لكن يحصل منه المقصود الأصلي منه...».
ويقول آقا ضياء الدين العراقي: «(و) كيف كان (لا يجزئ) في الصلاة (الترجمة) أي ترجمة القرآن، لعدم صدق القراءة التي هي عبارة عن ذكر ألفاظ القرآن بقصد حكاية كلامه تعالى، كما هو الشأن في قراءة عبارة شخص أو شعر أو غيره». أمّا جواز الترجمة فيرى علماء الإمامية جواز ذلك، بل رجحانه.
ويقول المحقق الطهراني في الذريعة: «نعم يمكن ترجمة خصوص ظواهر آيات الأحكام والآداب والقصص وأمثالها من القرآن بلغة أخرى وإن فات بالترجمة جميع المزايا التي بها عجزت الأنس والجن عن الإتيان بآية واحدة مثله ومع ذلك تعد عند أهل العرف هذه الترجمة كسوة ثانية لمعاني تلك الألفاظ الآلهية فينبغي أن يراعى في كتاب الترجمة جميع الشؤون والاحترامات العرفية التي لأصله ويحترز عن هتكه وتوهينه بمجرد تلك الإضافة وأما سائر الأحكام الثابتة في شرع الإسلام، من حرمة المس من غير طهر، وحرمة التنجيس، ووجوب إزالة النجاسة عنه، ووجوب القراءة به في الصلاة، ووجوب الانصات لها، وغير ذلك فإنما يلحق جميعها لنفس تلك الآيات والسور العربيّة وهي خاصة بها بعينها، وأما ترجمتها بلغة أخرى فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار مطلقًا وإن طابقتها حرفًا بحرف، إذ لا يخرج كتاب الترجمة عن كونه تأليف البشر نظير كتب التفاسير الفارسية والهندية التي هي ترجمة وزيادة شروح وبيانات، وقد ترجم القرآن بكثير من اللغات قديمًا وحديثًا».
ويقول الشيخ محمد جواد مغنية: «وتسأل: هل تجوز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية؟ ومع الجواز هل تجري أحكام القرآن على ترجمته فلا يمسها إلا المطهرون؟ الجواب: لا شبهة ولا ريب في جواز ترجمة القرآن إلى كل اللغات، بل ورجحانها أيضًا لأنّ القرآن هو رسالة اللَّه والإسلام إلى الإنسانية كلها، والترجمة عامل أساسي على بث هذه الرسالة الإلهية المحمدية وانتشاره...».
وبالنتيجة:
هناك فرق بين ترجمة نفس القرآن الكريم إلى لغة أخرى فهذا أمر غير ممكن أصلًا، وبين ترجمة معاني القرآن أي تفسير القرآن فهذا أمر ممكن بل واجب علينا من باب تبليغ الإسلام إلى غير العرب وبلغاتهم الخاصة، بالإضافة إلى أن علمنا بوجود تحريفات متعمدة أو غير متعمدة في ترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى قد يوجب علينا القيام بهذه المهمة؛ وهي ترجمة القرآن.
تُرجم القرآن أولًا إلى اللغات: الفارسية، والسريانية واللاتينية. فقد نقل السرخسي عن أبي حنيفة أن الفرس كتبوا إلى سلمان رضي الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤن ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية.
وترجمت آيات من القرآن قام بها مترجمون غير مسلمين وبخاصة من القساوسة السريان؛ حيث تضم مكتبة مانشستر البريطانية، والمتحف البريطاني في لندن مجموعة من المخطوطات باللغة السريانية يرجع تاريخها إلى عهد هشام بن عبد الملك. ويقول الفيكونت دوطرازي في دراسته عن القرآن إنّه اطّلع على ترجمة سريانية للقرآن كاملة، ويتوقع طرازي أن الذي ترجم هذه النسخة القديمة هو باسيل مطران الرها في حدود سنة 1145 م.
وفي أوروبا، رعى «بطرس المبجل» رئيس دير كلوني cluny الشهير أولَ ترجمة
للقرآن الكريم إلى اللاتينية، فقد عهد بهذه الترجمة إلى العالم الإنجليزي robert ketton بمساعدة الألماني«هرمانوس» وراهب إسباني آخر مجهول الاسم، وقد استغرقت هذه الترجمة ثلاث سنوات من 1141م إلى 1134 م.
فاللغة اللاتينية هي اللغة الأولى التي ترجم إليها القرآن الكريم، ويبدو أن الترجمة اللاتينية التي صار لها رواج في اللغات الأوروبية هي ترجمة دير كلوني. وقد ترجمت نسخة كلوني إلى اللغات الإيطالية والألمانية والهولندية والفرنسية والإنجليزية والروسية. والمهم أن نعلم أن حركة ترجمة القرآن الكريم من قبل المستشرقين عرفت مدارس متخصّصة عنيت بالموضوع أشهرها وأهمها: المدرسة الإسبانية والمدرسة الألمانية والمدرسة الإنجليزية.
وعندما نقوم باستقراء لبعض الترجمات سنجد أن أهداف وأغراض المترجمين تختلف بحسب توجهاتهم الدينيّة والفكرية، ويمكن تقسيم هذه الأغراض إلى نوعين من المحاولات:
1- محاولات منصفة، قام بها مستشرقون أمثال: آرثر ج. آربري، كان غرضهم الأساس هو إيصال رسالة القرآن الكريم وتوضيحها لمن لا يتقن اللغة العربية.
2- محاولات غير منصفة، قام بها أناس حاقدون على الدين الإسلاميّ، وكان
غرض بعضهم هو طمس معالم الدين الإسلاميّ الصافية والتشكيك في رسالة الإسلام.
يقول يوهان فوك في تأريخه للدراسات العربيّة في أوروبا: «ولقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن واللغة العربية، فكلما تلاشى الأمل في تحقيق نصر نهائي بقوة السلاح، بدا واضحًا أن احتلال البقاع المقدسة لم يؤدِّ إلى ثني المسلمين عن دينهم، بقدر ما أدى إلى عكس ذلك، وهو تأثُّر المقاتلين الصليبيين بحضارة المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم في حلبات الفكر».
ويضيف أنّ: «هذه الفكرة التي أدّت إلى ترجمة القرآن قد شهدت توسعًا من خلال تنقلات الوعاظ الدينيين لطائفتي الدومنيكان والفرنسيسكان».
ويقول جورج سيل في مقدمة ترجمته للقرآن: إنّ الهدف منها هو تسليح النصارى البروتستانت في حربهم التنصيريّة ضد الإسلام والمسلمين، لأنهم وحدهم قادرون على مهاجمة القرآن بنجاح، وأن العناية الإلهية قد ادَّخَرَتْ لهم مجد إسقاطه.
وقد حاول جملة من الباحثين تنويع وتقسيم الأهداف التي كانت وراء ترجمة هؤلاء للقرآن الكريم من أهداف دينية، علمية، اقتصادية، سياسية، استعمارية، وغير ذلك، ولكن يمكن إرجاع أهدافهم التي وضعوها للترجمة إلى هدفين أساسيين؛ هما:
لم يخلو ميدان ترجمة القرآن من بعض المترجمين المنصفين نسبيًا؛ أمثال: Arberry. J Arthur آرثر ج. آربري، وقد أطلق عليها عنوان:
Koran Interpreted The أي القرآن مترجمًا. وفي مقدمة كتابه دافع آربري عن القرآن الكريم وفصاحته وقوة عبارته وجمال أسلوبه ضد افتراءات المستشرقين، ومن أبرزهم Thomas Carlyle، إذ وصمه بالوحشية لعدم تذوقه لبلاغة القرآن وعدم فهمه لنصوصه، ورغم أن آربري لا يؤمن بأنّ القرآن كلام الله تعالى بل هو عمل قوة خارقة
Supernatural Power إلاّ أنه يثبت بطلان زعم المستشرقين أمثال مارجليوث Margoliouth وجب Gibb من أنّ القرآن هو كلام محمد صلىاللهعليهوآله.
فالاستفادة من تراث المسلمين -بوصفه عملًا علميًّا- كان من ضمن الأهداف الرّئيسة لبعض المستشرقين عندما أقدموا على جمع تراث المسلمين، ومن بينها الكلام المعجز القرآن الكريم.
ثانيًا: التشويه والتضليل والتشكيك بهدف تضعيف الإسلام ونصرة اليهودية والنصرانية ودول الاستعمار:
إنّ الغالبية العظمى من هؤلاء هم حاقدون على الإسلام ومتعصبون لأفكارهم الدينيّة أمثال: Wherry, George Sale, Rodwell, and Palmer القسّيس وهيري، وجورج سيل، وروديل، وبامر وغيرهم وليس مستغربًا أن يكون عنوان أول ترجمة إنجليزية للقرآن المنقولة عن الترجمة الفرنسية هو: Mahomet of Alcoran أي قرآن محمد للكاتب الإنجليزي Alexander Ross ألكزندر روس وغيرهم ولبيان مدى حقد هؤلاء وتعمدهم تويشه الحقيقة نذكر أنموذجًا على ذلك:
|
ترجمة آرثر ج. آربري |
ترجمة روديل(Rodwell) |
|
ترجمة قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ﴾ إلى: so pray unto thy Lord and sacrifice وهي ترجمة صحيحة. |
ترجم: and slay the victims أي (أقتل الضحايا). |
وقد ذكر الباحثون أمثلة كثيرة من واقع ترجمات المستشرقين المحرّفة، ومن ذلك ما ذكره صالح البنداق من وجوه التشويه وهي كالآتي:
1- القيام بالترجمة الحرّة كما يراه المترجم وتحاشي الترجمة العلميّة للقرآن كما تقتضيه آياته وألفاظه.
2- التقديم والتأخير والحذف والإضافة.
3- إزاحة الآيات القرآنيّة من مكانها التوقيفي لتضليل القارئ وإبعاده عن الإحاطة بحقيقة النص القرآني .
يقول محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار بأنّ: «ترجمات القرآن التي يعتمد عليها علماء الإفرنج في فهم القرآن كلها قاصرة عن أداء معانيه التي تؤديها عباراته العليا وأسلوبه المعجز للبشر».
فالترجمة اللاتينية الأولى للقرآن (ترجمة بطرس الموقر) التي تمت عام 1143 م اضطلعت بتقديم مضمون الفكرة فقط، ولم تكترث بأسلوب الأصل العربي وصياغته، وقام الدافع التنصيري حائلًا أمام الوفاء بتحقيق هذا الغرض.
وقد كانت هذه الترجمة مشوّهة الأصل الذي نبعت منها الترجمات الأخرى؛ فمنها نبعت الترجمة الإيطالية الأولى التي أشرف عليها أريفابيني عام 1547 م، وفي سنة 1616 م ترجم سالمون شفايجر إلى الألمانية عن الإيطالية، وعن الألمانية إلى الهولندية في سنة 1641م .
وعن هذه الترجمة اللاتينية الأولى وضع الحاخام اليهودي يعقوب بن إسرائيل أول ترجمة بالعبريّة عام 1634م.
لم يكتفِ هؤلاء بتشويه النص القرآني بل قاموا بوضع إضافات خاصة من عندهم أو من نصوص التوارة، تقول إحدى الباحثات عن ترجمات القرآن إلى الفرنسية: «رجعت إلى خمس وعشرين ترجمة للقرآن بالفرنسية، فوجدتها كلها محرَّفة، وتضيف نصوصًا من التوارة إلى آيات القرآن الكريم دون الإشارة إلى ذلك».
وممن قام بهذا الفعل المستشرق رودويل، في الطبعة الأولى من ترجمته عام 1886م 1304ﻫ، فقد رتّب السور على ترتيب زمني حسب نزولها فبدأ بسورة العلق واختتم بسورة المائدة وزعم أن هذا الترتيب التاريخي يعطي صورة صحيحة واضحة لسيرة الرسول العقلية والتطورات الجارية في النظريات القرآنيّة. أمّا في توزيع السور على تواريخ نزولها فقد كان اعتماده على بحث نولدكه (Nöldeke) في كتابه: (تاريخ القرآن) (Geschichte des Qurans)
أضاف بعض المترجمين بجانب القرآن مقدمات وملاحق محرفة لكلام الله، وهي عبارة عن مقدمات تفسيرية وملاحق شارحة، لا لمضمون النص المترجَم، بل مناقشات ضدّ أصالة القرآن، وسخرية من محتواه.
وهكذا فقد تضمنت الترجمة اللاتينية الأولى (ترجمة بطرس الموقر) التي قام بها الراهب الإنجليزي روبرت الرتيني، والراهب الألماني هرمان الدالماني، عددًا من المقدمات والملاحق سميت بمجموعة (دير كلوني)، وهي :
1- خطاب بطرس إلى بيرنهارد (القديس برنار دى كليوفر).
2- مجموعة مختصرة من الوثائق الشيطانية المضادة للطائفة الإسلاميّة الكافرة.
3- مقدمة روبرت الرتيني.
4- (تعاليم محمد) لهرمان الدالماني.
5- (أمة محمد ونشوزها) لهرمان الدالماني.
6- تاريخ المسلمين (أخبار المسلمين المعيبة المضحكة).
والترجمة اللاتينية التي قام بها الراهب الإيطالي لودوفيجومرّتشي 1698م بموافقة البابا انوسنت الحادي عشر، جاءت الترجمة في قسمين:
يشتمل القسّم الأول على النص العربي للقرآن مع ترجمته اللاتينية وحواشي جزئية للرد على بعض المواضع، ويشتمل القسّم الثاني على كتاب: (الرائد إلى الرد على القرآن).
أما ترجمة جورج سيل الإنجليزية التي ظهرت في لندن عام 1734م وأعيد طبعها أكثر من ثلاثين مرة، فقد تضمنت مقدمة جدلية ضد القرآن وصفت في أدبيات التنصير بأنها قيِّمة وأنها أفضل وصف موضوعي للإسلام .
إنّ ترجمات المستشرقين لمعاني القرآن الكريم -في غالبها- ترجمات غير أمينة، ولا يمكن أن تعبر عن المعاني الحقيقيّة للقرآن، بل تشوّه معانيه وتحرّفها؛ لأنها تنطلق من اعتقاد أساس راسخ عند هؤلاء المترجمين، وهو رفض حقيقة أن القرآن
منزَّل من عند الله، والادعاء أنه تأليف النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله، ومحاولة إثبات أنه نقل عن القدامى، أو قلَّدهم، والعمل على إبراز أنّ القرآن الكريم مليء بالعبارات المثيرة للسخرية أو الغموض، وأنّه لا يتضمن أيَّ تشريع يذكر، ومن طرائقهم في تمرير هذا الكذب والبهتان: اختيارهم لعبارات معينة، واستخدامهم الهوامش والتعليقات في آخر الصفحات، إضافة إلى المقدمات التي يكتبونها، والتي تعطي لهم المساحة الكافية للتزييف.
يقول موريس بوكاي «وإذا أمعنت النظر في طرائق المستشرقين لترجمة القرآن، علمت أنّه من غير الممكن أن تحصل على واحدة يُطْمَان إليها بين ترجماتهم».
أما القواعد المنهجية والأساليب التي أتبعها المستشرقون وقادت إلى هذه النتائج السيئة والكارثية في بعض الأحيان في ترجمة القرآن يمكن تلخيصها في الآتي:
اعتمد المستشرقون في ترجمة القرآن على النص وليس المعنى، ونلحظ هذه القاعدة من خلال عناوين بعض الترجمات، بل بعض المستشرقين صرحوا بذلك في مقدمات ترجماتهم.
يقول جاك بيرك في مقدمة ترجمته: «تعمقت من خلال دراساتي المتواصلة والمستمرة بحيث أكون في مستوى ترجمة النص، ولكي لا يحدث أي تقصير في النص الفرنسي الذي يتوخى تقديم القرآن الكريم بكل أبعاده اللغوية والروحية إلى لغة أخرى».
جاء في مقدمة ن.ج داود لترجمته المنشورة بعنوان «The Koran A new Translation»: «وفي إعداد هذه الترجمة الجديدة قصدت أن أقدم للقارئ نسخة من القرآن بالإنجليزية المعاصرة.. وأمددت القارئ بحواشٍ تفسيرية تفاديًا لقلب النص إلى تفسير بدلًا من ترجمة».
ومن الواضح أن اعتماد الترجمة النصيّة سيؤدي إلى نتائج خاطئةٍ لأنه يصطدم بحقيقة وواقع القرآن الإعجازية والذي ثبت عدم إمكانية الإتيان بمثله لأهل الفصاحة والبلاغة آنذاك.
فإن عجزت العربيّة بثرائها عن المجيء بمثل حديث من القرآن فغيرها من اللغات أعجز؛ لأسباب كثيرة؛ منها:
1- ثراء اللغة العربيّة بالمفردات والمترادفات ممّا ليس له مثيل في باقي اللغات.
2-بنية الجملة في اللغة العربيّة تختلف عنها في اللغات الأوربية.
3-النظام اللغوي من حيث الضمائر والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع.
4-الأساليب البلاغية، والنظام الصوتي، والتركيبات الصرفية وغير ذلك.
فإذا أضفنا خصائص اللغة القرآنيّة الإعجازية إلى خصائص اللغة العربية، فالنتيجة استحالة ترجمة النص القرآني إلى أي لغة في العالم؛ وذلك لقصور أي لغة عن استيعاب ذلك النص المعجز في بلاغته وفصاحته.
في بعض الأحيان نصطدم بجملة من المستشرقين قد ترجموا القرآن الكريم إلى لغاتهم أو لغات أخرى مع جهلهم باللغة العربيّة؛ كما صرح بعضهم فالترجمة تتم بواسطة أو بواسطتين أو ربما أكثر من ذلك مع أنّه من البديهي والمنطقي في علم الترجمة أن ننطلق من النص الأصلي لا من النصوص المُترجمة.
فإنّ ترجمات القرآن في المرحلة الأولى كانت ترجمة لترجمة دير كلوني أو للترجمتين الوسيطتين (ترجمة دي ريور الفرنسية، وترجمة أندريا أريفابيني الإيطالية. وفي المرحلة الثانية كانت الترجمات الاستشراقيّة للقرآن ترجمة لترجمة القسّ لودفيجوماراتشي أو وسيطتها (ترجمة جورج سيل الإنجليزية).
قد يكون من بديهيات قواعد الترجمة الالتزام بترتيب الكتاب الأصل، فلا يصح جعل الباب الثاني هو الباب الأول والمقدمة هي الخاتمة وهكذا، هذا في الكتب العادية، فكيف الحال في الكتب المقدسة وللأسف هذه المسألة لم يلتزم بها المستشرقون أثناء ترجمتهم القرآن الكريم، وسلكوا اتجاهات أخرى في ترتيب المصحف أنتجت ترتيبًا مختلفًا لسور القرآن الكريم والأنماط التي اعتمدها المستشرقون في هذا المجال هي الآتية:
التزم به بعض المستشرقين: مثل جورج سيل، وآرثر آربري.
كترجمة إدوارد بالمر، وترجمة جون رادويل، وترجمة ريتشارد بل.
بدأ هذه المحاولة المستشرق الألماني تيودور نولدكه في كتابه الشهير «تاريخ القرآن» عام 1860م، وتبعه مواطنه شيفالي في كتابه «تاريخ القرآن» عام 1909م وقد اعتمد هذا الترتيب التاريخي ريجيس بلاشير في ترجمة عام 1949م، يقول بلاشير في مقدمة ترجمته: «السور القرآنيّة تنقسم إلى أربع مجموعات توافق فترات رسالة محمد...».
هذه الإنماط هي المعتمدة عادة في ترتيب القرآن عند المستشرقين ولكن هناك نمط رابع شذ عن الإنماط المتقدمة وهو الترتيب الشاعري للقرآن.
فقد حاول اليهودي نجيب داود في ترجمته الإنجليزية عام 1956م أن يضع ترتيبًا خاصًا لسور القرآن، لم يلتزم فيه بالترتيبات السابقة، واعتمد فيه على أمرين:
أحدهما قصر السور وطولها، والثاني: شاعرية السور بزعمه، فبدأ ترجمته بالسورة القصيرة وتتضمن العنصر الأكثر شاعرية، ثم الأطول والأقل شاعرية. وهكذا وسوغ اعتماده هذا الترتيب رغبته في عدم صدمة القارئ بالسور الطويلة كالبقرة والنساء، ورغبته في تهيئة القارئ تدريجيًا.
ونعرض هذه الملاحظات النقدية في شكل نقاط:
1. الطريقة المعتمدة في تغيير ترتيب النص خروج عن الموضوعية العلميّة لأن ترجمة أي نص تقتضي الاعتماد عليه كما هو والالتزام بترتيبه وما قام به هؤلاء بعيد كلّ البعد عن الأمانة العلميّة.
2. تقسيم بلاشير لسور القرآن واعتماده مراحل الدعوة أوقعه في مخالفة صريحة للقرآن حيث أوصل سوره إلى 116 سورة في حين أنها 114، إذ قسّم سورتي العلق والمدثر إلى أربع سور وهو أمر جديد لا يعهده المسلمون ولا يتوافق مع المصحف الحالي بل حتى ما نقل عن المصاحف السابقة للصحابة.
3. الترتيب الشاعري هو أمر مخالف حتى للمعهود من المستشرقين وهي فكرة لم يقدم صاحبها أي دليل وهي مجرد تصرف ذوقي لا يخضع لأي ضوابط علمية.
الرأي السائد الذي يميل إليه أغلبُ المستشرقين أن بطرس المبجل، رئيس «دير كلوني» Clugny في جنوب فرنسا، هو الذي أمر بوضع أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللّغة اللاّتينية. وذلك سنة 1141 م. وقد ذهب «بلاشير» إلى أن ذلك كان من
تكليف المؤسسة الدينيّة الغربيّة عندما استشعرت بخطورة الزّحف الإسلاميّ في أوروبا.
كان «بطرس» PetrusVeneabilis يرى تنصير المسلمين لا إفنائهم هدفًا نهائيًا، وهو ما يستلزم دراسة دينهم ونصوصه. وهناك، أشرف بطرس على إصدار أول ترجمة لاتينية للقرآن.
وتلبية للواجب الدِّيني تنقل بطرس في أقطار أوروبا للشروع في خطّته، وحطّ أخيرًا في الأندلس ليجد من يتولى ذلك من اليهود الدارسين للغة العربية. وقد سعى لتحقيق هذا كل من روبرت كونت ROBERT KENET وهو من الدالماتي HEMANN DELMATI، فأخذ الأول على عاتقه ترجمة القرآن من العربيّة إلى اللاتينية، مع مقدّمة قصيرة. أما دالماتي فقد كُلّف بأن يكتب سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآله وأركان الإسلام وتاريخه، وأن يُدبّج ذلك كله بإسرائيليات عبد الله بن سلام وأساطير يهودية. ويقول بلاشير عن هذا العمل: «إنّ التّرجمة لم تكن أمينة ولا كاملة للنّص».
إن ميزَة هذه التّرجمة أنها تستند إلى العديد من الإسرائيليات، وتعمد إلى استخراج المعاني التخمينية بدون تحليل أو فهم حقيقي للّغة العربية.
وصف المستشرقون هذه الترجمة بأنّها حرّفت كثيرًا من النصوص التي أعادت صياغتها، وبالَغَ المترجمون في الإساءة للقرآن إلى درجة أن بطرس المبجّل قدّم القرآن للعالم الغربي بطريقة بذيئة.
والجدير بالذّكر أن المستشرقين مدينون لهذه التّرجمة، باعتبارها المصدر الأوحد
للتّرجمات الأوروبية، وكذلك لأنها الرّكيزة الأساسية والمأمونة في نظرهم للبدء بدراسات حقيقية وجديّة عن الإسلام.
«غير أنّ هذه الترجمة للقرآن بقيت في ضمن مخطوطات الدير، ولم تصدر الاّ في سنة 1543 م، مخافة أن تعدّها بعض الدوائر عاملًا مهمًا من شأنه أن يسهّل التعريف بالإسلام، ويُقال أن هذه الترجمة قد أُتلِفت فيما بعد، ولم تسمح الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن الكريم باللاتينية إلاّ في عهد البابا ألكسندر السابع (1555 - 1567 م)، ثم توالت بعدها الترجمات بلغات عدّة منها العبريّة».
يرى المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون أن المحرّك وراء اهتمام بطرس الموّقر بالإسلام «هو محاربة ما كان يسميه الهرطقات المتمثلة في اليهودية والمسيحيّة وتزويد المسيحيّين بحجج سليمة لتثبيت إيمانهم، وأنّ الجدل الديني كان يستهدف مسلمين خرافيين يبادون بسهولة على الورق».
وتتضح أهداف بطرس (المحترم)!! هذا من تأليفه كتابا سماه: «دحض العقيدة الإسلاميّة».
كما أنّه في العام نفسه الذي صدرت فيه الترجمة المذكورة ألَّف كتابًا للرد على الإسلام، وصفه د. عبد الرحمن بدوي بأنّه جاء في أربعة مقالات:
الأولى في حفظ اليهود والنصارى لكتبهم، وحاول فيها بيان صحة نص الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وأنه لم يُحرَّف كما يقول القرآن.
والثانية في حياة النبيّ محمد وفي القرآن، للطعن فيهما، مقارنًا بين النبوة في المسيحيّة والإسلام.
والثالثة تحدث فيها عن خلو حياة النبيّ محمد من المعجزات.
والرابعة جاءت استمرارًا لهذه المطاعن، وحديثًا عن أصول الإسلام المبتدعة.
ترجمة مراتشي تعتبر الترجمة اللاتينية الثانية، لأنّه سبقتها ترجمة «سكالييه شرشييه» (عربي - لاتيني) (1579م)، وترجمة «جبرائيل صهيون» الجزئية (باريس 1630م). ولكن ترجمة مراتشي هي أشهر الترجمات اللاتينية للقرآن وهي التي اعتمد عليها جورج سيل في ترجمته الإنجليزية للقرآن.
في عام 1698م، في مدينة بادوفا الإيطالية، نُشِرَ سفر أودع فيه «لودفيكومراتشي»، المستشرق والكاهن الكاثوليكي الإيطالي، عُصارة عمره المديد.
يحوي النص نقلًا للفظ القرآني الكامل بحروف لاتينية، مع ترجمة تفصيلية، وتعليقات وحواش مكثفة، نُقِلت عن مصادر عربيّة جديدة.
وبتوجيهات من «البابا» شرع في ترجمة لاتينية جديدة للقرآن الكريم، وذلك للرد على المسلمين، وللجـدل الديني. وعندما انتهى من عمله بعد أربعين سنة كان قد سطر (عدة مجلدات) وفيها كتب النص القرآني العربي، علاوة على الترجمة اللاتينية الحرفية، وفي هذه المرة رَقَّمَ الآيات، ثم أورد رأي المسلمين في شرحها، وأتبع ذلك بالنقد والرفض والهجوم الجدلي على القرآن الكريم..
مراتشي أسهب في عرض الردود والتفنيدات اللاهوتية، والتنقيب المتكلّف عن التناقضات النصية عقب كل فقرة مترجمة.
في الحقيقة، كانت الروح العدائية تكتنف نص مراتشي بأكمله من الصفحة الأولى إلى الأخيرة. ففي الأولى، نجد الكاتب يهدي عمله إلى ليوبولد الأول، الإمبراطور الروماني المقدس، قاهر العثمانيين وحامي بيضة الدين. وفي الأخيرة، يهنئ مراتشي نفسه على نجاحه في قتل محمد بنفس سيفه، كناية عن نصه المقدس.
وإذا كانت ترجمة «دير كلوني» اللاتينية الأولى هي المؤثر على الترجمات في
اللغات الأوروبية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فإن ترجمة «ماراكيوس أومراتشي» كانت المؤثر الأكبر على الترجمات في اللغات الأوروبية في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر. وبقدر الفرق بين الترجمتين الأولى والثانية من الناحية الأكاديمية كان الفرق بين الترجمات الأوروبية المتأثرة بالأولى والترجمات الأوروبية المتأثرة بالثانية. فإذا قلنا بتفاهة ترجمة «دي ديور» فيمكن إرجاع ذلك للنبع الذي أخذت منه، وهي ترجمة «كلوني»، وإذا قيل إن ترجمة «جورج سال» أكثر أكاديمية من ترجمات «روس» و«تيلور» فهذا بديهي، «فمراكيوس» قدم له ترجمة أكثر دقة من سابقه. وهو الفرق نفسه الذي نجده في الألمانية بين ترجمة «سلمون شفايجر» عن (الكلوني) وترجمة «دافيد نريتر» عن (ماراكيوس) فَرَجْعُ الصدى يتطابق مع مصدر الصوت.
في عام 1734، نشر «جورج سيل» المحامي والمستشرق الإنجليزي -الأكثر تأثرًا بفلسفة عصر النهضة، خاصة سبينوزا- ترجمته للقرآن عن اللغة العربية، وبالاستعانة بالترجمات الجادة السابقة وهي ترجمة مراتشي كما أسلفنا. ولكن يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات على هذه الترجمة نذكر أهمها، وهي:
ـ استخدام مصطلحات مسيحية في الترجمة.
ـ إدخال عبارات تفسيرية وتأويلية تستهدف تحريف المعاني.
ـ إسقاط ألفاظ من الأصل أو عبارات كاملة.
ـ إدخال عبارات إضافية ليس لها أي علاقة بالأصل.
ـ إدخاله في الترجمة تفاسير وتعليقات مبينّة على الظن أو على روايات غير صحيحة.
ـ هذه بعض شوائب هذه الترجمة والتي هي من أشهر الترجمات الإنجليزية للقرآن الكريم، ونبين بعضًا من هذه النماذج السيئة لهذه الترجمة.
ـ قد يسقط بعض الكلمات مثل إسقاطه لكلمة ﴿الرَّحِيمِ﴾ في ترجمة البسملة فيكتب في ترجمته:
أ. In the Name of the Most Merciful God ومعناها «بسم الله ذي الرحمة للغاية»، ويفعل ذلك في كل مكان تقع فيها الكلمتان ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾.
ـ إدخال بعض العبارات المسيحيّة كما فعل ذلك في ترجمة ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾.Who believe in the mysteriesof the faith. ومعناها: «الذين يؤمنون بأسرار العقيدة «. وهذه ليست ترجمة لمعنى كلمة الغيب والتي هي واضحة في اللغة العربيّة وهو ما يقابل عالم «الشهادة» وهو ما لا تناله الحواس أما ترجمة «سيل» فهي تتناسب مع مصطلح مسيحي وهو «سرّ القربان المقدس».
ـ تغير المعنى حتى للكلمات الواضحة مثل ترجمة: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾. ترجمها: because they have disbelieved «أي لأنهم لم يؤمنوا».
ـ قد لا يفهم العبارات العربيّة بطريقة صحيحة كقوله تعالى ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾. فكيتب معناها: do thou make him to see and to hear. هذا فعل التعجب ولكن سيل ظن أنّه أمر للنبي صلىاللهعليهوآله وعلق بقوله: «هذه عبارة سخرية تدل على سفاهة تعليم الإنسان لله».
ـ قد يدخل كلمة أو أكثر لتغيير المعنى مثل ترجمة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ في سور
البقرة بقوله: O men of Mecca يعني «يا أهل مكة «أو ترجمة ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ﴾. We make you O Arabians وهكذا فعل في أماكن أخرى ليثبت أن القرآن الكريم والإسلام يخصان العرب.
ـ قد يأتي بمعنى بعيد كل البعد عن الصحة فمثلًا يترجم ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾.The present life was ordained for those who believe not يعنى «قدرت أو قضيت الحياة الدنيا للذين كفروا».
هناك مئات من الأخطاء في ترجمة «سيل» ولكنها رغم ذلك تم تداولها أكثر من قرنين من الزمن وذلك لأنها تخدم الأهداف التي وضعت من أجلها طبعًا تغير الأمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فظهرت ترجمات أخرى للقرآن الكريم في شتى اللغات الأوروبية.
صدر كتاب رودويلThe Koran: translated from the Arabic, the surahs arranged in chronological order, with notes and index. في 1861م، وقد تأثر بكتابات موير، سبرنجر، ونولدكه. وكتب مقدمة طويلة تحدث فيها عن شخصية الرسول صلىاللهعليهوآله وعن الإسلام واعتبره خليط من النصرانية واليهودية فقال فهو: «يهودية مجردة عن شعائر موسوية ومسيحية مجردة عن التكفير والفداء atonement وعن التثليث the trinity... وأن الحجة التي ينبغي أن يستخدمها المبشر المسيحيّ في تعامله مع مسلم هي أن لا ينتقد الإسلام جملة من الأخطاء، بل يثبت أنه يتضمن شظايا منفصلة من الحق، أي أنه مبني على المسيحيّة واليهودية، ولا سيما الثانية، بدون فهمهما فهمًا كاملًا، ومشيرًا إلى أن المسيحيّة هي الشريعة النهائية final dispensation.
وقد قام رودويل: J.M. Rodwell بترتيب القرآن ترتيبًا زمنيًا حسب اقتراحات موير، ونولدكه في تاريخ نزول السور والآيات القرآنيّة، وطبعًا هدفه من ذلك كله إثبات أنّ القرآن الكريم من شظايا منفصلة من الحق، وأنه من تأليف محمد صلىاللهعليهوآله على كل الأحوال ترجمته هذه لم تلق صدى إلا في الدوائر التنصيريّة، لأن القارئ المسلم نظر إليها بعين الريبة، والقارئ غير المسلم لم يعدّها ترجمة صحيحة ومستقيمة للقرآن الكريم.
هناك ملاحظات كثيرة على ترجمة رودويل نذكر منها:
ترجم قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا﴾ .
Therefore be clear in thy discussions about them and ask
not any Christian concerning them
فقد ترجم الضمير في (مِنْهُمْ)، بقوله: ولا تسـأل أحدًا من النصارى عنهم، فتخصيص النصارى فيه قصور لأن المقصود هم أهل الكتاب عامة أو اليهود خاصة كما دلت الروايات على ذلك، لأن اليهود هم الذين طلبوا من المشركين أن يسألوا الرسول صلىاللهعليهوآله عن أهل الكهف.
ـ ترجم قوله تعالى: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ .Look thou and hearken unto Him alone. يعني: انظر انت واستمع.
ـ ترجم كلمة السجود في قوله تعالى:﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ . And when we said to the angels ((Bow down and worship Adam)) the angles
then worshipped they all, save Eblis. ترجم رودويل كلمة اسجدوا بما يفيد معنى العبادة وهذا غير صحيح فقد قال: Bow down and worship Adam أي اسجدوا سجود عبادة.
وهناك أخطاء كثيرة في هذه الترجمة من حذف لبعض الكلمات من إضافة لكلمات أخرى لا وجود لها في النص تقديم وتأخير بعض الكلمات خلاف النص الأصلي.
ولقد ملئت أيضًا تعليقات رودويل على النص القرآن بالافتراءت والأكاذيب عن القرآن والرسول صلىاللهعليهوآله نذكر أنموذجًا واحدًا لذلك وإلا هناك عشرات من هذه التعليقات يمكن مراجعتها في ترجمته.
فعند تعليق روديل على قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ . قال: لما وصل الرسول إلى قراءة هذه الآيات عند قراءته لهذه السورة في أول مرة تابع قائلًا: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم ترتجى، فأعجب الوثنيون بهذه الآيات، إلا أن محمدًا رفض هذه الآيات بعد أيام، واعتربها آيات شيطانية، واستبدلت بالآيات التي تلي هذه الآيات حاليًا. والاحتمال الوارد هو أنه أراد -بناء على الصعوبات التي واجهها- أن يحاول التقريب فيما بينه وبني المشركين، ولكنه سرعان ما ندم على ذلك. ويبدو أن رفض الأوثان في السور التي تلي هذه السورة جلي وواضح.
ﺗﻌﺪ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎﻛﺲ ﻫﻴﻨﻨﺞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﱰﲨﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎرا وﻗﺪ ﺻﺪرت ﻫﺬﻩ الترجمة عام (1901م) بالاسم المستعار ماكس هننغ، والتي قام بها -على الأغلب- أستاذ الاستشراق في جامعة لينيغراد البروفسور أوغست مولر، وتعد هذه الترجمة، وعلى الرغم من مرور مائة عام على صدروها- أكثر الترجمات قبولًا لدى المسلمين الألمان. وقد عبر هننغ في مقدمته عن توجسه من مستقبل الإسلام، وملأ حواشي
ترجمته بالإسرائيليات المخالفة للإسلام، ولكنه تمكن بالرغم من ذلك من المحافظة على القرب الشديد من معاني القرآن الكريم. طبعت هذه الترجمة اثنتي عشرة مرة مع تنقيح للأستاذة آنا ماري شمل عام (1960م) وتنقيح لـ كورت رودولف عام (1968م)، ولا تزال هذه الترجمة تحظى بأفضلية لدى المسلمين، وقد طبع هذه الترجمة الأستاذ مراد هوفمان طبعتين مختلفتين: إحداهما: بالنص الألماني فحسب. والثانية: بالنص الألماني مقابل الأصل العربي، وذلك بعد أن عمل على تنقيحها أكثر من ثلاث سنوات. وقد ألحق مراد هوفمان مع هذه الترجمة تفسيرًا مختصرًا مكان حواشي هننغ المخالفة للإسلام، وذلك في (744م)وضعًا، وأضاف كشافًا للمصطلحات.
وقد تركت ترجمة هننغ آثارًا كبيرة في عدد من الترجمات اللاحقة، وبشكل خاص في ترجمة الأحمدية، التي اعتمدت على الترجمة الإنجليزية لـ محمد علي عام (1917م). وصدرت الطبعة الأولى من هذه الترجمة عام (1939م)، ثم نشرها مرزا نصير أحمد عام (1945م) وتعد هذه الترجمة جيدة من ناحية المستوى اللغوي، غير أنها غير مقبولة بسبب تعليقاتها الطائفية.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻛﺲ ﻫﻴﻨﻨﺞ ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻊ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻗﺪ ﲡﻨﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﱰﲨﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، وﻳﻘﻮل ﻫﻮﻓﻤﺎن وﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ وﻗﺪم ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﱰﲨﺔ ﻫﻴﻨﻨﺞ: إن ﻫﻴﻨﻨﺞ قد اﺳﺘﺤﺪث أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﺒﲑات أﳌﺎﻧﻴﺔ لا تفي ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺰم ﻫﻴﻨﻨﺞ، ﺗﺮﲨﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺘﺸﺎﺑﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺣﻴﺜﻤﺎ وردت ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق.
وهناك ترجمات عديدة للقرآن الكريم أعرضنا عن ذكرها لأنّ الغرض ممّا تقدم هو الإشارة إلى بعض الترجمات الخاطئة والمغرضة والحاقدة في هذا المجال مع التفاوت الواضح بين هذه الترجمات.
تعرض لهذا الموضوع جملة من المستشرقين على رأسهم: المستشرق الفرنسي بلاشير، والمستشرق الألماني نولدكه، وجولدتسيهر، وكازانوفا، وغيرهم.
وقد تكلم «ريجي بلاشير» عن مراحل جمع القرآن على الشكل الآتي:
المرحلة الأولى: مرحلة الحفظ في الصدور والتي استمرت حوالي عشرين عامًا، ونفى أن يكون هناك أيّ قرآن مكتوب قبل هجرة النبيّ إلى المدينة. وﻳﺮى أنّ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮﺁن وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المشاكل؛ ﻷنّ اﻟﺘﺪوﻳّﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﺗﻤﺎﻣًﺎ، ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺁﻳﺎت كثيّرة ﻣﻨﻪ، وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن أدوات الكتابّة وما كان ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻢّ ﺑﺪون ﺿﺒﻂ أو ﻧﻈﺎم ﺑﻞ قد ضاع بعضها.
المرحلة الثانية: بدأت في عهد الخليّفة الأوّل ولم تتجاوز جمع ما كان في صدور الحفاظ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮﺁن وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ علميّة ﺻﺤﻴﺤﺔ؛ وﻣﻦ هنا كان ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﺰﻳﺎدة واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت. ولكن المرحلة الحاسمة في نظره كانت ما قام به الخليّفة الثالثة عثمان فهي علميّة ومنظمّة وأكثر شمولًا واتساعًا.. لكن ﻧﻈﺮًا ﻟﻐﻴﺎب أدوات اﻟﻨﻘﻂ واﻟﺮﺳﻢ ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﺰال اﺧﺘﻼف قراءاته. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، واﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ، ﻓﺈن هذه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺿﺎﻓﺖ وﺧﻠﻘﺖ ﺧﻼﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وقد زادت ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺣﺪة اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ـ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ـ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻴﻌﺘﻪ ﺑﺎﻻدﻋﺎء أنّ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻓﺎ اﻟﻘﺮﺁن وأﺳﻘﻄﺎ كثيرًا ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ وﺳﻮرﻩ، وﺣﺬﻓﻮا ﺟﻤﻴﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ اﻹﻣﺎم علي بصراحة إمامًا وخليفة للمسلمين.
المرحلة الثالثة: وهي اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ وقد ﺣﺼﻠﺖ إﺑّﺎن اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻮي وتمّ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻴ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻘﺮﺁن وﻧﻘﻄﻪ، ﻓﻘﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح واﻟﻴﻪ اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ. وﻗﺪ اﻗﺘﻀﻰ الأﻣﺮ أﻳﻀًﺎ ﺑﻌﺪ ضبط اﻟﻘﺮﺁن إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ
(371)ﺗﻤﺠﺪ ﻋﻠﻴًّﺎ، وأهل اﻟﺒﻴﺖ لأﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل لإنكارها. والملاحظ أن بلاشير في أدبياته أطلق على عملية جمع القرآن الكريم تنقيحًا.
وهذه التسمية التي أطلقها بلاشير يريد أن يُوحي من خلالها أنّ القرآن الكريم كأيّ جهد بشري قابل للزيادة والنقّصان والتبديل والتغيير للوصول به لما هو أفضل. وسنشير إلى أنّه من الذرائع المهمة التي تمسّكوا بها ودفعتهم لهذا اللون من التفكير هو ما نقل في عهد الصحابة وفي عهد التابعين أيضًا من طريقة جمع للقرآن الكريم وكيفية كتابته.
توفّي رسول الله والقرآن محفوظٌ في الأذهان، غيرُ مدوَّنٍ ولا مجموعٌ في محلٍّ واحدٍ، وما دُوِّن منه ليس كاملًا.
لا يوجد ما يضمن بقاء القرآن كلّه في الأذهان فإذا كان النبيّ صلىاللهعليهوآله، قد نسيَ بعضه فما الذي يضمن حفظ غيره للقرآن كاملًا دون نقيصةٍ أو زيادةٍ.
وذهب (نولدكه) و(ﻣﻮﻳﺮ) إلى اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺎت ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴًﺎ أو أﺳﻠﻮﺑﻴًّﺎ، ﻓﺼﻨّﻔﺎ اﻟﻘﺮﺁن إﻟﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺛﻼث:
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ: تتعلق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﻪ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ هذا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ الآﻳﺎت اﻟﻤﻜﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ كلّ فترة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎول ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هذه اﻵﻳﺎت.
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺗﺘﻨﺎول اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﻌﺒﺎدات.
وهناك آراء أخرى للمستشرقين في جمع القرآن الكريم وتدوينه يمكن أن نلخّصها بالنّقاط الآتية:
يقول أ.ت ويلش: «إنّ تاريخ القرآن بعد وفاة محمد لا يزال غير واضح، وإن إعداد النسخة الرسمية أو القانونية للقرآن مرّ بثالث مراحل عبر تطورّها، يصعب وضع تاريخ محدّد لكلّ منها، وإن الاعتقاد السائد بين المسلمين هو أن القرآن كان محفوظًا بطريقة شفهية، ثم كتب أثناء حياة النبيّ صلىاللهعليهوآله أو بعد موته بقليل، عندما جُمع ورُتّب لأوّل مرّة بواسطة الصحابة، ثم ظهرت النسخة الأمّ أو المصحف الإمام في عهد الخليفة عثمان».
ويشكّك ويلش في الروايات الواردة في موضوع الجمع فيقول: «إنّ المسلمين قبلوا هذه الروايات على أنّها صحيحة تاريخيًا، وأنّ ما فيها حقّ لا شكّ فيه، مع أنّ هناك مشكلات صعبة تحوط بها، حيث توجد روايات أخرى في كتب الأحاديث المعتمدة تناقض موضوع هذا الحديث».
أما المستشرقان كتاني وإسكواللي فيشكّكان في صحّة واقعة اليمامة التي كانت سببًا لجمع القرآن؛ قائلين: «إنّ عدد الذين استشهدوا في هذه الموقعة من الحفّاظ قليل، وهذا يعني أنّ خبر واقعة اليمامة لا يصلح أن يكون سببًا لانزعاج عمر، ودعوته لجمع القرآن، ويذكر هؤلاء أن عدد الذين استشهدوا من الحفاظ كانوا اثنين فقط».
يرى كثير من المستشرقين أن الآيات القرآنيّة لم تقيّد بالكتابة تحت رقابة النبيّ محمد فلم يضمّها ضمن مجموع كامل، بل اكتفى قبيل وفاته بالإعلان عن نهاية الوحي فقط. وإنّ كتابة بعض المقاطع من القرآن كانت بمبادرة من بعض الصحابة تدريجيًا وبوسائل بدائية ولم يتحقّق التدوين الرسمي لها إلا في عهد عثمان.
يرى نولدكه أن أجزاء من القرآن قد ضاعت، فيضع في كتابه تاريخ القرآن هذا العنوان الواضح: «الوحي الذي نزل على محمد ولم يحفظ في القرآن» وهذا ما تبنّاه المستشرقان اللذان كتبا مادة القرآن في دائرة المعارف؛ إذ ورد فيها: أنه ما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن قد ضاعت».
يقول نولدكه في كتابه تاريخ القرآن إن فواتح السور ليست من القرآن، وإنما هي رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين الأوائل قبل أن يوجد المصحف العثماني، فمثال حرف الميم كان رمزًا لصحف المغيرة، والهاء لصحف أبي هريرة، والصاد لصحف سعد بن أبي وقاص، والنون لصحف عثمان، فهي إشارة لملكية الصحف وقد تركت في مواضعها سهوًا، ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن فصارت قرآنًا».
إذا راجعنا إلى ما كتبه المستشرقون في بحث «جمع القرآن الكريم وتدوينه» نجد أن هناك مجموعة من الشبهات أثيرت على موضوع الجمع، تهدّد سلامة النص القرآني، وتوصل الباحث إلى الشك في صحة هذا النص، بل إلى الاعتقاد بتحريفه، ومن نافلة القول إن هذا البحث هو ناتج عن الأبحاث التي قام بها علماء الإسلام في مجال جمع القرآن الكريم وبالأخص بحث كيفيّة جمع القرآن؟ ومن جمعه؟ والمستشرقون تأثروا بالناتج العلمي لهذه الأبحاث بل بنوا أغلب أفكارهم عليها.
وأثاروا شبهة التحريف ووقوع الزيادة والنقصان في سور القرآن وآياته، محتجّين بما جاء في كتب الحديث والصحاحّ والسيرة وكتب التاريخ والتفسير عن قضيّة جمع القرآن وترتيبه بعد العصر النبوي.
والغريب في هذا الأمر أن جملة من علماء العامة يصرّون على جمع المصحف بعد العهد النبوي، بل يعمدون إلى تأكيد صحّة هذه الروايات؛ لأنّها واردة في كتب الصحاح، وهذا الأمر قد زاد من موقف المستشرقين المشكّكيين في سلامة القرآن وحفظه من التحريف، صلابةً وقوة؛ لأنّ إقرار هؤلاء العلماء ورجال الديّن بصحّة هذه الروايات ـ التى ليس للمشكّكين حجّة سواها للنيل من القرآن ـ شكّل ركيزة أساس وحجة قويّة لهم ظاهرًا للتأكيّد على عدم حفظ القرآن ووقوع التحريف فيه، فليس هناك حجّةً أقوى من شهادة شاهد من أهلها. وهكذا أقاموا شبهاتهم، انطلاقًا من قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
(375)وملخّص ما يذهب إليه هؤلاء المستشرقين؛ وهو قول أكثر علماء أهل السنة أنّ القرآن لم يتمّ تدوينه وجمعه في كتابٍ رسميٍّ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يكن لدى الصحابة آنذاك كتابًا مجموعًا بين دفتين، وإن كان مكتوبًا في صحف متفرقة.
وللأسف بعض الباحثين بل أغلب المتعصبيّن من الوهابيّة وغيرهم ولأسباب معروفة، ولحقد دفين على الشيعة والتشيّع، يفترون على الشيعة، ويعتبرون أن علماء الاستشراق تأثروا بالشيعة في موضوع جمع المصحف، وتأثروا بهم أيضًا في موضوع التحريف كما تقدّم، وفي سورتي الحفد والخلع مع أن هاتان السورتان المدّعتان لا أثر لهما في مصادر الشيعة بخلاف مصادر العامة، وغير ذلك من التهم الزائفة والمزورّة ولكن على قاعدة قلب الحقائق وإبعاد التهمّ عن علماء السلف. نأسف أن يصل مستوى البحث إلى هذا الحدّ من الإسفاف والتجنّي على الحقيقة.
وبناءً على هذا الرأي لعلماء السنّة ذهب الكثير من المستشرقين إلى هذا القول وعبّروا عنه بصيغ متنوّعة:
يرى ثيودور نولدكه: أن القرآن لا يمكن أن يكون قد جُمع في عهد النبيّ.
يذهب بلاشير إلى الاعتقاد بأنّ تاريخ القرآن وتطوّر العلوم القرآنيّةكان رهنًا بثلاثة عوامل:
1- استخدام خطّ بدائي لكتابة القرآن.
2- ضياع نسخة من الوحي كتبت بإشراف شخصي من النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله.
3. بالالتفات إلى ما تقدّم، يثبت ضعف الكتابة، وضياع النص الثابت، والاعتماد على الحفظ من الذاكرة والنقل مشافهة.
ويرى مونتغمري وات: أن القرآن جُمع رسميًا عام 650 للميلاد أي بعد مضي ثماني عشرة سنة على رحيل رسول الله صلىاللهعليهوآله.
ويذهب آرثر جيفري إلى القول بأنّ أبا بكر هو أول من كتب القرآن على صحف كبيرة. ثم قام عثمان بنشر هذه المصاحف بغية توحيد القراءات على قراءة واحدة.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عليهالسلام قَالَ: «إن رَسُولَ اَللَّهِ صلىاللهعليهوآله قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ القرآن خَلْفَ فِرَاشِي فِي اَلصُّحُفِ وَاَلْحَرِيرِ وَاَلْقَرَاطِيسِ فَخُذُوهُ وَاِجْمَعُوهُ وَلاَ تُضَيِّعُوهُ كَمَا ضَيَّعَتِ اَلْيَهُودُ اَلتَّوْرَاةَ فَانطَلَقَ عَلِيٌّ عليهالسلام فَجَمَعَهُ فِي ثَوْبٍ أَصْفَرَ ثم خَتَمَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ: لاَ أَرْتَدِي حَتَّى أَجْمَعَهُ فَانهُ كَان اَلرَّجُلُ لَيَأْتِيهِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ حَتَّى جَمَعَهُ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: لَوأن اَلنًاسَ قَرَؤوا القرآن كَمَا انزَلَ اَللَّهُ مَا اِخْتَلَفَ اِثْنَان».
وهذه الرواية تدّل على أن الرسولّ صلىاللهعليهوآله أمر بجمع القرآن والإمام علي عليهالسلام هو الذي جمعه بأمر مباشر من الرسول صلىاللهعليهوآله وذلك في حياته صلىاللهعليهوآله كما يستفاد من ظاهر الرواية. وهناك أدلّة كثيرة تفيد أن القرآن الكريم قد جمع في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله. وعلى ذلك اتفقت كلمة جمهور فقهاء الشيعة ففي مجمع البيان نقلًا عن السيد المرتضى قدسسره
أنه قال إنّ القرآن جمع في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشكل الذي هو اليوم بأيدينا.
وبذلك قال الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، وشيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم وغيرهم من كبار علماء الشيعة وهذا هو قول الإمامية إلى يومنا هذا.
فـ»القرآن الكريم جُمع في زمن الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، غير أنه لم يوضع في كتاب واحد كما عليه الكتاب طيلة القرون اللاّحقة، وإن الترتيب الذي عليه القرآن هو نفسه الترتيب الذي أقرّه الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله، وهذا القول تسنده روايات صحيحة وكذلك يرجحه العقل، لوضوح عدم مقبوليّة العقل أن يترك النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله الأمّة بدون أن يجمع لها كتابها الذي عليه المُعَوَّل، بل هو المرجع الأساس لهم في دنياهم وآخرتهم، وغاية ما فعله الخلفاء بعد وفاة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله هو أنهم جمعوا الناس على كتابٍ واحدٍ ولسان واحدٍ».
من الواضح أن آراء المستشرقين في مسألة الجمع كانت مستندة إلى آراء علماء السنة من أنّ جمع القرآن كان بعد زمان النبيّ، وأن أوّل عملية جمع وتدوين للقرآن تنسب إلى الخليفة الأوّل أبي بكر.
وقد ذهب المستشرقون إلى هذه النظرية تبعًا لشيخ المستشرقين الألمان ثيودور نولدكه.
إن الذي يمكن قوله بضرس قاطع هو أن استشهاد الحفّاظ للقرآن في حرب
اليمامة لا يمكن له أن يشكّل الذريعة الرئيسة لأبي بكر في الدعوة إلى جمع القرآن؛ وذلك لوجود صحابة آخرين حافظين للقرآن؛ من أمثال: أبيّ بن كعب في دمشق، أو المقداد في حمص، وآخرين... وكان لدى كلّ واحدٍ منهم مصاحف، يُضاف إلى ذلك أزمة خلافة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله التي تعرض لها المسلمون مؤخرًا وكانت تشغل حيّزًا كبيرًا من اهتمام الخليفة! ولكن من ناحية أخرى كان الإمام علي عليهالسلام قد جمع القرآن بأمر من النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله. وعليه لا بد من التغطية على هذه الفضيلة وطمسها بنحو من الانحاء. وبذلك فقد بادروا إلى القيام بعمل من عند أنفسهم، فعمدوا في المرحلة الأولى إلى جمع القرآن مجرّدًا عن أيّ نوع من أنواع التفسير، ولنسبة كرامة مفترضة للخليفة الأول في حفظ القرآن الكريم.
بيد أن هذا الجمع غير قابل للإثبات حتى بالدليل العقلي؛ وذلك لأنّ المسلمين لوكانوا بحاجة إلى قرآن مجموع حقيقة لما تحوّل هذا القرآن إلى مصحف خاص لأبي بكر، ولما أضحى داخلًا ضمن ممتلكاته الشخصية، فبقي عنده حتى موته ولم ينعم المسلمون بثمار هذا المجهود الذي بذلته الحكومة في عهد الخليفة الأول. وعليه لا نستطيع القول باعتبار جمع للقرآن تحقّق في عهد الخليفة الأول بوصفه أول من جمع القرآن، بل إنّ الذي تولى القيام بهذه المهمّة الخطيرة هو شخص النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله في حياته.
يقول نولدكه في هذا المجال «تقول روايات مختلفة إنّ عليًا بن أبي طالب.. كان وراء جمع القرآن.. لكي يأخذ الكرامة من أبي بكر.. لا شيء من الصحّة في هذا كله. فمصادر هذه الأخبار تفاسير قرآنية شيعية وكتب تاريخية سنية ذات أثر شيعي مشكوك بأمرها، ذلك أن كل ما يرويه الشيعة عن وليّ شيعتهم الأعلى غير موضوعي ومنحاز بجملته».
ويشكك بلاشير في موضوع جمع القرآن على يد أمير المؤمنين عليهالسلام فيقول: إنّ موقف الخوارج والشيعة هو الذهاب إلى القول من دون شك إن عليًا قد اهتمّ بهذا الأمر في حياة النبيّ قبل أيّ شخص آخر من الصحابة. بيد أن هذا التأكيد مقرون بالشك والتردّد.
يمكن لنا أن نستبين بعض الخبث في دراسات المستشرقين. فإنهم تبعًا لبعض المتعصبين، لا يرون أيّ فضيلة للإمام علي عليهالسلام في ما يتعلّق بجمع القرآن الكريم. في حين أنّ هناك روايات مستفيضة يتداولها العلماء من الفريقين بشأن مصحف الإمام علي عليهالسلام وعدِّه من قبلهم أول من جمع القرآن الكريم بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله أما جمعه في عهد أبي بكر خاليًا من أي تفسير أو تهميش، فقد كانت الغاية من وراء ذلك سياسية بحتة.
وسنكتفي بالرّد على «بلاشير» في جمع القرآن في زمن النبيّ، أما كلامه في جمعه في زمن الخليفة الأول أو الخليفة الثالث فلن نتعرض له خشية الإطالة مع وجود ملاحظات كثيرة عليه. وكذلك على «نولدكه» في تقسيمه الآيات لأن كثيرًا من المستشرقين تأثروا بهما، ومن خلال هذه الردود عليهما تتبيّن الردود على أقوال المستشرقين الأخرى المشابهة لكلامهما.
إن قوله: «يبدو أن فكرة تدوين مقاطع الوحي الهامة التي نزلت في السنوات السالفة على مواد خشنة من الجلود واللّخاف، لم تنشأ إلاّ بعد إقامة محمد في المدينة» لا يستند إلى دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ، ذﻟﻚ أن كُتّاب اﻟﻮﺣﻲ ﺑﺪؤوا ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ
اﻟﻬﺠﺮة، وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺷﻔﺎهًا ﻓﻘﻂ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ أرّﺧﺖ ﻟﺘﻠﻚ الفترة ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻮﺟﻮد أﻧﺎس في مكة ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﺑﻞ إنّ أهل اﻟﺒﻮادي ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎهلي كانوا ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﻣﺒﻌﺜﺮة ﻓﻲ أماكن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أهل اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
أﻣﺎ أهل الحضر ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن وﻳﻘﺮؤون، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻨﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮؤوا اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻷﺧﺮى وﺑﻠﻐﺎت ﻋﺒﺮﻳّﺔ وأﺟﻨﺒﻴّﺔ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم في ﺑﻤﻜﺔ كان ﺑﻬﺎ ﻗﻮم ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺑﻞ واﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ كتب اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى وكتب ﻓﺎرس أﻳﻀًﺎ، وواﻗﻌﺔ ﻓﺪاء أﺳﺮى ﺑﺪر ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺒﻴﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺸﻬﻮرة، ويؤكد اﻟﻤؤرﺧﻮن أﻧّﻪ ﻟﻤﺎ ﻧﺰل اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻲ ﻣﻜﺔ كان ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ رﺟلًا كلّهم ﻳﻜﺘﺐ، ﺳﻤّﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن، وأبا عبيدة بن الجراح، وطلحة.
فظاهرة كُتّاب الوحي مسألة مسلَّمة بين المؤرخين والمفسرين وإن اختلفت الآراء في الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلىاللهعليهوآله عدًّا وتشخيصًا، حتى لقد عدّ بعضهم من لم يكتب الوحي في جملة من كتبه، وآخرون أهملوا من كتّاب الوحي وعدّوا في من لم يكتبه، ولكن لا شك في وجود ما يسمى «كُتّاب الوحي» وذلك قبل الهجرة النبويّة الشريّفة.
يقول الرافعي: واتفقوا على أن من كتب القرآن وأكمله وكان قرآنه أصلًا للقرآنات المتأخرة: علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود.
وقد أورد الطبرسي رحمهالله في كتاب الاحتجاج حديث احتجاج أمير المؤمنين علي عليهالسلام
على جماعة من المهاجرين والأنصار، حيث يقوله فيه: «يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلىاللهعليهوآله عندي بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلىاللهعليهوآله وكل حرام وحلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط يدي حتى أرش الخدش...».
وهناك أدلة كثيرة تثبت كتابة القرآن الكريم قبل الهجرة النبويّة؛ أي في الفترة المكيّة نذكر منها:
1- قال ابن عباس عن سورة الأنعام: «هِيَ مَكِيَّة، نَزَلَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، نَزَلَتْ لَيْلًا، وَكَتَبُوْهَا مِنْ لَيْلَتِهِمْ غير ست آيات منها...».
2- قصة إسلام عمر بن الخطاب: فقد جاء في تفاصيل إسلامه: «فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة، فيها (طه) يقرئهما إياها، فلما سمعوا حس عمر، تغيب خباب في مخدع لهم، أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها».
3- في سيرة رافع بن مالك: وهو صحابي من أوائل من أسلم من الأنصار في مكة قبل بيعة العقبة، وأحد النقباء عن بني زريق يوم العقبة، وتردد على مكة قبل الهجرة، وقد جاء في سيرته: إنه هاجر إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله وأقام معه بمكة فلما نزلت سورة طه كتبها ثم أقبل بها إلى المدينة فقرأها على بني زريق. وكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة.
4- ومن شواهد حرص النبيّ صلىاللهعليهوآله على التدوين أنه لما هاجر إلى المدينة حمل معه أدوات الكتابة في أشد الأوقات وأصعبها.
إنّ التحريف الذي نسبه (بلاشير) إلى الشيعة كلام من دون دليل، لأنّ الشيعة بالإجماع ينفون تحريف القرآن الكريم. يقول الشيخ الطبرسي: «إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة فإنّ العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء فيما ذكرناه... لأنّ القرآن مفخرة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينيّة، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّرًا أو منقوصًا مع العناية الصادقة والضبط الشديد».
وهذا الكلام أيضًا لا دليل عليه، فما نقله لنا التاريخ أنّ ما قام به الحجاج هو مجرد إعجام القرآن الكريم ولم يُنقل لنا حذف أيّ آية تمجّد الإمام علي كما ادعى (بلاشير) بل المنقول أنّه بعد اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻹﺳﻼم واﺧﺘﻼط اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻌﺠﻢ وﺗﻔﺸّﻲ اﻟﻠﺤﻦ وﺑﺪأ اﻟﻠﺒﺲ واﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮﺁن ﻳﻠﺢ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻖّ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻬﺘﺪوا إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف اﻟﻤﺼﺤﻒ وكلماته، وهي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺠﻤﺔ، هناك أﻣﺮ اﻟﺤﺠﺎج هذا اﻷﻣﺮ اﻟﺨﻄﻴﺮ، ﻓﻨﺪب اﻟﺤﺠﺎج ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻠﻴﺜﻲ، وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺪواﻧﻲ، ﻓﺄﻋﺠﻤﺎ اﻟﻤﺼﺤﻒ، وﻧﻘﻄﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺮوﻓﻪ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ...». ومع ما في هذه الروايات من شك، فروح الدسّ والوضع من أنصار الأمويين ونسبة مثل هذه الأعمال إلى الحجاج وأمثاله من الطغاة والجبابرة في التاريخ الأموي، لا تخفى على القارئ اللبيب.
يعتقد بلاشير أن تاريخ القرآن والتطوّر الذي حصل في العلوم القرآنية مرتبطٌ بعواملَ ثلاثةٍ، هي:
1- الاستفادة من نُسخٍ خطيّةٍ ناقصةٍ.
2- فقدان نسخةٍ من القرآن مدوّنةٍ تحت إشراف النبيّ.
3- بناءً على ما ذكر من (نقص في الكتابة وفقدان متنٍ ثابتٍ لا يتغيّر) كان من الضروريّ الاعتماد على الحافظة والنقل الشفهي في جمع القرآن وحفظه.
والنتيجة التي ينتهي إليها بلاشير هي وجود فاصلةٍ زمنيةٍ بين نزول الوحي وبين تدوينه وجمعه، والدلائل التي يستند إليها في تأسيس مدّعياته في هذا المجال، يمكن حصرها في ما يأتي:
1- عدم وعي النبيّ بأهميّة رسالته.
2- عدم توفر الوسائل اللازمة.
كلام (بلاشير) عن عدم وعي النبيّ بأهمية رسالته واقعًا لا معنى له وقد لا يستحق الردّ فرسول الله، لم يكن ينقصه وعيٌ وفهمٌ لمعرفة مدى أهميّة ما يحمل من رسالةٍ إلى الناس، بل كان بصيرًا بأمر رسالته حريصًا على مستقبلها غاية الحرص، كما قال الله تعالى واصفًا النبيّ: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.
طبعًا هناك أمور استند عليها (بلاشيرم)ن روايات، وأحداث تاريخية، ومعتقدات يتبناها الجمهور، قد توصل الباحث إلى هذه النتائج الخطيرة؛ تبعًا للمصادر التي عتمد عليها، من قبيل بعض الروايات التي تُظهر النبيّ بمظهر الناسي لآيات القرآن الكريم من قبيل ما روي «عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
و[آله] وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَا، آيَةً كُنْتُ أنسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا «، مع أن الله تعالى قد وعد النبيّ بالحفظ وعدم النسيان كما في قوله: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ﴾ .
أو اعتماده على ما يعتقده العامة في موضوع الخلافة، فبلاشير يرى أن مسألة الخلافة كانت أهمّ من مسألة جمع القرآن ومع ذلك أغفلها النبيّ والمسلمون، وبالتالي فمن الطبيعيّ أن يتركوا الأمر الأقلّ أهميّة! مع أنه من أوضح الواضحات في معتقدات الإمامية أن تعيين الخليفة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله هو ضرورة عقلية وشرعية، وقد قام النبيّ صلىاللهعليهوآله بذلك فعلًا بتعيين الإمام أمير المؤمنين علي عليهالسلام للخلافة من بعده.
قد استعمل العرب قبل الإسلام قراطيس من ورق البردي المصري أو الرقاق المصنوعة من الجلود، وإنما استعمل بعض الصحابة غيرها من الأكتاف والألواح واللخاف لوفرتها وسهولة مسحها وإعادة استعمالها خلافا للرقاع من الورق أو جلد الغزال.
فقد استعمل العرب القراطيس في الكتابة والمراسلة، وراسل النبيّ صلىاللهعليهوآله ملوك عصره وقبائل العرب وكتب إلى الأنصار قبل الهجرة وكتبوا إليه، ولعل قصة المرأة التي أرسل معها حاطب بن أبي بلتعة رسالة لقريش تؤكد اعتماد الكتابة على قراطيس خفيفة يمكن حملها وحتى إخفاؤها بسهولة.
وقد كتب بعض الباحثين في مجال «كتابّة القرآن في العهد المكّي» وتوصّل إلى نتائج مهمة في هذا المجال أهمّها أنّ حالة الكتابة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تكن مرثيًا لها كما وصفها المؤرخون، وأنّ القرآن المكي قد كتب كلّه في مكّة، ثم
نُقل من مكّة المكرّمة الى المديّنة المنوّرة عن طريق الصحابة الذين كانوا ينتقلون بينهما من المهاجرين والأنصار؛ أمثال: رافع بن مالك. كما أنّ المسلمين استخدموا الجلد الرقيق، ونوعًا من الورق (الورق البردي) قبل ظهور الورق الصيني لكتابة القرآن الكريم وغيره، وما يروى من أنّ القرآن الكريم جمع من العسب واللخاف والأكتاف... إنما ورد في مجال التتبع والجمع الذي أريد به إشراك كل من عنده شيء من المكتوب في عهد أبي بكر، ومن باب الاحتياط لزيادة توثيق النص القرآني، وذلك لورود ما يفيد صراحة بأنّ القرآن الكريم كان يؤلف من الرقاع بإشراف الرسول صلىاللهعليهوآله، وهي إمّا من جلد أو ورق.
لقد بدأ اهتمام المستشرقين بترتيب نزول القرآن منذ القرن التاسع عشر، ولم يكتفوا بالتقسيم الذي تعارف عليه المسلمون من تقسيم القرآن إلى الحِقبتين: المكية والمدنية، بل عمد بعضهم إلى خصوص السور المكية فقسمها إلى ثلاث مراحل كما صنع (ثيودور نولدكه)، متأثرًا بصنيع سلفه المستشرق (جوستاف فايل)، ونجد لهذا التقسيم جذورًا حتى عند بعض المسلمين القدامى، وهو أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري إذ يقول في كتابه (التنبيه إلى فضل علوم القرآن): «من أشرف علوم القرآن، علم نزوله، وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة: ابتداءً ووسطًا وانتهاءً، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك...».
والرد التفصيلي على نولدكه وبيان الوهن والضعف في هذا التقسيم يحتاج إلى دراسة تفصيلية ولكن نشير إجمالًا إلى ما قاله بعض الباحثين في هذا المجال «أن (نولدكه) لم يأتِ بمعايير جديدة غير تلك التي ذكرها من سبقه من المسلمين
والمستشرقين، بحسن نية أو سوء نية، وقد تقدم أن أجبنا عن مدى صدقية هذه المعايير في معرض الحديث عن ظاهرة المكي والمدني، والتمييز بينهما في مطلع هذا الفصل، وبذلك نجد أنفسنا في غنى عن التكرار والإسهاب والإعادة. ومن الواضح أيضًا أنّ نولدكه شأنه في ترتيب نزول السور شأن المسلمين الأوائل الذين ميزوا بين الأسلوب المكي والمدني من السور (وسيأتي البحث عن المكي والمدني )، فقد استخرج هذه الخصائص والمعايير من السور المكية والمدنية بعد التعرف عليها عبر الرواية التاريخية، وعليه فإنّ جعل هذه الخصائص علامات للتمييز بين المكي والمدني أشبه بالدور. ولو سلمنا جدلًا بصحة هذه المعايير التي أعاد (نولدكه) اجترارها في بيان الترتيب التاريخي لترول سور القرآن، فإنما يقتصر نجاحه ـ إذا كتب له النجاح ـ على تحديد تاريخ نزول مجموعة من السور ضمن فترة زمنية بعينها، فنعلم أن الفترة المكية الثالثة قد شهدت مثلًا نزول السور رقم: ٣٢ و٤١ و٤٥ و١٦ و٣٠، ولكن ما هو المتقدم منها وما هو المتأخر ضمن هذه الفترة الواحدة؟ هذا ما لم يستطع (نولدكه) الجزم به بضرس قاطع. بل اعترف غير مرة بعجزه عن ذلك، كما ذكرنا مرارًا. لا بل إّنه عاب على (وليم مويرم)نهجه في تعيين تاريخ آحاد السور، قائلًا: (أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم، فهي انه يسعى إلى ترتيب السور واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا. وهو يتواضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه تمامًا، لكن هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه».
وملاحظة أخيرة على منهج المسشترقين فقد أشرنا في الأبحاث السابقة، إلى الانتقائية عند المستشرقين في التعامل مع المصادر، وفي مبحث جمع المصحف نرى بشكل واضح هذه الانتقائية في التعامل مع المصادر، والملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا المجال؛ هي:
أولًا: ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻴﺔ في مجال جمع المصحف ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ السني ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ.
ثانيًا: ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻮﺟﺪﻭﺍ ﺿﺎﻟّﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺎﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﺷﺎﺩﻭﺍ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻭﻧﺸﺮﻭﻫﺎ في بلاد المسلمين.
على سبيل المثال نذكر ما قام به المستشرق آرثر جيفري في موضوع «المصاحف»؛ فهو كما أشرنا سابقًا نشر كتاب «المصاحف» لابن أبي داود (ت316) وهو نجل ابن داود صاحب كتاب السنن. وفي الكتاب روايات ضعيفة جدًا اعتمدها جيفري وغيره من المستشرقين للطعن في موثوقية النص القرآني.
ولكي يثبت عدم موثوقية النص القرآني اعتمد على جملة من الروايات الضعيفة ليثبت تطور حركة المصاحف وأنّ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪ ﺗﻐﲑّ ﻭﺗﺒﺪّﻝ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﺇﱃ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻣﺮّﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪّﺩﺓ ﻭﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻧﺸﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺼﺎﺣﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺮّ ﺍﻟﻌﺼﻮر. ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺗﻄﻮّﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﻭﻫﻲ:
1- ﻃﻮﺭ ﺍﳌﺼﺎﺣﻒ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ.
2- ﻃﻮﺭ ﺍﳌﺼﺎﺣﻒ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ بعثت إلى الأمصار.
3- ﻃﻮﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ.
4- ﻃﻮﺭ ﺗﺴﻠّﻂ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ.
5- ﻃﻮﺭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ.
6- ﻃﻮﺭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﻔﺺ ﻭﻫﻮ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ.
من المباحث المهمة في تاريخ القرآن مبحث تقسيم السور والآيات القرآنية إلى مكّي ومدني وهناك آراء متعدّدة حول هذا الموضوع سواء من المسلمين أومن المستشرقين.
وقد تعرّض جملة من هؤلاء من قبيل: لامنس، وبلاشير، ونولدكه، لبحث المكّي والمدني وطرحوا مجموعة من الآراء والنظريات عن هذا الموضوع. وسنمهّد لمناقشة شبهات هؤلاء المستشرقين بتحديد معنى المكي والمدني وبيان طريقة معرفتهما، ونعرض بعد ذلك شبهات هؤلاء المتعلقة بالمكي والمدني سواء من جهة ادعاء تأثر القرآن بالبيئة، ومن هنا كان التقسيم، أو الإشكالات التي أثاروها على المعيار المضموني في التفريق بين المكي والمدني، أو المعيار الأسلوبي في التمييز، ونختم هذا المبحث بنقد شبهة التاريخية وتأثر النص القرآني بالظروف التاريخية لنزوله.
يُقْسّم القرآن في عرف علماء التفسير إلى مكّي ومدني فبعض آياته مكّية وبعض آياته مدنية وتوجد في التفسير اتجاهات عديدة لبيان هذا المصطلح.
الاتجاه الزماني: القائم على أساس الترتيب الزماني للآيات واعتبار الهجرة حدًا زمنيًا فاصلًا بين مرحلتين فكل آية نزلت قبل الهجرة تعتبر مكّية وكل آية نزلت بعد الهجرة فهي مدنية وإن كان مكان نزولها مكّة فالمقياس هو الناحية الزمنية لا المكانية.
الاتجاه المكاني: هو الأخذ بالناحية المكانية مقياسًا للتميّز بين المكّي والمدني فكل آية يلاحظ مكان نزولها فإن كان النبيّ صلىاللهعليهوآله حين نزولها في مكة، سميت مكّية وإن كان حينذاك في المدينة سميت مدنية.
(391)الاتجاه الخطابي: يقوم على أساس مراعاة أشخاص المخاطبين فهو يعتبر أن المكّي ما وقع خطابًا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة.
إنّ لفظ المكّي والمدني ليس لفظًا شرعيًا حدّد النبيّ مفهومه لكي نحاول اكتشاف ذلك المفهوم وإنما هو مجرد اصطلاح تواضع عليه علماء التفسيّر ولكنّنا نرى أن وضع مصطلح المكّي والمدني على أساس الترتيب الزمني كما يقرّره الاتجاه الأول أنفع للدراسات القرآنيّة لأنّ التمييز من ناحية زمنية بين ما أنزل من القرآن قبل الهجرة وما أنزل بعدها أكثر أهمية للبحوث القرآنيّة من التمييز على أساس المكان بين ما أنزل على النبيّ في مكة وما أنزل عليه في المدينة فكان جعل الزمن أساسًا للتمييز بين المكّي والمدني واستخدام هذا المصطلح لتحديد الناحية الزمنية أوفق بالهدف.
بدأ المفسرون عند محاولة التّمييز بين المكّي والمدني بالاعتماد على الروايات والنصوص التأريخية، التي تؤرخ السورة أو الآية وتشير إلى نزولها قبل الهجرة أو بعدها، وعن طريق تلك الروايات والنصوص التي تتبّعها المفسرّون واستوعبوها استطاعوا أن يعرفوا عددا كبيرًا من السور والآيات المكّية والمدنية ويميّزوا بينها.
ويمكن تلخيص ما ذكروه من الخصائص الأسلوبية والموضوعية للقسم المكّي في ما يأتي:
1- قصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي.
2- الدعوة إلى أصول الايمان بالله والوحي وعالم الغيب واليوم الآخر وتصوير الجنة والنار.
3- الدعوة للتمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير.
4- مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم.
5- استعمال السورة لكلمة «يا أيها الناس» وعدم استعمالها لكلمة «يا أيها الذين آمنوا».
وأما ما يشيع في القسّم المدني من خصائص عامة فهي:
1- طول السورة والآية وإطنابها.
2- تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينيّة.
3- مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم.
4- التحدّث عن المنافقين ومشاكلهم.
5- التّفصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين السياسية والاجتماعية والدولية.
والصحيح أن هذه الخصائص التي ذكرها علماء التفسير قد تؤدّي إلى ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في السور التي لم يرد نص بأنّها مكّية أو مدنية ولكن الاعتماد على تلك المقاييس إنما يجوز إذا أدّت إلى العلم، ولا يجوز الأخذ بها لمجرد الظن. فالفروق التي ذكرت لا تتسم بالكلية بل بالأغلبية النسبية ولا معنى للمبالغة في هذه الخصائص.
يقول العلامة الطباطبائي: «وللعلم بمكية السور ومدنيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام في الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبوية، وسيرها الروحي والسياسي والمدني في زمنه صلىاللهعليهوآله وتحليل سيرته الشريفة، والروايات -كما ترى- لا تصلح أن تنهض حجة معتمدًا عليها في إثبات شيء من ذلك على أن في ما بينها من التعارض ما يسقطها عن الاعتبار. فالطريق المتعين لهذا الغرض هو التدبر في سياق الآيات والاستمداد بما يتحصل من القرائن والأمارات الداخلية والخارجية، وعلى ذلك نجري في هذا الكتاب».
ما تقدّم هو مجمل ما أورده العلماء، في بيان الفروق بين المكي والمدني، وقد وضعها العلماء بعد ملاحظة واستقراء، ولكنهم لا يعتقدون أنّها قواعد كليّة.
وإذا لاحظنا جهود المستشرقين في مجال الدراسات القرآنيّة نجدها تتجه، -كما تقدّم- إلى إثبات أن القرآن الكريم من وضع النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله، وأنه لا صلة له بالوحي إطلاقًا، وقد تعدّدت مسالك المستشرقين، في الترويج لأفكارهم، وكان من بين الأبواب التي ولجها المستشرقون، باب المكي والمدني.
وقد أغرى هؤلاء في هذا المجال وجودُ دراسات في التراث الإسلاميّ أقرَّ فيها أهلها أن ثمة خصائص وميزات لكل من المكي والمدني -سبق ذكرها- ترقى لأن تصبح فروقًا قائمة برأسها.
وسعى المستشرقون إلى تضخيم هذه الخصائص، وإلى توظيفها بطريقة سيئة بتفسيرها في ضوء المنهج الذاتي الذي سيطر على دراستهم وهو يقوم على استحضار المستشرق لانتماءاته سواء أكانت دينية، أو علمية أو تاريخية، عند دراستهم لمباحث العلوم الإسلاميّة، بحيث جاء نتاجهم وبدرجات متفاوتة، مستجيبًا لثقافاتهم، لا لما تفرضه الدراسة العلميّة للمصادر الإسلاميّة من نظريات ورؤى. فجاء كلامهم متضمّنًا عددًا من المغالطات نعرض لها بإيجاز ونبيّن تهافتها.
وأساس هذه الشبهات هو: أن الفروق والميزات التي تلاحظ بين القسم المكّي من القرآن الكريم والقسّم المدني منه تدعو في نظر بعض المستشرقين إلى الاعتقاد بأنّ القرآن قد خضع لظروف بشرية مختلفة - اجتماعية وشخصية - تركت آثارها على أسلوب القرآن وطريقة عرضه، وعلى مادته والموضوعات التي عني بها.
(394)توهّم جملة من المستشرقين: أمثال نولدكه، جولدتسيهر، لامنز، وبلاشير، وكازانوفا، وغيرهم أن القرآن الكريم كان متأثرًا بالبيئة لا مؤثرًا فيها، وتعتبر هذه الفكرة أيّ تأثر القرآن أو تأثيره من الأبحاث التأسيسة في الرد على هذه الشبهات.
فقد زعم بلاشير أن الفروق بين المكّي والمدني، تدل على وجود قرآن مكّي، وآخر مدني، لا صلّة بينهما من الناحية الأسلوبيّة والمضمونية، وهذا ما قاله بلاشير في كتابه «مدخل إلى القرآن» وهذا يعني عنده تأثر القرآن بالبيئتين المكيّة والمدنية، الأمر الذي يدل بزعمه وزعم غيره على بشريّة القرآن الكريم.
ولذا «لا بدّ لنا أن نفرّق بين فكرة تأثر القرآن الكريم، وانفعاله بالظروف الموضوعية من البيئة وغيرها، وبين فكرة مراعاة القرآن لهذه الظروف بقصد تأثيره فيها وتطويرها لصالح الدعوة.
فإنّ الفكرة الأولى تعني في الحقيقة: بشريّة القرآن، حيث تفرض القرآن في مستوى الواقع المعيش وجزءًا من البيئة الاجتماعية يتأثر بها كما يؤثر فيها، بخلاف الفكرة الثانية فإنّها لا تعني شيئًا من ذلك، لأنّ طبيعة الموقف القرآني الذي يستهدف التغيير، وطبيعة الأهداف والغايات التي يرمي القرآن إلى تحقيقها قد تفرض هذه المراعاة، حيث تحدّد الغاية والهدف طبيعة الأسلوب الذي يجب سلوكه للوصول إليها».
فهناك فرق بين أن تفرض الظروف نفسها على الرسالة، وبين أن تفرض الأهداف والغايات- التي ترمي الرسالة إلى تحقيقها من خلال الواقع- أسلوبًا ومنهجًا للرسالة؛ لأن الهدف والغاية ليس شيئًا منفصلًا عن الرسالة ليكون تأثيرهما عليها تأثيرًا مفروضًا من الخارج.
فنحن في الوقت الذي نرفض فيه الفكرة الأولى بالنسبة إلى القرآن نجد أنفسنا لا تأبى التمسّك بالفكرة الثانية في تفسير الظواهر القرآنيّة المختلفة، سواء ما يرتبط منها بالأسلوب القرآني أو الموضوع والمادة المعروضة فيه.
قالوا إنّ القسّم المكّي يتفرد بالعنف والشدّة والقسّوة والحدّة، والغضب والسباب والوعيد والتهديد.
وبما أنّ السور المكيّة فيها عنف، وشدّة وسباب، وتقريع لأهل مكّة، فهذا يدل على تأثر النبيّ بالبيئة المكيّة، وتكيَّف حديثه مع ما يمتاز به أهل مكّة من غلظة وجهل وعناد.
- قولهم إن في القرآن المكّي يوجد سباب، فهذا كلام غير صحيح من جهتين:
الأولى: لا يعقل أن القرآن الذي جاء يعلم الناس أصول الآداب يخرج هو عن أصول الآداب إلى السباب؟
قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ فالله عز وجل في هذه الآية نهى عن السب والشتم.
والآية تذكر أدبًا دينيًا تصان به كرامة مقدّسات المجتمع الديني وتتوّقى ساحتها أن يتلوث بدرن الإهانة والإزراء بشنيع القول والسّب والشتم والسخرية ونحوها
فإن الإنسان يدافع عن كرامة ما يقدّسه،... فلو سب المؤمنون آلهة المشركين حملتهم عصبية الجاهلية أن يعارضوا المؤمنين بسب ما له عندهم كرامة الألوهية وهو الله عز اسمه ففي سب آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره تعالى بما لا يليق بساحة قدسه وكبريائه.
الثانية: أما احتجاجهم بسورة المسد أو التكاثر نقول وليس في السورتين أيُ سب أو بذاءة - كما يحاول المستشرقون أن يقولوا ذلك – وإنما فيهما تحذير ووعيد بالمصير الذي ينتهي إليه أبو لهب والكافرون بالله. نعم، يوجد في القرآن الكريم تقريع وتأنيب عنيف، وهو موجود في المدني كما هو في المكّي. ومن صور التقريع الذي ورد في السور المدنية نذكر الآتي:
قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾.
وقوله: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾. وغيرهما من الآيات.
- أما قولهم إن القسّم المكّي قد تفرد بالعنف والشدّة فينقضه أن في القسّم المدني شدةً وعنفًا فدعواهم بالتفرد باطلة. وإنما اشتمل القرآن الكريم بقسميه المكّي المدني على الشدة والعنف لأن ضرورة التربية الرشيدة في إصلاح الأفراد والشعوب تقضي أن يمزج المصلح في قانون هدايته بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والشدة واللين.
كما أن القسّم المدني لا يختص أيضًا -كما قد يفهم من الشبهة- بالأسلوب اللين
الهادئ الذي يفيض سماحة وعفوًا، بل نجد ذلك في المكّي، والشواهد القرآنيّة على ذلك كثيرة.
فمن القسّم المدني الذي اتسم بالشدة والعنف قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.
وقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ . إلى غير ذلك من الآيات.
كما نجد في القسّم المكّي لينا وسماحة نحو قوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.
وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.
يرى المستشرقون أن البيئة المكية كانت بيئة أمية، مغلقة، فناسب أن تأتي السور قصيرة، وكذا الآيات، في حين أن المدينة كانت متحضرة بسبب وجود اليهود فناسب أن تأتي السور المدنية طويلة وكذا آياتها.
والفكرة التي يريد هؤلاء طرحها من خلال هذه الشبهة هي أن هذا التفاوّت في القصر والطول للآيات والسور القرآنيّة يعــود إلى تأثّر النبيّ بالبيئة التي عاشــها، حيث كان المجتمع أُمّيًا لا يستوعب تفصيل المفاهيم، فجاءت الآيات والسور قصيرة وذلك لتتناسب مع المسنوى الفكري والثقافي للمجتمع المكّي، ولما هاجر
النبيّ وانتقل إلى بيئة أخرى وهي المدينة والتي تتمتع بمستوى ثقافي أفضل نسبيًا من مستوى البيئة المكّية جاءت الآيات والسور أطول؛ وذلك انسجامًا مع التطور الفكري والثقافي للبيئة المدنية.
نسجل على هذه الشبهة ملاحظات عدّة؛ هي:
- أن القصر والإيجاز ليسا مختصين بالقسّم المكّي، بل توجد في القسّم المدني سورًا قصيرة مثل سورة النصر، سورة الزلزلة، سورة البينة وغيرها. وأن في القسّم المكّي سورًا طويلة مثل سورة الأنعام، وسورة الأعراف.
وهذا يؤكّد على أن اختيار نمط السور أو الآيات يتبع الظروف والمقتضيات الزمنية والمكانية، لا أنه منفعل بالبيئة والمحيط الخاص، ويعتبر الإيجاز في السور المكّية مظهرًا من مظاهر القدرة الفائقة على التعبير، وبالتالي فهو من مظاهر الإعجاز، حيث نزل القرآن متحدّيًا ببلاغته العرب، ومن الواضح أن إيجاز السور والآيات أبلغ في التحدي والإعجاز هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد عرف عن القرشيين في مكة أنهم كانوا أهل ذكاء وألمعيّة وفصاحة وبلاغة وأهل المدينة على استنارتهم لم يبلغوا شأن قريش في تلك الخصائص والمزايا، فناسبهم بشكل عام الإيجاز دون غيره من الأساليب.
- لو افترضنا أن لطبيعة المجتمعين المكّي والمدني وثقافتهما دورًا في هذا التفاوت بين الأسلوبين فهذا لا يؤدي إلى بشريّة القرآن ونفي صلته وارتباطه بالسماء، لأنه لا يعني سوى انسجام القرآن مع الواقع الموضوعي، فهو يتحدّث بلغة البيئة والمحيط التي نزل فيها.
- من المعروف أن تفاعل الإنسان مع بيئته الجديدة تحتاج إلى وقت طويل حتى يفهم طبيعة المجتمع وعاداته ومستواه الفكري حتى يتمكن من مخاطبته بشكل صحيح، ولكن الذي يلاحظ القسّم المدني من القرآن فيجد أن القرآن نزل
(399)بشكل متلاحق، وفي بدايات الهجرة النبوية هذه السرعة لا تعطي النبيّ صلىاللهعليهوآله متسعًا من الوقت للتفاعل مع البيئة الجديدة، خصوصًا حينما نعرف أن أوّل سورة نزلت في المدينة هي سورة البقرة، وأن السّور الستّ الأولى النازلّة على النبيّ صلىاللهعليهوآله في المدينة هي: سورة البقرة، وسورة الانفال، وسورة آل عمران، وسورة الأحزاب، وسورة النساء وبين هذه السور ثلاث من السّبع الطوال كما هو معروف في تقسيم سور القرآن وهذا أن دلّ على شيء فإنه يدّل على عدم تأثّر القرآن بالمحيط بل القرآن الكريم هو الذي أثّر في المحيط المدني.
فكيف استطاع النبيّ المتأثّر بالمحيط والبيئة المكّية ذات المستوى الهابط ثقافيًا وفكريًا كما يقولون وفي هذه الفترة الزمنية الوجيزة أن يحدث تغييرًا عميقًا في الخطاب القرآني كمًا وكيّفًا ويُخرج لنا سورة بحجم وعمق ودقّة سورة البقرة؟
- من المعروف بين علماء التفسير قولهم: السورة مكّية عدا ما استثني والعكس أيضًا أي أننا نلحظ وجود آيات مكّية في سور مدنية، وآيات مدنية في سور مكّية، وفي كلتا الحالتين نجد انسجامًا بل تلاحمًا بين آيات السورة وكأنها كتلة واحدة ونزلت مرّة واحدة، وهذا يدّل على وجود صلة كاملة بين القسّمين.
خلا القسم المكّي من التشريع والأحكام بينما نجد القسّم المدني مشحونًا بتفاصيل التشريع والأحكام، وذلك يدّل على أنّ القرآن من وضع محمدٍ وتأليفه تبعًا لتأثرّه بالوسط الذي يعيش فيه، فهو عندما حلّ بالمدينة بين أهل الكتاب المثقفيّن جاء قرآنه المدني مليئًا بتلك العلوم والمعارف العالية.
فقد زعم جولدتسيهر، وفلهلهم رودلف، أن وجود التشريعات في القسّم المدني هو دليل على تأثّر الرسول باليهود في المدينة، وإفادته من تلك البيئة بما فيها من
(400)أحكام وتشريعات كانت بين يدي اليهود، وهو ما كان يفتقده في مكة التي كان أهلها جهلة أميين.
- ليس صحيحًا خلوّ القسّم المكّي من التشريعات، بل الصحيح هو عدم وجود تشريعات تفصيلية في هذا القسّم أيّ إنّه لم يهمل التشريع، وإنما تناول أصوله العامة كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.
كما أنّنا نلحظ في بعض آيات سورة الأنعام المكّية نقاشات تفصيلية لتشريعات أهل الكتاب والتزاماتهم، وهذا يدّل على معرفة القرآن الكريم بهذه التشريعات وغيرها مسبقًا أي قبل الهجرة إلى المدينة.
- بدءُ التشريعات في القسّم المدني من القرآن في أوّل سورة نزلت في المدينة وهي سورة البقرة، يدحض فكرة تأثّر القرآن بمحيطه وبيئته، فلم يمرّ على النبيّ وقتًا طويلًا يسمح بتفاعل النبيّ مع أهل الكتاب.
يقول ابن العربي: «إنّ في سورة البقرة، ألف أمر، وألف حكم، وألف نهي»، فهل يعقل أن يكون الرسول قد تأثّر بهذه السرعة مع البيئة ومن فيها، وأفاد من اليهود بهذه السرعة القياسيّة؟
- الحديث عن تفاصيل التشريع في مكة كان شيئًا سابقًا لأوانه، حيث لم يستلم الإسلام حينذاك زمام الحكم بعد، بينما الأمر في المدينة على العكس.
- إنّ إجراء مقارنة بين التشريع الإسلاميّ وتشريعات أهل الكتاب يكشف لنا أنّ هناك اختلافًا جوهريًا بينهما، فكيف يمكن الزعم بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أخذ التشريع من أهل الكتاب في المدينة، ولوكان ذلك واقعًا وحقيقة لادعاه أهل الكتاب المعاصرون للنبي صلىاللهعليهوآله والذين كان النبيّ صلىاللهعليهوآله يحاورهم ويدحض أفكارهم.
إن القسّم المكّي لا يتضمّن الأدلّة والبراهين على أصول العقيدة وتعاليم الرسالة بينما نجد ذلك واضحًا في القسّم المدني وهذا يعني مرة أخرى حسب ادعاءهم تأثّر النبيّ بمجتمعه، ففي المجتمع المكّي الساذج البسيط لم نرَ براهين وأدلّة على العقيدة لخلوّ المجتمع من ذلك، بخلاف الأمر عندما تواجد في المجتمع المدني المتحضّر واحتّك بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فانعكس ذلك على القسّم المدني من القرآن باعتبار أن القرآن ما هو إلا انعكاس لصورة المجتمع.
الوجه الأول: لم يخل القسّم المكّي من الأدلة والبراهين بل تناولها في كثير من سوره، وبذلك تنهار الشبهة من أساسها، والشواهد القرآنيّة على ذلك كثيرة وفي مجالات شتى نذكر منها:
ما ذكر حول الوحدانية:
قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.
وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾
الاستدلال على النبوة وارتباط ما جاء به النبيّ بالسماء:
قوله تعالى: (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُون)..... (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) .
الاستدلال على البعث والجزاء:
قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾.
وهناك آيات أخرى كثيرة في القسم المكّي تضمّنت البرهنة والاستدلال على أصول العقائد، والقرآن تناول أغلب قصص الأنبياء في القسم المكّي والتي لا تخلو من استدلالات ونقاشات عقدية درات بينهم وبين أقوامهم في التوحيد، والنبوة، والمعاد، وغير ذلك.
الوجه الثاني: حتّى لو تنزّلنا، وقبلنا بهذا الفارق بين القسمين، فمن الممكن تفسير هذا الفرق على أساس مراعاة طبيعة موقف المواجهة من الدعوة، حيث كانت تواجه الدعوة في مكّة مشركي العرب وعبدة الأصنام، والأدلّة التي كان يواجه القرآن بها هؤلاء أدلّة وجدانية، من الممكن أن تستوعبها مداركهم ويقتضيها وضوح بطلان العقيدة الوثنية، والقرآن - كما عرفنا - هو كتاب هداية وتغيير وتزكية وليس كتابًا علميًا فقد كان يواكب تطور الدعوة الإسلاميّة ومسيرتها في آياته ونزوله، وحين اختلفت طبيعة الموقف، وأصبحت الأفكار المعارضة تمتاز بكثير من التعقيد والتزييف والانحراف - كما هو الحال في عقائد أهل الكتاب - اقتضى الموقف مواجهتها، بأسلوب آخر من البرهان والدليل أكثر تعقيدًا وتفصيلًا.
أوصلها بعضهم إلى بضع آياتٍ؛ أيّ أن العدد أقلّ ممّا ذكره النّحاس بكثير.
مع العلم أنّ كثيرًا من هذه الآيات التي ادُّعي أنّها من الناسخ والمنسوخ هي ليست كذلك، ولا ينطبق عليها مصطلح النّسخ الذي أراده علماء التفسير، بل فيه خلط بين النّسخ والتخصص والتقييد وغير ذلك، وقد أطلق النّسخ كثيرًا على التخصيص في التفسر المنسوب إلى ابن عباس. بل أغلب ما يطلق عليه النسخ في النصوص القديمة يراد به التخصيص. يقول الشيخ معرفة: «فإطلاق النّسخ على التخصيص كان شائعًا في متداول السلف، ومن ثم أكثروا القول في عدد الآي المنسوخة».
تطالعنا كتب كثيرة عن مسألة «الناسخ والمنسوخ» في القرآن، وقد أُلّفت كتب مستقلّة في هذا العنوان، وقلّما تجد كتاب تفسير لم يتعرض للآيات الناسخة والمنسوخة، وهناك آيات كثيرة ادُّعي نسخها. وقد جمعها أبو بكر النّحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ» فبلغت «138» آية. وهناك نقاشات بين العلماء في عدد الآيات المنسوخة
النسخ في اللغة: إزالة شيء بشيء يتعقّبه كنسخ الشمس الظلّ، والظلّ الشمّس، والشيّب الشبابّ، فتارة يفهم منه الإزالة، وطورًا يفهم منه الإثبات، وتارة يفهم منه الأمران معًا، ومن هنا يكون معنى نسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقّبه، قال الله تعالى: ﴿۞ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) () ( ).
النّسخ هو: رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه.
لأّن الحكم في الشريعة المقدّسة له نحوان من الثبوّت:
الأول: ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والإنشاء، والحكم في هذه المرحلة يكون مجعولًا على نحو القضية الحقيقيّة، ولا فرق في ثبوته بين وجود الموضوع في الخارج وعدمه، وإنما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع. فإذا قال الشارع: شرب الخمر حرام -مثلًا- فليس معناه أن هنا خمرًا في الخارج. ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون إلا بالنّسخ.
الثاني: ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعليًا بسبب فعلية موضوعه خارجًا، كما إذا تحقّق وجود الخمر في الخارج، فإن الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل، وهذه الحرمة تستمرّ باستمرار موضوعها، فإذا انقلب خلًّا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريتّه، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النّسخ في شيء.
ويعرّفه العلامة الطباطبائي بأنه: «الإبانة عن انتهاء أمد الحكم وانقضاء أجله».
وعرّفه العلامة معرفت بأنه: «رفع تشريعٍ سابق -كان يقتضي الدّوام حسب ظاهره- بتشريعٍ لاحق، بحيث لا يمكن اجتماعهما معًا، إمًا ذاتًا، إذا كان التنافي بينهما بيّنًا، أو بدليلٍ خاص، من إجماعٍ أو نصٍّ صريح».
وإذا أردنا أن نبسِّط فكرة النّسخ فهي على الشكل الآتي:
يصدر حكم شرعي أوّل؛ كالتوجه إلى بيت المقدّس على سبيل المثال، ثم يصدر حكم آخر ناظر إلى الحكم الأول ورافع له؛ كالتوجه إلى البيت الحرام، فالأول يسمى الحكم المنسوخ والثاني الحكم الناسخ، وينتج عن هذه العملية الآتي:
أولًا: وقْفُ العمل بالحكم السابق وهو التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس.
ثانيًا: إحلال حكم آخر مكان الأول مثل التوّجه إلى المسجد الحرام بدل التوّجه إلى بيت المقدس، بمعنى أن النّص الأول يبقى نّصًا قرآنيًّا وما يُنسخ هو الحكم فقط؛ لأن علماء الإمامية -كما سيأتي- لا يوافقون على نسخ التلاوة أي رفع النّص القرآنيّ.
ثالثًا: لا بدّ أن يكون ظاهر النص الأول يقتضي الدوام، لا أن يكون محدّدا من البداية بأمدٍ معين، أيّ لولا ورود النص الثاني وهو التّوجه إلى المسجد الحرام في مثالنا، لكان العمل بالنّص الأوّل وهو الصلاة إلى بيت المقدّس هو المتعيّن لأن ظاهره الدوام.
رابعًا: لا بدّ من وجود حكمة قصدها الشارع المقدس من عملية النّسخ سواء تبيّن لنا ذلك أم لا.
وقد ذكرت شروط متعدّدة للنسخ منها: تحقّق التنافي بين تشريعين وقعا في القرآن بحيث لا يمكن اجتماعهما في تشريعٍ مستمرّ، تنافيًا ذاتيًا، ومنها: أن يكون التنافي كليًا على الإطلاق، لا جزئيًا، ومنها: أن لا يكون الحكم السابق محدّدًا بأمدٍ صريح، ومنها: أن يتعلّق النّسخ بالتّشريّعيات، وغير ذلك.
كتب جماعةٌ من المستشرقين الكتب والمقالات في مسألة النسخ في الإسلام، وخاصة النسخ في القرآن، واعتبروا أن ذلك كان وسيلة للنبيّ لتغيير الأحكام السابقة والعدول عنها، واعتبروا كذلك أن من الأسباب التي أدَّتْ إلى ظهور فكرة الناسخ والمنسوخ بين المسلمين تبرير التناقضات في القرآن، والاختلاف بين القرآن والسنّة، واختلاف فتاوى الفقهاء.
وقد اعترض المستشرقون على النّسخ واعتبره بعضهم دليل على بشريّة النّص القرآني ومن هؤلاء ما ذكره المستشرق «مونتغمري وات» في مؤلفه «محمد» حيث ذكر أن مفهوم النّسخ فيه نحو من تصويب للنص: «وربما يكون قد حاول- أي النبيّ محمد- أن يُصوَّب النّص إذا أحسَّ أن النصَّ الموحي به يحتاج إلى إصلاح».
وأرجع المستشرق جولدتسيهر النّسخ في القرآن إلى التطوّر الداخليّ فيه وأن النبيّ اضطرّ لذلك فقال: «إن الرّسول نفسه قد اضطرّ بسبب تطورّه الداخليّ الخاص وبحكم الظروف التي أحاطت به إلى تجاوز بعض الوحي القرآني إلى وحي
جديد في الحقيقة، إلى أن يعترف أنه يُنسخ بأمر الله ما سبق أن أوحاه إليه».
والمستشرق «رودنسون» Rodinson، أشار في مؤلفه «محمد» إلى تلك الآراء التي صرح بها «ريتشارد بل» R. Bell حيث قال: «إن القرآن الموجود بين أيدينا قد تعرّض إلى مراجعات عديدة، والتي حسب رأيه تبيّن أنها خضعت لدراسة قامت على وثائق مكتوبة، وأن هذا العمل قد أنجز تحت رعاية محمد؛ وإن لم يكن قد قام به من تلقاء نفسه…».
ثم يخرج في قوله باستنتاجين متباينين، فيعلن: «أن هذه المراجعات لم تكن خالية من الأخطاء والنتائج السيّئة. فالله يعيد وحيه ويعدّله… ولكن الله أجاب بأنه يملك الحرية المطلقة في فعل ما يشاء وتعديل رسالته كيفما يبتغي. ألم تكن حكمة الله اقتضت مراعاة الضعّف الذي يعتري البشر، فيخفّف من الواجبات الملقاة عليهم، وذلك بنسخها، وإحلال أحكام أخرى أخف منها لمصلحتهم؟».
ويرى المستشرق «روبير برونشنج» أن النّسخ في القرآن هو بسب التناقض الذي يظهر بين الآيات ولتجاوز التناقض شُرّع النّسخ، ويرى أيضًا أنه لا يمكن القبول بتغيير أو تبديل الأحكام الإلهية الصادرة من الله تعالى المتصف بالحكمة والخلود.
فهو يدّعي أن القرآن من تأليف النبيّ؛ فهو يبدّل ويغيّر فيه كيفما شاء، والسبب في ذلك اعتقاد هؤلاء أن القرآن هو من صنع محمد وليس وحيًا إلهيًا كما تقدم في الأبحاث السابقة.
ويعتقد جون بورتون وهو أشهر مستشرق تناول بحث النسخ، وهو أستاذٌ سابق في جامعة سانت أندروز ـ أن بعض الآيات حُذفت أثناء جمع القرآن، وما النسخ إلاّ لتبرير ذلك. وهذا التصوُّر نقرؤه أيضًا في كتاب «محمد في مكّة»، لمونتغمري واط؛
إذ يقول مثلًا: «أصبح نسخ حكم الآية وبقاء تلاوته أمرًا مشروعًا ومعتبرًا في بعض الموارد التي أُهملت الأحكام المستنبطة من آيات القرآن بقصد مطابقتها لأحكام الفقه»، معتبرًا أنّ مسألة النسخ ومصاحف الصحابة عللٌ تقتضي عدم انتساب جمع القرآن إلى النبيّ.
كما تعرَّض روبرت برانس جيف، في كتابه «دراسات إسلامية»، وفي هامش موضوع «المنطق والقانون في الإسلام»، بصورةٍ مختصرة لبحث النسخ، حيث يعتقد «أن المسلمين أدخلوا النسخ إلى القرآن بوصفه معيارًا قانونيًا؛ لإلغاء التناقضات الموجودة في النصوص القرآنيّة».
لقد استخدم المستشرقون مسألة النسخ، وخصوصًا في القرن الأخير، سلاحًا يرمون به القرآن، ويتَّهمونه بالاختلاف والتناقض والتحريف. وإذا دقَّقنا النظر قليلًا فسوف نرى أن منكري النسخ في هذا القرن قريبون للاتّفاق على هذه المسألة. ويمكن القول: إن إنكار النسخ من كثيرٍ من هؤلاء هو نوعٌ من الدفاع عن القرآن وصيانته، ودفعٌ للاتهامات والشبهات التي تستهدفه، تلك الشبهات التي تتأتّى من قبول النسخ في القرآن، وما «شبهة نقصان القرآن وتحريفه» إلاّ واحدة منها.
من خلال المراجعة والتمحيص للأقوال المتقدمة من آراء المستشرقين في النّسخ نستنتج النقاط الآتية:
1- اعتبارهم أن النّسخ إنما هو أداة أو وسيلة استغلّها الرسول لتغيير أحكام كان
قد أصدرها، ثم ما لبث أن أدرك عدم مسايرتها للأوضاع الجديدة، وكذا عدم فاعليتها في حلّ المشاكل المستجدّة.
2- التّغيير حسب ادعاءهم كان بيد الرسول ولكنّه صلىاللهعليهوآله ينسبه إلى الله تعالى.
3- وجود فكرة النسخ هي لإلغاء التناقضات الموجودة في النصوص القرآنيّة.
4- النسخ لتبرير الآيات التي حذفت أثناء جمع القرآن.
5- ويزعم هؤلاء أيضًا أنّه لا يمكن أن تصدر الأحكام ثم تنسخ من قبل الله فهذا لا ينسجم مع عالم الغيب، والذي يعلم مسبقًا عدم ملاءمة هذه الأحكام للأوضاع المستقبلة فالنّسخ مخالف للعلم والحكمة، ومن هنا انتهى الأمر بهم للقول ببشريّة النص القرآنيّ.
ومن خلال تتبع آراء هؤلاء، نرصد إشكالين اثنين أساسيّين:
والشبهة باختصار: لا يصحّ أن يكون في كلام الله ناسخ ومنسوخ ؛ لأن الناسخ والمنسوخ في كلام الله هو ضدّ حكمته وصدقه وعلمه، فالإنسان لقصور عنده يضع قوانين ويغيّرها ويبدلها بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف. لكنّ الله يعلم بالأشياء قبل حدوثها.
وهذه الشبهة على النّسخ قديمة وقد أوردها اليهود على أصل النّسخ وتقريرها: أنّ النّسخ يستلزم إما البداء (أي الجهل)، وإما العبث؛ وكلاهما لا يصحّ نسبتهما إلى الله تعالى.
فالنّسخ يستلزم الباطل، وكل ما يستلزم الباطل، فهو باطل؛ فالنتيجة تكون أن النّسخ باطل.
تشريع الحكم من الله تعالى لا بدّ أن يتضمّن مصلحة ما، فالتّشريع من دون مصلحة يتنافي مع حكمة الشارع.
فرفع الحكم الثابت بحكم آخر وهو ما نسميه الناسخ: إمّا أن يكون مع بقاء المصلحة وعلم الشارع بذلك فهذا ينافي الحكمة ويلزم منه العبثيّة في التّشريع.
وإمّا مع عدم علمه بالمصلحة الواقعيّة وهو البداء؛ بمعنى انكشاف المصحلة الجديدة أمامه وهو ما يتحقّق في القوانين الوضعيّة.
وبالنتيجة: وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النّسخ في الشريعة محالًا لأنه يستلزم المحال. إمّا البداء أو العبث؛ وهما محال على اللّه؛ لأنهما نقص لا يتّصف بهما.
للردّ على الشبهة نقدم مقدمة مختصرة عن تقسيم الأحكام، فالحكم المجعول من قبل الشارع يقسم إلى قسمين رئيسين؛ هما:
الأول: الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه بعث وزجر حقيقيّان كالأوامر والنواهي التي تجعل ويقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة. وهذا ما نسميّه بالحكم الامتحاني.
الثاني: الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزّجر حيث يقصد منه تحقيق متعلّقة بحسب الخارج. وهذا ما نسميّه بالحكم الحقيقي.
والقسم الأول دوره ينتهي بالامتحان نفسه فيرتفع حين ينتهي الامتحان ولحصول فائدته وغرضه.
والقسّم الثاني من الحكم، يمكن أن نلتزم بالنّسخ فيه دون أن يستلزم ذلك شيئًا من البداء أو العبث ومخالفة الحكمة حيث يمكن أن نضيف فرضًا ثالثًا إلى الفرضين اللذين ذكرتهما الشبهة.
وهذا الفرض هو أن يكون النسخ لحكمة كانت معلومة للّه سبحانه من أول الأمر ولم تكن خافية عليه وإن كانت مجهولة عند الناس غير معلومة لديهم فلا يكون هناك بداء لأنه ليس في النّسخ من جديد على اللّه لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقًا كما أنّه لا يكون عبث لوجود الحكمة في متعلّق الحكم الناسخ وزوالها في متعلق الحكم المنسوخ وليس هناك ما يشكل عقبة في طريق تعقّل النّسخ هذا... إلا الوهم الذي يأبى تصور ارتباط مصلحة الحكم بزمان معيّن بحيث تنتهي عنده. أو الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعيّن عن الناس جهلًا من اللّه بذلك الزمان. وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النّظائر الاجتماعية التي نرى فيها شيئًا اعتياديًا ليس فيه من المحال أثر ولا من العبث والبداء. فالطبيّب حين يعالج مريضًا ويرى أن مرحلة من مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواء معيّن فيصف له هذا الدواء لمدّة معيّنة ثم يستبدله بدواء آخر يصلح لمرحلة أخرى... لا يوصف عمله بالعبث والجهل.
فالحكمة في النّسخ هي الأساس الأول لمشروعيته، وهذه الحكمة تتجلّى في تحقيق مصالح الناس التي هي المقصود الأصلي في تشريع الأحكام، لأن هذه المصالح قد تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. فإذا شُرّع حكم لتحقيق مصلحة، ثم زالت تلك المصلحة كان المناسب لذلك أن ينتهي الحكم الذي شُرّع لها. ولذلك فليس في النص القرآني ما يمكن تسميته نسخ مخالف للحكمة أو موجب للعبث.
ثانيًا: النّسخ نظريّة جاء بها المسلمون لإزالة التعارض بين الآيات المتناقضة:
من المعروف أن التّعارض بين النّصين لا يوجب النّسخ بينهما ما لم يصل الأمر إلى درجة التناقض، لأنه قد يُرفع التعارض كما هو معروف في علم الأصول من خلال التخصيص، أو التّقييد، أو غير ذلك.
والسؤال الأساس كيف يمكن حلّ شبهة ملازمة النّسخ لبشريّة النّص القرآني؟
لأننا نفترض تناقضًا بين الآيات ومن المعروف أنه لا اختلاف بين الآيات القرآنيّة؛ فضلًا عن تناقضها.
والجواب: يكمن في فهم طبيعة الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد استقراره بينهما بحسب الظهور اللّفظي، هو الحكمة والمصلحة الموجودة بينهما. وقد ميّز العلامة الطباطبائي بين الرافع للتنافي الحاصل بين الناسخ والمنسوخ من جهة وبين الرافع للتّنافي الحاصل بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين من جهة أخرى باعتبار الثاني هو قوة الظهور الموجودة في الخاص والمقيد والمبين بالنسبة لما يقابلها من العام والمطلق والمجمل.
فالناسخ يشتمل على ما في المنسوخ من كمال ومصلحة، فتكون الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة، فالرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ هو الحكمة والمصلحة التي يشتمل عليها.
ولا يرى العلامة الطباطبائي ثمة تعارض أو تناقض في النّسخ فيقول: «النّسخ كما أنه ليس من المناقضة في القول وهو ظاهر، كذلك ليس من قبيل الاختلاف في النظر والحكم، وإنما هو ناشئ من الاختلاف في المصداق من حيث قبول انطباق الحكم يومًا لوجود مصلحته فيه وعدم قبوله الانطباق يومًا آخر لتبدل المصلحة من مصلحة أخرى توجب حكمًا آخر، ومن أوضح الشواهد على هذا أن الآيات المنسوخة الأحكام في القرآن مقترنة بقرائن لفظية تومىء إلى أن الحكم المذكور في الآية سينسخ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) . يقول العلامة الطباطبائي: انظر إلى التلّويح الذي تعطيه الجملة الأخيرة، والآيات المنسوخة، كما يرى
الطباطبائي لا تخلو من إيماء إلى النّسخ، كما في قوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾، المنسوخ بآية القتال، وقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) ، المنسوخ بآية الجلد، فقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾، وقوله: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾، لا يخلو من إشعار بأن الحكم مؤقّت مؤجّل سيلحقه نسخ.
بهذا أجاب العلامة الطباطبائي على ما يعنيه التّنافي بين النصوص، أو على ما إذا اقتضى أحد الدليلين المتساويين في القوّة نقيض ما يقتضيه الآخر، إذ هو يرى أن التّعارض هو في الظاهر، وليس تعارضًا حقيقيًا، لأن كلام الله تعالى منزّه عن الاختلاف، كما قال الله تعالى: ﴿الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. «ففي الواقع لا يوجد تعارض حقيقي بين آيات الكتاب، إذ أن ترتّب النّسخ على وقوعه دليل على أنه لم يبقَ بين النّصين تعارض حقيقي من حيث إن الحكمين أحدهما منسوخ بالآخر يجب أن يختلف زمن العمل بهما، فاتحاد الزمان بين الحكمين، وهو شرط لتحقق التعارض، مانع من النّسخ، واختلاف الزمن فيهما، وهو شرط لوقوع النّسخ، مانع من التعارض».
من المباحث التي تطرح عادة في مباحث النسخ هو «مبحث نسخ التلاوة»، وجملة من علماء الإمامية وبعض الباحثين في مجال علوم القرآن الكريم يدرجون هذا المبحث في مباحث تحريف القرآن أو صيانة القرآن من التحريف لأنّهم
يعتبرون أنّ هذا النوع من النسخ هو القول بالتحريف بالنقيصة، ولكن علماء العامة يدرجون هذا البحث في مباحث النسخ باعتبار أنّه نوع من أنواع النسخ المقبول عندهم ولذا أدرجنا البحث في مباحث النسخ.
قالوا النسخ في القرآن يقع على ثلاثة أقسام:
1- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الشرعي
2- نسخ الحكم الشرعي مع بقاء التلاوة
3- نسخ الحكم والتلاوة معًا.
استدلّ بعض علماء أهل السنة على فكرة نسخ التلاوة بآيتين؛ وهما:
الأولى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
فيكون المعنى ـ على حدّ زعمهم ـ ما ننسخ من آية من آيات القرآن أو نمحها من الأذهان، نأتِ بآيات قرآنية خير منها أو مثلها.
الثانية: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
فيكون المعنى فيها أيضًا: إذا بدّلنا آية من آيات سور القرآن مكان آية أخرى.
وبتبنّي علماء السنّة لفكرة نسخ التلاوة يتمكّنون حسب زعمهم من حلٍّ
للرّوايات التي تحدثت عندهم عن نقصان القرآن الكريم وقالوا: إنها نسخت تلاوتها، أي أن الله سبحانه كان قد أنزل على نبيّه صلىاللهعليهوآله تلكم الآيات والسور ثم نسخها مع حكمها أو بدون حكمها.
بعض علماء الامامية ذهبوا إلى أن هاتين الآيتين لا تدلان على نسخ التلاوة أصلًا وذلك لأمور، منها:
1. أن لفظ «آية» في قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ.. ﴾ إذا ورد في القرآن الكريم بصيغة المفرد فإنه يراد به الأمر العظيم الخارق للعادة، لا الفقرة القرآنيّة.
2. ولو سُلِّمَ، أنّ قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ.. ﴾ المراد به النسخ فقد ورد في مقام التعريض بأهل الكتاب والمشركين فلا بدّ وأن يراد به نسخ ما ورد في الشرايع السابقة لأجل هذه القرينة السياقية. سياق الآيات على الشكل الآتي: ﴿۞ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ .
فمع وجود هذه القرائن قبل الآية وبعدها نعلم أن المقصود من الآية ها هنا هو تبديل استقبال بيت المقدس في الصلاة بحكم استقبال الكعبة فيها، ومن ثم ندرك أن المقصود من تبديل آية مكان آية في قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ..﴾
وقد أورد علماء العامة نماذج كثيرة على نسخ التلاوة نذكر منها:
ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على
منبر رسول الله صلىاللهعليهوآله: أن الله قد بعث محمدًا صلىاللهعليهوآله بالحقِّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم، قرآناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلىاللهعليهوآله، ورجمنا بعدَه، فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجمَ في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجمَ في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أحصَن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف.
ومنها: آية: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» ثبت في صحيح البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب في خطبته المشهورة قوله: «ثم إنا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله أن: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)، أو (أن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم)».
بعد هذا البيان لا نستطيع توجيه اللوّم إلى المستشرقين، لذهابهم إلى القول بالتحريف استنادًا إلى فكرة «نسخ التلاوة» الموجودة في كتب العامة، ولا بدّ من رفضه نظرًا للوازمه الباطلة وهي التحريف الذي هو أمر باطل بالإجماع، وللأسف لا يقبل بعض الباحثين حتى النقاش في أصل فكرة نسخ التلاوة فيقول: «إن من أبرز سمات أهل الأهواء -في هذا الزمان- معاداةَ صحيحِ السنة النبوية، والتذرُّعَ إلى إبطالها بأدنى ملابسة وأهون الأسباب، بل وجعل الأهواء والعقول البشرية القاصرة حاكمةً عليها قبولًا وردًا،... ومن تلك البابة: مسألةُ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الشرعيّ، حيث لا يفتأ أهل الأهواء ينكرونها قديمًا وحديثًا، ولا يقتصر الأمر على مجرَّد الإنكار، بل يتعدَّى إلى رمي ما صحَّ من الأحاديث في إثباتها بأقذع الألفاظ وأسوأ العبارات».
رفض علماء الإمامية «نسخ التلاوة» واعتبروه ضربًا من التحريف، لأن هناك ملازمة واضحة بين القول بنسخ التلاوة والذي هو «رفع الآية من المصحف الشريف بعد نزولها»، وبين التحريف بالنقيصة. يقول السيد الخوئي: «نسخ التلاوة دون
الحكم: قد مثّلوا لذلك بآية الرّجم فقالوا: إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد قدّمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام».
يقول العلامة معرفت: هناك مزعومة لهج بها كثير من أصحاب الحديث وجماعة من أصوليّ العامّة، حاولوا معالجة ما صحّ لديهم من روايات تنمّ عن ضياع كثير من آي القرآن، فحاولوا توجيهها بأسلوب مختلق، قالوا: إنها من منسوخة التلاوة، ولو فرض الحكم باقيًا مع الأبد. كما في آية «الرضعات العشر» وآية «رجم الشيخ والشيخة» وآية «لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» وغيرهنّ كثير، حسبوها آيات قرآنية، كانت تتلى على عهده صلىاللهعليهوآله، لكنّها رفعت في ما بعد ونسيت عن الصدور، وإن بقي حكمها واجب العمل أبدًا. وبهذا الأسلوب الغريب حاولوا توجيه ما عساه كان ثابتًا لديهم من صحاح الأحاديث.
وأمّا علماؤنا المحقّقون فقد شطبوا على هكذا روايات تخالف صريح القرآن، ولم يصحّ لديهم شيء من أسانيدها بتاتًا، ولأن كتاب الله العزيز الحميد أعزّ شانًا وأعظم جانبًا من أن يحتمل التحريف. وقد تقدّم الكلام عن شبهات المستشرقين على آية الرجم وغيرها في مبحث تحريف القرآن الكريم.
وأكّد السيد الخوئي أيضًا: بأن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله صلىاللهعليهوآله وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده، فان أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله صلىاللهعليهوآله فهو أمر يحتاج إلى الإثبات. وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب حتى بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله بأخبار
هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله فهو عين القول بالتحريف.
فالمسألة لا محيص منها (مانعة خلو) لا تخلو: إما الالتزام بسقوط هذه الروايات وأمثالها من العشرات عن الاعتبار، أو الالتزام بصحة هذه الروايات واعتبارها ورفعها فوق مستوى الشبهات، وبالتالي «إن الالتزام بصحة هذه الروايات؛ التزام بوقوع التحريف في القرآن».
فيثبت بذلك سقوط هذه الروايات جميعها عن الاعتبار والنظر العلمي؛ لما تقدم، ولاصطدامها بالقاعدة المجمع عليها بين المسلمين والتي يجب الاعتماد عليها، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي «عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبيّ الأعظم صلىاللهعليهوآله».
ويقول العلامة الطباطبائي: «وأمّا حملهم الرواية وسائر ما ورد في التحريف وقد ذكر الآلوسي في تفسيره أنها فوق حدّ الإحصاء على منسوخ التلاوة فقد عرفت فساده وتحققت أن إثبات منسوخ التلاوة أشنع من إثبات أصل التحريف».
بالموضوعات اللّغوية والأسـلوبية، ومـن أهمها موضوعات: البلاغة، والإعجاز القرآني، ولغـة القرآن الكـريم، والأسـلوب القرآني، وغريب القرآن وغير ذلك.
وقد أوردوا على القرآن مطاعن عدة، حاولوا من خلالها التّشكيك في صحّة القرآن الكريم وقدسيّته وصـدوره عن الله، ومنها محاولة نفيهم إعجـاز القرآن والتّشكيك في صحّة أسلوبه وعظمة بيانه.
ومن جهة أخرى، يقوم بعض المستشرقين بتحليل الآيات القرآنيّة على أّنها أثر أدبي مثل أيّ نصٍّ أدبي آخر، وهم يريدون من وراء ذلك إثبات بشرية القرآن الكريم وأنّه من صنع النبيّ حتى وإن اعترف بعضهم بأنه نص لا يشبه النصوص العربيّة الأخرى.
نعرض أولًا: للشبهات العامة التي أوردوها على الإعجاز القرآني، ثم نعرض بعض النماذج من كلام بعض المستشرقين أمثال: «جولدتسيهر»، «وهاملتون» وغيرهما، والردود عليها؛ وبهذا يتّضح حال النّماذج الاستشراقيّة الأخرى.
(422)
(423)
القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلىاللهعليهوآله وقد تحدّى العرب بأن يأتوا ولو بسورة واحدة أو حديث مثله، والواقع التاريخي شاهد حيّ على عجز الجميع عن الإتيان بمثل آياته المباركة إلى يومنا هذا، لقوله تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾.
ومـن المجالات التي اهتمّ بها المستشرقون في الدّراسات القرآنيّة اهتمامهم
إنّ الموقف الذي ساد في البيئة الاستشراقيّة هو عدم الإقرار بإعجاز القرآن الكريم، ومن نماذج ذلك ما ورد في دائرة المعارف البريطانية (Encyclopedia Britannica) ضمن مادة القرآن: «القول بإعجاز لغة القرآن جمالًا وصفاءً مما يعجز عن محاكاته الأنس والجن حتى فصحاء العرب وبلغاؤهم أمر غير مقبول».
يمكن تقسيم هذه الشبهات العامّة إلى قسمين:
الأول: الشّبهات التي تدّعي النّقص والخطأ في الأسلوب والمحتوى القرآنيّ.
الثاني: الشّبهات التي تنفي الإعجاز في القرآن وأن البشر غير قادرين على الإتيان بمثله.
إن الإعجاز القرآني يرتكز بصورة رئيسة على الفصاحة والبلاغة القرآنيّة ونحن
نعرف أنّ العرب قد وضعوا قواعد وأسسًا للفصاحة، والبلاغة، والبيان تعتبر هي المقياس الرئيس في تمييز الكلام البليغ من غيره. وبالرغم من ذلك نجد في القرآن الكريم، بعض الآيات لا تنسجم مع هذه القواعد بل تخالفها الأمر الذي يدعونا إلى القول إنّ القرآن الكريم ليس معجزًا لأنه لم يسر على نهج القواعد العربيّة وأصولها. وتسرد الشبهة بعض الأمثلة لذلك.
الأول: ملاحقة الأمثلة والتفصيلات التي تسردها الشبهة وبيان انطباقها مع القواعد العربيّة المختلفة وانسجامها معها. وملاحظة شتى القراءات القرآنيّة التي يتفق الكثير منها مع هذه القواعد، بالشكل الذي لا يبقي مجالًا لورود الشبهة عليها. وسيأتي مناقشة بعض الأمثلة التي ذكروها في هذا المجال.
1- أن تأسيس قواعد اللغة العربيّةكان في وقت متأخر على نزول القرآن الكريم وفي العصور الأولى للدول الإسلاميّة بعد أن ظهرت الحاجة إليها بسبب التوسّع الإسلاميّ الذي أدى إلى اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب. ولا شك أن القرآن الكريم كان أهم تلك المصادر التي اعتمد عليها واضعو هذه القواعد في صياغتها وتأسيسها لأنه أوثق المصادر العربيّة والكلام البليغ الذي بلغ القمة. وعلى هذا الأساس التاريخي لوجود قواعد اللغة العربيّة يجب أن يكون الموقف تجاهها أن نجعل القرآن هو القياس الذي يتحكم في صحتها وخطئها لا أن نجعل القواعد مقياسًا نحكم به على القرآن.
2- ثم إذا لاحظنا موقف العرب المعاصرين للقرآن الكريم -وهم ذوو الخبرة والمعرفة الفائقة باللغة العربيّة- وجدناهم قد أذعنوا واستسلموا للبلاغة القرآنيّة وتأثروا بها وذلك إيمانًا منهم بأنه يسير على أدق القواعد والأساليب العربيّة في البيان والتعبير، ولوكان في القرآن الكريم ما يتنافى مع قواعد اللغة
(426)العربيّة وأصولها لكان من الجدير بهؤلاء الأعداء أن يتخذوا ذلك وسيلة لنقد القرآن ومنفذًا للطعن به.
اهتم المستشرقون بقصص الأنبياء في القرآن الكريم، وعقدوا مقارنـات لكـثير من هذه القصص بما يقابلها في أسفار العهد القديم والعهد الجديد. واهتم المستـشرقون أيضًا بالموضوعات المرتبطة باليهودية والنصرانية، وبالتصور القرآني للديانتين، وبالنقـد القرآني لهما. ومن الشبهات التي طرحوها في هذا لمجال هي أن القرآن قد تحدث عن قصص الأنبياء كما تحدثت الكتب الدينيّة الأخرى كالتوراة والإنجيل عنها، وعند المقارنة بين ما ذكره القرآن وما ورد في التوراة والإنجيل نجد القرآن يخالف تلك الكتب في حوادث كثيرة ينسبها إلى الأنبياء وأممهم الأمر الذي يجعلنا نشك في أن يكون مصدر القرآن الوحي الإلهي.
وهذه الشبهة لا يمكن أن تصمد للمناقشة إذا عرفنا أن هذه الكتب الدينيّة قد تعرضت للتحريف والتزوير بالإضافة إلى أن ملاحظة محتوى الخلاف بين القرآن الكريم والكتب الدينيّة الأخرى يدعونا بنفسه للإيمان بصدق القرآن الكريم، حين نجد التوراة والإنجيل يذكران في قصص هؤلاء الأنبياء مجموعة من الخرافات والأوهام يتجاوزها القرآن الكريم، وينسبان إلى الأنبياء أعمالًا ومواقف لا يصح نسبتها إليهم ولا تليق برسل اللّه والقوّامون على شريعته ودينه بل لا تليق بمصلحين عاديين من عامة البشر كما يتبين ذلك بوضوح عند المقارنة بين القرآن والكتب الدينيّة الأخرى.
إن أسلوب القرآن في تناوله الأفكار والمفاهيم وعرضها لا ينسجم مع أساليب البلاغة العربيّة ولا يسير على الطريقة العلميّة في المنهج والعرض وذلك لأنه يجعل
المواضيع المتعددة متشابكة بعضها مع بعض فبينما يتحدث القرآن في التاريخ ينتقل إلى موضوع آخر من الوعد والوعيد والحكم والأمثال والاحكام وغير ذلك من الجهات فلا يجعل القارئ قادرًا على الإلمام بالأفكار القرآنية، مع أن الموضوعات القرآنيّة لوكانت معروضة على شكل فصول وموضوعات مستقلة لكانت الفائدة المترتبة عليه أعظم والاستفادة منه أسهل وكان العرض منسجمًا مع الأسلوب العلمي المنهجي الصحيح.
وتناقش هذه الشبهة على أساس النقطتين التاليتين:
الأولى: أنّ القرآن الكريم ليس كتابًا علميًا ولا كتابًا مدرسيًا فهو ليس كتاب فقه أو تاريخ أو أخلاق وإنما هوكتاب هداية وتربية وهدفه الأساس هو إحداث التغيير الاجتماعي. والأسلوب القرآني خضع لهذا الهدف في طريقة العرض وفي التدرج، في النزول وفي غير ذلك من الظواهر القرآنيّة؛ كوجود الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.
الثانية: أن هذه الطريقة في العرض يمكن أن تعتبر إحدى الميزات التي يتجلّى فيها الإعجاز القرآني بصورة أوضح فإنه بالرغم من هذا التّشابك في الموضوعات تمكنّ القرآن الكريم من الاحتفاظ بجمال الأسلوب وقوّة التأثير وحسن الوقع على الأسماع والنفوس؛ الأمر الذي يدلل على براعة متناهية وقدرة عظيمة على عرض الموضوعات وطرح الأفكار.
لا شك أن ذوي القدرة والمعرفة باللغة العربيّة يتمكنون من الإتيان بمثل بعض الكلمات القرآنية، وحين تتوفر هذه القدرة في بعض الكلمات فمن المعقول أن تتوفر أيضًا في كلمات أخرى. وهذا ينتهي بنا إلى أن نجزم بوجود القدرة على الإتيان بسورة أو أكثر من القرآن الكريم لدى أمثال هؤلاء لأن من يقدر على بعض القرآن يمكن أن نتصور فيه القدرة على الباقي بشكل معقول.
(428)والمناقشة في هذه الشبهة واضحة، لأن الإعجاز القرآني يتمثل في جانبين رئيسين: جانب الأسلوب والتركيب البياني، وجانب المضمون والمحتوى والأفكار. وفي كل من الجانبين لا مجال لهذا الوهم والخيال.
أما في جانب المضمون فمن الواضح أن القدرة على إعطاء فكرة أو فكرتين لا يعني القدرة على إعطاء هذا المقدار الكبير المنسجم من الأفكار والمفاهيم وفي الظروف الموضوعية والذاتية نفسها التي جاء فيها القرآن الكريم. والتحدي الذي شرحناه في سابقا كان ضمن الظروف الخاصة التي عاشها النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله وجاء فيها القرآن الكريم.
وأما في جانب الأسلوب فإن القدرة على جملة أو مقدار من الكلمات لا يعني القدرة على تمام التركيب بعناصره المتعددة التي لا يمكن أن توجد أو تتوفر إلا ضمن التركيب بكامله. وقد استند بعض المستشرقين لفكرة الصرفة بأنّه يمكن الإتيان بمثل القرآن وسيأتي الكلام عنها.
القرآن ليس معجزة وإن كان يعجز جميع البشر عن الإتيان بمثله؛ فالمعجزة يجب أن تكون صالحة لأن يتعرف جميع الناس على جوانب التحدي فيها؛ كونها دليل النبوة التي يراد بواسطتها إثبات النبوة لهم. والكلام البليغ لا يكفي في إعجازه عجز الناس عن الإتيان بمثله، لأنّ معرفة جوانب التحدي والإعجاز فيه، من بلاغته وسمو التعبير فيه لا تتوفر إلا للخاصة منهم الذين يمارسون الكلام العربي ويعرفون دقائق تركيبه وميزاته.
ويمكن أن تناقش هذه الشبهة بالمناقشات التالية:
الأولى: الشبهة تتضمن اعترافًا بالإعجاز، ولكنها تناقش في دائرته وقدرة الناس على فهم هذا الإعجاز واستيعابه.
الثانية: الإيمان بالمعجزة لا يتوقف على التجربة الشخصية ولكل فرد فرد، وإنما
(429)يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق معرفة ذوي الاختصاص والخبرة من الناس، الشيء الذي يجعلنا نصدق بالمعجزة، وهذا هو السبيل الوحيد لإيماننا بكثير من حقائق الكون وخصائص عالم الطبيعة.
الثالثة: إن فكرة الاعجاز في القرآن الكريم من الممكن أن تشرح وتوضح على نطاق واسع وليس ذلك مما يتعسر فهمها فيفهمها الناس على حدّ سواء، العربي منهم وغير العربي وذوو الاختصاص وغيرهم لأن إعجاز القرآن لا يختص بالجانب البلاغي من أسلوبه بل هو المعجزة الخالدة التي لا تفنى والتي لا تختص بأمّة دون أخرى. وهناك جوانب كثيرة للإعجاز القرآني.
تعامل المستشرقون مع القرآن الكريم بوصفه نصًا أدبيـًا خاضـعًا لخصائص الأدب البشري، نازعين عنه سمة القدسية الدينيّة، فإن «هـذا -في الواقـع - انعكاس لطبيعة تعامل المستشرقين مع كتبهم الدينيّة؛ حيث يدرسونها كمـا يدرسـون الآثار الأدبية القديمة والأساطير والملاحم الخرافية. وهذه الظاهرة تكاد تكون عامـة في كتب «تاريخ الأدب»؛ حيث تعرضوا للقرآن باعتباره يمثل مرحلة مـن مراحـل الأدب العربي، وقوّموه بالمقاييس الأدبية الأوروبية تارة، وبالعربيّة تارة أخرى».
يقول هاملتون جيب وهو يتحدث عن القرآن الكريم: «وليس غريبًا أن لا يجد المسلم في أي كتابٍ مقدسٍ آخر شيئًا من هذه الصفة الشعرية الشعورية، وهذه القوة على تأييد ملكة الروح الحدسية وتقويتها، والطفرة الصاعدة للعقل والروح كي يقفا من خلال تجربةٍ محسوسةٍ على الواقع الكامن وراء الظواهر الزائلة في عالم المادة، غير أن هذا ليس هو كلّ شيءٍ هنالك؛ إذ تقف شخصية محمد نفسه مرتبطةً ارتباطًا لا انفصام له بالقرآن بروابط من المشاعر الحارة التي يسبغها الحب
الإنساني، مكملةً للقدرة العقلية في تعاليمه وللجوانب الشعورية في لُغته».
وجيب هنا ينظر للقرآن أولًا: على أن القرآن الكريم من تأليف النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وثانيًا: أنه يفهم هذا التميّز والإعجاز في لغة القرآن الكريم على أنه شعرية وحالة شعورية طاغية ناتجة عن تلاحم محمد صلىاللهعليهوآله مع النص الذي يرى جيب أنه قد ألّفه بقدراته العقلية والنفسية الفذة. وقد تقدم الردّ على هذا الكلام في مبحث الوحي.
وقد ركّز ( دافيد صموئيل مرجليوث )، شبهاته على إثارة الشكّ برواية الشعر العربي الجاهلي، فلعلّ في الشعر الجاهلي الذي لم يُروَ ما هو أبلغ من القرآن؛ وذلك لمنزلة الشعر الجاهلي باعتباره أمارة وعلامة على بلاغة القرآن وفصاحته، وهذا القول يطوي تحته تشكيكًا في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم.
وأنموذجًا من هذه الدراسات نذكر ما قام به «جولدتسيهر» مما يتصل بمباحث الإعجاز؛ حيث يزعم:
أولًا: مشابهة القرآن لكلام الكهنة.
ثانيًا: ضعف بلاغة المدني من القرآن.
ثالثًا: إنكار كل معجزات الرسول- طبعًا ومن ضمنها الإعجاز القرآنيّ.
وقد اعتمد «جولدتسيهر» وغيره من المستشرقين في دراساتهم بل افتراءاتهم على الأسلوب القرآني وإعجازه المنهج الفِيلُولُوجِي وقد تقدم الكلام عن هذا المنهج.
وركز «جولدتسيهر» أيضًا على مذهب «الصّرفة» لينفي إعجاز القرآن، ونسب إلى الشيعة القول بتفكيك السياقات القرآنيّة ممّا يضر بالتالي بالنظم القرآني.
ولكي يؤكد فكرته أي نفي الإعجاز نسب فكرة تفكيك السياق إلى الشيعة، فقال: «وفي العهد المبكر للانشـقاق الشـيعي حصـل فعـلًا الاسـتدلال علـى الطعـن
فـي القرآن الرسمي؛ للإشارة إلى تفكك السياق مـن جهـة المعنـى فـي الآيـات المتفرقـة المتتاليـة بعضـها مـع بعـض مما يمكن أن يكون سببه حذف الآيات الرابطة للسياق” .
وزعم أيضًا: «فلا ريب أنهم -أي الشيعة- قـد هـدفوا إلـى إقامـة البرهـان على مدى التهاون والسطحية التي اتبعت في كتابة المصحف العثماني، لأن لهـذه الكتابـة يرجـع ذلـك الطـابع المتقطـع غيـر متصـل السـياق والملاحـظ فـي مواضـع كثيرة مـن نـص القرآن فـي زعمهم- حيث ترتب على ذلك في رأيهم- تشويه لا علاج له في الجمال المعجز لـنظم الكتـاب الكـريم الـذي يجـب أن يعتـرف بـه كـل مسـلم.... ففـي نفـس الآيـة الواحـدة يسـود انقطـاع فـي صـلة السـياق، وإن الترتيـب الطبيعـي إنما يعـاد أولًا إذا بحثنـا عـن تمـام نصـف الآيـة فـي مكـان بعيـد عنهـا، وضـممنا مـا يتصـل بعضـه بـبعض مـن الأجـزاء بعيـدة التشـعيب وهـذا تشـكك ناقـد، قـد يلـح أحيانًا مثله على النظر العلمي أيضًا، وإن لم يكن إلى هذا الحدّ الذي لا يستسيغه العقل».
هذا الكلام الذي ادعاه «جولدتسيهر» وبالأخص ما نسبه إلى الشيعة من تحريف للقرآن، وتفكيك في سياقاته الذي يؤدّي بالتالي إلى خلل في ترتيب النظم وهو أحد أهم أوجه الإعجاز القرآني. وهذا الكلام لا يتوافق مع الرأي العام والصحيح عند علماء الإمامية كما أكدنا أكثر من مرّة سابقًا.
(433)
احتوى كتاب «تاريخ القرآن» لنولدكه على جملة من المباحث والشبهات على قراءات القرآن، والتي يمكن اعتبارها من المصادر الأساسية للدراسات الاستشراقيّة التي جاءت من بعده.
وكتاب «تاريخ القرآن»: يتكون من ثلاثة أجزاء، والجزء الثالث هو جزء مُخَصَّص للقراءات القرآنيّة.
بُني هذا الجزء على ثلاثة فصول:
خُصص الفصل الأوّل للرسم، وبُني على أربعة مباحث:
المبحث الأول في أخطاء النص العثماني،
والثاني في صياغات النسخ العثمانية،
والثالث في ضبط الكتابة،
والرابع فخُصص للصياغات والقراءات غير العثمانية.
واستقل الفصل الثاني ببحث موضوع القراءة، بُني هو الآخر على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: فيه تسعة مسائل الأولى منها في المصادر، والثانية في العلاقة مع الرسم، والثالثة في صحة اللغة، والرابعة في مبدأ التقليد، والخامسة في مبدأ الغالبية، والسادسة في توجيه القراءات، والسابعة في تدريس القرآن والقراءات، والثامنة في نقد الروايات، والتاسعة في المذهب السلفي.
المبحث الثاني في القراء والقراءات عولجت فيه النّقاط الخمسة الآتية: الأولى في المصادر، والثانية في لمحة عن القراء القدماء، والثالثة في التطور التاريخي، والرابعة في نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة، والخامسة في خصائص القراءات المشهورة واختلافاتها.
(435)المبحث الثالث: عولجت فيه كتب القراءات في إحدى عشرة نقطة، الأولى في الحقبة القديمة، والثانية في نشأة كتب القراءة المشهورة، والثالثة في تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية، والرابعة في توسيع نظام السبعة، والخامسة في مصادر القراءات الشاذة، والسادسة في كتابات عن المفردات، والسابعة في كتابات عن التجويد، والثامنة في الكتب الخاصة بالوقف، والتاسعة في كتابات عن تعدد الآيات، والعاشرة في أعمال عن كتابة القرآن، والحادية عشرة في كتب تفسير القرآن؛ بوصفها مصادر لعلم القراءات.
أمّا الفصل الثالث فأُفرد لمخطوطات القرآن، في خمسة مباحث مع ملحق:
المبحث الأول في الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات،
والثاني خط المصاحف القديمة،
والثالث في تزويد المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوين السور،
والرابع في تاريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها،
والخامس في نسخ القرآن الحديثة، أما الملحق فيتضمن نماذج من مخطوطات قرآن قديمة.
ومن بين الدراسات عن القراءات القرآنيّة ما قام به جولدتسيهر وقد ضمنه في الفصل الأول من كتابه «مذاهب التفسير الإسلاميّ» وأثار فيه مجموعة من الشبهات تداولتها الكتب الاستشراقيّة بعده، بل وبعض الكتّاب المعاصرين له، وقد أخذ جولدتسيهر بعضًا من هذه الشبهات من كتاب نولدكه، ولكنها على كل حال هي أشهر ما ورد على مبحث القراءات لذا سنشير إليها وإلى الردود عليها باختصار.
إن أحد معاني الاضطراب وعدم الثبات في النص القرآني أن يقرأ النص على وجوه مختلفة وصور متعددة، ويكون بين هذه الصور تناقض في المعنى وتعارض في المراد، وتضارب في الهدف، ولا يعرف الموحى به من هذه الصور من غيره.
يقول «جولدتسيهر» فلا يوجد كتاب تشريعي احتفظت به طائفة دينية على أنه نص منزل موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات، كما نجد في نص القرآن». فيزعم هنا أن النص القرآني مضطرب، وغير ثابت، وفيه اختلاف كثير. يُفهم من كلامه أن نص القرآن هو من أكثر النصوص الدينيّة اضطرابًا على الإطلاق. ويمكن تسجيل ملاحظات عدّة على هذا الكلام؛ منها:
• إذا كان «جولدتسيهر» لم يطلع على النصوص الأصلية للكتب السماوية من أين عرف أن نص القرآن هو من أكثر النصوص اضطرابًا؟!
• اعترف «جولدتسيهر» بأن التلمود يقول بنزول التوراة بلغات متعددة وفي وقت واحد. وهذا يمثل اختلافًا في نصوص التوارة بلا شك.
• اعترف أنّ للتوراة أكثر من نسخة مختلفة، ثم إن علماء العرب أثبتوا أنه كانت هناك ثلاث نسخ معروفة للتوراة. وللإنجيل نسخ كثيرة جدًا مختلفة اختلافات واسعة.
• اعترف المستشرق آرثر جيفري أن تاريخ التوراة والإنجيل ونسبتهما وحرفيتهما أبعد شيء عن الصحة والوثوق.
لا بدّ أن نشير إلى أنّه إذا افترضنا أنّ القراءات أدت إلى تناقض واضطراب في النص القرآني فهذا دليل على عدم صحة القراءات أصلًا، لا على عدم صحة النص القرآنيّ. طبعًا هذا الكلام واضح على مباني علماء الإمامية وآرائهم في مبحث القراءات القرآنيّة؛ لأنهم لا يرون تواتر القراءات فلا ملازمة بين ثبوت النص القرآني وبين القراءات؛ لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر بينما القراءات القرآنيّة ليست متواترة أصلًا، بل يعتبرها علماء الإمامية من الأمور الاجتهادية التي تخضع للضوابط والموازين العلميّة من صحة النقل، وموافقة القواعد العربيّة المشهورة وغير ذلك، ولذا لا يعتبر فقهاء الإمامية أن القراءات حجة في الاستدلال الفقهي بمجرد أنها من القراءات السبعة أو العشرة المشهورة، ولكنْ للانصاف هذا الفرض -أي إذا أدت القراءات إلى التناقض- من الصعوبة بمكان دفعه مع القول بحجية القراءات وتواترها؛ كما هو الأمر عند علماء أهل السنّة.
وأيضًا لا بد أن نشير إلى أننا لا نعترف بأي قراءة تؤدي إلى تبديل في النص القرآني؛ كأن نقرأ مكان كلمة «اهدنا» في سورة الفاتحة كلمة «ارشدنا» وما شابه ذلك من قراءات نُسبت إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود والتي قد تُفهم على أنها توضيحات وتفسيرات للنص، لا أنها قراءة للقرآن؛ وإلا فهذه القراءات هي عدل القول بتحريف القرآن الكريم؛ وهو مرفوض بالإجماع.
على كل الأحوال القراءات هي عبارة عن الوجوه المتعددة التي تواردت على النص القرآني، ولا تؤدي إلى تناقض وتضارب واضطراب في النص القرآني نفسه، والاضطراب والاختلاف منفي عن القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرً﴾، نعم قد تؤدي القراءات إلى اختلاف في المعنى ولكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى التضارب والتناقض حتمًا ومن الأمثلة على ذلك:
(438)اختلاف القراءات لفظًا واتحادهما في المعنى: كما فيه قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ فقد قُرئت «ملك» بأوجه مختلفة، كما قُرأت الصراط بالسين والصاد أي (الصراط-السراط) في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ولا فرق بينهما، وإنما هو مراعاة للسان العرب ولهجاتهم.
اختلاف القراءات لفظًا ومعنى، كما في قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ قرئت بتشديد الصاد وتخفيفها، فعلى قراءة التشديد يكون المعنى مشتقًا من تصدق أي الذين يخرجون صدقات أموالهم، وعلى قراءة التخفيف يكون المعنى مشتقًا من التصديق، أي الذين صدقوا الرسول وآمنوا بما جاء به، فالمعنيان مختلفان، غير أنهما يجتمعان في العبد المؤمن المتصدق وقيل إن «حكمة هذا النوع من الاختلاف أن تكون الآية بمنزلة آيتين وردتا لإفادة المعنيين جميعًا».
أما اختلاف التضاد فلا وجود له في القرآن، يقول ابن قتيبة في مشكل القرآن: «الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، واختلاف تضادّ. فاختلاف التّضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله في شيء من القرآن...».
إنّ سبب اختلاف القراءات القرآنيّة هو خلوّ المصاحف التي كتبها الخليفة عثمان من النقط والإعجام يقول «جولدتسيهر»: «وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية اللفظ العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية
مختلفة، تبعًا لاختلاف النقط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقط… وإذًا فاختلاف الحركات في المحصول موحّد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطًا أصلًا، أو لم تتحر الدقة في نقطه وتدقيقه».
حسب تاريخ جمع المصاحف فإن المصاحف التي جمعها الخليفة الثالث كانت خالية من التنقيط والتشكيل يقول الزرقاني في مناهل العرفان: «كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله، مبالغة منهم في المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف، وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى التغيير فيه... ولكن الزمان تغير -كما علمت - فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب، أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف، وخوفًا من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير فيه». مع التسليم بهذه الحقيقة التاريخية أجاب بعض علماء العامة عن الشبهة على الشكل الآتي:
الوجه الأول: أن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها، وتداول الناس القراءة بها في العهد النبوي، ومما يدل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال: «أَقرآني جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُني حَتَّى انتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ »، تمسكوا بهذا الحديث الذي لم يصح عندنا بل المروي في كتبنا خلافه وأن القرآن لم ينزل على سبعة أحرف بل نزل على حرف واحد.
فعَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أن اَلنًاسَ يَقُولُونَ أن القرآن نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ: «كَذَبُوا أَعْدَاءُ اَللَّهِ وَلَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ اَلْوَاحِدِ».
فهم استنادًا إلى النص المتقدم وغيره ادعوا أن الرسول تلقى القراءات السبع من جبريل وبلّغها لأصحابه. وعليه فزعم أن انعدام النقط هو سبب القراءات مردود عليه بشيوع القراءات القرآنيّة منذ العهد النبوي، وتدوينها، ما يجعل من الصعب ابتكار قراءة جديدة مع هذا الشيوع والتواتر، والأمر أصعب بعد التدوين وحمل الناس على مصحف واحد.
الوجه الثاني: يشبه الوجه الأول، بل هو نفسه لأنه يعتمد على حديث السبعة أحرف فقد وردت عندهم روايات متعددة منها ما روي لاستعجاب بعض الصحابة لبعض القراءات التي لم يعلموا بها في عهد النبيّ فبين لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
عن أُبي بن كعب قال كُنْتُ في المَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أنكَرْتُهَا عليه ثم دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمًا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه[وآله] وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: إن هذا قَرَأَ قِرَاءَةً أنكَرْتُهَا عليه، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فأمَرَهُما رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه[وآله] وَسَلَّمَ، فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عليه [وآله] وَسَلَّمَ شَأنهُمَا، فَسَقَطَ في نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إذْ كُنْتُ في الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمًا رَأَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه[وآله] وَسَلَّمَ ما قدْ غَشِيَني، ضَرَبَ في صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأنما أنظُرُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقالَ لِي: يا أُبَيُّ أُرْسِلَ إلَيَّ أن اقْرَأِ القرآن علَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إلَيْهِ أن هَوِّنْ علَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إلَيَّ الثًانيةَ اقْرَأْهُ علَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إلَيْهِ أن هَوِّنْ علَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إلَيَّ الثًالِثَةَ اقْرَأْهُ علَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنيهَا، فَقُلتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثًالِثَةَ لِيَومٍ يَرْغَبُ إلَيَّ الخَلْقُ كُلُّهُمْ، حتَّى إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عليه[وآله].. وغيرها من الأحاديث المنقولة في مجامع أهل السنّة، ويعتبر هؤلاء أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف هو من الأحاديث المتواترة». وقد ورد حديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جمع من الصحابة: أبي بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب
وسليمان بن صرد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمرو بن أبي سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأبي أيوب، فهؤلاء أحد وعشرون صحابيًا».
ومدرسة أهل البيت عليهمالسلام، لا تؤمن بصحة حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» فضلًا عن تواتره، وحتى لو سلّمنا بصحته فلا يصح تفسيره بالقراءات السبع أو غيرها؛ كما سنبيّن.
الوجه الثالث: لما كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى الأمصار لم يكتفِ الخليفة عثمان بإرسالها وحدها، بل أرسل مع كل مصحف عالمًا من علماء القراءة يعلّم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف، فكان كل واحد منهم يقريء أهل مصره بما تعلمه من القراءات الثابتة عن رسول الله بطريق التواتر التي يحتملها رسم المصحف، دون الثابتة بطريق الآحاد والمنسوخة، وإن كان يحتملها رسم المصحف، فالمقصود من إرسال القارىء تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات بالمنقول منها تواترًا.
الوجه الرابع: لوكان مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خلوّ المصاحف من النقط والشكل، وكان كل قارىء يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه، إذا كان الرسم محتملًا لها، ولم يكن مبعثها الوحي والمشافهة والتلقي من رسول الله، لكان بعض القرآن من كلام البشر، ولم يكن كله وحيًا سماويًا منزلًا من عند الله، ولوكان كذلك لذهبت أهم خاصية يمتاز بها القرآن وهي الإعجاز، ولو ذهبت خاصّيّة الإعجاز لم يكن للتحدي به أي وجه.
نحن نسلم بصحّة هذه الفكرة؛ لأنّ بعض القراءات بل أكثرها هي اجتهادات شخصية وهي ليست رواية عن رسول الله في كثير من الأحيان حتى نناقش أنها رواية آحاد أم رواية متواترة، لأن هذا البحث فرع إثبات أن هذه رواية أصلًا. ولا نوافق أيضًا أن كل هذه القراءات هي وحي من الله تعالى؛ كما سنبيّن.
الوجه الخامس: أنّ القرآن سجّل على رسول الله أنّه لا يستطيع أن يبدّل في القرآن الكريم ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾، فإذا كان الرسول صلىاللهعليهوآله لا يستطيع تغيير حرف ولا كلمة في القرآن فكيف يستطيع ذلك أحد من الصحابة أو التابعين.
الوجه السادس: وعد الله بحفظ كتابه؛ كما قال في سورة الحجر: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ولا شك أن قراءته بالرأي والاختيار تفضي إلى تعريض نصوصه للتحريف والتغيير، وذلك ينافي الوعد بحفظه.
وهناك أوجه أخرى يظهر منها التناقض فمثلًا دفاع بعض علماء أهل السنّة عن القراءات ورد شبهة «جولدتسيهر»؛ وهي أن قصة جمع عثمان للقراءات في مصحف واحد تقدح في هذه الشبهة، وتبين عوجها، وذلك أنّ السبب الباعث على جمعه للمصاحف هو اختلاف الناس في البلدان المفتوحة في قراءات القرآن، فخشي حذيفة بن اليمان من ذلك، وصادف أن عثمان لديه التخوّف نفسه أيضًا، فمما يذكر أنّه: «لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بعضًا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافًا، فكأنه والله أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك». فالقراءات كانت موجودة قبل التدوين العثماني للمصحف، واختلاف الناس فيها هو ما دفع عثمان للجمع في مصحف واحد، فأين هذه الحقيقة التاريخية الثابتة من وجوه عديدة متواترة من زعم «جولدتسيهر» أن انعدام النقط والإعجام هو السبب في نشأة القراءات.
ولو سلّمنا أن القراءات كانت موجودة في زمن النبيّ، فهذا يعني أنها مأخوذة ومنقولة عنه صلىاللهعليهوآله، وهي وحي، وكما قال علماء أهل السنّة هي متواترة، فكيف يحق للخليفة الثالث أن يُلغي جملة من القراءات المتواترة عن النبيّ ويوحدّ الأمّة على قراءة واحدة، فما فعله الخليفة هو اعتراف منه باجتهادية هذه القراءات، لأنّه لوكان يعلم أنها قراءات رسول الله، أو أنها قراءات لبعض الصحابة وقد أمضاها النبيّ صلىاللهعليهوآله وقد نقلت بشكل متواتر عنه وعلى الرغم من ذلك قام بإلغاءها فهذا تصرف غير جائز، فهل يصدر من الخليفة فعل كهذا؟!
الوجه السابع: قد يقال في جواب «جولدتسيهر» إنّ المعتبر في القراءات ليس الرسم العثماني، وإنّما صحة القراءة وتواترها، لأنّنا قد نجد كلمة رسمت في المصحف العثماني بشكل واحد، ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات التي يحتملها الرسم، فاختلف فيها القرّاء، وتنوعت قراءاتهم، وفي بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد، لأنّ غيره لم يصح به النقل، ولم تثبت به الرواية مع أن الرسم يحتمله، ومن الأمثلة على ذلك: كلمة ( مالك) فقد وردت في القرآن في ثلاث مواضع:
في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.
وقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
وقوله تعالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ .
ورسمت هذه الكلمة برسم واحد في المواضع الثلاثة (ملك)، بحذف الألف بعد الميم، ولكن القراء اختلفوا في قراءتها في سورة الفاتحة فقط، فمنهم من قرأها بحذف الألف، ومنهم من قرأها بإثباتها، وأما في موضع آل عمران فقد اتفقوا
على إثبات الألف، وفي موضع الناس اتفقوا على حذف الألف، فلو كانت القراءات بالاجتهاد والرأي لا بالتلقّي والتلقين، وكان تنوع القراءات تابعًا لرسم المصحف لم يكن اختلاف القراءات مقصورًا على موضع الفاتحة فقط، بل شمل موضعي آل عمران والناس، لكنهم اختلفوا في موضع واحد فقط، ما يبين أن القراءة ثابتة بالسند والرواية، وليس بالرسم الذي جعله «جولدتسيهر» أساسًا للقراءات.
نسلّم بأنّ العبرة بالرواية المنقولة بطريقة صحيحة عن رسول الله، حتى لولم تبلغ حدّ التواتر، وليس العبرة بالرسم العثماني، ولكن ما لا نسلم به أن ما قام به بعض القرًاء ليس اجتهاديًا.
قدّم السيد الخوئي قدسسره في كتابه البيان ترجمة دقيقة للقرّاء السبعة؛ وهم: عبد الله بن عامر، وابن كثير المكي، وعاصم بن بهدلة الكوفي، وأبو عمرو البصري، وحمزة الكوفي، ونافع المدني، والكسائي الكوفي. وأضاف ترجمة ثلاثة قراء آخرين هم: خلف بن هشام البزار، ويعقوب بن إسحاق، ويزيد بن القعقاع. وبعد هذا العرض لأحوال القرّاء توصّل إلى النتائج الآتية:
الأول: أن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد. فبعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته.
الثاني: أنّ التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء، يدلنا دلالة قطعية على أنّ هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد.
الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد.
الرابع: احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحة قراءته، واحتجاج تابعيه على
ذلك أيضًا، وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القراء وآرائهم، لأنّها لوكانت متواترة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج.
وأشار السيد الخوئي إلى آراء جملة من علماء أهل السنّة تنفي التواتر عن القراءات السبع وغيرها وهذا يؤكد عدم صحة الاحتجاج بهذه القراءات ما لم تخضع للضوابط العلميّة المعتبرة.
قال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم».
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. وقد صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
وبعد أن عرض السيد الخوئي جملة من آراء علماء أهل السنّة، قال: «هل تبقى قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلّهم بعدمه؟ وهل يمكن إثبات التواتر بالتقليد، وباتّباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل، ولا سيما إذا كانت دعوى التواتر ممّا يكذّبها الوجدان؟!».
وأمّا بالنسبة لحديث الأحرف السبعة وأنها مرتبطة بالقراءات السبعة فهذا الأمر لا يقبله كبار المحققين منأهل السنّة والشيعة. يقول السيد الخوئي: «قد يتخيل أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع، فيتمسك لإثبات كونها من القرآن بالروايات التي دلت على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فلا بد لنا أن ننبه على هذا الغلط، وأن ذلك شيء لم يتوهمه أحد من العلماء المحققين. هذا إذا سلمنا ورود هذه الروايات، ولم نتعرض لها بقليل ولا كثير».
إذا نظرنا إلى كتاب «تاريخ القرآن» لنولدكه وكتاب «مذاهب التفسير الإسلاميّ» لجولدتسيهر والذي تأثر بنولدكه بل أخذ عنه، نجد أنهما ركّزا على الأمور الآتية:
أ. من ناحية المنهج، فالمنهج الذي اعتمده هؤلاء هو المنهج الفيلولوجي، وهو المنهج الذي يُعنى بدراسة الآثار العلميّة والمخطوطات القديمة بُغية إعادة تركيب معرفة جديدة من خلالها، وهو المنهج الذي أرسى دعائمه المستشرق سلفستر دي ساسي. وقد تقدم نقد هذا المنهج بشكل عام.
ب. نجد اهتمام وإشادة واضحة بمصادر القدماء من المستشرقين في الوقت الذي لم تتوفر الدراسة على المصادر الأصلية والأساسية لهذه الأبحاث وهي المصادر العربية، بل حتى عند الأخذ والاقتباس من هذه المصادر نجد الحيطة والحذر في نقل بعض النصوص، بالإضافة إلى كثرة التأويلات والتخريجات غير العلميّة في كثير من الأحيان وقد تعرضنا في ما سبق لكيفية تعامل هؤلاء مع المصادر الإسلاميّة والعربيّة بشكل عام لا بخصوص بحث القراءات ولكن هذا الأمر انعكس بطبيعة الحال على هذا المبحث.
ج. استخدم هؤلاء مصطلحات خاصة وغير مشهورة في كتب علماء المسلمين بل خلطوا وبشكل متعمد بين بعض المصطلحات والتي لها مداليل مختلفة،
وفسروا بعض الكلمات في الآيات القرآنيّة بطريقة تتناسب مع خلفياتهم الفكرية والدينية، وهذا موجود في كل أبحاث المستشرقين بشكل عام ولكننا نراه بوضوح في بحث القراءات. وهذا الأسلوب في البحث يعتبر من أخطر الأساليب على موضوعية البحث لأن تغيير المصطلح أو تشويهه سيؤدي حتمًا إلى نتائج غير علمية.
مثلًا نولدكه ومن تبعه غيَّروا كثيرًا في معاني المصطلحات وحمّلوها ما لا تحتمل، من هذه المصطلحات مصطلح «القراءة» الذي يشتق منه اسم «القرآن» واسم «القراءات»، ويذهب نولدكه إلى أن «قـرأ» هي كلمة حضارية لا يمكن أن تنشأ عند العرب البدو، وافترض أنها انتقلت إلى بلاد العرب من شمال الجزيرة، وأعطى لمصطلح قراءة معنى «نادى «لأنّه هو المعنى الأصلي للكلمة في اللغتين العبريّة والآرامية، أما كلمة «اقرأ» في سورة العلق فقد فسرها بتفسير غريب وهو: «عظ»، ثم رتب على هذا كله أن كلمة «قرآن» لم تتطور داخل اللغة العربيّة فهي مأخوذة من كلمة سريانية ومطبقة على وزن فعلان.
أما المستشرق أوطوبرتزل فإنه يسمّي الأمور بغير مسمياتها، فهو يطلق على (الإدغام) (الدمج)، والدمج شيء والإدغام في القراءات شيء آخر، ويطلق على (الوقف) (القطع)، ويطلق على (الإخفاء) (الاختفاء) ومن الواضح الفرق بين هذه المصطلحات ونرى هذه الطريقة موجودة في كثير من دراسات المستشرقين.
د. اعتمدوا المقارنة بين مصاحف الصحابة وهذا في نفسه لا إشكال ولكنهم اعتبروا أن هذه المصاحف نصوصًا مختلفة من القرآن الكريم، فنولدكه على سبيل المثال يسمّي مصحف عبد الله بن مسعود «نص ابن مسعود»، ومصحف أُبَي بن كعب «نص أُبَي» ومصحف عثمان بن عفان «نص عثمان».
والهدف الذي يريد هؤلاء أن يصلوا إليه أنه لا يوجد نص موحّد للقرآن الكريم، بل هناك نصوص كثيرة مختلفة، زيادة ونقصانًا، بسبب اختلاف مصاحف الصحابة، ونحن ولو سلمنا باختلاف المصاحف ووجود بعض الملاحظات والتحفظات على بعضها مشروط بألاّ يؤدّي ذلك إلى تحريف القرآن بالزيادة أو النقيصة، لأن عدم تحريف القرآن من الأمور المسلمة والمتفق عليها بين المسلمين بل هي مورد إجماع عندهم.
وما يراه علماء الإمامية أن هذا النص القرآني الموجود بين الدفتين هو النص الذي أُنزل على النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله ونُقل إلينا بالتواتر، وباقي المصاحف تُقاس عليه فلو فرضنا نُقل لنا أن مصحف ابن مسعود حُذف منه سورة الناس، وسورة الفلق، وسورة الفاتحة، أو أن مصحف أُبي فيه زيادات فعدد سوره 116 أو أن مصحف الإمام علي عليهالسلام -طبعًا لو افترضنا ذلك- فيه زيادة في المورد أو في غيره -طبعًا نحن نحمل هذه الزيادات على التفسير-، فكل هذه الروايات لا يمكن قبولها ولسبب بسيط وهو أن النص المنقول إلينا والذي يُسمى المصحف العثماني نسبة لجمع الخليفة الثالث عثمان للمصحف هو منقول بالتواتر ومجمع على عدم تحريفه بين المسلمين، وأي قول آخر سواء نُسب إلى أهل السنة أم الشيعة فهو قول شاذ. أما باقي المصاحف فهي أولًا؛ مشكوك في صحة نسبتها إلى بعض الصحابة، وثانيًا؛ ما نُقل لنا من اختلاف في ترتيبها أو بعض تفاصيلها مع المصحف الحالي فهي لم تصل إلينا من خلال نصوص معتبرة، أو في أحسن الحالات هي آخبار آحاد لا يصح التمسك بها في مقابل تواتر المصحف العثماني.
والسبب الثاني والأساس عند الإمامية والذي يجعلهم يلتزمون بهذا النص القرآني الموجود وأنّه غير محرَّف لا بالزيادة ولا بالنقيصة هو إمضاء أمير المؤمنين الإمام علي عليهالسلام؛ أي قبوله بهذا القرآن وقبول باقي الأئمّة من بعده لذلك وإمضائهم له، وكما هو مقرر عندنا إمضاء الإمام المعصوم حجّة، سواء جمع المصحف عثمان أو غيره، لأنه عند ذلك تصبح هذه الأبحاث مجرد أبحاث تاريخية لا تؤثر على الموقف العقدي عند الإمامية بعد إحراز القطع بموافقة الإمام علي عليهالسلام لما يسمّى بالمصحف العثماني.
هناك شبهات كثيرة أوردها «جولدتسيهر» وغيره على القراءات القرآنيّة؛ كما تقدم، وبناء على عدم تواتر القراءات السبعة، وعدم صحة حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» أو لا أقلّ النقاش في أصل الحديث أو في صحة تطبيقه على القراءات السبع المشهورة، فالأفضل معالجة هذه الشبهات بأسلوب ومنهج مختلف لا يعتمد تواتر القراءات، وحديث الأحرف السبع.
والمنهج الأفضل هو المعالجة الجزئية لكل مورد أي تتبع كل ما طُرح بعنوان مثال أو أنموذج على القراءات والإشكالات التي أوردها «جولدتسيهر» أو غيره على القراءات وردّ كل إشكال على حدة، وتوجيه القراءة وتصحيحها ضمن الضوابط المعروفة من صحة الرواية؛ أي الإسناد، وموافقة القراءة لقواعد اللغة العربية، ولا يرد هنا إشكال أنّ الأصل هو القرآن لا قواعد اللغة فالقرآن هو المصدر الأول والأهم على الإطلاق لقواعد اللغة، لأن الكلام في القراءة المحدّدة وهي أحد أوجه القراءة لا أنّها هي النص القرآني نفسه؛ بمعنى أنّه لا تساوي بين قراءة النص القرآنيّ والنص القرآنيّ نفسه.
وقد جاء «جولدتسيهر» بأمثلة تطبيقية على كلامه في القراءات بلغت سبعة وأربعين مثالًا. فالصحيح هو الردّ على هذه الشبهات بالتفصيل لكي لا يتمكن هؤلاء من ادّعاء تحريف القرآن أو التشكيك بإعجازه وذلك بسبب اختلاف القراءات، وفي حال أدت إلى ذلك فنحن نرفع اليد عن القراءات الاجتهادية، لا عن سلامة النص القرآني وإعجازه والتي هي من الأمور المسلّمة بين المسلمين لأنه لم تثبت حجية القراءات كما يقول السيد الخوئي: «الحق عدم حجية هذه القراءات، فلا يستدل بها على الحكم الشرعي. والدليل على ذلك أنّ كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه، ولم يرد دليل من العقل، ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص، وقد استقل العقل، وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم. وإن قيل: إن القراءات -وإن لم تكن متواترة- إلا أنها منقولة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله فتشملها الأدلة القطعية التي أثبتت حجية الخبر الواحد.
(450)أولًا: أن القراءات لم يتضح كونها رواية، لتشملها هذه الأدلة، فلعلها اجتهادات من القراء، ولعل السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أنّ الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل.
ثانيًا: أنّ رواة كل قراءة من هذه القراءات، لم يثبت وثاقتهم أجمع، فلا تشمل أدلة حجية خبر الثقة روايتهم.
ثالثًا: أنا لو سلمنا أنّ القراءات كلها تستند إلى الرواية، وأن جميع رواتها ثقات، إلا أنّا نعلم علمًا إجماليًّا أنّ بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قطعًا، ومن الواضح أنّ مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات وتكون كل واحدة منها مكذّبة للأخرى، فتسقط جميعها عن الحجية، فإن تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجح، فلا بد من الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات».
زعم جملة من المستشرقين وجود مجموعة من الأخطاء اللغوية والنحويّة في القرآن الكريم، بل بعضهم اعتبر أن هناك أخطاء نحويّة كثيرة في القرآن الكريم، وهذه الشبهات يمكن طرحها بشكل مستقل أو طرحها في ذيل أبحاث الإعجاز القرآني لأنّهم قالوا: الإعجاز القرآني يرتكز بصورة رئيسة على فصاحته وبلاغته أي (لغته). ولقد وضع العرب قبل الإسلام -حسب ادّعاء هؤلاء- قواعد وأسسًا للفصاحة والبلاغة والنطق، تعتبر هي المقياس الرئيس في تمييز الكلام البليغ من غيره. وعلى هذه القواعد والأسس يجب أن تقاس النصوص.
والحال مع المسلمين مختلف تمامًا، لأنهم قلبوا القاعدة حين جعلوا القرآن هو القياس الذي يتحكم في صحة قواعد اللغة أو خطئها، فكان يجب على المسلمين أن يجعلوا من هذه القواعد مقياسًا يحكموا به على القرآن وليس العكس كما هو حاصل. وبالرغم من ذلك نجد في القرآن بعض الآيات التي لا تنسجم مع هذه القواعد بل تخالفها؛ الأمر الذي يدعونا إلى القول إنّ القرآن ليس معجزًا لأنه لم يسِر على نهج القواعد العربيّة وأصولها!
وزعمَ هؤلاء بوجود أخطاء لغوية، يصدر عن موقف عام للمستشرقين حيال القرآن الكريم، وهو إنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم، ومع إجماعهم على هذا الرأي، فقد انقسموا إلى فريقين:
الأول: أنّ القرآن قد نُقل من مصادر أخرى، وألّفه النبيّ محمد وادّعى أنّه موحى به من الله تعالى، ويمثل هذا الفريق جملة من المستشرقين منهم: سبنجر، نولدكه، مرجليوث، جولدتسيهر، وبرجستراسر، وغيرهم. ويرى هؤلاء أن سبب الأخطاء اللغوية في القرآن هو علاقة اللغة العربيّة باللغات الشرقيّة القديمة.
الثاني: يرى أن القرآن الكريم إنّما هو نتاج جمعي تطور على امتداد القرن الأول والثاني الهجري، واشترك في وضعه جملة من الكتّاب والأدباء والشعراء
(455)والخلفاء وغيرهم، ويمثل هذا الفريق جملة من المستشرقين منهم: يهودا دي نيفو، بيلامي، مايكل كوك، وباتريسيا كرون، وغيرهم. ويرى هذا الفريق أن السبب في وجود الأخطاء اللغوية للقرآن الكريم، هو ما قام به محمد ومن جاء من بعده في وضع القرآن، وكما يرون أن طبيعة اللغة العربيّة آنذاك، هي السبب المباشر لهذه الأخطاء اللغوية في القرآن.
ويعتبر نولدكه من أوائل علماء الاستشراق الذين تحدثوا عن أخطاء لغوية في القرآن، وتحدث عن مصادر القرآن، واعتبره عمل بشري قام به النبيّ محمد أي أنه عمل يعتريه النقص والخطأ وهي لوازم الطبيعة البشرية وقد أطلق على القرآن أوصافًا كثيرة تنسجم مع العمل البشري بل الظاهر من بعض تعابيره أنه عمل بشري غير متقن، فقال عن القرآن: «إنه غير متناسب الأجزاء» و«أسلوب نشاز» و«غير جميل» وغير ذلك واقترح على النبيّ أنه كان عليه «أن يتأمل طويلًا في محتوى وحيه قبل أن يبرزه للعالم. لكنه لم يعرْ اهتماما كبيرًا لأسلوبه». وسار على خطى نولدكه أكثر المستشرقين الذين كتبوا في هذا المجال.
يعتبر برجستراسر أول من فصَّل القول في الزعم بوجود أخطاء لغوية في القرآن الكريم وذلك في الجزء الثالث من كتاب «تاريخ القرآن» لنولدكه وهو الكتاب الذي أكلمه برجستراسر بعد وفاة نولدكه. وقد بُني هذا الجزء على ثلاثة فصول خُصص الفصل الأول للرسم، وبُني على أربعة مباحث: المبحث الأول في أخطاء النص العثماني.
ويقول في أول الفصل الثالث في أخطاء النص العثماني: «اعترف المسلمون منذ زمن طويل بأن نصَّ القرآن الذي أصدرته اللَّجنة التي عيَّنها عثمان لم يكن كاملًا على وجه الإطلاق، ويوجد بين أيدينا عددٌ من الروايات التي أخذت على هذا النص أخطاءه المباشرة».
الرواية الأولى: والتي اعتمد عليها برجستراسر لدعم رأيه في وجود أخطاء لغوية هي رواية اللَّحن وأردفها برواية خطأ الكتّاب المروية عن عائشة والرواية الأولى؛ هي:
«لما كتبت المصاحف عُرضت على عثمان، فوجد فيها حروفًا من اللحن، فقال: لا تغيّروها ؛ فإنّ العرب ستغيّرها -أو قال ستعرّبها بألسنتها- لوكان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف».
وقد كفانا علماء أهل السنّة مؤونة الردّ:
أ. أنّه لا تصح أسانيد هذه الآثار، وضعف أسانيدها يشكك في دقة متونها. وعن مصدر هذه المتون، قال الداني: «هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجّة، ولا يصحّ به دليل من جهتين، إحداهما: أنه -مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه- مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئًا، ولا رأياه، وأيضًا، فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان، لما فيه من الطعن عليه، مع محلّه من الدين ومكانه من الإسلام، وشدّة اجتهاده في بذل النصيحة، واهتباله بما فيه الصلاح للأمّة. فإن قال: فما وجه ذلك عندك لو صحّ عن عثمان؟ قلت: وجهه أن يكون عثمان أراد باللحن المذكور في التلاوة دون الرسم».
يقول محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار: «وروي عن عثمان أنه قال: إن في كتابة المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها، وقد ضعّف السخاوي هذه الرواية وفي سندها اضطراب وانقطاع. فالصواب أنها موضوعة، ولو صحّت لما صحّ أن يعدّ ما هنا من ذلك اللحن، لأنه فصيح بليغ...».
وهو رأي الرافعي ومحمد أبو زهرة، فقد وصف محمد أبو زهرة هذه الأحاديث المنافية لتواتر القرآن بـ: «الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر القرآن الكريم، التي احتوتها بطون بعض الكتب كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، التي تجمع كما يجمع حاطب ليل، يجمع الحطب والأفاعي، مع أن القرآن كالبناء الشامخ الأملس الذي لا يعلق به غبار». ثم استشهد بكلام الرافعي القائل: «... ونحسب أن أكثر هذا ممّا افترته الملحدة» وقال: «وإن ذلك الذي ذكره هذا الكاتب الإسلاميّ الكبير حقّ لا ريب فيه».
ب. وأجيب عن رواية عثمان ورواية عائشة الآتية: بأن هذا بعيد جدًّا، لأن الّذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة والقدوة على ذلك، فكيف يتركون في كتاب الله لحنًا يصلحه غيرهم، فلا ينبغي أن ينسب هذا لهم، قال ابن الأنباري: ما روي عن عثمان لا يصحّ لأنه غير متصل، ومحال أن يؤخّر عثمان شيئًا فاسدًا ليصلحه غيره. وقال الزمخشري في الكشّاف: ولا يلتفت إلى ما زعموا....
ت. هناك جملة من العلماء حاولوا توجية رواية عثمان وأمثالها من الروايات بما يتناسب مع الإجماع على عدم تحريف القرآن الكريم يمكن فهم كلام عثمان على أنه أراد باللحن: اللحن في التلاوة بسبب اشتباه الرسم على الناس في بعض الأحيان، فطمأنّ بأنّ سلامة ألسنة العرب ستصحّح تلاوة من يخطئ في قراءة كلمات القرآن. هذا تفسير أبي عمرو الداني للحديث.
الرواية الثانية: ما روي عن عائشة: يرويه هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ﴾، ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾، و﴿قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾، فقالت: يا ابن أختي! هذا عمل الكُتّاب، أخطؤوا في الكِتَاب.
أمّا الرد على هذه الرواية:
أ. تشكيك علماء أهل السنّة في هذه الرواية. وقد تنوعت طرق التشكيك، فمنهم من اكتفى «بالاستبعاد»، وآخر يقول: «فيه نظر»، وثالث يقول: «لا يخفى ركاكة هذا القول»، ورابع يقول: «لا يلتفت...»، وخامس يقول: «غريب»...، وبعض العلماء حكم بوضع هذه الأحاديث فقال: الحكيم الترمذي: «... ما أرى مثل هذه الروايات إلاّ من كيد الزنادقة....»
ب. الآيات التي ذكرت في الرواية ليس صحيحًا أنّ فيها لحن، فقد قال الزمخشري: «(والمقيمين) نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع قد ذكره سيبويه على أمثله وشواهد، ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خطّ المصحف...».
وقال الرازي: وأمّا قوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ ففيه أقوال؛ الأول: روي عن عثمان وعائشة أنّهما قالا: إن في المصحف لحنًا وستقيمه العرب بألسنتها. واعلم: أنّ هذا بعيد، لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه؟!.
ج. بعضهم حاول أن يوجّه رواية عائشة أيضًا بأنّه يمكن فهم كلام عائشة على أنّها ترى أنّه لو اختيرت القراءات الأخرى الموافقة للمشهور من قواعد اللغة العربيّة بين العامّة لكان أفضل، فتخطئتها للكتاب بمعنى مخالفة القراءة المشهورة، والوجه الفاشي في العرب من أعاريبها. وهذا التوجيه هو ملخّص ما ذكره الطبري في جامع البيان.
وبعد ذلك عرض برجستراسر مجموعة من الأخطاء اللغوية التي ادّعى وجودها في القرآن الكريم وقسّمها إلى قسمين:
-الأخطاء اللغوية المتعلقة بقواعد النحو.
-الأخطاء المتعلقة بالمحتوى أي المفردات؛ كاستبدال كلمة مكان أخرى.
ولا بد من أن نلفت عناية المهتمين في الرد على أمثال هذه الشبهات -والتي بالمناسبة صدرت من بعض المسلمين العرب وليست من مختصات الفكر الاستشراقي وإن كنا نلحظ أنّ أكثر شبهات هؤلاء ترجع إلى شبهات المستشرقين أو هي شبيهه بها إلى حد كبير- يمكن اتّباع أكثر من أسلوب في الردّ. ومن هذه الأساليب نذكر:
بأن نعمد إلى تتبع كل الجزئيات التي عرضها هؤلاء وادّعوا أنها تخالف قواعد اللغة ونجيب عن كل جزئية ونبين الأوجه النحوية واللغوية وغير ذلك من خلال الرجوع إلى الكتب الرئيسة في هذا المجال؛ كالكشاف للزمخشري، وإعراب القرآن للنحاس، وإعراب القرآن للزجاج، وكتب النحو العربي والبلاغة وغيرها من الكتب. وسنشير إلى بعض النماذج في هذا المجال. طبعًا هذا مع التسليم بصحّة هذه القواعد النحويّة وسلامتها.
(460)بأن نبيّن القواعد الكلّيّة التي بنيت على بعض الظواهر القرآنيّة التي لحظها في الآيات ويظنّها من لا خبرة له ولا تمرّس باللغة العربيّة أنها مخالفة للقواعد النحوية، فعلى سبيل المثال: فإنّ ما اعتقده بعض المستشرقين أمثال نولدكه وتبعه آخرون على ذلك من عدم المطابقة بين العدد والمعدود، أو المذكر والمؤنث، أو غير ذلك واستهجن من هذا الأمر واعتبره غير حسن، بل غير طبيعي وهو ما يسميه التحول النحوي في القرآن، أن كل هذه الأمور خاضعة لظاهرة بلاغية معروفة ومشهورة بين علماء اللغة بعنوان الالتفات. وسنشير إلى هذا الموضوع ولو باختصار. وعلى كل حال يمكن الدمج بين الأسلوبين.
ادّعى جيمس بيلامي أنّ القرآن قد تطور عبر التاريخ في القرنيين الهجريَّين الأوَّلين، واعتبر أن الأخطاء وقعت بسبب النُّساخ، وانصبت جهوده على مجموعة من «أخطاء النقل» أو الأخطاء الإملائية. ومن الأخطاء التي ذكرها:
أ. استند بيلامي إلى الروايات المنقولة عن عثمان في قضية الرسم وقد تقدمت الإجابة عن ذلك.
ب. استند إلى بعض الروايات المنقولة عن أمير المؤمنين عليهالسلام والتي تنقل أن الإمام علي اعترض على بعض الأخطاء في نسخ المصاحف من قبل قوله تعالى: ﴿وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾، وقال إن الصحيح هو «وطلع منضود».
ج. ذكر جملة من الأخطاء وأرجعها إلى القرّاء والنُّساخ والسبب في رأيه خلوّ القرآن الكريم من النقط والإعجام ومن ضعف الرواية الشفوية في التلقي عن النبيّ، لذا لم تصمد الرواية في وجه الكتابات غير المعجمة، ولأجل ذلك سقط القرّاء في أخطاء في المفردات والتعبيرات. ومن الأخطاء التي ذكرها:
• حصب أم حطب: قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾، وقد فسرت العبارة «حصب جهنم» بمعنى «كل ما يلقى فيها لتشتعل به». وهي المرة الوحيدة التي يستعمل فيها القرآن هذه كلمة. والصحيح عنده هو «حطب» كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ ويعتبر بيلامي أن الخطأ من النُّساخ فقد أبدلوا الطاء صادًا.
والصحيح: على الرغم من اختلاف التعبير في آيتين كريمتين من آيات القرآن الكريم بالنسبة إلى ما يلقى في نار جهنم بهدف الاحراق لكن النتيجة واحدة وهي الاحتراق، لكن هناك فرقًا لطيفًا بين التعبيرين.
الحَصَبْ هي جمع حصبة وهي الحجارة والحصى الصغيرة التي تُقذف باليد أو بالآلات اليدوية، وقد أكد القرآن الكريم بأن مصير العابدين للأصنام كمصير الأصنام فكلها تُقذف في نار جهنم لتحترق.
وقد يُتصور فرقًا لطيفًا بين الحطب والحصب، وهو أن الله عَزَّ وجَلَّ أراد احتقار الأوثان التي تعبد من دون الله وتشبيهها بالحصى الصغيرة التي لا قيمة لها ولا هيبة، فترمى في نار جهنم مع من كانوا يعبدونها.
• حِطةٌ أم خِطأة: قال تعالى: ﴿رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ ، قال بيلامي الصحيح «خِطأة».
• مثاني أم متالي: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، صححها إلى المتَالي اسم مفعول من المتْلُو.
• أمنيته أم إملائه قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا
نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ . عند بيلامي «إلا إذا يُملي ألقى الشيطان في إملائه».
• أماني أم أمالي قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ ، زعم أنها أماليَّ.
• كلمة صبغة في قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾، زعم أن ينبغي أن تغيير إلى «صنيعة الله».
• كلمة أعراف في قوله تعالى: ﴿الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾، أجراف بمعنى المكان العالي. إلى غيرها من الافترضات التي افترضها بيلامي.
اعتبر بعض المستشرقين أن هناك أخطاء نحوية كثيرة في الآيات القرآنيّة سببها عدم التطابق بين التذكير والتانيث، والإفراد والجمع، والعدد والمعدود، والصفة والموصوف، وغير ذلك. والواقع أنّهم يجهلون أساليب القرآن، وطرائقه البيانيّة ومن ذلك أسلوب الالتفات أو العدول.
ويمكن تعريف أسلوب الالتفات في القرآن أنّه: نَقْلُ الْكَلَامِ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى آخَرَ، مِنَ الْغَيْبَةِ إِلِى الْخِطَابِ، وَمِنَ الْخِطَابِ إِلِى الْغَيْبَةِ وَمِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْجَمْعِ، وَمِنَ الْخِطَابِ إِلِى التَّكَلُّمِ، وَمِنَ التَّكَلُّمِ إِلِى الْخِطَابِ.
قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾.
في الكلامِ الْتِفَاتٌ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ، وَلَو جَرَى الكلامُ عَلَى نسقٍ وَاحِدٍ لَكَان في غير كلام الله تعالى: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِكُمْ).
مِثَالُ الِالْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ:
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ . في هذه الآيةِ الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ في قوله: ﴿الَّذِي أَسْرَىٰ﴾، إِلَى التَّكَلُّمِ في قوله: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ﴾. وفيها الْتِفَاتٌ آخرُ مِنَ التَّكَلُّمِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ﴾، إِلَى الْغَيْبَةِ في قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾.
في هذه الآية ِالْتِفَاتٌ مِنَ الْوَاحِدِ في قوله: ﴿مَا حَوْلَهُ﴾ إِلَى الْجَمْعِ في قوله: ﴿بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾، وَلَو جَرَى الكلامُ عَلَى نسقٍ وَاحِدٍ لَكَان في غير كلام الله تعالى: (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُ). وَلا شك أن الِالْتِفَاتَ أَفْصَحُ فِي الْكَلَامِ، وأوقعُ في النفوسِ، وَأَبْلَغُ فِي نَظْمِ الْكَلَامِ.
وما نريد أن ننبه عليه أن كثيرًا من إشكالات المستشرقين المتعلقة بهذه الأمور سببه عدم فهمهم لظاهرة الالتفات والتي هي أحد أوجه البلاغة في اللغة العربية.
وهناك إشكالات متعددة على الإعراب أوردها هؤلاء من قبيل قولهم إنّ هذه
الجملة في القرآن خطأ لأنها لا تتناسب مع قواعد الإعراب المعروفة. وقد ألّف علماء اللغة العربيّة وغيرهم من الفقهاء والمحدّثين كتبًا للإجابة عن هذا النوع من الأسئلة وذلك لتوجيه ما قد نسميه مشكلة في الإعراب ونحن نعتقد أن الأصل هو التمسك بالقرآن لا بالتوجيهات اللغوية لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر وهو أفصح كلام العرب بل نحن المسلمون نعتقد بالإعجاز البلاغي للقرآن. ومن هذه الكتب يمكن مراجعة ما كتب عن المشكل في الإعراب من قبيل «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ت 276ه) وكتاب «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت 437ه) وكتاب «البستان في إعراب مشكلات القرآن» لأبي الهيثم الجيلي (ت 717ه) وغيرها من الكتب.
في الختام يجدر بنا أن نضع القارئ أمام حصيلة لأهم الاستخلاصات والنتائج التى قاد إليها هذا البحث عن الاستشراق والدراسات الاستشراقية القرآنية القديمة
(المنتصف الأول من القرن العشرين)، نعرضها في شكل نقاط على النحو الآتي:
• الشرق الذي اهتم الغرب بدراسته والتخصص في ثقافته وتراثه، ليس هو الشرق الجغرافي الطبيعي، وإنما هو «الشرق الهوية».
• مصطلح المستشرق ظهر أولًا في إنجلترا 1779 م أو1780م، ثم في فرنسا عام 1799م في حين لم تدخل كلمة «الاستشراق» معجم الأكاديمية الفرنسية؛ إلا عام 1838م.
• انتهى مصطلح الاستشراق، رسميًا، في مؤتمر باريس للاستشراق عام 1973 بمناسبة مرور قرن على بداية عقد المستشرقين لمؤتمراتهم العالمية التي كانت تعقد كل (3- 5) سنوات.
• طَلائِع المُستَشرِقين الأولى من النَّصارَى خرجَتْ من الكنائس والأديِرَة، بمناصب دينية، والبداية (الرسمية) للاستشراق من «مجمع فيينا الكنسي» سنة 712هـ - 1312م، الذي أَوصَى بإنشاء كراسٍ عدّة لِلُّغات، ومنها اللغة العربية.
• الهدف الرئيس من أعمال المستشرقين وجهودهم في بدايات الاستشراق في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التي تلت ذلك: هو التبشير.
• الهدف العلمي للاستشراق، هو أحد الدوافع التي دفعت بعض المستشرقين إلى دراسة علوم الشرق. ولكن للأسف هذا الصنف عدده قليل جدًا إذا قيس بأعداد المستشرقين الآخرين.
• لم يترك المستشرقون مجالًا من مجالات الأنشطة المعرفية والتوجيهية العليا إلّا تخصصوا فيها، ومنها التعليم الجامعي، وإنشاء المؤسسات العالمية لتوجيه
التعليم والتثقيف، وعقد المؤتمرات والندوات ولقاءات التحاور، وإصدار المجلات ونشر المقالات وجمع المخطوطات العربية، والتحقيق والنشر وتأليف الكتب.
• يمتاز الاستشراق الفرنسي بأنّه أسّس كثيرًا من المعاهد والمدارس الثقافية في بلاد الشرق، كما امتاز بالتخصص.
• يمتاز الاستشراق البريطاني بارتباطه بالحركة الاستعمارية، والاهتمام باللغة العربية.
• المدرسة الاستشراقيّة الألمانية لم تكن نتيجة لأهداف سياسية واستعمارية. أبرز ما قام به المستشرقون الألمان في مجال اللغة والتاريخ العربيين والدراسات الإسلاميّة هو أنهم جمعوا المخطوطات العربيّة، ونشروها، وفهرسوها.
• يعتبر الدافع العلمي المحرّك الأول للاستشراق الإسباني وكان للقساوسة والرهبان أثرٌ واضحٌ في تنشيط الاستشراق. وفهرسة المخطوطات العربيّة أحد المجالات التي اهتم بها المستشرقون الإسبان.
• الاستشراق الأمريكي بدأ عمليًا بعد الحرب العالمية الثانية، وشَهِد نهضةً شاملة حينما أَخْلَتْ بريطانيا مواقعَها للنفوذ الأمريكي، ومن أبرز اهتمامات السياسة الأمريكية دراسة الحركة الإسلاميّة وسبل مواجهتها والقضاء عليها، ومن ذلك أن مجموعة من المستشرقين والسياسيين الذين عملوا في العالم الإسلاميّ قدموا ثمرة خبراتهم وبحوثهم للكونجرس الأمريكي.
• أشهر الدراسات الاستشراقيّة عن السنة النبوية قام بها ألويس اشبرنجر، ووليم موير، وإجناتس جولدتسيهر، وأرند جان فِنْسِنْك، وجوزيف شاخت، وجيمس روبسون.
• منهجهم في دراسة السنة أي كتب الأحاديث يعتمد تكذيب الأحاديث
(467)المروية في الصحاح، وانتقاد طريقة اعتماد الأسانيد. وهم يدّعون أنّ الأسانيد أضيفت إلى المتون بتأثير خارجي.
• إنّ أشهر من صنف في السيرة النبويّة: جولدتسيهر، ومونتغمري وات، وجوستاف لوبون، وستانلي بول، وغيرهم.
• المنهج الاستشراقي ركز على: نفي النبوة، وإنكار ظاهرة الوحي، ونفي الخصوصية عن دين الإسلام، والتركيز على الجانب المادي السياسي والاقتصادي في السيرة النبوية، وتهميش الإصلاحات الاجتماعية والتربوية والفكرية الأخرى.
• جهل كثير من المستشرقين بحقائق الإسلام، أدى بهم إلى كثير من الأخطاء في استنتاجاتهم العلميّة.
• الحكم المسبق على الإسلام، وإنكار كثير من المسلمات التي يرتكز عليها الفكر الإسلاميّ، جعل أكثر الناتج الاستشراقي غير علمي.
• التفكير الذي يحكم عقلية المستشرق هي الدوافع المادية، ولذا مناهحهم دائمًا تسعى إلى ترجيح الدافع المادي.
• من المشاكل التي تحكم المناهج الاستشراقيّة مركزية الغرب في عملية أي تقويم لأي أنموذج آخر، فالثقافة والحضارة الغربيّة هي الأعلى والأسمى والأنقى.
• الدافع الديني يعتبر من أهم الدوافع لدراسة القرآن الكريم وعلومه، وتأتي بعده الدوافع الأخرى.
• لا يوجد ضابط واضح لتحديد عدد المناهج المشتركة بين المستشرقين.
• عندما بدأت دراسات المستشرقين للإسلام لم تكن كتابات علمية ومنهجية.
• ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ الخاصة بالمستشرقين في بحث الدراسات والقضايا القرآنية، تتغيّر
(468)وتتبدّل من بحث لآخر، تبعًا لخلفيات الباحث ومنطلقاته الفكرية في توظيف المنهج على الدراسة بعينها.
• المناهج الاستشراقيّة لا يمكنها أن تعالج الظواهر الغيبية؛ كالقرآن الكريم.
• هناك مناهج متعددة اعتمدها المستشرقون لدراسة القرآن.
• في المنهج الاستشراقي وفي تعامله مع المصادر القرآنيّة سجلنا ملاحظات عدّة:
• اعتماد عدد معين ومحدود من مصنفات علوم القرآن دون غيرها.
• انتقاء الروايات الضعيفة والشاذة من مصادر علوم القرآن.
• إهمال المصادر القرآنيّة الأصيلة والاكتفاء بدراسات المستشرقين السابقة.
• إنّ الانتقائية في انتخاب المصادر واضحة في أبحاث المستشرقين ودراساتهم، وبالأخص في المجال القرآني.
• أجرى المستشرقون عمليات إسقاطية على القرآن شملت:
- إسقاط المفاهيم الاستشراقيّة على التعريف بالقرآن الكريم.
- إسقاط المفاهيم الاستشراقيّة على تاريخ القرآن الكريم.
- إسقاط المفاهيم الاستشراقيّة على العقائد القرآنية .
• إنّ ترجمات المستشرقين لمعاني القرآن الكريم -في غالبها- ترجمات غير أمينة، ولا يمكن أن تعبّر عن المعاني الحقيقيّة للقرآن، بل تشوّه معانيه وتحرّفها؛ لأنّها تنطلق من اعتقاد أساس راسخ عند هؤلاء المترجمين، وهو رفض حقيقة أن القرآن منزَّل من عند الله، والادّعاء أنّه تأليف النبيّ محمد صلىاللهعليهوآله.
• هناك جهد واضح في كتابة الموسوعات وصناعة المعاجم ومنها المعاجم القرآنية. وقد سجلنا ملاحظات على بعض هذه الأعمال منها: الخطأ في الاستشهاد، والخطأ في التبيويب.
(469)• عند مراجعة الأبحاث والدراسات التي كتبها المستشرقون عن ﻣﺼﺪر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ نجدهم في الأغلب اتفقوا على نفي أي علاقة بين هذا الكتاب والسماء، والتعامل مع القرآن على أنه نتاج بشري وليس كتابًا سماويًا...
• في تعريف القرآن نجد الدراسات الاستشراقيّة، في عمومها، قائمة على اعتبار القرآن الكريم نتاجًا بشريًا، فهم لا يؤمنون بأنّ القرآن وحي إلهي.
• غلب على أكثر المناهج الاستشراقيّة في دراسة القرآن المناهج التي اعتمدها هؤلاء في دراسة التوراة والإنجيل وهو «منهج النقد الأعلى والأدنى للكتاب المقدس».
• يعتبر نولدكه من أوائل الذين فتحوا باب التشكيك في موثقية النص القرآني في كتابه تاريخ القرآن.
• «اجنتس جولدتسيهر» و«ريجي بلاشير» و«ريتشارد بل» حاولوا أن يشككوا في صحة القرآن من خلال نسبة التحريف إليه.
• مناشئ القول بتحريف القرآن الكريم عند المستشرقين: قياس القرآن على الكتب السماويّة السابقة، والأهداف التبشيريّة والسياسيّة، ووجود بعض الروايات الضعيفة عن تحريف القرآن الكريم.
• في الردّ على الروايات التي اعتمدوا عليها هي: روايات ضعيفة، أو موضوعة، أو صحيحة ومن خلال التأمّل فيها نصل إلى أن المقصود من التحريف فيها هو التحريف المعنوي.
• المستشرقون أثاروا شبهة التحريف ووقوع الزيادة والنقصان في سور القرآن وآياته، محتجّين بما جاء في كتب الحديث والسيرة وكتب التاريخ والتفسير عن قضيّة جمع القرآن وترتيبه بعد العصر النبوىي.
• ذهب أكثر المستشرقين ـ تبعًا لأهل السنّة إلى الاعتقاد بعدم جمع القرآن في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله بشكلٍ كاملٍ في مصحف واحد.
• الخصائص التي ذكرها علماء التفسير للمكّي والمدني قد تؤدّي إلى ترجيح
(470)أحد الاحتمالين على الآخر في السور التي لم يرد نص بأنها مكّية أو مدنية ولكن الاعتماد على تلك المقاييس إنما يجوز إذا أدّت إلى العلم، ولا يجوز الأخذ بها لمجرد الظن.
• سعى المستشرقون إلى تضخيم هذه الخصائص، وإلى توظيفها بطريقة سيئة بتفسيرها في ضوء المنهج الذاتي الذي سيطر على دراستهم.
• توهّم جملة من المستشرقين: أمثال نولدكه، وجولدتسيهر، ولامنز، وبلاشير، وكازانوفا، وغيرهم أن القرآن الكريم كان متأثرًا بالبيئة لا مؤثرًا فيها.
• الصحيح أن هناك فرق بين أن تفرض الظروف نفسها على الرسالة، وبين أن تفرض الأهداف والغايات- التي ترمي الرسالة إلى تحقيقها من خلال الواقع- أسلوبًا ومنهجًا للرسالة.
• نسخ التلاوة أمر واضح البطلان عند علماء الإمامية، بل هو عين القول بالتحريف ولا يوجد أي فرق بينهما إلا التغاير اللفظي.
• الموقف الذي ساد في البيئة الاستشراقيّة هو عدم الإقرار بإعجاز القرآن الكريم.
• المنهج الأفضل في بحث القراءات هو المعالجة الجزئية لكل مورد أي تتبع كل ما طُرح بعنوان مثال أو أنموذج على القراءات والإشكالات التي أوردها «جولدتسيهر» أو غيره على القراءات، ورد كل إشكال على حدة، وتوجيه القراءة وتصحيحها ضمن الضوابط المعروفة.
• زعم جملة من المستشرقين وجود مجموعة من الأخطاء اللغوية والنحويّة في القرآن الكريم، بل بعضهم اعتبر أن هناك أخطاء نحويّة كثيرة في القرآن الكريم.
• الصحيح أن هذا يدلّ على مشكلة في القواعد النّحوية لا العكس، وإن كان جملة من العلماء حاولوا توجيه الآيات بما يتناسب مع القواعد النحويّة ولكن ما نراه صحيحًا هو أنه في حال مخالفة القرآن للقواعد النحويّة نتمسك بالآيات لا بالقواعد في هذا المجال.
(471)القرآن الكريم.
1- ابن إبراهيم القمّيّ، علي: تفسير القمِّيّ، تصحيح وتقديم وتعليق: طيِّب الموسويّ الجزائريّ، لا ط، لا م، مطبعة النجف، 1387هـ.ق.
2- ابن إبراهيم، الطيِّب: الاستشراق الفرنسيّ وتعدُّد مهامّه خاصَّة في الجزائر، لا ط، الجزائر، دار المنابع للنشر والتوزيع، 2004م.
3- ابن إسحاق، محمَّد: السيرة النبويَّة محمَّد صلىاللهعليهوآله (المعروف بسيرة ابن اسحاق)، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ط1، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 2004م.
4- ابن الأثير، عليّ بن محمَّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ الجزريّ: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط1، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 2012م.
5- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمَّد بن محمَّد بن يوسف: النشر في القراءات العشر، تحقيق: عليّ محمَّد الضباع، لا ط، لا م، المطبعة التجاريَّة الكبرى، لا ت.
6- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمَّد: زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزَّاق المهدي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1422هـ.ق.
7- ابن الحجَّاج القشيري النيسابوري، مسلم: صحيح مسلم، ط1، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1991م.
8- ابن العربيّ المالكيّ، أبو بكر: أحكام القرآن، تحقيق: محمَّد عبد القادر عطا، ط3، لا م، دار الكتب العلميَّة، 2003م.
9- ابن حنبل، أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، ط1، لا م، مؤسَّسة الرسالة، 2001م.
10- ابن سعد، محمَّد: الطبقات الكبرى، تحقيق: عليّ محمَّد عمر، لا ط، بيروت، دار صادر، 2001م.
11- ابن عبود، محمَّد: "منهجيَّة الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلاميّ"، ضمن
كتاب: مناهج المستشرقين، تونس، المنظَّمة العربيَّة للعلوم والثقافة، 1985م.
12- ابن عساكر، عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله: تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محبّ الدين العموري، لا ط، دمشق، دار الفكر، لا ت.
13- ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمَّد هارون، لا ط، قم المقدَّسة، مكتبة الإعلام الإسلاميّ، 1404هـ.ق.
14- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، اعتنى به: حنان عبد المنان، لا ط، لبنان، بيت الأفكار الدوليَّة، 2004م.
15- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبويَّة، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، لا ط، بيروت، دار المعرفة، 1976م.
16- ابن منظور، محمَّد بن مكرم: لسان العرب، لا ط، قم المقدَّسة، نشر أدب الحوزة، 1405هـ.ق.
17- أبو خليل، شوقي: الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشِّرين، ط1، دمشق، دار الفكر المعاصر، 1998م.
18- أبو زهرة، محمَّد: المعجزة الخالدة، لا ط، القاهرة، دار الفكر العربيّ، لا ت.
19- أبو شهبة، محمَّد: المدخل لدراسة القرآن الكريم، ط3، الرياض، دار اللواء، 1978م.
20- أبو ليلة، محمَّد محمَّد: القرآن من المنظور الاستشراقيّ، ط1، مصر، دار النشر للجامعات، 2002م.
21- أحمد، إبراهيم خليل: المستشرقون والمبشِّرون في العالم العربيّ والإسلاميّ، لا ط، لا م، مكتبة الوعي العربيّ، لا ت.
22- آدم، بمبا: المستشرقون ودعوى الأخطاء اللغويَّة في القرآن، ط1، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 2015م.
23- آربري، أ.ج: المستشرقون البريطانيُّون، تعريب: محمَّد الدسوقي النويهي، لا ط، لندن، وليام كولينز، 1946م.
24- أرنولد، توماس: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: حسن إبراهيم حسن؛ عبد المجيد عابدين؛ إسماعيل النجراوي، لا ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصريَّة، 1970م.
25- اسبينداري، عبد الرحمن عمر محمَّد: كتابة القرآن الكريم في العهد المكِّيّ، لا ط، لا م، المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة، لا ت.
26- الأصفهانيّ، أبو الفرج: الأغاني، تحقيق ونشر: دار إحياء التراث العربيّ، ط1، بيروت، 1994م.
27- الأصفهانيّ، الراغب: مفردات غريب القرآن، ط2، لا م، دفتر نشر كتاب، 1404هـ.ق.
28- الأعظمي، محمَّد مصطفى: دراسات في الحديث النبويّ وتاريخ تدوينهن ط3، الرياض، شركة الطباعة العربيَّة السعوديَّة، 1401هـ.ق/1981م.
29- الأعظمي، محمَّد مصطفى: منهج النقد عند المحدّثين نشأته وتاريخه، ط2، الرياض، شركة الطباعة العربيَّة السعوديَّة المحدودة، 1402هـ.ق/1982م.
30- اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، محمَّد شريف: اﻟﺮﺳﻮل ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ المنصفة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
31- الأندلسيّ، أبو حيَّان: تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط1، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1422هـ.ق/2001م.
32- الأنصاري، مرتضى: كتاب الصلاة، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، ط1، لا م، نشر المؤتمر العالميّ بمناسبة الذكرى المئويَّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، 1415هـ.ق.
33- أنيس، إبراهيم؛ منتصر، عبد الحليم؛ الصوالحي، عطيَّة؛ خلف الله أحمد، محمَّد: المعجم الوسيط، لا ط، القاهرة، مجمع اللغة العربيَّة، لا ت.
34- الأوسي، عليّ: الطباطبائيّ ومنهجه في التفسير، ط1، طهران، معاونيَّة الرئاسة للعلاقات الدوليَّة في منظَّمة الإعلام الإسلاميّ، 1985م.
35- أوسينوبوس، لانجلوا؛ ماس، بول؛ كانت، إمانويل: النقد التاريخيّ، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ط4، الكويت، وكالة المطبوعات، 1981م.
36- البار، محمَّد عليّ: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، ط1، دمشق، دار القلم، 1410هـ.ق.
37- بارت، رودي: الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة في الجامعات الألمانيَّة المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكه، ترجمة: مصطفى ماهر، لا ط، المركز القوميّ للترجمة، لا ت.
38- البخَّاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البخَّاري، تحقيق: محمَّد زهير بن ناصر الناصر، لا ط، لا م، دار طوق النجاة، 1422هـ.ق.
39- بخيت، محمَّد حسن مهدي: الإسلام في مواجهة الغزو الفكريّ الاستشراقيّ والتبشيريّ، ط1، عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2011م.
40- بدوي، عبد الرحمن: دفاع القرآن ضدّ منتقديه، ترجمة: كمال جاد الله، لا ط، لا م، الدار العالميَّة للكتب والنشر، لا ت.
41- بدوي، عبد الرحمن: دفاع عن القرآن ضدَّ منتقديه، ترجمة: كمال جاد الله، لا ط، لا م، الدار العالميَّة للكتب والنشر، لا ت.
42- بدوي، عبد الرحمن: سيرة حياتي، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
43- بدوي، عبد الرحمن: موسوعة المستشرقين، ط5، بيروت، المؤسَّسة العربيَّة للدراسات والنشر، 2015م.
44- بدوي، موسوعة الفلسفة، ط1، بيروت، المؤسَّسة العربيَّة للدراسات والنشر، 1984م.
45- البرقي، أحمد بن محمَّد بن خالد: المحاسن، تحقيق: جلال الدين الحسينيّ، ط1، طهران، دار الكتب الإسلاميَّة، 1330هـ.ش.
46- بروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإسلاميَّة، ترجمة: منير البعلبكي؛ نبيلة أمين فارس، لا ط، بيروت، دار العلم للملايين، 1968م.
47- برّي، باقر: إضاءات على كتاب الاستشراق لإدوار سعيد، ط1، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م.
48- بشير، مشتاق: تطوُّر الاستشراق البريطانيّ، لا ط، بغداد، جامعة بغداد، 2001م.
49- البقاعي، برهان الدين: نظم الدرر في تناسق الآي والسور، لا ط، القاهرة، دار الكتاب الإسلاميّ، 1404هـ.ق.
50- البلاذري، أحمد بن يحيى: فتوح البلدان، تحقيق: صلاح الدين المجد، القاهرة، لا ن، 1965م.
51- بلاشير، ريجي: كتاب القرآن، ترجمة: رضا سعادة، ط1، بيروت، دار الكتاب اللبنانيّ، 1974م.
52- بلاشير، ريجيس: تاريخ القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره، ترجمة: رضا سعادة، ط1، بيروت، دار الكتاب اللبنانيّ، 1974م.
53- البلاغي، محمَّد جواد: آلاء الرحمن في تفسير القرآن، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، لا ت.
54- البلاغي، محمَّد جواد: الهدى إلى دين المصطفى، ط3، لا م، لا ن، 1405هـ.ق/1985م.
55- بِلر، جون سي: مصادر الإسلام بحث في مصادر وأركان الديانة المحمَّديَّة، ترجمة: مالك مسلماني، لا ط، لا م، جمعيَّة الأدب المسيحيّ للهند، 1925م.
56- البهي، محمَّد: الجانب الإلهيّ من التفكير الإسلاميّ، ط6، القاهرة، مكتبة وهبة، 1982م.
57- البهي، محمّد: الفكر الإسلاميّ الحديث وصلته بالاستعمار الغربيّ، ط4، لا م، مكتبة وهبة، لا ت.
58- البوطي، محمَّد سعيد رمضان: من روائع القرآن تأمُّلات علميَّة وأدبيَّة في كتاب الله عزَّ وجلّ، ط4، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1420هـ.ق.
59- بوكاي، موريس: الأفكار الخاطئة التي ينشرها المستشرقون خلل ترجمتهم للقرآن الكريم، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
60- التسخيري، محمَّد عليّ: محاضرات حول علوم القرآن، ط1، لا م، المنظَّمة العلميَّة للحوزات والمدارس الإسلاميَّة، 2003م.
61- التل، عبد الله: جـذور البـلاء، ط3، بيروت، المكتب الإسلاميّ، 1408هـ.ق/ 1998م.
62- التميمي، حيدر قاسم مطر: الجهاد الإسلاميّ في الدراسات الاستشراقيَّة دراسة تحليليَّة نقديَّة، مجلَّة دراسات استشراقيَّة، تصدر عن المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة المقدَّسة، العدد10، السنة الرابعة، شتاء 2017م / 1438هـ.
63- الثبيتي، أمل عبيد عواض: السيرة النبويَّة في كتابات المستشرقين البريطانيِّين دراسة تاريخيَّة نقديَّة لآراء (توماس كارلايل، توماس أرنولد، الفريد جيوم)، رسالة أُعدَّت لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلاميّ، جامعة أم القرى، 1424هـ.ق.
64- الجابري، محمَّد عابد: الرؤية الاستشراقيَّة في الفلسفة الإسلاميَّة طبيعتها ومكوِّناتها الأيديولوجيَّة والمنهجيَّة، ضمن: مناهج المستشرقين في الدراسات العربيَّة الإسلاميَّة، المنظمة العربيَّة للثقافة والتربية والعلوم، 1985م.
65- الجبري، عبد المتعال محمَّد: الاستشراق وجهٌ للاستعمار الفكريّ، ط1، القاهرة، مكتبة وهبة، 1416هـ.ق/1995م.
66- الجبري، عبد المتعال محمَّد: السيرة النبويَّة وأوهام المستشرقين، لا ط، القاهرة،
مكتبة وهبة، 1408هـ.ق/1988م.
67- جبل: محمَّد حسن حسن: الردّ على المستشرق اليهوديّ جولدتسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنيَّة، ط2، لام، القاهرة، كلِّيَّة القرآن الكريم في جامعة الأزهر، 1423هـ.ق.
68- جحا، ميشال: الدراسات العربيَّة والإسلاميَّة في أوروبا، لا ط، بيروت، معهد الإنماء العربيّ، 1982م.
69- جرَّار، مأمون فريز: في ظلال رسائل النور، ط1، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، دار المأمون، 2012م.
70- جريشة، عليّ محمَّد؛ الزيبق، محمَّد شريف: أساليـب الغـزو الفكريّ للعالم الإسلاميّ، ط3، لا م، دار الاعتصام، 1979م.
71- جلول، فيصل: الجنديّ المستعرب يوميَّات ماكسيم رودنسون في سوريا ولبنان، ط1، بيروت، دار الجديد، 1998م؛ ط2، بيروت، دار الفارابي، 2013م.
72- جمال الدين، محمَّد السعيد: الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم في دائرتَي المعارف الإسلاميَّة والبريطانيَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
73- جمال، أحمد محمَّد: مفتريات على الإسلام، ط3، القاهرة، مؤسَّسة دار الشعب، 1975م.
74- جمال، محمَّد أحمد: "نقد كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزيهر"، مجلَّة رابطة العالم الإسلاميّ، مكَّة المكرَّمة، تصدر عن إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلاميّ، المجلَّد 7، العدد 5، 1389هـ.ق/1969م.
75- الجندي، أنور: شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلاميّ، لا ط، لا م، المكتب الإسلاميّ، 1978م.
76- الجهني، مانع بن حمَّاد: الموسوعة الميسَّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب، ط4، لا م، دار الندوة العالميَّة، 1420هـ.ق.
77- جورافسكي، أليكس: الإسلام والمسيحيَّة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، العدد 215، 1996م.
78- جولدتسيهر، إيجناس: العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة: محمَّد يوسف موسى؛ عبد العزيز عبد الحقّ؛ علي حسن عبد القادر، لا ط، القاهرة، المركز القوميّ للترجمة، 2013م.
79- جولدتسيهر، إيجناس: مذاهب التفسير الإسلاميّ، ترجمة: عبد الحليم النجَّار، ط8، بيروت، دار اقرأ، 1403هـ.ق/1983م.
80- جيب، هاملتون: في النُّظم الفلسفة والدين في الإسلام، لا ط، دمشق، المركز العربيّ للكتاب، 1980م.
81- جيفري، آرثر: القرآن، لا ط، لا م، لا ن، 1982م.
82- الحاجّ، ساسي سالم: نقد الخطاب الاستشراقيّ، ط1، بيروت، دار المدار الإسلاميّ، 2002م.
83- الحاجّ، ساسي سالم: نقد الظاهرة الاستشراقيَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
84- حسن، محمَّد خليفة: تاريخ الأديان دراسة وصفيَّة مقارنة، لا ط، القاهرة، دار الثقافة العربيَّة، 2002م.
85- حسن، محمَّد خليفة: دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد الكتاب المقدَّس، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
86- حسين، محمَّد بهاء الدين: المستشرقون والحديث النبويّ، ط1، كوالالمبور، دار الفجر، 1420هـ.ق/1999م.
87- الحكيم، محمد باقر: علوم القرآن، ط3، قم المقدَّسة، مجمع الفكر الإسلاميّ، 1417هـ.ق.
88- حمد، عبد الله خضر: القرآن الكريم وشبهات المستشرقين، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، لا ت.
89- حمدان، عبد الحميد صالح: طبقات المستشرقين، لا ط، ليبيا، مكتبة مدبولي، لا ت.
90- الحميّد، حميّد بن ناصر خالد: الأخطاء العقديَّة في دائرة المعارف الإسلاميَّة دراسة تحليليَّة نقديَّة، رسالة دكتوراه، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
91- الحميّد، حميّد بن ناصر: القرآن الكريم في دائرة المعارف الإسلاميّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
92- الحميريّ، عبد الملك بن هشام بن أيُّوب: السيرة النبويَّة، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط3، لا م، دار الكتاب العربيّ، 1990م.
93- حنفي، حسن: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، لا ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصريَّة، لا ت.
94- الخازن، علاء الدين عليّ بن محمَّد بن إبراهيم بن عمر الشيحي: لباب التأويل في معاني التنزيل (المعروف بتفسير الخازن)، تصحيح: محمَّد عليّ شاهين، ط1، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1415هـ.ق.
95- خان، ظفر الإسلام: التلمود تاريخه وتعاليمه، ط5، بيروت، دار النفائس، لا ت.
96- الخضري، أمل عاطف محمَّد: التنصير في فلسطين في العصر الحديث، لا ط، لا م، لا ن، 2004م.
97- الخطيب، عبد الله: دراسة نقديَّة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزيَّة للمستشرق ج. م. رودويل، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
98- الخوئيّ، أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن، ط4، بيروت، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، 1975م.
99- الدجوي، قاسم؛ القمحاوي، محمَّد: قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، ط1، مصر، قطاع المعاهد المصريَّة، 1427هـ.ق.
100- درَّاز، عبد الله: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، لا ط، قطر، دار إحياء التراث الإسلاميّ، 1985م.
101- درَّاز، عبد الله: دستور الأخلاق في القرآن، تعريب: عبد الصبور شاهين، لا ط، لا م، مؤسَّسة الرسالة ناشرون، 1996م.
102- درَّاز، محمَّد عبد الله: المدخل إلى القرآن الكريم، ط1، الكويت، دار القلم، 1984م.
103- الدريس، خالد: العيوب المنهجيَّة في كتابات المستشرق شاخت المتعلِّقة بالسنَّة، لا ط، الرياض، دار المحدث، 1425هـ.ق.
104- الدسوقي، محمَّد: الفكر الاستشراقيّ تاريخه وتقويمه، لا ط، لا م، دار الوفاء، لا ت.
105- الدَّلفي، علي حسن عبد الحسين: فقه اللغة وعلم اللغة والفيلولوجيا مداخلات اصطلاحيَّة، مجلَّة العميد (مجلَّة فصليَّة محكّمة)، العدد 2، ذو الحجة 1435هـ.ق.
106- الدمياطي، أحمد بن محمَّد بن أحمد بن عبد الغني: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ط3، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1427هـ.ق.
107- الدينوري، ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، لا ط، لا م، المكتبة العلميَّة، 1973م.
108- ديورانت، وِل: قصَّة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود، تقديم: محيي الدين صابر، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
109- الذهبيّ، محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: تاريخ الإسلام، تحقيق: عمر عبد
السلام تدمري، لا ط، لا م، دار الكتاب العربيّ، 1990م.
110- الرافعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبويَّة، ط9، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1973م.
111- رشوان، حسين عبد الحميد: العلم والبحث العلميّ دراسة في مناهج العلوم، ط1، لا م، المكتب الجامعيّ الحديث، 2008م.
112- رشيدي، ﻣﺤﻤﻮد محمَّد حجَّاج: ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ اﻷﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء نظريَّات الترجمة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
113- رضا، أحمد: معجم متن اللغة العربيَّة (موسوعة لغويَّة حديثة)، لا ط، بيروت، دار مكتبة الحياة، لا ت.
114- رضا، محمَّد رشيد: الوحي المحمَّديّ، ط2، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1426هـ.ق/2005م.
115- رضا، محمَّد رشيد: تفسير المنار، لا ط، مصر، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، 1990م.
116- رضوان، عمر بن إبراهيم: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، لا ط، الرياض، دار طيبة، لا ت.
117- رودنسون، مكسيم: محمَّد، ط3، باريس، لا ن، 1974م.
118- رينان، أرنست: أسطورة محمَّد في الغرب، لا ط، لا م، نشر: Giora – ale storico della letteratura italiana، 1889م.
119- الزرقانيّ، محمَّد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: فوَّاز أحمد زمرلي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1995م.
120- الزركشي، بدر الدين: البرهان في علوم القرآن، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1990م.
121- الزرندي، أبو الفضل مير محمَّدي: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين، 1420هـ.ق.
122- الزرندي، أبو الفضل مير محمَّدي: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين، لا ت.
123- زقزوق، محمود حمدي: الاستشراق والخلفيَّة الفكريَّة للصراع الحضاريّ، لا ط، القاهرة، دار المعارف، 1997م.
124- زقزوق، محمود حمدي: الإسلام في مرآة الفكر الغربيّ، لا ط، لا م، دار الفكر العربيّ، 1994م.
125- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط3، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 1407هـ.ق.
126- زناتي، أنور محمود: مدارس الاستشراق.. المدرسة البريطانيَّة، على موقع شبكة «الألوكة» الإلكترونيّ: https://www.alukah.net/.
127- الزيادي، محمَّد فتح الله: الاستشراق أهدافه ووسائله دراسة تطبيقيَّة في منهج الغربيِّين في دراسة ابن خلدون، ط1، لا م، دار ابن قتيبة، 1998م.
128- الزيادي، محمَّد فتح الله: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها، ط1، طرابلس، الجماهيريَّة العربيَّة الليبيَّة، 1983م.
129- زيدان، جرجي: تاريخ التمدُّن الإسلاميّ، لا ط، القاهرة، مؤسَّسة هندواي للتعليم والثقافة، 2012م.
130- ساب، هيثم بن عبد العزيز: دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنكليزيَّة للمستشرق الإنكليزيّ آرثر ج. آربري، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
131- سال، جرجس: مقالة في الإسلام، ترجمة وتحقيق: هاشم العربيّ، ط1، لا م، منشورات أسمار، ضمن سلسلة: الإسلام من منظور آخر، 2006م.
132- السامرائيّ، قاسم: الاستشراق بين الموضوعيَّة والافتعاليَّة، ط1، الرياض، دار الرفاعي، 1403هـ.ق.
133- السامرائيّ، قاسم: الفهرس الوصفيّ للمنشورات الاستشراقيَّة المحفوظة في مركز البحوث في جامعة الإمام محمَّد بن سعود، لا ط، لا م، لا ن، 1408هـ.ق.
134- الساموك، سعدون محمود: الاستشراق الروسيّ دراسة تاريخيَّة شاملة، ط1، عمان، دار المناهج، 1423هـ.ق/2003م.
135- الساموك، سعدون: الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلاميَّة، ط1، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 1431هـ.ق/2010م.
136- السباعي، مصطفى: الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، ط3، بيروت، المكتب الإسلاميّ، 1405هـ.ق/ 1985م.
137- السباعي، مصطفى: منهجيَّة الاستشراق والمستشرقون، لا ط، بيروت، المكتب الإسلاميّ، 1979م.
138- السبحاني، جعفر: تهذيب الأصول (تقرير أبحاث آية الله السيِّد روح الله الموسويّ الخمينيّ)، لا ط، قم المقدَّسة، جماعة المدرِّسين، لا ت.
139- السجستانيّ، ابن أبي داوود: كتاب المصاحف، تحقيق وتقديم: آرثر جيفري، ط1، مصر، المطبعة الرحمانيَّة، 1936م.
140- السرخسي، محمَّد بن أحمد: المبسوط، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1986م.
141- السعدي، إسحاق بن عبد الله: دراسات في تميُّز الأمَّة الإسلاميَّة وموقف المستشرقين منه، ط1، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، 2013م.
142- سعيد، إدوارد: الاستشراق المفاهيم الغربيَّة للشرق، ترجمة: محمَّد عنَّاني، ط1، لا م، دار رؤية، 2006م.
143- سوذرن، ريتشارد: صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى، ترجمة: رضوان السيِّد، ط2، لا م، دار المدار الإسلاميّ، 2006م.
144- السيِّد، رضوان: المستشرقون الألمان النشوء والتأثير والمصادر، ط2، بيروت، دار المدار الإسلاميّ، 2016م.
145- السيوطي، جلال الدين عبدر الحمن بن أبي بكر: الدرّ المنثور في التفسير المأثور، لا ط، لا م، دار الفكر، لا ت.
146- السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن، ضبطه وصحَّحه وخرَّج آياته: محمَّد سالم هاشم، ط2، لا م، منشورات ذوي القربى، 1429هـ.ق/1387هـ.ش.
147- السيوطي، جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمَّد جاد المولى؛ محمَّد أبو الفضل إبراهيم؛ عليّ محمَّد البجاوي، لا ط، لا م، المكتبة العصريَّة، لا ت.
148- السيوطي، جلال الدين: قطف الثمر في موافقات عمر، شرح وتعليق: علي أسعد رباجي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، لا ت.
149- شاخت، جوزيف؛ بوزورث، كليفورد: الصورة الغربيَّة والدراسات الغربيَّة الإسلاميَّة في تراث الإسلام، ترجمة: محمَّد زهير السمهوري؛ حسين مؤنس؛ إحسان صدقي العمد، تعليق وتحقيق: شاكر مصطفى، مراجعة فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطنيّ للقافة والآداب والفنون، شعبان-رمضان 1398هـ.ق/ أغسطس 1978م.
150- شاخت، جوزيف؛ بوزورث، كليفورد: تراث الإسلام، ترجمة: محمَّد زهير المهوري؛ حسن مؤنس؛ إحسان صدقي، تعليق وتحقيق: شاكر مصطفى، مراجعة: فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطنيّ للثقافة والآداب والفنون، 1978م.
151- شاخت، يوسف: مدخل إلى الفقه الإسلاميّ، ترجمة: حمادي ذويب، مراجعة:
عبد الحميد الشرفي، ط1، بيروت، دار المدار الإسلاميّ، 2018م.
152- شاهين، عبد الصبور: تاريخ القرآن، ط3، لا م، نشر نهضة مصر، 2007م.
153- الشايب، خضر: نبوَّة محمَّد في الفكر الاستشراقيّ المعاصر، ط1، الرياض، مكتبة العبيكان، 1422هـ.ق.
154- الشرقاوي، محمَّد عبد الله: الاستشراق في الفكر الإسلاميّ المعاصر دراسات تحليليَّة تقويميَّة، لا ط، لا م، دار الفكر العربيّ، لا ت.
155- شريفي، عليّ: بررسي ونقد ديدگاه هاي مستشرقان درباره نسخ در قران كريم [بحث ونقد نظريَّات المستشرقين حول النسخ في القرآن الكريم]، ط1، قم المقدَّسة، نشر: كتاب مبين، 1387هـ.ش.
156- الشمري، رباح صعصعة عنان: جمع القرآن عند المستشرقين جون جلكريست أنموذجًا، ط1، لا م، دار الكفيل، 2014م.
157- الشهرستانيّ، محمَّد بن عبد الكريم: الملل والنحل، تحقيق: أحمد فهمي محمَّد، ط2، لا م، دار الكتب العلميَّة، 1992م.
158- الشيرازيّ، أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ: اللمع في أصول الفقه، ط2، بيروت، عالم الكتب، 1406هـ.ق.
159- الشيرازيّ، ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط2، قم المقدَّسة، مدرسة الإمام عليّ بن أبي طالب، 1429هـ.ق.
160- صابر، حلمي عبد المنعم: منهجيَّة البحث العلميّ وضوابطه في الإسلام، ط1، مكَّة المكرَّمة، رابطة العالم الإسلاميّ، 1418هـ.ق/1998م، ص19. صدر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 1998م.
161- الصالح، صبحي إبراهيم: دراسات في فقه اللغة، ط1، بيروت، دار العلم للملايين، 1960م.
162- الصالح، صبحي: مباحث في علوم القرآن، ط8، بيروت، دار العلم للملايين، 1974م.
163- صالح، فخري: كراهيَّة الإسلام كيف يصوِّر الاستشراق الجديد العرب والمسلمين، الدار العربيّة للعلوم ناشرون.
164- الصدوق، محمَّد بن عليّ بن بابويه القمِّي: الاعتقادات في دين الإماميَّة، تحقيق: عصام عبد السيِّد، ط2، لا م، دار المفيد، 1414هـ.ق.
165- الصغير، فالح بن محمَّد بن فالح: الاستشراق وموقفه من السنَّة النبويَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
166- الصغير، محمَّد حسين علي: المستشرقون والدراسات القرآنيَّة، ط1، بيروت، دار المؤرِّخ العربيّ، 1999م.
167- الصغير، محمَّد حسين علي: دراسات قرآنيَّة، ط2، لا م، مكتب الإعلام الإسلاميّ، 1413هـ.ق.
168- الطباطبائي، محمَّد حسين: الميزان في تفسير القرآن، لا ط، قم المقدَّسة، منشورات جماعة المدرِّسين، 1417هـ.ق.
169- الطبرسي، أحمد بن علي: الاحتجاج، تعليقات وملاحظات: محمَّد باقر الخرسان، لا ط، لا م، لا ن، 1966م.
170- الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط1، بيروت، مؤسٍّسة الأعلمي، 1995م.
171- الطبري، محمَّد بن جرير: دلائل الإمامة، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميَّة في مؤسَّسة البعثة، ط1، قم المقدَّسة، مركز الطباعة والنشر في مؤسَّسة البعثة، 1413هـ.ق.
172- الطبريّ، محمَّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك (المعروف بتاريخ الطبري)، لا ط، لا م، دار المعالرف، 1990م.
173- طرابيشي، جورج: معجم الفلاسفة، ط3، بيروت، دار الطليعة، 2006م.
174- الطعان، أحمد إدريس: العلمانيُّون والقرآن الكريم تاريخيَّة النصّ، ط1، الرياض، دار ابن حزم، 1428هـ.ق.
175- الطهراني، آغا بزرگ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط2، بيروت، دار الأضواء، لا ت.
176- الطهطاوي، محمَّد عزَّت إسماعيل: التبشير والاستشراق أحقاد وحملات، ط1، لا م، الزهراء للإعلام العربيّ، 1991م.
177- الطوسيّ، محمَّد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، ط1، قم المقدَّسة، مكتب الإعلام الإسلاميّ، 1409هـ.ق.
178- طويلة، عبد السلام عبد الوهاب: الكتب المقدَّسة في ميزان التوثيق، ط2، القاهرة، دار السلام، 2002م.
179- الطيار، مساعد بن صالح: كشَّافات آيات القرآن الكريم دراسة للاتِّجاهات النوعيَّة والعدديَّة وطرائق الترتيب، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
180- العالم، عمر لطفي: المستشرقون والقرآن، لا ط، لا م، مركز دراسات العالم الإسلاميّ، 2009م.
181- العاني، عبد القهَّار: الاستشراق والدراسات القرآنيَّة، لا ط، بغـداد، مطبعة العاني، 1973م.
182- عبَّاس، فضل حسن: قضايا قرآنيَّة في الموسوعة البريطانيَّة نقد مطاعن وردّ شبهات، ط2، الأردن، دار البشير، 1989م.
183- عبد الباقي، محمَّد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لا ط، القاهرة، دار الكتب المصريَّة، لا ت.
184- عبد الحميد، عرفان: المستشرقون والإسلام، ط2، بيروت، المكتب الإسلاميّ، 1980م.
185- عبد المحسن، عبد الراضي محمَّد: مناهج المستشرقين في ترجمة معاني القرآن، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
186- عبد المحسن، عبد الراضي: الغارة التنصيريَّة على أصالة القرآن الكريم، لا ط، لا م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لا ت.
187- عتر، حسن ضياء الدين: وحي الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنَّة نقض مزاعم المستشرقين، ط1، لا م، دار المكتَبِي، 1999م.
188- عتر، حسن: بينات المعجزة الخالدة، ط1، حلب، دار النصر، 1975م.
189- العراقي، ضياء الدين: شرح تبصرة المتعلِّمين، تحقيق: محمَّد الحسّون، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين، 1414هـ.ق.
190- عزوزي، حسن: آليَّات المنهج الاستشراقيّ في الدراسات الإسلاميَّة، ضمن: سلسلة تصحيح صورة الإسلام (4)، لا ط، فاس (المغرب)، لا ت.
191- عزوزي، حسن: مناهج المستشرقين البحثيَّة في دراسة القرآن الكريم، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
192- العسري، محمَّد عبد الواحد: الإسلام وتصوُّرات الاستشراق الإسبانيّ من ريموندس لولوس إلى آسين بلاثيوس، الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامَّة، 1424هـ.ق/2003م.
193- العسقلانيّ، ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لا ط، لا م، دار الفكر الإسلاميّ الحديث، 2000م.
194- العطاوي، عبد الرحيم: الاستشراق الروسيّ مدخل إلى تاريخ الدراسات العربيَّة
والإسلاميَّة في روسيا، لا ط، الدار البيضاء، المركز الثقافيّ العربيّ، 1993م.
195- العقيقي، نجيب: المستشرقون، لا ط، القاهرة، دار المعارف، 1980م.
196- علي، جواد: تاريخ العرب في الإسلام، ط2، بيروت، دار الحداثة، 1988م.
197- عمايرة، إسماعيل: المستشرقون والمناهج اللغويَّة، ط2، عمان، دار حزين، 1992م.
198- عمر، أحمد مختار عبد الحميد: معجم اللغة العربيَّة المعاصرة، ط1، القاهرة، عالم الكتب، 2008م.
199- العُمري، أكرم ضياء: موقف الاستشراق من السيرة النبويَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
200- عناية، غازي: شبهات حول القرآن وتفنيدها، لا ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1421هـ.ق.
201- عوَّاد، محمود: معجم الطبّ النفسيّ والعقليّ، ط1، عمان، دار أسامة، 2006م.
202- عوض، إبراهيم: دائرة المعارف الاستشراقيَّة الإسلاميَّة أضاليل وأباطيل، ط1، لا م، مكتبة البلد الأمين، 1989م.
203- العيَّاشي، محمَّد بن مسعود، تفسير العيَّاشي، تحقيق وتصحيح وتعليق: هاشم الرسولي المحلاتي، طهران، المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة، لا ت.
204- غايغر، أبراهام: اليهوديَّة والإسلام، ترجمة: نبيل فيَّاض، ط1، بغداد، دار الرافدين، 2018م.
205- غراب، أحمد عبد الحميد: رؤية إسلاميَّة للاستشراق، لا ط، لندن، المنتدى الإسلاميّ، 1411هـ.ق.
206- غراب، عبد الفتَّاح إسماعيل: العمل التنصيريّ في العالم العربيّ رصد لأهمّ مراحله التاريخيَّة والمعاصرة، لا ط، لا م، مكتبة البدر، لا ت.
207- الغزالي، محمَّد: دفاع عن العقيدة والشريعة ضدّ مطاعن المستشرقين، ط7، مصر، شركة نهضة مصر، 2005م.
208- غلاب، محمَّد: نظرات استشراقيَّة، لا ط، القاهرة، دار الكاتب العربيّ للطباعة والنشر، 1965م.
209- فاروق، عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلاميّ (القرون الإسلاميَّة الأولى)، ط1، لا م، منشورات الأهليَّة، 1998م.
210- فتَّاح، عرفان عبد الحميد: دراسات في الفكر العربيّ الإسلاميّ أبحاث في علم الكلام والتصوُّف والاستشراق والحركات الهدَّامة، لا ط، عمان، دار عمار، 1991م.
211- فرد، عارف هنديجانيّ: علوم القرآن عند العلَّامة آية الله السيِّد محمَّد حسين الطباطبائيّ (قده) دراسة مقارنة، ط1، بيروت، إعداد ونشر: جمعيَّة القرآن الكريم، 2013م.
212- فؤاد، عبد المنعم: من افتراءات المستشرقين على الأصول العقديَّة في الإسلام عرض ونقد، ط1، الرياض، مكتبة العبيكان، 2001م.
213- فوك، يوهان: تاريخ حركة الاستشراق، ترجمة: عمر لطفي العالم، ط2، طرابلس الغرب، دار المدار الإسلاميّ، 2001م.
214- الفيض الكاشانيّ، محمَّد محسن: التفسير الصافي، ط2، قم المقدَّسة، مؤسَّسة الهادي؛ طهران، مكتبة الصدر، 1416هـ.ق.
215- الفيض الكاشانيّ، محمَّد محسن: علم اليقين، تحقيق: محسن بيدارفر، ط1، قم المقدَّسة، انتشارات بيدار، 1418هـ.ق.
216- القاضي، عبد الفتَّاح: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، لا ط، مصر، دار مصر للطباعة، لا ت.
217- القطان، مناع: مباحث في علوم القرآن، ط8، لا م، مؤسَّسة الرسالة، لا ت.
218- قطب، محمَّد: المستشرقون والإسلام، لا ط، القاهرة، دار وهبة، 1999م.
219- كارليل، توماس: الأبطال، تعريب: محمَّد السباعي، ط3، المطبعة المصريَّة في الأزهر، 1930م.
220- كازانوفا، بول: محمَّد ونهاية العالم، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
221- كحالة، عمر: معجم المؤلِّفين، لا ط، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، لا ت.
222- كراتشكوفسكي، إغناطيوس: دراسات في تاريخ الاستعراب الروسيّ، لا ط، ليننغراد، منشورات أكاديميَّة العلوم للاتِّحاد السوفييتي، 1950م.
223- الكرديّ، محمَّد طاهر بن عبد القادر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه، ط2، مصر، مصطفى البابيّ الحلبيّ وأولاده، 1953م.
224- الكريطي، حاكم حبيب: معجم الشعراء الجاهليِّين والمخضرمين، ط1، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 2001م.
225- الكشميري، محسن بن حسن الفاني: دبستان المذاهب، لا ط، لا م، جامعة أوكسفورد، 1809م.
226- الكلينيّ، محمَّد بن يعقوب، الكافي، تحقيق: عليّ أكبر الغفّاري، ط5، طهران، دار الكتب الإسلاميَّة، 1363هـ.ش.
227- الكورانيّ العامليّ، علي: تدوين القرآن الكريم، ط1، قم المقدَّسة، دار القرآن الكريم، لا ت.
228- كويتسولو، خوان: في الاستشراق الإسبانيّ، ترجمة: كاظم جهاد، لا ط، بيروت، لا ن، 1987م.
229- الكيلانيّ، جمال الدين فالح؛ الصميدي، زياد حمد: بديع الزمان سعيد النورسي قراءة جديدة في فكره المستنير، لا ط، القاهرة، دار الزنبقة، 2013م.
230- لوبون، جوستاف لوبون: حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، لا ط، لا م، دار الكتب المصريَّة، 2018م.
231- اللوندي، سعيد: إشكاليَّة ترجمة القرآن الكريم، لا ط، مركز الحضارة العربيَّة للإعلام والنشر والدراسات، 2001م.
232- ماضي، محمود: الوحي القرآنيّ في المنظور الاستشراقيّ ونقده، ط1، الإسكندريَّة، دار الدعوة للطبع والنشر، 1996م.
233- مجموعة من الباحثين: موسوعة الملل والأديان، إشراف: عَلوي بن عبد القادر السقاف، المكتبة الشاملة الحديثة.
234- محمَّد ، إدريس حامد: آراء المستشرقين حول الوحي، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
235- محمَّد، إسماعيل عليّ: الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، ط6، القاهرة، دار الكلمة، 2014م.
236- محمَّد، إسماعيل علي: الغزو الفكريّ والتحدِّي والمواجهة، ط2، القاهرة، دار الكلمة، 2011م.
237- المحمَّديّ، فتح الله: سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإماميَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
238- محمود، عبد الحليم: الغزو الفكريّ وأثره في المجتمع الإسلاميّ، ط4، مصر، دار المنار الحديثة، 1412هـ.ق.
239- مدكور، عبد الحميد: نظرات في حركة الاستشراق، لا ط، القاهرة، دار الثقافة العربيَّة، 1990م.
240- مراد، يحيى: أسماء المستشرقين، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 2004م.
241- مرتضى العامليّ، جعفر: حقائق هامَّة حول القرآن، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة
النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين، 1410هـ.ق.
242- مرتضى، جعفر: مختصر مفيد أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة، ط1، لا م، المركز الإسلاميّ للدراسات، المجموعة السابعة، 2002م.
243- مرتضى، ملك غلام: دائرة المعارف الإسلاميَّة بين الجهل والتضليل، ترجمة: محمَّد كمال عليّ السيِّد، لا ط، لاهور (باكستان)، نشر: محمَّد زيد ملك، لا ت.
244- مرسي، جلال محمَّد عبد الحميد: منهج البحث العلميّ عند العرب في مجال العلوم الطبيعيَّة والكونيَّة، ط1، بيروت، دار الكتاب اللبنانيّ، 1989م.
245- مركز الثقافة والمعارف القرآنيَّة: علوم القرآن عند المفسِّرين، ط1، قم المقدَّسة، مكتب الإعلام الإسلاميّ، 1417هـ.ق.
246- المصطفويّ، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، لا ط، لا م، مؤسَّسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ، 1417هـ.ق.
247- مطر الهاشميّ، حسن علي حسن: قراءة نقديَّة في تاريخ القرآن للمستشرق تيودور نولدكه، ط1، لا م، المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة المقدَّسة، 2014م.
248- مظاهري، محمَّد عامر عبد الحميد: منهج الإسقاط في الدراسات القرآنيَّة عند المستشرقين، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
249- معرفت، محمَّد هادي: التمهيد في علوم القرآن، ط3، قم المقدَّسة، منشورات ذوي القربى، 2011م.
250- معرفت، محمَّد هادي: صيانة القرآن من التحريف، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة فرهنكي التمهيد، 2007م.
251- مغلي، محمَّد بشير: مناهج البحث في الإسلاميَّات لدى المستشرقين وعلماء الغرب، ط1، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميَّة، 2002م.
252- مغنيّة، محمَّد جواد: التفسير الكاشف، ط3، بيروت، دار العلم للملايين، 1981م.
253- المفيد، محمَّد بن محمَّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ط1، طهران، مؤسسة مطالعات اسلامى دانشگاه تهران، 1416هـ.ق.
254- مقبول، إدريس: الدراسات الاستشراقيّة للقران الكريم في رؤية إسلاميَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
255- المقريزي، تقيّ الدين: إمتاع الأسماع بما للنبيّ صلىاللهعليهوآله من الأحوال والأموال والحفدة المتاع، تحقيق: محمَّد عبد الحميد النميسي، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، 1999م.
256- المنجد، صلاح الدين: المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به، لا ط، بيروت، دار لجديد، لا ت.
257- مندي، جيريمي: مدخل إلى دراسات الترجمة نظريَّات وتطبيقات، ترجمة: هشام علي جواد، لا ط، لا م، لا ن، 2010م.
258- مهنا، أحمد إبراهيم: دراسة حول ترجمة القرآن الكريم، لا ط، القاهرة، مؤسَّسة دار الشعب، 1978م.
259- الميدانيّ، عبد الرحمن حسن جنبكة: أجنحـة المكـر الثلاثة وخوافيها: التبشير-الاستشراق-الاستعمار، ط8، دمشق، دار القلم، 2000م.
260- الميلانيّ، عليّ: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، لا ط، لا م، مركز الحقائق الإسلاميَّة، لا ت.
261- ناجي، عبد الجبَّار: الاستشراق في التأريخ الإشكاليَّات الدوافع التوجُّهات الاهتمامات، ط1، بيروت، المركز الأكاديميّ للأبحاث، 2013م.
262- ناجي، عبد الجبَّار: الإمام عليّ وإشكاليَّة جمع القرآن ودراسات المستشرقين، ط1، لبنان، الرافدين، 2017م.
263- النبهان، محمَّد فاروق: الاستشراق تعريفه مدارسه آثاره، لا ط، لا م، المنظَّمة الإسلاميَّة للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، 1433هـ.ق/2012م.
264- نجا، فاطمة هدى: نور الإسلام وأباطيل الاستشراق، لا ط، لبنان-طرابلس، دار الإيمان، لا ت.
265- الندوي، تقي الدين: السنَّة مع المستشرقين والمستغربين، لا ط، مكَّة المكرَّمة، المكتبة الإمداديَّة، 1402هـ.ق/1982م.
266- النعيمي، عبد الله محمَّد الأمين: الاستشراق في السيرة النبويَّة دراسة تاريخيَّة لآراء (وات-بروكلمان-فلهاوزنم)قارنة بالرؤية الإسلاميّة، القاهرة، المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، 1997م.
267- نكاوي، فاتح محمد سليمان سة: معجم مصطلحات الفكر الإسلاميّ المعاصر دلالاتها وتطوُّرها، لا ط، بيروت، دار الكتب العلميَّة، لا ت.
268- النملة، حمد بن إبراهيم الحمد: الاستشراق والدراسات الإسلاميَّة، لا ط،
الرياض، مكتبة النوبة، 1418هـ.ق.
269- النملة، عليّ بن إبراهيم: الاستشراق في الأدبيَّات العربيَّة، ط1، لا م، لا ن، 1993م.
270- النملة، عليّ بن إبراهيم: التنصير في المراجع العربيَّة، لا ط، الرياض، لا م، 1424هـ.ق.
271- النملة، عليّ بن إبراهيم: المستشرقون والتنصير، ط1، الرياض، مكتبة التوبة، 1998م.
272- نولدكه، تيودور: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ط1، لا م، لا ن، 2008م.
273- النووي، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزاميّ الحورانيّ: المجموع شرح المهذّب، تحقيق: محمَّد نجيب المطيعي، لا ط، جدَّة، مكتبة الإرشاد، لا ت.
274- النووي، يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربيّ، 14907هـ.ق/ 1987م.
275- هوتسما، م.ت؛ أرنولد، ت. و؛ باسيت، ر؛ هارتمان، ر: موجز دائرة المعارف الإسلاميّة، ط1، لا م، مركز الشارقة للإبداع الفكريّ، 1998م.
276- وات، وليم مونتغمري: الإسلام والمسيحيَّة في العالم المعاصر، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، لا ط، لا م، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، 1998م.
277- وات، وليم مونتغمري: تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى، لا ط، الموصل، لا ن، 1982م.
278- وات، وليم مونتغمري: محمَّد في المدينة، ترجمة: شعبان بركات، لا ط، صيدا، المكتبة العصريَّة، لا ت.
279- وات، وليم مونتغمري: محمَّد في مكَّة، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، لا ط، القاهرة، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، 1994م.
280- الوزان، عدنان: موقف المستشرقين من القرآن الكريم دراسة في بعض دوائر المعارف الغربيَّة، لا ط، لا م، لا ن، لا ت.
281- ويلز، هـ.ج: معالم تاريخ الإنسانيَّة، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، ط3، لا م، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، لا ت.
ثانيًا: المجلَّات والدوريَّات العربيَّة:
1- ابن زكريا، إدريس؛ ابن محمود، عبد الرحمن: "أساليب الاستشراق وغاياته من دراسة الفكر الإسلاميّ"، مجلَّة بحوث إسلاميَّة واجتماعيَّة، 2001م.
2- ابن نبي، مالك: "إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلاميّ الحديث"، مجلَّة الفكر العربيّ، العدد 32، السنة 5، 1983م.
3- أبو حسَّان، جمال محمود: "القرآن الكريم في موسوعة قصَّة الحضارة عرض ونقد لما كتبه ول ديوارنت بعنوان شكل القرآن"، مجلَّة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانيَّة، المجلَّد 17، العدد 1، 2017م.
4- الأعظمي، محمَّد مصطفى: "المستشرق شاخت والسنَّة النبويَّة"، في كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربيَّة الإسلاميَّة، 1405هـ.ق/1985م.
5- باعثمان، صلاح بن سعيد بن سالم: "منهج المستشرقين في دراسة القضايا القرآنيَّة"، حوليَّة جامعة الأزهر كلِّيَّة أصول الدين والدعوة بالمنوفيَّة، العدد 36، 2017م.
6- بدران، محمَّد أبو الفضل: مجلَّة الوعي الإسلاميّ، العدد 483، 16/1/2006م.
7- البريدي، أحمد: "تفصيل آيات القرآن الحكيم للمستشرق الفرنسيّ جول لابوم قراءة وصفيَّة ونقديَّة"، بحث مقدَّم لمؤتمر التفسير الموضوعيّ واقع وآفاق، لا ط، جامعة الشارقة، لا ت.
8- بيدگلي وآخرون، محمَّد تقي دياري: "إنكار النسخ في القرآن الكريم نظرة تاريخيَّة"، مجلَّة الاجتهاد والتجديد (مجلَّة فصليّةٌ متخصِّصة تعنى بقضـــايا الاجتهاد والفقــه الإسلاميّ)، بيروت، مركز البحوث المعاصرة، السنتان 9 و10، العددان 36 و37، 1436هـ.ق/خريف 2015م-1437هـ.ق/شتاء 2016م.
9- تسدال، كلير: "إضافات الشيعة إلى القرآن"، مجلَّة العالم المسلم، المجلَّد 3، العدد 3، 1913م.
10- الجعفري، نعمات محمَّد: "العيوب المنهجيَّة في سياق الروايات الحديثيَّة عند المستشرق مونتغمري وات في كتابَيْه «محمَّد في مكَّة»، و«محمَّد في المدينة»"، مجلَّة الشريعة والدراسات الإسلاميَّة، جامعة الكويت،السنة 29، العدد 97.
11- جمال، محمَّد أحمد: "نقد كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزيهر"، مجلَّة رابطة العالم الإسلاميّ، مكَّة المكرَّمة، تصدر عن إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلاميّ، المجلَّد 7، العدد 5، 1389هـ.ق/1969م.
12- الجندي، أنور: "مسؤوليَّة الاستشراق وسموم دائرة المعارف الإسلاميَّة"، مجلَّة الأزهر، ج8، السنة 60، شعبان 1408هـ.ق، ص1049.
13- حنفي، حسن: "الاستشراق والمنهج التحليليّ"، صحيفة الاتِّحاد، 22 أغسطس 2015م.
14- حنفي، حسن: "مناهج الاستشراق"، صحيفة الاتِّحاد، 28 سبتمبر 2018م.
15- الخطيب، عبد عبد الرحمن: "الردّ على مزاعم المستشرقين إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيَّدهما من المستغربين"، بحث مقدَّم في ندوة عناية المملكة العربيَّة السعوديَّة بالسنَّة والسيرة النبويَّة، 1425هـ.ق.
16- خليل، عماد الدين: "المستشرقون والسيرة النبوية، بحث مقارن في منهج المستشرق البريطانيّ المعاصر مونتغمري وات"، في كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربيَّة الإسلاميَّة، المنظَّمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم، مكتب التربية العربيّ لدول الخليج، 1405هـ.ق/1985م.
17- خليل، عماد الدين: "المستشرقون والسيرة النبويَّة"، مجلَّة البعث الإسلاميّ (تصدر عن ندوة العلماء في الهند، لكهنو، الهند، المجلَّد 27، العدد 1 و2، رمضان وشوَّال 1402هـ.ق/ يوليو وأغسطس 1982م.
18- دانييل، نورمان: "الإسلام والغرب"، مراجعة: محمَّد عطوي، مجلَّة الفكر العربيّ، العدد 32، السنة 5، نيسان-حزيران 1983م.
19- رزق الله، سهيل: "بارتولد والحضارة العربيَّة الإسلاميَّة"، مجلَّة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانيَّة، تصدر عن معهد الإنماء العربيّ في بيروت، السنة 5، العدد 31، كانون الثاني وآذار 1983م.
20- زادة، عيسى متَّقي: "جمع القرآن من قبل النبيّ صلىاللهعليهوآله والإمام علي عليهالسلام من وجهة نظر المستشرقين وأهل السنَّة"، مجلَّة دراسات استشراقيَّة (مجلَّة فصليَّة تعنى بالتراث الاستشراقيّ عرضًا ونقدًا)، بيروت، المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة المقدَّسة، السنة 1، العدد 2، 1436هـ.ق/ خريف 2014 م.
21- زماني، محمَّد حسن: "الاستشراق تاريخه ومراحله"، مجلَّة دراسات استشراقيَّة (مجلَّة فصليَّة تعنى بالتراث الاستشراقيّ عرضًا ونقدًا)، بيروت، المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة المقدَّسة، العدد 1، السنة 1، 2014م.
22- زهران، البدراوي: "التبشير والتنصير"، مجلَّة المنهل، جدَّة، العدد 510، جمادى الآخر 1414ﻫ.ق/ نوفمبر-ديسمبر 1993م.
23- السمان، محمَّد بن عبد اللَّه: "العقيدة وقضيَّة الانحراف"، مجلَّة الأُمَّة، قطر،
رئاسة المحاكم الشرعيَّة والشؤون الدينيَّة، العدد 30، جمادى الآخرة 1403هـ.ق/ مارس 1983م.
24- الشاهد، محمَّد: "الاستشراق ومنهجيَّة النقد عند المسلمين المعاصرين"، مجلَّة الاجتهاد (مجلَّة متخصِّصة تعنى بقضايا الدين والمجتمع والتجديد العربيّ الإسلاميّ)، العدد 22، السنة 6، 1994م.
25- الضامر، عبد العزيز بن عبد الرحمن: "هل تأثَّر المستشرقون بآراء الاثني عشريَّة في تاريخ القرآن الكريم؟!"، مجلَّة البيان، العدد 339، ذو القعدة 1436هـ.ق/ أغسطس-سبتمبر 2015م.
26- العبادي، أحمد المختار: "الإسلام في الأندلس"، مجلَّة عالم الفكر، العدد 2، 1979م.
27- عبد الله، رائد أمير: "المستشرقون الألمان وجهودهم تجاه المخطوطات العربيَّة الإسلاميَّة"، مجلَّة العلوم الإسلاميَّة، الموصل، 2014م.
28- عزوزي، حسن: "ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق جاك بيرك"، بحث مقدَّم لندوة ترجمة معاني القرآن الكريم بالمدينة المنوَّرة، 1423هـ.ق.
29- عطيَّة، عبد الرحمن السيِّد: "ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الروسيَّة"، بحثٌ مقدَّم لندوة ترجمة معاني القرآن الكريم بالمدينة المنوَّرة، 1423هـ.ق.
30- عيَّاد، محمَّد كامل: "صفحات من تاريخ الاستشراق"، مجلَّة مجمع اللغة العربيَّة بدمشق، المجلَّد 44، ج3، 1969م.
31- غويطاين، "جولدتسيهر أبو الدراسات الإسلاميَّة"، مجلَّة الكاتب المصري، المجلَّد 5، العدد 17، فبراير 1947م.
32- القاضي، محمَّد: "الاستعراب الإسبانيّ والتراث الأندلسيّ من خلال ثلاثة نماذج (خوان أندريس، غيانغوس، ريبيرا)"، مجلَّة التاريخ العربيّ، العدد 16، خريف 2000م.
33- قويدر، بشار: "المستشرق بارتولد وجهوده في كتابه تاريخ المشرق"، مجلَّة دراسات وأبحاث، العدد 8، 2012م.
34- كرد عليّ، محمَّد: "أثر المستعربين من علماء المشرقيَّات في الحضارة العربيَّة"، مجلَّة المجمع العلميّ العربيّ، دمشق، المجلَّد 7، ج10، تشرين الأوَّل 1927م.
35- كولييف، إلمير روفائيل: "اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﻘﺪيَّة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﱰﲨﺎت ﳌﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﱃ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮوﺳيَّة"، بحثٌ مقدَّم لندوة ترجمة معاني القرآن الكريم بالمدينة المنوَّرة 1423هـ.ق.
36- الليثي، ياسر عبد الرحمن: "اللغة العربيَّة ودراسات الاستشراق الإسلاميَّة"، مجلَّة التسامح وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة، سلطنة عمان، العدد 17، شتاء 1428هـ.ق/2007م.
37- الماجدي، خزعل: "مخالب الاستشراق الجديد.. ورؤوسه الثلاث"، صحيفة الاتِّحاد، الملحق الثقافيّ، 27 يناير 2016م.
38- المالك، فهد: "نظرات في قضيَّة ترجمة معاني القرآن الكريم"، مجلَّة البيان 2، لندن، المنتدى الإسلاميّ، العدد 96.
39- مهر عليّ، محمَّد: "ترجمة معاني القرآن والمستشرقون لمحة تاريخيَّة وتحليليَّة"، بحث مقدَّم لندوة ترجمة معاني القرآن الكريم بالمدينة المنوَّرة، 1423هـ.ق.
40- "مذكرة لدراسة القرآن الشيعيّ"، مجلَّة الدراسات السامية، 1991م.
41- نصري، أحمد: "موقف المستشرقين من لغة القرآن الكريم"، مجلَّة دعوة الحقّ، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة في المملكة المغربيَّة، العدد 343، محرم 1420هـ.ق/ مايو 1999م.
42- النملة، عليّ بن إبراهيم: "الاستشراق في خدمة التنصير واليهوديَّة"، مجلَّة جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، العدد 3، رجب 1410هـ.ق.
43- هدارة، محمَّد مصطفى: "التغريب وأثره في الشعر العربيّ الحديث"، مجلَّة الأدب الإسلاميّ، السعوديَّة، رابطة الأدب الإسلاميّ العالميَّة، المجلَّد 1، العدد 2، 1994م.
44- هرماس، عبد الرزَّاق بن إسماعيل: "الدراسات القرآنيَّة عند المستشرقين خلال الربع الأوَّل من القرن الخامس عشر الهجريّ"، مجلَّة البحوث والدراسات القرآنيَّة، العدد 6، السنة 3، لا ت.
45- هويدي، أحمد محمود: "الدراسات القرآنيَّة في ألمانيا دوافعها وآثارها"، مجلَّة الفكر، العدد 2، ج31، أكتوبر-ديسمبر 2002م.
1- www.dorar.net/adyan.
2- https://vb.tafsir.net/tafsir.
3- ar.wikipedia.org/wiki.
4- www.marefa.org.
5- : st-takla.org.
6- https://tafsir.net.
7- https://www.dohadictionary.org/.
8- http://turjomanquran.com/.
9- https://nosos.net/.
10- https://almoneer.org./
11- salafcenter.org.
12- www.alukah.net.
13- https://islamreligionisonlytruereligion.wordpress.com.
(496)