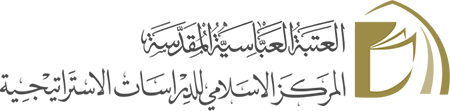
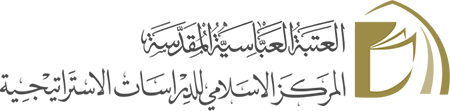
ملخص عن اهتمام المستشرقين بدراسة المخطوطات القرآنيّة | 25
المبحث الأوّل: بدايات اهتمام المستشرقين بدراسة المخطوطات القرآنيّة | 28
المبحث الثاني: المستشرقون ومحاولات التوصل إلى طبعة نقديّة للقرآن الكريم | 31
المبحث الثالث: المستشرقون المعاصرون ودراسة المخطوطات القرآنيّة | 35
المبحث الرابع: فهرس المؤلفات الاستشراقيّة حول المخطوطات القرآنيّة | 38
دانيل بروبيكر وكتابه «تصحيحات في المخطوطات القرآنيّة المبكرة» | 45
المبحث الأوّل: نبذة عن المؤلف | 47
المبحث الثاني: قراءة تحليليّة في كتاب بروبيكر | 51
ثانيًا: نماذج من التصحيحات في المخطوطات القرآنيّة | 59
المبحث الثالث: نظرة عابرة إلى الردود الموجهة على كتاب بروبيكر | 86
أوّلًا: مقالة بعنوان «استعراض الكتاب: تصحيحات في المخطوطات القرآنيّة المبكرة» | 86
ثانيًا: كتاب بعنوان «الرد على كتاب دانيل آلن بروبيكر» | 89
ثالثًا: كراسة بعنوان «تفاهة التصحيحات في المخطوطات القرآنيّة المبكرة» | 92
دراسة نقدية لمزاعم بروبيكر | 95
المبحث الأوّل: دراسة لمنهجيّة بروبيكر | 97
ثانيًا: المصاحف المخطوطة | 130
ثالثًا: المنهج الممارَس في الكتاب | 138
المبحث الثاني: المصاحف المتقدمة زمنيًّا على وثائق بروبيكر | 141
العتبة العباسية المقدسة
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
سلسلة القرآن في الدراسات الغربية 14
التحريف في المخطوطات القرآنية
دراسة نقدية لآراء دانيل بروبيكر في كتابه
تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة
تأليف : أمير حسين فراستي
إشراف : الدكتور مرتضى توكلي
(1)فراستي ، امير حسين ، مؤلف
التحريف في المخطوطات القرآنية : دراسة نقدية لآراء دانيل بروبيكر في كتابه تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة / تأليف أمير حسين فراستي ، اشراف الدكتور مرتضى توكلي .-الطبعة الاولى .- النجف ، العراق .- العتبة العباسية المقدسة ، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ، 1443 هـ . = 2022 .
224 صفحة : نسخ طبق الاصل ، 24 سم .-(سلسلة القرآن في الدراسات الغربية ، 14)
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة 210 - 224
ردمك : 9789922680040
1. القرآن --دفع مطاعن . 2. بروبيكر ، دانيال آلان. تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة. 3. الاستشراق والمستشرقون . أ .توكلي ، مرتضى ، مشرف . ب. العنوان .
LCC : BP130.1 .F57 2022
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
فهرسة اثناء النشر
(2)سلسلة القرآن في الدراسات الغربية
التحريف في المخطوطات القرآنية
دراسة نقدسة لآراء دانيل بروبيكر في كتابه
تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة
تأليف : أمير حسين فراستي
إشراف : الدكتور مرتضى توكلي
(3)
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
الإهداء
إلى أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي ، الحفظة لسرّ الله ، والخزنة لعلمه ، والمستودع لحكمته ، والتراجمة لوحيه ، الأئمة الدعاة ، والقادة الهداة ، والسادة الولاة ، الذين قرنهم الله بكتابه العزيز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وجعلهم رسوله صلى الله عليه وآله أحد الثقلين اللذين أودعهما في أمته ، عليهم أفضل الصلاة والسلام .
(5)مقدّمة المركز9
تمهيد17
الفصل الأوّل:
ملخص عن اهتمام المستشرقين بدراسة المخطوطات القرآنيّة25
المبحث الأوّل: بدايات اهتمام المستشرقين بدراسة
المخطوطات القرآنيّة28
المبحث الثاني: المستشرقون ومحاولات التوصل إلى
طبعة نقديّة للقرآن الكريم31
المبحث الثالث: المستشرقون المعاصرون ودراسة
المخطوطات القرآنيّة35
المبحث الرابع: فهرس المؤلفات الاستشراقيّة حول
المخطوطات القرآنيّة38
الفصل الثاني:
دانيل بروبيكر وكتابه
«تصحيحات في المخطوطات القرآنيّة المبكرة»45
المبحث الأوّل: نبذة عن المؤلف47
المبحث الثاني: قراءة تحليليّة في كتاب بروبيكر51
أوّلًا: مقدّمة الكتاب51
ثانيًا: نماذج من التصحيحات في المخطوطات القرآنيّة59
ثالثًا: الاستنتاج83
المبحث الثالث: نظرة عابرة إلى الردود الموجهة
على كتاب بروبيكر86
أوّلًا: مقالة بعنوان «استعراض الكتاب: تصحيحات في
المخطوطات القرآنيّة المبكرة»86
ثانيًا: كتاب بعنوان «الرد على كتاب دانيل آلن بروبيكر»89
ثالثًا: كراسة بعنوان «تفاهة التصحيحات في
المخطوطات القرآنيّة المبكرة» 92
الفصل الثالث:
دراسة نقدية لمزاعم بروبيكر 95
المبحث الأوّل: دراسة لمنهجيّة بروبيكر97
أوّلًا: المقدّمة98
ثانيًا: المصاحف المخطوطة130
ثالثًا: المنهج الممارَس في الكتاب138
المبحث الثاني: المصاحف المتقدمة زمنيًّا على وثائق بروبيكر141
الخاتمة208
قائمة المصادر والمراجع210
بسم الله الرحمن الرحيم
القرآن الكريم هو المصدر الأوّل للشريعة المقدّسة، وهو الحجّة القاطعة بيننا وبين الله تعالى، التي لا شك ولا ريب فيها، كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلىاللهعليهوآله، وكان يراجعه مع أمين الوحي في كلّ شهر من شهور رمضان للتأكّد من سلامته مبنًى ومعنًى، وقد بلَّغ نبيُّ الإسلام القرآن الكريم تبليغاً كاملاً باتّفاق المسلمين، وأمر بحفظه وكتابته وجمعه حال حياته، وأنّ ما بين الدفتين والمتداول بين المسلمين منذ عهد النبي صلىاللهعليهوآله، لم يزد فيه ولم ينقص منه، يقول الفقيد العلّامة حسن زاده آملي: «واعلم أنّ الحقّ المحقّق المبرهن بالبراهين القطعيّة من العقليّة والنقليّة أنّ ما في أيدي الناس من القرآن الكريم هو جميع ما أنزل الله تعالى على رسوله خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآله وما تطرّق إليه زيادة ونقصان أصلاً». ومن المتفّق عليه أنّ هذا القرآن تنزّل عليه منجَّماً في حوالي ثلاث وعشرين سنة، فاقتضت حكمة الله تعالى ألاّ ينزل القرآن على رسوله صلىاللهعليهوآله جملةً واحدةً، كما نزلت الكتب السماويّة الأخرى السابقة، وإنّما نزل متدرِّجاً ومفرَّقاً حسب الحوادث والوقائع ومقتضيات التشريع بعد نزوله على قلب النبيّ صلىاللهعليهوآله مرّة واحدة، ولهذا الأمر فلسفةٌ خاصّة ليس هنا محلُّ بحثها.
ومن الثّابت أنّ القرآن الكريم قد وصل إلينا بطريق التواتر، كتابةً في
المصاحف وحفظاً في الصدور، فقد نقله عن النبيّ صلىاللهعليهوآله جموعٌ غفيرةٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب أو الوهم أو الخطأ، أبرزهم الإمام علي عليهالسلام ومجموعة من الصحابة الأخيار، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء والفقهاء، وصولاً إلى عصرنا، حيث وصل إلينا مكتوباً في المصاحف. وإنّ ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه كلاهما منزَّل من عند الله تعالى، ووظيفة النبيّ صلىاللهعليهوآله إنّما هي تلقيّه عن الله تعالى وتبليغه إلى الناس وبيان ما يحتاج منه إلى بيان.
و«إنّ القرآن أُنزل لهداية البشر، وسوقهم إلى سعادتهم في الأُولی والأُخری، وليس هو بكتاب تاريخ أو فقه، أو أخلاق، أو ما يشبه ذلك ليعقد لكلٍّ من هذه الجهات بابًا مستقلًّا. ولا ريب في أنّ أسلوبه هذا أقرب الأساليب إلى حصول النتيجة المقصودة، فإنّ القارئ لبعض سور القرآن يمكنه أن يحيط بكثير من أغراضه وأهدافه في أقرب وقت وأقلّ كلفة، فيتوجّه نظره إلى المبدأ والمعاد، ويطّلع علی أحوال الماضين فيعتبر بهم، ويستفيد من الأخلاق الفاضلة، والمعارف العالية، ويتعلّم جانبًا من أحكامه في عباداته ومعاملاته. كلّ ذلك مع حفظ نظام الكلام، وتوفية حقوق البيان، ورعاية مقتضی الحال. وهذه الفوائد لا يمكن حصولها من القرآن إذا كان مبوّبًا؛ لأنّ القارئ لا يحيط بأغراض القرآن إلّا حين يتمّ تلاوة القرآن جميعه».
والقرآن هو أدلّ المصادر التشريعيّة وأهمّها على الإطلاق، وهو ما بين الدفتين الذي تداوله المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع شؤون حياتهم منذ بلّغه النبي صلىاللهعليهوآله إلى الأمّة الإسلاميّة، لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف. قال الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) ، وقال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء) وهذا لا يعني أنّه يحيط بكلّ جزئيّات الوقائع والحوادث ونصّ على تفاصيل أحكامها، بل هو تبيان لكل شيء من حيث إنّه أحاط بجميع الأصول
والقواعد والكليات، التي لا بدّ منها في كل قانون أو نظام، كوجوب العدل والمساواة، ورعاية الحقوق، وأداء الأمانات والوفاء بالعقود والعهود..، وما إلى ذلك من المبادئ العامّة التي لا يستطيع أن يشذّ عنها نظام يراد به صلاح الأمم وسعادتها، وقد ورد عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام قوله: «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتى -والله- ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أُنزل في القرآن، إلاّ وقد أنزل الله فيه».
و«إنّ آيات القرآن جميعها التي يفوق عددها ستة آلاف آية منسجمة مع بعضها، وهي بمنزلة كلام واحد؛ ذلك لأنّ القرآن نزل من مبدأ الحكمة، وبعد الإحكام وكونه حكيمًا تمّ تفصيله». ولا ريب في أنّ القرآن الكريم -في المجموع- له لغته الخاصّة، ولا يمكن قياسها باللغة الرائجة في مجموعة بشريّة خاصّة. إنّ مثل هذا الانسجام بين الألفاظ والمعاني، استقلال المطالب وترابطها، الوئام التامّ في مجموعة الكلام، الاستفادة من الأساليب المتنوّعة، والاحتواء علی المطالب والأسرار العجيبة في عين بساطة اللغة ووضوح البيان الذي هو الفصاحة والبلاغة يُعدّ إعجازًا وفوق قدرة البشر.
تتجلّى مكانة المخطوطات وأهميتها -التي اهتم المستشرقون بها- في كونها جزءاً من التراث العربي والإسلامي، الذي قامت عليه الحضارة العربيّة الإسلاميّة، ودراستها تدفع إلى التعرّف على أسباب النهوض وعوامله وعناصر قوّته والتطوّر والتقدّم والإبداع عند العرب المسلمين، ومعرفة الطريق الذي سار عليه الأقدمون في مسيرة بنائهم الحضاري.
وصحيح بأنّ دراسة المخطوطات وتحقيقها ونشرها قد بدأت مبكراً في حدود القرن الخامس عشر الميلادي في أوروبا، وكانت في طور نشأتها الأولى صناعة تحترف للكسب المعيشي، ثمّ تحوّلت من خلال ما مرّت به من تجارب عمليّة إلى علم له أصوله وقواعده، بدءاً من جمع نسخ المخطوط ومقابلتها، وصولاً إلى تدوين الاختلافات بين النسخ في الهوامش. إلّا أنّه من الواضح عندنا أنّه كان للاستشراق سبقُ الممارسة لا سبق التأسيس في هذا المجال، فإنّ إجراءات علم تحقيق المخطوطات معروفة في تراثنا العربي والإسلامي وعند علماء المسلمين منذ القدم، فإنّ العلماء المسلمين قد عرفوا القواعد المتعلّقة بعلم تحقيق المخطوطات مبكراً، إذ كانوا يتحرّون عن صحّة نسبة النصّ إلى صاحبه، ويهتمّون بضبطه وتوثيقه، ويقابلون بين أوجه روايات النصّ المختلفة، لانتقاء أوثقها.
ويظهر بوضوح للمتتبّع في تاريخ الاستشراق أنّ عدداً كبيراً من المستشرقين، قد أولى تحقيق هذه المخطوطات عنايةً خاصّةً واستثنائيّةً، نظراً لقيمتها العلميّة والحضاريّة، فضلاً عن كونها جزءًا مهمًّا من التراث العربي والإسلامي العريق. فقد عنيت الدراسات الاستشراقيّة بجمع المخطوطات الإسلاميّة، وتحديدًا في القرن السابع عشر الميلادي، وتمّ نقلها إلى الغرب، والقيام بحفظها وفهرستها وتحقيق بعضها ونشره، وتسجّل الوقائع التاريخية المرحلة التي جاب المستشرقون والرحّالة الغربيون الديار الإسلاميّة بحثاً عن المخطوطات. مع كل المحاذير والمشكلات والصعوبات التي تواجه عمليّة تحقيق المخطوطات ودراستها، نجد بأنّ المستشرقين على اختلاف مشاربهم وتوزّعهم الجغرافي قد اهتمّوا منذ زمن طويل بجمع المخطوطات العربيّة من كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي. وكان هذا العمل مبنيًّا على وعي تام بقيمة هذه المخطوطات التي تحمل تراًثا غنيًّا في شتّى مجالات العلوم. وكان بعض الحكّام في أوروبا يفرضون على كل سفينة تجاريّة تتعامل مع الشرق أن تحضر
معها بعض المخطوطات. وقد ساعد الفيض الهائل من المخطوطات المجلوبة من الشرق على تسهيل مهمّة الدراسات العربيّة في أوروبا وتنشيطها. وكانت الجهات المعنيّة في أوروبا ترسل مبعوثيها لشراء المخطوطات من الشرق. فعلى سبيل المثال أرسل «فريدريش فيلهلم الرابع» ملك بروسيا «ريتشارد ليبسيوس» إلى مصر عام 1842م، و«هينريش بترمان» عام 1825م إلى الشرق لشراء مخطوطات شرقيّة. وقد تمّ جمع المخطوطات من الشرق بطرق مشروعة وغير مشروعة. وقد لقيت هذه المخطوطات في أوروبا اهتمامًا لناحية حفظها وصيانتها من التلف، والعناية بها وفهرستها فهرسةً علميّة تصف المخطوط وصفًا دقيقًا، وتشير إلى ما يتضمّنه من موضوعات وتذكر اسم المؤلِّف وتاريخ ميلاده ووفاته وتاريخ تأليف الكتاب أو نسخه... إلخ. وبذلك وضعت تحت تصرّف الباحثين الراغبين في الاطّلاع عليها في مقرّ وجودها أو طلب تصويرها بلا روتين أو إجراءات معقّدة.
وقد قام مثلًا ألوارد (Ahlwardt) بوضع فهرس للمخطوطات العربيّة في مكتبة برلين في عشرة مجلّدات، وقد صدر هذا الفهرس في نهاية القرن الماضي، واشتمل على فهرس لنحو عشرة آلاف مخطوط. وقد قام المستشرقون في الجامعات والمكتبات الأوروبيّة كافّة بفهرسة المخطوطات العربيّة فهرسةً دقيقةً، وتقدّر المخطوطات العربيّة الإسلاميّة في مكتبات أوروبا بعشرات الآلاف. وهناك دراسات للمستشرقين عن هذه المخطوطات في مجالات عديدة. وعلى سبيل المثال قامت باحثة من المستشرقين بإعداد بحث عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم في القرن السادس عشر، قال عنه الشيخ أمين الخولي بعد أن سمعه أثناء حضوره لمؤتمر المستشرقين الدولي الخامس والعشرين: “لقد قدّمت السيّدة كراتشكوفسكي بحثًا عن نوادر مخطوطات القرآن في القرن السادس عشر الميلادي. وإنّي أشك في أنّ الكثيرين من أئمّة المسلمين يعرفون شيئًا عن
هذه المخطوطات، وأظنّ أنّ هذه المسألة لا يمكن التساهل في تقديرها”.
وعندما نريد تقييم جهود المستشرقين، يجب علينا ألّا نكتفي بالظاهر، بل علينا أن ندرس المخطوطات التي حقّقوها ونشروها؛ ونطرح العديد من الأسئلة حولها، فهل كان تحقيقهم مبنياً على أسس علميّة؟ وما هي أهدافهم من هذه العمليّة العلميّة المعقّدة؟ وما المخطوطات التي قاموا بتحقيقها؟ وهل عنوا بتحقيق ما يظهر تفوّق المسلمين ونبوغهم وعبقريتهم، أم أنّهم حقّقوا من المخطوطات ما يخدم أغراضهم وأهدافهم الاستعماريّة؟.
وبنظرة أوليّة، نجد أنّ النقد الموجّه لهذه الأعمال كان بالأعم الأغلب ضمن اتّجاهين. فقد عمد أصحاب الاتّجاه الأوّل إلى نقد النتائج والآراء الفكريّة للمحقّق في معالجته للنصّ المخطوط، وعادة ما تكون هذه الآراء ظاهرةً مثبتةً في مقدّمة التحقيق، بحيث يعبّر عنها المحقّق مباشرةً، موضّحًا رأيه في تلك القضايا التي يعالجها المخطوط، وفي بعض الأحيان تكون هذه الآراء مستنبطةً من المعالجة التحقيقيّة للنص المخطوط، وتظهر أكثر ما تظهر في هامش التحقيق، حيث تعليقات المحقّق على النصّ وترجيحاته. وهذا الاتّجاه في النّقد يشمل ما أنتجه المستشرقون من تحقيقات أو معالجات للنص المخطوط، ولهذا فقد تعرَّضتْ الآراء الفكريّة التي أثبتها المستشرقون في مقدّمات تحقيقاتهم لردودٍ كثيرة، من خلال المقدّمات التي كُتبت من قِبل المحقّقين العرب، الذي أعادوا تحقيق المخطوط الذي نشره المستشرق من قبلُ، وهذا المنحى من النّقد يفرض على الناقد لعمليّة التّحقيق أن يكون متخصّصًا في المتن موطن الدراسة؛ ليفهم أوّلًا مقصد المحقّق من كلامه، ثم يتمكّن ثانيًا من الرّدّ عليه ونقد آرائه الفكريّة.
بينما ذهب أصحاب الاتّجاه الثاني إلى نقد إجراءات التحقيق، أو نقد المنهج الذي اتَّبعه المستشرقون في إخراج المخطوط ونشره، وهو اتّجاه نقديّ يدور حول
المنهج المتّبع من قبل المستشرق في عمليّة المعالجة التحقيقيّة للنص المخطوط، وهذا الاتّجاه ينبثق من النّصّ ذاته دون الدخول مع المستشرق المحقّق للنصِّ في سجالٍ فكريٍّ حول أرائه التي حاول أن يبثَّها من خلال معالجته للنص المخطوط. ويحاول هؤلاء الإجابة على سؤال: هل استوفت المعالجة التحقيقيّة للمخطوط من قبل المستشرق إجراءات علم التحقيق؟
وفي كلا الحالتين، إنّ الجهود التي بُذلت إلى زماننا المعاصر لم ترتقِ إلى المستوى الذي يليق بتراث نهبه الغرب وتفرّغ لدراسته مئات الباحثين والمحقّقين؛ بحثاً وتحقيقاً وتنقيباً في كلّ ما يتعلّق بالتراث العربي والإسلامي؛ ليتمكّنوا من جعل مضامين هذا التراث مادةً مرجعيّةً دسمةً بين أيدي الباحثين ومراكز الدراسات والمؤسّسات التعليميّة العالية...، ويتم استثماره في المجالات العلميّة والتنمويّة والحضاريّة وغيرها من المجالات، في خدمة البلدان والمجتمعات الغربية التي طالما ادّعت التطوّر والتقدّم والرّقي والحضارة. إلى جانب فهمهم لواقع بلداننا ومجتمعاتنا وثرواتنا؛ كي تكون لقمةً يسهل تناولها برضا وتعاون أهلها وأصحابها. وهنا تكمن الخطورة والضّعف والوهن عند الكثير من الأنظمة في هذا العصر.
يتضمّن هذا الكتاب؛ التحريف في المخطوطات القرآنيّة: دراسة نقديّة لآراء دانيل بروبيكر في كتابه "تصحيحات في المخطوطات القرآنيّة المبكرة"، أربعة فصول وخاتمة: وقد ركّز الفصل الأوّل بنظرةٍ عابرةٍ على اهتمام المستشرقين بدراسة المخطوطات القرآنيّة، مع تعريف بأشهر المستشرقين وبأهمّ المؤلّفات في هذا المجال. أمّا الفصل الثاني، فقد ركّز على السيرة الذاتيّة للمستشرق الأمريكي دانيل بروبيكر وتعريف مختصر بأهم أعماله العلميّة. ثم تليه خلاصة عمّا ورد في كتاب بروبيكر من أوّله إلى آخره. هذا وينقسم الفصل الثالث، إلى مبحثين؛ في المبحث الأوّل قدّم الباحث ملاحظات على ما قاله بروبيكر في كتابه، وردّ على الشّبهات التي أثارها، ثم يذكر جملةً من التفاصيل المرتبطة بالمخطوطات التي استفاد منها
(15)بروبيكر في كتابه بقدر ما نُشرت من معلومات عنها وما اطّلعنا عليها. بعد ذلك يتناول الباحث منهجيّة بروبيكر ويقوّم نجاعتها في التوصّل إلى ما كان بصدده. وفي المبحث الثاني يتم تزويد القارئ الكريم بصور من المخطوطات القرآنيّة المبكرة السليمة من الأخطاء والتعديلات، والتي ترفض دعاوى بروبيكر بشأن التحريف الواقع في القرآن المجيد. وفي الفصل الرابع، يعرّف الباحث ثلاثة آثار أخرى مع الرّدّ على دعاوى بروبيكر. وفي الخاتمة يؤكّد الباحث أنّ ما عثر عليه بروبيكر وزعمه تحريفًا أو تعديلًا للنّصّ القرآنيّ ليس إلا أخطاء نسخيّة تصدر عن كلّ إنسان غير معصوم، فلا يُعبأ بها إذا كانت فريدةً لا تكرّر في جميع المخطوطات، كما لا تطعن في صحّة النصّ إذا كانت المخطوطات الأخرى خالية منها.
وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل من الأخ العزيز أميرحسين فراستي الباحث الإسلامي من إيران، طالب الماجستير في جامعة الإمام الصادق عليهالسلام .
(16)
لقد احتلّ القرآن الكريم مكانةً مرموقةً بين المصادر الإسلاميّة، بل هو أساس هذا الدين الإلهي، والركيزة الرئيسة التي يركن إليها المسلمون في معتقداتهم. وبما أنّ القرآن المجيد يحظى بالأهميّة البالغة في الدين الإسلامي، فلا يمكن التعويل على نصوصه الشريفة والرجوع إلى آياته الكريمة إلّا إذا كان سليمًا من التحريف ومصونًا من التغيير منذ نزوله على خاتم الأنبياء والمرسلين صلىاللهعليهوآله ؛ وإلّا فلا عبرة بالكتاب الذي تعرّض للدسّ والتبديل بالزيادة أو النقصان؛ إذ إنّ ذلك يؤدّي إلى نقض الغرض من إنزال القرآن الكريم، بقصد هداية البشريّة وتزكيتها وتعليمها...، وهذا ما يتنافى مع الحكيم.
لذلك شغلت مسألة عدم تحريف القرآن الكريم الأمّةَ الإسلاميّة منذ رحيل الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله ، بدءًا من مناقشة ونقد الروايات التي ورد فيها دعوى وجود قرآن يختلف عن الذي يتداوله المسلمون ويقرأونه ليلًا ونهارًا؛ إذ يدلّ بعضها على الزيادة أو النقيصة في النصّ القرآنيّ، ومنها ما يتحدّث عن التغيير في بعض الألفاظ القرآنيّة،
ومنها ما يُشير إلى الأخطاء التي ارتكبها كتّاب الوحي (كاظم، ٢٠١٥، ص31). وهذه الأخبار التي لا يخلو الموروث الروائيّ لكلا الفريقين منها حدت بالعلماء المسلمين من الشيعة وأهل السنّة أن يردّوا على القائل بتحريف القرآن الكريم، مستدلين بالأدلّة العقليّة والنقليّة، بما فيها الآيات القرآنيّة والأحاديث التي ترفض تصريحًا أو تلميحًا هذه الدعوى الهادفة إلى زعزعة الإسلام واجتثاث أصوله.
وبينما حاول البعض إثباتَ مبدأ سنيّ للروايات الدالّة على وقوع التحريف في القرآن الكريم، والتي ـ حسب ما توصّلَ إليه ـ تسرّبت في المؤلّفات الشيعيّة إثرَ السجالات الكلاميّة حول الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله بين الفريقين (مدرسي طباطبايي، ١٣٨٠، صص41 -59)، رأى البعضُ الآخر أصلًا شيعيًّا لتلك الروايات، والتي لا مثيل لها في كتب أهل السنّة والجماعة (طباطبايي، ١٣٩٤، ص83). لكن الرأي السائد بين العلماء المسلمين هو القول بعدم تحريف القرآن المنزَل على قلب النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله ؛ لذلك تُواجه الصراخاتُ التي تندلع بين حين وآخر لمعارضة هذا المعتقد الإسلامي ردودًا صارمةً من قبَل الباحثين وأهل الاختصاص في هذا المجال.
ولم تبقَ مسألة تحريف القرآن الكريم وعدمه حكرًا على العالَم الإسلامي؛
فمنذ انطلاق الدّراسات الاستشراقيّة حول القرآن ونقله حتى العصر الراهن، تناول جملة من المستشرقين هذه المسألة الخطيرة وعبّروا عن آرائهم في هذا الموضوع بين مؤيّد ومعارض. وربّما كان أوّل مستشرق ادّعى التحريف في القرآن دي ساسي الذي زعم الآية 138 من سورة آل عمران مختلقة، وتابعه وايل وزاد عليها آيات وسور أخرى، كما رافقهما اشبرنغر وهرشفلد في دعوى تحريف القرآن بالزيادة (Hirschfeld, 1902, pp. 138 -139). وأدلى بلاشير بتصريح أنّ جزءًا من الآيات أضيفت إلى القرآن لأسباب سياسيّة (١٣٧٤، ص219)، واعتقد آخرون أنّ عددًا من الآيات سقط من النّصّ القرآنيّ بحجّة عدم الملاءمة بين فواصلها (Nöldeke, 2013, pp. 111 -112)، أو بحجّة إهمالها في عمليّة جمع المصحف (Lowin, 2004, p. 449).
فضلًا عن اعتماد المستشرقين على المصادر الضعيفة والروايات الموضوعة في إثبات تحريف القرآن (ربيع نتاج، ١٤٣٠، ص247)، بذل بعضهم جهودًا في تحقيق الكتب المؤلّفة في اختلاف المصاحف وإخراجها إلى النور (انظر: الصغير، ١٩٩٩،
(19)صص74-75)، زاعمين أنّها تُثبت تعدّد نُسَخ القرآن وتكشف عن تحريفه عبر الزمان، وبالتالي عدم إلهيّة مصدره، كما يجدون أمثال هذه البراهين في انتقادات العلماء المسلمين بحق الكتاب المقدّس لليهود والنصارى (جانيپور، 5 -41، ص19). ومع الأسف لقد كانت الشيعة أشدّ اضطهادًا في هذه الدّراسات الغربيّة؛ إذ بدأت معرفة المستشرقين لرؤية الشيعة إلى القرآن الكريم في القرن التاسع عشر، عبر البحث عن موقفهم تجاه التحريف في كلام الله (طباطبايي، 1395، ص12)، فلقوا تهمة القول بتحريف القرآن منسوبة إلى هذه الطائفة المسلمة (جولدتسيهر، ١٩٥٥، ص293)، متأثرين بوجهة نظر جماعة من أهل السنة في هذا المجال (راد، ١٣٩٨، ص45)؛ إلى درجة ادّعى بعضهم إجماعَ المستشرقين على قبول هذه الفكرة بالنسبة إلى الشيعة القدامى (برونر، ١٣٩٥، ص152).
وفي المقابل، ثمّة عددٌ من المستشرقين -مع أنّهم لم يؤمنوا قط بالقرآن ولم يصدّقوا معارفه- أقرّوا بسلامته من التحريف في القرون الماضية؛ كما يرى توري أنّ القرآن بقي بشكلٍ خاصٍّ دون أيّ تغيير عمّا آتى به رسول الله صلىاللهعليهوآله (Torrey, 1933, p. 2). ويجد بول أصالة القرآن ميزةً متفوّقة له، إذ يمكن بكلّ ثقة قراءةُ ما أنزِل على رسول الله صلىاللهعليهوآله دون حدوث أي تغيير فيه (Lane -Poole, 1879, p. c). ويعتقد موير أنّ القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ظلّ نقيًّا في غابر الأزمان، فلم يقع فيه تحريف منذ العصر العثماني (Muir, 1912, pp. xxii -xxiii). وبينما ينفي بالمر ما نُسب إلى العلماء المسلمين من الإيمان بالتحريف قائلًا: إنّ النص القرآني أصبح أصيلًا ومقبوًلا لدى جميع المذاهب الإسلامية منذ العصر العثماني إلى يومنا هذا
(20)(Palmer, 1955, p. lix)، ويوضّح كلبرغ أنّ هذا المعتقد شاذ بين علماء الشيعة (Lawson, 1991, pp. 281 -282)، ويشير إلياش إلى زيف هذه التّهمة الموجّهة إليهم من قبَل المستشرقين (Eliash, 1969, p. 24).
إلى جانب هؤلاء المستشرقين الذين تتمحور معظم أدلّتهم -فيما يخصّ تحريف القرآن الكريم سلبًا أو إيجابًا- حول التراث الإسلامي وترتكز آراؤهم عنه على تأويلاتهم لمؤلّفات العلماء المسلمين، تمخضت في سبعينيات القرن العشرين فرقةٌ استشراقيّةٌ تميّزهم عن أسلافِهم رؤيتُهم الحديثة إلى المصادر الإسلاميّة، فهُم يثيرون الشكّ فيها مؤكّدين على ابتناء دراساتهم على أدلّة ماديّة تؤيّد آراءهم (فراستي، ٢٠٢١، ص15). ويرى هؤلاء -أمثال ونزبرو وبرتون وشوميكر- أنّ النّصّ القرآنيّ لم يكتمل في العهد النبوي صلىاللهعليهوآله ، بل لا يزال يتوسّع ويتقلّص في القرون الأولى -ولم يتفقوا على زمن محدّد- حتى أصبح أخيرًا بشكله النهائيّ (وحیدنیا، ١٣٩٧، صص108 -109). ولهذه المدرسة الاستشراقيّة أصحاب يدرسون المخطوطات القرآنيّة ـ كأدلّة ماديّة على نقل القرآن ـ بحثًا عن التحريف فيها.
(21)ولربّما أوّل من ادّعى وقوع التحريف في المخطوطات القرآنيّة الشريفة هما مينغانا ولويس في مقال لهما عن ثلاثة مخطوطات قديمة -حسب زعمهما- تختلف عن النّصّ القرآنيّ الراهن. ولكن «جرد بوين» هو أوّل من أثار ضجّة إعلاميّ بسبب دعواه بشأن التحريف في المخطوطات القرآنيّة المكتشفة بجامع صنعاء واختلافها عن النصّ القرآنيّ المتناول بين أيدينا. إلّا أنّ هؤلاء الثلاثة لم يكونوا أوّل من قام بدراسة المخطوطات القرآنيّة، ولا أوّل من خطرت على باله شبهةُ التحريف فيها، كما يسبقهم ويري الذي توقّعَ استكشاف قراءاتٍ جديدة للقرآن الكريم عبر دراسة مخطوطاته (Wherry, 1882, vol. 1, p. 349)، وكذلك جماعة من المستشرقين الذين طمحوا إلى إعداد طبعةٍ نقديّةٍ للمصحف الشريف على أساس تلك المخطوطات.
وقد استمرّ هذا الاتّجاه الاستشراقي إلى عصرنا هذا، ويعدّ اليوم «دانيل آلِن بروبيكر» من روّاد دعوى التحريف في المخطوطات القرآنيّة، والذي ألّف كتابًا بعنوان «تصحيحات في المخطوطات القرآنيّة المبكرة: عشرون نموذجا» المزمع دراسته وتقويمه فيما يلي من هذا الكتاب. يهدف بروبيكر في كتابه إلى إثبات أنّ المخطوطات القرآنيّة القديمة تعرّضت للتعديل والتّصحيح حتى بات النّصّ القرآنيّ بشكله الحالي في زمن متأخّر، وليس تثبيت هذا الكتاب المقدّس يعود إلى العصر النبويّ صلىاللهعليهوآله ، كما يعتقد المسلمون وينفون حدوث التحريف في مرور الأعوام. ويزوّد
(22)المؤلفُ القارئَ بصورٍ من المخطوطات القرآنيّة يَظهر فيها النّصّ القرآنيّ مختلفًا عن القرآن المطبوع في الوقت الراهن، والتصحيحُ الموجود فيها يجعل النصّ موافقًا للمصاحف التي بين أيدنا.
إضافة إلى النماذج التي يتناولها بروبيكر في كتابه هذا، له نماذج كثيرة أخرى من المصاحف المخطوطة التي عثر عليها؛ حيث يختلف فيها النّصّ القرآنيّ عن الذي بين أيدينا، أو أنّه عُدّل ليصبح موافقًا للقرآن المطبوع، ويأتي بصور هذه المخطوطات في فيديوهات ينشرها على اليوتيوب. ونجد -للأسف- أنّ هذه الفيديوهات قد تُترجم إلى العربية أو الفارسيّة من قبَل أعداء الإسلام؛ بغية إثارة الشبهة في قلوب من لا خبرة له في مجال دراسة المخطوطات، والإيحاء إليهم أنّ القرآن الكريم محرّفٌ ومختلفٌ عمّا كان في صدر الإسلام.
إذًا، من منطلق ضرورة الرّدّ على شبهات المستشرقين وتوعية المؤمنين حول القرآن الكريم وصونه من التحريف منذ نزوله على خاتم الأنبياء والمرسلينs إلى الوقت الراهن، سوف نتطرّق في دراستنا هذه إلى تقويم فرضيّة بروبيكر وجدوى وثائقه في إثبات دعاويه، وذلك عبر الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ما هي أهمّ دعاوى بروبيكر في كتابه المذكور آنفًا؟
2- هل يجدي المنهج الذي يسلكه بروبيكر في إثبات فرضيّته؟
3- هل تؤيّد الأدلّة الماديّة -أي المخطوطات القرآنيّة المبكرة- دعاوى بروبيكر؟
بناء على هذا، تتألّف هذه الدّراسة النقديّة من ثلاثة فصول، وهي: الفصل الأوّل، نلقي نظرةً عابرةً على اهتمام المستشرقين بدراسة المخطوطات القرآنيّة، مع تعريفٍ بأشهر المستشرقين وبأهمّ المؤلّفات في هذا المجال. وفي الفصل الثاني، تأتي السيرة الذاتيّة للمستشرق الأمريكي دانيل بروبيكر، وتعريف مختصر بأهمّ أعماله العلميّة، ثم يلي ذلك خلاصة عمّا ورد في كتاب بروبيكر من أوّله إلى آخره. ومن ثمّ نعرض لثلاثة آثار حاولت الرّدّ على دعاوى بروبيكر، مع التنويه إلى ما تمتاز به هذه الدراسة
عمّا سبقها. والفصل الثالث، ينقسم إلى مبحثين؛ في المبحث الأوّل نقدّم ملاحظاتٍ على ما قاله بروبيكر في كتابه، ونحاول الرّدّ على الشّبهات التي أثارها. ثم نذكر جملةً من التفاصيل المرتبطة بالمخطوطات التي استفاد منها بروبيكر في كتابه بقدر ما نُشرت من معلوماتها واطّلعنا عليها. بعد ذلك نتناول منهجيّة المؤلّف ونقوّم نجاعتها في التوصّل إلى ما كان بصدده. وفي المبحث الثاني نزوّد القارئ الكريم بصورٍ من المخطوطات القرآنيّة المبكرة السليمة من الأخطاء والتعديلات، والتي ترفض دعاوى بروبيكر بشأن التحريف الواقع في القرآن المجيد. وفي الخاتمة، نستنتج أنّ ما عثر عليه بروبيكر وزعمه تحريفًا أو تعديلًا للنّصّ القرآنيّ ليس إلّا أخطاء نسخيّة تصدر عن كلّ إنسان غير معصوم، فلا يُعبأ بها إذا كانت فريدةً لا تكرّر في جميع المخطوطات، كما لا تطعن في صحّة النّصّ إذا كانت المخطوطات الأخرى خاليةً منها.
وأخيرًا، أقدّم جزيل الشّكر والامتنان والتقدير والاحترام للمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، على موافقتهم على نشر هذه الدراسة؛ وأشكر كلّ الشكر أستاذي الغالي الدكتور مرتضى توكلي، مدير قسم الأبحاث بمركز طباعة القرآن الكريم ونشره في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أشرف على هذه الدراسة، وأرشدني إلى النهج القويم في إنجازها؛ كما أشكر مركز طباعة القرآن الكريم ونشره، الذي زوّدني بجملةٍ من صور المخطوطات القرآنيّة، والتي استخدمتها في تأليف هذا الكتاب. وأتمنّى من الله عزّ وجلّ أن يتقبّل هذه الدراسة المتواضعة، ويجعلها توعيةً للأمّة الإسلاميّة وصيانة لها من تضليل المستشرقين وأعداء الدين.
(24)
(25)
تمهيد
لقد كان لعالم الاستشراق دورٌ بارزٌ في مجال المخطوطات العربيّة القديمة، من جمعها، وحفظها، وفهرستها، وتحقيقها، ونشرها، وترجمتها، وما إلى ذلك من الجهود العلميّة التي بذلوها منذ ظهور المطبعة في القرن الخامس عشر للميلاد، فكانوا مِن أوّل مَن اعتنى بطباعة الكتب العربيّة (الطناحي، ١٤٠٥، ص213)، وقد كان هذا الاهتمام بالتراث العربيّ الإسلاميّ من منطلق وعيهم بنفعها وغنائها للحضارة الغربية (الچراخ، 1431، ص16)، وقد لجأوا في استقطاب المخطوطات وجلبها إلى بلدانهم الأوروبية إلى وسائل شرعيّة وغير شرعيّة، مثل إرسال البعثات العلميّة إلى أقطار العالِم الإسلامي، واستغلال المجاعة وعوز أصحاب الكتب إلى أموال زهيدة، وسرقة المكتبات، والاستعمار السياسيّ (انظر: عبد الله، ٢٠١٣، ص 450 -453).
وبما أنّ القرآن الكريم هو أهم كتاب عربي، وأثمنها قيمةً وأكثرها أثرًا على حياة الأمّة الإسلاميّة، فقد اكترثت جماعة من المستشرقين بدراسة مخطوطاته والبحث عمّا ورد في مطاوي أوراقها، وكانوا في هذا المسار بصدد الحصول على طبعةٍ نقديّة للقرآن الكريم، وهذا هو المشروع الذي أنجزوه بالنسبة إلى كتابهم المقدّس، حيث وجدوا نصوصه المنقولة عن الوثائق والشهود مكتظة باختلاف معقّد، إلى درجة يتعذّر الحصول على النّصّ الأصليّ دون استخدام منهج النقد [النصي]، أي عمليّة التمييز ونبذ القراءات التي نشأت في سلسلة الانتشار (Westcott & Hort, 1896, p. 1). لذلك لمّا رأوا منهج النّصّ النقديّ نافعًا بامتياز في التوصّل إلى غايتهم -إذ قارنوا بين مخطوطات العهدين والقرآن وظنّوا أنّ كليهما تعرّضا للتطوّر والتغيّر عبر القرون - حاولوا تطبيق ذلك المنهج على المخطوطات القرآنيّة (Small, 2011, pp. vii -viii).
وفي هذا الفصل، نتطرّق إلى أهميّة المخطوطات عند المستشرقين، ويتوزّع على أربعة مباحث، كالآتي:
(27)سنتحدّث فيما يلي باختصار عن المساعي التي بذلها عددٌ من المستشرقين في مجال دراسة المخطوطات القرآنيّة بغية الحصول على طبعةٍ نقديّةٍ للقرآن الكريم. هناك من يعتقد أنّ البحث عن الدليل الماديّ على نقل القرآن المكتوب بدأ في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وكان أوّل من اعتنى بهذا المجال یاكوب جورج كريستيان أدلر، إلّا أنّه واجه مشكلة تحديد وتأريخ المخطوطات القرآنيّة التي تعود إلى القرن الأوّل الهجري (Déroche, 2020, p. 167). وکان مستشرقًا ألمانيًّا وعالمًا لاهوتيًا رفيعَ المستوى في الدنمارك، ويُعرف اليوم بالرائد في علم المسكوكات الإسلاميّة (Heidemann, 2016, p. 160). درسَ أدلر سلسلةً لا مثيل لها من المخطوطات العبريّة والسريانيّة والعربيّة، عندما کان يرجع إلى المكتبات الأوربيّة طوال رحلاته، ووثَّق ملاحظاته في عدد من المذكرات، واستطاع أن ينشر بعضها في مؤلّفاته المطبوعة (Ronny, 2017, p. 275). وقد دُعي في عنفوان شبابه إلى زيارةٍ شاملةٍ للمكتبة الملكية بكوبنهاغن تحت رعاية رئيس الوزراء والمؤرخ الدنماركي غولدباغ، واهتمّ بدراسة مجموعة من المخطوطات القرآنيّة المبكرة التي تعود إلى العصر العباسي. ومع أنّ جميع دراساته السابقة كانت مبنيّة على الآثار المطبوعة، اعتنى أدلر عندئذ بالنّصوص غير المطبوعة وأقلامها القديمة، وتمكّنَ من تطوير خبرةٍ علميّةٍ ملحوظة في هذا المجال ونشْر دراساته حول المخطوطات الكوفية (ibid., pp. 284 -285).
لكن الحقيقة هي أنّ أدلر لم يكن أوّل من اهتمّ بالمخطوطات القرآنيّة في عالم الاستشراق، فقد سبقه بعض المستشرقين مثل باغانيني، والذي ظهرت أوّل نسخة
(28)مطبوعة من النص العربي للقرآن على يده في مدينة البندقية سنة 1530 للميلاد، إلّا أنّها أُتلِفتْ بعد قليل من طباعتها؛ إذ كان فيها من الأخطاء ما حالَ دون بيعها (Rezvan, 2020, p. 256). وقيل إنه طبعَ القرآن لأوّل مرة عام 1537 للميلاد، غير أنّه أُتلِف بسبب مرسوم بابوي (Albin, 2004, p. 265). وعلى أيّ حال، بما أنّ باغانيني كان أوّل من أعدّ نسخةً مطبوعةً من القرآن المجيد، فلم يكن قبل ذلك إلّا المصاحف المخطوطة، فلربما هو أوّل مستشرق اعتنى بدراسة علميّة فيما يخصّ المخطوطات القرآنيّة.
ثم تجدر الإشارة إلى هينكلمان، وهو عالم اللّاهوت البروتستاني والمستشرق الألماني، الذي اشتهر بسبب طباعة القرآن الكريم للمرة الثانية في العالَم عام 1964 للميلاد في هامبورغ، ورغم أنّ مصحفه لم يكن بريئًا من الأخطاء، ولكنّه كان نافعًا جدًا من المنظور الفيلولوجي. وعندما كان مشغولًا بتحضير هذه الطبعة النقديّة للقرآن، راجعَ جملة من مخطوطاته، فتمكّنَ من إخراج مصحف يماثل مخطوطات العهد العثماني في عددٍ من سماتها (Daub, 2016, pp. 156 -158). وبينما كانت الكنيسة الكاثوليكيّة تمنع طباعة القرآن الكريم منعًا باتًّا في القرون الوسطى، لكن الفاتيكان أدركت أخيرًا عدم جدوى هذا المنع. ثم تلت هذه الطبعة للقرآن الكريم طبعةٌ أخرى على يد المستشرق الإيطالي مارّاجي، والذي كان عمله مبنيًّا على أساس المخطوطات القرآنيّة (Rezvan, 2020, pp. 256 -258).
ومن المستشرقين المشاهير الذين اهتمّوا بدراسة المخطوطات القرآنيّة هو ميكله أماري، وكان هذا المستشرق الإيطالي أوّل من اصطلحَ «الخط الحجازي»، وذلك على أساس ما قاله ابن النديم، والمقارنة بين كلامه والمخطوطات القرآنيّة في باريس؛ غير
(29)أنّ عمله بقي مهجورًا، ولم تتقدّم الدراسات في هذا المجال بشكل ملحوظ حتى نشرت عبّود كتابها بعنوان «نشأة الخط العربي: مع وصف مفصل للمخطوطات القرآنية في المعهد الاستشراقي» (Déroche, 2004, p. 256). وكانت هي أول امرأة عضوًا في قسم اللغات الشرقيّة والمعهد الاستشراقي بجامعة شيكاغو الإمريكيّة. وخلال الحرب العالمية الثانية -عندما احتضن ذلك المعهد المخطوطات الإسلاميّة المبكرة - عكفت عبود على دراسة هذه الوثائق الثمينة عبر التاريخ الإسلامي والفيلولوجيا (Mahdi, 1981, pp. 163 -164)، وأخرجت كتابًا ومقالات منها ما تركز على المخطوطات القرآنيّة، مثل الكتاب المذكور آنفًا، ومقالة بعنوان "المخطوطات القرآنيّة المغربيّة من القرن السابع عشر إلى الثامن عشر [للميلاد]".
كذلك ألفونس مينغانا يُعدّ من المستشرقين الذين اهتمّوا بدراسة المخطوطات الإسلاميّة، وكان هو قسيسًا من المسيحيين الكلدان، وأستاذًا للّغات الشرقيّة -مثل السريانيّة والعربيّة والعبريّة- في الجامعات الأوروبيّة، وقد اشتهر اليوم بسبب مجموعة ثرية من المخطوطات التي جلبها من بلدان الشرق الأوسط طوال رحلاته في عشرينيات القرن العشرين على نفقة كادبوري، وبالنسبة إلى اهتمامه العلميّ بالمخطوطات القرآنيّة يمكنُ الإشارة إلى محاولاته في تحقيق ثلاثة مخطوطات قرآنيّة مبكرة بالتّعاون مع المستشرق الأسكتلندي أغنيس لويس (see: Margoliouth & Woledge, 2006)، وملاحظاته على عدّة مخطوطات قرآنيّة في مكتبة جان رايلاند.
(30)قبل الإشارة إلى المستشرقين الآخرين، يجدر الذكر أنّ ظهور الفيلولوجي الكلاسيكي كان له أثرٌ كبيرٌ في ألمانيا في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر على دراسة القرآن الكريم، كما وقد أدّى نجاحُ الألمان في دراسات العهدين إلى نزعةٍ نحو دراسة القرآن في القرن التاسع عشر (Rezvan, 2020, p. 266). كذلك ازدادت عناية المستشرقين بالحصول على طبعةٍ نقديّةٍ للمصادر العربيّة الأصليّة في القرن نفسه (Shah, 2020, p. 6). فنظرًا إلى هذه الرؤية الحديثة في عالم الاستشراق شعرَ فريق منهم بمسيس الحاجة إلى طبعةٍ نقديّةٍ للقرآن الكريم يمكن التعويل عليها؛ إذ طُبع في هذه البرهة من الزمن -يعني سنة 1834 الميلادية بالتحديد- مصحف آخر على يد المستشرق الألماني فلوغل، وحظي بمكانةٍ رفيعةٍ بين المستشرقين (Déroche, 2006, p. 184)، إلّا أنّ هذه الطبعة ما زالت غير قادرةٍ على تلبية طموحهم، كما وقد أعرب بعضهم عن استيائهم من هذا المصحف (Bergsträsser, 1930, s. 1)، إلى جانب مصحف آخر تمّت طباعته في القرن العشرين للميلاد في القاهرة عام 1342 الهجري، ألا وهو المصحف الأميري أو طبعة الملك فؤاد، والذي اعتنت بإعداده لجنةٌ من علماء الأزهر الشريف، يترأسهم الشيخ محمد علي خلف الحسيني وحفني ناصف وغيرهما (الرومي، ٢٠٠٥، ص 505)، لكي يسهّل تعليم القرآن المجيد في مصر، وبعد مرور بضع عشرة سنة تمّت إعادة النّظر في المصحف وطُبع ثانية في عهد الملك فاروق.
ورغم أنّ هذا المصحف أصبح متداولًا بين المسلمين -من الشيعة وأهل السنة- والباحثين الغربيين، لكنّه أيضًا لم تتحقّق غاية المستشرقين؛ لأنّ العلماء الذين ساهموا في إنجاز ذلك المشروع -أي المصحف الأميري- لم يسعوا في إعادة بناء
(31)الشكل القديم للقرآن، بل حاولوا فيه تقديم قراءة رسميّة، أي رواية حفص عن عاصم (Reynolds, 2008, p. 2). فضلا عنه، لم يكن إعداد هذا المصحف على أساس مراجعة المخطوطات القرآنيّة مع شيوعها وتوفّرها وقتئذ، بل اعتمدت اللجنة العلميّة على المؤلّفات المعروفة في علم القراءات والرسم وعد الآي (دية، ٢٠١٤، ص288). إذًا طرح مستشرقان -وهما برغشترسر وجفري- فكرة طبعة نقديّة للقرآن على أساس مخطوطاته المبكرة، وقدّم برغشترسر خطّته في محاضرة ألقاها في ذكرى يوم الاستشراق الألماني السادس عام 1930 للميلاد، وتلقّى اقتراحُه ترحيبًا من قبَل الباحثين الغربيين في فيينا. لذلك من الممكن افتراض أنّ مشروع طبعة نقديّة للقرآن كان مستوحًا مما قام به علماء القاهرة، إذ كان برغشترسر وجفري ناشطَين في مصر أثناء تدوين ذلك مصحف (Reynolds, 2008, pp. 3 -4).
بناء على ذلك المشروع المقترح، أقرّت الأكاديميّة البافاريّة للعلوم بمونيخ خطّة لجمع أكبر قدر ممكن من صور المخطوطات القرآنيّة القديمة، ومهّدت بذلك -لأوّل مرة- لبحث مادة هذه المصادر المهمّة (بريتسل، ٢٠٠٤، ص 677 -678)، غير أنّ هذا مشروع -أي طبعة نقديّة للقرآن- بات مهجورًا لمّا تُوفي برغشترسر عام 1933 الميلادي، ولكن زميله وخلَفه في مونيخ، بريتسل، واصلَ ذلك وعمل على إكماله (ibid., p. 4)، وهذا ما صرّح به جفري في كتابه الذي جمع بين جملة من المصاحف المخطوطة وقام بشرح اختلافاتها النصيّة قائلًا: إنّه كان يتعاون مع برغشترسر بغية تحضير مجموعة من المواد التي تساعد على الكتابة عن تاريخ تطوّر النّصّ القرآني. وقد جمع بريتسل [إلى الآن] مجموعةً كبيرةً من الصور من المصاحف الكوفيّة، إضافة إلى كتب غير منشورة للقراءات. فمن المأمول أن يُنشر نصّ القرآن مع أداة نقديّة تزوّد القارئ بمجموعة من الفوارق النصيّة (Jeffery, 1937, p. vii).
(32)ومع أنّ المشروع كان على وشك الاكتمال، حالت الحرب العالميّة الثانية دون تحقّق هذا الأمل؛ إذ دُعي بريتسل إلى الخدمة العسكرية ولقي حتفه سنة 1941 للميلاد. وبعد نهاية الحرب جاء اشبیتالر -والذي كان مترجمًا للجيش الألماني فیما سبق - كخلَفٍ لبريتسل في مونيخ، إلّا أنّه لم يكن يرى رؤية أسلافه في مشروع القرآن، فوضع نهاية لذلك. وقال جفري في تقرير له سنة 1964 الميلادية في أورشليم: أُتلِفت مجموعة مونيخ بالقصف والنار، فيجب بدء تلك المهمّة الضّخمة من الصفر (Reynolds, 2008, pp. 5 -6). فظنّ المستشرقون أنّ مجموعة صور المصاحف المخطوطة لم يبقَ منها شيء، كما اقترح بوين دراسة المخطوطات المستكشفة من جامع صنعاء كبديل لتلك المجموعة المدمَّرة (Puin, 1996, p. 107).
لكنّ الحقيقة هي أنّ المجموعة المذكورة كانت قد أنقِذت من الحرب، واشبیتالر -الذي كان يخبّئ ذلك الكنز الثمين ويتولى أمره بنفسه في هذه المدة الطويلة- لم يكن صادقًا في دعواه بأنّ مواصلة المشروع أصبحت مستحيلةً بالكامل. فقد أعطى هو تلك المجموعة لتلميذته نويورث قبل وفاته (Higgins, 2008)، وهي -أي صور المخطوطات القرآنيّة- اليوم في خدمة مشروع ضخم يسمى بـ«كوربوس كورانيكوم» (Bennett, 2013, p. 298)، وسيأتي الحديث عنه لاحقًا.
أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أثار استكشاف مجموعة ضخمة من المخطوطات القرآنيّة المبكرة في العاصمة اليمنيّة ضجّةً في الإعلام، فبعد هطول أمطار غزيرة في سنة 1965 باليمن -والذي أدّى إلى هدم سقف جامع صنعاء- اكتشف العمالُ لدى ترميمه خزانة تضم مخطوطات من المصاحف القديمة والكتب البالية، فألقوها بأمر من وزير الأوقاف في أكياس الحبوب، ووضعوها في مكتبة الأوقاف. ثم في سنة 1972 عندما أصبح جداره الغربي على وشك الانهيار،
(33)قرّرت وزارة الأوقاف اليمنيّة بهدم الجدار وبنائه مرة أخرى. وإبّان ذلك عُثر على كميات كبيرة من المخطوطات القرآنية المبكرة، فألقوها في الأكياس ولتنتقل إلى المتحف الوطني، ومن ثم إلى المكتبة الغربية المتاخمة للجامع، وهي اليوم يُحتفظ بها في «دار المخطوطات» المخصّصة لها. وإدراكًا لأهميّة هذه المصاحف القيّمة، طلب القاضي إسماعيل بن علي الأكوع -الرئيس السابق للهيئة العامة للآثار ودور الكتب- الدعم من الخبراء الأجانب لصيانة هذه المخطوطات وترميمها وفهرستها (شاكر، ٢٠٢٠، ص365 -368).
فعندما فتحت اليمن أبوابها على المستشرقين، انطلق مشروع لدراسة المخطوطات القرآنيّة منذ سنة 1980 الميلادية بالمساندة المالية للقسم الثقافي بالخارجية الألمانية، واستمر حتى سنة 1989 للميلاد، وساهم في ذلك: ألبرشت نوث (من جامعة هامبورغ) وجِرد بوين وهانس بُتمِر (كلاهما من جامعة زارلند) وأوزولا ترايبهُلتس (مرممة الوثائق النمساوية). ومع أنّ صور الميكروفيلم التي صوّرها بوين وبتمر من قطَع المخطوطات بقيت بعيدًا عن متناول أيدي الباحثين، نشرت إليزابيت بوين (زوجة جرد بوين) النص الباطني لعدد طفيف من الطروس (Sadeghi & Goudarzi, 2012, pp. 10 -12) في مقالات بعنوان «طرس قرآني مبكر من صنعاء».
(34)يوجد مجموعة من المستشرقين المعاصرين ممّن اهتمّ بدراسة مخطوطات صنعاء القرآنيّة، كالمستشرق الإيطالي سِرجو نويا نوسِدا، وهو الذي أسّس مؤسّسة للدراسات العربيّة والإسلاميّة سنة 1999 للميلاد (Rezvan, 2008, p. 72)، وأطلق مشروعًا بعنوان «مصادر النقل المكتوب للنص القرآني» لنشر أهمّ المخطوطات القرآنيّة المبكرة. وبعد أن نشرَ المجلد الثاني من دراساته، غيّر عنوانه إلى «المصاحف المبكرة: عصر الرسول صلىاللهعليهوآله والخلفاء الراشدين والأمويين»، وواصله وحيدا. كذلك بدأ مشروعًا يركّز على القطَع المبعثرة في المكتبات -مثل فاتيكان، ولايدن، وفيلادفيا، والقاهرة و...- غير أنّ نوسدا لقي حتفه في حادث سير لمّا كان المشروع في لمساته الأخيرة، فاشتغل كيث اسمال لأجل إنهائه. وكان نوسدا أيضًا بصدد نشْر المخطوطات البرديّة، إلّا أنّ عمله بقي غيرَ مكتمل، كما كان مُكبًّا على دراسة مخطوط صنعاء، وواصل هذه الدراسةَ كريستين روبين بعد وفاته، وهي مستمرّة اليوم بالتعاون مع مشروع «كوربوس كورانيكوم» (Rezvan, 2020, p. 267).
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى المستشرق الفرنسي فرانسوا ديروش، زميل نوسدا، والذي شاركه في إنجاز مشروع «مصادر النقل المكتوبـ« المذكور آنفًا، وهو أستاذ كلية دو فرانس ومتخصّص في علم المخطوطات والكتابات القديمة، ويترأس حاليًا
(35)كرسي «تاريخ القرآن: النص والنقل»، وله مؤلّفات كثيرة تتمحور حول دراسة المخطوطات القرآنيّة، مثل: «التقليد العباسي: المصاحف من القرن الثامن إلى العاشر [الهجري]»، و«النقل المكتوب للقرآن في عهود الإسلام الأولى»، و«المصاحف الأموية: نظرة عامة». وهناك عددٌ آخر من المستشرقين ممن عكف على دراسة مخطوطات القرآن، ولكن نكتفي بذكر هؤلاء.
وفي هذا الصّدد، تجدر الإشارة إلى مشروع ذاع صيته في هذا المجال، ألا وهو مشروع «كوربوس كورانيكوم»، ويترجم في العربية بـ«المدونة القرآنيّة» أو «الذخائر القرآنيّة»، وهو -كما تقدّم سابقًا- استمرار لمشروع برغشترسر وجفري وبریتسل للتوصّل إلى طبعةٍ نقديّةٍ للقرآن الكريم. وقد انطلق هذا المشروع منذ سنة 2007 الميلاديّة برعاية أكاديميّة برلين -برندبورغ للعلوم، ويتمتّع بتمويل يمتدّ حتى سنة 2025 للميلاد. تُشرف أنجليكا نويفرث -وهي أستاذة بجامعة برلين الحرة- على المشروع، ويديره تلميذُها ميشائيل ماركس. وقد تلقّى المشروع ردودَ فعلٍ بين التأييد والانتقاد من قبَل المسلمين والمستشرقين، مما دفع القائمين به إلى جولات في البلدان الإسلاميّة بصدد تبيين غاياته، وأنّه لا يطمح أصلًا إلى إخراج نسخة جديدة للقرآن، بل هدفه المنشود هو توثيق النّصّ القرآنيّ من خلال مخطوطاته وقراءاته، علاوة على تقديم تفسير يجعل القرآن في محيطه التاريخي (رشواني، ٢٠٢٠، ص73 -74).
بناء على ذلك، يتألّف مشروع كوربوس من أربعة أقسام، وهي: دراسة المخطوطات
(36)القرآنيّة القديمة، واختلاف القراءات، والوثائق المرتبطة بمحيط القرآن التاريخي، والشرح التاريخي التحليلي للقرآن (آقایی، ١٣٩٤، ص15). أما الجانب الذي يرتبط بهذا الكتاب، فهو يقوم على استقراء شامل للمخطوطات القرآنية القديمة، وما ورد من القراءات في التراث الإسلامي، ومن ثم عرض نتائجهما على المصادر الشفاهيّة والكتابيّة، وليكون أساسًا للنقد النصّي الذي يحتاج إليه البحثُ القرآني، وهذا مقدّمة لإعداد الأداة النقديّة لمصحف حفص عن عاصم، المعترف به عند جمهور المسلمين، دون إخراج طبعة نقديّة للقرآن، إذ الشواهد المتوفّرة لحدّ الآن على انتماء القراءات إلى نصّه الأصلي لا تصلح لذلك أبدًا (رشواني، ٢٠٢٠، ص75). ومن الميزات المتفوّقة لهذا المشروع هو نشر نتائجه بالكامل على موقع الويب المختص به، فضلًا عن رقمنة الصور التي التقطها برغشترسر طوال رحلاته في عشرينيات القرن العشرين من المخطوطات القرآنيّة التي قد ضاعت بعضها في الوقت الحالي، عندما عثر عليها أعضاءٌ من المشروع عام 2008 للميلاد (Schnöpf, 2012, pp. 362 -363).
ونكتفي بهذا المقدار من عرض اهتمام الاستشراق المعاصر بدراسة المخطوطات القرآنيّة، ما يدلّ على أهمّيتها البالغة لديهم ومكانتها الرفيعة بين الأبحاث الأكاديمية الغربية حول القرآن الكريم وتاريخه. ولا يمكن تأييد كلّ ما توصّلَ إليه هؤلاء العلماء، كما لا يمكن رفض نتائج دراساتهم كليًّا، بل كلّ منها يحتاج إلى دراسة نقديّة خاصّة تتناول مناهج مؤلفيها ومدى دقّتهم وحِيادهم في تطبيق تلك المناهج والوصول إلى الحقائق.
(37)فيما يلي فهرس بيبليوغرافي لجملة من أهم الآثار التي ألّفها المستشرقون في مجال دراسة المخطوطات القرآنيّة، رُتّب ترتيبًا زمنيًّا من الماضي -أي منذ القرن العشرين- إلى الحاضر:
تمهيد
نقدّم في هذا الفصل نبذةً عن حياة بروبيكر العلميّة أوّلًا، ثم يقع التطرّق إلى ملخّص عمّا ورد في كتابه الذي نطمح إلى دراسته النقديّة «تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة» مع حفظ الأمانة العلميّة. ومن ثمّ نعرض لبعض الدراسات التي كُتبت لأجل الردّ على دعاوى بروبيكر. وبناء عليه، يتوزّع هذا الفصل على ثلاثة مباحث.
(46)دانيل آلِن بروبيكر -كما يعرّف نفسَه في موقع الويب الخاص به- مستشرق وناقد نصيّ للمخطوطات القرآنيّة القديمة، التي تعود إلى حقبة تمتدّ من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلاديين. ناقش أطروحة دكتوراه بعنوان “التغييرات المتعمّدة في مخطوطات القرآن” عام 2014 للميلاد في جامعة رايس الأمريكية، ومنذ ذلك يستمر في البحث عن التصحيحات الواردة في المصاحف القديمة، فقد قام إلى الآن بدراسة ما يقارب عشرة آلاف ورقة من المخطوطات القرآنيّة المحفوظة في مختلف مكتبات العالَم. والجدير بالذكر أنّه عضوٌ لجمعيّة المخطوط الإسلامي، والجمعيّة الدوليّة للدراسات القرآنيّة، وجمعيّة دراسة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومجلس التحرير لاستعراض البحث القرآني، والجمعية الوطنية للباحثين.
أمّا بالنسبة إلى مؤلّفاته، فقد عثرنا بعد الاستقصاء على كتاب واحد -كما صرّح هو نفسه في موقعه بأنّ هذا الكتاب الذي نعالجه في هذه الدراسة هو أوّل كتاب منشور له- وله مقالات عدّة، معظمها قصيرة لا تتجاوز صفحات قليلة، وإليكم فهرس لآثار المؤلف:
. مقال بعنوان «مخالفة القوانين»، منشور في «الأشياء الأولى: جريدة شهرية للدين والحياة العامة»، سنة 2012 الميلادية، وفيه يناقش بروبيكر دعوى فيشر تجاه تفشي الشريعة في الولايات المتحدة ومعارضتها للدستور الأمريكي.
(47). مقال بعنوان «تصحيحاتٌ تشمل كلمة الرزق في المصاحف المبكرة»، قدّمه في مؤتمر الجمعية الدولية للدراسات القرآنية، سنة 2016 الميلادية، وفيه يشير إلى ما يسميه بالتصحيحات التي ترتبط بكلمة الرزق ومشتقاتها.
. مقال بعنوان «خالد بن الوليد»، منشور في المجلد الثاني من «موسوعة الحرب والديانة»، سنة 2017، وفيه يذكر ترجمة موجزة له، مؤكّدًا على جانبه العسكري.
. مقال بعنوان «ذكرى كيث اسمال»، منشور في «المخطوطات الشرقية: المجلة الدولية لدراسة المخطوطات الشرقية»، سنة 2018 للميلاد، ويماثله مقال آخر بعنوان «في ذكرى كيث اسمال»، منشور في المجلد الخامس من كتاب «تكون ديانة عالمية: القرآن كأداة للحكومة»، سنة 2020 الميلاديّة، وسيأتي الحديث عن علاقة بروبيكر باسمال عما قريب.
. مقالات عدّة منشورة في «موسوعة الدين والسياسة المعاصرة»، سنة 2019 الميلادية، مثل «حقوق الإنسان» و«المِلكية» و«الحرية الدينية» و«الحديث والضمير» و«الاتجاهات الإرهابية» و«الإسلام في إفريقيا» و«قانون الشريعة» و«الإسلام في أستراليا» و«حماس» و«الإسلام السني».
. مقال بعنوان «مخطوطات القرآن» ومقال آخر بعنوان «مكانة الميزان
(48)في التقدير»، منشوران في كتاب «القرآن مع شرح مسيحي»، سنة 2020 الميلادية.
إضافة إلى ذلك، بروبيكر هو من المؤسّسين لموقع «المدخل إلى القرآن»، وهو موقع الكترونيّ يتيح للمستخدم إمكانيات كثيرة متنوّعة للبحث في النصّ القرآنيّ الشريف، مثل مفرداته وجذورها وجملة من مخطوطاته، فضلًا عن الإحصائيات والرسوم والجداول للسور والآيات، إلى جانب تحليل لفواصلها وكلماتها. وما يلفت الأنظار هو فهرس مطوّل للتغييرات الواردة في المخطوطات القرآنيّة، يتكوّن ممّا يقارب 1200 صورة مزودَّةً بمعلومات السورة والآية اللتين ورد فيهما التغيير المزعوم.
وجدير بالذكر أنّ الهدف من تأسيس هذا الموقع -كما ورد في الموقع- هو تقديم أدوات حاسوبيّة رائعة للدراسات النقديّة للقرآن، كما توجد نظائرها لدراسات العهدين منذ سنين؛ فعندما اجتمع في عام 2014 للميلاد عدد من المستشرقين -منهم كيث اسمال واندرو بنستر ونيك چاترات- يتجاذبون أطراف الحديث عن الحاجة إلى ما أشير إليه سابقًا، واتّفقوا على إنشائه بعد حصولهم على تمويل لذلك. ثم التحق بهم بروبيكر، وبنفقة من هذا المشروع استطاع الرحلةَ إلى مكتبات العالم وتصوير مخطوطاتها القرآنيّة بغية الاستفادة منها في جزء من المشروع. في أواخر سنة 2016 الميلادية تم تدشين الموقع، وأصبح بروبيكر موظّفًا يترأس هذه الشركة الناشئة، إلّا أنّه غادر المشروع بعد سنتين حتى تسنح له فرصة أكثر لاستكمال دراساته.
(49)وعلى أيّ حال، كما يتّضح من مؤلّفات بروبيكر بجلاء، ليس هو حبرًا أو عالمًا كبيرًا في مجال دراسة المخطوطات القرآنيّة، فقد برز اهتمامه بهذا الحقل بعد أن التقى بكيث اسمال في مؤتمر أقامته جامعة أكسفورد سنة 2007 الميلادية، وهو الذي حثّه على دراسة المخطوطات القرآنيّة والتصحيحات الواردة فيها؛ إذ كان بروبيكر بصدد كتابة أطروحة دكتوراه حول النقد النصيّ للقرآن الكريم، فقرّر أن يجول في مكتبات العالم بحثًا عمّا نصحه به اسمال (Brubaker, 2019, pp. xxii -xxiii). ويبدو مما تقدّم، أنّ اسمال هو من دعا بروبيكر إلى الانضمام إلى المشروع المذكور آنفًا، وتحت إشرافه قويَ بروبيكر على المساهمة في ذلك، وتأليف أول كتاب له في هذا المجال.
ورغم أنّ بروبيكر ليس محنّكًا في دراسة المخطوطات القرآنيّة، ولكن كتابه هذا حظي بمكانةٍ مرموقةٍ لدى المستشرقين الذين كانوا يحاولون بما أوتوا من قوّة الطعنَ في الإسلام عامّة وفي النصّ القرآنيّ خاصّة، وكذلك لدى المسلمين الذين لا خبرة لهم في هذا المجال، فقد صار كتابه الأكثر مبيعًا كوثيقةٍ يستند إليها المبشّرون المسيحيون وغيرهم على الشبكة العنكبوتية لإثبات حدوث التحريف في القرآن المجيد. وفيما يلي نعالج دعاوى بروبيكر بشأن نص القرآن الكريم، ومن ثم نقيّم مدى نجاحه في إثبات مزاعمه.
(50)يتكوّن كتاب «تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة» من مقدّمة وكلمة شكر، يليهما مدخل إلى دراسة المخطوطات، وبالتالي يأتي أكثر من عشرين نموذجًا عثر عليها المؤلّف بزعمه في المخطوطات القرآنيّة العائدة إلى القرون الممتدة بين القرن السابع والعاشر الميلاديين. ثم هناك فهرس للآيات القرآنيّة الواردة في الكتاب، إلى جانب قاموس صغير للمصطلحات التي استخدمها، وبينهما فصل لا يتجاوز ثلاث صفحات ينصح فيه المؤلفُ القراءَ بمراجعة دراسات أخرى حول القرآن الكريم. والكتاب صغير الحجم نسبيًّا طُبع في حوالي مئة وأربعين صفحة سنة 2019 الميلادية لأوّل مرة.
يبدأ المؤلّف كتابه بشرح ذكرياته وما حفّزه على دراسة المخطوطات القرآنيّة، عندما شارك في مؤتمر حول نقد النّصّ القرآني، وتعرّف على كيث اسمال، الذي قدّم له صورًا من المخطوطات القرآنيّة، والتي تظهر فيها تصحيحاتٌ كبيرةٌ جدًا، كما يصفها المؤلّف. فعزم المؤلّف أن يقوم بدراسة تطوّر المخطوطات القرآنيّة، ويكتب أطروحة دكتوراه في ذلك المجال؛ فسافر إلى البلدان الأوروبيّة والشرق أوسطيّة ليلقي نظرةً على المخطوطات عن كثب، وتمكّن من جمع عددٍ كبير من التصحيحات والتعديلات في المخطوطات القرآنيّة لحد الآن، كما يواصل نفس المنهج ليزيد عليها.
بعد ما يشرح المؤلّف أهميّة كتابه هذا لمن يؤمن بالإسلام ومن لا يومن به، بما فيهم الأكاديميين والأساتذة الجامعيين، ينعت كتابه بعملٍ صغير في مجال تصحيح المخطوطات القرآنيّة، ويَعدُ القارئ بكتب ودراسات تليه في المستقبل، ما يضمّ عددًا أكبر من التصحيحات، ويؤكّد على أنّه لن يعالج فحوى القرآن، بل ما يهمّه هو نقد النص القرآني، والذي يجده أمرًا مذهلًا (Brubaker, 2019, pp. xvii -xxv).
ثم يشكر بروبيكر كلّ من ساعده في إنجاز دراساته حول المخطوطات
(51)القرآنيّة، من أساتذته وزملائه ورفاقه، وفي مقدّمة كتابه ينعت المخطوطات القرآنيّةَ بأنّها مليئةٌ بالتغييرات الماديّة والتصحيحات. وبعد ذلك يشير إلى أسماء عدد من المستشرقين الذين قاموا بجمع المخطوطات القرآنيّة والاحتفاظ بها في المكتبات الغربية، فأنقذوها من التلف. وعندما ينوّه إلى كثرة المخطوطات القرآنية المبكرة مقارنةً بالعدد الضئيل للمخطوطات الإنجيليّة، يذكر سببين لذلك؛ الأوّل: المخطوطات القرآنيّة المكتوبة على الرقّ [أي الجِلد]، وهذه المادة تبقى لآلاف السنين، بينما كُتبت الأناجيل على الأوراق البرديّة، والتي تتحلّل في غضون مئة أو مئتين عام. الثاني: قامت السلطات الحاكمة من المسلمين بنشر المصحف في منطقة واسعة من مشرق الأرض إلى مغربها، واهتم المسلمون بكتابة المصاحف وزخرفتها، خلافًا لما مرّ بالأناجيل [لدى الرومان المعارضين للنصارى] (ibid., pp. 1 -3).
ثم يتحدّث بروبيكر عن طرق تأريخ المخطوطات القرآنيّة، ويشير إلى أهميّة العلم بها، قائلًا: لكان رائًعا لو كانت المصاحف برمّتها مزوّدة بما يذكر تاريخ كتابتها، كما هو الأمر الاعتيادي بالنسبة إلى المخطوطات القرآنيّة المتأخّرة. لكن المخطوطات القديمة قد يتمّ تأريخها نظرًا إلى المعلومات التي عندنا من علم الخطاطة وتطور الأقلام العربية. وقد رتّب فرانسوا ديروش تلك الخطوط على أساس تاريخ ظهورها، إلّا أنّها قد تتداخل، أي بينما كان أحد الأقلام مستخدَمًا، كان الآخر على وشك الزوال. وليست هذه المعلومات مضبوطة، كما لم يكن الكتّاب إلّا بشًرا [فلم يلتزموا بقلم معيّن في كتابة المصاحف الشريفة. إذًا لا يمكن التعويل على هذه الطريقة من تأريخ المخطوطات].
أمّا الطريق الثاني، فهو تأريخ المصاحف على أساس مواصفاتها، وهذا ما يعتني به علم المخطوطات. ووُضع هذا العلم لأجل تبيين المسائل في مجال المخطوطات،
(52)فيجيب عن الأسئلة التالية: ما هو مادة هذا المخطوط؟ هل هو أفقيّ أو عمودي؟ كم أبعاد الكتاب والصفحات؟ كم سطرًا في كل صفحة؟ كيف تم تبويب الكتاب؟ هل في الصفحات من الصور والعناصر الفنيّة؟ ما هي الألوان المستخدَمة؟ هل للكتاب هوامش؟ كيف خِيط الكتاب؟ كيف غلاف الكتاب؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ومعرفة المواصفات الأخرى توفّر إشارات إلى عمر المخطوط.
وأما الطريق الثالث، -ولربما هو أشهر الطرق- هو التأريخ بالكربون المشعّ. يمكن تطبيق هذه الطريقة على كلّ كائن عضويّ؛ يعني كلّ شيء كان حيًّا، أي النباتات أو الحيوانات. وعليه، يمكن قياس الرقّ بهذه الطريقة. والدليل على ذلك هو أنّ النظير المشعّ للكربون موجود في كلّ كائن حي، ويضمحلّ ببطء عندما يموت ذلك، بحيث يمكن تقدير نسبته. فمتى ما تعرّض الِجلد لهذا القياس يُظهر فترات زمنيّة مبنيّة على الوقت المحتمل الذي كان صاحب الجلد (الماعز أو الخروف في الأعم الأغلب) فيه حيًّا. لا شكّ أنّ التأريخ بالكربون المشع لا يدلّنا على الوقت الذي كُتب فيه على الرق، إلّا أنّنا نفترض عادة أنّه لم يبقَ لمدّة عقود قبل أن يُكتب عليه لأوّل مرة؛ ولكن التأريخ بالكربون المشع ليس طريقةً مضمونةً؛ كما وقد ثبت اختلاف نتائج هذا التأريخ عن التاريخ المدرج على بعض المخطوطات لمدّة قرن أو أكثر. إذًا، من الأفضل استخدام هذه الطرق بأسْرها للحصول على نتيجة أدق (ibid., pp. 4 -6).
ثم يحاول المؤلّف أن يُقنع القارئ بأنّ المخطوطات التي اعتمد عليها في كتابه لها أصالة ومنشأ موثوق به؛ إلّا أنّه لا يصرّح بهذا الأمر، بل ينوّه إليه عندما يقول: في النظرة الأولى إلى المخطوطات نحب أن نفترض أنّنا قادرون على تبيين جميع التفاصيل المهمّة عنها. وهناك سياق لكلّ شيء مصنوع، وله سياقات تجاوزَها ذلك الشيء حتى تمّ استكشافه، وكذلك بعد استكشافه. ورغم أنّنا عاجزون عن الرحلة في الزمن إلى اللحظة التي صُنع فيه ذلك الشيء ومكانِه، فيفيدنا أن نعرف المكان الذي اكتُشف فيه، ومن قام به، وكيف اعتُني به منذ ذلك الوقت. فإنّ المكان الذي تمّ اكتشاف المخطوط فيه قد يزوّدنا بمعلوماتٍ حول المكان الذي صُنع فيه وزمنه، ومن قام بذلك، وما مرّ به بعد صنْعه.
(53)وبعد هذه الإشارة المختصرة، يتحدّث بروبيكر عن صلب الموضوع قائلًا: معظم المخطوطات التي عالجناها في الكتاب لم يُكتشف في التنقيبات الأثرية، بل على الأرجح في المساجد والمكتبات والمجموعات الخاصّة بالأسَر، وقد تناقلت بين الأجيال حتى وصلت إلى سوق السلع المستهلكة أو تاجر الآثار، فاشتراها زبون ذو بصيرة. ولسلسلة الحضانة أهميّة لأجل أصالة المخطوط، ونحن لا نريد أن نبني دراستنا التاريخيّة على أشياء ليست أصليّة. وأنا لا أخوض في منشأ [المخطوطات] في كتابي هذا، غير أنّي معتقد أنّ التاريخ الحديث لهذه المخطوطات موثّقٌ؛ لأنّ المؤسّسات [التي تحتفظ بها] تحذّر من الأشياء التي منشأها موضع ريب أو غير ثابت. وتجدر الإشارة أخيرًا إلى أنّ المنشأ المشبوه به لا يعني أنّ ذلك الشيء غير أصليّ أو يجب ألّا يؤخذ بعين الاعتبار؛ بل سلسلة الحضانة يعزّز ذلك [يعني أصالته] (ibid., pp. 6 -8).
ثم مسألة رسم المصحف وعلاقتها بالقراءات هي إحدى المواضيع التي يلفت بروبيكر النظر إليها؛ حيث يقول: وفقًا للتقارير التقليديّة الاختلاف [في رسم المصحف] مرونة أجازها محمد صلىاللهعليهوآله ، وقد تمثّل ذلك في القراءات الشتّى. لكن الحقيقة هي أنّ الرسم يختلف عن القراءات؛ فإنّ تاريخ الاعتراف بالقراءات أكثر تقعيدًا [مما نعرف]، وحسب ما توصّل إليه شادي ناصر فإنّها تابعةٌ للقضايا العمليّة أو الواقعيّة والسياسيّة، أكثر من أن تكون تاريخيّة. وتم اختيار القراءات [السبعة] لتكون نيابة جغرافيّة في عصر ابن مجاهد، وليست هي بالضرورة مبنيّة على أقوى البراهين.
وبعد ذلك، يشير إلى صعوبة أخرى في أمر القراءات، ألا وهو أنّ بعض المخطوطات القرآنيّة القديمة -مثل مصحف طوب قابي وإسطنبول والقاهرة- لا تعكس قراءة واحدة، بل مزيجًا من القراءات. ومن ثم يقول بروبيكر: إنّ كثيرًا من آلاف التصحيحات التي وثّقتُها لا يمتّ إلى القراءات المذكورة في المصادر
(54)الثانويّة بصلة. إذًا هذه التصحيحات تمثّل -في بعض الحالات على أقل التقدير- درجة أكبر من المرونة في النصّ القرآني للقرون المبكرة مما تمّ توثيقه في أدب القراءات (ibid., pp. 8 -9).
ثم يلقي بروبيكر نظرةً عامّةً على التصحيحات التي عثر عليها، ويقسّمها إلى ستة أقسام، كما يقدّر حجم كلّ منها على النحو التالي:
1- الحذف وإعادة الكتابة: 30 بالمئة تقريبًا
2- إعادة الكتابة بلا حذف: 18 بالمئة تقريبًا
3- الزيادة: 24 بالمئة تقريبًا
4- الحذف البسيط: 10 بالمئة تقريبًا
5- إعادة الكتابة المغطّية: 2 بالمئة تقريبًا
6- التغطية: 16 بالمئة تقريبًا
وعند ذلك يشير إلى نقطة يرى لها أهميّةً خاصّة قائلًا: لقد وجدت في معظم الأحيان أنّ التصحيحات في المخطوط القرآني تنتج عن التطابق بين المخطوط وبين رسم المعيار الجديد أي مصحف القاهرة 1924م، وهذا ما يُظهر حراكًا عامًا على مرّ التاريخ نحو التطابق (ibid., pp. 9 -11).
وبعد ذكر جملة من أسماء المكتبات العالميّة التي تحتفظ بالمخطوطات القرآنيّة، يقدّم المؤلف تاريخًا مختصرًا جدًا عن حياة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله ، والخلاف المستشري في فحوى القرآن، ومحاولة عثمان لتوحيد المصاحف، فضلًا عن التنويه إلى الفتوحات الإسلاميّة، وظهور الدولتين الأمويّة والعباسيّة وسقوطهما (ibid., pp. 11 -14).
ثم يطرح بروبيكر قضايا قرآنيّة عدّة يراها عويصة، ويبدأها بالإشارة إلى وجود
(55)المفردات الغامضة في القرآن الكريم، ونظرية ديفين استورات حول المفردات التي تعارض القوافي [يعني فواصل الآيات]، وهي مبنيّةٌ على أنّ الجيل اللّاحق أخطأ في نقط القرآن ورسمه؛ لأنّه كان في حرمان من الموروث الشفهي. وعلى أساس هذه النظريّة يحتمل بروبيكر أن تكون أخطاء أخرى أيضًا في رسم المصحف؛ كما أنّ هناك مفردات صعبة للمفسرين، فلا يُستبعد أن يُقرأ الرسم بشكلٍ يبدو مفهومًا، ولكنّه يختلف عن القراءة الموروثة.
ومن ثم يحاول إثارةَ شبهات حول المعتقدات الإسلاميّة، فيذكر أسئلة عدّة طرحها المستشرقون في السنوات الأخيرة، ويقول:
1- يبدو أنّ طبوغرافيا مكّة وميزاتها تختلف عن نعوت القرآن. فعلى سبيل المثال، تلاحظ باتريكا كرون أنّ التفاصيل الزراعيّة الواردة في سورة يس والواقعة من النخيل والأعناب وكذلك العيون المتدفّقة لا تمتّ إلى الواقع في مكة بصلة.
2- يبدو أنّ الدّراسات الأثريّة عن مكة لا تؤيّد البيان التقليدي من أنّ المكان الذي ترعرع فيه محمد صلىاللهعليهوآله قد شهد كثيرًا من الحضارات السالفة ظهورها وسقوطها.
3- السمات اللغويّة للقرآن في رؤية بعض علماء اللسانيات تثير أسئلةً حول مكان نشأته.
4- لقد لاحظ أحد الباحثين الجدد، دان جيبسون، أنّ القبلة في الأبنية المتبقّية من جميع المساجد القديمة قبل سنة 706م. [يعني 87ه.] لا تتّجه نحو مكة بالمرة، بل على الأرجح نحو الشمال. وبينما القبلة تتّجه نحو الجنوب من اتّجاهها الرئيسي بعد سنة 706م.، لكنّها لا تزال تتّجه نحو شمالي مكة. وأوّل قبلة تتّجه نحو مكة [يعني الكعبة المشرفة] يعود تاريخها إلى سنة 727 م [يعني 109ه.]. في الحقيقة تمّ توثيق بعض مسارات تطوّر اتّجاه القبلة في مصادر ذلك الزمن، وهي تظهر
أنّها كانت في البداية نحو الشرق؛ غير أنّ هذه المصادر تختلف عن أخرى تقول: إنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله حدّد القبلة أولًا نحو أورشليم، ومن ثم إلى مكة في فترة معيّنة من حياته.
ويستنتج بروبيكر من هذه الملاحظة أنّ الخلاف الجليّ بين سيرة محمد صلىاللهعليهوآله -الذي ألّفها ابن إسحاق وعدّلها ابن هشام- وبين ما يُرى من أبنية المساجد يسلّط الضوء على قضيّة أكبر وأشهر، ألا وهي مصداقيّة المصادر الثانويّة الموجودة، مثل التواريخ والجوامع الحديثيّة والسيَر وما إلى ذلك. هناك مصادر عربيّة كثيرة من القرنين الثامن والتاسع الميلاديين لمعرفة ما وقع في القرن الأول الهجري؛ ولكن في وثائقها تناقضات قد يتعذّر تحديد الجانب الصحيح في التقارير المتضاربة.
5- تدعم المخطوطات بعض الجوانب للحكاية التقليدية، كالفترة الزمنيّة التقريبيّة التي كُتب فيها القرآن (فعلى سبيل المثال هناك عدد من المخطوطات القرآنيّة يعود تاريخها إلى منتصف القرن السابع الميلادي)، وهذا يؤيّد عادةً وجودَ القراءات الشتى التي تم توثيقها في المصادر الثانويّة في القرون اللّاحقة. ولكن الميزات الأخرى تُظهر لغزًا يفتقر إلى الحلّ:
أوّلًا، إنّ كثيرًا من المخطوطات لا تتّبع قراءةً واحدةً، بل على الأرجح يبدو أنّها تتناقل بين القراءات، دون أيّ نمط واضح. وهذه ليست مشكلة، إلّا أنّها تثير هذا التساؤل: ما هي مكانة القراءات في زمن كتابة هذه المخطوطات؟
ثانيًا، هناك بعض الرقوق التي غُسلت أو أزيلت منها المحتويات القرآنيّة بشكل آخر، ثم كُتب عليها ثانيةً. وهذه -والتي تُسمى بالطِرس- هي أكثر التصحيحات انتشارًا التي وصلت إلينا. وفي كثير من الأحيان يمكن قراءة الذي كان مكتوبًا لأوّل مرّة، إمّا بالعين المجرّدة وإمّا باستخدام التقنية. ثم يقول بروبيكر إنّه لن يركّز على هذه [المخطوطات] لأنّ علماءً آخرين تناولوها في أبحاثهم.
ثالثًا، نظرًا إلى التقارير التقليديّة عن الخليفة الثالث، عثمان، وما عمل لتوحيد المصاحف -من منع [القراءات] المختلفة بحرقها أو طرق أخرى، وإنتاج نسخ رسميّة [للقرآن]- يكون غريبًا أن ليست هناك أيّة نسخة من تلك النسخ المعترف بها في العصر الراهن، وما ادُّعي أنّها منها يبدو هي مصنوعة بعد عثمان بزمن طويل، وبما أنّ لهذه الوثائق أهميّة كبيرة، فكان من المتوقّع أن يُحتفظ بها.
رابعًا، وجود المخطوطات التي كُتبت بشكل ممتاز ثم صُحّحت بعد فترةٍ طويلةٍ من الزمن أمرٌ مذهلٌ، وهو يتحدّى القول بأنّه كان اتّساقًا صارمًا واتّفاقًا شائعًا على كلّ مفردة وحرف [من القرآن]. ويعِد المؤلف أن يتحدّث عن هذا الموضوع لاحقًا في فصل "الاستنتاج" (ibid., pp. 15 -19).
ثم في نهاية هذه المقدّمة الطويلة يتطرّق بروبيكر إلى الأسباب التي أدّت إلى تصحيح المخطوطات، ويعتقد أنّها تختلف حسب الزمان، والمكان، وأدوات الكتابة، والأصل [المنسوخ منه]، والعالِم، والكاتب، وغير ذلك من الأمور. وبينما يؤكّد على الحالة التي ينتبه فيها كاتب النسخة إلى خطئه في الكتابة، فيباشر تصحيحه على الفور، يرى أنّ هناك حالات أخرى لا توافق تلك الفكرة حول تصحيح المخطوطات، وبالتالي يطرح عدّة تساؤلات قائلًا:
. هل هناك سببٌ واضحٌ لارتكاب خطأ بسيط؟ أحد الأسباب العامّة لارتكاب الخطأ في نَسخ المخطوط هو تكرار الكلمة أو تعاقب الكلمات المتقاربة بعضها من بعض.
. هل كانت فترة طويلة من الزمن بين الكتابة وتصحيح المخطوط؟ ومن الممكن استمرار هذا التّساؤل بطرح الأسئلة التالية:
1. هل يبدو أنّ أدوات الكتابة المستخدمة في التصحيح كانت تماثل التي اُستخدمت في صنعها؟
2. هل يختلف أسلوب الكتابة على ما كان سابقًا؟
(58)3. هل هناك فارق في قواعد الكتابة بين ما كُتب لأوّل مرة وبين ما تمّ تصحيحه؟
4. هل هناك علامات على الورقة تدلّ على التصحيح أكثر من مرة في أوقات مختلفة؟
5. ما هو أثرُ التصحيح؟ هل يمكننا العثور على ما كان مكتوبًا للمرة الأولى؟
6. ما هي نتيجة التصحيح؟ هل الرسم المصحَّح يلائم الرسم المعيار في يومنا هذا؟ هل قواعد الكتابة فيه [أي المخطوط المصحَّح] تحاذي المخطوطات الأخرى من نفس الفترة الزمنيّة؟ أو هل تحاذي إحدى القراءات الشتى المعترف بها؟
7. إن كانت الورقة مصحَّحة فكيف يَظهر ما بقي منها؟ هناك أجزاء منها لا توافق الرسم المعيار الراهن؟ وعلامَ يدلّ ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي تمّ التصحيح فيه أو من قام به؟
يعالج بروبيكر في الفصل الثاني من كتابه -وهو الفصل الرئيسي منه- أكثر من عشرين نموذجًا من التصحيحات التي عثر عليها في المخطوطات القرآنيّة، من مختلف الأقسام الستة المذكورة في المقدّمة (أي الحذف والزيادة وغيرهما). وقد اختار -كما يقول هو- مخطوطات تمثّل أساليب شتّى للكتابة، من المخطوطات العائدة إلى القرون المبكرة (يعني القرن السابع إلى التاسع الميلادي)
(ibid., p. 27). ثم يقارن هذه التصحيحات برسم مصحف القاهرة 1924
وليبيّن الفروق بينهما. ولن نأتي بصور مصحف القاهرة 1924 في هذه الخلاصة؛ لأنّ المصحف الشريف متداول اليوم لدى المسلمين وغيرهم، ولا صعوبة في الرجوع إليه؛ بل نكتفي بصورة من هذا المصحف -وقد تقدّم فيما سبق أنّه معروف بالمصحف الأميري- وصورة من مصحف المدينة، والذي تمّ إعداده على أساس المصحف الأميري، وهو الأكثر تداولًا عند الناس في العصر الراهن.
ما من المؤسف أنّ بروبيكر لم يرتّب النماذج التي يذكرها على أيّ أساس منطقيّ، لا من حيث التاريخ، ولا من حيث نوع التصحيح، ولا من حيث المخطوطات، وإليكم النماذج على أساس الترتيب الذي ورد في الكتاب:
النموذج الأوّل: زيادة كلمةٍ في مصحف عتيق يعود إلى القرن الثامن الميلادي
صورة 2: المصحف الشريف في طوب قابي، ورقة 122ظ، [السطر الثالث]
يصف بروبيكر هذا المصحف قائلًا: تقع هذه الزيادة في مصحف طوب قابي، وهو مصحف في 408 صفحات على الورق الرقي، وهو من أقدم المصاحف الكاملة (فُقدت منها ورقتان، ويبدو أنّ الأوراق الأخرى تم تعويضها في وقت مبكر). وقد أُرسل إلى سلطان محمود الثاني كهديّة من [محمد] علي باشا في سنة 1811م، وتمّ الاحتفاظ بها في متحف طوب قابي سرايي منذ وصوله إليه. وقد نُسب هذا المصحف إلى عثمان، وحاله كحال كثير من المصاحف المشهورة المنسوبة، يعني أنّ النسبة خاطئة؛ لأنّه من المحتمل أن يعود إلى قرن بعده، أي منتصف القرن الثامن الميلادي. كما يؤيّد ذلك إحسان أوغلي، المدير العام المؤسّس لإرسيكا والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي [في مقدمة النسخة المطبوعة من هذا المصحف الشريف].
ثم يتناول المؤلّف نموذجًا واحدًا من 25 تصحيحًا وجدها في هذا المصحف الشريف، ألا وهو زيادة لفظة “هو” في الصورة 2، في سورة التوبة الآية 72: (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) . يرى بروبيكر أنّ هذه الزيادة لا تؤثّر على المعنى، بل تجعل المخطوط موافقًا للرسم المعيار الراهن فقط. فضلًا عنه، أجري هذا التصحيح على يد شخص آخر، وبقلم آخر، وبأسلوب آخر، بعد فترة من صنع المخطوط (ibid., pp. 28 -30).
النموذج الثاني: الحذف وإعادة الكتابة في مصحف يعود إلى القرن الأول الهجري أو السابع الميلادي
صورة 3: BnF arabe 328، ورقة 58ظ، [بداية السطر الثاني]
هذه الورقة جزءٌ من مصحف باريسينو-بتروبوليتانوس، والذي يُحتفظ به اليوم في [المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة] والمكتبة الوطنيّة الروسيّة في سانت بطرسبورغ، ومكتبة فاتيكان، ومجموعة ناصر خليلي للفنّ الإسلامي في لندن. ويحدّد فرانسوا ديروش تاريخه بالربع الثالث للقرن السابع الميلادي، أي ما بين سنة 671 و695م على وجه التحديد. وكذلك الدكتور «آلتي قولاج» يحدّد تاريخه بالقرن السابع
(62)الميلادي، غير أنّه يرى المصحف ليس من مصاحف عثمان، بل على الأرجح أنّه منسوخ من مصحف أرسله إلى دمشق، أو مما نُسخ منه.
ثم بالنّسبة إلى الصورة 3 يعتقد بروبيكر أنّ فيه حذفًا وكتابة شيءٍ آخر مكانه. ويرى أنّ الحذف يجري عادة بمسح الحبر باستخدام حجر الخفاف، وهذا العمل يترك خربشةً على الجلد. ويقول عن هذا التصحيح: آثار الحذف واضحة في هذه البقعة، وتمّ التغيير على يد شخص آخر، وبقلم آخر، وبأسلوب آخر يختلف عن باقي الورقة. حرف اللام أكثر عموديًا من الاتجاه العام المائل إلى اليمين في الورقة، وخصوصًا اللام المحذوفة. وقد وقع هذا التصحيح في سورة الشورى الآية 21: (... شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) . ويبدو أنّ اللفظة المحذوفة هي: «له»، وقد أُبدل منها بـ«لهم»، وهكذا أصبح يوافق رسم مصحف قاهرة 1924
(ibid., pp. 31 -33).
النموذج الثالث: زيادات عدّة للفظة «الله» في المصاحف العائدة إلى القرنين الأوّل والثاني الهجريين أو السابع والثامن الميلاديين
صورة 4: عدة مصاحف مخطوطة
(63)وقعت هذه التصحيحات التسعة -كما يقول بروبيكر- في ثلاثة مصاحف؛ سبعة في مصحف الفسطاط الأموي، وواحد في مصحف من صنعاء، ومصحف آخر لم يعرّفه المؤلّف. ويعرِب عن استغرابه كيف نسي الكاتب كتابةَ لفظة «الله»، ولا يصدّق أنّها نُسيت حقيقةً؛ ففي معظم هذه النماذج ليس وجودها ضروريًّا من المنظور النحوي. لذلك يرى تكرار نفس التصحيح في حالات عدّة دليلًا على درجة معيّنة من المرونة في المخطوطات، وربما يعكس الطبيعةَ الشفهيّة لنشر [القراءات]، والذي اتّجه فيما بعد نحو الاتّساق.
وقبل أن يذكر الآيات التي وقع -بزعمه- فيها التصحيح، يقدّم خلاصة عن مصحف الفسطاط الأموي قائلًا: هذه من المصاحف التي تفرّقت وأجزاؤها في مكتبات مختلفة، وسمّاها ديروش بهذا الاسم، ويحتمل أن يكون مصحفًا أرسله الحجاج إلى جامع عمرو [بن العاص]، أو ما فعله عبد العزيز بن مروان ردًّا على ذلك العمل. على أيّ حال، كان محفوظًا في جامع عمرو حتى القرن الثامن عشر الميلادي، عندما اشترى بعض أجزائه رجل فرنسي، وذهب به إلى أوروبا. ويُحتفظ اليوم بأجزاء هذا المخطوط في روسيا وفرنسا وغيرهما. ثم يذكر بروبيكر ما عثر عليه من زيادة لفظة «الله» الشريفة في هذا المخطوط وآخرَين غيرهما على النحو التالي، والترتيب من أعلى يسار الصورة إلى أسفل يمينها:
1- NLR Marcel 11، ورقة 7ظ، في سورة الأحزاب الآية 18: (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ) ، [الصورة بالأعلى اليسار في السطر الثاني]. يقول بروبيكر: إنّ لفظتين [يعلم] و[الله] كانت محذوفة فكُتبت ثانية.
2- NLR Marcel 11، ورقة 8و، في سورة الأحزاب الآية 24: (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) ، [الصورة بالأعلى الوسط في السطر الثاني].
3- NLR Marcel 11، ورقة 10ظ، في سورة الأحزاب الآية 73: (وَيَتُوبَ اللَّهُ
(64)عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) ، [الصورة بالأعلى اليمين في السطر الثاني].
4- NLR Marcel 11، ورقة 12ظ، في سورة فصلت الآية 21: (قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) ، [الصورة الوسطى يسارًا فوقَ السطر].
5- NLR Marcel 13، ورقة 20ظ، في سورة الحج الآية 40: (يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) ، [الصورة الوسطى في السطر الثاني].
6- NLR Marcel 13، ورقة 23و، في سورة النور الآية 51: (دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، [الصورة الوسطى اليمين في السطر الثاني]. يقول بروبيكر: قبل هذه الزيادة كانت القراءة غير ممكنة.
7- NLR Marcel 13، ورقة 26و، في سورة فاطر الآية 11: (إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) ، [الصورة بالأسفل اليسار في السطر الثاني]. يقول بروبيكر: ليس واضحا كيف كانت القراءة قبل هذه الزيادة مفهومة؟
8- NLR Marcel 21، ورقة 4ظ، سطر 11، في سورة التوبة الآية 93: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) ، [الصورة بالأسفل الوسط في السطر الثاني]. يصف بروبيكر هذا المخطوط ويقدر تاريخه بأوائل القرن الثامن الميلادي.
9- UNESCO CD of Sanʿāʾ Qurʾāns، رقم 01 -20. 4، سورة التوبة الآية 78: (وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ، [الصورة بالأسفل اليمين في السطر الثالث]. يقول بروبيكر إنّه لم ينظر إلى هذا المخطوط عن كثب، ولكنه يقدّر أن يعود إلى أوائل القرن السابع أو أواخر القرن الثامن للميلاد.
وبعد ذكر هذه التصحيحات التسعة يقول بروبيكر: إنّها ثلاثة أرباع مما عثرتُ عليها لحد الآن من زيادة بسيطة للفظة [الله] (ibid., pp. 34 -44).
(65)النموذج الرابع: الحذف
صورة 5: حذف في Marcel 2، آخِر سطر من ورقة 30ظ، [نهاية السطر الثاني]
يقدّم بروبيكر معلومات عن هذا المصحف الشريف الذي يُحتفظ به في المكتبة الوطنيّة الروسيّة، ويقدّر تاريخه بأوائل القرن الثامن للميلاد، ويدّعي أنّه عثر على 26 تصحيحًا وقعت في هذا المخطوط. فيشير إلى أحدها قائلًا: التصحيح هنا هو حذف بسيط، ولم يعوَّض بشيء آخر. هناك فراغ في نهاية السطر الأخير من هذه الصفحة، وقبل هذا الفراغ كلمة «عقبة»، وتليها في مصحف القاهرة 1924كلمة «الَّذِينَ»، وهي الكلمة التي تبدأ بها الصفحة التالية من هذا المخطوط.
وبعد أن ينقل بروبيكر ترجمة من الآية التاسعة لسورة الروم: (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ، يحاول أن يكشف عن الكلمة المحذوفة، والتي تتكوّن من أربعة إلى ستة أحرف متّصلة -كما يدّعي- وتوافق القواعد النحويّة. فيخمّن أن تكون المحذوفة إحدى هذه الكلمات: كلُ مَن، كثيرٌ مِن، اليهودُ، الناسُ. ورغم أنّه لا يتأكّد من الكلمة المحذوفة في هذه الورقة، يدّعي بأنّ هناك تصحيحًا آخر في الهامش الأيسر منها، وهذا يجعل المخطوط موافقًا لرسم مصحف القاهرة 1924 (ibid., pp. 44 -46).
(66)النموذج الخامس: تصحيحات عدّة في مصحف يعود إلى القرن الثاني أو الثالث للهجرة أو الثامن أو التاسع للميلاد
صورة 6: MS.474.2003، ورقة 9ظ
هذه صورة التقطها بروبيكر من مصحف في متحف الفنّ الإسلامي بالدوحة، وقد عثر -كما يدّعي- على ثلاثين تغييرًا ماديًا في أوراقه الإثني عشر، مما يجعله مختلفًا عن مصحف القاهرة 1924. ويرى المؤلف فيه خمسة تصحيحات على أقلّ تقدير، ويصف هذه الورقة على النحو التالي:
تبدأ الورقة من وسط سورة الأنعام الآية 91 (وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ) ، ولكن فيه «وَ» بدلا من «وَلَا».
تختلف الآية 92 في هذا المخطوط عن مصحف القاهرة 1924، فالأوّل: «مبركا مصدقا»، والثاني: «مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ».
لا توجد واو قبل (وَلِتُنْذِرَ)، الأنعام: 92 في هذا المخطوط.
ما يُقرأ في مصحف القاهرة 1924 «صَلَاتِهِمْ» [الأنعام: 92]، كُتب في هذا
(67)المخطوط بالواو بدلا من الألف في وسط الكلمة؛ أي «صلاوتهم»، وهو جمع الصلاة.
. لفظة «أو» في الآية 93: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ) من مصحف القاهرة 1924، كُتبت «وَ» في هذا المخطوط.
. لفظة «إذ» في الآية 93 (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) ، كُتبت «إذا».
. لا توجد الألف الممدودة في الآية 93: «بَاسِطُو» من مصحف القاهرة 1924، في هذا المخطوط.
. هناك لفظة «ربكم» بين لفظتين «اللَّهُ» و«فَأَنَّى» في الآية 95: (ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) من هذا المخطوط؛ وبما أنّ المصحّحِين لم يحذفوا هذه اللفظة، فهل كانوا يعتقدون بصحّة وقوعها؟
وبعد ذكر هذه المواصفات، يشير بروبيكر إلى خمسة تصحيحات عثر عليها في هذه الورقة المخطوطة قائلًا:
حُذفت كلمتَين في نهاية السطر الثالث وبقي أثرهما، وهما ما بين لفظة “حَوْلَهَا وَ” ولفظة “الَّذِينَ” من الآية 92 (أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) . والنتيجة هي الموافقة بين رسم [هذا المصحف] ومصحف القاهرة 1924.
كلمة «عليه» في السطر السادس من الورقة المذكورة مكتوبةٌ على ما حُذف سابقًا من الآية 93 (بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ) ، وتأتي بعد (بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ) ، ولا تُقرأ هكذا في مصحف القاهرة 1924. وقد أجري التعديل التالي بغية إيجاد الموافقة بينه وبين هذا المخطوط.
وقع هذا التصحيح اللّاحق في الهامش الأيمن من الآية 93، حيث كُتب «على الله»، ولم يُمسح «عليه» الذي حلّ محلّه. إضافة إلى ذلك، كُتب هذا التعبير [يعني
(68)«على الله»] في بداية السطر التالي، بينما كان منويّا لتلك البقعة، أي الخط السابق الذي يبدأ بـ«عليه». وأغرب شيء يميّز هذا المخطوط عن موافقة مصحف القاهرة 1924 هو زيادة «تكفرون بالله و» بعد «بِمَا كُنْتُمْ». ويبدو بقاء هذه الكلمات بعد مرحلتين من التصحيح -رغم عدم الموافقة مع مصحف القاهرة 1924- مهمًّا.
تمّت زيادة كلمة «الذين» في السطر الثامن من الورقة المذكورة في الآية 94 (شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) ، وذلك بعد ما كانت ساقطة لأوّل مرة.
تمّت كتابة «يعلمون» على ما حُذف سابقًا في بداية السطر قبل الأخير، وهي في الآية 97 (قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). ومن المحتمل أن تكون الكلمة المحذوفة -حسب ما بقي من أثر الحذف- لفظة «يعمهون»، والتي تأتي في نهاية الآية 110 من هذه السورة (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (ibid., pp. 47 -51)!
النموذج السادس: تصحيحات عدّة في مصحف يعود إلى القرن الأول الهجري أو السابع الميلادي
صورة 7: MS.67.2007.1، متحف الفن الإسلامي بدوحة، [بين السطرين الثالث والرابع]
يقول بروبيكر: إنّ هذه القطعةتعود إلى نفس الفترة الزمنيّة وأسلوب [الكتابة] لمصحف باريسينو -بتروبوليتانوس ومصحف برمنغهام، والذي لفتت ألبا فيديلي انتباه العالَم إليه، وقدِّر تاريخ ذبح الحيوان [أي الذي كُتب على جلده مصحف برمنغهام] بما بين عامي 568 و645 للميلاد. أما من التصحيحات التي عثر عليها بروبيكر في هذا المخطوط (MS.67.2007.1) هو زيادة (وَعَمِلُوا
(69)الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا) في سورة المائدة الآية 93 (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا) . وقد أضيفت هذه الكلمات فوق السطر الأوسط من الصفحة. ويبدو أنّ الزيادة من الكاتب الرئيسي، وقام بالتصحيح بُعيد الانتهاء من الكتابة، وليس التصحيح مستغربًا لأجل [الألفاظ] المتكرّرة في هذه الآية، وهي التي جعلت الكاتب أن يرتكب خطأ يفتقر إلى التصحيح.
هناك جزء من هذه الزيادة يبدو أنّه يعود إلى تصحيح آخَر لاحق، ألا وهو زيادة الألف في نهاية “عملوا” بعد ما -أظنه- كان مفقودًا في التصحيح الأوّل. وبينما الألف المماثل في «آمنوا» في نهاية تلك الزيادة ساقط، كُتب هذا الألف عادةً في [الأفعال] الأخرى من هذه الورقة. وأغرب شيء هو أنّ الألف في بداية «أحسنوا» كان ساقطًا في الكتابة الأولى، ولكنّه أضيف لاحقًا بالحبر الأحمر الذي تمّ استخدامه لكتابة نقط تمثّل التشكيل في هذه الورقة. ويُعدّ هذا التعقيد دليلًا على أنّ المخطوط كان مستخدَمًا وذا أهميّة تطلبت التصحيح لمرات عدّة
(ibid., pp. 52 -54).
النموذج السابع: زيادة كلمة «السبع»
صورة 8: BnF arabe 327، ورقة 1و، [فوق السطر الثالث]
يدعي بروبيكر أنّه عثر على تسعة تصحيحات في هذه القطعة المخطوطة التي يقدّر تاريخه بالقرن الثامن الميلادي، ويشير إلى اثنين منها. فالأوّل هو زيادة كلمة
(70)«السبع» فوق السطر الثاني الذي ظهر في الصورة 8، في سورة المؤمنون الآية 86: (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَـٰوَٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) ، ويرى أنّها أضيفت على يد كاتب غير الكاتب الرئيسي، وبأسلوب كتابة يختلف عن أسلوبه. وعند ذلك يشير إلى مصحف آخر من مخطوطات صنعاء، وقد سقطت منه كلمة «السبع» في سورة التوبة الآية 80 (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) .
ثم يذكر المؤلفُ التصحيحَ الثاني، وهو زيادة الألف قبل «لله» في سورة المؤمنون الآية 87 (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) ، والذي يميّزه عن رسم مصحف القاهرة 1924م.، لكنه ينسجم مع قراءة أبي عمرو [بن العلاء، إمام القراءة بالبصرة]. وبعد ذلك يشير إلى ما قاله كوك عن هذه القراءة، إنّها تحاذي مصحف أرسله عثمان إلى البصرة، وعُزيت تلك الزيادة إلى الحجاج. وأخيرًا ينوّه بروبيكر إلى الخط البيضوي على كلمة «الأرض» [في الآية 86]، ليدلّ على إبدالها بـكلمة «السبع» الساقطة من النص (ibid., pp. 55 -57).
النموذج الثامن: حذف وإعادة كتابة في مصحف يعود إلى القرن الأول الهجري أو السابع الميلادي، من المحتمل أن أجري على يد الكاتب الرئيسي وبُعيد أوّل كتابة
صورة 9: BnF arabe 330، ورقة 55و، [السطر الثالث]
(71)بعد ذكر بعض المواصفات الظاهريّة لهذه المخطوطة، يدّعي بروبيكر أنّه عثر على 65 تصحيحًا فيها، ويكتفي بالإشارة إلى واحد منها في الصورة 9، ألا وهو كتابة «الله كان» في سورة النساء الآية 149 (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا) ، وذلك بعد أن مُسح ما كان قبله في هذه البقعة من الورقة. ويحتمل بروبيكر أنّ الذي باشر هذا التصحيح هو الكاتب الرئيسي؛ فعندما انتبه إلى الخطأ النحوي في «فإن الله عفوا قديرا»، عدّله بكتابة «الله كان». ويقول إنّ هناك تصحيحًا آخر في الورقة نفسها، ولكنّه لم يتحدّث عن تفاصيله (ibid., pp. 58 -59).
النموذج التاسع: زيادة كلمة «الرحيم» بعد كتابة المخطوط
صورة 10: BnF arabe 327، ورقة 12ظ، [السطر الأخير]
هذه الورقة -كما يقول بروبيكر- من نفس المصحف الذي أشيرَ إليه آنفًا في النموذج السابع، وفيه زيادة كلمة «الرحيم»، والتي كانت ساقطةً من سورة الشورى الآية 5: (أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) . ويبدو أنّ المصحّحَ غيرُ الكاتب الرئيسي، وأضاف الكلمة بعد فترة من الزمن، بقلم آخر يمتاز عن الأوّل بحدّته، ولكن الكلمة الزائدة تم مسحها جزئيًّا. وينوّه بروبيكر إلى أنّ الآية كانت صحيحةً من حيث النحو والمعنى قبل هذا التصحيح، إلّا أنّ القافية [يعني الفاصل] لا توافق الآيات الأخرى، وبهذا التصحيح أصبحت الآية موافقة للرسم المعيار الراهن
(ibid., pp. 60 -61).
النموذج العاشر: زيادة بين السطور في مصحف عائد إلى القرن الأوّل الهجري أو السابع الميلادي وبالخط الحجازي
صورة 11: BnF arabe 331، ورقة 1ظ، [السطر الثاني]
بعد الإشارة إلى بعض مواصفات هذا المخطوط الذي يُحتفظ به في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، يقول بروبيكر: تمت إضافة كلمة «مثل» وحرف «بـ» إلى سورة البقرة الآية 137 (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ) ، في وقت لاحق وبقلم أحدّ من السابق، بينما كانت ساقطة من قبلُ، فتبدو [الزيادةُ] كتدخُّل حديث في الورقة، إلّا أنّها تماثل الحبر الذي تم استخدامه في الكتابة الأولى. وينوّه المؤلّف إلى حرف الباء الوارد على «ما» في الآية (الصورة أعلاه)، ولم يتم حذفه ليوافق رسم مصحف القاهرة 1924، فأصبح النص «امنوا بمثل بما»، وهو قراءة غير ناجحة على ما يظهر (ibid., pp. 62 -63).
النموذج الحادي عشر: إضافة هامشيّة لكلمة «الله» في مصحف طوب قابي بعد كتابة المخطوط
صورة 12: مصحف طوب قابي، ورقة 374ظ، [نهاية السطر الثالث]
(73)أشار بروبيكر إلى هذا المصحف في النموذج الأوّل، ويتحدّث هنا عن زيادة لفظة «لله» في أوائل سورة التحريم الآية 8 (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) قائلًا: أجري التصحيح بقلم ضيّق جدًا، وربما بعد مدّة طويلة مِن كتابة المخطوط، فمن المحتمل أن تكون هذه الزيادة تدخُّلًا حديثًا. وبما أنّ المؤلّف يرى الألف قبل لفظة «لله» من الكتابة الأولى، لا يجد معنى للقراءة التي كانت قبل التصحيح [يعني: توبوا إلى الله توبة نصوحا] (ibid., pp. 64 -65).
النموذج الثاني عشر: حذف وإعادة كتابة ومط في مصحف يعود إلى القرن الأول الهجري أو السابع الميلادي
صورة 13: BnF arabe 328، ورقة 8و، [بداية السطر الثاني]
هذه الورقة من مصحف باريسينو -بتروبوليتانوس السابق ذكره في النموذج الثاني، والتصحيح الذي ادّعاه بروبيكر هو كتابة لفظة “ضل” من كلمة “فضل” في سورة آل عمران الآية 171 (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ) ، وحلّت هذه اللفظة -كما يقول المؤلف- محلّ عدة كلمات ممسوحة، ويقدّرها بخمس إلى إحدى عشر حرفًا. ويشير إلى أنّ المصحِّح استخدم قلمًا وحبرًا يختلفان عن القلم والحبر في النصّ
(74)الأصلي، وكتب اللفظة بأسلوب آخر، فليس عمله إلّا تدخُّلًا لاحًقا [في المصحف]، والذي يجعله يوافق رسم مصحف القاهرة 1924 (ibid., pp. 66 -67).
النموذج الثالث عشر: حذف وإعادة كتابة تبدو أنها تغيّر صرف الفعل
صورة 14: BnF arabe 340، ورقة 26و، [السطر الثاني]
يتحدّث بروبيكر عن هذا المصحف الشريف الذي يتألّف من 121 ورقة، وهو مركَّب من قطَعٍ عدّة. وبينما يدّعي أنّه عثر على 91 تصحيحًا في هذا المخطوط الذي يقدّر تاريخه بالقرن التاسع أو الثامن للميلاد، يشير إلى ما تمّ تصويره في الصورة 14، وهو حذف اللام من كلمة “قال” وكتابة اللام والواو والألف مكانها في سورة سبأ الآية 35: (وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا) ، فصار النصّ في المخطوط يوافق رسم مصحف القاهرة 1924. ثم يقول بروبيكر: إنّ هذا التصحيح ليس الأغرب في هذا المخطوط، ولكنه اختاره لأنّه يهدف في كتابه هذا إلى إظهار مدى ظاهرة [التصحيح في المخطوطات] (ibid., pp. 68 -69).
(75)
النموذج الرابع عشر: حذف يترك فراغًا في مصحف طوب قابي
صورة 15: مصحف طوب قابي، ورقة 65و، الإشارة إلى ألف محذوفة في نهاية السطر الـ11
صورة 16: مصحف طوب قابي، ورقة 65و، حُذف «لله قد» من بداية السطر الـ12
هذا النموذج الثالث الذي يرتبط بمصحف طوب قابي، وهو -كما يدعي بروبيكر- حذف لفظة «الله قد»، حيث الألف في نهاية السطر الـ 11، والمتبقي في بداية السطر الـ 12، في سورة النساء الآية 167: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا) . ومع أنّ بروبيكر يرى هذا الحذف الذي يميّز المخطوط
(76)في هذه الآية عن رسم مصحف القاهرة 1924 غيرَ معارض للمعنى وللنحو، لا يجد دليلًا واضحًا عليه. ثم يدّعي أنّ هناك حذفًا آخر في نهاية السطر الـعاشر؛ غير أنّه لم يدرس هذا المخطوط عن كثب، فليس متأكدًا عنه (ibid., pp. 70 -72).
النموذج الخامس عشر: حذف يترك فراغا في مصحف عائد إلى القرن الثامن أو التاسع للميلاد
صورة 17: MIA.2013.19.2، ظ، [بداية السطر الأخير]
يصف بروبيكر هذا المخطوط بالشَبَه بمصحف طوب قابي، ويشير إلى التصحيح الذي أجري فيه من حذف ما بين لفظة «فضله» ولفظة «والذين» في سورة النور الآية 33 (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ) ، وبهذا التصحيح أصبح المخطوط موافقا لرسم مصحف القاهرة، ولكن المحذوف تتعذر قراءتُه. ويدعي أخيرا أنه رأى في مخطوطين آخرَين هذه الآيةَ ذاتها أجري فيها تصحيحات أخرى (ibid., p. 73).
(77)النموذج السادس عشر: زيادة في مصحف القاهرة بعد كتابة المخطوط
صورة 18: المصحف الشريف بالقاهرة، ورقة 109و، [السطر الثاني]
هذه الصورة -كما يقول بروبيكر- تعود إلى مصحف في المشهد الحسيني بالقاهرة، ويماثل أسلوبُ كتابته مصحفَ طوب قابي، وقد نسبه البعض إلى عثمان، ولكن الدكتور آلتي قولاج يحدّد تاريخه بنهاية القرن الثامن أو بأوائل القرن التاسع للميلاد. وما عثر عليه بروبيكر هو زيادة كلمة «كان» في سورة النساء الآية 33: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) ، ويدّعي أنّها كانت ساقطة في زمن كتابة المخطوط، وأضيفت إليه لاحقًا بقلم لطيف، ولا يُقرأ منها إلا الكاف والألف؛ كما يدّعي أيضًا أنّ هناك مخطوطات أخرى فيها زيادة لكلمة «كان» (ibid., pp. 75 -76).
النموذج السابع عشر: تصحيح بالنسبة إلى كلمة «الله»
صورة 19: NLR Marcel 11، ورقة 7و، [السطر الثاني]
(78)يقول بروبيكر إنّه عثر على 46 تصحيحًا في هذا المخطوط الذي يتألّف من 12 ورقة، وهو جزء من مصحف الفسطاط الأموي، ويشير إلى واحد منها ما يظهر في الصورة 19، وهو كتابة لفظة «نعمة الله» -ما عدا حرفَيها الأولَين- بقلم وحبر آخر [يعني يختلف عن الكتابة الأولى] في سورة الأحزاب الآية 9 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) ، ويخمن أن المحذوف هو «نعمته». وجدير بالذكر أنّه أشار إلى سقوط كلمة «الله» الشريفة في هذا المخطوط سابقًا في النموذج الثالث (ibid., pp. 77 -78).
النموذج الثامن عشر: زيادة كلمة «الساعة» في مصحف عائد إلى القرن الثالث أو الرابع للهجرة أو التاسع أو العاشر للميلاد
صورة 20: NLR Marcel 7، ورقة 7و، [السطر الثاني]
يتحدّث بروبيكر عن المواصفات الظاهريّة لهذا المصحف، وأنّه عثر على ثمانية تصحيحات في أوراقه العشرة، ثم يشير إلى زيادة كلمة «الساعة» في سورة الأنعام الآية 40 (أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ) ، كما تظهر في الصورة 20، ويعتقد أنّ التصحيح أجري على يد شخص آخر وبقلم أحدّ. وبينما يدّعي أنّ كلمة «الساعة» تم تصحيحها في مخطوطات أخرى أيضًا، لا يأتي بصورها وتفصيلها في هذا الكتاب (ibid., pp. 79 -80).
(79)النموذج التاسع عشر: حذف وإعادة كتابة بالنسبة إلى كلمة «الله»
صورة 21: NLR Marcel 5، ورقة 11و
لا يقدّر بروبيكر تاريخَ هذا المخطوط الذي يُحتفظ به في المكتبة الوطنيّة الروسيّة، ويشير إلى كتابة لفظة «هو الله» على ما حُذف قبلها في سورة سبأ الآية 27: (بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ، وهذا هو النص الوارد في مصحف القاهرة 1924. ثم يحاول أن يخمّن المحذوفَ، فيفترضه كلمة «هو»، والتي أُبدلت بـ «هو الله» على يد شخص يختلف عن الكاتب الرئيسي، وقد استخدم حبرًا آخرَ لهذا العمل (ibid., pp. 81 -82).
النموذج العشرين: حذف وإعادة كتابة لِما يقارب من سطر واحد بالنسبة إلى كلمة «الرزق»
صورة 22: MIA.2014.491، ورقة 7ظ، [السطر الثاني]
(80)ينّوه بروبيكر في هذا المصحف الذي يُحتفظ به في متحف الفنّ الإسلامي بالدوحة، إلى كتابة (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) في سورة الأنفال الآية 3 (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) ، علاوة على الألف في بداية الآية التالية (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) ، وهي مكتوبة بشكل ممطوط على ما حُذف سابقًا وقد بقي أثره. ومن ثم يقول إنّ كلمة “الرزق” من أكثر الكلمات تصحيحًا في المخطوطات القرآنيّة المبكرة، وقد قدّم المؤلف ورقة بحثيّة عنها في مؤتمر دولي قبل سنوات عدّة (ibid., p. 83).
ظاهرة أخرى: تغطية في مصحف القاهرة
صورة 23: المصحف الشريف بالقاهرة، ورقة 33ظ
بعد الانتهاء من النماذج العشرين المذكورة، يشير بروبيكر إلى نوع آخر من التصحيحات التي عثر عليها في المخطوطات القرآنيّة، وذلك ما وجده في المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان نسخة المشهد الحسيني بالقاهرة، وهو مصحف يعود -كما نقل المؤلفُ عن الدكتور آلتي قولاج- إلى أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع للميلاد، وفيه آثار الشريط اللاصق، والتي يقول بروبيكر عنها: من المتوقّع أن يُستخدم الشريط اللاصق لأجل ترميم المخطوط إذا وُجد تمزقًا في بقعة منه؛
(81)ولكن عندما أبصرتُ صورة خلف الورقة وجدتها بلا مشكلة حيث لا حاجة إلى الترميم. إذًا من المحتمل أنّ الشريط اللاصق تم استخدامه لإخفاء ما كان مكتوبًا على الورقة. وإن افترضنا أنّ الذي كان تحت الشريط اللاصق يوافق رسم مصحف القاهرة، فالنصوص المغطاة ستكون على النحو التالي:
. السطر الأول: “ـرجهم من حيث”
. السطر الخامس: “ن قتلو”
. السطر السادس: “ـوهم كذلك”
. السطر السابع: “فان ا”
. السطر الثامن: “غفو حيم”
. السطر العاشر: “لدين لله”
. السطر الحادي عشر: “عدو”
. السطر الثاني عشر: “ـهر”
صورة 24: المصحف الشريف بالقاهرة، ورقة 430و
(82)وأخيرًا أشار بروبيكر إلى ظاهرة اللصق وإعادة الكتابة عليه، وهو ما يراه شائعًا في المخطوط المذكور آنفًا، فذكر نموذجًا لها ما يظهر في الصورة أعلاه، والنصوص المكتوبة على اللّاصق هي:
. السطر الأوّل: “نفسهم” في سورة الرعد الآية 11 (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)
. السطر قبل الأخير: “لذي يركم” بشكل ممطوط في الآية 12 (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا)
. السطر الأخير: “طمعا” في الآية السابقة
وختامًا لهذه النماذج الأخيرة يذكر احتمالين؛ الأوّل، أنّ ما كان مكتوبًا تحت اللاصق يوافق الذي كُتب عليه؛ والثاني، ما كان مكتوبا تحته يعارض الذي كُتب عليه، ولا يمكن تحديده إلا إذا أزيل اللاصق بدقّة (ibid., pp. 85 -90).
يشير بروبيكر هنا إلى أهميّة القرآن الكريم لدى المسلمين ومكانته في الأوساط العلميّة، ومن ثم يلقي نظرةً عابرةً إلى أنواع الدّراسات الأكاديميّة الغربيّة التي تعنى بالقرآن الكريم وجوانبه. وبالتالي، يتناول موضوع كتابه ويتحدّث عن المخطوطات القرآنيّة قائلًا: لقد قدّمتُ فيما سبق مخطوطات قرآنيّة تعود إلى عدة قرون أولى بعد وفاة محمد صلىاللهعليهوآله، وما اخترتُ الأغرب منها، بل أردتُ إظهار مدى الظاهرة باختيار أنواع من النماذج، كما تجنّبتُ إظهار الأخطاء التي ارتكبها النسّاخ ما عدا النموذج الثامن.
ثم يسعى بروبيكر إلى الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني وجود هذه التصحيحات؟ فيقول:
أوّلًا، رغم أنّ هناك آثارًا جمة لتوحيد «المصاحف» في معظم المخطوطات، من الواضح أيضًا وجود فوارق في الآراء حول الكلمات القرآنيّة الصحيحة حين كتابة المخطوطات، وتمت إعادة النّظر فيها متى تغيّرت الآراء أو بات توحيد [المصاحف]
(83)أكثر إتقانًا. وليس مستحيلًا أن يرتبط بعض هذا الخلاف في الآراء بالمناطق الجغرافيّة، فهذه المرونة تتجاوز حدود ما ورد في أدب القراءات.
ثانيًا، لم تقتصر هذه الاختلافات في الآراء على العقود الأولى بعد وفاة محمد صلىاللهعليهوآله ، بل استمرت بعضُ المرونة «في قراءة القرآن» لقرون عدّة بعدها. ولم تكن هذه المرونة كبيرةً، كما لا نرى تصحيحًا لجزءٍ كبير من النّصّ القرآني إلّا في مصحف صنعاء وبرمنغهام. وهذه المرونة تناسبُ ما وُجد في نقش قبّة الصخرة، والذي يوحي باضطراب النّصّ القرآني خلال استكماله في عهد عبد الملك بن مروان، وكذلك اختلافات تفتقر إلى التصحيح في المخطوطات حتى سنة 700 الميلادية «يعني 80 الهجرية». ولكن هذا «يعني دعاوى بعض المستشرقين حول اكتمال النص القرآني في سنة 700 للميلاد» لا يفسّر المخطوطات التي صُنعت بعد ذلك الزمن واحتاجت إلى التصحيح، إلّا أن تُنسب «التصحيحات» إلى التطوّرات الإملائيّة أو اختلاف القراءات أو أخطاء النسّاخ، ولكن الحقيقة ليست كذلك.
ثالثًا، التصحيحات الجزئيّة تُشير إلى حركةٍ تدريجيّةٍ نحو «النص» المعيار على مرّ الزمن. بعبارة أخرى، تمّ تصحيح أجزاء من المخطوطات حتى تصبح موافقة لرسم مصحف القاهرة 1924.
وبعد هذه الأجوبة المقترحة يشكّ المؤلّف في الرؤية الغالبة عن نقل القرآن الكريم وأنّ العامل الأساسي في ذلك هو الشفهيّة، كما يَقدر «الجميعُ» حتى الصبيان في سنّ مبكرة على استظهار القرآن الكريم، لكن بروبيكر لا يرى للنقل الشفهي دورًا مهمًّا في صدر الإسلام، بل يعتقد أنّ وجود المخطوطات دليل على «تداول] تقليد للنقل المكتوب، وخصائص المخطوطات تشير إلى نسخها من نموذج ما؛ أي أنّ الناسخ كان ينسخ من مخطوط موجود، ولا من ذاكرته أو من يقرأ عليه. وعلى هذا الأساس، يصرح بأنّه يهدف في دراسته هذه إلى إعادة بناء التاريخ المادي
(84)للمخطوطات والعلاقة القائمة بينها وبين التقليد الشفهي؛ ليحدّدَ المخطوط الذي نُسخ منه وما هو المنسوخ.
وفي نهاية هذا الاستنتاج يقول بروبيكر: إنّ الملاحظات المذكورة سابقًا لا تجيب عن السؤال: هل تلقّى محمد صلىاللهعليهوآله الوحي؟ أو هل الوحي من الله؟ بل تتحدّث عمّا حدث لاحقًا في مجتمع المؤمنين «بالوحي» حول حِفظه وتنقّله. يجب أن تؤخذ التصحيحات الموجودة في المخطوطات بعين الاعتبار، إذ تقيّم ما تم نشره «بين المسلمين». إنّ المخطوط تسجيلٌ ماديّ للنصّ وهو وسيلة للانتشار والحفظ، ويُحتمل فيه التدخّل والتحريف، فعلى الباحث في المخطوطات أن يميّز بين هذا التدخل وبين المعلومات النافعة فيها. ومن ثم يَعِد المؤلّف القرّاء بأبحاث علميّة أخرى عن المخطوطات سوف ينشره في المستقبل (ibid., pp. 93 -99).
(85)لم تبقَ دعاوى بروبيكر في كتابه بشأن التعديل في النص القرآنيّ من دون ردّ أو تأييد، بل أصبح كتابه -الأكثر مبيعًا- عرضةً للنقد أو المدح من قبَل المسلمين وغيرهم. وتوجد كلمات بعض الذين أشادوا بعمل بروبيكر في الغلاف الخلفي للكتاب، وهُم مارك دوري، وأسماء هلالي، ودانيل والس، وجِرد بوين، ومارين فان بوتن. إضافة إلى جِي اسميث الذي نشر فيديوهات عبر الإنترنت تأييدًا لكتاب بروبيكر. وفي المقابل هناك عدد من الباحثين المسلمين الذين أدركوا ضعف منهجيّة بروبيكر وعدم نجاعة نماذجه في إثبات ما ادّعاه، أي المرونة في النصّ القرآني وتعديله عبر الزمن، فبذلوا مساعيهم بغية الرد عليه. ومن هذه الردود مرئيات انتشرت عبر الإنترنت، ومنها دراسات علميّة نقديّة لمزاعم بروبيكر. وفيما يلي نعرض لثلاثة أعمال نقديّة لما طرحه بروبيكر:
ألّف هذه المقالة الدكتور هيثم صدقي، وهو المدير التنفيذي للجمعية الدولية للدراسات القرآنيّة بالولايات المتحدة، وتم نشرها في مجلّة العصور
الوسطى عام 2019 للميلاد، وفيها يعالج منهجيّةَ بروبيكر وعددًا من نماذجه، موجِّها إليه انتقادات جمة، كما يصرّح بأنّ كتابه يعاني من خللٍ فادح في المنهجيّة والتحليل والبحث، ودعاويه البارزة غير مبرهنة ومقنعةٍ للقارئ، إلّا أنّ أخطاءه في عرض المواد [أي المخطوطات القديمة] قليلة (Sidky, 2019, pp. 273 -274). ثم يقدم هيثم صدقي الملاحظات التالية على آراء بروبيكر في مقدّمة كتابه:
. يصرّح بروبيكر بعدم النقط في جملة من المخطوطات المبكرة وخصوصًا الحجازية، ولكنّ هذا سوء فهم عام؛ لأنّ المخطوطات الحجازيّة تحتوي على نقط الإعجام بعضَ الأحيان (ibid., p. 274).
. يقول بروبيكر إنّ الرسم يختلف عن القراءات ولا يتأثّر بها؛ ولكن الحقيقة هي ليس كل منهما مستقلًا عن الآخر. والأغرب هو أنّه يخلط بينهما عندما يتحدّث عن المصاحف التي حقّقها آلتي قولاج، مصرِّحا بأنّها تعكس عددًا من القراءات لا قراءة واحدة. ولكنّ ما أشار إليه آلتي قولاج هو اختلاف الرسم بين مصاحف الأمصار لا تراث القراءات؛ فمصحف القاهرة غير مشكَّل، والتشكيل ضروريّ في تحديد القراءة (ibid., p. 275).
. يلاحظ بروبيكر أنّ التصحيحات في معظم الأحيان تسبّب الموافقة للرسم المعيار الراهن لمصحف القاهرة 1924. ولكن هناك مشكلتان كبيرتان؛ الأولى هي المفارقة التاريخية الواضحة للمخطوطات القديمة التي تم تصحيحها حتى توافق مصحف القاهرة 1924. والثانية هي افتراضه المسبق أنّ ما بُني عليه معيارُ رسم مصحف القاهرة 1924 يختلف عن المعيار في زمن كتابة المخطوط. ومع ذلك، إجراء التصحيحات نحو الموافقة لرسم مصحف القاهرة
(87)ليست دليلًا على التغيير في المعيار؛ بل هو دليل على وجود المعيار منذ البداية. وهاتان المشكلتان تنبثقان من سوء الفهم لمصحف القاهرة؛ فإنّه يُفصل عن الإملاء المعيار للعربية الكلاسيكية، والذي يمتاز به جميع المصاحف السابقة عليه تقريبًا. وهذا يناقض استخدامه «أي مصحف القاهرة» كمعيار لتطور المصاحف (ibid., p. 276).
وبعد توجيه هذه الانتقادات، يمدح بروبيكرَ بما أنّه يزوّد القارئ بأسئلةٍ نافعةٍ ليفكّر حول أخطاء النسّاخ، كما يجد في ملاحظاته طيبة على العموم، إلّا بعضها، كالنموذج السادس (ibid., p. 279). ثم يتطرّق صدقي إلى دعاوى بروبيكر في تفسير المخطوطات، ويرى معظم ما عثر عليه، من الأخطاء النسخية فيها (ibid., p. 280). لذلك أهمّ نقطة نجدها في هذه المقالة هو محاولة المؤلّف لتعليل التصحيحات الواردة في المخطوطات ووصفِها بأخطاء ارتكبها النسّاخ. ففي كل نموذج يتناوله صدقي يقدّم تبريرًا لِما جعل الكاتب يخطئ في الاستنساخ (ibid., pp. 280 -286)، ويرى أنّ بروبيكر يتجنّب تفسير سقوط لفظة في المخطوط بخطأ الناسخ، بينما هو يعلم أنّ النّصّ لا يفيد معنى بعد سقوطها (ibid., p. 281)!
إضافة إلى ذلك، يخطّئ مؤلف المقالة ما عزاه بروبيكرُ إلى بعض العلماء، ويذكر غير ما نسب إليهما (ibid., p. 286)، وينكر أن يكون مصحف برمنغهام ومصحف صنعاء من رقّ ممسوح، خلافًا لما ادّعاه بروبيكر. ثم يستنتج في الختام قائلًا: لو أراد بروبيكر أن يثبت أثر إنسانيّة النسّاخ في انتشار القرآن لكان ناجحًا! ولكنّه فشل في المنهجيّة والتحليل. رغم أنّه يصرّح بإمعان النّظر إلى أخطاء النساخ، ولكن هذا لا يبدو من كتابه. في الحقيقة، من الممكن تعليل معظم النماذج بأخطاء نسخية بسيطة. ومع ذلك، تبقى نظريّته الرئيسية -أي المرونة للنص القرآني طوال القرون - غير ثابتة (ibid., p. 287).
(88)هذا الكاتب الصادر سنة 2020 الميلادية للدكتور طيار آلتي قولاج، وهو رئيس مركز البحوث الإسلاميّة بإسطنبول، ويبدأ بمقدّمة خالد إرن، وتليها مقدّمة المؤلف، ويشير فيها إلى رجل آخر ادّعى التغيير في المخطوطات القرآنيّة، مستدلًا بما أورده آلتي قولاج في هوامش المصاحف المخطوطة التي اعتنى بتحقيقها! ثم يعلّق المؤلف على تلك الدعوى قائلًا: ما عدا تلك الفوارق في قواعد الكتابة التي وردت في الهوامش، لا تختلف المصاحف التي صُنعت في شتى البقاع من حيث النص، وهذا دليل على أنّ النصّ القرآنيّ بقي سليمًا (Altıkulaç, 2020, p. 16). وخلال إشارة إلى معنى الاستشراق، يصف بروبيكر بأنّه إمّا يحتاج إلى المؤهلات الضروريّة [في مجال دراسة المخطوطات] وإما يعمل متأثّرًا بالتربية الغربية (ibid., p. 20)، وبالتالي ينوّه إلى اهتمامه القصير بالقرآن الكريم ودراساته (ibid., p. 21).
ثم يتحدّث المؤلّف عن منهج بروبيكر في كتابه قائلًا: التصحيحات «التي وجدها بروبيكر» ليس إلّا أخطاء نسخيّة. إنّ أوّل من جمع مثل هذه النماذج كأدلّة على التغيير في القرآن هو مينغانا، والذي نشر مع لويس كتابًا بعنوان «أوراق من ثلاثة مصاحف قديمة ربما قبلَ عثمان»، وحاول إثبات تعديل القرآن أثناء كتابته في عهد عثمان. فعملُ مينغانا أثار شهيّة المستشرقين الآخرين الذين زعموا أنّ القرآن تعرّضَ للتغيير (ibid, p. 23).
وبعد ذلك يسعى آلتي قولاج إلى إثبات عدم التغيير في القرآن، فيعلّق على قول
(89)بروبيكر أنّ القرآن يؤثّر على حياة مليارات الأناس في العصر الراهن، قائلًا: بما أنّ القرآن هو أقدم كتاب وصلنا، كان يحفظه المئات من الناس في القرن الأوّل، وقد ازداد العدد بمرور الزمن. فضلًا عنه، فقد تمّ تأليف عددٍ كبير من الكتب بالعربيّة في شتّى المجالات، وقد وصلنا بعض تلك المخطوطات مما كُتب في عصر صحابة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهذه مصدر للثقة بنصّ القرآن (ibid., pp. 24 -25).
ومن ثم ينتقد بروبيكرَ، ويقول: رغم أنّه ينوّه إلى الأخطاء الواقعة في النَسخ من الأصل، مثل سقوط اللفظة وتكرار اللفظة والزوغان في البصر، لا يحلو له أن يترك دعاويه التي لا أساس لها. أما بالنسبة إلى اختلاف القراءات عبر العصور، فيقول المؤلف: في عصر لم تكن الطباعة موجودة، وكانت هناك شحّ في أدوات الكتابة، وكان تعليم القرآن على أساس الاستظهار والتلقّي الشفهي، فكان الاختلاف طبيعيًّا؛ إلى جانب اختلاف اللهجات في شتّى المناطق الجغرافيّة «مما يؤثر على الاختلاف في القراءات» (ibid., pp. 27 -28). وبينما يثمن المؤلفُ جهودَ المستشرقين الذين قاموا بدراسة القرآن من غير تعصّب، يؤنّب بروبيكر لِما ادّعاه بشأن نشر القرآن في زمن عثمان، مستدلًّا بما أورده جملة من المؤرخين المسلمين حول توحيد المصاحف وإرسالها إلى عدّة أمصار (ibid., pp. 36 -37).
وبعد هذه المقدّمة، يبدأ آلتي قولاج بدراسة النماذج التي أوردها بروبيكر في كتابه وتقييم ما ادّعاه، أي التعديل في المخطوطات القرآن، ويستفيد في هذا المسار من المصاحف المخطوطة التي حقّقها نفسُه ونشرتها مؤسّسة إرسيكا حتى الآن، وهي -كما يقول- أقدم المخطوطات التي وصلتنا من القرنين الأوّل والثاني للهجرة: مصحف
(90)طوب قابي (2007 م.)، مصحف متحف الفنون الإسلاميّة والتركيّة (2007 م)، مصحف المشهد الحسيني عليهالسلام (2009 م)، مصحف صنعاء (2011 م)، مصحف باريس (2015 م)، مصحف توبينغن (2016 م)، مصحف لندن (2017 م)، مصحف برلين (2019 م)، مصحف طوب قابي -مدينة (2020 م). ويشير المؤلّف إلى أنّ بروبيكر اعتمد في ستة نماذج على ثلاثة من هذه المصاحف؛ أي مصحف طوب قابي، باريس، والمشهد الحسيني؛ غير أنّه [أي المؤلف] لا يعرف دراسة جامعيّة حول المخطوطات الأخرى ولا يعتقد أنّها موجودة أصلًا (ibid., pp. 39 -40)!
وعندما يعالج آلتي قولاج نماذج بروبيكر دراسةً ونقدًا، يشرح باختصار ما قاله بروبيكر في كتابه، ثم يأتي بصور من مصاحف مخطوطة أخرى، وهي -كما يقول آلتي قولاج- مصاحفُ معاصرة أو أقدم أحيانًا من المصاحف التي استند إليها بروبيكر، ولم ترد فيها تلك الزيادات أو سقوط الألفاظ أو غيرهما من الأخطاء، ويقصد بهذا العمل تعليلَ ما عثر عليها بروبيكر أنّها أخطاء النساخ وليست دليلًا على التعديل في نصّ القرآن (ibid., pp. 41 -95).
وجدير بالذكر أنّ آلتي قولاج يوافق على «المرونة» التي ادّعاها بروبيكر، لو كان قاصدًا بها الأحرف السبعة من القراءات، ولكنّه لا يعني ذلك (ibid., pp. 46 -47). وبينما ينتقد بروبيكرَ؛ لأنّه لم يراجع المخطوطات الأخرى التي كانت بين يديها حتى يتأكّد هل سقوط اللفظة التي أشار إليها وقع في جميعها أو يختص الأمر بمخطوط واحد دون غيرها (ibid, p. 49)، قد تصبح لهجته ألذع من هذا ويصف التفسير الذي قدّمه بروبيكر بغير مستحق للتقويم (ibid., p. 56)، كما ينعت نماذجه العشرين -بلا استثناء - بقتل الوقت دون جدوى (ibid., p. 89)!
ثم يستنتج آلتي قولاج أنّ النّماذج التي أوردها بروبيكر -ما عدا الرقم 6 و8 و9
(91)و15- لا تهدف إلّا إلى سناريو غير واقعيّ قائلًا: هذه النماذج الأربعة وردت في الكتاب بغير دليل واضح؛ إذ يحتمل المؤلف كونها أخطاءً نسخيّة، فما يميّز هذه عن الأخطاء النسخيّة الأخرى؟! أراد بروبيكر أن يناقش كما طاب له في مجال البحث الذي ظنّه بلا صاحب. فعمله باسم الجهود العلميّة -في الواقع- عمل متهوّر (ibid., p. 98). وختامًا لبحثه يقدّم المؤلّف تاريخًا مختصرًا جدًا لقراءة القرآن وحفظه لدى المسلمين، ويؤكّد على تراث «الإجازة» كمؤيّد لسلامة القرآن عن التحريف عبر العصور (ibid., pp. 99 -101).
ساهم في إعداد هذه الكراسة منصور أحمد وفريد البحريني، وهما من الباحثين والناشطين المسلمين، ويبدأ بمقدّمة لإيجاز أحمد، وهو أيضًا باحث وناشط مسلم، وانتشر عبر الإنترنت في عام 2020 الميلادي للمرة الأولى. تتكوّن هذه الكراسة من 290 صفحة، وتتضمّن المواضيع التالية: المقدمة (عن معنى القرآن والمصحف ورسمه والتغيير فيه، والفوارق في المخطوطات القرآنيّة، وهل هي إصدارات ونسَخ للقرآن)، الخلل في منهجيّة دانيل بروبيكر (يبدأ بملخّص عن دعوى بروبيكر واستنتاجه، وتليه أدلّة تاريخيّة تعارض ذلك، ثم يأتي كلام في أنّ ما عثر عليه بروبيكر ليس إلّا أخطاء نسخية في المخطوطات، وأخيرًا إشارة إلى السهو الذي ارتكبه بروبيكر في ترجمة الآيات ومواضع الأخرى). وبعد هذا المدخل يبدأ أصل الكراسة، وهي تضمّ صورًا كثيرة من المخطوطات القرآنيّة التي تُحتفظ في المكتبات الأوربية، فمنها مصاحف أقدم من المصاحف التي اعتمد عليها بروبيكر، ومنها معاصرة أو أحدث منها، ولا توجد فيها الأخطاء التي عثر عليها بروبيكر وزعمها تعديلًا في نص القرآن.
(92)وبعد التعريف بهذه الأعمال تجدر الإشارة إلى ما يميّز هذه الدراسة عنها، ألا وهو: أوّلًا، الملخّص عن اهتمام المستشرقين كدراسة تاريخيّة تمهيديّة للبحث؛ وثانيًا، نبذة عن المؤلف، وفي عدم خبرته في المجال الذي ألّف فيه. وثالثًا، الملاحظات التي قدّمناها على مقدمة كتاب بروبيكر محاولةً للرد على شبهاته وتسليط الضوء على ما كان ينبغي أن يتناوله بالتفصيل. ورابعًا، اقتصار هذه الدراسة على المخطوطات التي تسبق زمنيًّا على ما استفاد منه بروبيكر أو هي متزامنة لها، كيلا يتّسع له مجال قول إنّ ما استند إليه أعرقُ في التاريخ فلا عبرة بما هو متأخّر عنه لإمكانيّة التحريف والتغيير فيه لاحقًا. وخامسًا، صور من المخطوطات القرآنيّة التي يحتفظ بها في مكتبة العتبة الرضويّة المقدّسة بمدينة مشهد الإيرانية، وهي صور لم تُنشر من قبلُ، فجزيل الشكر للدكتور مرتضى توكلي على إتاحتها لي.
(93)
(95)
مقدمة الفصل
تقدّمَ في الفصل السابق ملخص عمّا ورد في كتاب بروبيكر، وحان الوقت لدراسة دعاوى هذا المستشرق الأمريكي بشأن القرآن الكريم، وتقويم منهجيّته ونماذجه التي تدعم فرضيّته. لذلك ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين؛ في المبحث الأوّل نقدّم ملاحظاتٍ على ما قاله بروبيكر في كتابه، ونحاول الرّدّ على الشّبهات التي أثارها، مع عرض التفاصيل المرتبطة بالمخطوطات التي استفاد منها بروبيكر، ثم يقع نقد منهجيّة المؤلّف. وفي المبحث الثاني نعرض صور المخطوطات القرآنيّة المبكرة السليمة من الأخطاء والتعديلات، والتي ترفض دعاوى بروبيكر بشأن التحريف الواقع في القرآن المجيد.
(96)
تحظى المنهجيّة في البحوث العلميّة بمكانةٍ رفيعةٍ، فهي المسار الذي يسلكه الباحث في فحص فرضيّاته المطروحة، وبها تتوصّل إلى النتائج المطلوبة. لذلك يؤدّي اتّباع المنهج الصحيح إلى اكتشاف حقائق علميّة تقنع القارئ المنصِف، والباحث الذي لا يوظّف منهجًا صائبًا معترفًا به في الأوساط العلميّة لن يهتدي إلى سواء السبيل، اللهم إلّا بالصدفة والحظ! ومن المعهود أن يشرح كلّ مؤلف منهَجه المقصود في مقدّمة عمله ويلتزم به طوال ذلك، غير أنّ الكتاب الذي نتناوله هنا بالدراسة والنقد لا يحتوي على فصل يختصّ بالمنهجيّة، كما أنّ بروبيكر لم يبح بها لا من قريب ولا من بعيد، بل ادّعى أمرًا عظيمًا وحاول إثباته بما وجده صحيحًا عنده.
وقد عرفنا فيما سبق أنّ بروبيكر يعتقد بمرونة النّصّ القرآني في العهود القديمة، يعني أنّ النّصّ القرآني لم يكن مضبوطًا في القرون المبكرة للإسلام، فكان من الممكن أن يقرأه الناس كما يشاؤون، ويَظهر ذلك من الاختلاف الوارد في المخطوطات القرآنيّة عن النصّ القرآني الحالي، وهذا ما يسمّيه المسلمون بالتحريف في القرآن الكريم. فهُم -على الأقل في العصر الراهن - لا يسمحون بالزيادة أو النقص في النص القرآني بلا ريب، ويحسبون أيًّا منهما تحريفًا لفظيًّا لا مسوّغ له. بعبارة أخرى، يهدف بروبيكر في كتابه هذا إلى إثبات التحريف اللفظي في القرآن الكريم، ويرى أنّه كان جائزًا في الماضي البعيد، وهذا غير ما ثبت في مصادر القراءات، فبعض التصحيحات التي عثر عليها بروبيكر لا يوافق أي قراءة عثمانيّة أو غيرها من الشواذ، ويجد المؤلّف هذه الحالات دليلًا على ما ادّعاه بشأن القرآن المجيد.
وفيما يلي من هذه الدراسة نطمح إلى تقويم فرضيّة بروبيكر -أي المرونة في النّصّ القرآنيّ أو بالأحرى أن يسمّى التحريف في القرآن- وتقديم فحص شامل لنماذجه، وقبل ذلك نسلّط الضوء على ما قاله في مقدّمة كتابه، فإنّها تتألّف من
(97)أجزاء صغيرة يجدر التطرّق إليها -ولو باختصار- والتعليق على كلّ منها، لكي تتّضح صحة دعاوى بروبيكر في هذا الجزء من كتابه، ومن ثم نقدّم تعريفًا للمصاحف المخطوطة التي استخدمها بروبيكر في كتابه واستند إليها في إثبات فرضيته، وأخيرًا نسعى إلى استخلاص منهجيّة المؤلّف حسب ما مارسه في نماذجه والرد عليه بشكل علميّ وموضوعيّ، إن شاء الله.
يظهر بعد دراسة مقدّمة كتاب بروبيكر أنّها تُقسَّم إلى أجزاء ثمانية، وتمّ تقديم خلاصة لكلّ منها في الفصل الماضي من هذا الكتاب، فنكتفي هنا بتذكير مختصر عنها مع تقديم الملاحظات المناسبة:
ذكر بروبيكر كلامًا منطقيًّا في هذا المجال؛ إذ علّلَ كثرة المخطوطات القرآنيّة المكتوبة على الجلد إزاء قلّة المخطوطات الإنجيليّة المكتوبة على ورق البردي؛ ونزيد على ذلك أنّ كلًّا من القرآن والإنجيل كان يُكتب على الجلد وورق البردي. أمّا بالنسبة إلى الإنجيل -مثل كثير من الرسائل والأعمال الأدبيّة في العصر الهلنستي-، فكان يُكتب على الجلد أو ورق البردي، ثم يُلصق أو يُخاط بعضه ببعض ليصبح طومارًا لا يتجاوز تسعة أمتار، ويُستخدم للكتابات الدينيّة أو الأدبيّة، أو يصبح مصحفًا يُحتفظ به في الكنائس، وإن كان هذا النّوع من المخطوط يُعدّ في مستوى متدنٍ من الأهميّة عندهم. ومنذ القرن الرابع الميلادي، لمّا صارت المسيحيّة ديانةً رسميّةً للإمبراطورية الرومانيّة في عهد قسطنطين، ازداد الإقبال على الجلد، وكُتب العهد الجديد عليه بالكامل حتى عصر الطباعة. وأمّا بالنسبة إلى القرآن الكريم، فكان يُكتب على ورق البردي، كما يُكتب على الجلد، إلّا أنّ عدد أوراق البردي
(98)المتبقّية إلى يومنا هذا ضئيل جدًا، ولا يكشف عن وجود مصحف كامل مكتوب عليه (Marx, 2019, pp. 9 -12). إذًا، بينما توجد المخطوطات القرآنيّة والإنجيليّة على كِلا المادتين -أي الجلد والبردي- لم يبقَ إلّا القليل مما كُتب منهما على ورق البردي، وهناك وفرة مما كُتب على الجلد.
تحدّثَ بروبيكر في المقدّمة عن ثلاثة طرق يستخدمها المستشرقون في تقدير عمر المخطوطات القرآنيّة، وبما أنّ تأريخ المخطوطات القرآنيّة من الأهميّة بمكان -لأنّ المخطوطات المبكرة بإمكانها أن تثبت أو تنكر صحّة ودقّة النّصّ القرآني الذي وصل إلينا- فنقدّم ملاحظتين على هذه الطرق، فضلًا عن التعريف بطريقة أخرى لم يشر إليها بروبيكر:
الملاحظة الأولى: لا يكاد يوجد مخطوطٌ قرآنيٌّ قديمٌ يعود إلى القرون الأربعة الأولى يحمل حَرد المتن، مما يتضمّن اسم الكاتب وتاريخ كتابته ومكانها، إلّا «مصحف أماجور» له وقفيّة تحدّد تاريخ كتابته منتصف القرن الثالث الهجري (Marx, 2019, p. 5)، بل كتابة معلومات المخطوط القرآني في نهايته أو وسطه عادةٌ متأخّرة عن القرن الثاني بل منتصف القرن الثالث الهجري (كريمي نيا، ١٤٠٠، ص 70). لذلك يلجأ المستشرقون إلى ثلاثة طرق لتقدير عمر المخطوطات القرآنية، غير أنّ هذه الطرق كلّها محتملة لا تحدّد التاريخ المضبوط لكتابة المخطوط، فالأفضل الاستعانة بجميعها للوصول إلى تقدير أقرب إلى الواقع.
الملاحظة الثانية: تنقسم الطرق لتقدير أعمار القطع الأثرية إلى قسمين؛ التأريخ النسبي والتأريخ المطلق. أمّا الأوّل، فهو مبنيّ على سلسلة من المقارنات
(99)بين القطع المستكشفة، نحو الفنون [والخطوط] المستخدمة في المخطوطات. والثاني مبنيّ على الخواص الفيزيائيّة الكيميائيّة للمواد المستخدمة في الحضارات القديمة وتفاعلاتها مع الظروف البيئيّة (Liritzis, et al., 2020, p. 54). وإنّ افتراض المصاحف الشريفة قِطع أثريّة ثمينة تخضع لعمليّة التأريخ، يحتاج إلى طرق لتأريخها النسبي -مثل علم المخطوطات وعلم الخطاطة- وطرق أخرى -مثل الفحص الكربوني المشع- لتأريخها المطلق. وفيما يلي إيضاح لهذه الطرق:
الطريق الأوّل: علم المخطوطات -أو الكوديكولوجيا- وهو علم يدرس الكتاب المخطوط وصناعته، ويشمل صناعة الأحبار والرقوق والكاغد وفن التوريق والنساخة والتجليد والتذهيب، وكذلك ما يتعلّق بالمخطوط نحو حجمه ونظام ترقيمه والتعقيبات والسِماعات والإجازات والقراءات والتقييدات للمِلكيّة والوقف واسم الكاتب وتاريخ الكتابة وغيرها من المعلومات، وهذا ما تلوح إليه كلمة كوديكولوجيا المتكوّنة من Codex بمعنى الكراسات المضمومة إلى بعضها، وكلمة Logos بمعنى المعرفة (السامرائي، ٢٠٠١، صص19 -20). كان الكوديكولوجيا -الذي وُلد في منتصف القرن العشرين للميلاد- في بادئ الأمر يُعنى بدراسة تاريخ المكتبات والمجموعات، ولكنّه اختصّ شيئًا فشيئًا بدراسة الشكل المادي للكتاب المخطوط وعناصره المكوّنة بغضّ النّظر عن نصّه وموضوعه، فيدرس الظروف التي كُتب فيها المخطوط، والطرق التي اتّبعها النسّاخ والورّاقون والمزخرِفون وغيرهم في إنتاجه، واختلاف البيئة الجغرافيّة والزمنيّة وأثره على ذلك، إلى جانب تاريخ النسخة وكيفيّة تكوينها وإعادة بناء المجموعات المخطوطة القديمة (سيد، ٢٠٠٥، صص13 -14).
يساعد علم المخطوطات على تقدير عمر المخطوط، حيث إنّ أدوات الكتابة -مثل الأحبار والأصباغ- وحواملها -مثل الرق والكاغد- وفنون النساخة والزخرفة وغير ما ذُكر آنفًا تغيّرت وتطوّرت بمرور الزمن، فالاطلاع على تاريخ استخدام تلك المواد وتطبيق تلك المناهج في إنتاج المخطوط، إضافةً إلى معرفة كوديكولوجيّة للمخطوط، يساعد على تأريخ كتابة المخطوط على وجه التقريب. على سبيل
(100)المثال، كانت كتابة القرآن على الجلد متداولةً لخمسة قرون في المشرق الإسلامي، وثمانية قرون في المغرب الإسلامي، خلافًا للكاغد فلم يُكتب عليها القرآن حتى القرن الرابع الهجري. كذلك كانت الكتب في صدر الإسلام بشكل يفضُل طوله على عرضه، لكن يوجد إقبال على كتب عرضها أكثر من طولها في القرون الأربعة الأولى، ومن ثم تراجع إلى المَقاس العمودي بعد تلك الفترة. ومثال آخر هو التجليد، فقلّما يوجد مصحف قديم يلفّه غلاف من الأديم، كما تندر المصاحف المذهّبة التي تعود إلى القرون الأولى للهجرة. بناء على هذه المعلومات يتمكّن الباحث أن يصنّف المصاحف وفقًا لتاريخ كتابتها (محمدي وتوكلي، ٢٠٢١، ص194 -196).
الطريق الثاني: علم الخطاطة أو علم الكتابات القديمة، ويعادله في اللغات الأوروبيّة مصطلحُ باليوغرافيا، وهي كلمة تتكوّن من جزءين؛ الأوّل palaeo وهو كلمة يونانيّة تعني القديم أو العتيق، والثاني graphy تعني الكتابة أو رسمها أو معرفتها. وكان الباليوغرافيا في البداية يعتني بالوثائق المزوّرة، ولكنّه تحوّل بمرور الزمن إلى علم يبحث في جميع الكتابات والرسوم والنقوش، واختبار المواد المستخدمة فيها، وتحليلها واستنباط النتائج منها. وهو اليوم علمٌ يهتمّ بفكّ الخطوط القديمة ورموز الكتابات الأثريّة والنقوش والمسكوكات (السامرائي، ٢٠٠١، صص17-18). وقد أُخِذ هذا المصطلح من كتاب ألّفه العالم الفرنسي ديمونتفوكن في عام 1708 الميلادي بعنوان «علم الخطاطة اليونانية»، غير أنّ مابيلون هو المؤسّس لعلم الخطاطة في كتابه «عن الوثائق». على الرغم من ذلك، لم يكن علم الخطاطة مجهولًا تمامًا قبلهما، فقراءة أو نسخ المخطوطات القديمة تنمّ عن معرفة عمليّة للخطوط المبكرة لدى القرّاء والنسّاخ (Déroche, et al., 2005, pp. 205 -206).
(101)أما الخطوة الأولى الحاسمة في علم الخطاطة، فهي وضع نظام التصنيف. فيبدأ عالم الخطاطة بمجموعةٍ من الوثائق (يعني المخطوطات) -من الأفضل أن تكون مؤرَّخَة أو لها إمكانيّة ذلك، والأفضل من ذلك أن تكون دالة على أصولها الجغرافيّة- تُظهر سمات رسوميّة مماثلة ليدرس شتّى أنواع الكتابة. ثم يفحصها بدقّة وبشكل انتقاديّ؛ ليُخرج ما هو أجنبيّ عن هذه المجموعة. ثم في المرحلة التالية، يستطيع عالمُ الخطاطة أن يحدّد السمات المميزة للخط. وأخيرًا يضع حدودًا زمنيّة -ومتى أمكن- وجغرافيّة للوثائق استعانةً بالإشارات التي يجدها -مثل الوقفيات أو حرد المتن أو الإجازات- أو المواصفات المادية للمخطوط (ibid., p. 208).
قيل إنّ أدلر هو أوّل مستشرق عكف على دراسة الخطاطة العربيّة وتاريخ الخط العربي عن طريق المخطوطات القرآنيّة في القرن الثامن عشر للميلاد. فكان يراجع المخطوطات القرآنيّة -والتي كُتبت بالخط الكوفي- في المكتبة الملكيّة بكوبنهاغن. ثم واصلَ سبيلَه سيلوستر دي ساسي وحسّن منهجَه أماري. ولكن أوّل دراسة ممنهجة ومذهلة لعلم الخطاطة العربيّة حول المخطوطات القرآنيّة أنجزها ديروش في عام 1983 الميلادي بعنوان «فهرس المخطوطات القرآنيّة في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة». ومخطوطاته الحجازية تُعدّ من أقدم أساليب الخط العربي. ترتكز دراسة ديروش على أكبر مجموعة من المخطوطات القرآنيّة القديمة، إذ صنّفها في 26 قسمًا (أربعة أقسام حجازية واثنين وعشرين قسمًا كوفيًا)، ولكنها قد لا تشتمل على المخطوطات التي سوف تُستكشف في المستقبل (Marx & Jocham, 2019, pp. 192 -193).
إلى جانب المساعي التي بذلها ديروش في تصنيف المخطوطات وترتيبها الزمني، لا يخلو هذا الفهرس من مشاكل؛ فعلى سبيل المثال: الخط المستخدَم في بعض
(102)القِطَع لا مكانة له في تصنيفه. وهناك مخطوطات -على الرغم من قِدَمها- يجب أن تُصنّف من القسم الكوفي. وسبع قِطَع من مكتبة برلين الحكوميّة صُنّفت من القسم الحجازي، إلّا أنّ نوعها غير واضح. لذلك بناءً على المخطوطات القرآنيّة المستجدّة في الوقت الراهن تحتاج دراسةُ الخطاطة التي قام بها ديروش أن تخضع للتعديل والتوسيع والتحسين (ibid., p. 193).
ولديروش فهرسٌ آخر أعدّه للمخطوطات المحفوظة في مجموعة ناصر داود خليلي بعنوان «التقليد العباسي»، وهو يضمّ 98 مخطوطة قرآنيّة تعود إلى ما بين القرن الثامن والعاشر للميلاد، ومعظمها قِطع قد لا تتجاوز ورقة واحدة أو تعرّضت لأضرار جسيمة. ركز فيه ديروش على الملامح المميّزة لبعض الأحرف دون غيرها، وهذا الأسلوب يلقي الضوء على السمات الرئيسيّة للخط، ويتجنّب التحليل العاطل المبني على الحروف كلّه (Soucek, 1999, p. 129). ويُعدّ هذا الفهرس من المراجع في تقدير عمر المخطوطات القرآنيّة على أساس دراسة باليوغرافية، فنتناول باختصار شديد كيفيّة تصنيف ديروش للمخطوطات.
أما ديروش، فيصنّف مخطوطات مجموعة خليلي في ثلاثة أقسام رئيسة؛ ثلاثة مخطوطات من الخط الحجازي، و71 مخطوطا من الخط العباسي المتقدّم، والمخطوطات المتبقّية -أي 24 مخطوطًا- تعتبر من الأسلوب الجديد. تشبه الحروفُ الحجازية النقوشَ المكتوبة قبل الإسلام، [لذلك] تُعدّ أقدم خط استخدمه النسّاخ لكتابة القرآن. ومما يلفت الانتباه هو أنّ المصاحف الحجازيّة عموديّة، بخلاف المصاحف الأخرى من القرن الثامن إلى القرن العاشر للميلاد، فهي أفقية
(ibid., p. 130). وإليكم نموذج من المخطوط الحجازي (Déroche, 1992, p. 30):
صورة 25: مصحف حجازي من مجموعة ناصر خليلي للفن الإسلامي برقم KFQ 60
(104)
والقسم الثاني من المخطوطات هي ما سمّاها ديروش بالخط العباسي المتقدّم، بدلًا ممّا اصطلح عليه المستشرقون في القرنين الثامن والتاسع عشر للميلاد بالخط الكوفي؛ لأنّ تلك التسمية توحي بأنّ الخطّ الكوفي يرجع أصله إلى الكوفة، ولكن هذه العلاقة غير ثابتة، بينما كان هذا الخطّ مستخدَمًا في منطقةٍ واسعةٍ ولفترةٍ طويلةٍ من الزمن. إذًا، تسمية ديروش تتكفّل بهذين الأمرين، أي المكان والزمان. يقسّم ديروش الخطّ العباسي المتقدّم إلى ستة أقسام (من حرف A إلى حرف F)، ثم يقسّم هذه إلى أقسام فرعيّة أخرى يعتبرها متزامنة لا متتابعة (Soucek, 1999, p. 130). وإليكم نموذج من المخطوط الكوفي (Déroche, 1992, p. 55):
صورة 26: مصحف كوفي (عباسي متقدم) من مجموعة ناصر خليلي للفن الإسلامي برقم KFQ 13
لقد شهد القرن العاشر الميلادي تغيّرًا مهمًّا في صناعة الكتب، إذ تم استبدال
(105)الرقّ بالكاغد والكتب الأفقيّة بالعموديّة، وظهرت في هذا القرن خطوط جديدة لكتابة القرآن الكريم، سماها ديروش بالأسلوب الجديد. وكانت تسمّى هذه الخطوط فيما سبق بالخط الكوفي الشرقي والغربي والمائل (Soucek, 1999, p. 131). وهذا هو القسم الثالث من المخطوطات التي فهرسها ديروش، وإليكم نموذج منها (Déroche, 1992, p. 144):
صورة 27: مصحف من مجموعة ناصر خليلي برقم QUR286
وجدير بالذكر أنّ هذا الكتاب -أي التقليد العباسي- على الرغم من نفعه في تقدير المخطوطات الحجازيّة لقصر فترتها وقلّة مخطوطاتها، قد لا يهدي الباحث في مجال المخطوطات العائدة إلى ما بين القرن الثالث والسابع للهجرة إلى تقدير يجدي. والمشكلة الأساسيّة هي أنّ ديروش لم يصنّف المخطوطات تصنيفًا زمنيًّا، وثمة حقائق تاريخيّة تعارض هذا التسلسل، كما توجد مخطوطات تعود إلى زمن متأخّر بينما وضعها ديروش من القسم الثاني أو العكس (محمدي وتوكلي، ٢٠٢١، صص204 -205). فهذا الكتاب أيضًا يفتقر إلى التعديل والتحسين حسب ما تمّ استكشافه من المخطوطات القرآنيّة منذ تأليفه.
(106)الطريق الثالث: التحليل الكربوني المشع، وقد صار هذا الطريق محطّ اهتمام للإعلام والصحف إلى الدرجة التي صار فيها البعضُ يزعم أنّ نتائجَ هذا الطريق محتومة لا ريب فيها، إلّا أنّ الحقيقة بعيدةٌ عن هذا الطريق كلّ البعد، ويجدر الحديث عن هذه الطريقة ودقّتها وتحدياتها لتتّضح نجاعتها في تأريخ المصاحف الشريفة ومصداقيّة نتائجها. أمّا الاختبار الكربوني المشع فهو أحد طرق التأريخ المطلق، وهي طرق ترتكز على التحلّل الإشعاعي، حيث يتحوّل العنصر المشعّ إلى عنصر مستقرّ بمعدّل ثابت، وتُعوَّل على نتائجها إذا كانت ملائمةً للتأريخ النسبي (Lerner, et al., 2004, pp. 1154 -1155). لقد حقّق إدراك العلماء للنشاط الإشعاعي في القرن العشرين ازدهارًا في جملة من الطرق للتأريخ على أساس النظائر الإشعاعي المنشأ، وخاصّة أنّ التطوّر في الفحص الكربوني المشع في عام 1949 للميلاد أنتج مئات الآلاف من تقدير الأعمار لعلماء الآثار (Rink & Thompson, 2015, p. xxvi).
تم تطوير تقنية التأريخ بالكربون المشع على أيدي فريق يترأسه الكيميائي الأمريكي ويلارد ليبي في أواسط القرن العشرين للميلاد. تُستخدم هذه التقنية لتقدير أعمار البقايا العضويّة أو قطع أثريّة لها أصل بيولوجي، ويرتبط هذا الأمر بالدورة الكونية للكربون في الغلاف الجوي للأرض، حيث يتكوّن الكربون المشع نتيجةً لتفاعل الأشعة الكونيّة -وهي جسيمات مشحونة ذات طاقة عالية تأتي من الشمس والفضاء الخارجي وتصطدم بالطبقات العليا من الغلاف الجوي- مع ذرات النيتروجين وتتحوّل إلى الكربون المشع. وبعد ذلك يتأكسد الكربون المشع وتتحوّل إلى ثاني أكسيد الكربون. ومن ثمّ يدخل في المجال الحيوي عبر التمثيل
(107)الضوئي للنباتات. ويستمر التوازن بين امتصاص الكربون المشع وتحلّله في الكائن الحي حتى موته. وبعد موت النبات -أو الحيوان الذي أكلَه- يضمحلّ الكربون المشع وتتقلّص نسبته، بينما الكربون المستقر نسبته ثابتة. إذًا الفحص الكربوني المشع يعتمد على قياس النسبة المتبقّية من الكربون المشع والمستقر في العيّنة (السامرائي، ٢٠١٨، صص596 -598)، وهناك صيَغ رياضية تقدَّر بها عمر العينة، توجد تفاصيلها في شتى الكتب المؤلّفة في هذا المجال.
يُجرى الفحص الكربوني المشع عادة بواسطة جهاز يسمّى مطياف الكتلة المسرّع، وهذا الجهاز يَقدر على قياس كتلة نظائر النويدات المشعة والمستقرة -وخصوصًا الكربون- في العيّنة، وميزته المتفوّقة -مقارنةً بالطرق الأخرى للاختبار الكربوني- هي استخدام عيّنات صغيرة لا تتجاوز بضعة ميليجرام، ويمكن الحصول على النتيجة خلال فترة وجيزة من الزمن (Hellborg & Skog, 2008, p. 398)، غير أنّه مكلِفٌ جدًّا.
جديرٌ بالذكر أنّ الفحص الكربوني المشع يقدّر العمرَ على أساس التقويم الكربوني، وهذا لا يوافق التقويم السنوي ولا يوجد علاقة ثابتة بينهما في الفترات الزمنيّة المختلفة. لذلك تقتضي الحاجة إلى منحنى المعايرة (Aitken, 1991, p. 7). الحقيقة هي أنّ العلماء أدركوا منذ سنة 1950 الميلادية أنّ نسبة الكربون المشع في الغلاف الجوي لم تكن ثابتةً على مرّ التاريخ، فحاولوا إخراجَ منحنى المعايرة ليمكّنهم من تحويل التقويم الكربوني إلى التقويم السنوي، وأكبّت لجان من علماء الآثار على دراسة نسبة الكربون المشع في أرجاء الكرة الأرضيّة من منطلق علمهم بأنّ النسبة تختلف من نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي (Hogg, et al., 2020, p. 759)، كما تختلف نسبة الكربون المشع في الغلاف الجوي عن تلك النسبة في البحار (Heaton, et al., 2020, p. 779). فاستطاعوا إخراجَ منحنيات
(108)معايرة وتحسينها منذ إعداد إصدارها الأول في عام 1960 للميلاد إلى إصداره الأخير في عام 2020 للميلاد، وهذا الأخير -وهو يرتكز على دراسة زمنيّة لحلقات الأشجار، ورواسب البُحيرات والمحيطات، والإرسابات المتدلية، والمرجانيات- يتيح الإمكانية لتقدير أعمار الأشياء التي تعود إلى ما يناهز 55 ألف سنة (Reimer & et al., 2020, p. 726).
وبغية التقريب إلى الذهن نضرب مثالًا للتأريخ الكربوني الذي أجري على مصحف قديم، وهو مخطوط على ورق البردي يُحتفظ به في مكتبة لايدن برقم Or. 8264، وخُضع للفحص في مختبر زوريخ برقم ETH -54173، ونتيجة الفحص الكربوني هي: . ثم إن طُبّقت نتيجة الاختبار الكربوني -أي عمر المخطوط حسب التقويم الكربوني- (المنحنى الأحمر) على منحنى المعايرة (الخط المتموج الأزرق)، ستكون النتيجة النهائيّة (المحني الرمادي) عمر المخطوط التقريبي حسب التقويم السنوي، كما تشير إليه المعلوماتُ التي كُتبت في الأعلى اليمين من الصورة أدناه (Youssef -Grob, 2019, p. 154).
صورة 28: منحنى المعايرة للمخطوط القرآني برقم Or. 8264
(109)وعلى ضوء ما تقدّم عن الاختبار الكربوني المشع، من الممكن تقييم نتائجه ومصداقيتها ودقّتها في تأريخ المخطوطات القرآنيّة القديمة، فثمّة ملاحظات عنها:
الأولى، تتحيّز النباتات ضدّ ثاني أكسيد الكربون الذي يحتوي على الكربون المشع، فتمتصّ كميّة أقلّ منه، لذلك تظهر نتائج الاختبار عمرًا أكبر من العمر الحقيقي لهذه النباتات. فضلًا عنه، فإنّ النباتات تختلف من نوع إلى آخر من حيث امتصاص الكربون.
والثانية، انخفضت نسبة الكربون المشع في الغلاف الجوي بعد عصر الصناعة جرّاء الاستخدام المتطرّف للوقود الأحفوري -والذي أدّى إلى زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي لا يحتوي على الكربون المشع- وهذا ما يجعل تقدير الأعمار أكبر من الواقع. كذلك الاختبارات النوويّة زادت الطين بلّة وأدّت إلى المزيد من الكربون المشع في الغلاف الجوي. علاوة على هذه التدخّلات البشريّة في البيئة، فإنّ التفاعلات الطبيعيّة -مثل الأشعة الكونيّة والتغيّرات المناخيّة- أثّرت في نسبة الكربون في الغلاف الجوي، لذلك فنسبة الكربون كثيرة التقلّب على مرّ التاريخ.
والثالثة، إنّ تلوُّث العيّنة التي يُجرى عليها الاختبار بالتربة أو المواد المستخدمة لترميم المخطوط يسبّب تغييرَ نسبة الكربون المشع وغيره في العيّنة، ويقلّل من دقّة نتائج الفحص الكربوني. كما يدخل تارة جزءٌ من الكربون عن طريق المحيطات إلى العيّنة، ويجعل نتائج الاختبار مريبة.
والرابعة، تختلف صناعة الرقوق في المشرق الإسلامي عن مثيلتها في المغرب الإسلامي، ولكلّ منهما منهج ومواد لا تماثل الآخر، ولهذه المناهج المتعدّدة والمواد المتنوّعة أثرٌ كبير على نتائج الاختبار الكربوني، فلا يمكن اعتبارها التاريخ المضبوط لزمن صناعة الرقوق؛ إذ هي متكوّنة من مواد تختلف نسبة الكربونات فيها من مادة إلى أخرى، ويؤدّي ذلك إلى دقّة منخفضة للفحص الكربوني المشع (السامرائي، ٢٠١٨، صص600 -608). لذلك التأريخ الكربوني المشع للمخطوطات على الجلد أكثرُ غموضًا من المخطوطات على ورق البردي؛ لأنّ:
1) ورق البردي نبات قصير العمر ويسهل قياس مستوى الكربون المشع في
(110)أليافه السلولوزيّة. بينما الجلد -والذي يُصنع منه الرق- نتاج حيوانيّ مركّب، لكن مستوى الكربون المشع يتعلّق غالبًا بالأعشاب.
2) يعود أصلُ معظم أوراق البردي إلى مصر، وهذه المعلومة تنفع في تطبيق منحني المعايرة، بخلاف الرقوق، فإنّ أصلها غير معروف، وإن كان أصلها معروفًا فليس هناك دراسات تختصّ بنسبة الكربون المشع المتواجدة في الشرق الأوسط [بغية إعداد منحني المعايرة لهذه المنطقة].
3) لا تُستخدم المواد الكيميائيّة في صناعة أوراق البردي ليؤثّر على نسبة الكربون المشع فيها. إضافة إلى ذلك، يُجرى الاختبار الكربوني على جزء من هامش الرق، والهوامش عادة ما أكثر تلوّثًا من باقي الورقة (Youssef -Grob, 2019, pp. 163 -165).
والخامسة، يُظهر التأريخ بالكربون المشعّ -للحد الأقصى- تاريخ ذبح الحيوان الذي صُنع من جلده الرق، دون الافتراض بأنّ المخطوط كُتب مباشرةً عليها بعد ذبحه (Blair, 2020, p. 221).
والسادسة، قد يحدث الخطأ في عدّ الجسيمات بيتًا، فيتمّ الإعلان عن نتيجة الفحص مرفقًا بنسبة الدقّة في الاختبار. لذلك نتيجة تقدير العمر فترة زمنيّة محتملة. وهذه الفترة قد تزيد على قرن أو قرنين، وهذا يعني عدم الحتميّة لهذه الفترة الطويلة. ولكن النتيجة قد تكون أكثر دقّةً وتقلّ إلى فترة تناهز عشرين سنة (وحیدنیا، ١٣٩٧، صص111 -113).
والسابعة، تختلف أحيانًا نتائج الفحص الكربوني في مختبرات شتّى اختلافًا شاسعًا، فعلى سبيل المثال، تمّ تأريخ عيّنات من مخطوط صنعاء DAM 01 -27.1، فبعض المختبرات أرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجري، والبعض أرجعه إلى -قرنين قبل الهجرة (المسيح، ٢٠١٧، ص196)!
فهذه الملاحظات -فضلًا عن الملاحظات التخصّصيّة في علم الكيمياء حول الاختبار الكربوني- تجعل التأريخ بالكربون المشع موضع ريب وشكّ، كما يشدّد
(111)بعض الباحثين على توخي الحيطة والحذر في نتائجها (Déroche, 2014, p. 11). إذًا الأفضل ألّا يُزعم نتيجة التحليل الكربوني تاريخًا مضبوطًا للمخطوطات القرآنيّة، بل هي تاريخ يثبِت قِدَم المخطوط على وجه التقريب، وما أشدّ هذا التقريب!
وحريّ بالذّكر أنّ التحديات التي يواجهها تأريخ الرقوق القرآنيّة دفع بعض المستشرقين إلى البحث عن طريق لتأريخ الحبر الذي كُتب به المخطوط. ولكن لا توجد لحدّ الآن أساليب علميّة لتأريخ الحبر الذي لا يرتكز على السخام، ولا ينجح قياس ذلك الحبر لأجل الكميّة [الكبيرة] المفتقرة إليها للاختبار (Marx & Jocham, 2019, p. 207). إضافة إلى ذلك، من الأفضل خلوّ العيّنة -أي الحبر- من الملوّثات للحصول على تأريخ أدقّ. والحقيقة هي أنّ عمليّة إزالة الملوّثات قد تُلحق أضرارًا بالرقّ وتدمّره لأجل كشط الحبر منه، وإن تُهمل العمليّة ستكون النتيجة غير أكيدة (السامرائي، ٢٠١٨، ص 612). فلا طريق إلى تأريخ دقيق للحبر في الوقت الراهن.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنّ هناك طرقًا أخرى للتأريخ في علم الآثار -مثل التأريخ بواسطة ترازم الحمض الأميني أو نسبة الكاتيونات أو التألق الحراري، أو استخدام عناصر مشعّة أخرى للتأريخ نحو يورانيوم وكالسيوم وألومنيوم- ولكن لا نعرف إلى الآن من يطبّق هذه العمليات على المخطوطات القرآنيّة، وستبدي لنا الأيام ما كنا نجهله.
والطريق الرابع، متفردات رسم المصحف، وهذا الطريق -وهو يظلّ مغفولًا عنه في الدّراسات الغربيّة حول المخطوطات القرآنيّة- لم يشر إليه بروبيكر. والمقصود بذلك هو الاستعانة بقواعد رسم المصحف في تقدير عمر المخطوط القرآني بعد توظيف
(112)الطرق السابقة ذكرها، وذلك أنّ الدّراسات الاستشراقيّة أظهرت الخلاف البيّن بين ما نقله علماء الرسم -لا سيّما أبي عمرو الداني (م. 444) وأبي داود سليمان بن نجاح (م. 496)- وبين المصاحف الحجازيّة القديمة الموجودة بأيدينا اليوم. فعلى الرغم من الكلمات التي رُسمت في تلك المصاحف على أساس أحد الوجوه التي ذكرها الشيخان، هناك كلمات لا توافق الرسم العثماني بالمرة. بناء على ذلك، يمكن القول بأنّ المصحف الذي تكثر فيه المتفردات -أي التي لا توافق ما رواه علماء الرسم عن المصاحف القديمة- يكون أكثر قدمًا (محمدي وتوكلي، ٢٠٢١، صص209 -210).
وخلاصة ما تقدّم عن طرق تأريخ المخطوطات القرآنيّة هي أنّه لا يوجد إلى حدّ الآن طريقٌ للوصول إلى عمر المخطوط أو زمن كتابته على وجه التحديد، إلّا ما التحق بالنسخة من حرود المتن، إن لم يثبت أنّها موضوعة. والتأريخ التقريبيّ تارة خاطئ وتارة لا يجدي نفعًا؛ لطول فترته المقدَّرة. إذًا يجب ألّا يقطع الباحث بالأعمار المقدَّرة للمخطوطات، بل لينظر إليها كدليل على قدم النسخة لا عمرها الأصلي.
استخدم بروبيكر -حسب رأيه- مصاحف مخطوطة ذات أصالة ومنشأ موثوق به؛ لأنّها تُحفظ في المكتبات المعتمَد عليها، وهذا ما يضمن مصداقيّة المخطوطات التي استند إليها، ولو افترضنا صحّة ما ادّعاه، فجدير بالذكر أنّ المخطوطات القرآنيّة التي كان يقرأها الناس ويستفيدون منها بغية التعليم والتعلّم أصبحت باليةً أو تعرّضت للتلف بمرور الزمن، وفي المقابل المخطوطات التي وُقفت على المساجد والعتبات المقدّسة حُفظت في وضع أفضل (Blair, 2020, p. 218). إذًا، لا يُستبعد أنّ المصاحف المبكرة التي بنى بروبيكر عليها فرضيّته، لم تكن في الدرجة الأولى من القيمة والأهميّة لدى المسلمين القدماء، حيث بقيت سليمة من التلف، رغم الظروف الطقسيّة التي مرّت بها في غابر الأيام؛ لأنّها كانت متداولةً بين المسلمين، إذ لم يُخترع بعدُ جهاز الطباعة حتى يطبع المصحف الشريف إلى ما
(113)يشاء ويُحتاج، فكان عدد المصاحف قليلا آنذاك، ولم يكن -كما في الوقت الراهن- المصحف الشريف متوفرًا في كلّ بيت من المؤمنين، فكان على من يريد قراءة القرآن الكريم أو التبرك به أو غيرهما من الشعائر الدينيّة أن يراجع المصاحف المخطوطة الموجودة في المساجد والمواقع المقدّسة، أو يستعيرها لمدة من الأيام، ولذلك كانت هذه المصاحف عرضةً للتلف والهلاك، ومن المتوقّع أن تكون هذه المصاحف المخطوطة المبكرة بالية أو غير قابلة للاستخدام.
وأمّا المصاحف القديمة التي بين أيدينا وأُنقِذت من الظروف الطارئة عليها، فكانت أقلّ استخدامًا من غيرها التي لم تصل إلى يومنا هذا، فلربّما كانت الأخطاء الواردة فيها سببًا لتركها في مسجد أو مكتبة دون تدنيسها أو الرجوع إليها بكثرة كما يُرجع إلى غيرها، وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام عند دراسة هذه المصاحف المبكرة، كما تجيب عن سؤال بروبيكر لمَ المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار لمْ يبقَ أثر منها، لأنّها كانت في متناول أيدي الناس، ويتشرّف بها المسلمون الذين أدركوا قيمتها الغالية، ولم تكن هذه المصاحف في واجهات المتاحف ينظر إليها المؤمنون من وراء الزجاج، فأصبحت لم يعد يُقرأ ما عليها وتمزّقت أوراقها عندما تناقلت بين أيدي الناس، فلا يوجد أثر منها بعد مرور أربعة عشر قرنًا من كتابتها.
يرى بروبيكر أنّ رسم المصحف والقراءات القرآنيّة مختلفان تمامًا، لا تأثُّر لأحدهما بالآخر، ولكن التراث الإسلامي فيما يخص الرسم والقراءات يعارض هذه الرؤية المتسرّعة؛ فقد أكّد العلماء المسلمون من السلف والخلف على العلاقة الوثيقة القائمة بينهما وجعلوا موافقة القراءة للرسم معيارًا لقبولها (ابن الجزري، لا ت.، ج 1، ص9)، كما حرّموا مخالفة الرسم (الطبري، ١٤٢٢، ج 1، ص347) ورفضوا الحروف التي تعارضه (الفراء، ١٩٨٠، ج2، صص293 -294)، وعند الترجيح بين الاختلافات اللغويّة في المفردات القرآنيّة اتّخذوا الرسم حجة فيما بينها (ابن
(114)خالويه، ١٤٠١، ص81)، كذلك القرّاء أنفسهم عرضوا قراءاتهم على أهل المعرفة بها وتركوا منها ما لم يوافق رسم المصحف وإن كان ملائمًا لإحدى اللغات العربيّة (ابن سلاّم، ١٤١٥، ص361).
وقد أظهر بعض الباحثين مدى تأثّرِ القراءة بالرسم وعكسه، فقسّموا ذلك إلى ثلاثة أقسام: الأوّل، قد يكون أكثر من قراءة ويتحمّله رسم واحد، ومثاله قراءة «مَلِكِ» و«مَالِكِ»، ويتحمّلهما «ملك»، وهذا هو الأكثر؛ والثاني، قد يكون أكثر من قراءة واكتُفي برسم واحد منها، مثل قراءة «يَبْسُطُ» و«يَبْصُطُ»، ويتحمل الرسمُ الثانيَ فقط؛ والثالث، قد يكون أكثر من قراءة ونُقل لكلّ منها رسم في الآثار، نحو قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر «وَأَوْصَىٰ»، خلافًا لقراءة الباقين «وَوَصَّىٰ» (مستفيد وتوكلي، ١٣٩٦، صص120 -124). ومن المستغرب أنّ بروبيكر أشار إلى نموذج من تأثّر الرسم باختلاف القراءة في النموذج السابع من كتابه -أي زيادة الألف قبل «لِلَّهِ» في قوله تعالى: «سَيَقُولُونَ لِلَّهِ» - وزعمه تصحيحًا في المخطوط! وما تقدّم آنفًا يُعبّر عن بطلان ما زعمه بروبيكر، وكأنّه لم يراجع المصادر الإسلاميّة لمعرفة الحقيقة الثابتة حول ما ادّعاه في كتابه، أو تجاهلها بغية إثبات دعواه.
ادّعى بروبيكر في مقدّمة كتابه أنّه وجد التصحيحات الواردة في المخطوطات القرآنيّة تتّجه نحو الموافقة لمصحف القاهرة 1924 (أي المصحف الأميري)، إلى جانب دعواه بشأن المرونة في النّصّ القرآنيّ في القرون المكبرة، وهذا يكشف عن افتراضه المسبق أنّ النّصّ القرآنيّ الشريف لم يكن مثبَّتًا ومحدَّدًا في القرون الماضية، وقد استكمل وتطوّر عبر الزمن حتى تجلّى بشكله النهائي في المصحف الأميري الذي أعدّه جماعة من علماء الأزهر سنة 1924 للميلاد، ولكن هذه الفرضيّة تعاني من مشاكل عدّة:
المشكلة الأولى، كيف جازت المرونة في النّصّ القرآني ورسول الله صلىاللهعليهوآله الذي نزل عليه القرآن الكريم لم يسمح لنفسه أن يغيّره من تلقاء نفسه: (قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِٕ نَفْسِيٓ) (يونس: 15)، وقد أوعده الله بالعذاب واستعجال
(115)العقوبة إن زاد في القرآن شيئًا من عنده: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ) (الحاقة: 44 -46)، وضمنَ ألّا يكتم شيئًا مما أنزله عليه فيخلو القرآنُ منه: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) (التكوير: 24). وعليه، كيف يعقل أنّ النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله -حسب ما قاله بروبيكر- يسمح للمسلمين بالزيادة والنقص -أو ما يسميه بروبيكر بالمرونة- في النص القرآني، ولا يجوز ذلك لنفسه المباركة؟! وبغضّ النّظر عن الآيات القرآنيّة -ولو افترضنا القرآن كتابًا اختلقه رسول الله صلىاللهعليهوآله- هل يوجد عاقل يسمح لغَيره أن يغيّر ما ألفّه كما يشاء؟!
علاوة على ذلك، لقد رفض العلماءُ المسلمون من مختلف المدراس والفرَق منذ أمد بعيد إلى العصر الحاضر أيّ زيادة أو نقص في الكلام الإلهي رفضًا صارمًا، وقد صرّح ببطلان دعوى التحريف في النص القرآني جملة من علماء الشيعة (انظر: معرفت، ١٣٧٩، صص55 -72) وأهل السنة (عياض، ١٤٠٩، ج 2، صص304 -305)، ناهيك عن أن يسمح أحد منهم بذلك. فلو كان هناك درجة كبيرة من المرونة في المصاحف المبكرة مقارنة بما في أدب القراءات واختلافها -كما ادعى بروبيكر- فلمَ لمْ تنعكس هذه المرونة في مؤلفاتهم ولمْ ينبسوا ببنت شفة عن وجودها في عصرهم؟ بعبارة أخرى، كيف اقتصرت تلك المرونة المزعومة على المصاحف المخطوطة القديمة ولا يوجد أثر لها في الكتب الأخرى المرتبطة بالقرآن الكريم ونصّه الشريف، فلمْ يصرّح أحد من العلماء المسلمين بجواز الزيادة والنقص في القرآن لمن يريدهما؟ وكيف كانت المرونة جائزة في الزمن الماضي البعيد وانتهت مدّة جوازها بعد إعداد المصحف الأميري في عام 1924 للميلاد، ولا يسمح العلماء المتأخرين بها على الرغم من وجودها لدى المتقدمين؟!
إذًا، ليس ما عثر عليه بروبيكر في المخطوطات القرآنيّة المبكرة مرونة في النص القرآني الشريف، بل هو إمّا تحريف قام به نسّاخ المخطوطات من عند أنفسهم أو هو أخطاء نسخيّة لا يُعبأ بها. أمّا الاحتمال الأوّل فلا يمكن تصديقه؛ لأنّ التحريف عمل متعمّدٌ وعن وعي، ومن المستبعد جدًا أن يرتكب ذلك ناسخ من المسلمين
(116)والذي يؤمن بقداسة القرآن المجيد ولا يتجاسر أن ينتهك حرمته، إلّا أن يكون الناسخ منافًقا لا يخشى الله أن يدسّ في كلامه الشريف أو يكون مرتزقًا لحاكم من الفسّاق والمعادين للإسلام، وإن كان كذلك أيضًا لن يتوغل التحريف في القرآن الكريم؛ لأنّ الناسخ إن كان منافقًا حرّف النص القرآنيّ كما طاب له، فسيُدرك التحريفَ مَن يقرأ ذلك المصحف المخطوط، فإمّا يصحّح التحريف الذي يجده وإما يردّ النسخة على ناسخها أو يترك ذلك المصحف المحرَّف إلى جانب حتى لا يتناوله أحد فيضلّ به. وإن كان الناسخ مرتزقًا لحاكم فاسق لا يتّقي الله أن يدنّس الوحي الإلهي، فلن يكون قادرًا على تحريف القرآن أبدًا؛ لأنّه يستطيع أن يستأجر عددًا من النساخ حتى يحرّفوا له القرآن كما يحلو له، وينشر بضعَ نسَخ منها في بعض المناطق من العالم الإسلامي، غير أنّ القرآن الكريم أصبح منتشرًا في بقاع الأرض منذ تدوينه في عهد عثمان بن عفان، وكان يقرأه المسلمون ليل نهار، ويحفظ جمّ غفير منهم آياته المباركة عن ظهر قلوب، فلم يعد أحد بعدُ بقادر على تحريفه دون أن يدرك أحد ذلك، إلا أن يجلب جميع المصاحف المخطوطة من مختلف المدن والأمصار، إضافة إلى كتب التفسير وغيره مما يحتوي على نص القرآن، ثم يضرم فيها النار ويقتل جميع حفاظ القرآن، وأخيرًا يدوّن مصحفًا آخر ينشره كبديل منها، ولا توجد في التاريخ إشارة إلى هذا الحادث، ومع أنّ له من الأهمية البالغة لكان على المؤرخين أن يسجّلوا ذلك بالتفاصيل، وبما أنّهم لم يقرّروا ذلك رغم توفّر الدواعي وفقدان الموانع، فلم يحدث شيء على أرض الواقع.
بناء على ذلك، يُطرد الاحتمال الأوّل -أي نعتبر المرونة المزعومة تحريفًا على أيدي نسّاخ المصاحف- ولا يعتدّ به. أمّا الاحتمال الثاني -أي نعتبر ما عثر عليه بروبيكر أخطاء نسخيّة في المخطوطات القرآنيّة- فلا يمكن إنكاره؛ لأنّه أمرٌ طبيعيٌّ وليس من المستبعد -بل هو شائع- أن يرتكب كلّ مَن يستنسخ نصًّا من أصل إلى نسخة أخرى عدّة أخطاء أثناء عمله. ولذلك كان النسّاخ يعارضون المصاحف المخطوطة التي كتبوها بالأصل الذي استنسخوا منه، أو يقرأونها على شخص آخر ليتأكدوا من صحّة ما أنجزوا، وكانوا يصحّحون ما يجدون فيها من الأخطاء، وإن نسوا ذلك لقام
(117)الآخرون الذين يقرأون هذه المصاحف بتصحيحها على أساس القرآن الذي كان عندهم موروثًا من الأجيال السالفة. وبما أنّ الأخطاء النسخيّة شيءٌ معتادٌ، يقع في كلّ مخطوط -مهما كان ذلك- فلا يُعبأ بها ولا يدلّ على التحريف أبدًا، كما يعدّ تضخيمها والكتابة عنها عملًا عبثًا.
وعلى أساس ما تقدّم، يتبيّن أنّ ما عثر عليه بروبيكر وسمّاه مرونة في النّصّ القرآنيّ ليس كذلك؛ بل وإن ثبت أنّه عثر على مصحف محرَّف لا يوافق النّصّ القرآني في العصر الراهن فلا يُثبت التحريفَ في القرآن، إذ هو مصحف واحد -أو للحد الأقصى عدد ضئيل من المصاحف- ويُترك إلى جانب. كذلك التصحيحات التي اتّجهت نحو الموافقة للمصحف الأميري -وفقًا لِما قاله بروبيكر- لا تدل على مؤامرة النسّاخ على إعداد مصحفٍ جديدٍ أو تحريف ما كان في السابق، بل يكشف عن وجود النصّ المعيار عندهم، فكانوا يصحّحون الأخطاء على أساس ذلك، وهو الذي يوافق المصحف الأميري المطبوع عام 1924 للميلاد.
ويبقى تساؤل آخر، وهو أليس اختلاف القراءات دليلًا على المرونة في القرآن؟ قد أشير فيما سبق أنّ بروبيكر يعتقد بدرجة أكبر من المرونة مما في مصادر القراءات واختلافها؛ فإنّ ما عثر عليه -في الأعم الأغلب- لا يوافق أي قراءة عثمانيّة ولا شاذة، بل أحيانًا هو خطأ يخلّ بالمعنى. وهذا الأخير أيضًا يؤيّد أنّ ما وجده بروبيكر ليس تحريفًا متعمّدًا في القرآن، فلا يعقل أن يحرّف أحد كلامًا بحيث لا يفيد أي معنى! بل هو مجرّد خطأ نسخيّ. أما إذا افترضنا المرونة هي نفس اختلاف القراءات فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول، أنّ علماء أهل السنة والجماعة لا يرون بأسًا بهذا النّوع من المرونة؛ إذ رووا عن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف (البخاري، ١٤٢٢، ج 6، ص184)، فهذه القراءات القرآنيّة كلّها منزّلة من عند الله سبحانه، وكلّما كانت المرونة في هذا النطاق فهي مقبولة. والثاني، أنّ علماء الشيعة رووا عن أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله أنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيئ من قبَل الرواة (الكليني، ١٤٠٧، ج 2، ص630)، والسبب في ذلك هو أنّ الخطّ العربيّ لم يكن ناضجًا في صدر الإسلام، كما لم يكن النّصّ القرآنيّ مشكَّلًا أو منقَّطًا بالكامل -كما يظهر
(118)ذلك من صور المصاحف التي استخدمها بروبيكر في كتابه- وهذا ما أثار الاختلاف في قراءة الكلمات والحروف (مستفيد وتوكلي، ١٣٩٦، صص76 -77)، وأصبح تدريجيًّا كسنّة متّبعة تقتصر فيها القراءات الرسميّة.
والنتيجة هي أنّ النماذج التي عثر عليها بروبيكر لا تعدّ مرونةً في المصاحف المخطوطة المبكرة؛ فإنّها إمّا هي تحريف وقع في مصحف أو عدّة مصاحف قليلة لا تُثبت توغّل التحريف في القرآن الكريم، كما أنّ الرجل الذي يقرأ القرآن لا يعدّ محرّفًا للقرآن، إلا أن يتّبعه جميع المسلمين، فلا يبقي القرآن إلّا أن يُقرأ مثله خطأ، وإما هي أخطاء نسخيّة لا تطعن في القرآن، كما هي متداولة في كلّ مخطوط يكتبه الإنسان.
المشكلة الثانية، دعوى اتّجاه التصحيحات في المخطوطات القرآنيّة نحو المطابقة لمصحف القاهرة 1924 (أو الأميري) تعارض كيفيّة إعداد هذا المصحف؛ فإنّ المصحف الأميري -كما ورد في «التعريف بهذا المصحف الشريف» في نهاية المصحف المطبوع- تمّت كتابته على أساس ما نقله علماء الرسم عن المصاحف التي بعثها عثمان إلى الأمصار، والمقصود بذلك التقارير التي رواها أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني وأبو داود سليمان بن نجاح عن المصاحف العثمانية، وهي أقدم المصاحف المخطوطة، ولكنّها لم تصل إلى يومنا هذا. وعليه، فدعوى بروبيكر باطلة:
فإمّا نصدّق ما رواه أبو عمر وأبو داود في كتبهما، وعلى هذا الأساس فالمصحف الأميري تم إعداده مبنيًّا على أقدم المخطوطات القرآنيّة، والتي تسبق زمنيًّا المصاحف التي استند إليها بروبيكر، فلا يصح له أن يدّعي أنّ التصحيحات اتّجهت نحو الموافقة لهذا المخطوط، فإنّ التصحيحات -ولو افترضناها مرونةً وتحريفًا في القرآن- فهي متأخّرة عن المصاحف العثمانيّة، وليس فيها ولا في المصحف الأميري أثر من تلك المرونة المزعومة.
وإمّا نكذّب ما رواه الشيخان، ولا نعوّل على عمل لجنة كتابة المصحف الأميري
(119)في إعداده على أساس المصاحف العثمانية، فهذا الاحتمال أيضًا لا يُؤيّد فرضيّة بروبيكر، فإنّ المصحف الأميري لم يتم إعداده على أساس المخطوطات القرآنيّة في الأصل، فلا تصحّ دعوى أنّ التصحيحات الواردة في المخطوطات القرآنيّة القديمة تجعل هذه المصاحفَ توافق ما ليس مبنيًّا عليها أصلًا.
المشكلة الثالثة، المنهج الذي انتهجه بروبيكر غير ناجع في إثبات ما ادّعاه، وسيأتي الحديث عنه لاحقًا.
بما أنّ هذا الموضوع خارج عن موضوع دراستنا هذه، فالأفضل أن يترك البحث المعمّق فيه إلى المصادر التاريخيّة والمرتبطة بالعلوم القرآنيّة، مثل كتاب «البيان في تفسير القرآن» لآية الله أبي القاسم الخوئي، و«مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، و«التمهيد في علوم القرآن» لآية الله محمد هادي معرفت، و«تاريخ القرآن» للدكتور محمد حسين علي الصغير.
يلفت بروبيكر انتباه القرّاء في مقدّمة كتابه إلى تساؤلات متفرّقة عن تاريخ الإسلام والقرآن، اثنان منها مرتبطان بمكّة المكرمة وأوضاعها البيئيّة، وواحد يختصّ بالسّمات اللغويّة للقرآن المجيد، وواحد عن اتّجاه القبلة، والأخير يتفرّع إلى فروع تتمحور حول الجوانب المختلفة للمخطوطات القرآنيّة. أمّا التساؤلات الأربعة الأولى، فهي لا تمتّ إلى الموضوع الذي يتناوله بروبيكر في كتابه بصلة، ولا داعي لطرحها إلّا لإثارة الشبهة في قلب القارئ المسلم حول مصداقيّة التراث الإسلامي التاريخي وإمكانيّة التعويل عليه -وهذا دأبُ بروبيكر في كثير من الأحيان، كما يظهر ذلك مما قاله غير مرة عن التصحيحات التي يدّعي أنّه عثر عليها في مخطوطات قرآنيّة، ولم تأتِ بصورة منها في كتابه هذا- فيوهم القارئ أنّ هناك
(120)أسئلة وإشكاليات لا تعدّ ولا تحصى عن أصل القرآن وكيفيّة تدوينه ونقله إلى العصر الراهن، غير أنّه ليس بصدد الإجابة عنها، بل يريد أن يشوّش ذهن القارئ ويشحنه بالشبهات. وذلك ما جعل كتابه محطّ الاهتمام لناقدي القرآن، فاكتظت مواقعهم الإلكترونية بمقتطفات من نماذجها، وكذلك يوصون الناس بقراءة هذا الكتاب. أما هذه التساؤلات الأربعة، فهي خارجة عن موضوع هذه الدراسة -والتي ترتكز على المخطوطات القرآنية- ويفتقر كل منها إلى دراسة مستقلة ليس هنا موردها.
ثم بالنسبة للتساؤل الخامس، فهو يتفرّع إلى أربعة تساؤلات، يراها بروبيكر لغزًا في مجال دراسة المخطوطات القرآنيّة، ولم يسعَ إلى الإجابة عنها، بل تركها -كما هو دأبه- شبهات تراود القارئَ. وفيما يلي نقدم ملاحظات عليها:
أعرب بروبيكر استغرابه من المخطوطات القرآنيّة التي لا تتّبع قراءة واحدة. في الحقيقة، يدلّ هذا الأمر على العلاقة القائمة بين القراءات ورسم المصحف، كما يكشف عن مدى التأثّر المتبادل بينهما، وهذا هو الذي أنكره بروبيكر قبل ذلك بقليل! أما القراءات المتعدّدة في مصحف واحد، فيمكن تقسيمها إلى قسمين؛ إما أن يكون اختلاف القراءات الذي أشار إليه بروبيكر بسبب الاختلاف في النقط والشَكل، فالإجابة عنه هو أنّ العرب لم يكونوا مهتمين بالتنقيط والتشكيل في صدر الإسلام إلا قليلا (فراستي، ٢٠٢١، صص 77 -78)، فالمصاحف المخطوطة المبكرة تخلو منهما إلا في حالات ضئيلة (Sidky, 2019, p. 274). لذلك نشب الاختلاف في القراءات لدى كثير من المفردات القرآنيّة رغم الاتفاق على رسمها، فليس غريبًا ولا لغزًا أن تتعدّد القراءات في مصحف مخطوط نقّطه أو شكّله الناسخ أو من جاء بعده حسب القراءة التي يرجّحها.
وإما أن يكون اختلاف القراءات بسبب الاختلاف في رسم المصحف، مثل الاختلاف
(121)بين قراءة «وَأَوْصَىٰ» وقراءة «وَوَصَّىٰ»، أو بين قراءة «وَأَكُنْ» وقراءة «وَأَكُونَ»، ويمكن تبريره بزيادة الألف والواو في إحداهما، إذ كان حذف المصوتات الطويلة من سمات الخط العربي في صدر الإسلام (مستفيد، ١٣٨١، صص47 -49). ومثل الاختلاف بين قراءة «وَلَا يَخَافُ» وقراءة «فَلَا يَخَافُ»، ويمكن تبريره بصعوبة قراءة الواو والفاء المتصلتين بما بعدهما في المخطوطات المبكرة، فربما كُتبت الواو بشكل بدا للقارئ أنّها فاء، علمًا بأنّ الفاء لم تكن منقّطة أيضًا في كثير من الأحيان. وزِدْ على ذلك القراءات التي حملها العلماء على قلّة ضبط الروّاة (أبو شامة، ١٩٧٥، صص 174 -176). وإذا وضعنا مثل هذه الاختلافات -أي التي تُبرّر بمشاكل كتابة الخط العربي في القرن الأوّل أو الخطأ في قراءتها أو نقلها- على جانب، فلا يبقى إلّا عدٌد طفيفٌ من اختلاف القراءات، وعند ذلك يقال عنها النادر كالمعدوم.
بناء على هذا، ما لفت بروبيكر انتباه القارئ إليه -أي تعدّد القراءات في مصحف مخطوط واحد- فهو إمّا بسبب الاختلاف في النقط والشكل المتأخّرَين عن زمن كتابة المخطوط وفقًا للقراءة التي رجّحها قارئ المصحف، وإما بسبب الاختلاف في وضع المصوتات الطويلة أو خطأ الكاتب في وضع أسنان الحروف أو خطأ القارئ في قراءتها. ومن المستبعد جدًا أن يقصد بروبيكر الثانيَ؛ إذ لا يمكن أن تُكتب الكلمات في مصحف واحد بصورتين مختلفتين، ولكن من الممكن -بل توجد أمثلة كثيرة لهذا- أن تُكتب الكلمات وتنقَّط وتشكَّل بحيث يوافق أكثر من قراءة، ولذلك تتعدّد القراءات في مصحف مخطوط واحد. وقد تقدّم سابقًا أنّ علماء أهل السنة والجماعة يرون هذه القراءات كلَّها من الوحي الإلهي، فلا يجدون في اختلاف بعضها عن بعض بأسًا؛ إذ هي منزَّلة من عند الله سبحانه. ويرى علماء الشيعة أنّ ذلك الاختلاف في القراءات لأجل كيفيّة كتابة المصحف في القرن الأوّل أو الاجتهاد في قراءتها، فهو من قبَل الروّاة لا من عند الله تبارك وتعالى.
أشار بروبيكر إلى المخطوطات التي مُحي ما كان مكتوبًا عليها، ثُم كُتب عليها
القرآن الكريم، قائلًا إنّها أكثر التصحيحات انتشارًا. ولكن هذه الدعوى لا توافق الحقيقة الواقعة. أما القرآن فكان يُكتب بعد العهد النبوي صلىاللهعليهوآله على الرقّ أو ورق البردي قبل اكتشاف الكاغد (السامرائي، ٢٠٠١، ص 226)، واستمرّ هذا العمل إلى أن ولي الخليفة العباسي هارون (م. 193)، فأمر باستبدالهما بالكاغد؛ لأنّ الجلود -على الرغم من طول بقائها- يقبل المحو وإعادة الكتابة، فهي عرضة للتزوير، ولكن الكاغد إذا مُحي نصّه فسد (القلقشندي، لا ت.، ج 2، صص 515 -516)، إلّا أنّ استخدامهما -أي الرق وورق البردي- بقي لدى بعض العلماء لكتابة القرآن الكريم والحديث الشريف (السامرائي، ٢٠٠١، ص 233).
ثم بالنسبة إلى الطروس التي كُتب عليها القرآن الكريم، فتنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول ما كان النّصّ الباطني -يعني الذي مُحي- غير القرآن -وهذا هو الشائع من القسمين- وكان للكتابة على هذه الطروس سببٌ اقتصادي؛ إذ لم يكن الورق آنذاك متوفرًا كعصرنا هذا، بل كان باهظًا إلى درجة اقتصر استخدامه في نسخ القرآن والوثائق الرسمية (سعيد، ٢٠١١، ج 3، ص12)، فاضطرّ البعض إلى محو ما كُتب على الجلود وإعادة الكتابة عليها، كما نُقل عن بعض الكتّاب أنّهم كانوا يكتبون ثم يمحون ثم يكتبون مكانه (البخاري، لا ت.، ج 7، ص50)، أو يغسلون ما لا يجدون فيه نفعًا (الحموي، ١٩٩٣، ج 5، ص2266). فهذا النّوع من الطروس لا يثير شبهةً بشأن تحريف القرآن الكريم أصلًا.
والقسم الثاني، ما كان النصّ الباطنيّ منه قرآنًا، وهذا بإمكانه أن يثير الشبهة بشأن صيانة القرآن الكريم من التحريف، غير أنّه لم يُعثر إلى الآن إلّا على طرس واحد يتّسم بهذه الخصيصة، وهو أحد المخطوطات المكتشفة بالجامع الكبير في صنعاء. فأثناء المشروع المشترك بين المستشرقين الألمان والسلطات اليمنيّة
(123)لدراسة تلك المخطوطات، ادّعى جِرد بوين في مقابلة أجراها صحيفة أتلانتيك الأمريكية الشهرية عام 1999 للميلاد أنّ مصاحف صنعاء تثبت تطوّر النّصّ القرآني عبر الزمن. ولكن عندما سمعت السلطات اليمنيّة بتصريحات بوين وأدركت موقفه المعادي للقرآن، بعث إليهم رسالة يفنّد ما نُشر في الصحيفة الأمريكية. والحقيقة هي أنّ هذه الرسالة مضلّلة؛ لأنّ بوين معروف في الأوساط العلميّة بآرائه المعارضة للإسلام (شاكر، ٢٠١٤، ص 8).
كذلك ادّعى بوين أنّ السلطات اليمنيّة تريد إخفاء تلك المصاحف عن الأنظار، مع أنّهم كانوا متعاونين حقًّا مع الوفود الأجانب لتصوير المخطوطات، كما أقاموا عدّة معارض لتلك المصاحف في القرن العشرين الميلادي. ومن المستغرب جدًا أنّ بوين -والذي يتملك مجموعة الصور من مخطوطات صنعاء- لا ينشر تلك الصور حتى تتّضح الحقيقةُ للعالَم -يعني هل القرآن الذي بين أيدينا يختلف عمّا كان فيما سبق أو لا- وهو يردّد دعوى تطوّر نصّ القرآن (المصدر السابق، صص9 -10). وقد لفت أحد المخطوطات هذه انتباهَ الباحثين في مجال الدراسات القرآنية، كما أثار ضجّةً في الإعلام والرأي العام، وهو الذي يُصطلح عليه بـ«طرس صنعاء» أو «مصحف صنعاء1». والميزة الفريدة لهذا المصحف هو أنّه طرس كُتب عليه القرآن، ثم محي ثم كُتب عليه القرآن للمرة الثانية، وهذا ما جعله محطّ الاهتمام والدراسة لدى عالَم الاستشراق.
(124)صورة 29: صورة النصين الفوقي (التصوير بالضوء المرئي) والتحتي (التصوير بالأشعة)
لطرس صنعاء، ورقة 2و
انقسم مصحف صنعاء 1 إلى ثلاثة أجزاء: 35 ورقة تُحتفظ تحت رقم DAM 01 -27.1 في دار المخطوطات في صنعاء. وأربعون ورقة تُحتفظ في المكتبة الشرقيّة في صنعاء وليس لها رقم تسلسلي، تم اكتشافها في عام 2012 الميلادي. وخمس أوراق بيعت في أسواق السلع القديمة، وهي محفوظة اليوم في عدة مكتبات أوروبية (Cellard, 2021, pp. 5 -6). إذًا عُثر لحدّ الآن على ثمانين ورقة من المصحف، إلّا أنّ الدراسات الاستشراقيّة تعتمد على الأوراق المحفوظة بها في أوروبا والصور التي التقطها بعثة فرنسيّة إيطاليّة من مخطوط DAM 01 -27.1. والأوراق الأربعون
(125)ظلّت مجهولة في الظروف القاسية التي تمرّ باليمن اليوم.
الطبقة العليا من هذا المخطوط -أي النص الفوقي- يوافق المصحف الرسمي، ويقدَّر تاريخ كتابتها بالقرن السابع أو أوائل القرن الثامن للميلاد، بينما الطبقة السفلى من المخطوط -أي النص التحتي- يلفت الانتباه؛ لأنّه المخطوط الوحيد الذي لا يوافق الرسم العثماني، ويقدّر تاريخ كتابها بالقرن السابع الميلادي (Sadeghi & Goudarzi, 2012, pp. 7 -8). حاول عدد من المستشرقين أن يفكّ النّصّ التحتي ويقرأه، كما بذلوا جهودهم لتقديم فرضيات عن سبب محو القرآن المكتوب وإعادة كتابته، إلّا أنّ هذه كلّها مجرّد احتمالات غير ثابتة يعارضُ بعضها بعضًا. ونشير إلى عدّة فرضيات مطروحة ونترك تقويمها؛ لأن البحث فيها خارج عن الموضوع الرئيسي لهذه الدراسة:
. كان مصحف صنعاء 1 مصحفًا كاملًا لأحد الصحابة تشتّت عبر الزمن، ويعود تاريخ كتابته إلى قبل العهد العثماني، ولكنّه مُحي جرّاء توحيد المصاحف -إذ كانت قراءتُه مرغوبًا عنها- وكُتب عليه القرآن بالرسم العثماني.
. كان هذا المصحف مجموعة من الأوراق استخدمها الطلاب بغية تعلّم القرآن وتفسيره، لذلك فيه اختلافات عن المصحف الرسمي، مما تدلّ على تفسير بعض الآيات، ولكنّه مُحي بعد سنوات وكُتب عليه القرآن الرسمي.
. كانت الطبقة السفلى من النّصّ القرآنَ الذي كتبه أهل اليمن بلا دراية عن المصحف بالرسم العثماني، فلمّا حصلوا على النسخة الرسمية للقرآن بعد توحيد المصاحف محَوا القرآن الذي كان مخالفًا نوعًا ما عن المصحف بالرسم العثماني وأعادوا كتابة القرآن عليه.
(126)إلى جانب هذه الفرضيات المحتملة هناك من يرى عمليّةَ محو القرآن من الرقّ وإعادة كتابته تحريفًا للقرآن الكريم، غير أنّه أغمض عن عشرات المخطوطات القرآنيّة التي تعود إلى العصر الذي كُتب فيه مصحف صنعاء 1 أو تسبقه زمنيًّا وهي توافق تمامًا القرآنَ الذي بين أيدينا، ويؤكّد على المخطوط الذي لا تختلف فيه الآيات عن المصحف الرسمي إلا من وجوه: منها أخطاء نسخيّة لا يعتدّ بها؛ ومنها الاختلاف في القراءة؛ ومنها زيادات تفسّر الآيات ولا يحسبها العلماء المسلمون تحريفًا، ومنها اختلافات يسيرة عن القرآن الرسمي في الألفاظ، وهي ما تسمَّى بالقراءات الشاذة ولها أمثلة كثيرة في كتب القراءات، وليست هذه أيضًا تحريفًا للقرآن.
والنتيجة هي أنّ استكشاف مصحف صنعاء 1 لا يزعزع أركان الإسلام ولا يضر بنص القرآن؛ فإنّ الطبقة السفلى من هذا الطرس -وإن لم يوافق المصاحف المتناولة بأيدينا اليوم مئة في المئة- يؤيّد جزءًا كبيرًا من النص القرآني في عصرنا هذا، كما تؤيّده عشرات المخطوطات القرآنيّة الأخرى المتزامنة معه أو السابقة عليه زمنيًّا، والاختلافات اليسيرة فيها قد توافق ما نُقل في الروايات الإسلاميّة عن مصاحف الصحابة (see: ibid., pp. 116 -122) وقد لا توافقها، وهذا الأخير هو ما أهمله الكتّاب إذ لم يجدوا طريقًا إلى تلك المصاحف -مثل مصحف صنعاء 1- وهي اليوم باتت في متناول أيدينا. والجدير بالذكر أنّ علماء المسلمين لم يخبّؤوا تلك القراءات الشاذة ولم يسمّوها بتحريف القرآن؛ لكنّ المستشرقين الذين يجهلون المعتقدات الإسلاميّة يزعمون أمثالَ هذا المصحف ونصَه الباطني دليلًا على تطوّر النّصّ القرآنيّ عبر الزمن؛ غير أنّها قراءات شاذّة قد تساعد على فهم القرآن الكريم وكيفيّة نقله في صدر الإسلام.
(127)وفقًا لِما ورد في جملةٍ من الكتب المرتبطة بتاريخ القرآن الكريم، أمر الخليفة الثالث بجمع القرآن الكريم، ومن ثمّ أرسل تلك المصاحف الموحَّدة إلى أمصار عدّة، مزوِّدًا كل مصحف بقارئ يعلّم الناس قراءةَ القرآن الرسمي. هذه القصّة تلقّت قبولًا من قبَل معظم العلماء المسلمين الذين افترضوها حقيقة تاريخيّة، ولكنّهم اختلفوا في كثير من تفاصيلها. أمّا هذه القصّة، فإن ثبت ضعفها ووضعها -أي لم يباشر عثمان بأيّ عمل تجاه القرآن، بل اختلاف المصاحف استمرّ بعده كما كان قبله- فلا حاجة للإجابة على السؤال الذي طرحه بروبيكر عن مصير المصاحف التي أرسلها عثمان إلى مختلف البلاد الإسلاميّة، إلّا أنّ القول بهذا الرأي يفتقر إلى دراسةٍ مفصّلةٍ تقوِّم جميع الروايات التاريخيّة، ولسنا هنا بصدد ذلك.
وأمّا إن ثبت حدوث تلك القصّة على أرض الواقع -وهو الرأي التقليدي لدى جمهور علماء المسلمين- فيمكن القول -إضافة إلى الملحوظة التي تقدّمت فيما سبق حول أصالة المخطوطات التي استخدمها بروبيكر- بأنّ تلك المصاحف الموحَّدة -كما تقدمَ في البحث عن طرق تأريخ المخطوطات القرآنيّة- لم يكن لها حرد المتن حتى يمكن تمييزها عن المصاحف الأخرى التي نُسخ منها. لذلك اختلف المؤرّخون في عددها (السيوطي، ١٩٧٤، ج 1، ص211) وقد ادّعى أهل كلّ بلد أنّ عثمانَ أرسل إليهم نسخة منها؛ لأنّ امتلاكها كان ميزةً متفوّقةً للمسلمين المعتقدين بأهميّة ما قام به الخليفة الثالث (رامیار، ١٣٦٩، ص460). كذلك لم يتّفق المؤرّخون على مصير هذه المصاحف وفي أيّ نقطة تاريخيّة انقطعت الأخبار عنها، بينما ادّعى عددٌ من الرحّالة والقدامى أنّهم رأوا تلك المصاحف في شتّى البقاع (انظر: صالح،
(128)١٣٧٢، صص87 -89)، وهذه مجرّد دعاوى لا يمكن تصديقها ولا تكذيبها.
ثم تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة غير واحد من المصاحف في يومنا هذا التي تُنسب إلى عثمان -نحو: مصاحف طشقند، وطوب قابي، ومتحف الآثار التركيّة والإسلاميّة، والمشهد الحسيني بالقاهرة، ولندن وسانت بطرسبورغ- كما يُنسب إلى الأئمة الأطهار عليهمالسلام عدد كبير من المصاحف. وقد أنكر الباحثون انتماءَ تلك المصاحف إلى عثمان (آلتي قولاج، ٢٠١٤، ص11)، كما استدلّوا على عدم انتسابها إلى الأئمة الأطهار عليهمالسلام (كريمينيا، ١٤٠٠، صص73 -79). وعلى أيّ حال، من نافلة القول أنّ عدم بقاء المصاحف المنسوبة إلى الأئمة الشيعة أو السنة لا يضرّ بصيانة القرآن؛ فإنّ القرآن المجيد تمّ كتابته منذ صدر الإسلام إلى عصرنا هذا لآلاف المرات، كما يقدَّر عدد مخطوطاته بما يربو 250 ألف نسخة (Al -Azami, 2003, p. 151)، فضلا عن حفّاظ القرآن، فإنّ عددَهم لا يعمله إلّا الله تعالى. إذًا معرفة مصير المصاحف التي أرسلها عثمان -على فرض صحّة هذه القصّة أو وضعها- لا تؤثّر على نقل القرآن في غابر الأزمان.
هذا التّساؤل هو الإشكاليّة الأساسيّة التي يتمحور حولها كتاب بروبيكر، وهذه الدراسة النقديّة تطمح إلى الردّ عليها، فهو يرى أنّ الأخطاء والتصحيحات التي عثر عليها في المخطوطات القرآنيّة تعارض فكرة الاتّفاق على حروف ومفردات القرآن منذ كتابته، ولكنّ الأدلّة التي نستند إليها فيما يلي من الكتاب ترفض تلك الدعوى وتُثبت ما آمن به المسلمون من القرون الأولى إلى يومنا هذا.
تنبغي الإشادة بطرح هذه الأسئلة قبل دراسة المخطوطات القرآنيّة، فهي أسئلة
(129)جذريّة في صلب الموضوع، والإجابة عنها تنفع الباحثين في هذا المجال، إلّا أّن بروبيكر لا يجيب عن كثير منها فيما يلي من كتابه، ويتركها أسئلة تشغل بال القارئ. وعلى كلّ، فالإجابة عن تلك الأسئلة عبء على عاتق المؤلّف، لا القارئ!
رغم أنّ بروبيكر لم يرتّب المصاحف التي درسها في كتابه على أيّ أساس -لا من حيث عمر المخطوط ولا المكتبة التي تحفظه ولا نوع التصحيح المزعوم - وأتى بنماذج لا يمتّ كل منها إلى غيره بصلة، لا يَصعب تصنيف هذه المخطوطات القرآنيّة ووضعها في ستة أقسام حسب المكتبة التي تحتضنها؛ فقد استفاد المؤلّف من 18 مخطوطًا في كتابه وقدّم لها تعريفًا مفصّلًا. هنا نعرض مواصفات تلك المخطوطات القرآنيّة لمسيس الحاجة إليها، وهي:
يتألّف هذا المصحف من 408 ورقة بمقاس 41×46 سم، وسطح الكتابة 32×40 سم، وسمكه 11 سم، وتضمّ كلّ صفحة 18 سطرًا تقريبًا، إلّا الأوراق الأولى، فهي متأخّرة زمنيًّا عن الأخرى، ويتراوح عدد سطورها بين 16 و19 سطرًا، وفي السور القصار يتراوح بين 13 و17 سطرًا. يمكن اعتبار هذه النسخة مصحفًا كاملًا -مقارنةً بالمصاحف التي تنقصها أوراق كثيرة- إلّا أنّ بعض أوراقه تصعب أو تستحيل قراءتُها بسبب تعرُّضها للظروف المناخيّة وعمليات الترميم وغيرِهما على مرّ العصور. المصحف مكتوب بالخط الكوفي على الرق، والأوراق الست الأولى إضافة إلى الورقة الحادية عشرة مكتوبة بقلم آخر يختلف عن الكاتب الأصلي للمصحف. ليس هذا المصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق، ولكنّه لا يُستبعد أن يكون منسوخًا منها أو من منسوخٍ منها، كما يماثل رسمُه مصحفَ المدينة المنورة، يعني ما نُقل عنها في مؤلّفات رسم المصاحف. ولا توافق قراءةُ المصحف -حسب نَقطه وشَكله- إحدى القراءات المشهورة بعينها، لكنّها لا تخرج عن نطاق القراءات الصحيحة المنقولة في المصادر الدينيّة. كُتب المصحف -الرسم
ونقط الإعجام- بالحبر الأسود ووُضعت علامات التشكيل بالحبر الأحمر بطريقة أبي الأسود الدؤلي، ولها علامات رؤوس الآيات والتخميس (يعني نهاية خمس آيات) والتعشير (يعني نهاية عشر آيات) بالحبر الملون، ومن المتوقّع وضعُها في زمن كتابة المصحف نفسه.
يبدو أنّ مصحف طوب قابي لم يخضع للمراجعة والتدقيق بعد كتابته، ولم يكن مستخدمًا لدى أئمة القراءات؛ فإنّ أخطاءه النسخيّة لا يُتصوّر بقاؤها بعد المراجعة الدقيقة واستخدامه عند أئمة القراءات. يقدَّر تاريخ كتابة هذا المصحف بالنصف الثاني من القرن الأوّل أو النصف الأوّل من القرن الثاني الهجري -أي العهد الأموي- ويقال إنّه كان محفوظًا في القاهرة منذ أمدٍ بعيدٍ حتى أهداه محمد علي باشا والي مصر إلى السلطان محمود الثاني في عام 1226ه/ 1811م، واحتُفظ به من بعدُ في دائرة البردة الشريفة داخل سراي طوب قابي. وكان الناس يزورونه في شهر رمضان من كلّ عام حتى أرسِلَ إلى مكتبة السليمانية في سنة 1984 بغية الترميم والإصلاح، ثم أعيد إلى متحف طوب قابي سراي بعد ثلاث سنوات، وهو لا يزال محفوظًا هناك تحت رقم 44/32 (آلتي قولاج، ٢٠٠٧، صص79 -89). استفاد بروبيكر من هذا المصحف في النماذج التالية: 1 و11 و14.
أ) NLR Marcel 2: رغم الاستقصاء لم نعثر على معلومات هذا المخطوط، فننقل ما ذكر عنه بروبيكر في كتابه: يتألّف من 42 ورقة أبعادها 41×41 سم تقريبًا، وسطح الكتابة 31×33 سم، وتضم كل صفحة 20 أو 21 سطرًا. له علامات عموديّة مائلة تدلّ على فواصل الآيات، وعلامات حمراء تتحلّق حول دوائر بنيّة للدلالة على مجموعة من الآيات، وهو مكتوب بخط من أسرة CIa حسب تصنيف ديروش، فلعلّه يعود إلى أوائل القرن الثامن الميلادي (Brubaker, 2019, pp. 44 -45). استفاد منه بروبيكر في النموذج الرابع.
(131)ب) NLR Marcel 5: هذه المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنيّة الروسية -والتي تتألّف من 17 ورقة أبعادها 345× 495مم- وخمس قطع مخطوطة أخرى (مخطوطة Arabe 335 في المكتبة الوطنية الفرنسيّة، ومخطوطة Cod.or. 14.545a في مكتبة جامعة لايدن، ومخطوطة A 6958 في المعهد الاستشراقي بشيكاغو، ومخطوطة KFQ 50 في المجموعة الخاصة بناصر خليلي، ومخطوطة E 16264 K في متحف جامعة بنسيلفانيا الأمريكية) تعود إلى مصحف واحد تم استكشافه في جامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط المصرية. ويقدر تاريخه -حسب الاختبار الكربوني المشع- إلى القرن الثامن الميلادي أو قبله. استفاد بروبيكر من القطعة الأولى في النموذج التاسع عشر.
ج) NLR Marcel 7: رغم الاستقصاء لم نعثر على معلومات هذا المخطوط إلا ما ذكره بروبيكر في كتابه: يتكوّن هذا المصحف الأفقي من 10 أوراق أبعادها 233×177 مم، وهو مكتوب بخط من أسرة DIV، فلعله يعود إلى القرن التاسع أو العاشر للميلاد (ibid., p. 79). استفاد منه بروبيكر في النموذج الثامن عشر.
د) NLR Marcel 11: يعود هذا المخطوط ومخطوط Marcel 13 ومخطوط Marcel 15 ومخطوط Arabe 328c إلى مصحف واحد تم استكشافه في جامع عمرو [بن العاص] بمدينة الفسطاط المصرية، وسماه ديروش بمصحف الفسطاط الأموي. يحتفظ بـ64 ورقة من أوراقه في المكتبة الوطنية الروسية تحت عنوان Marcel، وبتسع أوراق أخرى في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة تحت رقم Arabe 328c. أبعاد هذه الأوراق 31×37 سم، وسطح الكتابة 235× 275مم، وتضم كل ورقة 25 سطرا قدرُها 115 مم تقريبًا. تحتوي تلك القطَع الثلاثة في المكتبة الروسية على النص القرآني بدءًا من الآية 60 لسورة الإسراء وانتهاءً بالآية 32 لسورة فصل، ما عدى بعض الآيات والسور الساقطة من المخطوط (Déroche, 2014, pp. 76 -77). استفاد بروبيكر من مخطوطة Marcel 11 في النموذجين الثالث (أربع مرات) والسابع عشر.
(132)ه) NLR Marcel 13: إلى جانب ما سبق ذكره آنفًا، حري بالذكر أنّ هذا المصحف مكتوب على الرق، وأن نقط الإعراب فيه رُسم بالحبر الأحمر، كما توجد فيه علامات للفصل بين السور المباركة (ibid., p. 105). استفاد بروبيكر من هذه المخطوطة في النموذج الثالث ثلاث مرات.
و) NLR Marcel 21: رغم الاستقصاء لم نعثر على معلومات هذا المخطوط إلا ما قال عنه بروبيكر في كتابه: هذا المخطوط الأفقي يتكون من 12 ورقة، والورقة التي استفاد منه بروبيكر في الجزء الثامن من النموذج الثالث أبعادها 295×179مم، وسطح الكتابة 23×13سم، وهي مكتوبة بخط من أسرة AI، فلعله يعود إلى أوائل القرن الثامن الميلادي (Brubaker, 2019, p. 38).
أ) BnF Arabe 327 : لا يُعرف ناسخ المخطوط وتاريخ كتابته. نقط الإعجام فيه قليل ونقط الإعراب فيه يظهر أحيانًا باللون الأحمر. فُصل بين الآيات بثلاثة خطوط مائلة وفيه علامات التعشير. كذلك تنفصل السور بصورة حبل ذهبي يمتد من جانب إلى الآخر وينتهي بنقش نبات أحمر وأخضر، ثم أضيفت في وقت لاحق عبارة «فاتحة سورة ...» ورقم الآيات إلى المخطوط، كما وُضعت علامة للسجدة في هامش الأوراق. هذا المصحف مكتوب على الرق بالحبر الأسود وبخط من أسرة BIb، ويتألّف من 14 ورقة أبعادها 285 إلى 270 × 275 إلى 264مم، وتضم كل ورقة 18 سطرًا، وسطح الكتابة 225×220 مم، ويحوي آيات من سور المؤمنون والنور وسبأ وفاطر والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان (Déroche, 1983, p. 68). استفاد بروبيكر من هذا المصحف في النموذجين السابع والتاسع.
ب) BnF Arabe 328: يتألّف هذا المخطوط المعروف بـمصحف «باريسينو -بتروبوليتانوس» من 97 ورقة وينقسم إلى ستة أجزاء حسب الأقلام المستخدمة فيه، وبما أنّ بروبيكر استفاد من مخطوط Arabe 328a (يعني من ورقة 57 إلى
(133)70) في النموذج الثاني، ومن Arabe 328b (يعني من ورقة 1 إلى 56) في النموذج الثاني عشر، نكتفي بالمعلومات المتعلّقة بهذين الجزئين من هذا المصحف.
أمّا هذا المصحف، فقد عُثر عليه في جامع عمرو بن العاص في الفسطاط أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وجلبَ بعضَ أوراقه المستعرب الفرنسي مارسيل إلى فرنسا، وبعد سنوات قليلة رجل فرنسي آخر يدّعى شرفيل اشترى أوراق كثيرة منه عندما كان في القنصلية الفرنسيّة بالقاهرة، وبعد وفاته بيعتْ مجموعته المتكوّنة من المخطوطات العربيّة للمكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، وهي ما تُحفظ اليوم تحت رقم Arabe 328. فضلا عنه، باعت وريثة مارسيل المخطوطاتِ القرآنيّة التي حصل عليها للدولة الروسيّة، وهي تُحفظ اليوم في المكتبة الوطنيّة الروسيّة تحت رقم Marcel 18. إضافة إلى ذلك، هناك بعض الأوراق من المصحف المذكور يحتفظ بها في مكتبة فاتيكان وكذلك المجموعة الخاصة بناصر خليلي في لندن. يضم هذا المصحف الذي عمل خمسة نسّاخ في كتابته ما يقارب 45 بالمئة من النص القرآني. يختلف عدد السطور من ناسخ إلى آخر، بينما يَظهر استعداد متطوّر عندهم قبل العمل (Déroche, 2009, pp. 171 -173). يقدّر تاريخ كتابة هذا المصحف بالربع الثالث من القرن السابع الميلادي ويسبق مخطوطاتِ العصر الأموي، إلى جانب تطوّر في القواعد الإملائيّة. وقد كان مستخدمًا لدى عموم الناس حتى القرن التاسع للميلاد (ibid., p. 177).
ثم بالنسبة إلى الجزء Arabe 328a من المخطوط المحفوظ في فرنسا، فقد ساهم ناسخان في كتابته ولا يعرف تاريخها. الناسخ الأول -والذي كتب الأوراق التالية: 1و – 28و، 30ظ – 32و، 38ظ – 56ظ، بما فيها الورقة التي استند إليها بروبيكر - فصل بين الآيات بصَفّين من ثلاث نقط متراكبة، والناسخ الثاني -والذي كتب الأوراق الأخرى- فصل بينها بثلاثة صفوف من نقطتين متراكبتين. رُسم نقط الإعجام قليلًا ولا يوجد نقط الإعراب. ثمّة الألف باللون الأحمر تتحلق حوله دوائر
(134)فيها عدد مكتوب دلالةً على التخميس والتعشير على السواء، ويتخلّل فراغ بين السور. هذا المصحف مكتوب على الرق وخط هذا الجزء منه من أسرة Ḥiğāzī I، وأبعاد أوراقه 240×330 مم، وتضم كل ورقة ما يتراوح بين 22 و26 سطرًا، بينما سطح الكتابة 205إلى 210 × 310 إلى 330مم، ويحتوي على آيات من سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغیرها (Déroche, 1983, p. 59).
والجزء Arabe 328b من المخطوط يماثل الجزء Arabe 328a حيث يقلّ فيه نقط الإعجام وهو خالٍ من نقط الإعراب، وفيه علامات التخميس والتعشير كما في الجزء الأول، وكذلك تنفصل السور بفراغ بينها، وكاتبه غير معروف، إلّا أنّه فصل بين الآيات - بخلاف الناسخين الأولين- بمجموعات تتكوّن من أربع نقاط. هذا الجزء المكتوب بالحبر البني يحتوي على آيات من سور فصّلت والشورى والزخرف وغيرها، ويتألف من 14 ورقة أبعادها 230 إلى 245 ×330 مم، وتضم كل ورقة منها ما يتراوح بين 21 و25 سطرًا، وسطح الكتابة 210 إلى 245 × 330مم (ibid., p. 60).
ج) BnF Arabe 330: هذا المخطوط يتألف من 69 ورقة وينقسم إلى سبعة أجزاء وفقا لسماته الباليوغرافية، ونكتفي بما يتعلّق بالجزء Arabe 330g -أي من الورقة 50 إلى 69، بما فيها الورقةُ التي استفاد منها بروبيكر في النموذج الثامن - والذي يحتوي على آيات من سور آل عمران والنساء والأعراف والأنفال والتوبة ويونس. رُسم نقط الإعجام فيه تارة بشكل خطوط مائلة [قصيرة] ولكنه خالٍ من نقط الإعراب. وتفصلُ الآياتِ ثلاث أو أربع نقاط بيضويّة تقع في صَفَّين عموديين، ويتخلّل عادة بين السور فراغ يفصلها، وأضيفت علامات التعشير في وقت لاحق باللون الأسود. تضم كل ورقة من هذا الجزء المتكوّن من 20 ورقةً والمكتوب باللون البني الفاتح على الرق، ما يتراوح بين 19 و22 سطرًا، وأبعادها 280×335 مم، بينما سطح الكتابة 245×285 إلى 292مم. وكما لا يُعرف ناسخ المخطوط وتاريخ كتابته، لا يندرج خطُّه تحت تصنيف ديروش للمخطوطات القرآنيّة المحفوظة بالمكتبة الوطنيّة الفرنسيّة (ibid., pp. 145 -146). وجدير بالذكر أنّ هناك جزء آخر لهذا المخطوط يُحتفظ في مكتبة تشستر بيتي في دبلن تحت رقم Is. 1615 II، وجزء
(135)آخر في المكتبة الوطنيّة الروسيّة تحت رقم Marcel 16.
د) BnF Arabe 331: يتألّف هذا المخطوط من 56 ورقة أبعادها 348×413 مم، وتضم كلّ منها 19 سطرًا، بينما سطح الكتابة 284×342 مم، وهو مكتوب على الرق بالحبر البني الفاتح. نقط الإعجام في المخطوط قليل وليس له نقط الإعراب. تُفصل الآيات بستة خطوط مائلة [قصيرة] تشكّل مثلّثًا، وثمة دوائر تدل على تعشير الآيات، كما يتخلّل فراغ بين السور يفصلها، إضافة إلى عبارة «خاتمة سورة ...» التي تظهر بين حين وآخر. ويحتوي هذا المخطوطُ -والذي يصنّفه ديروش من أسرة BIa - على آيات من سور البقرة والأعراف والأنفال والتوبة وغيرها (ibid., p. 67). استفاد بروبيكر من هذا المصحف في النموذج العاشر.
ه) BnF Arabe 340: هذا المخطوط أكبر من المخطوطات الأخرى السابقة ذكرها؛ حيث إنّه يتألّف من 121 ورقة، وينقسم إلى عشرة أجزاء وفقًا لسماته الباليوغرافيّة. ومع أنّ الجزء Arabe 340b -أي من ورقة 13 إلى ورقة 30، بما فيها الورقة التي استفاد منه بروبيكر في النموذج الثالث عشر- لا يندرج تحت تصنيف ديروش لمخطوطات المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، لكنّه يماثل الأسرتين AوB من تصنیفه. رُسم فيه نقط الإعراب بعض الأحيان باللون الأحمر، بينما يقلّ فيه نقط الإعجام. تُفصل الآيات بثلاثة خطوط مائلة [قصيرة]، كما تدلّ على التعشير دوائرٌ حمراء تتحلّق حولها نقاط. أضيفت في بداية السور باللون الأحمر عبارة «فاتحة سورة ...» إلى جانب عدد آياتها. هذا الجزء المتكوّن من 18 ورقة تضم كلّ منها 16 سطرًا وأبعادها 284×342 مم، كُتب بالحبر الأسود الذي يضرب إلى البني، وأجريت التصحيحات فيه بالحبر الأسود. وسطح الكتابة 165×98إلى 103مم، ويحتوي على النّصّ القرآنيّ بدءًا من الآية 23 من سورة الروم وانتهاءً بالآية 51 من سورة يس (ibid., p. 147).
(136)على الرغم من الاستقصاء لم نعثر على معلومات لهذه المخطوطات المحفوظة في متحف الفنّ الإسلامي بالدوحة إلّا ما ذكره بروبيكر في كتابه:
أ) MIA.2013.19.2: هذه الورقة المقطّعة مكتوبة على الرقّ بخط من أسرة CIb حسب تصنيف ديروش، فلعلّها تعود إلى القرن الثامن أو التاسع للميلاد (Brubaker, 2019, p. 73). استفاد منها بروبيكر في النموذج الخامس عشر.
ب) MIA.2014.491: يتألّف هذا المصحف المخطوط الأفقي من تسع أوراق أبعادها 28×17 سم تقريبًا، وهو مكتوب على الرق بخط من أسرة BII
(ibid., p. 83). استفاد منه بروبيكر في النموذج العشرين.
ج) MS.67.2007.1: لا يبوح بروبيكر بمعلومات هذه القطعة المخطوطة إلّا القول إنّها تعود إلى القرن الأوّل الهجري (ibid., p. 52). وحريّ بالذكر أنّ هذه القطعة -والتي تتكوّن من أربع أوراق- ومخطوط Marcel 17 ومخطوط Isl. Ar. 1572b في جامعة برمنغهام تعود إلى أصل واحد. واستفاد منها بروبيكر في النموذج السادس.
د) MS.474.2003: يتألّف هذا المصحف المخطوط من 12 ورقة، وهو مكتوب بخط من أسرة AI، فلعلّه يعود إلى القرن الثامن أو التاسع للميلاد (ibid, p. 47). استفاد بروبيكر منه في النموذج الخامس.
كان هذا المصحف الشريف محفوظًا في خزانة الكتب للمدرسة الفاضليّة في العهد الأيوبي، ونُقل إلى المشهد الحسيني عام 1887 الميلادي، وظلّ محفوظًا فيه حتى انتقل إلى المكتبة المركزيّة للمخطوطات بالقاهرة عام 2006 الميلادي بغية
(137)ترميمه، وبقي هناك إلى يومنا هذا. للمصحف 1087 ورقة أبعادها 50 إلى 57×68 إلى 70سم، بينما سطح الكتابة 48×51 سم، وسمكه 60 سم، وزِنتُه 80 كيلوغرامًا، ويضم معظم أوراقه 12 سطرًا. كُتب المخطوط باللون الأسود، ولكن السور تُفصل برسوم نباتيّة ملوّنة، وتنفصل الآيات بخطوط مائلة صغيرة تتراوح عددها بين خمسة وثمانية.
وبينما يخلو المصحف من نقط الإعراب، تتضمّن بعض الأحرف خطوطًا قصيرة مائلة تدلّ على نقط الإعجام بدءًا من الورقة الثانية عشرة فصاعدًا. وأضيفت إليه عدّة أوراق في وقت لاحق بدلًا من الأوراق المفقودة، كما توجد أوراق تمزّقت أو بليت، فأعيد كتابتُها من جديد في عهد متأخّر. يبدو أنّ المصحف يعود إلى القرن الأول الهجري، ولكنّه ليس من المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار -خلافًا لزعم الكثيرين- لأنّه لا يوافق تمامًا ما رُوي عن تلك المصاحف، بل يختلف عنها في كثير من المواضع، ويحوي أخطاء نسخيّة لم تخضع للتصحيح، وذلك بسبب الحجم الكبير للمصحف، ما أدّى إلى صعوبة في استخدامه (آلتي قولاج، ٢٠٠٩، ص133 -141).
يُحتفظ بهذا المخطوط في دار المخطوطات في صنعاء، والورقة التي استفاد منها بروبيكر في كتابه (في النموذج الثالث) تضم 23 سطرًا، تشمل الآيات 71 إلى 80 من سورة التوبة، وهي ورقة أفقيّة مكتوبة بالخط الكوفي، ولا تُعرف أبعادها حسب المعلومات الواردة عنه في المصدر، وهو ضمن برنامج يونسكو المسمى بـ«ذاكرة العالم» (قرص يونسكو للمخطوطات القرآنية، صورة 140203B).
تقدّم فيما سبق أنّ بروبيكر لا يشرح منهجه المتّبع في كتابه، ويحسب أنّه مصيبٌ في ذلك، ولكن عدم إيضاحه للمسار الذي سلكه للتوصّل إلى النتائج المبتغاة، وإثبات نجاعته في مجال دراسته ينمّ عن عدم إفادة منهجه في الإيصال إلى الهدف المنشود منه، أي إثبات المرونة في النّصّ القرآنيّ المبكر أو ما يسمّيه المسلمون بالتحريف
(138)اللفظي. أمّا إذا حاولنا استخلاص المنهج الذي انتهجه بروبيكر -وفقًا لِما أظهره في كتابه ومارسه في دراسة نماذجه- فرأيناه يستند إلى مصحف مخطوط قديم ويكبّر منه كلَّ ما يخالف النّصّ القرآنيّ في الوقت الراهن، ثم ينعته بتصحيح متعمّد في النّصّ، وبالتالي هو دليل على مرونة شائعة في المخطوطات القرآنيّة المبكرة. ولكن كلّ مَن يمعن النّظر في هذه المنهجيّة يجدها غير مجدية في إثبات فرضيّة المؤلّف؛ فإنّ هذا المنهج يُثبت -للحد الأقصى- وقوع التصحيح في مصحف واحد، ويعجز عن إثباته في القرآن ذاته؛ إلّا أن يأتي المؤلّف بصور عدد من المصاحف المخطوطة تعود إلى أزمنة متقاربة وأمكنة متباعدة، والتي ورد فيها نفس التصحيح، ليدلّ ذلك على تواطؤ المسلمين -أو النسّاخ منهم على الأقل- على الدس في النّصّ القرآنيّ الشريف وتعديله كما يروق لهم! وما دام التصحيح الوارد في مخطوط قرآني قديم لا يوجد مثيل له في المصاحف الأخرى المتّصفة بالصفتين المذكورتين للتوّ، فليس سوى خطأ نسخيّ صحّحه الناسخ نفسُه أو من جاء بعده على أساس القرآن الموروث من الأجيال السالفة أي المصاحف المخطوطة الأخرى في ذلك الزمن.
وإن تنازلنا وافترضنا التصحيحَ تحريفًا على يد الناسخ أو غيرِه من المسلمين، فذلك أيضًا لا يثبت وجوده في القرآن ذاته إلا بعد إثبات هذه الظاهرة -أي التصحيح المذكور بعينه- في المصاحف الأخرى المعاصرة للمصحف المحرَّف. على سبيل المثال، إذا أراد بروبيكر أن يُثبت زيادة حرف أو كلمة في القرآن الكريم منذ القرن الثاني الهجري فعليه أن يأتي بصور عدد من المصاحف المخطوطة العائدة إلى القرن الثاني والتي أضيفت إليها تلك الزيادة بقلم يختلف عن قلم الناسخ الرئيسي للمصحف، إلى جانب صورة من مصحف مخطوط متقدّم عليها زمنيًّا وهو يخلو من تلك الزيادة. ويماثله المنهج الصائب لإثبات النقص في القرآن المجيد ومخطوطاته.
والجدير بالذكر أنّ تطبيق هذا المنهج لم يكن مستحيلًا على بروبيكر؛ إذ كان بإمكانه الرجوع إلى المصاحف التي درسها عن كثب والنظر فيها، ليرى هل التّصحيح الوارد في أحد المخطوطات وارد أيضًا في المخطوطات الأخرى؟ فإن كان كذلك، فسيتقدّم خطوة نحو الأمام في إثبات فرضيّته؛ وإن لم يكن كذلك، فالكتابة
(139)عن التصحيحات الواردة في نسخة واحدة لم يَثبت تكرارها في المخطوطات الأخرى ليس سوى تسويد الأوراق وتضييع الأوقات؛ فإنّ الأخطاء النسخيّة سهوٌ لا مناص منه ولا يُؤبه به متى ما كان الكاتب إنسانًا غير معصوم.
إذًا، هكذا يتبيّن أنّ المنهج الذي انتهجه بروبيكر في كتابه مضلّلٌ لا يهدي إلى الحقّ. بل يثير الشبهات بشأن صيانة القرآن الكريم من التحريف في قلب القارئ الذي لا خبرة له في مجال دراسة المخطوطات. ولربّما هذا هو الهدف المنشود من كتاب بروبيكر؛ إذ هو يخاطب عموم الناس ولا يخاطب الأخصائيين في مجال علم المخطوطات العربيّة -ويبدو ذلك من اللغة السهلة التي استخدمها المؤلّف في كتابه وعرّف للقارئ المصطلحات المتخصّصة حتى لا يكاد يحتاج إلى الرجوع إلى المصادر الأخرى عند قراءته- واستطاع بهذه الطريقة أن يجعل القارئَ يتردّد في صحّة ما ناله من القرآن الكريم عبر العصور الماضية، إلّا أنّ القارئ الفطن يفنّد ذلك الكلام المنمّق ولن تُغريه مزاعمه السقيمة. وستأتي فيما يلي من هذه الدراسة ردودٌ على النماذج التي بنى عليها بروبيكرُ دعاويه.
(140)ليس بروبيكر أوّل مستشرق عثر على الأخطاء النسخيّة في المخطوطات القرآنيّة، وزعمَ أنّ تعديلَها تحريفٌ للآيات الشريفة، بل هذه فكرةٌ شائعةٌ لدى جملةٍ من المستشرقين (آلتي قولاج، ٢٠١٤، ص6)؛ غير أنّ هذه الأخطاء تدلّ على عدم عصمة الناسخ ولا تحريفِه للقرآن (Al -Azami, 2003, p. 13, f. 37)، ومن هذا المنطلق تقتضي الحاجة إلى مراجعة المخطوط وتدقيقه وتعديله وفقًا للأصل الذي نُسخ منه حرفًا تلو الآخر ليكون على ثقة من المطابقة بينهما (عياض، ١٩٧٠، صص 159 -160)، وهو ما يسمّى بمعارضة أو بمقابلة المنسوخ مع الأصل. وبما أنّ المصحف الشريف كان من أكثر الكتب استنساخًا في العصر القديم -فضلًا عن الجم الغفير الذين يستظهرون القرآن الكريم عن قلوبهم- فكان بإمكان القارئ للمخطوط القرآني أن يعدّل الأخطاء التي أهملها الناسخُ طبقًا لِما يعلمه من النص القرآني ويجده في المصاحف الأخرى السابقة عليه.
والميزة المهمّة للخطأ النسخي هي أنّه فريد من نوعه؛ يعني أنّه لا يتكرّر في المخطوطات المتعدّدة إلّا نادًرا؛ فلعلّ الناسخ الألِف يخطئ في كتابة عبارة من القرآن الكريم، والناسخ باء يخطئ في عبارة قرآنيّة أخرى -وكلٌ إنسان عرضة للأخطاء- ولكنّهما لا يتّفقان على الخطأ الواحد إذا ارتكباه سهوًا. لذلك تقدّمَ في دراسة منهجيّة بروبيكر أنّها لا تحقِّق هدفه المنشود؛ لأنّه اكتفى بالأخطاء الواردة في كلّ مخطوط بمعزل عن غيره، ولكنّنا إذا نظرنا إلى المخطوطات القرآنيّة الأخرى التي تزامن كتابة الوثائق التي استند إليها بروبيكر أو هي أقدم منها وجدناها توافق المصحف الشريف الذي بين أيدينا، ولم ترد فيها تلك الأخطاء أو تصحيحاتها، وهذا أحسن دليل ماديّ على صيانة القرآن الكريم من التحريف منذ القرون المبكرة؛ لأنّ التصحيح إذا كان مقصودًا به تحريفَ القرآن، يقعُ في الخطأ الذي يسبقه، ولا فيما لم يكن قبلَه. فإن وجدنا مخطوطات قرآنيّة خالية من الخطأ الذي ادّعاها بروبيكر، وهي أقدم مما استند إليه، فالتّصحيح الذي عثر عليه ليس سوى تعديل المخطوط لأجل موافقته للمصاحف المتقدّم عليه -أي الأصل الذي نُسخ
(141)منه- إمّا على يد الناسخ نفسُه وإما على يد قارئ للنسخة في وقت لاحق.
كذلك تقدّمَ في البحث عن تأريخ المخطوطات القرآنيّة بالطريقة الباليوغرافيّة أنّ المصاحف الحجازيّة تُعدّ أقدم المصاحف، والتي كُتبت في فترةٍ وجيزةٍ من القرن الأوّل الهجري. بناء على هذا، نكتفي بصور المصاحف الحجازيّة التي تخلو من التصحيح الذي ادّعاه بروبيكر؛ لأنّها إمّا متقدّمة زمنيًّا على المخطوطات التي استند إليها بروبيكر -إن كان من المخطوطات الحجازية المتأخّرة أو غير الحجازيّة وهي ما يُصطلح عليه عادة بالكوفية- وإما متزامنة للمخطوطات الحجازية التي استفاد منها بروبيكر. وإن كان المخطوط الذي استند إليه بروبيكر من المصاحف الكوفية وأشار إلى تاريخ كتابته، نفترض صحّة ذلك التأريخ ونأتي بصور من المصاحف الكوفيّة التي تسبق ذلك المخطوط زمنيًّا أو متزامنة معه.
وعلى أيّ حال، فإنّ موافقة المخطوطات المتقدّمة زمنيًّا على ما استند إليه بروبيكر أو متزامنة لها مع النّصّ القرآنيّ في الوقت الراهن، ترفض دعواه بشأن التصحيحات التي تؤدّي إلى موافقة هذا المصحف الذي بين أيدينا؛ لأنّ هذا المصحف يوافق تمامًا المخطوطات القرآنيّة قبل أن تردَ فيها تلك التصحيحات المزعومة. وعلى هذا الأساس، سوف يتّضح أنّ التصحيحات التي عثر عليها بروبيكر وجمَعها في كتابه لا تثبت التحريف في النص القرآني. بدءا من هنا، نأتي بصور المصاحف إلى جانب تعريف مختصر لها، وفقًا لترتيب النماذج في كتاب بروبيكر.
أضيفت لفظة «هو» في سورة التوبة الآية 72: (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) إلى المخطوطات التالية لاحقًا، بل كُتبت إلى جانب المفردات الأخرى من الآية. إذًا ما وجده بروبيكر ليس إلّا سقوط الكلمة سهًوا من مصحف طوب قابي.
1 - السطر الرابع من الصورة أدناه. لقد تم التعريف بهذا المخطوط فيما سبق، إذ هو مما استفاد منه بروبيكر في كتابه.
(142)صورة 30: Arabe 328 ،41و
2 - السطر الثاني. هذا المخطوط أيضًا مما استفاد منه بروبيكر، وتمّ التعريف به فيما سبق، إلّا أنّه تجاهل موافقته للمصحف الذي بين أيدينا دون وقوع أي تصحيح في الآية المذكورة.
صورة 31: Arabe 330 ،66و
3 - نهاية السطر الثاني. هذا المخطوط Mashhad 18go وما سيأتي لاحقًا تحت رقم Mashhad 4116go هما يكوّنان مصحف يحفظ في مكتبة العتبة الرضويّة
(143)المقدّسة بمدينة مشهد الإيرانيّة، وهو المعروف بـ«مصحف مشهد». والمواصفات الظاهريّة لهذا المصحف الحجازي يُشعر بأنّه يعود إلى أمدٍ بعيد جدًا، ربما القرن الأول الهجري. ومع أنّ النّصّ القرآني فيه يوافق تمامًا الرسم العثماني، إلّا أنّ السور رُتّبت على أساس مصحف ابن مسعود. يتألّف القطعة المخطوطة الأولى من 122 ورقة -وتحتوي على السور بدء من سورة الحمد وانتهاء بسورة الكهف- والثانية من 129 ورقة -وتحتوي على السور بدءًا من وسط سورة طه وانتهاء بسورة الناس- وتشملان معًا حوالي 90 بالمئة من النص القرآني الشريف.
لا يُعرف أين كُتب هذا المصحف في الحجاز أو العراق، ولكنّه وُقف على العتبة الرضويّة المقدّسة في القرن الخامس الهجري، ونُسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام خطأ. أبعاد أوراقه المكتوبة على الرق -على وجه التقريب- في المخطوطة الأولى 34×42سم، وفي الثانية 30×40 سم، وسطح الكتابة 27 إلى 29×39 إلى 40سم، وتضمّ كلّ ورقة ما يتراوح بين 20 و25 سطرًا. يوجد نقط الإعجام في كلتا المخطوطتين، بينما أضيف إليهما نقط الإعراب بالحبر الأحمر في وقت لاحق. فُصلت الآيات عادة بخمسة أو ستة خطوط صغيرة بشكل مثلّثي، وأحيانًا بثلاثة خطوط صغيرة مائلة. يوافق رسم هذا المصحف ما يُعزى إلى مصحف المدينة، كما توافق قراءته القراءة المنسوبة إليها أيضًا (Karimi -Nia, 2019, pp. 292 -305).
صورة 32: Mashhad 18go ،79ظ
4 - السطر الأخير. يُحفظ هذا المخطوط في المكتبة البريطانيّة بلندن ويتألّف من 121 ورقة، ويعدُّ من أقدم المصاحف المكتوبة على الرق، ويضمّ نحو 60 بالمئة
(144)من النص القرآني، إذ يبدأ من الآية 42 من سورة الأعراف ويستمر بلا انقطاع حتى الآية 72 من سورة الزمر، ثم يبدأ من الآية 63 من سورة غافر وينتهي بالآية 71 من سورة الزخرف. وعلى الرغم من الزعم بأنّ هذا المصحف أحد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، فهو مصحف يعود إلى عهد متأخّر عن عثمان أقصاه النصف الثاني من القرن الأول الهجري، إلا أنّه يوافق خصائص المصحف الشامي حسب ما ورد في مصادر القراءات. يبدو أنّ الأب تشستر جلبه من مدينة الفسطاط المصرية -من جامع عمرو بن العاص على وجه التحديد - إلى إنجلترا وأهداه إلى المكتبة البريطانيّة عام 1879 الميلادي (آلتي قولاج، ٢٠١٧، صص 14 -27).
صورة 33: Or 2165 ،13ظ
5 - السطر الخامس. هذا المخطوط المحفوظ به في المكتبة الوطنيّة الروسيّة جزء من مصحف جلبه مارسيل في القرن الثامن عشر الميلادي من جامع عمرو بن العاص إلى فرنسا، وانتقل ضمن المجموعة الخاصّة به إلى المكتبة الروسية بعد موته. ويتألّف من 32 ورقة أبعادها 285×180مم، ويحتوي على النص القرآني بدءًا من سورة الأنفال وانتهاء بالآية 79 من سورة هود (Cellard, 2018, pp. 1 -3).
(145)صورة 34: Marcel 9 ،12ظ
توجد “لهم” في سورة الشورى الآية 21: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) في المخطوطات التالية دون إجراء تعديل سابق عليها. إذًا كتابة "لهم" فوقَ الكلمة الخاطئة المحذوفة تدلّ على التعديل الذي أجري بسبب إيجاد الموافقة بين مصحف باريسينو -بتروبوليتانوس والمخطوطات القرآنيّة السابقة عليه، والتي توافق النّصّ القرآنيّ في عصرنا هذا. وإن افترضنا أنّ الكلمة المحذوفة -كما ادّعى بروبيكر- هي لفظة «له»، فمن الواضح أنّ حذفها كان بسبب الخطأ النحوي في الآية بهذا التعبير؛ لأنّ الضمير إن كان مفردًا فلا مرجع له في هذا الكلام، وإن كان جمعًا فيعود إلى «لهم» في بداية هذه الآية المباركة.
1 - السطر الثالث. تقدم التعريف بهذا المخطوط في الرد على النموذج الأول.
صورة 35: Mashhad 4116go ،76و
(146)
2 - السطر الثالث. تقدمَ التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الأول.
صورة 36: Or 2165 ،118و
3 - السطر الثاني. تقدّمَ أنّ مارسيل وشرفيل جلبا بعض المخطوطات القرآنيّة من جامع عمرو إلى فرنسا، ومنها مصحف انقسم إلى عدة أجزاء، جزء منه محفوظ في المكتبة الوطنية الروسية تحت رقم Marcel 9، وجزء منه يُحتفظ به في المكتبة الوطنية الفرنسية تحت رقم Arabe 326a، وجزء منه يُحفظ في المجموعة الخاصّة بناصر خليلي، وجزء منه -وهو الذي التُقطت منه الصورة أدناه - بيع في مزاد أقيم في مدينة رين الفرنسية عام 2011 للميلاد لمتحف الفن الإسلامي بالدوحة، واليوم يحتفظ بـ29 ورقة منه تحت رقم MIA.2013.29.1 وبـ7 أوراق أخرى تحت رقم MIA.2013.29.2. والأول يحتوي على النص القرآني بدءًا من الآية 66 من سور غافر وانتهاء بالآية 38 من سورة الطور مع انقطاع في سورة الزخرف، والثاني يحوي آياتٍ من سور المجادلة والحشر والصف والجمعة (ibid., pp. 2 -3).
صورة 37: Rennes 1 = MIA 2013.29.1 ،7و
(147)4 - بداية السطر الرابع. تحتفظ بهذا المخطوط مكتبةُ تشستر بيتي في دبلن العاصمة الإيرلندية. ويتألّف من 32 ورقة أبعادها 305×381مم، مكتوبًا بالخط الحجازي على الرق، ويحتوي على النّصّ القرآني بدءًا من الآية 6 من سورة القصص وانتهاء بالآية 24 من سورة الفتح. لا يُعرف عمر المخطوط ولا ناسخُه، إلا أنّه يعود إلى القرن الأول الهجري.
صورة 38: Is 1615I ،24ظ
لم تسقط كلمة “الله” في الآيات التي أشار إليها بروبيكر من المخطوطات التالية، وهذا يدلّ على أنّ زيادة تلك الكلمة المباركة إلى النماذج التي عثر عليها بروبيكر ليست لها سبب إلا سهو الناسخ، وخصوصّا عندما أدّى سقوط هذه الكلمة المباركة إلى الخطأ المعنوي في الآية، كما صرّح بروبيكر بذلك، بينما زعم زيادَتها تحريفًا للقرآن ولا تدقيقًا للنسخة على أساس أصله.
أ) سورة الأحزاب الآية 18: (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ) .
(148)1 - السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الثاني.
صورة 39: Mashhad 4116go ،46و
2 - السطر الأول. تقدمَ التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الثاني.
صورة 40: Is 1615I ،8ظ
3 - السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الأول.
صورة 41: Or 2165 ،95و
4 - بداية السطر الأخير. هذه الصورة تعود إلى المصحف المعروف بـ"صنعاء 1"، والذي تقدّم ذكره في الفصل السابق، وهنا تجدر الإشارة إلى معلومات عن الكتابة
(149)الفوقيّة، وهي: إنّ أبعاد أوراق هذا المخطوط 28×37سم، وهي مكتوبة بالحبر البني الغامق، ويقل فيها نقط الإعجام، وتخلو من نقط الإعراب.
صورة 42: DAM 01 -27.1 ،23ظ
ب) سورة الأحزاب الآية 24: (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) .
1 - نهاية السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الثاني.
صورة 43: Mashhad 4116go ،46ظ
2 - السطر الثاني. تقدم التعريف به آنفا.
صورة 44: DAM 01 -27.1 ،24و
3 - السطر الثاني. يحتفظ بهذا المصحف الحجازي في مكتبة برلين الحكومية بألمانيا، ويتألف من 24 ورقة مكتوبة على الرق الأصفر الناعم أبعادها 28×33
(150)إلى36مم، وكل ورقة تضم ما يتراوح بين 31 و33 سطرا، ويحتوي على آيات من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
صورة 45: Ms. or. fol. 379 ،4و
4 - نهاية السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المخطوط في الرد على النموذج الثاني.
صورة 46: Is 1615I ،8ظ
5 - نهاية السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الأول.
صورة 47: Or 2165 ،95ظ
ج) سورة الأحزاب الآية 73: (وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) .
(151)1 - السطر الثالث. تقدم التعريف بهذا المخطوط.
صورة 48: Mashhad 4116go ،49ظ
2 - السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المخطوط.
صورة 49: Or 2165 ،98ظ
3 - السطر الأخير. هذا المصحف هو أحد المخطوطات المكتشفة في الجامع الكبير بصنعاء، ويحتفظ به في دار المخطوطات في العاصمة اليمنية، ويتألف من 35 ورقة أبعادها 300×420مم، مكتوبًا على الرق بالخط الحجازي.
صورة 50: DAM 01 -29.1 ،20ظ
د) سورة فصلت الآية 21: (قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ).
(152)1- السطر الثاني. تقدم التعريف به في الرد على النموذج الثاني.
صورة 51: Rennes 1 = MIA 2013.29.1 ،3و
2- السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 52: Is 1615I ،23و
3- نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 53: Or 2165 ،115ظ
(153)4- نهاية السطر الثالث من الجانب الأيسر وبداية السطر الرابع من الجانب الأيمن. تقدم التعريف به.
صورة 54: DAM 01 -27.1 ،30و
ه) سورة الحج الآية 40: (يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) .
1- نهاية السطر الأول وبداية السطر الثاني. هذا المخطوط من المصاحف التي درسها بروبيكر، ووجد فيها عددًا من الأخطاء، ولكنّه لم يستند إلى هذا الجزء -أي الجزء Arabe 328c من مصحف باريسينو -بتروبوليتانوس- لأنّه يرفض دعواه بشأن زيادة كلمة «الله» المباركة في وقت متأخّر عن كتابة المخطوطات المبكرة. والجدير بالذكر أنّ هذا الجزء من المصحف يماثل جزءه الثاني السابق ذكره من حيث الخط، كما يقلّ فيه نقط الإعجام ويخلو من نقط الإعراب، وكذلك كُتب بالحبر البني على الرق، إلّا أنّ أبعاد أوراقه الستة عشر تختلف عن أوراق الجزء الثاني، إذ تضم كل ورقة من هذا ما يتراوح بين 24 و25 سطرًا، وأبعادها 245×333مم، بينما سطح الكتابة 215×300 إلى 312 مم، فضلًا عن أنّ هذا الجزء ليست فيه علامات التخميس والتعشير بخلاف الجزء الثاني (Déroche, 1983, pp. 60 -61).
صورة 55: Arabe 328 ،84ظ
(154)2- نهاية السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 56: Mashhad 4116go ،8ظ
3- السطر الثالث. تقدم التعريف به آنفا.
صورة 57: DAM 01 -29.1 ،19و
4- السطر الثاني. تقدم التعريف به.
صورة 58: Or 2165 ،60ظ
و) سورة النور الآية 51: (دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .
1- بداية السطر الثالث. تقدم التعريف به. من المستغرب أنّ بروبيكر يصرّح بأنّ الآية لو كانت (دُعُوا إِلَى وَرَسُولِهِ) -كما عثر عليها في مخطوط Marcel 13- لفسد المعنى، بينما لا يرى سقوطَ الكلمة خطأً وقع من الناسخ وزيادتَها تصحيحًا لذلك الخطأ النسخي!
(155)صورة 59: Mashhad 4116go ،17ظ
2 - السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 60: Or 2165 ،68ظ
3 - السطر الأوّل. هذا المصحف هو من أقدم المخطوطات القرآنيّة التي جلبها المستشرق الألماني ويتسشتاين من المسجد الأموي بدمشق إلى أوروبا في القرن التاسع العشر الميلادي، وباعها لمكتبة برلين الحكوميّة، وهي اليوم في نفس المكتبة. يتكوّن هذا المصحف من 210 ورقة، وهو مكتوب بالخط الحجازي المعيار (Déroche, 2019, pp. 107 -109)، بألوان البني والأسود والأحمر، على رق أصفر وأبيض. أبعاد أوراقها 265×335م، وسطح الكتابة22×29سم، وكل صفحة تضم ما يتراوح بين 23 و25 سطرًا. وُضع في المصحف نقط الإعراب باللون الأحمر عادة، وهناك علامات لفواصل الآيات، وهي ست خطوط صغيرة تقع في ثلاثة صفوف مائلة.
(156)صورة 61: Wetzstein II 1913 ،135و
ز) سورة فاطر الآية 11: (إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) .
1 - السطر الثاني. تقدم التعريف به. يَعرف بروبيكر تمامًا أنّ الآية لو كانت «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى يَسِيرٌ» -كما عثر عليه في المخطوط المشار إليه- لخالفتْ القواعدَ العربية؛ أفيُعقل أنّ الآية نزلت هكذا لا تفيد معنى ثم عُدّلت بعد مرور أعوام من وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟! أم كانت الآية كما توجد في المصاحف التي بين أيدينا اليوم ولكن ناسخ مخطوط Marcel 13 أخطأ في كتابتها، فتمّ تصحيحها فيما بعد على أساس المخطوطات الأخرى الصحيحة في ذلك الزمن، كما وردت الآية في المخطوطات التالية دون إجراء تصحيح عليها.
صورة 62: Is 1615I ،12و
2 - السطر الأخير. تقدم التعريف به.
صورة 63: Mashhad 4116go ،53ظ
(157)3 - السطر الثاني. تقدم التعريف به.
صورة 64: Or 2165 ،102و
4 - السطر الثالث. ما يلفت الانتباه في هذا المخطوط هو كتابة حرف «على» بشكل «علا»، وهذا خلاف ما ورد أن حرف «على» رُسم في جميع المصاحف القديمة بالياء (المهدوي، ١٤٣٠، ص54)! وتوجد هذه الظاهرة في بعض المخطوطات القرآنيّة الأخرى بالخط الكوفي أيضًا.
صورة 65: DAM 01 -27.1 ،25ظ
ح) سورة التوبة الآية 93: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) .
(158)1- بداية السطر الثالث. تقدّم التعريف به. ليس من المستبعد أنّ كاتب مخطوط Marcel 21 أخطأ بين هذه الآية الشريفة والآية 87 من السورة ذاتها: (وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ) ، فأسقطَ لفظ الجلالة من الآية 93 أيضًا.
صورة 66: Mashhad 18go، 80ظ
2- نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث. هذا المخطوط هو أحد المصاحف التي درسها بروبيكر واستند إليه في كتابه، إلا أنّه تجاهل عن موافقة الآيات في هذا المصحف الحجازي القديم مع النص القرآني في الوقت الراهن بغية إثبات فرضيته.
صورة 67: Arabe 328، 42ظ
3- السطر الثالث. هذا مصحف حجازي آخر استفاد منه بروبيكر في كتابه، دون أن يستند إليه حيث يعارض دعواه، كما يظهر في الصورة أدناه.
صورة 68: Arabe 330، 66ظ
(159)4- السطر الثالث. تقدم التعريف به سابقًا.
صورة 69: Marcel 9 ،14ظ
5- السطر الثاني. تقدم التعريف به.
صورة 70: Or 2165 ،14ظ
ط) سورة التوبة الآية 78: (وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) .
1- السطر الثاني. مع أنّ هذا المصحف هو أحد المخطوطات التي استفاد منها بروبيكر في كتابه، ولكنّه لم يأتِ بصورة من هذا المخطوط الذي تظهر فيه هذه الآية المذكورة دون إجراء تصحيح عليها، إذ هي ترفض دعواه بشأن تلك الآية الشريفة.
صورة 71: Arabe 328 ،41ظ
(160)2- السطر الثالث. تقدّم التعريف بهذا المخطوط الذي استند إليه بروبيكر في كتابه، ولم يلتفت إلى عدم التصحيح في هذه الآية المباركة، كما هو دأبه في كثير من نماذجه.
صورة 72: Arabe 330 ،66ظ
3- السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 73: Mashhad 18go ،79ظ
4- بداية السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 74: Or 2165 ،14و
(161)5- السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 75: Marcel 9 ،13و
لا توجد لفظة في المصاحف القديمة بين كلمة “عاقبة” وكلمة “الذين” في سورة الروم الآية 9: (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ، خلافًا لِما زعمه بروبيكر أنّ لفظة تتكوّن من نحو ستة أحرف أزيلت من القرآن، كما يظهر فارغ بينهما في مخطوط Marcel 2. في الحقيقة المصاحف القديمة تؤيّد النّصّ القرآني الذي بين أيدينا -كما يظهر ذلك في الصور التالية- وتدلّ على الخطأ النسخي الوارد في ذلك المخطوط المذكور؛ فلعلّ ناسخَه كتب “... عقبة الذين” في آخِر سطر من الورقة 30ظ، ثم بدأ بـ “الذين من ...” في الورقة التالية، ولمّا راجعَ ما كتبه أدرك الخطأ، فأزال المفردة المكرّرة في الورقة 30ظ، فبقي فارغًا بعد “عقبة”، وهو يلائم لفظة تتكوّن من نحو ستة أحرف، وهي كلمة “الذين” المكوَّنة من خمسة أحرف.
1 - نهاية السطر الثاني.
صورة 76: Mashhad 4116go ،39و
(162)2- نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث.
صورة 77: Or 2165 ،88ظ
إضافة إلى هذين المصحفين اللذين يسبقان مخطوط Marcel 2 زمنيًّا، ثمّة مصاحف مخطوطة أخرى يقدَّر تاريخه بالقرن الثاني الهجري، أي الفترة التي كُتب فيها مخطوط Marcel 2 حسب ما قاله بروبيكر.
3- السطر الثالث. يحتفظ بهذا المصحف الشريف في المكتبة المركزيّة للعتبة الرضويّة المقدّسة بمدينة مشهد، ويُنسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام، ويحتوي على النص القرآني بكامله إلّا ما فُقد من أوراق المصحف. ويتألّف من 341 ورقة أفقيّة أبعادها 25×32سم، وسطح الكتابة 20×25سم، وتضمّ كل ورقة 16 سطرًا. وكُتب بالحبر الأسود على الجلد، ووُضع فيه نقط الإعجام، وكذلك رُسم نقط الإعراب باللون الأحمر. وُقف المصحف على العتبة المقدّسة في عام 1009هـ. على يد الشاه عباس الأول.
صورة 78: Mashhad 1go ،238و
4- نهاية السطر الثالث وبداية السطر الرابع. يحفظ هذا المصحف الشريف في المكتبة المركزيّة للعتبة الرضويّة المقدّسة، ويتألّف من 363 ورقة أفقيّة أبعادها 22×82سم، بينما سطح الكتابة 18×24 سم، وتضمّ كلّ من الأوراق 15 سطرًا، وتحتوي على القرآن الكريم ما عدا بعض السور الأخيرة التي سقطت من هذا المصحف. وكُتب بالخط الكوفي على الرق بالحبر الأسود، وفيه نقط الإعجام قليلًا،
(163)بينما يمتاز بثلاثة ألوان لنقْط الإعراب؛ ففيه نقَط حمراء للدلالة على قراءة المصحف، بينما توجد فيها نقاط خضراء ونقاط زرقاء للدلالة على قراءتين أخريين. ورُسمت فيه زهور صفراء للفصل بين الآيات المباركة.
صورة 79: Mashhad 21go ،224ظ
5- نهاية السطر الثالث. هذا المصحف الشريف محفوظ في متحف العتبة الرضوية المقدسة، وهو يتألّف من 310 ورقة أفقيّة أبعادها 20×29سم، بينما سطح الكتابة 15×23 سم، وتضم كل ورقة منه 15 سطرًا. وكُتب بالخط الكوفي على الرق الحناوي بالقلم الأسود، ووُضع فيه نقط الإعجام، كما رُسم فيه نقط الإعراب بالحبرين الأحمر والأخضر للدلالة على قراءتين.
صورة 80: Mashhad 26gom، 206ظ
6- بداية السطر الأخير. تَحتفظ بهذا المصحف الشريف المكتبةُ المركزية للعتبة الرضوية المقدّسة، ويتألّف من 325 ورقة أفقية أبعادها 23×29سم، بينما سطح الكتابة 16×22سم، وتضم كل ورقة منه 17 سطرًا. وكُتب على الرق الحمّصي بالقلم الأسود، ويخلو من نقط الإعجام، ولكنه تحتوي على نقط الإعراب باللون الأحمر. كذلك فيه خطوط مائلة صغيرة للدلالة على فواصل الآيات، كما توجد فيه زخرفات تفصل السور.
(164)صورة 81: Mashhad 3540go، 212ظ
استند بروبيكر في هذا النموذج إلى مصحف عائد إلى القرن الثامن أو التاسع للميلاد، وعثر على حوالي ثلاثين تصحيحًا في أوراقه الاثنتي عشرة، تؤدّي بعضُ التصحيحات إلى معارضة هذا المصحف مع النص القرآني الراهن (Brubaker, 2019, p. 47). مع أنّ هذا التصريح -أي معارضة بعض التصحيحات الواردة فيه مع القرآن الذي بين أيدينا اليوم- ترفض دعوى بروبيكر نفسِه أنّ التصحيحات الواردة في المخطوطات القرآنيّة تتّجه نحو الموافقة للمصحف الأميري، ولكن ما وجده في هذا المخطوط مجرّد أخطاء نسخيّة ارتكبها كاتب مبتذل. لذلك ثمّة ملاحظة جديرة بالذكر حول هذا المخطوط المغلوط قبل عرض الصور من المصاحف المبكرة التي وردت فيها الآيات المباركة حيث توافق النص القرآني دون اجراء تصحيح عليها بالمرة، وهي:
تختلف نفاسة النسَخ المخطوطة وقيمتُها باختلاف نسّاخها؛ إذ كان بينهم جاهل وعالم وطالب العلم والمتوسط بينهم (الطباع، ٢٠١١، ص165). وقد ساعد بعض النسّاخ الذين تنحصر جهودهم في استنساخ الكتب وبيعها للناس على ظاهرة التصحيف في المخطوطات؛ إذ كانوا غالبًا غيَر عالمين باللّغة ليتمكّنوا من تمييز الكلمات والحروف، فارتكبوا أخطاء في الكتابة (دياب، ١٩٩٣، ص171)؛ كما سقطوا حروف العطف تارة وأبدلوها بغيرها تارة أخرى، أو نسوا كلمات صغيرة، مثل: عن، من، به، له. كذلك قد قفزوا كلمة أو أكثر، أو تخطّوا سطرًا بكامله. إضافة إلى ذلك، قد وقعوا أحيانًا في الأخطاء النحويّة أو غيّروا ترتيب الحروف من الكلمة، ولا سيما أحرف المضارعة من الأفعال (التونجي، ١٩٨٦، صص168 -169). فضلًا
(165)عنه، لقد أخطأ هؤلاء النسّاخ كثيرًا عندما نقلوا النصوص من أصل قديم مكتوب بالخط الحجازي إلى مخطوط كتبوه بالخط الكوفي جرّاء عدم معرفتهم لذلك الخط وخصائصه (برغشترسر، ١٩٨٢، ص81).
بناء على هذا، يتم التأكيد على معرفة الناسخ ومقدار كفاءته العلميّة بغية التعرّف على مقدار ضبطه في الأداء وعيوبه (الطباع، ٢٠٠٣، ص26)؛ حيث يفضِّل المحقّقون النسخة المخطوطة التي تتمتّع بالإتقان والصحّة والضبط على ما ليست لها ميزة سوى القِدم مع كثرة التحريف والتصحيف فيها (عسيلان، ١٩٩٤، ص134). فتزداد قيمة النسخة التي كتبها عالم جليل أو قابلها أو امتلكها أو راجعَها (الغرياني، ٢٠٠٦، ص31؛ عبد التواب، ١٩٨٥، ص67)، ولا بأس بصرف النّظر عن نشر المخطوطات التي ليس لها جدوى تذكر بسبب قلّة الضبط والصحّة فيها (عسيلان، ١٩٩٤، ص 49)؛ إذ تتفاوت النسَخ المخطوطة، حيث هناك ما لا قيمة له من أجل التصحيح (برغشترسر، ١٩٨٢، ص15).
وعلى هذا الأساس اشترط العلماء لناسخ أيّ علمٍ مهما كان ألّا يكتب شيئًا إلّا بعد اطّلاعه على ذلك العلم وممارسته له، حتى يَسلم من الغلط والتحريف والتبديل والتصحيف (النويري، ١٤٢٣، ج 9، ص214). وإذا كان الناسخ مجهولًا، فلننظرْ فيما استنسخه؛ فإنّ كفاءته ودقّته وأمانته تتجلّى في النّصّ الذي كتبَه؛ فإن كان النصّ سليمًا يوافق الأصل المنسوخ منه، فالنّاسخ بارع في عمله، وإن كان النّصّ يكثر فيه الأخطاء -كالأخطاء النحويّة والإملائيّة وغيرهما- فما أجاد الناسخ عملَه، فلا قيمة للنسخة المكتظة بالتصحيف والتحريف والخطأ للدراسة والتحقيق. ثم بالنسبة إلى المخطوطات القرآنيّة، إن لم يكن ناسخها على دراية بعلوم كرسم المصحف والقراءات وعد الآي والتخميس والتعشير، يقدّم نسخة مغلوطة -على الرغم من شرفها للنص المبارك الذي تحمله- لا تستحق التحقيق والتعويل عليها في مجال دراسة المخطوطات القرآنيّة القديمة.
وقد واجهنا في هذا النموذج من كتاب بروبيكر مصحفًا مليئًا بالأخطاء والتصحيحات، وهذا يُشعر بأنّ الكاتب لم يحظَ بالمؤهلات التي يفتقر إليها ناسخ القرآن الكريم، وكأنّه كان رسّامًا ليس واعيًا عمّا يستنسخه. ويتّضح ذلك من الأخطاء النحويّة والإملائيّة التي أشار إليها بروبيكر بصدد إثبات فرضيّته، مبنيًّا على هذا الدليل الذي لا يصلح أبدًا. ولكن بغضّ النّظر عن عدم صلاحيّة هذا المخطوط للتحقيق والدراسة العلميّة، نأتي بصور من المصاحف التي ترجع إلى عهد أقدم من هذا المخطوط أو هي متزامنة معه. وتثبِت هذه المصاحف القديمة أنّ النّصّ القرآنيّ لم يتعرّض للتغيير منذ كتابته، وأنّ الذي وجده بروبيكر في المخطوط المغلوط ليس سوى أخطاء نسخيّة ارتكبها كاتب غير بارع.
تمّ تحديد المواضع الثالثة عشر التي يختلف فيها مخطوط MS.474. 2003 عن المصاحف الأخرى القديمة -والتي توافق القرآن الذي بين أيدينا- في الصور التالية، وتشتمل على أجزاء من الآيات 91 إلى 97 من سورة الأنعام: (...أَنتُمْ (وَلَآ) ءَابَآؤُكُمْ... أَنزَلْنَٰهُ (مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ) الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (وَلِتُنذِرَ) أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ (حَوْلَهَا وَالَّذِينَ) يُؤْمِنُونَ... عَلَىٰ (صَلَاتِهِمْ) يُحَافِظُونَ...كَذِبًا (أَوْ)"قَالَ... وَلَوْ تَرَىٰٓ (إِذِ)"الظَّٰلِمُونَ... وَالْمَلَٰٓئِكَةُ (بَاسِطُوٓاْ) أَيْدِيهِمْ... بِمَا (كُنتُمْ تَقُولُونَ)"(عَلَى اللَّهِ)"غَيْرَ الْحَقِّ... شُفَعَآءَكُمُ (الَّذِينَ) زَعَمْتُمْ... ذَٰلِكُمُ (اللَّهُ فَأَنَّىٰ) تُؤْفَكُونَ... قَدْ فَصَّلْنَا الْأٓيَٰتِ لِقَوْمٍ (يَعْلَمُونَ) ) .
1- تظهر المواضع المذكورة في أحد المصاحف التي استند إليه بروبيكر، وهي موافقة تمامًا للقرآن الكريم المتداول بين المسلمين.
(167)صورة 82: Arabe 328، 26و
2- تظهر المواضع الثلاثة عشر في هذين الصورتين. يُحتفظ بهذا المخطوط في المكتبة الوطنيّة الروسيّة ويعود تاريخه -حسب الاختبار الكربوني المشع- إلى ما بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن، غير أنّ دراسة كوديكولوجيّة تقدر تاريخه أكثر من هذا. يتألّف هذا المصحف من 84 ورقة، 26 ورقة منه في المكتبة الوطنيّة الروسيّة (أبعادها 41×37سم)، و56 ورقة في المكتبة الوطنية الفرنسيّة تحت رقم Arabe 331، وورقتين في مكتبة جامعة لايدن تحت رقمين Cod.or. 14.545b و Cod.or. 14.545c. كُتب المخطوط بالحبر البني على يد ناسخ واحد
(168)بخط BIa وفقًا لتصنيف ديروش. ويقلّ فيه نقط الإعجام وليس له نقط الإعراب. وهذا المخطوط بكامله يشمل 40 في المئة من النص القرآني الشريف.
صورة 83: Marcel 3 ،12و
صورة 84: Marcel 3 ،12ظ
(169)3- تم تحديد المواضع في هذا المصحف الذي تقدّم التعريف به في الرد على النموذج الثالث (جزء و).
صورة 85: Wetzstein II 1913 ،50و
صورة 86: Wetzstein II 1913 ،50ظ
4- تظهر المواضع السابقة الذكر في مصحف باريسينو -بتروبوليتانوس حيث توافق المصاحف المطبوعة. والصورة أدناه تعود إلى الجزء Arabe 328e منه، أي
(170)من الورقة 90 إلى 95، والذي كُتب بالحبر الأسود وبالخط الحجازي على الرق. يظهر في هذا الجزء نقطُ الإعجام بخطوط مائلة [صغيرة]، بينما يخلو من نقط الإعراب، ولكنّه يتمتّع بعلامات تحدّد التخميس والتعشير، كما وُضعت فيه نقاط ثمانية بشكل دائري للفصل بين الآيات. وأوراقه تضمّ ما يتراوح بين 24 و26 سطرًا، وأبعادها 215×315 مم، وتحتوي على آيات من سورتي المائدة والأنعام (Déroche, 1983, p. 62).
صورة 87: Arabe 328، 94ظ
صورة 88: Arabe 328 ،95و
(171)من المستغرب جدًّا أنّ بروبيكر يقرّ بأنّ الخطأ الذي أشار إليه في نموذج السادس خطأٌ نسخيٌّ بسيطٌ وقع جرّاء خلط الناسخ بين التعابير الواردة في سورة المائدة الآية 93: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا) ، وعلى الرّغم من ذلك يتشبّث بهذا التصحيح دليلًا على التحريف في القرآن الكريم! إضافة إلى ذلك، قال إنّ زيادة الألِف في نهاية «عملوا» بقلم يختلف عن قلم الناسخ للمخطوط تتعلّق بقواعد الكتابة (Brubaker, 2019, pp. 52 -53)، فليست زيادتها أو سقوطها دليلًا على التحريف في النّصّ القرآنيّ الشريف، ولا داعيَ للرد على ما تقدّم من كلامه. وأمّا ما ذكره من زيادة الألِف في بداية «أحسنوا» فهو خطأ نسخي آخر؛ فليس من المستبعد أن ينسى الناسخُ الذي يهمل جزءًا من الآية، ينسى جزءًا من الكلمة سهوا. لذلك لم يحدث هذا الخطأ في المخطوطات القرآنيّة المبكرة؛ لأنّ ما وجده بروبيكر ليس سوى تصحيح على أساس المصاحف المتقدّمة زمنيًّا على المخطوط الذي أشار إليه.
1 - السطر الثاني فصاعدًا. تقدمّ التعريف به في الرد على النموذج الثالث.
صورة 89: Wetzstein II 1913 ،43ظ
(172)2- السطر الأول وما بعده.
صورة 90: Mashhad 18go ،48و
3 - السطران الثاني والثالث. هذه الصورة للمخطوط المعروف بمصحف سانت بطرسبورغ. يتألّف هذا المخطوط من 97 ورقة (منها 81 ورقة تتعلّق بجمعيّة الدراسات الشرقيّة في سانت بطرسبورغ، و12 ورقة تتعلّق بنسخة مستكشفة في قرية كاتا لانجر، وورقتان لمكتبة ابن سينا في بخارَى، وورقة لجمعيّة الدراسات الشرقيّة في طشقند، وورقة لمكتبة إدارة شؤون المسلمين في طشقند) ويحتوي على النص القرآني بدءًا من الآية 17 لسورة البقرة وانتهاء بالآية 12 لسورة نوح، إلّا ما فُقدت من أوراقه. قام المستعرب الروسي إفيم رضوان بتحقيق هذا المصحف ونشرِ صورة طبق الأصل عام 2004 الميلادي، وأهدي ذلك بعنوان «مصحف عثمان» إلى قادة البلدان الإسلاميّة. ورغم أنّ الاختبار الكربوني المشع قدّر تاريخه بفترةٍ زمنيّةٍ تتراوح بين عامين 158 و385 للهجرة، تظهر الدراسات الباليوغرافية أنّ المصحف يعود إلى القرن الثاني الهجري، أي فترة تطوّرَ فيها الخط الحجازي إلى الخط الكوفي (توكلي ومحمدي أنويق، ١٣٩٥، صص136 -141). إذًا يمكن تصنيف هذا المصحف من نوع الحجازي المتأخّر، وعلى هذا الأساس ليست كتابته بعيدًا جدًا عن المصحف الذي استند إليه بروبيكر.
(173)صورة 91: E20، 19و
ليس التصحيح المشار إليه في هذا النموذج إلا خطأ نسخيّا آخرَ تمّ تصحيحه على يد كاتب أدرك الخطأ عند قراءة المصحف، فعدّله على أساس المصاحف الأخرى التي يرد فيها ذلك التصحيح -مثل المصاحف القديمة التي تمّ تصويرها فيما يلي- وهي التي توافق النّصّ القرآني في العصر الراهن. ولا يبدو سقوط كلمة «السبع» من سورة المؤمنون الآية 86: (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) وكتابة "والأرض" بدلًا منها غريبًا؛ لأنّ تعبير "السماوات والأرض" من التعابير الشائعة والمتداولة في القرآن الكريم، لذلك عندما كتب الناسخُ كلمةَ "السموت"، ظنّ أنّ الكلمة اللاحقة هي "والأرض"، فكتبها ولم ينتبه إلى خطئه، ولكن الذي قرأ المصحف فيما بعد قام بتصحيحه بقلم يختلف عن قلم الناسخ، كما كتب "السبع" وخربش "والأرض".
ثم بالنّسبة إلى زيادة الألِف قبل كلمة "لله" المباركة في الآية التالية: (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ)، فهي نموذج للأثر المتبادل بين القراءة ورسم المصحف -والذي أنكره بروبيكر كما مرّ سابقًا- ولا يُعدّ تحريفًا للقرآن المجيد؛ لأنّ اختلاف القراءات -كما تقدّم في البحث عن "التصحيحات التي تؤدّي إلى الوفاق بين المخطوطات ومصحف القاهرة 1924"- ليس دليلًا على المرونة في النصّ القرآنيّ ولا التحريف في آياته الشريفة؛ فما كتبَه الناسخ الأصلي يوافق قراءة عدد من القرّاء -بما فيها قراءة عاصم برواية حفص، وهي قراءة المصحف الأميري- ولكن التصحيح الوارد في المخطوط جعله
(174)موافقًا لقراءة عبد الله والحسن والجحدري ونصر بن عاصم وأبي عمرو ويعقوب واليزيدي وبعض آخر من القرّاء (انظر: الخطيب، ١٤٢٢، ج 6، صص200 -201). وسترى نماذج أخرى لهذا الاختلاف في القراءة تظهر بجلاء في المخطوطات التالية.
1 - السطر الثاني. يبدو أنّ الألف أضيفت في وقت متأخّر إلى السطر الثالث قبل كلمة «لله»، وجعلتْ الآيةَ موافقة لقراءة القرّاء المذكورين آنفًا، إلّا أنّها لا تؤثّر على المعنى تأثيرًا.
صورة 92: Or 2165 ،64ظ
فضلًا عن هذا المخطوط الحجازي القديم، هناك مخطوطات كوفيّة يقدَّر تاريخها بالقرن الثاني للهجرة، أي الفترة التي يعود إليها المخطوط الذي استند إليه بروبيكر حسب قوله، توجد فيها الآياتُ المباركة حيث توافق المصاحف التي بين أيدينا اليوم.
2- بداية السطر الثاني. تقدّم التعريف بهذا المخطوط في الرد على النموذج الرابع. نجد في هذا المصحف الشريف في نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث وردت الآيتان 87 و89 من سورة المؤمنون بلفظ (سَيَقُولُونَ اللَّهُ) ، وهذا يوافق القراءة التي رآه بروبيكر في المخطوط الذي استند إليه، دون إجراء تعديل عليه في هذا المصحف.
(175)صورة 93: Mashhad 1go ،203ظ
3 - السطر الثالث. يُحفظ هذا المصحف الشريف في المكتبة المركزيّة للعتبة الرضوية المقدّسة، ويتألّف من 202 ورقة أبعادها 13×9سم، وسطح الكتابة 95×145مم، وكل منها تضم 16 سطرًا، وهو يحتوي على النص القرآني بدءًا من الآية 67 لسورة آل عمران وانتهاء بالآية 42 لسورة الطور، وهذا يعني أنّ أوراقًا كثيرةً منه قد ضاعت. وكُتب على الجلد بالقلم الأسود وبالخط الكوفي. يقلّ فيه نقط الإعجام، ولكن نقط الإعراب فيه موضوع بالحبر الأحمر عادة. جدير بالذكر أنّ الآيتان 87 و89 من سورة المؤمنون وردتا في هذا المصحف أيضًا بلفظ (سَيَقُولُونَ اللَّهُ) ، وما أضيفت إليهما الألفُ لاحقًا، بل هي كتابة الكتاب الأصلي للمخطوط.
صورة 94: Mashhad 3148go ،107ظ
4- السطر الثالث. تقدّم التعريف بهذا المخطوط في الرد على النموذج الرابع. قراءة هذا المصحف أيضًا توافق المصحف الذي أشار إليه بروبيكر، غير أنّها ترجع إلى الكتابة الأولى للمخطوط، دون إجراء تعديل عليه.
(176)صورة 95: Mashhad 3540go، 181ظ
5- بداية السطر الثالث. تقدم التعريف بهذا المخطوط في الردّ على النموذج الرابع، وكذلك يشمل قراءتين -إحداهما وُضعت باللون الأحمر والأخرى بالأخضر- تتضحان بجلاء في هذه الصورة، إذ نجد الألف في السطر الثالث كُتبت بالحبر الأخضر للدلالة على الاختلاف في قراءة الآية عن القراءة التي تُسقِط الألف وتضيف إلى الكلمة لامَ الجرّ.
صورة 96: Mashhad 26gom، 176و
6- السطر الثالث. تقدّم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الرابع. هذه الصورة أوضح في الدلالة على الاختلاف في قراءة الآيتين المذكورتين منذ القرون الأولى، ففي السطرين الثالث والخامس الألفُ مكتوبة بالقلم الأسود، وعليهما خربشة خضراء تشير إلى عدمهما في القراءات الأخرى.
صورة 97: Mashhad 21go، 190و
(177)قال بروبيكر بكل صراحة أن التصحيح الذي عثر عليه في هذا النموذج أجري على يد مَن كتب المخطوط نفسُه، وذلك بعد أن أدرك خطأه في الكتابة الأولى (Brubaker, 2019, p 58). فلا يُعرف أيّ شيء يريد إثباتَه بهذا النموذج الذي لا يمت إلى تحريف القرآن بصلة! لذلك نترك الرد على هذا النموذج -أي الخطأ النسخي الواضح- الذي لا يعتدّ به.
لم تسقط كلمة “الرحيم” في سورة الشورى الآية 5: (أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) من المخطوطات التالية، وهذا دليل على أنّ المخطوط الذي يخلو من هذه الكلمة حدث فيه خطأ نسخيّ، ثم عُدّل على يد شخص آخر أدرك معارضة هذا المخطوط المغلوط للمخطوطات الأخرى الصحيحة في ذلك الزمن.
1- السطر الثالث. هذا المخطوط من المصاحف التي استفاد منها بروبيكر في كتابه ولم يستند إليه حيث وجده معارضًا لدعواه.
صورة 98: Arabe 328 ،58و
2- السطر الثالث.
صورة 99: Rennes 1 = MIA 2013.29.1 ،5و
(178)3- بداية السطر الثالث.
صورة 100: Wetzstein II 1913 ،166و
4- نهاية السطر الثالث وبداية السطر الرابع.
صورة 101: Or 2165 ،117و
5- بداية السطر الثاني. للأسف لا تظهر المفردات الأخرى قبل «الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» في السطر الأول من هذه الصورة بسبب الأضرار اللّاحقة بالورقة.
صورة 102: Mashhad 4116go ،75ظ
قراءة الجمهور للآية 137 من سورة البقرة هي: (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ)، ولكنها رُويت عن ابن عباس وابن مسعود وابن مجاهد وأبي صالح وأنس بحذف «مثل» (الخطيب، ١٤٢٢، ج 1، ص201)، غير أنّ هذه القراءة تخالف رسم مصاحف الأمصار جميعها (ابن أبي داود، ١٤٢٣، ص196)، فهي قراءة شاذة -ولعلّها
(179)اجتهاد ممن رُوي عنه أو عُزي إليه- لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه؛ لأنّها غير متواترة لم تُنقل إلا عن عدد قليل من الصحابة، إن افترضنا صحّة ما نُسب إليهم. فضلًا عنه، كتابة هذه الآية في المخطوطات القرآنيّة المبكرة تدلّ على صحّة القراءة المتّفق عليها، وكذلك حاجة المخطوط الذي تعرّضَ للتصحيح إلى ذلك التعديل الذي جعله موافقًا للمصاحف المتقدّمة عليها.
1- بداية السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج السادس.
صورة 103: E20، 2و
2- السطر الثالث.
صورة 104: Wetzstein II 1913، 5و
3- السطر ما قبل الأخير. هذه الصورة تظهِر مصحفًا حجازيًّا صوّره برغشترسر في تركيا، وهي محفوظة ضمن مجموعة صوره التي يمتلكها مشروع «كوربوس كورانيكوم» الألماني -الفرنسي، وتقدّم الكلام عنها في فصل «ملخص من اهتمام المستشرقين».
(180)صورة 105: Gotthelf -Bergsträßer -Archiv: Saray Medina 2 ،5و
يذكر بروبيكر أنّ لفظ الجلالة كُتب ناقصًا في سورة التحريم الآية 8 (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) في مصحف طوب قابي، وأنّ الآية لا تفيد معنًى لو كانت: «توبوا إلى ا توبة نصوحا»، كما وردت في هذا المخطوط (Brubaker, 2019, p. 65)، ومع ذلك لا يرى احتماليّة أنّ السبب هو الخطأ في الكتابة! إذ كانت كتابةُ جزءٍ من الكلمة في نهاية السطر وكتابة الجزء المتبقّي في بداية السطر التالي شائعة في المصاحف القديمة، فلعلّ الناسخ كتبَ الألِف من لفظ الجلالة في نهاية السطر ليكتب ما يتبقّى منه في بداية السطر التالي، ولكنّه نسي أن يكتبه، فبدأ بكتابة الكلمة التالية، ثم باشر شخص آخر تصحيحَ المخطوط وفقًا لِما ورد في المخطوطات المبكرة الأخرى، كما تظهر بعض الصور منها فيما يلي:
1- السطر الثالث. استفاد بروبيكر من هذا المصحف القديم في كتابه، ولم يستند إليه عندما ظهرت فيه الآية المذكورة بشكل يوافق النص القرآني في العصر الراهن دون اجراء تصحيح عليها.
(181)صورة 106: Arabe 328 ،67ظ
2 - السطر الثالث.
صورة 107: Wetzstein II 1913 ،200ظ
ثمة مخطوطات قرآنيّة أخرى تعود إلى فترةٍ زمنيّةٍ قريبةٍ من كتابة مصحف طوب قابي، وفيها النّصّ القرآنيّ موافقًا للمصاحف التي بين أيدينا دون إجراء تعديل عليها.
3- نهاية السطر الثالث. تقدم التعريف به في الرد على النموذج الرابع.
صورة 108: Mashhad 1go ،333ظ
4- السطر الثالث. تقدم التعريف به في الرد على النموذج الرابع.
صورة 109: Mashhad 21go ،319ظ
(182)
5- بداية السطر الثاني.
صورة 110: Mashhad 26gom ،227ظ
6 - نهاية السطر الثالث.
صورة 111: Mashhad 3540go ،303ظ
ما يؤيّد نظرة بروبيكر في هذا النموذج -أي في سورة آل عمران الآية 171: (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ) من مصحف باريسينو -بتروبوليتانوس- هو خطأ نسخيّ، وهو أنّ الآية وردت في المصاحف المبكرة الأخرى -كما تظهر في الصور التالية- حيث توافق النص القرآني في يومنا هذا دون إجراء تصحيح عليها.
1- بداية السطر الثالث.
صورة 112: Mashhad 18go، 28و
2- نهاية السطر الثالث. هذه صورة أخرى من مجموعة برغشترسر، وتَعرضُ مصحفًا قديمًا يُحفظ في دار الكتب والوثائق القوميّة (المكتبة الخديوية قديمًا) في العاصمة المصرية تحت رقم ق 47، ويقدَّر تاريخ كتابته بالنصف الأوّل من القرن
(183)السابع الميلادي وفقًا للاختبار الكربوني المشع. وللمخطوط 33 ورقة مكتوبة على الرق وأبعادها 262×393 مم، ويُعدّ من أقدم المصاحف المخطوطة في العالم.
صورة 113: Gotthelf -Bergsträßer -Archiv: Kairo ،10ظ
3 - نهاية السطر الثالث.
صورة 114: Wetzstein II 1913 ،24و
من الواضح أنّ سورة سبأ الآية 35: (وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا) -كما ادعى بروبيكر- لو كانت: «وقال نحن ...» في الأصل ثم صُحّح في وقت لاحق بحيث يوافق النص القرآني الراهن، لخالفت القواعد العربيّة وفسد معناها في الأصل؛ لأنّ فعلَ قال مجهولٌ ولا مرجع في هذا الكلام للضمير المستتر في هذا الفعل. لذلك لا يُتصور لهذا التعبير: «وقال نحن ...» سبب إلا الخطأ في الكتابة، وهذا هو الذي حدا بالقارئ للمخطوط أن يصحّحه على أساس المخطوطات القرآنيّة القديمة.
والجدير بالذكر أنّ الورقة التي استند إليها بروبيكر تجمع بين أخطاء نسخيّة أخرى، قد تعارض القواعد العربيّة -كما يظهر نموذج منها في السطر الثاني من الصورة أدناه؛ إذ كانت الآية المكتوبة قبل التصحيح: «قالوا هذا إلا رجل ...»، وهي تعبير غير صحيح؛ لأنّ «هذا» في الآية لا عموم له، فلا يصحّ الاستثناء منه، والصحيح
(184)هو: (قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ) (سبأ: 43)- وهذا يُشعر بأنّ الناسخ لم يكن بارعًا في عمله، فالمخطوط غير صالح للدراسة والتحقيق لكثرة الأخطاء الواردة فيه.
صورة 115: Arabe 340 ،26و
1 - نهاية السطر الأول.
صورة 116: Mashhad 4116go ،52و
2- نهاية السطر الثاني.
صورة 117: Or 2165 ،100ظ
ثم تليهما صور من المخطوطات القرآنيّة التي تسبق زمنيًّا المصحفَ الذي استند إليه بروبيكر وقدّر تاريخه بالقرن الثالث الهجري.
(185)3- نهاية السطر الثالث وبداية السطر الرابع. تقدم التعريف به.
صورة 118: Mashhad 1go ،254و
4- السطر الرابع. تقدم التعريف به.
صورة 119: Mashhad 21go ،242ظ
5 - السطر الثالث. تقدم التعريف به.
صورة 120: Mashhad 26gom ،220ظ
6- بداية السطر الثاني. تقدم التعريف به.
صورة 121: Mashhad 3540go ،228و
(186)صورة 122: مصحف طوب قابي، 65و
يبدو من الصورة أعلاه أنّ ما أسماه بروبيكر تصحيحًا في الآية (يعني الشطب على الألف من نهاية السطر الثالث وما يليها في بداية السطر الرابع) ليس إلّا اختفاء الكلمات في مرور السنين بسبب تناول المصحف الشريف بين أيدي المسلمين، كما مُحيت جزئيّا كلمة «الله» الواقعة في نهاية السطر الخامس أيضًا. وليس مِن المنطقي أن يحذف مَن أراد تحريفَ القرآن الكريم مفردات منه تترك النصَّ المتبقّي بلا معنى واضح: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيلٍ ضلوا». وما يثبِت أنّ اختفاء الألفاظ لم يحدث عن قصد هو أنّ هذه الآية وردت في المخطوطات الأخرى حيث توافق القرآن المطبوع اليوم، وهذه المخطوطات إما متقدّمة على مصحف طوب قابي وإمّا متقاربة معه.
1- السطران الثاني والثالث. تقدّمَ مرارًا أنّ هذا المخطوط هو من المصاحف التي استند إليه بروبيكر ولكنّه تغاضى عنه إذا وجده موافقًا للقرآن الذي بين أيدينا.
صورة 123: Arabe 328 ،20و
(187)2- نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث. تقدمَ للتوّ.
صورة 124: Arabe 330 ،55ظ
3- السطر الثاني.
صورة 125: Mashhad 18go ،40و
4- السطر الثاني.
صورة 126: Wetzstein II 1913، 36ظ
5- السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الرابع عشر.
صورة 127: Marcel 3 ،6و
(188)لم يُحذف شيء ما بين لفظة «فضله» ولفظة «والذين» في سورة النور الآية 33 (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ) في المصاحف التي تسبق زمنيًّا المخطوطَ الذي استند إليه بروبيكر، بل الفارغ في ذلك المخطوط جاء نتيجةً لكتابة كلمة خاطئة ومسحِها بعد إدراك ذلك الخطأ. فلربّما الناسخ بعد أن كتب «... من فضله» في هذه الآية، نظر إلى الأصل المنسوخ منه ورأى الآية السابقة: (إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَاللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ) بدلا من الآية 33، فواصل الكتابةَ من الآية 32 مخطئًا: «والله واسع عليم»، ولمّا راجع ما كتبه وجد الخطأ فمسحَه وبقي أثره فارغًا في الورقة.
1- السطر الرابع.
صورة 128: Mashhad 4116go ،16ظ
2- نهاية السطر الثالث وبداية السطر الرابع.
صورة 129: Or 2165 ،67ظ
(189)3- السطر الرابع.
صورة 130: Wetzstein II 1913 ،134ظ
إلى جانب هذه المخطوطات الحجازيّة، ثمّة مصاحف كوفيّة -وهي أقدم من المصحف الذي استند إليه بروبيكر أو متزامنة له- تحوي نصَ الآية المباركة بلا تغيير أو تعديل فيها.
4- بداية السطر الثالث.
صورة 131: Mashhad 1go ،207ظ
5- السطر الأخير.
صورة 132: Mashhad 21go ،194و
6- نهاية السطر الثالث.
صورة 133: Mashhad 26gom ،179ظ
(190)7 - نهاية السطر الثالث وبداية السطر الرابع.
صورة 134: Mashhad 3540go ،185و
يؤدّي سقوط لفظة «كان» من سورة النساء الآية 33: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) إلى خطأ نحوي في الكلام، فليس لسقوطها سبب إلّا الخطأ في الكتابة. لذلك لا يُعتبر سقوطها تحريًفا للقرآن، خلافًا لِما زعم بروبيكر. ولم تسقط هذه اللفظة في المخطوطات التي تأتي فيما يلي، وهي أقدم من مصحف المشهد الحسيني -عليه السلام- بالقاهرة أو متزامنة معه.
1- نهاية السطر الأوّل وبداية السطر الثاني. هذا مصحف استفاد منه بروبيكر، ولم يستند إلى هذه الورقة منه لكيلا يتّضح خلاف دعواه بشأن التحريف في الآية الشريفة المذكورة.
صورة 135: Arabe 328 ،12ظ
2- السطر الثالث. هذا نموذج آخر لتجاهل بروبيكر عن المصاحف المبكرة حيث يعارض دعواه.
صورة 136: Arabe 330 ،52و
(191)3- السطر الثالث.
صورة 137: Mashhad 18go ،32ظ
4- السطر الثالث. تقدم التعريف به في الرد على النموذج الثاني عشر.
صورة 138: Gotthelf -Bergsträßer -Archiv: Kairo ،14ظ
5- بداية السطر الثالث. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الثالث.
صورة 139: DAM 01 -29.1 ،5و
لا تؤيّد المخطوطات القرآنيّة المبكرة أنّ التّصحيح الوارد في مخطوط Marcel 11 في سورة الأحزاب الآية 9: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) هو تحريف على يد أحد المتأخرين؛ لأنّه فريد في نوعه ولا يتكرّر في المصاحف الحجازيّة
(192)الأخرى. فضلًا عن أنّ المخطوط الذي استند إليه بروبيكر مليء بالأخطاء النسخيّة -حسب ما قاله بروبيكر إنّه عثر على 46 تصحيحًا في 12 ورقة من هذا المخطوط (Brubaker, 2019, p. 77)- ويوحي بأنّ النّاسخ لم يكن بارعًا في عمله، فلا عبرة بهذا المخطوط للدراسة والتحقيق. وقد أعجب هذا المخطوط المغلوط بروبيكرَ إلى درجة استند إليه خمس مرات في كتابه؛ أربع مرات في النموذج الثالث ومرة في النموذج السابع عشر.
1- السطر الثالث.
صورة 140: Mashhad 4116go، 45ظ
2- السطر الثالث. تم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الثالث.
صورة 141: Ms. or. fol. 379 ،3ظ
3- نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث.
صورة 142: DAM 01 -27.1 ،23ظ
(193)لو تُحذف كلمة «الساعة» من سورة الأنعام الآية 40: (أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ) -كما سقطت من المخطوط المشار إليه والذي يعود إلى القرن التاسع أو العاشر للميلاد حسب ما قاله بروبيكر- لفسدَ المعنى، وأصبح الفاعل في «أتتكم» ضميرًا لا مرجع له في الكلام. بناء على هذا، لن يكون لسقوط لفظة «الساعة» سببٌ إلا نسيان الكاتب، وتمت إضافتها إلى المخطوط بعد مراجعته وتدقيقه في وقت متأخر عن كتابته.
1- بداية السطر الثالث. تقدم غير مرة أن بروبيكر استند إلى هذا المصحف بشكل منحاز.
صورة 143: Arabe 328 ،23ظ
2- السطر الثاني. هذه الورقة مأخوذة من المخطوط المعروف بـمصحف «باريسينو -بتروبوليتانوس» وهي ضمن الجزء Arabe 328e منه، وقد تقدّم التعريف به في الرد على النموذج الخامس من كتاب بروبيكر.
صورة 144: Arabe 328 ،93و
(194)3- السطر الثاني.
صورة 145: Mashhad 18go ،52و
4- السطر الثاني. تقدم التعريف بهذا المصحف في الرد على النموذج الرابع عشر.
صورة 146: Marcel 3 ،8ظ
وردت هذه الآية الشريفة في المخطوطات الكوفيّة القديمة أيضًا، كما نجدها في النّصّ القرآني الراهن. ولا يتقدّم المخطوط الذي استفاد منه بروبيكر على هذه المخطوطات الكوفيّة حسب المعلومات الباليوغرافية.
5- السطر الثالث.
صورة 147: Mashhad 1go ،69ظ
(195)6- السطر الثالث.
صورة 148: Mashhad 21go ،77ظ
7- السطر الرابع.
صورة 149: Mashhad 26gom ،67ظ
8- نهاية السطر الرابع.
صورة 150: Mashhad 3148go ،40و
9- نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث.
صورة 151: Mashhad 3540go ،66و
لا يختلف هذا النموذج عن النماذج الأخرى، إذ هو خطأ نسخي ارتكبه الكاتب في سورة سبأ الآية 27: (بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، وقد احتاج إلى المسح وإعادة الكتابة على أساس المخطوطات التي كُتبت قبل ذلك المصحف الذي استند إليه بروبيكر. وتظهر بعض الصور من تلك المخطوطات القرآنيّة المبكرة فيما يلي:
(196)1- نهاية السطر الثاني.
صورة 152: Or 2165 ،100و
2- نهاية السطر الثاني.
صورة 153: Mashhad 4116go ،51ظ
3- نهاية السطر الثالث.
صورة 154: Is 1615I ،11و
بما أنّ المصحف الذي استفاد منه بروبيكر يعود إلى القرن الأوّل أو الثاني الهجري فمن الممكن عرضُ المخطوطات الكوفيّة القديمة تأييدًا على موافقة هذه الآية الواردة فيها للنص القرآني الراهن.
(197)4- السطر الثاني.
صورة 155: Mashhad 1go ،253ظ
5- بداية السطر الأول.
صورة 156: Mashhad 21go ،241و
6- السطر الثاني.
صورة 157: Mashhad 26gom، 220و
7- بداية السطر الأخير.
صورة 158: Mashhad 3148go، 151و
8- السطر الثالث.
صورة 159: Mashhad 3540go ،227ظ
(198)توجد في المصاحف المخطوطة المبكرة الآيةُ الثالثة من سورة الأنفال الآية 3: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) كما نجده في المصاحف المطبوعة. وبما أنّ الآية الشريفة واردة في المصاحف التي تسبق زمنيًّا مخطوطَ MIA.2014.491 أو هي متزامنة معه، ولا تختلف هذه الآية في تلك المصاحف القديمة عن نفس الآية في النص القرآني الراهن، فلم يقع أي تحريف في هذه الآية المباركة، خلافًا لِما زعمه بروبيكر.
1- السطر الثاني. تقدم الكلام غير مرة عن هذا المصحف واستفادة بروبيكر منه بشكل منحاز.
صورة 160: Arabe 328 ،40و
2- السطر الثالث. لا حاجة إلى التكرار....
صورة 161: Arabe 330 ،59و
3 - السطر الثاني.
صورة 162: Mashhad 18go ،70و
(199)إضافة إلى هذه المصاحف الحجازيّة العائدة إلى القرن الأوّل الهجري، يمكن عرضُ عدد من المصاحف الكوفيّة المتقاربة مع المصحف الذي استفاد منه بروبيكر في هذا النموذج تأكيدًا على سلامة النص القرآني من التحريف والتعديل.
4- نهاية السطر الثاني.
صورة 163: Mashhad 1go ،105و
5- نهاية السطر الثاني.
صورة 164: Mashhad 26gom ،89ظ
6- نهاية السطر الثاني.
صورة 165: Mashhad 3148go ،64و
7- نهاية السطر الثالث.
صورة 166: Mashhad 3540go ،90ظ
(200)ادّعى بروبيكر أنّ استخدام الشريط اللّاصق في بعض الأوراق من المصحف المنسوب إلى عثمان نسخة المشهد الحسيني بالقاهرة، كان بسبب تغطية بعض الأجزاء من الآيات القرآنيّة لا ترميم تلك الورقة. كذلك توجد في المصحف بقاعٌ مغطاة بالشريط اللّاصق ومن ثُم كُتب عليها النّصّ القرآني بخطّ يختلف عن خط الكاتب الرئيسي للمخطوط. أمّا هذه الدعوى، فإن قُصد بها التحريف في بعض الأجزاء من الآيات القرآنيّة فلا أساس لها؛ لأنّ تلك الأشرطة اللّاصقة المستخدَمة تجعل المفردات القرآنيّة غير مقروءة جزئيًّا أو كليًّا -كما نوّه بروبيكر إلى تلك المفردات المغطاة بالشريط اللاصق- فيصبح النصُّ المتبقّي كلماتٍ ناقصةً لا تفيد معنًى. وليس من المنطقي أن يتلاعب المحرِّفُ بالنّصّ، فيحذف جزءًا من المفردات ويترك جزءًا آخر حتى تبقى منه حروف مشتّتة لا يُفهم منها أيّ شيء. لذلك لم يُقصد باستخدام الشريط اللاصق تحريف القرآن أو تغطية مفردات منه تؤدّي إلى التغيير في المعنى، بل السبب هو ترميم الورقة؛ إذ هي تعاني من الشقوق، كما هو ظاهر عند النظر إلى الجهة الأخرى من الورقة التي استند إليها بروبيكر وادّعى أنها سليمة لا تحتاج إلى الترميم:
(201)صورة 167: مصحف المشهد الحسيني، ورقة 33و
وقد صرّح آلتي قولاج -والذي حقّق هذا المصحف الشريف ودرسه عن كثب - بالحالة الحرجة لهذه الورقة (Altıkulaç, 2020, p. 92)، كما تدلّ المعلومات الواردة في القرص المدمج الذي أعدّته المكتبة المركزيّة للمخطوطات الإسلاميّة بالقاهرة (عام 2006 الميلادي) لهذا المصحف على حاجته الماسة إلى الترميم. إذًا لا تصحّ دعوى بروبيكر بشأن هذا المصحف وتحريف آياته. فضلًا عنه، توجد الآيات المباركة المغطاة بالشريط اللاصق في الورقة المذكورة -أي 33ظ- في المخطوطات القرآنيّة المبكرة، وهي توافق القرآن الذي بين أيدينا اليوم في سورة البقرة الآيات 191 إلى 194 في هذه المواضع السبعة: (وَأَخْرِجُوهُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ فَإِنِ انْتَهَوْا غَفُورٌ رَحِيمٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَلَا عُدْوَانَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ) .
(202)1- تم تحديد المواضع السبعة، غير أنّ الموضع الأوّل مشوّش بسبب الأضرار اللّاحقة بالورقة.
صورة 168: Mashhad 18go ،12ظ
2- تم تحديد المواضع السبعة بكاملها.
صورة 169: Wetzstein II 1913 ،8و
صورة 170: Wetzstein II 1913 ،8ظ
فضلًا عن هذين المصحفين الحجازيين، نأتي بصور من مصحفين كوفيين ترد فيهما الآيات حيث توافق المصحف المطبوع.
(203)3- تم تحديد المواضع في الصورة.
صورة 171: Mashhad 1go ،17ظ
4- تتّضح في الصورة أدناه موافقة هذا المخطوط الكوفي -والذي يقدّر تاريخه بالقرن الثاني- والقرآن الذي يُطبع في العالم الإسلامي اليوم، وفيه الآياتُ التي زعمها بروبيكرُ محرّفةً.
صورة 172: Mashhad 21go ،19و
صورة 173: Mashhad 21go ،19ظ
والنموذج الأخير فيه، هو الآيات القرآنيّة من سورة الرعد، الآيتان 11 و12: (حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا)، وهي مكتوبة على الشريط اللاصق. وقد زعم بروبيكر أنّها كُتبت بشكل ممطوط لتغطّي النصّ التحتي، ولكن الحقيقة هي: أوّلًا، الكتابة بشكل ممطوط شائعة في هذا المصحف
(204)بقلم الناسخ الأصلي للمخطوط، كما يظهر نموذج لها في الصورة أدناه:
صورة 174: مصحف المشهد الحسيني، 1103ظ
وثانيًا، توجد المواضع التي أشار إليها بروبيكر من الآيتين المذكورتين في المخطوطات القرآنيّة المبكرة، وهي توافق النّصّ القرآنيّ الراهن دون إجراء تعديل عليها، وهذا يدلّ على عدم التغيير في هاتين الآيتين منذ كتابتهما الأولى.
1- تم تحديد المواضع الثلاثة في هذا المخطوط الذي استند إليه بروبيكر في نموذج آخر.
صورة 175: Arabe 328 ،50و
2- تم تحديد المواضع في هذا المصحف الذي تقدم التعريف به، إلّا أنّ الموضع الثالث مشوّش بسبب الأضرار اللاحقة بالورقة.
(205)صورة 176: Or 2165 ،28و
3- تم تحديد المواضع، إلا أنّ الموضع الثاني مشوش بعض الشيء.
صورة 177: Mashhad 18go ،99ظ
صورة 178: Mashhad 18go ،100و
توجد هذه الواضع الثلاثة في المخطوطات القرآنيّة الكوفيّة التي تقاربُ زمنيًّا مصحف المشهد الحسيني عليهالسلام بالقاهرة، وهي سليمة من الأضرار التي التحقت بذلك المصحف المبارك.
4- تم تحديد المواضع بكاملها.
صورة 179: Mashhad 1go ،148ظ
(206)5- المواضع الثلاثة محدّدة.
صورة 180: Mashhad 21go ،150ظ
صورة 181: Mashhad 21go ،151و
6- المواضع الثلاثة واضحة تمامًا.
صورة 182: Mashhad 26gom ،107ظ
7- تم تحديد المواضع الثلاثة.
صورة 183: Mashhad 3540go ،130و
(207)تبيّن مما تقدّم أنّ المستشرق الأمريكي «دانيل بروبيكر» يسعى في كتابه المسمى بـ «تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة» إلى إثبات فرضيّته أنّ النّصّ القرآنيّ الشريف لم يثبَّت في العهد النبوي، ولا فيما يدعَى بعمليّة توحيد المصاحف في العهد العثماني، بل تعرّضَ للتصحيح والتعديل في القرون الأولى، إلى أن أصبح بشكله النهائي في مصحف القاهرة 1924 -المعروف بـالمصحف الأميري- وتدلّ على ذلك المخطوطاتُ التي يَظهر فيها الخلاف بينها وبين النص القرآني الراهن، والتي عُدّلت بقلم الكاتب للنسخة أو على يد أخرى حتى توافق القرآن الذي بين أيدينا. ويستنتج بروبيكر من هذا أنّ النّصّ القرآنيّ القديم اتّجه نحو الموافقة للمصحف الأميري، ويسمي هذه الظاهرةَ بالمرونة في القرآن المجيد.
ولقد أثبتنا فيما سبق أنّ هذه الدّعاوى عارية عن الصحّة، لأسباب عدّة:
أوّلًا، المنهجيّة التي اتّبعها بروبيكر لا يوصله إلى ما هو بصدده؛ فهي تُثبت للحد الأقصى التحريف في نسخة واحدة، ولا تثبت التحريف في القرآن الكريم، إلا إذا زوّدنا بصور يَرد فيها التصحيح المزعوم بعينه في مخطوطات متقاربة من حيث الزمان ومتباعدة من حيث المكان.
ثانيًا، ثمّة مخطوطات قرآنيّة كثيرة -تسبق زمنيًّا ما استند إليه بروبيكر أو تتزامن معها- وهي خالية من التصحيح الذي عثر عليه بروبيكر في المصحف المخطوط المشار إليه، فهذا دليلٌ على أنّ النّصّ القرآنيّ كان موافقًا لِما بين أيدنا اليوم في المصاحف المطبوعة قبل أن يتعرّض للتصحيح في ذلك المصحف المخطوط.
ثالثًا، تثبت هذه المخطوطات المبكرة التي توافق النّصّ القرآنيّ الراهن أنّ الخطأ الوارد في المخطوط الذي استند إليه بروبيكر ليس سوى خطأ نسخي، أي هو سهو من كاتبه وليس تعمّدًا لتحريف القرآن الكريم.
رابعًا، قد يكون المخطوط مغلوطًا إلى درجة لا يصلح للدراسة والتحقيق، وهذا
هو الحال لبعض المخطوطات التي استند إليه بروبيكر، وصرّح بأنّه عثر على عدد كبير من الأخطاء فيها.
خامسًا، أثار بروبيكر شبهات عدّة في مقدّمة كتابه بالتساؤلات التي طرحها، ولم يبحث عن الإجابات المقنعة عليها في التراث الإسلامي، فقدّمنا ملاحظات على كلّ تساؤل فيما يخصّ مخطوطات القرآن.
وفي الختام، أدعو العلماء والباحثين الإسلاميين إلى المزيد من التحقيق والدراسة في مخطوطات القرآن القديمة؛ فهذه الأدلّة الماديّة خير شاهد على سلامة هذا الكتاب المقدّس من التحريف في غابر الأزمان ومن أيدي أعداء الإسلام.
سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
وَسَلَٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ
(209)
1- المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان: نسخة متحف طوپ قاپي سرايي. (2007). تحقيق: طيار آلتي قولاج. ترجمة: صالح سعداوي. إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.
2- المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان: نسخة المشهد الحسيني بالقاهرة. (2009). تحقيق: طيار آلتي قولاج. إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.
3- المصحف الشريف: نسخة المكتبة البريطانية في لندن. (2017). تحقيق: طيار آلتي قولاج. ترجمة: صالح سعداوي. إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.
1- آلتي قولاج، طيار. (2014). المصاحف المنسوبة إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. ترجمة: معتز حسن. مدونة الدراسات القرآنية، 5 -17.
2- أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل. (1975). المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. تحقيق: طيار آلتي قولاج. بيروت: دار صادر.
3- أبو عيشة، الأمير محفوظ. (2020). دراسات استشراقية معاصرة للقرآن الكريم: المدرستان الفرنسية والألمانية أنموذجا (الطبعة الأولى). النجف: مركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية.
4- ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان. (1423). كتاب المصاحف (الطبعة الأولى). القاهرة: الفاروق الحديثة.
5- ابن الجزري، محمد بن محمد. (لا ت.). النشر في القراءات العشر. تحقيق: علي محمد الضباع. لا م.: المطبعة التجارية الكبرى.
6- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. (1422). زاد المسير في علم التفسير. تحقيق: عبد الرزاق المهدي (الطبعة الأولى). بيروت: دار الكتاب العربي.
7- ابن النديم، محمد بن إسحاق. (1417). الفهرست. تحقيق: إبراهيم رمضان (الطبعة الثانية). بيروت: دار المعرفة.
8- ابن بابويه، محمد بن علي. (1406). ثواب الأعمال وعقاب الأعمال (الطبعة الثانية). قم: دار الشريف الرضي للنشر.
9- ابن خالويه، الحسين بن أحمد. (1401). الحجة في القراءات السبع. تحقيق: عبد العال سالم مكرم. بيروت: دار الشروق.
10- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. (1408). ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق: خليل شحادة (الطبعة الثانية). بيروت: دار الفكر.
11- ابن سلام، القاسم. (1415). فضائل القرآن. تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين (الطبعة الأولى). دمشق - بيروت: دار ابن كثير.
12- ابن شهر آشوب، محمد بن علي. (1380). معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديما وحديثا (الطبعة الأولى). النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية.
13- الأسد، ناصر الدين. (1988). مصادر الشعر الجاهلي (الطبعة السابعة). مصر: دار المعارف.
14- الباباني البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين. (لا ت.). إيضاح المكنون في
الذيل على كشف الظنون. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
15- الباقلاني، محمد بن الطيب. (1422). الانتصار للقرآن. تحقيق: محمد عصام القضاة (الطبعة الأولى). عمان: دار الفتح.
16- البخاري، محمد بن إسماعيل. (1422). صحيح البخاري (الطبعة الأولى). بيروت: دار طوق النجاة.
17- البخاري، محمد بن إسماعيل. (لا ت.). التاريخ الكبير. حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية.
18- التونجي، محمد. (1984). المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات. لا م.: عالم الكتب.
19- الچراخ، عباس هاني. (1431). منهاج تحقيق المخطوطات. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.
20- الحموي، ياقوت بن عبد الله. (1993). معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي.
21- الخطيب، عبد الطيف. (1422). معجم القراءات. دمشق: دار سعد الدين.
22- السامرائي، قاسم. (2001). علم الاكتناه العربي الإسلامي (الطبعة الأولى). الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
23- السامرائي، قاسم. (2018). دقة الاختبار الكربوني (C14) في توريخ الرقوق القرآنية وعلاقتها بالطروس. ترجمة: مراد تدغوت، القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين (الطبعة الأولى). لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.
24- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. (1974). الإتقان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
25- الصغير، محمد حسين علي. (1999). المستشرقون والدراسات القرآنية (الطبعة الأولى). بيروت: دار المؤرخ العربي.
26- الطباع، إياد خالد. (2003). منهج تحقيق المخطوطات. دمشق: دار الفكر.
27- الطباع، إياد خالد. (2011). المخطوط العربي: دراسة في أبعاد الزمان والمكان. دمشق: إحياء التراث العربي.
28- الطبري، محمد بن جرير. (1422). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (الطبعة الأولى). لا م.: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.
29- الطحاوي، أحمد بن محمد. (1415). شرح مشكل الآثار. تحقيق: شعيب الأرناؤوط (الطبعة الأولى). لا م.: مؤسسة الرسالة.
30- الطناحي، محمود محمد. (1405). مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي. القاهرة: مكتبة الخانجى.
31- الطوسي، محمد بن الحسن. (1414). الأمالي. تصحيح: مؤسسة البعثة (الطبعة الأولى). قم: دار الثقافة.
32- الغرياني، الصادق بن عبد الرحمن. (2006). تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث (الطبعة الأولى). بيروت: دار ابن حزم.
33- الفراء، يحيى بن زياد. (1980). معاني القرآن. تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار (الطبعة الثانية). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
34- القلقشندي، أحمد بن علي. (لا ت.). صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. بيروت: دار الكتب العلمية.
35- القمي، علي بن إبراهيم. (1404). تفسير القمي. تصحيح: طيب الموسوي الجزائري (الطبعة الثالثة). قم: دار الكتب.
36- الكليني، محمد بن يعقوب. (1407). الكافي. تصحيح: علي أكبر غفاري (الطبعة الرابعة). تهران: دار الكتب الإسلامية.
37- المارغني، إبراهيم بن أحمد. (لا ت.). دليل الحيران على مورد الظمآن. القاهرة: دار الحديث.
38- المروزي، عبد الكريم بن محمد. (1417). المنتخب من معجم شيوخ السمعاني. تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر (الطبعة الأولى). الرياض: دار عالم الكتب.
39- المسيح، محمد. (2017). مخطوطات القرآن: مدخل لدراسة المخطوطات القديمة (الطبعة الأولى). Canada: Water Life Publishing.
40- المفيد، محمد بن محمد. (1413). الاختصاص. تحقيق: علي أكبر غفاري ومحمود محرمي زرندي (الطبعة الأولى). قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.
41- المهدوي، أحمد بن عمار. (1430). هجاء مصاحف الأمصار. تحقيق: حاتم صالح الضامن (الطبعة الأولى). المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي.
42- النويري، أحمد بن عبد الوهاب. (1423). نهاية الأرب في فنون الأدب (الطبعة الأولى). القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
43- برغشترسر، غوتهلف. (1982). أصول نقد النصوص ونشر الكتب. الریاض: دار المريخ.
44- بريتسل، أوتو. (2004). تاريخ القرآن لـتيودور نولدكه. ترجمة: جورج تامر
(ج 3). بيروت: كونراد -أدناور.
45- جب، هاملتون. (1943). خواطر في الأدب العربي: بدأ التأليف النثري. الأدب والفن، (2)، 2 -18.
46- جولدتسيهر، إجنتس. (1955). مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: عبد الحليم النجار. مصر: مكتبة الخانجى.
47- دياب، عبد المجيد. (١٩٩٣). تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره. القاهرة: دار المعارف.
48- دية، إسلام. (2014). طباعة المصحف بين فيلولوجيا الاستشراق وفيلولوجيا علم القراءات: موازنة بين مصحف فلوغل 1834 ومصحف الأزهر 1924. التفاهم، 12(45)، 281 -297.
49- ربيع نتاج، علي أكبر. (1430). شبهة تحريف القرآن في نظر المستشرقين. المنهاج، (55)، 229 -252.
50- رشواني، سامر. (٢٠٢٠). الموسوعة القرآنية (Corpus Coranicum) من الفيلولوجيا إلى التحليل الأدبي: قراءة نقدية في قاعدة البيانات. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 38(1)، 72 -90.
51- سعيد، خير الله. (٢٠١١). موسوعة الوراقة والوارقين في الحضارة العربية الإسلامية (الطبعة الأولى). بيروت: مؤسسة الانتشار العربي.
52- سيد، أيمن فؤاد. (2005). مقدمة المترجم. مدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي (ص 13 -38). لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.
53- شاكر، أحمد وسام. (2014). مصاحف صنعاء. الدراسات الدينية، (1)، 7 -14.
54- ـــــــــــــــــــــ (٢٠٢٠). مصاحف اليمن: مكتشفات الرقوق القرآنية بالجامع الكبير بصنعاء. در القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين (٢) (ص 363 -406). لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.
55- شوقي، أحمد؛ طوبي، مصطفى. (2005). معجم مصطلحات المخطوط العربي: قاموس كوديكولوجي. الرباط: الخزانة الحسنية.
56- صالح، صبحي. (١٣٧٢). مباحث في علوم القرآن (الطبعة الخامسة). قم: منشورات الرضي.
57- عبد التواب، رمضان. (1985). منهاج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين (الطبعة الأولى). القاهرة: مكتبة الخانجى.
58- عبد الله، رائد أمير. (٢٠١٣). المستشرقون وجهودهم في خدمة التراث العربي المخطوط. آداب الرافدين، 67، 437 -466.
59- عسيلان، عبد الله بن عبد الرحيم. (1994). تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.
60- عياض، أبو الفضل. (1409). الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لا م. دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع.
61- ـــــــــــــــــــــ (١٩٧٠). الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. تحقيق: السيد أحمد صقر (الطبعة الأولى). القاهرة: دار التراث.
62- فراستي، أميرحسين. (2021). القراءة السريانية الآرامية للقرآن الكريم: دراسة نقدية لآراء كريستوف لكسنبرغ (الطبعة الأولى). النجف: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية.
63- كاظم، مؤمل جواد. (2015). القراءات القرآنية المنسوبة لائمة اهل البيت
عليهمالسلام وآثارها (رسالة الماجستير). جامعة الكوفة.
64- مالك بن أنس. (1406). الموطأ. تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
65- محمدي، مجتبى؛ توكلي، مرتضى. (2021). معايير تقدير عمر المصاحف المخطوطة. تحقيق المخطوطات، (3)، 189 -220.
66- معرفت، محمدهادي. (1379). صيانة القرآن من التحريف (الطبعة الأولى). تهران: وزارت امور خارجه.
1- آقایی، علی. (١٣٩٤). گزارشی از پروژه کرپوس کرانیکوم. سخن ما، (8)، 14 -15.
2- برونر، راينر. (١٣٩٥). مسئله تحریف قرآن در تفاسیر شیعه اثناعشری. ترجمة: مجيد منتظرمهدي، في: قرآنشناسی امامیه در پژوهشهای غربی (الطبعة الأولى، ص 147 -192). قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث. بلاشر، رژي. (١٣٧٤). در آستانه قرآن. ترجمة: محمود رامیار (الطبعة الرابعة). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
3- توكلي، مرتضى؛ محمدي أنويق، مجتبى. (١٣٩٥). مصحف سن پترزبورگ و جایگاه آن در مطالعات تاریخ قرآن کریم. مطالعات تاريخي قرآن و حديث، (60)، 133 -165.
4- جانيپور، محمد. (1394). بررسی پيشینه و انگيزههای مستشرقين از پرداختن به موضوع اختلاف قرائات قرآنی. مطالعات قرآن وحدیث، 17(1). ٥ -٤١.
5- راد، علي. (١٣٩٨). خاورشناسان و چالش تحریف قرآن در نگاه امامیه. مشكوة، (142)، 4 -49.
6- رامیار، محمود. (١٣٦٩). تاریخ قرآن (الطبعة الثالثة). تهران: امير کبير.
7- طباطبايي، محمدعلي. (١٣٩٤). سیر تطور پژوهش های غربی درباره تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم. تفسير أهل بيت عليهم السلام، 5(1)، 65 -91.
8- ـــــــــــــــــــــ (١٣٩٥). مقدمه سرويراستار. در قرآنشناسی امامیه در پژوهشهای غربی الطبعة الأولى. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
9- كريمينيا، مرتضى. (١٤٠٠). نسخه شناسی مصاحف قرآنی (١٣). آينه پژوهش، (188)، 67 -106.
10- مدرسي طباطبايي، حسين. (١٣٨٠). بررسی ستیزههای دیرین درباره تحریف قرآن. ترجمة: محمدكاظم رحمتي. هفت آسمان، (11)، 41 -78.
11- مستفيد، حميدرضا. (١٣٨١). تأثیر خط در پیدایش قراءات. تحقيقات اسلامي، (1و2)، 27 -64.
12- ـــــــــــــــــــــ ؛ توكلي، مرتضى. (١٣٩٦). پژوهشی در رسم المصحف (الطبعة الأولى). تهران: مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران.
13- وحیدنیا، آلاء. (١٣٩٧). تاريخگذاری مخطوطات قرآنی در پرتو روشهای نوین علمی (آزمایش کربن ١٤). مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، (3)، 107 -142.
1- Aitken, M. J. (1991). Principles of radioactive dating. In Scientific Dating Methods. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
2- Al -Azami, Muhammad Mustafa. (2003). The History of The Quranic Text: From Revelation To Compilation. England: UK Islamic Academy.
3- Albin, Michael. (2004). Printing of the Qurān. In Encyclopaedia of the Quran (Vol. 4). Leiden – Boston: Brill.
4- Altıkulaç, Tayyar. (2020). Refutation of Daniel Alan Brubaker’s “Corrections in Early Qurʾan Manuscripts.” Istanbul: IRCICA.
5- Bennett, Clinton. (2013). Chronology. In The Bloomsbury Companion to Islamic Studies (First edition). UK & USA: Bloomsbury Academic.
6- Bergsträsser, Gotthelf. (1930). Plan eines Apparatus criticus zum Koran. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
7- Blair, Sheila. (2020). Glorifying God’s Word: Manuscripts of the Qur’an. In The Oxford Handbook of Quranic Studies (First edition). United Kingdom: Oxford University Press.
8- Brubaker, Daniel Alan. (2019). Corrections in Early Qur’an Manuscripts: Twenty Examples. Lovettsville: Think and Tell Press.
9- Cellard, Éléonore. (2018). Codex Amrensis. Leiden - Boston: Brill.
10- ـــــــــــــــــــــ (2021). The Sạnʿāʾ Palimpsest: Materializing the Codices. Journal of Near Eastern Studies, 80(1), 1 -30.
11- Daub, Frederike -Wiebke. (2016). Abraham Hinckelmann (1652–1695). In Catalogue for the Exhibition “Wonders of Creation – Ottoman Manuscripts in Hamburg Collections” (Second edition, pp. 156 -159). Hamburg: Centre for the Study of Manuscript Cultures.
12- Déroche, François. (1983). Catalogue Des Manuscrits Arabes. Paris: Bibliothèque Nationale.
(219)13- ـــــــــــــــــــــ (1992). The Abbasid Tradition: Qur’ans of the 8th to the 10th Centuries A.D. United Kingdom: The Nour Foundation.
14- ـــــــــــــــــــــ (2004). Manuscripts of the Qurān. In Encyclopaedia of the Quran (Vol. 3). Leiden – Boston: Brill.
15- ـــــــــــــــــــــ (2006). Written Transmission. In The Blackwell Companion to the Qur’an (First edition,). USA & UK & Australia: Blackwell Publishing.
16- ـــــــــــــــــــــ (2009). English summary. In La transmission écrite du Coran dans les débuts de l’islam: Le codex Parisino -petropolitanus. Leiden - Boston: Brill.
17- ـــــــــــــــــــــ (2014). Qurʾans of the Umayyads: A First Overview. Leiden - Boston: Brill.
18- ـــــــــــــــــــــ (2019). The Quranic Collections Acquired by Wetzstein. In Manuscripts, Politics and Oriental Studies: Life and Collections of Johann Gottfried Wetzstein (1815–1905) in Context. Leiden - Boston: Brill.
19- ـــــــــــــــــــــ (2020). The Manuscript and Archaeological Traditions: Physical Evidence. In The Oxford Handbook of Quranic Studies (First edition,). United Kingdom: Oxford University Press.
20- ـــــــــــــــــــــ ; & et al. (2005). Islamic Codicology: An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script. (Deke Dusinberre & David Radzinowicz, trans.). London: Al -Furq’an Islamic Heritage Foundation.
21- Eliash, Joseph. (1969). The Šīʿite Qurʾān: A Reconsideration of Goldziher’s Interpretation. Arabica, (16), 15 -24.
22- Gacek, Adam. (2001). The Arabic Manuscript Tradition: A Glossary of Technical Terms and Bibliography. Leiden - Boston: Brill.
23- Heaton, Timothy; & et al. (2020). Marine20—The Marine
(220)Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55,000 Cal BP). Radiocarbon, 62 (4), 779 -820.
24- Heidemann, Stefan. (2016). Jacob Georg Christian Adler (1756–1834). In Catalogue for the Exhibition “Wonders of Creation – Ottoman Manuscripts in Hamburg Collections” (Second edition, pp. 160 -163). Hamburg: Centre for the Study of Manuscript Cultures.
25- Hellborg, Ragnar; & Skog, Göran. (2008). Accelerator Mass Spectrometry. Wiley InterScience, 27, 398 -427.
26- Higgins, Andrew. (2008). The Lost Archive Missing: for a half century, a cache of photos spurs sensitive research on Islam’s holy text. The Wall Street Journal.
27- Hilali, Asma. (2017). The Sanaa Palimpsest: The Transmission of the Qur’an in the First Centuries AH. London: Oxford & The Institute of Ismaili Studies.
28- Hirschfeld, Hartwig. (1902). New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran. London: Royal Asiatic Society.
29- Hogg, Alan; & et al. (2020). SHCal20 Southern Hemisphere Calibration, 0–55,000 Years Cal BP. Radiocarbon, 62(4), 759 -778.
30- Jeffery, Arthur. (1937). Materials for The History of The Text of The Quran: The Old Codices. Leiden: Brill.
31- Karimi -Nia, Morteza. (2019). A New Document in the Early History of the Qurʾān: Codex Mashhad, an ʿUthmānic Text of the Qurʾān in Ibn Masʿūd’s Arrangement of Sūras. Journal of Islamic Manuscripts, (10), 292 -326.
32- Lane -Poole, Stanley. (1879). Introduction. In Selections from the Kur -an. London: Trübner and Co. Ludgate Hill.
33- Lawson, Todd. (1991). Note for the study of a “Shīʿī Qurʾān.” Journal of Semitic Studies, 2(36), 279 -295.
(221)34- Lerner, Lee; & et al. (2004). Dating Techniques. In The Gale Encyclopedia of Science (Third edition, Vol. 2, pp. 1154 -1158). Gale.
35- Liritzis, I.; & et al. (2020). Archaeometry: An Overview. Scientific culture, 6 (1), 49 -98.
36- Lowin, Shari. (2004). Revision and Alteration. In Encyclopaedia of the Qur’ān (Vol. 4, pp. 448 -451). Leiden–Boston–Köln: Brill.
37- Mahdi, Muhsin. (1981). Foreword. Journal of Near Eastern Studies, 40(3), 162 -164.
38- Margoliouth, David Samuel; & Woledge, G. (2006). Alphonse Mingana (1881 -1937). In A. Mingana (compiler), Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts (Vol. 3, pp. v -xii). USA: Gorgias Press.
39- Marx, Michael. (2019). Introduction. In Qurʾān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th–10th Centuries. Leiden - Boston: Brill.
40- ـــــــــــــــــــــ ; & Jocham, Tobias. (2019). Radiocarbon (14C) Dating of Qurʾān Manuscripts. In Qurʾān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th–10th Centuries. Leiden - Boston: Brill.
41- Motzki, Harald. (2001). The Collection of the Qur’an: A Reconsideration of Western Views in Light of Recent Methodological Developments. Der Islam, (78), 1 -34.
42- Muir, William. (1912). The Life of Moḥammad from Original Sources. Edinburgh: John Grant.
43- Nöldeke, Theodor. (2013). The History of the Qurʾān. (Friedrich Schwally, ed., Wolfgang Behn, tran.). Leiden - Boston: Brill.
44- Palmer, Edward Henry. (1955). The Qur’ān: Part 1. India: Jainendra Prakash Jain At Shri Jainendra Pres.
45- Puin, Gerd -Rudiger. (1996). Observations on Early Qur’an Manuscripts in San“a.” In The Quʼran as Text (pp. 107 -112).
(222)Germany: Brill.
46- Reimer, Paula; & et al. (2020). The INTCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 Cal kBP). Radiocarbon, 62 (4), 725 -757.
47- Reynolds, Gabriel Said. (2008). Qur’anic studies and its controversies. In The Qur’an in Its Historical Context (First edition). USA & Canada: Routledge.
48- Rezvan, Efim. (2008). “From Russia with Love”: Prof. Sergio Noja Noseda (1931 -2008). Manuscripta Orientalia, 14 (1), 71 -72.
49- ـــــــــــــــــــــ (2020). A History of Printed Editions of the Qur’an. In The Oxford Handbook of Quranic Studies (First edition). United Kingdom: Oxford University Press.
50- Rink, William; & Thompson, Jeroen. (2015). Preface. In Encyclopedia Of Scientific Dating Methods. Heidelberg, New York, London: Springer.
51- Ronny, Vollandt. (2017). Jacob Georg Christian Adler (1756–1834) and his Books. In Jewish Manuscript Cultures (pp. 275 -306). Berlin & Boston: De Gruyter.
52- Sadeghi, Behnam; & Goudarzi, Mohsen. (2012). Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Qur’ān. Der Islam, (87), 1 -129.
53- Sayoud, H. (2018). Statistical analysis of the Birmingham Quran folios and Comparison with the Sanaa manuscript. International Journal of Hidden Data Mining and Scientific Knowledge Discovery, 4(1), 101 -126.
54- Schnöpf, Markus. (2012). Corpus Coranicum - A digital landscape for the study of the Qu’ran (pp. 362 -364). Presented at the Digital Humanities, Germany: University of Hamburg.
55- Shah, Mustafa. (2020). Introduction. In The Oxford Handbook of
(223)Quranic Studies (First edition). United Kingdom: Oxford University Press.
56- Sidky, Hythem. (2019). Book Review: Corrections in Early Qurʾān Manuscripts. Al -ʿUṣūr al -Wusṭā, (27), 273 -288.
57- ـــــــــــــــــــــ (2020). On The Regionality of Qurʾānic Codices. Journal of the International Qur’anic Studies Association, (5), 133 -210.
58- Small, Keith. (2011). Textual Criticism and Qur’an Manuscripts. UK: Lexington Books.
59- Soucek, Priscilla. (1999). Book Reviews: The Abbasid Tradition. Studies in the Decorative Arts, 6 (2), 129 -131.
60- Torrey, Charles Cutler. (1933). The Jewish Foundation of Islam. New York: Jewish Institute of Religion Press.
61- Westcott, Brooke Foss; & Hort, Fenton John Anthony. (1896). The New Testament in the original Greek (Second edition). New York: Macmillan.
62- Wherry, Elwood Morris. (1882). A Comprehensive Commentary on The Quran. London: Trübner and Co. Ludgate Hill.
63- Youssef -Grob, Eva Mira. (2019). Radiocarbon (14C) Dating of Early Islamic Documents: Background and Prospects. In Qurʾān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th–10th Centuries. Leiden - Boston: Brill.
(224)