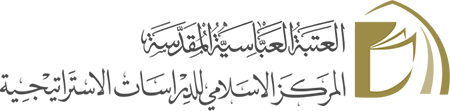
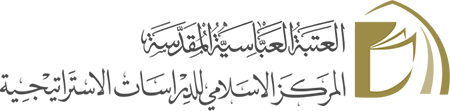
الحياة الطيِّبة هي الوضعيّة المنشودة لحياة البشر؛ في الأبعاد الإيمانيّة، والاجتماعيّة، وغيرها. وتتأكّد أهمية التربية على نمط الحياة الطيّبة بسعة التشريعات والقيم الإسلاميّة وتنوّعها، والتي تشمل إضافةً للبعد الإيماني التربوي، البعدَيْن السلوكي الفردي والاجتماعي، حيث التربية على الحياة الأسريّة والاجتماعيّة. ومنها التربية على الرضا ببعده الإيماني أولا، حيث بيّنت النصوص أنّ الإيمان بخيريّة قضاء الله هو العامل الأساس في الرضا عن الإنسان، وببعده الاجتماعي ثانياً، حيث اعتُبر الرضا في الإسلام من المفاهيم التي لها أهمّية استثنائية وهامة؛ كونه يشكّل جزءًا أساسيًا من السعادة والرفاهية، بل هو أحد عوامل السعادة، كما جاء عن النبي صلىاللهعليهوآله : «مِن سَعادَةِ ابنِ آدَمَ رِضاهُ بِما قَضَی اللّهُ لَهُ..." وهو أفضل رفيقٍ للإنسان، وعدّ الشخص الراضي من المحظوظين الذين يُغبطون على حالهم.
ختامًا لا شك بأنّ التزام الإنسان نمط الحياة الطيّبة، ومراعاته لقواعدها وأصولها يكفلان له أعلى درجات السعادة والرضا والإطمئنان في حياته الدنيوية والأخرويّة.
هذا الكتاب "سرُّ الرضا"؛ هو دراسة عن الرضا من وجهة النظر الإسلامية. ابتداءً من بيان مفهوم الرضا ومكوّناته، وتفسيره، واستراتيجيات تحقيق الرضا وفقًا للمصادر والنظريات الإسلامية.
والحمد للّه رب العالمين
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة
(11)إنّ من أبرز مؤشّرات الحياة الجيّدة التمتّع بشعور الرضا. وإنّ الحياة تتألّف من وجهين: إيجابيّ وسلبيّ، وتتحقّق الحياة الجيّدة عندما يتمكّن الفرد من رؤية النعم في كلتا الحالتين ـ الإيجابيّة والسلبيّة ـ والشعور بالرضا. لا يوجد إنسانٌ ناجحٌ يفتقر إلى مهارة (الرضا عن الحياة)؛ إذ بدون الرضا لا يمكن تحقيق التقدّم والنجاح.
يسعى هذا العمل إلى تقديم رؤية الإسلام حول الرضا عن الحياة بأسلوبٍ جديدٍ ومنظّم. تنقسم محتويات هذا العمل إلى عدّة أقسام: أوّلها نظريّة الرضا من منظور الإسلام، التي تركز على مفهوم (الخير المُدرَك) والمناقشات المرتبطة به، وقد وردت في الفصل الثاني. القسم الثاني هو استراتيجيّات الرضا، التي تشمل، استراتيجيّة الرضا التي تتضمّن استراتيجيّة الخير ومتطلّبات الرضا (معرفة الخير، إدراك النعم، وتقييم الخير)، ووردت في الفصل الثالث.عوامل الرضا (إيجاد الخير، البحث عن الخير، والإيمان بالخير)، ووردت في الفصل الرابع.
استراتيجيّات التكيّف، القبول، والسرور، ووردت في الفصل الخامس.
ختاماً أجد من واجبي أنْ أشكر آية الله الري شهري (رحمه الله)، وجميع زملائي وكل من ساهم في هذا العمل.
عباس پسندیده
17 رجب 1444 هـ
الرضا هو أساس النجاح والازدهار؛ إذ لا يوجد إنسانٌ ناجحٌ لا يتمتّع بفنّ (الرضا عن الحياة). ومن دون الرضا، لا يمكن تحقيق التقدّم والنجاح. الأشخاص الناجحون هم الذين لا يواجهون مشكلة مع حياتهم. لا تخطئ! لا أقول: إنّهم لا يواجهون مشاكل (في) حياتهم، بل أقول: إنّهم لا يواجهون مشاكل (مع) حياتهم. وجود المشكلات في الحياة شيء، ووجود المشكلات مع الحياة شيءٌ آخر. في الحقيقة، في أغلب الأحيان، الأشخاص الناجحون قد واجهوا العديد من المشكلات والصعوبات، ولكنّهم لم يشعروا بعدم الرضا عن حياتهم. يمكن القول إنّ الرضا عن الحياة هو أحد الأسرار غير المكتشفة في حياة الأشخاص الناجحين.
الرضا عن الحياة، إذا لم يكن هو الهدف النهائي، فإنّه على الأقل شرطٌ ضروريٌّ للحياة وأساس النجاح والازدهار. من دون الشعور بالرضا، لا يمكن بناء حياةٍ جيدةٍ وناجحة. الأفراد غير الراضين يفتقرون إلى الطاقة وراحة البال اللازمة للتخطيط والتدبير، واتّخاذ الخطوات نحو حياةٍ جيّدة.
(14)الرضا عن الحياة هو من القضايا المهمّة التي لاقت اهتمام علماء النفس. ومع ظهور علم النفس الإيجابي في أواخر القرن العشرين، أصبح الرضا عن الحياة موضوعًا أكثر جدّيّة ضمن أبحاث علماء النفس. الرضا عن الحياة هو أحد العناصر والمكونات الأساسيّة للسعادة والرفاهيّة الذهنيّة، وهو نوعٌ من التقييم المعرفي للحياة يتم وفقًا لمعايير الفرد الذاتيّة.
الأطروحات والمقالات الفلسفيّة والدينيّة والسياسيّة مثل (الأخلاق النيقوماخيّة) لأرسطو، و(الحياة السعيدة) لأوغسطين، وحتى (إعلان الاستقلال) للولايات المتّحدة الأمريكيّة، تدعي أنّ البحث عن السعادة والرفاهيّة هو الهدف النهائي للإنسان، وأنّ تحقيق أيّ هدفٍ آخر ليس إلّا وسيلة لتحقيق هذا الغرض.
مع ذلك، وعلى الرغم من أهميّة هذا الموضوع في الأدبيّات العامّة، فإنّ الدراسة العلميّة لطبيعة وعوامل السعادة والرفاهيّة بدأت حديثًا فقط (لوبيز، 2009). تُظهر الأبحاث أنّ السعادة والرفاهية ليست ذات بُعدٍ واحد، بل تتكوّن من مكوّنين: مكوّن عاطفيّ يتضمّن مشاعر وأحاسيس إيجابيّةً كثيرةً، ومشاعر وأحاسيس سلبيّةً قليلة، ومكوّن معرفيّ يشير عادةً إلى الرضا عن الحياة.
ذُكر في تفسير أسباب الرضا عن الحياة أنّ جزءًا من الرضا عن الحياة يتحدّد من خلال الجينات الوراثيّة، ولكن على الرغم
من ذلك، يمكن تعديل رضا الأفراد عن حياتهم استجابةً للظروف البيئيّة. أظهرت الدراسات الحديثة أنّ الرضا عن الحياة يتغيّر على المدى القصير نتيجةً لتغير جودة الإدراك، والزواج، والعمل، وكذلك التغيّرات في مقدار الوقت الذي يُقضى في الأنشطة المثمرة والبنّاءة، والأهداف التي يختارها الأفراد (براتي، 2009).
لذلك، فإنّ هناك عوامل مختلفةً تؤثّر على الرضا عن الحياة، منها الصحة الجسديّة والنفسيّة، والسمات الشخصيّة، والعوامل الديموغرافيّة مثل الجنس، والفئة العمريّة، الحالة الزوجيّة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، الأمل، والصلابة النفسيّة، والثقافة، والدين، والروحانيّة.
بالرجوع إلى المصادر الإسلاميّة (الآيات والروايات)، يتّضح أنّ الرضا في الإسلام هو مفهوم ذو أهميّةٍ كبيرةٍ، ويُعدّ جزءًا أساسيًّا من السعادة والرفاهيّة. في المصادر الإسلاميّة، يُعدّ الرضا أحد عوامل السعادة، وهو هديّةٌ خاصّةٌ من الله تعالى للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وصف الإمام علي عليهالسلام الرضا بأنّه أفضل رفيقٍ للإنسان، وعدّ الشخص الراضي من المحظوظين الذين يُغبطون على حالهم.
إذا تأمّلنا في حياة الأنبياء وأولياء الله، نجد أنّهم تحمّلوا أشدّ المصاعب، ومع ذلك لم يكونوا غير راضين، ولا يائسين، ولا عاجزين. ولهذا السبب، كانوا أنجح الأشخاص في تاريخ البشريّة.
فنّ الرضا عن الحياة يوفّر بيئةً هادئةً للتقدّم، وأرضيّةً ثابتةً لبناء قصر النجاح الإنساني. لذلك، يجب أنْ نتذكر دائمًا أنّ الرضا عن الحياة هو أساس النجاحات، وبدونه فإنّ الوصول إلى السعادة ليس سوى وهم. الأشخاص الناجحون ينتقلون من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ويكتشفون قوانين الحياة لبناء قصر نجاحهم.
الإنسان في سعي دائمٍ للبحث عن الرضا في حياته. سرّ النجاح في العثور على المفقود هو أنّ يعرف الباحث ماهيّة ما يبحث عنه، والسؤال هنا: ما هو الرضا؟ وأين يمكن العثور
عليه؟ الشخص الذي لا يعرف ما هو الرضا يشبه من يبحث في صحراء شاسعةٍ دون أنْ يعلم ما الذي ينشده! الفشل هو إحدى نتائج الحالة التي لا يعلم فيها الإنسان ما الذي يريده أو ما الذي يبحث عنه. الشخص الذي لا يعرف على الإطلاق ما يجب أنْ يسعى وراءه قد يمرّ بمفقوده مرارًا وتكرارًا من دون أنْ يتعرّف عليه.
تصوّر أنّ أمًّا فقدت طفلها العزيز وهي لا تزال تجهل أيّ علامةٍ تدلّ عليه. وفي المقابل، تصور أنّ طفلًا يبحث عن أمّه، لكنّه لم يرها أبدًا ولا يملك أيّ دليلٍ عنها. هذان الاثنان قد يلتقيان مراتٍ عديدةً من دون أنْ يعرف أحدهما الآخر. (العثور) يختلف عن (الرؤية). الشرط الأساس للعثور هو (المعرفة). الشخص الذي يسعى وراء السعادة والنجاح والرضا يجب أنْ يعرف ماهيّة ما يبحث عنه. إذا لم يكن يعرف الرضا ولم يكن لديه أيّ مؤشّرٍ عليه، فإنّ جهوده ستذهب هباءً، ممّا يزيد من شعوره بعدم الرضا والضيق.
إلى جانب الفشل، فإنّ الحيرة والتشتّت هما أيضًا من نتائج عدم معرفة ماهية الرضا. الشخص الذي يبحث دون أنْ يعلم ما يبحث عنه في هذا الكون الفسيح سيبقى في حيرةٍ وتردّد، وسيفقد القدرة على الاختيار، ولن يجد مفقوده. هذا الأمر سيزيد من عدم رضاه وتوتره. الفشل والتشتّت يؤدّيان إلى اليأس والعجز، فإنّ الباحث الفاشل والمتردّد يصبح يائسًا وعاجزًا؛
(18)فلا يتصوّر لنفسه مستقبلًا مشرقًا، ولا يجد في نفسه القدرة على التحرّك. مثل هذا الشخص، المنهك والمثقل بالهموم، سيسقط في زاويةٍ من زوايا الحياة، ولن تكون هناك أيّ صدمةٍ تعيده إلى الحياة.
ما نسعى إليه في هذا الكتاب هو دراسة الرضا من وجهة النظر الإسلاميّة. السؤال الأساس هو: ما هو تعريف الرضا وفقًا للمصادر الإسلاميّة؟ وما هي مكوّناته؟ إضافةً إلى ذلك، ما هي النظريّة الإسلاميّة التي يمكن أنْ تفسّر الرضا؟ فضلًا عن ذلك، فإنّ استراتيجيّات تحقيق الرضا تمثّل قضيّةً مهمّةً ينبغي معالجتها. الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أنْ تمهّد الطريق لأبحاثٍ تجريبيّةٍ مستقبليّة.
سنجيب عن هذه الأسئلة في الفصول القادمة.
(19)أ) الرضا في النظريّات
في القرن التاسع عشر، بعد انفصال علم النفس عن الفلسفة، كان التوجّه نحو مذهب اللذّة واضحًا في أعمال علماء النفس. يشير ويترسو بشكلٍ خاصٍّ إلى جيمس، وثرندايك، وفونت، وفرويد في هذا السياق. خلال النصف الأول من القرن العشرين، ناقش كلٌّ من بول توماس يونغ (الذي عمل مع الفئران) وبيبه - سنتر (الذي عمل مع البشر) الدور الحيوي للملذّات. حاول كلاهما بناء علمٍ يستند إلى مبدأ اللذّة.
بعد فترةٍ وجيزة، طرح بيرلاين فكرة أنّ اللذّة تحدّدها الإمكانات المثيرة للمثيرات. خلال هذه السنوات، قام كلٌّ من أولدز وملنر بدراسة العصبيّة النفسيّة للذّة، وأعلن أولدز في عام 1956م أنّه اكتشف (مراكز اللذّة) في الدماغ.
في عام 1986م، قدّم غريفين (نظريّة الحاجة)، والتي تشير إلى أنّ السعادة تعني تحقيق ما تريده، بغضّ النظر عمّا
إذا كان ذلك يشمل اللذّة أم لا. وفي عام 1992م، قدّمت نوسبام (نظريّة قائمة الأهداف)، التي تفيد بأنّ السعادة تتمثّل في تحقيق عددٍ من الأهداف ذات القيمة الحقيقيّة في الحياة، مثل: الوظيفة، والصداقة، والتعليم، والمعرفة، والراحة، والرفاه المادّي، والصحة.
رغم أنّ مذهب اللذّة ظلّ يظهر في نصوص علم النفس خلال القرن العشرين، فإنّه لا شكّ في أنّ التوجّه النفسي في الألفيّة الجديدة، خاصّة في علم النفس الإيجابي، يعتمد بنحوٍ أكبر على مذهب السعادة بدلًا من مذهب اللذّة.
قدّم ويسينغ في عام 1988م، ووان دان في عام 1994م، قدّما بناءً عامًا للرفاهيّة النفسيّة يتميّز بـ(الشعور بالانسجام والترابط) في الحياة، التوازن العاطفي، والرضا العام عن الحياة. وأكّدا أنّ الرفاه النفسي هو بناء ذو أربعة أبعاد: العاطفة، والإدراك، والسلوك، والعلاقات بين الأفراد.
اكتشف دينر وسندویك وبافوت في عام 1991م، أنّ التوازن العام بين المشاعر الإيجابيّة والسلبيّة لدى الأفراد يُعدّ مؤشّرًا على شعورهم بالرفاهيّة. بناءً على هذا الاكتشاف، صرّح كانيمان في عام 1999م بأنّ السعادة الموضوعيّة يمكن قياسها من خلال تتبع المشاعر العابرة الإيجابيّة والسلبيّة لدى الأفراد. وفقًا
لهذا الرأي، فإنّ المشاعر الإيجابيّة مجرّد مؤشّرٍ على الرفاهيّة. وفي السنوات من 1998م إلى 2001م، عبّر فريدريكسون عن وجهة نظرٍ مشابهةٍ مع بعض الاختلافات. وبعد عام 2000م، قدّم أشخاص مثل أرجايل ودينر (نظريّة الرفاهيّة النفسيّة)، التي تضمّنت ثلاثة مكوّنات للسعادة: المشاعر الممتعة، والرضا عن الحياة، وغياب العواطف السلبيّة.
من وجهة نظر دينر وزملائه في أبحاثهم بين عامَيْ 1995م و2004م، فإنّ مفهوم (الرفاهيّة الذهنيّة) يتكوّن من ثلاثة عناصر رئيسة: أوّلًا، التقييم المعرفي للفرد لحياته في الجوانب العامّة والخاصّة، ثانيًا، وجود تأثير إيجابي، وثالثًا، غياب التأثير السلبي. يشير العنصر الأوّل إلى المكوّن المعرفي للرفاهيّة، في حين يشير العنصران الآخران إلى المكوّنات العاطفيّة للرفاهيّة. الأشخاص الذين يتمتّعون بمستوى عالٍ من الرفاهيّة الذاتيّة يوصفون بأنّ لديهم تجاربَ سلبيّةً قليلة، وتأثيراتٍ إيجابيّةً عالية، ورضًا كبيرًا عن الحياة. كما يُلاحظ، فإنّ الرضا عن الحياة هو أحد المكوّنات البارزة للرفاهيّة الذاتيّة. مقارنةً بالمكوّنات العاطفيّة، فإنّ الرضا عن الحياة يُعدّ أكثر استقرارًا، وله فوائد كبيرةٌ للصحة النفسيّة وجودة حياة الأفراد. وفقًا لهم، يسمح الرضا عن الحياة للأفراد بإجراء تقييماتٍ طويلة الأمد لحياتهم بناءً على مجموعة معاييرهم الخاصة.
في عام 2004م، قدّم ألان كار نظريّةً جديدةً، حيث ألغى
المكوّن الثالث، وعدّ التجارب العاطفيّة والرضا من مكوّنات السعادة. لذلك، فإنّ الرضا عن الحياة هو جزءٌ من بنيةٍ أوسع للرفاهيّة النفسيّة، التي تحتوي على ثلاثة مكوّنات: تقييم المشاعر الإيجابيّة، والمشاعر السلبيّة، والرضا عن الحياة. بسبب طبيعته المعرفيّة، فإنّ الرضا عن الحياة يختلف عن تقييم المشاعر. الرضا عن الحياة هو حالةٌ عاطفيّةٌ تنشأ عند تحقيق هدف معيّن. بنحوٍ عامّ، الرضا يمثّل شعورًا مريحًا ينشأ عن الشعور بحسن الأداء بعد تقييم نتائج الأنشطة والأعمال المنجزة.
الإنسان كائن ذو أهداف، ولن يشعر بالرضا حتى يحقّق رغباته. على العكس، عندما يحقّق رغباته، يشعر بالرضا، ولكن المشكلة تكمن في أنّ هذا الشعور غير دائم. تناول إنجلهارت هذا الموضوع وقدّم نموذج (الرغبة – التكيّف) في عام 2010م. تنصّ نظريّة التكيّف العقلي لإنجلهارت على أنّ مستوى رغبات الفرد يتكيّف تدريجيًّا مع وضعه الموضوعي، وأنّ السعادة دائمًا ما تكوّن فوق تلةٍ أخرى.
بحسب سليجمن، تنقسم المشاعر الإيجابيّة إلى ثلاث فئات: الحاضر، والماضي، والمستقبل، ويُعدّ الرضا شعورًا متعلّقًا بالماضي. في عام 2004م، يرى جوندلاخ أنّ السعادة والرفاهيّة الذاتيّة تتألّفان من مكوّنين: السعادة والرضا عن الحياة. السعادة تشير إلى البعد العاطفي، والرضا عن الحياة يشير إلى البعد المعرفي لمفهوم الرفاهيّة الذاتيّة. كذلك، عدّ
فينهوفن -في عام 2000م- الرضا نتيجة عمليّة تقييم استقصائيّة وفكريّة. معيار السعادة في هذا الرأي هو رضا الفرد الداخلي عن كلّيّة حياته، وتبلغ السعادة أقصاها عندما يكون الفرد راضيًا في تقييمه المعرفي عن كلّيّة حياته.
أعلن فينهوفن أيضًا في عام 2006م أنّ السعادة تعني الدرجة التي يحكم فيها الشخص على جودة حياته كلّيًا بشكل إيجابي. شين وجونسون يريان أنّ الرضا هو تقييمٌ عامٌّ لجودة الحياة بناءً على معايير الفرد وقيمه. كذلك، أشار دينر وزملاؤه في بحثٍ أجروه عام 1985م إلى أنّ الرضا يعتمد على مقارنة الظروف الحالية بمعايير الفرد الشخصية.
وفقًا لما أعلنه هليول في عام 2003م وهليول وباتنام في عام 2006م، فإنّهما يعتقدان أنّ السعادة تُعرَّف بنحوٍ رئيس بالإشارة إلى المشاعر اللحظيّة والعاطفيّة، بينما يشير الرضا عن الحياة إلى تقييمٍ عامٍّ أكثر شموليّةً للحياة والرفاهيّة والسعادة. البعد المعرفي للسعادة يمثّل نوعًا من الفرح العميق والمتجذّر الذي يتشكّل بناءً على تقييم إيجابي. يعدّ باتريك هذا النوع من السعادة معادلًا للرضا عن الحياة، مشيرًا إلى أنّ الرضا والقناعة يحملان معنى السعادة العميقة والجذريّة، وليس السعادة السطحيّة والعابرة؛ وهي حالةٌ لا يمكن تقليلها بالضرورة إلى شعورٍ معينٍ من النشوة أو النشاط.
كان الإغريق القدماء يستخدمون مصطلح (Eudemonia) للإشارة إلى (العيش والعمل الجيّدين)، وهو ما يعبّر عن هذه الحالة من الرضا العميق والمستدام.
تمّ تصوير الرضا عن الحياة على أنّه الفرق بين ما يريده الشخص وما هو عليه في الواقع؛ بشكلٍ أساسي، الفرق بين الواقع والمثاليّة. وفقًا لنظريّةٍ متعدّدة الأبعاد قدّمها ألكس مايكس في عام 1986م، يتمّ تحديد الرضا عن الحياة من خلال الإدراك الشخصي للفرد حول (كيف هي الأشياء)، مقارنةً بـ(كيف يجب أنْ تكون). يتعلّق الأمر بمقارنةٍ بين طبيعة الأشياء وما يريد الشخص أنْ يملكه، وما يملكه الشخص بالفعل وما يتوقّعه، وما يملكه الآخرون وما يشعر أنّه يستحقه.
في جميع هذه التعريفات، يعتمد معيار الرضا عن الحياة على عقليّة الانسان، بمعنى إلى أيّ مدى يشعر الفرد عقليًّا بالتوافق بين واقع حياته ومثله العليا. كما يرى كامبل أنّ الرضا عن الحياة يعكس التوازن بين رغبات الفرد ووضعه الحالي.
ب) دور الأمور المادية في الرضا
أظهرت تحليلات إنجلهارت لبيانات من 24 دولة، والتي نُشرت في عام 2010م وجود ارتباطٍ إحصائي قدره 0.67 بين الناتج المحلّي الإجمالي والرضا عن الحياة. ومع ذلك، وفقًا لدراسات أسكنز في عام 1998م، لا يؤدّي هذا العامل دورًا
حاسمًا في مستوى رضا الأفراد. من الملاحظ أنّ زيادة مستوى الوضع الاقتصادي أو الدخل تؤثّر فقط إلى حدٍّ معينٍ على الرضا عن الحياة، وليس لها تأثير غير محدود.
وفقًا لدراسات باوس وزملائه في عام 2008م، فإنّ الدخل له تأثيرٌ ضئيلٌ على المستويات العليا من الرضا عن الحياة، ولكنّه يقلل بشكلٍ كبيرٍ من شعور عدم الرضا. السبب في ذلك هو أنّ الدخل يلبّي الاحتياجات الأساسيّة للإنسان، وبالتالي مع ارتفاع مستوى الأمن الاقتصادي، تحلّ الاحتياجات والأهداف الأخرى، التي تكون غالبًا غير مادية، محلّها. كما أشار لازاروس، نشعر بالسعادة والرضا عندما نحقّق تقدّمًا معقولًا نحو تحقيق أهدافنا.
أمّا استرلين، من خلال دمج النظريّات النفسيّة والاقتصاديّة، حاول تفسير الرضا عن الحياة. فرأى أنّ عامل الرضا لدى الأفراد يعتمد على مدى الفجوة بين الرغبات ومستوى تحقيقها في كلّ مجالٍ من مجالات الحياة، وكذلك على الأهميّة النسبيّة لكلّ مجالٍ من حيث وظيفته المثلى بالنسبة للفرد.
كما أنّ العوامل الجغرافيّة والبيئيّة يمكن أنْ تؤثّر على الرضا عن الحياة. ذكر بجورنسكو أنّ دراسة شملت 37 دولة أظهرت أنّ الاعتدال في المناخ يؤدّي إلى زيادة الرضا عن الحياة، والسبب في ذلك هو غياب الضغوط الفيزيولوجيّة الناتجة عن
الحرارة أو البرودة الشديدة. يبرز هذا الأمر بشكلٍ خاصّ اليوم، حيث يمكن للناس بفضل وسائل الإعلام مقارنة أوضاعهم بأوضاع الآخرين حول العالم.
في عام 2001م، عرّف لوباميرسكي الرضا على أنّه مقارنة بين ما يمتلكه الفرد وما يودّ أن يمتلكه. بينما ذكر ميكالوس في عام 1985م أنّ نظريّات الحكم النسبي تشير إلى أنّ رضا الفرد عن دخله يعتمد على المقارنة الاجتماعية، أي مقارنة ما كان يمتلكه في الماضي بما يمتلكه الآن، وما يتطلّع إلى امتلاكه في المستقبل، وما يمتلكه الآخرون. هذه المقارنات تفسّر مستوى الرضا عن الحياة.
أظهرت التحليلات الشاملة للدراسات المتعلّقة بالمادّيّة وجود علاقةٍ سلبيّةٍ عامّةٍ بين الرفاهيّة والمادّيّة. الثروة تزيد من رفاهيّة الأفراد الفقراء، ولكن عندما تُلبّى احتياجاتهم الأساسيّة، لا يكون لها تأثير كبيرٌ على الرفاهيّة؛ بمعنى أنّ العلاقة بين المال والرفاهيّة ليست واضحة.
كتب نجفي وزملاؤه (2015) أنّ العوامل الظرفيّة والخارجيّة، مثل الوضع الاقتصادي، تبدو فعّالةً على المدى القصير في تعزيز الرفاهيّة والسعادة، لكنّها غير فعّالةٍ على المدى الطويل. العوامل الداخليّة، مثل الشخصيّة، التفاؤل، والأمل، والكفاءة الذاتية، واحترام الذات، تكون أكثر فاعليّة. ومع ذلك، قبل
الشروع في تعزيز السعادة، من الضروري أوّلًا تلبية الاحتياجات الأساسيّة والأوّلية (لوكاس وزملاؤه؛ نقلًا عن لوباميرسكي، كينغ، ودينر 2005).
يدرك الباحثون أنّ المكانة الاجتماعيّة، والثروة، والوصول إلى الموارد المادّيّة، رغم أنّها تسهم في تحقيق السعادة، فإنّ تأثيرها الإيجابي يتلاشى تدريجيًّا بسبب آليّة التكيّف. ونتيجة لذلك، فإنّ المواقف الحياتيّة لها تأثيرٌ مؤقّتٌ على الشعور بالرفاهيّة الذاتيّة (هديو وويرينغ، 1992). تُظهر نتائج هذا البحث أنّ النمو والتطوّر الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة الناس يعزّز سعادتهم إلى حدٍّ يلبّي احتياجاتهم. ومع ذلك، بعد تلبية الاحتياجات الأساسيّة، فإنّ الزيادات الإضافيّة في المؤشّرات الاقتصاديّة لا يكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على تعزيز مستوى السعادة، ممّا يجعل التركيز على أبعاد أخرى أكثر أهميّة. ورغم أنّ الحالة الاقتصاديّة تُعدّ من الركائز الأساسيّة للرضا والسعادة، فإنّ الأفراد ما إنْ يتمتّعوا بهذه الإمكانات الأساسيّة ويؤمّنوا احتياجاتهم الضرورية، لا تعود الثروة تؤدّي دورًا رئيسيًّا في حياتهم (دينر، 1995).
ج) دور الثقافة في الرضا
أُجريت دراساتٌ عديدةٌ لتحديد العلاقة والعوامل المؤثّرة في رضا الأفراد عن حياتهم ضمن ثقافات مختلفة. تركّز النظريّات الثقافيّة على خصائص الثقافات الفرديّة والجماعيّة لتفسير
العوامل المؤثّرة على الرضا عن الحياة، كما تهدف إلى تحديد الإطار المفاهيمي لهذا المصطلح. غالبًا ما تستند هذه النظريّات إلى خصيصة الفرديّة/ الجماعيّة. يرى منظّرو هذه النظريّات أنّ التنمية الاقتصاديّة تعزّز الرضا والرفاهيّة الذهنيّة من خلال خلق بيئةٍ ثقافيّةٍ تسمح للأفراد بالسعي لتحقيق الرضا الشخصي عبر تصرّفاتٍ تتجاوز الالتزامات الاجتماعيّة. هذا التحوّل يعكس تطوّرًا ثقافيًّا من الجماعيّة إلى الفرديّة وتغليب القيم الفرديّة.
تختلف تأثيرات الفرديّة على مستوى الرضا في المجتمعات. ففي الدول الفقيرة، تقلّل الفرديّة من رضا الأفراد عن حياتهم، بينما يكون العكس صحيحًا في الدول الغنيّة.
تأكيدًا على هذه النظريّة، قام أسشيماك وزملاؤه في عام 2002م بإجراء دراسةٍ استقصائيّةٍ لتقييم تأثير الثقافة على الرضا الاجتماعي. خلصوا إلى أنّ الثقافة عاملٌ وسيطٌ يؤثّر من خلاله السمات الشخصيّة على الرضا عن الحياة. اختاروا عيناتٍ من ثقافتين فرديّتين (الولايات المتّحدة وألمانيا)، وثلاث ثقافاتٍ جماعيّةٍ (اليابان، المكسيك، وغانا)، وقاموا من خلال إجراء بعض الفحوصات بقياس مدى التوازن بين اللذّة والرضا عن الحياة لدى المشاركين. أظهرت النتائج أنّ تأثير الشخصيّة على المكوّنات العاطفيّة والمعرفيّة للرضا عن الحياة يعتمد على الثقافة. بناءً على ذلك، تُعدّ الثقافة أحد المكوّنات الرئيسة للرضا في أيّ مجتمع.
في هذا البحث، لا يتمّ التطرّق إلى المكانة، والعوامل أو النظريّات، بل يتمّ التركيز على تعريف الرضا في الثقافة الإسلاميّة، على أنْ تأتي الموضوعات الأخرى في المناقشات القادمة. في التعريف، يتمّ استخدام منهج تحليل المفاهيم من خلال دراسة آراء اللغويّين والمفكّرين، والنصوص الدينيّة، وفي النهاية يتمّ الوصول إلى مكوّنات الرضا.
بعض اللغويّين عرّفوا الرضا بضدّه، وهو (عدم السخط)، بينما عرّفه آخرون بـ(عدم الكراهيّة)، فيكون الرضا هو (الحبّ والإقبال)، و(الاختيار)، و(الموافقة/ التوافق). ويرى بعضهم أنّ الأصل في معنى الرضا هو التوافق بين إرادة الشخص وحاله الراهنة.
يرى بعضهم أنّ هذا المفهوم لدى الإنسان بمعنى عدم الكراهية لتقدير الله، وبالنسبة لله تعالى بمعنى أنْ يرى العبد في حالة تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. كما استُخدم لفظ (رضيّ)،
بمعنى (المطيع)، وأحيانًا بمعنى (الضامن)، وفُسّر (ارتضاه) بمعنى (عدّه أهلًا لذلك). وقد فسّر الطريحي عبارة «رضيتُ بالله ربًّا»، بمعنى الاكتفاء بالله وعدم طلب غيره. هذه الاستخدامات تتوافق مع معنى «الموافقة»، إذ إنّ الطاعة تعني توافق أفعال الفرد مع الأمر، وعدّ الشخص أهلًا يعني توافقه مع الصفات المطلوبة.
في مقابل الرضا، يأتي السخط، وقد عرّفه بعضهم بأنّه ضدّ الرضا، بينما فسّره آخرون بمعنى «الكراهيّة وعدم القبول». ويعتقد آخرون أنّ السخط يختلف مع المواقف المختلفة، فيمكن أنْ يعني الغضب، التقليل من قيمة النعمة، أو عدّها بلا أهميّة.
بصورةٍ عامّةٍ، عرّف اللغويّون الرضا بمزيج من الإقبال، والاختيار، والموافقة.
أمّا في الاصطلاح، فقد عرّف بعضهم الرضا بأنّه:
- سرور القلب بالتقدير.
- عدم الجزع عند البلاء.
- استقبال الحكم الإلهي بفرح.
- سكون واطمئنان القلب تجاه قضاء الله.
«طيب النفس»، بمعنى عدم تغيّر الحال أثناء الشدائد.
الرضا كإحساسٍ داخليّ لا يختلف معناه في المصادر الإسلاميّة عن غيرها. وعادةً، لا يوجد اختلافٌ بين التعريف الإسلاميّ وغير الإسلاميّ له. وتأثير الثقافة والدين إنّما هو في تحديد المصاديق والمؤشرات.
وردت في النصوص الدينيّة أمثلةً تساعد على توضيح المفهوم وفهمه بشكلٍ أفضل، ومنها أنّ الشخص الراضي:
1. يقبل أقدار الله.
2. يُقبل عليها برضا.
3. لا يتمنى وضعًا غير ما قدّره الله.
4. لا يطلب تأخيرًا أو تعجيلًا في الأقدار.
5. يعتقد أنّ أقدار الله خير ومصلحة له ولهذا، فإنّ الشخص الراضي يصبر على الشدائد، ويشكر الله على النعم.
من خلال دراسة المفاهيم اللغويّة، الاصطلاحيّة، والدينيّة، يتّضح أنّ الرضا يتكوّن من العناصر التالية:
١. المطابقة: تعني التوافق والانسجام بين الوضع القائم والوضع المتوقّع. قد يقيّم الإنسان حالته بطرقٍ مختلفة، إحداها هو تقييم الوضع بناءً على توقّعاته. في هذا التقييم، إذا رأى الفرد أنّ الوضعين متوافقان ومنسجمان، يتولّد شعور بالرضا.
٢. القبول: يعني تقبّل الفرد لوضعه والاستسلام له. الشخص الراضي هو من يقبّل الوضع الذي تم تقييمه، بل قد يرحّب به، دون أنْ يتمنى وضعًا مختلفًا عن الوضع المقدّر له. كما أنّه لا يرغب في تأخير أو تسريع الأقدار، ويصبر على الشدائد، ويشكر الله على النعم. بالإضافة إلى ذلك، يكون لديه ميلٌ للطاعة وكراهية للمعصية.
٣. الارتياح: يعني الشعور بالفرح أو على الأقل عدم الشعور
بعدم الارتياح. الشخص الراضي لا يشعر بالجزع أو الحزن تجاه ما يرضى عنه، بل يكون لديه شعورٌ داخليّ بالسرور، والفرح، وراحة البال، والاطمئنان.
إنّ تركيبة هذه المكونات الثلاثة تولّد شعور الرضا. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التركيبة هي تركيبٌ مزجيّ مترابط، وليست ثلاثة عناصر منفصلة موضوعة جنبًا إلى جنب؛ لذلك، لا يمكن فصل بعضها عن بعض أو ملاحظتها بشكلٍ مستقلٍّ في شعور الرضا.
المراد بالأساس النظري للرضا هو العامل الأكثر جوهريّةً الذي يمكن من خلاله تفسير شعور الرضا. في أيّ موضوع، توجد عوامل تسهم في تحقيقه، ولكن هناك عناصر أساسيّة تعود إليها جميع الأمور. هذه العناصر يمكن استخدامها كأساس للتنظير. في موضوع الرضا، السؤال الأساس هو: ما هو الأساس النظري للرضا من وجهة نظر الإسلام؟ وما هو العنصر الذي يشكّل جوهر شعور الرضا؟
من خلال مراجعة النصوص المتعلّقة بالقضاء الإلهي، يتبيّن أنّ «الخير المُدرَك» هو الأساس النظري للرضا في الإسلام؛ أي أنّ استناد الحياة إلى الخير الحقيقي يشكّل أساس شعور الرضا.
أ) الخير المُدرَك
استنادًا إلى المصادر الإسلاميّة، فإنّ تقدير الله تعالى مبنيٌّ على الخير. كلّ ما يقدره الله ويحكم به، سواء في التشريع أم في التكوين، لا يكون إلّا خيرًا[1]، سواء كان ذلك نعمة وفيرة أم مصيبة مؤلمة[2].
عن صهيب قال: صلّيت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله إحدى صلاتي العشاء، فلمّا انصرف أقبل إلينا بوجهه ضاحكًا، فقال: «ألا تسألوني ممَّ ضحكتُ؟ّ!» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عجبتُ من قضاء الله للعبد المسلم إنّ كلّ ما قضى الله له خير، وليس أحد كلّ قضاء الله له خير إلّا العبد المسلم»[3] وفي بعض الروايات، استُعمل تعبير «الحسن» بدلًا من «الخير».
فقد وصفَ النبيُّ صلىاللهعليهوآله اللهَ تعالى بعبارة «حسن القضاء»[1]، ويمدح الإمام زين العابدين عليهالسلام اللهَ تعالى للسبب نفسه[2]. كما أنّه في بعض الروايات الأخرى استُعمل تعبير (الحكمة)، كما في قول الإمام عليّ عليهالسلام: «أمرُهُ قَضاءٌ وَحِكمَةٌ، وَرِضاهُ أمانٌ وَرَحمَةٌ، یَقضي بِعِلمٍ، وَیَعفو بِحِلمٍ»[3].
إرادة الله، وإنْ بدت غير محبوبة، فهي أفضل من إرادة البشر، وإنْ بدت محبوبة؛ لأنّ إرادة الله تعالى مبنيّةٌ على خيرٍ خفيّ ولكنّه دائم، بينما إرادة البشر مبنيّةٌ على خير ظاهر، ولكنّها تحتوي على شرٍّ خفيّ ودائم[4]. وقد بيّن الإمام الصادق عليهالسلام حكاية مميزة في هذا السياق، حيث قال:
«إنّ بني إسرائيل أتوا موسى عليهالسلام فسألوه أنْ يسأل الله (عزّ وجلّ) أنْ يمطر السماء عليهم إذا أرادوا، ويحبسها إذا أرادوا، فسأل الله (عزّ وجلّ) ذلك لهم فقال الله (عزّ وجلّ): ذلك لهم يا موسى فأخبرهم موسى فحرثوا، ولم يتركوا شيئًا إلّا زرعوه، ثمّ استنزلوا المطر على إرادتهم، وحبسوه على إرادتهم؛ فصارت
زروعهم كأنها الجبال والآجام، ثم حصدوا وداسوا وذروا فلم يجدوا شيئًا؛ فضجّوا إلى موسى عليهالسلام وقالوا: إنّما سألناك أنْ تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأُجابنا، ثم صيّرها علينا ضررًا! فقال: يا رب إنّ بني إسرائيل ضجّوا ممّا صنعت بهم، فقال: وممَّ ذاك يا موسى؟ قال: سألوني أنْ أسألك أنْ تمطر السماء إذا أرادوا وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم، ثم صيّرتها عليهم ضررًا. فقال: يا موسى أنا كنت المقدر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت».
ما هو مهم هنا هو رد الفعل الإيجابي للإنسان تجاه تقدير الله. القضاء والقدر يمثلان ظرفًا خارجيًا، في حين أنّ الرضا أو السخط هما حالتان نفسيّتان تتشكّلان كردّ فعلٍ لهذا الظرف. وفقًا للمصادر الإسلاميّة، فإنّ الرد الإيجابي على القضاء والقدر يُعبّر عنه بالرضا (الرضا بقضاء الله)، بينما الرد السلبي يُعبّر عنه بالسخط (السخط على القضاء).
ورد في المصادر الإسلاميّة مصطلح (الرضا بقضاء الله)، كما جاء في قول الإمام علي عليهالسلام: «عَلامَةُ رِضَا اللّهِ سُبحانَهُ عَنِ العَبدِ، رِضاهُ بِما قَضیٰ بِهِ سُبحانَهُ لَهُ وَ عَلَیه».
وفي حديثٍ آخر عن الإمام علي عليهالسلام :«إنْ عَقَدتَ أیمَانَك فَارْضَ بِالمَقضِي عَلَیك وَلَك، وَلا تَرجُ أحَدًا إلَّا اللّهَ، وَانْتَظِر ما أتاك بِهِ القَدَر».
كما أشار الإمام زين العابدين عليهالسلام إلى الرضا في تقديرات الله، سواء كانت محبوبة أم مكروهة، سواء بدت نافعة أم ضارة للإنسان. ويقول الإمام الصادق عليهالسلام: «اِعلَموا أنَّهُ لَن یُؤمِنَ عَبدٌ مِن عَبیدِهِ حَتّیٰ یَرضی عَنِ اللّهِ فیما صَنَعَ اللّهُ إلَیهِ، وَصَنَعَ بِهِ عَلی مَا أحَبَّ وَكرِهَ».
من خلال هذه النصوص، يتّضح أنّ الإيمان بخيرية قضاء الله هو العامل الأساس في الرضا عنه. ما يهم هنا هو أنّ التقدير يمثّل مصداقًا. وبإلغاء الخصوصيّة، يتبيّن أنّ (الخير) يجلب الرضا، بينما (الشر) يجلب السخط. إذا عدَّ الإنسان شيئًا شرًا، فإنّه يشعر بالسخط تجاهه، وإذا إذا عدَّه خيرًا، فإنّه يرضى عنه.
بعبارةٍ أخرى، تم تصميم النظام النفسي للإنسان بنحو أنّ الإحساس بالرضا يُثار تجاه (الخير المدرَك)؛ لذلك، فإنّ (الخير المدرَك) هو الأساس النظري لشعور الرضا. إذا قيّم الفرد حياته على أنّها جيّدة (حياة جيّدة)، فإنّ شعور الرضا سيتولّد.
ب) الأساس النظري للتقدير
في النصوص الدينيّة، وردت إشاراتٌ عديدةٌ إلى خيريّة
التقدير التكويني والتشريعي لله تعالى (بأنواعه المختلفة). ويمكن تقسيم هذه الإشارات إلى ثلاثة أقسام: خيريّة البلاء، وخيريّة المال، وخيريّة التكليف. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما النظريّة التي يمكن أنْ تفسّر هذه الأمور؟ يبدو أنّ الأساس النظري لكلّ هذه الجوانب هو (النمو والتكامل الإنساني)، أو ما يمكن تسميته بـ(التفتح التوحيدي).
الإنسان كائن ذو قدراتٍ واستعداداتٍ متعدّدة، ويجب أنْ تزدهر جميعها لتصل إلى الكمال. هذا النمو والتفتح يتماشى مع فلسفة خلق الإنسان، التي تهدف إلى جعله توحيديًّا. النمو والتكامل الأساسي للإنسان يتحقّق عندما يتجاوز الأمور الدنيوية ويتجاوز نفسه (تجاوز غير الله) ليصبح إلهيًّا، وهو ما نسمّيه (النمو التوحيدي) أو (التفتح التوحيدي). ومع ذلك، وكما مرَّ في المباني، يمكن للإنسان أنْ يتحول إلى كائنٍ شيطاني ونفسي. ولكن المهم وجود إمكانيّة الترقي للإنسان كي يصبح إلهيًّا، ولتحقيق هذا التفتح، وُضعت النعم، والمصائب، والتكاليف.
في الحقيقة، أحيانًا يمنح الله النعمة ليزرع في الإنسان الرؤية التوحيدية من خلال النعم والسرور، حتى يدرك الإنسان أنّ كلّ شيءٍ يأتي من الله، ويستخدم هذه النعم في سياق نموه وتكامله. وأحيانًا يبتليه بالمصائب ليطوّر الرؤية التوحيديّة في جانب المصائب، وليثبت ثباته على عهده مع الله. يُظهر
(41)الإنسان من خلال ذلك أنّه حتى لو منحه الله المصائب، فإنّه لن ينصرف عنه. فالمصائب يمكنها أنْ تعيد الإنسان المخطئ إلى طريق الله وتطهره، ويمكنها أنْ تحافظ على دينه، أو ترفع درجته. جميع هذه الأمور تصب في سياق النمو التوحيدي.
كما أنّه، من خلال الأمر بما ينفر منه الإنسان والنهي عمّا يرغب فيه، يربي الله محوريّة الله في الإنسان، ليُظهر ما إذا كان مستعدًّا للتخلّي عن كلّ شيءٍ من أجل الله. هناك خاصيةٌ مشتركةٌ في جميع هذه الجوانب، وهي أنّ الإنسان يكون مستعدًا للتخلّي عن كلّ المغريات الدنيوية والرغبات النفسيّة ويركز فقط على الله. هذا هو قمّة النمو والتكامل الإنساني. لذلك، فإنّ فلسفة القضاء التكويني والتشريعي لله تعالى هي التفتّح أو الازدهار التوحيدي.
ج) الرضا الصادق والكاذب
نظريّة الرضا في الإسلام هي نظريّةٌ تعتمد الحقائق. وهذا يعني أنّ الرضا يكون صحيحًا عندما يكون بسبب خيرٍ حقيقي، وليس خيرًا وهميًّا، وأنّ السخط يكون صحيحًا عندما يكون بسبب شرٍّ حقيقي، وليس شرًا وهميًّا. معيار صحّة أو خطأ الرضا والسخط هو توافقهما أو عدم توافقهما مع الحقائق. لذلك، إذا كان شخص ما غنيًّا، لا يمكن القول بمجرّد كونه غنيًّا فإنّه يجب أنْ يكون راضيًا، أوإذا كان فقيرًا، فإنّه يجب أنْ
(42)يكون ساخطًا، وإذا كُلَّف شخصٌ بمهمة، لا يمكن القول بمجرد وجود التكليف يوجب أنْ يكون ساخطًا.
المال والثروة، رغم جاذبيتهما وحلاوتهما، إذا لم يكونا في المسار الذي يمثّل خير المال، فإنّ الرضا عنهما يكون خاطئًا (رضا كاذب)، والسخط منهما يكون منطقيًّا وصحيحًا (سخط الصادق). المال، بسبب جاذبيّته، قد يقف في مواجهة مكوناتٍ إيجابيّةٍ للحياة.
في الروايات الإسلاميّة، وُصف المال بأنّه «مادّة الشهوات الباطلة»، و«فخ إبليس»، ويُعدّ من «أسباب هلاك الإنسان». لذلك، تم التحذير من حبّ المال. هذا النوع من النعم هو ما يُشار إليه في الأدبيّات الدينيّة باسم «نعمة الاستدراج». بناءً على ذلك، يمكن أنْ يكون المال من أسباب السخط.
أيضًا، إذا كانت المصيبة أو البلاء، على الرغم من مرارتها وصعوبتها، في إطار ما يجعلها خيرًا، فإنّ السخط منها يكون
غير منطقي وخاطئ (سخط كاذب)، والرضا عنها يكون صحيحًا (رضا صادق). المصيبة تكون سيئةً عندما لا يصبر الإنسان عليها ويسخط على الله. في بعض الروايات، ذُكر أنّ المصاب الحقيقي هو من يُحرم من ثواب المصيبة. هذا يُظهر أنّ المصيبة في حدّ ذاتها ليست حرمانًا؛ بل فقدان ثوابها هو الحرمان الحقيقي. بناءً على ذلك، يمكن أنْ يكون البلاء أيضًا من أسباب الرضا.
إنّ الفرد إذا عمل بالتكليف، فإنّ خيره مضمون، فيكون السخط منه يكون خاطئًا (سخط كاذب)، والرضا عنه منطقيًا وصحيحًا (رضا صادق). ولكن إذا لم يعمل بالتكليف، رغم أنّه قد يشعر بالراحة، فإنّه يُصاب بالشرّ؛ لذا فإنّ رضاه في هذه الحالة يكون خاطئًا (رضا كاذب)، وسخطه يكون صحيحًا ومنطقيًا (سخط صادق).
ممّا سبق يتضح أنّ الرضا من وجهة نظر الإسلام لا يُعدّ مجرد ظاهرة نفسية؛ بل هو ظاهرة نفسية مرتبطة بالواقع. نسمّي هذا (الرضا الواقعي). في هذه النظريّة، الرضا الصحيح هو الذي يتوافق مع الحقائق، بينما الرضا الذي لا يمتلك هذا التوافق ليس رضا صحيحًا؛ بل مجرد إحساسٍ غير مستقرٍّ ومخادعٍ قد يؤدّي بالفرد في المستقبل إلى الانهيار والفشل المفاجئ.
إذا أردنا رؤية الرضا بشكلٍ ملموسٍ في الحياة، علينا أنْ ندرس أبعاد الحياة الطيِّبة والخير في الحياة. هناك أربعة أمور يجب التركيز عليها في الحياة:
التقديرات: وتشمل الأحداث السارة (النعم)، وغير السارة (المصائب) في الحياة، بالإضافة إلى التكاليف الحاكمة على الحياة التي تنشأ عنها الطاعة والمعصية.
المعيشة: وتشير إلى البعد الاقتصادي للحياة.
العلاقات: وتعني التواصل والتفاعل مع الآخرين.
السياسة: وتشير إلى النظام السياسي والاجتماعي السائد في المجتمع.
لذلك، الحياة الطيِّبة هي مزيجٌ خاصٌّ من التقدير الطيِّب، والعلاقات الطيِّبة، المعيشة الطيِّبة، والنظام الطيِّب. وفيما يلي سنتناول هذه العناصر الأربعة بالتفصيل:
أ) التقدير الطيب
جزءٌ من الحياة تتكوّن من التقديرات الخاصّة لله تعالى، التي يُشار إليها في الأدبيّات الدينيّة باسم (القضاء والقدر).
القضاء: مأخوذ من الجذر (ق ض ي)، بمعنى إتمام شيء،
وجعله متينًا وفق فلسفته الوجوديّة.
القدر: مأخوذ من الجذر (ق د ر)، بمعنى تحديد مقدار الشيء وحدوده وجوهره ونهايته. التقدير: يعني تحديد مقدار الشيء.
القضاء والقدر يُستعملان في القرآن الكريم والأحاديث بمعانٍ متعددة. وفقًا لحديث عن الإمام (علي عليهالسلام)، فإنّ كلمة القضاء وردت في القرآن بعشرة معانٍ.
ولكن هنا فالمقصود من القدر يشير إلى هندسة الأشياء وحدودها، والقضاء يعني الحكم بتحقيقها. وبعبارةٍ أخرى، كلّ ظاهرةٍ تحتاج إلى مقدّماتٍ لتحقيقها، والقدر والقضاء هما مقدّمتان رئيسيّتان لتحقيق أيّ شيء. القدر: هو قياس أبعاد وجود الظاهرة. والقضاء: هو تنفيذ هذا التقدير وتحقيقه.
الله تعالى، قبل أنْ يفعل أيّ شيءٍ أو يخلق أيّ ظاهرة، يقوم أولًا بتحديد حدود وجودها من جميع الجوانب، فتلك الحدود هي القدر وهذا العمل هو التقدير، وبعد ذلك يأتي القضاء، حيث يحقق الله ما قدّره بالفعل. وبعبارة أخرى إنّ الوجود العيني لكلّ ظاهرةٍ، يعدّ في الواقع تحقيقًا لوجودها التقديري،
لذلك فإنّ القدر يسبق القضاء، رغم أنّ القضاء يُذكر أوّلًا في النصوص لتسهيل التعبير والاستخدام.
القضاء والقدر، من منظورٍ معيّن، ينقسمان إلى تكوينيّ، وتشريعي. القضاء والقدر التكوينيّان يتعلّقان بجانب الخلق وكيفيّة تنظيم قوانين الحياة وأحداثها. أمّا القضاء والقدر في مجال التشريع، فمعناهما أنّ الله تعالى قد وزن أفعال الإنسان الاختياريّة، وبناءً على مصالحها ومفاسدها، قسمها إلى: واجب، مستحب، حرام، مكروه، ومباح، وحدد مقدار الثواب والعقاب المترتب على كلٍّ منها. القضاء التشريعي هو أنّ الله تعالى قد أصدر الأمر بتنفيذ القدر التشريعي.
ما يتعلّق ببحثنا من القضاء والقدر التكوينيين هو الحوادث والوقائع التي تطرأ في مسار حياة كلّ فرد. تنقسم حوادث الحياة إلى قسمين: الأيام السارّة، والأيّام غير السارّة؛ لهذا السبب، قسّم الإمام عليّ عليهالسلام الحياة إلى قسمين: «يومٌ لك» و«يومٌ عليك». وهناك مفاهيم أخرى تتّصل بهذه الحقيقة: السعادة في الحياة «يومٌ لك» هي ما يُطلق عليه في الأدبيّات الدينيّة (النعمة).
الشقاء في الحياة «يومٌ عليك» هو ما يُشار إليه بمصطلحات مثل البلاء، المصيبة، والنقمة.
في الروايات، وردت ثلاث كلمات معًا: القضاء، والبلاء، والنعماء، كما وردت أيضًا ثلاثة مفاهيم مترابطة: الرضا، والصبر، والشكر. الرضا هو رد الفعل تجاه القضاء. والصبر هو رد الفعل تجاه البلاء. والشكر هو رد الفعل تجاه النعماء.
على سبيل المثال، ورد في حديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّ الأشخاص الذين تكون ردود أفعالهم تجاه القضاء والبلاء والنعم هي الرضا والصبر والشكر، فإنّ الله تعالى يعدّهم من عباده الصادقين[1].
رُوي عن الإمام الكاظم عليهالسلام: «رَفَعَ إلىٰ رَسولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآله قَومٌ فی بَعضِ غَزَواتِهِ، فَقالَ: مَنِ القَومُ؟ فَقالوا: مُؤمِنونَ یا رَسولَ اللّهِ! قالَ: وَما بَلَغَ مِن إیمانِكم؟ قالوا: الصَّبرُ عِندَ البَلاءِ، وَالشُّكرُ عِندَ الرَّخاءِ، والرِّضا بِالقَضاءِ. فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: حُلَماءُ عُلَماءُ، كادوا مِنَ الفِقهِ أنْ یَكونوا أنبِیاءَ. إنْ كنتُم كما تَصِفونَ، فَلا تَبنوا ما لا تَسكنونَ، وَلا تَجمَعوا ما لا تَأكلونَ، وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذي إلَیهِ تُرجَعونَ»[2].
كما نُقل عن الإمام علي عليهالسلام أنّه استعمل هذه المفاهيم
الثلاثة بالطريقة، وقال: «ثَلاثٌ مَن كنَّ فیهِ فَقَد رُزِقَ خَیرَ الدُّنیا وَالآخِرَةِ؛ هُنَّ: الرِّضا بِالقَضاءِ، وَالصَّبرُ عَلَی البَلاءِ، وَالشُّكرُ فِي الرَّخاء. وقال عليهالسلام أيضًا: إنَّكم إن صَبَرتُم عَلَی البَلاءِ، وَشَكرتُم فِی الرَّخاءِ، وَرَضیتُم بِالقَضاءِ، كانَ مِن اللِه سُبحانَهُ الرَّضا». لذلك كان يدعو الله أنْ يمنحه هذه الصفات الثلاث في دعائه.
في بعض الروايات، ورد ذكر العنوانين (الرضا والصبر) معًا. وفي جزءٍ آخر من الروايات، استُعملت تعبيرات بديلة عن كلمتي البلاء والنعمة، يمكن من خلالها تفسير العلاقة بينهما وبين الرضا. هذه التعبيرات تشير إلى كون ظروف الحياة إمّا مريحة وإمّا غير مريحة. على سبيل المثال، يقول الإمام علي عليهالسلام : «عَلامَةُ رِضَا اللّهِ سُبحانَهُ عَنِ العَبدِ، رِضاهُ بِما قَضی بِهِ سُبحانَهُ لَهُ وَعَلَیهِ».
هذا الحديث يوضح بجلاء أنّ حكم الله وقضاءه على عبده إمّا أنْ يكون لصالحه (نعمة)، وإمّا ضده (بلاء).
استعمل الإمام زين العابدين عليهالسلام تعبيرات مثل: (فیما قَضَی
عَلَیهِ)، (فیما أحَبَّ أو كرِهَ)[1]، (ما قَضَیتَ لي وَعَلَيَّ) . في وصية لقمان لابنه، تم الإشارة إلى أنّ قضاء الله تعالى إمّا أنْ يكون محبوبًا لدى الإنسان (نعمة) وإمّا مكروهًا (بلاء).
وقال الإمام الصادق عليهالسلام في هذا السياق: «اِعلَموا أنَّهُ لَن یُؤمِنَ عَبدٌ مِن عَبیدِهِ حَتّی یَرضی عَنِ اللّهِ فیما صَنَعَ اللّهُ إلَیهِ، وَصَنَعَ بِهِ عَلی ما أحَبَّ وَكرِهَ، وَلَن یَصنَعَ اللّهُ بِمَن صَبَرَ وَرَضِيَ عَنِ اللّهِ إلّا ما هُوَ أهلُهُ، وَهُوَ خَیرٌ لَهُ مِمّا أحَبَّ وَكرِهَ».
وفي حديثٍ آخر منقولٍ عن الإمام علي عليهالسلام قسّم فيه القضاء إلى قسمين: النفع والضرر. قال الإمام عليهالسلام: «إنْ عَقَدتَ أیمَانَك فَارْضَ بِالمَقضِيّ عَلَیك وَلَك، وَلا تَرجُ أحَدًا إلَّا اللّهَ، وَانْتَظِر مَا أتاك بِهِ القَدَرُ».
في جميع الروايات المذكورة، أُشير إلى أنّ القضاء الإلهي إمّا أنْ يكون محبوبًا وإمّا أنْ يكون مكروهًا. إذا وضعنا هذا بجانب تلك الروايات التي ذكرت فيها الكلمات الثلاث (القضاء، البلاء، والنعماء) معًا، يتبين أنّ السعادة في قضاء الله هي حالة (نعماء)،
وأنّ الشقاء في قضاء الله هو حالة (بلاء)؛ لذلك، يمكن القول إنّ القضاء يظهر ويتجسّد في شكلين: البلاء والنعماء.
بناءً على ذلك، فإنّ تقدير الله تعالى قائمٌ على الخير، وعلى هذا الأساس يُفهم الرضا بقضاء الله، والصبر على بلائه، والشكر على نعمه. وقد نقل الإمام الصادق عليهالسلام كلامًا عن الله تعالى يثبت فيه أنّ الرضا، الصبر، والشكر مبنيان على مبدأ (خيريّة القضاء): «عَبدِي المُؤمِنُ لا أصرِفُهُ في شَيءٍ إلّا جَعَلتُهُ خَیرًا لَهُ، فَلیَرضَ بِقَضائي، وَلیَصبِر عَلی بَلائي، وَلیَشكر نَعمائي، أكتُبهُ - یا محمّد - مِنَ الصِّدّیقینَ عِندي».
وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليهالسلام يشير الله تعالى بتفصيلٍ أكبر إلى بعض الأمثلة، ويؤكد أنّ العناوين الثلاثة مبنيةٌ على المبدأ الأساسي نفسه: «یا موسَی بنَ عِمرانَ! ما خَلَقتُ خَلقًا أحَبَّ إلَيَّ مِن عَبدِي المُؤمِنِ، فَإنّي إنَّما أبتَلیهِ لِما هُوَ خَیرٌ لَهُ، وَأُعافیهِ لِما هُوَ خَیرٌ لَهُ، وَأزوي عَنهُ ما هُوَ شَرٌّ لَهُ لِما هُوَ خَیرٌ لَهُ، وَأنَا أعلَمُ بِما یَصلُحُ عَلَیهِ عَبدي، فَلیَصبِر عَلی بَلائي، وَلیَشكر نَعمائي، وَلیَرضَ بِقَضائي، أكتُبهُ في الصِّدّیقینَ عِندي، إذا عَمِلَ بِرِضائي وَأطاعَ أمري».
ما سبق يتعلّق بالتقدير التكويني. أمّا الآن يجب أيضًا دراسة التقدير التشريعي. التشريع يسبب التكليف، بمعنى أنّه عندما
يتم وضع قانون، يصبح مخاطبو هذا القانون مكلّفين بالالتزام به. التكليف، نظرًا لما ينطوي عليه من صعوبات، يُعدّ من الأمور غير المرغوبة. الأمور غير المرغوبة تحتاج إلى الصبر. الصبر يعني (تحمّل المشاقّ والصعوبات والامتناع عن الجزع وفقدان الصبر). موضوع الصبر الأساس هو الأمور غير المرغوبة التي تجعل النفس غير مستقرّة، وتميل إلى الجزع والقلق؛ لذلك، موضوع الصبر يشمل الأمور المكروهة وغير المرغوبة. وهذه الأمور غير المرغوبة تنبع إمّا من متعةٍ يجب تركها، وإمّا من محنةٍ يجب تحملها؛ لهذا السبب، قُسّم الصبر في الروايات الإسلاميّة إلى قسمين:
- الصبر على المحنة.
- الصبر عن اللذّة.
وفقًا للروايات الإسلاميّة، الطاعة تصاحبها المحنة، والمعصية تصاحبها اللذة. لذلك، فإن أداء الطاعة وترك المعصية كلاهما صعب وغير مرغوب. يقول الإمام علي عليهالسلام بعد نقل جملة من النبي صلىاللهعليهوآله: «وَاعْلَموا أنَّهُ ما مِن طاعَةِ اللّهِ شَيءٌ إلّا یَأتي فی كرهٍ، وَما مِن مَعصیَةِ اللّهِ شَیءٌ إلّا یَأتی في شَهوَةٍ».
البُعد الآخر للأمور غير المرغوبة التي يجب تحملها هو
البلاء، كما ذُكر في المناقشة السابقة؛ لذلك، يشمل الصبر على المحنة: الصبر على البلاء والصبر على الطاعة. كما يشمل الصبر عن اللذّة: الصبر عن المعصية. لهذا السبب، ورد في بعض الروايات تقسيم الصبر إلى ثلاثة أنواع.
علاقة التقدير الإلهي بدور الإنسان
رغم أنّ التقدير الإلهي قائم على الخير، إلّا أنّ تحقيق نتائجه يعتمد على رضا الإنسان نفسه بقضاء الله. وهذا قانونٌ آخر من قوانين الحياة؛ لذلك، فإنّ كون التقدير الإلهي خيرًا يُبرر رضا الإنسان، ورضا الإنسان هو مفتاح لجعل التقديرات الإلهية مثمرةً في حياته.
قال الإمام الصادق عليهالسلام: «ما قَضَی اللّهُ لِمُؤمِنٍ قَضاءً فَرَضِيَ بِهِ، إلّا جَعَلَ اللّهُ لَهُ الخِیَرَةَ فیما یَقضي»، كما أوضح النبي صلىاللهعليهوآله هذا الأمر بقوله: «إنَّ اللّهَ تَعالیٰ لَیَبتَلِي العَبدَ بِالرِّزقِ لِیَنظُرَ كیفَ یَعمَلُ؛ فَإنْ رَضِيَ بورِك لَهُ، وَإنْ لَم یَرضَ لَم یُبارَك لَهُ».
في رواياتٍ أخرى، ورد هذا المبدأ في مواقف معينة، وفي حديثٍ آخر نقل عن النبي صلىاللهعليهوآله قول الله تعالى في حديث قدسي: «قالَ اللّهُ (عزّ وجلّ): لَولا أنّي أستَحي مِن عَبدِي المُؤمِنِ، ما
تَرَكتُ عَلَیهِ خِرقَةً یَتَواری بِها، وَإذا أكمَلتُ لَهُ الإیمانَ ابتَلَیتُهُ بِضَعفٍ في قُوَّتِهِ، وَقِلَّةٍ في رِزقِهِ، فَإنْ هُوَ جَزِعَ أعَدتُ عَلَیهِ، وَإنْ صَبَرَ باهَیتُ بِهِ مَلائِكتي».
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أبدى تعجّبه من حال المؤمن، وقال: «عَجَبًا لِأَمرِ المُؤمِنِ، إنَّ أمرَهُ كلَّهُ خَیرٌ، وَلَیسَ ذاك لِأَحَدٍ إلّا لِلمُؤمِنِ، إنْ أصابَتهُ سَرّاءُ شَكرَ فَكانَ خَیرًا لَهُ، وَإنْ أصابَتهُ ضَرّاءُ صَبَرَ فَكانَ خَیرًا لَهُ».
في الحقيقة، كون قضاء الله خيرًا للمؤمن يعود إلى رضا المؤمن في كلّ الأحوال، حتى لو أُخذت حياته.
في جزءٍ آخر من الروايات، تم التصريح بأنّ تأثير المال وفعاليته يعتمدان على شكر النعمة. هذه النقطة ذات أهميةٍ خاصّةٍ في موضوع الرضا. إذا كان المال موجودًا ولكنه فاقدٌ لخاصية التأثير، فإنّ وجوده كعدمه؛ لذا، فإنّ المال لا يكون
مثمرًا إلّا إذا أوصل صاحبه إلى مرحلة الشكر. يصوّر الإمام الصادق عليهالسلام حقيقة الذين أُعطوا المال ولم يشكروا عليه كمن لا يملكون المال. وفي روايةٍ أخرى عنه، عدَّ مثل هذا المال سببًا للابتلاء والمحنة.
يقول الإمام علي عليهالسلام في تعبير جميل: «النَّعمَةُ مِحنَةٌ؛ فَإن شُكرت صارت نعمة، فَإن كُفِرت صارَت نِقمَةً»؛ لذلك، ما يجعل النعمة مفيدةً هو الشكر. من الواضح أنّ النعمة تصبح سببًا للرضا فقط عندما يصل الشخص إلى مرحلة الشكر. لهذا السبب، عندما طلب ثعلبة بن حاطب من النبيّ صلىاللهعليهوآله أنْ يدعو له بالثراء، قال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : «قَلیلٌ تُؤَدّي شُكرَهُ خَیرٌ مِن كثیرٍ لا تُطیقُهُ».
يمكننا القول بأنّ هناك مفهومين: الخير المُقدِّر، والخير المؤثِّر، الخير الذي قدره الله في ظواهر الكون يمكن أنْ يصبح مؤثّرًا، ويجعل الحياة خيرًا في الواقع عندما يكون الإنسان راضيًا عنه. لذلك، رضا الإنسان يعتمد على كون تقديرات الله خيرًا، وتأثير التقديرات الإلهيّة في حياة الإنسان يعتمد على رضاه
عنها.
هذا التفسير مبنيٌّ على التفريق بين مقام (القضاء والقدر)، (مقام الجعل)، و(مقام الرضا)، و(مقام التنفيذ). في مقام الجعل تكون تقديرات الإنسان مبنيةً على الخير. وفي مقام التنفيذ، يصل الإنسان إلى الرضا من خلال التفاعل مع ما تَقرّر في مقام الجعل.
نتيجة لذلك، تصبح التقديرات في حياة الإنسان مصدرًا للخير. العامل الأساس في تحويل هذا الخير، هو ردود فعل الإنسان الإيجابيّة تجاه أنواع التقدير المختلفة. في بعض الروايات، تمّ التصريح بأنّ قضاء الله يشمل كلا البعدين السار وغير السار، وتمّ التأكيد على أنّ الصبر والشكر هما العاملان اللذان يجعلان قضاء الله مثمرًا بالخير. فيما يتعلّق بالبُعد التشريعي، لم يُعثر على نصٍّ صريحٍ يشترط فعاليّة الخير الكامن في التقديرات التشريعية على العمل بالطاعة، ولكن من خلال الاستفادة من المناقشات السابقة ومنطق العقل، يمكن القول إنّ آثار الطاعة تُكتسب فقط عند القيام بها، وإنّ تجنّب أضرار المعصية يتحقّق بتركها. لذلك، ورغم أنّ الخير هو أساس التكليف، فإنّ تحقيق ثماره يعتمد على الامتثال للتكليف.
ذكرت في المصادر الإسلاميّة، الوسائل المادّيّة مثل:
(56)المسكن، ووسيلة النقل، والوظيفة، وغيرها، بوصفها عوامل للسعادة؛ لأنّ الإنسان كائنٌ محتاج، وإحدى جوانب حياته تعتمد على تلبية احتياجاته؛ لهذا السبب، وضع الله تعالى في الطبيعة ما يلبّي احتياجاته.
والأمر الآخر تصنيف الاحتياجات حسب أهميتها للبقاء على قيد الحياة، فكلّما زادت أهمية الحاجة للإنسان وأصبحت أكثر حيوية، سهّل الله الوصول إليها. وكلّما قلت ضرورتها، أصبح الوصول إليها يعتمد على وسائل إضافية. هذا هو قانون العالم. لذلك، أوصى الله تعالى بتوفير وسائل العيش، بل عدَّ ذلك واجبًا.
من منظور الإسلام، المؤمن هو الذي يهتم بأمر دنياه بجانب اهتمامه بآخرته. في القرآن الكريم أمر الله عباده بالسعي وراء
الرزق بعد أداء الصلاة، وأثنى على الذين يفعلون ذلك، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ (الجاثية: 12) لذلك، فإنّ السعي وراء الرزق لا يتعارض مع التدين.
من الواضح أنّ تأمين الرزق يؤدّي دورًا كبيرًا في تحقيق الطمأنينة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا بالعمل والاجتهاد. الرزق لا يتحقّق بمجرد الجلوس والدعاء. عندما لا يُؤمَّن الرزق، يصبح الإنسان مضطربًا، والاضطراب يؤدي إلى السخط؛ لذلك، فإنّ من أبعاد الحياة الطيِّبة، التمتع بمعيشةٍ طيبة. وسنتحدث عن هذا الموضوع بشكلٍ أكثر تفصيلًا في الفصل السابع.
من الجوانب المهمة للحياة العلاقة مع الآخرين؛ لأنّ الإنسان كائن اجتماعي. يوضح القرآن الكريم أنّ فلسفة اختلاف البشر هي التواصل الاجتماعي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).
يقول العلّامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية الكريمة: «إنّ الناس بما هم ناس يساوي بعضهم بعضًا، لا اختلاف بينهم، ولا
فضل لأحدهم على غيره، وإنّ الاختلاف المترائي في الخلقة من حيث الشعوب والقبائل إنّما هو للتوصل به إلى تعارفهم، ليقوم به الاجتماع المنعقد بينهم؛ إذ لا يتمُّ ائتلافٌ ولا تعاونٌ وتعاضدٌ من غير تعرّف، فهذا هو غرض الخلقة من الاختلاف المجعول، لا أنْ تتفاخروا بالأنساب، وتتفاضلوا بأمثال البياض والسواد، فيستعبد بذلك بعضهم بعضًا، ويستخدم إنسان إنسانًا، ويستعلي قومٌ على قومٍ فينجر إلى ظهور الفساد في البر والبحر، وهلاك الحرث والنسل، فينقلب الدواء داءً».
وفي هذا السياق دعا الإمام الصادق عليهالسلام شيعته للتواصل مع أهل الطوائف الأخرى، معللًا ذلك بأنّ الإنسان مضطرٌّ للتواصل مع الآخرين ولا يمكنه الاستغناء عنهم.
في المصادر الدينيّة، يُعدّ وجود علاقةٍ جيدةٍ وإيجابيّةٍ مع الآخرين (بجوانبها المختلفة) من عوامل السعادة. هذا يُظهر أنّ العلاقات مع الآخرين ليست فقط ضرورة، بل هي أيضًا سبب للسعادة. لقد أشارت هذه المصادر إلى أنّ وجود الأسرة الجيدة والجيران والأصدقاء الجيدين، والتعامل الحسن مع المخالفين، يعدّ من مصاديق التعامل مع الآخرين.
فلو كان للإنسان زواج جيد، وله زوجة صالح مؤاتية أمينة، وجميلة مهما أمكن، وله ذرّيّةٌ صالحة، فقد اكتملت إحدى أبعاد سعادته الاجتماعية. وكذلك لو كان له في محيط سكنه جيران صالحون، أو كان مورد اعتماد الناس في المجتمع، وعدّة أصدقاء صلحاء وكرماء، فقد تم
تأمين أبعاد أخرى من سعادته.
لذلك، يُعدُّ التواصل مع الآخرين أحد ضرورات حياة الإنسان، وقد وردت لذلك في المصادر الدينيّة توصياتٌ كثيرةٌ بشأن التواصل مع الآخرين، كما تم تقديم العديد من الإرشادات لتحسين العلاقات وتنظيم التواصل مع مختلف أفراد وفئات المجتمع. هدف هذا القسم من النصوص الإسلاميّة هو تحقيق علاقاتٍ ناجحةٍ ومرضيةٍ، بنحوٍ إذا ابتعد الفرد عن الناس اشتاقوا إليه، وإذا مات ذرفوا الدموع حزنًا عليه، لا أنْ يحمدوا الله على رحيله!. أو على الأقل، أنْ تقلَّ أضرار العلاقة إلى أدنى حد، ويُضبط الاستياء. هذا هو ما أُشير إليه بـ(الرضا الاجتماعي). هذا النمط من العلاقات يتطلب أسلوبًا ومهاراتٍ تم شرحها بالتفصيل في النصوص الدينيّة. وسنتحدث عن هذا الموضوع في الفصل الثامن.
النظام السياسي أوسع نطاقًا من العلاقات الاجتماعية؛ إذ يشمل جميع أركان المجتمع. إنّ وجود النظام السياسي ووجود الحاكم يُعدُّ من ضروريات حياة الإنسان. يُعرف هذا المفهوم في الأدبيات الدينيّة بمصطلح (الولاية والإمامة).
إنّ الإسلام، مع تأكيده على أعلى مراتب الإمامة والقيادة لتحقيق كمال الإنسان والمجتمع الإنساني، يشدّد أيضًا على ضرورة القيادة السياسية حتى في الظروف التي لا تتوفّر فيها القيادة المثالية. والإسلام مع فرضه على المسلمين واجب التمهيد لحكومة الصالحين، لا ينكر أبدًا حاجة المجتمع إلى القيادة السياسيّة. لا يسمح الإسلام للمجتمع الإسلامي بأنْ يغفل عن مسألة القيادة السياسيّة أو أنْ يستسلم للفوضى. جميع الروايات التي تؤكّد على ضرورة وجود القيادة السياسيّة تُشير إلى أنّها أفضل من الفتنة والفوضى.
لذلك، الخطوة الأولى نحو سعادة الإنسان هي وجود نظامٍ سياسي. أمّا الخطوة الثانية والأهم فهي وجود نظامٍ سياسيّ صالحٍ وعادل. الخطوة الأولى هي خطوة تهدف إلى إزالة الاستياء، بينما الخطوة الثانية تُعدّ خطوةً تكامليةً تهدف إلى تحقيق السعادة الحقيقية. ولهذا السبب يعدّ اتّباع النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله، وأهل بيته عليهمالسلام في النصوص الإسلاميّة، من العوامل
الرئيسة لتحقيق السعادة. أمّا مواصفات الحكومة الجيدة، فهو موضوع يتطلّب دراسةً منفصلةً. ما يهمهنا هو أنّ النظام السياسي يُعدّ أحد العوامل المؤثّرة في تحقيق الرضا، وأحد الأبعاد المهمّة للحياة الطيِّبة.
٥. بناء الرضا
في مناقشة بناء الرضا، الهدف هو تحديد مكوّنات وعناصر الرضا. من خلال ما سبق، يتبيّن أنّ الحياة الطيِّبة تتألّف من أربعة أبعادٍ رئيسة: تقديرٍ جيّدٍ يشمل التقديرات السارّة (النِّعَم)، والتقديرات غير السارّة (المصائب والتكاليف)، ومعيشةٍ جيدة، وعلاقاتٍ جيّدةٍ، ونظامٍ جيّد.
النقطة المهمة هنا هي أنّ الأبعاد الأربعة للحياة الطيّبة تنقسم إلى قسمين رئيسين: التقدير الجيد، ومجالات الحياة الطيِّبة.
يعود ذلك إلى أنّ تقديرات الحياة ليست عنصرًا موازيًا للعناصر الأخرى، بل تأتي فوقها وتؤثّر عليها. بمعنى أنّ كلّ مجالٍ من مجالات الحياة يمتلك أبعاد التقدير الثلاثة: فمن جهةٍ يكون في حالة سارّة أو غير سارّة، ومن جهةٍ أخرى، له تكليفه الخاصّ.
لذلك، فإنّ التقدير الإلهي هو حالةٌ شاملةٌ تُلقي بظلالها على جميع الأبعاد المذكورة أعلاه أو الأبعاد المحتملة الأخرى. يمكن القول إنّ الأبعاد الاجتماعية والمعيشية والسياسية للحياة هي أمورٌ يكون للإنسان دورٌ أكبر فيها، مع أنّ كلّ شيءٍ يقع ضمن إرادة الله تعالى، بينما يكون للتقدير دورٌ يتعلّق أكثر بمشيئة الله، مع تأثيرٍ محدودٍ للإنسان فيه.
بناءً على ذلك، قد يكون يكون الدور الأساس لله تعالى في موضوع التقدير، أمّا في الأبعاد الثلاثة الأخرى، يكون الدور الأساس للإنسان. وبمعنى آخر، الإنسان له دورٌ في تحقيق الرضا عن الحياة، وعليه القيام بأعمالٍ معيّنةٍ لكي يحقّق الله له الحياة الطيّبة. أما في موضوع التقدير، فإنّ الله تعالى يقدّر للإنسان أمورًا تتعلّق بأحد الأبعاد الثلاثة، ويجب على الإنسان أنْ يتعامل معها بردّ فعلٍ مناسب. هذا هو تصوير لمواقف الحياة.
المهم بعد ذلك هو أنّ ردود فعل الإنسان في كلّ موقفٍ من هذه المواقف تدخل مفاهيم جديدة في النقاش، (الخير المدرك) يؤثّر على مستويين:
(64)- في المستوى الأوّل، يؤدّي إلى الشعور بالرضا.
- في المستوى الأدنى والأكثر واقعية، يجعل الفرد في الجانب السارّ يرى جميع ما يمتلكه في حياته ويعدّها نعمًا وهدايا من الله فيثمّنها، ثم يشكر الله عليها (الشكر). وفي الجانب غير السارّ، يرى الإنسان الآلام ومصاعب المصيبة والتكليف في مصلحته ويصبر عليها، ممّا يؤدّي إلى تحقّق (الصبر).
والمحور المهم الآخر هو أنّه في مناقشة الحياة الطيِّبة هناك مقامان: أحدهما مقام (التقدير)، والآخر مقام (التحقّق). مقام التقدير يختلف عن مقام التحقّق. الله سبحانه وتعالى يقدّر كلّ شيء، وهو ما نطلق عليه (الخير المقدّر)، ولكن ليس كلّ ما يقدّره الله يتحقّق في حياة الإنسان. تحقّق ذلك مشروط (تقدير مشروط)، وشرطه هو استجابة الإنسان المناسبة. وعليه فإنّنا في مناقشة الحياة الطيّبة، أمام ثلاث مراحل: التقدير، والاستجابة، والتحقّق. نوع استجابة الإنسان هو الذي يحدّد تحقّق الخير أو عدمه. الاستجابة المناسبة تؤدّي إلى تحقق التقدير وهو ما نطلق عليه الخير المؤثّر، والاستجابة غير المناسبة تؤدّي إلى عدم تحقّقه.
الاستجابة المناسبة للخير المقدّر عمليّةٌ معقّدةٌ ولها أنواعٌ متعدّدة. أحد هذه الأنواع هو الاستجابة النفسيّة للتقدير. هذه الاستجابة لها مستويان: المستوى الأوّل هو الاستجابة العامّة تجاه تقدير الله، والمستوى الثاني هو الاستجابة المتعلّقة
(65)بالمواقف الثنائيّة (السارّة وغير السارّة). الاستجابة العامّة هي الرضا، والاستجابات المتعلّقة بالمواقف هي الشكر والصبر، كما أُشير إليها سابقًا.
ما يفسّر تقسيم الاستجابة النفسية إلى مستويين هو نوع العلاقة بين القضاء والقدر وأبعادهما الأربعة. هناك تقديرٌ عامٌ يظهر في شكلين: السارّ وغير السارّ. هذا النوع من التقدير يؤدّي إلى نوعين من التقييم. عندما يتمّ تقييم الخير المقدّر ككل، من دون النظر إلى تفاصيل الأبعاد، يحدث الرضا عن التقدير. وعندما يتم تقييم أبعاده الثنائية، ينشأ الشكر في الجوانب السارّة والصبر في الجوانب غير السارّة.
النوع الآخر من الاستجابة هو الاستجابة العمليّة، وهي جزءٌ آخر يحدّد بناء الرضا. في تصميم الله تعالى، بالإضافة إلى التقدير، هناك دورٌ للاستجابة العمليّة وجهود الإنسان ضمن عملية تحقيق الحياة الطيِّبة. بناءً على ذلك، يجب على الإنسان أنْ يسعى لتأمين الحياة الطيِّبة التي قُدرت له، أو بعبارةٍ أخرى أنْ يبنيها. السبب في ذلك أنّ الله يقدر، والإنسان يجب أنْ يسعى للوصول إلى ما قُدِّر له. بعبارةٍ أخرى، في مجال التقدير الإلهي، الأمر المهمّ هو أن نؤمن بخيريته ونقبله -كما تمّ توضيحه سابقًا- ولكن عندما ننتقل إلى مجالات الحياة، إلى جانب التقدير، يُطرح دور الفرد في تحقيق الخير، بمعنى أنّه يجب عليه أنْ يسعى في إطار إرادة الله لبناء حياةٍ طيِّبة. من خلال ضرب
(66)التقدير الجيّد في البناء الجيّد، تتحقّق الحياة الطيِّبة.
إزاء تقدير الله، هناك نوعان من الاستجابة لدى الإنسان: الأولى هي الاستجابة النفسيّة (الرضا، والشكر، والصبر)، والثانية هي الاستجابة العمليّة (السعي لبناء الحياة الطيِّبة). عندما يتحقّق هذا الأمر، يتحوّل الخير المقدَّر إلى خيرٍ مؤثّر، ويؤدّي الخير المؤثّر إلى تشكيل حياةٍ طيِّبة، ممّا يثمر في النهاية عن رضا ثانوي عن الحياة. الرضا الأوّل هو الرضا عن التقدير الخير، والرضا الثاني هو الرضا عن تحقّق الخير (الحياة الطيِّبة).
بناءً على ما سبق، إذا أراد الخير المقدَّر أنْ يتحقّق في الحياة ويشكل حياةً طيِّبةً قائمةً على الخير، فإنّه يعتمد من جهة على: الرضا العامّ عن التقدير، والشكر في الحالات السارّة، والصبر في الحالات غير السارّة، ومن جهةٍ أخرى، يعتمد على: بناء الحياة. ثم إنّ تحقّق الحياة الطيّبة يُنتج أيضًا رضًا ثانويًّا عن الحياة.
(67)
إنّ السعي وراء السعادة والهناء هو الهدف النهائي للإنسان، وتحقيق أيّ هدفٍ آخر ليس إلّا وسيلة للوصول إلى هذا الغاية. تتكون السعادة من بعدين:
البُعد العاطفي: ويتضمّن المشاعر الإيجابيّة الكثيرة، والمشاعر السلبيّة القليلة.
البُعد المعرفي: الذي يشير عادةً إلى الرضا عن الحياة.
من المهمّ التمييز بين الرضا عن الحياة والسعادة، إذ يُنظر إلى الرضا عن الحياة في علم النفس كأمرٍ معرفيّ وتقييميّ ينتج عن مقارنة بين الطموحات والإنجازات. كلما قلّت الفجوة بين الطموحات والواقع الحالي، زاد الشعور بالرضا، والعكس صحيح.
أمّا في الثقافة الإسلاميّة، فإنّ الرضا يتكوّن من:
1. التطابق: أي توافق الوضع الحالي مع الوضع المتوقّع.
2. القبول: أي قبول الوضع والتسليم به.
3. الرضا: أي الشعور بالسعادة، أو على الأقل عدم الشعور بعدم الرضا.
تشير الدراسات إلى أنّ (الخير المدرَك) هو الأساس النظري للرضا في الإسلام. وهذا يعني أنّ اعتماد الحياة على الخير
الحقيقي يشكّل أساس الرضا. وهذا يشير إلى أنّ النظام النفسي للإنسان مصمّمٌ بطريقةٍ تجعله يستجيب بالرضا للخير المدرَك. ومن ثَمَّ إذا قيّم الإنسان حياته على أنّها جيدة، فإنّه يحقّق الشعور بالرضا في نفسه.
من منظور الإسلام، لا يُنظر إلى الرضا بوصفه ظاهرةً نفسيّةً بحتة؛ بل بوصفه ظاهرةً نفسيّةً مرتبطةً بالواقع. نُطلق على هذا (الرضا الواقعي). في هذه النظريّة، الرضا الصحيح هو الذي يتطابق مع الحقائق، وأيّ رضا لا يمتلك هذا التوافق ليس رضًا صحيحًا؛ بل هو مجرد شعورٍ غير مستقرٍّ ومضلّلٍ قد يؤدّي بالإنسان لاحقًا إلى الفشل والانهيار.
إذا أردنا رؤية الرضا بشكلٍ ملموسٍ في الحياة، يجب أنْ ننظر إلى أبعاد الحياة الطيِّبة والخير فيها. تشمل هذه الأبعاد أربعة أمور:
التقدير: الأحداث السارّة (النعمة) وغير السارّة (المصيبة) في الحياة، بالإضافة إلى التكاليف التي تكون نتيجتها الطاعة أو المعصية.
المعيشة: الجانب الاقتصادي للحياة.
العلاقات: التواصل والتفاعل مع الآخرين.
السياسة: النظام السياسي والاجتماعي السائد في المجتمع.
بالتالي، الحياة الطيِّبة هي مزيجٌ من التقدير الجيّد، والعلاقات
(69)الجيّدة، والمعيشة الجيّدة، والنظام الجيّد.
يتّضح ممّا سبق أنّ الخير المدرَك يجلب الرضا، بينما الشر يسبّب السخط. إذا عدَّ الإنسانُ شيئًا شرًّا، فإنّه يشعر بعدم الرضا عنه، وإذا عدّه خيرًا، فإنّه يرضى به. ومن ثَمّ، فإنّ الخير هو الأساس النظري للرضا، وامتلاك الحياة الطيِّبة هو العامل الرئيس له.
هذه القاعدة تنطبق على المجالات الثلاثة للحياة:
1. مجال المعيشة.
2. مجال العلاقات الاجتماعيّة.
3. مجال النظام السياسي.
ما يهمّ هو أنّ الخير يجلب الرضا، وهذا الخير قد يكون في تقدير الله الشامل أو في المجالات المعيشة، أو مجالات العلاقات الاجتماعيّة، أو المجالات السياسيّة.
في مجال التقدير الإلهي، يجب أنْ نؤمن بخيريّة التقدير ونقبله. ولكن عند الانتقال إلى مجالات الحياة، يصبح دور الفرد في تحقيق الخير أمرًا أساسيًّا، ممّا يعني أنّه يجب أنْ يسعى في إطار إرادة الله لبناء حياةٍ طيِّبة. هذا الموضوع سيتمّ تناوله في مناقشة عوامل الرضا.
في التعريف السابق، تبيّن أنّ الرضا يتكوّن من ثلاثة عناصر: المطابقة، والقبول، والسرور. كما أُشير إلى أنّ الأساس النظريّ للرضا هو (الخير المُدرَك). بناءً على ذلك، يمكن القول إنّ استراتيجيّات الرضا تشمل: الانطباق، والخير، والقبول، والسرور. في هذا الفصل والفصل التالي، سنتناول استراتيجيّة الخير، وفي الفصول اللاحقة سنناقش الاستراتيجيّات الأخرى.
كما ذُكر سابقًا، تُظهر الدراسات أنّ الخير المُدرَك هو أساس الرضا في الإسلام؛ أي أنّ اعتماد الحياة على الخير الحقيقي هو العامل الأساسي للرضا. هذه القاعدة تنطبق على المجالات الثلاثة للحياة، بمعنى أنّ إدراك الخير يوجب الرضا بنحوٍ عام، سواء أكان في تقدير الله أم في نطاق المعيشة، أم نطاق العلاقات الاجتماعيّة والنظام السياسي.
في مجال التقدير الإلهي، المهم هو أنْ نؤمن بـخيريّة هذا التقدير ونقبله. ولكن عندما ننتقل إلى مجالات الحياة، تتغير القضية. أوّلًا، بجانب التقدير، يظهر دور الفرد في تحقيق الخير؛ بمعنى أنّه يجب عليه السعي لبناء حياةٍ طيِّبةٍ ضمن إطار إرادة
(72)الله. في هذه الحالة، (التقدير الجيِّد مع البناء الجيِّد) تتحقّق حياةٌ طيِّبة، وعلى الفرد أنْ يدركها ويؤمن بها للوصول إلى الرضا.
بعبارةٍ أخرى، في جانب التقدير، يجب أنْ يكون لدينا إيمانٌ بخيريّة التقدير. أمّا في جانب أبعاد الحياة، فعلينا أنْ نبني حياةً طيِّبة. ثانيًا، يجب أنْ يمتلك الفرد القدرة على اكتشاف وتحديد الخير الموجود في حياته. بعبارةٍ أخرى، في جانب التقدير، يجب أنْ نؤمن بخيريّة التقدير، وهو ما نسمّيه الإيمان بالخير. أمّا في جانب أبعاد الحياة، فمن جهة علينا أنْ نبني حياةً طيِّبةً وهو ما نسمّيه (تحقيق الخير)، ومن جهة أخرى علينا أنْ نتعرّف على الخير الموجود وهو ما نسميه (اكتشاف الخير). بناءً على ذلك، فإنّ الرضا هو مزيجٌ من الإيمان بالخير، وتحقيق الخير، واكتشاف الخير.
فعاليّة هذه المبادئ الثلاثة تتطلّب ثلاثة أمورٍ أساسيّة:
1. معرفة الخير.
2. معرفة الحوائج.
3. النزعة نحو الخير في التقييم.
من دون التعرّف على الخير الحقيقي والتمييز بينه وبين الخير الوهمي، ومن دون وجود قائمةٍ حقيقيّةٍ بالحوائج اللازمة لحياةٍ ناجحة، لن يتمكن الإنسان من تحقيق الإيمان بالخير أو اكتشافه
أو تحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، لمّا كان الرضا في حقيقته حكمًا وتقويمًا للحياة، فيجب أن يكون نموذج هذا الحكم قائمًا على النزعة نحو الخير؛ لذلك، فإنّ معرفة الخير، ومعرفة الحوائج، والنزعة نحو الخير في التقييم، هي متطلّباتٌ أساسيّةٌ للرضا.
الآن نناقش هذه المتطلّبات الثلاثة:
للوصول إلى الرضا، نحتاج إلى معرفة مصاديق الخير بنحوٍ ملموس. يجب أنْ يعرف الفرد ما هو الخير في حياته حتى يتمكن من تقييم حياته بناءً عليه أو السعي لتحقيقه. من بين القدرات اللازمة لتحقيق الرضا، القدرة على التعرّف على الخير وتمييزه عن الشرّ، وهي إحدى الميزات التي تميز الإنسان عن الحيوان؛ لذلك، فإنّ إحدى مهام النصوص الدينيّة هي تعريف الخير والشر. ولأنّ الوحي مطلع على المصالح والمفاسد الحقيقية للإنسان، فهو أفضل وأوثق مصدرٍ لمعرفة الخير.
خُصّصت بعض النصوص الدينيّة لهذا الموضوع. قدَّم الله تعالى والمعصومون عليهمالسلام معلوماتٍ شاملةً حول الخير وأبعاده المختلفة. جمع كتاب (الخير والبركة في القرآن والحديث)
الروايات حول هذا الموضوع وصنّفها بشكلٍ ملائم. كما أنّ النصوص الدينيّة الأخرى تتناول أبعاد الخير في التقديرات التكوينيّة والتشريعيّة لله. من هنا، فإنّ القرآن والحديث هما مصدران أساسيّان لمعرفة الخير؛ لذلك، يجب أن يستعين الإنسان بالنصوص الدينيّة لاكتشاف الخير.
مع ذلك، يجب أنْ نلاحظ أنّ الثروة والممتلكات، مع كونها إحدى مصاديق الخير بلا شك، فهي ليست كلّ الخير ولا أعظمه قيمة. عندما سُئل الإمام علي عليهالسلام عن ماهية الخير، قال: «لَيسَ الخَيرُ أنْ يكثُرَ مالُك ووَلَدُك، ولٰكنَّ الخَيرَ أنْ يكثُرَ عِلمُك، وأنْ يعظُمَ حِلمُك، وأنْ تُباهِي النّاسَ بِعِبادَةِ رَبِّك، فَإنْ أحسَنتَ حَمِدتَ اللَّهَ، وإنْ أسَأتَ استَغفَرتَ اللَّهَ».
في هذه الرواية، ذُكِرت أمور مثل: العلم، والحلم، وعبادة الله، وحمد الله، والاستغفار لله بوصفها مصاديق للخير، ممّا يدلّ على أنّ حصر الخير في الأمور المادية هو خطأ، وأحد أسباب عدم الرضا. ومن ثَمّ، فإنّ أحد الطرق الفعّالة لتحقيق الرضا هو التعرّف على موارد الخير ومصاديقه، التي سنناقشها باختصار فيما يأتي:
في بعض الروايات، ورد ذكر أمور بوصفها خير الدنيا والآخرة، وأهمّها:
- لسانٌ ذاكرٌ لله، وذكرٌ مخصوصٌ لأغراضٍ معيّنة.
- قلبٌ شاكرٌ وخاشع، وجسدٌ صابرٌ على البلاء، وزوجةٌ أمينةٌ على العرض والمال.
- التوكّل على الله.
بعض هذه الأمور وردت تحت مصطلح (جوامع الخير)، وهي صفاتٌ إذا تحلّى بها الإنسان، فإنّه يحقّق باقي القيم الأخلاقيّة والعمليّة. وأهمّها:
عبادة الله، وجزاء الأعمال، وإجابة الدعاء من الله، وحبّ الخير للآخرين كما يحبّه لنفسه، وخشية الله، والحبّ والبغض لأجل الله، ومعرفة أهل البيت (عليهم السلام وولايتهم)، والإحسان. والقيام بالأعمال الباقية والابتعاد عن الأمور الزائلة، وحبّ الإسلام والمسلمين والفقراء ومجالستهم، وعدم اليأس من الأشرار (لعلهم يصبحون صالحين)، وعدم الأمن من الأخيار (لعلهم ينحرفون)، والامتناع عن الانشغال بعيوب الآخرين، والعبرة، والصمت المتأمل،
والكلام الذي يذكّر بالله، واستشارة الناصحين، وإيصال النعمة للآخرين، والوفاء بالعهود، وصلة الرحم، ومعرفة النفس، ضبط النفس، وقطع الأمل عن الناس، وإدخال السرور على المؤمنين.
ربما يمكن جمع هذه الأمور كلّها تحت مفهوم (التديّن). فقد ورد عن الإمام علي عليهالسلام أنّ من كان متدينًا، فقد رزق خير الدنيا والآخرة، وهذا لأنّ جميع هذه الأمور أو غيرها ممّا لم يُذكر، قد وردت في معارف الدين. بناءً على ذلك، إذا عمل الإنسان بالدين حقًا، فإنّه يحقّق جميع هذه الأمور.
المهم هو أنّ الخير ليس محصورًا في الأمور المادّيّة
والحسّيّة، بل يشمل طيفًا واسعًا من الأمور. بناءً على ذلك، في نظريّة الخير المُدرَك، فإنّ الخير له مفهوم ومصاديق واسعة، والاهتمام به يمكن أن يبعث شعور الرضا.
للوصول إلى الرضا في الحياة، يحتاج الإنسان إلى موارد متعددة، ولكن تحديد ماهية هذه الموارد هو مسألةٌ حاسمة، إذ إنّ الخطأ في هذا التحديد يؤدّي إلى الشعور بعدم الرضا. إنّ قائمة النعم هي العنصر الذي من خلاله يتمّ قياس مدى التمتّع أو الحرمان، كما أنّها تحدّد اتّجاه الجهد والنشاط البشري.
بعض الأشخاص يرون أنّ ما يمتلكونه في الحياة يقتصر على الأمور المادّيّة؛ ولذلك فإنّ معيار تقييمهم وقياسهم يعتمد على امتلاك أو عدم امتلاك الموارد المادّيّة. بناءً على ذلك، عندما تنقص الموارد المادّيّة، فإنّهم لا يأخذون في الاعتبار الموارد غير المادّيّة، ممّا يجعلهم يشعرون بأنّهم محرومون. لكن في الواقع، عندما يتمّ تقييم الموارد وفقًا لمقياس الإنسان، تظهر أيضًا مصاديق غير مادّيّة؛ لذا، مع وجود الموارد غير المادّيّة، لا يمكن الشعور بالحرمان وعدم الرضا بنحوٍ كامل. كما أنّه لا يمكن تجاهل تأمين هذا الجزء من الموارد؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى الشعور بعدم الرضا الحقيقي. بناءً على ذلك، فإنّ أحد عوامل الرضا هو تصحيح قائمة الموارد استنادًا إلى الحقائق الإنسانيّة.
نظرًا لأنّ الإنسان يمتلك بُعدًا غير مادّي، وهدفًا يتجاوز التمتع الدنيوي، فإنّ ما يمتلكه يشمل أيضًا أمورًا غير مادّيّة. الحقيقة هي أنّ حياة الإنسان -لا سيّما المؤمن- ليست فارغة. هناك العديد من النعم في حياة الإنسان التي يمكن أنْ تجلب له شعورًا بالسعادة، لكنّها تظلّ غير معروفةٍ؛ ولذا لا تؤثّر في حياته.
مع أنّ الدين يعدّ الأمور المادّيّة جزءًا من الموارد اللازمة للحياة، فإنّه يرفض حصر الموارد في هذه الأمور؛ ذلك لأنّ الحديث هنا عن الإنسان، وليس عن الجمادات أو النباتات أو الحيوانات. بناءً على ذلك، فإنّ ما يمتلكه الإنسان ويحتاجه في حياته يتم تعريفه بناءً على ماهيته. ومن جهةٍ أخرى، لا ينبغي التوقّف عند المادّيّات فحسب وإهمال الأمور غير المادّيّة في مجال توفير الموارد.
المقصود بالمصاديق هو الموارد اللازمة لتحقيق الرضا. الحياة تحتاج إلى أمور (احتياجات)، يتم من خلالها تحقيقها (الموارد). بناءً على ذلك، ما يمتلكه الفرد من هذه الموارد يُسمّى (حوائج الحياة). ولكن السؤال الأوّل هنا هو: في أيّ مجالاتٍ يجب البحث عن حوائج الإنسان؟ وما هي الأمور التي تُعدّ حوائج بالنسبة للإنسان؟ هذه من أهمّ القضايا في تحقيق الرضا.
هناك من يشعرون بعدم الرضا الزائف؛ لأنّهم لا يدركون ما الذي يُعدّ جزءًا من حوائج الإنسان، وما الذي يمتلكونه بالفعل. وهناك أيضًا من يشعرون بالرضا الزائف؛ لأنّهم لا يعلمون ما الذي يُعدّ من الحوائج وما الذي يفتقرون إليه. إذا تمّ توعية
(80)الناس بأنواع الأمور التي يمتلكونها، سيتم القضاء على مشاعر الرضا وعدم الرضا الزائفة. لذلك، فإنّ إعادة اكتشاف حوائج حياة الإنسان تؤدّي دورًا مهمًّا في تحقيق الرضا الصادق.
فيما يتعلّق بحوائج الحياة، هناك نصوصٌ كثيرةٌ وردت بمصطلحاتٍ مختلفة، تشمل هذه الكلمات المفتاحيّة: نعمة، سعادة، عيشة، راحة، وغنى. بسبب كثرة الروايات وتداخل المواضيع، سنبدأ أوّلًا بتحليل الروايات المتعلّقة بكلّ مصطلح، ثمّ نقوم بتصنيفها.
جزءٌ من هذه النصوص يجب البحث عنه في الروايات المتعلّقة بـالنعمة. وقد بيّن القرآن الكريم بأنّ الله أعطى الإنسان كلّ ما طلبه، وأنّ نعمه لا تُحصى، ومع ذلك فإنّ الإنسان ظالمٌ وجاحد، لكنّ الله غفورٌ ورحيم؛ ولهذا السبب، يشكر الإمام علي عليهالسلام اللهَ الذي يعجز المتحدّثون عن مدحه، ويعجز الحاسبون عن عدّ نعمه، لذا أشار الإمام علي عليهالسلام إلى كميل بن زياد بقوله: «يا كمَيلُ! إنّهُ لا تَخلو مِن نِعمَةِ اللّهِ (عزّ وجلّ) عِندَك
وعافِيتِهِ، فلا تَخلُ مِن تَحميدِهِ وتَمجيدِهِ وتَسبيحِهِ وتَقديسِهِ وشُكرِهِ وذِكرِهِ عَلىٰ كلِّ حالٍ».
وذات يوم سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمير المؤمنين عليهالسلام: «ما أوّل نعمة بلاك الله (عز وجل)، وأنعم عليك بها؟ قال: أن خلقني جلّ ثناؤه. ولم أكُ شيئًا مذكورًا. قال: صدقت».
وقد ذكّر الله (عزَّ وجلَّ) في القرآن الكريم بنعمه الظاهرة والباطنة. في تفسير هذه الآية، تحدّث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الإسلام، والخَلْق الحسن والمنسجم للإنسان، وكذلك عن الرزق بوصفه نعمةً ظاهرة، وعن ستر العيوب وعدم الفضيحة أمام الناس بوصفه نعمةً باطنة.
الإمام الباقرعليهالسلام وصف النعمة الظاهرة بالتوحيد ومعرفة
الله، والنعمة الباطنة بولاية أهل البيت عليهمالسلام. والإمام الكاظم عليهالسلام أشار إلى أنّ النعمة الظاهرة هي الإمام الحاضر، والنعمة الباطنة هي الإمام الغائب.
كما تحدّث الإمام علي عليهالسلام عن حسن الخلق، واجتناب المعصية، وألفة الناس بعضهم مع بعض كنعمة. وفي روايةٍ أخرى، وذكرت النعم الآتية في ترتيب تصاعدي: المال، والصحّة، وتقوى القلب.
وأيضًا، أشار الإمام الصادق عليهالسلام إلى التوحيد في محبّة الله بوصفه أعظم نعمة. وفي رواياتٍ أخرى، وُصِفت الصحّة، والفراغ، والأمن بأنّها نعم منسية. وفي روايةٍ عن الإمام علي عليهالسلام ، ذُكر أنّ المصائب التي يُصرفها الله عن الإنسان قبل وقوعها تعدّ نعمة أيضًا بالإضافة إلى ما يمنحه الله من عطايا وما يستره من أخطاء.
ورد في الأدعية المأثورة عن المعصومين عليهمالسلام جزءٌ مهمٌّ من النعم، وشمولية هذه الأدعية دفعتنا لتخصيصها ببحثٍ مستقلّ:
دعاء كميل
في دعاء كميل: «اللّٰهُمَّ ومَولاي، كم مِن قَبيحٍ سَتَرتَهُ، وكم مِن فادِحٍ مِنَ البَلاءِ أَقَلتَهُ، وكم مِن عِثارٍ وَقَيتَهُ، وكم مِن مَكروهٍ دَفَعتَهُ، وكم مِن ثَناءٍ جَميلٍ لَستُ أهلًا لَهُ نَشَرتَهُ».
دعاء الجوشن الصغير
دعاء الجوشن الصغير هو دعاء ورد عن الإمام الكاظم عليهالسلام يتعلّق بموضوع الشكر، ويحتوي هذا الدعاء على مقاطع متعددةٍ كلّما يذكر فيها الإمام نعمةً من نعم الله، يقول:
«فَلَكَ الحَمدُ يا رَبِّ مِن مُقتَدِرٍ لا يُغلَبُ وذي أنَاةٍ لا يَعجَلُ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، واجعَلني لِنَعَمائِكَ مِنَ الشّاكِرِينَ، ولِآلائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ».
المقاطع البارزة في الدعاء:
-في المقاطع الأولى حتى الثالثة، يشير الإمام عليهالسلام إلى الأعداء المتربصين وأصحاب الحيلة والحاسدين الذين ردّ الله شرّهم عليهم.
- في المقطع الرابع، يتحدّث الإمام عليهالسلام عن الكروب التي انهمرت كالمطر، والتي أزالها الله وألبسه لباس العافية.
- في المقطع الخامس، يشيرعليهالسلام إلى تحقّق حسن الظنّ بالله ونعمه التي لا تنتهي رغم عصياننا له.
- في المقطعين السادس والسابع، يقارن حاله بمن يقتربون من الموت أو يعانون من الأمراض، وهو في عافيةٍ وصحة.
- في المقاطع من الثامن إلى الثاني عشر، يقارن حاله بمن
(85)يعانون من الخوف، أو النفي، أو المعارك، أو الكوارث الطبيعية، بينما هو في أمان.
- في المقطع الثالث عشر، يقارن حاله بالفقراء والمحتاجين، وهو في رفاه وكرامة.
- في المقطع الرابع عشر، يقارن حاله بمن يعانون من العلل والإعاقات، وهو سالم بفضل الله.
- في المقطع الخامس عشر، يشير إلى المحتضرين الذين لا يملكون التحكّم بمصيرهم، بينما هو في راحةٍ بلطف الله.
- في المقطع السادس عشر، يقارن حاله بالمعتقلين الذين يعانون من السجن والتعذيب، بينما هو في حرية.
- في المقطع السابع عشر، يشير إلى الأسرى الذين يرزحون تحت قيود الأعداء بعيدًا عن أهلهم، بينما هو في حرية.
وفي نهاية الدعاء، يطلب من الله أنْ يغفر له ذنوبه ويقضي حاجاته.
دعاء يوم عرفة
1- في دعاء يوم عرفة، يذكر الإمام الحسين عليهالسلام نعم الله بشكلٍ مفصّل، ومن بينها:
2- عندما كنت عدمًا، منحني الله نعمة الوجود.
3- خلقني من التراب، ثم حفظني في أصلاب الآباء من تقلبات الزمان والمصائب.
4- بسبب رأفته بي، لم يخلقني في زمن أئمّة الكفر، بل في عهد خاتم النبيّين.
5- أكرمني بنعمة الوجود وخلقني من نطفة، وأعطاني الحياة في رحم أمي بين اللحم والدم.
6- أخرجني إلى الدنيا بخلقٍ متكاملٍ، وأوصلني إلى درجات المعرفة.
7- حفظني عندما كنت طفلًا عاجزًا، ورزقني لبنًا طيِّبًا.
8- جعل قلوب من حولي تمتلئ بالحنان والرعاية لي.
9- صانني من الجن والشياطين بعطف الأمهات ورعايتهن.
10- أنعم عليّ بجسمٍ كاملٍ وخالٍ من العيوب.
11- علّمني الكلام، وأكمل نعمه عليّ عامًا بعد عام.
12- بلغني الكمال الجسدي والذهني، وألهمني معرفته في قلبي.
13- جعلني أنظر إلى روائع خلقه في السماوات والأرض.
14-ذكَّرني بذكره، وشكر نعمه التي لا تُحصى.
15- رضيتَ لي طاعتك وعبادتك، ومنحتني فهم العلوم والحقائق التي جاء بها أنبياؤك عبر الوحي.
16- وهبتني روحًا عظيمةً لفهم وقبول الحقائق، وسهّلت لي بسعة صدرك الوصول إلى مقام الرضا والتسليم، وكنتَ في جميع هذه النعم مُعينًا ومنَّانًا.
17- وبعد أنْ خلقتني من أفضل التراب، لم تكتفِ بإراحة نفسي بنعمةٍ واحدة، بل أنعمت عليَّ بنعم لا تُحصى.
18- رزقتني كلّ أنواع الطعام واللباس والأدوات اللازمة للحياة، وهذا كلّه كان فقط من جودك اللامحدود وإحسانك العظيم.
19- مع أنّك أكملت نعمك عَلَيَّ، وأزلت كلّ مصيبة وبلاء عني، إلا أنّ جهلي وجرأتي لم يمنعاك من إرشادي وتقريبي إلى مقام قربك بإبعاد كلّ ما يجلب غضبك.
20- على الرغم من جرأتي وذنوبي، كنت تستجيب لي كلما دعوتك، وتمنحني كلّ ما أطلبه منك، وتعطيني جزاءً كاملًا عندما أطيعك.
21- إذا شكرتك زدتَ في نعمتك، وهذا الإحسان كلّه لتكمل نعمك عَلَيّ:
22- «فَسُبحانَكَ سُبحانَكَ مِن مُبدِئٍ مُعِیدٍ حَمِیدٍ مَجِیدٍ،
وَتَقَدَّسَت أسماؤُكَ وَعَظُمَت آلاؤكَ. فَأيّ نِعَمِكَ یا إلٰهِي أُحصِي عَدَدًا وَذِكرًا، أم أيّ عَطایاكَ أقومُ بِها شُكرًا! وَهِي یا رَبِّ أَكثَرُ (أكبَرُ) مِن أَنْ یُحصِیَها العادُّونَ أو یَبلُغَ عِلمًا بِها الحافِظونَ».
23- يا ربِّ! إنّ المصائب التي صرفتها عني برحمتك أكثر من كلّ النعم والعافية التي أراها ظاهرًا.
دعاء أبي حمزة الثمالي
دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء علّمه الإمام زين العابدين علیه السلام لأبي حمزة. في هذا الدعاء، تُذكر نعم الله تعالى غالبًا في مواضع ترد فيها عبارة «الحَمدُ لله» ومنها:
«الحَمدُ لِلهِ الَّذِي أدعوهُ فَیُجِیبُنِي، وإنْ كنتُ بَطیئًا حینَ یَدعونِي».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذِي أسأَلُهُ فَیُعطینِي، وإنْ كنتُ بَخِیلًا حِینَ یَستَقرِضُنِي».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذي اُنادِیهِ كلَّما شِئتُ لِحاجَتي، وأخلو بِهِ حَیثُ شِئتُ لِسِرّي بِغَیرِ شَفیعٍ فَیَقضِی لي حاجَتي».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذِي لا أدعو غَیرَهُ، ولَو دَعَوتُ غَیرَهُ لَم یَستَجِب لي دُعائي».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذي لا أرجو غَیرَهُ، ولَو رَجَوتُ غَیرَهُ لَأَخلَفَ رَجائي».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذي وَكلَني إلَیهِ فَأَكرَمَنِی، ولَم یَكلني إلَى النّاسِ فَیُهینوني».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذي تَحَبَّبَ إلَيّ وهُوَ غَنِيٌّ عَنّي».
«والحَمدُ لِلهِ الَّذي یَحلُمُ عَنِّي حَتّىٰ كأَنّي لا ذَنبَ لي، فَرَبِّي أحمَدُ شَيءٍ عِندِي وأحَقُّ بِحَمدي».
«فَلَوِ اطَّلَعَ الیَومَ عَلىٰ ذَنبِي غَیرُك ما فَعَلتُهُ، ولَو خِفتُ تَعجیلَ العُقوبَةِ لاجتَنَبتُهُ، لا لِأَنَّك أهوَنُ النّاظِرینَ (إلَيّ)، وأخَفُّ المُطَّلِعینَ (عَلَيَّ)، بَل لِأَنَّك یا رَبِّ خَیرُ الساتِرینَ، وأحكمُ الحاكمینَ (وأحلَمُ الأَحلَمِینَ)، وأكرَمُ الأَكرَمِینَ، سَتَّارُ العُیوبِ غَفّارُ الذُّنوبِ عَلّامُ الغُیوبِ، تَستُرُ الذَّنبَ بِكرَمِك وتُؤَخِّرُ العُقوبَةِ بِحِلمِك، فَلَك الحَمدُ عَلیٰ حِلمِك بَعدَ عِلمِك، وعَلىٰ عَفوِك بَعدَ قُدرَتِك».
«تُصِیبُ بِرَحمَتِك مَن تَشَاءُ وتَهدي بِكرامَتِك مَن تُحِبُّ، فَلَك الحَمدُ عَلى ما نَقَّیتَ مِنَ الشِّرك قَلبي».
«ولَك الحَمدُ عَلَى بَسطِ لِسانِي»
وغيرها...
(90)ما ذكر أعلاه هو نماذج من النعم التي وردت في الأدعية، ومع مراجعة أدعية أخرى يمكن تحديد المزيد من هذه النعم.
في روايات السعادة، وردت أمورٌ أخرى ذُكرت كعوامل للسعادة. فقد أشار النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الزواج[1]، والولد الصالح، والتشابه مع الأب، والمركب كعوامل للسعادة.
في بعض الأحاديث، تمّ تفصيل صفات عوامل السعادة، مما يُظهر أنّ هذه الأمور من دون هذه الصفات قد لا تكون نعمةً مكتملة، أو على الأقل قد تكون نعمةً غير مؤكدة. في حديث، أشار النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الزوجة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب السريع، والولد الصالح بوصفها أسبابًا للسعادة في الدنيا. وفي حديثٍ آخر، أشار إلى التشابه مع الأب، والجمال والدين كصفات للولد والزوجة.
وفي روايةٍ أخرى، عَدّ النبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الزوجة التي يكون النظر إليها باعثًا على السرور، والأمينة على العرض والمال في غياب زوجها، من أسباب السعادة. وعدّ المركب الذي يسير بسرعة ويوصل الإنسان إلى أصحابه، والبيت الواسع المريح من أسباب السعادة أيضًا.
وفي روايةٍ أخرى، أُضيف إلى المسكن والمركب، الجار الصالح. وفي حديثٍ آخر، ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة أمور كان اثنان منها جديدين وهما: الأصدقاء الصالحون، والعمل في الوطن. كما أضاف صفة الانسجام والتوافق للزوجة. وفي روايةٍ أخرى، أضاف محبّة آل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى هذه العوامل الأربعة.
كما ذكرصلىاللهعليهوآلهوسلم حُسن الخلق كعامل للسعادة.
الإمام علي عليهالسلام أشار إلى الجمال، والسلامة من ألسنة الناس، وحُسن السمعة بين الناس، والعلم الذي يجلب القيمة في الدنيا والآخرة، والتقوى التي تؤدي إلى العظمة، والقناعة التي تحقق الغنى، والابتعاد عن الناس الذي يجلب الراحة في الدارين، وطاعة الله التي تُفضي إلى السلامة، وقبول الحق الذي يؤدي إلى التواضع، وترك الهوى الذي يجلب العيش الطيب، والكرم الذي يجعل الإنسان محمودًا بين الناس كنعمة من نعم الله.
ومن عوامل السعادة ذكر الإمام زين العابدين عليهالسلام التجارة في الوطن، والأصدقاء الصالحين، والأبناء الذين يُعينون
آباءهم، وذكر الإمام الباقرعليهالسلام الولد الذي يشبه أباه في الشكل، والأخلاق، والصفات، وذكر الإمام الصادق عليهالسلام البيت الواسع، والمركب الذي يُلبي احتياجات صاحبه وحقوق إخوته، والقدرة على توفير الرزق للعائلة، وأنْ يكون رزق الفرد في أيدي أهل الخير، ورؤية الولد الصالح. وذكر الإمام الرضاعليهالسلام بياض الزوجة، وسعة البيت، وكثرة الأحبة، ووفاق الزوجة.
في الجانب المقابل:
في روايات الشقاء، أشار النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الجار السيّئ، والزوجة السيّئة، والبيت الصغير، والمركب السيّئ بوصفها عوامل للشقاء في الدنيا. وفي روايةٍ أخرى، جعل صلىاللهعليهوآلهوسلم سوء البيت بسوء الجار وضيق المسكن، وسوء المركب بصعوبته وقلّة راحته، وسوء الزوجة بعقمها وسوء خلقها.
في روايةٍ أخرى، ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثةً من أسباب الشقاء: امرأةً تؤذي زوجها في حضوره وتخونه في غيابه، إضافةً إلى دابةٍ بطيئة الحركة، فإذا ضربتها أتعبتك، وإذا ركبتها لم توصلك إلى أصحابك، وبيت صغير ضيق يُقَلِّل الراحة،. وعدَّ الإمامُ زين العابدين عليهالسلام المرأة التي يُحبها زوجها لكنها تخونه، من أسباب التعاسة.
تأتي مجموعةٌ أخرى من النصوص في روايات العيش. فقد أوضح النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام أنّ العيش الهنيء يتمثّل في ثلاثة أمور: بيت واسع، وجارية حسناء، ودابة سريعة.
وعدّ الإمام علي عليهالسلام رفاهية الحياة في الأمن والسلامة، وأنّ العيش الطيب يتحقق عبر: صديق لا يُحصي أخطاء يوم الصلح ليستخدمها يوم العداء، وزوجة تُدخل السرور عند الحضور وتكون أمينة عند الغياب، وخادم يُلبّي الطلبات قبل أن تُطلب. وأشار الإمام الكاظم عليهالسلام إلى أنّ العيش الأفضل في الدنيا يتمثّل في البيت الواسع، وكثرة الأصدقاء، ووجود خادم.
وفي الجهة المقابلة، عُدّ ضيق البيت، والانتقال المستمر
من منزلٍ إلى آخر، وسوء الدابة، وفقدان الأمن، وتفرق الأصدقاء، والحاكم الظالم، والجار السيّئ، والزوجة سيئة اللسان، ممّا يفسد العيش.
تشير روايات الراحة إلى أمورٍ ماديةٍ تسهم في راحة الحياة، مثل: البيت الواسع الذي يستر عورة الشخص ويُخفي سوءَ معيشته عن الآخرين، زوجة صالحة تكون عونًا له في أمور الدنيا والآخرة، ابنة يطمئن عليها سواء بالزواج أو برحيلها عن المنزل، ودابة سريعة ومريحة.
تناولنا روايات الغنى سابقًا بمناسبة أخرى، وهنا نُركّز على جانب آخر يتعلق بمصاديق الغنى. لا شك في أنّ المال والثروة يُعدّان من مصاديق الغنى، لكنهما ليسا كلّ شيء. الإنسان لديه
أبعاد متعدّدة، وبناءً عليها تتنوّع مصاديق الغنى والامتلاك.
تشير الروايات إلى أنّ الغنى بالله هو أعظم أنواع الغنى، أمّا الغنى بغير الله فهو فقرٌ وشقاء. من يمتلئ قلبه بمعرفة الله يملأه الاكتفاء بالله. ومع وجود الله، فإنّ الفقر المادّي لا يُسبّب ضررًا حقيقيًّا للإنسان؛ لذلك، غنى المؤمن هو بالله وليس بالمال. فمن يمتلك الله هو أغنى الناس.
تناولت الروايات أيضًا القرآن الكريم كأحد مصاديق الغنى، فبحسب الروايات، من يمتلك القرآن لا يُصاب بالفقر، ومن يفتقده لا يعرف الغنى؛ ولهذا، يُعدّ من يحمل القرآن في قلبه غنيًا.
وتُعدّ ولاية أهل البيت عليهمالسلام من أعظم كنوز الإنسان في الحياة، وهي نعمةٌ لا تُعادلها أيّ ثروة. وقد جاء في الروايات تصريح بأنّ
هذه الولاية لا يمكن أنْ تُقارَن بأيّ مقدارٍ من المال.
مورد آخر، «العقل». وفقًا للروايات، لا غنى أعظم من العقل، ولا فقر أشدّ من الجهل. فالعاقل مستغنٍ بعلمه وحكمته، حتى إنْ لم يكن لديه مالٌ أو ثروة، بينما الجاهل فقير، حتى وإنْ كان ثريًّا.
نظرًا لتداخل مصاديق الغنى من جهة، واتّساع نطاقها من جهةٍ أخرى، يجب فصلها وتصنيفها للحصول على قائمةٍ منظمّةٍ بالإمكانات اللازمة للحياة. وهذا التصنيف يساعد في مرحلة
(معرفة الممتلكات) على التقييم الصحيح للموقع.
الفئة الأولى: الإمكانات المادّيّة
تشير الإمكانات المادّيّة إلى الأمور المتعلّقة بالجوانب المادّيّة والبنية التحتيّة للحياة. وهذه الإمكانات جاءت في النصوص الدينيّة على النحو الآتي:
نعمة الوجود: أساس كلّ متعةٍ ورفاهيةٍ هو وجود الإنسان نفسه. مجرّد أنْ نكون موجودين هو نعمة بحد ذاته.
الخَلق الحسن والتناسق: خلق الله الإنسان في أحسن صورةٍ وبنيةٍ جسديّةٍ متناسقةٍ تتناسب مع احتياجاته الإنسانيّة.
الرزق: الرزق وتوفير متطلّبات الحياة الأساسيّة هو حاجة أوّلية للإنسان. الله هو الذي يمنح الرزق، ولولا ذلك لما استطاع الإنسان توفير قوت يومه بمفرده.
العمل: وجود وظيفة لتأمين الرزق نعمة أخرى. فالعمل يحقق الاكتفاء، وإنْ كان العمل داخل الوطن بحيث لا يضطر الشخص لتحمّل عناء السفر، وكان ربّ العمل شخصًا يقدّر جهود الآخرين، فإنّ أهميّة هذه النعمة تزداد. وإنْ كان المرء مستقلًا في العمل فهو المطلوب، أمّا إذا كان يعمل لحساب الآخرين، فمن الضروري أنْ يختار منهم أهل الخير والشرف.
(100)المال: المال من النعم التي تتيح للشخص تأمين الاحتياجات اللازمة في حياته.
المسكن: حاجة الإنسان إلى مكان للعيش أمر ضروري. المنزل هو نقطة استقرار الفرد. وجود منزلٍ ثابتٍ يلبّي احتياجات الأسرة ويوفّر الستر عن أنظار الغرباء يُعدّ من ضروريات الحياة. كما أنّ كبر مساحة المنزل يُحسن من رفاهيّة الأسرة، بشرط أنْ يتناسب مع الظروف المادّيّة من دون إسرافٍ أو ترف. تذمّ بعض الروايات من له القدرة على شراء دارٍ واسعةٍ، ولكنّه لا يقدم على ذلك، علمًا بأنّ المراد من الدار الواسعة الدار المتناسقة مع ضروريّات حياة كلّ فرد.
وسيلة النقل: الحياة تحتاج إلى الحركة والتنقل؛ لذا فإنّ توفّر وسيلة نقلٍ سريعةٍ ومجهزة أمرٌ مهمٌ لضمان وصول الفرد إلى مقصده من دون عناء، مع القدرة على تلبية احتياجاته واحتياجات الآخرين.
الخادم: في الحياة اليوميّة، قد تكون هناك أعمال كثيرة يصعب إنجازها أو تعيق الفرد عن القيام بمهام أكبر؛ لذا فإنّ وجود خادمٍ يُسهل إنجاز هذه الأعمال، ويوفّر وقتًا للطاقة والمجهود في أمور أكثر أهميّة، يعدّ نعمةً على الإنسان.
الجمال: رغم أنّ المظهر ليس المعيار الأساس، إلا أنّه لا يمكن إنكار دور الجمال في الحياة. جمال المظهر يُعدّ من نعم
(101)الله التي قد تسهم في تسهيل بعض الأمور في الحياة.
الإمكانات غير المادّيّة يمكن دراستها على عدّة مستويات، وسنستعرضها في ما يأتي:
يشمل هذا المستوى مجموعةً من الإمكانات التي ليست ماديةً بطبيعتها لكنّها تُكمل البعد المادّي للحياة:
1. الصحّة: امتلاك جميع إمكانيات الحياة يصبح هنيئًا نافعًا عندما يكون الشخص بصحةٍ جيدةٍ وقادرًا على الاستفادة منها؛ إذ من دون الصحة، لن يكون لأيّ ثروةٍ قيمةٍ أو متعة. لذلك، الصحة واحدة من احتياجات الإنسان الرئيسة.
2. الأمن: الإنسان لا يمكنه أنْ يعيش حياةً هادئةً ومريحةً إلّا إذا كان يتمتّع بـالأمن. في ظروف الخوف وانعدام الأمن، تفقد الحياة معناها؛ لذا، الأمان من شر الأعداء الظاهرين والخفيين يُعدّ نعمةً من نعم الحياة الأساسيّة.
3. راحة البال: من شروط الحياة المريحة التمتع بـ(ذهن هادئ)؛ لأنّه مع ذهنٍ مشغولٍ ومضطربٍ لا يمكن للإنسان الاستمتاع بالحياة. لذلك، راحة البال من إمكانيّات الحياة المريحة والمبهجة.
4. القناعة: كما ذكرنا في تفسير المفهوم، الشعور بالغنى لا يأتي من المال والممتلكات، بل من الرضا بما هو موجود؛ لذلك القناعة نعمة من نعم الله.
5. دفع البلاء: الله سبحانه وتعالى يدفع عن الإنسان كثيرًا من البلاء قبل وقوعه. وهذه نعمةٌ خفيّة لكنّها عظيمة. النعمة ليست دائمًا في العطاء المادّي أو المعنوي، بل أيضًا في منع المشاكل.
6. حلّ المشكلات: المشكلات التي تحدث في الحياة إذا لم تُحلّ قد تتحوّل إلى أزماتٍ أكبر وأكثر إيلامًا. من نعم الله سبحانه وتعالى أنّه يزيل عن الإنسان مشاكله، ولا أحد غير الله قادر على فعل ذلك.
يتعلّق هذا المستوى بالبُعد الاجتماعي للإنسان، ويشمل:
1. الأُلفة بين الناس: في مجال العلاقات الاجتماعيّة، يحتاج الإنسان إلى (الألفة) لخلق علاقاتٍ دافئةٍ وصادقة. ومن دون هذا العنصر، لن تتشكّل العلاقات التواصليّة، وستكون الحياة البعيدة عن تلك العلاقات باردةً وقاسية.
2. ستر العيوب وعدم الفضح: من احتياجات الحياة الكرامة
والاعتبار الاجتماعي. إذا لم يكن الله ستّارًا، لما كان للناس أيّ اعتبارٍ اجتماعيّ تقريبًا.
3. السلامة من ألسنة الناس: الغيبة والافتراء قد تجعل الحياة صعبةً جدًا على الإنسان. لذا، الأمان من ألسنة الناس المؤذية يعدّ إحدى إمكانيات الحياة الإيجابيّة.
4. نشر السمعة الحسنة: السمعة الطيِّبة واحدةٌ من احتياجات الحياة الاجتماعية. أحيانًا يمنح الله الإنسان سمعةً حسنةً قد لا يستحقّها، وهذا لطفٌ آخر من الله.
5. حُسن الخُلق: تعتمد صحة العلاقات الاجتماعية على الأخلاق الإيجابيّة في التعامل، والتي يُشار إليها في الأدبيات الدينيّة بـ(حسن الخلق). لذلك، يُعد حسن الخلق من نعم الله ومن إمكانيات الحياة الإيجابيّة.
6. الزواج: من احتياجات الإنسان إشباع الغريزة الجنسيّة والأنس مع الشريك؛ لذلك، الزواج يُعدّ إحدى نِعَم الحياة. بالطبع، الزواج له أبعاد أخرى سيتم تناولها في مكانها المناسب.
7. الزوج/ الزوجة: بعيدًا عن الجانب الجنسي، الإنسان بحاجة أيضًا إلى شريك من الناحية العاطفيّة والعلاقاتيّة. لذلك، وجود الزوج أو الزوجة نعمة، ولكن يجب أنْ يتمتّع الشريك بصفاتٍ مثل الصلاح، والتديّن، والأمانة، والإيجابيّة، والجمال.
8. الأبناء: الأبناء أيضًا من احتياجات الحياة ووجودهم يُعد من الإمكانيات. لكن يجب أنْ يتمتع الأبناء بصفاتٍ مثل الصلاح، وأن يكونوا عونًا لأبويهما، ومن سعادة الوالد أن يشبهه ولده.
9. محبّة الوالدينِ: يحتاج الطفل من فترة الرضاعة حتى البلوغ، وكذلك لتلبية احتياجاته العاطفية، إلى محبّة الوالدين. تُزرع هذه المحبّة في قلوب الوالدين من قِبل الله؛ لذا فهي نعمة أخرى من الله.
10. الصديق: الصداقة حاجة أخرى للإنسان. الصديق يُعد رفيقًا عاطفيًا ومساعدًا في الأزمات ومعينًا في التكامل الروحي؛ لذلك، الصديق يُعدّ من إمكانيات الحياة. لكن يجب أن يكون الصديق صالحًا ومتدينًا.
11. الجيران: بعض الأشخاص تربطهم علاقةٌ اجتماعيّةٌ بموقع السكن. فإنْ كان الجار سيئًا وغير صالح، فإنّه يُفسد الحياة حتى لو كانت في قصر؛ لذلك، وجود جارٍ صالحٍ يسهم في الراحة، ويكون عونًا عند الحاجة.
12. الابتعاد عن الناس: عندما يسود الفساد والشرّ في المجتمع، فإنّ أفضل حلٍّ هو العزلة والابتعاد. في هذه الحالة، ليس العيش مع الآخرين، بل العيش بدونهم يكون نعمةً.
13. الحاكم العادل: الحياة الاجتماعيّة تحتاج إلى حاكمٍ يُدير شؤون المجتمع. ورغم أنّ الحاكم السيّئ أفضل من الفوضى، إلّا أنّ وجود حاكمٍ عادلٍ ضروريّ لحياةٍ مريحةٍ وممتعة. لذا، وجود حاكمٍ عادلٍ يُعدّ من النعم والإمكانات الكبيرة.
المستوى الثالث (الفضائل)
المستوى الثالث يشمل تلك الإمكانات التي تُعدُّ من الفضائل الداخلية مثل:
1. العقل: العقل هو من أعمق المفاهيم الأخلاقية. وفقًا للروايات، يُقصد بالعقل «الإدراك المانع» وهو أم الأخلاق الإسلاميّة. لذلك، فإنّ التمتّع بالعقل بمعناه الأخلاقي يُعدُّ أحد أعظم النِّعَم.
2. العلم: العلم يؤدّي دورًا مهمًّا في تحقيق الرضا عن الحياة. فالرضا يعتمد على عوامل وموانع، ولإدراكها تأثيرٌ كبيرٌ في تحقيقه. كما أنّ الشخص المتعلّم يستطيع، حتى مع إمكاناتٍ قليلة، أنْ يحقّق نجاحاتٍ كبيرة، أمّا الشخص الجاهل يهدر حتى الموارد الوفيرة. ومن جانب آخر، الشخص العالم يتقبل الحقّ ويبتعد عن الباطل؛ لذا، فإنّ التمتع بالعلم والمعرفة يُعدُّ من الإمكانات الكبيرة في الحياة.
3. التقوى: التقوى عاملٌ مهمٌ في ضبط النفس والسيطرة
عليها. المؤمن يحتاج إلى التقوى للقيام ببعض الأفعال والامتناع عن بعضها للوصول إلى الرضا، وبالتقوى يتحرّر الإنسان من شهواته النفسانيّة، ويعمل بما هو مصلحة له. لذلك، فإنّ التمتّع بهذه القدرة يُعدُّ إمكانيَّة عظيمة.
المستوى الرابع يشير إلى تلك الإمكانات التي ترتبط مباشرةً بالجانب الروحاني والديني:
1. الله سبحانه وتعالى: الله هو الوجود الوحيد الأصيل في الكون، وكلّ شيءٍ في الوجود هو بإرادته. ومن أسماء الله الحسنى (الغني)، أي الغنى المطلق؛ لذلك، من يملك الله يملك كلّ شيء. ومن جانبٍ آخر، استجابة الله لجميع مطالب البشر وإمكانية التواصل المباشر معه من دون وسيط يُعدُّ نعمة. كما أنّ حِلم الله وصبره على ذنوب الإنسان هو نعمةٌ أخرى. لذلك، فإنّ الله هو أعظم إمكانيَّة في حياة الإنسان.
2. القرآن والإسلام: الوصول إلى الرضا يحتاج إلى برنامج. والقرآن هو كتاب الهداية وبرنامج سعادة الإنسان. وكلّ ما يشمله الدين والإسلام يقع تحت هذا المبدأ؛ لذا، فإنّ أحد الإمكانات اللازمة لتحقيق الرضا هو القرآن والإسلام.
3. النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم، وأهل البيت عليهمالسلام: تحقيق السعادة والرضا يتطلّب مرشدين قد ساروا في هذا الطريق. الأنبياء وأولياء الله هم الذين يعرفون طريق السعادة ويملكون القدرة على الإرشاد؛ لذا، فإنّ وجود هؤلاء الحُجج الإلهية هو من أعظم النعم للبشر. لولاهم لما كان بالإمكان العثور على طريق السعادة.
4. الإيمان: جميع الإمكانيات الروحانية لتحقيق الرضا -والتي تمّ ذكرها حتى الآن- لن تكون مثمرة بدون الإيمان. الله، والإسلام، وحُجج الله جميعها حقائق في عالم الخلق، لكن إذا لم يقبلها الإنسان، فإنها لن تؤثر على رضا الإنسان. الإيمان يعني معرفة الله ودينه وحُججه وقبول ولايته وولاية حُججه. الشخص الذي يصل إلى الإيمان الحقيقي يتمتع بجميع النعم المذكورة سابقًا.
عندما يُطرح موضوع الإيمان بالخيريّة ومعرفة الخير، يُشار إلى نظام التقييم. النماذج التقييميّة للأمور تختلف، فليس نظام الإدراك البشري دائمًا يعمل على نموذجٍ واحد؛ ولذلك لا يمكن لأيّ نظامٍ تقييم أنْ يُحقّق الإيمان بالخيريّة. إذا لم يكن نظام التقييم خيريًّا، فلن يؤدّي إلى الإيمان بالخيريّة.
السبب في ذلك هو ازدواجيّة الأبعاد للظواهر، ممّا يؤدي إلى ازدواجيّة في نظام التقييم. الظواهر وأمور الحياة البشريّة
لها بُعدان: البُعد الظاهري- الذي بموجبه تكون الظواهر محببة أو غير محببة للطبيعة البشريّة -والبُعد الباطني- الذي بموجبه تكون الظواهر خيرة أو شريرة للحياة البشريّة.
محور البُعد الظاهري هو رغبات الإنسان، ومحور البُعد الباطني هو مصلحته. بناءً على هذا، هناك نظامان للتقييم: نظام التقييم المبني على اللذّة، أو المبني على الرغبة، ونظام التقييم المبني على المصلحة، أو المبني على الخير.
إذا كان نظام تقييم الشخص قائمًا على الرغبة، فإنّه يُقيّم كلّ الأمور على أساس (المحبب - غير المحبب)، ولا يفكر فيما وراء ذلك؛ لذا، لن يتمكّن من تمييز الخير والشر الحقيقيين. فإنّ نتيجة كلّ تقييم من هذا النوع هي أنّ هذا الشيء خير؛ لأنّه عدّ المحبّب خيرًا، ولكنّه في الواقع يختلف عن الخير الحقيقي.
إذا كان نظام تقييم الفرد يقوم على الخيرية، فإنّه يتجاوز ظاهر الأمور إلى أعماقها، ويفحص جميع الأمور في إطار (الخير - الشر)، و(المصلحة - المفسدة)، ولا ينشغل بشيء سواهما. هذا النظام يمتلك القدرة على تقييم مدى خيرية الأمور ويمكن الاعتماد عليه في تحديد الخير. في الآية الكريمة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ)(البقرة: 216)، تظهر الفروق بين هذين النظامين التقييميَّين بوضوح. هذه القاعدة
وضّح أحيانًا أنّ الخير والسعادة الحقيقيّة للإنسان قد تكون في المشقّة والمعاناة، وأنّ اللذّة قد لا تجلب سوى الشر والضرر. بناءً على ذلك، تطرح الآية في بدايتها مسألة القتال -الذي هو أمرٌ شاقٌّ ومؤلم- وتبيّن، بالاستناد إلى هذه القاعدة، أنّ الخير لهم في هذا القتال رغم كراهتهم له (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، وأنّ الناس يفرحون بترك القتال، وقد يكون الشرّ في ذلك.
وفي موضعٍ آخر، تتناول الآية مسألة الكراهية تجاه الزوجة، فتقول إنّه إذا كرهتم زوجاتكم فلا تسارعوا إلى طلاقهن، فقد تكون هناك خيريةٌ كبيرةٌ لكم فيما تكرهونه: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)(النساء: 19).
وفي الجهة المقابلة، يتمّ التطرق إلى المال الذي يعدّ لذيذًا للناس، لكن الآية تحذر من الظن بأنّه خيرٌ لهم: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)(آل عمران: 178). كذلك، فإنّ المعصية ممتعة لكنها تؤدّي إلى الخراب، بينما الطاعة شاقّة لكنّها تُفضي إلى السعادة والنجاح[1].المهم هنا أنّ محور تعاليم الإسلام ليس اللذّة، بل الخير ومصلحة الإنسان. هذا التوجّه ليس جديدًا؛ بل يعود إلى جميع الأديان السماويّة والأنبياء الإلهيين. هنا يظهر النقاش حول معيار الخير والشر. دور نظام التقييم هو تحديد الخير والشر. حتّى نظام التقييم القائم على الرغبات
يدّعي تعريف الخير رغم أنّه لا يصل إلى الخير الحقيقي. بناءً على ذلك، تختلف معايير الخير والشر. وبالتالي، فإنّ إصلاح نظام التقييم مرتبطٌ بإصلاح معيار الخير والشر، ولإصلاح نظام التقييم يجب تحديد معيار الخير والشر الحقيقيين واستخدامه كأساسٍ للتقييم.
تمّ في البداية تعريف الرضا بأنّه يتألّف من ثلاثة عناصر: المطابقة، والقبول، والسرور. كما أنّ الأساس النظري للرضا هو (الخير المُدرَك). بناءً على ذلك، يمكن القول إنّ استراتيجيات الرضا تشمل: المطابقة، والخير، والقبول، والسرور.
كما أظهرت المراجعات أنّ (الخير المُدرَك) هو أساس الرضا في الإسلام؛ أي أنّ استناد الحياة إلى الخير الحقيقي هو العامل الأساس لتحقيق الرضا. هذه القاعدة تنطبق في المجالات الثلاثة للحياة، بمعنى أنّ إدراك الخير يؤدّي إلى الرضا، سواء أكان ذلك في قضاء الله، أم في مجال المعيشة، أم العلاقات الاجتماعيّة، أم النظام السياسي.
عامل الرضا في مجال القضاء هو الإيمان بالخير، وفي مجال جوانب الحياة الأخرى، يتمثّل من جهة في جلب الخير لبناء حياة جيّدة، ومن جهة أخرى في البحث عن الخير الموجود. بناءً على ذلك، فإنّ الرضا هو مزيجٌ من الإيمان بالخير، وجلب
(111)الخير، والبحث عن الخير.
يتطلّب تحقيق هذه المبادئ الثلاثة ثلاثة شروط أساسيّة: أوّلها معرفة الخير، وثانيها معرفة الممتلكات، وثالثها التركيز على الخير في التقييم. حتى يتمكّن الإنسان من تمييز الخير الحقيقي عن الخير الوهمي، وحتى يحصل على قائمةٍ دقيقةٍ بما يملك من ضروريات الحياة الناجحة، سيكون عاجزًا في الجوانب الثلاثة للإيمان بالخير، وجلب الخير، والبحث عن الخير. كما أنّ الرضا في جوهره حكم وتقييم للحياة، لذلك يجب أنْ يكون نموذج التقييم خيريًّا. ولهذا السبب، فإنّ معرفة الخير، ومعرفة الممتلكات، والتركيز على الخير في التقييم هي شروط أساسيّة للرضا.
(112)
بعد توافر المتطلّبات الأساسيّة، يحين دور العوامل المؤثّرة في تحقيق الرضا، والتي تشمل: جلب الخير، واكتشاف الخير، والإيمان بالخير. في هذا الفصل، سنتناولها بالتفصيل:
صحيح أنّ الحياة تحتوي على حقائق ينبغي أنْ نتكيّف معها، ولكن هذا ليس كلّ شيء. لبناء حياة جيّدة، يجب السعي والعمل الجاد، وهذا أحد القوانين الحاكمة في الحياة. التكيّف غالبًا يحمل طبيعةً سلبيّةً، بينما جلب الخير يتميز بالطبيعة الإيجابيّة والديناميكية، رغم أنّه أيضًا يتبع القوانين الحاكمة في الحياة. بمعنى آخر، الخير هو مصدر الرضا، ولكن ينبغي أنْ يُجلب إلى الحياة. هذا هو قانون الحياة: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39). يقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم: «إنَّمَا العِلمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإنَّمَا الحِلمُ بِالتَّحَلُّمِ؛ مَن یَتَحَرَّ الخَیرَ یُعطَهُ، ومَن یَتَّقِ الشَّرَّ یوقَهُ».
هذا ما نعنيه بمفهوم (جلب الخير). على الإنسان أنْ يسعى
لتأمين حياةٍ جيّدة. الإسلام يؤكّد بشكلٍ جادّ على أهمية السعي والعمل. من يبذل قصارى جهده، يصل إلى غايته أو إلى جزءٍ منها. إنّ الذي يتهاون ويميل إلى الكسل يُحرم من السعادة، فالكسل عدو السعي والاجتهاد، ومن يصاب به يُحرم من خيرات الدنيا والآخرة، بل الكسل مفتاح كلّ شرٍّ وبلاء، وقفل لكلّ خيرٍ وبركة؛ فإنّ الإنسان إذا أُصيب بالكسل، فإنّه لن يصل إلى أهدافه، ويفوّت الفرص، ويعيش في حرمان، وقد يؤدي إلى الهلاك، وفي النهاية يشعر بالإحباط والندم.
ممّا سبق يتبيّن أنّ الكسل من عوامل عدم الرضا؛ لأنه يحرم الإنسان من خيرات الدنيا والآخرة. الشخص الذي يتهاون في جهوده يصبح عبئًا على الآخرين. هذا ما نعنيه بمفهوم (جلب الخير)، أي أنّ الإنسان يجب أنْ يعمل بجدٍّ لبناء حياةٍ جيّدة. هذا الجهد قد يتعلّق بالمعيشة، أو العلاقات الاجتماعية، أو النظام السياسي والاجتماعي. معرفة ما يجب فعله في كلّ جانبٍ، موضوعٌ كبيرٌ يحتاج إلى بحثٍ مستقل. المهم هو التعرّف على خصائص كلّ بُعدٍ من أبعاد الحياة الجيّدة والعمل على تحقيقها.
السؤال المطروح هو: كيف يمكن للإنسان أنْ يكون مؤمنًا بالقدر وفي الوقت ذاته يسعى لجلب الخير؟ إذا كانت كلّ الأمور خاضعةً لتقدير الله، فما فائدة السعي لجلب الخير؟ وإذا كان الأمر متروكًا لسعي الإنسان، فأين مكان الإيمان بالقدر؟ وهل يمكن الجمع بين الأمرين؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يمكن القول: صحيح أنّ الأحاديث الكثيرة تؤكّد أنّ الإنسان لا يتمتع ببركات الإيمان الحقيقي إلّا إذا آمن بالقدر الإلهي، وأنّ من ينكر القدر وهو يدعي الإسلام يُعدّ كافرًا، أو مجوسيًّا ملعونًا، ولكن يجب التنبّه إلى نقطةٍ مهمّة، وهي أنّ الإيمان بالقدر لا يتعارض مع التدبير والتخطيط والسعي لحياة أفضل، بل إنّ التدبير والسعي هما جزءٌ
(116)من القدر ذاته. كما جاء في القرآن الكريم: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾، وهذه الآية تشير إلى أنّ نظام الخلق مبنيٌّ على أنّ الإنسان لا يجني إلّا نتيجة سعيه وتدبيره، وهذا وفقًا لتقدير الله. لذلك، فإنّ الاستفادة من الأدوية أو الدعاء أو الوسائل الأخرى تكون نافعةً للإنسان. وإذا بدت بعض الأحاديث وكأنّها تشير إلى تعارض التدبير مع التقدير، فإنّ المقصود بها هو معنى آخر.
في النظرة الأوّلية لبعض الأحاديث، قد يظهر أنّ الإيمان بالقدر يتعارض مع التخطيط والتدبير للحياة، لكن بالتأمل يتضح أنّ هذا التعارض ظاهريٌّ فقط. على سبيل المثال، ورد في حديث: «ربّ حياة سببها الموت، وربّ موت سببه طلب الحياة». هذا الحديث يوضح أنّ التدبير ليس دائمًا مجديًا؛ بل أحيانًا قد يحدث عكس ما تم التخطيط له. لذلك، فإنّ المؤمن، بجانب تدبيره وسعيه، لا ينبغي أنْ يعتمد اعتمادًا كليًّا على الأسباب الظاهرة، بل يجب أنْ يتوكل على الله، ويستعين به لضمان مستقبله.
هذا الحديث يشير إلى أنّ التوكّل هو المكمّل والمتمّم للتدبير، ومن دونه قد لا تؤدّي التدابير إلى النتائج المرجوة، أو قد تنتج عكسها.
ورد في أحد الأحاديث عن زید الشحّام عن الإمام الصادق عليهالسلام: «إنَّ أمیرَ المُؤمِنینَ (صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ) جَلَسَ إلىٰ
(117)حائِطٍ مائِلٍ یَقضي بَینَ النّاسِ، فَقالَ بَعضُهُم: لا تَقعُد تَحتَ هٰذَا الحائِطِ فَإنَّهُ مُعوِرٌ. فَقالَ أمیرُ المُؤمِنینَ عليهالسلام: حَرَسَ امرَأً أجَلُهُ. فَلَمّا قامَ سَقَطَ الحائِطُ. قالَ: وكانَ أمیرُ المُؤمِنینَ عليهالسلام مِمّا یَفعَلُ هٰذا وأشباهَهُ، وهٰذا الیَقینُ».
في المقابل، ورد حديثٌ آخر عن الإمام علي عليهالسلام في حادثةٍ مشابهة، فعن الأصبغ بن نباتة: أنَّ أمیرَ المُؤمِنینَ عَدَلَ مِن عِندِ حائِطٍ مائِلٍ إلىٰ حائِطٍ آخَرَ، فَقیلَ لَهُ: یا أمیرَ المُؤمِنینَ! أتَفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ؟ فَقالَ: «أفِرُّ مِن قَضاءِ اللهِ إلىٰ قَدَرِ اللّهِ عزّ وجلّ».
هذا يعني أنّ الإصابة تحت الجدار المائل هي من قضاء الله، وكذلك النجاة بالابتعاد عنه هي أيضًا من تقدير الله؛ لكن لا أحد منهما قضاء حتمي والإنسان مكلّف بالفرار من قضاء والالتجاء الى قضاء آخر لحفظ نفسه.
ورد حديثٍ آخر: «إنَّ مَعَ كلِّ إنسانٍ مَلَكينِ يحفَظانِهِ، فَإذا جاءَ القَدَرُ خَلَّيا بَينَهُ وبَينَهُ». والمقصود هنا بالتقدير هو التقدير الحتمي الذي لا ينفع معه أي تدبير أو سعي، وليس التقدير المعلّق الذي يمكن تغييره بالدعاء والتوكّل على الله. بما أنّ الإنسان لا يعلم مقدراته الحتمية والمعلقة، فهو دائمًا بحاجةٍ إلى الجمع بين السعي والتدبير مع الاستعانة بالله والدعاء
لتجنّب المشكلات المحتملة وتحقيق مستقبلٍ أفضل.
خلاصة القول أنّ الأساس النظري للرضا هو الخير. ونظرًا لأنّ أمور حياتنا تنقسم من منظورٍ معين إلى قسمين: تقدير الله، وجهد الإنسان، فإنّ الرضا يتجزأ أيضًا إلى قسمين: الإيمان بأنّ تقدير الله خير (الإيمان بالخير)، والسعي لإيجاد حياةٍ طيّبةٍ بما يتماشى مع تقدير الله (إيجاد الخير).
كما سبق، فإنّ محور الرضا هو خيرات الحياة، ولهذا السبب، فإنّ إدراك تلك الخيرات ذو أهمية كبيرة. فوجود النعمة وحده لا يكفي، بل يجب إدراكها. بعض الناس يجهلون ما لديهم من نعم. وبعض السلبيّين لا يرون ما لديهم، بل يركزون على ما لا يمتلكونه. يؤدّي ذلك إلى تقييمٍ خاطئٍ للوضع الحالي، ما يولّد شعورًا بالحرمان ويزيد الألم والمعاناة، وبالتالي يقلّ مستوى الرضا، ويصل إلى عدم الرضا. لذا، فإنّ وجود النعمة ليس له تأثيرٌ كبيرٌ على الرضا، بل إنّ إدراك النعمة هو العامل الذي يحقق الرضا عن الحياة. وبالتالي، فإنّ الطريق لتحقيق الشعور بالرضا هو إدراك النعم ومعرفتها. يقول الإمام الصادق عليهالسلام في كلمةٍ جوهريةٍ: «كم مِن مُنعَمٍ عَلَیهِ وهُوَ لا یَعلَمُ».
يمكننا من هذا الحديث أنّ نفهم سبب عدم الرضا وتحديد
استراتيجية تحقيقه، هو الجهل بالنعم الموجودة، والاستراتيجية هي إدراك النعم. الحقيقة هي أنّ حياة الإنسان (خصوصًا المؤمن) ليست فارغة. هناك نعمٌ كثيرةٌ في حياة الإنسان يمكن أنْ تمنحه شعورًا بالسعادة، لكنّها تظلّ غير معروفة، وبالتالي لا تؤثّر. لذا، يجب التعرف عليها لتحقيق الرضا. وفيما يلي نتكلم عن العوامل المؤثّرة في البحث عن الخير.
وفقًا لما سبق، تشمل النعم نطاقًا واسعًا، وإذا فقدت بعض النعم، يمكن للإنسان أنْ يشعر بالغنى بالنظر إلى النعم الأخرى. الأئمّةعليهمالسلام استخدموا هذا النهج لإعادة الرضا إلى أصحابهم. يقول الإمام علي عليهالسلام في هذا الصدد :«إذا طَلَبتَ شَیئًا مِن الدُّنیا فَزُوِيَ عَنك، فَاذكر ما خَصَّك اللَّهُ بِهِ مِن دینِك وَصَرَفَهُ عَن غَیرِك، فَإنَّ ذٰلِك أحری أنْ تَستَحِقَّ بِما فاتَك».
كانت هذه الطريقة التي استخدمها الأئمّةعليهمالسلام لإعادة الرضا إلى أتباعهم. يذكر الشيخ الكليني (رحمه الله) عن أحمد بن عمر قال: دَخَلتُ عَلىٰ أبي الحَسَنِ الرِّضاعليهالسلام أنَا وَحُسَینُ بنُ ثُوَیرِ بنِ أبي فاخِتَةَ، فَقُلتُ لَهُ: جُعِلتُ فِداك! إنّا كنّا في سَعَةٍ مِنَ الرِّزقِ وغَضارَةٍ مِنَ العَیشِ، فَتَغَیَّرَتِ الحالُ بَعضَ التَّغییرِ،
فَادعُ اللَّهَ (عزّ وجلّ) أنْ یَرُدَّ ذٰلِك إلَینا. فَقالَ: «أيَّ شَيءٍ تُریدونَ؛ تَكونونَ مُلوكًا؟ أیَسُرُّك أنْ تَكونَ مِثلَ طاهِرٍ وهَرثَمَةَ، وأنَّك عَلىٰ خِلافِ ما أنتَ عَلَیهِ؟». قُلتُ: لا واللَّهِ، ما یَسُرُّني أنَّ لي الدُّنیا بِما فیها ذَهَبًا وفِضَّةً وأنّي عَلىٰ خِلافِ ما أنَا عَلَیهِ. قالَ: فَقالَ: «فَمَن أیسَرَ مِنكم فَلیَشكرِ اللَّهَ، إنَّ اللَّهَ (عزّ وجلّ)، یَقولُ: ﴿لَئِن شَكرتُم لَأَزِیدَنَّكم﴾، وَقالَ سُبحانَهُ وَتَعالىٰ: ﴿اعمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكرًا وَقَلِیلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكورُ﴾، وَأحسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ، فَإنَّ أبا عَبدِ اللَّهِ عليهالسلام كانَ یَقولُ: مَن حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللهِ كانَ اللَّهُ عِندَ ظَنِّهِ بِهِ، وَمَن رَضِيَ بِالقَلیلِ مِنَ الرِّزقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنهُ الیسیرَ مِنَ العَمَلِ، وَمَن رَضِيَ بِالیسیرِ مِنَ الحَلالِ خَفَّت مَؤونَتُهُ وَتَنَعَّمَ أهلُهُ، وَبَصَّرَهُ اللَّهُ داءَ الدُّنیا وَدَواءَها، وَأخرَجَهُ مِنها سالِمًا إلى دارِ السَّلامِ».
وذكر الكليني في روايةٍ أخرى: كانَ رَجلٌ یَدخُلُ عَلىٰ أبي عَبدِ اللّهِ عليهالسلام مِن أصحابِهِ فَغَبَرَ زَمانًا لا یَحُجُّ، فَدَخَلَ عَلَیهِ بَعضُ مَعارِفِهِ، فَقالَ لَهُ: «فُلانٌ ما فَعَلَ؟» قال: فَجَعَلَ یُضَجِّعُ الكلامَ یَظُنُّ أنَّهُ إنّما یَعنِي المَیسَرَةَ والدنیا. فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليهالسلام: «كیفَ دینُهُ؟». فَقالَ: كما تُحِبُّ، فَقالَ: «هُوَ واللهِ الغِنَي».
من هذه الحادثة وغيرها يمكننا أنْ نستنتج أنّ النظرة الأحادية للأشياء التي نملكها تعدّ من أسباب عدم الرضا. وكما تبيّن في موضوع التعرف على الخيرات وتصحيح قائمة النعم، إذا عرف
الناس كلّ ما يُعدّ من ممتلكاتهم وإمكاناتهم الحقيقيّة للحياة، ثمّ انتبهوا إليها، سيدركون أنّ هناك الكثير من النعم التي تستحق أنْ يعتزوا بها، ولن يشعروا بالحرمان مطلقًا.
من الطرق التي نستخدمها في حياتنا لتقييم أوضاعنا هي مقارنة أنفسنا بالآخرين. في هذه المقارنة، يحدد الإنسان موقعه الاجتماعي ونجاحه في الحياة. ونتائج هذه المقارنة قد تكون رضًا عن الحياة يصحبه أملٌ وحيويّة، أو استياءً وعدم رضا يصحبه يأسٌ وعجز. وفيما يلي نتطرّق الى بيان هاتين الصورتين:
المقارنة الصعوديّة تؤدّي إلى انخفاض مستوى الرضا في الحالات الجيّدة. فعندما يقارن الإنسان نفسه بمن هم في مستويات أعلى، ينخفض مستوى رضاه عن حياته. والسبب أنّ مقارنة وضعه بمن هم في وضعٍ أفضل تؤدّي إلى تقليل قيمة ما يملك، وتعظيم قيمة ما لدى الآخرين، ثم التركيز على ما يفتقده. هذه المقارنة تشبه تأثير الشمس التي تخفي القمر والنجوم نهارًا.
في الحياة، توجد أشياء كثيرة يمكن أنْ تجعل الإنسان سعيدًا ومبتهجًا. لكن المقارنة الصعودية تجعل الإنسان يغفل عن هذه الأمور، ويركز على ما يفتقده في حياته، ممّا يسبب الحزن والأسى.
(122)ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال: «إیّاكم أنْ تَمُدّوا أطرافَكم إلی ما في أیدي أبناءِ الدُّنیا، فَمَن مَدَّ طَرفَهُ إلیٰ ذٰلِك طالَ حُزنُهُ، وَلَم یَشفَ غَیظُهُ، وَاستَصغَرَ نِعمَةَ اللهِ عِندَهُ؛ فَیَقِلُّ شُكرُهُ لِلهِ». قال عليهالسلام في حديثٍ آخر: «خَصلَتانِ مَن كانَتا فيه كَتَبَهُ اللَّهُ شاكِرًا صابِرًا، وَمَن لَم تَكونا فيه لَم يَكتُبْهُ اللَّهُ شاكِرًا وَلا صابِرًا:... وَمَن نَظَرَ في دينِهِ إلى مَن هُوَ دونَهُ وَنَظَرَ في دُنيا إلى مَن هُوَ فوقَهُ فَأَسِفَ على ما فاتَهُ، لَم يَكتُبْهُ اللَّهُ شاكِرًا وَلا صابِرًا».
ومن البديهي أنّ من يبتلى بالمقارنة الصعوديّة لا هو الشاكر لما عنده، ولا هو الصابر على ما ليس عنده، لذا ورد في القرآن الكريم: (لا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجًا مِنْهُمْ ولا تَحْزَنْ عَلَيهِمْ).
إضافةً إلى ما ورد عن تأثير المقارنة الصعودية، يشير القرآن الكريم إلى أن هذه المقارنة تزيد من حزن الإنسان. وفي حديث آخر يُصرح بأنّ المقارنة الصعوديّة تزيد في حزن الانسان.
ونُقل أن جبرائيل عليهالسلام نزل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال له: «يا رسول الله، إن الله عزّ وجلّ يُرسل سلامه إليك، ويقول: (بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ...)». وبعد نزول هذه الآية، أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنْ يبلغ هذا الرسالة للناس: «مَن لَم يَتَأَدَّب بِأَدَبِ اللَّهِ تَقَطَّعَت نَفسُهُ عَلَى الدُّنيا حَسَراتٍ».
الحياة في حالة كأنّها تحتضر، كيف تكون؟ هل يمكن لمن هو في مثل هذه الحالة أنْ يشعر بالرضا؟ من أين ينشأ هذا الشعور بعدم الرضا؟ المقارنة التصاعدية تجعل الحياة صعبةً للغاية على الإنسان حتى يبدو كأنّه يلفظ أنفاسه الأخيرة. في هذه الظروف، لا يمكن توقّع حياة هادئة وممتعة.
من هذه الروايات يُفهم أنّ المقارنة التصاعدية تؤدّي إلى الحسرات على ما ليس موجودًا، وتسبب الحزن الشديد والطويل. في ظلّ هذه الظروف، لا يمكن توقّع أنْ يكون الإنسان راضيًا عن حياته أو مستمتعًا بها.
المقارنة التي تزيد مستوى الرضا هي المقارنة التنازليّة. المقارنة التنازليّة تعني النظر إلى من هم أدنى منك، ومقارنة حياتك بحياتهم. المقارنة التنازليّة تعدّ من العوامل المؤثّرة في تحقّق الرضا. السؤال هنا: ما التأثير النفسي للمقارنة التصاعديّة الذي يؤدّي إلى عدم الرضا؟
المقارنة التنازليّة تُظهر الجوانب الإيجابيّة والمُبشِّرة في الحياة، وهي الجوانب التي تُخفيها المقارنة التصاعديّة تحت ظلالها القاتمة. هذه المقارنة ليست من نوعيّة التعليمات الوهميّة التي تطالب الشخص بإيهام نفسه بأنّ لديه حياة مثاليّة، بل هي تعتمد على إدراك الحقائق واستكشاف النقاط الإيجابيّة الحقيقيّة في الحياة. فنّ المقارنة التنازليّة يكمن في إظهار الجوانب الإيجابيّة والمبشّرة في الحياة ووضعها أمام أعين الشخص.
قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله».
تصغير قيمة النعم هو التأثير النفسي للمقارنة التصاعديّة. لكن المقارنة التنازليّة تمنع هذا التأثير وتظهر للشخص ما يملكه بالفعل. الإنسان المتوازن يدرك بشجاعة أنّ الآخرين قد يملكون أشياء لا يملكها، ولكنّه في الوقت ذاته يملك أشياء كثيرةً يفتقدها الآخرون، وهذا يمكن أنْ يجعله يشعر بالفرح والأمل لمواصلة حياته.
لهذا السبب، من التوصيات الدينيّة للمؤمنين استخدام المقارنة التنازليّة. عندما أراد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تربية شخصيّة مثل أبي ذر، أوصاه بتجنّب المقارنة التصاعديّة والاعتماد على المقارنة التنازليّة.
لذا، من المهارات المهمّة لتحقيق النجاح في الحياة استخدام المقارنة التنازليّة. الاختلاف في مستويات الحياة هو حقيقة لا يمكن إنكارها، فإذا قارن الإنسان نفسه بحياة أفضل، سيشعر بالمرارة والإحباط، ولن يستمتع بحياته. وعندما يحدث ذلك، يكون أحد أفضل الحلول هو استخدام المقارنة التنازلية. هذه الطريقة مستمدةٌ من تعاليم أولياء الدين. وممّا روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم: «إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّل عليه في المال والجمال، فلينظر إلى من هو أسفل منه».
نقطةٌ مثيرةٌ للاهتمام في هذا الحديث هي أنّ المقارنة لا تكون دائمًا في المال والثروة؛ بل قد تكون أحيانًا في الجمال والمظهر. هذه المسألة تظهر بشكلٍ أكبر بين الشباب، وخاصّة بين الفتيات. مقارنة الشخص لنفسه بمن هم أجمل منه تسبب الحزن والكآبة. هذا أيضًا نوعٌ من المقارنة التصاعديّة. في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام المقارنة التنازلية لإزالة هذا الشعور غير المريح.
كذلك، قد تحدّث المقارنة التصاعديّة في الجمال الظاهري داخل حياة أسريّة، عندما يقارن أحد الزوجين شريكه بشريك آخر أكثر جمالًا (سواء كان رجلًا أم امرأة). هذه المقارنة -التي قد تحدث بسبب رؤية الشخص الآخر مباشرة أو صورته- تؤثّر على حكم الفرد وتغير إدراكه. أظهرت الدراسات أنّه إذا رأى
أحدٌ -قبل الحكم والتقييم- فردًا أو أفرادًا أكثر جاذبيّة، فإنّ تقييمه للشخص المعني يكون أقلّ من حيث الجاذبيّة والجمال.
كما أثبتت دراسة أخرى أنّ الرجال عندما يشاهدون صور نساء شديدات الجمال، يقلّ تقييمهم لجاذبيّة زوجاتهم. بناءً على ذلك، يمكن أنْ تكون المقارنة التصاعديّة في الجانب المالي أو الجمالي. وعليه فإنّ طريقة التعامل مع المشاعر غير المريحة الناتجة عن المقارنة التصاعديّة هي استخدام المقارنة التنازليّة. ومن الطريف أنّ المقارنة لا يجب أنْ تكون دائمًا مع حياةٍ حاضرة؛ بل يمكن الاستفادة من حياةٍ تاريخيّةٍ سابقة، كما أشار الإمام الباقرعليهالسلام إلى حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الأمر المهمّ هنا أنّ الإنسان قد يعتقد أحيانًا أنّ سوء أوضاع حياته هو نتيجة لغضب الله عليه وعلامة على الشقاء. ولكن عندما ينظر إلى حياة شخصيات مثل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأولياء الدين الآخرين، يدرك بطلان هذا التصوّر؛ لأنّه يرى أنّ أسمى البشر قد عاشوا حياةً بسيطةً، بل وصعبة أحيانًا. وهكذا يهدأ وينأى بنفسه عن الشعور غير المريح والتصوّر الخاطئ.
ومن المثير أنّ بعض الروايات صرّحت بدور هذه المقارنة في الشكر. فالشكر يعتمد على معرفة النعم. المقارنة التصاعديّة تقلل من قيمة النعم وتؤدّي إلى الجحود؛ أمّا المقارنة التنازليّة،
فتظهر النعم وتدفع الإنسان إلى الشكر. والأكثر إثارة للاهتمام أنّ هذا الفعل يؤدّي إلى زيادة النعم، وبالتالي يوسع نطاق الرضا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿لَئِن شَكرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكمْ وَلَئِن كفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم: 7). كذلك، يضيف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الصبر كأحد آثار المقارنة التنازليّة. عندما يرى الإنسان حياة أقل منه، يدرك ما لديه، فيشكر الله ويحمده، وفي الوقت نفسه يدرك أنّ حياته ليست بالقدر من السوء أو عدم التحمّل كما يتصوّر. وبهذا، يقلّ شعوره بالضيق، وينخفض الضغط النفسي إلى أدنى مستوى، وتزداد قدرته على التحمل والصبر.
لذلك، فإنّ استخدام المقارنة التنازليّة يعدّ أحد عوامل الرضا عن الحياة. أولئك الذين يقارنون حياتهم بمن هم أدنى منهم، سيكتفون بما وهبهم الله ويرضون به.
إنَّ الشعور بالفقر أحد أسباب الشعور بعدم الرضا، والشعور بالغنى أحد أسباب الشعور بالرضا. لذلك، فإنَّ الرضا في البُعد
التكويني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهومي الفقر والغنى. وما يهمّ هنا هو ضرورة امتلاك تعريفٍ دقيقٍ وصحيحٍ لهذين المفهومين، بوصفهما مسألتين جوهريّتين لتحقيق الرضا. الفقر والغنى، وفقًا لطبيعة الإنسان وطبيعة العالم الذي يعيش فيه (الدنيا)، يحملان تعريفًا خاصًا. من يسعى لتحقيق الرضا، يجب أنْ ينسجم تعريفه الشخصي مع هذه التعريفات. لا يمكننا السعي نحو الرضا من خلال تعريفاتٍ ذاتيةٍ ومبنيةٍ على الأهواء. الفقر والغنى في مفهوم الإنسان يحملان حقيقةً ثابتةً قرّرها الله سبحانه وتعالى. وهذا واقع لا يمكن تغييره في الحياة، كما أشرنا سابقًا. بناءً على ذلك، ينبغي علينا مواءمة تعريفنا للفقر والغنى مع هذه الحقيقة الإلهيّة. هنا يبرز مجددًا الحديث عن الانسجام مع الواقع؛ وهو انسجام تعريفنا لمفهومي الفقر والغنى مع حقيقتيهما. هذا النقاش بُعده معرفيٌّ بحت. من يريد تحقيق الرضا، ينبغي عليه أنْ يبحث في البُعد الفكري عن التعريف الحقيقي للفقر والغنى. كثيرٌ من المشاعر الوهميّة بعدم الرضا ناتجة عن عدم واقعية فهم هذه القضية. فبعض الناس ليسوا محرومين فعليًّا؛ ولكن بسبب عدم تقييمهم الصحيح لهذه المسألة، يعيشون مشاعر الحرمان وعدم الرضا. كما أنَّ السبب وراء كثيرٍ من مشاعر الرضا الوهمية يعود إلى هذا الفهم الخاطئ.
التفسير الشائع يعدّ الغنى هو التمتّع بالمال والإمكانات والمستلزمات المادّيّة للحياة، والفقر هو الحرمان من هذه
(129)الأمور. هذا التفسير يعطي الفقر والغنى طابعًا اقتصاديًّا، ويرى أنّ الإنسان الذي يمتلك الوسائل اللازمة للحياة يُعدّ غنيًّا، ومن يفتقر إليها يكون فقيرًا. هذا التفسير الاقتصادي والعيني للفقر والغنى واردٌ في النصوص الدينيّة، ولكنّه ليس محصورًا فيهما. السؤال هنا: هل كلّ من يملك الإمكانات اللازمة للحياة راضٍ عن حياته؟ وهل كلّ من يفتقدها يشعر بعدم الرضا؟ الجواب بالنفي؛ لأنَّ مجرد امتلاك الإمكانات كواقعٍ خارجي ليس كافيًا؛ بل يجب أنْ يكون هناك شعور بالاكتفاء أيضًا. كما أنَّ الحرمان من الإمكانات كواقعٍ خارجي ليس بالضرورة دافعًا لعدم الرضا؛ بل إنّ الشعور بالفقر هو العامل المحدّد. لذلك، نجد كثيرًا من الأغنياء يشعرون بالفقر، وكثيرًا من الفقراء يشعرون بالغنى.
التفسير الآخر هو التفسير النفسي، وفقًا لهذا التفسير، فإنَّ الفقر والغنى قبل أنْ يكونا مفهومين اقتصاديين وعينيين، هما مفهومان روحيان ونفسيان. فالغنى يعني الشعور بالاكتفاء، وليس التمتّع بالممتلكات، والفقر يعني الشعور بالاحتياج، وليس الافتقار للممتلكات. المال والثروة هما من ضمن عوامل تحقيق الشعور بالاكتفاء، ولكنّهما ليسا المعنى الأساسي. بناءً على هذا التفسير، الغنى هو الشعور الداخلي بالاكتفاء، والغني هو من يشعر بهذا الشعور، حتى لو كان يفتقر إلى الموارد المادية، والفقر هو الشعور الداخلي بالاحتياج، والفقير هو من يشعر بذلك، حتى لو كان يتمتّع بالإمكانات؛ لذا، فإنَّ مجرد
(130)وجود الإمكانات لا يضمن الرضا، وعدم وجودها لا يؤدّي بالضرورة إلى عدم الرضا. المهم هنا هو الشعور بالاكتفاء، وهو مسألةٌ داخليةٌ ونفسيةٌ، وليست خارجيةً ومادية. لهذا السبب، كان قادة الدين يعملون على تصحيح النظرة تجاه الفقر والغنى. لتحقيق الرضا، يجب تنمية الغنى النفسي والداخلي، وليس المادي؛ ولهذا السبب قال عيسى عليهالسلام : «خادِمي یَدايَ ودابَّتي رِجلايَ، وفراش الأَرضُ ووِسادي الحَجَرُ... أبیتُ ولَیسَ لي شَيءٌ، واُصبِحُ ولَیسَ لي شَيءٌ، ولَیسَ علىٰ وَجهِ الأَرضِ أحدٌ أغنى مِنّي».
وفقًا للتفسير الصحيح للغنى، يتّضح سبب عدم رضا بعض الأغنياء ورضا بعض الفقراء. كما قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «كم مِن فَقیرٍ غَنِيٌّ، وغَنِیٍّ مُفتَقِرٌ»، ولذلك، «رُبَّ فَقیرٍ أغنى مِن كلِّ غَنِیٍّ»! بناءً على ذلك، ما يُحقق الشعور بالرضا هو الغنى الداخلي والنفسي، وليس الغنى المادي. الأشخاص الذين يمتلكون غنى النفس لا يشعرون بالحاجة والنقص؛ ولهذا السبب، لن يكونوا غير راضين، بل سيشعرون بالرضا عن حياتهم.
وفقًا لما ذُكر في تفسير الفقر والغنى، هناك أشخاص يقتصرون في تصوّرهم لموجودات الحياة ومفقوداتها على الأمور المادّيّة فقط، ممّا يجعل معيار تقييمهم وقياسهم هو امتلاك أو عدم امتلاك الإمكانات المادّيّة. لذلك، عندما يفتقرون إلى الإمكانات المادّيّة، لا يُدرجون الإمكانات غير المادية ضمن حساباتهم، فيعدّون أنفسهم محرومين. كذلك، عند فقدان الإمكانات غير المادّيّة، لا يشعرون بالحرمان ولا يسعون لتأمينها.
يمكن تقييم وضع الشخص من حيث الحرمان فقط إذا عُرفت مصاديق الفقر والحرمان وفق التعريف الواقعي لهما. إذا تمكّن الإنسان من تحديد هذه المصاديق بواقعيّة، فإنّه أثناء مواجهة المشكلات يمكنه أنْ يدرس الوضع ليتأكّد ممّا إذا كان فعلًا محرومًا أم لا. النصوص الدينيّة تُبيّن مصاديق الحرمان، والحرمان من وجهة نظرها نوعان: حرمان قابل للتحمّل، وحرمان غير قابل للتحمّل. أساس هذا التقسيم هو نوع الممتلكات التي يتمتع بها الإنسان (مادّيّة أو معنويّة). بناءً على ذلك، الحرمان غير القابل للتحمّل هو الحرمان المعنوي، أمّا الحرمان القابل للتحمّل فهو الحرمان المادي.
إذا كان الشخص يعاني من حرمان معنوي، فقد أصيب
(132)بخسارةٍ كبيرةٍ، ويجب أنْ يشعر بعدم الرضا. وإذا كان لديه هذا الشعور، فهو أمرٌ طبيعي، وإذا لم يشعر بعدم الرضا، فيجب تنبيهه إلى هذا الأمر. ولكن إذا كان الشخص يعاني من حرمان مادي، فإنّه لم يتكبد خسارةً كبيرة، بل ربما يكون هذا الحرمان فرصةً لتحقيق منفعةٍ عظيمة. لذلك، إذا لم يشعر بعدم الرضا وكان قانعًا، فإنّ وضعه جيّد ومناسب. أمّا إذا شعر بعدم الرضا، فيجب مساعدته على تحقيق الرضا باستخدام العوامل التي سيتم ذكرها.
جزءٌ من النصوص الدينيّة يُخصّص لمناقشة مصاديق الحرمان الأساسي. وعلى الرغم من أنّ التعاليم الإسلاميّة تولي اهتمامًا مناسبًا بالحرمان المادّي، إلا أنّ الحرمان الأساسي وغير المحتمل هو الحرمان المعنوي. ويمكن استنتاج ذلك من خلال المصادر الدينيّة المتعلقة بتحديد المصاديق. في الأدبيّات الدينيّة، يتمّ تناول هذا الموضوع باستخدام مصطلحاتٍ متنوّعة مثل: الحرمان، والغبن، والخسران، والمصيبة، والشر، والتي سنناقشها في ما يلي.
ذكرت في النصوص الدينيّة أمثلة ومصاديق متعدّدة للحرمان. من بين هذه المظاهر، (الحرمان من خير المال). يعتقد الناس أنّ الحرمان يتمثّل في عدم امتلاك المال، لكن الحقيقة هي أنّ
(133)
عدم الاستفادة من المال هو علامة الحرمان، وليس فقدانه. وهذا الأمر يعتمد على كيفيّة استخدام المال. فبعض الناس يستفيدون من المال لجلب الخير، بينما يستخدمه البعض الآخر لجلب الشر. وفقًا للمنطق الإسلامي، الشخص الذي لا يملك المال لا يُعدّ محرومًا؛ بل المحروم هو من لا يستطيع الاستفادة من المال للخير.
مثال آخر هو (الحرمان من نعيم الآخرة). قد يعتقد بعض الناس أنّ عدم التمتّع بنعيم الدنيا هو علامة الحرمان، لكن الحرمان الدنيوي لا يُقارن بالحرمان من نعيم الآخرة. إنّ النعيم الدنيوي إذا أدّى إلى حرمان من نعيم الآخرة، فإنّه لا يساوي شيئًا. يقول الإمام علي عليهالسلام : «إنَّ عَلامَةَ الرّاغِبِ في ثَوابِ الآخِرَةِ، زُهدُهُ في عاجِلِ زَهرَةِ الدُّنيا، أما إنَّ زُهدَ الزّاهِدِ في هٰذِهِ الدُّنيا لا ينقُصُهُ مِمّا قَسَمَ اللّهُ (عزَّ وجلَّ) لَهُ فيها وإنْ زَهِدَ، وإنَّ حِرصَ الحَريصِ عَلى عاجِلِ زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا لا يزيدُهُ فيها وإنْ حَرَصَ، فَالمَغبونُ مَن حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الآخِرَةِ».
ومن مظاهر الحرمان الأخرى، (الحرمان من بركات شهر رمضان). هذا الشهر هو أكثر الشهور فضلًا، ويحمل الكثير من
البركات؛ لذلك، من يُحرم من خيراته يُعدّ محرومًا. وفي بعض الروايات، تم التركيز على المغفرة في هذا الشهر، وتم التأكيد على أنّ المحروم هو من يُحرم من مغفرة الله فيه. اللافت أنّ هذه الروايات استخدمت مصطلح (الشقي) للإشارة إلى المحرومين من بركات هذا الشهر، ممّا يدل على أنّ هذا النوع من الحرمان يؤدّي إلى الشقاء والبؤس، وليس فقط الحرمان المادي.
وفي رواياتٍ أخرى، تم الإشارة تحديدًا إلى ليالي القدر، وتم عدّ المحروم هو من يُحرم من بركات هذه الليالي. ولهذا السبب «كانَت فاطِمَةُعليهاالسلام لا تَدَعُ أحَدًا مِن أهلِها ينامُ تِلك اللَّيلَةَ (اللَّيلَة الثّالِثَةَ والعِشرينَ)، وتُداويهِم بِقِلَّةِ الطَّعامِ، وتَتَأَهَّبُ لَها مِنَ النَّهارِ، وتَقولُ: «مَحرومٌ مَن حُرِمَ خَيرَها».
في موضعٍ آخر، ذُكر (فقدان العقل)، وتم التصريح بأنّ
من يُحرَم من (نفع العقل) يُعَدّ محرومًا. عدّ الإمام الحسن المجتبى عليهالسلام في تعبيرٍ أكثر وضوحًا العقلَ وسيلةً للحصول على الدنيا والآخرة، وعدّ الإنسان الذي يفتقر إلى العقل محرومًا من الدنيا والآخرة معًا. المثير للاهتمام أنّ الرواية الأولى أشارت أيضًا إلى فقدان العقل كعامل يؤدّي إلى الشقاء وعدم السعادة.
في موضعٍ آخر، يُعرّف النبيُّ صلىاللهعليهوآله المحرومَ بأنّه من يُحرَم من الوصية. وكما سبق ذكره، القدرة على الوصية لما بعد الوفاة هي إحدى نعم الله العظيمة، ومن يفتقد هذه النعمة هو بالفعل محروم.
كما أشار النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى أنّ فقدان الرفق في العلاقات الاجتماعية هو أيضًا نوع من أنواع الحرمان. العلاقات مع الآخرين يمكن أنْ تحقّق بركات عديدة، والرفق هو أحد عوامل النجاح فيها؛ لذا، من يفتقر إلى الرفق يُحرَم من بركات تلك العلاقات.
وأخيرًا، في موضوعٍ أكثر إثارة، أُشير إلى قضيّة المصيبة، التي
هي موضوع نقاشنا الأساسي. نحن نعدّ وقوع المصائب علامةً على الحرمان، ولكن وفقًا للروايات، المحروم الحقيقي هو من يُحرَم من ثواب الصبر على المصيبة. سيتمّ الإشارة لاحقًا إلى أنّ إحدى فلسفات المصاعب في الحياة هي التمهيد لنيل الثواب. المصاب الذي ينال أجر الصبر على مصيبته ليس بمحروم. بعد وفاة النبي صلىاللهعليهوآله ، وعندما حان وقت التعزية، جاء شخصٌ كان أهل البيت عليهمالسلام يسمعون صوته لكنّهم لا يرونه، وقال في جزءٍ من حديثه: «فَإنَّ المُصابَ مَن حُرِمَ الثَّوابَ»[1]، هذا يُظهر أنّ وقوع المصيبة وحده ليس حرمانًا، ولكن فقدان ثوابها هو الحرمان الحقيقي.
في روايةٍ أخرى، يُوضّح الإمام الصادق عليهالسلام لإسحاق بن عمار مفهوم المصيبة الحقيقية بقوله: «لا تَعُدَّنَّ مُصيبَةً أُعطِیتَ عَلَیها الصَّبرَ، واستَوجَبتَ عَلَیها مِنَ اللّهِ (عزّ وجلّ) الثَّوابَ، إنَّما المُصيبَةُ الّتي یُحرَمُ صاحِبُها أجرَها وثَوابَها إذا لَم یَصبِر عِندَ نُزولِها»[2].
يمكن أيضًا ملاحظة معنى الحرمان ومفهومه في الآيات
والروايات المتعلّقة بالخُسران. في هذه النصوص، تم ذكر أمثلةٍ متعددة، وأحد أهمّها الإضرار بالنفس، إذ لا يفقد الإنسان المال والثروة فقط، بل أيضًا صحّته وأمنه، بل يخسر كيان وجوده الإنساني بأكمله. يقول القرآن الكريم: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ فُسّرت عبارة (خسروا أنفسهم) بأنّها تعني (غبنوا أنفسهم)، أي أضرّوا بأنفسهم.
ذكر العلّامة الطباطبائي قدسسره في تفسيره لهذه الآية أنّ كلمة (خسر)، و(خسران) تعنيان فقدان رأس المال، سواء كله أم بعضه. وكلمة (خسران) أكثر دلالةً من كلمة (خسر)، و(خسران النفس) تعني أنّ الإنسان يُعرّض نفسه للهلاك والشقاء، بنحو يُفقَد استعداده للكمال وتبتعد عنه السعادة تمامًا. وخسارة الأهل تحمل المعنى ذاته، وهو ما يُعرف بالخسران الحقيقي.
خسران الدنيا بكلّ أشكاله، سواء كان في المال أم الجاه، زائلٌ وغير دائم، على عكس خسران يوم القيامة الذي لا نهاية له، فهو دائمٌ وأبدي. إذ لا يزول ولا ينقطع. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المال والجاه إذا ضاعا بخسران، يمكن تعويضهما، وربما يُعوَّضان بما يماثلهما أو بما هو أفضل منهما، بخلاف خسران
النفس الذي لا يمكن تعويضه مطلقًا.
في آياتٍ من سورة هود، تم التطرّق أيضًا إلى خسران النفس. يكتب العلّامة الطباطبائي في تفسير هذه الآيات أنّ الكفّار أوقعوا الخسران في أنفسهم، والسبب في ذلك أنّ الإنسان يملك نفسه فقط، لكن ملكيّته هذه ليست استقلالية، بل هي بتملّك من الله تعالى. وعندما يشتري الإنسان شيئًا لنفسه يكون سببًا في هلاكه، ويبيع رأس ماله من عمره وماله وكلّ ما لديه، مقابل شراء الكفر والمعصية، يكون قد أوقع نفسه في خسارة، وهذه الخسارة صنعها بنفسه.
يقول الله تعالى في آيةٍ أخرى ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يظْلِمُونَ﴾، والجدير بالذكر أنّ هذه الآية تُرجع سبب هذا الخسران إلى ظلمهم لآيات الله، وهو ظلم يتمثّل في عدم الإيمان، كما أُكّد في الآية الثانية عشرة من سورة الأنعام. وهناك آياتٌ ورواياتٌ أخرى تؤكّد هذا المعنى.
وفقًا لبعض الآيات القرآنيّة، فإنّ هؤلاء سيكونون في عذابٍ دائمٍ يوم القيامة. وهذا يتماشى مع ما ورد في تعريف السعادة، وهو أنّ نهاية السعادة الحقيقيّة لا تكون إلّا في نعيم الآخرة الأبدي. الذين يعانون من خسران أنفسهم يفقدون هذه النهاية السعيدة، أمّا من يخسر المال والثروة في الدنيا، فليس بالضرورة أنْ يصل إلى هذه النقطة من الشقاء.
الواقع هو أنّ وفرة الدنيا تؤدّي إلى نقصان في الآخرة، والعكس صحيح، نقصان الدنيا يؤدّي إلى وفرة الآخرة. هذه هي إحدى قوانين الحياة الدنيا. وبناءً على ذلك، لدينا نموذجان في هذا الصدد: الأول هو الربح في الدنيا الذي يُنتج خسران الآخرة (ربح الدنيا - خسران الآخرة)، والثاني هو الخسران في الدنيا الذي يُنتج ربح الآخرة (خسران الدنيا - ربح الآخرة). والآن يجب أنْ نرى أيًّا من هذين النموذجين أكثر مناسبةً وأكثر نفعًا. إذا أخذنا في الاعتبار زوال الدنيا وقلّة متاعها مقابل خلود الآخرة ونعيمها الذي لا مثيل له، فإنّنا بلا شكّ سنختار ربح الآخرة وقبول نقصان الدنيا؛ لأنّ الخسران الحقيقي هو فقدان الآخرة.
الإمام علي عليهالسلام ، بمقارنة هذين النموذجين، يؤكّد على أفضلية نموذج (خسران الدنيا - ربح الآخرة)، إذ يقول : «اِعلَموا
أنَّ ما نَقَصَ مِنَ الدُّنیا وَزادَ فِي الآخِرَةِ خَیرٌ مِمّا نَقَصَ مِنَ الآخِرَةِ وَزادَ فِي الدُّنیا، فَكم مِن مَنقوصٍ رابحٍ وَمَزیدٍ خاسِرٍ»!
قاعدة (النقص المُربِح)، و(الزيادة المُضِرّة) من القواعد المهمّة في الحياة الدنيويّة، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المكاسب والخسائر. ينبغي أنْ يُعلم أنَّ ليس كلّ ما هو غير محبوبٍ يُؤدّي إلى الخسارة، وليس كلّ ما هو محبوب يُؤدّي إلى المكسب.
الغبن يعني الخسارة. ومن البديهي أنّ من يتعرّض للخسارة يكون غير راضٍ، ومن يحقّق المكاسب يكون راضيًا. هذان الموضوعان وردا في أدبيّات الدين تحت عنوان الغبن (الخسارة)، والغبطة (الهناء). وما يخصّ هذا النقاش هو مفهوم (الغبن).
بالنظر إلى تأثير الغبن على الرضا، يجب فهم معناه وتحديد مصاديقه. في الروايات، تم تفسير الغبن (الخسارة، الهزيمة) والمغبون (الخاسر) بمعانٍ دقيقة. ركّزت بعض الروايات على
موضوع العمر، ومن هذا المنطلق فسّرت الغبن بأنّه خسارة مَن يقضي عمره في غير طاعة الله تعالى.
عندما تُقارَن الدنيا بالآخرة، فإنّ أيّ مكسبٍ من الدنيا يُعدّ خسارة بالمقارنة. لذلك، من ينشغل بالدنيا، ويُهمل العمل للآخرة، ويبيع الجنة مقابل معصية تافهة، أو يُضيّع الفرصة لعبادة مثل صلاة الليل، فإنّه مغبون. الجدير بالذكر أنّ النصوص الدينيّة تؤكّد أنّ من يُضحّي بالدين من أجل الدنيا، فإنّه في الواقع قد خسر نفسه ووجوده، بينما من يسعى لتهذيب نفسه يكون هو الرابح.
وورد عن الإمام علي عليهالسلام أنّه قال: «المَغبونُ مَن غَبَنَ دینَهُ، والمَغبوطُ مَن حَسُنَ یَقینُهُ»، كما نقل الإمام الصادق عليهالسلام عن عيسى عليهالسلام قوله لأصحابه: «یا بَني آدَمَ! اهرَبوا مِنَ الدُّنیا إلَی
اللّهِ، وَأخرِجوا قُلوبَكم عَنها؛ فَإنَّكم لا تَصلُحونَ لَها وَلا تَصلُحُ لَكم، وَلا تَبقَونَ فیها وَلا تَبقیٰ لَكم، هِي الخَدّاعَةُ الفَجّاعَةُ، المَغرورُ مَنِ اغتَرَّ بِها، المَغبونُ مَنِ اطمَأَنَّ إلَیها، الهالِك مَن أحَبَّها وَأرادَها، فَتوبوا إلیٰ بارِئِكم وَاتَّقوا رَبَّكم، وَاخشَوا یَومًا لا یَجزي والِدٌ عَن وَلَدِهِ، وَلا مَولودٌ عَن والِدِهِ شَیئًا».
إنّ الخاسر هو مَن يضع ثقته في الدنيا. ولهذا يُوصى بالزهد فيها، والمغبون الحقيقي هو مَن يبيع دينه بدنيا فانية، وينسى الله وآخرته، وليس مَن يخسر الدنيا. والسبب في ذلك هو أنّ وجود الإنسان مرتبط بالله ودينه، فالتخلّي عنهما يعني فقدان الذات.
ورد في الروايات، أنَّ كلّ ما يصيب المؤمن ويشعر تجاهه بالاستياء يُعدُّ (مصيبة)؛ لذا فإنّ أمورًا مثل: الخوف وانعدام الأمن، الفقر والجوع، نقصان المال والنفس والثمار، وحتى
أمورًا بسيطة مثل انطفاء المصباح ليلًا أو انقطاع شريط الحذاء، تُعدّ من المصائب.
من جهة أخرى، فقدان الأمور غير المادية -التي هي أهم من الأمور المادّيّة- يُعدّ أيضًا من المصائب. ومن هذه الأمور: فقدان الدين، ومعصية الله، والاستهانة بالمعصية، وإنفاق المال
في المعصية، والجهل، والطمع في الدنيا، والاحتياج في الآخرة. لذلك، فإنّ فقدان الأمور غير المادية يُعدُّ أيضًا جزءًا من مصائب الحياة، ولا يمكن حصر المصائب في فقدان الأمور المادّيّة فقط.
الإنسان ينظر فقط إلى النعم التي يرى بأنّها كبيرةٌ وقيمة، وما يُعدّ صغيرًا لا يُحسب ضمن ممتلكاته، ولا يؤدّي إلى الرضا والشكر؛ لذا، فإنّ إحدى القضايا المهمّة في هذا النقاش هي معيار قياس حجم النعم. قياس حجم النعم يتمّ بناءً على معيارٍ خاص. يجب أنْ نرى أيَّ معيارٍ يؤدّي إلى الشكر، وأيّ معيارٍ يؤدّي إلى الجحود.
ذكر سابقًا أنّ تصغير النعم يؤدّي إلى الجحود وعدم الرضا. هذا بسبب أنّ قياس الظواهر يتمّ باستخدام معيار المادّة الخاصّ بها. الظواهر من حيث المادّة تتراوح بين أصغر وأكبر، وجميعها
موجودة في الحياة؛ لذلك، إذا استخدم معيار المادة، فإنّ بعض الأمور ستُقيَّم على أنّها صغيرة، ممّا يؤدّي إلى الجحود وعدم الرضا.
في المقابل، من العوامل التي تؤدّي إلى الشكر هو تعظيم النعم. عندما يُعظِّم الإنسان ما لديه، يشعر بالتمتّع، وهذا الشعور يجلب معه الرضا. لذلك، للوصول إلى الرضا يجب أنْ يُعظِّم الإنسان ما لديه. وإنّ تعظيم النعم يحتاج إلى أساس، والأساس يمكن أنْ يكون (واهب النعمة)، وليس النعمة ذاتها. الظواهر لها بُعدٌ آخر يتعلّق بـواهب النعمة. يقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذا الصدد: «أوحى الله (عزَّ وجلَّ) إلى عزير: يا عزير! إذا أُوتيت رزقًا مني فلا تنظر إلى قلّته، ولكن انظر إلى من أهداه».
لذلك، من خلال هذه الطريقة يمكن للإنسان أنْ يعظِّم ما لديه في الحياة، لكي يصل إلى شعور التمتع والرضا. ولهذا السبب، قال الإمام الباقرعليهالسلام لجابر بن يزيد الجعفي: «استكثرْ لنفسك من الله قليلَ الرزق؛ تخليصًا إلى الشكر». علاوةً على ذلك، التعظيم يؤدّي إلى بركة النعمة وزيادة الرزق، ممّا يزيد من مستوى الرضا. الشخص الذي يعدّ الرزق القليل قليلًا يُحرم من الرزق الكثير.
عن عبد الرحمان بن عبد اللّه بن قریب وزید بن أخرم: حَدَّثَنا سُفیانُ بنُ عُیَینَة عَن جَعفَرِ بنِ محمّدعليهالسلام أنَّهُ دَخَلَ عَلىٰ أبي جَعفَرٍ المَنصورِ وَعِندَهُ رَجُلٌ مِن وُلدِ الزُّبَیرِ بنِ العَوّامِ وَقَد سَأَلَهُ، وَقَد أمَرَ لَهُ بِشَيءٍ، فَتَسَخَّطَهُ الزُّبَیرِي فَاستَقَلَّهُ، فَأَغضَبَ المَنصورَ ذٰلِك مِنَ الزُّبَیرِيِّ حَتّىٰ بانَ فیهِ الغَضَبُ، فَأَقبَلَ عَلَیهِ جَعفَرٌ فَقالَ: یا أمیرَ المُؤمِنینَ! حَدَّثَني أبي عَن أبیهِ عَلِيِّ بنِ الحُسَینِ عَن أبیهِ عَن عَلِيِّ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَن أعطىٰ عَطِیَّةً طَیَّبَةً بِها نَفسُهُ بورِك لِلمُعطی وَالمُعطىٰ. فَقالَ أبو جَعفَرٍ: وَاللهِ لَقَد أعطَیتُهُ وَأنَا غَیرُ طَیَّبِ النَّفسِ بِها، وَلَقَد طابَت بِحَدیثِك هٰذا. ثُمَّ أقبَلَ عَلى الزُّبَیرِيّ، فَقالَ: حَدَّثَني أبي عَن أبیهِ عَن جَدِّهِ عَن أمیرِ المُؤمِنینَ عَليّ عليهالسلام قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنِ استَقَلَّ قَلیلَ الرِّزقِ حَرَمَهُ اللّهُ كثیرَهُ. فَقالَ الزُّبَیرِي: وَاللهِ لَقَد كانَ عِندي قَلیلًا وَلَقَد كثُرَ عِندي بِحَدیثِك هٰذا. قالَ سُفیانُ: فَلَقیتُ الزُّبَیرِيّ فَسَأَلتُهُ عَن تِلك العَطِیَّةِ، فَقالَ: لَقَد كانَت نَزرَةً قَلیلَةً فَقَبِلتُها فَبَلَغَت في یَدي خَمسینَ ألفَ دِرهَمٍ».
وعن الحسن بن بسّام الجمّال: كنتُ عِندَ إسحاقَ بنِ عَمّارٍ الصَّیرَفِي، فَجاءَ رَجُلٌ یَطلُبُ غَلَّةً بِدینارٍ، وَكانَ قَد أغلَقَ بابَ الحانوتِ وَخَتَمَ الكیسَ، فَأَعطاهُ غَلَّةً بِدینارٍ، فَقُلتُ لَهُ: وَیحَك یا إسحاقُ! رُبَّما حُمِلَت لَك مِنَ السَّفینَة ألفُ ألفِ دِرهَمٍ. قالَ: فَقالَ لي: تَرىٰ كانَ لي هٰذا! لٰكنّي سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليهالسلام
یَقولُ: «مَنِ استَقَلَّ قَلیلَ الرِّزقِ حُرِمَ كثیرَهُ». ثُمَّ التَفَتَ إلَيّ فَقالَ: یا إسحاقُ! لا تَستَقِلَّ قَلیلَ الرِّزقِ فَتُحرَمَ كثیرَه.
البلاء والمشكلة یؤثّران في لحظة الحاضر، ولذلك يصبح الحاضر موضع تقییم الإنسان. وقد یكون هذا الحكم إیجابیًّا أو سلبیًّا، ممّا یؤدّي إمّا إلی زیادة الضغط النفسي وإمّا إلی تخفیفه. ومن هنا فإنّ نمط التقییم الذي نتبناه للحاضر یؤدّي دورًا مهمًا فی تحقّق الرضا.
ما یجعل الوضع غیر قابل للتحمّل هو التقییم الذی یركز علی المشكلة فقط، بمعنی أنّ البلاء یُعدّ الجانب الوحید الموجود فی الحیاة. في هذه الحالة، یشعر الإنسان بأنّه یعیش فی فضاءٍ مظلمٍ وضیّقٍ لا یوجد فیه أيّ نافذةٍ للتنفّس. إذا نظر الإنسان إلی الحیاة بوصفها مرارة وصعوبة كلها، تصبح حیاةً مرهقةً وغیر محتملة. عند مواجهة مشكلة، قد یحدث تعمیم للآثار السلبیة لتشمل الماضي والمستقبل وجمیع أبعاد الحاضر. وفي بعض الحالات، قد یحدث تركیز شدید علی الجوانب السلبیة للحاضر دون النظر إلی أيّ شيء آخر. ومع هذا التعمیم أو التركیز، لا یبقی أيّ جانب إیجابي یمكن للإنسان أنْ یتعلّق به، لیبقی الأمل حیًّا، ویساعده في تجاوز المشكلات.
يستند التقييم المعتمد على الجوانب الإيجابيّة إلى مبدأ رؤية الجوانب الإيجابيّة الأخرى في الحياة. هذا النموذج من التقييم يوجّه انتباه الشخص المتألّم من المصائب من المشكلات والصعوبات إلى الجوانب الجيّدة والجماليات. في الحقيقة، التفكير الإيجابي هو وسيلةٌ لإعادة التركيز من الأمور السلبيّة إلى الأمور الإيجابيّة. قد نواجه مشاكل في جانبٍ من جوانب حياتنا، ولكن في المقابل نجد جوانب أخرى إيجابيّةً خاليةً من المشكلات. إذا كانت هناك أمورٌ سارةٌ إلى جانب المشكلات، فإنّها تخفّف من شدّة التوتر. تعمل هذه الطريقة على إدخال عناصر مفرحة ومبهجة إلى الحالة النفسية للشخص المتضرّر، ممّا يقلل من حدة آلامه ومعاناته.
ومع ذلك، لا يُقصد بالتفكير الإيجابي هنا التخيل الإيجابي فقط؛ فالتخيّل الإيجابي، لافتقاده للأساس الواقعي، يشبه الخداع الهشّ وغير الفعّال. الطريقة التي يوصي بها الدين في هذا المجال ليست مبنيّةً على الأوهام، بل التفكير الإيجابي في الدين يعتمد على اكتشاف الحقائق المبهجة. لا يسعى الدين لدفعك إلى الأوهام أو القصص الخياليّة، بل يهدف إلى مساعدتك في اكتشاف جماليات حياتك الواقعيّة وإضافتها إلى حسابك بجانب كلّ مشاكلك.
(149)هذا ما يمكن أنْ نسمّيه (التفكير الإيجابي الواقعي)، وهو لا يعني خلق خيالاتٍ ممتعة، بل يعني التعرّف على الأمور المبهجة الموجودة فعلًا. لذلك، فإنّه يعتمد على (معرفة الإيجابيّات). قد تكون هناك نقاطٌ إيجابيّةٌ وأمورٌ تبعث على الأمل، لكنّها قد لا تُدرك أو تُلاحظ. وما يمنح النقاط الإيجابيّة في الحياة خاصية تهدئة النفس هو فهمها والتركيز عليها. بناءً عليه، عندما يواجه الإنسان حادثةً ما ويركز على الأمور السلبيّة أو يعممها، فإنّ أفضل طريقةٍ لتخفيف التوتر هي إعادة التوازن من خلال معرفة الإيجابيّات.
في مواقف التوتر، توجد العديد من النقاط الإيجابيّة التي يمكن من خلالها تخفيف التوتر النفسي وتحقيق الرضا. الأهمّ هو تحديد هذه النقاط الإيجابيّة والانتباه إليها. عندما تُحدد هذه النقاط، فإنّ الشعور بالرضا يتشكّل حتى مع وجود المشكلات.
بناءً على ما سبق، كان المعصومون عليهمالسلام يوجّهون الناس إلى النقاط الإيجابيّة التي يمتلكونها أثناء معاناتهم من المشاكل. وسنتطرّق فيما يأتي إلى المجالات التي يمكن العثور فيها على الجوانب الإيجابيّة في الحياة:
من نتائج المواقف السلبيّة التركيز على الأمور غير السارة ونسيان التجارب الإيجابيّة الماضية، ممّا يؤدّي إلى الانفصال عن
(150)الماضي الإيجابي والمواقف المبهجة السابقة. في هذه الحالة، تفقد التجارب الإيجابيّة السابقة قدرتها على تهدئة النفس وتعزيز الأمل، ويبدو كلّ شيءٍ وجميع الفترات مليئة بالسلبيّة. هذا التضخيم يزيد من الضغط النفسي ويجعله غير محتمل.
في حين أنّ التجارب الإيجابيّة السابقة تشكّل أحد مصادر القوة في مواجهة المشكلات. إذا قُورنت الأمور السلبيّة بالتجارب الإيجابيّة السابقة، فإنّها تفقد أهميتها المبالغ فيها. رؤية القليل من المتاعب ممن قدم لنا كثيرًا من الخير لا تُزعجنا ولا تجعلنا نفقد صبرنا. مثل هذه المتاعب تبدو تافهةً وغير مرئيةٍ بجانب السعادة الأخرى. الأشخاص الذين يصابون بالضيق الشديد عند مواجهة حادثٍ سلبيّ لا يرون الأحداث الإيجابيّة الأخرى في حياتهم.
لهذا السبب، تُعدّ استعادة الذكريات السعيدة والتجارب الإيجابيّة الماضية إحدى الطرق لتخفيف التوتر. بناءً عليه، يقول الإمام الصادق عليهالسلام: «لا خَیرَ في عَبدٍ شَكا مِن مِحنَةٍ تَقَدَّمَها ألفُ نِعمَةٍ وَاتَّبَعَها ألفُ راحَةٍ».
كان أحد تجار المدينة ممّن له علاقة بالإمام الصادق عليهالسلام ميسورًا ثم تغيرت أحواله المالية، فجاء يشكو للإمام. فقام الإمام عليهالسلام بتهدئته من خلال تذكيره بحياته المزدهرة السابقة.
رغم أنّ المصيبة تحدث في الحاضر وتؤثر فيه، إلا أنّه ينبغي أنْ نعلم أنّ السوء لا يشمل جميع جوانب الحاضر. الحادثة تقع في بُعدٍ أو عدّة أبعاد فقط، أمّا الأبعاد الأخرى من الحاضر فهي خالية منها.
غالبًا ما نعمم الجوانب السلبيّة للماضي والمستقبل، ونتجاهل الجوانب الإيجابيّة فيهما. حتى في الحاضر، قد نعمم السوء الذي يصيب بُعدًا معينًا ليشمل جميع أبعاد الحاضر، أو نتجاهل الأبعاد الأخرى تمامًا، وكأنّها غير موجودة. من الواضح أنّ هذا يزيد من الضغط النفسي.
لكن في الواقع، السوء يخصّ فقط بعض الأبعاد الزمنيّة الحاضرة. وبجانب الجوانب السلبيّة، توجد جوانب إيجابيّة ربما تكون أكثر أهمية. ولذلك، يمكن للانتباه إلى هذه الإيجابيّات أنْ يقلّل من دائرة السوء ويزيد من مستوى الرضا عن الحياة.
قال الإمام علي عليهالسلام: «إذا طَلَبتَ شَیئًا مِنَ الدُّنیا فَزُوِيَ عَنكَ، فَاذكر ما خَصَّك اللّهُ بِهِ مِن دینِك، وَصَرَفَهُ عَن غَیرِك، فَإنَّ ذٰلِكَ أحریٰ أنْ تَسخو بِما فاتَك».
في التاريخ، نجد أنّ بعض الأشخاص الذين كانوا يعانون
من مشاكل وضغوط نفسيّة عندما لجأوا إلى الأئمّةعليهمالسلام ، وجدوا الشفاء بأسلوبٍ مشابه. مثال ذلك أبو هاشم الجعفري، الذي كان يعاني من ضيقٍ شديد، فعندما لجأ إلى الإمام الهادي عليهالسلام، هدّأه الإمام من خلال توضيح النعم التي يملكها، ممّا جعله يشعر بالراحة.
وضع المصاعب بجانب الإيجابيّات يؤدّي إلى نتيجتين:
تقليل حجم المشكلة.
لفت الانتباه إلى النقاط الإيجابيّة التي تلطف الأجواء النفسية.
من الجوانب الإيجابيّة للفترة الصعبة هي تقليل المسؤوليّات. فالممتلكات تجلب المسؤولية، ومن يُحرم من نعمةٍ ما يُعفى من بعض التكاليف.
غالبًا ما نركز على فقدان النعمة، لكن الوجه الآخر لفقدانها هو تخفيف المسؤوليّات، وهو بحدّ ذاته نعمة؛ ولذلك، فإنّ
الانتباه إلى هذا الجانب يمكن أنْ يقلّل الضغط النفسي الناتج عن فقدان النعمة، ويمنح الإنسان الرضا والطمأنينة.
يبدو أنّ أحمد بن محمد بن أبي نصر كان يواجه مشكلة، فهو يقول بنفسه: ذَكرتُ لِلرِّضاعليهالسلام شَیئًا فَقالَ: «اِصبِر؛ فإنّي أرجو أنْ یَصنَعَ اللّهُ لَك إنْ شاءَ اللّهُ». ثُمَّ قالَ: «فَوَاللهِ ما أخَّرَ اللّهُ عَنِ المُؤمنِ مِن هٰذِهِ الدُّنیا خَیرٌ لَهُ مِمّا عَجَّلَ لَهُ فیها». ثُمّ صَغَّرَ الدُّنیا وَقالَ: «أيُّ شَيءٍ هِي؟!»، ثُمَّ قالَ: «إنَّ صاحِبَ النِّعمَةِ عَلى ٰخَطَرٍ؛ إنَّهُ یَجِبُ عَلَیهِ حُقوقُ اللهِ فیها. وَاللّهِ، إنَّهُ لَتَكونُ عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ اللّهِ (عزّ وجلّ) فَما أزالُ مِنها عَلى وَجَلٍ -وحَرَّك یَدَهُ- حَتّىٰ أخرُجَ مِن الحُقوقِ الّتي تَجِبُ لِلهِ عَلَيَّ فیها». فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداك! أنتَ فی قَدرِك تَخافُ هٰذا؟! قالَ: «نَعَم، فَأَحمَدُ رَبّي على ما مَنَّ بهِ عَلَيَّ».
بناءً على ذلك، فإنّ أحد الجوانب الإيجابيّة لفقد النعمة هو تقليل المسؤوليّة والحرية من التكليف وتبعاته.
أوامر الله (عزّ وجلّ) تتضمّن مجموعةً من الواجبات والمحظورات التي تشكل منظومةً واحدةً تُسمّى (الدين). والعمل بها يُسمّى (الطاعة)، وعدم العمل بها يُسمّى (المعصية).
المسألة المهمّة هي أنّ أوامر الله (عزّ وجلّ) ونواهيه غالبًا ما تتعارض مع رغبات البشر. من يريد العمل بأوامر الله عليه أنْ يقبل بما لا يُحب (الطاعة)، ويتجنّب ما يُحب (المعصية). وفقًا لرواية عن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الجَنَّةَ والنَّارَ أرسَلَ جِبريلَ إلَى الجَنَّةِ، فَقالَ: انظُر إلَيها وإلى ما أعدَدتُ لِأَهلِها فيها. قالَ: فَجاءَها ونَظَرَ إلَيها وإلى ما أعَدَّ اللَّهُ لِأَهلِها فيها، قالَ: فَرَجَعَ إلَيهِ، قالَ: فَوَعِزَّتِك لَا يسمَعُ بِها أحَدٌ إلّا دَخَلَها، فَأَمَرَ بِها فَحُفَّت بِالمَكارِهِ، فَقالَ: اِرجِع إلَيها فَانظُر إِلى ما أَعدَدتُ لِأَهلها فيها، قالَ: فَرَجَعَ إلَيها، فَإذا هِي قَد حُفَّت بِالمَكارِهِ، فَرَجَعَ إلَيهِ فَقالَ: وَعِزَّتِك لَقَد خِفتُ ألّا يدخُلَها أحَدٌ. قالَ: اِذهَب إلَى النَّارِ فَانظُر إلَيها وإلى ما أَعدَدتُ لِأَهلِها فيها، فَإذا هِي يركبُ بَعضُها بَعضًا، فَرَجَعَ إلَيهِ فَقالَ: وَعِزَّتِك لا يسْمَعُ بِها أحَدٌ فَيدخُلَها، فَأَمَرَ بِها فَحُفَّت بِالشَّهَواتِ، فَقالَ: اِرجِع إلَيها، فَرَجَعَ إلَيها، فَقالَ: وَعِزَّتِك لَقَد خَشِيتُ ألّا ينجُوَ مِنها أحَدٌ إلّا دَخَلَها».
ولهذا السبب، كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول دائمًا: «ألا إنَّ الآخِرَةَ الیَومَ مُحَفَّفَةِ بِالمَكارِهِ، وَإنَّ الدُّنیا مُحَفَّفَة بِالشَّهواتِ».
الإمام علي عليهالسلام، بنقل هذا الحديث واستنادًا إلى هذا المبدأ كان يقول: «واعلَموا أنَّهُ ما مِن طاعةِ اللهِ شَيءٌ إلّا يأتي في كرهٍ، وما مِن مَعصيةِ اللهِ شَيءٌ إلّا يأتي في شَهوَةٍ».
السؤال هنا: إذا كان الوضع كذلك، فما هو تفسير الرضا بالتكليف؟
من الأسباب المهمّة والأساسيّة لعدم الرضا عن أوامر الشريعة هو التصوّر الخاطئ لسبب التشريع والجهل بحكمته. وبما أنّ الإنسان كائن هدفه تحقيق مصلحته، فإنّه ينفر من الأمور التي لا يرى لها منفعة. فإذا ظنّ الشخص أنّ عملًا ما لا يحبّه ويجب عليه القيام به أو عملًا يحبه ويجب عليه تركه لا يعود عليه بأيّ فائدة، فإنّه سيشعر بعدم الرضا تجاهه.
إحدى الاعتقادات الخاطئة حول الشريعة هي أنّ أوامر الشريعة وضعت لتحقيق مصالح الدين وأن فوائدها تعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتقاد -الذي يمكن تسميته بـ(الفائدة الإلهيّة)- وإنْ كان ربّما مخفيًّا، غير أنّه يؤدّي إلى الشعور بعدم الرضا عن الشريعة. وأول خطوةٍ نحو تحقيق الرضا عن التشريع هي إزالة هذا التصوّر الخاطئ.
الحقيقة هي أنّ الله سبحانه وتعالى ودينه في غنًى عن عبادات البشر. بل البشر هم الذين يحتاجون إلى الشريعة كبرنامج للسعادة الأصيلة. وقد صرّحت النصوص الدينيّة، بعدم منفعة الله تعالى من طاعة عباده، ونفي أيّ ضررٍ يناله من
(156)معصيتهم، مع التأكيد على غناه عن عبادة العباد.
بناءً على هذه الحقيقة، يقول الإمام علي عليهالسلام مخاطبًا الله (عزّ وجلّ): «لَم تَخلُقِ الخَلقَ لوَحشَةٍ، ولا استَعمَلتَهُم لِمَنفَعَةٍ... ولا یَنقُصُ سُلطانَك مَن عَصاك، ولا یَزیدُ في مُلكك مَن أطاعَك».
من جهةٍ أخرى، في بعض النصوص الدينيّة، نُسب ضرر المعصية إلى الإنسان نفسه، وليس إلى الله (عزّ وجلّ).
بناءً على ذلك، فإنّ الله سبحانه وتعالى لا يستفيد شيئًا من طاعة وعبادة عباده. أوامر الشريعة لا تعود إلّا بالنفع على الإنسان، وكلّ منافعها تعود إليه هو. هذه إحدى الحقائق الأساسية في مجال التشريع التي لم يُلتفت إليها كثيرًا. والاهتمام بهذه الحقيقة -التي يمكن تسميتها بـ(الفائدة الإنسانيّة)- يؤدّي إلى تحقيق الرضا عن التشريع واستحضار الشعور الإيجابي تجاه التكليف.
وبناءً على ذلك، تمّ التأكيد في النصوص الدينيّة على محوريّة الإنسان في الفوائد والأضرار الناتجة عن الطاعة والمعصية:
﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (الإسراء: 7).
ذات يوم قال الإمام علي عليهالسلام: «ما أحسَنتُ إلىٰ أحَدٍ قَطُّ! فَرَفَعَ النّاسُ رُؤوسَهُم تَعَجُّبًا، فَقَرَأَ: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكمْ وإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾».
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مَن يطِعِ اللَّهَ ورَسولَهُ فَقَد رَشَدَ، ومَن يعصِهِما فَإنَّهُ لا يضُرُّ إلّا نَفسَهُ ولا يضُرُّ اللَّهَ شَيئًا». وقد ورد هذا المضمون عن بقية المعصومين عليهمالسلام أيضًا.
يقول إسماعيل بن جابر: كتب الإمام الصادق عليهالسلام رسالةً إلى أصحابه وأمرهم بأنْ يقرأوها دائمًا، ويتأملوا فيها، ويهتموا بها ويعملوا بمقتضاها. ولذا كانوا يضعون هذه الرسالة في مصلّى منازلهم ويتدبرونها بعد الصلاة. وفي بعض أجزاء هذه الرسالة، ومع التأكيد على التفكير بمنطق (الإنسان - المستفيد)،
تم التركيز على طاعة الله واجتناب معصيته.
وبعبارةٍ أخرى، فإنّ للطاعة والمعصية حقيقتين مزدوجتين: ظاهر وباطن. فالظاهر الظاهر للطاعة يبدو غير مريح، وظاهر المعصية يبدو جذابًا، ولكن الباطن والخفي للطاعة واجتناب المعصية يحملان الخير والمنفعة؛ لأنّهما وُضِعا وفق مصالح الإنسان. قد تبدو الطاعة واجتناب المعصية غير مريحين ظاهريًا، ولكنّهما في الواقع خيرٌ للإنسان؛ لأنّ الحلال والحرام الإلهيين يتبعان مصالح الإنسان ومفاسده. والخالق الذي خلق الإنسان يعلم تمامًا ما ينفعه وما يفسده؛ ولهذا وضع الحلال والحرام بناءً على ذلك.
القوانين الإلهيّة مبنيّةٌ على مصالح ومفاسد حقيقيّة للإنسان،
وليست مجرد أهواء عابرةٍ ومشاعر مدمّرة. لذلك فإنّ القضاء التشريعي لله أيضًا قائمٌ على الخير، وهو ما يمكن أنْ يكون أساسًا قويًا للرضا.
الإنسان كائن يسعى للراحة ويهرب من المشقّة. لذلك، إحدى التقييمات التي يجريها الإنسان تجاه بعض الأمور، ومنها الدين، هي تقييم مدى التحمّل. فإذا شعر الإنسان بأنّ أمرًا ما يفوق قدرته، سيشعر بعدم الرضا، وإذا كان سهلًا وضمن حدود طاقته، سيشعر بالرضا. إذا قُيّم الدين على أنّه صعب ويتجاوز حدود الطاقة، فإنّه يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا والابتعاد عنه، وإذا قُيّم على أنّه سهل ويتناسب مع الطاقة، فإنّه يولد الميل والرغبة فيه والرضا به.
يعتقد البعض أنّ الدين يتضمن أوامر صعبةً وشاقةً ومرهقة، وليس له هدف سوى إرهاق أتباعه. الإنسان بطبيعته يهرب من كلّ ما يسبب له العناء ويشعره بالمعاناة. وهذا التصوّر يخلق شعورًا بعدم الرضا لدى الفرد.
الدين ليس شيئًا يسبب عدم الرضا. العامل الرئيس لعدم
الرضا التشريعي هو الجهل بالشريعة. مع فهم الطبيعة الحقيقيّة للدين، يتحقّق الرضا التشريعي. لذلك، ركّزت بعض النصوص الدينيّة على تقديم خصائص الدين. في النصوص الدينيّة، يُذكر الدين على أنّه شريعةٌ سهلةٌ وميسرة. هذه الحقيقة وردت أحيانًا بتعبير (السمحة). الله يحبّ اليسر للناس، ويكره لهم العسر والمشقّة. لهذا السبب، أشار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى دين الله على أنّه دينٌ ميسّرٌ وسهل، وأعلن «بُعِثتُ بِالحَنيفيّةِ السَّمحَةِ».
هذا هو الإطار العام للدين. في بعض النصوص الدينيّة، تمّ نفي أيّ أساسٍ للتشدّد. قد يعتقد بعضهم أنّ التكاليف الدينيّة ليست سوى تشدّداتٍ غير مبرّرة. هذا التصوّر أيضًا يثير النفور من الشريعة، ولكن هذا التصوّر غير صحيح. يؤكّد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ويقول: ﴿يرِيدُ اللهُ بِكمُ الْيسْرَ وَلاَ يرِيدُ بِكمُ الْعُسْرَ﴾. وعلى هذا الأساس، فإنّ ما شرعه الله سبحانه وتعالى يتماشى مع قدرة البشر. وفي إجابة الإمام علي عليهالسلام عن سؤال حول معنى «لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلّا بِاللّه»، قال: «إنّا لا نَملِكُ مَعَ اللّهِ شَیئًا، وَلا نَملِكُ إلّا ما مَلَّكَنَا، فَمَتیٰ مَلَّكَنَا ما هُو
أملَكُ بِهِ مِنّا كَلَّفَنا، وَمَتیٰ أخَذَهُ مِنّا وَضَعَ تَكلیفَهُ عَنّا». والإمام الصادق عليهالسلام أيضًا أكّد على مبدأ (توافق التكليف مع القدرة) .
الناس يميلون إلى ما هو ميسّرٌ ويرضون به، ويبتعدون عن كلّ ما هو شاقٌّ وصعب. يبدو أنّ المشكلة في هذا السياق ليست في طبيعة الدين ذاته، بل إمّا الجهل بحقيقة الدين والتصوّر الخاطئ عنه، وإمّا في طريقة التديّن لدى الناس، وإمّا في أسلوب تبليغ الدين. سنتحدث لاحقًا عن أسلوب التبليغ. ما يجب التركيز عليه هنا هو فهم الدين وطريقة التديّن الصحيحة. يجب أنْ يتطابق فهمنا للدين مع حقيقته، وهذا الجزء المهم يعتمد على أسلوب تبليغه؛ لذلك، يجب على الأفراد السعي لفهم حقيقة الدين، وكذلك على من تقع على عاتقهم مسؤولية تبليغ الدين أنْ يقدّموا الصورة الحقيقية للدين بشكلٍ صحيح.
من المثير للاهتمام أنّ هذه المسألة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ عدالة الله -الذي تمّت الإشارة إليه سابقًا-. فالذي يعتقد
بعدالة الله لا يظنّ أنّ تكاليفه تفوق طاقة الإنسان. وقد ورد في الروايات أنّ الله سبحانه وتعالى أعدل من أنْ يُكلِّف أحدًا بما يفوق قدرته.
الدين مجموعةٌ محدّدةٌ وغير قابلة للتغيير؛ لكن نمط تعامل الأفراد مع الدين يختلف. لذلك، فإنّ طريقة التديّن تُعدّ من العوامل المؤثّرة في الرضا أو عدم الرضا، وسنناقشها فيما يأتي.
في بعض الأحيان، يتصرّف المتديّنون بطريقةٍ تجعل الدين يبدو شاقًّا عليهم. إنّ ممارسة الدين بطريقةٍ متشدّدةٍ ومرهقةٍ تجعل الفرد يتعب ويُصاب بالإحباط، وتُبعد الآخرين عن الدين.
ومن المسائل التي أشارت إليها الروايات، هو التيسير في الدين وتجنّب التشدّد الزائد عن المطلوب. فلّما كان الدين ميسّرًا، وشريعته تتوافق مع قدرة الإنسان، فإنّ التزام المتديّنين به كما هو من دون زيادةٍ أو نقصانٍ لن يُدخلهم في مشقّة غير
معقولة. وقد عدّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أفضلَ وأحبَّ وأحسنَ التديّن عند الله هو التديّن السهل والميسر، الذي يتماشى مع طبيعة الدين نفسه. وقد أعلن صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه بُعث بشريعةٍ سهلةٍ ميسّرة، وعدّ التيسير الذي يتماشى مع طبيعة الدين سُنّةً من سُننه، وحذّر الناس من مخالفتها.
وأكّد في أحاديثه أنّ الدين يُسر، وأنّ من يشدّد على نفسه في الدين فإنّه سيُهزم.
يروي بريدة الأسلمي ويقول: خَرَجتُ ذاتَ یَومٍ لِحاجَةٍ فَإذا أنَا بِالنَّبِيّ -علیه الصلاةُ وَالسَّلامُ- یَمشي بَینَ یَدَيَّ، فَأَخَذَ بِیَدي، فَانطَلَقنا نَمشي جَمیعًا، فَإذا نَحنُ بَینَ أیدینا بِرَجُلٍ یُصلّي یُكثِرُ الرُّكوعَ وَالسُّجودَ، فَقالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أَتَراهُ یُرائي، فَقُلتُ: اللَّهُ وَرَسولُهُ أعلَمُ»، فَتَرَك یَدي مِن یَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَینَ یَدَیهِ فَجَعَلَ یُصَوِّبُهُما وَیَرفَعُهُما وَیَقولُ: «عَلَیكم هَدیًا قاصِدًا، عَلَیكم هَدیًا قاصِدًا، عَلَیكم هَدیًا
قاصِدًا، فَإنَّهُ مَن یُشّادُّ هٰذَا الدّینَ یَغلِبهُ».
ويروي محجن بن أدرع حادثةً مشابهةً، حيث قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَأى رَجُلًا يُصلّي فَتَراءاه بِبَصَرِهِ ساعَةً، فَقالَ: «أتَراهُ يُصلّي صادِقًا؟» قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، ذا أكثَرُ أهلِ المَدينَةِ صَلاةً! فَقالَ: «لا تُسمِعُهُ فَتُهلِكهُ». وَقالَ: «إنَّ اللَّهَ إنَّما أرادَ بِهٰذِهِ الاُمَّةِ اليسرَ وَلا يرِد بِهِمُ العُسرَ».
وفي روايةٍ أخرى، أنّ النَّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَخَلَ المَسجِدَ وَإذا هُوَ بِرَجُلٍ يُصلّي، فَقالَ لي: «مَن هٰذا؟» فَأثنَيتُ عَلَيهِ خَيرًا. فَقالَ: «اسكت لا تُسمِعهُ فَتُهلِكهُ». قالَ: ثُمّ أتىٰ حُجرَةَ امرَأةٍ مِن نِسائِهِ فَنَفَضَ يدَهُ مِن يدي قالَ: «إنَّ خَيرَ دينِكم أيسَرُهُ، إنَّ خَيرَ دينِكم أيسَرُهُ».
وفي رواية غاضرة بن عروة الفقيمي: أخبَرَني أبي قالَ: أتَيتُ المَدينَةَ فَدَخَلتُ المَسجِدَ وَالنّاسُ ينتَظِرونَ الصَّلاةَ، فَخَرَجَ عَلَينا رَجُلٌ يقَطّر رَأسُهُ مِن وُضوءٍ تَوَضَّأَهُ أو غُسلٍ اغتَسَلَهُ، صَلّىٰ بِنا، فَلَمّا صَلَّينا جَعَلَ النّاسُ يقومونَ إلَيهِ يقولونَ: يا رَسولَ اللهِ! أرَأيتَ كذا، أَرأيتَ كذا، يرَدّدُها مَرّاتٍ فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يا أيّها النّاسُ! إنَّ دينَ اللهِ في يسرٍ، يا أيّها النّاسُ! إنَّ دينَ اللهِ في يسرٍ».
لذا، فإنّ الدين سهلٌ وميسّر، ويجب أنْ يؤخذ بيسر. وأخذ
الدين بيسر يعني ألّا يُشدد بما يفوق ما ورد فيه. فإذا عرف الإنسان حقيقة الدين كما هو (معرفة الدين)، وعمل به بالقدر الذي أمر به (التدين)، فلن ينفر من الدين أبدًا، بل سيحبّه ويرضى به. إنّ العديد من حالات عدم الرضا عن التشريع، تنبع من الجهل بحقيقة الدين أو من التطبيق الخاطئ في التديّن. ويمكن تحقيق الرضا التشريعي من خلال تصحيح هذه الأمور.
كما أُشير سابقًا، فإنّ أساس التكاليف الإلهية هو خير الإنسان. لكن هذا الخير لا يتحقّق إلّا إذا طُبقت التكاليف. فمجرد تقدير الخير في التكاليف لا يكفي؛ بل يجب القيام بالطاعة وترك المعصية ليصبح الخير المقدّر في التكاليف واقعًا، ولتُثمر عن حياة طيِّبة.
غير أنّ الإنسان مزيجٌ من قوتين: العقل والجهل. وكلّ واحدةٍ منهما تسعى للسيطرة على كيانه. إنّ ازدواجية تأثير مراتب الروح الثلاث تُعزى إلى هذه الخاصية. في المعركة بين العقل والجهل، يكون المنتصر منهما هو المؤثّر على كلّ أنشطة الإنسان السلوكيّة والنفسيّة. وبناءً على ذلك، يستطيع الإنسان أنْ يسير في طريق الخير أو الشر.
الإنسان بطبيعته يفرّ من السلوكيّات التي تُسمّى طاعة،
وينجذب إلى تلك التي تُسمّى معصية. ولهذا السبب، فإنّ الجنة محفوفةٌ بالمكاره، والنار محفوفةٌ بالشهوات. ومن هنا تظهر أهمية السيطرة على النفس وتنظيم السلوك. وقد يكره الإنسان شيئًا وهو خير له، ويحبّ شيئًا وهو شرٌّ له.
ممّا سبق يتضح أنّ تحقيق الطاعة وترك المعصية يتطلبان السيطرة على النفس وتنظيم السلوك. فإذا كانت المعصية ممتعةً والطاعة شاقةً، فإنّ الحاجة إلى ضبط النفس وتنظيم السلوك تصبح مُلحّة. هذا هو ما يُعرف في الأدبيات الدينيّة بـ(التقوى). والسؤال هنا: كيف يمكن التغلّب على هوى النفس وتنظيم السلوك؟
العوامل التي تسهم في ضبط النفس، وتؤدّي إلى الطاعة وترك المعصية، هي من المسائل المهمّة التي لا يمكن تناولها بالكامل هنا. ويؤمن الباحث بأنّ السيطرة على النفس وتنظيم السلوك يتطلّبان قوة كبحٍ وقدرةٍ على ضبط النفس، وهو ما يُسمّى بـ(التقوى).
بطبيعة الحال، التقوى تنبع من مصدر يُعرف بـ(العقل). العقل
هو كيان مركّبٌ يجمع بين المعرفة والكبح، وهو ما يُسمّى في الأدبيات الدينيّة بـ(العلم والتقوى). يمكن القول إنّ نظريّة الدين في السيطرة على النفس وتنظيم السلوك تعتمد على ضبط النفس العقلاني. الإنسان الذي يتمتع بضبط النفس لديه القدرة على كبح السلوكيّات غير الملائمة، وتحفيز السلوكيّات المناسبة. ومن هنا يستطيع أنْ يسيطر على نفسه وينظم سلوكيّاته.
بالتأكيد، التقوى ليست عنصرًا عمليًّا قائمًا بذاته يمكن اعتباره بجانب الصفات الأخرى ليعمل مباشرة كأحد عناصر تنظيم السلوك. بل إنّ التقوى مفهومٌ عامٌّ ومجردٌ يتألّف من مجموعةٍ من العناصر التي تعمل على تنظيم السلوك. بناءً على ذلك، على الرغم من أنّ التقوى تُعدّ عاملًا لضبط النفس وتنظيم السلوك، فإنّها مفهومٌ شاملٌ يتضمّن مجموعةً من القوى التنفيذيّة التي تتدخّل في المواقف المختلفة لضبط السلوك وتنظيمه. وتُعرف هذه الأمور باسم (الأصول). لذا، فإنّ أصول ضبط النفس وتنظيم السلوك هي العناصر التنفيذية والعملية للتقوى. وتشمل هذه الأصول: التجربة، والعبرة، والحزم (بُعد النظر)، والخوف، والرجاء، والحياء، والمحبة، والشكر.
من العوامل المهمّة في الرضا الإيمان بالخير. وكما أُشير سابقًا في بناء مفهوم الرضا، فإنّ تقديرات الله سبحانه وتعالى
كحقيقة قائمة، تجري في الأبعاد الثلاثة للحياة: المعيشة، والعلاقات الاجتماعيّة، والنظام السياسي. ومن ثمّ، لتحقيق الرضا، يجب على الفرد أنْ يحدّد موقفه تجاه هذا العنصر المهم.
سبق أنْ ذُكر أنّ الرضا يتألّف من: أوّلًا، المطابقة؛ أي توافق الحالة الحالية مع الحالة المتوقّعة، ثانيًا، القبول؛ أي قبول الوضع الراهن والاستسلام له، وثالثًا، السرور؛ أي الشعور بالفرح أو على الأقل عدم الشعور بالضيق. كما تم توضيح أنّ (الخير المدرَك) يشكل الأساس النظري للرضا في الإسلام؛ أي أنّ استناد الحياة إلى الخير الحقيقي يُشكّل أساس الرضا. هذا يعني أنّ النظام النفسي للإنسان مصممٌ بطريقةٍ تجعل الشعور بالرضا يُثار تجاه الخير المدرك. بناءً على ذلك، فإنّ «الخير المدرَك» هو الأساس النظري للشعور بالرضا. إذا قيّم الفرد حياته على أنّها حياةٌ جيدة، سيشعر بالرضا.
علاوة على ذلك، أُشير سابقًا إلى أنّ قضاء الله دائمًا مبنيٌّ على الخير، وأنّ الخير هو أساس الرضا. فإذا أدرك الفرد هذا الخير واعتقد به، فإنّ الرضا سيتحقّق. هنا تتشكّل مساحة العمل ودور الفرد، وهنا أيضًا دور المستشارين الذين يسهمون في هذا المجال. إذا استطاع الفرد، سواء بمفرده أم بمساعدة الآخرين، إدراك الخير في قضاء الله، سيشعر بالرضا.
العديد من مشاعر عدم الرضا تنشأ من عدم إدراك الخير
(169)في ما يحدث. فالأفراد غير الراضين يعدّون ما يحدث لهم (الأحداث)، أو ما يتوجب عليهم فعله (التكاليف) شرًّا، وبالتالي يشعرون بعدم الرضا. وهذا يتعارض مع الحقيقة. فعدم الرضا هنا ناتجٌ عن عدم التوافق بين معرفة الفرد والواقع.
لذلك، نظرًا لأنّ قضاء الله دائمًا مبنيّ على الخير، فإنّ طريق تحقيق الرضا يكمن في تنسيق معرفة الفرد مع الواقع. الواقع الإلهي ثابت وغير قابل للتغيير؛ لذا، لا يمكن تغييره ليوافق رغبات البشر لتحقيق الرضا؛ بل يجب تعديل معرفة البشر - التي يمكن تغييرها - لتتوافق مع الواقع، ومن ثم ينشأ الشعور بالرضا. ويتطلب تحقيق هذا التوافق فهم وإدراك خير قضاء الله.
في هذا النقاش، نحن بحاجةٍ إلى عدّة أمورٍ أساسيّة: أوّلًا، أنْ نعرف ما هو وجه الخير في أقدار الله. ثانيًا، أنْ نتعرّف على مصاديق الخير الملموسة في الحياة. ثالثًا، أنْ نفهم أي نظام تقييم يمكن أنْ يؤدّي إلى الإيمان بالخير.
سبق أنْ تناولنا الجوانب النظريّة لهذه الأسئلة الثلاثة المهمّة. الإجابة عن السؤال الأول هي أنّ فلسفة أقدار الله تعالى في ضوء المصادر الإسلاميّة هي نمو الإنسان وتكامله الروحي. الله يقدّر أقدارًا مختلفةً تناسب كلّ فردٍ ليقوده إلى النموّ والتكامل الروحي. أمّا السؤالان الآخران فقد تمّ الإجابة عنهما في الفصل الثالث (المتطلبات الأساسيّة). من ناحية أخرى، تم تعريف
(170)الخيرات بشكلٍ واضحٍ في المصادر الإسلاميّة. معرفة هذه الأمور يمكن أنْ تساعد الإنسان على الإيمان العام بخيرية القدر، ومعرفة الخيرات الحقيقيّة التي تشكّل تلك الأقدار. الاطلاع على قائمةٍ شاملةٍ لهذه الخيرات يساعد الفرد على التعرّف على الخير الكامن في أقدار الله تعالى. ومن ناحيةٍ أخرى، هناك نظام تقييم الإنسان الذي إذا كان موجّهًا نحو الخير، يمكنه التعرّف على خيرات القدر. عندما تجتمع هذه العناصر الثلاثة، يتحقّق الإيمان بالخير.
لتحقيق الإيمان بالخير، يجب أنْ يكون الفرد على يقين من خيريّة القدر. ولهذا الغرض، يجب توضيح وجه الخير له. سبق أنْ أشرنا إلى أنّ قضاء الله تعالى دائمًا ما يستند إلى الخير، وأنّ الخير هو أساس الرضا. إذا تعرّف الفرد على هذا الخير وآمن به، يتحقّق الرضا. وهنا تظهر أهميّة دور الفرد وتدخل المستشارين. إذا استطاع الفرد، بمفرده أو بمساعدة الآخرين، فهم خيرية قضاء الله، سيشعر بالرضا. هذا ما نُطلق عليه (الإيمان بالخير).
كثير من مشاعر عدم الرضا تنبع من عدم فهم خيرية الأقدار. الأفراد غير الراضين ينظرون إلى ما قدّره الله لهم (الأحداث) أو ما فرضه عليهم (التكاليف) على أنّه شر، وبالتالي يشعرون بعدم الرضا. في حين أنّ الواقع ليس كذلك. هذا الشعور بعدم الرضا
(171)ينشأ نتيجة عدم التوافق بين معرفة الفرد والواقع.
في هذا النقاش، نحتاج إلى معرفة وجه الخير في أقدار الله، وقلنا إنّ قضاء الله دائمًا ما يستند إلى الخير كحقيقةٍ واقعية. ولكن السؤال الذي يُطرح هنا هو: ما هو وجه الخير في أقدار الله؟
معرفة وجه الخير في أقدار الله يمكن أنْ تمهّد للإيمان بالخير، وتكون سببًا في تحقيق الرضا. فيما يأتي، سنتناول وجه الخير في الأنواع الثلاثة للأقدار: (الابتلاء، والمال، والتكليف).
أحد عوامل زيادة عدم الرضا هو الشعور بعدم جدوى الأحداث. إذا قُيّمت الحوادث غير السارّة في الحياة على أنّها بلا معنى وعديمة الجدوى، فإنّها تصبح غير قابلةٍ للتحمّل. الأشخاص الذين يفقدون صبرهم أثناء الشدائد لا يرون فقط تلك الحالات بلا معنى، بل يقيّمونها أيضًا بنحوٍ سلبي. غالبًا ما يصف هؤلاء الأشخاص المصاعب بأنّها غير عادلة، ومعاناة ومن دون سبب، ولا جدوى، وأنّها عوائق، وأحيانًا إهانة. من الواضح أنّ مثل هذا التصور يزيد من الضغط النفسي ويقلّل من مستوى الصبر والرضا.
المظاهر غير السارّة تحمل طابعًا مريرًا في الظاهر، لكنّها
(172)تحتوي على جانبٍ لطيفٍ في الباطن. إذا نظرنا إلى ظاهرها، فإنّها قد تكون غير مرضية، لكن النظر إلى باطنها يجلب الصبر ويزيد من الرضا. جميع الأمور غير السارّة بالنسبة للمؤمن تحمل أهدافًا وحِكمًا تؤدي إلى الخير والصلاح، ويُشار إلى هذه الحِكم بـ(المعنى). إذا تم فهم المعنى الحقيقي للأمور غير السارّة، تزول مرارتها الظاهرة. لذلك، التركيز على هذا الجانب من الأمور غير السارّة في الحياة يؤدّي إلى الرضا. ولهذا السبب، تتكرر الإشارة إلى فوائد البلايا والمصائب في العديد من الآيات والروايات الإسلاميّة.
ثم إنّ الأبعاد الإيجابيّة للبلايا تشتمل على عدة أمور: تعزيز العلاقة مع الله تعالى، وحفظ الدين والإيمان، وتطهير الذنوب، ورفع الدرجات، ونيل الثواب الأخروي.
العلاقة مع الله من احتياجات الإنسان الأساسية، ومن العوامل المهمة للسعادة والبهجة؛ لكن هذه العلاقة غالبًا لا تتحقّق في الظروف العادية؛ لذلك، يهيّئ الله تعالى من خلال المصاعب والشدائد فرصةً للعودة إليه، وتعزيز العلاقة معه. يقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا رأيتم الرجل ألمَّ الله به الفقر والمرض، فإنّ الله تعالى يريد أن يصافيه».
لذلك، لا ينبغي أنْ تكون المصيبة سببًا للضيق، ولا النعمة سببًا للفرح فقط.
من الفوائد الأخرى للبلايا هو حفظ الدين. البشر لديهم خصائص وقدرات مختلفة، فبعضهم يفقد إيمانه في الفقر، لذلك يكون الغنى وسيلةً لحفظ دينهم. بينما آخرون يفقدون إيمانهم في الغنى، لذلك يكون الفقر والحرمان مفيدًا لهم.
قال الإمام الصادق عليهالسلام في ردّه على سؤال كافرٍ عن سبب تفاوت الفقر والغنى، مشيرًا إلى قدرات الأفراد ومدى تأثّر دينهم : «وَوَجهٌ آخَرُ: فَإنَّهُ عَلِمَ احتِمالَ كلِّ قَومٍ فَأَعطاهُم عَلىٰ قَدرِ احتِمالِهِم، وَلَو كانَ الخَلقُ كلُّهُم أغنِیاءَ لَخَرِبَتِ الدُّنیا، وَفَسَدَ التَّدبیرُ، وَصارَ أهلُها إلَى الفَناءِ، وَلكن جَعَلَ بَعضَهُم لِبَعضٍ عَونًا، وَجَعَلَ أسبابَ أرزاقِهِم فی ضُروبِ الأَعمالِ وَأنواعِ الصِّناعاتِ؛ وَذٰلِك أدوَمُ فِي البَقاءِ وَأصَحُّ فِي التَّدبیرِ. ثُمَّ اختَبَرَ الأَغنِیاءَ بِالاِستِعطافِ عَلَى الفُقَراءِ. كلُّ ذٰلِك لُطفٌ وَرَحمَةٌ مِنَ الحَكیمِ الَّذي لا یُعابُ تَدبیرُهُ».
نقل الإمام الباقرعليهالسلام في حديثٍ عن بعض ما ورد في المعراج: «لَمّا أُسرِيَ بِالنَّبِيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قالَ: یا رَبِّ! ما حالُ المُؤمِنِ عِندَك؟ قالَ: ... وَإنَّ مِن عِبادِيَ المُؤمِنینَ مَن لا یُصلِحُهُ إلَّا الغِنىٰ، وَلَو صَرَفتُهُ إلىٰ غَیرِ ذٰلِك لَهَلَك؛ وَإنَّ مِن عِبادِيَ المُؤمِنینَ مَن لا یُصلِحُهُ إلَّا الفَقرُ، وَلَو صَرَفتُهُ إلى غَیرِ ذٰلِك لَهَلَك».
لذلك، قد لا تُستجاب دعوات المؤمن لزيادة المال والثروة. ولا ينبغي عدّ هذا نوعًا من الحرمان. وبالتالي، فإنّ مثل هذه الحرمان يعدّ من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى؛ لأنّها على الرغم من تسبّبها في بعض المشكلات الصغيرة، إلّا أنّها تضمن السعادة الحقيقيّة والأصيلة للإنسان. من هنا، أحيانًا يجب أنْ تكون السعادة الحقيقيّة في الفقر وليس الغنى، وأن يكون القلق الحقيقي من الغنى وليس الفقر.
ذهب عبد الله بن حوالة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يشتكي الفقر وقلة المال. فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أبشِروا! فَوَاللَّهِ لَأَنَا بِكثرَةِ الشَّيءِ أخوَفُني عَلَیكم مِن قِلَّتِه».
هذه الخشية هي خشية على الدين، فقد يكون الغنى سببًا لهلاك الدين، ومن هنا يصبح الفقر مصدرًا للبشرى.
قد يقع الإنسان في زلّات وأخطاء يكون بقاؤها للحساب في الآخرة أمرًا شديد الصعوبة. إذا أمكن تسوية الذنوب في هذه الدنيا، فإنّ ذلك نجاح عظيم. ويتمّ هذا من خلال البلاء والمصائب.
«لَمّا نَزَلَت هٰذِهِ الآیة: ﴿مَن یعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ﴾، قالَ بَعضُ أصحابِ رَسولِ اللَّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أشَدَّها مِن آیَةٍ! فَقالَ لَهُم رَسولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما تُبتَلونَ في أموالِكم وَأنفُسِكم وَذَراریكم؟ قالوا: بَلى. قالَ: هٰذا مِمّا یَكتُبُ اللَّهُ لَكم بِهِ الحَسَناتِ وَیَمحو بِهِ السَّیئاتِ».
صعوبة البلاء هي صعوبة التخلّص من الشوائب، والتطهّر يستحق تلك الصعوبات. فالبلاء أشبه بالفرن الذي يُزيل شوائب الإنسان. إنّ ارتقاء قيمة الإنسانية يتم عبر البلاءات، ومن خلال البلاءات والمصائب، تُطهَّر من الذنوب -التي هي شوائب قيمة الإنسانية-، وأحيانًا أمور بسيطة مثل: الخوف في
المنام، أو إصابة الجسد، أو التعرّض للأذى، أو التعثر، أو الضيق، أو الفقر، أو تمزّق رباط الحذاء، وأشياء من هذا القبيل، تغسل روح الإنسان وجسده من أثر الذنوب .
اللافت أنّ البلاءات والمصائب تعدّ علامةً على كرامة الإنسان عند الله، وليس كما يظنّ البعض أنّ المُصاب بها مطرودٌ من الله، وصاحب النعمة محبوبٌ عنده. شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، قَالَ : يَا رَبِّ، يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يُؤْمِنُ بِكَ، وَيَعْمَلُ بِطَاعَتِكَ فَتُزْوِي عَنْهُ الدُّنْيَا، وَتَعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَكْفُرُ بِكَ، وَيَعْمَلُ بِمَعَاصِيكَ فَتُزْوِي عَنْهُ الْبَلَاءَ، وَتَعْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا. فَأَوْحَى الله (عَزَّ وَجَلَّ) إِلَيْهِ: «... وَأَمَّا عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ فَلَهُ سَيِّئَاتٌ؛ فَأَزْوِي عَنْهُ الدُّنْيَا وَأُعْرِضُ لَهُ ابْتِلَاءً حَتَّىٰ يَأْتِيَنِي فَأُجْزِيَهُ بِحَسَنَاتٍ. وَأَمَّا عَبْدِيَ الْكَافِرُ فَلَهُ حَسَنَاتٌ؛ فَأَزْوِي عَنْهُ الْبَلَاءَ وَأُعْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنِي فَأُجْزِيَهُ بِسَيِّئَاتِهِ».
وروي أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا لَهُ؛ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ. فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وَیحَك، وَما یُدریك لَو أنَّ اللَّهَ ابتَلاهُ بِمَرَضٍ یُكفِّرُ بِهِ مِن سَیِّئاتِهِ».
البلاء للمؤمن حلو ومفيد، وإنْ كان ظاهره مرًّا. من لا يرى معنى للبلاءات فلا إيمان له. فالذين لا يستطيعون تحمّل المصائب هم من ليس لديهم إجابة عن لماذا البلاء. فإذا عرف الإنسان الإجابة، هدأت نفسه ولم يجزع. وقد لخّص الإمام الصادق عليهالسلام الكلام كلّها في هذه العبارة القصيرة: «لِلهِ فِي السَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّفَضُّلِ، وَفِي الضَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّطَهُّرِ».
وفي هذا الحديث، يشير الإمام إلى البلاء على أنّه نعمة، نعمة التطهّر من الذنوب؛ لذلك، فإنّ البلاءات ليست موضع شكوى ونحيب، بل هي موضع حمدٍ وثناء.
واللافت أنّه في بعض الروايات، أشير إلى هذا الموضوع
(البلاء كوسيلة للتطهّر) على أنّه (خير)، ممّا يدلّ على أثره في تحقيق الرضا.
من فوائد المصائب والشدائد، رفع الدرجة. فالبلاءات ليست دائمًا دليلًا على وجود ذنب، بل أحيانًا يبتلي الله العبد ليرفع درجته. وهنا يتضح سرّ ابتلاء الأنبياء وأولياء الله بالشدائد. فالبلاءات بالنسبة لهم، وهم المعصومون، ليست تطهيريّة، بل ترفيعيّة.
في القرآن الكريم، هناك آية تقول: ﴿وَما أَصَبَكم مِّن مُّصِيبَة فَبِمَا كسَبَتْ أَيدِيكمْ﴾، ولكن من جهة أخرى، نجد أنّ أهل البيت عليهمالسلام -مع كونهم معصومين- قد تعرضوا لكثيرٍ من المصائب والشدائد.
هذا السؤال أثاره أحد أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام، فقال: هل ما أصاب أمير المؤمنين عليهالسلام وأولاده من بعده كان بسبب أعمالهم، وهم أهل البيت المعصومون الطاهرون؟ فأجاب الإمام عليهالسلام: «إنَّ اللَّهَ (عزّ وجلّ) يخُصُّ أولِياءَهُ بِالمَصائِبِ لِيأجُرَهُم مِن غَيرِ ذَنبٍ». وهنا لا يتعلّق الأمر بالذنوب، بل يتعلّق بمقامات
في الجنة لا تُنال إلّا عبر هذا الطريق.
ذات يوم، مرضَ النبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بشدّة حتى كان يتلوّى من الألم ويئن. فقالت عائشة، وقد تعجبت من حاله: لو أنّ أحدنا فعل ذلك، لانتقدته. فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنَّ الصّالِحینَ یُشَدَّدُ عَلَیهِم، وَإنَّهُ لا یُصیبُ مُؤمِنًا نَكبَةٌ مِن شَوكةٍ فَما فَوقَ ذٰلِك إلّا حَطَّت بِهِ عَنهُ خَطیئَةً، وَرُفِعَ بِها دَرَجَةً».
هذه الأنواع من البلاءات ليست خاصةً بالمعصومين عليهمالسلام. فأحيانًا يُبتلى أهل الإيمان بمثل هذه البلاءات، حتى وإنْ كان لديهم ذنوب. السبب هو أنّ بعض المقامات لا تُنال إلّا عبر هذا الطريق. الموضوع ليس ما فعله الشخص ليصيبه البلاء، بل ما يُراد له أنْ يناله من المقامات العظيمة.
في الحقيقة، هذه البلاءات تكون تعويضًا لنقص الأعمال الصالحة لدى بعض الأفراد. فأحيانًا يقدّر الله مقامًا لعبد من عباده، ولا تكون أعماله كافيةً للوصول إلى هذا المقام. في هذه
الحالة، يُكمل الله هذا النقص من خلال البلاءات والمحن. فإذا صار الألم وسيلةً لرفع الدرجة ونيل المقامات العليا، أصبح تحمّله ممكنًا.
الألم الذي لا يجلب ثمرةً ولا مكافأةً هو ألمٌ مرهقٌ ومؤلم. إذا تم تقييم الوضع غير السارّ على أنّه بلا نتيجة أو مكافأة، فإنّه يصبح غير قابلٍ للتحمّل. أحد التصوّرات البشريّة هو أنّ المصاعب بلا مكافأة، وهذا التقييم يزيد من الاستياء. لكن الحقيقة أنّ مصاعب المؤمنين تحمل أجرًا وثوابًا. المكافأة على المصاعب من المبادئ الثابتة في الإسلام، ولكن المهمّ هو أنّ إدراك هذه الحقيقة يخفف من الاستياء. ما يحقّق الرضا هو الانتباه إلى هذه الحقيقة والإيمان بها. عندما سُئل الإمام الصادق عليهالسلام، من قبل كافرٍ عن سبب الفقر والغنى، أجاب أنّ أحد الأسباب هو هذا المبدأ.
عندما يعتقد الإنسان أنّه سينال مكافأةً على كلّ مصيبةٍ يتحمّلها، فإنّه يرضى. الإنسان على استعداد لتحمّل المصاعب للوصول إلى مكاسب أكبر؛ لذلك، يُخصَّص جزءٌ كبيرٌ من
القرآن والسنّة النبويّة لبيان مكافآت الصابرين. في الحقيقة، أحد العوامل التي تحفّز الرضا وتدعمه هو الثواب.
إنّ ابن أبي يعفور، عندما اشتد به المرض اشتكى من آلامه إلى الإمام الصادق عليهالسلام، فأجابه الإمام قائلًا: «لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب، لتمنى أنّه قُرِضَ بالمقاريض».
وعندما دفنوا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سمع أهل البيت عليهمالسلام نداءً من السماء يعزيهم، وفي جزءٍ من التعزية قيل :«إنَّ في اللهِ خلفًا من كلّ ذاهب، وعزاءً من كلّ مصيبة، ودركًا من كلّ ما فات. فبالله فثقوا، وعليه فتوكّلوا، وإيّاه فارجوا. إنّما المصاب من حُرم الثواب».
إذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة، فإنّ اعتقاده بأنّ الحرمان علامةٌ على الإذلال سيختفي. وروي عن الإمام الباقرعليهالسلام أنّه قال : «إذا كانَ یَومُ القِیامَةِ أمَرَ اللَّهُ تَبارَك وَتَعالى مُنادِیًا یُنادي بَینَ یَدَیهِ: أینَ الفُقَراءُ؟ فَیَقومُ عُنُقٌ مِنَ النّاسِ كثیرٌ. فَیَقولُ: عِبادي! فَیَقولونَ لَبَّیك رَبَّنا. فَیَقولُ: إنّي لَم أُفقِركم لِهَوانٍ بِكم عَلَيَّ، وَلكنَّني إنَّمَا اختَرتُكم لِمِثلِ هٰذَا الیَومِ، تَصَفَّحوا وُجوهَ النّاسِ فَمَن صَنَعَ إلَیكم
مَعروفًا لَم یَصنَعهُ إلّا فِيَّ فَكافوهُ عَنّي بِالجَنَّةِ».
هذا يعني مقام الشفاعة؛ فالأغنياء يدخلون الجنّة بشفاعة المحرومين. إذًا فقر الفقراء ليس نتيجةً لإهمال الله لهم. إنّ الانتباه إلى هذه الأمور يُظهر خيريّة البلاء ويؤدّي إلى الرضا.
ربّما يبدو النقاش حول كون المال خيرًا أمرًا غير ضروري؛ لأنّه قد يُقال إنّ أحدًا لا يشكّ في ذلك. ربّما يكون هذا صحيحًا، ولكن هذا جانبٌ واحدٌ من القصة. ليس من الضروري أنْ يكون المال خيرًا دائمًا؛ لأنّ مجرد امتلاك المال لا يجعله خيرًا؛ بل كيفيّة إنفاقه هي التي تظهر خيره. الامتلاك والإنفاق من دون ضوابط لا يجعلان الحياة جيدة. النموذج القائم على الامتلاك والإنفاق العشوائي قد يؤدّي أحيانًا إلى الشرّ، ويُشار إليه في الأدبيّات الدينيّة بـ(سنّة الاستدراج). في هذا النموذج، ينفق الفرد المال وفقًا لأهوائه دون اعتبار لهدف الحياة، ممّا يقوده تدريجيًّا إلى الضلال حتّى يواجه الهلاك فجأة. أمّا النموذج القائم على الامتلاك والإنفاق العقلاني، فإنّه يوجّه المال نحو ما يحقّق الخير والصلاح، ويقود الفرد إلى حياةٍ جيدة. لذلك، فإنّ
فهم خير المال يُعدّ أمرًا ذا أهمية.
المال هو هديّة من الله تعالى للإنسان، ليستخدمه في طريق النمو والكمال. ما يمنحه الله تعالى للإنسان ليس وسيلةً لتسيير أمور الحياة فقط، بل أيضًا وسيلة للنمو الروحي وإظهار الفضائل الإنسانيّة. في الحقيقة، المال هو ابتلاء واختبار يمكن للإنسان من خلاله تحقيق الخير في الدنيا والآخرة. في هذا السياق، يتمّ تناول وجه خير المال فيما يتعلّق بالنمو المادي والروحي للإنسان.
في النصوص الدينيّة، تمّت الإشارة إلى أمورٍ تتعلّق بخير المال، ومن أهمّها ما يلي:
في القرآن الكريم، تمّ التصريح بأنّ المال هو قوام الحياة، كما أنّ الروايات تدلّ على ذلك أيضًا.
امتلاك المال يزيد من إمكانية الحصول على الأجر والثواب.
فالشخص الثري، بالإضافة إلى ما يمكن أنْ يفعله الفقراء، يمتلك الفرصة لتحقيق الأجر من خلال المال. هذا الأثر يضمن السعادة الأخرويّة، التي تشكل جزءًا أساسيًّا من الحياة الأبديّة للإنسان. ومن ثمّ، يؤدّي المال دورًا مهمًّا في السعادة الحقيقيّة. بعض هذا الدور يتعلّق بالآخرة، وبعضه يتجلّى في الشعور الإيجابي في هذه الدنيا بسبب ما ينتظر في الآخرة.
التمتّع بالمال يتيح الاستفادة من المزيد من الإمكانيّات ويخفي عيوب الإنسان. هذا الأمر يستهدف الحياة الاجتماعية ويمنع نقصان مكانة الفرد وكرامته. وبالتالي، يسهم في ضمان العلاقات السليمة ويولد شعورًا بالسعادة.
ظهور بعض الفضائل الإنسانيّة يعتمد على المال. فإنّ أمورًا مثل: الإنفاق، والصدقة، والسخاء، والمروءة، ومساعدة الآخرين ونحو ذلك كلها من الفضائل الإنسانيّة المرتبطة بالمال. ومن اللافت أنّ جزءًا من الرضا يتحقّق من خلال الجمع بين التمتّع بالفضائل الإنسانيّة والتمتع بالمزايا المالية. ومن ثَمّ، يؤثر المال أيضًا على الرضا من هذا الجانب.
من بين آثار وبركات المال، الراحة النفسيّة. فالتمتع بالمال يُمكِّن الإنسان من توفير المزيد من الإمكانات لتحسين الحياة؛ ولهذا السبب، تزول المخاوف من الفقدان والحرمان، كما تخف حدّة أزمات الحياة إلى حدٍّ كبير. يعدّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم توفّر الرزق سببًا لطمأنينة النفس؛ لذلك، من بركات المال أنّه يوفّر الراحة النفسية للفرد.
يؤدّي سؤال (ما هي فلسفة التشريع؟) دورًا مهمًّا في تحقيق الرضا. فالتعرّف على آثار وفوائد الدين يزيل مشقّة التكليف ويمنح الإنسان النشاط والسرور؛ ولهذا، خصّصت بعض النصوص الدينيّة أقسامًا لشرح فلسفة التشريع. وفيما يأتي سنشير إلى أبرز هذه النقاط:
يُعرِّف القرآن الكريم الهدف الأساس للتشريع بأنّه إحياء الإنسان وإعطاؤه الحياة. فالله سبحانه وتعالى، بعد أنْ دعا الناس
إلى طاعته وطاعة رسوله، وحذّرهم من الإعراض عنهما، أكّد مرةً أخرى هذه الدعوة، وأوصى المؤمنين بالاستجابة لله ورسوله عند دعوتهم لما يحييهم. وأوضح أنّ حقيقة هذه الدعوة وركيزتها الأساسيّة هي إنقاذ الإنسان من الهلاك ومنحه الحياة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال: 24).
فسّر العلامة الطباطبائي قدسسره مفهوم (الحياة) في القرآن الكريم بثلاثة معانٍ أو مراتب: الحياة الدنيويّة، والحياة الأخرويّة، والحياة الطيِّبة. بناءً على ذلك، يرى أنّ الحياة في هذه الآية لا تشير إلى الحياة الدنيويّة فحسب، بل إلى الحياة الأخرويّة والحياة الطيِّبة أيضًا. ويشدّد على أنّ هناك حياةً حقيقيّةً للإنسان، أشرف وأكمل من الحياة الدنيويّة الدنيّة، ولا يصل إليها الإنسان إلّا عندما تكتمل استعداداته، وهذا الكمال يتحقّق بفضل الالتزام بالدين والانضمام إلى صفوف أولياء الله الصالحين، تمامًا كما يكتسب الجنين حياةً دنيويّةً من خلال تطوّر نطفته واكتمال استعداده.
يشير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ إلى استعداد الإنسان للوصول إلى تلك الحياة الحقيقيّة، ويدعو إلى العمل بالدعوة الحقّة للإسلام التي
تهدف إلى إعداد البشر لتلك الحياة. وهذه الحياة هي مصدر الإسلام، حيث ينبثق منها العلم النافع والعمل الصالح. ويؤكّد قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾، هذا المفهوم.
ختامًا، فإنّ الحياة المشار إليها في الآية: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ شاملةٌ لكلّ دعوات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم التي تُحيي القلوب، وللنتائج المترتبة على هذه الدعوات، بما في ذلك أنواع الحياة السعيدة الحقيقيّة، كالحياة الأخروية في جوار الله. بناءً على ذلك، لا ينبغي تقييد هذه الآية بمعنى محدّد.
اتّضح أنّ هذه الحياة -وهي السعادة الأصيلة والحقيقيّة للإنسان- تعتمد على عوامل أقرّها الله (عزّ وجلّ)، وأظهرها من خلال الشريعة، وجعل الإنسان مكلّفًا بها. وبالتالي، فإنّ هذه الشريعة والتكليف هما عاملان أساسيّان للحياة الأصيلة والسعادة الحقيقيّة للبشر، وإذا تمّ الانتباه إليهما، فإنّهما يحقّقان الرضا التشريعي.
قضاء الله التشريعي يشمل القوانين أو ما يُعرف بـ(الأوامر والنواهي). الأساس الذي يقوم عليه التشريع هو مصلحة
(188)الإنسان؛ ولهذا فإنّ سعادة الإنسان الحقيقيّة والأصيلة تعتمد على طاعته لهذه القوانين. وهذا قانون لا يتغير. من خلال الالتزام بقوانين الشريعة، يحالف الحظ الإنسان ويحقّق الفلاح. لذلك، يجب السعي نحو الطاعة لتحقيق الفلاح. وفي المقابل، فإنّ معصية الله تعالى تؤدّي إلى الشقاء. بناءً على ذلك، يُبدي الأفراد الواعون رغبتهم وسعادتهم تجاه الطاعة، وينفرون ويحزنون عند الوقوع في المعصية. وبالنظر إلى الحقائق والقوانين التي تحكم الكون، يجب على الإنسان أن يفرح بالأعمال الصالحة التي قدّمها مسبقًا، وأنْ يشعر بالحزن تجاه الفرص التي أضاعها.
أساس الأوامر والنواهي الإلهيّة هو المصلحة والمفسدة في
حياة البشر. الوصول إلى الحياة الأصيلة يتطلّب عوامل تُسمّى «المصلحة»، ولديه عوائق تُعرف بـ(المفسدة). أمر الله تعالى الإنسان بما فيه صلاحه، ونهى عمّا يضره. وقد وردت هذه الحقيقة بتعبيراتٍ متنوّعةٍ في النصوص الدينيّة. القرآن الكريم يعدّ المعروف والمنكر أساسًا للأوامر والنواهي الإلهيّة. كما يؤكد أنّ الله تعالى لا يأمر بالفحشاء؛ بل ينهى عنها، ويأمر بما هو حسن. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليهالسلام: «إنَّهُ لَم يَأمُرْكَ إلَّا بِحُسْنٍ وَ لَم يَنْهَكَ إلَّا عَنْ قَبِيحٍ». ويؤكّد الإمام الصادق عليهالسلام أيضًا أنّ الله تعالى لا يُصدر أيّ حكمٍ من دون حكمة.
بناءً على ذلك، فإنّ السعادة الحقيقيّة والحياة الأصيلة للإنسان هي معيار التكاليف الإلهيّة. أهم مراتب الحياة الأصيلة هي الحياة الأخرويّة، وما ورد من أوامر ونواهٍ إلهيةٍ يتعلّق بتحقيق هذه المرتبة من الحياة.
وثمّة مرتبة أخرى تتعلّق بالتكامل الروحي واكتساب الفضائل الأخلاقية. والوصول إلى هذه المرتبة من الحياة الأصيلة يحتاج إلى فهم المصالح والمفاسد الحقيقيّة، التي تتجلّى في أوامر الله تعالى ونواهيه، ممّا يتيح للناس من خلالها معرفة عوامل ومعوّقات النموّ الأخلاقي والتكامل الروحي.
تناولت النصوص الدينيّة فوائد الأوامر التشريعيّة، وقد وردت نصوصٌ عديدةٌ حول هذا الموضوع. ربما يكون من أبرز العناوين في هذا الشأن (الحصول على رحمة الله). نحن كائناتٌ ضعيفةٌ بحاجة إلى رحمة الله تعالى. يقول الله (عزّ وجلّ) في القرآن الكريم: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.
وثمّة عنوانٌ شاملٌ آخر هو (الحصول على ما عند الله)، بمعنى أنّ كلّ شيءٍ بيد الله، وللوصول إليه يجب المرور عبر
طريق الطاعة. يقول الإمام علي عليهالسلام في هذا الشأن: «وَٱطْلُبُوا مَا عِندَهُ بِطَاعَتِهِ، وَٱلْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ ٱلْخَيْرُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ».
من المثير للاهتمام في هذا الحديث أنّ الخير قد ذُكر كواحدٍ من المحاور الأساسية للرضا، وأنّ اكتسابه متوقف على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيما يأتي نستعرض بعض الجوانب التي وردت في النصوص الإسلاميّة:
في بعض النصوص، ذُكرت آثار للطاعة تتعلّق بالجوانب الروحيّة والمعنويّة للإنسان. من ذلك، يمكن الإشارة إلى (الملجأ المنيع). فمن الاحتياجات الجادّة للإنسان، وجود ملجإٍ آمنٍ، وهذا يتحقق في ظلّ طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن كان من أهل الطاعة، وضع نفسه تحت راية الله وجلب لنفسه عونه ودعمه.
كذلك، فإنّ الطاعة تُقرِّب الإنسان إلى الله، وتُثمر (المحبّة
مع الله). فالله (عزَّ وجلَّ) هو مُبدِئ الإنسان ومنشؤه، ولذلك فهو يحتاج إلى علاقةٍ قريبةٍ مع خالقه. والأهم هنا أنّ طاعة الله هي من الأمور التي تقرّب الإنسان إلى الله وتُوجِد هذه الصلة الحميمة معه.
ومن الآثار الأخرى للطاعة، (تذوّق حلاوة الإيمان). فمن طهر نفسه من الذنوب واقترب من الله بطاعته، وملأ قلبه بحبه، فإنّه ينال حلاوة العلاقة مع الله وفهمه له، وهي حلاوةٌ لا مثيل لها.
ومن الآثار الأخرى كذلك، (تكريم النفس). فلمّا كانت طاعة الله تشتمل على الأفعال الحسنة والقيمة، والمعصية تشتمل على الأفعال القبيحة وغير القيمة، فإنّ من كان من أهل الطاعة فإنّه يكرّم نفسه من خلال إلزامها بما هو قيم ورفيع. كما أنّ الله سبحانه وتعالى هو مصدر الكرامة والخير والبركة، فالاقتراب منه والاتصال به يُكرّم النفس ويمنحها شعورًا بالقيمة.
كذلك، أُشير إلى طاعة الله على أنّها (نور العين)، ممّا يدلّ على الأثر النفسي الإيجابي الذي تتركه في النفس. فمن يؤدي الطاعة يشعر بالنشاط والسرور، وكما يُقال تكون (قُرّة عينه).
من بين الآثار الدنيوية للطاعة يمكن الإشارة إلى (كفاية الأمور). فالحياة مليئةٌ بالاحتياجات المختلفة، ومن أفضل وأعظم المصادر التي يمكنها تلبية هذه الاحتياجات الله سبحانه وتعالى، ويمكن الوصول إلى هذا المصدر عبر الطاعة.
ومن الآثار الأخرى أنّ طاعة الله سبحانه وتعالى هي (مفتاح كلّ صلاحٍ، وإصلاح لكلّ فساد)، وتُخلّص الإنسان من الشرور وتمنحه كلّ خير وبركة. وفي مسيرة الحياة، قد يواجه الإنسان أمورًا تحتاج إلى تصحيحٍ وتسوية، ويتم ذلك من خلال الطاعة. ربما أحد الأسباب الرئيسة لذلك هو أنّ الطاعة أساسًا تُزيل المشكلات وتُبعد السيئات عن الإنسان. وربما لهذا السبب، وصفت الطاعة بأنّها (أقوى سبب).
ومن الآثار الأخرى، (إجابة الدعاء). فالدعاء هو وسيلة طلب من الله، وتحقيق هذا الطلب يعتمد على إجابة الله، وهذه الإجابة تعتمد على الطاعة.
من الآثار الأخرى للطاعة، (الشعبيّة الاجتماعيّة). من يتبع كلام الله تعالى يمنحه الله العِزّة، ويجعله محبوبًا بين الناس.
في مجال الآثار الأخروية، ذُكرت مجموعتان من الآثار؛ المجموعة الأولى تركز على (إخماد غضب الله)، و(مغفرة الذنوب)، مما يؤدّي إلى «الأمن من العذاب». أمّا المجموعة
[1]- النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «قالَ اللَّهُ -جَلَّ جَلالَهُ-: أیُّما عَبدٍ أطاعَني لَم أكلهُ إلىٰ غَیرِي، وأیُّما عَبدٍ عَصاني وَكلتُهُ إلى نَفسِهِ، ثُمَّ لَم أُبالِ في أيّ وادٍ هَلَك» [كتاب من لا یحضره الفقیه، ج٤، ص٤٠٣، ح٥٨٦٩].
عن الإمام الصادق عليهالسلام: «مَن أطاعَ اللّهَ (عزّ وجلّ) فیما أمَرَهُ، ثُمَّ دَعاهُ مِن جِهَةِ الدُّعاءِ أجابَهُ» [الكافي، ج٢، ص٤٨٦، ح٨].
[2]- عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنَّ العَبدَ إذا عَمِلَ بِطاعَةِ اللِه أحَبَّهُ اللّهُ، فَإذا أحَبَّهُ اللّهُ حَبَّبَهُ إلیٰ خَلقِهِ، وإذا عَمِلَ بِمَعصیَةِ اللهِ أبغَضَهُ اللّهُ، وإذا أبغَضَهُ اللّهُ بَغَّضَهُ إلیٰ خَلقِهِ» (كنز العمّال، ج١٦، ص١٢٥، ح٤٤٢٥٦).
[3]- عن الإمام علي عليهالسلام: «الطّاعَةُ تُطفِئُ غَضَبَ الرَبِّ» [غرر الحكم، ح١٢٤٣].
[4]- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (نوح: ٢-٤).
﴿وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحجرات: ١٤).
[5]- ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (النمل: ٨٩).
الإمام علي عليهالسلام: «إنّ أنصَحَكم لِنَفسِهِ أطوَعُكم لِرَبِّهِ وأغَشَّكم لِنَفسِهِ أعصاكم لِرَبِّهِ، ومَن یُطِعِ اللّهَ یَأمَنْ ویَستَبشِرْ، ومَن یَعصِ اللّهَ یَخِبْ ویَندَمْ» [الكافي، ج١، ص٤٥، ح٦].
الثانية فتؤكّد على (الثواب الإلهي)، و(دخول الجنة). هاتان المجموعتان معًا ترسمان أفضل صورةٍ للحياة الأبديّة للإنسان.
ممّا تقدّم، يتضح أنّ طاعة الله تعالى لها آثار وفوائد قيّمة للإنسان. إذا وصل الإنسان إلى قناعة بأنّ الطاعة ليست لله وإنّما له هو نفسه، فلن يشعر بعدم الرضا عند القيام بها. في هذه النصوص، تمت الإشارة بنحوٍ عام إلى آثار طاعة الأوامر الإلهية. وقد حدّدت بعض النصوص بنحوٍ خاصٍّ حكمة تشريع بعض التكاليف، وهذا ما يُعرف بـ(علل الشرائع). وبناءً على ذلك، قام الشيخ الصدوق (رحمه الله) بتأليف كتابٍ يحمل هذا الاسم.
إنّ تناول هذه الجوانب بشكلٍ مفصّلٍ يتجاوز نطاق وحدود هذا البحث. في كلّ حالةٍ قد يواجه فيها الفرد مشكلة، ينبغي توضيح حكمتها. وبناءً عليه، يحتاج الإنسان إلى طاعة الله تعالى لتلبية احتياجاته. يقول لقمان الحكيم لابنه: «أطِعِ اللّهَ بِقَدرِ حاجَتِك إلَيهِ».
رغم أنّ المعصية تحمل لذّة، إلا أنّ نتيجتها ليست سوى (الإساءة للنفس). هذه قاعدةٌ أساسيةٌ في حياة الإنسان. ولهذا يؤكد القرآن الكريم أنّ الله لا يظلم أحدًا. وبناءً على ذلك، يشير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أنّ الإنسان العاصي لا يسيء إلّا لنفسه ولا يضرّها إلّا بيده. ويؤكّد الإمام علي عليهالسلام أيضًا هذه النقطة، ببيان أنّ ارتكاب المعصية وترك الطاعة هو سبب الخسران. يروي الإمام الصادق عليهالسلام: «كتَبَ رَجلٌ إلىٰ أبي ذَرٍّ (رضي الله عنه): یا أبا ذَرٍّ! أطرِفني بِشَيءٍ مِنَ العِلمِ، فَكتَبَ إلَیهِ: إنَّ العِلمَ كثیرٌ، وَلكن إنْ قَدَرتَ ألّا تُسِيءَ إلى مَن تُحِبُّهُ فَافعَل. قالَ: فَقالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَهَل رَأیتَ أحَدًا یُسيءُ إلىٰ مَن یُحِبُّهُ؟! فَقالَ لَهُ: نَعَم، نَفسُك أحَبُّ الأَنفُسِ إلَیك، فَإذا أنتَ عَصَیتَ اللَّهَ فَقد أسَأتَ إلَیها».
وأكدّ نبيُّ الله سليمان عليهالسلام هذه القاعدة، وشبّه نبيُّ الله عيسى عليهالسلام عدم ضرر المعصية لله تعالى، بعدم تضرر البحر بغرق السفينة فیه.
لذلك، فإنّ ترك المعصية مكسبٌ كبيرٌ يحمل آثارًا إيجابيّةً عديدة. في بعض الروايات، تم ذكر آثار إيجابيّة لترك الذنب، من بين هذه الآثار، عَدُّ ترك الذنب حسنة. ولهذا، فإنّ الله تعالى يعدّ ترك الذنب حسنة، أي يكون تارك الذنب كأنّه من المحسنين.
أثر آخر هو (مغفرة الذنوب)، فمن يترك الذنب يغفر الله له ذنوبه. ومن الفوائد الأخرى لترك المعصية يمكن الإشارة إلى
مضاعفة ثواب الحسنات، ورفع الدرجات، وتذوّق حلاوة العبادة، وتيسير الموت، والحصول على الجنة.
تطرّقت النصوص الدينيّة إلى أمثلةٍ متعددةٍ تُظهر أنّ القضاء التكويني والتشريعي لله تعالى (بأنواعه) يحمل الخير، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. والسؤال هو: ما النظريّة التي يمكن أنْ تفسِّر هذه الأمور؟ يبدو أنّ الأساس النظري لكلّ هذه الأمور هو (نمو الإنسان وتكامله)، أو ما يمكن تسميته (التوحيد المتفتّح).
الإنسان كائنٌ يمتلك قدراتٍ متعددةً يجب أنْ تتفتح وتصل إلى الكمال. بالطبع، هذا النموّ والتفتح يتماشى مع فلسفة خلق الإنسان، وهي التوحيد. النموّ والتكامل الأساس للإنسان هو أنْ يتجاوز أمورًا كالدنيا ونفسه (الابتعاد عن غير الله) ليصبح إلهيًّا،
وهو ما يُسمّى (النموّ التوحيدي)، أو (التفتّح التوحيدي). من الممكن للإنسان أنْ يصبح مخلوقًا شيطانيًّا ونفسيًّا أيضًا. ولهذا السبب، الأهم هو أنّ الاستعداد لأنّ يصبح إلهيًّا موجودٌ في الإنسان، ولإطلاق هذا الاستعداد تم وضع النعمة، والمصيبة، والتكليف.
في الحقيقة، أحيانًا يمنح الله النعمة لينمّي التوحيد في جانب النعم والفرح، فيرى الإنسان أنّ كلّ شيءٍ من الله ويستخدم هذه النعم في سبيل نموّه وتكامله. وأحيانًا يرسل المصائب لينمي التوحيد في جانب المصائب، ويثبت التزامه بعهده مع الله، حتى لو كان ذلك مع وجود المصائب. المصيبة يمكنها أنْ تعيد الإنسان المخطئ إلى الله، وتطهّره، وتحفظ دينه، وترفع درجته. ذلك كلّه يصب في مسار النموّ التوحيدي.
كذلك، من خلال تكليفه بأمورٍ يكرهها، ونهيه عن أمورٍ يرغب فيها، تُنمّى محورية الله في الإنسان، ليتبيّن ما إذا كان مستعدًا للتخلّي عن كلّ شيءٍ من أجل الله. السمة المشتركة في ذلك كلّه هي أنّ الإنسان مستعدٌّ للتخلّي عن جميع إغراءات الدنيا وميول النفس، ليرى الله وحده. هذا هو قمة النموّ والتكامل للإنسان. في الراحة واليسر لا تتفتّح القدرات الكامنة للإنسان.
يقول الشهيد مطهري في هذا الصدد: «القبح تمهيدٌ لوجود الجمال وهو خالقه ومبدعه. في بطن المصائب والمآسي تختبئ
السعادة والنعيم». الإنسان كائنٌ يمتلك قدراتٍ واستعداداتٍ عديدة يجب أنْ تتطوّر لتحقيق السعادة والرخاء، وتتحوّل من القوة إلى الفعل. ما يهيّئ لهذا الأمر هو الصعوبات والمصائب، والمكان الذي يحدث فيه هذا التحوّل هو الدنيا. أساس وجود الدنيا هو تربية القدرات الكامنة للإنسان. هذا هو معنى أنّ الدنيا مقدّمةٌ للآخرة.
الآخرة، سواء الجنّة أم النار، هي مكان لظهور (القدرات المتطوّرة)، وليس فيها مجال للقدرات الكامنة. لذلك خُلقَت الدنيا لتكون ورشةً لتطوير القدرات وإظهار الإمكانيّات، وأدواتها هي الامتحانات والابتلاءات. يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس: 7-8). أنْ يصبح الإنسان شيطانًا أو ملاكًا يعتمد على كيفية بناء نفسه. ما يهيّئ لهذه المهمة هو المواقف المرّة والحلوة التي تدفع البشر إلى التفاعل. ولهذا السبب خلق الله الإنسان في كَبَد: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.
يرى الشهيد مطهري: «أنّ هذه الخاصية تتعلّق بالكائنات الحية، وخصوصًا الإنسان، حيث إنّ الصعوبات والمحن مقدمةٌ لتحقيق الكمالات والتقدّم. فالضربات تدمّر الجمادات وتُضعف قدرتها، لكنها تحفز الكائنات الحيّة وتقويها. (كم
من زيادةٍ تأتي من النقصان). المصائب والشدائد ضروريّة لتكامل الإنسان. إذا لم تكن هناك محن ومصاعب، سيهلك الإنسان... يجب على الإنسان أنْ يتحمل المشقّات ويكابد الصعوبات ليكتشف وجوده اللائق. التناقض والصراع هما السوط الذي يحفّز الكمال. تسير الكائنات الحية نحو الكمال بهذا السوط».
وهذا هو ما يُشار إليه في الأدبيات الدينيّة بـ(الابتلاء). الدنيا وحياتها خُلقت للاختبار، والاختبار يهدف إلى بناء شخصية الإنسان. في هذه الحياة توجد صعوباتٌ تدفع الإنسان إلى التفاعل، وطريقة تفاعله تكشف عن إمكاناته الكامنة. الصبر هو ردّ الفعل المنطقيّ والإيجابيّ الذي يُنمّي الإنسانية؛ ولهذا يُبشّر به.
ويؤكّد الإمام الصادق عليهالسلام مبدأ أنّ الحرمان المادي وسيلةٌ لاختبار الفرد بقوله: «ما أُعطِي عَبدٌ مِنَ الدُّنیا إلَّا اعتِبارًا، وَمَا زُوِيَ عَنهُ إلَّا اختِبارًا»[4]. كما يشير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى غاية الابتلاء والآثار المترتبة على طريقة التعامل معه بقوله: «إنَّ اللَّهَ تَعالى لَيبتَلِي العَبدَ بِالرِّزقِ لِينظُرَ كيفَ يعمَلُ؛
فَإنْ رَضِيَ بورِك لَهُ، وَإنْ لَم يرضَ لَم يُبارَك لَه».
وينقل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الله سبحانه قوله:
«لَولا أنّي أستَحيي مِن عَبدِىَ المُؤمِنِ، ما تَرَكتُ عَلَیهِ خِرقَةً یَتَوارىٰ بِها، وَإذا أكمَلتُ لَهُ الإیمانَ ابتَلَیتُهُ بِضَعفٍ في قُوَّتِهِ، وَقِلَّةٍ في رِزقِهِ، فَإنْ هُوَ جَزِعَ أعَدتُ عَلَیهِ، وَإنْ صَبَرَ باهَیتُ بِهِ مَلائِكتي».
الفقر والغنى وسائل لكشف خصائص الإنسان وصفاته الكامنة. يقول الإمام علي عليهالسلام في تفسير الآية الكريمة: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾: «وَمَعنىٰ ذٰلِك أنَّهُ یَختَبِرُهُم بِالأَموالِ وَالأَولادِ؛ لِیَتَبَیَّنَ السّاخِطَ لِرِزقِهِ، وَالرّاضِي بِقِسمِهِ، وَإن كانَ سُبحانَهُ أعلَمَ بِهِم مِن أنفُسِهِم، وَلٰكن لِتَظهَرَ الأَفعالُ الَّتي بِها یُستَحَقُّ الثَّوابُ وَالعِقابُ؛ لِأَنَّ بَعضَهُم یُحِبُّ الذُّكورَ وَیَكرَهُ الإناثَ، وَبَعضَهُم یُحِبُّ تَثمیرَ المالِ وَیَكرَهُ انثِلامَ الحالِ».
وفي الحديث عن حكمة تقييد الرزق وبسطه، يشير الإمام عليهالسلام إلى أنّ الغاية ذلك الاختبار والامتحان لمعرفة مَنْ يَشكر ومَنْ يَصبر، فيقول: «قَدَّرَ الأَرزاقَ فَكثَّرَها وَقَلَّلَها، وَقَسَّمَها
عَلَى الضّیقِ وَالسَّعَةِ، فَعَدَلَ فیها لِیَبتَلِيَ مَن أرادَ بِمَیسورِها وَمَعسورِها، وَلِیَختَبِرَ بِذٰلِك الشُّكرَ وَالصَّبرَ مِن غَنِیِّها وَفَقیرِها. ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِها عَقابیلَ فاقَتِها، وَبِسَلامَتِها طَوارِقَ آفاتِها، وَبِفُرَجِ أفراحِها غُصَصَ أتراحِها. وَخَلَقَ الآجالَ فَأَطالَها وَقَصَّرَها، وَقَدَّمَها وَأخَّرَها، وَوَصَلَ بِالمَوتِ أسبابَها، وجَعَلَهُ خالِجًا لِأَشطانِها، وقاطِعًا لِمَرائِرِ أقرانِها».
أكّد الإمام الباقرعليهالسلام، في تفسيره للآية الكريمة: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾، هذا المبدأ قائلًا :«أي اختَبَرنَا الأغنِياءَ بِالغَناءِ؛ لِنَنظُرَ كيفَ مُواساتُهُم لِلفُقَراءِ، وَكَيفَ يُخرِجونَ ما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيهِم في أموالِهِم، فَاختَبَرنَا الفُقَراءَ لِنَنظُرَ كَيفَ صَبرُهُم عَلَى الفَقرِ وَعَمّا في أيدِي الأغنِياءِ». وهذا ماذكره الإمام الصادق عليهالسلام أيضًا ردًّا على كافرٍ سأله عن علّة الفقر والغنى، إذ قال عليهالسلام: «اِختَبَرَ الأَغنِیاءَ بِما أعطاهُم لِیَنظُرَ كیفَ شُكرهُم، وَالفُقَراءَ بِما مَنَعَهُم لِیَنظُرَ كیفَ صَبرهُم».
لذلك، الفقر والغنى، والضعف والقوة، ليسا دليلين على قيمة الإنسان أو مكانته عند الله. يقول الإمام علي عليهالسلام: «لا تَعتَبِرُوا الرِّضا وَالسُّخطَ بِالمالِ وَالوَلَدِ جَهلًا بِمَواقِعِ الفِتنَةِ وَالاِختِبارِ في مَوضِعِ الغِنى وَالإقتِارِ، فَقَد قالَ سُبحانَهُ وَتَعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا
نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ﴾ (المؤمنون: 55-56)، فَإنَّ اللّهَ سُبحانَهُ يختَبِرُ عِبادَهُ المُستَكبِرينَ في أنفُسِهِم بِأَولِيائِهِ المُستَضعَفينَ في أعينِهِم». فالإمام علي عليهالسلام يرى هذا التصوّر الخاطئ نتيجةً للجهل. ومن هنا، المعرفة والوعي يمكن أنْ يُزِيلا هذا التصوّر الباطل ويُحِلّا مكانه تصوّرًا صحيحًا.
مما سبق يتضح أنّ البلايا والصعوبات من أيّ نوعٍ كانت، ليست عديمة المعنى أو الفائدة، بل هي ضرورية لحياة الإنسان. فالإنسان من دون الصعوبات والتحديات لا يكون ذا قيمة. وبالتالي، فلسفة التقديرات التكوينية والتشريعية لله تعالى هي تنمية التوحيد. فهل يمكن عدّ المصاعب شرًا أو عديمة النفع؟! من دون البلايا والاختبارات، يصبح الإنسان مثل شتلةٍ لم تنمُ أو بذرة لم تُنبِت، سرعان ما تُهلك. المصاعب ليست عديمة المعنى؛ لذا لا يجب أنْ نحزن بسببها، بل يجب تقديرها واحترامها؛ ولهذا، يجب ألّا يكون المرء غير راضٍ عن الابتلاءات.
خلاصة الفصل
الأساس النظري للرضا يقوم على الخير، فإذا كانت الحياة قائمةً على الخير، يتحقّق الرضا. وتقدير الله للإنسان قائمٌ على
الخير والصلاح، حتى لو بدا للفرد عكس ذلك. جوهر هذا الخير يعود إلى فلسفة الخلق، أي نمو الإنسان وتكامله. الخير الحقيقي للإنسان يكمن في توحيده لله وتألّهه. لذلك، تنمية التوحيد هي الأساس النظري لتقدير الله في حياة الإنسان.
هذا يتحقّق أحيانًا من خلال المصائب، التي تؤدّي إلى عودة الإنسان الضال، وتطهيره من الذنوب، وحماية دينه، ورفع درجته. وأحيانًا من خلال النعم، التي تعزّز شكر الله واستخدام النعمة في طاعته. وأحيانًا من خلال التكليف، الذي يؤدّي إلى مخالفة النفس وطاعة الله، ممّا يتيح للإنسان الاستفادة من فوائده الإلهية.
نقطة البداية للخير هي تقدير الله، لكنْ للإنسان دورٌ في تحقيقه؛ لذلك، السلوك الصحيح للإنسان شرط لتحقيق الخير في حياته. وبناءً على ذلك، هناك ثلاث ركائز للرضا: الأولى الإيمان بخيريّة التقدير (الإيمان بالخير)، والثانية السعي لتحقيق الخير في النطاق الذي يملكه الإنسان (جلب الخير)، والثالثة اكتشاف الخيرات الموجودة لكنّها مخفية في الحياة (البحث عن الخير).
(206)
من أهمّ مكونات الرضا هو التكيّف؛ أي التكيّف بين التوقّعات والوضع الحالي. عدم التوافق بين التوقّعات والإنجازات يشكّل عاملًا مهمًا في عدم الرضا. كلّ عاملٍ يقلّل هذا الفجوة يزيد من مستوى الرضا. إلى جانب ما ورد في استراتيجية الخير، فإنّ ضبط التوقّعات والطموحات والرغبات يؤدّي أيضًا إلى تقليل هذه الفجوة. فالرضا لا يتحقّق دائمًا من خلال تحقيق التوقعات والرغبات، بل في بعض الأحيان يجب تعديلها. وفيما يأتي سنتحدث عن هذا الموضوع:
توقّعاتنا من الحياة تشمل الرغبات والطموحات المادّيّة؛ أي الأشياء التي نرغب في الحصول عليها والأمور التي لا نرغب في وقوعها. كلّ إنسانٍ يحب بعض الأمور، وينفر من أمورٍ أخرى، ولذا يرغب في أنْ تسير حياته على وفق ما يحبّ، وتبتعد عمّا يكره. كيفيّة ضبط التوقّعات تؤدّي دورًا مهمًا في تحقيق الرضا أو عدمه. والسؤال هنا: كيف يجب أنْ تُضبط توقعات الإنسان
بنحوٍ تكون ردود أفعاله إيجابيّةً سواء في الظروف الملائمة أم غير الملائمة، ويحقق الرضا؟
فيما يأتي نستعرض العلاقة بين التوقّعات والواقع لنوضح أيّ نموذجٍ من ضبط التوقّعات يحقّق الرضا.
التوقّعات غير الواقعية
توقّعات بعض الأشخاص لا تتماشى مع واقع الحياة في الدنيا. فالسعادة والمعاناة هما وجهان لعملةٍ واحدةٍ في الحياة الدنيا. الحياة لها قوانين تمثّل واقعها، وهذه القوانين وضعها الله تعالى وهي غير قابلة للتغيير. وقد تم تنظيمها بطريقةٍ تضمن السعادة الحقيقية والأصيلة للإنسان؛ لأنّها قائمةٌ على مصلحته. وبالتالي، فإنّ عدم توافق التوقّعات مع الواقع هو سببٌ رئيس لعدم الرضا؛ لأنّ هذا التعارض يؤدّي إلى الشعور بالإحباط، والإحباط في التوقّعات يؤدّي إلى الشعور بعدم الرضا.
إذا تحقّقت توقّعات الإنسان، فإنّها تجلب له الرضا والسعادة، وإذا لم تتحقّق، تسبّب له الشعور بعدم الرضا. بعضهم يسعى لتركيز اهتمامه على توقّعاته، ويحاول جعل الواقع يتماشى مع هذه التوقّعات، أي جعل الواقع متوافقًا مع توقعاتهم. وبالنظر إلى ما سبق، فإنّ قوانين وحقائق الدنيا التي وضعها الله تعالى غير قابلةٍ للتغيير. يقول القرآن الكريم عن واقع الحياة البشريّة في الدنيا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.
(209)الإمام علي عليهالسلام نقل هذا الواقع لابنه الإمام الحسن عليهالسلام كوصية. الإنسان يرغب في الراحة والرفاهية والتمتع، ويرى الدنيا كمكانٍ لتحقيق هذه الرغبات، أو على الأقل يريد أنْ تكون كذلك. ولكن الحقيقة أنّ الدنيا ليست مكانًا للراحة والرفاهية. وهنا ينشأ التعارض بين التوقّعات والواقع، وهذا التعارض يؤدّي إلى الشعور بالإحباط؛ لأنّ الإنسان لا يجد ما يريده ويتوقّعه. في الأساس، الدنيا لم تُخلق للراحة، ومن الواضح أنّ السعي وراء شيءٍ غير موجودٍ يؤدّي إلى المعاناة والعذاب. يقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذا السياق: «إنَّ اللّهَ (عزّ وجلّ) يقولُ:... وَضَعتُ الرّاحَةَ فِي الجَنَّةِ وَالناسُ يطلُبونَها فِي الدُّنيا فَلا يجدونَها». إنّ البحث عن شيءٍ غير موجودٍ يؤدّي إلى الفشل، والشعور بالفشل يجرّ إلى الإحباط وعدم الرضا.
يروي الزهري أنّ الإمام زين العابدين عليهالسلام توجّه يومًا إلى أحد الحاضرين في مجلسه، وقال: «اتَّقِ اللَّهَ، وَأجمِل فِي الطَّلَبِ، وَلا تَطلُب ما لَم یُخلَق؛ فَإنَّ مَن طَلَبَ ما لَم یُخلَق تَقَطَّعَت نَفسُهُ حَسَراتٍ وَلَم یَنَل ما طَلَبَ، ثُمَّ قالَ: وَكیفَ یُنالُ ما لَم یُخلَق!؟». فَقالَ الرَّجُلُ: وَكیفَ یُطلَبُ ما لَم یُخلَق؟ فَقالَ عليهالسلام : «مَن طَلَبَ الغِنى وَالأموالَ وَالسَّعَةَ فِي الدُّنیا، فَإنَّما یَطلُبُ ذٰلِك لِلرَّاحَةِ،
وَالرَّاحَةُ لَم تُخلَق فِي الدُّنیا وَلا لِأهلِ الدُّنیا، إنَّما خُلِقَتِ الرَّاحَةُ فِي الجَنَّةِ وَلِأَهلِ الجَنَّةِ، وَالتَّعَبُ وَالنَّصَبُ خُلِقَا فِی الدُّنیا وَلِأَهلِ الدُّنیا، وَما أُعطِيَ أحَدٌ مِنها جَفنَةً إلَّا أُعطِيَ مِنَ الحِرصِ مِثلَیها، ومَن أصابَ مِنَ الدُّنیا أكثَرَ كانَ فیها أشَدَّ فَقرًا؛ لِأنَّهُ یَفتَقِرُ إلَى النّاسِ في حِفظِ أموالِهِ وَیَفتَقِرُ إلى كلِّ آلَةٍ مِن آلاتِ الدُّنیا فَلَیسَ في غِنَى الدُّنیا راحَةٌ، وَلٰكنَّ الشَّیطانَ یُوَسوِسُ إلَى ابنِ آدَمَ أنَّ لَهُ في جَمعِ ذٰلِك المالِ راحَةً، وَإنَّما یَسوقُهُ إلَى التَّعَبِ فِي الدُّنیا وَالحِسَابِ عَلَیهِ فِي الآخِرَةِ».
كما علّم الإمام الصادق عليهالسلام أصحابه هذا المبدأ لتوفير حياةٍ أفضل لهم. قال الإمام يومًا لأصحابه: «لا تتمنّوا المستحيل». فتعجّبوا وسألوا: «ومَنْ ذا الذي يتمنّى المستحيل؟!». فأجاب الإمام عليهالسلام: «أنتُم، ألَستُم تَمَنَّونَ الرّاحَةَ فِي الدُّنيا؟ قالوا: بلى. فقال الإمام عليهالسلام :«الراحة للمؤمن في الدنيا مستحيلة».
التوفيق بين التوقّعات والواقع
ممّا سبق يتّضح أنّ محاولة تغيير الواقع وتطويعه لتلبية التوقّعات أشبه بضرب الماء في الهواء، وهي محاولةٌ عبثيةٌ لا تؤدّي إلاّ إلى مزيدٍ من الألم والمعاناة وزيادة الشعور بعدم الرضا. الحقيقة أنّ الدنيا دار مشقّةٍ وابتلاءات. وبناءً على هذه الحقيقة، يتشكّل واقعٌ آخر، وهو أنّ «المشقّات أمرٌ لا مفرّ منه».
الواقع أنّ المشقّات لا يمكن تجنّبها، وهذه الحقيقة يجب تقبّلها، إذ إنكارها لن يغيّر شيئًا. الدنيا كدار للحياة لها مقتضياتها التي تخرج عن إرادتنا؛ فنحن لا نملك دورًا في تنظيمها ولا قدرة على تغييرها. خصائص الدنيا قد تمّ تنظيمها على وفق حكمةٍ ومصلحةٍ إلهية، وفيها خيرٌ وصلاحٌ للإنسان.
ما علينا فعله هو فهم حقيقة الدنيا وقبولها كما هي. توقّع حياة خالية من المشقّات هو توقّعٌ غير واقعي. المشقّات جزءٌ من حياتنا وإنكارها لا يغيّر من واقعها. وعندما ينسجم توقّع الإنسان مع الواقع، تصبح توقّعاته واقعيّة، ممّا يمنع شعور الفشل، ويحقّق الرضا عن الحياة.
ولهذا السبب، يشير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى بعض خصائص الدنيا موضّحًا كيف أنّ معرفة حقيقتها يمكن أنْ تعدّل ردود الأفعال السلبيّة تجاه المواقف المختلفة «أيهَا النّاسُ! هٰذِهِ دارُ تَرَحٍ لا دارُ فَرَحٍ، وَدارُ التِواءٍ لا دارُ استِواءٍ، فَمَن عَرَفَها لَم يفرَح لِرَجاءٍ، وَلَم يحزَن لِشَقاءٍ».
في جزءٍ آخر من الروايات، تم التركيز على دور معرفة الدنيا في الأوقات الصعبة. المصائب والابتلاءات تعدّ من أهمّ أسباب عدم الرضا. فالحزن والاكتئاب وعدم الرضا تُعدّ من النتائج المترتبة على مصائب الحياة. الإمام علي عليهالسلام يشير إلى مبدأٍ
رئيسٍ يتمثّل في أنّه إذا عرف الإنسان الدنيا على حقيقتها، فلن يشعر بالحزن وعدم الرضا حيال مصاعبها. الإمام لا يقول إنّ الدنيا يجب أن تُتصور مليئةً بالفرح والراحة، بل يشير إلى أنّه إذا كانت معرفتكم للدنيا واقعية، فحتى مع الإقرار بوجود المصاعب، لن تشعروا بالحزن وعدم الرضا. التعاليم الدينيّة التي تبني الحياة تُربي الإنسان بنحوٍ لا ييأس أو يكتئب حتى في أشدّ لحظات المصاعب والابتلاءات.
ما يمكن استخلاصه من هذا المبدأ هو أنّ مواءمة التوقّعات مع الواقع ليست مقتصرةً على الدنيا بنحوٍ عامٍ مجمل، بل يمكن تعميمها على كلّ شؤون الحياة التفصيليّة. على سبيل المثال، في العلاقات الاجتماعية والعائلية، يجب أنْ تكون التوقّعات من الطرف الآخر متناسبةً مع خصائصه. كذلك، يجب تعديل التوقّعات بشأن الوظيفة، ومكان العمل، ومكان السكن، وأمور أخرى مثل وسيلة النقل وغيرها بما يتناسب مع طبيعتها. وبالطبع، هذا التعديل يؤدّي إلى الشعور بالرضا.
تعدّ الأماني أحد أبعاد الحياة؛ فكلّ إنسانٍ في حياته لديه مجموعةٍ من الأماني، وهذه الأماني قد تؤدي إلى الشعور بعدم الرضا؛ لذلك،
يجب أنْ نفهم النموذج الصحيح للأماني لتحقيق الرضا. في بعض الروايات، يُذكر أنّ الأماني البعيدة تؤدّي إلى تقليل الاستمتاع بالنِعَم وتصغير قيمتها، وتقلل من الشكر، وتزيد الحسرة على عدم تحصيلها. روايات أخرى تتحدّث عن خداع الأماني وتشير إلى أنّها تسبب خيبة الأمل، وتُوقع الإنسان في انتظارٍ لا نهاية له، تمامًا كمن يطارد السراب، ممّا يزيد من الألم والحزن.
يمكن تقسيم هذه الخصائص إلى مجموعتين: إما نِعَم حاضرة، وإمّا أشياء مفقودة مُتمناة. بالنسبة للنِعَم الحاضرة، تتسبب الأماني في تقليل قيمتها وعدم الاستمتاع بها، بينما بالنسبة للمفقودات، تتسبب الأماني البعيدة في الإحباط وخيبة الأمل، وتزيد من نطاق الأماني، مّما يؤدّي إلى زيادة المعاناة.
مع الأخذ في الاعتبار هذا التصنيف، يمكن توضيح العلاقة بين الأماني والرضا وتفسير السبب. كما يتضح، تؤثر الأماني
البعيدة سلبًا على الإنسان من جهتين: الأولى على النِعَم التي يمتلكها والثانية على المفقودات التي يتمنى الحصول عليها. في الجزء الأول، يشعر الإنسان بالحرمان من النِعَم بسبب تقليل قيمتها، ممّا يؤدّي إلى عدم الرضا. أمّا في الجزء الثاني، فإنّ السعي وراء أمانيّ بعيدةٍ وغير قابلةٍ للتحقيق يؤدّي إلى الإحباط وخيبة الأمل، ممّا يسهم في تقليل مستوى الرضا؛ لهذا السبب، يقول الإمام علي عليهالسلام: «مَن كثُرَ مُناهُ قَلَّ رِضاهُ».
الأمل الطويل أو البعيد -الذي يُعرف أكثر في الأدبيّات الدينيّة بكلمة (أمل)- له جذور في الرجاء. ولذلك، يرى بعض اللغويين أنّ الأمل يعني الرجاء أو التوقّع. هذه الخاصيّة هي ما يدفع الحياة ويُحرّك الإنسان. العالم يقوم على الأمل، والإنسان يعيش بالأمل. إذا أُخذ الأمل من الإنسان، لن تُرضع أيُّ أمٍ ولدَها، ولن يزرع أيُّ بستانيٍّ شجرةَ، ولن يتم إنجاز أيِّ عملٍ. الأمل هو رحمةٌ إلهيةٌ على الناس؛ لكن المهم هو ألّا يتجاوز هذا الأمل حدوده أو ينحرف عن مساره الصحيح. ما ورد من ذمٍّ للأمل في النصوص الدينيّة يختصّ بالحالات التي يصاب فيها الأمل بآفة. هذا الاستخدام السلبيّ للأمل يظهر في
الحالات التي تتميز بعدّة خصائص:
أوّلًا: أنْ يكون متكرّرًا بلا توقف، بحيث لا يتوقّف الإنسان عند أيّ حدٍّ من الأماني الدنيويّة. مع تحقيق كلّ أمنيةٍ، تظهر أمنيةٌ أخرى، وتستمر هذه الدائرة. فمثل هؤلاء الأفراد لا يشبعون من التمنيّ والسعي وراء ما لا يملكون. هنا، لا يتهمّ الفرد بم يمتلكه؛ المهم عنده هو أنّه ما يفتقده، لأنّه يمتلك شخصيةً دائمة التطلّع إلى أمانيّ دنيويّةٍ كبيرة. وصاحب هذا الطبع لا يمكن أنْ يُشبع أبدًا.
ثانيًا: أنْ تكون موضوعات الأماني غير واقعيةٍ وغير قابلةٍ للتحقيق. وقد يكون ذلك بسبب عدم انتهاء الأماني -كما أُشير سابقًا- أو بسبب طبيعة الأمنيات نفسها. بعض أماني الناس لا يمكن تحقيقها في الدنيا، أو أنّ مستوى أماني بعضهم يتجاوز أعمارهم. جاء في عدّة روايات، أنّ النبيّ محمّدًاصلىاللهعليهوآلهوسلم خطّ خطًّا، وقال: «هذا الإنسان»، ثم خطّ خطًّا آخر، وقال: «هذا أجله»، وخطَّ خطًّا ثالثًا بعيدًا عن الأول، وقال: «وهذا أمله».
وفي روايةٍ أخرى، رسم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مربعًا يمثّل عمر الإنسان، وخطوطًا حوله تمثّل البلايا وحوادث الحياة، وخطًّا خارج المربع يمثّل أمل الإنسان. بهذه الطريقة، بيّن أنّ أماني الإنسان تتجاوز أعمارهم.
عقلنة الأماني
للوصول إلى الرضا، يجب إدارة الأماني وتنظيمها بحيث لا تقلل من قيمة ما يملك، ولا تؤدّي إلى عدم الرضا. يكمن أصل هذا الخلل في ضعف المعرفة. الأماني الطويلة والكثيرة ظاهرةٌ مخالفةٌ لحقائق الحياة. وما كان مخالفًا للواقع، فهو محالٌ وغير قابلٍ للتحقيق، وهذا ينشأ عن الجهل وضعف الإدراك. هذا مبدأ أساسي: «رَغبَتُك فِي المُستَحيلِ جَهلٌ»؛ لذلك، فإنّ تصحيح المعتقدات وفهم الحقائق هو الحلّ لهذه المشكلة. يجب أنْ تتماشى الأماني مع حقائق الحياة.
واقعیة الحیاة هي أنّ الدنیا لكلّ شخصٍ لیست إلّا أیامًا معدودة؛ لأنّ عمر الإنسان محدود. من یؤمن بهذه الحقیقة، سیكون أمله قصیرًا وواقعیًّا. إذا تأمّل الإنسان فی نهایة عمره، وفي المصیر الذي یتجّه نحوه، وفكر في الموضع الذی یسیر إلیه، فإنّه بالتأكید سیبتعد عن الآمال المهلكة، ولن ینخدع بها. المهم هو أنْ یُدخل الإنسان الموت فی حساباته. بناءً على
ذلك، فإنّ الفهم الصحیح للحیاة والعمر والموت یعدّ أصلًا أساسیًّا یؤدي إلى تصحیح آمال الإنسان.
وعدّ النبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، النظر إلى انتهاء الآجال وعدم بلوغ الآمال، سببًا في بغض إطالة الأمل في الدنيا، ومانعًا من الاغترار به. بناءً على هذا، یوصی الإمام زین العابدین عليهالسلام ابنه الإمام الباقرعليهالسلام قائلًا: «إيّاك وَالأَمَلَ الطَّويلَ، فَكم مِن مُؤَمِّلٍ أمَلًا لا يبلُغُهُ وَجامِعِ مالٍ لا يأكلُهُ». في ظلّ هذه الحقائق، یبدو من الغریب أنّ یتعلّق المرء بآمالٍ طویلة[4]. وللحفاظ على النفس من آفة الآمال الطویلة والوصول إلى حیاةٍ سلیمة، یجب أنْ یتم إعادة النظر في فهم الإنسان للدنیا وتطبیقه مع حقائق الحیاة.
من القضایا المهمّة المتعلّقة بالرزق هو الشعور الذي یجب أنْ یحمله الإنسان بعد السعي لتحصیل الرزق المقدَّر. أحیانًا، قد یشعر الإنسان بشعورٍ غیر صحیحٍ تجاه الرزق الذی لم یُكتب له، ممّا یؤّدي إلى عدم الرضا. وأحیانًا، قد یكون الشعور تجاه الرزق المحقّق غیر صحیح، ممّا یؤدّي أیضًا إلى عدم الرضا.
ینبغي تنظیم شعور الإنسان تجاه الرزق الذی حصل علیه. مجرد حصول الإنسان على الرزق لا یكفي؛ بل الشعور الذی یحمله تجاه هذا الرزق له دور مهم؛ لذا، یجب تنظیم شعورنا بطریقةٍ صحیحةٍ لیسهم في تحقیق الرضا.
من العوامل التی تعرقل الوصول إلى الرضا هو الحرص. الحرص یعني حالةً من الرغبة الزائدة بلا حدود، التي لا یمكن إشباعها بأيّ شيء. من لا یرضى بالكفاف یقع في فخ الطمع؛ ولهذا ورد عن الإمام علي عليهالسلام: «لا تُطمِعَنَّ نَفسَك في ما فَوقَ الكفافِ فَيغلِبَك بِالزِّيادَةِ».
الفرق بین الشخص القانع والشخص الحريص غیر الراضي یكمن فی الشعور بالهدوء والطمأنینة التي یتمتّع بها القانع، ویُحرم منها الحريص. فالطمع لم یزد فی رزق الحريص، والقناعة لم تنقص من رزق القانع؛ لذا، إذا رضيَ الإنسان بما قُسم له، سیتمتع بنعمة الهدوء؛ وهي النعمة التي یُحرم منها الحريص.
من هذا المنطلق، فإنّ حاجة الإنسان إلى القناعة تفوق
حاجته إلى الطمع والجشع. فكلّما ازداد الإنسان حرصًا، ابتعد بالقدر نفسه عن الطمأنینة. فالطریق الذي یسلكه الحریص لا یؤدي إلى وادي الطمأنینة، ولا ینال منه شیئًا، بل قد یفقد حتى القلیل الذی یمتلكه. ویُعدّ الشخص الحریص، من حیث الراحة النفسیة ولذة الحیاة، محرومًا. الحریص یعتقد أنّه یمكنه بزیادة طمعه وجهوده أنْ یزید من رزقه، ولكنْ وفقًا لقانون الرزق، كلّ شيءٍ مقدّر، فلا طائل من حرصه؛ لذا، من جهةٍ یرهق نفسه، ومن جهةٍ أخرى يُصاب بالإحباط، ممّا یؤدي إلى شعور بعدم الرضا.
القناعة
كما ذكرنا، فإنّ الله یضمن الرزق للإنسان الساعي. وأصل
ثابت أنّ رزق الإنسان یحدده الله، ولا یستطیع أحدٌ منعه. النبيّ یطمئن الناس بشأن هذه الحقیقة قائلًا: «لَو أنَّ جَميعَ الخَلائِقِ اجتَمَعوا عَلى أنْ يصرِفوا عَنك شَيئًا قَد قُدِّرَ لَك لَم يستَطيعوا، وَلَو أنَّ جَميعَ الخَلائِقِ اجتَمَعوا عَلى أنْ يصرِفوا إلَيك شَيئًا لَم يقَدَّر لَك لَم يستَطيعوا».
یقول الإمام الصادق عليهالسلام: «كانَ أمیرُ المُؤمِنینَ عليهالسلام كثیرًا ما یَقولُ: اِعلَموا عِلمًا یَقینًا أنَّ اللَّهَ (عزّ وجلّ) لَم یَجعَل لِلعَبدِ وَإنِ اشتَدَّ جَهدُهُ وَعَظُمَت حیلَتُهُ وَكثُرَت مُكابَدَتُهُ أنْ یَسبِقَ ما سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكرِ الحَكیمِ، وَلَم یَحُل مِنَ العَبدِ في ضَعفِهِ وَقِلَّةِ حیلَتِهِ أنْ یَبلُغَ ما سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكرِ الحَكیمِ. أیُّهَا النّاسُ! إنَّهُ لَن یَزدادَ امرُؤٌ نَقیرًا بِحِذقِهِ، وَلَم یَنتَقِصِ امرُؤٌ نَقیرًا لِحُمقِهِ. فَالعالِمُ لِهـٰذَا العامِلُ بِهِ أعظَمُ النّاسِ راحَةً في مَنفَعَتِهِ، وَالعالِمُ لِهٰذَا التّارِك لَهُ أعظَمُ النّاسِ شُغُلًا في مَضَرَّتِهِ».
بناءً على ذلك، نحن بحاجة إلى شعور بالاكتفاء لتحقیق الرضا مع السعي والاعتماد على الله. فإذا كان الإنسان یبذل جهده، فإنّ رزقه المقدّر سیأتیه من دون شك، ولا شيء یمكن أنْ یزید علیه. هذه حقیقة. ولكن، للوصول إلى الرضا، یجب أنْ یرافق هذا الجهد شعورٌ بالرضا بما قدّره الله. هذا ما تعبّر عنه النصوص الدینیة بمصطلح (القناعة). القناعة تعني الرضا
بالمقدار الذي یراه الله كفایةً لتلك اللحظة.
وقد عدَّ الإمامُ عليّ عليهالسلام القناعة بالكفاف سبیلًا للراحة النفسیة. وورد عن النبيّ أنّه قال: «... فَعَلَى أوَّلِ بابٍ مِنها (الجَنَّةِ) مَكتوبٌ... لِكلِّ شَيءٍ حيلَةٌ، وَحيلَةُ العَيشِ أربَعُ خِصالٍ: القَناعَةُ، وَبَذلُ الحَقِّ، وَتَرك الحِقد،ِ وَمُجالَسَةُ أهلِ الخيرِ». وینقل عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّ لقمان قال لابنه: «اِقنَع بِقَسمِ اللهِ لَك يصفُ عَيشُك».
تحقیق الحیاة الطیبة هو طموح أهل الإیمان. وعندما سُئل أمیر المؤمنین عليهالسلام عن تفسیر الآیة الكریمة: ﴿فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً﴾، أجاب قائلًا إنّ الحیاة الطیبة هي القناعة.
أهمّ أثرٍ داخلي للقناعة هو شعور الإنسان بالاستغناء، فوفقًا للروایات، القناعة مصدر بركة، وهي ثروة لا تنفد.
وثمرة القناعة هي الغنى والاستغناء؛ لهذا السبب، قال الإمام علي عليهالسلام: «لا مالَ أذهَبُ بِالفاقَةِ مِنَ الرِّضا بِالقَناعَةِ، وَلا كنزَ أغنى مِنَ القُنوعِ، وَمَنِ اقتَصَرَ عَلى بُلغَةِ الكفافِ؛ فَقَدِ انتَظَمَ الرّاحَةَ وَتَبَوَّأَ خَفضَ الدَّعَةِ». وفي روایةٍ أخرى، یؤكّد الإمام علي عليهالسلام «لا مالَ أذهَبُ لِلفاقَةِ مِنَ الرِّضا بِالقُوتِ». یوضح الإمام في هذه الروایة أنّ ما تحقّقه القناعة، لا یمكن للمال أنْ یحقّقه؛ لأنّه -كما ذُكر- الأهمّ هو القضاء على شعور الفقر، وهذا یتحقّق بالقناعة ولیس بالمال.
هذه قاعدةٌ ثابتة: «الاستغناء في القناعة». إذا أراد الإنسان أنْ یشعر بالاستغناء، فعلیه أنْ یبحث عنه في القناعة، لا في كثرة المال. من یصل إلى القناعة، یصل إلى الغنى الحقیقی. ولهذا السبب، يكون القانع مستغنيًا عن الناس، ومحصلًا
للغنى الواقعي. وهكذا، إذا تمكّن أحدٌ من تحصیل حالة الاكتفاء الداخلي، فإنّ أقلّ قلیل من متاع الدنیا یكفیه، ومن حُرم هذه الحالة، فلا شيء فی الدنیا یكفیه.
هذه نقطةٌ جوهریّةٌ فی هذا الموضوع. وفقًا للروایات الإسلامیة، من یرضا بما یكفیه من الدنیا، فإنّ أقل متاع الدنیا یكفیه، ومن لا یرضا بما یكفیه، فلن یكفیه شيءٌ من الدنیا.
لذلك، لتحقیق الرضا، یجب أنْ یتوافق طلب الرزق مع الرزق المقدّر -الذي یأتي بالجهد- وهذا التوافق یمنع الفجوة بین الرزق الموجود وتوقّعات الإنسان، ممّا یؤدّي إلى الشعور بالرضا.
كما ذكر سابقًا، قبول الوضع الحالي والإقبال علیه هو من عناصر الرضا. الشخص الراضي هو من یقبل بكل إقبال وضعه الحالي؛ ولكن هذا القبول والإقبال لا یرتبط دائمًا بمقدار ما یحصل علیه من الخارج، بل یعتمد أیضًا على حالته النفسیّة. قد تكون الظروف الخارجیة جیّدة، ولكن الفرد قد یفتقد الإقبال والرضا.
فی هذا النقاش، نسعى لتوضیح كیفیّة تحقیق هذا الهدف:
من القضایا المهمة في التعامل مع التقدیر الإلهي هو قبول الإنسان لهذا التقدیر أو عدم قبوله. كیفیة تعامل الإنسان مع التقدیر الإلهي لها تأثیرٌ كبیرٌ في الرضا أو عدمه. التعامل الخاطئ مع التقدیر هو رفضه ومعارضته. وهذا یعني أنّ الشخص لا یقبله، بل یحاول إزالته من حیاته. مع ما ورد سابقًا بشأن التقدیر، فإنّ هذا التصرّف عدیم الجدوى. فی حدیثٍ عن الإمام علي عليهالسلام، ینقل أنّ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود علیه السلام قائلًا: «يا داوودُ! تُريدُ وَأُريدُ، وَلا يكونُ إلّا ما أُريدُ، فَإنْ أسلَمتَ لِما أُريدُ أعطَيتُك ما تُريدُ، وَإنْ لَم تُسلِمْ لِما أُريدُ أتعَبتُك فيما تُريدُ، ثُمَّ لا يكونُ إلّا ما أُريدُ».
هذا يدلُّ على أنّ معارضة التقدير ومقاومته لا طائل منها، ولن تؤدّي إلّا إلى الخيبة والفشل. ومن الطبيعي أنَّه في مثل هذا السياق لا يُمكن توقُّعُ الشعور بالرضا.
إذا تبيَّن أنَّ كلَّ الأمور بيد الله، وأنَّ شيئًا لا يحدث في الدنيا إلّا بإرادته، وإذا تبيَّن أنّ الله يعمل لمصلحة البشر، وكلّ ما يُريده أو يفعله هو خيرٌ لهم، فإنّ السبيل للوصول إلى السعادة
الحقيقيّة هو قَبول مشيئته وكلِّ تقديراته التكوينيّة والتشريعيّة. في الحقيقة، القَبول بإرادة الله والعمل بموجبها هو الضمانة لسعادة الإنسان. وهذا هو ما يُشار إليه في الأدبيات الدينيّة بمصطلح (التسليم لأمر الله). الشخص المُسلِّم لأمر الله يقبل بكلِّ أوامره التكوينيّة والتشريعيّة ولا يُقاومها.
مقاومة أوامر الله تعالى تعني معارضة قوانينه وسننه الثابتة، والسير عكس تيار الكون، ولن تؤدّي إلّا إلى زيادة المعاناة والمشكلات، كما تؤدّي إلى الفشل والإحباط في الحياة، فينجم عنهما مشاعر عدم الرضا.
لذلك، فإنَّ التسليم في جميع الأمور هو من المبادئ التي حثّت عليها التعاليم الدينيّة. وقد سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن قوله تعالى: ﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (النساء: 65) قال: «هو التسليم في الأمور».
ونُقل عن الإمام علي عليهالسلام أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مُسلِّمًا لله
وراضيًا في كلِّ الأمور. وجاء في دعاء الإمام الكاظم عليهالسلام أنَّ من صفات أصحاب الإمام المهدي عليهالسلام التسليم.
واللافت أنّ هذا المفهوم يرتبط بشكلٍ وثيق بالإيمان بالله. فقد عدّ رسولُ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التسليمَ أحد الأركان الخمسة للإيمان وحقيقته. كما عدَّه الإمام عليُّ عليهالسلام أحد أركان الإيمان الأربعة
التي لا يكتمل الإيمان من دونها. وبناءً على ذلك، فإنّ الإمام الصادق عليهالسلام يَعدّ التسليم في جميع أوامر الله هو معيار معرفة المؤمن.
ومن هنا، كان أحد الأدعية التي كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يطلبها من الله هو أنْ يَجعله مُسلِّمًا لإرادته، وكذلك الإمام علي عليهالسلام كان يطلب من الله أنْ يرزقه التسليم حتّى لا يرغب بتعجيل ما أخَّره الله، ولا بتأخير ما عجَّله. ونُقل عن الإمام زين العابدين عليهالسلام أنّ الإمام عليًّاعليهالسلام كان يدعو بهذا الدعاء دائمًا: «اللّٰهُمَّ مُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوكلِ عَلَيك، وَالتَّفويضِ إلَيك، وَالرِّضا بِقَدَرِك، وَالتَّسليمِ لِأَمرِك، حَتّى لا أحِبَّ تَعجيلَ ما أخَّرتَ وَلا تَأخيرَ ما عَجَّلتَ، يا رَبَّ العالَمينَ».
والجدير بالذكر أنَّ جذور التسليم تكمن في معرفة الله. فالشخص الذي يعرف الله حقَّ المعرفة، سيَطمئنُّ إلى إرادته ومشيئته، ويُصبح مُسلِّمًا له، ولن يشعر بأي قلقٍ أو اضطراب. لذلك، يُمكن استخدام التسليم كعاملٍ في جميع أبعاد الرضا. لكن لا شكَّ في أنَّ الوصول إلى مرحلة الاطمئنان والتسليم يتطلَّب أسسًا معرفيةً خاصّةً، وهذه الأُسس تتجاوز نطاق هذا النصّ.
أثناء مواجهة الشدائد، تزداد أهمية التحلّي بالمرونة. في الأوقات التي تظهر فيها المشاكل، يميل الإنسان عادةً إلى رفض حقيقة تلك المحن والسعي لمقاومتها، على الرغم من أنّ المحن لا يمكن إعادتها أو إزالتها. هذا التنافر بين الواقع وردّ الفعل يؤدّي إلى زيادة الضغوط النفسية ويعزّز الشعور بعدم الرضا. لذا يُعزى جزءٌ من تفاقم الضغوط والألم أثناء الأزمات إلى هذا النوع من ردود الأفعال.
المصاعب تُقدّر بحكمةٍ إلهيةٍ ومصلحةٍ للإنسان. وعليه، عندما تواجه الإنسان محنة، فإنّها لن تزول حتى تُحقّق غاياتها وتُتمّ مهمتها. لكلّ محنةٍ دورة يجب أنْ تُستكمل. قد يختلف
طول هذه الدورة من شخصٍ لآخر، ولكنّ مبدأها الرئيس هو أنّها غير قابلةٍ للإلغاء أو الإرجاع.
عندما تحدث المحنة، عادةً ما يميل الإنسان إلى التركيز على التخلّص منها بدلًا من إدارتها، ويتمنّى العودة السريعة إلى الوضع السابق. هذه الرغبة تخلق معركةً مع المحن، حيث يحاول الإنسان إزالتها بأيّ وسيلةٍ كانت. لكن كما ذكرنا سابقًا، فإنّ الجزع والشكوى لا يُؤثّران على المحنة نفسها ولا يُحوّلانها إلى أمرٍ إيجابي، بل يزيدان من عبء المصيبة.
لذلك، الفهم الصحيح لهذا الواقع يُشير إلى أنّ الحلّ يكمن في المرونة وقبول المحن كجزءٍ من الحقيقة. النبيّ محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: «الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنونَ لَيِّنونَ؛ كَالجَمَلِ الأنِفِ، إنْ قِيدَ انقادَ، وَإنْ أُنيخَ عَلى صَخرَةٍ استَناخَ».
في بعض الروايات الأخرى، تم الإشارة إلى ضرورة المرونة أمام المصاعب، حيث يُشبه المؤمن بالسنبلة التي تنحني برفق
أمام الرياح ولا تنكسر. يذكر الإمام عليّ عليهالسلام أنّ قبول المحنة هو السبيل الأنجع لتجاوزها بسلام إذ يقول: «إنَّ لِلنَّكباتِ نِهاياتٍ لابُدَّ لِأَحَدٍ إذا نُكبَ مِن أن ينتَهِي إلَيها، فَينبَغي لِلعاقِلِ إذا أصابَتهُ نَكبَةٌ أنْ ينامَ لَها حَتّى تَنقَضِي مُدَّتُها؛ فَإنَّ في دَفعِها قَبلَ انقِضاءِ مُدَّتِها زِيادَةً في مَكروهِها».
تُظهر المرونة حكمة الإنسان، إذ إنّ مواجهة المصاعب بالصدام تزيد من حدّتها، بينما القبول بها يُمكّن الإنسان من السيطرة عليها وإدارتها بنحوٍ أفضل. النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عندما علم بمصيبة أصابت أحد أصحابه، كتب إليه رسالةً يسلّيه فيها، مشيرًا إلى حقيقتين: الأولى هي أنّ المصاعب لا مفرّ منها، والثانية أنّها غير قابلةٍ للإرجاع. بهذه الطريقة، يُحفّز القبول والرضا بمواجهة الواقع الصعب.
المرضُ هو أحد مصاعب الحياة التي وُعد لها بأجر عظيم، ولكن بشرط القبول بها، أي أنّ المريض يحصل على الأجر إذا قَبِل مرضه ولم يُعارضه أو يشتكي منه. من الواضح أنّ تقبّل الواقع هو أحد المفاهيم المهمة التي يجب الانتباه إليها عند مواجهة الصعوبات.
كان لأشعث بن قيس أخٌ تُوفي، فأحزنه ذلك وأثّر فيه. فجاء أمير المؤمنين عليهالسلام لزيارته وتعزيته، وأشار إلى مبدأ (عدم رجوع المصائب)، ومن خلال كلام الإمام عليّ عليهالسلام يُمكن استنتاج أنّ الجزع ومعارضة المصائب لا ينتج عنهما سوى الخسارة.
فضيل بن ميّسر يروي أنّه كان ذات يومٍ في حضرة الإمام الصادق عليهالسلام ، فجاء رجلٌ يشكو من مصيبةٍ ألمّت به. فاستند الإمام عليهالسلام إلى المبدأ نفسه لإرشاده. كما أنّ رجلًا آخر يُدعى مهران كتب إلى الإمام الكاظم عليهالسلام يشكو من ديونه وتغيّر حاله، فجاء جواب الإمام على وفق المبدأ نفسه.
في جميع هذه الأحاديث، تمّ التركيز على مبدأ (عدم رجوع
المصائب)، وأنّه كما أنّ وقوعها ليس بيد الإنسان، فإنّ زوالها أيضًا ليس بيده. لذلك يجب قبول المصيبة والتعامل معها بدلًا من مواجهتها. هذا المبدأ الأساسي يُعلّمنا أنّ الوقوف بجانب الأحداث بدلًا من مواجهتها يُمكّن الإنسان من اتخاذ قراراتٍ صائبةٍ بشأن ما يجب عليه فعله.
ذُكر سابقًا أنّ الشعور بالرضا عن الواقع هو أحد عناصر الرضا. الشخص الراضي يعيش إحساسًا إيجابيًّا وجيدًا. قد يبدو الأمر بسيطًا بأنّه بمجرد تحقيق التوافق وتقييم الواقع على أنّه خير، فإنّ الشعور الإيجابي يتحقّق؛ ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. نظرًا لتعقيد مفهوم الخير ومصاديقه، وكذلك موضوع التوافق، فإنّ الوصول إلى شعور الرضا ليس سهلًا. يجب أنْ يتبع نظام رضا الفرد نموذجًا متماشيًا مع بقية العناصر.
من الأمور المهمة في الحياة تنظيم الحزن (عدم الرضا) والسرور (الرضا). الحزن والسرور هما من الأبعاد المهمة للإنسان التي يجب تنظيمها وعدم تركها دون ضبط. عندما كان الإمام زين العابدين عليهالسلام يشعر بالحزن، كان يدعو الله أنْ يُعينه
حتى لا يغترّ بما أُعطي من الدنيا ولا يحزن على ما أُخذ منه. هذا السلوك يعكس خصائص الإنسان الناضج.
رُوي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّ لقمان الحكيم كان يتحلّى بهذه الصفة أيضًا. لكن السؤال هو: كيف يمكن تنظيم الحزن والسرور بشكلٍ صحيح؟ الجواب يكمن في معرفة حقائق الحياة.إذا تأسست مشاعر الحزن والسرور على مبدأ صحيح، فإنّه يمكن السيطرة على ردود الفعل السلبيّة. يعتمد تنظيم هذه المشاعر على فهم الإنسان لما يستحق حقًا الحزن أو السرور. هذه المعرفة لها دور مهم في تنظيم المشاعر، وتعتمد على فهم حقائق الكون، التي سنناقشها في الأقسام التالية.
الرزق والعمر من أهمّ قضايا الحياة التي قد تكون سببًا للحزن أو السرور المفرط. الحزن يأتي بسبب القلق على الرزق في المستقبل، والسرور بسبب الاعتقاد باستمرارية العمر. ومع ذلك، الحقيقة تختلف عن ذلك. الله تعالى قد ضمن رزق الإنسان، وإذا أدرك الإنسان ذلك، فإنّه لن يشعر بالحزن أو
القلق. كذلك، فإنّ عمر الإنسان يتعرض للنقصان والزوال، ومن يدرك هذا الواقع لن يصاب بالغرور أو الطغيان.
الملمّات والمسرّات في الحياة هي من الأمور التي قد تسبب الحزن أو السرور السلبي. الوقوع في البلاء والمصيبة قد يجعل الإنسان حزينًا، بينما التمتّع بالنعمة قد يجعله مغترًا. ولكن إذا أدرك الإنسان أنّ البلاء والمصيبة يقربانه إلى الله، فإنّ الحزن سيتحول إلى سرور، وإذا علم أنّ النعمة قد تبعده عن الله، فإنّ الغرور والسعادة المفرطة سيتلاشيان.
مسألة تحديد مصدر الأمور السارّة وغير السارّة ومن يديرها لها تأثيرٌ كبيرٌ في مشاعر الحزن والسرور لدى الإنسان. إذا ظنّ الإنسان أنّ الأمور غير السارّة تحدث بلا هدف، فإنّه سيتألم
عند وقوعها. وإذا اعتقد أنّ النعمة كانت بفضل جهده، فإنّه سيصاب بالغرور. ولكن إذا أدرك أنّ جميع الأمور، سواء السارّة أم غير السارّة، تحدث بتقدير الله الحكيم، فإنّه لن يحزن على المصائب؛ لأنّه سيعدّها لصالحه، ولن يفرح بالنعمة فرحًا مفرطًا؛ لأنّها ليست بجهده فقط، وقد تزول في أيّ لحظة.
قال الإمام علي عليهالسلام في رسالةٍ إلى عبد الله بن عباس: «فَقَد يَسُرُّ المَرءَ ما لَم يَكُن لِيَفوتَهُ، وَيَحزُنُهُ ما لَم يَكُن لِيُصيبَهُ أبَدًا وَإنْ جَهَدَ، فَليَكُن سُرورُك بِما قَدَّمتَ مِن عَمَلٍ صالِحٍ أو حُكمٍ أو قَولٍ، وَليَكُن أسَفُك فيما فَرَّطتَ فيهِ مِن ذٰلِك، وَدَعَ ما فَاتَك مِنَ الدُّنيا فَلا تُكثِر عَلَيهِ حُزنًا، وَما أصابَك مِنها فَلا تُنعَم بِهِ سُرورًا، وَليَكُن هَمُّك فيما بَعدَ المَوتِ، وَالسَّلامُ».
الأفكار الخاطئة حول المستقبل سواء في النعمة أم البلاء قد تسبّب الحزن أو السرور السلبي؛ فإذا اعتقد الإنسان أنّ الأمور التي فقدها يمكن استرجاعها، فلن يتجاوزها وسيعيش في ألمٍ مستمر. وإذا ظنّ أنّ الأمور المكتسبة دائمة، فقد يغترّ ويفرط في فرحته. ولكن إذا أدرك الإنسان أنّ كلّ شيءٍ يحدث بتقدير الله ولا يمكن تغييره، فسيتقبل المصائب ولن يستسلم للحزن. وإذا
علم أنّ الأمور المكتسبة ليست دائمةً، وقد تفقد في أيّ لحظةٍ، فإنّه سيبقى متوازنًا ولن يفرط في السرور.
ما يكسبه الإنسان وما يدفعه ثمنًا له يؤدّي دورًا مهمًا في تنظيم فرحه وحزنه. قد يفرح الإنسان بحصوله على متاع من الدنيا، لكنّه يغفل عن حقيقة أنّ ما خسره من الآخرة في سبيل هذا المكسب أعظم بكثير. التفكير في قيمة الثمن المدفوع يقلل من الغرور المفرط. كذلك، إذا أدرك الإنسان أنّ المصائب التي دفع ثمنها في الدنيا قد عادت عليه بأجرٍ عظيمٍ في الآخرة، فإنّه سيتجاوز الحزن السلبي.
ما يكتسبه الإنسان أو يخسره من الخير يُحدّد مشاعره من حزن وسرور. الأمر لا يتعلّق فقط بالسعادة أو الشقاء الظاهري، بل بما يتمّ كسبه أو فقدانه من خير. إذا كان الإنسان في حالةٍ طيبةٍ لكنه يخسر العديد من الأمور الإيجابيّة أو يفشل في تحقيق
مكاسب ممكنة، فلا ينبغي أنْ يكون سعيدًا. على العكس، إذا كان في وضعٍ صعبٍ لكنّه يحقّق خيرًا أو مكاسب إيجابيّة، فإنّه يجب أنْ يكون سعيدًا. الأساس هو (تحقيق الخير)، وليس مجرد الحصول على الأمور المبهجة أو المزعجة.
من المسائل المهمّة كيفيّة تعاملنا مع مصائب الاخرين. هل يرتبط حزن وسعادة الأفراد ببعضهم أم أنّ كلّ فردٍ يعيش في جزيرة منعزلة؟ في هذا الصدد، نستعرض التصوّرات الآتية:
قد يظن البعض أنّ أحوال الآخرين لا تؤثّر في حالته الشخصية، وفي ظلّ هذا التصور، يسعى كلّ فردٍ لتخفيف ألمه من خلال الأمور المرتبطة به فقط، ممّا يؤدّي إلى اللامبالاة بمعاناة الآخرين وعدم الشعور بالمسؤوليّة تجاههم. لكن هذا تصوّر خاطئ لا يتوافق مع قوانين الحياة.
أحد قوانين الخلق التي أُشير إليها في النصوص الدينيّة
(238)هو ترابط أحوال أفراد المجتمع. يبدو أن الحزن والفرح مشترك بين الناس. اللامبالاة تجاه المحتاجين والتركيز فقط على الذات يؤدي إلى تلاشي الفرح الداخلي، بينما الرحمة والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين والعمل على حل مشاكلهم يُنشط الروح ويُدخل السرور للنفس. هذه السعادة لا تقتصر على الدنيا فقط، بل تشمل الآخرة أيضًا. وفي ذلك يقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مَن أرادَ أن تُستَجابَ دَعوَتُهُ وَأَن تُكشَفَ كربَتُهُ، فَليفَرِّجُ عَن مُعسِرٍ».
ويقول صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضًا: «مَن أعانَ مُؤمِنًا نَفَّسَ اللّهُ (عزّ وجلّ) عَنهُ ثَلاثًا وَسَبعينَ كربَةً، واحِدَةً في الدُّنيا وَاثِنتَينِ وَسَبعينَ كُرَبةً عِندَ كُرَبِهِ العُظمى، قال: حَيثُ يتشاغَلُ النّاسُ بِأنفُسِهِم». ونُقِل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال: «مَن أجرَى اللَّهُ عَلىٰ يدِهِ فَرَجًا لِمُسلِمٍ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنهُ كُربَ الدُّنيا وَالآخِرَةِ». وقال أيضًا: «المُسلِمُ أخو المُسلِمُ لا يظلِمُهُ وَلا يسلِمُهُ، وَمَن كانَ في حاجَةِ أخيهِ كانَ اللَّهُ في حاجَتِهِ، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسلِمٍ كربَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنهُ كربَةً مِن كرُباتِ يومِ القِيامَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يومَ القِيامَةِ».
هذه من قوانين الحياة. ومن المفاهيم الإسلاميّة في هذا المجال (الصدقة). فقد أكّد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على إزالة الغمّ والهمّ بالصدقة.
في استراتيجية التكيّف، يتمثّل الأساس في أنّ الحياة في الدنيا، وجميع أبعادها، تنطوي على حقائق غير قابلةٍ للتغيير. السعي لتغيير هذه الحقائق لتتماشى مع التوقّعات يشبه محاولة طحن الماء، وهو جهد بلا فائدة، لن يؤدي إلّا إلى زيادة الألم والمعاناة وتوسيع دائرة السخط. الرضا لا يتحقّق دائمًا عبر تحقيق المطالب والتوقّعات، بل في بعض الأحيان، ينبغي تعديل التوقّعات والطموحات والرغبات. من أهم عناصر الرضا هو التكيّف؛ أي مواءمة التوقعات مع الواقع القائم. إنّ عدم التناسق بين التوقّعات والنتائج يشكّل عاملًا مهمًّا في السخط، وكلّ ما يقلل هذه الفجوة يزيد من مستوى الرضا.
في استراتيجية القبول، يتمثّل الأساس في ضرورة فهم الواقع القائم وقبوله في أيّ ظرف كان. القبول لا يعني التأييد أو الخضوع، بل يتطلّب إدراك المشكلة لتتمكن من إدارتها. هناك عاملان رئيسانِ يمكن أنْ يُساعدا الإنسان في هذا الإطار: الأول هو التسليم للتقدير؛ لأنّ المواجهة الخاطئة مع التقدير تتمثّل في عدم قبوله والصراع معه، وهي محاولة بلا جدوى؛ لأنّ ما قدّره الله لا يمكن تغييره. العامل الثاني هو المرونة، فأمام وقوع ما هو حتمي وقاطع، يجب أنْ يتحلّى الإنسان بالمرونة لتجنب أنْ يُدمّر كيانه. فالشجرة الصلبة تنكسر أمام العواصف، بينما السنبلة الليِّنة والمنحنية تظلّ سليمة. المرونة والليونة في
(240)مواجهة المشكلات تساعد الإنسان على الحفاظ على سلامته.
أمّا في استراتيجيّة السرور، فقد يبدو أنّ تحقيق التكيّف وتقييم الواقع على أنّه خير يؤدّي تلقائيًّا إلى الشعور بالإيجابيّة والراحة. لكن بالنظر إلى تعقيد مفهوم الخير ومظاهره، وكذلك طبيعة التكيّف، فإنّ تحقيق الشعور بالرضا لا يبدو أمرًا بسيطًا وسهلًا. يجب أنْ تتبع منظومة السرور لدى الإنسان نموذجًا ومنهجًا متناسقًا مع بقية العناصر، وهذه النماذج قد وردت في النصوص الدينيّة.
(241)1. الاحتجاج، أحمد بن علي الطَبَرسي (م ٦٢٠ق)، قم: أُسوه، ١٤١٣ق.
2. الاختصاص، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشیخ المفید) (م ٤١٣ق)، تحقیق: علي أكبر الغفّاري، بیروت: دار المفید، ١٤١٤ق.
3. الأُصول الستّة عشر، عدّة من الرواة، قم: دار الشبستري، ١٤٠٥ق.
4. الأعمال، علي بن موسی الحلّي (السیّد ابن طاووس) (م ٦٦٤ق)، تحقیق: محمّد جواد القیّومي، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٤ق.
5. الأمالي، محمّد بن الحسن الطوسي (الشیخ الطوسي) (م ٤٦٠ق)، تحقیق: علی أكبر الغفّاري، بیروت: دار المفید، ١٤١٤ق.
6. الأمالي، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، تحقیق: مؤسّسة البعثة، قم: دار الثقافة، ١٤١٤ق.
7. الأمالي، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشیخ المفید) (م ٤١٣ق)، تحقیق: مؤسّسة البعثة، قم: مؤسّسة البعثة، ١٤٠٧ق.
8. الأنوار البهیّة، شیخ عبّاس القمي، قم: دار الذخائر، 1370ش.
9. الأنوار القدسیّة في بیان آداب العبودیّة (فى هامش الطبقات الكبرى)، عبد الوهّاب بن أحمد الأنصاري (م ق 10ق)، بیروت: دار الفكر.
10. الأنوار النعمانیّة، السیّد نعمة اللّٰه الجزائري (م 1112ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي، 1٤٠٤ق.
11. الأولیاء، أبو بكر عبد اللّٰه بن محمّد القرشي المعروف بابن أبي الدنیا (م 281ق)، تحقیق: محمّد السعید بن بسیوني زغلول، بیروت: مؤسّسة الكتب الثقافیّة، 1٤13ق.
12. أخلاق وحیانی (دو فصل نامه علمی - پژوهشی)، قم: پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، بنیاد بین المللی اسرا.
13. اخلاق پژوهی حدیثی، عبّاس پسندیده، تهران: سازمان مطالعات وتدوین كتب درسی علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشكده علوم حدیث، ١٣٨٩ش.
14. إرشاد القلوب، الحسن بن أبي الحسن علي الدیلمي (ق ٨ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي، ١٤١٣ق.
15. الإرشاد، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشیخ المفید) (م ٤١٣ق)، قم: المؤتمر العالمیّة لألفیّة الشیخ المفید، ١٤١٣ق.
16. الإصابة فی تمییز الصحابة، أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر) (م ٨٥٢ق)، تصحیح: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١٥ق.
17. أعلام الدین، الحسن بن أبي الحسن علي الدیلمي (ق ٨ق)، بیروت: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤١٣ق.
18. الگوی اسلامی شادكامی با رویكرد روان شناسی مثبتگرا، عبّاس پسندیده، قم: مؤسّسه علمی - فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، ١٣٩٢ش.
19. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی (فصل نامه علمی - پژوهشی)، ش ٩، «مشخّصه های روان سنجی مقیاس رضایت از زندگی»، منصوره شیخی و همكاران، ١٣٩٠.
20. بحار الأنوار، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (العلّامة المجلسي) (م ١١١١ق)، تهران: المكتبة الإسلامیّة، ١٣٨٨ق.
21. بررسی رابطۀ جهتگیری مذهبی با بهزیستی روانی دانشجویان دانشگاه علّامه طباطبایی تهران»، پایان نامه كارشناسی، چاپ نشده، قم: دانشگاه پیام نور، 138٦ش.
22. «بررسی نقش واسطهای شكر در رابطۀ آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی - روانشناختی آن»، پایان نامه كارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبتگرا، قم: دانشگاه قرآن و حدیث.
23. بشارة المصطفی، عماد الدین أبو جعفر محمّد بن محمّد الطبري الآملي (م ٥٢٥ق)، قم: مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرّسین، ١٤٢٠ق.
24. بصائر الدرجات، محمّد بن الحسن الصفّار القمّي (ابن فرّوخ) (م ٢٩٠ق)، قم: المكتبة الحیدریّة.
25. پژوهش نامه روان شناسی اسلامی (علمی - ترویجی)، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث، حوزه موضوعی: دینی - روان شناسی.
26. پژوهشهای نوین روان شناسی (علمی - پژوهشی)، تبریز: دانشگاه تبریز، حوزه موضوعی: روان شناسی (بالینی، كودك و نوجوان، شخصیت، عمومی، رشد، سلامت، تربیتی، اجتماعی، شناختی، مشاوره، روان سنجی، علوم اعصاب شناختی).
27. تاج العروس، السیّد محمّد المرتضی بن محمّد الحسیني الزَّبیدي (م ١٢٠٥ق)، بیروت: دار الفكر، ١٤١٤ق.
28. تاریخ الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب (م 28٤ق)، بیروت، دار صادر.
29. تاریخ بغداد، أحمد بن علي الخطیب البغدادي (م ٤٦٣ق)، بیروت: دار الكتب العلمیّة.
30. تاریخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة اللّٰه الدمشقي (ابن عساكر) (م ٥٧١ ق)، تحقیق: علي شیري، بیروت: دار الفكر، ١٤١٥ق.
31. تحف العقول، الحسن بن علي الحرّاني (ابن شعبة) (م ٣٨١ق)، قم: آل علي، ١٣٨٢ش.
32. التحقیق في كلمات القرآن الكریم، حسن مصطفوي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 13٦0ش.
33. ترجمه تفسیر المیزان، سیّد محمّد باقر موسوي همداني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٣٧٩ش.
34. تفسیر العیّاشي، محمّد بن مسعود السُّلمي السمرقندي (العیّاشي) (م ٣٢٠ق)، قم: موسّسة البعثة، ١٤٢١ق.
35. تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي (م ٦٧١ق)، تحقیق: محمّد عبد الرحمان المرعشلي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ١٤٠٥ق.
36. تفسیر القمّي، علي بن إبراهیم القمّي (م ٣٠٧ق)، قم: دار الكتاب، ١٤٠٤ق.
37. التفسیر المنسوب إلی الإمام العسكري، تحقیق: مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام ، قم: مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام ، ١٣٦٧ش.
38. التمحیص، أبو علي محمّد بن همام الإسكافي (ابن همام) (م 33٦ق)، تحقیق: مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام ؟، قم: مدرسة الإمام المهدي، 1٤٠٤ق.
39. تنبیه الخواطر، أبو الحسین ورّام بن أبي فراس الحمدان النخعي الحلّي (م ٦٠٥ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي.
40. تهذیب الأحكام، محمّد بن الحسن الطوسي (الشیخ الطوسي) (م ٤٦٠ق)، تهران: دار الكتب الإسلامیّة، ١٣٦٤ش.
41. توحید المفضّل، مفضّل بن عمر الكوفي (ق ٢ق)، تهران: كتابچی.
42. التوحید، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، تحقیق: السیّد هاشم الحسیني الطهراني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٣٩٨ق.
43. توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث، محمّد محمّدی ریشهری، با همكاری سیّد رضا حسینی، ترجمه: سیّد أبو القاسم حسینی (ژرفا)، قم: دار الحدیث، ١٣٨٢ش.
44. ثواب الأعمال، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ ق)، تحقیق: السیّد حسن خرسان، قم: الشریف الرضي، ١٣٦٨ش.
45. جامع الأحادیث، جعفر بن أحمد بن علي القمّي (ابن الرازي) (ق ٤ق)، تحقیق: السیّد محمّد الحسیني النیسابوري، مشهد: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للحضرة الرضویّة المقدّسة، ١٤١٣ق.
46. جامع الأخبار أو معارج الیقین في أصول الدین، محمّد بن محمّد الشعیري السبزواري (ق ٧ق)، تحقیق: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، قم: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤١٤ق.
47. الجعفریّات (الأشعثیّات)، محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي (ق ٤ق)، تهران: مكتبة نینویٰ (طُبع فی ضمن قرب الإسناد).
48. حلیة الأولیاء، أحمد بن عبد اللّٰه الأصبهاني (أبو نعیم) (م ٤٣٠ق)، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١٤ق.
49. الخصال، محمّد بن علي ابن بابویه القمی (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، تحقیق: علیأكبر الغفّاری، بیروت: مؤسّسة الأعلمی، ١٤١٠ق.
50. الخواطر (تنبیه الخواطر)، أبو الحسین ورّام بن أبي فراس الحمدان النخعي الحلّي (م ٦٠٥ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي.
51. خیر و بركت از نگاه قرآن و حدیث، محمّد محمّدی ریشهری، با همكاری محمّد تقدیری، ترجمه: جواد محدّثی، قم: مؤسّسۀ علمی - فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، (١٤٢٤ق/ ١٣٨٢ش).
52. «چگونه دین به سلامتی و بهزیستی ما كمك میكند؟»، فرد ریكسون، ترجمه: هانی موسوی، مجلّه روان شناسی و دین، ش 3، قم 1387.
53. دانش نامه قرآن و حدیث، محمّد محمّدی ریشهری و دیگران، قم: دار الحدیث، ١٣٩٠ش.
54. الدرّ المنثور، عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي (م ٩١١ق)، قم: مكتبة آیة اللّٰه المرعشي، ١٤١٤ق.
55. الدروع الواقیة، علي بن موسی الحلّي (السیّد ابن طاووس) (م ٦٦٤ق)، قم: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤١٤ق.
56. دستور معالم الحكم، محمّد بن سلامة (القاضی القضاعی) (م ٤٥٤ق)، بیروت: دار الأرقم، ١٤١٨ق.
57. الدعاء، سلیمان بن أحمد الطبراني (م ٣٦٠ق)، بیروت: دار البشائر الإسلامیّة، ١٤٠٧ق.
58. دعائم الإسلام، النعمان بن محمّد ابن حیّون التمیمي المغربي (القاضي أبو حنیفة) (م ٣٦٣ق)، بیروت: مؤسّسة النور، ١٤٢٦ق.
59. الدعوات، علي بن أحمد الواحدي، تحقیق: عادل الفریحات، دمشق: نور الطباعة، ١٤٢٨ق.
60. دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث، محمّد محمّدی ریشهری، با همكاری رسول موسوی، ترجمه: حمید رضا شیخی، قم: دار الحدیث، ١٣٨٤ش.
61. راهبرد (راهبرد فرهنگ)، ش ٥، «رابطه سبكهای همسرگزینی با كیفیت و پایداری خانواده»، محمّدعلی مظاهری و همكاران (١٣٨٨ش).
62. رجال النجاشي، أحمد بن علي النجاشي (م ٤٥٠ق)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٦ق.
63. رضایت از زندگی، عبّاس پسندیده، قم: دار الحدیث، ١٣٧٤ش.
64. روان پزشكی و روان شناسی بالینی ایران (فصل نامه علمی - پژوهشی)، دانشگاه علوم پزشكی ایران، حوزه موضوعی نشریّه: بهداشت
روان، روان پزشكی و روان شناسی بالینی، تهران.
65. روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، جمعی از مؤلّفان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهمن ١٣٩٨.
66. روان شناسی شادی، مایكل آرگایل، ترجمه: مسعود گوهری و دیگران، اصفهان: جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، ١٣٨٢ش.
67. روضة الواعظین، محمّد بن الحسن الفتّال النیشابوري (م ٥٠٨ق)، قم: الشریف الرضي.
68. رویكردهای نوین آموزشی (دو فصل نامه علمی - پژوهشی)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان.
69. الزهد، أبو محمّد الحسین بن سعید الكوفي الأهوازي (م ٢٥٠ق)، تحقیق: أحمد غلام علي، قم: دار الحدیث، ١٤٢٦ق.
70. الزهد، عبد اللّٰه بن المبارك الحنظلي المروزي (ابن المبارك) (م ١٨١ ق)، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١٥ق.
71. سعادت و شادكامی از دیدگاه اسلام، حمزه عبدی، قم: دار الحدیث، ١٣٩١ش.
72. سلیم بن قیس، سلیم بن قیس الهلالي العامري (م حوالي 90ق)، تحقیق: محمّد باقر الأنصاري، قم: نشر الهادي، 1٤١٥ق.
73. سنن ابن ماجة عن عائشة، محمّد بن یزید القزویني (ابن ماجة) (م ٢٧٥ق)، تحقیق: محمّد فؤاد عبد الباقي، بیروت: دار الفكر.
74. سنن أبي داوود، سلیمان بن أشعث السجستاني الأزدي (م ٢٧٥ق)، تحقیق: محمّد محیي الدین عبد الحمید، بیروت: دار إحیاء السنّة النبویّة.
75. سنن الترمذي (الجامع الصحیح)، محمّد بن عیسی الترمذي (أبو عیسی) (م ٢٧٩ق)، تحقیق: أحمد محمّد شاكر، بیروت: دار إحیاء التراث.
76. السنن الكبری، أحمد بن الحسین البیهقي (م ٤٥٨ق)، تحقیق: محمّد عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١٤ق.
77. السنن الكبری، أحمد بن شعیب النسائي (م ٣٠٣ق)، تحقیق: سلیمان البغدادي وكسروي حسن، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١١ق.
78. شادمانی درونی، مارتن ای پی سلیگمن، ترجمه: مصطفی تبریزی، رامین كریمی و علی نیلوفری، تهران: نشر دانژه، ١٣٨٩ش.
79. شرح نهج البلاغة، عبد الحمید بن محمّد المدائني (ابن أبي الحدید) (م ٦٥٦ق)، تحقیق: أبو الفضل إبراهیم، القاهرة: دار إحیاء الكتب العربیّة، ١٣٨٧ق.
80. شعب الإیمان، أحمد بن الحسین البیهقي (م ٤٥٨ق)، تحقیق: محمّد السعید بسیوني زغلول، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١٠ق.
81. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربیّة)، إسماعیل بن حمّاد الجوهري (م ٣٩٨ ق)، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطّار، بیروت: دار العلم للملایین، ١٣٧٦ق.
82. صحیح ابن حبّان، أبو حاتم محمّد بن حبان البُستي (م 3٥٤ق).
83. صحیح البخاري، محمّد بن إسماعیل البخاري (م ٢٥٦ق)، بیروت: دار الفكر، ١٤٠١ق.
84. صحیح مسلم، مسلم بن الحجّاج القشیري النیسابوري (م ٢٦١ق)، بیروت: دار الفكر.
85. صحیفه سجّادیه، المنسوب إلی الإمام علي بن الحسین عليهالسلام ، تهران: كتاب فروشی اسلامیّه، ١٣٧٥ش.
86. صحیفه نور، امام خمینى، تهران: مركز مدارك فرهنگى، 13٦1ش.
87. الطبقات الكبری، محمّد بن سعد الزُّهري (كاتب الواقدي) (م ٢٣٠ق)، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ١٤١٧ق.
88. عدّة الداعي، أحمد بن محمّد الحلّي الأسدي (ابن فهد) (م ٨٤١ق)، قم: مؤسّسة المعارف الإسلامیّة، ١٤٢٠ق.
89. علل الشرائع، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، النجف، المكتبة الحیدریّة، ١٣٨٦ق.
90. علوم اجتماعی (فصل نامه علمی)، دانشگاه علّامه طباطبایی، حوزه تخصّصی: علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، تاریخ اجتماعی)، تهران.
91. العمّال (كنز العمّال)، علي المتّقي بن حسام الدین الهندي (م ٩٧٥ق)، بیروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤٠٩ق، اوّل.
92. عوالي اللآلي، محمّد بن علي الأحسائي (ابن أبي الجمهور)، تحقیق: مجتبی العراقي، قم: سیّد الشهدا، ١٤٠٣ق.
93. العین، خلیل بن أحمد الفراهیدي (م ١٧٥ق)، قم: مؤسّسة دار الهجرة، ١٤٠٩ق.
94. عیون أخبار الرضاعليهالسلام ، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، تحقیق: السیّد مهدي الحسیني اللاجوردی، تهران: جهان.
95. عیون الحكم والمواعظ، علي بن محمّد اللیثي الواسطي (ق ٦ق)، تحقیق: حسین الحسني البیرجندي، قم: دار الحدیث، ١٣٧٦ش.
96. غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد بن محمّد الآمدي، ترجمه و شرح: آقا جمال خوانساری، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٧٣ش.
97. الغیبة، محمّد بن الحسن الطوسي (الشیخ الطوسي) (م ٤٦٠ق)، تحقیق: عباد اللّٰه الطهراني وعلي أحمد ناصح، قم: مؤسّسة المعارف الإسلامیّة، ١٤١١ق.
98. الفردوس بمأثور الخطاب، شیرویة بن شهردار الدیلمی الهمداني (م ٥٠٩ق)، تحقیق: محمّد السعید بسیوني زغلول، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤٠٦ق.
99. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فصل نامه علمی - پژوهشی)، دانشگاه علّامه طباطبایی، تهران.
100. فرهنگ نامه آرزو، محمّد محمّدی ریشهری، با همكاری سیّد محمّد كاظم طباطبایی، ترجمه: حمید رضا شیخی، قم: دار الحدیث، ١٣٨٥ش.
101. فقه الرضاعليهالسلام ، المنسوب إلی الإمام الرضاعليهالسلام ، تحقیق: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، مشهد: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤٠٦ق.
102. قرب الإسناد، عبد اللّٰه بن جعفر الحمیري القمّي (م بعد از ٣٠٤ق)، قم: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤١٣ق.
103. قصص الأنبیاء، سعید بن هبة اللّٰه الراوندي (قطب الدین الراوندي) (م ٥٧٣ق)، بیروت: مؤسّسة المفید، ١٤٠٩ق.
104. قضاء حقوق المؤمنین، سدید الدین أبو علي بن طاهر الصوري (ق ٦ق)، تحقیق: حامد الخفّاف، بیروت: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤١٠ق.
105. الكافي (دار الحدیث)، محمّد بن یعقوب الكلیني الرازي (م ٣٢٩ق)، تهران: دار الكتب الإسلامیّة، ١٣٦٣ش، پنجم.
106. الكافي، محمّد بن یعقوب الكلیني الرازي (م ٣٢٩ق)، تهران: دار الكتب الإسلامیّة، ١٣٦٣ش، پنجم.
107. كتاب من لا یحضره الفقیه، الفضل بن الحسن الطَّبرِسي (أمین الإسلام) (م ٥٤٨ق)، تهران: فراهاني، ١٣٨١ش.
108. كشف الغمّة، علي بن عیسى الإربلى (م ٦٨٧ق)، تصحیح: سیّد هاشم رسولي، بیروت: دار الكتاب، 1٤01ق.
109. كفایة الأثر فی النصّ على الأئمّة الاثني عشر، علي بن محمّد الخزّار القمّي (ق ٤ق)، تحقیق: السیّد عبد اللطیف الحسیني، قم: بیدار، ١٤٠١ق.
110. كمال الدین وتمام النعمة، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي، ١٤١٢ق.
111. كنز العمّال، علي المتّقي بن حسام الدین الهندي (م ٩٧٥ق)، بیروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤٠٩ق، اوّل.
112. كنز الفوائد، علي المتّقي بن حسام الدین الهندي (م ٩٧٥ق)، بیروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤٠٩ق، اوّل.
113. لسان العرب، محمّد بن مكرّم المصري الأنصاري (ابن منظور) (م ٧١١ق)، قم: أدب الحوزة، ١٤٠٥ق.
114. مبانی و عوامل شادكامی از دیدگاه اسلام با رویكرد روانشناسی
مثبتگرا، عبّاس پسندیده، قم: دانشگاه قرآن و حدیث، 1389ش.
115. مجمع البیان في تفسیر القرآن، الفضل بن الحسن الطَّبرِسي (أمین الإسلام) (م ٥٤٨ ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي، ١٤١٥ق.
116. مجموعه آثار شهید مطهّري، مرتضی مطهّري، تهران: صدرا، ١٣٧٥ش.
117. المحاسن، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي القمّي (م ٢٨٠ق)، تحقیق: مهدي رجائي، قم: المجمع العالمي لأهل البیت عليهمالسلام، ١٤١٣ق.
118. مختصر بصائر الدرجات، سعد بن عبد اللّٰه بن أبي خلف الأشعري (م ٣٠١ق)، اختصار: حسن بن سلیمان الحلّي (ق ٨ق)، قم: الرسول المصطفی.
119. مدارج السالكین، محمّد بن أبي بكر ابن قیّم الجوزیة (م ٧٥١ق)، القاهره: دار الحدیث، ١٤٠١ق.
120. مستدرك الوسائل، میرزا حسین النوري الطَبَرسي (م ١٣٢٠ق)، قم: مؤسّسة آل البیت، ١٤٠٨ق.
121. المستدرك علی الصحیحین، محمّد بن عبد اللّٰه الحاكم النیسابوري (م ٤٠٥ق)، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١١ق.
122. مسكن الفؤاد، زین الدین بن علي الجبعي العاملي (الشهید
الثاني) (م ٩٦٥ق)، قم: مكتبة بصیرتي.
123. مسند ابن حنبل، أحمد بن محمّد الشیباني (ابن حنبل) (م ٢٤١ق)، بیروت: دار صادر.
124. مسند أبي یعلی، أحمد بن علي التمیمي الموصلي (أبو یَعلیٰ) (م ٣٠٧ق)، تحقیق: إرشاد الحق الأثري، جدّه: دار القبلة، ١٤٠٨ق، أوّل.
125. مسند الشامیّین، سلیمان بن أحمد الطبراني (م ٣٦٠ق)، تحقیق: عبد الحمید السلفي، بیروت: مؤسّسة الرسالة، ١٩٨٩م.
126. مسند الشهاب، محمّد بن سلامة (القاضي القضاعي) (م ٤٥٤ق)، بیروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤٠٥ق.
127. مشكاة الأنوار، علي بن الحسن الطِّبرِسي (ق ٧ق)، تحقیق: مهدي هوشمند، قم: دار الثقلین، ١٣٧٨ش.
128. مصباح المتهجّد، محمّد بن الحسن الطوسي (الشیخ الطوسي) (م ٤٦٠ ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي، ١٤٢٥ق.
129. المصباح المنیر، أحمد بن محمّد القیّومي (م ٧٧٠ق)، قم: مؤسّسة دار الهجرة، ١٤١٤ق.
130. المصباح، إبراهیم بن علی الحارثي العاملي (الكفعمي) (م ٩٠٠ق)، بیروت: مؤسّسة الأعلمي، ١٤١٤ق.
131. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم، محمّد بن طلحة
النصیبي الشافعي (م ٦٥٢ق)، تحقیق: ماجد أحمد العطیّة، بیروت: مؤسّسة أُمّ القرى، ١٤٢٠ق.
132. مطالعات روان شناسی (مجلّه بین المللی)، سال ١٠، ش ٣، مركز علوم و آموزش كانادا.
133. معاني الأخبار، محمّد بن علي ابن بابویه القمّي (الشیخ الصدوق) (م ٣٨١ق)، تحقیق: علی أكبر الغفّاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٣٦١ش.
134. المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني
(٣٦٠ق)، تحقیق: طارق بن عوض اللّٰه وعبد الحسن بن إبراهیم الحسیني، القاهره: دار الحرمین، ١٤١٥ق.
135. معجم السفر، أبو نعیم أحمد بن محمّد الإصفهاني (م ٥٧٦ق)، تحقیق: عبد اللّٰه عمر البارودي، بیروت: دار الفكر، 1٤١٤ق.
136. المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني (م ٣٦٠ق)، تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ١٤٠٤ق.
137. معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس الرازي (م ٣٩٥ق)، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤٠٤ق.
138. معدن الجواهر، محمّد بن علي الكراجكي (م ٤٤٩ق)، تحقیق: السیّد أحمد الحسیني، تهران: المكتبة المرتضویّة، ١٣٤٩ق.
139. مفاتیح الجنان، عبّاس القمّي (م 13٥٩ق)، تحقیق: حسین أُستاذ وَلي، قم: منشورات أُمّ أبیها، 1379ش، ششم.
140. مفردات ألفاظ القرآن الكریم، حسین بن محمّد الراغب الإصفهاني (م ٥٠٢ق)، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم، ١٤١٢ق.
141. مقتل الحسین، موفّق بن أحمد المكي الخوارزمي (م ٥٦٨ق)، قم: أنوار الهدی، ١٤١٨ق.
142. مكارم الأخلاق، الفضل بن الحسن الطَّبرِسي (أمین الإسلام) (م ٥٤٨ق)، تهران: فراهانی، ١٣٨١ش.
143. المناقب، الموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي (م ٥٦٨ق)، تحقیق: مالك المحمودي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٤ق.
144. مهج الدعوات، علي بن موسی الحلّي (السیّد ابن طاووس) (م ٦٦٤ق) بیروت: المؤسّسة الإسلامیّة للنشر، ١٤٠٧ق.
145. الموطّأ (التمهید لما في الموطّأ من المعاني والأسانید)، یوسف بن عبد اللّٰه القُرطُبي (ابن عبد البرّ) (م ٤٦٣ق)، تحقیق: مصطفى العلوي ومحمّد عبد الكبیر البكري، جدّه: مكتبة السوادي، 1387ق.
146. المؤمن، حسین بن سعید الكوفي الأهوازي (ق ٣ق)، تحقیق: مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام، قم: مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام، ١٤٠٤ق.
147. میزان الحكمه، با ترجمه فارسی، محمّد محمّدی ری شهری، ترجمه: حمید رضا شیخی، قم: دار الحدیث، ١٣٧٧ش.
148. نثر الدرّ، منصور بن الحسین الآبي (أبو سعید الوزیر) (م ٤٢١ق)، تحقیق: محمّد علي قرنة، القاهره: الهیئة المصریّة العامّة للكتاب.
149. نزهة الناظر، الحسین بن محمّد الحلواني (ق ٥ق)، تحقیق: عبد الهادي مسعودي، قم: دار الحدیث، ١٣٨٣ش.
150. النهایة في غریب الحدیث والأثر، مبارك بن محمّد الجَزَري (ابن الأثیر) (م ٦٠٦ق)، تحقیق: محمّد الطناحي، قم: مؤسّسه اسماعیلیان، ١٣٦٧ ش.
151. نهج البلاغة، جمع وتدوین: محمّد بن الحسین الموسوي (الشریف الرضي) (م ٤٠٦ ق)، شرح: صبحي الصالح، قم: دار الحدیث، ١٤٢٤ ق.
152. نوادر الأصول في معرفة أحادیث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم، محمّد بن علي بن سورة التِّرمِذي (م ٣٢٠ ق)، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیّة، ١٤١٣ ق.
153. النوادر، فضل اللّٰه بن علي الحسنی الراوندي (م ٥٧١ ق)، تحقیق: علي عسكری، قم: دار الحدیث، ١٣٧٧ ش.
154. وسائل الشیعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (م ١١٠٤ ق)، تحقیق: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، قم: مؤسّسة آل البیت عليهمالسلام، ١٤١٤ ق.